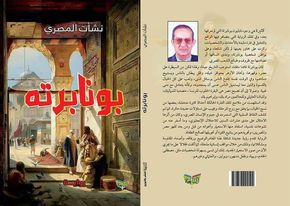الجغرافيا بوجود الإنسان فيها وعليها؛ ينتج عنهما تاريخ، فالتاريخ نتاج فعل الإنسان في الجغرافيا، فلا تاريخ بدون جغرافيا، والإنسان لايمكن أن يعيش إلّا في حيّز جغرافيّ ضئيل من هذا الكون، ولن تتجلّى ذكرياته الجميلة إلّا إذا اقترنت بالجغرافيا، ومن هنا تولدّت فكرة الأوطان، والتعلّق بهان والذّود عن حياضها، واكتسب المفهوم من الأدبيّات التي لا حصر لها، حتى استحقّ إراقة الدم من أجله، وأن الأرض تُعادل العِرْض الذي يستوجب الدفاع عنه من التدنيس.
من هنا من الممكن أن نتفهّم تبرير (محمد صوالحة) وَلَعهُ بالسّفر والتّرحال إلى أماكن مجنونة، أحبّ أن يكون فيها، ويترك هناك ذكرياته المجنونة.
ولماذا الجنون؟.
جاء الجنون بمفردتيْه وَسْمًا للعنوان، مرّة جاء بصيغة المُذكّر للبطل الرّحالة، وأخرى بصيغة المؤنث للمُدُن، ولعلّني أستشفُّ عبارة جاءت على لسان أبي يونس: (يا بنيّ الطريق طويلة، ولا يلزمنا مجانين، لأنّهم قد يُعطلوننا عن مسيرنا، ويقتلون الوقت بأشياء مجنونة).
وجاء الردّ من الأمّ: (وهل لذّة العيش إلّا للمجانين، ليتنا كلّنا نحمل ما يحمل -ابنها- من جنون، أبدًا لا يضيع منه الوقت إلّا في البحث والتأمّل، ومع ذلك فهو في مدرسته لا يُصنّف مع المُتفوّقين، لا ولا يقترب منهم، همّه الحصول على علامة النّجاح، ليُرضيني ويُرضي أباه "هيك خلقه ربّه، شو نسوّي إحنا").
في هذا المقطع أبان لنا الروائي محمد: أن الجنون ما هو إلّا البحث والتأمل في أشياء بعيدة عن منهاج المدرسة، وهو عنده أحد حالات الإبداع، فما بين العقل الإبداعي والنمطيّ إلّا خيط رهيف أقرب إلى حالة الجنون، وعلى هذا يكون الإبداع في أحد أوجهه جنون، لأنه خروج عن النمطيّ والمألوف لدى عامّة النّاس.
يجوز لنا كقرّاء أن نُصنّف كتاب (مذكرات مجنون في مدن مجنون) على أنّه جزء من أدب التّرحال، وهناك نماذج في الأدب العربي (ابن بطّوطة)، و(ابن جبير)، و(محمد أسد) في كتابه (الطّريق إلى مكة)، وفي روح الكتاب هناك تقنيّة القصّ الروائيّ من حوارات مع البطل والأشخاص الذين التقاهم (ديالوج)، والحوار الداخلي للبطل (مونولوج)، ووقفتُ على فصول الكتاب الرواية مُتنقّلًا ما بين الأردنّ (عمّان والسّلط والبتراء)، ومصر والحجاز(المدينة المنوّرة) ودمشق وبيروت وبغداد، والإمارات العربيّة (الشارقة).
ومن هنا جاء إبداع محمد صوالحة في اكتشافه لهذه المدن المجنونة بخصوصيّة تشتهر تمايزًا كلّ واحدة عن الأخرى، ومجنونة باحتلال ذاكرته على مدار سنواته المتباعدة زمانيّا عنه، ثم عودة الوعي بعد ذلك إلى ذاكرته المُتوقدّة في استحضار كلّ هذا الوصف بمشاهده ومناظره الآسرة، ببساطة مُطلَقَة كما عرفتُ بساطة محمد صوالحة في تعامله التلقائيّ بمحبّة ومودّة.
وفي هذا الصّدد، أشارت الأديبة القاصّة (عنان محروس)، كاتبة مقدّمة الكتاب فهي تميل إلى تصنيفه ضمن كتب أدب الرّحلات: (ونعود لمسمّى أدب الرّحلات، فهو مسمّى واسع، فرغم التباين بين ابن بطّوطة، ماركو بولو، تشارلز داروين، أرنست همنجواي، ونجيب محفوظ، إلّا أن الفكرة التي تجمعهم على فكرة الرحلة نفسها زمانيًّا ومكانيًّا ونفسيًّا).
***
وعلى اختلاف هذه العنوانات في الكتاب، فإنها تختلف عن بعضها في المؤدّى والمضمون، غير مرتبطة في سردها القصصيّ بل جاءت فصولًا، جمعتها عنوة دفّتيْ الكتاب الرواية، أدّى تصويرًا جميلًا وبثًّا مباشرًا، نقلنا من خلاله من مواقعنا إلى تلك الأماكن بطريقة محبّبة سلسة بسيطة في سردها الحكائيّ.
ليعود بعد سنوات لاسترجاعها على أنغام أوتار الحنين والشوق لها: (ملعون هذا القلب الذي أحبّ السّفر، وعشق التّرحال، ولم يَجْنِ من فوائده إلّا الذكريات).
استهلّ الكاتب روايته بكلمة (ملعونة)، حينما لعن الدنيا والمال والحياة والقلب، وملعونة هي المسافة أيضًا، ثم ينتقل (للآه) .. التي تكرّرت في موقف تأمليّ عجيب فلسفيٍّ:
(آه ما أضيق العمر لولا فسحة الأمل).
(آه ما أبشع الكلمات، لولا إنها تطرّزت بأسماء النساء، وتوشّحت بقصائد الحب والغزل).
(آه ما أقصر أيّام الإنسان في هذه الدنيا، وما أعسر الحال). هذا القلق البشريّ أمام جبروت الحياة القاسي.
***
وجاء الفصل الأول تحت عنوان (في الفِسْطاط)، وهو بيتٌ يُتّخذ من الشَّعْر والوَبَر (خيمة)، وهو مدينة مصر العتيقة، ليعود بذاكرتنا إلى عصر فتح مصر عام 641م، وحصرًا إلى الصحابيّ الجليل (عمربن العاص) قائد الفتح الذي بنى مدينة الفسطاط على مقربة من حصن بابليون على ساحل النيل من طرفه الشرقيّ، وكان الموقع شماليّ القاهرة.
والعنوان بداية تكريس لاستعادة التاريخ.
ولماذا مصر أوّلًا؟.
فقد جاءت الإجابة واضحة من الكاتب، بتساؤلاته القلقة: (لماذا مصر دون غيرها تراودني عن نفسها، فأجدني أهمّ بها، كما همّت بي؟، لماذا هذا العشق لسيّدة التاريخ، وأمّ الحضارات؟).
وجاء لقاء الطريق مع فاطمة المُسافرة على متن الحافلة التي سافر عليها بطل الرواية، تجلس على الكرسيّ المُحاذي له، وجرى بينهما من المجاملات والتودّد، والتلصّص في استراق نظرات مُتعطّشة اشتهاء متعة الجسد، لحظات تجسّس على بعض مفاتن فاطمة، خاصّة وهي ترضع وليدها، ولم نعرف ما إذا تبادلا هما حالة التلصّص بينهما، وشيطانه الداخليّ هو المحرّك الأساسيّ لاعتداء الحوّاس على الحوّاس.
موضوع مهمّ قطع استغراقه في أوهام أحلامه، عندما وصل إلى مدينة السّويْس، وتذكّره العدوان الثلاثيّ، وبطولة وصمود أهلها في التصدّي:
(في هذه المعركة تجلّت النخوة العربيّة، والبطل العربيّ السوريّ جول جمال، الذي قاوم بطائرته إحدى حاملات الطائرات، ليُخبر العالم بأسره: بأنّ الأرض والانتماء لقدسيّتها هي من تجعمنا، وإن اختلفت طوائفنا وانتماءاتنا).
هذا الشعور القوميّ الطّاغي، والذي ما زال وَهَجَهُ في قلوب هذه الأجيال، ويأبى الكاتب على قارئه إلّا أن يُذكّره بهذا العُدوان، وأن إرادة الشّعوب لا تقهر، هكذا هو منطق التّاريخ الذي توشّح به هذا الكتاب.
***
وكان الوصول للقاهرة والالتقاء بعائلة صديقه، الذي كان عمل في الأردن فيما سبق، ٍولعلّ من الصعب الإفصاح عمّا بداخل النّفوس، لكن الكاتب خالف القاعدة: (أيّ شيطان يسكنُني ويثيرني ويجعلني أُعرّي كلّ ما تسقط عليه عيني، التي لم تترك شيئًا إلّا واقتنصته).
وهذا ما جعله يتلصّص على فاطمة أثناء طريق السّفر، وفيما بعد يتكرّر هذا الأمر مع بنات عائلة صديقه، اللّواتي تعاملن معه بتلقائيّة بسيطه مُفرطة في الثّقة، على أنّه أحد أفراد العائلة، أثناء الجلوس على مائدة الطعام، أو احتساء القهوة والشّاي على الشُّرفة المُطلّة على الشارع، وفي جولاتهم في أماكن عامّة من القاهرة؛ بقصد الزيارة أو التسوّق.
وبين الفيّنة والأخرى يعودُ لمنبته الأصيل: (هل لبدويّتي وتربية أمّي أن تنتصر على شيطاني، أم ستكون لشيطاني كلمة الفصل؟، هل سأتّبع وسوسة هذا الملعون الذي يحتلّني، أم سأكون على قدر الكرم الذي عوملتُ به وأكثر وفاء)، صراع الفضيلة والرذيلة صراع الخير والشرّ، مُحتدم في نفس البطل(أبو صخر)، وما ينتابه لا يعدو أن يبقى في مرحلة الوَسوَسة، والعودة به إلى أصوله البدويّة الشمّاء بشموخها وترفّعها عن الكثير من الدنايا:
(أبحث عن نفسي، فأجدها مكبّلة بقيود شيطاني، ودومًا ما تنقذني بدويّتي).
***
في موقف فريد أثناء زيارتهم لمسجد السيّدة زينب في القاهرة، وتساؤلاته عن سبب تسمية المكان باسمها، ويبيّن السبب، والقارئ لا مفرّ له من مجاراة الكاتب والدّخول معه للمسجد المذكور، من خلال متابعته للوصف الجماليّ للمكان، وأبهائه الروحيّة التي تغرّد بها الأرواح.
وينقل الكاتب لنا صورة واضحة لا لبس فيها، بعين الواقع الذي رآه وعاينه: (في إحدى الزوايا للمسجد هناك شبكٌ حديديٌّ فيه ضريح مغطًى بالقماش الأخضر، وشيء يثير الدّهشة والاستغراب، نسوة ورجال يلتّفون حول الشّبك، يتعلّقون به، ينادون أمّ الأيتام ويدعونها. هذه تطلب منه إزالة الغمّة عنها، وهذه تدعوها لتساعدها على الإنجاب، وآخر إليها، وهو يبكي أن تشفي صغيره).
وهنا يحدث نقاشٌ حادٌّ مع المُشرف على هذا المكان، وهو نقاش قديم متجدّد بين مدرستيْن فكريّتيْن إسلاميّتيْن (السلفيّة والصوفيّة)، وكلٌّ له حجّته في هذا الموضوع، ما بين تقديس وتعظيم، وأخرى مناقضة بتحريم وتكفير، ذلك لأنّه شرك ظاهر في الأفعال والأقوال.
وفي فكرة أخرى: (أنا في القاهرة، قاهرة المعزّ لدين الله الفاطميّ، أنا في فسطاط عمرو بن العاص، أنا في أرض الفراعنة، أنا في البلاد التي هاجر منها نبيّ بني إسرائيل - قاتلًا لبلادي-، ليعود إليها نبيًّا ورسولا، على هذه الأرض تلقّفت عا موسى أفاعي السّحرة، وأبطلت كيدهم، هنا ولد موسى عليه السّلام، وهنا تبنّته حتشبسوت، من هنا طرد بني إسرائيل. وهنا تحالفت مصر الفرعونيّة مع مملكة الأنباط العربيّة، هنا لَثَغَ التّاريخ حروفه الأولى وانطلق إلى الدنيا... إلخ).
هذه مصر أمّ الدّنيا، يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، منها انطلقت الفتوحات والانتصارات، وفي جولاته اللّاحقة في مدينة تجلّت الدنيا بها. وتعود بي الذّاكرة إلى خماسيّة الكاتب (أسامة أنور عكاشة) إلى (ليالي الحلميّة)، المسلسل الرائع الذي تابعه مئات الملايين من العرب، وهم يتشمّمون فيه رائحة أسواق القاهرة، مسجد الحسين، والموسكي، وسور الأزبكيّة، وباب زويلة، وقلعة صلاح الدين، وميدان التحرير، والفراعنة، والعرب، والمماليك، وألبان محمد علي باشا وعهود ذريّته من بعده الملكيّة الخديويّة، والثورة وما استتبعها، القاهرة حكاية الكون أجمع.
وهذا ما أفصحت عنه روايات (نجيب محفوظ)، (بين القصرين، قصر الشوق، والموسكي)، وغيرها التي شرحت الكثير عن دقائق الحياة في شوارع وأزقّة وحواري المدينة النّابضة.
وكما قيل: (مصر هبة النّيل)، فهو الرّوح التي أقامت الحياة على أرض مباركة ذكرها القرآن الكريم: (اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين)، وهو متنفّس لأهلها، ومصدر رزق، ومقام يسكنونه على متن طوّافات راسية على شواطئه.
وهنا أتوقّف أمام هذا النّهر العظيم، وأنا أردّد مع (محمد عبد الوهّاب)، قصيدة (النهر الخالد) للشاعر (أحمد حسن إسماعيل)، وتتجلّى القصيدة ببهائها في الخاتمة: ( آه على سرّك الرّهيب، وموجك التّائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب).
وللإسكندريّة وبهائها نصيب من مذكّرات الكتاب، وهو يغوص في خصوصيّتها التاريخيّة والحاليّة.
وللمجنون مُبرّر أن يبقى مجنونًا مدى حياته، وهو غارق بجنون هذه المدن النابضة بالحياة، رغم نوائب الدّهر والحروب والنّكبات والنّكسات، ذهب الغزاة والطغاة والخونة والمارقون إلى مزبلة التّاريخ، وبقيت ذكرى همجيّتهم بصورتهم القاتمة السوداء.
وستبقى مصر أصالة العرب بأزهرها، وقبطيّتها الأرثوكسيّة الحريصة على الوحدة الوطنية، كما (الأب شنودة)، و(ميلاد حنّا).
عمّان \ الأردن
21-6-2018
من هنا من الممكن أن نتفهّم تبرير (محمد صوالحة) وَلَعهُ بالسّفر والتّرحال إلى أماكن مجنونة، أحبّ أن يكون فيها، ويترك هناك ذكرياته المجنونة.
ولماذا الجنون؟.
جاء الجنون بمفردتيْه وَسْمًا للعنوان، مرّة جاء بصيغة المُذكّر للبطل الرّحالة، وأخرى بصيغة المؤنث للمُدُن، ولعلّني أستشفُّ عبارة جاءت على لسان أبي يونس: (يا بنيّ الطريق طويلة، ولا يلزمنا مجانين، لأنّهم قد يُعطلوننا عن مسيرنا، ويقتلون الوقت بأشياء مجنونة).
وجاء الردّ من الأمّ: (وهل لذّة العيش إلّا للمجانين، ليتنا كلّنا نحمل ما يحمل -ابنها- من جنون، أبدًا لا يضيع منه الوقت إلّا في البحث والتأمّل، ومع ذلك فهو في مدرسته لا يُصنّف مع المُتفوّقين، لا ولا يقترب منهم، همّه الحصول على علامة النّجاح، ليُرضيني ويُرضي أباه "هيك خلقه ربّه، شو نسوّي إحنا").
في هذا المقطع أبان لنا الروائي محمد: أن الجنون ما هو إلّا البحث والتأمل في أشياء بعيدة عن منهاج المدرسة، وهو عنده أحد حالات الإبداع، فما بين العقل الإبداعي والنمطيّ إلّا خيط رهيف أقرب إلى حالة الجنون، وعلى هذا يكون الإبداع في أحد أوجهه جنون، لأنه خروج عن النمطيّ والمألوف لدى عامّة النّاس.
يجوز لنا كقرّاء أن نُصنّف كتاب (مذكرات مجنون في مدن مجنون) على أنّه جزء من أدب التّرحال، وهناك نماذج في الأدب العربي (ابن بطّوطة)، و(ابن جبير)، و(محمد أسد) في كتابه (الطّريق إلى مكة)، وفي روح الكتاب هناك تقنيّة القصّ الروائيّ من حوارات مع البطل والأشخاص الذين التقاهم (ديالوج)، والحوار الداخلي للبطل (مونولوج)، ووقفتُ على فصول الكتاب الرواية مُتنقّلًا ما بين الأردنّ (عمّان والسّلط والبتراء)، ومصر والحجاز(المدينة المنوّرة) ودمشق وبيروت وبغداد، والإمارات العربيّة (الشارقة).
ومن هنا جاء إبداع محمد صوالحة في اكتشافه لهذه المدن المجنونة بخصوصيّة تشتهر تمايزًا كلّ واحدة عن الأخرى، ومجنونة باحتلال ذاكرته على مدار سنواته المتباعدة زمانيّا عنه، ثم عودة الوعي بعد ذلك إلى ذاكرته المُتوقدّة في استحضار كلّ هذا الوصف بمشاهده ومناظره الآسرة، ببساطة مُطلَقَة كما عرفتُ بساطة محمد صوالحة في تعامله التلقائيّ بمحبّة ومودّة.
وفي هذا الصّدد، أشارت الأديبة القاصّة (عنان محروس)، كاتبة مقدّمة الكتاب فهي تميل إلى تصنيفه ضمن كتب أدب الرّحلات: (ونعود لمسمّى أدب الرّحلات، فهو مسمّى واسع، فرغم التباين بين ابن بطّوطة، ماركو بولو، تشارلز داروين، أرنست همنجواي، ونجيب محفوظ، إلّا أن الفكرة التي تجمعهم على فكرة الرحلة نفسها زمانيًّا ومكانيًّا ونفسيًّا).
***
وعلى اختلاف هذه العنوانات في الكتاب، فإنها تختلف عن بعضها في المؤدّى والمضمون، غير مرتبطة في سردها القصصيّ بل جاءت فصولًا، جمعتها عنوة دفّتيْ الكتاب الرواية، أدّى تصويرًا جميلًا وبثًّا مباشرًا، نقلنا من خلاله من مواقعنا إلى تلك الأماكن بطريقة محبّبة سلسة بسيطة في سردها الحكائيّ.
ليعود بعد سنوات لاسترجاعها على أنغام أوتار الحنين والشوق لها: (ملعون هذا القلب الذي أحبّ السّفر، وعشق التّرحال، ولم يَجْنِ من فوائده إلّا الذكريات).
استهلّ الكاتب روايته بكلمة (ملعونة)، حينما لعن الدنيا والمال والحياة والقلب، وملعونة هي المسافة أيضًا، ثم ينتقل (للآه) .. التي تكرّرت في موقف تأمليّ عجيب فلسفيٍّ:
(آه ما أضيق العمر لولا فسحة الأمل).
(آه ما أبشع الكلمات، لولا إنها تطرّزت بأسماء النساء، وتوشّحت بقصائد الحب والغزل).
(آه ما أقصر أيّام الإنسان في هذه الدنيا، وما أعسر الحال). هذا القلق البشريّ أمام جبروت الحياة القاسي.
***
وجاء الفصل الأول تحت عنوان (في الفِسْطاط)، وهو بيتٌ يُتّخذ من الشَّعْر والوَبَر (خيمة)، وهو مدينة مصر العتيقة، ليعود بذاكرتنا إلى عصر فتح مصر عام 641م، وحصرًا إلى الصحابيّ الجليل (عمربن العاص) قائد الفتح الذي بنى مدينة الفسطاط على مقربة من حصن بابليون على ساحل النيل من طرفه الشرقيّ، وكان الموقع شماليّ القاهرة.
والعنوان بداية تكريس لاستعادة التاريخ.
ولماذا مصر أوّلًا؟.
فقد جاءت الإجابة واضحة من الكاتب، بتساؤلاته القلقة: (لماذا مصر دون غيرها تراودني عن نفسها، فأجدني أهمّ بها، كما همّت بي؟، لماذا هذا العشق لسيّدة التاريخ، وأمّ الحضارات؟).
وجاء لقاء الطريق مع فاطمة المُسافرة على متن الحافلة التي سافر عليها بطل الرواية، تجلس على الكرسيّ المُحاذي له، وجرى بينهما من المجاملات والتودّد، والتلصّص في استراق نظرات مُتعطّشة اشتهاء متعة الجسد، لحظات تجسّس على بعض مفاتن فاطمة، خاصّة وهي ترضع وليدها، ولم نعرف ما إذا تبادلا هما حالة التلصّص بينهما، وشيطانه الداخليّ هو المحرّك الأساسيّ لاعتداء الحوّاس على الحوّاس.
موضوع مهمّ قطع استغراقه في أوهام أحلامه، عندما وصل إلى مدينة السّويْس، وتذكّره العدوان الثلاثيّ، وبطولة وصمود أهلها في التصدّي:
(في هذه المعركة تجلّت النخوة العربيّة، والبطل العربيّ السوريّ جول جمال، الذي قاوم بطائرته إحدى حاملات الطائرات، ليُخبر العالم بأسره: بأنّ الأرض والانتماء لقدسيّتها هي من تجعمنا، وإن اختلفت طوائفنا وانتماءاتنا).
هذا الشعور القوميّ الطّاغي، والذي ما زال وَهَجَهُ في قلوب هذه الأجيال، ويأبى الكاتب على قارئه إلّا أن يُذكّره بهذا العُدوان، وأن إرادة الشّعوب لا تقهر، هكذا هو منطق التّاريخ الذي توشّح به هذا الكتاب.
***
وكان الوصول للقاهرة والالتقاء بعائلة صديقه، الذي كان عمل في الأردن فيما سبق، ٍولعلّ من الصعب الإفصاح عمّا بداخل النّفوس، لكن الكاتب خالف القاعدة: (أيّ شيطان يسكنُني ويثيرني ويجعلني أُعرّي كلّ ما تسقط عليه عيني، التي لم تترك شيئًا إلّا واقتنصته).
وهذا ما جعله يتلصّص على فاطمة أثناء طريق السّفر، وفيما بعد يتكرّر هذا الأمر مع بنات عائلة صديقه، اللّواتي تعاملن معه بتلقائيّة بسيطه مُفرطة في الثّقة، على أنّه أحد أفراد العائلة، أثناء الجلوس على مائدة الطعام، أو احتساء القهوة والشّاي على الشُّرفة المُطلّة على الشارع، وفي جولاتهم في أماكن عامّة من القاهرة؛ بقصد الزيارة أو التسوّق.
وبين الفيّنة والأخرى يعودُ لمنبته الأصيل: (هل لبدويّتي وتربية أمّي أن تنتصر على شيطاني، أم ستكون لشيطاني كلمة الفصل؟، هل سأتّبع وسوسة هذا الملعون الذي يحتلّني، أم سأكون على قدر الكرم الذي عوملتُ به وأكثر وفاء)، صراع الفضيلة والرذيلة صراع الخير والشرّ، مُحتدم في نفس البطل(أبو صخر)، وما ينتابه لا يعدو أن يبقى في مرحلة الوَسوَسة، والعودة به إلى أصوله البدويّة الشمّاء بشموخها وترفّعها عن الكثير من الدنايا:
(أبحث عن نفسي، فأجدها مكبّلة بقيود شيطاني، ودومًا ما تنقذني بدويّتي).
***
في موقف فريد أثناء زيارتهم لمسجد السيّدة زينب في القاهرة، وتساؤلاته عن سبب تسمية المكان باسمها، ويبيّن السبب، والقارئ لا مفرّ له من مجاراة الكاتب والدّخول معه للمسجد المذكور، من خلال متابعته للوصف الجماليّ للمكان، وأبهائه الروحيّة التي تغرّد بها الأرواح.
وينقل الكاتب لنا صورة واضحة لا لبس فيها، بعين الواقع الذي رآه وعاينه: (في إحدى الزوايا للمسجد هناك شبكٌ حديديٌّ فيه ضريح مغطًى بالقماش الأخضر، وشيء يثير الدّهشة والاستغراب، نسوة ورجال يلتّفون حول الشّبك، يتعلّقون به، ينادون أمّ الأيتام ويدعونها. هذه تطلب منه إزالة الغمّة عنها، وهذه تدعوها لتساعدها على الإنجاب، وآخر إليها، وهو يبكي أن تشفي صغيره).
وهنا يحدث نقاشٌ حادٌّ مع المُشرف على هذا المكان، وهو نقاش قديم متجدّد بين مدرستيْن فكريّتيْن إسلاميّتيْن (السلفيّة والصوفيّة)، وكلٌّ له حجّته في هذا الموضوع، ما بين تقديس وتعظيم، وأخرى مناقضة بتحريم وتكفير، ذلك لأنّه شرك ظاهر في الأفعال والأقوال.
وفي فكرة أخرى: (أنا في القاهرة، قاهرة المعزّ لدين الله الفاطميّ، أنا في فسطاط عمرو بن العاص، أنا في أرض الفراعنة، أنا في البلاد التي هاجر منها نبيّ بني إسرائيل - قاتلًا لبلادي-، ليعود إليها نبيًّا ورسولا، على هذه الأرض تلقّفت عا موسى أفاعي السّحرة، وأبطلت كيدهم، هنا ولد موسى عليه السّلام، وهنا تبنّته حتشبسوت، من هنا طرد بني إسرائيل. وهنا تحالفت مصر الفرعونيّة مع مملكة الأنباط العربيّة، هنا لَثَغَ التّاريخ حروفه الأولى وانطلق إلى الدنيا... إلخ).
هذه مصر أمّ الدّنيا، يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، منها انطلقت الفتوحات والانتصارات، وفي جولاته اللّاحقة في مدينة تجلّت الدنيا بها. وتعود بي الذّاكرة إلى خماسيّة الكاتب (أسامة أنور عكاشة) إلى (ليالي الحلميّة)، المسلسل الرائع الذي تابعه مئات الملايين من العرب، وهم يتشمّمون فيه رائحة أسواق القاهرة، مسجد الحسين، والموسكي، وسور الأزبكيّة، وباب زويلة، وقلعة صلاح الدين، وميدان التحرير، والفراعنة، والعرب، والمماليك، وألبان محمد علي باشا وعهود ذريّته من بعده الملكيّة الخديويّة، والثورة وما استتبعها، القاهرة حكاية الكون أجمع.
وهذا ما أفصحت عنه روايات (نجيب محفوظ)، (بين القصرين، قصر الشوق، والموسكي)، وغيرها التي شرحت الكثير عن دقائق الحياة في شوارع وأزقّة وحواري المدينة النّابضة.
وكما قيل: (مصر هبة النّيل)، فهو الرّوح التي أقامت الحياة على أرض مباركة ذكرها القرآن الكريم: (اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين)، وهو متنفّس لأهلها، ومصدر رزق، ومقام يسكنونه على متن طوّافات راسية على شواطئه.
وهنا أتوقّف أمام هذا النّهر العظيم، وأنا أردّد مع (محمد عبد الوهّاب)، قصيدة (النهر الخالد) للشاعر (أحمد حسن إسماعيل)، وتتجلّى القصيدة ببهائها في الخاتمة: ( آه على سرّك الرّهيب، وموجك التّائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب).
وللإسكندريّة وبهائها نصيب من مذكّرات الكتاب، وهو يغوص في خصوصيّتها التاريخيّة والحاليّة.
وللمجنون مُبرّر أن يبقى مجنونًا مدى حياته، وهو غارق بجنون هذه المدن النابضة بالحياة، رغم نوائب الدّهر والحروب والنّكبات والنّكسات، ذهب الغزاة والطغاة والخونة والمارقون إلى مزبلة التّاريخ، وبقيت ذكرى همجيّتهم بصورتهم القاتمة السوداء.
وستبقى مصر أصالة العرب بأزهرها، وقبطيّتها الأرثوكسيّة الحريصة على الوحدة الوطنية، كما (الأب شنودة)، و(ميلاد حنّا).
عمّان \ الأردن
21-6-2018