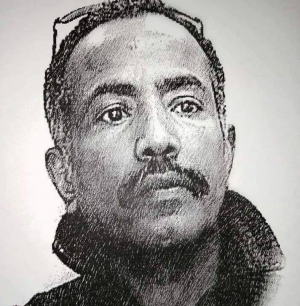[أرى قِدمي أراقَ دمي]
السهروردي
كنا نسير، الواحد خلف الآخر، في طابور طويل، تدفعنا إرادة مبهمة. التصنيف والاستقراء، تركناه للجهاز الذي يحمله من يتقدمنا في هذا الطابور، كان قائدنا، لا غرو فهو الوحيد الذي ينتمي وبانسجام منمَّق إلى المؤسسة العسكرية.
يمدّ كلٌّ منّا قامة انهدَّ عاتقها رهقاً، ضَمُرَت لحائمُها من فرط الجوع والأحمال الثقيلة، ليس ثمة فرائس نصطادها، تردم هوة جوعنا، أزيز الرصاص المتَّصل طوال العام يجعل تلك الفرائس تغادر إلى أماكن أكثر أماناً.
كلٌّ يشحذ قدميه حماساً قسرياً، ويوعز لهما بالتقدم، وإلا فالموت متربِّص من كل حدب.
على غضون الجميع أسئلةٌ حيرى، وخذلان عارم بالدواخل، يلفنا صمت قاسٍ، لا تنشّزه إلا دعسات أحذيتنا العسكرية الثقيلة، وهي تطأ الأعشاب الدغلية في دواسها المتلاحق.
من حولنا، تمازجت روائح جثث متعفنة، بروائح أجسادنا المتَّسخة منذ شهر أو يزيد. فالنهر بمحاذاتنا، ولكن التعليمات الصارمة تحذِّر من خطورة الاقتراب، فالألغام في كل مكان.
يأمرنا القائد بالتوقف، وعلى صفحة وجهه الداكنةِ ظِلُّ رهقٍ مكتوم، يقرر بثقة وأناة، أن لدينا ساعة واحدة فقط للراحة.
يتفرق جمعنا الصغير متناثراً، كلٌّ ينشد الراحة والاسترخاء، كانت الساعات تعبر ونحن نسير، وها هي قد عبرت عشر مرات حين قرر قائدنا التوقف.
كنت أحس بأن مثانتي ستنفجر لو أبقيتها أكثر من ذلك دقيقة واحدة، ولم أفرغها من محتواها السائل.
أرمق ساعتي، أجدها الواحدة بعد الظهر، بعزيمة خائرة أحيد عن أفراد المجموعة قليلاً، بغية قضاء تلك الحاجة البغيضة.
أطأ الأوراق الجافة، أسمع خشخشتها وتكسرها تحت البوت الثقيل، يعجبني أنينها، أتمنى لو أنني لم أتوقف، أصل النقطة التي أريد، أسحب (سوستة) البنطال، أحبذ لو أقضي حاجتي جالساً.
اندفاع البول بقوة واصطدامه بالأرض، يجعله يسيل حثيثاً باتجاه قدمي اليمنى، بينما رذاذه المتطاير يكاد يصيب وجهي، أميل برأسي تجاه اليسار، ساحباً قدمي اليمنى إلى الوراء، لأدع انزياح هذا السائل الحامض يزحف كيف يشاء، متواطئاً مع صوت ارتطامه المصطخب تحت الرغوة البيضاء، التي تعلو كقبة من الزبد.
أحس بقدمي اليمنى قد وطأت شيئاً ما، كما لو أنّه مسمار معقوف، أسمع صوتاً غريباً تحت البوت، صوتاً أشبه بطقطقة رتاج قديم.
أرمي نظرة جزعة باتجاه الصوت، أجد نفسي، وبرغم الحذر والتيقُّظ، قد وقعت في المحظور.
وطأت اللغم اللعين، كل ذلك بسبب هذه المثانة الرعناء، تختلط أحاسيسي، وتنصهر بذاكرتي الجرباء، أخيلة وأطياف عدّة، يتداخل الأمس والغد في طاحونة اليوم، التي ستدور تروسها الشرسة بعد حين، لو قمت بتحريك قدمي المتورطة، ولو جزءاً من الملميتر.
يزداد وجيف قلبي، أكاد أسمع نبضاته كأنها دقات طبول بعيدة، بصوت مبحوح كأنه احتكاك أخشاب جافة، أنادي، يهبّ الجميع بجزع تحت عفوية التنبيه، وخبث الإثارة.
الذاكرة لوحة بيضاء، أنهض متشنجاً، يأخذني لهاث شديد، أكابد أحزاني، أجول ببصري في الفراغ، الشمس تنعكس طافية على سطح النهر، يتكرر قيظ النهارات الفائتة، ينفطر فجأة، كقنبلة يدوية عتيقة، أنادي بصوت ملتاع واهن كعشب يابس، يبزغ طيف أمي، تنز عيناي بدمع سخين، ينضح عرق مالح يغمر جسدي، أتساءل بحزن: كيف انخرطت خطاي، وانفرط توازنها لتنغرس هنا؟
كيف انزلقت في فخ الموت المفزع؟
أين قذفت بالتعليمات والأوامر؟
يعتريهم اضطراب بالغ، وجوههم الشاحبة المتسخة ارتعبت من هول الصدمة المباغتة، خِلْجَان العرق على سحناتهم الداكنة يلسعني رثاؤها المستسلم لعدم الحيلة، يهرعون نحوي، مأخوذين بذهول شاسع، لوثة حزن ماحقة تطلّ من أعينهم المترقرقة بدمع نبيل، تسقط نظراتهم التعبة على هيئتي التي تتجاسر تحت عطبها المحتمل.
يهرع القائد باتجاهي، يحث الجميع على عدم الاقتراب، والتزام الحيطة والحذر، يركن إلى خوف طفيف، وارتباك سببه جسامة المسؤولية، وارتخاء انضباطنا، وعدم اتباعنا للأوامر، الشيء الذي يجعل العواقب الوخيمة تتربص بنا.
بصوته الممتقع، ونبراته المفككة في محيط ارتجافها، يأمر بمزج الطين، يلتقط بعضهم الإشارة، يشرعون في سكب الماء من (زمزمياتهم) بغية تنفيذ الأوامر على جناح السرعة.
يبدأ بإحاطة قدمي اليمنى بالطين، كانت لحظة بطيئة، يمر الوقت ثقيلاً، يأمر بمزيد من الطين، ملامح البوت اختفت، مثلما اختفت ساقي تحت لزوجة الوحل، أحسها كأنها ليست ساقي•
يتساءل البعض:
- لماذا الطين أيها القائد؟
يقول:
- حتى تبدو القدم راسخة دون حراك، ربما ستطول وقفته.
- أحس بظمأ حارق أيها القائد، أريد بعض الماء أطفئ به هذا الحريق.
- ليس بعد، تجلد قليلاً، عسانا نعبر هذه المحنة بسلام، أو بأقل خسائر ممكنة.
هكذا رد عليّ، وطفق يبسط كفيه الملطختين بالطين، إعلاناً لانتهاء المهمة الأولى في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
رديم الوحل يبدو كتلٍّ صغير، يبتلع يمناي المستسلمة لمصير ضالع في غموضه، طاعن في جفافه المستدير المدبَّب.
أسمعه يهمس بكلمات مبهمة، كآبة كبيرة تسكن أعماقي، وتجعل محاولة الإمساك بسر اللحظات القادمة أمراً شديد الصعوبة، أجيل بصري في المدى البعيد، ثمة أسراب من طيور تخفق خفيفة، تختفي خلف غيمات بعيدة شاحبة، خواء شاسع يتملك روحي، وثمة ريح لافحة تصلي وجهي، أطبق أجفاني على مهل، خاضعاً للحظة يأس خانقة، ثم افتحهما، فتفزعني نظرات الترقب الساكنة على محاجر الجميع.
أحاول تذكُّر الساعات الجميلة التي مرت على حياتي، عساني أسلّي نفسي، فيتقاطع عليَّ خاطري ويطفر شبح جارنا الذي دفعني إلى هذا الجحيم المرعب، بغية التخلص مني وإبعادي، حتى يتسنى له تنفيذ مراميه الشاذة بالزواج من شقيقتي ذات العشرين عاماً كزوجة ثالثة، يدفن على صدرها الصبي خيباته المتتالية، ويضيء بها عتمة أيامه القليلة الباقية.
إمامته للمصلين لم تشفع لتلاعبه بحليب الأطفال المغشوش الفاسد.
ورعه المصطنع لا يستطيع قبر سيرته المتعفنة القذرة، ولا يمحو علاقاته بشخوص يشوبهم القيل والقال. تملّقه وتزلّفه لشخصيات نافذة في مواقع القرار أعطاه الفرصة ليكون عيناً راصدة، ويداً باطشة لمصلحة جهة ما، لا يستطيع أحد البوح باسمها علناً.
قبل موت أبي لم يستطع حتى الاقتراب من باب منزلنا، كان أبي يقول عنه إنه أتفه من مشى على الأرض.
حذرته بأنني سأغرز أصابعي في عينيه إن هو تطفل علينا مرة أخرى طالباً يد شقيقتي، وعندما أيقن أنني صادق في ما أقول، رشقني بنظرة حارقة، تستبطن ما تستبطن من تهديد.
بعد ثلاثة أيام طرقوا بابنا، فتحت الباب، وجدتهم؛ مجموعة من العسكر، غارقين في بزاتهم الكاكية، لم أتبين عددهم، جميعهم مسلحون، اقتلعوني اقتلاعاً من أمام منزلنا، قذفوا بي في جوف سيارة محكمة الإغلاق، تلقتني وجوه من هم مثلي، لا حيلة لهم سوى النظر بعيون زائغة وخوف مصلوب على الجوانح، اقتلعوني هكذا، عنوة واقتداراً، وكان ما كان.
يتخلّص من الطين على يديه، يكفكف كمي قميصه المتسخ، يدور حولي بحرص، وهو يطوّف بالجهاز متحسّساً النقطة التي سيبدأ منها المرحلة التالية.
يشرع بحفر مساحة صغيرة بأظافره المدببة على الأرض قرب قدمي المتورطة، يتعرى اللغم قليلاً، يحدد موقع الفتيل، ألمحه وهو منكفئ، وقد تبلل ظهره بالعرق، والتصق القميص بجسده الناحل، كما لو أن غرَّاءً ماهراً قام بإلصاقه هكذا.
تنفتح شاشة الذاكرة مرة أخرى، يظهر فيها طفل بالغ الشقاوة، ذلك الطفل الذي كنته، يتحسس علاقاته بالأشياء برعونة غير محتملة، وبتحدٍّ صبياني.
كان النجار الذي اصطحبه أبي لترميم الدولاب العتيق، قد استجلب معه علبةً بيضاء، كنت شغوفاً بمعرفة محتوى هذه العلبة، أتحيّن الفرص لسبر كنه ما بداخلها.
لسبب ما، يخرج النجار، أفتح العلبة، يتلقاني الغراء الأبيض كالحليب، أرفع العلبة إلى أعلى، أفرغ ربع محتواها في جوفي الذي ما كان له أن يتسع لولا شهوتي التي تتعرّم أمام بياض الحليب، ونكهته التي لا تقاوم، أكرع الجرعة تلو الأخرى، بحثاً عن الطعم الغائب.
يلمحني النجار من خلال الباب المفتوح، يهرع نحوي، ينتزع العلبة، يتلجلج، يصاب بارتباك، يصرخ، يهذي، يبكي، تهرع أمي بخطىً واسعة، يلفني غثيان ماحق، تحيطني دوامة من الدوار، يتصبب العرق، تغيم الدنيا أمام ناظري أحسّني أهوي في لبّ بئر لا قرار لها، أطيح على وجهي، وعندما أفيق أجد نفسي ممداً داخل غرفة الطبيب، وأمي المسكينة يسيل نهر دموعها دون توقف، بينما أبي انتصب بقامته المديدة قرب رأسي، يرمقني بأسىً، والطبيب يغمغم بكلمات الاطمئنان وزوال الخطر مهدئًا من روع الجميع.
عندما أتماثل للشفاء سيصلبني أبي تحت شمس نصائحه التي لا تنتهي.
يعود من انكفاءته، يتقطّر العرق من جبينه المقطّب، يمسح بكفه المعروقة العريضة على وجهٍ عرّش عليه حزن عميق، يتلفت حوله بوهن ضالع، لا يجد إلا الحيرة على وجوه الجميع.
أحس بخدر طفيف يتسلق ساقي المتوحلة، كأن الأوعية الدموية تجمدت هي الأخرى، وتوقفت عن فاعليتها.
أتراني سأنجو، وأنام ملء جفني هذه الليلة مباعداً بين ساقي حسب التعليمات والأوامر تجنباً لأي طارئ تفعله هوام الأرض الزاحفة؟ أم أنها المرة الأخيرة التي أرى فيها ساقي وهي متصلة بجسدي المنهدم؟ أتراني سأنجو بهذا الحد الأدنى؟ أم ستنقصف روحي وإلى الأبد؟
أتآكل ببطء في انتظار النتيجة المؤجلة، أحاول التواؤم مع ما هو قادم، رغم مرارته وغموضه الذي سيتكشف بدوي منتظر، تتطاير عقبه الأشلاء في الآفاق كلها.
لم تكن مهمتنا صعبة، حين تم اختيارنا قبل شهر أو يزيد، كنا مجموعة من المجندين، أغلبنا طلاب على أعتاب المرحلة الجامعية، تم اصطيادنا بطرق مختلفة، وبعد تدريب قصير تم ترحيلنا ليلاً، مشمولين بحراسة مشدّدة، تخوفاً من هروب جماعي أو فردي ينفّذ في أي لحظة، نجد أنفسنا داخل الطائرة العسكرية الكالحة، نحلق عالياً، وبعد ساعة تهبط بنا في موقع عسكري وسط غابة كثيفة الأشجار، ننزلق خارج السمكة الحديدية الطائرة، يستقبلنا الجنود بمشاعر محايدة، لا يمكن تحديد اتجاهاتها، تتملص أسماؤنا عنا، أو بالأحرى تُنزع بصلف عسكري غريب، لتحل محلها (مجند رقم كذا).
يتم التسليم والتسلّم، تقلع الطائرة، آخر مظاهر الحياة تختفي مع اختفاء الطائرة وانقطاع أزيزها المضطرد.
يتسلمنا الجندي الذي سيتولى أمرنا طويلاً بعد ذلك، يرحب بنا باقتضاب، يلقي على مسامعنا الأوامر التي يجب علينا اتباعها، يحدد لنا مهامنا بلا مواربة، يقول إنها غير صعبة إذا ما التزمنا اتباع الأوامر والتعليمات.
علينا اجتياز طرقات كثيرة بمحاذاة النهر، لتحديد طرق خالية من الألغام، نقوم بوضع علامات متفق عليها تعلن أن المكان ينعم بالأمن، هذه المهمة تبدأ منذ اللحظة وتستمر إلى أجل غير مسمى.
في جنح الظلام نتحرك، تحت إمرة قائدنا الجديد، جهاز الكشف عن الألغام تحت رعاية القائد، وهو الوحيد الذي يستطيع تشغيله ليس غيره، فالكل لم ير في حياته مثل تلك الأجهزة.
يشير إلى الزملاء بتوخي الحذر، بالانبطاح خلف سواتر واقية، أوقن أن اللحظة الحاسمة أوشكت على بيانها، قشعريرة عارمة تلامس أعصابي، تتقلص أمعائي على نفسها، أحس كما لو أن حجراً مكوّراً سكن أحشائي.
أشعر بسخونة سائلة على فخذي، ألقي نظرة، أجدني قد تبوّلت على نفسي دون إرادة.
يحفر حفرة عميقة كلحد، يتخندق فيها، يأمرني بصوت واهن أن أتبع الأوامر بدقة، وأنه سيعد حتى الرقم ثلاثة، وبعدها عليَّ أن أميل بجسمي إلى اليسار، متخذاً وضع القوس، مع الحفاظ على رسوخ قدمي المتورمة في وحلها الذي أوشك على الجفاف.
أدرك أنه قرر بتر ساقي، كحد أدنى من جوف الفجيعة المحدقة، يتجمع رعب القرون كلها على صدري، أميل بسرعة، ثم يسحب الفتيل.
يتجلجل دوي فخيم، يصم أذني ويرجّ المكان كله، يندغم صوت زغرودة نسوية تنطلق في نفس اللحظة في مكان ما من هذا العالم.
أفيق بعد ثلاثة أيام، أجد نفسي ممدداً على سرير متآكل الأطراف، مهدّل الأعماق، داخل المستشفى العسكري في المدينة الحدودية التي لم أسمع باسمها ولو لمرة واحدة في حياتي، وعلى وجه مطببي شبح ابتسامة مصطنعة، يهدئ بها روعي، ثم يدس في كفي ورقة صغيرة مطوية بحرص، أفضها تحت طنين أذنيّ الذي لا ينقطع، أقرأ فيها:
"إنه في الساعة الواحدة بعد الظهر، من اليوم الثالث في هذا الشهر، تم زفاف شقيقتك كزوجة ثالثة على سنة الله ورسوله إلى كنف جاركم العزيز فلان ابن فلان... مبروك.
وشكراً
التوقيع/ مجهول"
أرمق التقويم السنوي على الجدار متآكل الجوانب، والملطخ بالأوساخ، أجد أن تاريخ اليوم هو السادس من نفس الشهر.
أتقيأ أمعائي، وينزف جرحي باضطراد.
* كاتب قصّة من السودان
السهروردي
كنا نسير، الواحد خلف الآخر، في طابور طويل، تدفعنا إرادة مبهمة. التصنيف والاستقراء، تركناه للجهاز الذي يحمله من يتقدمنا في هذا الطابور، كان قائدنا، لا غرو فهو الوحيد الذي ينتمي وبانسجام منمَّق إلى المؤسسة العسكرية.
يمدّ كلٌّ منّا قامة انهدَّ عاتقها رهقاً، ضَمُرَت لحائمُها من فرط الجوع والأحمال الثقيلة، ليس ثمة فرائس نصطادها، تردم هوة جوعنا، أزيز الرصاص المتَّصل طوال العام يجعل تلك الفرائس تغادر إلى أماكن أكثر أماناً.
كلٌّ يشحذ قدميه حماساً قسرياً، ويوعز لهما بالتقدم، وإلا فالموت متربِّص من كل حدب.
على غضون الجميع أسئلةٌ حيرى، وخذلان عارم بالدواخل، يلفنا صمت قاسٍ، لا تنشّزه إلا دعسات أحذيتنا العسكرية الثقيلة، وهي تطأ الأعشاب الدغلية في دواسها المتلاحق.
من حولنا، تمازجت روائح جثث متعفنة، بروائح أجسادنا المتَّسخة منذ شهر أو يزيد. فالنهر بمحاذاتنا، ولكن التعليمات الصارمة تحذِّر من خطورة الاقتراب، فالألغام في كل مكان.
يأمرنا القائد بالتوقف، وعلى صفحة وجهه الداكنةِ ظِلُّ رهقٍ مكتوم، يقرر بثقة وأناة، أن لدينا ساعة واحدة فقط للراحة.
يتفرق جمعنا الصغير متناثراً، كلٌّ ينشد الراحة والاسترخاء، كانت الساعات تعبر ونحن نسير، وها هي قد عبرت عشر مرات حين قرر قائدنا التوقف.
كنت أحس بأن مثانتي ستنفجر لو أبقيتها أكثر من ذلك دقيقة واحدة، ولم أفرغها من محتواها السائل.
أرمق ساعتي، أجدها الواحدة بعد الظهر، بعزيمة خائرة أحيد عن أفراد المجموعة قليلاً، بغية قضاء تلك الحاجة البغيضة.
أطأ الأوراق الجافة، أسمع خشخشتها وتكسرها تحت البوت الثقيل، يعجبني أنينها، أتمنى لو أنني لم أتوقف، أصل النقطة التي أريد، أسحب (سوستة) البنطال، أحبذ لو أقضي حاجتي جالساً.
اندفاع البول بقوة واصطدامه بالأرض، يجعله يسيل حثيثاً باتجاه قدمي اليمنى، بينما رذاذه المتطاير يكاد يصيب وجهي، أميل برأسي تجاه اليسار، ساحباً قدمي اليمنى إلى الوراء، لأدع انزياح هذا السائل الحامض يزحف كيف يشاء، متواطئاً مع صوت ارتطامه المصطخب تحت الرغوة البيضاء، التي تعلو كقبة من الزبد.
أحس بقدمي اليمنى قد وطأت شيئاً ما، كما لو أنّه مسمار معقوف، أسمع صوتاً غريباً تحت البوت، صوتاً أشبه بطقطقة رتاج قديم.
أرمي نظرة جزعة باتجاه الصوت، أجد نفسي، وبرغم الحذر والتيقُّظ، قد وقعت في المحظور.
وطأت اللغم اللعين، كل ذلك بسبب هذه المثانة الرعناء، تختلط أحاسيسي، وتنصهر بذاكرتي الجرباء، أخيلة وأطياف عدّة، يتداخل الأمس والغد في طاحونة اليوم، التي ستدور تروسها الشرسة بعد حين، لو قمت بتحريك قدمي المتورطة، ولو جزءاً من الملميتر.
يزداد وجيف قلبي، أكاد أسمع نبضاته كأنها دقات طبول بعيدة، بصوت مبحوح كأنه احتكاك أخشاب جافة، أنادي، يهبّ الجميع بجزع تحت عفوية التنبيه، وخبث الإثارة.
الذاكرة لوحة بيضاء، أنهض متشنجاً، يأخذني لهاث شديد، أكابد أحزاني، أجول ببصري في الفراغ، الشمس تنعكس طافية على سطح النهر، يتكرر قيظ النهارات الفائتة، ينفطر فجأة، كقنبلة يدوية عتيقة، أنادي بصوت ملتاع واهن كعشب يابس، يبزغ طيف أمي، تنز عيناي بدمع سخين، ينضح عرق مالح يغمر جسدي، أتساءل بحزن: كيف انخرطت خطاي، وانفرط توازنها لتنغرس هنا؟
كيف انزلقت في فخ الموت المفزع؟
أين قذفت بالتعليمات والأوامر؟
يعتريهم اضطراب بالغ، وجوههم الشاحبة المتسخة ارتعبت من هول الصدمة المباغتة، خِلْجَان العرق على سحناتهم الداكنة يلسعني رثاؤها المستسلم لعدم الحيلة، يهرعون نحوي، مأخوذين بذهول شاسع، لوثة حزن ماحقة تطلّ من أعينهم المترقرقة بدمع نبيل، تسقط نظراتهم التعبة على هيئتي التي تتجاسر تحت عطبها المحتمل.
يهرع القائد باتجاهي، يحث الجميع على عدم الاقتراب، والتزام الحيطة والحذر، يركن إلى خوف طفيف، وارتباك سببه جسامة المسؤولية، وارتخاء انضباطنا، وعدم اتباعنا للأوامر، الشيء الذي يجعل العواقب الوخيمة تتربص بنا.
بصوته الممتقع، ونبراته المفككة في محيط ارتجافها، يأمر بمزج الطين، يلتقط بعضهم الإشارة، يشرعون في سكب الماء من (زمزمياتهم) بغية تنفيذ الأوامر على جناح السرعة.
يبدأ بإحاطة قدمي اليمنى بالطين، كانت لحظة بطيئة، يمر الوقت ثقيلاً، يأمر بمزيد من الطين، ملامح البوت اختفت، مثلما اختفت ساقي تحت لزوجة الوحل، أحسها كأنها ليست ساقي•
يتساءل البعض:
- لماذا الطين أيها القائد؟
يقول:
- حتى تبدو القدم راسخة دون حراك، ربما ستطول وقفته.
- أحس بظمأ حارق أيها القائد، أريد بعض الماء أطفئ به هذا الحريق.
- ليس بعد، تجلد قليلاً، عسانا نعبر هذه المحنة بسلام، أو بأقل خسائر ممكنة.
هكذا رد عليّ، وطفق يبسط كفيه الملطختين بالطين، إعلاناً لانتهاء المهمة الأولى في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
رديم الوحل يبدو كتلٍّ صغير، يبتلع يمناي المستسلمة لمصير ضالع في غموضه، طاعن في جفافه المستدير المدبَّب.
أسمعه يهمس بكلمات مبهمة، كآبة كبيرة تسكن أعماقي، وتجعل محاولة الإمساك بسر اللحظات القادمة أمراً شديد الصعوبة، أجيل بصري في المدى البعيد، ثمة أسراب من طيور تخفق خفيفة، تختفي خلف غيمات بعيدة شاحبة، خواء شاسع يتملك روحي، وثمة ريح لافحة تصلي وجهي، أطبق أجفاني على مهل، خاضعاً للحظة يأس خانقة، ثم افتحهما، فتفزعني نظرات الترقب الساكنة على محاجر الجميع.
أحاول تذكُّر الساعات الجميلة التي مرت على حياتي، عساني أسلّي نفسي، فيتقاطع عليَّ خاطري ويطفر شبح جارنا الذي دفعني إلى هذا الجحيم المرعب، بغية التخلص مني وإبعادي، حتى يتسنى له تنفيذ مراميه الشاذة بالزواج من شقيقتي ذات العشرين عاماً كزوجة ثالثة، يدفن على صدرها الصبي خيباته المتتالية، ويضيء بها عتمة أيامه القليلة الباقية.
إمامته للمصلين لم تشفع لتلاعبه بحليب الأطفال المغشوش الفاسد.
ورعه المصطنع لا يستطيع قبر سيرته المتعفنة القذرة، ولا يمحو علاقاته بشخوص يشوبهم القيل والقال. تملّقه وتزلّفه لشخصيات نافذة في مواقع القرار أعطاه الفرصة ليكون عيناً راصدة، ويداً باطشة لمصلحة جهة ما، لا يستطيع أحد البوح باسمها علناً.
قبل موت أبي لم يستطع حتى الاقتراب من باب منزلنا، كان أبي يقول عنه إنه أتفه من مشى على الأرض.
حذرته بأنني سأغرز أصابعي في عينيه إن هو تطفل علينا مرة أخرى طالباً يد شقيقتي، وعندما أيقن أنني صادق في ما أقول، رشقني بنظرة حارقة، تستبطن ما تستبطن من تهديد.
بعد ثلاثة أيام طرقوا بابنا، فتحت الباب، وجدتهم؛ مجموعة من العسكر، غارقين في بزاتهم الكاكية، لم أتبين عددهم، جميعهم مسلحون، اقتلعوني اقتلاعاً من أمام منزلنا، قذفوا بي في جوف سيارة محكمة الإغلاق، تلقتني وجوه من هم مثلي، لا حيلة لهم سوى النظر بعيون زائغة وخوف مصلوب على الجوانح، اقتلعوني هكذا، عنوة واقتداراً، وكان ما كان.
يتخلّص من الطين على يديه، يكفكف كمي قميصه المتسخ، يدور حولي بحرص، وهو يطوّف بالجهاز متحسّساً النقطة التي سيبدأ منها المرحلة التالية.
يشرع بحفر مساحة صغيرة بأظافره المدببة على الأرض قرب قدمي المتورطة، يتعرى اللغم قليلاً، يحدد موقع الفتيل، ألمحه وهو منكفئ، وقد تبلل ظهره بالعرق، والتصق القميص بجسده الناحل، كما لو أن غرَّاءً ماهراً قام بإلصاقه هكذا.
تنفتح شاشة الذاكرة مرة أخرى، يظهر فيها طفل بالغ الشقاوة، ذلك الطفل الذي كنته، يتحسس علاقاته بالأشياء برعونة غير محتملة، وبتحدٍّ صبياني.
كان النجار الذي اصطحبه أبي لترميم الدولاب العتيق، قد استجلب معه علبةً بيضاء، كنت شغوفاً بمعرفة محتوى هذه العلبة، أتحيّن الفرص لسبر كنه ما بداخلها.
لسبب ما، يخرج النجار، أفتح العلبة، يتلقاني الغراء الأبيض كالحليب، أرفع العلبة إلى أعلى، أفرغ ربع محتواها في جوفي الذي ما كان له أن يتسع لولا شهوتي التي تتعرّم أمام بياض الحليب، ونكهته التي لا تقاوم، أكرع الجرعة تلو الأخرى، بحثاً عن الطعم الغائب.
يلمحني النجار من خلال الباب المفتوح، يهرع نحوي، ينتزع العلبة، يتلجلج، يصاب بارتباك، يصرخ، يهذي، يبكي، تهرع أمي بخطىً واسعة، يلفني غثيان ماحق، تحيطني دوامة من الدوار، يتصبب العرق، تغيم الدنيا أمام ناظري أحسّني أهوي في لبّ بئر لا قرار لها، أطيح على وجهي، وعندما أفيق أجد نفسي ممداً داخل غرفة الطبيب، وأمي المسكينة يسيل نهر دموعها دون توقف، بينما أبي انتصب بقامته المديدة قرب رأسي، يرمقني بأسىً، والطبيب يغمغم بكلمات الاطمئنان وزوال الخطر مهدئًا من روع الجميع.
عندما أتماثل للشفاء سيصلبني أبي تحت شمس نصائحه التي لا تنتهي.
يعود من انكفاءته، يتقطّر العرق من جبينه المقطّب، يمسح بكفه المعروقة العريضة على وجهٍ عرّش عليه حزن عميق، يتلفت حوله بوهن ضالع، لا يجد إلا الحيرة على وجوه الجميع.
أحس بخدر طفيف يتسلق ساقي المتوحلة، كأن الأوعية الدموية تجمدت هي الأخرى، وتوقفت عن فاعليتها.
أتراني سأنجو، وأنام ملء جفني هذه الليلة مباعداً بين ساقي حسب التعليمات والأوامر تجنباً لأي طارئ تفعله هوام الأرض الزاحفة؟ أم أنها المرة الأخيرة التي أرى فيها ساقي وهي متصلة بجسدي المنهدم؟ أتراني سأنجو بهذا الحد الأدنى؟ أم ستنقصف روحي وإلى الأبد؟
أتآكل ببطء في انتظار النتيجة المؤجلة، أحاول التواؤم مع ما هو قادم، رغم مرارته وغموضه الذي سيتكشف بدوي منتظر، تتطاير عقبه الأشلاء في الآفاق كلها.
لم تكن مهمتنا صعبة، حين تم اختيارنا قبل شهر أو يزيد، كنا مجموعة من المجندين، أغلبنا طلاب على أعتاب المرحلة الجامعية، تم اصطيادنا بطرق مختلفة، وبعد تدريب قصير تم ترحيلنا ليلاً، مشمولين بحراسة مشدّدة، تخوفاً من هروب جماعي أو فردي ينفّذ في أي لحظة، نجد أنفسنا داخل الطائرة العسكرية الكالحة، نحلق عالياً، وبعد ساعة تهبط بنا في موقع عسكري وسط غابة كثيفة الأشجار، ننزلق خارج السمكة الحديدية الطائرة، يستقبلنا الجنود بمشاعر محايدة، لا يمكن تحديد اتجاهاتها، تتملص أسماؤنا عنا، أو بالأحرى تُنزع بصلف عسكري غريب، لتحل محلها (مجند رقم كذا).
يتم التسليم والتسلّم، تقلع الطائرة، آخر مظاهر الحياة تختفي مع اختفاء الطائرة وانقطاع أزيزها المضطرد.
يتسلمنا الجندي الذي سيتولى أمرنا طويلاً بعد ذلك، يرحب بنا باقتضاب، يلقي على مسامعنا الأوامر التي يجب علينا اتباعها، يحدد لنا مهامنا بلا مواربة، يقول إنها غير صعبة إذا ما التزمنا اتباع الأوامر والتعليمات.
علينا اجتياز طرقات كثيرة بمحاذاة النهر، لتحديد طرق خالية من الألغام، نقوم بوضع علامات متفق عليها تعلن أن المكان ينعم بالأمن، هذه المهمة تبدأ منذ اللحظة وتستمر إلى أجل غير مسمى.
في جنح الظلام نتحرك، تحت إمرة قائدنا الجديد، جهاز الكشف عن الألغام تحت رعاية القائد، وهو الوحيد الذي يستطيع تشغيله ليس غيره، فالكل لم ير في حياته مثل تلك الأجهزة.
يشير إلى الزملاء بتوخي الحذر، بالانبطاح خلف سواتر واقية، أوقن أن اللحظة الحاسمة أوشكت على بيانها، قشعريرة عارمة تلامس أعصابي، تتقلص أمعائي على نفسها، أحس كما لو أن حجراً مكوّراً سكن أحشائي.
أشعر بسخونة سائلة على فخذي، ألقي نظرة، أجدني قد تبوّلت على نفسي دون إرادة.
يحفر حفرة عميقة كلحد، يتخندق فيها، يأمرني بصوت واهن أن أتبع الأوامر بدقة، وأنه سيعد حتى الرقم ثلاثة، وبعدها عليَّ أن أميل بجسمي إلى اليسار، متخذاً وضع القوس، مع الحفاظ على رسوخ قدمي المتورمة في وحلها الذي أوشك على الجفاف.
أدرك أنه قرر بتر ساقي، كحد أدنى من جوف الفجيعة المحدقة، يتجمع رعب القرون كلها على صدري، أميل بسرعة، ثم يسحب الفتيل.
يتجلجل دوي فخيم، يصم أذني ويرجّ المكان كله، يندغم صوت زغرودة نسوية تنطلق في نفس اللحظة في مكان ما من هذا العالم.
أفيق بعد ثلاثة أيام، أجد نفسي ممدداً على سرير متآكل الأطراف، مهدّل الأعماق، داخل المستشفى العسكري في المدينة الحدودية التي لم أسمع باسمها ولو لمرة واحدة في حياتي، وعلى وجه مطببي شبح ابتسامة مصطنعة، يهدئ بها روعي، ثم يدس في كفي ورقة صغيرة مطوية بحرص، أفضها تحت طنين أذنيّ الذي لا ينقطع، أقرأ فيها:
"إنه في الساعة الواحدة بعد الظهر، من اليوم الثالث في هذا الشهر، تم زفاف شقيقتك كزوجة ثالثة على سنة الله ورسوله إلى كنف جاركم العزيز فلان ابن فلان... مبروك.
وشكراً
التوقيع/ مجهول"
أرمق التقويم السنوي على الجدار متآكل الجوانب، والملطخ بالأوساخ، أجد أن تاريخ اليوم هو السادس من نفس الشهر.
أتقيأ أمعائي، وينزف جرحي باضطراد.
* كاتب قصّة من السودان