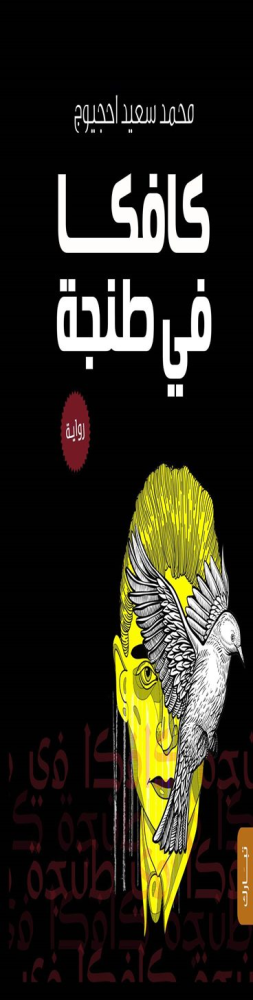بسلال الأشهى ممّا تشربّته روحه من وصايا الشرق، سندباد قصيد حلّ، حطّ على غصن آخر ممتدّ في جيوب عشق الانشطار ما بين قلبين أحدهما لهذا الوطن، والآخر لقصائد لا تتسربل بغير عنفوان جدلية الإبداع والسياسة، مثلما تُجري أنهر معسول المعنى على فيض النخوة وتواضع الحكماء والأناقة والشكيمة والمروءة إذ تضوّع من المبدع الإنسان والأكاديمي والشاعر النبيل المسكون بأسئلته النضالية التي تثوّر مشهد تخليق الثقافي للسياسي والعكس بالعكس تماما، وتنشد صحوته: حياتياً وإبداعياً.
هو صوْغ مغاير لدوال المعنى الوجودي،تدشّنه أنامل الجميل عبد الناصر لقاح، تمنحه الحلّة الهلامية الشاهدة على ترنيمة بنكهة لعنة أبدية، تباهي بالنص خارج لغته،خارج زمنه، وأمام زجاج ذاكرة مثقوبة،تنهل وتنسى،مغدقة على الذات الشاعرة بأسباب التجريبية المنشودة،واقية إياها مثالب النسخ وجريرة الاجترار.
صاحب “السرو المشتعل” و”أشجار نصيرة الجذلى” و”ديوان الأرق” و”جداول الروح” المظللة بذكرى الراحل المرحوم الشاعر العلامة فريد الأنصاري، الشريك في هذا الإصدار الأخير…
من قصيدة مناضل أقتبس له هذا الطقس، وكيف أنه يعكس تمرّدا خفيضا للذات:
“ها صار الثوري الأنقى يشدو عشقا شبقا /ينسى نارا /ينسى دمه/ يهوى بارا /يهوى فمه ويحاصر أشجارا / تنمو في مهوى الريح / ووراءه ثوري /يبكي ويصيح/سقطت أنوال في الريح/سقطت /أنوال
/في الريح”.
وكأنّ روح الشعر، أوسعُ من أن تنحسر في معطيات التاريخ المستعاد، التي لم بتمّ إقحامها في السياقّ لأجل الثرثرة،بل يكون حضورها بهدف تلوين تجويفات النص،على نحو يومئ إلى مختزل الذاكرة المنشطرة بين كتابتين للتاريخ: إحداهما تقول بزيف هذا التاريخ، وتقاربه من زوايا التشكيك والطعن في مصداقية مصادره، كون المنتصر هو من يكتب التاريخ في النهاية على هواه وسجيته، ما يجعلها كتابة منافقة بعيدة كل البعد عن أسباب الموضوعية وأدبياتها.
في حين تفتي الأخرى بضرورة قطف العظة والعبر من التاريخ مهما يكن مقنّعاً، ومخجلاً بصفحاته الملطّخة بالأخطاء والهزائم، المهم هو ربط الحاضر بالماضي، قصد تبيّن ملامح المستقبل ونفض سلبيات الماضوية عن خارطة استشرافية، بانية لآماد قريبة مثلما يشتهيها الإنسان في سعيه الحثيث إلى حيازة مقومات ثقافة جديدة، قد تنهل من الموروث أيّا تك كتابته، لكن من المفترض أن تفضي إلى صناعة هوية جديدة كذلك.
ومن قصيدة شرود نطالع له: “كل قبر هو قبر لأمي/ فلا تدخل إلى قلبي/حتّى تغسل اسمك بالتربة والأسئلة/ أو تغزل وجهك بالجسم الأول/ والشهقة المستحيلة/ لا تدخل في الأنوثة حتّى ترحل في الماء”.
إنها ذاكرة أمومة، مثل ما هو مستقرّ في رحم التصوير، وكأن الخطاب الملحمي، من وجهة نظر شاعرنا، لا يستقيم بغير المسكوب في مثل هذا الامتداد الواعي، ترعاه ذاتية التعدّد،لتبديه مزداناً بتيمة تنتقى بعناية وحرص، تنتشل من معجم عائم،كي تحقق الانسجام المطلوب، دالاً على سعة الأنا ومبرزاً مداها التصالحي في كليته، أي مع مركز الذات وسائر ما يتفرّع عنها من عناصر مشكّلة أو ناسخة لظلال هذه الذات.
كل مفردة محسوبة على قائلها، وحري أن تقفز من الحلق، وهي في مستوى مصادقة نرجسية لعناصر الطبيعة وكل المكونات الوجودية.
ومن ديوان “جداول الروح” المشترك، نقتبس له هذه التوقيعة الغامزة بعنفوان الصداقة ،في بعدها النّشاز، الذي يؤنسن العنصر الطبيعي: “أحبك/ كي لا أكذّبَ أشجار روحي / وشهوة خوفي /وماء جروحي/ وكي لا / أراجع قلبي / وأغدو ذليلا / أحبّك حتّى لتغدو العوالم آسره / ويغدو القبيح جميلا /أحبذك حتّى تصيري امتداد اخضراري/ وأطلقُ فيكِ حصانا نبيلا”.
بهذه الطاقة الجبارة، مسكونة بغنائية النرجسي، يبسط لقاح يدا بيضاء، وقلبا مفتوحا للصداقة العارية تماما، يبني رؤيته الفلسفية، على ما قد يستلهمه من إيقاعات مخاتلة، أو انطباعات مخملية تتركها ظلال الطبيعة الحالمة في عبورها، كي تعطي لودنا معنى ما.
وصدقا، ليس أقدر من قلب شاعر على ارتجال المقامرات الجنونية، مزهوا باشتعاله العاطفي،تجاه كلّ ما هو له صدى وامتدادا،ما يُصبغُ على أفق الإبداع،ههنا، في حالة الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح،دفقا من المعني الموغلة في المتخيل،ضمن حدود حوارية، ناسجة لخيوط الخطاب الشعري، انطلاقا من المختزل المُعطّل في ذاكرة،تغازل بمحوريْن: الأمومة والصداقة.
جملة إرهاصات ،تنبض بها مثل هذه العلاقة في لبوس الوعي بقيمة ما يكمّل الذات الشاعرة، وينكتب حسب منسوب المعاناة وعمق التجربة.
إن شجر السرو وإن عتّب باكورة إصدارات شاعرنا، يقبع رافلا بوشاياته الضمنية،مغرضة بانتهاكات سقف المعنى المنوط بتفسيرات رغوية سطحية،ليقرع حقل دوال الفوقية التي تفيد سلالات أخرى من الشجر،كالزيتون، الملهم الأول،بحيث تظل رمزيته طاغية على خيال شاعر من هذه الطينة أضاف إلى مخزونه الجمالي والمعرفي من درر سياحة روحية بامتياز،تتقمّص دور بطولتها، تلكم الشجرة المباركة،كأبرز العناصر حضورا سواء من حيث طوباويتها أو قداستها، وقدرا تسجّل به ولوجها في تشكيل وعي ورؤى شاعر بحجم هذا الإخلاص في مصادقة الشجر،بشكل خاص.
كيف لا وهو في انتمائه الأكاديمي، الابن البارّ لمدينة مغربية عريقة بثقافتها وآثارها وناسها وطبيعتها وأشيائها، تكنّى “مكناسة الزيتون”..؟
ألا يفجّر نظير هذا التوجّه، في الذات المبدعة،على مختلف التجارب والحساسيات، طقوس الإبداع المحسود عليه،في معنييْ الأمومة والصداقة الجدية البريئة التي تعطي أكثر ممّا تأخذ،دون أن تستسلم لغواية الأقنعة..؟
هو صوْغ مغاير لدوال المعنى الوجودي،تدشّنه أنامل الجميل عبد الناصر لقاح، تمنحه الحلّة الهلامية الشاهدة على ترنيمة بنكهة لعنة أبدية، تباهي بالنص خارج لغته،خارج زمنه، وأمام زجاج ذاكرة مثقوبة،تنهل وتنسى،مغدقة على الذات الشاعرة بأسباب التجريبية المنشودة،واقية إياها مثالب النسخ وجريرة الاجترار.
صاحب “السرو المشتعل” و”أشجار نصيرة الجذلى” و”ديوان الأرق” و”جداول الروح” المظللة بذكرى الراحل المرحوم الشاعر العلامة فريد الأنصاري، الشريك في هذا الإصدار الأخير…
من قصيدة مناضل أقتبس له هذا الطقس، وكيف أنه يعكس تمرّدا خفيضا للذات:
“ها صار الثوري الأنقى يشدو عشقا شبقا /ينسى نارا /ينسى دمه/ يهوى بارا /يهوى فمه ويحاصر أشجارا / تنمو في مهوى الريح / ووراءه ثوري /يبكي ويصيح/سقطت أنوال في الريح/سقطت /أنوال
/في الريح”.
وكأنّ روح الشعر، أوسعُ من أن تنحسر في معطيات التاريخ المستعاد، التي لم بتمّ إقحامها في السياقّ لأجل الثرثرة،بل يكون حضورها بهدف تلوين تجويفات النص،على نحو يومئ إلى مختزل الذاكرة المنشطرة بين كتابتين للتاريخ: إحداهما تقول بزيف هذا التاريخ، وتقاربه من زوايا التشكيك والطعن في مصداقية مصادره، كون المنتصر هو من يكتب التاريخ في النهاية على هواه وسجيته، ما يجعلها كتابة منافقة بعيدة كل البعد عن أسباب الموضوعية وأدبياتها.
في حين تفتي الأخرى بضرورة قطف العظة والعبر من التاريخ مهما يكن مقنّعاً، ومخجلاً بصفحاته الملطّخة بالأخطاء والهزائم، المهم هو ربط الحاضر بالماضي، قصد تبيّن ملامح المستقبل ونفض سلبيات الماضوية عن خارطة استشرافية، بانية لآماد قريبة مثلما يشتهيها الإنسان في سعيه الحثيث إلى حيازة مقومات ثقافة جديدة، قد تنهل من الموروث أيّا تك كتابته، لكن من المفترض أن تفضي إلى صناعة هوية جديدة كذلك.
ومن قصيدة شرود نطالع له: “كل قبر هو قبر لأمي/ فلا تدخل إلى قلبي/حتّى تغسل اسمك بالتربة والأسئلة/ أو تغزل وجهك بالجسم الأول/ والشهقة المستحيلة/ لا تدخل في الأنوثة حتّى ترحل في الماء”.
إنها ذاكرة أمومة، مثل ما هو مستقرّ في رحم التصوير، وكأن الخطاب الملحمي، من وجهة نظر شاعرنا، لا يستقيم بغير المسكوب في مثل هذا الامتداد الواعي، ترعاه ذاتية التعدّد،لتبديه مزداناً بتيمة تنتقى بعناية وحرص، تنتشل من معجم عائم،كي تحقق الانسجام المطلوب، دالاً على سعة الأنا ومبرزاً مداها التصالحي في كليته، أي مع مركز الذات وسائر ما يتفرّع عنها من عناصر مشكّلة أو ناسخة لظلال هذه الذات.
كل مفردة محسوبة على قائلها، وحري أن تقفز من الحلق، وهي في مستوى مصادقة نرجسية لعناصر الطبيعة وكل المكونات الوجودية.
ومن ديوان “جداول الروح” المشترك، نقتبس له هذه التوقيعة الغامزة بعنفوان الصداقة ،في بعدها النّشاز، الذي يؤنسن العنصر الطبيعي: “أحبك/ كي لا أكذّبَ أشجار روحي / وشهوة خوفي /وماء جروحي/ وكي لا / أراجع قلبي / وأغدو ذليلا / أحبّك حتّى لتغدو العوالم آسره / ويغدو القبيح جميلا /أحبذك حتّى تصيري امتداد اخضراري/ وأطلقُ فيكِ حصانا نبيلا”.
بهذه الطاقة الجبارة، مسكونة بغنائية النرجسي، يبسط لقاح يدا بيضاء، وقلبا مفتوحا للصداقة العارية تماما، يبني رؤيته الفلسفية، على ما قد يستلهمه من إيقاعات مخاتلة، أو انطباعات مخملية تتركها ظلال الطبيعة الحالمة في عبورها، كي تعطي لودنا معنى ما.
وصدقا، ليس أقدر من قلب شاعر على ارتجال المقامرات الجنونية، مزهوا باشتعاله العاطفي،تجاه كلّ ما هو له صدى وامتدادا،ما يُصبغُ على أفق الإبداع،ههنا، في حالة الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح،دفقا من المعني الموغلة في المتخيل،ضمن حدود حوارية، ناسجة لخيوط الخطاب الشعري، انطلاقا من المختزل المُعطّل في ذاكرة،تغازل بمحوريْن: الأمومة والصداقة.
جملة إرهاصات ،تنبض بها مثل هذه العلاقة في لبوس الوعي بقيمة ما يكمّل الذات الشاعرة، وينكتب حسب منسوب المعاناة وعمق التجربة.
إن شجر السرو وإن عتّب باكورة إصدارات شاعرنا، يقبع رافلا بوشاياته الضمنية،مغرضة بانتهاكات سقف المعنى المنوط بتفسيرات رغوية سطحية،ليقرع حقل دوال الفوقية التي تفيد سلالات أخرى من الشجر،كالزيتون، الملهم الأول،بحيث تظل رمزيته طاغية على خيال شاعر من هذه الطينة أضاف إلى مخزونه الجمالي والمعرفي من درر سياحة روحية بامتياز،تتقمّص دور بطولتها، تلكم الشجرة المباركة،كأبرز العناصر حضورا سواء من حيث طوباويتها أو قداستها، وقدرا تسجّل به ولوجها في تشكيل وعي ورؤى شاعر بحجم هذا الإخلاص في مصادقة الشجر،بشكل خاص.
كيف لا وهو في انتمائه الأكاديمي، الابن البارّ لمدينة مغربية عريقة بثقافتها وآثارها وناسها وطبيعتها وأشيائها، تكنّى “مكناسة الزيتون”..؟
ألا يفجّر نظير هذا التوجّه، في الذات المبدعة،على مختلف التجارب والحساسيات، طقوس الإبداع المحسود عليه،في معنييْ الأمومة والصداقة الجدية البريئة التي تعطي أكثر ممّا تأخذ،دون أن تستسلم لغواية الأقنعة..؟