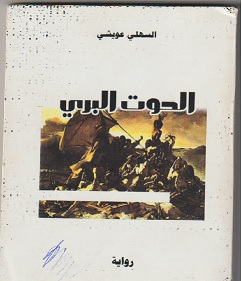يكثر ترداد كلمة (الذوق) في البلاغة، كما يكثر ترداد كلمة (العقل) في الفلسفة. ذلك لأن حاسة الذوق هي أداة الفن، كما أن ملكة العقل هي أداة العلم. فمن لا يذق لا يدرك الجمال، كذلك من لا يفقه لا يعرف الحق. ولم تؤتَ البلاغة إلا من فساد الذوق فيمن يكتب أو فيمن يقرأ. ولم أجد فيما أثر من أدبنا، ولا فيما نقل إلى لغتنا، كلاماً يفيد طالب البلاغة في موضوع الذوق على ما له من بليغ الأثر في إنشاء العمل الفني وصحة تقديره ودقة نقده. لذلك لم أر من الفضول، وأنا في مقام الدفاع عن البلاغة، أن أحاول تجلية هذا المعنى بمقدار ما يحسن الاستطراد في موضوع يؤديَّ على الطرف الأقصى من الإيجاز
ما هو الذوق؟ والذوق حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر. وقديماً فطن الناس إلى الشبه بين الذوق الحسي الذي يميز بين الطعوم، وبين هذا الذوق المعنوي الذي يحكم في نتاج الفنون. وما أظنهم وقفوا بوجه الشبه بين هاتين الحاستين عند طبيعة الإدراك، وإنما تعدوا به إلى قابليتهما للكمال والنقص، واختلافها بين الناس باختلاف الزمان والمكان والخلق والمادة على أن التنوع والتغير والاختلاف في الذوق الحسي أضعف وأقل، لأن مجاله محدود؛ وأدراك المادي قريب، واستيعاب المحدود ممكن، وفعل الطبيعة والبيئة في تطوير الغرائز بطئ لا يكاد يحس. أما الذوق المعنوي فمجاله ما يعجب وما لا يعجب من أعمال النفس والذهن. والمعجب وغير المعجب من هذه الأعمال أمور لا تزال تتأثر بعوامل الزمن والإقليم والجنس والتربية والثقافة والحضارة والطبقة والسن؛ وكلما التبست هذه الأمور التبس الذوق الذي يسيرها ويدبرها ويفرق بينها ويحكم عليها. فالذوق الحسي مرجعه إلى الطبيعة وللطبيعة طريقة واحدة؛ والذوق المعنوي مرجعه إلى العادة وللعادة طرق متعددة. وإذن لا يمكن الظفر بذوق عام تصدر عنه أحكام الناس على الأعمال الفنية، فإن ما يعجب الحضري قد لا يعجب البدوي، وما يطرب المصري قد لا يطرب الأوربي؛ فرقص (ببا) خزي عند الغربيين، وغناء (جانيت) نهيق عد الشرقيين. وفي الغالب نرى الشيء الواحد يثير الاستحسان في نفس والاستهجان في أخرى. فكيف نجعل الذوق أذن ميزاناً في وهو على هذا الاختلاف؟
إن للذوق مصدرين يستمد منهما الحكم في جميع قضاياه: الأول العقل المتزن، وهو يحكم في التناسب والقصد والترتيب والعلائق المشتركة بين السبب والنتيجة، أو بين الطريقة والغاية. والذوق المستمد من هذا المصدر له ما للعقل من الوضوح الذي يشرق في كل نفس مهذبة؛ وقواعده كقواعد العقل لا تتغير لأنه ثابت مطرد. والفنان الذي أوتي ثقوب الذهن يكون في مأمن من الزيغ إذا اتبع قواعد الفن لأنها وضعت على هذا الأساس المكين
والمصدر الآخر هو العاطفة، وهي الشعور الواقع على النفس مباشرة من طريق الحواس. وهنا كان مجال الاختلاف وسبب التباين؛ لأن الحقيقة في الفنون غير الحقيقية في العلوم: هي في العلوم محصورة مضبوطة، ولكنها في الفنون منتشرة مبسوطة؛ ومن ذلك كان التدرج من الحسن إلى الأحسن، ومن الفائق إلى الممتاز. ولم ينشئ هذه الفروق إلا هذا الذوق العاطفي الذي يتولد من الصفات والعادات والحوادث فيجعل الحقيقة الفنية تختلف في نفسها من شعب إلى شعب، ومن قرن إلى قرن، حتى لتختلف في المكان الواحد، وفي الزمان الواحد، وفي الإنسان الواحدة، تبعاً لحالات العواطف وانطباعات الحوادث واختلافات الميول
ضع نموذجا أمام مائة طالب ليرسموه، ثم انظر بعد ذلك فيما عملوا تجد الرسوم كلها تتشابه لأول وهلة؛ فإذا أطلت فيها النظر لا تجد رسمين منها يتشابهان، لأن الذوق الخاص بكل راسم جعل الصور تختلف في حقيقتها، وإن لم تختلف في جوهرها وطبيعتها
لا بد للذوق إذن من استمداد العقل والعاطفة كليهما في تكوين حكمه: هذا بمقتضى المنطق السليم، وتلك بمقتضى الشعور الحاصل. ومرجع كل حكم من أحكام الذوق إلى القاضي الأعلى وهو الطبيعة. وللطبيعة، والحمد لله، قانون نافذ على كل كائن. وقد كان للناس قبل أن يوجد الفن ذوق معنوي خلقته الطبيعة فيهم كما تخلق الغرائز؛ وكان لهذه الحاسة من ميلها ونفورها قاض يحكم على كل شئ فلا يخطئ حكمه. فلما ظهر الفن لم يعارض الطبيعة ولم يناقضها، وإنما حسنها وزينها وعمل أحسن مما عملت باتباع طريقتها واقتباس وسيلتها وملاحظة تطورها إن الفنان كلما دنا من الطبيعة كان أنقى وأصدق. أنظر إلى أدب الجاهليين من العرب والإغريق تجد أظهر خصائصه الحقيقية والسذاجة والوضوح. ذلك لأن البدوي أو الهمجي يمتاز بقوة بصره وحدة سمعه؛ وإن حاسته المعنوية التي تتصل بعينه وأذنه تمتاز كذلك بوضوح الإدراك وصدق الحساسة. وإذا كان ذوقه أضعف من ذوق المتمدن في التحليل والتحديد والتمييز، فإنه ثابت غير مضطرب، خالص غير مشوب. لقد اخترع البدوي المجازات البيانية والصور الخطابية قبل أن ينشأ الفن ويوضع البيان. ولقد كان إذا ما ضرم النوى أنفاسه، وأرمض الهوى نفسه، يخاطب الغياب ويظنهم يسمعونه، ويكلم الأطلال والأموات ويعتقد أنهم يفهمونه. أسمعه حين تصيبه مصيبة فيشكو، أو تسعفه صنيعة فيشكر، أو تمسه إهانة فينتقم، تجده قد شعر بأثر ذلك في نفسه كل الشعور، وإدارة بالعبارة الملائمة أصدق الأداء، فلا يوارب ولا يبالغ ولا يتكلف. لأن الطبيعة صادقة لا تعرف التمويه، صريحة لا تقبل الرياء.
وهل تنتظر من رجل لا يقول إلا ليعبر عما في نفسه أن يقول غير ما في نفسه؟ وكيف يجازف بالألفاظ حين يصف وهو لا يصف إلا ما أثر في قلبه أو وقع تحت حسه؟ فليت شعري هل نستطيع أن نكون اليوم كالبدو طبيعيين نستلهم الواقع ونستوحي الطبيعة! اليقين الذي لا ريب فيه أننا لا نستطيع، لأن حياتنا قد أصبحت من التركيب والتعقيد والتصنع بحيث لا تجد غريزة على جبلتها، ولا عادة على طبيعتها، ولا عاطفة من عواطف الناس على أصلها وحقيقتها. فنحن نتغزل من غير حب، ونمدح من غير عاطفة، ونصف ما لم نر، ونقص ما لم يقع، ونتقمص في القصص أشخاصاً خياليين أو حقيقيين فنتكلم بلسانهم، ونشعر بشعورهم. فكيف نستطيع في هذه الأحوال أن نجد العبارة والحرارة اللتين يجدهما البدوي أو الهمجي، من دون كد ولا معانات؟ لقد جعلنا الطبيعة بالتصنع فناً، فينبغي أن نجعل الفن بالتطبع طبيعة.
(للكلام بقية)
احمد حسن الزيات
مجلة الرسالة - العدد 506
بتاريخ: 15 - 03 - 1943
ما هو الذوق؟ والذوق حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر. وقديماً فطن الناس إلى الشبه بين الذوق الحسي الذي يميز بين الطعوم، وبين هذا الذوق المعنوي الذي يحكم في نتاج الفنون. وما أظنهم وقفوا بوجه الشبه بين هاتين الحاستين عند طبيعة الإدراك، وإنما تعدوا به إلى قابليتهما للكمال والنقص، واختلافها بين الناس باختلاف الزمان والمكان والخلق والمادة على أن التنوع والتغير والاختلاف في الذوق الحسي أضعف وأقل، لأن مجاله محدود؛ وأدراك المادي قريب، واستيعاب المحدود ممكن، وفعل الطبيعة والبيئة في تطوير الغرائز بطئ لا يكاد يحس. أما الذوق المعنوي فمجاله ما يعجب وما لا يعجب من أعمال النفس والذهن. والمعجب وغير المعجب من هذه الأعمال أمور لا تزال تتأثر بعوامل الزمن والإقليم والجنس والتربية والثقافة والحضارة والطبقة والسن؛ وكلما التبست هذه الأمور التبس الذوق الذي يسيرها ويدبرها ويفرق بينها ويحكم عليها. فالذوق الحسي مرجعه إلى الطبيعة وللطبيعة طريقة واحدة؛ والذوق المعنوي مرجعه إلى العادة وللعادة طرق متعددة. وإذن لا يمكن الظفر بذوق عام تصدر عنه أحكام الناس على الأعمال الفنية، فإن ما يعجب الحضري قد لا يعجب البدوي، وما يطرب المصري قد لا يطرب الأوربي؛ فرقص (ببا) خزي عند الغربيين، وغناء (جانيت) نهيق عد الشرقيين. وفي الغالب نرى الشيء الواحد يثير الاستحسان في نفس والاستهجان في أخرى. فكيف نجعل الذوق أذن ميزاناً في وهو على هذا الاختلاف؟
إن للذوق مصدرين يستمد منهما الحكم في جميع قضاياه: الأول العقل المتزن، وهو يحكم في التناسب والقصد والترتيب والعلائق المشتركة بين السبب والنتيجة، أو بين الطريقة والغاية. والذوق المستمد من هذا المصدر له ما للعقل من الوضوح الذي يشرق في كل نفس مهذبة؛ وقواعده كقواعد العقل لا تتغير لأنه ثابت مطرد. والفنان الذي أوتي ثقوب الذهن يكون في مأمن من الزيغ إذا اتبع قواعد الفن لأنها وضعت على هذا الأساس المكين
والمصدر الآخر هو العاطفة، وهي الشعور الواقع على النفس مباشرة من طريق الحواس. وهنا كان مجال الاختلاف وسبب التباين؛ لأن الحقيقة في الفنون غير الحقيقية في العلوم: هي في العلوم محصورة مضبوطة، ولكنها في الفنون منتشرة مبسوطة؛ ومن ذلك كان التدرج من الحسن إلى الأحسن، ومن الفائق إلى الممتاز. ولم ينشئ هذه الفروق إلا هذا الذوق العاطفي الذي يتولد من الصفات والعادات والحوادث فيجعل الحقيقة الفنية تختلف في نفسها من شعب إلى شعب، ومن قرن إلى قرن، حتى لتختلف في المكان الواحد، وفي الزمان الواحد، وفي الإنسان الواحدة، تبعاً لحالات العواطف وانطباعات الحوادث واختلافات الميول
ضع نموذجا أمام مائة طالب ليرسموه، ثم انظر بعد ذلك فيما عملوا تجد الرسوم كلها تتشابه لأول وهلة؛ فإذا أطلت فيها النظر لا تجد رسمين منها يتشابهان، لأن الذوق الخاص بكل راسم جعل الصور تختلف في حقيقتها، وإن لم تختلف في جوهرها وطبيعتها
لا بد للذوق إذن من استمداد العقل والعاطفة كليهما في تكوين حكمه: هذا بمقتضى المنطق السليم، وتلك بمقتضى الشعور الحاصل. ومرجع كل حكم من أحكام الذوق إلى القاضي الأعلى وهو الطبيعة. وللطبيعة، والحمد لله، قانون نافذ على كل كائن. وقد كان للناس قبل أن يوجد الفن ذوق معنوي خلقته الطبيعة فيهم كما تخلق الغرائز؛ وكان لهذه الحاسة من ميلها ونفورها قاض يحكم على كل شئ فلا يخطئ حكمه. فلما ظهر الفن لم يعارض الطبيعة ولم يناقضها، وإنما حسنها وزينها وعمل أحسن مما عملت باتباع طريقتها واقتباس وسيلتها وملاحظة تطورها إن الفنان كلما دنا من الطبيعة كان أنقى وأصدق. أنظر إلى أدب الجاهليين من العرب والإغريق تجد أظهر خصائصه الحقيقية والسذاجة والوضوح. ذلك لأن البدوي أو الهمجي يمتاز بقوة بصره وحدة سمعه؛ وإن حاسته المعنوية التي تتصل بعينه وأذنه تمتاز كذلك بوضوح الإدراك وصدق الحساسة. وإذا كان ذوقه أضعف من ذوق المتمدن في التحليل والتحديد والتمييز، فإنه ثابت غير مضطرب، خالص غير مشوب. لقد اخترع البدوي المجازات البيانية والصور الخطابية قبل أن ينشأ الفن ويوضع البيان. ولقد كان إذا ما ضرم النوى أنفاسه، وأرمض الهوى نفسه، يخاطب الغياب ويظنهم يسمعونه، ويكلم الأطلال والأموات ويعتقد أنهم يفهمونه. أسمعه حين تصيبه مصيبة فيشكو، أو تسعفه صنيعة فيشكر، أو تمسه إهانة فينتقم، تجده قد شعر بأثر ذلك في نفسه كل الشعور، وإدارة بالعبارة الملائمة أصدق الأداء، فلا يوارب ولا يبالغ ولا يتكلف. لأن الطبيعة صادقة لا تعرف التمويه، صريحة لا تقبل الرياء.
وهل تنتظر من رجل لا يقول إلا ليعبر عما في نفسه أن يقول غير ما في نفسه؟ وكيف يجازف بالألفاظ حين يصف وهو لا يصف إلا ما أثر في قلبه أو وقع تحت حسه؟ فليت شعري هل نستطيع أن نكون اليوم كالبدو طبيعيين نستلهم الواقع ونستوحي الطبيعة! اليقين الذي لا ريب فيه أننا لا نستطيع، لأن حياتنا قد أصبحت من التركيب والتعقيد والتصنع بحيث لا تجد غريزة على جبلتها، ولا عادة على طبيعتها، ولا عاطفة من عواطف الناس على أصلها وحقيقتها. فنحن نتغزل من غير حب، ونمدح من غير عاطفة، ونصف ما لم نر، ونقص ما لم يقع، ونتقمص في القصص أشخاصاً خياليين أو حقيقيين فنتكلم بلسانهم، ونشعر بشعورهم. فكيف نستطيع في هذه الأحوال أن نجد العبارة والحرارة اللتين يجدهما البدوي أو الهمجي، من دون كد ولا معانات؟ لقد جعلنا الطبيعة بالتصنع فناً، فينبغي أن نجعل الفن بالتطبع طبيعة.
(للكلام بقية)
احمد حسن الزيات
مجلة الرسالة - العدد 506
بتاريخ: 15 - 03 - 1943