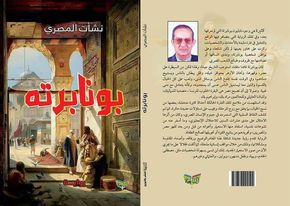يشير معظم الباحثين إلى أن القصة القصيرة في الخليج العربي ، تطورت تطورا ملحوظا بعد الحرب العالمية الأولي ، وساهمت عدة عوامل في عملية تطورها - منذ البداية - ومن أهمها : ازدياد نسبة المتعلمين في المجتمع الخليجي والحجازي ، نتيجة إنشاء المدارس ، ولقد ظلت المملكة العربية السعودية محرومة من التعليم حتى قيام الدولة الثانية في عهد
الملك ( عبد العزيز بن سعود ) الذي قام بإنشاء المدارس ، واهتم بتوفير المدرسين والمعلمين الذين وقع علي عاتقهم عبء تعليم أبناء الجزيرة ، وأيضا كان لوصول الصحف العربية في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، إلى منطقة الخليج دوره الكبير في ظهور هذا الفن ، خاصة صحف : الأهرام – المقتطف – الهلال – العروة الوثقي ..ومما عمل علي النهضة الثقافية ظهور الصحف والمجلات ، خلال الربع الأول من القرن العشرين ( 1900-1925) ، وكان لظهور الصحافة في السعودية دورها كوسيلة اتصال ، وممارسة للدور الثقافي والفكري لعدد من المثقفين ، ولذلك ظهرت بعض إبداعات القصة في تلك الآونة ، وكانت خصائص القصة القصيرة - في تلك المرحلة - تتميز بعدد من السمات منها : الميل إلى الأسلوب الخطابي والوعظ ، وكانت لغتها الفنية ركيكة ، ومن ناحية الموضوع ركزت علي موضوعات الوعظ الديني ، والإصلاح الاجتماعي ، والتعليم ، وكان المجتمع السعودي في تلك الآونة ، متمسكا بأنواع من التقاليد والقيم الاجتماعية المتخلفة كالإيمان بالمشعوذين – علي سبيل المثال – ولكن القصة القصيرة في المرحلة الثانية لتطورها ، تخلصت من بعض مشكلات الماضي ، التي لم تعد موجودة في المجتمع الجديد ، بفضل التطور الذي أصاب المنطقة ، وفي الوقت الذي صمتت فيه القصة القصيرة عن الحديث عن القضايا الاجتماعية – في مرحلتها الأولي – حفاظا علي كيان الأسرة الخليجية ، نجدها في مرحلتها الجديدة ، تهتم بمناقشة القضايا الاجتماعية ، فقرأنا عن مشكلات الخيانة الزوجية ، والوافدين وغير ذلك من المشكلات، التي لم تكن تحفل بها قصص البدايات
- 1 -
ولكن القصة القصيرة في السعودية تطورت فيما بعد – الآن- تطورا كبيرا وملحوظا ، تبعا للتطور ذاته الذي حدث في المجتمع السعودي ، علي المستويات الاجتماعية بشكل خاص ، والاقتصادية والسياسية بشكل عام ، ويعود الفضل إلى ذلك لعدد من كتابها الذين آمنوا بأن مهمة الكاتب الحقيقي أن يكون مع التطوير ، ومع الجديد ، من أجل النهوض ، أو العمل علي النهوض بمجتمعه ، بما يضمن له دوام الوجود والازدهار .
وهذه الدراسة تتعرض لبعض أعمال كتاب القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ممن ينتمون للجيل الثالث ، من كتابها ، وهذا الجيل ظهرت إبداعاته المتعددة خلال فترة الثمانينيات وضم عددا كبيرا من الكتاب منهم : سليمان سندي- عبد الله السلمي- وحسين علي حسين - وسباعي عثمان ، وعلي حسون - لطيفة السالم - محمد علي قدس - يوسف المحيميد - عبده خال - أحمد إبراهيم يوسف - محمد منصور الشقحاء وغيرهم ، ولقد وقع عبء التجديد علي عاتق هؤلاء الكتاب ، ولكن بدرجات متفاوتة ، وتبعا لثقافة الكاتب وموقفه من الحياة والواقع ، ومدي إدراكه بطبيعة هذا الفن الصعب ، والهموم الفنية المتعلقة به ، فهناك بعض الكتاب الذين أضافوا علي المستويين الشكلي والمضموني ، وهناك من اهتم فقط بالشكل ، دون اهتمام باختيار موضوعات جديدة تعبر عن الواقع في لحظته الحضارية الآنية .. ونهتم هنا بالكتابة عن بعض أعمال الكتاب الذين أضافوا أشياء لافتة ، وعالجوا موضوعات لم تكن مطروقة في المنجز القصصي السابق عليهم ، ومن هؤلاء : عبده خال – يوسف المحيميد – محمد المنصور الشقحاء - محمد علي قدس .
هذا الجيل الثالث جاء لاحقا لجيلين سابقين : أولهما يمثله الكتاب الذين ظهرت أعمالهم القصصية في الثلاثينيات ومنهم : أحمد رضا حوحو ومحمد علي مغربي ، ومحمد أمين يحيي ، ومحمد عالم الأفغاني ، وفي تلك الفترة غطي الاهتمام بالشعر علي الاهتمام بالقصة ، وكان الاتجاه الفني الذي ساد في الإنتاج الأول : هو الاتجاه الرومانسي ، وكذلك الاتجاه نحو الواقعية أو الطبيعية .. وظهر الجيل الثاني و تألقت أسماء مثل : عبد الله الجفري - وعلوي طه الصاوي ود. محمد عبده يماني ود. عصام خوقير وحامد الدمنهوري وخديجة السقاف ، وعبد العزيز صالح الصقعبي وغيرهم ...
و كتابات الكاتب السعودي ( عبده خال )
- 2 -
تأتي لتقدم نموذجا للكتابة التي لا تسير وراء التقليدي ، ولا تستسلم للقيود التي تقف أمام بعض الكتاب ، وتمنعهم من المغامرة ، - المغامرة الفنية - وفي واقع الأمر ، فان المغامرة أمر مطلوب ، لأنها كفيلة بدفع دماء جديدة في شرايين الإبداع الأدبي والفني ، تلك الدماء الجديدة ، هي التي تقوي فعل الاستمرارية ، وتخطي عتبات الإجادة والإضافة ، وهو من كتاب الجيل الثالث ، في حلقة أجيال القصة في المملكة العربية السعودية ، ومعه الكاتب ( يوسف المحيميد ) . وهذا الجيل أخذ علي عاتقه إضافة جماليات جديدة للقصة القصيرة في المملكة ، ربما لم تستوعبها الكتابات السابقة ، باستثناء بعض كتابات الجيل الثاني ، وبخاصة عند ( عبد العزيز مشري – الصقعبي ) ..
ونشير في هذه الدراسة إلى مجموعة مختارة من قصص الكاتب ( عبده خال ) ، منها قصص قصيرة جدا ، ونستطلع من خلالها سمات وعلامات التجديد لديه ، وأيضا علامات المغايرة والاختلاف عن الكتاب الآخرين ، والقصص القصيرة جدا يختزل الكاتب - فيها - التجربة اختزالا شديدا جدا ، فيقصر حجمها ليصبح مجرد سطر واحد أو سطرين ، ولقد اعتمدنا هنا علي قصص ( عبور – العنيد – الغناء الفصيح – دعوة لتبادل الأمكنة - ثمرة خسئة - بلادة - رويدا أيها الحالم - ذبول - نزاهة – حنين - لا أحد ينتظر الحسناوات - حياة - عقر - هروب - سيدة الأشواك ) ..
وبقراءة تلك القصص يُمكن أن نُجمل بعض الظواهر الفنية – من خلال تعامله مع هذا الشكل الفني - في التالي :
1- الاقتراب من شكل وفحوي الأمثولة أو النادرة ( عبور - رويدا أيها الحالم - حنين - هروب – عقر
2- غرائبية التناول ، وغموض الدلالة ( العنيد - الغناء الفصيح - سيدة الأشواك -
3- الحكي الغنائي والشعري ( حياة )
4- غلبة التصوير الخارجي ، والانحياز للصورة علي حساب السرد المعتاد . ( بلادة - ذبول - نزاهة - لا أحد ينتظر الحسناوات -
في قصة ( عبور ) يحاول الكاتب معالجة عبارة ( خبيء حزنك في النسيان ) ، لكن المعالجة لم تخرج عن إطار المعالجة التقليدية التي نراها في الأمثال ، أو الحكم ، وفي قصة (العنيد ) ُيقدم ما يُشبه اللغز ، وهذا اللغز لا يفصح عن شيء محدد ، ويبدو أمامنا - في بنائه ، ومحتواه ، ودلالته الغائبة - أشبه بما يكتبه شُعراء قصيدة النثر ، تلك التي لا تهتم بالدلالة ، بقدر اهتمامها بالتشكيل ، والغرائبية في التناول ، علي الرغم من قصر التجربة الشديد جدا – سطر ونصف فقط – إلا أننا نلمس تلك الغرائبية التي أشرت إليها .
( كان يعبر ليلا فصيحا ، وحفيف ثوب ، وطرق نعل يتبعان خطواته ، التفت ، فخر الليل ، وجاء الصبح العنيد ) وهنا تنتهي القصة !!
وفي نفس الإطار تأتي قصته ( الغناء الفصيح ) :
( مر بالمدينة ، فوجد مصابيحها نائمة ، والأغاني مُعطلة ، فقطف موالا ساحليا ، وتموج به حتى تغرغرت شوارع المدينة بالغناء الفصيح ) !!
وانعكاسا لتلك الغرائبية التي لا تُفضي إلي شيء محدد تأتي قصة ( ثمرة خسئة ) :
( عندما نظرت إلي المرآة ، ولمحت جسدي الُملقي علي الفراش ، أيقنت بأنني أصبحت ثمرة خاسئة ، ألقيت علي ألأرض .. آه يا للكارثة ، لقد ماتت تلك الشجرة العظيمة !!) نرصد هنا ذلك الاختزال ، المخل – إذا صح التعبير – الاختزال ، الذي لا تبرره الرغبة في التكثيف ، أو الهروب من طرق السرد التقليدي ، أو التخلص من الجُمل الزائدة ، فعلي الرغم من هذا الاختزال ، إلا أننا نلمس عيوبا وجدناها في القصص التقليدي ، ومنها : إعلاء صوت الكاتب ، انظر إلي عبارته ( آه يا للكارثة ، لقد ماتت تلك الشجرة العظيمة ) والمباشرة في عبارته ( أيقنت بأنني أصبحت ثمرة خاسئة ) والرصد الخارجي أيضا في عبارته ( لمحت جسدي الُملقي علي الفراش ) .. ما الذي تبقي من تلك التجربة .. إذن ؟! فعلي الرغم من قصرها الشديد جدا إلا أننا نستطيع رصد ما يلي : 1- إعلاء صوت الكاتب 2- الُمباشرة 3- الرصد الخارجي .. وكلها من مظاهر القصص التقليدي .. ولذلك فان الشكل – وحده – لا يُعد كاشفا عن رغبة الكاتب - أي كاتب - في الولوج إلي المناطق الجديدة في التناول والمعالجة ، بل إن طُرق المعالجة والتناول هي الجديرة بالاهتمام ، والشكل مرتبط - دائما - بالمحتوي أو المضمون ، وليس العكس .. أي أن كل تجربة فنية تُبرز شكلها ، ولذلك فان السعي نحو التجريب الشكلي ، يأتي علي حساب التجربة ذاتها ، ويُضعف من إمكانيات الكاتب في الولوج إلي مناطق جديدة وُطرق مغايرة..
ما هو الفرق بين القصة القصيرة ، والحكاية الشعبية ، أو الحكاية الفلكلورية التي ربما قرأناها - من قبل - في كتاب مثل كتاب - كليلة ودمنة - مثلا- ؟؟ إن الكاتب ( عبده خال ) يقدم قصته ( دعوة لتبادل الأمكنة ) لنكتشف أنه ، يُحاكي - تماما - القص الشعبي الذي يجعل الحيوان مثلا يتكلم مع الإنسان ، من أجل إعطاء حكمة ، أو ضرب مثل ، أو الخروج بموعظة حسنة !! انظر إلي القصة كاملة ، وحاول الوصول إلي إجابة للسؤال الذي طرحته ..
( دخل حارس الحديقة ، ليتفقد الحيوانات ، فوجد القرد حزينا ، بائسا ، قابعا ، في ركن منزو من القفص ، يقلب بين يديه غصن شجرة يابس ، ويطلق تنهدا ته العميقة ، الحارة فخاطبه الحارس :
- عجبا لأمرك .. أنت أذكي الحيوانات ، وأكثرها مرحا ، والجميع يجمع علي حبك ، فما بالك حزينا ، منكس الخاطر ؟؟
- فرد عليه القرد :
- - تعالي مكاني ، وستعرف ؟ )
وتنتهي القصة !! أليست هذه حكاية ، بكل ما للحكاية من خصائص ؟؟
ولقد جاءت قصة ( رويدا أيها الحالم ) أقرب إلي النادرة منها إلي القصة القصيرة الفنية .
( حلم أحد المساجين بأنه خرج من عتمات الزنازين ، ورأي نفسه يسير في الشوارع متمتعا بحريته ، فاستيقظ من نومه سعيدا ، وقام بتقسيم جميع حوائجه علي زملائه المساجين ، فصاح به الذي بجواره
- ابق شيئا لنفسك ، فلازلت بداخل السجن !! )
والنادرة لها سمات منها : أنها قصيرة الحجم ، مع وجود عدد من الشخصيات ، ولكل شخصية من هذه الشخصيات دوره في الحدث ، والنادرة تُقدم الشخوص من الخارج ، وتهمل ما يعتمل في داخلهم من مشاعر وأحاسيس ، وتلجأ إلي الرصد الخارجي ، بالإضافة إلي توافر عنصر السخرية ، ووجود المفارقة ،بالإضافة إلي الابتسامة التي من الممكن أن يُسببها التناول ، أليست كل هذه السمات متحققة في قصة ( رويدا أيها الحالم ) ؟!
وأود أن انوه هنا إلي أن قالب القصة القصيرة هو الذي يحدد طولها ، ولا يوجد " أي مقياس للطول في القصة القصيرة ، إلا ذلك المقياس الذي تحتمه المادة نفسها ، ومما يفسدها – لا محالة – أن تُحشي حشوا لتصل إلي طول معين ، أو تُبتر بترا لتنقص إلي طول معين " وفي هذا الإطار نفسه يعبر الناقد ( فرانك أوكونور ) عن خشيته من أن القصة القصيرة متأثرة بشكل خطير بأفكار محرري الصحف ، فيما ينبغي أن يكون عليه طولها
- 3 -
إن كاتب القصة القصيرة حين يتعمد اختزال اللغة في القصة القصيرة ، بدون أن تكون هناك ضرورة لهذا الاختزال ، فانه يكون أقرب إلي الشاعر منه إلي كاتب القصة القصيرة ، حيث إن الشاعر يعتمد علي لغة الشعر التي تقوم بتوليد المعاني والدلالات ، من خلال قوة المجاز ، الذي تحمله اللغة ، بينما لغة القصة ترتكز علي النمو ، والتطور ، وتهتم بأن تكون صاحبة وظيفة محددة في اتجاه المعني ، وعندما تتماهي الفروق بين الوظيفتين ، يُصبح التناول محفوفا بالمخاطر ، بل نستطيع أن نقول : إن الكاتب يقع في مأزق خطير جدا ، حين لا يستطيع تقديم تجربة شعرية خالصة ، أو تجربة قصصية خالصة ، صحيح أنه من الممكن أن يكون هناك مزجا بين النوعين ، من خلال تداخل الأنواع الأدبية في القصة القصيرة- أثناء المعالجة ولضرورة فنية تتطلب هذا المزج - لكن التداخل لا يعني الاستغناء نهائيا عن لغة القص ، اعتمادا علي أن لغة الشعر المختزلة ، يكمن أن تحل محلها ، ومن المعلوم أن مفهوم التوصيل يختلف في الحالتين ..
وعلي حد تعبير الناقد د . عبد المنعم تليمه - وهو علي حق فيما ذهب إليه- حين قال : " وقد انتهت اللغة إلى ضمور شديد وعقم بيّن حين انفصمت العلاقة فيها بين الدور الجمالي والدور الاجتماعي. وحين وقعت في أسر الغلو الشكلي، وحين برز تكريس مقولة أن الأدب ظاهرة مسيرة بقوانينها الذاتية"
- 4 -
وعلي العكس من كتاباته في مجال القصة القصيرة جدا ، تأتي قصص (عبده خال )الأخرى
بعيدا عن الرغبة في الولوج إلي مناطق التجديد بلا ضرورة فنية - محققة درجة عالية من التجديد الفني الحقيقي ، والواعي ، بل وتُعد قصصا لافته ومتميزة عن أبناء جيله فهو كاتب يُجيد اختيار موضوعات مبتكرة ، إنسانية ، جياشة ، مليئة بالمشاعر العارمة ، والأحاسيس الدافئة ، تتميز لغته الفنية بنعومة آسية ، وقدرة علي الإفصاح عن المكنون ، والداخل ، وقصصه تحتفي بالواقع الاجتماعي احتفاء كبيرا ، ربما نجد الرمز يُغلف التجربة إلا أن البعد الرمزي لا يقلل من واقعيتها ، بقدر ما يُعمق المعني ويجعله ، يُفصح عن دلالات متعددة ، هذه الدلالات تدفع المتلقي والقارئ إلي الاستمتاع بالقصة ، والاندفاع نحوها ، لمحاولة اكتشاف رموزها ، ولذلك نجد شخوص قصصه يعبرون عن الواقع ، ويعملون اتصالا بالقوانين المحركة له والمحيطة به ، أحيانا تكون قوانين سياسية ، لكنها ليست مباشرة ، وليست هي غاية المعالجة ، لكن موقف الكاتب الفكري والسياسي ، نستطيع التعرف عليهما من خلال متابعة ما يكتبه ، وتلك المسألة ، تدعم عملية الإبداع - بشكل عام - وذلك لأن الكاتب - أي كاتب - يكتب لأن لديه شيئا يريد أن يقوله ، وإلا فلماذا يكتب إذن ؟؟ وتتحقق كل هذه المعاني مع عدد كبير من القصص التي سنتناولها هنا بالدراسة والتحليل ، ومنها ( الجدار – البلوزة – عصفور الزينة – الذباب – جارتنا الصغيرة –آآآآآآ 5) وغيرها من القصص ، وقصة ( الجدار ) تُعد نموذجا للقصة القصيرة مُحكمة الصنع ، ليس بالمفهوم التقليدي لعبارة ( محكمة الصنع ) ولكن بمعني أن الكاتب يملك القدرة علي بناء قصته بشكل فني جيد ، ويعرف كيف يسيطر علي شخوصه تلك السيطرة التي لا تجعل الأحداث تفلت منه ، أو تضيع الشخصيات ، الكاتب يُقدم نصين تحت عنوان واحد ( الجدار) ، النص الأول قصير جدا لايتعدي سوي ثلاثة سطور ، يكشف فيه عن أزمة نفسية يعيشها بطل القصة ، حيث (انه يري فيما يري النائم ، أنه في زنزانة ضيقة نتنه ، كان يقف فيها بصعوبة ،والمسامير تأكل من جسده ، فتهطل دماؤه سوداء ، ويصرخ فلا يسمع لصوته صدي ، ورأي حية رقطاء تلتف حول عنقه ، وتهم بغرس أنيابها في حبل الوريد ، وقبل أن تفعل ذلك استيقظ من نومه فزعا ، ودفع غطاءه ، لكن الغطاء استحال إلي جدار ) هذا هو النص الأول كاملا
وكما نلاحظ أنه - برغم قصره الشديد - نص محكم ، بمعني أن هناك شخصية وهناك حدثا تتعرض له الشخصية ،وهناك أزمة ، وهناك دلالة ، فمن الممكن أن نفهم أن تلك الزنزانة تمثل المجتمع كله ، وأن الغطاء الذي تحول إلي جدار ، إنما هو يشير إلي فكرة افتقاد الحرية في مجتمع قاتل ، يشبه الحية الرقطاء ، التي تلتف حول العنق ، وتمص الدماء ، ذلك المشهد الفانتازي القصير ، في النص الأول ، استكمله الكاتب بنصه الثاني - وبنفس العنوان - بضمير المتكلم ، أي بضمير الشخصية الرئيسة في النص الأول ، والتي قدمها بضمير الغائب ، اعتماده - هنا - علي ضمير المتكلم ، جاء متفقا مع طبيعة التجربة ،لأننا في النص الأول ، لم نكن نعلم عن تلك الشخصية شيئا ، لكن الكاتب ، قدمها في نصه الثاني شخصية حية ، واقعية ، وجعلها تتفاعل مع المحيط الخاص بها تفاعلا كشف عن طبيعتها ، وأفصح عن أزمتها ، بل كشف من خلال كل ذلك ، عن أزمة مجتمع ، لا يحفل بالفرد ، بل يجعله يواجه الظروف المحيطة به بمفرده ، بدون أن يتيح له حرية الحركة ، وحرية التفكير ، وحرية الإرادة ، فحين يقرأ رواية (الفراشة )
- 5 -
يهدأ قليلا ، لأنه طمئن نفسه ، بأن فرنسا - نفسها - تغتال الأحلام ، انه تبرير لتهدئة موقفه تجاه مجتمعه ، الذي لا يتيح للفرد ، أن يحقق أحلامه ، بحرية ، أن يعيش حياته بحرية ، وللقارئ أن يصل إلى المعاني التي يريد أن يصل إليها ، فالقصة أعطته ، وأتاحت له الفرصة للوصول إلى التفسير الذي يتوافق مع مواقفه ، وثقافته ، ومزاجه النفسي . فإذا كان شخص القصة في النص الأول قد شعر بأن الغطاء قد تحول إلى جدار ، يحول بينه وبين الحرية ، فان الجدار في النص الثاني ، جلب أنينا كان يسمعه - من خلفه - ولم يسمعه غيره ، ولذلك يتهمه المقربون منه بالجنون ، وبضرورة أن يعالج نفسه ، بأي طريقة ، لكن طرق العلاج جميعها تفشل ، لأنه وحده ، يعلم أن وراء الجدار أنين مكتوم ، لن يختفي صداه إلا باختفاء الجدار ذاته .. ولذلك حمل شخص القصة معولا هوي به علي الجدار ، ليحطمه .. تمرد طبيعي علي واقع ، يسلبك حريتك ، في أن تحيا كما تريد ، وتتنفس كما تشاء ، لا أن تكون عائشا بإحساس السجين ، هذا هو المعني والدلالة التي أعطتها القصة لنا ، بشكل طبيعي ، وبسيط ، وبلغة شفافة ، غير زاعقة ، برغم ذلك الضمير الذي من الممكن أن يجعل تجربة - كهذه – تبدو وكأنها تجربة ذاتية ، لكن هذا الأمر لم يحدث لأن الكاتب ( عبده خال ) يعرف كيف يُسيطر علي ضمير المتكلم سيطرة فنيه كاملة ..
إن اختيار الموضوعات الجديدة الجيدة - كما أشرت - تُعد علامة من علامات التجديد في مجال القصة القصيرة في السعودية ، والولوج إلى مناطق لم تكن القصة السعودية تلج إليها ، فضل يُحسب للكاتب ولا شك ، بل ويحسب لكل الذين يأخذون علي عاتقهم التعبير عن هموم الواقع ، والحديث عن اللحظة الحضارية الآنية بكل ما تحمله من منغصات ، نفسية ، وإنسانية ، وحياتية . وفي هذا الإطار نفسه تأتي قصة( البلوزة ) وهي قصة تتناول موضوعا ظل من الموضوعات المُحرمة في المملكة ، والتي لم يهتم كثير من الكتاب بتناولها ربما خشية من الرقابة ، وعدم النشر ، وأعني بالموضوع ( الحرمان الجنسي ) الذي من الممكن أن يعيشه الفرد في مجتمع ، يضع القيود الصارمة ، والقوانين الرادعة التي تُحاسب أي مارق ، أو خارج عليها ..
والقصة تذكرنا بتمثال ( جالاتيا) الذي صنعه ( بيجماليون) في محاولة منه للتأكيد علي قدرته علي خلق امرأة بيديه ، وتكون أجمل امرأة ، لأنه هو نفسه خالقها !! امرأة أجمل من كل النساء ، متحديا في ذلك النساء اللاتي اتهمنه بأنه لا يشعر بوجودهن !! ونراه يقع في حب التمثال الذي قام بصنعه ، برغم أنه تمثال حجري ، لا حياة فيه ، ولا روح ، ولذلك نراه كل ليلة ، يحتضنه ، ويبثه أشواقه ، لعله يستجيب ، ولعل جالاتيا ، تصبح امرأة حقيقية من لحم ودم ، وحين يفشل في ذلك ، يلجأ إلي إلهة الحب ، طالبا منها أن تنفخ الروح في تمثاله الحجري ،وبالفعل تستجيب الآلهة لطلبه ؛ ،فيجد التمثال يلين بين يديه وتصبح ( جالاتيا ) أنثي كاملة .. وبطل قصة ( البلوزة ) التي كتبها ( عبده خال) يفعل نفس الشيء ، لكن الدمية تظل دمية كما هي ، لأنه لا يستطيع أن يُخاطب ربة الحب ، كما فعل بيجماليون ، فتلك كانت أسطورة ، وما يحكيه البطل- هنا- واقع وليس أسطورة من الأساطير ، لذلك يظل تمثاله حجرا ، وتظل دميته ، دمية ، وان حاول أن يجعلها بكل الطرق، حقيقية ، أو علي الأقل تشبه تلك الفتاة التي رآها في المغسلة ، حين أتت إليه بملابسها ليقوم بغسلها ، ومن يومها لا يستطيع فراق صورتها ، ولا نسيان رائحة عطرها !!
، لقد حاول أن يجعل دميته تتكلم ، فقام - خفية - بتسجيل صوت الفتاة حين أتت إلي دكانه مرة أخري ، وقام بتركيب الصوت ووضعه بجانب دميته ، ليجعلها تتكلم ، ويعيش خياله وكأنه واقع، وحين ظلت تلك الملابس لأكثر من شهر ، أحضرت معها رجلا ، زجره ، وطلب منه سرعة تسليمه للملابس ، وهنا يسقط حلمه ، ويرتطم علي أرض الواقع ، ( تشاغلت يده بتعرية الدمية ، كوم البلوزة ، والتنورة في صدره ، تهاوي فجأة ، شعر بالذوبان ، ونار حامية تصهره ، فأخذ يشهق بالبكاء ..) ..
وقصة ( البلوزة ) تعتمد علي أسلوب الحكاية
- 6 -
- أحداث وشخصيات - ، ويعكس الكاتب - من خلالها - جماليات متعددة ، علي مستوي اللغة ، وعلي مستوي المعالجة ، فعلي مستوي اللغة ، نجده لا يُسرف في تفصيلات ، ترهق القارئ، ولم يلجأ إلي الحشو الزائد أو الاستطراد ، أو الوصف بصورته التقليدية ، أو المباشرة ، وكلها من خصائص القصص القديم أو التقليدي - بمعني أصح - انظر إلي اللغة التي جاءت في سطور القصة الأولي ، ومن خلالها يضعنا مباشرة مع شخصية الفتاة التي ملكت فؤاد راوي القصة وبطلها :
"تعبره كل يوم فتعمق في شغاف قلبه أخدودا من الوله،يتبع ممشاها فتسيل رغبته ويزداد توتره . تصليه حمم جسده ويفور ..يفور ..يفور بعجلة يبلله طوفان الرغبة،يغرقه في ماء آسن ويذوي قبل أن تغادر عينيه،يذوي ككلب ركض وركض فلم يكن نصيبه إلا نصف ظل ولهاث مديد .اليوم وقفت على باب مغسلته"
انه يقوم بتقديم شخصية القصة مباشرة ، وتلك جمالية من جماليات القصة الجديدة ، تلك التي تمردت علي التمهيد التقليدي للحدث أو التمهيد المُسرف للشخصية !!
وهو علي مستوي المعالجة يلجأ إلي استخدام حيلة التذكر ، والاستدعاء - استدعاء الشخصية من الخيال - حين نراه يتذكر تلك الفتاة الريفية ( خضراء) التي يريدون منه أن يتزوجها ، بينما تمتلكه صورة الفتاة التي أتت إليه في المغسلة ، تلك التي شدت انتباهه ، وحركت مشاعره ، ونشطت خياله الجامح !! وهنا يلعب الوصف لعبته ، حين يقارن بينها وبين فتاة القرية :
قفزت (خضراء) أمامه،فتاة بائسة امتص الجوع عودها،وجرى العطب بين راحتيها من مسكة المنجل وجرف سيل الانتظار جبلي صدرها اللذين كانا ينهضان لمقدم من زرع في مخيلتها رغبة الوقوف عليهما،غدت فتاة مهدمة،تقول الرسائل القادمة من هناك :
- خضرا تقترب من الثلاثين وهي لازالت تنتظرك ..حرام عليك لم تعد صالحة للزواج إلا بك
سقطت كل ذاكرته حينما لوت عنقها باتجاهه"
بينما تلعب نفس اللغة لعبتها وبنفس درجة إجادة الوصف الدقيق الجيد حين يتحدث عن فتاة الحلم ( تقف السيارة أمام المغسلة تماما ، في هذه اللحظة (بالذات ) تكون عيناه منفتحتين على اتساعهما فحين تدفع الباب تظهر ساقاها نافرين من تلك الغلالة السوداء فتبين قدمان ممتلئتان مستديرتان تنتهيان بحذاءين يتغيران كل يومين أو ثلاثة ثم يستقيم عودها طاعنا الفضاء بقامة فارعة رطبة، تلملم عباءتها على صدرها مخفية ثمرتين نادرتين في استوائهما ..أصابع يديها ناعمة مرتوية كالأقلام الفاخرة تنتهي بأظافر مدببة منسابة أبقت على مداد قاني الاحمرار. تعبر الرصيف تاركة جسدها يُراقص الهواء والأمكنة بينما تتوقف رائحتها لتحرس مشيتها وتثبت الأمكنة في مواضعها كي لا تتساقط حجارتها كمدا على اختفائها،في كل هذا الارتباك يزهر بمقدمها بيت واحد إذ تدس فتنتها في بوابته الواسعة فيضمها ويعبس للدنيا مغلقا ردفيه ".
والمجتمع الذي ربما ينظر إلى الرجل الذي لا يستطيع الإنجاب ، نظرة شك وريبة ، كان موضوع قصة ( عصفور الزينة ) فالمرأة من وجهة نظر هذا المجتمع الُمزعج ، المرأة غير القادرة علي الإنجاب ، تُصبح كعصفور الزينة ، مجرد ديكور ، جميل ، ولا أكثر من ذلك ، ولذلك نري الزوج المُحب لزوجته ، والمستهجن لكل رجل يُقدم علي إهانة المرأة ، ذلك الرجل ، يُقدم علي إهانة زوجته ، ضاربا ما يؤمن به عرض الحائط ، لأن رغبة الإنجاب ملكته ، وأصبحت هي الرغبة القوية ، حتى أن الحب تلاشي ، وانزوي الحنان ، في زاويا الحزن ، والاتهام ، والمرأة في تلك القصة امرأة محبة بالفعل ، لكنها عاجزة عن تحقيق ما يتمناه الزوج، وتلك أزمتها الفعلية ، وعندما تتعرض للإهانة من الرجل الذي تُحبه بجنون ، تصفع باب شقتها وتخرج منه ، متمردة علي تلك الإهانة ، ويذكرنا فعلها بفعل نورا في مسرحية ( هنريك ابس) النرويجي ، حين صفقت -هي الأخرى - الباب ، وتركت بيتها بعد أن شعرت بأنها مجرد دمية في البيت ، هنا تشعر المرأة أنها مجرد عصفور للزينة داخل البيت ، ومن ثم ، تترك البيت لأن صاحبة لم يحترمها كامرأة ، تلك فكرة جديدة ن ثورية ، لأنك حين تجعل تمرد المرأة يأخذ مداه في مجتمع ، لا يحترم هذا التمرد ، حتى ولو كان صاحبه علي حق ، فانك بهذا الطرح ، تكون ثوريا ، وتكون قد وجهت لذلك المجتمع القامع صفعة قوية ، ربما لن يغفرها لك ، أتحدث هنا عن الكاتب ، تلك مسؤولية الكاتب الملتزم ، بقضايا مجتمعه، وبقضايا قومه ، وناسه . شخص القصة حين واجه تمرد زوجته المُحبة ، وكانت علي حق ، علم بقيمتها كامرأة، ولم يكن يتمني أن يقوم بإهانتها أمام صديقتها متعمدا ذلك ، قائلا لها أن العطر الذي تضعه يخنقه ، وعليها أن تغيره ، في حين أن الصديقة تثني عليه ، بل وُتبدي إعجابها باختيار ذلك العطر .. إن العطر هنا مجرد أداة للإهانة ، وتلك الإهانة هي التي فجرت ذلك الغضب الذي لم تستطع المرأة في القصة أن تفعل شيئا تجاهه غير الرحيل من البيت ، وشعور الزوج بالوحشة ، هو الذي جعله يتمني أن يجدها تقف علي الباب من جديد - كما كانت تفعل - وتجذبه لحضنها ، وتناوله كأس الماء الذي يتجرعه منذ عشرين عاما – مدة الزواج – سواء كان في حاجة إليه أم لا .
وعلي الرغم من أن الكاتب ( عبده خال) يُعد من الكُتاب القلائل الذين يهتمون باللغة القصصية ، ويبعدونها عن منطقة المباشرة والخطابية ، إلا أنه في هذه القصة ، وقع في دائرة المباشرة في بعض مناطق القصة ، ربما بسبب أن القصة تدور وقائعها ، اعتمادا علي ضمير المتكلم ، وهو ضمير - كما سبق وأوضحنا - يمكن أن يتحول للإفصاح عن صوت الكاتب ، إذا فاته ذلك أثناء الكتابة ، انظر مثلا إلى عباراته تلك : " الرجال أشبه بحلاقين تجري شفار ألسنتهم علي جلود النساء ، من غير اكتراث ، ولو جري الدم لا يكلف الواحد منهم إزالته بكلمة اعتذار رقيقة " أو قوله " المرأة أشبه بمنشفة بالية يدسونها في المطابخ أو في غرفة مغلقة حيث يدلقون عليها الدنس بسرية تامة " وقوله : " ما بالنا نري كل النساء جميلات ، فيما عدا زوجاتنا؟!" .. هذه العبارات تُعد حشوا زائدا عن الحاجة ، وتُؤثر في جماليات التشكيل .
وعن البطالة والمحسوبية يكتب قصته ( الذباب) ، ويتناول جمالية فنية أخري ، باعتماده علي بنية الحوار ، ليكون بديلا عن السرد القصصي ، بحيث انك لا تستطيع أن تشعر بملل متابعة الحوار ، لأنه ليس حوارا مسرحيا مثلا. والحوار في تلك القصة يعكس حسا كوميديا راقيا ، لأنه يكشف المفارقة ، ويكشف طبيعة الشخصية المتكلمة .. ويكشف طبيعة الحدث ذاته.
واهتمام الكاتب بفضح بعض جوانب الفساد في مجتمع يدعي الفضيلة ، ويدعي بأنه يدافع عنها ، يُعد هذا الاهتمام ، من الجوانب الإيجابية ، التي تُحسب لكاتب القصة ، لأن القص القديم لم يكن يهتم بخاصية الكشف ، والفضح ، باعتبار ذلك من المحرمات التي تواجه تعنت السلطات وغضبها ، وربما دفعها ذلك إلى ممارسة الرقابة ، وممارسة حق المنع ، لأن التناول جاء ضد ما تريده .. وفضلا عن اهتمام الكاتب بفضح المحسوبية ، فانه يكشف - أيضا - أن بعض النساء ، في ذلك المجتمع المُغلق ، يقمن بهذه الوساطة ، اعتمادا علي أنوثتهن ، فعلي الرغم من أن والدة الشاب الذي تريد توظيفه ، امرأة محافظة ، وتعلم أن جارتها لها معارف من الرجال ، وكانت تستريب منها ، وتبتعد عنها ، إلا أنها أمام الحاجة الماسة لتوظيف ابنها ، تتنازل عن هذه الكراهية ، والاستهجان - ولو مؤقتا - من أجل تحقيق هدفها " كانت والدتي تستريب من جارتنا تلك ، بسبب كثرة معارفها ، وتبرج لسانها غير متورعة عن ذكر إعجاب الرجال بقوامها الهارب من غلاله ، ومدعية أن عيونهم ترف بين نهديها الشامخين ومقسمة أن أحدا لم يجرؤ علي بناء عشه علي قمتهما ، حين تشيح عنهما عباءتها في محاولة إغواء صغيرة " .. مثل هذه العبارات ما كانت تسمح بها السلطات في ذلك المجتمع المغلق ،وربما لا تسمح بها الآن باعتبارها تضمن ألفاظا خارجة ، من وجهة نظر مجتمع محافظ ، لا يريد كشف عوراته ، باعتبارها من الأمور الخاصة التي لا يجوز فضحها ، يتستر علي ذلك ، في حين أن كل شيء ربما يدور في الخفاء ، والقصة ، أخرجت الأشياء الخافية ، ووضعتها أمام القارئ ، لكي يري من خلالها ، ما يدور في مجتمعه ، وربما لايراه بشكل واضح . القصة تضع الإنسان أمام نفسه ليراها ، وأم الراوي في هذه القصة تُحب ولدها ، ولاتحب أن يفشل كما فشل أبوه - من قبل - ولذلك نراها تلجأ إلى تلك الأساليب الملتوية ، في مصادقة تلك المرأة التي تُعد - من وجهة نظر الأم - امرأة فاسقة ، ولكن لامانع من مصادقتها ، إذا جاء ت تلك المصادقة بفائدة لابنها ، ذلك الموقف الانتهازي ، من المواقف التي كشفها الكاتب هنا ، وجعلنا نتأملها ، ونمعن فيها النظر ، ولقد لجأ الكاتب إلى حيلة فنية بسيطة ، أشار - من خلالها - إلى موقف تلك الأم من زوجها الذي مات ، الموقف الذي يتمثل في إدانتها له ، وذلك من خلال تكنيك الاستدعاء ، حيث يستدعي الشاب أثناء وقوفه الملول أمام الضابط الذي سيساعده في أمر توظيفه ، بناء علي كارت توصية المرأة ، استنادا إلى اللغة أيضا ، نراه يقول:" عدت أحدق في ذلك المكتب الواسع ، واتمني لو أنني أستطيع أن أتحرك ، لأهرب من هذا الموقف ، كنت أفكر جديا في ترك مكتبه ، وكلما هممت بذلك تداعت إلى مخيلتي صورة أمي التي ستصفني بأقذع النعوت ، لو أخبرتها بنكوصي ، وستذكرني بكل ما صنعه أبي معها ، وقد تتمادى في ذلك، وتنعتني ب( ذيل الكلب) .. قد ضقت ذرعا بها ، وبتذمرها وتذكيري الدائم بما جناه أبي علي حياتها ، وما خلفه من حرائق لم تطفئها عظام أبي الرميمة " .. وهكذا يستدعي الكاتب الماضي ليتماهي ويذوب في الحاضر ، ليصبحا معا نسيجا واحدا ، لا تستطيع الفصل بينهما ، هذا التكنيك ، ساعد كثيرا في حل الُبعد الزمني في القصة ، ذلك البُعد الذي لا يمكن أن يكون ممتدا أبدا ، بل ينبغي أن يكون وحدة واحدة ، هنا يصبح الامتداد الزماني مبررا فنيا لوجود أداة الاسترجاع ، فيبدو أمامنا وكأنه تيار شعور البطل حين تواجهه أزمة في اللحظة الراهنة ، فيتذكر ، ما يشبهها في الماضي ، سواء كانت الأحداث متعلقة به ، أو متعلقة بغيره .
وهذه القصة تُعد نموذجا كاشفا لقدرة الكاتب علي رسم الشخصية ، من خلال مواقفها وليس من خلال وصفها الخارجي ، كما كانت تفعل القصة التقليدية ، فنتعرف من خلال المواقف ، والانفعالات ، والصراع ، علي شخصية الضابط ، فنراه متعجرفا ، مختالا، ملولا ، بليد الحس ، جاف المشاعر ، يمتلك قدرا كبيرا من الصلف ، كل هذه الأوصاف ، لم نتعرف عليها بشكل مباشر ، بل تعرفنا عليها من خلال المواقف ذاتها ، والقصص الجيد هو الذي يفعل هذا..
وفي نفس إطار فضح الواقع الاجتماعي للمجتمع الُمغلق ، تأتي قصة ( جارتنا الصغيرة ) ، وموضوعها لا يختلف كثيرا من حيث جرأة التناول عن سابقه في قصة ( الذباب) ، والموضوع يدور حول ما يحدث ليلة الزفاف ، في المجتمعات الشرقية ، يُحاكم الكاتب - من خلاله- التقاليد العربية التي تُجبر الرجل الشرقي التقليدي ، أن يقهر أنوثة المرأة في تلك الليلة ، بصرف النظر عن مشاعرها ، ويقوم بقمعها ، بصرف النظر عن المشاعر الإنسانية التي تتطلب منه الانتظار ، إذا واجهته موانع نفسية ، أو واجهت الطرف الآخر ، ولذلك يلجأ إلى ممارسة فحولته ، ليؤكد للناس أنه قادر ، وأنه رجل بحق ، ,انه ذكر ، بصرف النظر عن الآلام النفسية ، وربما العضوية - وهذا ما حدث مع المرأة في هذه القصة - التي سيسببها للطرف الآخر الضعيف ، فالعروس الصغيرة وجدت نفسها بين يوم وليلة في أحضان رجل اشتراها بتلك العمارة التي وهبها إياها في مقابل موافقتها علي الزواج منه ، ولو كان الأمر بيدها ، لرفضت ، لكن أمرها بيد والدها؛ الذي أعتبرها مجرد سلعة ، من حقه أن يبيعها ، ومن حقه أن يشتريها !! وعلي الجانب الآخر هناك جار متزوج - راوي القصة - كان مُعجبا بتلك الجارة الصغيرة ، وكان يتطلع إليها خلسة ، ونراه - في نهاية القصة - يُرسل لها ابتسامة ، ويغمز لها بعينيه ، ونراها تستجيب له ، وتشير بيديها أن ينتظرها ، وهذا الذي يحدث من تفسخ اجتماعي ، وربما خيانة زوجية ، في المستقبل ، سببه ذلك الُركام من التقاليد التي لا تُبيح للمرأة أن تختار ، وتُعطي للرجل – وحده - حق الاختيار ، وأيضا حين يختار هو ، فانه يختار الجميلة ، الصغيرة ، لأنه يملك ، بمعني آخر يشتريها .. العواطف والمشاعر في حالة غياب ، وبسبب هذا الغياب تتولد القيم المهترئة ، وتنمو قيم الرذيلة ، وكما هو واضح فان موضوع القصة ، يوجه نقدا لاذعا للتقاليد الاجتماعية ، التي تجعل النساء مجرد متاع ، أو وسيلة للمتعة فقط ، وتدين - في الوقت نفسه - المجتمع الذي يشجع هذا السلوك ، وتُقدم صورا للتفسخ الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه بعض الناس في مجتمع مُغلق علي ذاته ، وأسلوب التناول يتميز بجرأة ، وصدق . أنظر إلى تلك العبارات لتتعرف علي مقدرة الكاتب علي ألا يمتثل للتقاليد التي ربما تمنع نشر قصته تلك ، داخل بلاده ، بسبب الألفاظ التي جاءت فيها ، وهذه الألفاظ ، ليست لذاتها ، بل لضرورة ، استلزمت وجودها بحق " كان خبر العروس غامضا ، حيث قيل إن بكارتها ، استعصت علي زوجها ، مما حمله علي وكزها بقوة جعل الدم يتدفق بغزارة ، وعلقن المسنات علي هذه الحكاية ، بأن فتيات هذا الزمان ارق من ورق السلوفان ، لكن هؤلاء المسنات سحبن هذا التعليق ، واستبدلنه باللوم علي رجال هذا الزمان ، الذين يبحثون عن البكور ، ليذيقهن فحولة رخوة لا تقيمها إلا أصابع اليد !! " وأقرأ أيضا تلك العبارة : " فروت ليلي - جارتها الملاصقة - انه استبدل عضوه بإبهامه ، وأخري - زوجة من قام بنقله إلى المستشفي- روت أنه اندفع علي المسكينة كحيوان كاسر فجر القناتين ، وجعل مجراهما واحدا " .
واستفادة من أسلوب الفنتازيا في المعالجة الفنية ، تأتي قصة ( آآآآه ه ) ، حيث يواجه بطلها موقفا غريبا ، كان بمثابة اللغز بالنسبة له ، وهو أن كل من يراه يضحك ، هذا هو موضوع تلك القصة ، ومن الوهلة الأولى ربما تري أن الموضوع لا يستحق ، لكن الكاتب استطاع عن طريق التواتر اللغوي ، أن يكشف حجم المأساة ، والمعاناة التي يعيشها ذلك البطل الذي لا يعرف سببا لسلوك الناس تجاهه ، في الشارع ، في البيت ، في مكان العمل ، حتى بواب العمارة ، كل من يقابله يضحك .. ( شيء ما يحرك هذا الضحك الأرعن ، فكلما أطليت بوجهي في أي اتجاه ، وجدت تلك الضحكات تتسع وتتمدد ، تتمدد ، وتستحيل إلى أزيز ينخر رأسي ، وعبثا حاولت معرفة سر تلك الضحكات) .. ولذلك نراه يتأمل نفسه ، ليصل إلى حل اللغز ( تفحصت وجهي ، كان وجها صقيلا لامعا ، تتقافز منه ملاحة لذيذة ، فالأنف مستقيم باستقامة رهيفة يطل زاهيا علي شارب كث ، وفم مغلق ، لا يتسع للقمتين في آن واحد ، وله وجنتان منبستطان كأرض ممهدة تقف في أعلاها جمجمة مستوية ، يهفهف من فوقها شعر ناعم غارق في لونه البني الداكن ، وثمة عينان يشع منهما ذكاء حاد يشي أن صاحبه يخترق الحياة بيسر وثقة .. الخ)
هذا الوصف الدقيق كان من الممكن أن يصيب القصة في مقتل ، لو أن الكاتب ذكره في سرد تقليدي ، أو ذكره في السرد القصصي علي لسان الراوي ، كما كان يحدث في القصص التقليدي ، لكنه لجأ هنا إلى حيلة فنية ، هذا الحيلة خرجت وولدت من طبيعة الموقف ذاته ، فكيف تتصور شخصا يواجه فعلا كهذا أن يفعل ، لابد أنه سيتأمل نفسه ، وينظر إلى شكله ومظهره ، هذا ما فعله شخص القصة بالضبط ، ولذلك اصبح المباشر غير مباشر ، وأصبح الرصد رصدا فنيا ، وليس رصدا خارجيا ، وأصبحت متابعته الشخصية لذاته ، جزء من التجربة ، وجزء من انفعالات الشخصية ، وليست خارجة عن كل هذا ، ذلك التناول يكشف أن الكاتب علي وعي تام باستخدام جماليات جديدة ، في المعالجة، هذه الجماليات تتخلق أثناء الكتابة ، ومن الموقف ذاته ، وليست سابقة علي حالة الإبداع ، بل متزامنة معها ، ومتماهية فيها ..
والفنتازيا ، ذلك الإطار الذي دارت داخله التجربة ، جعلتها أقرب إلى الأحلام ، أو الكوابيس ، لكن الفرق - هنا - أن الكاتب مزج الواقعي بالخيالي ، مما اكسب التجربة طعما متميزا ، وخاصا لم تستغرقه الفنتازيا ، ولذلك لم تُفلت منه الفكرة التي أراد أن يقدمها للقارئ .. ومؤداها : أن الإنسان ربما يشعر باغترابه - أي أنه غريب - في العالم المحيط به ، وفي نفس الوقت لا يستطيع الوصول إلى أسباب اغترابه ..
وهذا السرد الغرائبي يُميز كتابات ( عبده خال) ، وكذلك المنحي التعبيري نجده متوفرا في هذه القصة وقصص أخرى من القصص السابق الشارة إليها - في هذه- الدراسة - ذلك الذي يأتي مُعبرا ( عن حالة خوف أو قلق أو إحباط ، ينطلق منها ، ولكن دون أن يكون سببها عثرة سيكولوجية متعلقة بنفسية البطل ، إن الصورة التعبيرية قد يبدو فيها البطل في حالة خوف من خطر مبهم دون أن يرجع هذا الخوف إلى سبب حقيقي مؤثر ، وهذه الأحاسيس والهواجس يكون مردها حالة احتياج إزاء عدوانية خارجية )
- 7 -
وعلي حد قول الدكتور نعيم عطية ، حين تحدث عن المؤثرات الأوربية في القصة القصيرة في مصر ، انه يري أنه مع التيارات الحديثة في الفن والأدب- بصفة عامة- تركنا الشواطئ الآمنة ، وخرجنا إلى بحار تبتلع فيها الدوامات اعتي المراكب ، وتلوح جزر لا يلبث أن يبين ألا وجود لها في مواضعها التي بدت للملاحين . لقد تركنا شواطئ (العقل النفعي) ، الذي يتعقب الأحداث في تتابعها الزمني ، ويتقصي لكل فعل عن سبب مبرر له ، ونتائج تترتب عليه ، وفق قوانين صارمة ، ومن خلال ميكانيكية العقل الذي أرساها ، تركنا شواطئ اليقين إلى الحدس ، والهواتف ، وشفرات من عوالم أخري ، وشطحات الخيال ،والحلم ، وتيارات الشعور ، والذكريات الموغلة في القدم ، لاسترجاع شذرات حتى مما جري في الرحم ، والكتابة التلقائية ، وممارسة الجنون والسحر ، والعودة إلى الطفولة ، وتقمص حيوات أخري ، من أجل كسر الحاجز الذي يخنق الحياة الإنسانية ، لاكتشاف السور ، ولو أدي ذلك إلى الكسر.. إلى الطوفان ..
ولذلك نلاحظ أن أنفاس القاص تلاقت مع أنفاس الشاعر في قصص ( عبده خال) ..
اقرأ هذه الفقرة لتتعرف علي ما ذهبت إلى شرحه: ( لم يعد أمامي إلا أسئلة أنشئها وأنقضها،فأغلقت كل المنافذ التي توصلني إلى الخارج فبعد متابعتي للتلفاز أيقنت أن مؤامرة تحاك ضدي،فقد كان فم المذيع يفتر عن ضحكة صامتة كلما تلاقت عينانا بالرغم من أنه كان يتلو فاجعة حلت بإحدى العواصم..ساعتها أيقنت بأنني دخلت مرحلة خطيرة وأن عناكب تغزل هواجسا وتشرعها أمام بصري وأيقنت بأنني مقدم على انهيار عصبي سيؤدى بما تبقى لدى من جلد . في بادئ الأمر كذبت عيني وأخذت أتربص بالمذيع بين فترة وأخرى فلمحته يمد لسانه ويرفع يديه إلى أذنيه ويهزهما كجناحي عصفور يهم بالتحليق فأسرعت غالقا التلفاز وكدت أن أجهش بالبكاء ولكنني تمالكت نفسي وأخذت أتحدث بصوت مرتفع لاقناعها بأن ما يحدث أوهام عشعشت وشاخت بمخيلتي لا غير، ولكي لا يتجدد يقيني فقد امتنعت عن مشاهدة التلفاز وأصبحت حبيس جدران غرفتي ..)
وبنفس السرد الغرائبي ، القريب من قصص الواقعية السحرية ، تلك التي توغل في عمق الأسطورة ، وربما تستقي من عوالمها ، روحها الأخاذة ، اللافتة ، تأتي قصة( نبت القاع)
- 8 -
للقاص ( عبده خال) ، لتبدو أمامنا ، بأسلوب سردها الغرائبي وكأنها حكاية شعبية ، مما يروي ، في تراثنا ، لكن القصة ، ليست مستقاة من القص الشعبي .. من الممكن أن يكون هناك تقابل بينها وبين ما هو متعارف عليه من صيغ القص الشعبي .. الغرائبي .. الفنتازي ، العجيب ، الذي يسلبك لبك ، ويُنشط في ذهنك مناطق الخيال ، وينقلك إلى عوالم أخري ، ربما كوسيلة للهروب من شيء ما ، غامض ، أو محدد ، فتلك المرأة التي ظلت تنتظر زوجها البحار منذ رحل ، وهي تؤمن بأنه سيعود من نفس المكان الذي رحل منه ، والمكان هو سقف حجرتها ( في كل عام تمضي مواسم الأمطار ، مخلفة حلما قديما شاخ بذاكرة تلك المرأة التي لم تيأس من عودة زوجها ، الذي خرج ذات ليلة ولم يعد ، فقد حكي لها قبل اختفائه أنه رأي نسرا قويا يخطفه ، ويُحلق به في الفضاء ، ويقذف به في عتمة البحار النائية ، وبعدها بليلة واحدة ،وبينما كانت نائمة أحست بشيء يتحرك من حولها ، وينفرج سقف غرفتها لتلمح زوجها معلقا في الفضاء ، كطائر عملاق يخفق بجناحيه بشدة ، صوب البحر ، كانت تظن أنها تحلم فأغمضت عينيها ، وواصلت نومها ، وعندما أفاقت وجدت جزءا من سقف غرفتها منبعجا ولم تجد زوجها )
وهذه المرأة تعيش - نتيجة لما حدث - حياة بوهيمية ، وتؤمن بأن زوجها سيعود من فتحة السقف ، ولذلك نراها لا تقوم بإصلاحها أبدا ، تتصرف وكأنها امرأة مجنونة ، ولا يستطيع ولدها البالغ من العمر ثلاثين عاما أن يُبعدها عن ما تؤمن به .. إلى هذا الحد والحكاية تبدو محدودة ، لكن الكاتب آثر أن يضيف أبعادا غرائبية أخري ، أو أراد أن يلهب حواس المتلقي أكثر ، لاستقبال حكاية أسطورية ، مكتملة ، حين وضع الابن في حالة مشابهة لحالة الأم بعد أن قابله ذلك الصياد ، الذي أبلغه بأن أباه موجود وسيعود ( تناول كأس شاي فارغ وصب به من مائه ، ورفعه إلى فمه ، وأخذ يتمتم عليه ، وأدناه من عيني لألمح رجلا يجلس في قارب يغزل شراعا بمهل ، وإتقان ، وقد أصابه الضمور ، كنت أحدق بدهشة ، ولم أفق إلا علي صوت البحار السوداني وهو يقول : هذا أبوك انتظره .. سيعود من البحر كما ذهب إليه ) بعدها لم يستطع الابن أن يعيش في أمان ، وصار حاله أشد من حال أمه ، إذ كان الدوار يصيبه بشدة لدرجة لا يستطيع معها أن يسيطر علي نفسه ، وتنتهي القصة وقد رأي نفسه وقد ابتلعته دوامة كبيرة ، ويلمح البحر يقذف بأمواجه ، ويسعي في الشوارع يدخل البيوت ، ويسحبه صوب جثة انتفخت علي سطحه ، ليسحبها ويتلاشي معها في القاع .
فكرة الانتظار ، انتظار مالا يجيء ، ذلك الذي يمكن أن يُهلك المنتظر ، تلك الفكرة هي ما تشير إليه تلك القصة ، انتظار مالا يجيء ، كما حدث لشخوص بيكيت العبثيين ، هؤلاء الذين كانوا ينتظرون ما لا يجيء .. ما هو الشي الذي لا يجي ء .. ؟؟ أي شيء ، تشعر به ، وترغبه ، وتتمناه ، وتخاف منه ، وأنت في انتظاره ، تعيش حالة من الرعب ، وحالة من الفزع اللانهائي .. السرد الغرائبي - كما ذكرت - سيطر سيطرة بالغة علي القصة ، ومعالجة الموضوع ، والكاتب كان متأثرا جدا ، بذلك السرد الذي وجدناه عند ماركيز - علي سبيل المثال – خاصة في قصصه القصيرة - فحين نقول واقعية سحرية ، فهذا معناه أن الواقع حاضر ، كما أن السحر حاضر ، إذن هو اختلاط بين الواقعي واللاواقعي ، اختلاط بين المتحقق ، وغير المتحقق ، اختلاط الملموس ، وغير الملموس ، واقعية سحرية ، لكنها يمكن أن ترمي إلى همومنا العربية ، تلك التي تجعلنا في حالة انتظار دائم ، لشيء ما ، ربما يكون في هذا الشيء سعادتنا ، وربما يكون في هذا الشيء تعاستنا ، وربما يكون فيه هلاكنا ، لكننا مع ذلك ننتظر ، وسنظل .
ولقد مزج الكاتب بين ضميرين في هذه القصة : ضمير الغائب وضمير المتكلم ، بحيث انك لا تستطيع التفريق بين الضميرين ، مما أعطي إحساسا ، أن أزمة الشخصين واحدة ، الراوي ، والبطل ، لافرق ، الأزمة التي تبدو متعلقة بشخص ما ، نجدها خاصة بشخص معين بعد متابعتنا للأحداث ، وهذا المزج ، يُعد أداة جديدة من أدوات المعالجة المعاصرة في القصة القصيرة ، ويُعد جمالية من جمالياتها ، وبراعة في التشكيل لو أُحسن استخدامه .
هذا الجزء من دراسة طويلة ، اشتركت بها في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب الذي عقد في الشارقة بدولة الامارات العربية في نهاية الشهر الماضي يناير 2006 ، ولقد اكتفيت به ؛ حيث ان قصص عبده خال التي اعتمدت عليها في الدراسة منشورة في موقع القصة العربية .
¤ للتعرف أكثر علي طبيعة القصة القصيرة جدا ، وقراءة بعض النماذج التطبيقية لها ن يمكن الرجوع لكتاب ( إشكالية الشكل والرؤية في القص المعاصر) – أحمد عبد الرازق أبو العلا – الهيئة العامة لقصور الثقافة – 1997 مصر
1- يمكن مراجعة مقال القصة القصيرة في الخليج العربي والجزيرة العربية نشأتها وقضاياها الاجتماعية – د. نورية الرومي – مجلة فصول – الهيئة المصرية العامة للكتاب – المجلد الثاني – العدد الرابع – 1982 الصفحات من 239 إلى 256
2- فرانك أوكونور – الصوت المنفرد – ترجمة د. محمود الربيعي _ وزارة الثقافة – المكتبة العربية – العدد 99 – الترجمة 6 – 1969- الصفحات 21/ 22
3- عبده خال – من مواليد جازان -1962 من أعماله في مجال القصة القصيرة : حوار علي بوابة الأرض 1984- لا أحد 1986- ليس هناك ما يبهج 1988- من يغني في هذا الليل 1999- ومن أعماله في مجال الرواية : الموت يمر من هنا 1991- مدن تأكل العشب 1998 – الأيام لا تخبئ أحدا 2000
( من أقوال الكاتب عبده خال التي يمكن أن تضيء شخصيته كمبدع : إنني أؤمن أن الإنسان هو نص مفتوح من الأزل ينطوي على طابع التجدد لذا فان من هواجسه البحث عن الجديد، إذن كون الإنسان نصا مفتوحا وقابلا لان يتطور داخلياً، يعني أن النص الباحث عن التجديد هو فطرة طبيعية في الإنسان والذي يحد منها مطامع شخصية لفئة معينة تحد من الانطلاقة الطبيعية للإنسان وبالتالي تضع أمامه حواجز أو سدودا أو ترسم له طريقا محددا يسير وفقه. )
(إن مشكلة الحداثة في العالم العربي أنها اصطدمت بالعديد من المعوقات، فإذا آمنا أن الثقافة هي مغايرة للماضي نجد أننا نسير بذاكرة حافظة تحمل ماضيها حتى لو آمن الكثير منا بهذا التجديد أو هذا التحديث لكن هنالك من يسير باتجاه الحداثة ولكن بفكر ما ضوي.. إذن وقع نوع من الخلخلة في تمثل هذا الأمر، إضافة لذلك أن العالم العربي لا يتحدث بصوت واحد، فهو تارة يتحدث بقطرية وأخرى بإقليمية ولذا تجد بلدا هو أكثر حداثة من البلد الذي يجاوره.. بينما نجد نماذج لأمم أخرى وهي تتحرك كتلة واحدة، من هنا رأى الساسة أن مشاريعنا المستقبلية تسير بخطوة واحدة ونهج واحد يخص حالة كل بلد ونظرته وهذا كله كان له انعكاس واضح على الكاتب المحلي فمفهومي أنا للحداثة قد يختلف عن مفهوم مثقف آخر في المغرب أو في الأردن، وكذلك الاقتراب والابتعاد عن مراحل التحديث لها دور مؤثر آخر ..)
( حوار أجراه في إحدى الصحف)
4- عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة سنة 1973 ص12، ص17، ص41.
5- رواية (الفراشة) لكاتبها السجين الفرنسي (هنري شاريير (
والعمل عبارة عن يوميات حقيقية لذلك السجين دون فيها سنواته الطويلة الملوثة بالوحل الحضاري الأسود مستعرضا محاولات هروبه المتكر حتى خروجه من السجن نهائيا مستردا حريته ، وقد تحولت الرواية الى فيلم قام ببطولته (داستن هوفمن) و(ستيف ماكوين)
6- إن الموضوع القصصي هو الحكاية ذاتها ، تلك التي تتكون من أحداث وشخصيات ، ولا يمكن أن تكون هناك حكاية بدو نهما
7- د.نعيم عطية - مؤثرات أوربية في القصة المصرية في السبعينيات - فصول - المجلد الثاني - العدد الرابع 1982 صفحة 209
8- نُشرت قصة ( نبت القاع) في مجلة ( الراوي ) السعودية – العدد الأول – مارس 1998 ، واعتمدنا - هنا - علي القصة المنشورة في كتاب ( القصة السعودية المعاصرة ) اختيار وتقديم د.طه وادي – الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة آفاق عربية – العدد 57 سبتمبر 2002 – والقصة منشورة في الصفحات من 239الي 251 .. والقصص الأخرى التي تناولناها بالدراسة والتحليل هنا ، تم اختيارها من الانترنيت ، وبخاصة من موقع القصة العربية www.arabicstory.net
الملك ( عبد العزيز بن سعود ) الذي قام بإنشاء المدارس ، واهتم بتوفير المدرسين والمعلمين الذين وقع علي عاتقهم عبء تعليم أبناء الجزيرة ، وأيضا كان لوصول الصحف العربية في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، إلى منطقة الخليج دوره الكبير في ظهور هذا الفن ، خاصة صحف : الأهرام – المقتطف – الهلال – العروة الوثقي ..ومما عمل علي النهضة الثقافية ظهور الصحف والمجلات ، خلال الربع الأول من القرن العشرين ( 1900-1925) ، وكان لظهور الصحافة في السعودية دورها كوسيلة اتصال ، وممارسة للدور الثقافي والفكري لعدد من المثقفين ، ولذلك ظهرت بعض إبداعات القصة في تلك الآونة ، وكانت خصائص القصة القصيرة - في تلك المرحلة - تتميز بعدد من السمات منها : الميل إلى الأسلوب الخطابي والوعظ ، وكانت لغتها الفنية ركيكة ، ومن ناحية الموضوع ركزت علي موضوعات الوعظ الديني ، والإصلاح الاجتماعي ، والتعليم ، وكان المجتمع السعودي في تلك الآونة ، متمسكا بأنواع من التقاليد والقيم الاجتماعية المتخلفة كالإيمان بالمشعوذين – علي سبيل المثال – ولكن القصة القصيرة في المرحلة الثانية لتطورها ، تخلصت من بعض مشكلات الماضي ، التي لم تعد موجودة في المجتمع الجديد ، بفضل التطور الذي أصاب المنطقة ، وفي الوقت الذي صمتت فيه القصة القصيرة عن الحديث عن القضايا الاجتماعية – في مرحلتها الأولي – حفاظا علي كيان الأسرة الخليجية ، نجدها في مرحلتها الجديدة ، تهتم بمناقشة القضايا الاجتماعية ، فقرأنا عن مشكلات الخيانة الزوجية ، والوافدين وغير ذلك من المشكلات، التي لم تكن تحفل بها قصص البدايات
- 1 -
ولكن القصة القصيرة في السعودية تطورت فيما بعد – الآن- تطورا كبيرا وملحوظا ، تبعا للتطور ذاته الذي حدث في المجتمع السعودي ، علي المستويات الاجتماعية بشكل خاص ، والاقتصادية والسياسية بشكل عام ، ويعود الفضل إلى ذلك لعدد من كتابها الذين آمنوا بأن مهمة الكاتب الحقيقي أن يكون مع التطوير ، ومع الجديد ، من أجل النهوض ، أو العمل علي النهوض بمجتمعه ، بما يضمن له دوام الوجود والازدهار .
وهذه الدراسة تتعرض لبعض أعمال كتاب القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ممن ينتمون للجيل الثالث ، من كتابها ، وهذا الجيل ظهرت إبداعاته المتعددة خلال فترة الثمانينيات وضم عددا كبيرا من الكتاب منهم : سليمان سندي- عبد الله السلمي- وحسين علي حسين - وسباعي عثمان ، وعلي حسون - لطيفة السالم - محمد علي قدس - يوسف المحيميد - عبده خال - أحمد إبراهيم يوسف - محمد منصور الشقحاء وغيرهم ، ولقد وقع عبء التجديد علي عاتق هؤلاء الكتاب ، ولكن بدرجات متفاوتة ، وتبعا لثقافة الكاتب وموقفه من الحياة والواقع ، ومدي إدراكه بطبيعة هذا الفن الصعب ، والهموم الفنية المتعلقة به ، فهناك بعض الكتاب الذين أضافوا علي المستويين الشكلي والمضموني ، وهناك من اهتم فقط بالشكل ، دون اهتمام باختيار موضوعات جديدة تعبر عن الواقع في لحظته الحضارية الآنية .. ونهتم هنا بالكتابة عن بعض أعمال الكتاب الذين أضافوا أشياء لافتة ، وعالجوا موضوعات لم تكن مطروقة في المنجز القصصي السابق عليهم ، ومن هؤلاء : عبده خال – يوسف المحيميد – محمد المنصور الشقحاء - محمد علي قدس .
هذا الجيل الثالث جاء لاحقا لجيلين سابقين : أولهما يمثله الكتاب الذين ظهرت أعمالهم القصصية في الثلاثينيات ومنهم : أحمد رضا حوحو ومحمد علي مغربي ، ومحمد أمين يحيي ، ومحمد عالم الأفغاني ، وفي تلك الفترة غطي الاهتمام بالشعر علي الاهتمام بالقصة ، وكان الاتجاه الفني الذي ساد في الإنتاج الأول : هو الاتجاه الرومانسي ، وكذلك الاتجاه نحو الواقعية أو الطبيعية .. وظهر الجيل الثاني و تألقت أسماء مثل : عبد الله الجفري - وعلوي طه الصاوي ود. محمد عبده يماني ود. عصام خوقير وحامد الدمنهوري وخديجة السقاف ، وعبد العزيز صالح الصقعبي وغيرهم ...
و كتابات الكاتب السعودي ( عبده خال )
- 2 -
تأتي لتقدم نموذجا للكتابة التي لا تسير وراء التقليدي ، ولا تستسلم للقيود التي تقف أمام بعض الكتاب ، وتمنعهم من المغامرة ، - المغامرة الفنية - وفي واقع الأمر ، فان المغامرة أمر مطلوب ، لأنها كفيلة بدفع دماء جديدة في شرايين الإبداع الأدبي والفني ، تلك الدماء الجديدة ، هي التي تقوي فعل الاستمرارية ، وتخطي عتبات الإجادة والإضافة ، وهو من كتاب الجيل الثالث ، في حلقة أجيال القصة في المملكة العربية السعودية ، ومعه الكاتب ( يوسف المحيميد ) . وهذا الجيل أخذ علي عاتقه إضافة جماليات جديدة للقصة القصيرة في المملكة ، ربما لم تستوعبها الكتابات السابقة ، باستثناء بعض كتابات الجيل الثاني ، وبخاصة عند ( عبد العزيز مشري – الصقعبي ) ..
ونشير في هذه الدراسة إلى مجموعة مختارة من قصص الكاتب ( عبده خال ) ، منها قصص قصيرة جدا ، ونستطلع من خلالها سمات وعلامات التجديد لديه ، وأيضا علامات المغايرة والاختلاف عن الكتاب الآخرين ، والقصص القصيرة جدا يختزل الكاتب - فيها - التجربة اختزالا شديدا جدا ، فيقصر حجمها ليصبح مجرد سطر واحد أو سطرين ، ولقد اعتمدنا هنا علي قصص ( عبور – العنيد – الغناء الفصيح – دعوة لتبادل الأمكنة - ثمرة خسئة - بلادة - رويدا أيها الحالم - ذبول - نزاهة – حنين - لا أحد ينتظر الحسناوات - حياة - عقر - هروب - سيدة الأشواك ) ..
وبقراءة تلك القصص يُمكن أن نُجمل بعض الظواهر الفنية – من خلال تعامله مع هذا الشكل الفني - في التالي :
1- الاقتراب من شكل وفحوي الأمثولة أو النادرة ( عبور - رويدا أيها الحالم - حنين - هروب – عقر
2- غرائبية التناول ، وغموض الدلالة ( العنيد - الغناء الفصيح - سيدة الأشواك -
3- الحكي الغنائي والشعري ( حياة )
4- غلبة التصوير الخارجي ، والانحياز للصورة علي حساب السرد المعتاد . ( بلادة - ذبول - نزاهة - لا أحد ينتظر الحسناوات -
في قصة ( عبور ) يحاول الكاتب معالجة عبارة ( خبيء حزنك في النسيان ) ، لكن المعالجة لم تخرج عن إطار المعالجة التقليدية التي نراها في الأمثال ، أو الحكم ، وفي قصة (العنيد ) ُيقدم ما يُشبه اللغز ، وهذا اللغز لا يفصح عن شيء محدد ، ويبدو أمامنا - في بنائه ، ومحتواه ، ودلالته الغائبة - أشبه بما يكتبه شُعراء قصيدة النثر ، تلك التي لا تهتم بالدلالة ، بقدر اهتمامها بالتشكيل ، والغرائبية في التناول ، علي الرغم من قصر التجربة الشديد جدا – سطر ونصف فقط – إلا أننا نلمس تلك الغرائبية التي أشرت إليها .
( كان يعبر ليلا فصيحا ، وحفيف ثوب ، وطرق نعل يتبعان خطواته ، التفت ، فخر الليل ، وجاء الصبح العنيد ) وهنا تنتهي القصة !!
وفي نفس الإطار تأتي قصته ( الغناء الفصيح ) :
( مر بالمدينة ، فوجد مصابيحها نائمة ، والأغاني مُعطلة ، فقطف موالا ساحليا ، وتموج به حتى تغرغرت شوارع المدينة بالغناء الفصيح ) !!
وانعكاسا لتلك الغرائبية التي لا تُفضي إلي شيء محدد تأتي قصة ( ثمرة خسئة ) :
( عندما نظرت إلي المرآة ، ولمحت جسدي الُملقي علي الفراش ، أيقنت بأنني أصبحت ثمرة خاسئة ، ألقيت علي ألأرض .. آه يا للكارثة ، لقد ماتت تلك الشجرة العظيمة !!) نرصد هنا ذلك الاختزال ، المخل – إذا صح التعبير – الاختزال ، الذي لا تبرره الرغبة في التكثيف ، أو الهروب من طرق السرد التقليدي ، أو التخلص من الجُمل الزائدة ، فعلي الرغم من هذا الاختزال ، إلا أننا نلمس عيوبا وجدناها في القصص التقليدي ، ومنها : إعلاء صوت الكاتب ، انظر إلي عبارته ( آه يا للكارثة ، لقد ماتت تلك الشجرة العظيمة ) والمباشرة في عبارته ( أيقنت بأنني أصبحت ثمرة خاسئة ) والرصد الخارجي أيضا في عبارته ( لمحت جسدي الُملقي علي الفراش ) .. ما الذي تبقي من تلك التجربة .. إذن ؟! فعلي الرغم من قصرها الشديد جدا إلا أننا نستطيع رصد ما يلي : 1- إعلاء صوت الكاتب 2- الُمباشرة 3- الرصد الخارجي .. وكلها من مظاهر القصص التقليدي .. ولذلك فان الشكل – وحده – لا يُعد كاشفا عن رغبة الكاتب - أي كاتب - في الولوج إلي المناطق الجديدة في التناول والمعالجة ، بل إن طُرق المعالجة والتناول هي الجديرة بالاهتمام ، والشكل مرتبط - دائما - بالمحتوي أو المضمون ، وليس العكس .. أي أن كل تجربة فنية تُبرز شكلها ، ولذلك فان السعي نحو التجريب الشكلي ، يأتي علي حساب التجربة ذاتها ، ويُضعف من إمكانيات الكاتب في الولوج إلي مناطق جديدة وُطرق مغايرة..
ما هو الفرق بين القصة القصيرة ، والحكاية الشعبية ، أو الحكاية الفلكلورية التي ربما قرأناها - من قبل - في كتاب مثل كتاب - كليلة ودمنة - مثلا- ؟؟ إن الكاتب ( عبده خال ) يقدم قصته ( دعوة لتبادل الأمكنة ) لنكتشف أنه ، يُحاكي - تماما - القص الشعبي الذي يجعل الحيوان مثلا يتكلم مع الإنسان ، من أجل إعطاء حكمة ، أو ضرب مثل ، أو الخروج بموعظة حسنة !! انظر إلي القصة كاملة ، وحاول الوصول إلي إجابة للسؤال الذي طرحته ..
( دخل حارس الحديقة ، ليتفقد الحيوانات ، فوجد القرد حزينا ، بائسا ، قابعا ، في ركن منزو من القفص ، يقلب بين يديه غصن شجرة يابس ، ويطلق تنهدا ته العميقة ، الحارة فخاطبه الحارس :
- عجبا لأمرك .. أنت أذكي الحيوانات ، وأكثرها مرحا ، والجميع يجمع علي حبك ، فما بالك حزينا ، منكس الخاطر ؟؟
- فرد عليه القرد :
- - تعالي مكاني ، وستعرف ؟ )
وتنتهي القصة !! أليست هذه حكاية ، بكل ما للحكاية من خصائص ؟؟
ولقد جاءت قصة ( رويدا أيها الحالم ) أقرب إلي النادرة منها إلي القصة القصيرة الفنية .
( حلم أحد المساجين بأنه خرج من عتمات الزنازين ، ورأي نفسه يسير في الشوارع متمتعا بحريته ، فاستيقظ من نومه سعيدا ، وقام بتقسيم جميع حوائجه علي زملائه المساجين ، فصاح به الذي بجواره
- ابق شيئا لنفسك ، فلازلت بداخل السجن !! )
والنادرة لها سمات منها : أنها قصيرة الحجم ، مع وجود عدد من الشخصيات ، ولكل شخصية من هذه الشخصيات دوره في الحدث ، والنادرة تُقدم الشخوص من الخارج ، وتهمل ما يعتمل في داخلهم من مشاعر وأحاسيس ، وتلجأ إلي الرصد الخارجي ، بالإضافة إلي توافر عنصر السخرية ، ووجود المفارقة ،بالإضافة إلي الابتسامة التي من الممكن أن يُسببها التناول ، أليست كل هذه السمات متحققة في قصة ( رويدا أيها الحالم ) ؟!
وأود أن انوه هنا إلي أن قالب القصة القصيرة هو الذي يحدد طولها ، ولا يوجد " أي مقياس للطول في القصة القصيرة ، إلا ذلك المقياس الذي تحتمه المادة نفسها ، ومما يفسدها – لا محالة – أن تُحشي حشوا لتصل إلي طول معين ، أو تُبتر بترا لتنقص إلي طول معين " وفي هذا الإطار نفسه يعبر الناقد ( فرانك أوكونور ) عن خشيته من أن القصة القصيرة متأثرة بشكل خطير بأفكار محرري الصحف ، فيما ينبغي أن يكون عليه طولها
- 3 -
إن كاتب القصة القصيرة حين يتعمد اختزال اللغة في القصة القصيرة ، بدون أن تكون هناك ضرورة لهذا الاختزال ، فانه يكون أقرب إلي الشاعر منه إلي كاتب القصة القصيرة ، حيث إن الشاعر يعتمد علي لغة الشعر التي تقوم بتوليد المعاني والدلالات ، من خلال قوة المجاز ، الذي تحمله اللغة ، بينما لغة القصة ترتكز علي النمو ، والتطور ، وتهتم بأن تكون صاحبة وظيفة محددة في اتجاه المعني ، وعندما تتماهي الفروق بين الوظيفتين ، يُصبح التناول محفوفا بالمخاطر ، بل نستطيع أن نقول : إن الكاتب يقع في مأزق خطير جدا ، حين لا يستطيع تقديم تجربة شعرية خالصة ، أو تجربة قصصية خالصة ، صحيح أنه من الممكن أن يكون هناك مزجا بين النوعين ، من خلال تداخل الأنواع الأدبية في القصة القصيرة- أثناء المعالجة ولضرورة فنية تتطلب هذا المزج - لكن التداخل لا يعني الاستغناء نهائيا عن لغة القص ، اعتمادا علي أن لغة الشعر المختزلة ، يكمن أن تحل محلها ، ومن المعلوم أن مفهوم التوصيل يختلف في الحالتين ..
وعلي حد تعبير الناقد د . عبد المنعم تليمه - وهو علي حق فيما ذهب إليه- حين قال : " وقد انتهت اللغة إلى ضمور شديد وعقم بيّن حين انفصمت العلاقة فيها بين الدور الجمالي والدور الاجتماعي. وحين وقعت في أسر الغلو الشكلي، وحين برز تكريس مقولة أن الأدب ظاهرة مسيرة بقوانينها الذاتية"
- 4 -
وعلي العكس من كتاباته في مجال القصة القصيرة جدا ، تأتي قصص (عبده خال )الأخرى
بعيدا عن الرغبة في الولوج إلي مناطق التجديد بلا ضرورة فنية - محققة درجة عالية من التجديد الفني الحقيقي ، والواعي ، بل وتُعد قصصا لافته ومتميزة عن أبناء جيله فهو كاتب يُجيد اختيار موضوعات مبتكرة ، إنسانية ، جياشة ، مليئة بالمشاعر العارمة ، والأحاسيس الدافئة ، تتميز لغته الفنية بنعومة آسية ، وقدرة علي الإفصاح عن المكنون ، والداخل ، وقصصه تحتفي بالواقع الاجتماعي احتفاء كبيرا ، ربما نجد الرمز يُغلف التجربة إلا أن البعد الرمزي لا يقلل من واقعيتها ، بقدر ما يُعمق المعني ويجعله ، يُفصح عن دلالات متعددة ، هذه الدلالات تدفع المتلقي والقارئ إلي الاستمتاع بالقصة ، والاندفاع نحوها ، لمحاولة اكتشاف رموزها ، ولذلك نجد شخوص قصصه يعبرون عن الواقع ، ويعملون اتصالا بالقوانين المحركة له والمحيطة به ، أحيانا تكون قوانين سياسية ، لكنها ليست مباشرة ، وليست هي غاية المعالجة ، لكن موقف الكاتب الفكري والسياسي ، نستطيع التعرف عليهما من خلال متابعة ما يكتبه ، وتلك المسألة ، تدعم عملية الإبداع - بشكل عام - وذلك لأن الكاتب - أي كاتب - يكتب لأن لديه شيئا يريد أن يقوله ، وإلا فلماذا يكتب إذن ؟؟ وتتحقق كل هذه المعاني مع عدد كبير من القصص التي سنتناولها هنا بالدراسة والتحليل ، ومنها ( الجدار – البلوزة – عصفور الزينة – الذباب – جارتنا الصغيرة –آآآآآآ 5) وغيرها من القصص ، وقصة ( الجدار ) تُعد نموذجا للقصة القصيرة مُحكمة الصنع ، ليس بالمفهوم التقليدي لعبارة ( محكمة الصنع ) ولكن بمعني أن الكاتب يملك القدرة علي بناء قصته بشكل فني جيد ، ويعرف كيف يسيطر علي شخوصه تلك السيطرة التي لا تجعل الأحداث تفلت منه ، أو تضيع الشخصيات ، الكاتب يُقدم نصين تحت عنوان واحد ( الجدار) ، النص الأول قصير جدا لايتعدي سوي ثلاثة سطور ، يكشف فيه عن أزمة نفسية يعيشها بطل القصة ، حيث (انه يري فيما يري النائم ، أنه في زنزانة ضيقة نتنه ، كان يقف فيها بصعوبة ،والمسامير تأكل من جسده ، فتهطل دماؤه سوداء ، ويصرخ فلا يسمع لصوته صدي ، ورأي حية رقطاء تلتف حول عنقه ، وتهم بغرس أنيابها في حبل الوريد ، وقبل أن تفعل ذلك استيقظ من نومه فزعا ، ودفع غطاءه ، لكن الغطاء استحال إلي جدار ) هذا هو النص الأول كاملا
وكما نلاحظ أنه - برغم قصره الشديد - نص محكم ، بمعني أن هناك شخصية وهناك حدثا تتعرض له الشخصية ،وهناك أزمة ، وهناك دلالة ، فمن الممكن أن نفهم أن تلك الزنزانة تمثل المجتمع كله ، وأن الغطاء الذي تحول إلي جدار ، إنما هو يشير إلي فكرة افتقاد الحرية في مجتمع قاتل ، يشبه الحية الرقطاء ، التي تلتف حول العنق ، وتمص الدماء ، ذلك المشهد الفانتازي القصير ، في النص الأول ، استكمله الكاتب بنصه الثاني - وبنفس العنوان - بضمير المتكلم ، أي بضمير الشخصية الرئيسة في النص الأول ، والتي قدمها بضمير الغائب ، اعتماده - هنا - علي ضمير المتكلم ، جاء متفقا مع طبيعة التجربة ،لأننا في النص الأول ، لم نكن نعلم عن تلك الشخصية شيئا ، لكن الكاتب ، قدمها في نصه الثاني شخصية حية ، واقعية ، وجعلها تتفاعل مع المحيط الخاص بها تفاعلا كشف عن طبيعتها ، وأفصح عن أزمتها ، بل كشف من خلال كل ذلك ، عن أزمة مجتمع ، لا يحفل بالفرد ، بل يجعله يواجه الظروف المحيطة به بمفرده ، بدون أن يتيح له حرية الحركة ، وحرية التفكير ، وحرية الإرادة ، فحين يقرأ رواية (الفراشة )
- 5 -
يهدأ قليلا ، لأنه طمئن نفسه ، بأن فرنسا - نفسها - تغتال الأحلام ، انه تبرير لتهدئة موقفه تجاه مجتمعه ، الذي لا يتيح للفرد ، أن يحقق أحلامه ، بحرية ، أن يعيش حياته بحرية ، وللقارئ أن يصل إلى المعاني التي يريد أن يصل إليها ، فالقصة أعطته ، وأتاحت له الفرصة للوصول إلى التفسير الذي يتوافق مع مواقفه ، وثقافته ، ومزاجه النفسي . فإذا كان شخص القصة في النص الأول قد شعر بأن الغطاء قد تحول إلى جدار ، يحول بينه وبين الحرية ، فان الجدار في النص الثاني ، جلب أنينا كان يسمعه - من خلفه - ولم يسمعه غيره ، ولذلك يتهمه المقربون منه بالجنون ، وبضرورة أن يعالج نفسه ، بأي طريقة ، لكن طرق العلاج جميعها تفشل ، لأنه وحده ، يعلم أن وراء الجدار أنين مكتوم ، لن يختفي صداه إلا باختفاء الجدار ذاته .. ولذلك حمل شخص القصة معولا هوي به علي الجدار ، ليحطمه .. تمرد طبيعي علي واقع ، يسلبك حريتك ، في أن تحيا كما تريد ، وتتنفس كما تشاء ، لا أن تكون عائشا بإحساس السجين ، هذا هو المعني والدلالة التي أعطتها القصة لنا ، بشكل طبيعي ، وبسيط ، وبلغة شفافة ، غير زاعقة ، برغم ذلك الضمير الذي من الممكن أن يجعل تجربة - كهذه – تبدو وكأنها تجربة ذاتية ، لكن هذا الأمر لم يحدث لأن الكاتب ( عبده خال ) يعرف كيف يُسيطر علي ضمير المتكلم سيطرة فنيه كاملة ..
إن اختيار الموضوعات الجديدة الجيدة - كما أشرت - تُعد علامة من علامات التجديد في مجال القصة القصيرة في السعودية ، والولوج إلى مناطق لم تكن القصة السعودية تلج إليها ، فضل يُحسب للكاتب ولا شك ، بل ويحسب لكل الذين يأخذون علي عاتقهم التعبير عن هموم الواقع ، والحديث عن اللحظة الحضارية الآنية بكل ما تحمله من منغصات ، نفسية ، وإنسانية ، وحياتية . وفي هذا الإطار نفسه تأتي قصة( البلوزة ) وهي قصة تتناول موضوعا ظل من الموضوعات المُحرمة في المملكة ، والتي لم يهتم كثير من الكتاب بتناولها ربما خشية من الرقابة ، وعدم النشر ، وأعني بالموضوع ( الحرمان الجنسي ) الذي من الممكن أن يعيشه الفرد في مجتمع ، يضع القيود الصارمة ، والقوانين الرادعة التي تُحاسب أي مارق ، أو خارج عليها ..
والقصة تذكرنا بتمثال ( جالاتيا) الذي صنعه ( بيجماليون) في محاولة منه للتأكيد علي قدرته علي خلق امرأة بيديه ، وتكون أجمل امرأة ، لأنه هو نفسه خالقها !! امرأة أجمل من كل النساء ، متحديا في ذلك النساء اللاتي اتهمنه بأنه لا يشعر بوجودهن !! ونراه يقع في حب التمثال الذي قام بصنعه ، برغم أنه تمثال حجري ، لا حياة فيه ، ولا روح ، ولذلك نراه كل ليلة ، يحتضنه ، ويبثه أشواقه ، لعله يستجيب ، ولعل جالاتيا ، تصبح امرأة حقيقية من لحم ودم ، وحين يفشل في ذلك ، يلجأ إلي إلهة الحب ، طالبا منها أن تنفخ الروح في تمثاله الحجري ،وبالفعل تستجيب الآلهة لطلبه ؛ ،فيجد التمثال يلين بين يديه وتصبح ( جالاتيا ) أنثي كاملة .. وبطل قصة ( البلوزة ) التي كتبها ( عبده خال) يفعل نفس الشيء ، لكن الدمية تظل دمية كما هي ، لأنه لا يستطيع أن يُخاطب ربة الحب ، كما فعل بيجماليون ، فتلك كانت أسطورة ، وما يحكيه البطل- هنا- واقع وليس أسطورة من الأساطير ، لذلك يظل تمثاله حجرا ، وتظل دميته ، دمية ، وان حاول أن يجعلها بكل الطرق، حقيقية ، أو علي الأقل تشبه تلك الفتاة التي رآها في المغسلة ، حين أتت إليه بملابسها ليقوم بغسلها ، ومن يومها لا يستطيع فراق صورتها ، ولا نسيان رائحة عطرها !!
، لقد حاول أن يجعل دميته تتكلم ، فقام - خفية - بتسجيل صوت الفتاة حين أتت إلي دكانه مرة أخري ، وقام بتركيب الصوت ووضعه بجانب دميته ، ليجعلها تتكلم ، ويعيش خياله وكأنه واقع، وحين ظلت تلك الملابس لأكثر من شهر ، أحضرت معها رجلا ، زجره ، وطلب منه سرعة تسليمه للملابس ، وهنا يسقط حلمه ، ويرتطم علي أرض الواقع ، ( تشاغلت يده بتعرية الدمية ، كوم البلوزة ، والتنورة في صدره ، تهاوي فجأة ، شعر بالذوبان ، ونار حامية تصهره ، فأخذ يشهق بالبكاء ..) ..
وقصة ( البلوزة ) تعتمد علي أسلوب الحكاية
- 6 -
- أحداث وشخصيات - ، ويعكس الكاتب - من خلالها - جماليات متعددة ، علي مستوي اللغة ، وعلي مستوي المعالجة ، فعلي مستوي اللغة ، نجده لا يُسرف في تفصيلات ، ترهق القارئ، ولم يلجأ إلي الحشو الزائد أو الاستطراد ، أو الوصف بصورته التقليدية ، أو المباشرة ، وكلها من خصائص القصص القديم أو التقليدي - بمعني أصح - انظر إلي اللغة التي جاءت في سطور القصة الأولي ، ومن خلالها يضعنا مباشرة مع شخصية الفتاة التي ملكت فؤاد راوي القصة وبطلها :
"تعبره كل يوم فتعمق في شغاف قلبه أخدودا من الوله،يتبع ممشاها فتسيل رغبته ويزداد توتره . تصليه حمم جسده ويفور ..يفور ..يفور بعجلة يبلله طوفان الرغبة،يغرقه في ماء آسن ويذوي قبل أن تغادر عينيه،يذوي ككلب ركض وركض فلم يكن نصيبه إلا نصف ظل ولهاث مديد .اليوم وقفت على باب مغسلته"
انه يقوم بتقديم شخصية القصة مباشرة ، وتلك جمالية من جماليات القصة الجديدة ، تلك التي تمردت علي التمهيد التقليدي للحدث أو التمهيد المُسرف للشخصية !!
وهو علي مستوي المعالجة يلجأ إلي استخدام حيلة التذكر ، والاستدعاء - استدعاء الشخصية من الخيال - حين نراه يتذكر تلك الفتاة الريفية ( خضراء) التي يريدون منه أن يتزوجها ، بينما تمتلكه صورة الفتاة التي أتت إليه في المغسلة ، تلك التي شدت انتباهه ، وحركت مشاعره ، ونشطت خياله الجامح !! وهنا يلعب الوصف لعبته ، حين يقارن بينها وبين فتاة القرية :
قفزت (خضراء) أمامه،فتاة بائسة امتص الجوع عودها،وجرى العطب بين راحتيها من مسكة المنجل وجرف سيل الانتظار جبلي صدرها اللذين كانا ينهضان لمقدم من زرع في مخيلتها رغبة الوقوف عليهما،غدت فتاة مهدمة،تقول الرسائل القادمة من هناك :
- خضرا تقترب من الثلاثين وهي لازالت تنتظرك ..حرام عليك لم تعد صالحة للزواج إلا بك
سقطت كل ذاكرته حينما لوت عنقها باتجاهه"
بينما تلعب نفس اللغة لعبتها وبنفس درجة إجادة الوصف الدقيق الجيد حين يتحدث عن فتاة الحلم ( تقف السيارة أمام المغسلة تماما ، في هذه اللحظة (بالذات ) تكون عيناه منفتحتين على اتساعهما فحين تدفع الباب تظهر ساقاها نافرين من تلك الغلالة السوداء فتبين قدمان ممتلئتان مستديرتان تنتهيان بحذاءين يتغيران كل يومين أو ثلاثة ثم يستقيم عودها طاعنا الفضاء بقامة فارعة رطبة، تلملم عباءتها على صدرها مخفية ثمرتين نادرتين في استوائهما ..أصابع يديها ناعمة مرتوية كالأقلام الفاخرة تنتهي بأظافر مدببة منسابة أبقت على مداد قاني الاحمرار. تعبر الرصيف تاركة جسدها يُراقص الهواء والأمكنة بينما تتوقف رائحتها لتحرس مشيتها وتثبت الأمكنة في مواضعها كي لا تتساقط حجارتها كمدا على اختفائها،في كل هذا الارتباك يزهر بمقدمها بيت واحد إذ تدس فتنتها في بوابته الواسعة فيضمها ويعبس للدنيا مغلقا ردفيه ".
والمجتمع الذي ربما ينظر إلى الرجل الذي لا يستطيع الإنجاب ، نظرة شك وريبة ، كان موضوع قصة ( عصفور الزينة ) فالمرأة من وجهة نظر هذا المجتمع الُمزعج ، المرأة غير القادرة علي الإنجاب ، تُصبح كعصفور الزينة ، مجرد ديكور ، جميل ، ولا أكثر من ذلك ، ولذلك نري الزوج المُحب لزوجته ، والمستهجن لكل رجل يُقدم علي إهانة المرأة ، ذلك الرجل ، يُقدم علي إهانة زوجته ، ضاربا ما يؤمن به عرض الحائط ، لأن رغبة الإنجاب ملكته ، وأصبحت هي الرغبة القوية ، حتى أن الحب تلاشي ، وانزوي الحنان ، في زاويا الحزن ، والاتهام ، والمرأة في تلك القصة امرأة محبة بالفعل ، لكنها عاجزة عن تحقيق ما يتمناه الزوج، وتلك أزمتها الفعلية ، وعندما تتعرض للإهانة من الرجل الذي تُحبه بجنون ، تصفع باب شقتها وتخرج منه ، متمردة علي تلك الإهانة ، ويذكرنا فعلها بفعل نورا في مسرحية ( هنريك ابس) النرويجي ، حين صفقت -هي الأخرى - الباب ، وتركت بيتها بعد أن شعرت بأنها مجرد دمية في البيت ، هنا تشعر المرأة أنها مجرد عصفور للزينة داخل البيت ، ومن ثم ، تترك البيت لأن صاحبة لم يحترمها كامرأة ، تلك فكرة جديدة ن ثورية ، لأنك حين تجعل تمرد المرأة يأخذ مداه في مجتمع ، لا يحترم هذا التمرد ، حتى ولو كان صاحبه علي حق ، فانك بهذا الطرح ، تكون ثوريا ، وتكون قد وجهت لذلك المجتمع القامع صفعة قوية ، ربما لن يغفرها لك ، أتحدث هنا عن الكاتب ، تلك مسؤولية الكاتب الملتزم ، بقضايا مجتمعه، وبقضايا قومه ، وناسه . شخص القصة حين واجه تمرد زوجته المُحبة ، وكانت علي حق ، علم بقيمتها كامرأة، ولم يكن يتمني أن يقوم بإهانتها أمام صديقتها متعمدا ذلك ، قائلا لها أن العطر الذي تضعه يخنقه ، وعليها أن تغيره ، في حين أن الصديقة تثني عليه ، بل وُتبدي إعجابها باختيار ذلك العطر .. إن العطر هنا مجرد أداة للإهانة ، وتلك الإهانة هي التي فجرت ذلك الغضب الذي لم تستطع المرأة في القصة أن تفعل شيئا تجاهه غير الرحيل من البيت ، وشعور الزوج بالوحشة ، هو الذي جعله يتمني أن يجدها تقف علي الباب من جديد - كما كانت تفعل - وتجذبه لحضنها ، وتناوله كأس الماء الذي يتجرعه منذ عشرين عاما – مدة الزواج – سواء كان في حاجة إليه أم لا .
وعلي الرغم من أن الكاتب ( عبده خال) يُعد من الكُتاب القلائل الذين يهتمون باللغة القصصية ، ويبعدونها عن منطقة المباشرة والخطابية ، إلا أنه في هذه القصة ، وقع في دائرة المباشرة في بعض مناطق القصة ، ربما بسبب أن القصة تدور وقائعها ، اعتمادا علي ضمير المتكلم ، وهو ضمير - كما سبق وأوضحنا - يمكن أن يتحول للإفصاح عن صوت الكاتب ، إذا فاته ذلك أثناء الكتابة ، انظر مثلا إلى عباراته تلك : " الرجال أشبه بحلاقين تجري شفار ألسنتهم علي جلود النساء ، من غير اكتراث ، ولو جري الدم لا يكلف الواحد منهم إزالته بكلمة اعتذار رقيقة " أو قوله " المرأة أشبه بمنشفة بالية يدسونها في المطابخ أو في غرفة مغلقة حيث يدلقون عليها الدنس بسرية تامة " وقوله : " ما بالنا نري كل النساء جميلات ، فيما عدا زوجاتنا؟!" .. هذه العبارات تُعد حشوا زائدا عن الحاجة ، وتُؤثر في جماليات التشكيل .
وعن البطالة والمحسوبية يكتب قصته ( الذباب) ، ويتناول جمالية فنية أخري ، باعتماده علي بنية الحوار ، ليكون بديلا عن السرد القصصي ، بحيث انك لا تستطيع أن تشعر بملل متابعة الحوار ، لأنه ليس حوارا مسرحيا مثلا. والحوار في تلك القصة يعكس حسا كوميديا راقيا ، لأنه يكشف المفارقة ، ويكشف طبيعة الشخصية المتكلمة .. ويكشف طبيعة الحدث ذاته.
واهتمام الكاتب بفضح بعض جوانب الفساد في مجتمع يدعي الفضيلة ، ويدعي بأنه يدافع عنها ، يُعد هذا الاهتمام ، من الجوانب الإيجابية ، التي تُحسب لكاتب القصة ، لأن القص القديم لم يكن يهتم بخاصية الكشف ، والفضح ، باعتبار ذلك من المحرمات التي تواجه تعنت السلطات وغضبها ، وربما دفعها ذلك إلى ممارسة الرقابة ، وممارسة حق المنع ، لأن التناول جاء ضد ما تريده .. وفضلا عن اهتمام الكاتب بفضح المحسوبية ، فانه يكشف - أيضا - أن بعض النساء ، في ذلك المجتمع المُغلق ، يقمن بهذه الوساطة ، اعتمادا علي أنوثتهن ، فعلي الرغم من أن والدة الشاب الذي تريد توظيفه ، امرأة محافظة ، وتعلم أن جارتها لها معارف من الرجال ، وكانت تستريب منها ، وتبتعد عنها ، إلا أنها أمام الحاجة الماسة لتوظيف ابنها ، تتنازل عن هذه الكراهية ، والاستهجان - ولو مؤقتا - من أجل تحقيق هدفها " كانت والدتي تستريب من جارتنا تلك ، بسبب كثرة معارفها ، وتبرج لسانها غير متورعة عن ذكر إعجاب الرجال بقوامها الهارب من غلاله ، ومدعية أن عيونهم ترف بين نهديها الشامخين ومقسمة أن أحدا لم يجرؤ علي بناء عشه علي قمتهما ، حين تشيح عنهما عباءتها في محاولة إغواء صغيرة " .. مثل هذه العبارات ما كانت تسمح بها السلطات في ذلك المجتمع المغلق ،وربما لا تسمح بها الآن باعتبارها تضمن ألفاظا خارجة ، من وجهة نظر مجتمع محافظ ، لا يريد كشف عوراته ، باعتبارها من الأمور الخاصة التي لا يجوز فضحها ، يتستر علي ذلك ، في حين أن كل شيء ربما يدور في الخفاء ، والقصة ، أخرجت الأشياء الخافية ، ووضعتها أمام القارئ ، لكي يري من خلالها ، ما يدور في مجتمعه ، وربما لايراه بشكل واضح . القصة تضع الإنسان أمام نفسه ليراها ، وأم الراوي في هذه القصة تُحب ولدها ، ولاتحب أن يفشل كما فشل أبوه - من قبل - ولذلك نراها تلجأ إلى تلك الأساليب الملتوية ، في مصادقة تلك المرأة التي تُعد - من وجهة نظر الأم - امرأة فاسقة ، ولكن لامانع من مصادقتها ، إذا جاء ت تلك المصادقة بفائدة لابنها ، ذلك الموقف الانتهازي ، من المواقف التي كشفها الكاتب هنا ، وجعلنا نتأملها ، ونمعن فيها النظر ، ولقد لجأ الكاتب إلى حيلة فنية بسيطة ، أشار - من خلالها - إلى موقف تلك الأم من زوجها الذي مات ، الموقف الذي يتمثل في إدانتها له ، وذلك من خلال تكنيك الاستدعاء ، حيث يستدعي الشاب أثناء وقوفه الملول أمام الضابط الذي سيساعده في أمر توظيفه ، بناء علي كارت توصية المرأة ، استنادا إلى اللغة أيضا ، نراه يقول:" عدت أحدق في ذلك المكتب الواسع ، واتمني لو أنني أستطيع أن أتحرك ، لأهرب من هذا الموقف ، كنت أفكر جديا في ترك مكتبه ، وكلما هممت بذلك تداعت إلى مخيلتي صورة أمي التي ستصفني بأقذع النعوت ، لو أخبرتها بنكوصي ، وستذكرني بكل ما صنعه أبي معها ، وقد تتمادى في ذلك، وتنعتني ب( ذيل الكلب) .. قد ضقت ذرعا بها ، وبتذمرها وتذكيري الدائم بما جناه أبي علي حياتها ، وما خلفه من حرائق لم تطفئها عظام أبي الرميمة " .. وهكذا يستدعي الكاتب الماضي ليتماهي ويذوب في الحاضر ، ليصبحا معا نسيجا واحدا ، لا تستطيع الفصل بينهما ، هذا التكنيك ، ساعد كثيرا في حل الُبعد الزمني في القصة ، ذلك البُعد الذي لا يمكن أن يكون ممتدا أبدا ، بل ينبغي أن يكون وحدة واحدة ، هنا يصبح الامتداد الزماني مبررا فنيا لوجود أداة الاسترجاع ، فيبدو أمامنا وكأنه تيار شعور البطل حين تواجهه أزمة في اللحظة الراهنة ، فيتذكر ، ما يشبهها في الماضي ، سواء كانت الأحداث متعلقة به ، أو متعلقة بغيره .
وهذه القصة تُعد نموذجا كاشفا لقدرة الكاتب علي رسم الشخصية ، من خلال مواقفها وليس من خلال وصفها الخارجي ، كما كانت تفعل القصة التقليدية ، فنتعرف من خلال المواقف ، والانفعالات ، والصراع ، علي شخصية الضابط ، فنراه متعجرفا ، مختالا، ملولا ، بليد الحس ، جاف المشاعر ، يمتلك قدرا كبيرا من الصلف ، كل هذه الأوصاف ، لم نتعرف عليها بشكل مباشر ، بل تعرفنا عليها من خلال المواقف ذاتها ، والقصص الجيد هو الذي يفعل هذا..
وفي نفس إطار فضح الواقع الاجتماعي للمجتمع الُمغلق ، تأتي قصة ( جارتنا الصغيرة ) ، وموضوعها لا يختلف كثيرا من حيث جرأة التناول عن سابقه في قصة ( الذباب) ، والموضوع يدور حول ما يحدث ليلة الزفاف ، في المجتمعات الشرقية ، يُحاكم الكاتب - من خلاله- التقاليد العربية التي تُجبر الرجل الشرقي التقليدي ، أن يقهر أنوثة المرأة في تلك الليلة ، بصرف النظر عن مشاعرها ، ويقوم بقمعها ، بصرف النظر عن المشاعر الإنسانية التي تتطلب منه الانتظار ، إذا واجهته موانع نفسية ، أو واجهت الطرف الآخر ، ولذلك يلجأ إلى ممارسة فحولته ، ليؤكد للناس أنه قادر ، وأنه رجل بحق ، ,انه ذكر ، بصرف النظر عن الآلام النفسية ، وربما العضوية - وهذا ما حدث مع المرأة في هذه القصة - التي سيسببها للطرف الآخر الضعيف ، فالعروس الصغيرة وجدت نفسها بين يوم وليلة في أحضان رجل اشتراها بتلك العمارة التي وهبها إياها في مقابل موافقتها علي الزواج منه ، ولو كان الأمر بيدها ، لرفضت ، لكن أمرها بيد والدها؛ الذي أعتبرها مجرد سلعة ، من حقه أن يبيعها ، ومن حقه أن يشتريها !! وعلي الجانب الآخر هناك جار متزوج - راوي القصة - كان مُعجبا بتلك الجارة الصغيرة ، وكان يتطلع إليها خلسة ، ونراه - في نهاية القصة - يُرسل لها ابتسامة ، ويغمز لها بعينيه ، ونراها تستجيب له ، وتشير بيديها أن ينتظرها ، وهذا الذي يحدث من تفسخ اجتماعي ، وربما خيانة زوجية ، في المستقبل ، سببه ذلك الُركام من التقاليد التي لا تُبيح للمرأة أن تختار ، وتُعطي للرجل – وحده - حق الاختيار ، وأيضا حين يختار هو ، فانه يختار الجميلة ، الصغيرة ، لأنه يملك ، بمعني آخر يشتريها .. العواطف والمشاعر في حالة غياب ، وبسبب هذا الغياب تتولد القيم المهترئة ، وتنمو قيم الرذيلة ، وكما هو واضح فان موضوع القصة ، يوجه نقدا لاذعا للتقاليد الاجتماعية ، التي تجعل النساء مجرد متاع ، أو وسيلة للمتعة فقط ، وتدين - في الوقت نفسه - المجتمع الذي يشجع هذا السلوك ، وتُقدم صورا للتفسخ الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه بعض الناس في مجتمع مُغلق علي ذاته ، وأسلوب التناول يتميز بجرأة ، وصدق . أنظر إلى تلك العبارات لتتعرف علي مقدرة الكاتب علي ألا يمتثل للتقاليد التي ربما تمنع نشر قصته تلك ، داخل بلاده ، بسبب الألفاظ التي جاءت فيها ، وهذه الألفاظ ، ليست لذاتها ، بل لضرورة ، استلزمت وجودها بحق " كان خبر العروس غامضا ، حيث قيل إن بكارتها ، استعصت علي زوجها ، مما حمله علي وكزها بقوة جعل الدم يتدفق بغزارة ، وعلقن المسنات علي هذه الحكاية ، بأن فتيات هذا الزمان ارق من ورق السلوفان ، لكن هؤلاء المسنات سحبن هذا التعليق ، واستبدلنه باللوم علي رجال هذا الزمان ، الذين يبحثون عن البكور ، ليذيقهن فحولة رخوة لا تقيمها إلا أصابع اليد !! " وأقرأ أيضا تلك العبارة : " فروت ليلي - جارتها الملاصقة - انه استبدل عضوه بإبهامه ، وأخري - زوجة من قام بنقله إلى المستشفي- روت أنه اندفع علي المسكينة كحيوان كاسر فجر القناتين ، وجعل مجراهما واحدا " .
واستفادة من أسلوب الفنتازيا في المعالجة الفنية ، تأتي قصة ( آآآآه ه ) ، حيث يواجه بطلها موقفا غريبا ، كان بمثابة اللغز بالنسبة له ، وهو أن كل من يراه يضحك ، هذا هو موضوع تلك القصة ، ومن الوهلة الأولى ربما تري أن الموضوع لا يستحق ، لكن الكاتب استطاع عن طريق التواتر اللغوي ، أن يكشف حجم المأساة ، والمعاناة التي يعيشها ذلك البطل الذي لا يعرف سببا لسلوك الناس تجاهه ، في الشارع ، في البيت ، في مكان العمل ، حتى بواب العمارة ، كل من يقابله يضحك .. ( شيء ما يحرك هذا الضحك الأرعن ، فكلما أطليت بوجهي في أي اتجاه ، وجدت تلك الضحكات تتسع وتتمدد ، تتمدد ، وتستحيل إلى أزيز ينخر رأسي ، وعبثا حاولت معرفة سر تلك الضحكات) .. ولذلك نراه يتأمل نفسه ، ليصل إلى حل اللغز ( تفحصت وجهي ، كان وجها صقيلا لامعا ، تتقافز منه ملاحة لذيذة ، فالأنف مستقيم باستقامة رهيفة يطل زاهيا علي شارب كث ، وفم مغلق ، لا يتسع للقمتين في آن واحد ، وله وجنتان منبستطان كأرض ممهدة تقف في أعلاها جمجمة مستوية ، يهفهف من فوقها شعر ناعم غارق في لونه البني الداكن ، وثمة عينان يشع منهما ذكاء حاد يشي أن صاحبه يخترق الحياة بيسر وثقة .. الخ)
هذا الوصف الدقيق كان من الممكن أن يصيب القصة في مقتل ، لو أن الكاتب ذكره في سرد تقليدي ، أو ذكره في السرد القصصي علي لسان الراوي ، كما كان يحدث في القصص التقليدي ، لكنه لجأ هنا إلى حيلة فنية ، هذا الحيلة خرجت وولدت من طبيعة الموقف ذاته ، فكيف تتصور شخصا يواجه فعلا كهذا أن يفعل ، لابد أنه سيتأمل نفسه ، وينظر إلى شكله ومظهره ، هذا ما فعله شخص القصة بالضبط ، ولذلك اصبح المباشر غير مباشر ، وأصبح الرصد رصدا فنيا ، وليس رصدا خارجيا ، وأصبحت متابعته الشخصية لذاته ، جزء من التجربة ، وجزء من انفعالات الشخصية ، وليست خارجة عن كل هذا ، ذلك التناول يكشف أن الكاتب علي وعي تام باستخدام جماليات جديدة ، في المعالجة، هذه الجماليات تتخلق أثناء الكتابة ، ومن الموقف ذاته ، وليست سابقة علي حالة الإبداع ، بل متزامنة معها ، ومتماهية فيها ..
والفنتازيا ، ذلك الإطار الذي دارت داخله التجربة ، جعلتها أقرب إلى الأحلام ، أو الكوابيس ، لكن الفرق - هنا - أن الكاتب مزج الواقعي بالخيالي ، مما اكسب التجربة طعما متميزا ، وخاصا لم تستغرقه الفنتازيا ، ولذلك لم تُفلت منه الفكرة التي أراد أن يقدمها للقارئ .. ومؤداها : أن الإنسان ربما يشعر باغترابه - أي أنه غريب - في العالم المحيط به ، وفي نفس الوقت لا يستطيع الوصول إلى أسباب اغترابه ..
وهذا السرد الغرائبي يُميز كتابات ( عبده خال) ، وكذلك المنحي التعبيري نجده متوفرا في هذه القصة وقصص أخرى من القصص السابق الشارة إليها - في هذه- الدراسة - ذلك الذي يأتي مُعبرا ( عن حالة خوف أو قلق أو إحباط ، ينطلق منها ، ولكن دون أن يكون سببها عثرة سيكولوجية متعلقة بنفسية البطل ، إن الصورة التعبيرية قد يبدو فيها البطل في حالة خوف من خطر مبهم دون أن يرجع هذا الخوف إلى سبب حقيقي مؤثر ، وهذه الأحاسيس والهواجس يكون مردها حالة احتياج إزاء عدوانية خارجية )
- 7 -
وعلي حد قول الدكتور نعيم عطية ، حين تحدث عن المؤثرات الأوربية في القصة القصيرة في مصر ، انه يري أنه مع التيارات الحديثة في الفن والأدب- بصفة عامة- تركنا الشواطئ الآمنة ، وخرجنا إلى بحار تبتلع فيها الدوامات اعتي المراكب ، وتلوح جزر لا يلبث أن يبين ألا وجود لها في مواضعها التي بدت للملاحين . لقد تركنا شواطئ (العقل النفعي) ، الذي يتعقب الأحداث في تتابعها الزمني ، ويتقصي لكل فعل عن سبب مبرر له ، ونتائج تترتب عليه ، وفق قوانين صارمة ، ومن خلال ميكانيكية العقل الذي أرساها ، تركنا شواطئ اليقين إلى الحدس ، والهواتف ، وشفرات من عوالم أخري ، وشطحات الخيال ،والحلم ، وتيارات الشعور ، والذكريات الموغلة في القدم ، لاسترجاع شذرات حتى مما جري في الرحم ، والكتابة التلقائية ، وممارسة الجنون والسحر ، والعودة إلى الطفولة ، وتقمص حيوات أخري ، من أجل كسر الحاجز الذي يخنق الحياة الإنسانية ، لاكتشاف السور ، ولو أدي ذلك إلى الكسر.. إلى الطوفان ..
ولذلك نلاحظ أن أنفاس القاص تلاقت مع أنفاس الشاعر في قصص ( عبده خال) ..
اقرأ هذه الفقرة لتتعرف علي ما ذهبت إلى شرحه: ( لم يعد أمامي إلا أسئلة أنشئها وأنقضها،فأغلقت كل المنافذ التي توصلني إلى الخارج فبعد متابعتي للتلفاز أيقنت أن مؤامرة تحاك ضدي،فقد كان فم المذيع يفتر عن ضحكة صامتة كلما تلاقت عينانا بالرغم من أنه كان يتلو فاجعة حلت بإحدى العواصم..ساعتها أيقنت بأنني دخلت مرحلة خطيرة وأن عناكب تغزل هواجسا وتشرعها أمام بصري وأيقنت بأنني مقدم على انهيار عصبي سيؤدى بما تبقى لدى من جلد . في بادئ الأمر كذبت عيني وأخذت أتربص بالمذيع بين فترة وأخرى فلمحته يمد لسانه ويرفع يديه إلى أذنيه ويهزهما كجناحي عصفور يهم بالتحليق فأسرعت غالقا التلفاز وكدت أن أجهش بالبكاء ولكنني تمالكت نفسي وأخذت أتحدث بصوت مرتفع لاقناعها بأن ما يحدث أوهام عشعشت وشاخت بمخيلتي لا غير، ولكي لا يتجدد يقيني فقد امتنعت عن مشاهدة التلفاز وأصبحت حبيس جدران غرفتي ..)
وبنفس السرد الغرائبي ، القريب من قصص الواقعية السحرية ، تلك التي توغل في عمق الأسطورة ، وربما تستقي من عوالمها ، روحها الأخاذة ، اللافتة ، تأتي قصة( نبت القاع)
- 8 -
للقاص ( عبده خال) ، لتبدو أمامنا ، بأسلوب سردها الغرائبي وكأنها حكاية شعبية ، مما يروي ، في تراثنا ، لكن القصة ، ليست مستقاة من القص الشعبي .. من الممكن أن يكون هناك تقابل بينها وبين ما هو متعارف عليه من صيغ القص الشعبي .. الغرائبي .. الفنتازي ، العجيب ، الذي يسلبك لبك ، ويُنشط في ذهنك مناطق الخيال ، وينقلك إلى عوالم أخري ، ربما كوسيلة للهروب من شيء ما ، غامض ، أو محدد ، فتلك المرأة التي ظلت تنتظر زوجها البحار منذ رحل ، وهي تؤمن بأنه سيعود من نفس المكان الذي رحل منه ، والمكان هو سقف حجرتها ( في كل عام تمضي مواسم الأمطار ، مخلفة حلما قديما شاخ بذاكرة تلك المرأة التي لم تيأس من عودة زوجها ، الذي خرج ذات ليلة ولم يعد ، فقد حكي لها قبل اختفائه أنه رأي نسرا قويا يخطفه ، ويُحلق به في الفضاء ، ويقذف به في عتمة البحار النائية ، وبعدها بليلة واحدة ،وبينما كانت نائمة أحست بشيء يتحرك من حولها ، وينفرج سقف غرفتها لتلمح زوجها معلقا في الفضاء ، كطائر عملاق يخفق بجناحيه بشدة ، صوب البحر ، كانت تظن أنها تحلم فأغمضت عينيها ، وواصلت نومها ، وعندما أفاقت وجدت جزءا من سقف غرفتها منبعجا ولم تجد زوجها )
وهذه المرأة تعيش - نتيجة لما حدث - حياة بوهيمية ، وتؤمن بأن زوجها سيعود من فتحة السقف ، ولذلك نراها لا تقوم بإصلاحها أبدا ، تتصرف وكأنها امرأة مجنونة ، ولا يستطيع ولدها البالغ من العمر ثلاثين عاما أن يُبعدها عن ما تؤمن به .. إلى هذا الحد والحكاية تبدو محدودة ، لكن الكاتب آثر أن يضيف أبعادا غرائبية أخري ، أو أراد أن يلهب حواس المتلقي أكثر ، لاستقبال حكاية أسطورية ، مكتملة ، حين وضع الابن في حالة مشابهة لحالة الأم بعد أن قابله ذلك الصياد ، الذي أبلغه بأن أباه موجود وسيعود ( تناول كأس شاي فارغ وصب به من مائه ، ورفعه إلى فمه ، وأخذ يتمتم عليه ، وأدناه من عيني لألمح رجلا يجلس في قارب يغزل شراعا بمهل ، وإتقان ، وقد أصابه الضمور ، كنت أحدق بدهشة ، ولم أفق إلا علي صوت البحار السوداني وهو يقول : هذا أبوك انتظره .. سيعود من البحر كما ذهب إليه ) بعدها لم يستطع الابن أن يعيش في أمان ، وصار حاله أشد من حال أمه ، إذ كان الدوار يصيبه بشدة لدرجة لا يستطيع معها أن يسيطر علي نفسه ، وتنتهي القصة وقد رأي نفسه وقد ابتلعته دوامة كبيرة ، ويلمح البحر يقذف بأمواجه ، ويسعي في الشوارع يدخل البيوت ، ويسحبه صوب جثة انتفخت علي سطحه ، ليسحبها ويتلاشي معها في القاع .
فكرة الانتظار ، انتظار مالا يجيء ، ذلك الذي يمكن أن يُهلك المنتظر ، تلك الفكرة هي ما تشير إليه تلك القصة ، انتظار مالا يجيء ، كما حدث لشخوص بيكيت العبثيين ، هؤلاء الذين كانوا ينتظرون ما لا يجيء .. ما هو الشي الذي لا يجي ء .. ؟؟ أي شيء ، تشعر به ، وترغبه ، وتتمناه ، وتخاف منه ، وأنت في انتظاره ، تعيش حالة من الرعب ، وحالة من الفزع اللانهائي .. السرد الغرائبي - كما ذكرت - سيطر سيطرة بالغة علي القصة ، ومعالجة الموضوع ، والكاتب كان متأثرا جدا ، بذلك السرد الذي وجدناه عند ماركيز - علي سبيل المثال – خاصة في قصصه القصيرة - فحين نقول واقعية سحرية ، فهذا معناه أن الواقع حاضر ، كما أن السحر حاضر ، إذن هو اختلاط بين الواقعي واللاواقعي ، اختلاط بين المتحقق ، وغير المتحقق ، اختلاط الملموس ، وغير الملموس ، واقعية سحرية ، لكنها يمكن أن ترمي إلى همومنا العربية ، تلك التي تجعلنا في حالة انتظار دائم ، لشيء ما ، ربما يكون في هذا الشيء سعادتنا ، وربما يكون في هذا الشيء تعاستنا ، وربما يكون فيه هلاكنا ، لكننا مع ذلك ننتظر ، وسنظل .
ولقد مزج الكاتب بين ضميرين في هذه القصة : ضمير الغائب وضمير المتكلم ، بحيث انك لا تستطيع التفريق بين الضميرين ، مما أعطي إحساسا ، أن أزمة الشخصين واحدة ، الراوي ، والبطل ، لافرق ، الأزمة التي تبدو متعلقة بشخص ما ، نجدها خاصة بشخص معين بعد متابعتنا للأحداث ، وهذا المزج ، يُعد أداة جديدة من أدوات المعالجة المعاصرة في القصة القصيرة ، ويُعد جمالية من جمالياتها ، وبراعة في التشكيل لو أُحسن استخدامه .
هذا الجزء من دراسة طويلة ، اشتركت بها في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب الذي عقد في الشارقة بدولة الامارات العربية في نهاية الشهر الماضي يناير 2006 ، ولقد اكتفيت به ؛ حيث ان قصص عبده خال التي اعتمدت عليها في الدراسة منشورة في موقع القصة العربية .
¤ للتعرف أكثر علي طبيعة القصة القصيرة جدا ، وقراءة بعض النماذج التطبيقية لها ن يمكن الرجوع لكتاب ( إشكالية الشكل والرؤية في القص المعاصر) – أحمد عبد الرازق أبو العلا – الهيئة العامة لقصور الثقافة – 1997 مصر
1- يمكن مراجعة مقال القصة القصيرة في الخليج العربي والجزيرة العربية نشأتها وقضاياها الاجتماعية – د. نورية الرومي – مجلة فصول – الهيئة المصرية العامة للكتاب – المجلد الثاني – العدد الرابع – 1982 الصفحات من 239 إلى 256
2- فرانك أوكونور – الصوت المنفرد – ترجمة د. محمود الربيعي _ وزارة الثقافة – المكتبة العربية – العدد 99 – الترجمة 6 – 1969- الصفحات 21/ 22
3- عبده خال – من مواليد جازان -1962 من أعماله في مجال القصة القصيرة : حوار علي بوابة الأرض 1984- لا أحد 1986- ليس هناك ما يبهج 1988- من يغني في هذا الليل 1999- ومن أعماله في مجال الرواية : الموت يمر من هنا 1991- مدن تأكل العشب 1998 – الأيام لا تخبئ أحدا 2000
( من أقوال الكاتب عبده خال التي يمكن أن تضيء شخصيته كمبدع : إنني أؤمن أن الإنسان هو نص مفتوح من الأزل ينطوي على طابع التجدد لذا فان من هواجسه البحث عن الجديد، إذن كون الإنسان نصا مفتوحا وقابلا لان يتطور داخلياً، يعني أن النص الباحث عن التجديد هو فطرة طبيعية في الإنسان والذي يحد منها مطامع شخصية لفئة معينة تحد من الانطلاقة الطبيعية للإنسان وبالتالي تضع أمامه حواجز أو سدودا أو ترسم له طريقا محددا يسير وفقه. )
(إن مشكلة الحداثة في العالم العربي أنها اصطدمت بالعديد من المعوقات، فإذا آمنا أن الثقافة هي مغايرة للماضي نجد أننا نسير بذاكرة حافظة تحمل ماضيها حتى لو آمن الكثير منا بهذا التجديد أو هذا التحديث لكن هنالك من يسير باتجاه الحداثة ولكن بفكر ما ضوي.. إذن وقع نوع من الخلخلة في تمثل هذا الأمر، إضافة لذلك أن العالم العربي لا يتحدث بصوت واحد، فهو تارة يتحدث بقطرية وأخرى بإقليمية ولذا تجد بلدا هو أكثر حداثة من البلد الذي يجاوره.. بينما نجد نماذج لأمم أخرى وهي تتحرك كتلة واحدة، من هنا رأى الساسة أن مشاريعنا المستقبلية تسير بخطوة واحدة ونهج واحد يخص حالة كل بلد ونظرته وهذا كله كان له انعكاس واضح على الكاتب المحلي فمفهومي أنا للحداثة قد يختلف عن مفهوم مثقف آخر في المغرب أو في الأردن، وكذلك الاقتراب والابتعاد عن مراحل التحديث لها دور مؤثر آخر ..)
( حوار أجراه في إحدى الصحف)
4- عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة سنة 1973 ص12، ص17، ص41.
5- رواية (الفراشة) لكاتبها السجين الفرنسي (هنري شاريير (
والعمل عبارة عن يوميات حقيقية لذلك السجين دون فيها سنواته الطويلة الملوثة بالوحل الحضاري الأسود مستعرضا محاولات هروبه المتكر حتى خروجه من السجن نهائيا مستردا حريته ، وقد تحولت الرواية الى فيلم قام ببطولته (داستن هوفمن) و(ستيف ماكوين)
6- إن الموضوع القصصي هو الحكاية ذاتها ، تلك التي تتكون من أحداث وشخصيات ، ولا يمكن أن تكون هناك حكاية بدو نهما
7- د.نعيم عطية - مؤثرات أوربية في القصة المصرية في السبعينيات - فصول - المجلد الثاني - العدد الرابع 1982 صفحة 209
8- نُشرت قصة ( نبت القاع) في مجلة ( الراوي ) السعودية – العدد الأول – مارس 1998 ، واعتمدنا - هنا - علي القصة المنشورة في كتاب ( القصة السعودية المعاصرة ) اختيار وتقديم د.طه وادي – الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة آفاق عربية – العدد 57 سبتمبر 2002 – والقصة منشورة في الصفحات من 239الي 251 .. والقصص الأخرى التي تناولناها بالدراسة والتحليل هنا ، تم اختيارها من الانترنيت ، وبخاصة من موقع القصة العربية www.arabicstory.net