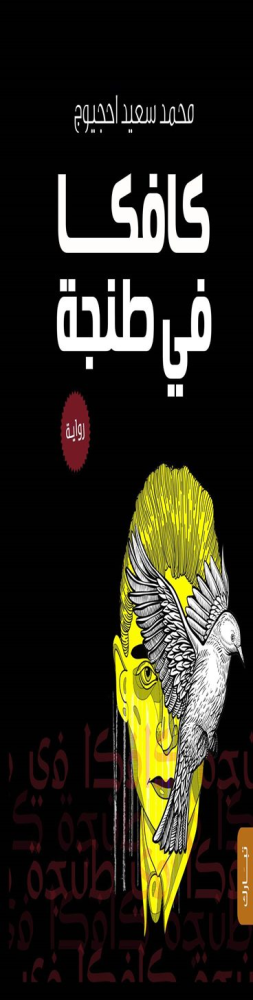الطبيعة والإنسان وحدهما من يخلقا تكاملا على مستوى الوجود, فالإنسان بتلمسه لجمال الطبيعة, هذا الحضن الرحب للأشياء المختلفة, هو وحده من يمتلك سرَّ ديمومة تصوير الجمال, على الرغم من حقيقة ان جمال الطبيعة قائم بذاته, لكن حقيقة تعالق الإنسان والطبيعة يحقق صورة الوجود في تماهيه وانسجامه, في إبراز طبيعة الاشياء, لذا بات من المفيد إدامة هذا التناغم بين الإنسان والطبيعة, الذي من شأنه أن يذهب بنا بعيدا في تصويره للمحسوس, وفي الحفاظ على صورة جمال الموجودات, عبر وحدة وجودها, لما لها من تأثير جلي في عديد التجارب الحياتية والإنسانية كالفنون مثلا, وما الشعر بمنأى عن مؤثرات الطبيعة, ان صورة الطبيعة حاضرة في المخيلة الشعرية, ويحق لنا عدها مساهم فاعل في تذكية خيال الشاعر والفنان, لما تشكله من انعطافة كبيرة في مجال الشعر والرسم, وما تركته الطبيعة في الشعر الأندلسي على سبيل المثال, من أثر ايجابي في توسعة الخيال, وإضافة نوعا من السكينة والهدوء الذي انعكس على مجمل مضامين قصائدهم, بما مثلته من عنوانات ومتون لنصوص شعرية بارزة في وقتها, متخذين من الخضرة والأنهار والمناخ المعتدل, الذي أثر بشكل مباشر على اقتناء المفردة التي تتناسب والطبيعة كبيئة معاشة, ان تأثير الطبيعة وأجوائها الخلابة على النصوص الشعرية أخذ مجالا واسعا في اتساع الرقعة الشعرية في أصقاع العالم كافة, حتى النص الغربي تأثر هو الآخر بها, وما الشاعر الروسي (سيرغي يسينين) بعيدا عن التوصيف, إذ عدَّ نفسه آخر الشعراء القرويين, ومنذ فترات ليست بالقريبة ظهر إلى الواجهة ما أطلق عليهم (شعراء القرى) تماشيا مع التوصيف الأول من كونهم شعراء الطبيعة, وذلك لما واجهوه من إقصاء قسري عن رحم الطبيعة وتأكيد انتسابهم للمكان/ الطبيعة, أو كونهم تمسكوا بالطبيعة/ القرية, ولم يفارقوها, وما عمدوا إليه من إضفاء توصيف دقيق للهوية المكانية/ القرى, التي ينتسبون إليها, معتمدين على مفردات تدل دلالة واضحة على تواصلهم مع بيئتهم الأم, وأكثر هذه المفردات تحمل السمة الريفية/ القروية, خصوصا عند أغلب شعراء القرى في العراق, مثل استخدام مفردة, (النهر ,الشجر ,العصافير ,الريح, الحقول, حمام الفاخت....الخ), مجسدين التصاقهم بالطبيعة /القرية, تحديدا, من خلال توظيف المفردة الملتصقة بالقرى في شعرهم كالسيّاب, وحسب الشيخ جعفر, وعيسى حسن الياسري, حتى وان غادروها فحقولها وأنهارها عالقة بالأذهان وقامات نخيلها حاضرة والارتباط الوثيق بأرض الأجداد كذلك حاضر وبقوة, رباط لا يفارق المخيلة, وهذا بالضبط ما سار على خطاه الشاعر عمار المسعودي متخذا من مجموعته الشعرية, ( يزرعُ بهجاته), منصة ليعلن التحاقه بركب شعراء الطبيعة/ شعراء القرى, محاولا إعادة الشعر إلى رحم الطبيعة, ممثلا بالقرية, بعد انصراف الكثيرين, إلى موضوعات ترتبط ارتباطا مباشرا بالشعر الوجداني وتوجهاته المتعددة, أو انشغال البعض بموضوعات المدينة وهمومها التي لا تقل شأنا عن الطبيعة, أو موضوعات إدانة الحرب, والوجع اليومي, والدعوة إلى الخلاص من الأوضاع المتردية وغيرها من الموضوعات التي صرفت ذهن الشاعر عن الطبيعة, كما صُرف ذهن المزارع عن القرية واستصلاح أرضها, لكن المسعودي هنا, خاض تجربة شعرية ذاتية, من أجل إعادة النص الشعري إلى رحم الجمال و الزقزقات والنقاء, تجربة عبر فيها عن انتمائه إلى سديم هذه الأرض التي تولد فيها ونشأ.
أن تأثير الطبيعة متحقق من خلال عتبات المجموعة بدءاً من عنوانها, (يزرعُ بهجاتِه), فالفعل المضارع, (يزرعُ), يدل على الاستمرارية في زرع البهجة والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على الشاعر/ المسعودي/ المزارع, المفتون ببذار الأرض والكلمة, مُؤسساً لعتبات نصية تتخذ في قسم غالب منها الطبيعة منطلقا لها, مثل, (بساتينه, بالقمر ولا يضاء, خوف رمانتين, صغار الباقلاء, كانت من نخيل, أنا ذابل, فاكهة لبهجاتي, استبدلها بشجرة, تمايل نخيل, لوازم قروية, خيال شجرة), مُؤكداً انتمائه للقرية, وقد أكد هذا المعنى في عتبتين نصيتين, هما,( لم أرَ البحر), في نفي لرؤيته البحر وما يمثله من علامة للنأي والهجر, وفي هذا إشارة واضحة لتعلقه بالنهر والقرية التي تمثل الوطن بكل معاني الانتماء, وما تصريحه في عتبة, (لا أصلحُ للهجرة) إلا إعلان عن رفضه لهجرة أرض الأجداد, وتأكيد على مكوثه في حضن الطبيعة/ القرية, وما متون النصوص بمنأى عن الارتباط الوثيق مع الطبيعة/ القرية
(ان تمتَّعتَ بخضرتي
فلا تحدَّثنَ أحد عنها
فان تحدثت وبحتَ ببعض أسرارها
سكنتك صحاراك وهجرتك قراك. ص8)
بحسب النص الشعري يبدو الانتماء إلى الطبيعة/ القرية, يأخذ منحى مختلفا, إذ إننا لا نجد الشاعر هنا يفكر مجرد تفكير بهجرة القرية فحسب, وإنما يدعو من يتمتع بخضرتها, إلا يحدث أحداً عن أسرارها وما تتمتع به من كنوز لا يروم فقدها بمجرد إخبار الآخرين في إضفاء الصبغة القداسة عليها, لقوله, (سكنتك صحاراك وهجرتك قراك) فكأنما تسكنك الصحاري وتهجرك قراك بخضرتها, لعنة تطالك بمجرد الحديث عنها للآخرين, لتعيش الجدب والفاقة.
(لا تكتب أية خضرة
ما بيني وبين حقولي
لا تكتب أية زهرة
لا تكتب أي غصن
ان كتبت كل ذلك,
فقد محوتني ص21)
من خلال النص الشعري, نجد خشية الشاعر من أن يكتب الخضرة أو الزهرة أو أي غصن بينه وحقوله, لكي لا يشكل فاصلا بينه وبين تماهيه والطبيعة, مغطيا المساحات الفارغة, قاطعا الطريق على من يروم كتابة أي شيء يحول وهذا التواشج الغريب, فما عداه, محو له شخصياً, متخذا من ثيمة المحو سلاحا لمحو من يحاول الحؤول بينه والحقول, حتى لو كانت من بذار الأرض/ الحقل, كالخضرة, والزهرة, والغصن, من أجل الاستمرار بحفظ أسرار القرية التي, مازالت حصونها بمأمن من الوشاة والطامعين.
(لو تتركني هذه الفاختة
ألعب الاختفاء تحت عينيها
أتسلق-في غفلة- أسراب التين
في الجانب الآخر من النهر
لو تتركني أصوِّرُ
أنينها ووحدتها ص23)
في النص الشعري, نجد الفاخت تمثل بؤرة تمركز النص هذا وما يليه في تتمة للرؤية, حيث أن حمام الفاخت, يدل دلالة واضحة على البساتين والأنهار, وإضفاء صفة العين الحارسة على (أسراب التين), في ضفة النهر الأخرى, حارس أمين على ممتلكات القرية المقابلة, حتى أنَّ شاعرنا/ المزارع/ الحارس, تمنى لو يلعب لعبة الاختفاء تحت عينيها في تصريح واضح ليقظتها, وما تمنيه للتسلق في غفلتها إلا دليل واضح على اليقظة التامة, في تناغم واضح مابين الإنسان الشاعر/ المزارع, وما بين موجودات الطبيعة الأخرى/ حمامة الفاخت/ الحارس الأمين, ناهيك عما يحمله هذا النوع من الحمام بالذات من صفات تحمل السمة الألفة بينها وبين البشر, فما ان نظرت إليها إلا رافق نظرتك الشعور بالوحدة, التي هي من سمات البشر, كذلك نجد سمة الأنين هنا, إلا سمة مشتركة, في تجسيد للوضع النفسي الضاغط, الذي عاشهُ الحارسان/ الإنسان والفاخت, في أنسنة لها.
(كان صوتها النازل
من أعلى الشجرة موجعاً
أسمعه فأتفقد أمِّي ص23)
نجد حاجة ملحة لاستكمال المقطع الشعري, ليمكننا توضيح الرؤية التي جاء بها النص الشعري, ان هذا النوع من الحمام, التي تهوى المكوث في أعلى الشجرة, لكن صوتها النازل إلى الأرض يثير فينا شجون الفقد, وان أول ما يتبادر إلى الذهن هنا فقد الأم, في إشارة بليغة لكون حمام الفاخت/ الام, في الطرف الثاني من النهر فقدت الحارس/ الزوج, الموكل إليه رعاية البستان, وحماية أسراب التين/ الصبايا, وهذا سرُّ أنينها ووحدتها, فكيف يمكنها إطباق جفن, والأخطار تحيق بها من كل صوب؟ لذا فأن حفظ خضرة القرى من حفظ أسراها, فليس الرجال وحدهم من تتقن كتمان السرِّ.
(لا أصلح للهجرة كوني لا أمتلك حقيبةً
تتسع لبساتيني
لأصدقائي
لدروبي إلى المدرسة
لأبي الذي لا يستبدلُ
بكل هذا العالم
قريته الحسناءَ ص65)
يصرح النص الشعري عن التصاق الشاعر بالبساتين/ الطبيعة/ القرية, فهو لا يصلح لهجرتها, وليس بمقدوره هجرة الأصدقاء, والمدرسة, فالقرية هنا لم تقتصر على الطبيعة فقط, وإنما على أبنائها والأماكن التي ارتادها في مقتبل العمر(المدرسة) وهو يحث خطاه في دروب قريته الناعسة, والارتباط يتوثق أكثر بارتباط أسرته هي الأخرى وما ارتباط أبيه بقريته, إلا توثيق عرى الانتماء, حتى انه لا يبادل حسنها بكل العالم, في ترميز عالٍ لجمال القرى الظاهر والباطن, في مشاكسة واضحة لقبح العالم الخارجي, بكل مغرياته.
من هذا نجد القرية/ الطبيعة, ملتصقة في وجدان الشاعر, والالتصاق مصيري, قد يذهب إلى ابعد من خشية فضح إسرار القرى للغرباء, بل إنّ الخشية تأخذ منحى آخر, من خلال الخشية من الخروج من رحم الطبيعة/ القرية, ودخوله في زحمة العالم الفسيح, فهو لا يغامر بترك إرثٍ من الذكريات, أو ترك ارثٍ من الارتباط الوثيق؟, فالقرية أرض الآباء والأجداد.
أن تأثير الطبيعة متحقق من خلال عتبات المجموعة بدءاً من عنوانها, (يزرعُ بهجاتِه), فالفعل المضارع, (يزرعُ), يدل على الاستمرارية في زرع البهجة والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على الشاعر/ المسعودي/ المزارع, المفتون ببذار الأرض والكلمة, مُؤسساً لعتبات نصية تتخذ في قسم غالب منها الطبيعة منطلقا لها, مثل, (بساتينه, بالقمر ولا يضاء, خوف رمانتين, صغار الباقلاء, كانت من نخيل, أنا ذابل, فاكهة لبهجاتي, استبدلها بشجرة, تمايل نخيل, لوازم قروية, خيال شجرة), مُؤكداً انتمائه للقرية, وقد أكد هذا المعنى في عتبتين نصيتين, هما,( لم أرَ البحر), في نفي لرؤيته البحر وما يمثله من علامة للنأي والهجر, وفي هذا إشارة واضحة لتعلقه بالنهر والقرية التي تمثل الوطن بكل معاني الانتماء, وما تصريحه في عتبة, (لا أصلحُ للهجرة) إلا إعلان عن رفضه لهجرة أرض الأجداد, وتأكيد على مكوثه في حضن الطبيعة/ القرية, وما متون النصوص بمنأى عن الارتباط الوثيق مع الطبيعة/ القرية
(ان تمتَّعتَ بخضرتي
فلا تحدَّثنَ أحد عنها
فان تحدثت وبحتَ ببعض أسرارها
سكنتك صحاراك وهجرتك قراك. ص8)
بحسب النص الشعري يبدو الانتماء إلى الطبيعة/ القرية, يأخذ منحى مختلفا, إذ إننا لا نجد الشاعر هنا يفكر مجرد تفكير بهجرة القرية فحسب, وإنما يدعو من يتمتع بخضرتها, إلا يحدث أحداً عن أسرارها وما تتمتع به من كنوز لا يروم فقدها بمجرد إخبار الآخرين في إضفاء الصبغة القداسة عليها, لقوله, (سكنتك صحاراك وهجرتك قراك) فكأنما تسكنك الصحاري وتهجرك قراك بخضرتها, لعنة تطالك بمجرد الحديث عنها للآخرين, لتعيش الجدب والفاقة.
(لا تكتب أية خضرة
ما بيني وبين حقولي
لا تكتب أية زهرة
لا تكتب أي غصن
ان كتبت كل ذلك,
فقد محوتني ص21)
من خلال النص الشعري, نجد خشية الشاعر من أن يكتب الخضرة أو الزهرة أو أي غصن بينه وحقوله, لكي لا يشكل فاصلا بينه وبين تماهيه والطبيعة, مغطيا المساحات الفارغة, قاطعا الطريق على من يروم كتابة أي شيء يحول وهذا التواشج الغريب, فما عداه, محو له شخصياً, متخذا من ثيمة المحو سلاحا لمحو من يحاول الحؤول بينه والحقول, حتى لو كانت من بذار الأرض/ الحقل, كالخضرة, والزهرة, والغصن, من أجل الاستمرار بحفظ أسرار القرية التي, مازالت حصونها بمأمن من الوشاة والطامعين.
(لو تتركني هذه الفاختة
ألعب الاختفاء تحت عينيها
أتسلق-في غفلة- أسراب التين
في الجانب الآخر من النهر
لو تتركني أصوِّرُ
أنينها ووحدتها ص23)
في النص الشعري, نجد الفاخت تمثل بؤرة تمركز النص هذا وما يليه في تتمة للرؤية, حيث أن حمام الفاخت, يدل دلالة واضحة على البساتين والأنهار, وإضفاء صفة العين الحارسة على (أسراب التين), في ضفة النهر الأخرى, حارس أمين على ممتلكات القرية المقابلة, حتى أنَّ شاعرنا/ المزارع/ الحارس, تمنى لو يلعب لعبة الاختفاء تحت عينيها في تصريح واضح ليقظتها, وما تمنيه للتسلق في غفلتها إلا دليل واضح على اليقظة التامة, في تناغم واضح مابين الإنسان الشاعر/ المزارع, وما بين موجودات الطبيعة الأخرى/ حمامة الفاخت/ الحارس الأمين, ناهيك عما يحمله هذا النوع من الحمام بالذات من صفات تحمل السمة الألفة بينها وبين البشر, فما ان نظرت إليها إلا رافق نظرتك الشعور بالوحدة, التي هي من سمات البشر, كذلك نجد سمة الأنين هنا, إلا سمة مشتركة, في تجسيد للوضع النفسي الضاغط, الذي عاشهُ الحارسان/ الإنسان والفاخت, في أنسنة لها.
(كان صوتها النازل
من أعلى الشجرة موجعاً
أسمعه فأتفقد أمِّي ص23)
نجد حاجة ملحة لاستكمال المقطع الشعري, ليمكننا توضيح الرؤية التي جاء بها النص الشعري, ان هذا النوع من الحمام, التي تهوى المكوث في أعلى الشجرة, لكن صوتها النازل إلى الأرض يثير فينا شجون الفقد, وان أول ما يتبادر إلى الذهن هنا فقد الأم, في إشارة بليغة لكون حمام الفاخت/ الام, في الطرف الثاني من النهر فقدت الحارس/ الزوج, الموكل إليه رعاية البستان, وحماية أسراب التين/ الصبايا, وهذا سرُّ أنينها ووحدتها, فكيف يمكنها إطباق جفن, والأخطار تحيق بها من كل صوب؟ لذا فأن حفظ خضرة القرى من حفظ أسراها, فليس الرجال وحدهم من تتقن كتمان السرِّ.
(لا أصلح للهجرة كوني لا أمتلك حقيبةً
تتسع لبساتيني
لأصدقائي
لدروبي إلى المدرسة
لأبي الذي لا يستبدلُ
بكل هذا العالم
قريته الحسناءَ ص65)
يصرح النص الشعري عن التصاق الشاعر بالبساتين/ الطبيعة/ القرية, فهو لا يصلح لهجرتها, وليس بمقدوره هجرة الأصدقاء, والمدرسة, فالقرية هنا لم تقتصر على الطبيعة فقط, وإنما على أبنائها والأماكن التي ارتادها في مقتبل العمر(المدرسة) وهو يحث خطاه في دروب قريته الناعسة, والارتباط يتوثق أكثر بارتباط أسرته هي الأخرى وما ارتباط أبيه بقريته, إلا توثيق عرى الانتماء, حتى انه لا يبادل حسنها بكل العالم, في ترميز عالٍ لجمال القرى الظاهر والباطن, في مشاكسة واضحة لقبح العالم الخارجي, بكل مغرياته.
من هذا نجد القرية/ الطبيعة, ملتصقة في وجدان الشاعر, والالتصاق مصيري, قد يذهب إلى ابعد من خشية فضح إسرار القرى للغرباء, بل إنّ الخشية تأخذ منحى آخر, من خلال الخشية من الخروج من رحم الطبيعة/ القرية, ودخوله في زحمة العالم الفسيح, فهو لا يغامر بترك إرثٍ من الذكريات, أو ترك ارثٍ من الارتباط الوثيق؟, فالقرية أرض الآباء والأجداد.