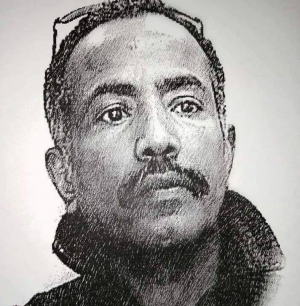لم تستوقفني فاطمة لأنها طفلة تتسول، فقد اعتدتُ رغماً عَنّي على منظر المتسولين الأطفال يداهمون المارة في الأزقة والشوارع، ليشعرونني كل مرة كم أن للحياة طعماً رديئاً.. لكن فاطمة التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ـ كما قدّرت ـ شلّت تفكيري، واستقطبت أحاسيسي، وجعلتني أشعر كلما التقيتها، أو زارتني في مكتبي أن صرخة خرساء تمزّق قلبي.. من اللحظات الأولى استفزتني تلك المتسولة الصغيرة، إذ لم أتّوقع أن أجدَّ متسولاً شديد الاعتداد بنفسه كفاطمة، فهذه مهنة الذل والانكسار، لكن فاطمة تملك إحساساً فطرياً عالياً بكرامتها الشخصية، إنها لم تسمع عن الكرامة، ولا تعرف ماهي، لكنها تملكها في داخلها كمن يملك جوهرة يجهل قيمتها. سيطرت عليَّ تلك الطفلة وأملّت شروطها. كنتُ جالسةً في مكتبي أنعم بدفء الشوفاج وأتلذذ بفنجان قهوة يساعدني على تحمل جرعات الإحباط اليومية التي تقدمها نشرات الأخبار، ومن حين لآخر أهرب بنظري من شاشة التلفاز إلى النافذة، لأتفرج على الأمطار الهائجة التي سقطت بعد احتباس طويل، كدموعٍ مخنوقة فاضت بها الروح أخيراً..
دخلت عليَّ فاطمة أشبه بفزاعة عصافير، هيكل عظمي لطفلة تكسوه أسمال بالية فضفاضة ومن حذائها المهترئ تظهر أصابع قدميها القذرة المزرقة من البرد، دخلت منتصبة القامة، ترسم ابتسامة متعبة على وجهها الطفولي المدبوغ بالإعياء والألم رغم نضارته، أدهشني امتلاء وجهها مقارنة مع نحولها الشديد، كان شعرها المقصوص بطريقة مشوهة مبلولاً ويقطر ماءً على رقبتها وكتفيها. تحمل في يمناها كيساً أسود. سألتني بصوت واثق لا يحمل أي نغمة استجداء:
ـ هل تشترين هذه الكنزة؟!!..
أخرجت كنزة خضراء عتيقة من الكيس، وعرضتها علي بطريقة نزقة، عارفةً أنني لا يمكن أن أشتري هذه الخرقة..
لم أستطع أن أصرفها، علاقتي مع المتسولين الصغار كانت بالهروب منهم، أسرع بإعطائهم النقود أو أسرع خطواتي كي يفهموا ألا يتبعوني ويتعبوا أنفسهم، ماكنتُ أتحمل مظهرهم الرث فقلبي طافح بأنواع كثيرة من الغمّ والقهر.
لكن فاطمة فرضت نفسها عليَّ بطريقةٍ غامضةٍ أجبرتني أن أراها بقلبي ـ أسرتني تلك المفارقة في شخصها، فتلك المتشردة الصغيرة، البردانة والجائعة والمُهملة، شبه الحافية، تملك كرامة متحدية واعتداداً حقيقياً بنفسها، هل أردتُ أن أحلَّ لغز النظرة؟.. سألتها: من أنتِ...؟!
أجابت: فاطمة...
ـ ولِمَ تتسولين يا فاطمة...؟
هَزَّت؟؟؟؟ كتفيها ساخرة من سؤالي، ابتسمت كاشفة عن أسنان مصفّرة.
سألها: ألم تذهبي إلى المدرسة؟..
ـ أجل وصلت حتى الصف الخامس.
ـ ولِمَ تركت المدرسة يا فاطمة؟
بصوتٍ بالغ الحياد أجابت: أخرجتني أمي كي أعمل.
ـ أهي التي تدفعك للتسول؟..
ـ أجل...
كنتُ أحدّقُ بها كحالة للدراسة، كنموذج خاص لمتسول، كانت عيناها الواسعتان العسليتان تحدّقان بوجهي بنظرة نقية صافية تستحث محبتي إنما ليس شفقتي...
نظرتها تعني، لا تنظري إلي نظرة فوقية، لا تهينينني بشفقتك، فأنا إنسانة مثلك، لكن ظروفي صعبة..
وجدتني أعطيها مبلغاً كبيراً من المال، ليس لإرضائها، وإرضاء ضميري، إنما لغاية أكثر تعقيداً، فقد أردتُ ـ أنا التي وقعتُ تحت سطوتها ـ أن أسيطر عليها بهذا المبلغ الذي لم تحلم به..
أخذت المال ببساطة ودسته في جيبة بنطال واسع تحزمه بشريط ثخين، ابتسمت لي شاكرة، وعادت تمسح وجهي بحنان بعينيها الصافيتين...
سألتها: إحكِ لي عن أسرتك، أمكِ، أبيكِ؟..
قاطعتني: والدي توفيَ منذ عامين بالسرطان، لديَّ أربع أخوة يصغرونني..
ـ وأمكِ، ماذا تعمل؟..
ـ لا شيء..
ـ وكيف تعيشون..
رفعت كتفيها بلا مبالاة، وقالت: الله يعيننا، أحياناً الأقرباء يرسلون لنا طعاماً..
أغاظتني تلك الطفلة بمظاهر الرضى التام لواقعها، كأنها لا تخجل مما هي فيه، من نذالة أمها وبؤس طفولتها، أحسستها تريد أن تحب الحياة مهما كانت قاسية عليها..
قاومت مشاعر غيظي وتابعت الحوار معها..
ـ هل تعرف أمك أنك تدورين من مكتب إلى مكتب تشحذين المال؟..
ـ أجل..
ـ ألا تخشى عليك من اعتداء، أو تحرُّش أو خطف أو....
قاطعتني: لا أعرف، لا أظن..
ـ متى تخرجين من البيت؟..
ـ منذ السابعة صباحاً..
ـ ومتى تعودين؟..
ـ أعود بين الثامنة والتاسعة مساءً...
ـ وأين تقضين كل هذا الوقت؟..
هزت كتفيها مستخفة بسؤالي قائلة بثقة واعتداد: أشحذ..
لم تشعر فاطمة أن هناك ما يهين في التسول، وجدت نفسها محشورة في زقاق الفقر، محاصرة مع أخوتها في فم غول اسمه الجوع..
ـ وهل تجمعين مبلغاً جيداً..؟..
ـ ليس دوماً..
ـ ما أكبر مبلغ جمعته؟..
ـ ذات يوم جمعت سبع مئة ليرة في اليوم..
فكرتُ أنه دخل موظف خلال أسبوع؟!!..
فجأةً لم أعد قادرة على محادثتها... شعرتُ أن وادٍ سحيق يفصلني عنها ويفصلها عني، لا يمكنني عبوره مهما دفعتُ لها مالاً، يبدو أنها شعرت أني لم أعد قادرة على تحمَّل وجودها، وبأنها تسبب لي الضيق، فحملت كيسها وهمت بالانصراف..
استوقفتها لأعطيها قالب شوكولا... امتدت يدها النحيلة كغصن مقطوع تأخذه مع نظرة امتنان لكني لم أشعر بلهفتها لتذوقه ـ قلتُ لها: كُليه يا فاطمة...
قالت: لا،.. سأخبؤه لأمي فهي تحب الشوكولا...
وددتُ لو أصرخ بها: وهل تستحق أمك أن تحبُيها؟..
لكني كبحتُ صراخي، ونفثت سموم حقدي في وجه طفلة بريئة من مصيرها...
ـ هل تحبين أمك التي ترميك في الشارع يا فاطمة؟..
حدقتْ بي بعينين زائغيتن زفرت همَّاً يضيق بها صدرها الطفولي، وقالت: كيف لا أحبها... إنها أمي... كرهتُ نفسي لأنني سببتُ لها الألم، وحين استدارت لتنصرف، تأملت عظم نقرتها وعظام كتفيها وأضلاعها التي تشف عن كنزة فضفاضة مهترئة، رجليها أشبه بعودين يابسين، لكن مشيتها شامخة، كأنها لا تريد أن تنهزم أمام نحولها، وبؤس طفولتها...
تركتني فاطمة مستنفدة بذكراها لأيام، التصقت هذه الطفلة بمشاعري، أحسستُها تريد أن تعطي مغزىً آخر لأيامي، إذ أحس بحضورها وأنا في السيارة، فأتخيلها هائمة في الشوارع، تفاجؤني ترنو إلي بعينيها الواسعتين العسليتين، وأنا آكل طعامي الشهي المدروس جيداً على الفيتامينات والسعرات الحرارية أحس بجوعها المُكابر... بلبلت مشاعري تلك المتسولة الصغيرة، فما عدتُ أعرف هل أرغب بلقائها أم لا...
لكني بعد أيام فرحت حقاً حين أطلّت عليَّ كشبح طفل يتقدم نحوي بثبات... لم أكن أعرف أن حميمية خاصة ولدت بيني وبينها، استقبلتها كأنني معتادة على استقبالها دوماً...
لكنها سمّمتني بالغضب حين قالت لي بابتهاج حقيقي: كم فرحت أمي بقالب الشوكولا..
كنتُ أريدها أن تكره أمها، وأن تعرف أن تلك الأم سيئة لأنها تدفع بطفلتها للتسول، كنتُ أطلب من طفلة لم تتعلم الكره بعد أن تعكَّر صفاء روحها وتكره، وتفهم قوانين استغلال الأطفال والإساءة إليهم، وأن تتمرد على مصيرها وتحاكم أمها، وبالتالي مجتمعاً بأكمله، ينتهك طفولتها..
سألتُها بحنق: كان يجب أن تأكلين الشوكولا أنت؟..
ـ لكن أمي تحب الشوكولا كثيراً..
ـ أمك هذه غريبة، كيف ترمي بك في الشارع لتتسولين؟...
كنتُ أشعر كم ينقل الصوت شحنات الحقد المسمومة، كم استاءت من غضبي الذي لم تتوقعه لأنها دخلت مكتبي بلهفة المشتاق، فلم تتوقع عجرفتي، أعطتني فاطمة درساً لن أنساه في أن العجرفة دليل الجهل... ماذا أعرف أنا عن هذا القاع الذي تعيش فيه فاطمة كي أنظرّ عليها وعلى أمها؟!!!...
كبحتُ غضبي وأعطيتها المال، فأخذته وهي تشيح بعينيها عني بنظرة انكسار، وجدتني أرّق للحال، وأطلب إليها أن تقترب مني، تركت الكيس الأسود الذي لم أسألها ماذا يضم، واقتربت مني، احتضنتها، ياه كم هي نحيلة، إنها بالكاد تملك قواماً...
سألتها: ألا تأكلين يا فاطمة؟...
ـ أجل، آكل مساءً حين أعود إلى البيت...
ـ وأثناء النهار..
ـ نادراً ما آكل، أحياناً إذا اشتدَّ علي الجوع، أشتري فولاً...
ـ لكن كيف ستكبرين وتصيرين صبية إن لم تأكلي...
أدارت جذعها بطريقة تعمّدت أن تلصق خدها بخدي، قالت لي كأنها توشوشني .
ـ حكيت لأمي عنك..
ـ وماذا قلتِ لها؟
ضحكت: قلتُ كلاماً جميلاً...
سألتها: لِمَ لا تحاول أمكِ أن تعمل...
ـ لا أعرف، أخوتي صغار، كيف ستتركهم...
ـ ووالدك ماذا كان يعمل؟
ـ سائق باص..
ـ أكان موظفاً..؟
ـ أجل..
ـ ألا تقبضون راتبه بعد وفاته..
ـ تقبض أمي نصف راتبه، أي ألفي ليرة..
ألفي ليرة!... لا تكفي ثمن خبز تسد به أرملة أفواه أطفالها الخمسة!...
أعدتُ سؤالي الغبي: أتحبين أمك يا فاطمة؟..
كأنني توقعت هذه المرة أن تصارحني بالحقيقة وتقول :لا..
نظرت إليَّ بعتب وتساءلت: وهل يوجد إنسان لا يحب أمه؟..
كانت أمها انتماؤها ودنياها، كانت وطنها، أليس للوطن وجه أم؟!... لم أعرف كم أن فاطمة تحب أمها إلا بعد شهر من ترددها عليَّ، يوم قررتُ أن أكتب رسالة لتلك الأم ـ عساني أحثها أن ترحم ابنتها من حياة التسول، وأحرّض فيها نخوة البحث عن عمل لإعالة أولادها.
لم أتردد بشأن الرسالة، لأن ذلك اليوم كان مشحوناً ببؤس فاطمة فوق قدرتي على الاحتمال...
كنتُ قد التقيتها صباحاً، وأعطيتها مالاً على عجل، وعند الظهر كانت عاصفة قوية تهب بجنون مقتلعة بضعة أشجار، ومسقطة عمودي كهرباء، كنتُ غاطسة في معطفي، أوصي سائق التكسي أن يكون حذراً خوفاً من جنون العاصفة، حين لمحتُ عَرَضاً فاطمة كشبح تقف عند مدخل أحد البنايات، تحمل الكيس الأسود بيدٍ، وتنفخ على يدها الثانية لتتدفأ.
كنتُ في مكان بعيد جداً عن مكتبي، تساءلت بدهشة: هل تصل فاطمة إلى هذه الأحياء!.. هزّني منظر المتسولة بقوة، ولم أستطع الاسترخاء طيلة النهار، ولعظيم دهشتي زارتني في يوم جنون الطبيعة مساءً في مكتبي، فانفجرتُ بها بلا شفقة: ألا زلت خارج البيت كيف تتجولين في الشوارع والعاصفة...
لكني لم أستطع أن أكمل كلامي الذي انقطع فجأةً أمام دموع عينيها، دموع بسبب البرد أسرعت تلتصق بالشوفاج، تقبض على قضبانه بأصابعها الصغيرة المحمرة، وتمسح بكم كنزتها أنفها الذي يسيل، وتقول لي متجاهلة استنكاري: ياه، البرد فظيع اليوم...
سألتها بسخرية:وكيف كانت الغلّة اليوم؟...
ردت ببساطة مسالمة: ليست سيئة.. جمعتُ مئة ليرة لأمي..
انفجرتُ لدى سماعي كلمة أمي، تلك المجرمة، عند هذا الحد قررتُ أن أكتب لتلك الأم رسالة، لا أذكر تماماً ماذا كتبت، لكن كلماتي كانت قاسية، لدرجة أن وجه فاطمة غام وراء غيمة حزن، عكرت ملامحها العذبة، لأول مرة شعرتُ كم هي مشوشة بالخوف وعدم الأمان، قطّبت وهي تنظر إليَّ بعتبٍ وألم، لكنني ألححتُ عليها أن تعطي أمها الرسالة، وأن تطلب إليها أن تزورني، كنتُ أريدُ أن أتفرج على تلك الطينة من الأمهات اللاتي يدفعن أولادهن إلى فم الغول..
أخذت فاطمة الرسالة وانصرفت، لكني فوجئتُ وأنا أغلقُ باب مكتبي أنهامزقت الرسالة، وألقت بالقصاصات عند بابي بتحدٍّ واحتقار. كتمت غيظي وقررتُ أن أحذفَ تلك المتسولة من حياتي، فلا يمكنني أن أقدم لها شيئاً، وفعلاً تجاهلتها خلال أسابيع، لكني تنبهتُ أنها هي التي بدأت تتجاهلني، فلم تعد تزورني، وتبتعد عني حين تصدفني في الشارع...
سخرتُ من نفسي واعترفت بأنني أسأتُ لهذه الطفلة، فأنا أشجعها على التسول حين أعطيها المال بطريقة لا تحلم بها...
صرتُ أتفرج عليها وهي تدور في الشوارع حاملة الكيس الأسود، تسير بقامتها الضئيلة الشامخة دوماً، شيء ما يضحك ويبكي في منظر تلك المتسولة المعتدة بنفسها، أراها جالسةً على درج، أو تقزز لب دوار الشمس، رفاهيتها الوحيدة ربما، تتفرج على الحياة حولها بعينينها الواسعتين الصافيتين، لا أذكر أنني رأيت عينان بصفاء عيني فاطمة، لم أرها مرة تأكل...
لكن فاطمة ظلت الغائبة الحاضرة، تركت بصمتها في روحي ومضت، بقي جزء منها في فضاء مكتبي يحفّ بي على الدوام، حاصرتني نظرتها الصافية التي تنجح دوماً في مداراة ألم أكبر من سعة صدرها النحيل، سجنتني في عسل عينيها، ياه ليس هناك من سجن أصعب من سجن العيون...
حاولتُ إقناع نفسي أن فاطمة وأمثالها أمرٌ واقعٌ، يجب تقبله، كما نقبل رغماً عنا مظاهر انتهاك كثيرة، الأذى الذي يحدثه فينا منظر المتسولين الأطفال، يشبه الأذى الذي نُحسِّهُ حين نرى سيارات فارهة يقودها لصوص يمصون دم الشعب. وجهان لعملة واحدة...كما أقول لنفسي...
لم أكن أعرف إلى أي حدّ تغلغلت في روحي تلك الطفلة، إلا بعد أسابيع طويلة من القطيعة بيننا، حين كنتُ أنتظر اللّحام يدق لي قطع اللحم لتصير شرائح رقيقة كنتُ أقف خارج الدكان هرباً من رائحة اللحم النيء، فجأة لمحتُ في زجاج الواجهة صورة فاطمة على الرصيف المقابل، ترنو إليَّ بنظرة لا نهائية، لم أستدر، ولم أقم بأية حركة، كانت تقف مستمرة بالنظر إليَّ، بشوق وعذوبة، صرتُ بدوري أحدّق بها من خلال الواجهة الزجاجية لدكان اللحام..
تنبهتُ أنني أدير لها ظهري، فيما هي تفتح لي صدرها بمودة إنسانية هائلة، لم أشعر بمثلها في حياتي، كانت أعيننا تتلاقى من خلال الزجاج في نظرات لا نهائية، نظرة لا يمكن وصفها إلا أنها نظرة إنسانية، نظرة إنسان لإنسان، كأنني أتعرف على نفسي من خلالها، وتتعرف علىنفسها من خلالي.هزَّني الشوق لتلك الطفلة ودفعني للاستدارة نحوها، كانت نظرة فاطمة قادرة على الوصول إلى نخاع روحي، لم نتكلم، ولم نلوّح لبعضنا، عبرتْ الشارع العريض بمشيتها الواثقة وتركت جسدها النحيل يرتاح بين ذراعي، مسحتُ على شعرها الأجعد القصير جداً، وقلت لها مدارية دوامة مشاعر تأثر تعصف بي: ماذا فعلت بشعركِ؟...
ضحكت: قصته لي أمي...
ـ لكن لِمَ قصته بهذه الطريقة، لقد شوهتك يا فاطمة...
ضحكت بتسامح: كي لا يتحرش بي أحد...
سألتها مازحةً كي أداري تأثري: ما أخباركِ يا فاطمة، أما زلت تفتلين في الشوارع...
ـ أجل....
أدركتُ حماقتي حين كتبتُ رسالة لأمها، ما أغباني هل اعتقدتُ أنني مصلحة اجتماعية، أو ساحرة قادرة أن أقلب بؤس تلك الأسرة إلى نعيم...
أمسكتُ يدها فتركتني أقودها حيثُ أريدُ، كانت تلك الصغيرة مستعدةً أن تتبعني، وأن تتركني أقودها حتى آخر الدنيا...
في مكتبي أعطيتها نقوداً كالعادة، وطلبتُ منها كما لو أننا صديقتين أن تُريني ماذا يضم كيسها الأسود أخرجت بنطالاً بالياً تحلم أن تبيعه، أكلت فولاً وشربت كولا، حدثتني عن أسفها الشديد لأنها باعت مظلتها معتقدةً أنَّ الشتاء قد ولَّى، ضربت كفاً بكف وهي تقول: تصوري يوم بعت المظلة بدأت الأمطار تهطل غزيرة، سأذهب إلى البائع لأستردها...
أبديتُ إعجابي بحذائها الرخيص الجديد، قالت إنها اشترته على العيد...
سألتُها: وهل تسوّلت في العيد؟...
قالت: طبعاً، وجمعت مبلغاً لا بأس به...
حكت لي فاطمة وهي تطقطق أصابعها النحيلة، أن أمها دائمة الشجار مع أصحاب الغرفة التي يعيشون بها، وأنهم ينوون طردهم من تلك الغرفةِ، وبأنها لن تسمح أن تصير أمها في الشارع...
توقدت بشرة فاطمة وتألقت نظرتها وهي تخبرني عن قَسَمِها أنها لن تسمح لأحد أن يطرد أمها وأخوتها من تلك الغرفة...
حكت لي تلك الصغيرة الجبارة عن رجل عجوز يملك دكاناً، يلّوح لفاطمة بالمال كلما مرّت قرب دكانه ويبرطم بكلام غير مفهوم، حذرتها منه، فابتسمت لي تطمئنني أن لاداعي لتحذيراتي.
ذات مساء فاجأتني فاطمة في ساعة متأخرة، ما إن رأيتها حتى نظرتُ في ساعتي، قلتُ لها: فاطمة تقترب من التاسعة، ألم ترجعي لبيتكِ بعد..
ـ سأرجع، لكني أردتُ أن أخبرك شيئاً...
اعتقدتُ أن أمراً خطيراً حدث مع فاطمة أو أحد أفراد أسرتها، سألتها بقلق...
ـ خير يا فاطمة...
ـ أردتُ أن أقول لك أنني مزّقتُ الرسالة لأنني... تعثرتُ بالكلام، ثم استجمعت قواها وتابعت، لأن أمي كانت ستضربني، فذات يوم أرسلت سيدة لطيفة مثلك رسالة لأمي، فضربتني بقسوة، وقالت لي لا تتحدثي مع الناس، إطلبي منهم المال فقط.
غَشِيَ دمعٌ حار عينيها، وقالت وهي تمسح عينيها بكم كنزتها طيب أنا ما ذنبي؟؟؟
ـ ألهذا السبب جئتِ الآن...
ـ أجل. طيب أنا ما ذنبي؟!..
كانت تسأل الدنيا حولها هذا السؤال الأليم. لم أستطع أن أقول شيئاً سوى معك حق يا فاطمة...
أمسكتُ بيدها وقلتُ لها هيا آن الأوان لترجعي إلى البيت، أجبرتها أن تأكل قطعة حلوى، أرادت أن تخبؤها في الكيس الأسود، انتظرتُ الباص مع فاطمة ليحملها إلى غرفة بؤسها، حيث سترتمي على فراشٍ حقيرٍ لتنام. وقبل أن تصعد الباص التفتت إليَّ وهي تضحك من قلبها.. قالت:
ـ أتعرفين، أحب كلامك عني...
حين تسألينني أما زلت تدورين في الشوارع.. لم أفهم ما الذي يضحك فاطمة في هذا الكلام، لعل أحاسيسها ملتبسة بين ضحك وبكاء، فكرتُ بأيام فاطمة التي تقضيها في دوران مضني في الشوارع متسللة إلى المكاتب تشحذ، متعرضة لتحرشات وكلمات لن تبوح بها لإنسان. فاطمة التي تدور وتدور بلاجدوى في شوارع مدينة تنتهكها كل يوم، باحثة عن حب دافئ، عن حلم طفولة يتبدد يوماً بعد يوم، عن حلم يهترئ ويبلى، كتلك الأشياء المهترئة التي تضعها فاطمة في كيسها الأسود..
ترى كم يساوي حلمك يا فاطمة؟!...
*كاتبة من سورية
دخلت عليَّ فاطمة أشبه بفزاعة عصافير، هيكل عظمي لطفلة تكسوه أسمال بالية فضفاضة ومن حذائها المهترئ تظهر أصابع قدميها القذرة المزرقة من البرد، دخلت منتصبة القامة، ترسم ابتسامة متعبة على وجهها الطفولي المدبوغ بالإعياء والألم رغم نضارته، أدهشني امتلاء وجهها مقارنة مع نحولها الشديد، كان شعرها المقصوص بطريقة مشوهة مبلولاً ويقطر ماءً على رقبتها وكتفيها. تحمل في يمناها كيساً أسود. سألتني بصوت واثق لا يحمل أي نغمة استجداء:
ـ هل تشترين هذه الكنزة؟!!..
أخرجت كنزة خضراء عتيقة من الكيس، وعرضتها علي بطريقة نزقة، عارفةً أنني لا يمكن أن أشتري هذه الخرقة..
لم أستطع أن أصرفها، علاقتي مع المتسولين الصغار كانت بالهروب منهم، أسرع بإعطائهم النقود أو أسرع خطواتي كي يفهموا ألا يتبعوني ويتعبوا أنفسهم، ماكنتُ أتحمل مظهرهم الرث فقلبي طافح بأنواع كثيرة من الغمّ والقهر.
لكن فاطمة فرضت نفسها عليَّ بطريقةٍ غامضةٍ أجبرتني أن أراها بقلبي ـ أسرتني تلك المفارقة في شخصها، فتلك المتشردة الصغيرة، البردانة والجائعة والمُهملة، شبه الحافية، تملك كرامة متحدية واعتداداً حقيقياً بنفسها، هل أردتُ أن أحلَّ لغز النظرة؟.. سألتها: من أنتِ...؟!
أجابت: فاطمة...
ـ ولِمَ تتسولين يا فاطمة...؟
هَزَّت؟؟؟؟ كتفيها ساخرة من سؤالي، ابتسمت كاشفة عن أسنان مصفّرة.
سألها: ألم تذهبي إلى المدرسة؟..
ـ أجل وصلت حتى الصف الخامس.
ـ ولِمَ تركت المدرسة يا فاطمة؟
بصوتٍ بالغ الحياد أجابت: أخرجتني أمي كي أعمل.
ـ أهي التي تدفعك للتسول؟..
ـ أجل...
كنتُ أحدّقُ بها كحالة للدراسة، كنموذج خاص لمتسول، كانت عيناها الواسعتان العسليتان تحدّقان بوجهي بنظرة نقية صافية تستحث محبتي إنما ليس شفقتي...
نظرتها تعني، لا تنظري إلي نظرة فوقية، لا تهينينني بشفقتك، فأنا إنسانة مثلك، لكن ظروفي صعبة..
وجدتني أعطيها مبلغاً كبيراً من المال، ليس لإرضائها، وإرضاء ضميري، إنما لغاية أكثر تعقيداً، فقد أردتُ ـ أنا التي وقعتُ تحت سطوتها ـ أن أسيطر عليها بهذا المبلغ الذي لم تحلم به..
أخذت المال ببساطة ودسته في جيبة بنطال واسع تحزمه بشريط ثخين، ابتسمت لي شاكرة، وعادت تمسح وجهي بحنان بعينيها الصافيتين...
سألتها: إحكِ لي عن أسرتك، أمكِ، أبيكِ؟..
قاطعتني: والدي توفيَ منذ عامين بالسرطان، لديَّ أربع أخوة يصغرونني..
ـ وأمكِ، ماذا تعمل؟..
ـ لا شيء..
ـ وكيف تعيشون..
رفعت كتفيها بلا مبالاة، وقالت: الله يعيننا، أحياناً الأقرباء يرسلون لنا طعاماً..
أغاظتني تلك الطفلة بمظاهر الرضى التام لواقعها، كأنها لا تخجل مما هي فيه، من نذالة أمها وبؤس طفولتها، أحسستها تريد أن تحب الحياة مهما كانت قاسية عليها..
قاومت مشاعر غيظي وتابعت الحوار معها..
ـ هل تعرف أمك أنك تدورين من مكتب إلى مكتب تشحذين المال؟..
ـ أجل..
ـ ألا تخشى عليك من اعتداء، أو تحرُّش أو خطف أو....
قاطعتني: لا أعرف، لا أظن..
ـ متى تخرجين من البيت؟..
ـ منذ السابعة صباحاً..
ـ ومتى تعودين؟..
ـ أعود بين الثامنة والتاسعة مساءً...
ـ وأين تقضين كل هذا الوقت؟..
هزت كتفيها مستخفة بسؤالي قائلة بثقة واعتداد: أشحذ..
لم تشعر فاطمة أن هناك ما يهين في التسول، وجدت نفسها محشورة في زقاق الفقر، محاصرة مع أخوتها في فم غول اسمه الجوع..
ـ وهل تجمعين مبلغاً جيداً..؟..
ـ ليس دوماً..
ـ ما أكبر مبلغ جمعته؟..
ـ ذات يوم جمعت سبع مئة ليرة في اليوم..
فكرتُ أنه دخل موظف خلال أسبوع؟!!..
فجأةً لم أعد قادرة على محادثتها... شعرتُ أن وادٍ سحيق يفصلني عنها ويفصلها عني، لا يمكنني عبوره مهما دفعتُ لها مالاً، يبدو أنها شعرت أني لم أعد قادرة على تحمَّل وجودها، وبأنها تسبب لي الضيق، فحملت كيسها وهمت بالانصراف..
استوقفتها لأعطيها قالب شوكولا... امتدت يدها النحيلة كغصن مقطوع تأخذه مع نظرة امتنان لكني لم أشعر بلهفتها لتذوقه ـ قلتُ لها: كُليه يا فاطمة...
قالت: لا،.. سأخبؤه لأمي فهي تحب الشوكولا...
وددتُ لو أصرخ بها: وهل تستحق أمك أن تحبُيها؟..
لكني كبحتُ صراخي، ونفثت سموم حقدي في وجه طفلة بريئة من مصيرها...
ـ هل تحبين أمك التي ترميك في الشارع يا فاطمة؟..
حدقتْ بي بعينين زائغيتن زفرت همَّاً يضيق بها صدرها الطفولي، وقالت: كيف لا أحبها... إنها أمي... كرهتُ نفسي لأنني سببتُ لها الألم، وحين استدارت لتنصرف، تأملت عظم نقرتها وعظام كتفيها وأضلاعها التي تشف عن كنزة فضفاضة مهترئة، رجليها أشبه بعودين يابسين، لكن مشيتها شامخة، كأنها لا تريد أن تنهزم أمام نحولها، وبؤس طفولتها...
تركتني فاطمة مستنفدة بذكراها لأيام، التصقت هذه الطفلة بمشاعري، أحسستُها تريد أن تعطي مغزىً آخر لأيامي، إذ أحس بحضورها وأنا في السيارة، فأتخيلها هائمة في الشوارع، تفاجؤني ترنو إلي بعينيها الواسعتين العسليتين، وأنا آكل طعامي الشهي المدروس جيداً على الفيتامينات والسعرات الحرارية أحس بجوعها المُكابر... بلبلت مشاعري تلك المتسولة الصغيرة، فما عدتُ أعرف هل أرغب بلقائها أم لا...
لكني بعد أيام فرحت حقاً حين أطلّت عليَّ كشبح طفل يتقدم نحوي بثبات... لم أكن أعرف أن حميمية خاصة ولدت بيني وبينها، استقبلتها كأنني معتادة على استقبالها دوماً...
لكنها سمّمتني بالغضب حين قالت لي بابتهاج حقيقي: كم فرحت أمي بقالب الشوكولا..
كنتُ أريدها أن تكره أمها، وأن تعرف أن تلك الأم سيئة لأنها تدفع بطفلتها للتسول، كنتُ أطلب من طفلة لم تتعلم الكره بعد أن تعكَّر صفاء روحها وتكره، وتفهم قوانين استغلال الأطفال والإساءة إليهم، وأن تتمرد على مصيرها وتحاكم أمها، وبالتالي مجتمعاً بأكمله، ينتهك طفولتها..
سألتُها بحنق: كان يجب أن تأكلين الشوكولا أنت؟..
ـ لكن أمي تحب الشوكولا كثيراً..
ـ أمك هذه غريبة، كيف ترمي بك في الشارع لتتسولين؟...
كنتُ أشعر كم ينقل الصوت شحنات الحقد المسمومة، كم استاءت من غضبي الذي لم تتوقعه لأنها دخلت مكتبي بلهفة المشتاق، فلم تتوقع عجرفتي، أعطتني فاطمة درساً لن أنساه في أن العجرفة دليل الجهل... ماذا أعرف أنا عن هذا القاع الذي تعيش فيه فاطمة كي أنظرّ عليها وعلى أمها؟!!!...
كبحتُ غضبي وأعطيتها المال، فأخذته وهي تشيح بعينيها عني بنظرة انكسار، وجدتني أرّق للحال، وأطلب إليها أن تقترب مني، تركت الكيس الأسود الذي لم أسألها ماذا يضم، واقتربت مني، احتضنتها، ياه كم هي نحيلة، إنها بالكاد تملك قواماً...
سألتها: ألا تأكلين يا فاطمة؟...
ـ أجل، آكل مساءً حين أعود إلى البيت...
ـ وأثناء النهار..
ـ نادراً ما آكل، أحياناً إذا اشتدَّ علي الجوع، أشتري فولاً...
ـ لكن كيف ستكبرين وتصيرين صبية إن لم تأكلي...
أدارت جذعها بطريقة تعمّدت أن تلصق خدها بخدي، قالت لي كأنها توشوشني .
ـ حكيت لأمي عنك..
ـ وماذا قلتِ لها؟
ضحكت: قلتُ كلاماً جميلاً...
سألتها: لِمَ لا تحاول أمكِ أن تعمل...
ـ لا أعرف، أخوتي صغار، كيف ستتركهم...
ـ ووالدك ماذا كان يعمل؟
ـ سائق باص..
ـ أكان موظفاً..؟
ـ أجل..
ـ ألا تقبضون راتبه بعد وفاته..
ـ تقبض أمي نصف راتبه، أي ألفي ليرة..
ألفي ليرة!... لا تكفي ثمن خبز تسد به أرملة أفواه أطفالها الخمسة!...
أعدتُ سؤالي الغبي: أتحبين أمك يا فاطمة؟..
كأنني توقعت هذه المرة أن تصارحني بالحقيقة وتقول :لا..
نظرت إليَّ بعتب وتساءلت: وهل يوجد إنسان لا يحب أمه؟..
كانت أمها انتماؤها ودنياها، كانت وطنها، أليس للوطن وجه أم؟!... لم أعرف كم أن فاطمة تحب أمها إلا بعد شهر من ترددها عليَّ، يوم قررتُ أن أكتب رسالة لتلك الأم ـ عساني أحثها أن ترحم ابنتها من حياة التسول، وأحرّض فيها نخوة البحث عن عمل لإعالة أولادها.
لم أتردد بشأن الرسالة، لأن ذلك اليوم كان مشحوناً ببؤس فاطمة فوق قدرتي على الاحتمال...
كنتُ قد التقيتها صباحاً، وأعطيتها مالاً على عجل، وعند الظهر كانت عاصفة قوية تهب بجنون مقتلعة بضعة أشجار، ومسقطة عمودي كهرباء، كنتُ غاطسة في معطفي، أوصي سائق التكسي أن يكون حذراً خوفاً من جنون العاصفة، حين لمحتُ عَرَضاً فاطمة كشبح تقف عند مدخل أحد البنايات، تحمل الكيس الأسود بيدٍ، وتنفخ على يدها الثانية لتتدفأ.
كنتُ في مكان بعيد جداً عن مكتبي، تساءلت بدهشة: هل تصل فاطمة إلى هذه الأحياء!.. هزّني منظر المتسولة بقوة، ولم أستطع الاسترخاء طيلة النهار، ولعظيم دهشتي زارتني في يوم جنون الطبيعة مساءً في مكتبي، فانفجرتُ بها بلا شفقة: ألا زلت خارج البيت كيف تتجولين في الشوارع والعاصفة...
لكني لم أستطع أن أكمل كلامي الذي انقطع فجأةً أمام دموع عينيها، دموع بسبب البرد أسرعت تلتصق بالشوفاج، تقبض على قضبانه بأصابعها الصغيرة المحمرة، وتمسح بكم كنزتها أنفها الذي يسيل، وتقول لي متجاهلة استنكاري: ياه، البرد فظيع اليوم...
سألتها بسخرية:وكيف كانت الغلّة اليوم؟...
ردت ببساطة مسالمة: ليست سيئة.. جمعتُ مئة ليرة لأمي..
انفجرتُ لدى سماعي كلمة أمي، تلك المجرمة، عند هذا الحد قررتُ أن أكتب لتلك الأم رسالة، لا أذكر تماماً ماذا كتبت، لكن كلماتي كانت قاسية، لدرجة أن وجه فاطمة غام وراء غيمة حزن، عكرت ملامحها العذبة، لأول مرة شعرتُ كم هي مشوشة بالخوف وعدم الأمان، قطّبت وهي تنظر إليَّ بعتبٍ وألم، لكنني ألححتُ عليها أن تعطي أمها الرسالة، وأن تطلب إليها أن تزورني، كنتُ أريدُ أن أتفرج على تلك الطينة من الأمهات اللاتي يدفعن أولادهن إلى فم الغول..
أخذت فاطمة الرسالة وانصرفت، لكني فوجئتُ وأنا أغلقُ باب مكتبي أنهامزقت الرسالة، وألقت بالقصاصات عند بابي بتحدٍّ واحتقار. كتمت غيظي وقررتُ أن أحذفَ تلك المتسولة من حياتي، فلا يمكنني أن أقدم لها شيئاً، وفعلاً تجاهلتها خلال أسابيع، لكني تنبهتُ أنها هي التي بدأت تتجاهلني، فلم تعد تزورني، وتبتعد عني حين تصدفني في الشارع...
سخرتُ من نفسي واعترفت بأنني أسأتُ لهذه الطفلة، فأنا أشجعها على التسول حين أعطيها المال بطريقة لا تحلم بها...
صرتُ أتفرج عليها وهي تدور في الشوارع حاملة الكيس الأسود، تسير بقامتها الضئيلة الشامخة دوماً، شيء ما يضحك ويبكي في منظر تلك المتسولة المعتدة بنفسها، أراها جالسةً على درج، أو تقزز لب دوار الشمس، رفاهيتها الوحيدة ربما، تتفرج على الحياة حولها بعينينها الواسعتين الصافيتين، لا أذكر أنني رأيت عينان بصفاء عيني فاطمة، لم أرها مرة تأكل...
لكن فاطمة ظلت الغائبة الحاضرة، تركت بصمتها في روحي ومضت، بقي جزء منها في فضاء مكتبي يحفّ بي على الدوام، حاصرتني نظرتها الصافية التي تنجح دوماً في مداراة ألم أكبر من سعة صدرها النحيل، سجنتني في عسل عينيها، ياه ليس هناك من سجن أصعب من سجن العيون...
حاولتُ إقناع نفسي أن فاطمة وأمثالها أمرٌ واقعٌ، يجب تقبله، كما نقبل رغماً عنا مظاهر انتهاك كثيرة، الأذى الذي يحدثه فينا منظر المتسولين الأطفال، يشبه الأذى الذي نُحسِّهُ حين نرى سيارات فارهة يقودها لصوص يمصون دم الشعب. وجهان لعملة واحدة...كما أقول لنفسي...
لم أكن أعرف إلى أي حدّ تغلغلت في روحي تلك الطفلة، إلا بعد أسابيع طويلة من القطيعة بيننا، حين كنتُ أنتظر اللّحام يدق لي قطع اللحم لتصير شرائح رقيقة كنتُ أقف خارج الدكان هرباً من رائحة اللحم النيء، فجأة لمحتُ في زجاج الواجهة صورة فاطمة على الرصيف المقابل، ترنو إليَّ بنظرة لا نهائية، لم أستدر، ولم أقم بأية حركة، كانت تقف مستمرة بالنظر إليَّ، بشوق وعذوبة، صرتُ بدوري أحدّق بها من خلال الواجهة الزجاجية لدكان اللحام..
تنبهتُ أنني أدير لها ظهري، فيما هي تفتح لي صدرها بمودة إنسانية هائلة، لم أشعر بمثلها في حياتي، كانت أعيننا تتلاقى من خلال الزجاج في نظرات لا نهائية، نظرة لا يمكن وصفها إلا أنها نظرة إنسانية، نظرة إنسان لإنسان، كأنني أتعرف على نفسي من خلالها، وتتعرف علىنفسها من خلالي.هزَّني الشوق لتلك الطفلة ودفعني للاستدارة نحوها، كانت نظرة فاطمة قادرة على الوصول إلى نخاع روحي، لم نتكلم، ولم نلوّح لبعضنا، عبرتْ الشارع العريض بمشيتها الواثقة وتركت جسدها النحيل يرتاح بين ذراعي، مسحتُ على شعرها الأجعد القصير جداً، وقلت لها مدارية دوامة مشاعر تأثر تعصف بي: ماذا فعلت بشعركِ؟...
ضحكت: قصته لي أمي...
ـ لكن لِمَ قصته بهذه الطريقة، لقد شوهتك يا فاطمة...
ضحكت بتسامح: كي لا يتحرش بي أحد...
سألتها مازحةً كي أداري تأثري: ما أخباركِ يا فاطمة، أما زلت تفتلين في الشوارع...
ـ أجل....
أدركتُ حماقتي حين كتبتُ رسالة لأمها، ما أغباني هل اعتقدتُ أنني مصلحة اجتماعية، أو ساحرة قادرة أن أقلب بؤس تلك الأسرة إلى نعيم...
أمسكتُ يدها فتركتني أقودها حيثُ أريدُ، كانت تلك الصغيرة مستعدةً أن تتبعني، وأن تتركني أقودها حتى آخر الدنيا...
في مكتبي أعطيتها نقوداً كالعادة، وطلبتُ منها كما لو أننا صديقتين أن تُريني ماذا يضم كيسها الأسود أخرجت بنطالاً بالياً تحلم أن تبيعه، أكلت فولاً وشربت كولا، حدثتني عن أسفها الشديد لأنها باعت مظلتها معتقدةً أنَّ الشتاء قد ولَّى، ضربت كفاً بكف وهي تقول: تصوري يوم بعت المظلة بدأت الأمطار تهطل غزيرة، سأذهب إلى البائع لأستردها...
أبديتُ إعجابي بحذائها الرخيص الجديد، قالت إنها اشترته على العيد...
سألتُها: وهل تسوّلت في العيد؟...
قالت: طبعاً، وجمعت مبلغاً لا بأس به...
حكت لي فاطمة وهي تطقطق أصابعها النحيلة، أن أمها دائمة الشجار مع أصحاب الغرفة التي يعيشون بها، وأنهم ينوون طردهم من تلك الغرفةِ، وبأنها لن تسمح أن تصير أمها في الشارع...
توقدت بشرة فاطمة وتألقت نظرتها وهي تخبرني عن قَسَمِها أنها لن تسمح لأحد أن يطرد أمها وأخوتها من تلك الغرفة...
حكت لي تلك الصغيرة الجبارة عن رجل عجوز يملك دكاناً، يلّوح لفاطمة بالمال كلما مرّت قرب دكانه ويبرطم بكلام غير مفهوم، حذرتها منه، فابتسمت لي تطمئنني أن لاداعي لتحذيراتي.
ذات مساء فاجأتني فاطمة في ساعة متأخرة، ما إن رأيتها حتى نظرتُ في ساعتي، قلتُ لها: فاطمة تقترب من التاسعة، ألم ترجعي لبيتكِ بعد..
ـ سأرجع، لكني أردتُ أن أخبرك شيئاً...
اعتقدتُ أن أمراً خطيراً حدث مع فاطمة أو أحد أفراد أسرتها، سألتها بقلق...
ـ خير يا فاطمة...
ـ أردتُ أن أقول لك أنني مزّقتُ الرسالة لأنني... تعثرتُ بالكلام، ثم استجمعت قواها وتابعت، لأن أمي كانت ستضربني، فذات يوم أرسلت سيدة لطيفة مثلك رسالة لأمي، فضربتني بقسوة، وقالت لي لا تتحدثي مع الناس، إطلبي منهم المال فقط.
غَشِيَ دمعٌ حار عينيها، وقالت وهي تمسح عينيها بكم كنزتها طيب أنا ما ذنبي؟؟؟
ـ ألهذا السبب جئتِ الآن...
ـ أجل. طيب أنا ما ذنبي؟!..
كانت تسأل الدنيا حولها هذا السؤال الأليم. لم أستطع أن أقول شيئاً سوى معك حق يا فاطمة...
أمسكتُ بيدها وقلتُ لها هيا آن الأوان لترجعي إلى البيت، أجبرتها أن تأكل قطعة حلوى، أرادت أن تخبؤها في الكيس الأسود، انتظرتُ الباص مع فاطمة ليحملها إلى غرفة بؤسها، حيث سترتمي على فراشٍ حقيرٍ لتنام. وقبل أن تصعد الباص التفتت إليَّ وهي تضحك من قلبها.. قالت:
ـ أتعرفين، أحب كلامك عني...
حين تسألينني أما زلت تدورين في الشوارع.. لم أفهم ما الذي يضحك فاطمة في هذا الكلام، لعل أحاسيسها ملتبسة بين ضحك وبكاء، فكرتُ بأيام فاطمة التي تقضيها في دوران مضني في الشوارع متسللة إلى المكاتب تشحذ، متعرضة لتحرشات وكلمات لن تبوح بها لإنسان. فاطمة التي تدور وتدور بلاجدوى في شوارع مدينة تنتهكها كل يوم، باحثة عن حب دافئ، عن حلم طفولة يتبدد يوماً بعد يوم، عن حلم يهترئ ويبلى، كتلك الأشياء المهترئة التي تضعها فاطمة في كيسها الأسود..
ترى كم يساوي حلمك يا فاطمة؟!...
*كاتبة من سورية