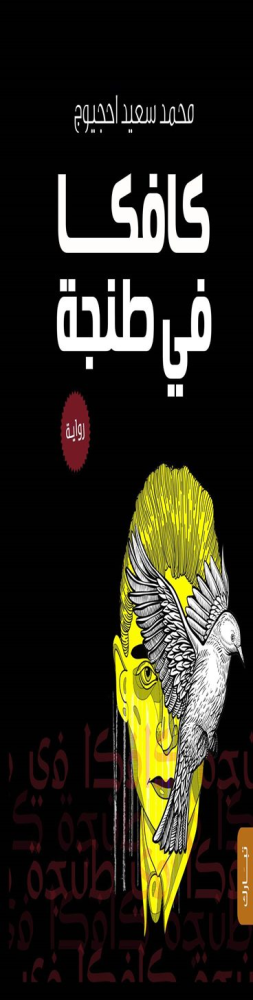راكم ميلودي حمدوشي كتابة الرواية البوليسية منذ زمن، ولأن هذا الجنس لا يكتب فيه إلا القليل من الكتاب، فإن ريادة صاحبنا المبنية على استراتيجية محددة، وهي مربوطة بين الممارسة والكتابة. بمعنى أن الكاتب لا يرتهن للتخييل فحسب. وإنما يندفع نحو تحرير تجربته الميدانية السابقة أفقا للكتابة، قد نقول، بدون مواربة، أن تقاطع التجربة السابقة، وكيفية استثمارها كتابة تقدم لنا نظاما مائزا في هذا النوع من الكتابة، ولأن هذا الجنس الإبداعي له خصائص ترمي إلى الوضوح والدقة في الوصف، والجمل القصيرة، وعقلنة السرد، وعدم الانجرار وراء التجريب الأدبي، واللعب باللغة، أو النزوع نحو جنون الكتابة فإنها تظل كتابة تخييلية حتى إن كانت خارجة من مكاتب التحقيق البوليسي، ومن الواقع الميداني، ما دامت اللغة بحمولاتها الدلالية ترمي إلى ذلك.
نحن إذن أمام نص روائي يرسخ جنسه في الأدب المغربي، وهذا يضعني بين أسئلة متعددة. أسئلة تحاور النص وتلهث نحو إعادة كتابته، ولأن الأسئلة تقلق القارئ وتخلخل النص. لا للإجابة عنها بل في سبيل إيجاد طريق ممكن للقراءة، هل تبدأ القراءة من عنوان الرواية، والصفحة الأولى منها، أو من النتائج التي توصل إليها الضابط البكري المسؤول عن التحقيق في الجرائم التي وقعت؟ إذا افترضنا الإجابة عن هذا السؤال. فإننا بالكاد نعيد الرواية بطريقتنا. كما لو كنا نريد حكيها من جديد. وهذا أمر ممكن إذا ما أردنا إنهاء الرواية، ورميها في الذاكرة، أما إذا حاولنا تدقيق النظر في موضوعاتها، والأشكال التي تم التعبير بها، والقضايا التي أسست بناءها كالشخوص والأزمنة والأمكنة والمرجع… الخ. فهذا يعني تحليلها وفق استراتيجية تفكيكية تندفع نحو مساءلة البياضات التي تركها الكاتب لقرائه.
لا يبتعد السؤال الأول عن الثاني، بقدر ما يتداخلان، وفي تداخلهما نتوقف على مجموعة من النقط، محاولين عبثا متابعة تدرجها وتكونها، كما يقوم به السارد/ الضابط تماما.
العنوان: هو العتبة الرئيسة في أي عمل إبداعي. لا نريد فلسفته عبر البحث عن التسمية ومرجعها. كما لو كان مولودا نعطيه التسمية كي يكون، أو نعطيه دلالة الوجود. لنضع اعتباطية التسمية جانبا، ولنقترب أكثر من العنوان «السكين الحرون» كلمتان واضحتان، إلا أنهما تندسان في غموضهما، كما الجريمة تماما، فالسكين أداة الجريمة، مثلما هي أداة مطبخية، أو هي أداة بدائية حربية خلقها الإنسان لحراسة وجوده، أو هي العلامة التي دشنت الأضحية في التاريخ الإنساني. لقد كان الكاتب موفقا في التسمية. وهذا مبني على دلالة مركبة، من حيث وظيفته المتأرججة بين المطبخ والقتل، وصنعه في ضواحي الجديدة. معنى ذلك أننا أمام منتوج أصيل، يفيد التضاد، هنا تكون السكين بنية دلالية في الرواية، أو هي العنصر الرئيس فيها. ليس لأنها أداة الجريمة. وإنما في البعد الرمزي والوظيفي الذي تحدث عنه التاجر. تشكل إذن هذه الأداة مفصلا حقيقيا في بؤرة التحقيق البوليسي. ليس فقط في البقايا التي يخلقها القتل، وليس في غرسها في رقبة الضحية كدليل مرئي على ذلك. وإنما في الانتقال المروع بين محل صنعها، والمتجر الذي تباع فيه والمطبخ. ربما تعدد استعمالها هو ما يجعلها حرونا، لكن كيف نفهم وصف السكين بالحرون؟ فالحرون في لسان العرب «الدابة تحرُنُ- حٍرانا وحُرانًا وحَرُنَت، لغة، وهي حَرُونٌ: وهي التي استُدِرَ جَريُها وقفت، وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة (…) وفرس حَرُونٌ من خيل حُرُنٍ: لا ينقاد، إذا اشتد به الجري وقف. وقد حَرَنَ يَحرُنُ حُرُونًا وحَرُنَ، بالضم أيضا: صار حَرُونًا، والاسم الحِرَانُ والحَرُونُ: اسم فرس كان لجاهلة، إليه تنسب الخيل الحَرُونٍية». إذا استبدلنا الدابة بالسكين رغم أن هذا الاستبدال يصعب تصديقه، ولأن الأدب يعطي للاستبدال سعة تأويلية. فإننا سنتحصل على شيء لا يتوقف. وإن توقف لحظة زاد تحركه. ودلالة ذلك تعود لرمزية السكين التي لا تسكن غمدها. ولا تستقر على حال. فدلالتها تحيل إلى الدم. وما دام هذا الأخير لا ينفجر إلا بفعل مادة حادة. وهو لا يتوقف على شيء واحد. الرواية ترصد لنا ثلاث محطات في القتل/ الجريمة، تتشابه في الشكل، وتبحث عن ضابط ذكي لتوقيف هذه السكين الحرون. بهذا المعنى تكون مادة القتل في هذا النص الروائي عنصرا مهما. ليس لماديته، ولكن لحرونته. لذا يكون الدليل أفقا لتحرير الفراغ الموجود بين الدال والمدلول، بين السكين والحرون. وهي إمكانية برع الكاتب في تظهيرها بطريقة بوليسية مدهشة.
في الحكاية البوليسية : ثمة طرائق متعددة في الحكي. الحكي البوليسي يتأسس على عقلنة فضائه العام، مثلما يرمي إلى فك جريمة ما. حسبما تقتضيه من أمور مشروطة بها كمكان وزمان الجريمة، والبحث الميداني، والتشخيص الطبي، والمواد المستعملة، والأثر، والبصمات والشهود والمعارف.. الخ. إن كل هذه العناصر وغيرها تفترض العقلنة، ومحو الأفكار المسبقة. وهذا لا يتم إلا بوضع فرضيات يقوم بها الضابط المحقق لبيانها وتظهير المخفي منها. العقلنة هي البوصلة التي يضيء بها المحقق عمله. يقول ديكارت» مثل رجل يسير وحده في الظلمات، عزمت أن أسير ببطء شديد وأن أتخذ كثيرا من الحيطة في جميع الأمور. ولأن كنت لم أتقدم إلا قليلا جدا، فقد صنت نفسي على الأقل من السقوط. حتى أنني لم أشأ البتة أن أنبذ أي رأي من الآراء التي انتقلت في وقت ما إلى نفسي بغير طريق العقل، إلا إذا أنفقت وقتا كافيا من إعداد خطة العمل الذي توليته في البحث عن الطريقة الصحيحة الموصلة إلى جميع الأشياء التي يقدر عليها عقلي».
دعانا هذا النص الروائي إلى الاستشهاد بأب العقلانية الحديثة. ولأن كل دعوة مهجوسة بسياقها، فإن السياق هو تركيز الضابط/ المحقق على العقل، وعدم الانكماش في القشور، والتروي والصبر في النظر للأمور. وهذا ما يعبر عنه السارد في أكثر من مرة بالليل والنهار، أو الظلمة والنور، فإذا كان العقل نورا كما يقول المثل العربي، فإن تظهيره محفوف بالمخاطر والمزالق. وهو الشيء نفسه الذي يعبر عنه ديكارت في النص أعلاه ليس لأن المشي في الظلام يحيل إلى السقوط في الحفر، وجلب المشقة، بقدر ما يكون التريث، وعدم ارتكان للأحكام المسبقة. وهذا لن يتأتى إلا في جعل العقل جسرا للوصول إلى الحقيقة.
إن السارد لا يستدعي ديكارت، بقدر ما يستضيف عالمين في علم الإجرام. كما لو كان يبرر التباس الجريمة، وكيفية الوصول إلى الحقيقة من خلال هذين العالمين الكبيرين. بين الليل والنهار التباس زمني، والتباس الرؤية. الشيء الذي سيتم فصلهما رغبة في الوضوح. يتحدث السارد عنهما بكثير من الدقة. في الصفحات 59-79-103-136-147 وغيرها. ينكشفان كموضوعة بنيوية في النص، ليس في بعدها الزمني فقط وإنما في بعدها الأنطولوجي. يقول السارد «مهما اعتكر الليل واشتد سواد الظلمة فلا بد للنور أن يسطع. لي اليقين أن الفرقة ستصل إلى نتيجة في أقرب الآجال فثقتي فيها كاملة». لا تعني محاربة الظلمة كطريقة لبيان النور، بل تحرير الالتباس الحاصل في الجريمة. وهذا لا يتم في نظرنا إلا بعد إعادة مسرح الجريمة. يحكي السارد عن جريمة قتل مروعة في أحد أزقة مدينة الجديدة القريبة من البحر، حيث كان البيت الرفيع الذي يعود لمالك برتغالي اقتناه المسمى العميري، وبعد تقاعده من وزارة الفلاحة، اشترى هذا البيت ليستقر فيه، يصف السارد البيت بدقة شديدة، مثلما يبحث عن الفرضية التي تؤسس تحقيقه. وأول فرضية هي معرفة الضحية انطلاقا من العلاقات التي تربطه بالآخرين، خصوصا أن باب البيت لم يكن مكسرا. بمعنى أن القاتل من أصدقائه. ستكون الخادمة عائشة نقطة البداية في سرد بعض التفاصيل حول حياة الهالك. قبل تفكيك هذه الجريمة. حصلت أخرى لشخصية رئيسة في الرواية، وهو علي الفيلالي أستاذ العلوم السياسية، لقد تمت تصفية هذا الأخير في الحديقة.
جريمتان تعلنان الطريق، وتحجبان الفاعل، سينضاف إليهما قتيل آخر، هو وجدي إدريس. إننا أمام شخصيات تم اغتيالها من أجل بيانها وتعريتها. وكأنها شخصيات ملتبسة. فالعميري مثلا يحجبه عمله الجديد كمساعد للفئات الفقيرة. بينما علي الفيلالي باختلال وخبل عقله يحيل إلى حجب ماضيه. أما وجدي إدريس فغموض شخصيته نابع من اسمه الأول المعلن وبصماته. إن الحجب موضوعة دالة على الشخوص والأمكنة. كما الليل والنهار تماما. إذا كان الأمر كذلك، فإن الضابط البكري بصبره وعناده، وإكراهاته المتعددة يخاطر بوجوده المهني لمعرفة الحقيقة. وهذه الأخيرة لن تتأتى له، إلا من خلال المرأة. وكأن هذه الأخيرة حجاب يفترض الكشف عنه. إنها أداة تفجير الجريمة. بواسطتها ستتم كتابة التقرير الأخير، الذي يعلن فيه الضابط الجريمة المرتكبة، والشخوص الذين ارتكبوها. المرأة إذن هي حجاب الجريمة. ليس لأنها ارتكبتها وإنما في المساعدة التي قدمتها للعصابة، التي تمتهن النصب والاستيلاء على الممتلكات، والتزوير في الوثائق…. وما إلى ذلك.
سردية الرواية : لقد تحدثنا سابقا عن عقلنة السرد الروائي البوليسي. أما الآن فبإمكاننا الوقوف على أشكال سردية اشتغل عليها الكاتب من قبيل تكرار الأمثلة العربية، كما لو كانت هذه الأمثلة تندفع نحو استراحة السارد، أو على الأقل تبعث رسائل خلقية، ووجودية، واجتماعية. إنها رسائل برقية تحتجب بين الكلمات، لتبرق في البعد الأخير من قارئ الرواية. إضافة إلى استلهامه لأقوال عالمين في علوم الإجرام. ربما أن السارد/ الضابط يستحضر هذين المرجعين لتثبيت خطته في التحقيق. وأخيرا وليس آخرا الوصف الدقيق للشخوص والأمكنة بطريقة تجعل القارئ أمام شريط سينمائي، أو بالأحرى يكون الكاتب مساعدا لمخرج مفترض لهذا العمل الروائي.
بلا خاتمة: لأول مرة أكتب عن رواية بوليسية. لا أقول، هل توفقت في ذلك أم لا ؟ كيفما كان الجواب، فالمسألة سيان. مادامت رواية ميلودي حمدوشي قد ورطتني في الكتابة عنها. فهذا يعني أنها خلقت لدي مادة الكتابة، أي أن الحبكة الرئيسة فيها مخدومة بخبرة مبدع متميز. ولأنها كذلك فهي تستدعي مقاربات أخرى، تضع موضوعات الرواية أسئلة نقدية منفتحة.
كان من الممكن أن نضع المدينة والجريمة سؤالا. مثلما قد نرصد التحولات الاجتماعية، والأخلاقية والسياسية في المغرب الراهن. الرواية تكشف ذلك، وتلخص القيم الفارقة في المجتمع، وتسرد التناقضات في سلوكيات الشخوص والمجتمع…. إلا أننا تركنا ذلك إلى المقبل من الأيام، أو نهديه إلى قراء آخرين للبحث فيها، وبيانها. إن كل نص يتستر في عتباته الأولى. مثل علاقة الجريمة في زمننا الراهن بالتاريخ، وعلاقة العنوان بصاحبه وصورة الغلاف، إنها الحجب التي تفترض منا التأمل والكتابة.
* ميلودي حمدوشي، السكين الحرون، منشورات عكاظ، البيضاء، 2014.

نحن إذن أمام نص روائي يرسخ جنسه في الأدب المغربي، وهذا يضعني بين أسئلة متعددة. أسئلة تحاور النص وتلهث نحو إعادة كتابته، ولأن الأسئلة تقلق القارئ وتخلخل النص. لا للإجابة عنها بل في سبيل إيجاد طريق ممكن للقراءة، هل تبدأ القراءة من عنوان الرواية، والصفحة الأولى منها، أو من النتائج التي توصل إليها الضابط البكري المسؤول عن التحقيق في الجرائم التي وقعت؟ إذا افترضنا الإجابة عن هذا السؤال. فإننا بالكاد نعيد الرواية بطريقتنا. كما لو كنا نريد حكيها من جديد. وهذا أمر ممكن إذا ما أردنا إنهاء الرواية، ورميها في الذاكرة، أما إذا حاولنا تدقيق النظر في موضوعاتها، والأشكال التي تم التعبير بها، والقضايا التي أسست بناءها كالشخوص والأزمنة والأمكنة والمرجع… الخ. فهذا يعني تحليلها وفق استراتيجية تفكيكية تندفع نحو مساءلة البياضات التي تركها الكاتب لقرائه.
لا يبتعد السؤال الأول عن الثاني، بقدر ما يتداخلان، وفي تداخلهما نتوقف على مجموعة من النقط، محاولين عبثا متابعة تدرجها وتكونها، كما يقوم به السارد/ الضابط تماما.
العنوان: هو العتبة الرئيسة في أي عمل إبداعي. لا نريد فلسفته عبر البحث عن التسمية ومرجعها. كما لو كان مولودا نعطيه التسمية كي يكون، أو نعطيه دلالة الوجود. لنضع اعتباطية التسمية جانبا، ولنقترب أكثر من العنوان «السكين الحرون» كلمتان واضحتان، إلا أنهما تندسان في غموضهما، كما الجريمة تماما، فالسكين أداة الجريمة، مثلما هي أداة مطبخية، أو هي أداة بدائية حربية خلقها الإنسان لحراسة وجوده، أو هي العلامة التي دشنت الأضحية في التاريخ الإنساني. لقد كان الكاتب موفقا في التسمية. وهذا مبني على دلالة مركبة، من حيث وظيفته المتأرججة بين المطبخ والقتل، وصنعه في ضواحي الجديدة. معنى ذلك أننا أمام منتوج أصيل، يفيد التضاد، هنا تكون السكين بنية دلالية في الرواية، أو هي العنصر الرئيس فيها. ليس لأنها أداة الجريمة. وإنما في البعد الرمزي والوظيفي الذي تحدث عنه التاجر. تشكل إذن هذه الأداة مفصلا حقيقيا في بؤرة التحقيق البوليسي. ليس فقط في البقايا التي يخلقها القتل، وليس في غرسها في رقبة الضحية كدليل مرئي على ذلك. وإنما في الانتقال المروع بين محل صنعها، والمتجر الذي تباع فيه والمطبخ. ربما تعدد استعمالها هو ما يجعلها حرونا، لكن كيف نفهم وصف السكين بالحرون؟ فالحرون في لسان العرب «الدابة تحرُنُ- حٍرانا وحُرانًا وحَرُنَت، لغة، وهي حَرُونٌ: وهي التي استُدِرَ جَريُها وقفت، وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة (…) وفرس حَرُونٌ من خيل حُرُنٍ: لا ينقاد، إذا اشتد به الجري وقف. وقد حَرَنَ يَحرُنُ حُرُونًا وحَرُنَ، بالضم أيضا: صار حَرُونًا، والاسم الحِرَانُ والحَرُونُ: اسم فرس كان لجاهلة، إليه تنسب الخيل الحَرُونٍية». إذا استبدلنا الدابة بالسكين رغم أن هذا الاستبدال يصعب تصديقه، ولأن الأدب يعطي للاستبدال سعة تأويلية. فإننا سنتحصل على شيء لا يتوقف. وإن توقف لحظة زاد تحركه. ودلالة ذلك تعود لرمزية السكين التي لا تسكن غمدها. ولا تستقر على حال. فدلالتها تحيل إلى الدم. وما دام هذا الأخير لا ينفجر إلا بفعل مادة حادة. وهو لا يتوقف على شيء واحد. الرواية ترصد لنا ثلاث محطات في القتل/ الجريمة، تتشابه في الشكل، وتبحث عن ضابط ذكي لتوقيف هذه السكين الحرون. بهذا المعنى تكون مادة القتل في هذا النص الروائي عنصرا مهما. ليس لماديته، ولكن لحرونته. لذا يكون الدليل أفقا لتحرير الفراغ الموجود بين الدال والمدلول، بين السكين والحرون. وهي إمكانية برع الكاتب في تظهيرها بطريقة بوليسية مدهشة.
في الحكاية البوليسية : ثمة طرائق متعددة في الحكي. الحكي البوليسي يتأسس على عقلنة فضائه العام، مثلما يرمي إلى فك جريمة ما. حسبما تقتضيه من أمور مشروطة بها كمكان وزمان الجريمة، والبحث الميداني، والتشخيص الطبي، والمواد المستعملة، والأثر، والبصمات والشهود والمعارف.. الخ. إن كل هذه العناصر وغيرها تفترض العقلنة، ومحو الأفكار المسبقة. وهذا لا يتم إلا بوضع فرضيات يقوم بها الضابط المحقق لبيانها وتظهير المخفي منها. العقلنة هي البوصلة التي يضيء بها المحقق عمله. يقول ديكارت» مثل رجل يسير وحده في الظلمات، عزمت أن أسير ببطء شديد وأن أتخذ كثيرا من الحيطة في جميع الأمور. ولأن كنت لم أتقدم إلا قليلا جدا، فقد صنت نفسي على الأقل من السقوط. حتى أنني لم أشأ البتة أن أنبذ أي رأي من الآراء التي انتقلت في وقت ما إلى نفسي بغير طريق العقل، إلا إذا أنفقت وقتا كافيا من إعداد خطة العمل الذي توليته في البحث عن الطريقة الصحيحة الموصلة إلى جميع الأشياء التي يقدر عليها عقلي».
دعانا هذا النص الروائي إلى الاستشهاد بأب العقلانية الحديثة. ولأن كل دعوة مهجوسة بسياقها، فإن السياق هو تركيز الضابط/ المحقق على العقل، وعدم الانكماش في القشور، والتروي والصبر في النظر للأمور. وهذا ما يعبر عنه السارد في أكثر من مرة بالليل والنهار، أو الظلمة والنور، فإذا كان العقل نورا كما يقول المثل العربي، فإن تظهيره محفوف بالمخاطر والمزالق. وهو الشيء نفسه الذي يعبر عنه ديكارت في النص أعلاه ليس لأن المشي في الظلام يحيل إلى السقوط في الحفر، وجلب المشقة، بقدر ما يكون التريث، وعدم ارتكان للأحكام المسبقة. وهذا لن يتأتى إلا في جعل العقل جسرا للوصول إلى الحقيقة.
إن السارد لا يستدعي ديكارت، بقدر ما يستضيف عالمين في علم الإجرام. كما لو كان يبرر التباس الجريمة، وكيفية الوصول إلى الحقيقة من خلال هذين العالمين الكبيرين. بين الليل والنهار التباس زمني، والتباس الرؤية. الشيء الذي سيتم فصلهما رغبة في الوضوح. يتحدث السارد عنهما بكثير من الدقة. في الصفحات 59-79-103-136-147 وغيرها. ينكشفان كموضوعة بنيوية في النص، ليس في بعدها الزمني فقط وإنما في بعدها الأنطولوجي. يقول السارد «مهما اعتكر الليل واشتد سواد الظلمة فلا بد للنور أن يسطع. لي اليقين أن الفرقة ستصل إلى نتيجة في أقرب الآجال فثقتي فيها كاملة». لا تعني محاربة الظلمة كطريقة لبيان النور، بل تحرير الالتباس الحاصل في الجريمة. وهذا لا يتم في نظرنا إلا بعد إعادة مسرح الجريمة. يحكي السارد عن جريمة قتل مروعة في أحد أزقة مدينة الجديدة القريبة من البحر، حيث كان البيت الرفيع الذي يعود لمالك برتغالي اقتناه المسمى العميري، وبعد تقاعده من وزارة الفلاحة، اشترى هذا البيت ليستقر فيه، يصف السارد البيت بدقة شديدة، مثلما يبحث عن الفرضية التي تؤسس تحقيقه. وأول فرضية هي معرفة الضحية انطلاقا من العلاقات التي تربطه بالآخرين، خصوصا أن باب البيت لم يكن مكسرا. بمعنى أن القاتل من أصدقائه. ستكون الخادمة عائشة نقطة البداية في سرد بعض التفاصيل حول حياة الهالك. قبل تفكيك هذه الجريمة. حصلت أخرى لشخصية رئيسة في الرواية، وهو علي الفيلالي أستاذ العلوم السياسية، لقد تمت تصفية هذا الأخير في الحديقة.
جريمتان تعلنان الطريق، وتحجبان الفاعل، سينضاف إليهما قتيل آخر، هو وجدي إدريس. إننا أمام شخصيات تم اغتيالها من أجل بيانها وتعريتها. وكأنها شخصيات ملتبسة. فالعميري مثلا يحجبه عمله الجديد كمساعد للفئات الفقيرة. بينما علي الفيلالي باختلال وخبل عقله يحيل إلى حجب ماضيه. أما وجدي إدريس فغموض شخصيته نابع من اسمه الأول المعلن وبصماته. إن الحجب موضوعة دالة على الشخوص والأمكنة. كما الليل والنهار تماما. إذا كان الأمر كذلك، فإن الضابط البكري بصبره وعناده، وإكراهاته المتعددة يخاطر بوجوده المهني لمعرفة الحقيقة. وهذه الأخيرة لن تتأتى له، إلا من خلال المرأة. وكأن هذه الأخيرة حجاب يفترض الكشف عنه. إنها أداة تفجير الجريمة. بواسطتها ستتم كتابة التقرير الأخير، الذي يعلن فيه الضابط الجريمة المرتكبة، والشخوص الذين ارتكبوها. المرأة إذن هي حجاب الجريمة. ليس لأنها ارتكبتها وإنما في المساعدة التي قدمتها للعصابة، التي تمتهن النصب والاستيلاء على الممتلكات، والتزوير في الوثائق…. وما إلى ذلك.
سردية الرواية : لقد تحدثنا سابقا عن عقلنة السرد الروائي البوليسي. أما الآن فبإمكاننا الوقوف على أشكال سردية اشتغل عليها الكاتب من قبيل تكرار الأمثلة العربية، كما لو كانت هذه الأمثلة تندفع نحو استراحة السارد، أو على الأقل تبعث رسائل خلقية، ووجودية، واجتماعية. إنها رسائل برقية تحتجب بين الكلمات، لتبرق في البعد الأخير من قارئ الرواية. إضافة إلى استلهامه لأقوال عالمين في علوم الإجرام. ربما أن السارد/ الضابط يستحضر هذين المرجعين لتثبيت خطته في التحقيق. وأخيرا وليس آخرا الوصف الدقيق للشخوص والأمكنة بطريقة تجعل القارئ أمام شريط سينمائي، أو بالأحرى يكون الكاتب مساعدا لمخرج مفترض لهذا العمل الروائي.
بلا خاتمة: لأول مرة أكتب عن رواية بوليسية. لا أقول، هل توفقت في ذلك أم لا ؟ كيفما كان الجواب، فالمسألة سيان. مادامت رواية ميلودي حمدوشي قد ورطتني في الكتابة عنها. فهذا يعني أنها خلقت لدي مادة الكتابة، أي أن الحبكة الرئيسة فيها مخدومة بخبرة مبدع متميز. ولأنها كذلك فهي تستدعي مقاربات أخرى، تضع موضوعات الرواية أسئلة نقدية منفتحة.
كان من الممكن أن نضع المدينة والجريمة سؤالا. مثلما قد نرصد التحولات الاجتماعية، والأخلاقية والسياسية في المغرب الراهن. الرواية تكشف ذلك، وتلخص القيم الفارقة في المجتمع، وتسرد التناقضات في سلوكيات الشخوص والمجتمع…. إلا أننا تركنا ذلك إلى المقبل من الأيام، أو نهديه إلى قراء آخرين للبحث فيها، وبيانها. إن كل نص يتستر في عتباته الأولى. مثل علاقة الجريمة في زمننا الراهن بالتاريخ، وعلاقة العنوان بصاحبه وصورة الغلاف، إنها الحجب التي تفترض منا التأمل والكتابة.
* ميلودي حمدوشي، السكين الحرون، منشورات عكاظ، البيضاء، 2014.

عقلنة السرد في «السكين الحرون» للمغربي ميلودي حمدوشي
راكم ميلودي حمدوشي كتابة الرواية البوليسية منذ زمن، ولأن هذا الجنس لا يكتب فيه إلا القليل من الكتاب، فإن ريادة صاحبنا المبنية على استراتيجية محددة، وهي مربوطة بين الممارسة والكتابة. بمعنى أن الكاتب لا
www.alquds.co.uk