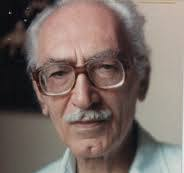"ترحيل لسجن الحضرة". أظن أنه كان يوم 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2013... نادى مخبر على اسمي من "النضّارة" (فتحة مستطيلة صغيرة في الباب الحديدي)، بمديرية أمن الإسكندرية. في سجن الحضرة، مكثت أياماً في زنزانة الإيراد، ثم وُزّعتُ على زنزانة سُكني. كانت باردة كثلاجة. فكرت أن الميزة الكبرى لتلك الثلاجة هي خلوّها من أية حشرات. لم يكن لي تاريخ مع الصراصير في الأسبوعين اللذين قضيتهما بمديرية الأمن، حيث الحياة أقرب للملكي من الميري.
في سجن الحضرة اختلف كل شيء. حتى المقشّة الصغيرة أو "اللمامة" البلاستيك ممنوعة. لا منطق أبداً في الحياة الميري. كل شيء ممنوع باستثناء الملابس الميري والطعام (ليس كله) وبعض الأدوية (ليس دائماً). حتى مطهر "الديتول" السائل كان ممنوعاً وقتها. كلما طلب أحدنا إدخال شيء من ذلك، جاءه الردّ غاضباً: "إنت فاكر نفسك في فندق ولا إيه؟!" كأن مستلزمات النظافة من شروط سُكنى الفنادق!
ثمّة نظام محكم في السجون، يتلقاه السجين من زملائه الأقدم مثلما يتعلم الصنايعي أصول المهنة من معلّمه. السجين الأحدث لا يختار مكانه في الزنزانة، بل يذهب إلى المكان المتاح.. الذي يكون الأسوأ. ومع ترحيل زملاء أقدم أو انتهاء عقوبتهم، تُتاح أماكنهم الجيدة للأقدم بعدهم، وبالتالي أماكن هؤلاء للسجناء الأحدث، الذين صارت لهم الآن بعض الأقدمية، فيتركون مواقعهم السيئة للوافدين الجدد. هكذا يتحقق نوع من "العدالة الاجتماعية".
كان الموقع المتاح لي أول موقع في أحد أضلاع الزنزانة. عن يميني باب الزنزانة الحديدي، كلما انفتح في الصباح الباكر هاجمني تيار هواء بارد محمل بالروائح الكريهة. هناك أيضاً الرائحة الدائمة لبرميل "الزبالة" المجاور للباب من الناحية الأخرى. كان عرض الباب متراً واحداً يفصلني عن البرميل الذي لا يمكن غسله. كان وطناً للعفن والحشرات. أول ما صدمني في الأمر أن الصراصير هنا لا تعرف البيات الشتوي، ربما لأن الصراصير كالسجناء: تضطر للتكيف مع الظروف القاتلة للحياة حتى لا تفنى. كان جيراني من سكان برميل الزبالة وركن الزنزانة الذي يحتضنه متنوعين عرقياً. صراصير صغيرة جداً وكبيرة ومتوسطة. الصغيرة والمتوسطة فاتحة اللون دائماً، والكبيرة بنية غامقة كما نعرفها خارج السجن.
بدأ تاريخي مع الصراصير تدريجياً. هذا أيسر. في صباح من صباحات كانون الأول/ ديسمبر، صحوت منتعشاً بحلم لطيف بطلته إمرأة أحببتها من قبل، وانتهى حبنا نهاية بائسة. فتحت عيني فرأيت صرصاراً صغيراً فاتحاً يمشي مبتعداً عن وسادتي التي كانت حقيبة يد صغيرة. كان اتجاه الصرصار يدلّ على أنه مر غالباً على رأسي في مساره. فزعت فضربتُه بطرف البطانية ثم أمسكته بمنديل ورقي وأطبقتُ عليه جيداً، ثم احترتُ: كيف أنظف طرف البطانية؟
هذه الصراصير الصغيرة كانت هائلة العدد، لكنها تثير الشفقة لهشاشتها. مرة رأى زميل صرصاراً من هؤلاء فامتنع عن قتله رأفة بحاله! في مساء آخر، جلس صديقي إسلام حسنين بجواري وبدأ يحكي لي عن الكتاكيت التي كان يربيها في منزلهم الريفي، وظلت صراصير صغيرة تسقط علينا من أعلى حيث أغراضنا المعلقة فوق رؤوسنا: أكياس ملابسنا وطعامنا.. نعم طعامنا، لكننا لا ندري كيف تعلمنا الكثير من التسامح في السجن.
ظللت أهيّئ نفسي لأول مواجهة مباشرة مع صرصار، حيث أصحو على وقع دغدغة سريعة على وجهي مثلًا. هيأتُ نفسي كي لا يصيبني مس من الهيستيريا لأن خوفي من الصراصير تحديداً بلا حدود. لكن الحياة كانت طيبة معي، أو لنقل: لكن الصراصير كانت طيبة معي، فترفّقت بي. في صباح تالٍ أخبرني زميل أنه صحا باكراً فوجد صرصاراً على فرشته، فحاول اصطياده بمنديل، لكنه أفلت وجرى مختبئاً خلف مخدتي (حقيبتي). تسمّرتُ.. هل مشى على رأسي؟ لم أجرؤ على سؤال زميلي، ثم بدأت أطوي بطانيتي وأرفع المخدة بحذر، فلم أجد أثراً. المتسلل هرب بسلام. قلت لزميلي بأنني قد لا أجده لأنه صغير. "كان قد كده". أوضح مشيراً بإصبعه كاملًا! ماشي يا حاج.
لا أذكر لقاءات أخرى مع صراصير سجن الحضرة.
لكن في سجن برج العرب، سمعت زميلاً قديماً يحكي لزميل جديد مثلي أن صراصير السجن هنا "عفية" لأننا في سجن صحراوي. بدا رأياً حكيماً حقًا، لكنني الآن أقوى مراساً مع الصراصير. مع قدوم الربيع، سمعت زميلاً آخر يحكي عن صرصار كبير رآه يتجول طائراً في الزنزانة قبل الفجر، ولم يرَ في الظلام أين هبط.
في إحدى ليالي ربيع 2014، قررت النوم فجراً وغطيت رأسي بالبطانية جيداً (كان الجو بارداً) لكنني شعرت بصديقي وجاري لؤي القهوجي يتحرك حركة مفاجئة غريبة، فرفعت البطانية متوجساً فرأيته يجلس ويفتش مخدته (التي كانت جزءاً من البطانية مطبقاً طبقات عدة). سألته فطمأنني أنه يرتب الفرشة فقط.
بعد قليل رفعت البطانية عن وجهي لأن زميلًا تحرك في الزنزانة لصلاة الفجر، فلمحتُ صرصاراً هائلاً يتمشى على بطانية لؤي التي كان يغطي بها وجهه. تبخّرت استعداداتي النفسية، أمسكت بطانيتي وهجمت بها على الصرصار الذي كان إزاء صدر لؤي (فوق بطانيته) فنهض صامتاً. طبعاً لم أقتل الصرصار بهذه الهجمة المذعورة، بل سمحت له بالاختباء بين البطاطين ثم قمت ونظرت إلى جسدي فلم أجده، ثم رفعت البطاطين بحذر حتى وجدته على فرشتي فدهستُه بقدمي دهساً مجنوناً، بلا تفكير أيضاً.
هنا كان لؤي يقهقه لأنه فهم كل شيء منذ شعر بالصرصار يمشي على ذراعه تحت البطانية في الظلام، فقام يبحث عنه ولم يخبرني حين سألته، لعلمه برعبي من الصراصير. ظل لؤي يتندر على هجمتي المجنونة عليه، كلما صادق زميلاً جديداً. لا أذكر كيف نظفت قدمي وفرشتي لأنها كانت ليلة صعبة. لم أنمْ حتى الصباح.
إنها بشارة بقدوم "ربيعنا".
2
في ربيع 2014، اعتدتُ في المعتقل على النوم أوّل المساء لأصحو عند منتصف الليل، حين ينام الزملاء، فأضيء لمبتي الصغيرة، ملفوفة في علبة كرتون فوق رأسي، لتقتصر إضاءتها الصغيرة على كرّاستي التي كنت أكتب فيها روايتي "الحياة باللون الأبيض". صحوت يوماً كعادتي.. كل شيء هادئ، غير أن جاري الخمسيني اللئيم، كانت لديه حكاية صغيرة لي، عن مطاردة مثيرة لصرصار عظيم تسلل من باب الزنزانة، وظلّ الزملاء يطاردونه حتى أمسكوه فوق قدمي. هكذا تمّ لقائي المرتقب مع الصراصير. كان لطفاً منها أن تلاقيني وأنا نائم. حين فكرت لاحظت كم كان ذلك يسيراً، بسيطاً، لا يخلو من إثارة.
بعدها بأيام تجدّد لقاؤنا. كنت صاحياً ورأيت المطاردة تقترب مني. لا شعورياً أمسكت علبة المناديل، وفور وصول الصرصار إلى مخدتي (وهي طبقات متعددة من بطانية) هويت بعلبة المناديل فوقه. لاحظت أنها أصابتْه فلم أرفعها، بل ضغطتُها فوقه بكل قوتي. لم أحتمل فكرة هروبه من تحت العلبة واستمرار المطاردة على فرشتي. كنت حاسماً تماماً. حين رفعت العلبة كانت أمامي عجينة صرصار. المشكلة الوحيدة أنها كانت فوق مخدتي!
الذي استغربته أنني كنت قد ألصقت قطعاً من عجينة دواءٍ طارد للصراصير على الحائط فوق رأسي، فلماذا تأتيني هذه الصراصير كلها؟ أخرجت علبة العجينة لأتأكد من صلاحيتها، فقرأت مذهولًا آلية عملها: تجذب الصراصير برائحتها لتأكل منها فتقتلها مسمومة خلال 24 ساعة! العجينة تجذبها إذاً! وأنا الذي ألصقتها فوق رأسي.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، صحا بعض الزملاء للسحور. كنت نائماً ليلتها. ثمّة جلسة استشكال لنا في الصباح. صحوتُ على أصوات الزملاء والنوم يغالبني. غطيت وجهي جيداً بقطعة ملابس نظيفة اعتدت لفّها على وجهي اتقاء للأصوات والإضاءة والصراصير. ظللت أقترب من النوم ببطء حتى سمعت زميلًا ريفياً طيباً: "الحق يا أحمد الصرصار اللي ماشي على الأستاذ عمر هناك ده". أصبحت الآن أكثر دراية وحكمة: لا يصحّ أن أنتفض مذعوراً كعادتي: سيهرب الصرصار في ثنايا فرشتي.
لم أتحرّك. فقط أغلقت فمي وعينيَّ جيداً. لم أكن أعرف مدى مهارة أحمد في اصطياد الصراصير. ركزتُ طاقتي الإيجابية كلها مع أحمد ليُنهي المعركة بأقل الخسائر. شعرت بخطواته، ثم بلمسة خفيفة فوق ركبتي، ثم صوت أحمد العظيم "خلاص مسكته". يا فرج الله.. تحركتُ، كشفت وجهي، فاعتذر أحمد الطيب، ظانًّا أنه أيقظني. شرح لي خجلاً أن صرصاراً كبيراً كان يمشي عليّ وأنه اصطاده، مادّاً يده تجاهي بالمنديل الملفوف دليلًا على صدقه!
أشرت له بإصبعي إشارة "اللايك" المشهورة، فانصرف مطمئناً. حين غطيت وجهي ثانية خطر لي أن ذلك الصرصار ربما كان بشارة بخروجنا من السجن. كانت الجميلة ماهينور قد خرجت باستشكال قبلنا في القضية ذاتها، وكانت المرة الأولى التي يمشي فيها صرصار كبير على جسدي وأنا صاحٍ. لابد أن لذلك دلالة على شيء ما. في الصباح رفض المستشار محمد الطنّيخي استشكالنا، ثم قُبِض عليه بعدها بشهور متلبساً برشوة من أحد رموز الحزب الوطني، وفقاً لتقارير صحافية كثيرة. لكنه استقال من القضاء فأخليَ سبيله وغادر البلاد. لعلها هي تلك البشارة التي لم أفهمها ليلتها.
مع ذلك، كانت لصراصير أخرى مغامرات لطيفة، إذ لم تكن تكتفي بمطاردة سريعة. لنتفق على أن الصراصير كالبشر، تتكيّف مع قسوة الظروف. وهي ترى نفسها صاحبة البيت هنا، هذا مسكنها ونحن المتطفّلون عليه، لابد من اللعب إذاً..
بعضها كنا نجده في أواني الطبيخ الميري ("التعيين") اليومي. هذه كانت تقهرنا حقاً. في مغامرات أخرى، يهرب صرصار من مطاردة ليلية، يختفي، ثم يُطفأ النور، ونظلّ نترقبه لأننا نعلم أنه هنا، بيننا، سيظهر حين يقرّر. ما زلت أذكر مغامرتين على هذا النحو. في أولاهما أخفى الزملاء عني الخبر. ظهر الصرصار صباحاً وقُتل. لكن ما الذي فعله تحت "جنح الظلام" مثلما يقول الأدباء؟ سأترك ذلك لخيالك.
في المغامرة الأخرى انتبهت للأمر، فلم أنَم. كان الصرصار قد اختفى في الصفّ المواجه لي. كان أحدهم صاحياً أيضاً. فجأة انتفض زميلي مفزوعاً وهو يضرب قفاه بكفه، حيث أحسّ بالصرصار يتمشّى.. نعم ضرب الرجل نفسه "بالقفا"، لكن اللعين أفلت. هذه المرة شاركتُ في المطاردة. رفعنا كل شيء قطعة قطعة فلم نجده. ظللت صاحياً حتى طلع الصباح. ثم أخبرنا زميل آخر أنه رأى في الظلام بقعة سوداء كبيرة تجري نحو حمام الزنزانة. اطمأننت بعض اطمئنان: سيكون بعيداً عني إذاً. مع ذلك لم أنَم إلا صباحاً.
في ربيع 2015، قامت الصراصير بغزوة كبرى، هذه المرة في السجن كله: مرة واحدة! ألم أقل إنها مغامرات؟ حدث سدد في مواسير الصرف، فارتفع منسوب مياه المجاري في المواسير الكبيرة التي لا تمتلئ أبداً. لم تصل إلينا المياه لأن السدد كان بسيطاً، لكن منسوب المياه طرد جيوش الصراصير التي كانت تستعد لموسم الربيع في أعالي المواسير التي تكون جافة دائماً. لذلك هربتْ إلينا من جميع المنافذ حتى لا يغرقها الماء.. من فتحة المرحاض البلدي و"البلاليع" في ممرات التريّض.
.. هكذا تفتّحت الصراصير وليس الزهور في الربيع.
Du verlässt Facebook
assafirarabi.com
قصة السجين مع الصراصير | عمر حاذق
صراصير الزنزانة.. كيف يسعى المصاب برهاب الصراصير الى تقبّل وجود هذه الحشرات الدائم…
في سجن الحضرة اختلف كل شيء. حتى المقشّة الصغيرة أو "اللمامة" البلاستيك ممنوعة. لا منطق أبداً في الحياة الميري. كل شيء ممنوع باستثناء الملابس الميري والطعام (ليس كله) وبعض الأدوية (ليس دائماً). حتى مطهر "الديتول" السائل كان ممنوعاً وقتها. كلما طلب أحدنا إدخال شيء من ذلك، جاءه الردّ غاضباً: "إنت فاكر نفسك في فندق ولا إيه؟!" كأن مستلزمات النظافة من شروط سُكنى الفنادق!
ثمّة نظام محكم في السجون، يتلقاه السجين من زملائه الأقدم مثلما يتعلم الصنايعي أصول المهنة من معلّمه. السجين الأحدث لا يختار مكانه في الزنزانة، بل يذهب إلى المكان المتاح.. الذي يكون الأسوأ. ومع ترحيل زملاء أقدم أو انتهاء عقوبتهم، تُتاح أماكنهم الجيدة للأقدم بعدهم، وبالتالي أماكن هؤلاء للسجناء الأحدث، الذين صارت لهم الآن بعض الأقدمية، فيتركون مواقعهم السيئة للوافدين الجدد. هكذا يتحقق نوع من "العدالة الاجتماعية".
كان الموقع المتاح لي أول موقع في أحد أضلاع الزنزانة. عن يميني باب الزنزانة الحديدي، كلما انفتح في الصباح الباكر هاجمني تيار هواء بارد محمل بالروائح الكريهة. هناك أيضاً الرائحة الدائمة لبرميل "الزبالة" المجاور للباب من الناحية الأخرى. كان عرض الباب متراً واحداً يفصلني عن البرميل الذي لا يمكن غسله. كان وطناً للعفن والحشرات. أول ما صدمني في الأمر أن الصراصير هنا لا تعرف البيات الشتوي، ربما لأن الصراصير كالسجناء: تضطر للتكيف مع الظروف القاتلة للحياة حتى لا تفنى. كان جيراني من سكان برميل الزبالة وركن الزنزانة الذي يحتضنه متنوعين عرقياً. صراصير صغيرة جداً وكبيرة ومتوسطة. الصغيرة والمتوسطة فاتحة اللون دائماً، والكبيرة بنية غامقة كما نعرفها خارج السجن.
بدأ تاريخي مع الصراصير تدريجياً. هذا أيسر. في صباح من صباحات كانون الأول/ ديسمبر، صحوت منتعشاً بحلم لطيف بطلته إمرأة أحببتها من قبل، وانتهى حبنا نهاية بائسة. فتحت عيني فرأيت صرصاراً صغيراً فاتحاً يمشي مبتعداً عن وسادتي التي كانت حقيبة يد صغيرة. كان اتجاه الصرصار يدلّ على أنه مر غالباً على رأسي في مساره. فزعت فضربتُه بطرف البطانية ثم أمسكته بمنديل ورقي وأطبقتُ عليه جيداً، ثم احترتُ: كيف أنظف طرف البطانية؟
هذه الصراصير الصغيرة كانت هائلة العدد، لكنها تثير الشفقة لهشاشتها. مرة رأى زميل صرصاراً من هؤلاء فامتنع عن قتله رأفة بحاله! في مساء آخر، جلس صديقي إسلام حسنين بجواري وبدأ يحكي لي عن الكتاكيت التي كان يربيها في منزلهم الريفي، وظلت صراصير صغيرة تسقط علينا من أعلى حيث أغراضنا المعلقة فوق رؤوسنا: أكياس ملابسنا وطعامنا.. نعم طعامنا، لكننا لا ندري كيف تعلمنا الكثير من التسامح في السجن.
ظللت أهيّئ نفسي لأول مواجهة مباشرة مع صرصار، حيث أصحو على وقع دغدغة سريعة على وجهي مثلًا. هيأتُ نفسي كي لا يصيبني مس من الهيستيريا لأن خوفي من الصراصير تحديداً بلا حدود. لكن الحياة كانت طيبة معي، أو لنقل: لكن الصراصير كانت طيبة معي، فترفّقت بي. في صباح تالٍ أخبرني زميل أنه صحا باكراً فوجد صرصاراً على فرشته، فحاول اصطياده بمنديل، لكنه أفلت وجرى مختبئاً خلف مخدتي (حقيبتي). تسمّرتُ.. هل مشى على رأسي؟ لم أجرؤ على سؤال زميلي، ثم بدأت أطوي بطانيتي وأرفع المخدة بحذر، فلم أجد أثراً. المتسلل هرب بسلام. قلت لزميلي بأنني قد لا أجده لأنه صغير. "كان قد كده". أوضح مشيراً بإصبعه كاملًا! ماشي يا حاج.
لا أذكر لقاءات أخرى مع صراصير سجن الحضرة.
لكن في سجن برج العرب، سمعت زميلاً قديماً يحكي لزميل جديد مثلي أن صراصير السجن هنا "عفية" لأننا في سجن صحراوي. بدا رأياً حكيماً حقًا، لكنني الآن أقوى مراساً مع الصراصير. مع قدوم الربيع، سمعت زميلاً آخر يحكي عن صرصار كبير رآه يتجول طائراً في الزنزانة قبل الفجر، ولم يرَ في الظلام أين هبط.
في إحدى ليالي ربيع 2014، قررت النوم فجراً وغطيت رأسي بالبطانية جيداً (كان الجو بارداً) لكنني شعرت بصديقي وجاري لؤي القهوجي يتحرك حركة مفاجئة غريبة، فرفعت البطانية متوجساً فرأيته يجلس ويفتش مخدته (التي كانت جزءاً من البطانية مطبقاً طبقات عدة). سألته فطمأنني أنه يرتب الفرشة فقط.
بعد قليل رفعت البطانية عن وجهي لأن زميلًا تحرك في الزنزانة لصلاة الفجر، فلمحتُ صرصاراً هائلاً يتمشى على بطانية لؤي التي كان يغطي بها وجهه. تبخّرت استعداداتي النفسية، أمسكت بطانيتي وهجمت بها على الصرصار الذي كان إزاء صدر لؤي (فوق بطانيته) فنهض صامتاً. طبعاً لم أقتل الصرصار بهذه الهجمة المذعورة، بل سمحت له بالاختباء بين البطاطين ثم قمت ونظرت إلى جسدي فلم أجده، ثم رفعت البطاطين بحذر حتى وجدته على فرشتي فدهستُه بقدمي دهساً مجنوناً، بلا تفكير أيضاً.
هنا كان لؤي يقهقه لأنه فهم كل شيء منذ شعر بالصرصار يمشي على ذراعه تحت البطانية في الظلام، فقام يبحث عنه ولم يخبرني حين سألته، لعلمه برعبي من الصراصير. ظل لؤي يتندر على هجمتي المجنونة عليه، كلما صادق زميلاً جديداً. لا أذكر كيف نظفت قدمي وفرشتي لأنها كانت ليلة صعبة. لم أنمْ حتى الصباح.
إنها بشارة بقدوم "ربيعنا".
2
في ربيع 2014، اعتدتُ في المعتقل على النوم أوّل المساء لأصحو عند منتصف الليل، حين ينام الزملاء، فأضيء لمبتي الصغيرة، ملفوفة في علبة كرتون فوق رأسي، لتقتصر إضاءتها الصغيرة على كرّاستي التي كنت أكتب فيها روايتي "الحياة باللون الأبيض". صحوت يوماً كعادتي.. كل شيء هادئ، غير أن جاري الخمسيني اللئيم، كانت لديه حكاية صغيرة لي، عن مطاردة مثيرة لصرصار عظيم تسلل من باب الزنزانة، وظلّ الزملاء يطاردونه حتى أمسكوه فوق قدمي. هكذا تمّ لقائي المرتقب مع الصراصير. كان لطفاً منها أن تلاقيني وأنا نائم. حين فكرت لاحظت كم كان ذلك يسيراً، بسيطاً، لا يخلو من إثارة.
بعدها بأيام تجدّد لقاؤنا. كنت صاحياً ورأيت المطاردة تقترب مني. لا شعورياً أمسكت علبة المناديل، وفور وصول الصرصار إلى مخدتي (وهي طبقات متعددة من بطانية) هويت بعلبة المناديل فوقه. لاحظت أنها أصابتْه فلم أرفعها، بل ضغطتُها فوقه بكل قوتي. لم أحتمل فكرة هروبه من تحت العلبة واستمرار المطاردة على فرشتي. كنت حاسماً تماماً. حين رفعت العلبة كانت أمامي عجينة صرصار. المشكلة الوحيدة أنها كانت فوق مخدتي!
الذي استغربته أنني كنت قد ألصقت قطعاً من عجينة دواءٍ طارد للصراصير على الحائط فوق رأسي، فلماذا تأتيني هذه الصراصير كلها؟ أخرجت علبة العجينة لأتأكد من صلاحيتها، فقرأت مذهولًا آلية عملها: تجذب الصراصير برائحتها لتأكل منها فتقتلها مسمومة خلال 24 ساعة! العجينة تجذبها إذاً! وأنا الذي ألصقتها فوق رأسي.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، صحا بعض الزملاء للسحور. كنت نائماً ليلتها. ثمّة جلسة استشكال لنا في الصباح. صحوتُ على أصوات الزملاء والنوم يغالبني. غطيت وجهي جيداً بقطعة ملابس نظيفة اعتدت لفّها على وجهي اتقاء للأصوات والإضاءة والصراصير. ظللت أقترب من النوم ببطء حتى سمعت زميلًا ريفياً طيباً: "الحق يا أحمد الصرصار اللي ماشي على الأستاذ عمر هناك ده". أصبحت الآن أكثر دراية وحكمة: لا يصحّ أن أنتفض مذعوراً كعادتي: سيهرب الصرصار في ثنايا فرشتي.
لم أتحرّك. فقط أغلقت فمي وعينيَّ جيداً. لم أكن أعرف مدى مهارة أحمد في اصطياد الصراصير. ركزتُ طاقتي الإيجابية كلها مع أحمد ليُنهي المعركة بأقل الخسائر. شعرت بخطواته، ثم بلمسة خفيفة فوق ركبتي، ثم صوت أحمد العظيم "خلاص مسكته". يا فرج الله.. تحركتُ، كشفت وجهي، فاعتذر أحمد الطيب، ظانًّا أنه أيقظني. شرح لي خجلاً أن صرصاراً كبيراً كان يمشي عليّ وأنه اصطاده، مادّاً يده تجاهي بالمنديل الملفوف دليلًا على صدقه!
أشرت له بإصبعي إشارة "اللايك" المشهورة، فانصرف مطمئناً. حين غطيت وجهي ثانية خطر لي أن ذلك الصرصار ربما كان بشارة بخروجنا من السجن. كانت الجميلة ماهينور قد خرجت باستشكال قبلنا في القضية ذاتها، وكانت المرة الأولى التي يمشي فيها صرصار كبير على جسدي وأنا صاحٍ. لابد أن لذلك دلالة على شيء ما. في الصباح رفض المستشار محمد الطنّيخي استشكالنا، ثم قُبِض عليه بعدها بشهور متلبساً برشوة من أحد رموز الحزب الوطني، وفقاً لتقارير صحافية كثيرة. لكنه استقال من القضاء فأخليَ سبيله وغادر البلاد. لعلها هي تلك البشارة التي لم أفهمها ليلتها.
مع ذلك، كانت لصراصير أخرى مغامرات لطيفة، إذ لم تكن تكتفي بمطاردة سريعة. لنتفق على أن الصراصير كالبشر، تتكيّف مع قسوة الظروف. وهي ترى نفسها صاحبة البيت هنا، هذا مسكنها ونحن المتطفّلون عليه، لابد من اللعب إذاً..
بعضها كنا نجده في أواني الطبيخ الميري ("التعيين") اليومي. هذه كانت تقهرنا حقاً. في مغامرات أخرى، يهرب صرصار من مطاردة ليلية، يختفي، ثم يُطفأ النور، ونظلّ نترقبه لأننا نعلم أنه هنا، بيننا، سيظهر حين يقرّر. ما زلت أذكر مغامرتين على هذا النحو. في أولاهما أخفى الزملاء عني الخبر. ظهر الصرصار صباحاً وقُتل. لكن ما الذي فعله تحت "جنح الظلام" مثلما يقول الأدباء؟ سأترك ذلك لخيالك.
في المغامرة الأخرى انتبهت للأمر، فلم أنَم. كان الصرصار قد اختفى في الصفّ المواجه لي. كان أحدهم صاحياً أيضاً. فجأة انتفض زميلي مفزوعاً وهو يضرب قفاه بكفه، حيث أحسّ بالصرصار يتمشّى.. نعم ضرب الرجل نفسه "بالقفا"، لكن اللعين أفلت. هذه المرة شاركتُ في المطاردة. رفعنا كل شيء قطعة قطعة فلم نجده. ظللت صاحياً حتى طلع الصباح. ثم أخبرنا زميل آخر أنه رأى في الظلام بقعة سوداء كبيرة تجري نحو حمام الزنزانة. اطمأننت بعض اطمئنان: سيكون بعيداً عني إذاً. مع ذلك لم أنَم إلا صباحاً.
في ربيع 2015، قامت الصراصير بغزوة كبرى، هذه المرة في السجن كله: مرة واحدة! ألم أقل إنها مغامرات؟ حدث سدد في مواسير الصرف، فارتفع منسوب مياه المجاري في المواسير الكبيرة التي لا تمتلئ أبداً. لم تصل إلينا المياه لأن السدد كان بسيطاً، لكن منسوب المياه طرد جيوش الصراصير التي كانت تستعد لموسم الربيع في أعالي المواسير التي تكون جافة دائماً. لذلك هربتْ إلينا من جميع المنافذ حتى لا يغرقها الماء.. من فتحة المرحاض البلدي و"البلاليع" في ممرات التريّض.
.. هكذا تفتّحت الصراصير وليس الزهور في الربيع.
Du verlässt Facebook
assafirarabi.com
قصة السجين مع الصراصير | عمر حاذق
صراصير الزنزانة.. كيف يسعى المصاب برهاب الصراصير الى تقبّل وجود هذه الحشرات الدائم…