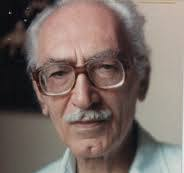قضية لاجئي الداخل في دولة إسرائيل، أي الفلسطينيين لاجئي سنة 1948 الذين هجروا من قراهم وبلداتهم خلال الحرب لكنهم بقوا داخل حدود الدولة وأصبحوا مواطنين فيها، لازمت تاريخ علاقات دولة إسرائيل بمواطنيها العرب منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا. فمنذ سنة 1948 يطالب هؤلاء اللاجئون، ولا يزالون يطالبون حتى اليوم، بالعودة الى قراهم. لكن ـ من جهة اخرى ـ رفضت حكومات إسرائيل المتعاقبة السماح بعودة اللاجئين الى قراهم، وفي اغلب الأحوال أعطيت أراضيهم للمستوطنات اليهودية من أجل استغلالها. هذا الخلاف يعتبر أحد المظاهر الملموسة للصراع القائم في علاقة الدولة بمواطنيها العرب، بكل ما يترتب على هذا الأمر من تبعات قيمية ـ خلقية وسياسية وعملية.
إن جذور ظاهرة اللجوء الداخلي تعود الى أنماط هجرة السكان العرب من المناطق التي كانت القوات اليهودية احتلتها سنة 1948. وفي العادة، كان السكان العرب يفرون هرباً من المعارك الدائرة الى قرية مجاورة غير محتلة، او الى مدينة كبيرة أملاً بإيجاد ملجأ فيها. وعندما كانت المعارك تقترب من مكان اللجوء كان بعضهم يواصل الفرار، في حين كان البعض الآخر يفضل البقاء حيث هو. وكانت مدينة الناصرة، التي تلقت معاملة خاصة من الجيش الإسرائيلي نظراً الى قدسيتها لدى المسيحيين، ملجأ لآلاف اللاجئين من القرى المجاورة، ومن مناطق أبعد. وقد بقي هؤلاء اللاجئون فيها بعد الاحتلال. وهذا ما حدث لكثيرين من اللاجئين كانوا تجمعوا في قرى الجليل الأعلى والجليل الغربي.
كانت ردة الفعل الفورية للجيش الإسرائيلي، كما يظهر من مختلف المرجعيات، طرد اللاجئين الذين بقوا داخل حدود الدولة الى خارجها، للحؤول دون عودتهم الى قراهم. وهكذا طُرد آلاف اللاجئين.
على الرغم من عمليات الترحيل القسرية فقد بقي داخل حدود الدولة نحو 25,000 لاجئ*، شكلوا سدس السكان العرب تقريباً ـ وقد كانوا في أغلبيتهم الساحقة في الجليل ـ ومنذ ذلك الحين توجب على الدولة إيجاد طرق للحؤول دون عودتهم الى قراهم، ووضع يدها على أراضيهم. وفي الأعوام الأولى عملت السلطة التنفيذية غير مرة بصورة مخالفة للقانون، او استغلت ثغرات لا يغطيها القانون، لتحقيق هذين الهدفين. إلا انه مع مرور الوقت أصدرت السلطات عدداً من الأوامر والأنظمة والقوانين التي أعطت شرعية قانونية لممارساتها، وأهمها قانون أموال الغائبين بمختلف صيغه وتحوّلاته.
إضافة الى الوسائل القانونية عملت سلطات الدولة بالطرق البيروقراطية والقضائية، وبالوسائل العنيفة، من اجل اقتلاع هوية اللجوء الجماعية للاجئي الداخل، وذلك افتراضاً منها ان هذا الأمر سيقمع مطالب اللاجئين بالعودة الى قراهم الأصلية واستعادة أراضيهم. من جهة اخرى، سعى النشطاء من اللاجئين، ولا يزالون يسعون، للحفاظ على هوية اللجوء بشتى الطرق، الى جانب الاستمرار في المطالبة بالعودة. وقد زادت وتيرة هذه المساعي منذ التسعينيات فصاعداً. ولإدراك كنه هذه الحقيقة علينا ان نفهم، بداية، ما هي «هوية اللجوء». في هذه الهوية يمكن تحديد مركبين: الأول ـ ويعتبر مركباً إيجابياً ـ هو ان يكون الشخص ابن بلدة (قرية) محددة لم يعد لها وجود، بطرقها المهجورة وبيوتها المهدمة وروائحها التي لم يعد لها أثر. ويمكن تسمية هذا الجانب من الهوية: «أنا من هناك». أما المركب الثاني من هوية اللجوء ـ ويعتبر مركباً سلبياً ـ فهو النظرة الذاتية ونظرة الآخرين الى الشخص كلاجئ وكغريب ودخيل على المكان: «أنا لست من هنا». وتتجلى هذه النظرة في الشعور بالغربة في مكان اللجوء، الذي تزداد حدته أحياناً بسبب رفض أبناء البلدة التي استوعبت اللاجئين.
اتخذت الدولة الإسرائيلية التدابير التالية: إزالة اسماء القرى المهجرة من خرائط الدولة، استثناء لاجئي الداخل من احصاء اللاجئين الذي أجرته الأونروا وإدراجهم في احصاءاتها بحسب قرى اللجوء، عدم الإشارة الى القرى المهجرة وقضية اللاجئين في المناهج التعليمية، بما فيها تلك الموجهة الى الطلاب العرب.
كان الهدف الاول من منع دخول اللاجئين الى قراهم إحداث القطيعة التامة بين اللاجئين وقراهم الأصلية، وذلك في نطاق خطة تهدف الى تسليم أراضيهم للمستوطنات اليهودية. وكانت القطيعة القسرية عن القرى بمثابة خطوة اولى في عملية انتزاع هوية اللجوء الايجابية، فالجيل الجديد الذي ولد بعد الحرب لن يكون في إمكانه ان يقول «أنا من هناك»، بل حتى أبناء الجيل الأكبر سناً لن يتمكنوا من الإشارة بأصابعهم الى مكان سكناهم. إذ ان هدم القرى، الذي تم في مرحلة لاحقة، كان من المفترض ان يرمز الى استحالة تحقيق حلم العودة إليها، وأن يكرس هذه الاستحالة. مع ذلك افترضت السلطات ان هذه التدابير لن تفي بالغرض في حال عدم إيجاد حلول سكنية للاجئين.
كذلك لجأت الدولة الى وسيلة اخرى مهمة هي تدابير التعويضات التي أقرها قانون استملاك الأراضي الذي ذكرناه آنفاً، والتي اشتملت على بند إسكان اللاجئين في أماكن بديلة، إضافة الى إعطائهم تعويضات عن أملاكهم في قراهم الأصلية. وما إن سُنّ القانون حتى مورست ضغوط شديدة على لاجئي الداخل من أجل إجبارهم على التوصل الى تسويات مع الدولة في شأن أراضيهم. وكان على اللاجئين من اجل الحصول على التعويضات، ان يوقعوا مستنداً يصرّحون فيه ان ليست لديهم اية مطالب من الدولة تتعلق بأراضيهم. وبطبيعة الحال اعترض كثيرون على هذا القانون. وحتى بعد إقراره وسريان مفعوله، امتنع كثيرون من لاجئي الداخل عن المطالبة بتعويضاتهم عن أراضيهم التي تمّ الاستيلاء عليها. فقد اعتبروا هذا الأمر عدولاً عن مطلب العودة المثالي على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيدين القومي والمجتمعي. زيادة على ذلك، كان هذا المبدأ عاملاً موحّداً وحافظاً للهوية، والحياد عنه قد يؤدي الى التفكك الاجتماعي.
عملت الدولة أيضاً بأساليب أخرى للتأثير في الوعي من اجل تحقيق الهدف نفسه، أي عدم تشكيل هوية اللجوء فقد تعمدت، في الإحصاءات السكانية، ألا تشير الى القرى الأصلية التي جاء منها لاجئو الداخل، الذين لم تشملهم إحصاءات الأونروا أيضاً، كذلك تم تغييب أسماء القرى المهجرة عن الخرائط، كما أنه غنيّ عن الذكر عدم إقامة أي متحف في دولة إسرائيل يصور الحياة الريفية التي كانت واندثرت.
واستخدام الخريطة في هذا السياق بارز للعيان: فدائرة المساحة الإسرائيلية، المسؤولة عن مسح الأراضي، محت من خرائطها القرى الفلسطينية المهجرة. وليس في إمكاننا اليوم تحديد موقع غير عدد قليل من القرى في الخرائط الطوبوغرافية المتعددة. وهذا ينطبق على القرى التي أقيمت في مواقعها مستوطنات يهودية، كما ينطبق على القرى التي لم يقم في مواقعها مثل هذه المستوطنات.
كذلك تم استخدام إحصاء السكان بطريقة مماثلة. فإلى جانب إزالة القرى المهجرة عن الخرائط تم استثناء لاجئي الداخل الذين كانوا يسكنون في هذه القرى من قوائم اللاجئين التي أعدّتها الأونروا. وحتى سنة 1952 كانت الاونروا تقدم الى اللاجئين في إسرائيل الخدمات نفسها التي كانت تقدمها الى اللاجئين في المخيمات في الدول العربية: أي انها كانت توزع عليهم الحصص التموينية، وتساعدهم في إيجاد عمل. لكن في صيف سنة 1952، قررت الحكومة تحمل مسؤولية اللاجئين الذين شملتهم الأونروا برعايتها، وقد ترافق هذا الأمر مع إعلان وزارة الخارجية انه «لم يعد هناك أي لاجئين في دولة إسرائيل». وفي الإحصاءات السكانية التي أجرتها الدولة تمّ تسجيلهم بحسب القرى التي لجأوا إليها، لا بحسب قراهم الأصلية. وهكذا فقد استخدم إحصاء السكان لتمرير رسالة فحواها أن لا رابط بعد الآن بين اللاجئين وقراهم الأصلية.
لكن، على الرغم من الجهود كلها التي بذلتها الدولة فقد بدأت بوادر هوية اللجوء تطلّ برأسها من جديد في أوائل التسعينيات، وزادت وتيرة هذه العملية مع تأليف أكثر من عشرين لجنة محلية للاجئي الداخل انتظمت في إطار لجنة قطرية عليا.
هذا الانبعاث السريع لـ«هوية اللجوء» يشير الى ان هذه الهوية حفظت لا لدى أبناء الجيل الأول، أي اللاجئين أنفسهم، فحسب بل ايضاً لدى أبنائهم وأحفادهم. وهذا يدلّ على ان هذه الهوية بقيت دفينة في صدور اللاجئين على مرّ الزمن، على الرغم من سياسة الحكومة التي تحدّثنا عنها آنفاً. ويمكن الافتراض ان هذه الهوية حفظت خلال الأعوام الاولى بفضل النضال من اجل العودة الى القرى، وفيما بعد بفضل الشعور بالغربة الذي راود اللاجئين في القرى والمدن التي لجأوا إليها.
هليل كوهين باحث اسرائيلي وناقد للسياسات الاسرائيلية وله كتاب: «الغائبون الحاضرون» الذي اصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالعربية سنة 2003. * صاروا في سنة 2009 نحو 200 ألف
إن جذور ظاهرة اللجوء الداخلي تعود الى أنماط هجرة السكان العرب من المناطق التي كانت القوات اليهودية احتلتها سنة 1948. وفي العادة، كان السكان العرب يفرون هرباً من المعارك الدائرة الى قرية مجاورة غير محتلة، او الى مدينة كبيرة أملاً بإيجاد ملجأ فيها. وعندما كانت المعارك تقترب من مكان اللجوء كان بعضهم يواصل الفرار، في حين كان البعض الآخر يفضل البقاء حيث هو. وكانت مدينة الناصرة، التي تلقت معاملة خاصة من الجيش الإسرائيلي نظراً الى قدسيتها لدى المسيحيين، ملجأ لآلاف اللاجئين من القرى المجاورة، ومن مناطق أبعد. وقد بقي هؤلاء اللاجئون فيها بعد الاحتلال. وهذا ما حدث لكثيرين من اللاجئين كانوا تجمعوا في قرى الجليل الأعلى والجليل الغربي.
كانت ردة الفعل الفورية للجيش الإسرائيلي، كما يظهر من مختلف المرجعيات، طرد اللاجئين الذين بقوا داخل حدود الدولة الى خارجها، للحؤول دون عودتهم الى قراهم. وهكذا طُرد آلاف اللاجئين.
على الرغم من عمليات الترحيل القسرية فقد بقي داخل حدود الدولة نحو 25,000 لاجئ*، شكلوا سدس السكان العرب تقريباً ـ وقد كانوا في أغلبيتهم الساحقة في الجليل ـ ومنذ ذلك الحين توجب على الدولة إيجاد طرق للحؤول دون عودتهم الى قراهم، ووضع يدها على أراضيهم. وفي الأعوام الأولى عملت السلطة التنفيذية غير مرة بصورة مخالفة للقانون، او استغلت ثغرات لا يغطيها القانون، لتحقيق هذين الهدفين. إلا انه مع مرور الوقت أصدرت السلطات عدداً من الأوامر والأنظمة والقوانين التي أعطت شرعية قانونية لممارساتها، وأهمها قانون أموال الغائبين بمختلف صيغه وتحوّلاته.
إضافة الى الوسائل القانونية عملت سلطات الدولة بالطرق البيروقراطية والقضائية، وبالوسائل العنيفة، من اجل اقتلاع هوية اللجوء الجماعية للاجئي الداخل، وذلك افتراضاً منها ان هذا الأمر سيقمع مطالب اللاجئين بالعودة الى قراهم الأصلية واستعادة أراضيهم. من جهة اخرى، سعى النشطاء من اللاجئين، ولا يزالون يسعون، للحفاظ على هوية اللجوء بشتى الطرق، الى جانب الاستمرار في المطالبة بالعودة. وقد زادت وتيرة هذه المساعي منذ التسعينيات فصاعداً. ولإدراك كنه هذه الحقيقة علينا ان نفهم، بداية، ما هي «هوية اللجوء». في هذه الهوية يمكن تحديد مركبين: الأول ـ ويعتبر مركباً إيجابياً ـ هو ان يكون الشخص ابن بلدة (قرية) محددة لم يعد لها وجود، بطرقها المهجورة وبيوتها المهدمة وروائحها التي لم يعد لها أثر. ويمكن تسمية هذا الجانب من الهوية: «أنا من هناك». أما المركب الثاني من هوية اللجوء ـ ويعتبر مركباً سلبياً ـ فهو النظرة الذاتية ونظرة الآخرين الى الشخص كلاجئ وكغريب ودخيل على المكان: «أنا لست من هنا». وتتجلى هذه النظرة في الشعور بالغربة في مكان اللجوء، الذي تزداد حدته أحياناً بسبب رفض أبناء البلدة التي استوعبت اللاجئين.
اتخذت الدولة الإسرائيلية التدابير التالية: إزالة اسماء القرى المهجرة من خرائط الدولة، استثناء لاجئي الداخل من احصاء اللاجئين الذي أجرته الأونروا وإدراجهم في احصاءاتها بحسب قرى اللجوء، عدم الإشارة الى القرى المهجرة وقضية اللاجئين في المناهج التعليمية، بما فيها تلك الموجهة الى الطلاب العرب.
كان الهدف الاول من منع دخول اللاجئين الى قراهم إحداث القطيعة التامة بين اللاجئين وقراهم الأصلية، وذلك في نطاق خطة تهدف الى تسليم أراضيهم للمستوطنات اليهودية. وكانت القطيعة القسرية عن القرى بمثابة خطوة اولى في عملية انتزاع هوية اللجوء الايجابية، فالجيل الجديد الذي ولد بعد الحرب لن يكون في إمكانه ان يقول «أنا من هناك»، بل حتى أبناء الجيل الأكبر سناً لن يتمكنوا من الإشارة بأصابعهم الى مكان سكناهم. إذ ان هدم القرى، الذي تم في مرحلة لاحقة، كان من المفترض ان يرمز الى استحالة تحقيق حلم العودة إليها، وأن يكرس هذه الاستحالة. مع ذلك افترضت السلطات ان هذه التدابير لن تفي بالغرض في حال عدم إيجاد حلول سكنية للاجئين.
كذلك لجأت الدولة الى وسيلة اخرى مهمة هي تدابير التعويضات التي أقرها قانون استملاك الأراضي الذي ذكرناه آنفاً، والتي اشتملت على بند إسكان اللاجئين في أماكن بديلة، إضافة الى إعطائهم تعويضات عن أملاكهم في قراهم الأصلية. وما إن سُنّ القانون حتى مورست ضغوط شديدة على لاجئي الداخل من أجل إجبارهم على التوصل الى تسويات مع الدولة في شأن أراضيهم. وكان على اللاجئين من اجل الحصول على التعويضات، ان يوقعوا مستنداً يصرّحون فيه ان ليست لديهم اية مطالب من الدولة تتعلق بأراضيهم. وبطبيعة الحال اعترض كثيرون على هذا القانون. وحتى بعد إقراره وسريان مفعوله، امتنع كثيرون من لاجئي الداخل عن المطالبة بتعويضاتهم عن أراضيهم التي تمّ الاستيلاء عليها. فقد اعتبروا هذا الأمر عدولاً عن مطلب العودة المثالي على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيدين القومي والمجتمعي. زيادة على ذلك، كان هذا المبدأ عاملاً موحّداً وحافظاً للهوية، والحياد عنه قد يؤدي الى التفكك الاجتماعي.
عملت الدولة أيضاً بأساليب أخرى للتأثير في الوعي من اجل تحقيق الهدف نفسه، أي عدم تشكيل هوية اللجوء فقد تعمدت، في الإحصاءات السكانية، ألا تشير الى القرى الأصلية التي جاء منها لاجئو الداخل، الذين لم تشملهم إحصاءات الأونروا أيضاً، كذلك تم تغييب أسماء القرى المهجرة عن الخرائط، كما أنه غنيّ عن الذكر عدم إقامة أي متحف في دولة إسرائيل يصور الحياة الريفية التي كانت واندثرت.
واستخدام الخريطة في هذا السياق بارز للعيان: فدائرة المساحة الإسرائيلية، المسؤولة عن مسح الأراضي، محت من خرائطها القرى الفلسطينية المهجرة. وليس في إمكاننا اليوم تحديد موقع غير عدد قليل من القرى في الخرائط الطوبوغرافية المتعددة. وهذا ينطبق على القرى التي أقيمت في مواقعها مستوطنات يهودية، كما ينطبق على القرى التي لم يقم في مواقعها مثل هذه المستوطنات.
كذلك تم استخدام إحصاء السكان بطريقة مماثلة. فإلى جانب إزالة القرى المهجرة عن الخرائط تم استثناء لاجئي الداخل الذين كانوا يسكنون في هذه القرى من قوائم اللاجئين التي أعدّتها الأونروا. وحتى سنة 1952 كانت الاونروا تقدم الى اللاجئين في إسرائيل الخدمات نفسها التي كانت تقدمها الى اللاجئين في المخيمات في الدول العربية: أي انها كانت توزع عليهم الحصص التموينية، وتساعدهم في إيجاد عمل. لكن في صيف سنة 1952، قررت الحكومة تحمل مسؤولية اللاجئين الذين شملتهم الأونروا برعايتها، وقد ترافق هذا الأمر مع إعلان وزارة الخارجية انه «لم يعد هناك أي لاجئين في دولة إسرائيل». وفي الإحصاءات السكانية التي أجرتها الدولة تمّ تسجيلهم بحسب القرى التي لجأوا إليها، لا بحسب قراهم الأصلية. وهكذا فقد استخدم إحصاء السكان لتمرير رسالة فحواها أن لا رابط بعد الآن بين اللاجئين وقراهم الأصلية.
لكن، على الرغم من الجهود كلها التي بذلتها الدولة فقد بدأت بوادر هوية اللجوء تطلّ برأسها من جديد في أوائل التسعينيات، وزادت وتيرة هذه العملية مع تأليف أكثر من عشرين لجنة محلية للاجئي الداخل انتظمت في إطار لجنة قطرية عليا.
هذا الانبعاث السريع لـ«هوية اللجوء» يشير الى ان هذه الهوية حفظت لا لدى أبناء الجيل الأول، أي اللاجئين أنفسهم، فحسب بل ايضاً لدى أبنائهم وأحفادهم. وهذا يدلّ على ان هذه الهوية بقيت دفينة في صدور اللاجئين على مرّ الزمن، على الرغم من سياسة الحكومة التي تحدّثنا عنها آنفاً. ويمكن الافتراض ان هذه الهوية حفظت خلال الأعوام الاولى بفضل النضال من اجل العودة الى القرى، وفيما بعد بفضل الشعور بالغربة الذي راود اللاجئين في القرى والمدن التي لجأوا إليها.
هليل كوهين باحث اسرائيلي وناقد للسياسات الاسرائيلية وله كتاب: «الغائبون الحاضرون» الذي اصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالعربية سنة 2003. * صاروا في سنة 2009 نحو 200 ألف