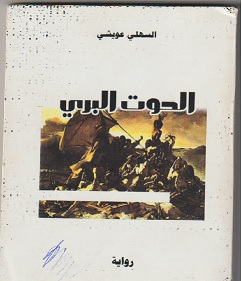إِنَّ ٱلكِتَابَةَ، حَتَّى في أَعْلَى وَفي أَجْلَى مَرَاتِبِهَا ٱلاِسْتِيهَامِيَّةِ،
لَثَوْرَةٌ دَائِمَةٌ عَلى حِذْقِيَّةِ ٱلرَّاقِعِ، ثَوْرَةٌ دَائِمَةٌ عَلى فِعْلِيَّةِ ٱلوَاقِعِ!
جيمس جويس
أذكُرُ جيدًا كذلك أنَّ صَدِيقًا قريبًا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُهُ على المَلأِ الأدْنَى كانَ قدْ ردَّ بتعقيبٍ نقديٍّ يَسْتَجْلِبُ الاهتمامَ كلَّهُ، فعلاً، على مقالِ صبحي حديدي «يومُ ليوبولد بلوم العجائبيُّ» (القدس العربي، 19 حزيران 2017) – وهو المقالُ الأخيرُ الذي يُعِيدُ بنَحْوٍ أو بآخَرَ كتابةَ كُلٍّ من مقالَيْهِ الآخَرَيْنِ، على الترتيبِ: المقالِ الآنِفِ «صورةُ جيمس جويس في شبابِهِ» (القدس العربي، 20 حزيران 2016) والمقالِ الآنَفِ «ألغازُ جويس وسُلْطَةُ المُخَيِّلَةِ» (القدس العربي، 14 حزيران 2015). فقدْ جاءتْ هذهِ المقالاتُ في أحْيَانِهَا تِبَاعًا حَوْلِيًّا، مثلما هو مألوفٌ في أدبِ، أو آدابِ، الكتابةِ النقديةِ وغيرِ النقديةِ، على حَدٍّ سِوًى، فقدْ جاءتِ احتفاءً أدبيًّا (وَوَاجِبِيًّا، كذلك) بالذكرى السَّنويةِ لِمَا يُسَمَّى محليًّا داخلَ إيرلندا وعالميًّا خارجَها بـ«يَوْمِ بْلُوم» الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من كلِّ عامٍ، ذلك اليومِ الذي تجري فيهِ «مَيْمَنَاتُ» الأحداثِ الظاهريةِ، جَهْرًا، و«مَشْأَمَاتُ» الأجداثِ الباطنيةِ، سِرًّا، في رائعةِ جيمس جويس «يُولِيس» Ulysses بالذاتِ (أو «عُولِيس»، كما يعرِّبُهَا اِسميًّا بعضٌ من المترجمينَ والنقَّادِ الأدبيِّينَ العربِ). ففي هذهِ الرائعةِ المتعدِّدةِ الوُجُوهِ والأقنعةِ، يتبدَّى ذلك اليومُ، والحالُ هذهِ، على اعتبارِهِ أطولَ يومٍ فَنِّيٍّ مُتَخَيَّلٍ في تاريخِ الأدبِ (الروائيِّ أو، بالحَرِيِّ، اللاروائيِّ) المكتوبِ باللغةِ الإنكليزيةِ، إنْ لمْ نقُلْ «والمكتوبِ بغيرِ اللغةِ الإنكليزيةِ»، قاطبةً. وقدْ رِيمَتْ، مَا بينَ هَزْلٍ وجِدٍّ، كتابةُ «يَوْمُ بْلُوم» Bloomsday (أو «يَوْمُبْلُوم»، نَقْحَرَةً) كتابةً لاتينيَّةً على شاكلتِها التكثيفيةِ الحَالِيَّةِ بما يُوحِي رَسْمًا ووَقْعًا إنكليزيَّيْنِ إِيحَاءً ليسَ إلاَّ، وذلك احتذاءً واقتداءً بالثورةِ اللغويةِ النفسيةِ الفريدةِ التي شنَّها جيمس جويس ذاتُهُ، من خلالِ ما انتهجَهُ من منهجٍ كتابيٍّ تركيبيٍّ وتراكُبيٍّ فريدٍ، شنًّا «حرفيًّا» وشنًّا «مجازيًّا» على بنيانِ اللغةِ الإنكليزيةِ ذاتِها، بوصفِها لغةً استعماريةً وإمبرياليةً في الصَّميمِ، وبصفتِهَا من ثمَّ لغةً عنصريةً وعِرْقِيَّةً في صَميمِ الصَّميمِ: إذْ كُتِبتْ هذهِ الكتابةُ عمدًا مُتَعَمَّدًا على خلافِ ما يُكتبُ عادةً حَسْبَمَا هوُ موروثٌ ومُتَوَارَثٌ لِسَانيًّا، جيلاً بعدَ جيلٍ، في منظُومةِ هذهِ اللغةِ اللَّدَائِنيَّةِ نَحْوًا وصَرْفًا (أيْ «يَوْمُ بْلُوم» Bloom’s Day، على وجهِ الضَّبْطِ)، كما يتوقَّعُ في الرَّسْمِ وَ/أوِ في الوَقْعِ لِسَانُ الناطقِ الإنكليزيِّ السَّلِيقِيِّ، أو حتى لِسَانُ الناطقِ الإنكليزيِّ اللاسَلِيقِيِّ. تلك، إذنْ، كانتْ ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً، حقًّا، بالمعنيَيْنِ السياسيِّ القريبِ والسياسيِّ البعيدِ كلَيْهِمَا، شاءَ المُسْتَعْبِدُونِ «المُسَيَّدُونَ» مِنْ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمِرِ الإنكليزيِّ، ومَنْ تملَّقَهُمْ (وإليهِمْ) ومَنْ دَاهَنَهُمْ ودَالَسَهُمْ (ولُهُمْ) وإلى حَدِّ التَّوَاطُؤِ الوَضِيعِ واللَّكِيعِ مِنَ المُسْتَعْبَدِينِ «المُسَيِّدِينَ» مِنْ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمَرِ الإيرلنديِّ ذَوَاتِهِمْ، أمْ أَبَوْا.
لقدَ كانتْ تلك ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً بالمعنى السياسيِّ القريبِ، من طرفٍ، لأنَّ جويس لمْ يَكُنْ يُريدُ في طَوِيَّتِهِ، منذُ البَدْءِ، أنْ تتمخَّضَ رائعتُهُ «يُولِيس» عن عملٍ روائيٍّ بأيِّ نوعٍ من أنواعِهِ الفَنِّيَّةِ المعروفةِ في العالَمِ بأسرهِ، مثلما يَخَالُهَا العديدُ من النقَّادِ الأدبيِّينَ في بلادِ الغَرْبِ (حتى قبلَ أنْ يَخَالَهَا مثلَهُمُ العديدُ من النقَّادِ الأدبيِّينَ في بلادِ العَرَبِ)، بلْ كانَ يَرُومُ في صَرِيمَتِهِ أنْ تُسْفِرَ هذهِ الرائعةُ الاستثنائيةُ عنْ عملٍ كتابيٍّ (لاروائيٍّ) تتجلَّى فيهِ تجلِّيًا أجناسُ الكتابةِ كلُّها، وتتجلَّى فيهِ تجلِّيًا أكثرَ ما تحملُهُ هذهِ الأجناسُ بينَ طيَّاتِها من جَمَائِلَ أو قَبَائِحَ أو بينَ بينَ. كانَ يقضي يومًا بأكملِهِ، أو يزيدُ، دُونَمَا كَلَلٍ أو مَلَلٍ أو هَوَادةٍ حتى على المَأْتَاةِ ببَحْتِ جُمْلةٍ يَتِيمَةٍ، أو بمَحْضِ عبارةٍ لَطِيمَةٍ، تُحْبِرُ، في الحيِّزِ الأولِ، ذائقتَهُ المُوسِيقِيَّةَ من كلِّ جهةٍ ذاتيةٍ أو حتى موضوعيةٍ، وتسعى من ثمَّ، في الحيِّزِ الثاني، إلى إحْبَارِ الذائقاتِ المُوسِيقِيَّةِ النظيرةِ عندَ صِنْوانِهِ الظِّمَاءِ من الإيرلنديِّينَ والإيرلنديَّاتِ، أيَّةً كانتْ خلفيَّاتُهُمُ الثقافيةُ أو حتى «اللاثقافيةُ»، وتسعى، في المقابلِ، في الحيِّزِ الأخيرِ، إلى خَدْشِ أسْمَاعِ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمِرِ الإنكليزيِّ خاصَّةً، وإلى نَفْخِ أوْدَاجِهِمْ وإيغَارِ صُدُورِهِمْ أينما كانوا، وإلى تنغيصِ حَيَوَاتِهِمْ وتذكيرِهِمْ على الدوامِ بما ارتكبوهُ من شُرُورٍ وآثامٍ بإزاءِ بناتِ وأبناءِ هذهِ «الأمَّةِ» السِّلْتِيَّةِ الإيرلنديةِ، أو حتى الاسكتلنديةِ. وقدَ كانتْ تلك ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً بالمعنى السياسيِّ البعيدِ، من طرفٍ آخَرَ، لأنَّ جويس كانَ يعلمُ علمَ اليقينِ بأنَّ أيَّةَ نزعةٍ «قوميَّةٍ» تُؤَطِّرُهَا عَنْوَةً أُطُرٌ مكانيةٌ وَ/أوْ زمانيةٌ، بأيَّةِ مثابةٍ «أيديولوجيَّةٍ» موجَّهةٍ كانتْ، لا تعدو أن تكونَ، من حيثُ المبدأُ، شكلاً قميئًا من أشكالِ العنصريةِ الفِطْرِيَّةِ، أو حتى العرقيةِ الحُوشِيَّةِ، في حدِّ ذاتِها. لهذا السببِ، لمْ يَكُنْ هذا الكاتبُ العالميُّ الفذُّ، في حقيقةِ الأمرِ، يكتفي بهكذا تمرُّدٍ لغويٍّ نفسيٍّ محدَّدِ المَعَالِمِ «القوميَّةِ»، كما يُمكنُ أنْ يتراءَى على السَّطْحِ والظهرِ للرَّائي المنتمِي، أو للرَّائي اللامنتمي حتى – فقدْ كانَ هذا الكاتبُ العالميُّ عينُهُ في العُمْقِ والغَوْرِ، قَبْلَئِذٍ، قدْ تمرَّدَ خَائِلاً خَيْلُولةً مَقْصُودَةً على كلِّ «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» Institutionalized Countenance من سيماءَاتِ القوَّةِ، أو السُّلْطَةِ، بالذاتِ، وذلك عَبْرَ تَجْسِيدَاتِها التَّراتُبِيَّةِ السَّائدةِ، ابتداءً من تجسيدِهَا الاجتماعيِّ في العائلةِ (النَّمُوذَجِيَّةِ التقليديةِ)، واهتداءً إلى تجسيدِهَا الدينيِّ في الكنيسةِ (الكاثوليكيةِ، أو حتى البروتستانتيةِ)، ومرُورًا بتجسيدِهَا الثقافيِّ في الأكَادِيمْيَا الهَرَمِيَّةِ الجَوْفَاءِ، وانتهاءً بتجسيدِهَا السياسيِّ في الدَّوْلةِ القوميةِ العَجْفَاءِ.
هكذا، إذنْ، كانتْ نُخْبَةُ المبادئِ التمرُّديةِ، أو النضاليةِ، التي اتَّخذَهَا جويس على المستوى المحلِّيِّ اتِّخاذًا مَسِيريًّا، قبلَ كلِّ شيءٍ، دونَ أنْ يحيدَ عنْ سَبيلِ أيٍّ من هذهِ المبادئِ قَيْدَ شَعْرَةٍ، كما حَادَ الكثيرُ من أسلافِهِ ومعاصريهِ من الكُتّابِ الإيرلنديِّينَ (المحلِّيِّينَ)، على الأخصِّ – هذا فضلاً عنْ حُيُودِ الكثيرِ المُمَاثِلِ مِمَّنْ كانوا يعتبرونَ أنفسَهُمْ أدباءَ أو شعراءَ محلِّيِّينَ، أو حتى «وطنيِّينَ»، ومِمَّنْ قدْ أثبتُوا في مُسْتَهَلِّ الثَّوَرَانِ الشعبيِّ مَدَى انتهازيَّتِهِمْ ومَدَى انهزاميَّتِهِمْ أيَّما إثباتٍ داخلَ هذهِ البلادِ، بلادِ العربِ، الكئيبةِ بالذواتِ. وهكذا، إذنْ، كانتْ صَفْوَةُ المَنَاهِي الثوريةِ، أو الكفاحيةِ، التي اعتمدَهَا جويس على المستوى العالميِّ اعتمادًا مَصِيريًّا، بعدَ كلِّ شيءٍ، دونَ أنْ ينحرفَ عنْ صِرَاطِ أيٍّ من هذهِ المَنَاهِي قَيْدَ أُنْمُلَةٍ كذلك، مثلما انحرفَ العديدُ من أسلافِهِ ومعاصريهِ من الكُتّابِ الأوربيِّينَ غيرِ الإيرلنديِّينَ (العالميِّينَ)، على الأعمِّ – وهذا علاوةً أيضًا على انحرافِ العديدِ المُشَابِهِ مِمَّنْ صَاروا يظنُّونَ أنفسَهُمْ أدباءَ أو شعراءَ عالميِّينَ، أو حتى «كَوْنِيِّينَ»، ومِمَّنْ قدْ برهَنُوا في أعقابِ الثَّوَرَانِ الشعبيِّ ذاكَ مُنْتَهى طائفيَّتِهِمْ ومُنْتَهى عنصريَّتِهِمْ وعرقيَّتِهِم أيَّما بُرهانٍ خارجَ تلك البلادِ، بلادِ العربِ، الكَرِيبةِ بالذواتِ كذلك. فلا غَرْوَ، مِمَّا كانَ مُرْتَقَبًا من تكامُلِ أو من تعاضُدِ هذينِ المستوَيَيْنِ المحلِّيِّ والعالميِّ، أنْ يصُبَّ جويس جَامَ اكْتراثِهِ كلِّهِ (وقدْ كانَ اكتراثًا هُجَاسيًّا عُصابيًّا، ولا ريبَ) على ما يُسمَّى بـ«الإيقاعِ اللَّحْنِيِّ» Melodic Cadence للكَلِمِ إبَّانَ نَظْمِهِ إيَّاهُ في آناءِ الصَّمْتِ وفي أطرافِ الضَّجيجِ، من جانبٍ موازٍ للمستوى (المحلِّيِّ) الأول، وأنْ يصُبَّ جامَ اعتنائِهِ كلِّهِ كذلك على ما يُدْعَى بـ«التكاثُفِ الزَّمَنِيِّ» Temporal Condensation حتى بينَ إيقاعٍ لحنيٍّ وإيقاعٍ لحنيٍّ آخَرَ، بحيثُ إنَّ اللحظةَ الزمنيةَ الوحيدةَ قدْ تكونُ حُبْلى بِحُقْبَةٍ زمنيَّةٍ «لاسياسيَّةٍ» مُؤَيَّسَةٍ بِرُمَّتِهَا (أو، على النَّقيضِ، بِحُقْبَةٍ تاريخيةٍ سياسيَّةٍ أو مُسَيَّسةٍ بِكُلِّيَّتِهَا)، من جانبٍ موازٍ للمستوى (العالميِّ) الثاني – وإنَّ حَدَّ، لا بَلْ حِدَّةَ أو شِدَّةَ، هذا التكامُلِ، أو التعاضُدِ، ما بينَ المستوَيَيْنِ المَعْنِيَّيْنِ هذينِ لَهُمَا اللذانِ يُمَيِّزَانِ جويس، بوصفِهِ قائلاً ذا موهبةٍ موسيقيةٍ لاحِبَةٍ، عنْ أيِّ قائلٍ «لاروائيٍّ» قَدَامَوِيٍّ أو ما قبلَ قَدَامَوِيٍّ في الأدبِ الشِّفَاهيِّ، إنْ جازَ التعبيرُ، فيُمَيِّزَانِهِ (أي جويس) من ثمَّ، بصفتِهِ كاتبًا ذا موهبةٍ كتابيةٍ لا تقلُّ لُحُوبًا، عنْ أيِّ كاتبٍ «روائيٍّ» حَدَاثَوِيٍّ أو ما بعدَ حَدَاثَوِيٍّ في الأدبِ اللاَّشِفَاهيِّ، إنْ جازَ التعبيرُ، كذلك.
وَلِلْحُبِّ الحقيقيِّ (الغَيْريِّ، لا الأنانيِّ)، ها هُنا، إشْرَاقَةٌ وإصْبَاحٌ يتجلَّيَانِ في مَعْمَعَانِ ذينك التمرُّدِ والثَّوَرَانِ، لا مَحَالَ: ففي ذلك اليومِ بالذاتِ على أرضِ الواقعِ، واقعِ دبلنَ المدينةِ الشَّجِينَةِ، في «يَوْمِ بْلُوم» الواقعيِّ الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من العامِ 1904 تحديدًا، كانَ اللقاءُ الغراميُّ الأولُ بينَ الشابِّ الدَّعَّابِ دَعَابَةً «ثقافيَّةً» أو «أدبيةً»، جيمس جويس نفسِهِ، وبينَ حبيبتهِ الشابَّةِ الدَّعَّابَةِ دَعَابَةً «لاثقافيَّةً» أو «لاأدبيةً» (أو حتى «سُوقِيَّةً»)، نورا بارْنَكِلْ، حبيبتهِ التي صَارتْ زوجتَهُ وفقًا لـ«قانُونٍ اجتماعيٍّ» خاصٍّ تَوَخَّيَاهُ فيما بعد، فصَارتْ من ثمَّ رفيقةَ عمرِهِ المستديمةَ أينما حلَّ وأينما نزلَ. وهكذا، دونَما أيِّ سابقِ إيمَاءَةٍ شاهدةٍ واعدةٍ، فقدْ كانَ الكتابُ الخالدُ «يُولِيس» ذاتُهُ بمثابةِ هديةٍ «أدبيةٍ» أو «لاأدبيةٍ» لا تُقَدَّرُ بأيِّمَا ثمنٍ كانَ من الكاتبِ العالميِّ الفذِّ إلى رفيقةِ عمرِهِ ذاتِهَا، وذلك من أجلِ تخليدِ ذلك اليومِ، يومِ لقائِهِمَا الغراميِّ الأولِ، تخليدًا عالميًّا بقدرِ ما كانَ منهجُهُ الكتابيُّ التركيبيُّ والتراكُبيُّ الفريدُ يَصْبُو إليهِ من عالميَّةٍ لا مِرَاءَ فيها – وكان ذاك الاحتفاءُ «الحَفِيُّ» العالميُّ بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا وخارجَها حتى هذا اليومِ، على الرَّغم من أنَّهُ لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، نوعًا مُسْتَحَبًّا من أنواعِ ما يُمْكِنُ أنْ نسمِّيَهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ»، لا شكلاً مُسْتَكْرَهًا، أو أكثرَ حتى، من أشكالِ ما يُمْكِنُ أنْ ندعوَهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ».
ومن قبيلِ التذكيرِ بأُسْلُوبٍ آخَرَ في المَجَازِ والإيجَازِ، قُلْتُ آنِفًا إنَّ الكاتبَ العالميَّ الفذَّ، جيمس جويس، كانَ قدْ ثارَ بعدَ أنْ تمرَّدَ، أيَّامَئِذٍ، على كلِّ شيءٍ يَتَشَيَّأُ من أيِّمَا «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» Institutionalized Countenance من سيماءَاتِ القوَّةِ، أو السُّلْطَةِ، بالذاتِ قدَّامَ عينَيْهِ البَصَرِيَّتَيْنِ والعَقْلِيَّتَيْنِ، في آنٍ معًا، بدءًا من تمرُّدِهِ وثَوَرَانِهِ على ذاتِهِ بالذاتِ، إنِ اعْتَرَاهَا واعْتَوَرَهَا شيءٌ من هذا الصَّعيدِ، على الرَّغْمِ الرَّغِيمِ مِمَّا كانَ يريدُ، أو حتى مِمَّا كانَ لا يريدُ – حتى أنَّهُ، فيما له مِسَاسٌ بموهبتِهِ الموسيقيةِ اللاحِبَةِ، كانَ جويس يُعْرِبُ عنْ تمرُّدِهِ وعنْ ثَوَرَانِهِ هذينِ على امْرِئٍ معيَّنٍ، أو حتى على امرأةٍ معيَّنةٍ، يتجَاهَرَانِ بالتفكُّرِ «الألْمَعِيِّ» وبالتكلُّمِ «اللَّوْذَعِيِّ» تَجَاهُرًا، كانَ يُعْرِبُ عنهُمَا من خلالِ سُلوكٍ «عُصَابِيٍّ» يَحْدُو بِهِ إلى التنغُّمِ الصَّادِي بِنَغَمٍ مَا، أو التغنِّي المُتَصَادِي بأغنيةٍ مَا، وإلى حَدِّ اعتبارِهِ (أي جويسَ ذاتِهِ) كُلَّ الاعتبارِ إنسانًا «مجنونًا» منْ لَدُنْ غريبٍ وَضِيعٍ مَهِينٍ وحَاقِدٍ، أو منْ لَدُنْ قريبٍ لَكِيعٍ ضَنِينٍ وحَاسِدٍ. وهكذا، على مَرِّ الزَّمَانِ وجَرِّ المَكَانِ، سُرْعَانَ ما سَرَى تأثيرُ كُلٍّ مِنْ هذينِ التمرُّدِ والثَّوَرَانِ جائحَيْنِ أيَّمَا جَوْحٍ وجِيَاحَةٍ مَوْضِعَ جويسَ الذي تَمَوْضَعَ فيهِ مِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الاجتماعيِّ» المتمثِّلِ في الأُسْرَةِ (النَّمُوذَجِيَّةِ التقليديةِ)، أولاً، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الدينيِّ» المتجسِّدِ في الكنيسةِ (الكاثوليكيةِ، أو حتى البروتستانتيةِ)، ثانيًا، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الثقافيِّ» المتجسِّمِ في الجامعةِ الهَرَمِيَّةِ الجَوْفَاءِ، ثالثًا، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ السياسيِّ» المُتَبَدِّنِ في الدَّوْلةِ القوميةِ العَجْفَاءِ، رابعًا (وأخيرًا، وليسَ آخِرًا). وَلِلْحُبِّ الحقيقيِّ (الغَيْريِّ، لا الأنانيِّ) فوقَ كلِّ ذلك، هَا هُنا، إشْرَاقَةٌ وإصْبَاحٌ يتجلَّيَانِ في مَعْمَعَانِ ذينك التمرُّدِ والثَّوَرَانِ كِلَيْهِمَا، لا مَحَالَ: ففي ذلك اليومِ المعنيِّ بالذاتِ على أرضِ الواقعِ، واقعِ دبلنَ المدينةِ الشَّجِينَةِ، في «يَوْمِ بْلُوم» الواقعيِّ الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من العامِ 1904 تحديدًا، كانَ ذاك اللقاءُ الغراميُّ الأولُ بينَ ذلك الشابِّ الدَّعَّابِ دَعَابَةً «ثقافيَّةً» أو «أدبيةً»، جيمس جويس، وبينَ حبيبتهِ الشابَّةِ الدَّعَّابَةِ دَعَابَةً «لاثقافيَّةً» أو «لاأدبيةً» (أو حتى «سُوقِيَّةً»)، نورا بارْنَكِلْ، حبيبتهِ تلك التي صَارتْ «زوجتَهُ» وفاقًا لـ«قانُونٍ اجتماعيٍّ» خاصٍّ تَوَخَّيَاهُ فيمَا بَعْدُ، فصَارتْ مِنْ ثمَّ رفيقةَ عمرِهِ المستديمةَ أينما حلَّ وأينما نزلَ. وهكذا أيضًا، دونَما أيِّ سَابقِ إيمَاءَةٍ شاهدةٍ أو واعدةٍ، فقدْ كانَ الكتابُ الخالدُ «يُولِيس» Ulysses ذاتُهُ بمثابةِ هديةٍ «أدبيةٍ»، أو «لاأدبيةٍ»، لا تُقَدَّرُ بأيِّمَا ثمنٍ كانَ من الكاتبِ العالميِّ الفذِّ ذاتِهِ إلى رفيقةِ عمرِهِ الفذَّةِ ذاتِهَا، وذلك من أجلِ تخليدِ ذلك اليومِ، يومِ لقائِهِمَا الغراميِّ الأولِ، تخليدًا عالميًّا بقدرِ مَا كانَ منهجُهُ الكتابيُّ التركيبيُّ والتراكُبيُّ الفريدُ يَصْبُو إليهِ مِنْ عالميَّةٍ (أو، بالقَمِينِ، مِنْ كَوْنِيَّةٍ) لا مِرَاءَ فيها – وكان ذاك الاحتفاءُ «الحَفِيُّ» العالميُّ بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا وخارجَها حتى هذا اليومِ، على الرَّغم مِنْ أنَّهُ لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، نوعًا مُسْتَحَبًّا مِنْ أنواعِ مَا يُمْكِنُ أنْ نسمِّيَهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ»، لا شكلاً مُسْتَكْرَهًا، أو أكثرَ حتى، من أشكالِ ما يُمْكِنُ أنْ ندعوَهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ».
من هنا، ليسَ ثَمَّةَ من شاردةٍ ولا من واردةٍ، في ثنايا كتابِ جويس «يُولِيس»، لمْ تَكُنْ مُسْتَلْهَمَةً بالفعلِ اسْتِلْهَامًا واعيًا، ولا حتى مُسْتَوْحَاةً بالقوةِ اسْتيحَاءً لاواعيًا، مِمَّا جرى، أو حتى مِمَّا لمْ يَجْرِ، في أطرافِ ذلك اليومِ، يومِ اللقاءِ الغراميِّ الأولِ بينَ الكاتبِ المنقطعِ النَّظيرِ وبينَ حبيبتِهِ الغريبةِ الأطوارِ (ومن ثمَّ تجوالِهِمَا الهُياميِّ في بِضْعَةٍ من أحياءِ دبلنَ المدينةِ)، من مُحَادثاتٍ أو أحداثٍ «رئيسيةٍ»، أو من مُشَاهداتٍ أو أشهادٍ «فرعيةٍ»، أو حتى من مُهَامَسَاتٍ أو أهْمَاسٍ «جانبيةٍ» أو «هامشيةٍ» تكادُ ألاَّ تستأهلَ الذِّكْرَ بأيَّتِمَا مَثابةٍ كانتْ. ويُمْكِنُ، بادئَ ذِي بَدْءٍ، لِمَنْ تسْتقرِئُ مَا جَاءَ في فَحْوَى «سِيرَةِ» الكاتبِ من سُطورِ الواقعِ، ومَا جاءَ في فَحْواءِ كتابِ «يُولِيس» من سُطورِ الخيالِ، استقراءً متوازيًا أو متوازنًا بعضَ الشيءِ، يُمْكِنُ لَهَا عندئذٍ أنْ تدركَ حقَّ الإدراكِ مدى التطابُقِ العَفْويِّ (أو حتى اللاعَفْويِّ) اللافتِ بينَ ذلك المَسَارِ الذي سَارَ عليهِ الشَّابُّ المُتَوَلِّهُ جيمس جويس أثناءَ لقائِهِ الغراميِّ بالشَّابَّةِ المُتَوَلَّهِ بِهَا نورا بارْنَكِلْ، وأثناءَ تجوالِهِ المنشُودِ والمشدُودِ في مَعِيِّتِهَا في تلك الأحياءِ، من جانبٍ، وبينَ ذلك «المَصَارِ» الذي صَارَ إليهِ الرجلُ المُتَبَصِّرُ لِيُوبُولْد بْلُوم إبَّانَ لقائِهِ الحَميميِّ باليافعِ المُتَبَصَّرِ بِهِ سْتِيفِن ديدالوس، وإبَّانَ تجوالِهِ المَسْرُودِ والمَرْصُودِ في مَعِيِّتِهِ في تلك الأحياءِ ذَوَاتِهَا، من جانبٍ آخَرَ – وفي كلٍّ من هذين اللقائَيْنِ المتقابلَيْنِ، في نهايةِ اللقاءِ، يعودُ كلٌّ من المُلْتَقِي والمُلْتَقَى بِهِ إلى بيتِهِ سَارِحًا بأفكارٍ كانتْ قدْ تولَّدتْ من تفاعُلِهِ وانفعالِهِ المعقولَيْنِ (أو حتى اللامعقولَيْنِ) الناجِمَينِ عَمَّا أبدَاهُ الآخَرُ منْ أفكارِ أُخرى، بنحوٍ أو بآخَرَ. حتى أنَّ مرورَ بلوم وديدالوس مرورًا تعاقُبيًّا بمَبْغَى الخليلةِ بيللا كوهين في الفصلِ الخامسَ عَشَرَ من كتابِ «يُولِيس» المُسَمَّى بِـ«سِيرْسِهْ» Circe، ذلك الفصلِ المكتوبِ بأُسْلوبِ حوارٍ مَسْرَحِيٍّ قائمٍ بذاتِهِ (ولِذَاتِه) رغمَ تخلُّلِ «اهْتِلاسَاتِ» كلٍّ من بلوم وديدالوس حَبْكَتَهُ القَصِّيَّةَ حينًا بعدَ حينٍ، حتى أنَّ مرورَهُمَا (التعاقُبيَّ) بهذا المَبْغَى جسدَيْنِ ذَكَرِيَّيْنِ «مُتَهَيِّجَيْنِ» عَسَى جسدٌ أنثويٌّ أنْ يُفْرِغَ «شُحْنَتَيْهِمَا» فيه، في «الحرفِ» أو حتى في «المجازِ»، إنَّما تتجذَّرُ جُذُورُهُ في حَنايا ذلك اللقاءِ الغراميِّ الأولِ بينَ العاشِقِ جيمس جويس وعشيقتِهِ نورا بارْنَكِلْ بالذات. فلمْ يَكُنْ ذلك اللقاءُ، في واقعِ الأمرِ، لقاءً «غراميًّا» بالمعنى التقليديِّ السَّائِدِ آنئذٍ، كَجَرْيِهِ مثلاً على عاداتِ تبادُلِ النَّظَرَاتِ واللَّمْسَاتِ والقُبُلاتِ الرومانسيةِ الخفيفةِ، بلْ كانَ لقاءً حَافلاً بالمغامرةِ الغراميةِ التي خَرَقَتْ كافَّةَ الأعْرافِ والتقاليدِ وآدابِ التَّلاقي مَا بينَ الحبيبَيْنِ: إذْ تجلَّتْ هذهِ المغامرةُ الغراميَّةُ في شخصيةِ نورا بارْنَكِلْ نفسِهَا أيَّمَا تَجَلٍّ، وذلك من جَرَّاءِ شجاعتِهَا وجَرَاءَتِهَا التَّلْقَائيَّتَيْنِ الخارقتَيْنِ للمألوفِ بالفعلِ، وإلى حَدِّ أنَّهَا، عندما مَرَّتْ وجويسَ أثناءَ تجوالِهِمَا في حيِّ رِينْغْزَنْدْ Ringsend الدبلنيِّ بجمهرةٍ من النساءِ المتبرِّجَاتِ اللواتي كُنَّ يكشفنَ عن «إمكانيَّاتِهِنَّ البارزةِ»، وعندما لاحظتْ «تهيُّجَ» جويسَ نفسِهِ و«لهاثَهُ» و«انتصابَهُ» الواضحَيْنِ من أثرِ ذلك المُرورِ، تَنَحَّتْ بِهِ مَحَلاًّ منعزلاً على شاطئِ البحرِ وأخذتْ «تَسْتَمْنِيهِ بيدِهَا»، دونَمَا تردُّدٍ أو تلكُّؤٍ، إلى أنْ وصلَ إلى رعشةٍ عَارِمَةٍ لم يصلْ إلى مثيلتِهَا منْ قبلُ.
هكذا شَجَاعةٌ وهكذا جَرَاءَةٌ «أُنْثَوِيَّتَانِ» تَلْقَائِيَّتَانِ خَارِقتَانِ للمألوفِ، إذنْ، ليسَ لهُمَا سِوى أنْ تجْعَلا الشَّابَّ جيمس جويس يقعُ وُقُوعًا، بكلِّ جَوارحِهِ، في حُبِّ الشَّابَّةِ نورا بارْنَكِلْ منذُ ذلك اللقاءِ الغراميِّ الأولِ. وهكذا شَجَاعةٌ وهكذا جَرَاءَةٌ «أُنْثَوِيَّتَانِ»، كذلك، ليسَ لهُمَا سِوى أنْ تجْعَلا هذا الشَّابَّ ذاتَهُ عَازِمًا عزمًا وعزيمةً، بكلِّ جَوانحِهِ، على إهداءِ هذهِ الشَّابَّةِ ذاتِهَا الكتابَ «المردودَ» واللامردودَ «يُولِيس» لكيما يخلِّدَ تاريخَ وقائعِ تجوالِهِمَا الهُياميِّ «المعهودِ» واللامعهودِ إلى أبدِ الآبدينَ – خصوصًا وأنهُ الكاتبُ الفريدُ الذي ثارَ كلَّ الثَّوَرَانِ بعدَ أنْ تمرَّدَ كلَّ التَّمَرُّدِ، أيَّامَئِذٍ، على كلِّ شيءٍ يَتَشَيَّأُ من أيِّمَا «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» قدَّامَ عينًيْهِ البَصَرِيَّتَيْنِ والعَقْلِيَّتَيْنِ، في آنٍ معًا، بدءًا من تمرُّدِهِ وثَوَرَانِهِ على ذاتِهِ بالذاتِ، كما تمَّ ذِكْرُهُ آنِفًا. فقدْ كانَ هذا الكاتبُ الفريدُ يؤمنُ إيمانًا حَازمًا وإيمانًا حَاسمًا (حتى أشدَّ حَزَامَةً وأشدَّ حَسَامَةً من إيمانِ الكاتبِ الروائيِّ الإنكليزيِّ ديفيد هيرْبِرْت لورَنْس، وهو الكاتبُ المبدئيُّ المعروفُ بإيمانِهِ العميقِ بـ«فلسفةٍ للجَسَدِ» خاصَّةٍ بِهِ)، بأنَّ حُرِّيَّةَ الإنسانِ الحَقَّ والحَقِيقَ، على كلٍّ من المستوى النفسيِّ والمستوى الاجتماعيِّ، من طرفٍ، وعلى المستوى السياسيِّ عَبْرَ كلٍّ من ذينك المستويَيْنِ الأوَّلَيْنِ، من طرفٍ آخَرَ، إنَّما تبدأُ بَدْءًا حَازمًا وبَدْءًا حَاسمًا بحُرِّيَّةِ الجَسَدِ، قبلَ حُرِّيَّةِ أيِّ شيءٍ آخَرَ: تلك هي الفلسفةُ الحَقُّ، «فلسفةُ الجَسَدِ» الحَقيقُ، التي تتحدَّى مداهمةَ الموتِ سَائرةً عكسَ التيَّارِ المُهَيْمِنِ شكلاً ومضمونًا، والتي تتشوَّفُ من ثمَّ إلى فاعليَّاتِ الرفضِ والعنادِ والتَّصَاوُلِ واللاتَصَالُح، على حَدِّ عباراتِ الناقدِ الأدبيِّ الفذِّ إدوارد سعيد. وتلك هي الفلسفةُ الحَقُّ، «فلسفةُ الجَسَدِ» الحَقيقُ، التي فَهِمَتْهَا الحَبيبةُ الاِستثنائيَّةُ نورا بارْنَكِلْ من حَبيبِهَا الاِستثنائيِّ جيمس جويس شكلاً ومضمونًا، على الوتيرةِ ذاتِهَا، كما «تفهمُ الحَبيباتُ اللَّبيبَاتُ من مَحْضِ الإشَارةِ»! فليسَ من أمْرٍ عَجَبٍ، إذنْ، أنْ يتبدَّى الرجلُ المُتَبَصِّرُ لِيُوبُولْد بْلُوم ذاتُهُ، بكُلِّيَّةِ حُضُورِهِ الواقعيِّ و/أوِ الخَيَاليِّ في ثنايَا الكتابِ، كتابِ «يُولِيس» بالذاتِ، ليسَ عَجَبًا أنْ يتبدَّى على هيئةِ «مُمَثِّلٍ» (أو، بالخَليقِ، «سَفِيرٍ») كونِيٍّ نموذجيٍّ لـ«فلسفةِ الجَسَدِ» هذهِ قولاً وفعلاً، وإلى حَدِّ النظرِ الوَكِيدِ إلى هذا الكتابِ بوصفهِ «ملحمةَ الجَسَدِ»، في حَدِّ ذاتِهَا، تلك الملحمةَ العَوِيصَةَ التي تصوِّرُ تَصْوِيرًا لُغَوِيًّا عُصَابِيًّا تَجْوَالَ هذا «المُمَثِّلِ»، أو «السَّفِيرِ»، الكونِيِّ باحِثًا عن ضَالَّتِهِ المنشودةِ، في وَضَحِ النَّهَارِ، وفي جُلِّ هذا النَّهَارِ.
وبمَا أنَّ هكذا «مُمَثِّلاً»، أو «سَّفِيرًا»، كونِيًّا، لِيُوبُولْد بْلُوم ذاتَهُ، يتمثَّلُ في كتابِ «يُولِيس» بالذاتِ على اعتبارِهِ مُواطِنًا مَجَرِيًّا-إيرلنديًّا «يهوديًّا» مُهَاجِرًا لاسِيَاسيًّا، و/أو لاجِئًا سِيَاسيًّا، إلى أرْحَابِ جمهوريةِ إيرلندا «الحِيَادِيَّةِ»، في أعقابِ وَيْلاتِ الحربِ العالميةِ الأولى WWI، فإنَّ ثَمَّةَ الكثيرَ الكثيرَ من أولئكَ «القوميِّينَ» المتطرِّفينَ والمتعنِّتينَ المعروفينَ ميثَاقًا بالولاءِ الطَّلِيسِ والأعمى لمبادِئِ ومَنَاهِي مَا يُسَمَّى بـ«المنظَّمةِ الصُّهيونيةِ العالمية» WZO، التي نشأتْ قبلَ تلك الحربِ بحوالَيْ عقدَيْنِ من الزمانِ، يعمِدُونَ بكلِّ ما أُوتُوا من «تنويراتِ» تلك «المعرفةِ الأدبيةِ النقديةِ» التخرُّصِيَّةِ إلى استغلالِ فَحْوَى ذلك التَّجْوالِ الذي قامَ بِهِ هكذا «مُمَثِّلٌ»، أو «سَّفِيرٌ»، كونِيٌّ باحِثًا حَاثًّا عن ضَالَّتِهِ المنشودةِ، والذي حَدَا بِهِ كلَّ الحَدْوِ عائدًا جَادًّا إلى «عُقْرِ دَارِهِ» في آخِرِ المَطافِ، فيعمِدُونَ دائبينَ من ثمَّ إلى تأويلِ زمنِ ذلك التَّجْوالِ عَيْنِ عينِهِ تأويلاً تلفيقيًّا مُفَبْرَكًا على أنَّهُ رمزٌ لزمنِ التِّيهِ، تِيهِ «اليهوديِّ التَّائِهِ» Wandering Jew (حسبَ تعريبِهِ القرآنيِّ، كما جَاءَ في الآيةِ المَائِدِيَّةِ، نحوَ: «يَتِيهُونَ في الأَرْضِ [أَرْبَعِينَ سَنَةً]» (المائدة: 26)، لا حسبَ تعريبِهِ التُّرْجُمَانِيِّ، نحوَ: «اليهوديِّ الضَّالِّ»، وما شَابهَ ذلك، كما يحسبُ البعضُ من المترجمينَ والنُّقَّادِ الأدبيِّينَ العربِ): إذْ يُنْظَرُ إلى هذا «اليهوديِّ التَّائِهِ» نَظَرًا سياسيًّا ذَرَائِعِيًّا لاأخلاقيًّا مَحْضًا، وبالاستنادِ «التوفيقيِّ» المُحَنَّكِ إلى ذلك التأويلِ التلفيقيِّ المُفَبْرَكِ، يُنْظَرُ إليهِ بصفتِهِ «يهوديًّا تَائِهًا» لا بُدَّ لهُ من أنْ يعودَ إلى «وطنِهِ الأُمِّ» إسرائيلَ، شاءَ أيٌّ من أولئك «الحُسَّادُ» و«الضُّغَّانُ» من أولئك «العربِ» و«العربانِ» ومن غيرهم، أمْ أبَوْا – رغمَ أنَّ هذهِ الـ«إسرائيلَ» مُخْتَلَقَةٌ، في السِّرِّ، اختلاقًا استعماريًّا جَائِرًا، ورغمَ أنَّ هذهِ الـ«إسرائيلَ» مُصْطَنَعَةٌ كذلك، في الجَهْرِ، اصطناعًا إمبرياليًّا سَافرًا، وعلى غِرارِ ما يصطلحُ عليهِ إدوارد سعيد بأحَابيلِ «الجغرافيا الخياليةِ»، في كتابِهِ «الاستشراقُ» الغنيِّ عنِ التعريفِ، تلك الأحَابيلِ الدنيئةِ والدَّنِيَّةِ التي لا يلجأُ إليها إلاَّ مَنْ هُمْ في حَضِيضِ الحَضِيضِ أدنى مرتبةً بكثيرٍ وكثيرٍ من مرتبةِ «الحَيَوانِ المَريضِ»! غيرَ أنَّ جيمس جويس لمْ يكنْ هناك لِكَيْمَا يَتْرُكَ «التأويلَ» ذاك سَائبًا لِمَنْ كانوا، ومَا زالوا، يُصِرُّونَ إصْرَارَ الجَهُولِ على تطرُّفهِمْ وتعنُّتِهِمْ مِنْ أولئك الصَّهَاينةِ الأخَاسِسِ والأخَاسِئِ طُرًّا، ولا لكيْ يَتْرُكَهُ سَائبًا أيضًا لِمَنْ كانوا، ومَا زالوا، على شَاكلتِهِمْ أنَّى تواجَدُوا في هذا العالَمِ اليقينيِّ مِنْ بعدِ ذلك «التِّيهِ الأربعينيِّ» الذي حُمِّلَ مَا لا يحملُ مِنْ تأصيلٍ ومِنْ «تأثِيلٍ»، بَتَّةً، منذُ ذلك الحينِ. حتى الرسولُ محمدٌ جاءَ ذِكْرُهُ في كتابِ «يُولِيس» ذِكْرًا لا يُمْكِنُ للقارئةِ والقارئِ النَّبيهَيْنِ أنْ يظُنَّاهُ ذِكْرًا «عابرًا» على طريقةِ مَنْ كانَ يحلمُ أحلامَ الليلِ، أو حتى أحلامَ النَّهارِ، مُرْتَقِبًا مرحلةَ انْمِحَاءِ مَا تَحتويهِ مِنْ فَحْواءَ (أو مِنْ فَحَاوٍ) مِنْ على صَفَحَاتِ الذِّهْنِ الحَلُومِ إلى غيرِ رجعةٍ. لقد جاءَ ذِكْرُ الرسولِ محمدٍ، والحَالُ هذهِ، على طريقةِ مَنْ كانَ يتأمَّلُ في دَخيلةِ نفسِهِ تأمُّلاً عميقًا أيَّمَا عَمَاقَةٍ، في اليَقَاظِ لا في المَنَامِ، تأمُّلاً تتجلَّى إرهاصَاتُهُ في تداعياتِ تَيَّارٍ ذهنيٍّ تَسَاؤُلِيٍّ، من حيثُ البناءُ، سُمِّيَ بعدئذٍ بـ«تَيَّارِ الوَعْيِ» Stream of Consciousness: إذْ تستحضرُ تلك التداعياتُ إنسانيةَ الرسولِ محمدٍ حينما تُثيرُ دهشةً وذُهُولاً غيرَ عاديَّيْنِ من خلالِ تلميحٍ جليلٍ إلى رفقهِ اللافتِ بالحَيَوانِ (إلى قصَّتهِ الشهيرةِ معَ تلك القطةِ التي نامتْ على أذيالِ عباءتهِ، سَاعةَ كانَ يخطبُ في «الأُمَّةِ» سَاعاتٍ وسَاعاتٍ)، ومن خلالِ تلميحٍ أجَلَّ، لا بلْ أشدَّ جَلالاً، إلى تألُّمهِ الشديدِ على حَالِ البائسينَ وأحوالِ المعذَّبينَ في الأرضِ.
يبقى، في الأخيرِ، مَا دعَوْناهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ»، تسْييسِ ذاك الاِحتفاءِ «الحَفِيِّ» المحلِّيِّ، حتى قبلَ العالميِّ، بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا البَلَدِ «العَتِيدِ»، ومنْ لَدُنْ سَاسَةِ هذهِ الـ«إيرلندا»، على وجهِ التحديدِ، ذلك «اليومِ» الذي لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، ما سمَّيْناهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ». بجليِّ الكلامِ، هَا هُنا، هكذا احتفاءٌ «حَفِيٌّ» تظاهُريٌّ مزعُومٌ بيومٍ أدبيٍّ متخَيَّلٍ تخيُّلاً فَنِّيًّا مَحْضًا لا يُمْكِنُ اعتبارُهُ، في حقيقةِ الأمرِ، «بُرْهانًا سَاطعًا على سَطْوَةِ الأدبِ وسُلْطَةِ المخيِّلةِ»، كما يَخَالُ قائلُ هذا الكلامِ، صبحي حديدي، بِخَوْلِهِ منفعلاً ومنطلقًا من نقطةِ انطلاقٍ «نقديةٍ أدبيةٍ» تعميميَّةٍ إلى حدِّ السَّذاجةِ، بلْ ينبغي اعتبارُهُ، على نقيضِ الأمرِ، برهانًا أشدَّ سُطوعًا على نفاقِ سَاسَةِ هذهِ الـ«إيرلندا» السَّافرِ أيَّمَا سُفُورٍ، وعلى تدْجِيلِ هؤلاءِ السَّاسَةِ الفاضحِ أيَّمَا فُضُوحٍ، هؤلاءِ السَّاسَةِ الذينَ صَارُوا، من جهةٍ، يُدِرُّونَ الأموالَ الخياليةَ من جَرَّاءِ رَعْيِهِمْ لهكذا احتفاءٍ رَعْيًا «وَفِيًّا» و«مُخْلِصًا» في ذلك «اليومِ» من كلِّ عامٍ، والذينَ كانوا، من جهةٍ أُخرى، يمارسُونَ كلَّ أنواعِ القمعِ والقسرِ والاضطهادِ بحقِّ كاتبٍ مبدعٍ إبداعًا أدبيًّا وفَنِّيًّا متفرِّدًا في كلِّ شيءٍ، كاتبٍ عاشَ جُلَّ حياتهِ بعيدًا عن مَسْقِطِ رأسهِ، دبلن، ولكنَّهُ لمْ يكتبْ في سيرتهِ «الكِتابيَّةِ» كلِّها سِوَى عن دبلن، لكيمَا تكونَ «مدينةَ المدائنِ» في تاريخِ الأدبِ العالميِّ الحديثِ وما بعدَ الحديثِ.
غياث المرزوق
دبلن، 19 آب 2018
لَثَوْرَةٌ دَائِمَةٌ عَلى حِذْقِيَّةِ ٱلرَّاقِعِ، ثَوْرَةٌ دَائِمَةٌ عَلى فِعْلِيَّةِ ٱلوَاقِعِ!
جيمس جويس
أذكُرُ جيدًا كذلك أنَّ صَدِيقًا قريبًا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُهُ على المَلأِ الأدْنَى كانَ قدْ ردَّ بتعقيبٍ نقديٍّ يَسْتَجْلِبُ الاهتمامَ كلَّهُ، فعلاً، على مقالِ صبحي حديدي «يومُ ليوبولد بلوم العجائبيُّ» (القدس العربي، 19 حزيران 2017) – وهو المقالُ الأخيرُ الذي يُعِيدُ بنَحْوٍ أو بآخَرَ كتابةَ كُلٍّ من مقالَيْهِ الآخَرَيْنِ، على الترتيبِ: المقالِ الآنِفِ «صورةُ جيمس جويس في شبابِهِ» (القدس العربي، 20 حزيران 2016) والمقالِ الآنَفِ «ألغازُ جويس وسُلْطَةُ المُخَيِّلَةِ» (القدس العربي، 14 حزيران 2015). فقدْ جاءتْ هذهِ المقالاتُ في أحْيَانِهَا تِبَاعًا حَوْلِيًّا، مثلما هو مألوفٌ في أدبِ، أو آدابِ، الكتابةِ النقديةِ وغيرِ النقديةِ، على حَدٍّ سِوًى، فقدْ جاءتِ احتفاءً أدبيًّا (وَوَاجِبِيًّا، كذلك) بالذكرى السَّنويةِ لِمَا يُسَمَّى محليًّا داخلَ إيرلندا وعالميًّا خارجَها بـ«يَوْمِ بْلُوم» الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من كلِّ عامٍ، ذلك اليومِ الذي تجري فيهِ «مَيْمَنَاتُ» الأحداثِ الظاهريةِ، جَهْرًا، و«مَشْأَمَاتُ» الأجداثِ الباطنيةِ، سِرًّا، في رائعةِ جيمس جويس «يُولِيس» Ulysses بالذاتِ (أو «عُولِيس»، كما يعرِّبُهَا اِسميًّا بعضٌ من المترجمينَ والنقَّادِ الأدبيِّينَ العربِ). ففي هذهِ الرائعةِ المتعدِّدةِ الوُجُوهِ والأقنعةِ، يتبدَّى ذلك اليومُ، والحالُ هذهِ، على اعتبارِهِ أطولَ يومٍ فَنِّيٍّ مُتَخَيَّلٍ في تاريخِ الأدبِ (الروائيِّ أو، بالحَرِيِّ، اللاروائيِّ) المكتوبِ باللغةِ الإنكليزيةِ، إنْ لمْ نقُلْ «والمكتوبِ بغيرِ اللغةِ الإنكليزيةِ»، قاطبةً. وقدْ رِيمَتْ، مَا بينَ هَزْلٍ وجِدٍّ، كتابةُ «يَوْمُ بْلُوم» Bloomsday (أو «يَوْمُبْلُوم»، نَقْحَرَةً) كتابةً لاتينيَّةً على شاكلتِها التكثيفيةِ الحَالِيَّةِ بما يُوحِي رَسْمًا ووَقْعًا إنكليزيَّيْنِ إِيحَاءً ليسَ إلاَّ، وذلك احتذاءً واقتداءً بالثورةِ اللغويةِ النفسيةِ الفريدةِ التي شنَّها جيمس جويس ذاتُهُ، من خلالِ ما انتهجَهُ من منهجٍ كتابيٍّ تركيبيٍّ وتراكُبيٍّ فريدٍ، شنًّا «حرفيًّا» وشنًّا «مجازيًّا» على بنيانِ اللغةِ الإنكليزيةِ ذاتِها، بوصفِها لغةً استعماريةً وإمبرياليةً في الصَّميمِ، وبصفتِهَا من ثمَّ لغةً عنصريةً وعِرْقِيَّةً في صَميمِ الصَّميمِ: إذْ كُتِبتْ هذهِ الكتابةُ عمدًا مُتَعَمَّدًا على خلافِ ما يُكتبُ عادةً حَسْبَمَا هوُ موروثٌ ومُتَوَارَثٌ لِسَانيًّا، جيلاً بعدَ جيلٍ، في منظُومةِ هذهِ اللغةِ اللَّدَائِنيَّةِ نَحْوًا وصَرْفًا (أيْ «يَوْمُ بْلُوم» Bloom’s Day، على وجهِ الضَّبْطِ)، كما يتوقَّعُ في الرَّسْمِ وَ/أوِ في الوَقْعِ لِسَانُ الناطقِ الإنكليزيِّ السَّلِيقِيِّ، أو حتى لِسَانُ الناطقِ الإنكليزيِّ اللاسَلِيقِيِّ. تلك، إذنْ، كانتْ ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً، حقًّا، بالمعنيَيْنِ السياسيِّ القريبِ والسياسيِّ البعيدِ كلَيْهِمَا، شاءَ المُسْتَعْبِدُونِ «المُسَيَّدُونَ» مِنْ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمِرِ الإنكليزيِّ، ومَنْ تملَّقَهُمْ (وإليهِمْ) ومَنْ دَاهَنَهُمْ ودَالَسَهُمْ (ولُهُمْ) وإلى حَدِّ التَّوَاطُؤِ الوَضِيعِ واللَّكِيعِ مِنَ المُسْتَعْبَدِينِ «المُسَيِّدِينَ» مِنْ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمَرِ الإيرلنديِّ ذَوَاتِهِمْ، أمْ أَبَوْا.
لقدَ كانتْ تلك ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً بالمعنى السياسيِّ القريبِ، من طرفٍ، لأنَّ جويس لمْ يَكُنْ يُريدُ في طَوِيَّتِهِ، منذُ البَدْءِ، أنْ تتمخَّضَ رائعتُهُ «يُولِيس» عن عملٍ روائيٍّ بأيِّ نوعٍ من أنواعِهِ الفَنِّيَّةِ المعروفةِ في العالَمِ بأسرهِ، مثلما يَخَالُهَا العديدُ من النقَّادِ الأدبيِّينَ في بلادِ الغَرْبِ (حتى قبلَ أنْ يَخَالَهَا مثلَهُمُ العديدُ من النقَّادِ الأدبيِّينَ في بلادِ العَرَبِ)، بلْ كانَ يَرُومُ في صَرِيمَتِهِ أنْ تُسْفِرَ هذهِ الرائعةُ الاستثنائيةُ عنْ عملٍ كتابيٍّ (لاروائيٍّ) تتجلَّى فيهِ تجلِّيًا أجناسُ الكتابةِ كلُّها، وتتجلَّى فيهِ تجلِّيًا أكثرَ ما تحملُهُ هذهِ الأجناسُ بينَ طيَّاتِها من جَمَائِلَ أو قَبَائِحَ أو بينَ بينَ. كانَ يقضي يومًا بأكملِهِ، أو يزيدُ، دُونَمَا كَلَلٍ أو مَلَلٍ أو هَوَادةٍ حتى على المَأْتَاةِ ببَحْتِ جُمْلةٍ يَتِيمَةٍ، أو بمَحْضِ عبارةٍ لَطِيمَةٍ، تُحْبِرُ، في الحيِّزِ الأولِ، ذائقتَهُ المُوسِيقِيَّةَ من كلِّ جهةٍ ذاتيةٍ أو حتى موضوعيةٍ، وتسعى من ثمَّ، في الحيِّزِ الثاني، إلى إحْبَارِ الذائقاتِ المُوسِيقِيَّةِ النظيرةِ عندَ صِنْوانِهِ الظِّمَاءِ من الإيرلنديِّينَ والإيرلنديَّاتِ، أيَّةً كانتْ خلفيَّاتُهُمُ الثقافيةُ أو حتى «اللاثقافيةُ»، وتسعى، في المقابلِ، في الحيِّزِ الأخيرِ، إلى خَدْشِ أسْمَاعِ زَبَانِيَةِ المُسْتَعْمِرِ الإنكليزيِّ خاصَّةً، وإلى نَفْخِ أوْدَاجِهِمْ وإيغَارِ صُدُورِهِمْ أينما كانوا، وإلى تنغيصِ حَيَوَاتِهِمْ وتذكيرِهِمْ على الدوامِ بما ارتكبوهُ من شُرُورٍ وآثامٍ بإزاءِ بناتِ وأبناءِ هذهِ «الأمَّةِ» السِّلْتِيَّةِ الإيرلنديةِ، أو حتى الاسكتلنديةِ. وقدَ كانتْ تلك ثورةً لغويةً نفسيةً فريدةً بالمعنى السياسيِّ البعيدِ، من طرفٍ آخَرَ، لأنَّ جويس كانَ يعلمُ علمَ اليقينِ بأنَّ أيَّةَ نزعةٍ «قوميَّةٍ» تُؤَطِّرُهَا عَنْوَةً أُطُرٌ مكانيةٌ وَ/أوْ زمانيةٌ، بأيَّةِ مثابةٍ «أيديولوجيَّةٍ» موجَّهةٍ كانتْ، لا تعدو أن تكونَ، من حيثُ المبدأُ، شكلاً قميئًا من أشكالِ العنصريةِ الفِطْرِيَّةِ، أو حتى العرقيةِ الحُوشِيَّةِ، في حدِّ ذاتِها. لهذا السببِ، لمْ يَكُنْ هذا الكاتبُ العالميُّ الفذُّ، في حقيقةِ الأمرِ، يكتفي بهكذا تمرُّدٍ لغويٍّ نفسيٍّ محدَّدِ المَعَالِمِ «القوميَّةِ»، كما يُمكنُ أنْ يتراءَى على السَّطْحِ والظهرِ للرَّائي المنتمِي، أو للرَّائي اللامنتمي حتى – فقدْ كانَ هذا الكاتبُ العالميُّ عينُهُ في العُمْقِ والغَوْرِ، قَبْلَئِذٍ، قدْ تمرَّدَ خَائِلاً خَيْلُولةً مَقْصُودَةً على كلِّ «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» Institutionalized Countenance من سيماءَاتِ القوَّةِ، أو السُّلْطَةِ، بالذاتِ، وذلك عَبْرَ تَجْسِيدَاتِها التَّراتُبِيَّةِ السَّائدةِ، ابتداءً من تجسيدِهَا الاجتماعيِّ في العائلةِ (النَّمُوذَجِيَّةِ التقليديةِ)، واهتداءً إلى تجسيدِهَا الدينيِّ في الكنيسةِ (الكاثوليكيةِ، أو حتى البروتستانتيةِ)، ومرُورًا بتجسيدِهَا الثقافيِّ في الأكَادِيمْيَا الهَرَمِيَّةِ الجَوْفَاءِ، وانتهاءً بتجسيدِهَا السياسيِّ في الدَّوْلةِ القوميةِ العَجْفَاءِ.
هكذا، إذنْ، كانتْ نُخْبَةُ المبادئِ التمرُّديةِ، أو النضاليةِ، التي اتَّخذَهَا جويس على المستوى المحلِّيِّ اتِّخاذًا مَسِيريًّا، قبلَ كلِّ شيءٍ، دونَ أنْ يحيدَ عنْ سَبيلِ أيٍّ من هذهِ المبادئِ قَيْدَ شَعْرَةٍ، كما حَادَ الكثيرُ من أسلافِهِ ومعاصريهِ من الكُتّابِ الإيرلنديِّينَ (المحلِّيِّينَ)، على الأخصِّ – هذا فضلاً عنْ حُيُودِ الكثيرِ المُمَاثِلِ مِمَّنْ كانوا يعتبرونَ أنفسَهُمْ أدباءَ أو شعراءَ محلِّيِّينَ، أو حتى «وطنيِّينَ»، ومِمَّنْ قدْ أثبتُوا في مُسْتَهَلِّ الثَّوَرَانِ الشعبيِّ مَدَى انتهازيَّتِهِمْ ومَدَى انهزاميَّتِهِمْ أيَّما إثباتٍ داخلَ هذهِ البلادِ، بلادِ العربِ، الكئيبةِ بالذواتِ. وهكذا، إذنْ، كانتْ صَفْوَةُ المَنَاهِي الثوريةِ، أو الكفاحيةِ، التي اعتمدَهَا جويس على المستوى العالميِّ اعتمادًا مَصِيريًّا، بعدَ كلِّ شيءٍ، دونَ أنْ ينحرفَ عنْ صِرَاطِ أيٍّ من هذهِ المَنَاهِي قَيْدَ أُنْمُلَةٍ كذلك، مثلما انحرفَ العديدُ من أسلافِهِ ومعاصريهِ من الكُتّابِ الأوربيِّينَ غيرِ الإيرلنديِّينَ (العالميِّينَ)، على الأعمِّ – وهذا علاوةً أيضًا على انحرافِ العديدِ المُشَابِهِ مِمَّنْ صَاروا يظنُّونَ أنفسَهُمْ أدباءَ أو شعراءَ عالميِّينَ، أو حتى «كَوْنِيِّينَ»، ومِمَّنْ قدْ برهَنُوا في أعقابِ الثَّوَرَانِ الشعبيِّ ذاكَ مُنْتَهى طائفيَّتِهِمْ ومُنْتَهى عنصريَّتِهِمْ وعرقيَّتِهِم أيَّما بُرهانٍ خارجَ تلك البلادِ، بلادِ العربِ، الكَرِيبةِ بالذواتِ كذلك. فلا غَرْوَ، مِمَّا كانَ مُرْتَقَبًا من تكامُلِ أو من تعاضُدِ هذينِ المستوَيَيْنِ المحلِّيِّ والعالميِّ، أنْ يصُبَّ جويس جَامَ اكْتراثِهِ كلِّهِ (وقدْ كانَ اكتراثًا هُجَاسيًّا عُصابيًّا، ولا ريبَ) على ما يُسمَّى بـ«الإيقاعِ اللَّحْنِيِّ» Melodic Cadence للكَلِمِ إبَّانَ نَظْمِهِ إيَّاهُ في آناءِ الصَّمْتِ وفي أطرافِ الضَّجيجِ، من جانبٍ موازٍ للمستوى (المحلِّيِّ) الأول، وأنْ يصُبَّ جامَ اعتنائِهِ كلِّهِ كذلك على ما يُدْعَى بـ«التكاثُفِ الزَّمَنِيِّ» Temporal Condensation حتى بينَ إيقاعٍ لحنيٍّ وإيقاعٍ لحنيٍّ آخَرَ، بحيثُ إنَّ اللحظةَ الزمنيةَ الوحيدةَ قدْ تكونُ حُبْلى بِحُقْبَةٍ زمنيَّةٍ «لاسياسيَّةٍ» مُؤَيَّسَةٍ بِرُمَّتِهَا (أو، على النَّقيضِ، بِحُقْبَةٍ تاريخيةٍ سياسيَّةٍ أو مُسَيَّسةٍ بِكُلِّيَّتِهَا)، من جانبٍ موازٍ للمستوى (العالميِّ) الثاني – وإنَّ حَدَّ، لا بَلْ حِدَّةَ أو شِدَّةَ، هذا التكامُلِ، أو التعاضُدِ، ما بينَ المستوَيَيْنِ المَعْنِيَّيْنِ هذينِ لَهُمَا اللذانِ يُمَيِّزَانِ جويس، بوصفِهِ قائلاً ذا موهبةٍ موسيقيةٍ لاحِبَةٍ، عنْ أيِّ قائلٍ «لاروائيٍّ» قَدَامَوِيٍّ أو ما قبلَ قَدَامَوِيٍّ في الأدبِ الشِّفَاهيِّ، إنْ جازَ التعبيرُ، فيُمَيِّزَانِهِ (أي جويس) من ثمَّ، بصفتِهِ كاتبًا ذا موهبةٍ كتابيةٍ لا تقلُّ لُحُوبًا، عنْ أيِّ كاتبٍ «روائيٍّ» حَدَاثَوِيٍّ أو ما بعدَ حَدَاثَوِيٍّ في الأدبِ اللاَّشِفَاهيِّ، إنْ جازَ التعبيرُ، كذلك.
وَلِلْحُبِّ الحقيقيِّ (الغَيْريِّ، لا الأنانيِّ)، ها هُنا، إشْرَاقَةٌ وإصْبَاحٌ يتجلَّيَانِ في مَعْمَعَانِ ذينك التمرُّدِ والثَّوَرَانِ، لا مَحَالَ: ففي ذلك اليومِ بالذاتِ على أرضِ الواقعِ، واقعِ دبلنَ المدينةِ الشَّجِينَةِ، في «يَوْمِ بْلُوم» الواقعيِّ الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من العامِ 1904 تحديدًا، كانَ اللقاءُ الغراميُّ الأولُ بينَ الشابِّ الدَّعَّابِ دَعَابَةً «ثقافيَّةً» أو «أدبيةً»، جيمس جويس نفسِهِ، وبينَ حبيبتهِ الشابَّةِ الدَّعَّابَةِ دَعَابَةً «لاثقافيَّةً» أو «لاأدبيةً» (أو حتى «سُوقِيَّةً»)، نورا بارْنَكِلْ، حبيبتهِ التي صَارتْ زوجتَهُ وفقًا لـ«قانُونٍ اجتماعيٍّ» خاصٍّ تَوَخَّيَاهُ فيما بعد، فصَارتْ من ثمَّ رفيقةَ عمرِهِ المستديمةَ أينما حلَّ وأينما نزلَ. وهكذا، دونَما أيِّ سابقِ إيمَاءَةٍ شاهدةٍ واعدةٍ، فقدْ كانَ الكتابُ الخالدُ «يُولِيس» ذاتُهُ بمثابةِ هديةٍ «أدبيةٍ» أو «لاأدبيةٍ» لا تُقَدَّرُ بأيِّمَا ثمنٍ كانَ من الكاتبِ العالميِّ الفذِّ إلى رفيقةِ عمرِهِ ذاتِهَا، وذلك من أجلِ تخليدِ ذلك اليومِ، يومِ لقائِهِمَا الغراميِّ الأولِ، تخليدًا عالميًّا بقدرِ ما كانَ منهجُهُ الكتابيُّ التركيبيُّ والتراكُبيُّ الفريدُ يَصْبُو إليهِ من عالميَّةٍ لا مِرَاءَ فيها – وكان ذاك الاحتفاءُ «الحَفِيُّ» العالميُّ بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا وخارجَها حتى هذا اليومِ، على الرَّغم من أنَّهُ لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، نوعًا مُسْتَحَبًّا من أنواعِ ما يُمْكِنُ أنْ نسمِّيَهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ»، لا شكلاً مُسْتَكْرَهًا، أو أكثرَ حتى، من أشكالِ ما يُمْكِنُ أنْ ندعوَهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ».
ومن قبيلِ التذكيرِ بأُسْلُوبٍ آخَرَ في المَجَازِ والإيجَازِ، قُلْتُ آنِفًا إنَّ الكاتبَ العالميَّ الفذَّ، جيمس جويس، كانَ قدْ ثارَ بعدَ أنْ تمرَّدَ، أيَّامَئِذٍ، على كلِّ شيءٍ يَتَشَيَّأُ من أيِّمَا «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» Institutionalized Countenance من سيماءَاتِ القوَّةِ، أو السُّلْطَةِ، بالذاتِ قدَّامَ عينَيْهِ البَصَرِيَّتَيْنِ والعَقْلِيَّتَيْنِ، في آنٍ معًا، بدءًا من تمرُّدِهِ وثَوَرَانِهِ على ذاتِهِ بالذاتِ، إنِ اعْتَرَاهَا واعْتَوَرَهَا شيءٌ من هذا الصَّعيدِ، على الرَّغْمِ الرَّغِيمِ مِمَّا كانَ يريدُ، أو حتى مِمَّا كانَ لا يريدُ – حتى أنَّهُ، فيما له مِسَاسٌ بموهبتِهِ الموسيقيةِ اللاحِبَةِ، كانَ جويس يُعْرِبُ عنْ تمرُّدِهِ وعنْ ثَوَرَانِهِ هذينِ على امْرِئٍ معيَّنٍ، أو حتى على امرأةٍ معيَّنةٍ، يتجَاهَرَانِ بالتفكُّرِ «الألْمَعِيِّ» وبالتكلُّمِ «اللَّوْذَعِيِّ» تَجَاهُرًا، كانَ يُعْرِبُ عنهُمَا من خلالِ سُلوكٍ «عُصَابِيٍّ» يَحْدُو بِهِ إلى التنغُّمِ الصَّادِي بِنَغَمٍ مَا، أو التغنِّي المُتَصَادِي بأغنيةٍ مَا، وإلى حَدِّ اعتبارِهِ (أي جويسَ ذاتِهِ) كُلَّ الاعتبارِ إنسانًا «مجنونًا» منْ لَدُنْ غريبٍ وَضِيعٍ مَهِينٍ وحَاقِدٍ، أو منْ لَدُنْ قريبٍ لَكِيعٍ ضَنِينٍ وحَاسِدٍ. وهكذا، على مَرِّ الزَّمَانِ وجَرِّ المَكَانِ، سُرْعَانَ ما سَرَى تأثيرُ كُلٍّ مِنْ هذينِ التمرُّدِ والثَّوَرَانِ جائحَيْنِ أيَّمَا جَوْحٍ وجِيَاحَةٍ مَوْضِعَ جويسَ الذي تَمَوْضَعَ فيهِ مِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الاجتماعيِّ» المتمثِّلِ في الأُسْرَةِ (النَّمُوذَجِيَّةِ التقليديةِ)، أولاً، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الدينيِّ» المتجسِّدِ في الكنيسةِ (الكاثوليكيةِ، أو حتى البروتستانتيةِ)، ثانيًا، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ الثقافيِّ» المتجسِّمِ في الجامعةِ الهَرَمِيَّةِ الجَوْفَاءِ، ثالثًا، ومِنْ ذلك «السِّيمَاءِ السياسيِّ» المُتَبَدِّنِ في الدَّوْلةِ القوميةِ العَجْفَاءِ، رابعًا (وأخيرًا، وليسَ آخِرًا). وَلِلْحُبِّ الحقيقيِّ (الغَيْريِّ، لا الأنانيِّ) فوقَ كلِّ ذلك، هَا هُنا، إشْرَاقَةٌ وإصْبَاحٌ يتجلَّيَانِ في مَعْمَعَانِ ذينك التمرُّدِ والثَّوَرَانِ كِلَيْهِمَا، لا مَحَالَ: ففي ذلك اليومِ المعنيِّ بالذاتِ على أرضِ الواقعِ، واقعِ دبلنَ المدينةِ الشَّجِينَةِ، في «يَوْمِ بْلُوم» الواقعيِّ الواقعِ في اليومِ السَّادِسَ عَشَرَ من شهرِ حزيرانَ من العامِ 1904 تحديدًا، كانَ ذاك اللقاءُ الغراميُّ الأولُ بينَ ذلك الشابِّ الدَّعَّابِ دَعَابَةً «ثقافيَّةً» أو «أدبيةً»، جيمس جويس، وبينَ حبيبتهِ الشابَّةِ الدَّعَّابَةِ دَعَابَةً «لاثقافيَّةً» أو «لاأدبيةً» (أو حتى «سُوقِيَّةً»)، نورا بارْنَكِلْ، حبيبتهِ تلك التي صَارتْ «زوجتَهُ» وفاقًا لـ«قانُونٍ اجتماعيٍّ» خاصٍّ تَوَخَّيَاهُ فيمَا بَعْدُ، فصَارتْ مِنْ ثمَّ رفيقةَ عمرِهِ المستديمةَ أينما حلَّ وأينما نزلَ. وهكذا أيضًا، دونَما أيِّ سَابقِ إيمَاءَةٍ شاهدةٍ أو واعدةٍ، فقدْ كانَ الكتابُ الخالدُ «يُولِيس» Ulysses ذاتُهُ بمثابةِ هديةٍ «أدبيةٍ»، أو «لاأدبيةٍ»، لا تُقَدَّرُ بأيِّمَا ثمنٍ كانَ من الكاتبِ العالميِّ الفذِّ ذاتِهِ إلى رفيقةِ عمرِهِ الفذَّةِ ذاتِهَا، وذلك من أجلِ تخليدِ ذلك اليومِ، يومِ لقائِهِمَا الغراميِّ الأولِ، تخليدًا عالميًّا بقدرِ مَا كانَ منهجُهُ الكتابيُّ التركيبيُّ والتراكُبيُّ الفريدُ يَصْبُو إليهِ مِنْ عالميَّةٍ (أو، بالقَمِينِ، مِنْ كَوْنِيَّةٍ) لا مِرَاءَ فيها – وكان ذاك الاحتفاءُ «الحَفِيُّ» العالميُّ بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا وخارجَها حتى هذا اليومِ، على الرَّغم مِنْ أنَّهُ لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، نوعًا مُسْتَحَبًّا مِنْ أنواعِ مَا يُمْكِنُ أنْ نسمِّيَهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ»، لا شكلاً مُسْتَكْرَهًا، أو أكثرَ حتى، من أشكالِ ما يُمْكِنُ أنْ ندعوَهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ».
من هنا، ليسَ ثَمَّةَ من شاردةٍ ولا من واردةٍ، في ثنايا كتابِ جويس «يُولِيس»، لمْ تَكُنْ مُسْتَلْهَمَةً بالفعلِ اسْتِلْهَامًا واعيًا، ولا حتى مُسْتَوْحَاةً بالقوةِ اسْتيحَاءً لاواعيًا، مِمَّا جرى، أو حتى مِمَّا لمْ يَجْرِ، في أطرافِ ذلك اليومِ، يومِ اللقاءِ الغراميِّ الأولِ بينَ الكاتبِ المنقطعِ النَّظيرِ وبينَ حبيبتِهِ الغريبةِ الأطوارِ (ومن ثمَّ تجوالِهِمَا الهُياميِّ في بِضْعَةٍ من أحياءِ دبلنَ المدينةِ)، من مُحَادثاتٍ أو أحداثٍ «رئيسيةٍ»، أو من مُشَاهداتٍ أو أشهادٍ «فرعيةٍ»، أو حتى من مُهَامَسَاتٍ أو أهْمَاسٍ «جانبيةٍ» أو «هامشيةٍ» تكادُ ألاَّ تستأهلَ الذِّكْرَ بأيَّتِمَا مَثابةٍ كانتْ. ويُمْكِنُ، بادئَ ذِي بَدْءٍ، لِمَنْ تسْتقرِئُ مَا جَاءَ في فَحْوَى «سِيرَةِ» الكاتبِ من سُطورِ الواقعِ، ومَا جاءَ في فَحْواءِ كتابِ «يُولِيس» من سُطورِ الخيالِ، استقراءً متوازيًا أو متوازنًا بعضَ الشيءِ، يُمْكِنُ لَهَا عندئذٍ أنْ تدركَ حقَّ الإدراكِ مدى التطابُقِ العَفْويِّ (أو حتى اللاعَفْويِّ) اللافتِ بينَ ذلك المَسَارِ الذي سَارَ عليهِ الشَّابُّ المُتَوَلِّهُ جيمس جويس أثناءَ لقائِهِ الغراميِّ بالشَّابَّةِ المُتَوَلَّهِ بِهَا نورا بارْنَكِلْ، وأثناءَ تجوالِهِ المنشُودِ والمشدُودِ في مَعِيِّتِهَا في تلك الأحياءِ، من جانبٍ، وبينَ ذلك «المَصَارِ» الذي صَارَ إليهِ الرجلُ المُتَبَصِّرُ لِيُوبُولْد بْلُوم إبَّانَ لقائِهِ الحَميميِّ باليافعِ المُتَبَصَّرِ بِهِ سْتِيفِن ديدالوس، وإبَّانَ تجوالِهِ المَسْرُودِ والمَرْصُودِ في مَعِيِّتِهِ في تلك الأحياءِ ذَوَاتِهَا، من جانبٍ آخَرَ – وفي كلٍّ من هذين اللقائَيْنِ المتقابلَيْنِ، في نهايةِ اللقاءِ، يعودُ كلٌّ من المُلْتَقِي والمُلْتَقَى بِهِ إلى بيتِهِ سَارِحًا بأفكارٍ كانتْ قدْ تولَّدتْ من تفاعُلِهِ وانفعالِهِ المعقولَيْنِ (أو حتى اللامعقولَيْنِ) الناجِمَينِ عَمَّا أبدَاهُ الآخَرُ منْ أفكارِ أُخرى، بنحوٍ أو بآخَرَ. حتى أنَّ مرورَ بلوم وديدالوس مرورًا تعاقُبيًّا بمَبْغَى الخليلةِ بيللا كوهين في الفصلِ الخامسَ عَشَرَ من كتابِ «يُولِيس» المُسَمَّى بِـ«سِيرْسِهْ» Circe، ذلك الفصلِ المكتوبِ بأُسْلوبِ حوارٍ مَسْرَحِيٍّ قائمٍ بذاتِهِ (ولِذَاتِه) رغمَ تخلُّلِ «اهْتِلاسَاتِ» كلٍّ من بلوم وديدالوس حَبْكَتَهُ القَصِّيَّةَ حينًا بعدَ حينٍ، حتى أنَّ مرورَهُمَا (التعاقُبيَّ) بهذا المَبْغَى جسدَيْنِ ذَكَرِيَّيْنِ «مُتَهَيِّجَيْنِ» عَسَى جسدٌ أنثويٌّ أنْ يُفْرِغَ «شُحْنَتَيْهِمَا» فيه، في «الحرفِ» أو حتى في «المجازِ»، إنَّما تتجذَّرُ جُذُورُهُ في حَنايا ذلك اللقاءِ الغراميِّ الأولِ بينَ العاشِقِ جيمس جويس وعشيقتِهِ نورا بارْنَكِلْ بالذات. فلمْ يَكُنْ ذلك اللقاءُ، في واقعِ الأمرِ، لقاءً «غراميًّا» بالمعنى التقليديِّ السَّائِدِ آنئذٍ، كَجَرْيِهِ مثلاً على عاداتِ تبادُلِ النَّظَرَاتِ واللَّمْسَاتِ والقُبُلاتِ الرومانسيةِ الخفيفةِ، بلْ كانَ لقاءً حَافلاً بالمغامرةِ الغراميةِ التي خَرَقَتْ كافَّةَ الأعْرافِ والتقاليدِ وآدابِ التَّلاقي مَا بينَ الحبيبَيْنِ: إذْ تجلَّتْ هذهِ المغامرةُ الغراميَّةُ في شخصيةِ نورا بارْنَكِلْ نفسِهَا أيَّمَا تَجَلٍّ، وذلك من جَرَّاءِ شجاعتِهَا وجَرَاءَتِهَا التَّلْقَائيَّتَيْنِ الخارقتَيْنِ للمألوفِ بالفعلِ، وإلى حَدِّ أنَّهَا، عندما مَرَّتْ وجويسَ أثناءَ تجوالِهِمَا في حيِّ رِينْغْزَنْدْ Ringsend الدبلنيِّ بجمهرةٍ من النساءِ المتبرِّجَاتِ اللواتي كُنَّ يكشفنَ عن «إمكانيَّاتِهِنَّ البارزةِ»، وعندما لاحظتْ «تهيُّجَ» جويسَ نفسِهِ و«لهاثَهُ» و«انتصابَهُ» الواضحَيْنِ من أثرِ ذلك المُرورِ، تَنَحَّتْ بِهِ مَحَلاًّ منعزلاً على شاطئِ البحرِ وأخذتْ «تَسْتَمْنِيهِ بيدِهَا»، دونَمَا تردُّدٍ أو تلكُّؤٍ، إلى أنْ وصلَ إلى رعشةٍ عَارِمَةٍ لم يصلْ إلى مثيلتِهَا منْ قبلُ.
هكذا شَجَاعةٌ وهكذا جَرَاءَةٌ «أُنْثَوِيَّتَانِ» تَلْقَائِيَّتَانِ خَارِقتَانِ للمألوفِ، إذنْ، ليسَ لهُمَا سِوى أنْ تجْعَلا الشَّابَّ جيمس جويس يقعُ وُقُوعًا، بكلِّ جَوارحِهِ، في حُبِّ الشَّابَّةِ نورا بارْنَكِلْ منذُ ذلك اللقاءِ الغراميِّ الأولِ. وهكذا شَجَاعةٌ وهكذا جَرَاءَةٌ «أُنْثَوِيَّتَانِ»، كذلك، ليسَ لهُمَا سِوى أنْ تجْعَلا هذا الشَّابَّ ذاتَهُ عَازِمًا عزمًا وعزيمةً، بكلِّ جَوانحِهِ، على إهداءِ هذهِ الشَّابَّةِ ذاتِهَا الكتابَ «المردودَ» واللامردودَ «يُولِيس» لكيما يخلِّدَ تاريخَ وقائعِ تجوالِهِمَا الهُياميِّ «المعهودِ» واللامعهودِ إلى أبدِ الآبدينَ – خصوصًا وأنهُ الكاتبُ الفريدُ الذي ثارَ كلَّ الثَّوَرَانِ بعدَ أنْ تمرَّدَ كلَّ التَّمَرُّدِ، أيَّامَئِذٍ، على كلِّ شيءٍ يَتَشَيَّأُ من أيِّمَا «سِيمَاءٍ مُؤَسْأَسٍ» قدَّامَ عينًيْهِ البَصَرِيَّتَيْنِ والعَقْلِيَّتَيْنِ، في آنٍ معًا، بدءًا من تمرُّدِهِ وثَوَرَانِهِ على ذاتِهِ بالذاتِ، كما تمَّ ذِكْرُهُ آنِفًا. فقدْ كانَ هذا الكاتبُ الفريدُ يؤمنُ إيمانًا حَازمًا وإيمانًا حَاسمًا (حتى أشدَّ حَزَامَةً وأشدَّ حَسَامَةً من إيمانِ الكاتبِ الروائيِّ الإنكليزيِّ ديفيد هيرْبِرْت لورَنْس، وهو الكاتبُ المبدئيُّ المعروفُ بإيمانِهِ العميقِ بـ«فلسفةٍ للجَسَدِ» خاصَّةٍ بِهِ)، بأنَّ حُرِّيَّةَ الإنسانِ الحَقَّ والحَقِيقَ، على كلٍّ من المستوى النفسيِّ والمستوى الاجتماعيِّ، من طرفٍ، وعلى المستوى السياسيِّ عَبْرَ كلٍّ من ذينك المستويَيْنِ الأوَّلَيْنِ، من طرفٍ آخَرَ، إنَّما تبدأُ بَدْءًا حَازمًا وبَدْءًا حَاسمًا بحُرِّيَّةِ الجَسَدِ، قبلَ حُرِّيَّةِ أيِّ شيءٍ آخَرَ: تلك هي الفلسفةُ الحَقُّ، «فلسفةُ الجَسَدِ» الحَقيقُ، التي تتحدَّى مداهمةَ الموتِ سَائرةً عكسَ التيَّارِ المُهَيْمِنِ شكلاً ومضمونًا، والتي تتشوَّفُ من ثمَّ إلى فاعليَّاتِ الرفضِ والعنادِ والتَّصَاوُلِ واللاتَصَالُح، على حَدِّ عباراتِ الناقدِ الأدبيِّ الفذِّ إدوارد سعيد. وتلك هي الفلسفةُ الحَقُّ، «فلسفةُ الجَسَدِ» الحَقيقُ، التي فَهِمَتْهَا الحَبيبةُ الاِستثنائيَّةُ نورا بارْنَكِلْ من حَبيبِهَا الاِستثنائيِّ جيمس جويس شكلاً ومضمونًا، على الوتيرةِ ذاتِهَا، كما «تفهمُ الحَبيباتُ اللَّبيبَاتُ من مَحْضِ الإشَارةِ»! فليسَ من أمْرٍ عَجَبٍ، إذنْ، أنْ يتبدَّى الرجلُ المُتَبَصِّرُ لِيُوبُولْد بْلُوم ذاتُهُ، بكُلِّيَّةِ حُضُورِهِ الواقعيِّ و/أوِ الخَيَاليِّ في ثنايَا الكتابِ، كتابِ «يُولِيس» بالذاتِ، ليسَ عَجَبًا أنْ يتبدَّى على هيئةِ «مُمَثِّلٍ» (أو، بالخَليقِ، «سَفِيرٍ») كونِيٍّ نموذجيٍّ لـ«فلسفةِ الجَسَدِ» هذهِ قولاً وفعلاً، وإلى حَدِّ النظرِ الوَكِيدِ إلى هذا الكتابِ بوصفهِ «ملحمةَ الجَسَدِ»، في حَدِّ ذاتِهَا، تلك الملحمةَ العَوِيصَةَ التي تصوِّرُ تَصْوِيرًا لُغَوِيًّا عُصَابِيًّا تَجْوَالَ هذا «المُمَثِّلِ»، أو «السَّفِيرِ»، الكونِيِّ باحِثًا عن ضَالَّتِهِ المنشودةِ، في وَضَحِ النَّهَارِ، وفي جُلِّ هذا النَّهَارِ.
وبمَا أنَّ هكذا «مُمَثِّلاً»، أو «سَّفِيرًا»، كونِيًّا، لِيُوبُولْد بْلُوم ذاتَهُ، يتمثَّلُ في كتابِ «يُولِيس» بالذاتِ على اعتبارِهِ مُواطِنًا مَجَرِيًّا-إيرلنديًّا «يهوديًّا» مُهَاجِرًا لاسِيَاسيًّا، و/أو لاجِئًا سِيَاسيًّا، إلى أرْحَابِ جمهوريةِ إيرلندا «الحِيَادِيَّةِ»، في أعقابِ وَيْلاتِ الحربِ العالميةِ الأولى WWI، فإنَّ ثَمَّةَ الكثيرَ الكثيرَ من أولئكَ «القوميِّينَ» المتطرِّفينَ والمتعنِّتينَ المعروفينَ ميثَاقًا بالولاءِ الطَّلِيسِ والأعمى لمبادِئِ ومَنَاهِي مَا يُسَمَّى بـ«المنظَّمةِ الصُّهيونيةِ العالمية» WZO، التي نشأتْ قبلَ تلك الحربِ بحوالَيْ عقدَيْنِ من الزمانِ، يعمِدُونَ بكلِّ ما أُوتُوا من «تنويراتِ» تلك «المعرفةِ الأدبيةِ النقديةِ» التخرُّصِيَّةِ إلى استغلالِ فَحْوَى ذلك التَّجْوالِ الذي قامَ بِهِ هكذا «مُمَثِّلٌ»، أو «سَّفِيرٌ»، كونِيٌّ باحِثًا حَاثًّا عن ضَالَّتِهِ المنشودةِ، والذي حَدَا بِهِ كلَّ الحَدْوِ عائدًا جَادًّا إلى «عُقْرِ دَارِهِ» في آخِرِ المَطافِ، فيعمِدُونَ دائبينَ من ثمَّ إلى تأويلِ زمنِ ذلك التَّجْوالِ عَيْنِ عينِهِ تأويلاً تلفيقيًّا مُفَبْرَكًا على أنَّهُ رمزٌ لزمنِ التِّيهِ، تِيهِ «اليهوديِّ التَّائِهِ» Wandering Jew (حسبَ تعريبِهِ القرآنيِّ، كما جَاءَ في الآيةِ المَائِدِيَّةِ، نحوَ: «يَتِيهُونَ في الأَرْضِ [أَرْبَعِينَ سَنَةً]» (المائدة: 26)، لا حسبَ تعريبِهِ التُّرْجُمَانِيِّ، نحوَ: «اليهوديِّ الضَّالِّ»، وما شَابهَ ذلك، كما يحسبُ البعضُ من المترجمينَ والنُّقَّادِ الأدبيِّينَ العربِ): إذْ يُنْظَرُ إلى هذا «اليهوديِّ التَّائِهِ» نَظَرًا سياسيًّا ذَرَائِعِيًّا لاأخلاقيًّا مَحْضًا، وبالاستنادِ «التوفيقيِّ» المُحَنَّكِ إلى ذلك التأويلِ التلفيقيِّ المُفَبْرَكِ، يُنْظَرُ إليهِ بصفتِهِ «يهوديًّا تَائِهًا» لا بُدَّ لهُ من أنْ يعودَ إلى «وطنِهِ الأُمِّ» إسرائيلَ، شاءَ أيٌّ من أولئك «الحُسَّادُ» و«الضُّغَّانُ» من أولئك «العربِ» و«العربانِ» ومن غيرهم، أمْ أبَوْا – رغمَ أنَّ هذهِ الـ«إسرائيلَ» مُخْتَلَقَةٌ، في السِّرِّ، اختلاقًا استعماريًّا جَائِرًا، ورغمَ أنَّ هذهِ الـ«إسرائيلَ» مُصْطَنَعَةٌ كذلك، في الجَهْرِ، اصطناعًا إمبرياليًّا سَافرًا، وعلى غِرارِ ما يصطلحُ عليهِ إدوارد سعيد بأحَابيلِ «الجغرافيا الخياليةِ»، في كتابِهِ «الاستشراقُ» الغنيِّ عنِ التعريفِ، تلك الأحَابيلِ الدنيئةِ والدَّنِيَّةِ التي لا يلجأُ إليها إلاَّ مَنْ هُمْ في حَضِيضِ الحَضِيضِ أدنى مرتبةً بكثيرٍ وكثيرٍ من مرتبةِ «الحَيَوانِ المَريضِ»! غيرَ أنَّ جيمس جويس لمْ يكنْ هناك لِكَيْمَا يَتْرُكَ «التأويلَ» ذاك سَائبًا لِمَنْ كانوا، ومَا زالوا، يُصِرُّونَ إصْرَارَ الجَهُولِ على تطرُّفهِمْ وتعنُّتِهِمْ مِنْ أولئك الصَّهَاينةِ الأخَاسِسِ والأخَاسِئِ طُرًّا، ولا لكيْ يَتْرُكَهُ سَائبًا أيضًا لِمَنْ كانوا، ومَا زالوا، على شَاكلتِهِمْ أنَّى تواجَدُوا في هذا العالَمِ اليقينيِّ مِنْ بعدِ ذلك «التِّيهِ الأربعينيِّ» الذي حُمِّلَ مَا لا يحملُ مِنْ تأصيلٍ ومِنْ «تأثِيلٍ»، بَتَّةً، منذُ ذلك الحينِ. حتى الرسولُ محمدٌ جاءَ ذِكْرُهُ في كتابِ «يُولِيس» ذِكْرًا لا يُمْكِنُ للقارئةِ والقارئِ النَّبيهَيْنِ أنْ يظُنَّاهُ ذِكْرًا «عابرًا» على طريقةِ مَنْ كانَ يحلمُ أحلامَ الليلِ، أو حتى أحلامَ النَّهارِ، مُرْتَقِبًا مرحلةَ انْمِحَاءِ مَا تَحتويهِ مِنْ فَحْواءَ (أو مِنْ فَحَاوٍ) مِنْ على صَفَحَاتِ الذِّهْنِ الحَلُومِ إلى غيرِ رجعةٍ. لقد جاءَ ذِكْرُ الرسولِ محمدٍ، والحَالُ هذهِ، على طريقةِ مَنْ كانَ يتأمَّلُ في دَخيلةِ نفسِهِ تأمُّلاً عميقًا أيَّمَا عَمَاقَةٍ، في اليَقَاظِ لا في المَنَامِ، تأمُّلاً تتجلَّى إرهاصَاتُهُ في تداعياتِ تَيَّارٍ ذهنيٍّ تَسَاؤُلِيٍّ، من حيثُ البناءُ، سُمِّيَ بعدئذٍ بـ«تَيَّارِ الوَعْيِ» Stream of Consciousness: إذْ تستحضرُ تلك التداعياتُ إنسانيةَ الرسولِ محمدٍ حينما تُثيرُ دهشةً وذُهُولاً غيرَ عاديَّيْنِ من خلالِ تلميحٍ جليلٍ إلى رفقهِ اللافتِ بالحَيَوانِ (إلى قصَّتهِ الشهيرةِ معَ تلك القطةِ التي نامتْ على أذيالِ عباءتهِ، سَاعةَ كانَ يخطبُ في «الأُمَّةِ» سَاعاتٍ وسَاعاتٍ)، ومن خلالِ تلميحٍ أجَلَّ، لا بلْ أشدَّ جَلالاً، إلى تألُّمهِ الشديدِ على حَالِ البائسينَ وأحوالِ المعذَّبينَ في الأرضِ.
يبقى، في الأخيرِ، مَا دعَوْناهُ بـ«نِفَاقِ التَّسْيِيسِ»، تسْييسِ ذاك الاِحتفاءِ «الحَفِيِّ» المحلِّيِّ، حتى قبلَ العالميِّ، بـ«يَوْمِ بْلُوم» داخلَ إيرلندا البَلَدِ «العَتِيدِ»، ومنْ لَدُنْ سَاسَةِ هذهِ الـ«إيرلندا»، على وجهِ التحديدِ، ذلك «اليومِ» الذي لمْ يَعُدْ، في هذا اليومِ بالذاتِ، يمثِّلُ، مثلما كانَ الكاتبُ العالميُّ بالذاتِ يتمنَّى، ما سمَّيْناهُ بـ«شِقَاقِ التَّأْيِيسِ». بجليِّ الكلامِ، هَا هُنا، هكذا احتفاءٌ «حَفِيٌّ» تظاهُريٌّ مزعُومٌ بيومٍ أدبيٍّ متخَيَّلٍ تخيُّلاً فَنِّيًّا مَحْضًا لا يُمْكِنُ اعتبارُهُ، في حقيقةِ الأمرِ، «بُرْهانًا سَاطعًا على سَطْوَةِ الأدبِ وسُلْطَةِ المخيِّلةِ»، كما يَخَالُ قائلُ هذا الكلامِ، صبحي حديدي، بِخَوْلِهِ منفعلاً ومنطلقًا من نقطةِ انطلاقٍ «نقديةٍ أدبيةٍ» تعميميَّةٍ إلى حدِّ السَّذاجةِ، بلْ ينبغي اعتبارُهُ، على نقيضِ الأمرِ، برهانًا أشدَّ سُطوعًا على نفاقِ سَاسَةِ هذهِ الـ«إيرلندا» السَّافرِ أيَّمَا سُفُورٍ، وعلى تدْجِيلِ هؤلاءِ السَّاسَةِ الفاضحِ أيَّمَا فُضُوحٍ، هؤلاءِ السَّاسَةِ الذينَ صَارُوا، من جهةٍ، يُدِرُّونَ الأموالَ الخياليةَ من جَرَّاءِ رَعْيِهِمْ لهكذا احتفاءٍ رَعْيًا «وَفِيًّا» و«مُخْلِصًا» في ذلك «اليومِ» من كلِّ عامٍ، والذينَ كانوا، من جهةٍ أُخرى، يمارسُونَ كلَّ أنواعِ القمعِ والقسرِ والاضطهادِ بحقِّ كاتبٍ مبدعٍ إبداعًا أدبيًّا وفَنِّيًّا متفرِّدًا في كلِّ شيءٍ، كاتبٍ عاشَ جُلَّ حياتهِ بعيدًا عن مَسْقِطِ رأسهِ، دبلن، ولكنَّهُ لمْ يكتبْ في سيرتهِ «الكِتابيَّةِ» كلِّها سِوَى عن دبلن، لكيمَا تكونَ «مدينةَ المدائنِ» في تاريخِ الأدبِ العالميِّ الحديثِ وما بعدَ الحديثِ.
غياث المرزوق
دبلن، 19 آب 2018