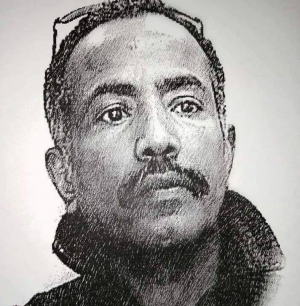"أستغفر الله.. وأتوب إليه"..
ترددتْ تسع مرات خلال خمس دقائق، وفي كل مرة ألتقط حدة لحرف السين ليست كسابقتها، ومرة كان الضغط على الغين، أما اللام فكانت مقلقلة بوضوح رغم استرخاء اللسان فيها..
علاوة على رمقات استهجانية تبرق من عينيها الصغيرتين تحت نقابها الضيق جداً.. النقاب كان محاصِراً لوجهها وتفاصيل هويّتها، وبالتالي لم أكن أعرف ما تفكر به، كنتُ أبدو مستفزة بالنسبة لها، أو هكذا شعرت، والحقيقة أنها دفعتني لهذا الشعور حتى بان الضيق عليّ والاستياء!
استمرتْ في اللهو بأزارير الجوال على بعض العروض والصور والنصائح، فكان تقليبها السريع مؤشراً على الضيق مع استمرار الاستغفار، كان مقعدانا لصيقين جداً ويبدوان أصغر حجماً من المقاعد الأخرى في الدرجة السياحية، نظراً لأنهما يقعان عند مخرج الطوارئ، الذي يشترط فيمن يجلس بالقرب منه أن يكون فوق سن الخمسة عشر عاماً، وأن يكون قادراً على الحركة في حالة وقوع أي أمر طارئ لا سمح الله.. ترى ما الذي يمكن أن يقع! وما الذي يمكن أن أقوم به بجلوسي كامرأة راشدة هنا! ربما قفزتُ قبل الآخرين – وقبل جارتي بلا شك - وحولتُ العباءة الواسعة لبراشوت انقاذ..
كان ضرورياً أن تتحملني وأتحملها وأن نتبادل وضع مرفقينا على المسندة الوسطى حتى لا تشتعل النيران، اضطررتُ بعدما ارتفعت نبرة الاستغفار ووتيرته، أن أتحول بكتفي الأيسر إلى الجهة الأخرى معطية إشارة توحي: "أنا أيضاً لم أحبك"..
عَبَر المضيف المتفاخر بمشيته - وبصوته في الميكروفون - وأشرت له بالاقتراب والدنو.. فلم يفعل! كنت أرغب في تجنب تسرب الكلمات إلى مسامعها، لكنه هو من اختار..
- إذا سمحت ممكن تشوف لي مقعد آخر!
رد بجدية فورية:
- ما نزال نتوقع ركاباً قادمين..
التزمتُ الصمت هذه المرة ووفّرتُ إيحاءاتي الجسدية فلم أنبئ بشئ، لا بد لي أن أتحملها وتتحملني! أُغلقت الأبواب، وأنا أستدير بين حين وآخر لأراقب مقعداً شاغراً كان متبقياً في الصفوف الخلفية، رجوت الله أن يبقى كذلك حتى الإقلاع، كم رائحة قهوة الطائرة لذيذة.. يبدو أنها لركاب درجة الأعمال..
ناديتُ على المضيفة المغربية وأومأت برأسي لها أن تقترب، فلم تفعل! يبدو أن من قواعد العمل عدم تجاوز مسافة محددة بينها وبين وجه الراكب..
- لو سمحتِ.. ممكن أنتقل إلى مقعد آخر بما أننا أقلعنا الآن..
- لا توجد مقاعد شاغرة عزيزتي!
صوبتُ نظري فوراً إلى الخلف، كان المقعد قد طار.. مشغولاً..
يبدو أنها لاحظت قلقي، بادرت سيدة الاستغفار:
- ابقِ هنا فالمكان "عندنا" أوسع، لا تخافي من الباب!
عدّلتُ جلستي وبقيتُ، ولأزيح عنها الاحساس بالذنب قلتُ:
- فقط أحب الجلوس بجانب نافذة..
بعد مرور دقائق ترقّب من الطرفين، زفرتْ وهي تبادر بانفعال أرهقها وتودد مصطنع:
- كم مرة أقرّر فيها ألا أسافر وحدى..
ثم انطلقتْ تقصّ مخاوفها من الطائرة ومن الإقلاع تحديداً، وتحوّلتْ إلى التعليم وعدد المدارس التي انتقلت بينها حتى وصل بها الأمر إلى العيش في منطقة بعيدة عن أهلها وعائلتها، انتهينا إلى أساليب معايشة المرأة لوضعها بعد الطلاق.. وعلمتُ أنها كذلك..
بعد مضي أكثر من نصف الرحلة، تنحّت كل واحدة منّا إلى جانبها الآخر في استكانة إعادة تقييم الموقف، واستراحة محارب، هل كانت فتحة عينيها المشدودة أم لون شفاهي الأحمر المستعار؟ هل كعبي العالي نسبياً هو السبب أم سواد عباءتها الكالح؟
عاتبتُ نفسي على الحكم عليها..
بدأتُ أُدخل عادة الاستغفار أثناء تخفيف الإضاءة استعدداً للهبوط لأقطع بها الصمت بيننا، وأزيز المحرّكات يكاد يقوم بالمهمة لولا أن بيننا طبقة خفية من الترقب والتحفز..
في حين اطمأنتْ لي.. بدأتْ وتيرة الاستغفار تتناقص.. وتتباعد..
* نشرت الطبعة الأولى عام 1437 دار سيبويه
ترددتْ تسع مرات خلال خمس دقائق، وفي كل مرة ألتقط حدة لحرف السين ليست كسابقتها، ومرة كان الضغط على الغين، أما اللام فكانت مقلقلة بوضوح رغم استرخاء اللسان فيها..
علاوة على رمقات استهجانية تبرق من عينيها الصغيرتين تحت نقابها الضيق جداً.. النقاب كان محاصِراً لوجهها وتفاصيل هويّتها، وبالتالي لم أكن أعرف ما تفكر به، كنتُ أبدو مستفزة بالنسبة لها، أو هكذا شعرت، والحقيقة أنها دفعتني لهذا الشعور حتى بان الضيق عليّ والاستياء!
استمرتْ في اللهو بأزارير الجوال على بعض العروض والصور والنصائح، فكان تقليبها السريع مؤشراً على الضيق مع استمرار الاستغفار، كان مقعدانا لصيقين جداً ويبدوان أصغر حجماً من المقاعد الأخرى في الدرجة السياحية، نظراً لأنهما يقعان عند مخرج الطوارئ، الذي يشترط فيمن يجلس بالقرب منه أن يكون فوق سن الخمسة عشر عاماً، وأن يكون قادراً على الحركة في حالة وقوع أي أمر طارئ لا سمح الله.. ترى ما الذي يمكن أن يقع! وما الذي يمكن أن أقوم به بجلوسي كامرأة راشدة هنا! ربما قفزتُ قبل الآخرين – وقبل جارتي بلا شك - وحولتُ العباءة الواسعة لبراشوت انقاذ..
كان ضرورياً أن تتحملني وأتحملها وأن نتبادل وضع مرفقينا على المسندة الوسطى حتى لا تشتعل النيران، اضطررتُ بعدما ارتفعت نبرة الاستغفار ووتيرته، أن أتحول بكتفي الأيسر إلى الجهة الأخرى معطية إشارة توحي: "أنا أيضاً لم أحبك"..
عَبَر المضيف المتفاخر بمشيته - وبصوته في الميكروفون - وأشرت له بالاقتراب والدنو.. فلم يفعل! كنت أرغب في تجنب تسرب الكلمات إلى مسامعها، لكنه هو من اختار..
- إذا سمحت ممكن تشوف لي مقعد آخر!
رد بجدية فورية:
- ما نزال نتوقع ركاباً قادمين..
التزمتُ الصمت هذه المرة ووفّرتُ إيحاءاتي الجسدية فلم أنبئ بشئ، لا بد لي أن أتحملها وتتحملني! أُغلقت الأبواب، وأنا أستدير بين حين وآخر لأراقب مقعداً شاغراً كان متبقياً في الصفوف الخلفية، رجوت الله أن يبقى كذلك حتى الإقلاع، كم رائحة قهوة الطائرة لذيذة.. يبدو أنها لركاب درجة الأعمال..
ناديتُ على المضيفة المغربية وأومأت برأسي لها أن تقترب، فلم تفعل! يبدو أن من قواعد العمل عدم تجاوز مسافة محددة بينها وبين وجه الراكب..
- لو سمحتِ.. ممكن أنتقل إلى مقعد آخر بما أننا أقلعنا الآن..
- لا توجد مقاعد شاغرة عزيزتي!
صوبتُ نظري فوراً إلى الخلف، كان المقعد قد طار.. مشغولاً..
يبدو أنها لاحظت قلقي، بادرت سيدة الاستغفار:
- ابقِ هنا فالمكان "عندنا" أوسع، لا تخافي من الباب!
عدّلتُ جلستي وبقيتُ، ولأزيح عنها الاحساس بالذنب قلتُ:
- فقط أحب الجلوس بجانب نافذة..
بعد مرور دقائق ترقّب من الطرفين، زفرتْ وهي تبادر بانفعال أرهقها وتودد مصطنع:
- كم مرة أقرّر فيها ألا أسافر وحدى..
ثم انطلقتْ تقصّ مخاوفها من الطائرة ومن الإقلاع تحديداً، وتحوّلتْ إلى التعليم وعدد المدارس التي انتقلت بينها حتى وصل بها الأمر إلى العيش في منطقة بعيدة عن أهلها وعائلتها، انتهينا إلى أساليب معايشة المرأة لوضعها بعد الطلاق.. وعلمتُ أنها كذلك..
بعد مضي أكثر من نصف الرحلة، تنحّت كل واحدة منّا إلى جانبها الآخر في استكانة إعادة تقييم الموقف، واستراحة محارب، هل كانت فتحة عينيها المشدودة أم لون شفاهي الأحمر المستعار؟ هل كعبي العالي نسبياً هو السبب أم سواد عباءتها الكالح؟
عاتبتُ نفسي على الحكم عليها..
بدأتُ أُدخل عادة الاستغفار أثناء تخفيف الإضاءة استعدداً للهبوط لأقطع بها الصمت بيننا، وأزيز المحرّكات يكاد يقوم بالمهمة لولا أن بيننا طبقة خفية من الترقب والتحفز..
في حين اطمأنتْ لي.. بدأتْ وتيرة الاستغفار تتناقص.. وتتباعد..
* نشرت الطبعة الأولى عام 1437 دار سيبويه