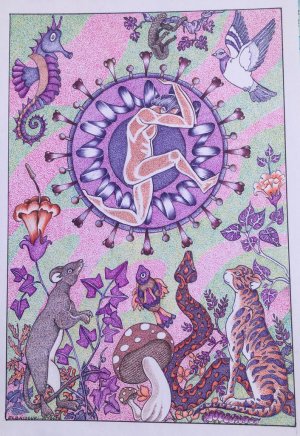لا أجد أي تفسير أدبي مُقنع للسبب الذي دفع ألبير كامو لجعل مدينة وهران في الجزائر مسرحاً لروايته «الطاعون». فالمدينة ليست سوى إطار للرواية ولا علاقة لها بمصائر أبطالها.
المدينة غير مهمة في ذاتها، وتاريخ حدوث طاعونها ليس مذكوراً. نحن أمام تجريد للشرط الوجودي في مواجهة الوباء، فلماذا أعطى الكاتب الفرنسي للمدينة اسمها العربي -الأمازيغي؟ هل لأنه أقام فيها فترة من الزمن؟ وهل يشكّل هذا سبباً مُقنعاً؟
لو ذهب كامو في رسم مدينة الطاعون هذه إلى أقصى التجريد، وتجاهل سكانها العرب بشكل كامل، لقلنا إن وهران اسم مستعار لأي مدينة فرنسية أو أوروبية، لكن الكاتب انزلق في ثلاثة أماكن من روايته إلى الإشارة إلى سكانها العرب. نعرف أولاً أن الصحافي ريمون رامبير يقوم بتحقيق لحساب صحيفة فرنسية كبرى عن ظروف حياة العرب، لكن مشروع رامبير سرعان ما يتلاشى.
ثم نعثر على العرب مرتين أخريين: الأولى، عبر إشارة إلى رواية «الغريب»، حين تقوم بائعة التبغ في حديثها مع جوزف غران بذكر عامل تجاري في الجزائر كان قد قتل عربياً في أحد الشواطئ»، أما الإشارة الثالثة فهي تذكير بمهمة الصحافي التي نسيها في فترة انشغاله بتدبير وسيلة للخروج من المدينة، حين يُذكّر رامبير الطبيب برنار ريو بها.
الرواية التي يعود الكثيرون إلى قراءتها في أيام كورونا هذه، تدور بين ثلاثة مستويات:
مستوى واقعي قائم على وصف دقيق لأعراض الطاعون الذي ضرب وهران ومعرفة جدية بتاريخ الوباء الذي ينتقل من الجراذين إلى البشر. ومستوى تجريدي فلسفي يطرح أسئلة عميقة حول علاقة الإنسان بالموت والله، والتوتر بين الفردي والجماعي. وأخيراً مستوى ثالث سوف أطلق عليه اسم الغياب من خلال تغييب سكان المدينة الأصليين، كأن موتهم لا يعني شيئاً، فالذي يعيش خارج اللغة الفرنسية الكولونيالية يموت من دون أن يكون لموته صدى.
تخيلوا معي روائياً إسرائيلياً سوف يكتب بعد نهاية كابوس «كوفيد 19» رواية تدور في مستوطنة الناصرة العليا التي صار اسمها نوف هاجليل التي يشكل الفسطينيون ربع سكانها اليوم، أو في مستعمرة كريات أربع في الخليل، ولا يلتفت إلى الفلسطينيين؟ هل سيتابع «الأقدام السود» الإسرائيليون الترسيمة نفسها التي بناها «الأقدام السود» الفرنسيون؟
لكن رواية كامو على الرغم من خللها على هذا المستوى تحمل قيمة أدبية رفيعة، جعلت الأكثرية الساحقة للنقاد لا تتنبّه إلى هذا التشوّه الكولونيالي، الذي يطرح أسئلة عميقة سبق لإدوارد سعيد أن كان من أوائل من أشار إليها في نقده لرواية «الغريب».
كي أكتنه الأعماق الفكرية والأدبية لرواية «الطاعون»، عليّ أن أتناسى أنني عربي، وأنا على استعداد لفعل ذلك مؤقتاً، فالدروس التي استخلصها كامو بعبقريته ولغته الأدبية المدهشة، تخاطب أسئلتنا الوجودية اليوم.
أقول مؤقتاً، لأنني أعتقد أننا لا نستطيع تجزئة الشرط الإنساني، إذ إن إخراج الوهرانيات والوهرانيين من حكاية مدينتهم المنكوبة هو جزء من الطاعون العنصري الكولونيالي الذي سقط فيه كامو حين أعلن في لقاء مع مجموعة من الطلاب في السويد بعد نيله جائزة نوبل، أنه إذا خُيّر بين أمه والعدالة، فسيختار أمه.
ميزة هذه الرواية الفذة هي أنها تمزج الأحداث المأساوية التي يعيشها أبطالها بحوارات عميقة تأخذنا إلى الأسئلة الإنسانية الكبرى، من سؤال الكلام إلى سؤال الصمت، ومن الخوف إلى الجنون، ومن شجاعة لا وجود لها إلى شجاعة الدكتور ريو وصحبه، وهم يقاومون وباء يعرفون أنهم ضحاياه. كما أنها يمكن أن تُقرأ في أحــــد جوانبها كرمز للاحتلال النازي لفرنسا.
مجانية الموت الطاعوني تعطي مجانية الحياة معناها بصفتها بحثاً عن خلاص أرضي فقدت السماء القدرة على التدخل فيه. وهذا ما تعبّر عنه عظة الكاهن بانولو التي اعتبرت الطاعون غضباً إلهياً وعقاباً سماوياً، فالعقاب هو «طريقة الله في حبه لكم». لكن هذا الافتراض سينهار مرتين، الأولى على لسان الدكتور ريو أمام طفل مطعون يموت: «لقد كان هذا على الأقل بريئاً، وأنت تعرف هذا جيداً… سأرفض حتى الموت هذا الخَلق الذي يُعذّب فيه الأطفال»، والثانية حين يموت الكاهن وحيداً وفي صمت بلا رحمة.
لكن هذا الحيز الفلسفي الديني على أهميته، ليس متن الرواية العميق الذي يقوم على ثلاثة افتراضات:
الافتراض الأول هو المنفى، «إن أول ما حمله الطاعون لمواطنينا هو النفي». فالطاعون الذي يغرب ثم يعود من جديد هو تذكير بالمنفى الذي يعيشه البشر. فالمنفى الداخلي وسط أمواج الموت هو أقسى أنواع المنافي.
الافتراض الثاني هو الصراع بين سعادة الإنسان وتجريدات الطاعون، أي بين الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، بين الهرب وخوض المواجهة مع الوباء الذي يشبه القدر.
الافتراض الثالث هو الشــرف، فالإنسان ليس فكرة، والأبطال والقديسون لا وجود لهم، الحاضر يجب أن يعاش كشكل من أشكال المواجهة، وهذا ما سيدفع الصحافي في النهاية إلى البقاء في المدينة، فالطاعون جعل من المدينة المُصابة مدينته.
كان الدكتور ريو يعرف أن أحد أشكال مواجهة الوباء هي أن يموت الإنسان بشرف وكرامة.
هذه الافتراضات الثلاثة تشكّل المفاتيح الفكرية لقراءة هذا العمل الأدبي الكبير، وتأخذنا إلى السؤال الإنساني. فبعد أن يقول جان تارو، الذي كتب مذكراته في تلك الأيام العصيبة وصار «مؤرخاً لما لا تاريخ له»، إن كل إنسان يحمل في جلده الطاعون، يطرح السؤال: «هل في وسع الإنسان أن يكون قديساً من غير الله؟» فيأتيه جواب الطبيب: «أنا لا أحب البطولة ولا القداسة، إن الذي يهمني هو أن يكون المرء إنساناً».
وبعد هذا الحوار يسبح الصديقان في البحر الدافئ وكأنهما يقومان بمعمودية بديلة.
أسئلة هذه الرواية لا تنتهي، لكن سؤال موت الأطفال الذي لم يقترب منه كامو إلا بشكل عَرَضي، سوف تأتي كاتبة لبنانية- مصرية- سورية هي اندريه شديد، لتعالجه عام 1960، أي بعد ثلاثة عشر عاماً من صدور رواية «الطاعون»، في روايتها «اليوم السادس»، التي تروي حكايات الأسى ومواجهة الموت في الكوليرا التي ضربت مصر عام 1947. وهذا يحتاج إلى مقال خاص.
المدينة غير مهمة في ذاتها، وتاريخ حدوث طاعونها ليس مذكوراً. نحن أمام تجريد للشرط الوجودي في مواجهة الوباء، فلماذا أعطى الكاتب الفرنسي للمدينة اسمها العربي -الأمازيغي؟ هل لأنه أقام فيها فترة من الزمن؟ وهل يشكّل هذا سبباً مُقنعاً؟
لو ذهب كامو في رسم مدينة الطاعون هذه إلى أقصى التجريد، وتجاهل سكانها العرب بشكل كامل، لقلنا إن وهران اسم مستعار لأي مدينة فرنسية أو أوروبية، لكن الكاتب انزلق في ثلاثة أماكن من روايته إلى الإشارة إلى سكانها العرب. نعرف أولاً أن الصحافي ريمون رامبير يقوم بتحقيق لحساب صحيفة فرنسية كبرى عن ظروف حياة العرب، لكن مشروع رامبير سرعان ما يتلاشى.
ثم نعثر على العرب مرتين أخريين: الأولى، عبر إشارة إلى رواية «الغريب»، حين تقوم بائعة التبغ في حديثها مع جوزف غران بذكر عامل تجاري في الجزائر كان قد قتل عربياً في أحد الشواطئ»، أما الإشارة الثالثة فهي تذكير بمهمة الصحافي التي نسيها في فترة انشغاله بتدبير وسيلة للخروج من المدينة، حين يُذكّر رامبير الطبيب برنار ريو بها.
الرواية التي يعود الكثيرون إلى قراءتها في أيام كورونا هذه، تدور بين ثلاثة مستويات:
مستوى واقعي قائم على وصف دقيق لأعراض الطاعون الذي ضرب وهران ومعرفة جدية بتاريخ الوباء الذي ينتقل من الجراذين إلى البشر. ومستوى تجريدي فلسفي يطرح أسئلة عميقة حول علاقة الإنسان بالموت والله، والتوتر بين الفردي والجماعي. وأخيراً مستوى ثالث سوف أطلق عليه اسم الغياب من خلال تغييب سكان المدينة الأصليين، كأن موتهم لا يعني شيئاً، فالذي يعيش خارج اللغة الفرنسية الكولونيالية يموت من دون أن يكون لموته صدى.
تخيلوا معي روائياً إسرائيلياً سوف يكتب بعد نهاية كابوس «كوفيد 19» رواية تدور في مستوطنة الناصرة العليا التي صار اسمها نوف هاجليل التي يشكل الفسطينيون ربع سكانها اليوم، أو في مستعمرة كريات أربع في الخليل، ولا يلتفت إلى الفلسطينيين؟ هل سيتابع «الأقدام السود» الإسرائيليون الترسيمة نفسها التي بناها «الأقدام السود» الفرنسيون؟
لكن رواية كامو على الرغم من خللها على هذا المستوى تحمل قيمة أدبية رفيعة، جعلت الأكثرية الساحقة للنقاد لا تتنبّه إلى هذا التشوّه الكولونيالي، الذي يطرح أسئلة عميقة سبق لإدوارد سعيد أن كان من أوائل من أشار إليها في نقده لرواية «الغريب».
كي أكتنه الأعماق الفكرية والأدبية لرواية «الطاعون»، عليّ أن أتناسى أنني عربي، وأنا على استعداد لفعل ذلك مؤقتاً، فالدروس التي استخلصها كامو بعبقريته ولغته الأدبية المدهشة، تخاطب أسئلتنا الوجودية اليوم.
أقول مؤقتاً، لأنني أعتقد أننا لا نستطيع تجزئة الشرط الإنساني، إذ إن إخراج الوهرانيات والوهرانيين من حكاية مدينتهم المنكوبة هو جزء من الطاعون العنصري الكولونيالي الذي سقط فيه كامو حين أعلن في لقاء مع مجموعة من الطلاب في السويد بعد نيله جائزة نوبل، أنه إذا خُيّر بين أمه والعدالة، فسيختار أمه.
ميزة هذه الرواية الفذة هي أنها تمزج الأحداث المأساوية التي يعيشها أبطالها بحوارات عميقة تأخذنا إلى الأسئلة الإنسانية الكبرى، من سؤال الكلام إلى سؤال الصمت، ومن الخوف إلى الجنون، ومن شجاعة لا وجود لها إلى شجاعة الدكتور ريو وصحبه، وهم يقاومون وباء يعرفون أنهم ضحاياه. كما أنها يمكن أن تُقرأ في أحــــد جوانبها كرمز للاحتلال النازي لفرنسا.
مجانية الموت الطاعوني تعطي مجانية الحياة معناها بصفتها بحثاً عن خلاص أرضي فقدت السماء القدرة على التدخل فيه. وهذا ما تعبّر عنه عظة الكاهن بانولو التي اعتبرت الطاعون غضباً إلهياً وعقاباً سماوياً، فالعقاب هو «طريقة الله في حبه لكم». لكن هذا الافتراض سينهار مرتين، الأولى على لسان الدكتور ريو أمام طفل مطعون يموت: «لقد كان هذا على الأقل بريئاً، وأنت تعرف هذا جيداً… سأرفض حتى الموت هذا الخَلق الذي يُعذّب فيه الأطفال»، والثانية حين يموت الكاهن وحيداً وفي صمت بلا رحمة.
لكن هذا الحيز الفلسفي الديني على أهميته، ليس متن الرواية العميق الذي يقوم على ثلاثة افتراضات:
الافتراض الأول هو المنفى، «إن أول ما حمله الطاعون لمواطنينا هو النفي». فالطاعون الذي يغرب ثم يعود من جديد هو تذكير بالمنفى الذي يعيشه البشر. فالمنفى الداخلي وسط أمواج الموت هو أقسى أنواع المنافي.
الافتراض الثاني هو الصراع بين سعادة الإنسان وتجريدات الطاعون، أي بين الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، بين الهرب وخوض المواجهة مع الوباء الذي يشبه القدر.
الافتراض الثالث هو الشــرف، فالإنسان ليس فكرة، والأبطال والقديسون لا وجود لهم، الحاضر يجب أن يعاش كشكل من أشكال المواجهة، وهذا ما سيدفع الصحافي في النهاية إلى البقاء في المدينة، فالطاعون جعل من المدينة المُصابة مدينته.
كان الدكتور ريو يعرف أن أحد أشكال مواجهة الوباء هي أن يموت الإنسان بشرف وكرامة.
هذه الافتراضات الثلاثة تشكّل المفاتيح الفكرية لقراءة هذا العمل الأدبي الكبير، وتأخذنا إلى السؤال الإنساني. فبعد أن يقول جان تارو، الذي كتب مذكراته في تلك الأيام العصيبة وصار «مؤرخاً لما لا تاريخ له»، إن كل إنسان يحمل في جلده الطاعون، يطرح السؤال: «هل في وسع الإنسان أن يكون قديساً من غير الله؟» فيأتيه جواب الطبيب: «أنا لا أحب البطولة ولا القداسة، إن الذي يهمني هو أن يكون المرء إنساناً».
وبعد هذا الحوار يسبح الصديقان في البحر الدافئ وكأنهما يقومان بمعمودية بديلة.
أسئلة هذه الرواية لا تنتهي، لكن سؤال موت الأطفال الذي لم يقترب منه كامو إلا بشكل عَرَضي، سوف تأتي كاتبة لبنانية- مصرية- سورية هي اندريه شديد، لتعالجه عام 1960، أي بعد ثلاثة عشر عاماً من صدور رواية «الطاعون»، في روايتها «اليوم السادس»، التي تروي حكايات الأسى ومواجهة الموت في الكوليرا التي ضربت مصر عام 1947. وهذا يحتاج إلى مقال خاص.