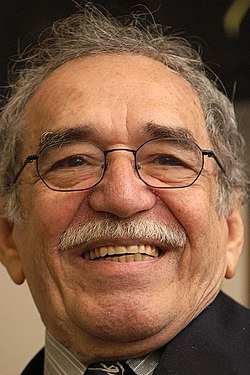خرج القطار من داخل نفق الصخور الرملية المترجرجة، وراح يعبر مزارع الموز المتماثلة التي تكاد لا تنتهي. الهواء مال الى الرطوبة ولم يعد بالإمكان الإحساس بنسيم البحر البتة. هبة خانقة من الدخان عبرت نافذة العربة. على الطريق الضيق الموازي لسكة الحديد ثمة عربات تجرها ثيران محملة بـ»قروط» خضراء من الموز. ما وراء الطريق وفي قطعة أرض غير محروثة، تقوم على أبعاد متباينة مكاتب تحوي مراوح كهربائية، مبان ذات قرميد أحمر، وبيوت مع كراس وطاولات بيضاء صغيرة فوق مصاطب كامنة بين أشجار نخيل مغبرة وشجيرات ورد. كانت الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولم يكن القيظ قد بدأ بعد.
«الأفضل لكِ أن تغلقي النافذة»، قالت المرأة «شعركِ سيمتلئ بالسخام».
حاولت الفتاة، لكن درفة النافذة لم تتحرك بسبب الصدأ. كانتا الراكبتين الوحيدتين في مقصورة الدرجة الثالثة. بسبب استمرار دخول دخان القاطرة عبر النافذة، تركت الفتاة مقعدها واضعة أشياءهما القليلة على الأرض: كيس بلاستيكي فيه أشياء للأكل وباقة من الزهور ملفوفة بأوراق صحيفة.
جلست على المقعد المقابل، بعيداً عن النافذة، بمواجهة والدتها. كانتا ترتديان ملابس محتشمة ومتواضعة النوعية خاصة بالصباح.
الفتاة في الثانية عشرة، وهذه أول مرة تركب فيها قطار. بدت الأم أكبر بكثير من أن تكون والدتها، بسبب الأوردة الزرقاء على جفونها فضلاً عن أن جسدها الضئيل الليّن، العديم الشكل مكسو بفستان أشبه برداء الراهبة. كانت تجلس وعمودها الفقري يضغط بشدة على ظهر المقعد، وتحمل بيديها فوق حضنها حقيبة يد تبدو لمّاعة الجلد رغم كونها مقشّرة. كان يبدو عليها صفاء الضمير الحي لامرأة معتادة على الفقر.
في الثانية عشرة بدأ القيظ. توقف القطار مدة عشر دقائق للتزوّد بالماء في محطة لا تقع داخل بلدة. خارجاً، وفي كنف الصمت الغامض للمزارع، بدت الظلال نظيفة. لكن الهواء الساكن داخل العربة كانت له رائحة الجلد غير المدبوغ.
لم يتح للقطار زيادة سرعته بشكل ملحوظ. اضطر للتوقف عند بلدتين متماثلتين لجهة دهن منازلهما بألوان ساطعة. راح رأس المرأة يطأطئ مرتجاً ثم غفت. نزعت الفتاة حذاءها، من ثم ذهبت الى دورة المياه لتضع باقة الزهور داخل قدر من الماء.
حين عادت الى مقعدها، كانت الوالدة بانتظارها لتأكلا. ناولتها قطعة جبنة، نصف كعكة ذرة، وقطعة بسكويت، وأخذت حصة مساوية لها من الكيس البلاستيكي. فيما هما تأكلان عَبَر القطار ببطء جسراً حديدياً ومر ببلدة كالتي من قبل، إلا أنه في هذه كان يوجد جمهور في الساحة العامة. كان ثمة فرقة تعزف بحيوية رغم الشمس العدائية القيظ. في الجانب الآخر من البلدة انتهت المزارع عند سهل تشققت تربته من الجفاف.
توقفت المرأة عن الأكل.
«إنتعلي حذاءك»، قالت لها.
تطلّعت الفتاة صوب الخارج. لم ترَ سوى السهل القاحل، حيث بدأ القطار يسرع من جديد، فعمدت الى وضع آخر بسكوتة في الكيس وأسرعت في ارتداء حذاءها. ناولتها المرأة مشطاً.
«مشّطي شعرك»، قالت لها.
بدأ القطار يطلق صفارته فيما الفتاة تسرّح شعرها. قامت المرأة بتجفيف العرق من على رقبتها ومسحت الزيت عن وجهها بأصابعها. حين توقفت الفتاة عن تسريح شعرها، كان القطار يمر بالبيوت النائية لبلدة أكبر ولكن أكثر حزناً من السابقات.
«إذا كنتِ تشعرين بالحاجة الى فعل أي شيء، فافعليه الآن». قالت المرأة «لاحقاً لا تأخذي شربة ماء من أي مكان حتى ولو كنت تموتين من العطش. والأهم، لا بكاء».
أومأت الفتاة برأسها علامة الاستجابة. دخلت عبر النافذة ريح حارة جنباً الى جنب مع صفير القاطرة وقعقعة العربات القديمة. طوت المرأة كيس النايلون وبداخله بقية الطعام ثم وضعته داخل حقيبة يدها. لبضع لحظات، شّعت صورة كاملة للبلدة على زجاج النافذة في ذاك الثلاثاء الزاهي من آب. لفّت الفتاة الأزهار داخل الصحيفة المبتلّة، ثم تحرّكت قليلاً بعيداً عن النافذة وتطلّعت بعدها بوالدتها. حظيت في المقابل بتعبير من الرضى. بدأ القطار بالصفير ليتباطأ بعدها، وبعد لحظة توقف.
لم يكن هناك من أحد عند المحطة. في الجانب الآخر من الشارع، وبموازاة الرصيف المظلل بشجر اللوز، وحدها قاعة البليارد كان مفتوحة. كانت البلدة تغرق في القيظ. نزلت المرأة والفتاة من القطار وعبرتا المحطة المهجورة بلاطاتها منفلقة عن بعضها البعض بفعل الحشائش النامية بينها نحو الجانب الظليل من الشارع.
قاربت الثانية ظهراً. في تلك الساعة، وبسبب ثقل النعاس تلجأ البلدة الى أخذ قيلولة. المخازن، المكاتب، المدرسة الرسمية.. كانت قد أغلقت جميعها في الحادية عشرة ولا تعود الى فتح أبوابها حتى قبيل الرابعة بقليل، حين يكون القطار قد عاد. وحده الفندق المقابل للمحطة، مع باره وقاعة بليارده، فضلاً عن مكتب البريد الذي يقع على أحد جوانب الباحة العامة يبقى مفتوحاً.
من حيث المنازل، ومعظمها مبني على طراز شركة الموز، أبوابها مقفلة من الداخل ومصاريعها منزلة. كانت الحرارة شديدة داخل بعضها، ما حدا القاطنين على تناول الغداء في الباحة المرصوفة. والبعض الآخر عمد الى إسناد كرسي بالحائط، في ظل شجر الموز، ليمضي القيلولة في الشارع تماماً.
بتتبعهما للظل الواقي لشجر الموز، دخلت المرأة والفتاة البلدة من دون التسبّب بإزعاج طقوس فترة القيلولة. قصدتا مباشرة بناء الأبرشية. حكّت المرأة شبكية الباب المعدنية بظفر إصبعها، انتظرت قليلاً ثم حكّت ثانية. في الداخل سُمع صوت مروحة كهربائية تهمهم. لم يتناه إليهما صوت الدعسات القادمة صوب الباب. بالكاد سمعتا صرير باب، وبادرهما في الحال صوت حذر قريباً من المحفة المعدنية للشبكية: «من القادم؟». حاولت المرأة الرؤية عبر عين الشبكية:
«أريد مقابلة الكاهن»، ردّت المرأة.
«هو نائم الآن».
«إنها حالة طارئة»، أصرّت المرأة.
دلّت بنبرة صوتها المتأنية عن تصميم هادئ.
فُتح الباب قليلاً، من دون ضجة، وظهرت إمرأة ممتلئة وأكبر منها سناً، مع بشرة شاحبة وشعر بلون الحديد. بدت عيناها ضئيلتين وراء نظارتها السميكة.
«أدخلا»، قالت، وفتحت الباب على وسعه.
دخلت الثلاث غرفة تغشاها رائحة أزهار عتيقة. قادتهما المرأة نحو مقعد خشبي وأشارت لهما بالجلوس. جلست الفتاة لكن والدتها بقيت واقفة، شاردة الذهن فيما تقبض يداها الإثنتان على حقيبة يدها. لم تكن من ضجة تُسمع فوق ما يصدر عن قرقعة المروحة الكهربائية.
إمرأة الدار ظهرت من جديد عند الباب في الطرف الأبعد للغرفة. «يقول إن عليكِ العودة بعد الثالثة»، قالت بصوت منخفض جداً. «لم يمض على استلقائه أكثر من خمس دقائق».
«يغادر القطار في الثالثة والنصف»، ردّت المرأة.
كان جواباً قصيراً وينمّ عن ثقة بالنفس، لكن صوتها بقي سائغاً وخفيضاً. إمرأة الدار ابتسمت للمرة الأولى.
«حسناً»، قالت.
حين أغلق الباب البعيد ثانية، جلست المرأة قرب ابنتها. كانت غرفة الانتظار الضيّقة فقيرة، لكن مرتّبة ونظيفة. على الجانب الآخر من الدرابزين الذي قسّم الغرفة، ثمة طاولة خاصة بالعمل، من النوع العادي وعليها غطاء مشمّع، وفوق الطاولة آلة كاتبة بدائية، قرب إناء أزهار. سجلات الأبرشية كانت وراء الطاولة. يمكن الاستنتاج أنه مكتب حرصت على إبقائه منظماً إمرأة عانس.
فُتح الباب البعيد، وظهر هذه المرة الكاهن، وهو ينظف نظارته بمحرمة. فقط بعد أن وضعها على عينيه كان واضحاً أنه شقيق المرأة التي فتحت الباب.
«كيف لي مساعدتكما؟» سأل الكاهن
«مفاتيح المقبرة»، أجابته المرأة.
كانت الفتاة جالسة فيما الأزهار ـ في حضنها وقدماها مشبوكتان تحت المقعد. نظر الكاهن اليها، ثم الى المرأة، ومن ثم عبر الشبك المعدني للنافذة باتجاه السماء الساطعة الصافية.
«في مثل هذا الغيظ»، كان بمقدوركما الانتظار حتى غروب الشمس»
حركت المرأة رأسها بصمت. توجه الكاهن نحو الجانب الآخر من الدرابزين، تناول من الخزانة دفتر ملاحظات داخل قماش مشمع، وحامل اقلام معدني، فضلاً عن محبرة، ثم جلس الى الطاولة. كان ثمة شعر على يديه يفوق ما هو ناقص من راسه.
«أي قبر تنويان زيارته؟» سأل الكاهن
«قبر كارلوس سينتينو»، أجابت المرأة.
«قبر من»؟
«كارلوس سنتينو»، كررت المرأة.
رغم الإعادة لم يفهم الكاهن من تعني.
«انه اللص الذي قتل هنا الاسبوع الماضي»، قالت المرأة بنبرة الصوت نفسها «أنا أمه».
أمعن فيها الكاهن النظر. حدقت فيه بسيطرة هادئة على النفس، فما كان الا ان احمر وجه الكاهن. حتى رأسه وبدأ بالكتابة. ما ان ملأ الصفحة، طلب من المرأة التعريف عن نفسها، وأجابت من دون تردد، ذاكرة معلومات مفصلة،كأنها تقوم بقراءتها. بدأ الأب بالتعرف قامت الفتاة بحل ابزيم فردة حذائها اليسرى، سحبت قدمها منه، ثم اراحتها فوق طرف المقعد. بعدها فعلت الأمر نفسه مع اليمنى.
بدأ الأمر يوم الاثنين من الاسبوع المنصرم، عند الثالثة فجراً، على بعد مفارق قليلة من هنا. ربيكا، أرملة وحيدة كانت تعيش داخل بيت مليء بالقطع وبقاياها، تناهى الى مسمعها رغم رذات المطر صوت محاولة أحدهم محاولة فتح الباب الأمامي من الخارج، نهضت، نقبت في خزانتها عن مسدس قديم لم يطلق منه أحد رصاصة منذ أيام الكولونيل أوريليانو بيانديا، وقصدت غرفة الجلوس من دون اضاءة النور. استجمعت نفسها لا ارادياً ليس تماماً بسبب الضجة المنبعثة من القفل، بل بدافع الفزع الذي اعتمل في داخلها بسبب ثمان وعشرين سنة من الوحدة، ثم عمدت الى تركيز مخيلتها ليس فقط على بقعة تواجد الباب بل ايضا على الارتفاع الدقيق للقفل، قبضت بإحكام على المسدس بكلتا يديها، أغلقت عينيها، وضغطت الزناد. كانت المرة الأولى في حياتها تطلق فيها النار من سلاح، بعد الانتحار مباشرة لم تسمع شيئاً سوى وقع الرذاذ فوق السطح المغطى بالزنك، من ثم سمعت صوت خبطة اشبه بالمعدنية فوق سطح الشرفة الأمامية للمنزل، وبعدها تناهى اليها، صوت خفيض، محبب لكن متعب جداً: آه، يا أمنا مريم». الرجل الذي وجدوه ميتاً أمام المنزل صباحاً، وقد استحال أنفه شقفاً، كان يرتدي قميصاً من الفلانيل مع تقليمات ملونة، وسروالاً عادياً مع حبل كحزام، وكان حافي القدمين لم يكن أحد في البلدة يعرفه.
«إذن، كان اسمه كارلوس سنتينو»، تختتم الكاهن بعد أن أنهى الكتابة.
«سنتينو آيالا»، قالت المرأة. كان صبي الوحيد».
عاد الكاهن الى خزانته. كان ثمة مفتاحان كبيران صدئان معلقتين داخل الخزانة. تخيلت الفتاة، كما قد تكون أمها فعلت حين كانت فتاة مثلها، وكذلك كما قد يكون الكاهن نفسه تخيل ذات يوم، انهما كانا مفتاحي القديس بطرس، تناولهما، وضعهما فوق دفتر الملاحظات المفتوح فوق الدرابزين، واشار بسبابته الى موضع في الصفحة حيث كتب للتو، وهو ينظر الى المرأة.
«وقعي هنا»
خربشت المرأة اسمها، معلقة حقيبة اليد بذراعها، التقطت الفتاة الأزهار، توجهت صوب الدرابزين جارة قدميها، وراقبت ما ستفعله أمها بتمعن.
أطلق الكاهن تنهيدة.
«الم تحاولي مرة جلبه إلى طيق الصواب»؟
أجابت المرأة بعد الانتهاء من التوقيع.
«كان رجلاً صالحاً».
نظر الكاهن بداية في المرأة ومن ثم في الفتاة، وأدرك بنوع من الذهول التقني أنهما ليستا على وشك البكاء. تابعت المرأة بالنبرة نفسها:
«قلت له الا يقدم على سرقة شيء يحتاج أحد ما لأكله، وكان يطاوعني من جهة أخرى، حين كن يمارس الملاكمة، يضطره ذلك الى ملازمة الفراش ثلاثة أيام، تعباً من تلقي الكلمات».
«كان يفترض اقتلاع كل أسنانه»، قاطعت الفتاة.
«هذا صحيح»، وافقت المرأة. «كل لقمة تناولتها انا في تلك الايام كان لها طعم الكلمات التي كان يتلقاها ابني في أمامي أيام السبت.
«لا رد لمشيئة الله»، قال «الأب» الكاهن.
لكنه نطق بذلك دون الكثير من الاقتناع، لسببين اثنين. جعلته التجربة مشككاً نوعاً ما، وكذلك بسبب حرارة الجو. اقترح على المرأة وابنتها تغطية رأسيهما لاتقاء ضربة الشمس. متثائباً وأقرب ما يكون الى حالة النوم، زودهما بمعلومات تساعدهما على إيجاد قبر كارلوس سنتينو. واضاف، عندما تعودان يفترض بهما وضع المفتاح تحت الباب.. وفي حال أمكن بوسعهما وضع تبرع ما للكنيسة في مكان وضع المفتاح ذاته. أصغت المرأة لتعليماته باهتمام كبير، لكنها شكرته من دون أية اشارة ابتسام.
لاحظ الكاهن ان ثمة من يحاول في الخارج النظر عبر احدى عيون مشربية الباب الى الداخل. ضغط أنفه على المشربية، حتى قبل ان يفتح الباب المؤدي الى الشارع. في الخارج كان ثمة مجموعة من الأولاد، حين فتح الباب على مصراعيه تفرق الأولاد. عادة في مثل هذه الساعة، لا يتواجد أحد في الشارع. الآن لم يكن هناك فقط الأولاد. كان يوجد مجموعات من الناس تحت اشجار اللوز. تأمل «الأب» الشارع الغارق في القيظ فبان له الأمر. أغلق الباب على مهل ثانية.
«إنتظري لحظة»، قال للمرأة دون ان ينظر إليها
ظهرت شقيقته عند الباب البعيد مع سترة سوداء فوق قميص نومها فيما شعرها منسدل فوق اكتافها. نظرت بصمت الى الأب.
«ماذا هناك؟» سالها
«لاحظ الناس وجودهما» تمتمت شقيقته
«الأفضل خروجكما من الخلف الى الغناء»، قال «الأب»
«الوضع نفسه هناك أيضاً، قالت شقيقته متابعة، «كل الناس واقفة الى النوافذ».
لم يكن قد حظيت المرأة ما يجري حتى الآن. حاولت النظر الى الشارع عبر عين المشربية. من ثم تناولت باقة الأزهار من الفتاة وبدأت بالتحرك صوب الباب. لحقت الفتاة بها.
«إنتظرا الى ان تغرب الشمس». قال «الأب». «ستذوبان»، اضافت شقيقته، وهي واقفة بلا حراك عند مؤخرة العربة. «إنتظارا وسنعيركما مظلة».
«شكراً»، قالت المرأة «لا بأس بحالنا الحاضرة»
بعدها أخذت الفتاة من يدها وخرجتا الى الشارع.
«الأفضل لكِ أن تغلقي النافذة»، قالت المرأة «شعركِ سيمتلئ بالسخام».
حاولت الفتاة، لكن درفة النافذة لم تتحرك بسبب الصدأ. كانتا الراكبتين الوحيدتين في مقصورة الدرجة الثالثة. بسبب استمرار دخول دخان القاطرة عبر النافذة، تركت الفتاة مقعدها واضعة أشياءهما القليلة على الأرض: كيس بلاستيكي فيه أشياء للأكل وباقة من الزهور ملفوفة بأوراق صحيفة.
جلست على المقعد المقابل، بعيداً عن النافذة، بمواجهة والدتها. كانتا ترتديان ملابس محتشمة ومتواضعة النوعية خاصة بالصباح.
الفتاة في الثانية عشرة، وهذه أول مرة تركب فيها قطار. بدت الأم أكبر بكثير من أن تكون والدتها، بسبب الأوردة الزرقاء على جفونها فضلاً عن أن جسدها الضئيل الليّن، العديم الشكل مكسو بفستان أشبه برداء الراهبة. كانت تجلس وعمودها الفقري يضغط بشدة على ظهر المقعد، وتحمل بيديها فوق حضنها حقيبة يد تبدو لمّاعة الجلد رغم كونها مقشّرة. كان يبدو عليها صفاء الضمير الحي لامرأة معتادة على الفقر.
في الثانية عشرة بدأ القيظ. توقف القطار مدة عشر دقائق للتزوّد بالماء في محطة لا تقع داخل بلدة. خارجاً، وفي كنف الصمت الغامض للمزارع، بدت الظلال نظيفة. لكن الهواء الساكن داخل العربة كانت له رائحة الجلد غير المدبوغ.
لم يتح للقطار زيادة سرعته بشكل ملحوظ. اضطر للتوقف عند بلدتين متماثلتين لجهة دهن منازلهما بألوان ساطعة. راح رأس المرأة يطأطئ مرتجاً ثم غفت. نزعت الفتاة حذاءها، من ثم ذهبت الى دورة المياه لتضع باقة الزهور داخل قدر من الماء.
حين عادت الى مقعدها، كانت الوالدة بانتظارها لتأكلا. ناولتها قطعة جبنة، نصف كعكة ذرة، وقطعة بسكويت، وأخذت حصة مساوية لها من الكيس البلاستيكي. فيما هما تأكلان عَبَر القطار ببطء جسراً حديدياً ومر ببلدة كالتي من قبل، إلا أنه في هذه كان يوجد جمهور في الساحة العامة. كان ثمة فرقة تعزف بحيوية رغم الشمس العدائية القيظ. في الجانب الآخر من البلدة انتهت المزارع عند سهل تشققت تربته من الجفاف.
توقفت المرأة عن الأكل.
«إنتعلي حذاءك»، قالت لها.
تطلّعت الفتاة صوب الخارج. لم ترَ سوى السهل القاحل، حيث بدأ القطار يسرع من جديد، فعمدت الى وضع آخر بسكوتة في الكيس وأسرعت في ارتداء حذاءها. ناولتها المرأة مشطاً.
«مشّطي شعرك»، قالت لها.
بدأ القطار يطلق صفارته فيما الفتاة تسرّح شعرها. قامت المرأة بتجفيف العرق من على رقبتها ومسحت الزيت عن وجهها بأصابعها. حين توقفت الفتاة عن تسريح شعرها، كان القطار يمر بالبيوت النائية لبلدة أكبر ولكن أكثر حزناً من السابقات.
«إذا كنتِ تشعرين بالحاجة الى فعل أي شيء، فافعليه الآن». قالت المرأة «لاحقاً لا تأخذي شربة ماء من أي مكان حتى ولو كنت تموتين من العطش. والأهم، لا بكاء».
أومأت الفتاة برأسها علامة الاستجابة. دخلت عبر النافذة ريح حارة جنباً الى جنب مع صفير القاطرة وقعقعة العربات القديمة. طوت المرأة كيس النايلون وبداخله بقية الطعام ثم وضعته داخل حقيبة يدها. لبضع لحظات، شّعت صورة كاملة للبلدة على زجاج النافذة في ذاك الثلاثاء الزاهي من آب. لفّت الفتاة الأزهار داخل الصحيفة المبتلّة، ثم تحرّكت قليلاً بعيداً عن النافذة وتطلّعت بعدها بوالدتها. حظيت في المقابل بتعبير من الرضى. بدأ القطار بالصفير ليتباطأ بعدها، وبعد لحظة توقف.
لم يكن هناك من أحد عند المحطة. في الجانب الآخر من الشارع، وبموازاة الرصيف المظلل بشجر اللوز، وحدها قاعة البليارد كان مفتوحة. كانت البلدة تغرق في القيظ. نزلت المرأة والفتاة من القطار وعبرتا المحطة المهجورة بلاطاتها منفلقة عن بعضها البعض بفعل الحشائش النامية بينها نحو الجانب الظليل من الشارع.
قاربت الثانية ظهراً. في تلك الساعة، وبسبب ثقل النعاس تلجأ البلدة الى أخذ قيلولة. المخازن، المكاتب، المدرسة الرسمية.. كانت قد أغلقت جميعها في الحادية عشرة ولا تعود الى فتح أبوابها حتى قبيل الرابعة بقليل، حين يكون القطار قد عاد. وحده الفندق المقابل للمحطة، مع باره وقاعة بليارده، فضلاً عن مكتب البريد الذي يقع على أحد جوانب الباحة العامة يبقى مفتوحاً.
من حيث المنازل، ومعظمها مبني على طراز شركة الموز، أبوابها مقفلة من الداخل ومصاريعها منزلة. كانت الحرارة شديدة داخل بعضها، ما حدا القاطنين على تناول الغداء في الباحة المرصوفة. والبعض الآخر عمد الى إسناد كرسي بالحائط، في ظل شجر الموز، ليمضي القيلولة في الشارع تماماً.
بتتبعهما للظل الواقي لشجر الموز، دخلت المرأة والفتاة البلدة من دون التسبّب بإزعاج طقوس فترة القيلولة. قصدتا مباشرة بناء الأبرشية. حكّت المرأة شبكية الباب المعدنية بظفر إصبعها، انتظرت قليلاً ثم حكّت ثانية. في الداخل سُمع صوت مروحة كهربائية تهمهم. لم يتناه إليهما صوت الدعسات القادمة صوب الباب. بالكاد سمعتا صرير باب، وبادرهما في الحال صوت حذر قريباً من المحفة المعدنية للشبكية: «من القادم؟». حاولت المرأة الرؤية عبر عين الشبكية:
«أريد مقابلة الكاهن»، ردّت المرأة.
«هو نائم الآن».
«إنها حالة طارئة»، أصرّت المرأة.
دلّت بنبرة صوتها المتأنية عن تصميم هادئ.
فُتح الباب قليلاً، من دون ضجة، وظهرت إمرأة ممتلئة وأكبر منها سناً، مع بشرة شاحبة وشعر بلون الحديد. بدت عيناها ضئيلتين وراء نظارتها السميكة.
«أدخلا»، قالت، وفتحت الباب على وسعه.
دخلت الثلاث غرفة تغشاها رائحة أزهار عتيقة. قادتهما المرأة نحو مقعد خشبي وأشارت لهما بالجلوس. جلست الفتاة لكن والدتها بقيت واقفة، شاردة الذهن فيما تقبض يداها الإثنتان على حقيبة يدها. لم تكن من ضجة تُسمع فوق ما يصدر عن قرقعة المروحة الكهربائية.
إمرأة الدار ظهرت من جديد عند الباب في الطرف الأبعد للغرفة. «يقول إن عليكِ العودة بعد الثالثة»، قالت بصوت منخفض جداً. «لم يمض على استلقائه أكثر من خمس دقائق».
«يغادر القطار في الثالثة والنصف»، ردّت المرأة.
كان جواباً قصيراً وينمّ عن ثقة بالنفس، لكن صوتها بقي سائغاً وخفيضاً. إمرأة الدار ابتسمت للمرة الأولى.
«حسناً»، قالت.
حين أغلق الباب البعيد ثانية، جلست المرأة قرب ابنتها. كانت غرفة الانتظار الضيّقة فقيرة، لكن مرتّبة ونظيفة. على الجانب الآخر من الدرابزين الذي قسّم الغرفة، ثمة طاولة خاصة بالعمل، من النوع العادي وعليها غطاء مشمّع، وفوق الطاولة آلة كاتبة بدائية، قرب إناء أزهار. سجلات الأبرشية كانت وراء الطاولة. يمكن الاستنتاج أنه مكتب حرصت على إبقائه منظماً إمرأة عانس.
فُتح الباب البعيد، وظهر هذه المرة الكاهن، وهو ينظف نظارته بمحرمة. فقط بعد أن وضعها على عينيه كان واضحاً أنه شقيق المرأة التي فتحت الباب.
«كيف لي مساعدتكما؟» سأل الكاهن
«مفاتيح المقبرة»، أجابته المرأة.
كانت الفتاة جالسة فيما الأزهار ـ في حضنها وقدماها مشبوكتان تحت المقعد. نظر الكاهن اليها، ثم الى المرأة، ومن ثم عبر الشبك المعدني للنافذة باتجاه السماء الساطعة الصافية.
«في مثل هذا الغيظ»، كان بمقدوركما الانتظار حتى غروب الشمس»
حركت المرأة رأسها بصمت. توجه الكاهن نحو الجانب الآخر من الدرابزين، تناول من الخزانة دفتر ملاحظات داخل قماش مشمع، وحامل اقلام معدني، فضلاً عن محبرة، ثم جلس الى الطاولة. كان ثمة شعر على يديه يفوق ما هو ناقص من راسه.
«أي قبر تنويان زيارته؟» سأل الكاهن
«قبر كارلوس سينتينو»، أجابت المرأة.
«قبر من»؟
«كارلوس سنتينو»، كررت المرأة.
رغم الإعادة لم يفهم الكاهن من تعني.
«انه اللص الذي قتل هنا الاسبوع الماضي»، قالت المرأة بنبرة الصوت نفسها «أنا أمه».
أمعن فيها الكاهن النظر. حدقت فيه بسيطرة هادئة على النفس، فما كان الا ان احمر وجه الكاهن. حتى رأسه وبدأ بالكتابة. ما ان ملأ الصفحة، طلب من المرأة التعريف عن نفسها، وأجابت من دون تردد، ذاكرة معلومات مفصلة،كأنها تقوم بقراءتها. بدأ الأب بالتعرف قامت الفتاة بحل ابزيم فردة حذائها اليسرى، سحبت قدمها منه، ثم اراحتها فوق طرف المقعد. بعدها فعلت الأمر نفسه مع اليمنى.
بدأ الأمر يوم الاثنين من الاسبوع المنصرم، عند الثالثة فجراً، على بعد مفارق قليلة من هنا. ربيكا، أرملة وحيدة كانت تعيش داخل بيت مليء بالقطع وبقاياها، تناهى الى مسمعها رغم رذات المطر صوت محاولة أحدهم محاولة فتح الباب الأمامي من الخارج، نهضت، نقبت في خزانتها عن مسدس قديم لم يطلق منه أحد رصاصة منذ أيام الكولونيل أوريليانو بيانديا، وقصدت غرفة الجلوس من دون اضاءة النور. استجمعت نفسها لا ارادياً ليس تماماً بسبب الضجة المنبعثة من القفل، بل بدافع الفزع الذي اعتمل في داخلها بسبب ثمان وعشرين سنة من الوحدة، ثم عمدت الى تركيز مخيلتها ليس فقط على بقعة تواجد الباب بل ايضا على الارتفاع الدقيق للقفل، قبضت بإحكام على المسدس بكلتا يديها، أغلقت عينيها، وضغطت الزناد. كانت المرة الأولى في حياتها تطلق فيها النار من سلاح، بعد الانتحار مباشرة لم تسمع شيئاً سوى وقع الرذاذ فوق السطح المغطى بالزنك، من ثم سمعت صوت خبطة اشبه بالمعدنية فوق سطح الشرفة الأمامية للمنزل، وبعدها تناهى اليها، صوت خفيض، محبب لكن متعب جداً: آه، يا أمنا مريم». الرجل الذي وجدوه ميتاً أمام المنزل صباحاً، وقد استحال أنفه شقفاً، كان يرتدي قميصاً من الفلانيل مع تقليمات ملونة، وسروالاً عادياً مع حبل كحزام، وكان حافي القدمين لم يكن أحد في البلدة يعرفه.
«إذن، كان اسمه كارلوس سنتينو»، تختتم الكاهن بعد أن أنهى الكتابة.
«سنتينو آيالا»، قالت المرأة. كان صبي الوحيد».
عاد الكاهن الى خزانته. كان ثمة مفتاحان كبيران صدئان معلقتين داخل الخزانة. تخيلت الفتاة، كما قد تكون أمها فعلت حين كانت فتاة مثلها، وكذلك كما قد يكون الكاهن نفسه تخيل ذات يوم، انهما كانا مفتاحي القديس بطرس، تناولهما، وضعهما فوق دفتر الملاحظات المفتوح فوق الدرابزين، واشار بسبابته الى موضع في الصفحة حيث كتب للتو، وهو ينظر الى المرأة.
«وقعي هنا»
خربشت المرأة اسمها، معلقة حقيبة اليد بذراعها، التقطت الفتاة الأزهار، توجهت صوب الدرابزين جارة قدميها، وراقبت ما ستفعله أمها بتمعن.
أطلق الكاهن تنهيدة.
«الم تحاولي مرة جلبه إلى طيق الصواب»؟
أجابت المرأة بعد الانتهاء من التوقيع.
«كان رجلاً صالحاً».
نظر الكاهن بداية في المرأة ومن ثم في الفتاة، وأدرك بنوع من الذهول التقني أنهما ليستا على وشك البكاء. تابعت المرأة بالنبرة نفسها:
«قلت له الا يقدم على سرقة شيء يحتاج أحد ما لأكله، وكان يطاوعني من جهة أخرى، حين كن يمارس الملاكمة، يضطره ذلك الى ملازمة الفراش ثلاثة أيام، تعباً من تلقي الكلمات».
«كان يفترض اقتلاع كل أسنانه»، قاطعت الفتاة.
«هذا صحيح»، وافقت المرأة. «كل لقمة تناولتها انا في تلك الايام كان لها طعم الكلمات التي كان يتلقاها ابني في أمامي أيام السبت.
«لا رد لمشيئة الله»، قال «الأب» الكاهن.
لكنه نطق بذلك دون الكثير من الاقتناع، لسببين اثنين. جعلته التجربة مشككاً نوعاً ما، وكذلك بسبب حرارة الجو. اقترح على المرأة وابنتها تغطية رأسيهما لاتقاء ضربة الشمس. متثائباً وأقرب ما يكون الى حالة النوم، زودهما بمعلومات تساعدهما على إيجاد قبر كارلوس سنتينو. واضاف، عندما تعودان يفترض بهما وضع المفتاح تحت الباب.. وفي حال أمكن بوسعهما وضع تبرع ما للكنيسة في مكان وضع المفتاح ذاته. أصغت المرأة لتعليماته باهتمام كبير، لكنها شكرته من دون أية اشارة ابتسام.
لاحظ الكاهن ان ثمة من يحاول في الخارج النظر عبر احدى عيون مشربية الباب الى الداخل. ضغط أنفه على المشربية، حتى قبل ان يفتح الباب المؤدي الى الشارع. في الخارج كان ثمة مجموعة من الأولاد، حين فتح الباب على مصراعيه تفرق الأولاد. عادة في مثل هذه الساعة، لا يتواجد أحد في الشارع. الآن لم يكن هناك فقط الأولاد. كان يوجد مجموعات من الناس تحت اشجار اللوز. تأمل «الأب» الشارع الغارق في القيظ فبان له الأمر. أغلق الباب على مهل ثانية.
«إنتظري لحظة»، قال للمرأة دون ان ينظر إليها
ظهرت شقيقته عند الباب البعيد مع سترة سوداء فوق قميص نومها فيما شعرها منسدل فوق اكتافها. نظرت بصمت الى الأب.
«ماذا هناك؟» سالها
«لاحظ الناس وجودهما» تمتمت شقيقته
«الأفضل خروجكما من الخلف الى الغناء»، قال «الأب»
«الوضع نفسه هناك أيضاً، قالت شقيقته متابعة، «كل الناس واقفة الى النوافذ».
لم يكن قد حظيت المرأة ما يجري حتى الآن. حاولت النظر الى الشارع عبر عين المشربية. من ثم تناولت باقة الأزهار من الفتاة وبدأت بالتحرك صوب الباب. لحقت الفتاة بها.
«إنتظرا الى ان تغرب الشمس». قال «الأب». «ستذوبان»، اضافت شقيقته، وهي واقفة بلا حراك عند مؤخرة العربة. «إنتظارا وسنعيركما مظلة».
«شكراً»، قالت المرأة «لا بأس بحالنا الحاضرة»
بعدها أخذت الفتاة من يدها وخرجتا الى الشارع.