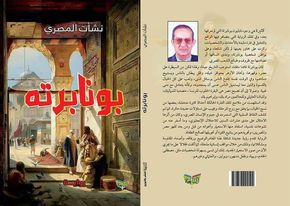اد. عادل الأسطة : إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني: محمود درويش نموذجاً (ملف/6)
2017/09/09 ملفات 2 تعليقان 196 زيارة
إشارة :
بمناسبة ذكرى رحيل شاعر فلسطين والعروبة؛ الشاعر الكبير “محمود درويش” ، تفتتح أسرة موقع الناقد العراقي هذا الملف عن الراحل الكبير وتدعو الأحبة الكتاب والقراء للمساهمة فيه بالمقالات والصور والوثائق. تحية لروح شاعر فلسطين والعروبة في عليّين.
المقالة :
تمهيد :
ترمي هذه الدراسة الى متابعة التغيرات التي يجريها محمود درويش على شعره، وبالتحديد تلك التغيرات التي تتم بناء على تغير في الموقف السياسي للشاعر(1)، أو بناء على إشكالية سياسية تثيرها القصائد التي يكتبها أو بناء على بعض المفردات التي ترد فيها. وهي بذلك تلقي الضوء، إلى حد ما، على علاقة الشاعر بالسياسي في الأدب الفلسطيني (2) .وكان شاكر النابلسي في كتابه “مجنون التراب: دراسة في شعر وفكر محمود درويش قد وقف إزاء هذه الاشكالية وقفة متأنية لا أرى ضرورة لتكرارها(3).
وتعد هذه الدراسة مكملة لبحث عنوانه “ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية” نشر في مجلة النجاح للأبحاث عام 1995، وقد نشر جزء منه على صفحات مجلة تابعة للجبهة الشعبية، تصدر في الأردن، في صيف 1993، تحت عنوان “محمود درويش .. هل يبحث عن مجد شخصي؟ ”
وما دفعني، مجددا، الى الكتابة في هذا الموضوع، النقاش الذي دار بيني وبين الشاعر، في اللقاء الذي عقدته وزارة الثقافة الفلسطينية، في مقرها، في رام الله، بتاريخ 9/5/1996. وقد كرر الشاعر، يومها، مقولة الناقد الاسرائيلي (حاييم غوري): “الشعر لا يكذب” التي أوردها (غوري) في نقده قصيدة درويش المشهورة: “عابرون في كلام عابر” (1988).
وكما هو معروف، فقد أثارت القصيدة، في حينه، ضجة كبيرة (4) .
منهج الدراسة :
يوظف الدارس هنا مصطلحي نقد الرواية “الزمن الكتابي (الابداعي)” “والزمن الروائي” لقراءة القصائد، ويستخدم الأول كما هو، قاصدا به زمن كتابة القصيدة، ويستخدم الثاني للاشارة الى الزمن المصوغ شعرا، مستبدلا كلمة الروائي بكلمة الشعري. وكما هو معروف فان المقصود بالزمن الروائي هو الزمن الذي تجري فيه أحداث الرواية(5) .
ويحيل الدارس النص الشعري إلى ما هو خارجه، فيقرأه بما يعرفه عن كاتبه وبما كتب عنه أيضا، وان كان هذا يجعل من الدراسة دراسة أدبية سياسية في الوقت نفسه.
ويفيد الدارس من قراءاته للمنهج البنيوي في أثناء قراءة النصوص. وهو بذلك يربط بعضها ببعض لملاحظة الصلة بينها. حقا إنه لا يبحث عن بنية النص وصلتها ببنى النصوص الأخرى- كما فعل (ريفاتيري) الفرنسي حين درس قصيدتين لـ (بودلير) الفرنسي قاصدا تتبع بنية كل منهما لملاحظة التشابه بين بنيتيهما (6) – ولكنه يحاول استنطاق النصوص باحثا عما يدور بخلد الشاعر ولا وعيه، من أجل تعزيز ما يذهب الدارس اليه.
موقف النقاد من هذه الاشكالية في حالة محمود درويش :
يقول الدكتور غالي شكري في دراسة له عن محمود درويش :
” ليس من شاعر ظلمته السياسة قدر ما ظلمت محمود درويش، فقد لعبت في حياته دور الغمامة التي حجبت احيانا وجهه الشعري الأهم.. فبالرغم من نبالة القضية الفلسطينية وشرف الانتماء اليها، الا أن درويش صاحب الموهبة الاستثنائية كان يدرك الحدود الفاصلة بين الابداع والموقف السياسي. كان يعطي ما لقيصر لقيصر وما للشعر للشعر، فإذا تطلب الكفاح من أجل القضية حزبا أو أيديولوجية أو سجونا أو معتقلات لا يتردد في اتخاذ الموقف الصحيح الى جانب شعبه. أما الابداع فشيء آخر لا يخلط بين متطلباته ومقتضيات السياسة، حتى ولو كان في السياسة ما يغري بالجماهيرية والذيوع وسعة الانتشار”.
ويتابع :
“لذلك كان شعره من قبل أن يغادر الأرض المحتلة الى اليوم بحاجة الى رؤى لاعادة التقييم في ضوء الشعر لا تحت أضواء السياسة” (7) .
ومطلب غالي شكري هو مطلب محمود درويش الملح. يقول محمود درويش في مقابلة أجريت معه على إثر نشر قصيدته “أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي” :
“لقد ركز بعضهم على عبارة “معاهدة الصلح” وأضاف: “ولو كنت أعرف أن هذه العبارة سوف تسرق اهتمام القارئ الحديث أو المراقب الصحفي والمجتمع السياسي العربي الى هذا الحد لكنت تخليت عنها. وسأسمح لنفسي، في أية طبعة جديدة، بتغييرها، ليس تنصلا من المدلول، ولكن حرصاً مني على إبقاء القارئ في الحقل الإجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها، وليس لعبارة واحدة سمح التأويل بتحويلها الى لافتة أو شعار” (8) .
ويتساءل المرء، ومعه حق في ذلك، ان كان قارئ محمود درويش يستطيع ان يفصل فصلا مطلقا بين شعره ومواقفه السياسية من ناحية، وبين محمود الشاعر ومحمود السياسي من ناحية ثانية، ويعتمد في ذلك على أمور عديدة أبرزها :
أولا : لقد اختلط في أشعار الشاعر الأولى الخطاب الشعري بالخطاب السياسي، ونظر الى محمود على أنه شاعر وسياسي معا. وقد وصل الأمر ببعض دارسيه الى إسقاط الواو دون إسقاط ما بعدها.
ثانيا : واستمرت هذه النغمة في أشعار الشاعر التي كتبها حتى فترة متأخرة تقريبا. ولا يستطيع أي قارئ لديوان “حصار لمدائح البحر” إغفال ذلك، وتحديدا في قصائد “بيروت” و”مديح الظل العالي” و “اللقاء الاخير في روما”.
وقد نعت درويش قصيدة “مديح الظل العالي”، في طبعة المجلد الثاني من أعماله الصادر عام 1984 عن دار العودة، نعتها على انها “قصيدة تسجيلية”.
ثالثا : لم يبتعد درويش في فترات حياته عن الساحة السياسية، فقد قبل، لفترة من الزمن، عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت . ف، وكتب غير مقالة تدرج تحت باب الأدب السياسي.
وفوق ذلك كله لا يخفى على غالي شكري ومحمود درويش معا أن النص هو، في نهاية الأمر، مثير يستجيب له القراء استجابات متعددة. ولا أعتقد أن درويش قادر أن يبقي “القارئ في الحقل الجمالي والتــاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”. وهو إن فعل ذلك فانما يحيل القراء جميعا إلى زمن اخر، زمن واحـد، وهو ما لا يستطيع عليه أي شاعر، فزمن القارئ، كما هو معروف، زمن متعدد بتعدد ثقافات القراء في الزمن نفسه.
ويذهب الدارس الى ما هو أبعد من ذلك. لم يستطع درويش حتى وهو يقرأ من ناقد أديب مثقف، هو ادوارد سعيد، أن يبقيه “في الحقل الجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”، ولنقرأ ما يكتبه ادوارد سعيد حول القصيدة :
“القصيدة المترجمة في هذا العدد “أحد عشر كوكبا على الأندلس” كتبت ونشرت في عام 1992. ولقد انبثقت من ثبات مناسبات متباعدة: الذكرى الـ 500 للعام 1492 [سقوط غرناطة، رحلة كولومبوس]، سفر درويش إلى اسبانيا للمرة الأولى، وأخيرا قرار م. ت. ف الاشتراك في عملية السلام تحت رعاية روسية – أمريكية وانعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول 1991″.
ويتابع :
“والحق أن هذه المقطوعات الشعرية تنطوي على نغمة الكلل وهبوط الروح والتسليم بالقدر، والتي تلتقط – عند العديد من الفلسطينيين – مؤشر الانحدار في أقدار فلسطين التي، مثل الأندلس، هبطت من ذروة ثقافية كبرى إلى حضيض قطيع من النقد، على صعيد الواقعة والاستعارة معا. لكن هذا يفسر جانبا واحدا من جوانب القصيدة. فالعنوان في الأصل العربي هو ببساطة “أحد عشر كوكبا” ولقد أضيفت عبارة “على الأندلس” لايضاح الخلفية المعاصرة للقصيدة” (9).
ولا يستغرب القارئ، بعد قراءة رأي سعيد، أن يرى القارئ العربي أو المراقب الصحفي أو المجتمع السياسي العربي أن درويش يعبر في القصيدة عما يجري، الآن، على الساحة الفلسطينية.
وثمة قضية أخرى يجدر، الآن، الإشارة إليها، لأنها ستوضح نقطتين سيؤتى على ذكرهما بوضوح أكثر وهما: تأثير النص على القارئ واستجابة الأخير له، وصوت المتكلم في القصيدة وأعني بذلك: من هو المتكلم في القصيدة ؟.
لقد كتب محمود درويش في عامي 86/1987 العديد من القطع الشعرية الساخرة، ونشرها على صفحات مجلة “اليوم السابع” الصادرة، في حينه، في باريس، تحت عنوان ” من خطب الدكتاتور الموزونة”، ولم يجمعها، حتى الآن، في كتاب (10).
وقد التفتت إلى إحداها بعض الصحف العربية ونشرتها على صفحاتها، دون أن تلتفت إلى تاريخ كتابتها أو تحديد الشخص المتكلم فيها. وقدم معيد نشرها إليها بما يلي:
“الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش الذي استقال من عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف احتجاجا على الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي كتب قصيدة جديدة بعنوان “خطاب السلام” عبر فيها عن موقف الرافض من اتفاق غزة أريحا بأسلوب تهكمي لاذع”(11) .
وقد قرأ حسن عبد الله المحرر الأدبي في جريدة “كنعان” القصيدة، دون أن يلتفت أيضا إلى زمن نشرها ولسان المتكلم فيها، وعقب عليها قائلا :
“أعرب محمود درويش كبير الشعراء الفلسطينيين عن موقفه الرافض لاتفاق غزة اريحا خلال قصيدته الأخيرة” خطاب السلام” التي تهكم فيها على الحكم الذاتي، ونسج من حروفها وشاح المرحلة السوداء…”
وتابع : “وقد تضمنت القصيدة مفارقات غاية في الغرابة، تستند إلى معرفة دقيقة لطبيعة التفكير القيادي الذي لم يكن درويش بعيدا عن أجوائه” (12) .
وقد عقب الشاعر على سوء الفهم الناجم عن قراءة النص، وأوضح أن الخطاب ليس ذا صلة إطلاقا بالاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي. وأكد “أن اجتزاء بعض تلك الخطابات والادعاء بأنها كتبت بعد اتفاق أيلول يفتقد إلى النزاهة، وينبغي الإشارة إلى سياق الخطاب وزمنه، وبعكس ذلك يصبح تزويرا” (13)
وعلى الرغم من أن ما يقوله الشاعر صحيح إلا أن نشر النص وفهمه يعكسان، بوضوح أهمية المقولات النقدية السابقة. فقد استجاب له القراء استجابات مختلفة (14) وترك زمن القراءة أثره عليه. وهو فوق ذلك يلقي بالظلال على نفسية الشاعر.
لقد رفض درويش اتفاقيات (كامب ديفيد)، في حينها، وسخر من أنور السادات سخرية مرةً . وهو برفضه هذا كان يرفض الحكم الذاتي الذي وافق عليه الفلسطينيون، فيما بعد، واستقال درويش، على إثر قبوله، من عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف.
والسؤال الذي يثار هنا: ما الذي يحدو بدرويش، إذن، رفض نشر الخطاب “خطاب السلام” الآن؟
رضوخ الثقافي للسياسي :
ذهبت بعض الدوريات(15) إلى أن قصيدة “للحقيقة وجهان والثلج أسود” أثارت غضب السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف ، في حينه، وأنه، تبعا لذلك، استدعى الشاعر الذي كان يقيم في باريس ليستفسر منه عما يقصده في القصيدة.
ولا يستغرب المرء، ما ذكر أعلاه، فقد أبدى الشاعر استعداده لحذف كلمات من القصيدة واستبدالها بأخرى، وهو ما لاحظناه في عبارته السابقة. وهذا ما أقدم عليه درويش فيما بعد. وهكذا يرضخ الثقافي للسياسي.
وقد يرد الشاعر على هذا الرأي، ويذهب إلى أنه يفعل ذلك دائما. وثمة ما يؤكد ذلك. فمن يقرأ بعض قصائده التي نشرها على صفحات “شؤون فلسطينية” أولا ثم أعاد نشرها، فيما بعد، في مجموعات شعرية، يلحظ أن الشاعر يفعل ذلك دون ضغط من أحد. وخير مثال على ذلك قصيدة “بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا” التي نشرت في ديوان “محاولة رقم 7” (1974). لقد نشرها الشاعر على صفحات “شؤون فلسطينية” تحت عنوان “حوار مع مدينة” (16) ولم تبد في الديوان كما ما بدت على صفحات المجلة. ثمة تغيير واضح يلحظه المرء، وهو ما يبدو أيضا في قصيدة “الرمل” التي نشرت على صفحات “شؤون فلسطينية” ثم أعيد نشرها على صفحات ديوان “أعراس” (1977).
ويتكلم المرء، هنا، عن ثلاثة أنواع من التغيير في أشعار الشاعر. التغيير الجمالي والتغيير السياسي والتغيير الديني، وما يهمنا هنا هو الثاني، وان كان في هذا ظلم للشاعر(17).
ومن يقرأ قصيدة “للحقيقة وجهان والثلج أسود” في الطبعة الصادرة عام 1994 عن دار الآداب، ويقارنها بطبعات ديوان “احد عشر كوكبا”، يلحظ أن الشاعر أبر بوعده.
فما هي مواطن التغيير ؟ وما دلالة ذلك؟
أولا : يلاحظ الدارس لدواوين الشاعر في طبعاتها المختلفة أن هناك اختلافا في طبعتي ديوان ” أحد عشر كوكبا” الصادرتين في الأرض المحتلة. وكانت إحداهما تصويرا عن طبعة صدرت في المشرق العربي، وثانيتهما تصويراً عن طبعة صدرت في المغرب العربي. ويبرز موطن الاختلاف في السطر الخامس عشر من القصيدة المذكورة “للحقيقة وجهان..” إذ يرد السطر في طبعة دار العربي (18).
“إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار”
في حين يرد في طبعة دار الجديد (19):
“إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار”
ثانيا : تختلف الصيغة الواردة في طبعة دار العودة عنها في الطبعتين المذكورتين ويصبح السطر الناص
“… يتلو علينا” معاهدة الصلح ” يا ملك الاحتضار”
على النحو التالي :
” … يتلو علينا ” معاهدة اليأس” يا ملك الاحتضار”
ويصبح السطر الناص :
” فلماذا تطيل التفاوض، يا ملك الاحتضار؟ ”
على النحو التالي :
“فلماذا تطيل النهاية، يا ملك الاحتضار؟ ”
وتلتزم طبعة دار العودة بما ورد في طبعة دار العربي – أي طبعة المغرب العربي – في السطر الناص:
“إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار”.
ثالثا : تجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن الشاعر أعاد نشر قصيدة “عابرون في كلام عابر” في كتاب يحمل عنوان القصيدة، ويحتوي على مقالات نثرية فقط، منها ما له صلة بالقصيدة، ومنها ما لاصلة له بها.
وقد تيسر لي، مؤخراً، الاطلاع على الطبعة الثانية الصادرة عام 1994 عن دار العودة التي لم يشر صاحبها إلى تاريخ الطبعة الأولى. وبناء على ذلك فإنني لا أستطيع أن اجزم إن كان الشاعر اطلع على الدراسة المنشورة عام 1993، والمشار إليها في بداية هذه الدراسة. ومع ذلك يظل سلوك الشاعر موضع سؤال، ويحتاج إلى دراسة. فما معنى أن ينشر قصيدة شعرية في كتاب نثري؟ وليست القصيدة هذه هي الأسوأ فنيا في شعر الشاعر. وهي لا تختلف في لهجتها ووضوحها عن قصيدة “مديح الظل العالي” وعن قصائد أخرى كتبها الشاعر تحت وطأة لحظة زمنية قاسية مرعبة.
وهنا يتساءل الدارس : ما هي الإشكاليات العديدة التي تثار جراء تغيير الشاعر بعض المفردات واستبدالها بأخرى ؟
يثير التغيير، كما يرى الدارس، عدة إشكالات أهمها :
أولا : تبعية الأديب للسياسي والرضوخ لأوامره.
ثانيا : تخلي الشاعر عن مواقفه والتراجع عما يراه ويعتقده. ويقوده الرضوخ: إلى تعزيز ظاهرة الشاعر التابع وتقويض ظاهرة الشاعر الشهيد؛ الشاعر الملتزم بالكلمة. وتصبح المقولة التي كررها “الشعر لا يكذب” مقولة مفرغة من محتواها، وتحتل مكانها مقولة أخرى هي: “أجمل الشعر أكذبه”، وتحيلنا هذه العبارة إلى تفسيرات محمود درويش المبهمة لها:
“إذا كذب الشعر أو الشاعر فهو كذب جمالي يقدم مبررات جمالية لوجود مهدد أحيانا. قول العرب القديم الذي قابلناه بسخرية: “إن أعذب الشعر أكذبه” يجب ألا نتعامل معه تعاملا بسيطا، فالكذبة الجمالية ذات ملابسات ومبررات أعمق بكثير من الكذبة الأخلاقية لارتباطها بطبيعة الإبداع الخاصة، لأن كل صورة شعرية،إذ قارنا بينها وبين الواقع فهي كذبة أو هي واقع محور.
وقد نقول أيضا “إن أعمق الشعر أصدقه”، فالصدق هنا له معنى آخر غير المعنى الأخلاقي. الشاعر في هذه الحالة لم يكذب. لا الشاعر كذب على القصيدة، ولا القصيدة كذبت على الشاعر، ولا الشعر كذب على الشعر”(20).
ثالثا : ويتحول الأديب هنا إلى سياسي يتعامل مع الراهن، فيتغاضى عن الحقيقة ويتجاهل ذكرها ولا يجرؤ على إشهارها، وذلك من أجل تسيير أموره، وهو الحلقة الأضعف في عالم يقمع فيه السياسي كل من يخالفه الرأي مباشرة. وهكذا يرضخ من لا يملك سوى الكلمات إلى من يملك المسدس والمال. ويؤكد هذا الرأي – بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل رغبة الشاعر في التنقل من مكان إلى آخر وحصوله على إقامة في هذا البلد أو ذاك – عدم جمع خطب الدكتاتور الموزونة، حتى الآن، في كتاب، وعدم ضم بعض المقالات النثرية المهمة، مثل المقال الذي نشره درويش تعقيبا على خطاب الملك حسين بعد فشل التنسيق مع م. ت. ف في النصف الثاني من الثمانينيات، إلى ما نشره نثرا في كتاب(21).
وأقف الآن عند نقطة مهمة كانت موضع جدل مع الشاعر في أثناء حديثه، في اللقاء المذكور، وهي أنه لم يكن، في قصيدته “أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي”، يعبر عن الواقع الراهن.
لا يذهب كثير من الدارسين النقاد، وبخاصة الآن، إلى الأخذ بالمقولة النقدية القديمة “المعنى في بطن الشاعر”، معتمدين على مقولات نقدية معاصرة أبرزها ما ذكرته، ابتداء، من أن النص مثير والقارئ متعدد، وأن المعنى غير مغلق، بمعنى آخر: ليس هناك تفسير نهائي لنص من النصوص (22).
وتقتضي الضرورة، هنا، التركيز على مصطلحي الزمن الكتابي والزمن الشعري.
يكتب درويش نصه الشعري، عام 1992، عن سقوط غرناطة الذي تم قبل 500 عام. وهو يكتب ما يكتبه وفق رؤية معاصرة اعتمدت على ما كتب حتى هذه اللحظة. ومن المؤكد أن النص ما كان ليكون على ما هو عليه لو كتب قبل 500 عام. وهذا ما يؤكده لنا شكل القصيدة الذي ينتمي إلى ما بعد عام 1947. ويعزز ذلك أيضا ظهور مفردات ما كانت معروفة عام 1492 مثل (كولومبوس، لوركا، غيتار). وان كان (كولومبوس) عاش في ذلك العام، إلا أنه، على ما يرجح، لم يكن معروفا للشعراء العرب، في حينه .
واذا كانت هذه المفردات قد سقطت، في القصيدة، سهوا، فلماذا لا تسقط ايضا رؤية الشاعر لما يجري الآن في فلسطين على ما جرى، من قبل، في الأندلس؟ ويعتبر محمود درويش واحدا من كثيرين يرون في فلسطين أندلساً جديدة (23) .
ويمكن أن يوضح الدارس هذا من خلال قراءة لقصيدتين وردتا في ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” (1995) هما: “من روميات أبي فراس” و “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” . وكما هو واضح فان القصيدتين تتمحوران حول شخصيتين تاريخيتين تنتميان إلى العصر الجاهلي والعصر العباسي. وهكذا يختلف فيهما الزمنان: الكتابي والشعري. فهل استطاع درويش فيهما أن يتمثل العصرين تمثلا كليا ليعبر عن الشخصيتين دون إسقاط رؤية معاصرة، هي رؤيته الخاصة ؟
يدرج الشاعر قصيدة “من روميات أبي فراس” مع قصائد آخر تحت عنوان فرعي هو “غرفة للكلام مع النفس”، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قصيدة “تدابير شعرية” لتليها، على التوالي، القصائد التالية: “من سماء الى أختها يعبر الحالمون” و “قال المسافر للمسافر .. لن نعود كما ” و “قافية من أجل المعلقات” و “الدوري كما هو، كما هو”.
وليس اختيار العنوان اختيارا عشوائيا، ويمكن قول الشيء نفسه عن إدراج القصائد تحته. ولا يخطئ حســين حمودة الذي قرأ الديوان حين كتب عنه “تستقل، ظاهريا، كل قصيدة، وكل قســـم، من قصائــد الديوان وأقسامه، بملامح خاصة، ولكن هذا الاستقلال الظاهري ينطوي على عالم فني واحد، يربط هذه القصائد والأقسام في سياق متصل، إذ تلتف كلها حول دلالات الغياب، وحول مستويات الوعي به.. (24).
” تتردد هذه العناصر والمفردات، خلال القصائد، وتتكرر تكرارا لافتا، لتسهم في صياغة “أسطورة” خاصة بالشاعر، خفية، كامنة، متجذرة في قصائد الديوان جميعا، مما يجعل من عوالم هذه القصائد عالما ممتدا، ومن نصوصها نصا متصلا، برغم تنوع هذه القصائد، وبرغم تباين مراحل الغياب التي تلتقطها وترصدها على مستويات الوعي والذاكرة والزمن جميعا.. (25).
وبناء عليه يشير أيضا إلى ترابط قصائد “غرفة للكلام مع النفس” واتصالها فيما بينها. وأرى أن ثمة رابطاً يربط بين قصائد هذا القسم، فدرويش، في القصيدة الأولى، يكتب، وفي الثانية ينطق شاعرا أسيرا، ويصور، في الثالثة، الفراشة المتنقلة بلا قيود، ويطلب المسافر، في الرابعة، من المسافر أن يكتب حكايته، وأتي، في الخامسة، على ذكر المعلقات التي ينبغي أن يخلفها نثر الهي لينتصر الرسول، في حين يشكل الدوري، في السادسة، النقيض للمتكلم الجالس في منزله مأهولا بالوقت. ويبدو فضاء القصائد فضاء واحدا: تنتظم القصائد الستة حالة واحدة للمتكلم/ الشاعر هي “غرفة للكلام مع النفس”.
وبناء على ما سبق تبدو أية قراءة لأية قصيدة منعزلة عن بقية القصائد، قراءة ناقصة غير مكتملة، وان بدت “من روميات أبي فراس” ذات خصوصية معينة، إذ يستحضر درويش فيها شاعرا عربيا عاش في القرن الرابع الهجري، ويتقمص شخصيته، ليعبر من خلالها، عما يجول في خاطره، وهو في منفاه في الأسر – أي الحمداني هنا -، بطريقة يكتب فيها الشاعر العربي المعاصر الذي ينتمي إلى ما بعد عام 1947، عام بزوع القصيدة الحديثة الشكل.
ولا يرى المرء كبير فرق بين حالتي الحمداني ودرويش: كلاهما يعيش منفيا عن وطنه، وإن اختلف سبب النفي: الأسر في حالة الأول، والهجرة في حالة الثاني، وهي هجرة بدت طوعية، ولكنها سرعان ما أصبحت قسرية، فقد أصبح الشاعر في وضع لا يستطيع فيه العودة إلى مسقط رأسه، إن رغب في ذلك. ويسترجع درويش، وهو في منفاه، بعض ماضيه في حيفا، وبخاصة تجربته في السجن، وهنا تتشابه تجربته وتجربة الحمداني.
ويثار، في أثناء قراءة هذه القصيدة التي صيغت بضمير المتكلم، سؤال مهم هو: من هو المتكلم في هذه القصيدة؟ هل هو الحمداني أم هو محمود درويش؟ ويتلو هذا السؤال سؤال أخر هو: عم يتكلم ؟ (26).
إذا قيل ان المتكلم في قصيدة “من روميات أبي فراس” هو الحمداني، فهناك ما يؤيد ذلك، وهناك ما ينفيه أيضا. يستحضر “أنا المتكلم” مفردات تاريخية ارتبطت بأبي فراس وتجربته، ووردت في أشعاره:”الحمامة وحلب وابن عمي وروميات، و فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى، والخيل والغزوات”. ولكن المتكلم يورد كلمات لا تنتمي إلى عصر الحمداني. وورودها – إن أصر الشاعر على أن الناطق هو أبو فراس – يجعل في النص مفارقة تاريخية تتمثل في وضع شيء في غير زمانه الصحيح (استعمال يوليوس قيصر التلفون أو ركوبه الطيارة)، وهو هنا، في حالة أبي فراس، وجود القطار وشكل القصيدة.
ومن يقرأ النص، مستعينا بما هو خارجه، أي بناء على معرفته لحياة محمود درويش وما مر فيه من تجارب، وما قاله هو شخصياً بهذا الخصوص، يعرف أن درويش، في القصيدة، يعبر عن ذاته.
وتبين النصوص المقتبسة من القصيدة تأثير الزمن الكتابي على الزمن الشعري، وتشير الى أن أنا المتكلم هو درويش لا الحمداني(27).
يرد في القصيدة :
ثمة أهل يزورننـا
غدا في خميس الزيارات . ثمة ظل
لنا في الممر . وشمس لنا في سلال
الفواكه ثمة أم تعاتب سجاننا :
لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا
شقي ؟
و :
وزنزانتي اتسعت، في الصدى، شرفة
كثوب الفتاة التي رافقتني سدى
الى شرفات القطار، وقالت : أبي
لا يحبك. أمي تحبك . فاحذر سدوم غدا .
يكتب الشاعر نصه الآن (1995) عن شاعر عاش في القرن الرابع الهجري، حيث لم يكن القطار موجودا، ولم تكن القهوة مكتشفة. وهنا يبدو تأثير الزمن الكتابي على الزمن الشعري واضحا. ويعزز هذا ما يذكره الشاعر في المقابلة التي أجراها معه عباس بيضون :
” وأنا في السادسة عشرة من عمري زارتني أمي في السجن، وحملت لي قهوة وفواكه، واحتضنتني وقبلتني” (28).
ويقول أيضا :
“أحببت مرة فتاة لأب بولندي وأم روسية. قبلتني الأم ورفضني الأب. لم يكن الرفض لمجرد كوني عربيا. ذلك الحين لم أشعر كثيرا بالعنصرية والكره الغريزي. لكن حرب 1967 غيرت الأمور “(29).
ونعود إلى عبارة الشاعر التي فسر فيها إقدامه على استبدال كلمات بأخر: “ولكن حرصا مني على إبقاء القارئ في الحقل الجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”، فهل نجح الشاعر في ذلك؟ وهل سيقرأ القارئ القصيدة وذهنه منصرف إلى ما حدث، في حينه، في الاندلس؟ أم أنه سيرى سقوط فلسطين في سقوط غرناطة. وهذا ما رآه ادوارد سعيد؟
هنا يمكن أن نقف عند قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” فقد تسعفنا قراءتها في الاجابة عن السؤال وتوضيح فكرتنا، أكثر مما تسعفنا القصيدة السابقة، وذلك لأنها ذات بعد سياسي واضح.
لا تختلف هذه القصيدة عن السابقة وعن قصائد أخرى عبر فيها الشاعر عما يجول في خاطره من خلال قناع، أبرزها – أي القصائد – “رحلة المتنبي إلى مصر” التي كتبها عام 1978 ونشرها في مجموعة “حصار لمدائح البحر”(30).
وتشير ظاهرة اللجوء إلى قناع للتعبير من خلاله، بوضوح، إلى إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني بخاصة، وفي الأدب المكتوب في ظل أنظمة قمعية بعامة. وهي في الأدب الفلسطيني ذات بعد خاص، وذلك لأن الشعر الفلسطيني في جانب منه كان شعرا سياسيا وكتب تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يحارب الشعر المعادي للسلطة الإسرائيلية، ولم يكن الأمر، على هذه الشاكلة، فيما يخص الشاعر والمؤسسة الفلسطينية لأن الانسجام بينهما، إلا في حالات نادرة، كان كبيرا. وهو في حالة درويش خير دليل على ذلك، فالعلاقة بين القيادة السياسية وبينه علاقة جيدة عموما، ولم تعتورها إشكالات الا في حالات قليلة هي التي سنقف عندها، وأشار اليها محمود درويش أحيانا (31) .
ويدرج الشاعر قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” مع قصائد أخرى هي “شهادة من برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية 1967” و “متتاليات لزمن آخر” و “عندما يبتعد “يدرجها تحت عنوان فرعي هو : “أغلقوا المشهد”.
ويتساءل القارئ عن الضمير في أغلقوا وعن المشهد الذي أغلق. ويجد الإجابة عموما من خلال القصائد الأربعة معا (32)، وان بدت الإجابة أوضح ما تكون في قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس”.
ويوصل تحليل القصائد والبحث عن الثنائيات الأساسية فيها، يوصل القارئ في النهاية إلى أن هناك رابطا بينها، والى أن الشاعر يرمي، في النهاية، إلى التعبير عن المشهد الشرق أوسطي. وأن بريخت، مثله مثل امرئ القيس، ليس سوى قناع يختفي وراءه شخص محدد . وكما هو معروف، فإن (بريخت) الألماني، وهو كاتب مسرحي مشهور، توفي عام 1956، ولم يشهد حرب 1967، ليكون شاهدا عليها.
تقوم قصيدة “شهادة من برتولد بريخت أمام محكمة عسكرية 1967” على ثنائية الضحية التي تحولت إلى جلاد والضحية الجديدة – أي عرب فلسطين. وليس المتكلم في النص، وهو، كما يشير العنوان، (برتولد بريخت)، سوى قناع للشاعر الذي يشهد عما جرى في حرب 1967، ويدلي، بناء على ذلك، بشهادته أمام المحكمة التي هي محكمة عسكرية. وتعبر القصيدة عما يفعله الإسرائيليون بالعرب الفلسطينيين.
لقد بدأ المشهد، في الديوان كله الذي أرى أنه كتاب متكامل، باطلالة الشاعر المنفى على ما يريد، وبتأريخه لمأساته – مأساة شعبه منذ التهجير عام 1948. وبدأ المشهد في “أغلقوا المشهد” بحرب حزيران 1967 وانتهى بتوقيع الصلح وبغناء الشاعر لزمن آخر “متتاليات لزمن آخر”. وعاد الشاعر – المتكلم في نص “خلاف، غير لغوي … ” إلى غده ناقصا، وهي عبارة وردت على لسان محمود درويش في الكلمة التي ألقاها، في حيفا، في تأبين الراحل إميل حبيبي (33) بتاريخ 4/5/1996. وهكذا إذا استعنا بما هو خارج النص لنفهم النص أدركنا أن صوت درويش هو المسموع في القصيدة :
” … ثم انحنينا نسلم
أسماءنا للمشاة على الجانبين. وعدنا
إلى غدنا ناقصين”
وتقوم قصيدة “خلاف …” على ثنائية المنتصر والمهزوم. الأول الذي أخذ ما يريد والثاني الذي لم يجد نجمة للشمال ولا خيمة للجنوب، ولم يتعرف على صوته أبداً.
وتبرز هذه الثنائية، بوضوح، في قصيدة “عندما يبتعد”، إذ لا يختفي الشاعر فيها وراء قناع، وبالتالي فان القارئ لا يتساءل عمن يكمن وراء القناع.
يقول درويش فيها :
“للعدو الذي يشرب الشاي في كوخنا
فرس للدخان … ”
“لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض
فينا تدور على نفسها !
فلنكن طيبين إذا . كان يسألنا
أن نكون طيبين. ويقرأ شعرا
لطيار “ييتس” : أنا لا أحب الذين
أدافع عنهم، كما أنني لا أعادي
الذين أحاربهم” .
والكلام الذي يرد على لسان الطيار هو كلام صديق الشاعر الذي عرفه قبل حرب 1967 (34) .
ونعود لنثير السؤال من جديد: من هو امرؤ القيس في القصيدة؟ وما هو موقف المتكلم منه حقيقة؟ ومن هم أيضا الذين أغلقوا المشهد ؟ ومن هم الذين عادوا إلى غدهم ناقصين؟
تتكون القصيدة من خمسة مقاطع، تبدأ ثلاثة منها بعبارة ” أغلقوا المشهد” وهي المقاطع 1، 2،4، ويقابل الضمير (هم) الضمير (نحن). والضمير الأول (هم) الفاعل القوي في حين أن الضمير (نحن) يمثل المهزومين الذين سمح لهم العودة إلى غدهم ناقصين. وهم، في المقطع الثاني، الذين انتصروا، وهم الذين عبروا أمسنا كله. وينتهي المقطع الأول بهزيمة النحن، في حين ينتهي المقطع الثاني بانتصار (هم) بعد أن غيروا جرس الوقت. ويركز المقطع الثالث على اعتذار (النحن) عن المفردات التي اهترأت مثل وصف حرية لم تجد خبزها ووصف خبز بلا ملح حرية. ويقول المقطع الرابع ما أصبحوا (هم) عليه: لقد انتصروا وصوروا ما يريدونه من سماوات الـ (نحن) نجمة نجمة حاصلين على ما يريدونه. ويكثف المقطع الخامس شعور الـ (نحن) بالهزيمة، فقد خسر(نا) كل شيء ولم نعد كما كنا (لم نتعرف على صوتنا أبدا). ويوجه الخطاب الى امرئ القيس الذي اتكأ، يوم وقع، على لغة بعثرت قلبها عندما غيرت دربها – أي تغيير الدرب الثوري الى درب الاستسلام – ، وتنتهي القصيدة بالمقطع التالي :
لم يقل أحد لامرىء القيس : ماذا صنعت
بنا وبنفسك ؟ فاذهب على درب
قيصر، خلف دخان يطل من
الوقت أسود، وحدك، وحدك، وحدك
واترك لنا، هــهنا، لغتك.
وقد يقول محمود درويش هناك من قال للقيادة التي وقعت: ماذا صنعت بنا وبنفسك؟ وأن ياسر عرفات لا يجيد اللغة ليتركها لنا. والجواب واضح: لم يقل من يسير في فلك القيادة للقيادة ما يخالف رأيها، ومن قال وخالف عاد وسار في الركب. وليس بالضرورة، هنا أن يكون المقصود باللغة اللغة الفصيحة، فقد تكون اللغة الثورية التي سمعها الشاعر من القائد قبل توقيع الاتفاق. وعدا ذلك فالخلاف، كما يقول عنوان القصيدة، ليس خلافا لغويا.
ويتساءل المرء: أليس ذهاب امرئ القيس على درب قيصر موازيا لذهاب القائد على درب (كلينتون) ؟
الخلاصة :
يتوصل المتأمل لعلاقة الثقافي بالسياسي إلى النتيجة التالية :
تظل هذه العلاقة علاقة تصالح ما دام الثقافي والسياسي يسيران معا فكرا وممارسة، فإذا ما اختلفا وجب على الثقافي أن يختار أحد الحلول التالية: المواجهة وما يترتب عليها من قمع وسجن واضطهاد وربما القتل، أو الخضوع وما يترتب عليه من تذويب الذات الثقافية في الذات السياسية وترداد خطاب الثانية وهي لا تؤمن به، أو المحافظة على وضع فيه قدر من التصالح مع الذات والآخر، وهنا لا يلجأ الثقافي إلى التعبير، عن وجهة نظرة، بأسلوب مباشر وإنما يحاور ويناور ويرتدي قناعا يختفي وراءه، أو العيش في المنفى، وهنا يتصالح المرء مع الذات فقط، وينجم عن ذلك حالات قد تكون أقسى من البقاء في الوطن مثل الغربة والاغتراب والوحدة، أو الصمت.
وإذا كان ما سبق ينطبق على المثقف الذي يعيش في ظل أنظمة دكتاتورية، وهو عموما ما لم يعرفه المثقف الفلسطيني، من قبل، إلا نادراً، فإن المرحلة الحالية، مرحلة تحول الثورة إلى سلطة، قد تضع المثقف أمام واحد من الخيارات السابقة، وهو ما لا نأمله، وان كان ما حدث مع محمود درويش، وما جرى، مؤخرا، من منع كتب ادوارد سعيد، يشير إلى أننا نسير في الاتجاه نفسه الذي سارت فيه العلاقة بين الثقافي والسياسي في العالم العربي ودول العالم الثالث وربما أيضا بعض دول العالم الأول .
([1]) ثمة إشكالية أثارها دارسو محمود درويش يوم صدرت مجموعته الشعرية الكاملة عن دار العودة خالية من بعض المفردات مثل “الشيوعية” في عبارة “يحبون الشيوعية” . واختلف الدارسون إن كان الحذف من الشاعر أو من دار العودة نفسها. حول ذلك انظر: حسين جميل البرغوثي، أزمة الشعر المحلي، القدس، 1979. ص 51 وما بعدها. وانظر دراستي “ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية” مجلة النجاح للأبحاث ، آيار 1995.
(2) حول ذلك انظر مقالتي “الابداعي والسياسي” في كتاب “تأملات في المشهد الثقافي” نابلس 1995. ص 67 – ص 73. وانظر ما نشرته مجلة “مشارف” في العدد السابع وبخاصة افتتاحية إميل حبيبي، (آذار 1996) وفي العدد الثامن تحت “ملف العدد” (نيسان 1996). وقد خاض أكثر من كاتب فلسطيني في موضوع هموم السياسي وهموم المبدع ، ونشرت الاراء في أعداد مشارف التالية: العدد الثامن، نيسان 1996، والعدد الثاني عشر، تشرين الثاني 1996، والعدد الرابع عشر، شباط 1997، والعدد الخامس عشر، آذار ونيسان 1997.
(3) أنظر الفصل الأول من كتابه المذكور، وتحديدا الصفحات 29-66. وما تنجزه دراستي هذه يكمن في انعكاس العلاقة بين السياسي والشاعر على النص الشعري مباشرة، وهي تتجاوز تتبع مواقف درويش السياسية والتغيرات التي تطرأ عليها، كما تبدو من خلال المقالات النثرية السياسية، والمقابلات التي يجريها الصحفيون معه .
(4) حول القصيدة وما آثارته انظر دراستي “ظواهر سلبية”، ص 255، وتحديدا احالات هامش (40)، و ص248 إحالات هامش 21.
(5) حول مصطلحات الزمن في الرواية انظر دراسة عبد العالي بوطيب “إشكالية الزمن في النص السردي” مجلة فصول، صيف 1993. ص 129 وما بعدها .
(6) حول ذلك انظر : مارين جريزباخ، مناهج الدراسة الآدبية، توبنغن، 1985 ط 9 ، ص 104 (بالألمانية) .
(7) غالي شكري، القاهرة، العدد 151حزيران 1995. ص 9. (محمود درويش : عصفور الجنة أم طائر النار).
(8) مجلة “تكوين”، عكا، 1993. ص 15. وقد صدر عدد واحد من المجلة .
(9) ادوارد سعيد، تلاحم عسير للشعر وللذاكرة الجمعية، مجلة القاهرة، العدد 151 حزيران 1995. ص 22 وما بعدها.
(10) لا أدري اذا كان الاستاذ طلعت الشايب اطلع على دراستي هذه، وهي دراسة أنجزت قسما منها في تموز 1996، وأنهيتها في ايلول 1996، وقدمتها لتنشر في مجلة النجاح للأبحاث، وللحصول على جائزة توفيق زياد التي تمنحها وزارة الثقافة ، وبناء على ذلك عمل على جمع خطب الدكتاتور الموزونة ونشرها في مجلة أدب ونقد المصرية، عدد 141، آيار 1997.
(11) جريد النهار المقدسية ، 6/1/1994.
(12) جريدة كنعان، 11/1/1994.
(13) النهار، 26/1/1994 نقلا عن الدستور الاردنية.
(14) عادل الاسطة، نابلس (جريدة نابلس)، 4/2/1994.ر
(15) حول ذلك انظر دراستي “ظواهر سلبية ..” .
(16) شؤون فلسطينية، العدد الخامس عشر، تشرين الثاني، 1972. ص 58 وما بعدها .
(17) ثمة مقاطع قليلة جدا في أشعار الشاعر، كتبت في فترات عصيبة، يبدو فيها ضرب من التمرد على الذات الالهية، ومنها ما ورد في قصيدة “مديح الظل العالي” التي نظمت إثر الخروج الفلسطيني من بيروت عام 1982، ومما ورد في نصها الأول :
“الله أكبر
هذه آياتنا، فاقرأ
باسم الفدائي الذي خلقا
من جزمة أفقا.”
وقد غير الشاعر السطر الأخير ليصبح المقطع في الطبعة الصادرة عن دار العودة عام 1994 (الأعمال الكاملة، المجلد الثاني) على النحو التالي :
” الله أكبر
هذه آياتنا ، فاقرأ
باسم الفدائي الذي خلقا
من جرحه شفقا”
وحول الصيغة الأولى للنص أنظر: محمود درويش ، حصار لمدائح البحر، دار الاسوار، عكا، 1984، ص 130.
(18) عكا، 1993. عن طبعة المغرب العربي .
(19) د . م ، 1993. عن طبعة المشرق العربي في بيروت .
(20) أجريت المقابلة في باريس ، ونشرتها رفيف فتوح على صفحات مجلة “الوطن العربي” الصادرة في باريس. وأعيد نشرها، هنا، على صفحات جريدة “الشعب” المقدسية في 12/8/1986.
(21) انظر جريدة “الشعب” المقدسية 21/3/1986. وأرى أن شاعرا كبيرا مثل محمود درويش يستحق أن تطبع أعماله كلها، شعرها ونثرها، دون انتقاء، وذلك لأنها لم تعد ملكا شخصيا له. وانظر ملاحظة 9 من هذه الدراسة.
(22) حول ذلك انظر حسن ناظم، مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، بيروت، 1994. ص 133 وما بعدها .
وانظر أيضا : كمال أبو ديب، الواحد / المتعدد، البنية المعرفية والعلاقة بين النص والعالم، مجلة فصول، المجلد 15، العدد 2، صيف 1996، ص 40 وما بعدها. وتحديدا المقطع الثالث في الصفحتين 42 و 43 حيث يناقش مقولة المعنى الواحد وتعدد المعنى ويقف أمام مقولات الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني بهذا الخصوص.
(23) انظر دراستي “ظواهر سلبية ..”، ص 239. وانظر مقالة ادوارد سعيد المشار اليها في هامش 8. وانظر ايضا مقالة فخري صالح، لماذا تركت الحصان وحيدا: عن اللحظة الفلسطينية الملتبسة، مجلة “فصول” المصرية، المجلد 15، العدد 2، صيف 1996. حيث يرى أن درويش ينطق المحرومين في نصوصه “في محاولة لخلق تعبير مواز وغير مباشر عن التجربة الفلسطينية” (ص 243) . ويعترف محمود درويش بأن قصيدته “أحد عشر كوكبا” التي تصور سقوط غرناطه، قصيرة تستوحي مرحلة تاريخية” وتتسرب منها دلالات الى الراهن، فلا بد لفكرتها أن تنفضح، لكنني أحسب أن بنية القصيدة تحتمل ذلك” (انظر : مشارف، عدد3، تشرين أول 1995، ص 92).
(24) حول ذلك انظر دراسة حسين حمودة “مسار النأي، مدار الغياب” مجلة القاهرة، حزيران 1995. ص 44.
(25) السابق ص 45 وما بعدها .
(26) حول ذلك انظر مقالة (إيفا هورن) في كتاب “مدخل الى علم الأدب” إعداد (ميلتوس بشليفانوس) وآخرين، شتوتجارت، 1995. ص 299 وما بعدها .
(27) يقر الشاعر بأن مجموعة “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” هي محاولة لكتابة سيرته الذاتية شعرا، وعليه ، إذا أحلنا النص الى ما هو خارج النص، فان درويش كان يتخفى وراء أبي فراس، وأن الاخير ليس سوى قناع، حول ذلك أنظر اللقاء الذي أجرته معه رلى الزين ونشرته جريدة الأيام بتاريخ 26 و 27/5/1997.
وكان درويش ، من قبل، قد ذهب الى هذا، وذلك في اللقاء الذي أجراه معه عباس بيضون. انظر مشارف 3، تشرين 1995، ص 109. وفي اللقاء المذكور يوافق درويش بيضون من أن “لماذا تركت الحصان وحيدا” ليس سيرة فرديه له وحسب، بل سيرة شعرية، ويرى أن قصيدتي “شهادة برتولت بريخت” مكتوبة بلغة الستينات ، وكذلك تقفيه القصيدة عن أبي فراس الحمداني. “اذن تجد هذا المستوى من السيرة الشعرية الذي يرافق السيرة الذاتية، لقد عدت الى ماضي ذاتي، ماضي في الكتابة، ذاتي الشعرية”.
(28) مشارف، العدد 3، تشرين الأول، 1995. ص 72.
(29) السابق ، ص 75.
(30) محمود درويش، حصار لمدائح البحر، حيفا وعكا، 1984.
(31) محمود درويش وسميح القاسم، الرسائل، حيفا، 1990. ط2. رسالة “حاضر سابق” ص 93.
(32) حسين حموده، مسار النأي، ص 50 وما بعدها .
(33) مشارف، العدد 9، حزيران 1996. ص 32. ويقول درويش في ص 34 :
“واغفر لنا يا معلمنا ما صنعت بنا وبنفسك. اغفر لنا أننا سنعود بعد قليل الى أنفسنا ناقصين”.
(34) مشارف، العدد الثالث ، تشرين الأول، 1995. ص 76. يقول محمود درويش :
“في قصيدتي” جندي يحلم بالزنابق البيضاء” كتبت عن هذا الصديق الذي جاءني بعد الحرب ليقول لي انه قرر أن يغادر البلاد نهائيا. لأنه لا يستطيع أن يبقى ترسا في آلة حربية. كانت انسانيته عالية، وتربيته قائمة على التعدد والانفتاح على الاخر. جاء الى اسرائيل وفي باله مشروع انساني فوجد ان الحقيقة غير ذلك. لذا هاجر ورحل….” .
* عن

 www.alnaked-aliraqi.net
www.alnaked-aliraqi.net
2017/09/09 ملفات 2 تعليقان 196 زيارة
إشارة :
بمناسبة ذكرى رحيل شاعر فلسطين والعروبة؛ الشاعر الكبير “محمود درويش” ، تفتتح أسرة موقع الناقد العراقي هذا الملف عن الراحل الكبير وتدعو الأحبة الكتاب والقراء للمساهمة فيه بالمقالات والصور والوثائق. تحية لروح شاعر فلسطين والعروبة في عليّين.
المقالة :
تمهيد :
ترمي هذه الدراسة الى متابعة التغيرات التي يجريها محمود درويش على شعره، وبالتحديد تلك التغيرات التي تتم بناء على تغير في الموقف السياسي للشاعر(1)، أو بناء على إشكالية سياسية تثيرها القصائد التي يكتبها أو بناء على بعض المفردات التي ترد فيها. وهي بذلك تلقي الضوء، إلى حد ما، على علاقة الشاعر بالسياسي في الأدب الفلسطيني (2) .وكان شاكر النابلسي في كتابه “مجنون التراب: دراسة في شعر وفكر محمود درويش قد وقف إزاء هذه الاشكالية وقفة متأنية لا أرى ضرورة لتكرارها(3).
وتعد هذه الدراسة مكملة لبحث عنوانه “ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية” نشر في مجلة النجاح للأبحاث عام 1995، وقد نشر جزء منه على صفحات مجلة تابعة للجبهة الشعبية، تصدر في الأردن، في صيف 1993، تحت عنوان “محمود درويش .. هل يبحث عن مجد شخصي؟ ”
وما دفعني، مجددا، الى الكتابة في هذا الموضوع، النقاش الذي دار بيني وبين الشاعر، في اللقاء الذي عقدته وزارة الثقافة الفلسطينية، في مقرها، في رام الله، بتاريخ 9/5/1996. وقد كرر الشاعر، يومها، مقولة الناقد الاسرائيلي (حاييم غوري): “الشعر لا يكذب” التي أوردها (غوري) في نقده قصيدة درويش المشهورة: “عابرون في كلام عابر” (1988).
وكما هو معروف، فقد أثارت القصيدة، في حينه، ضجة كبيرة (4) .
منهج الدراسة :
يوظف الدارس هنا مصطلحي نقد الرواية “الزمن الكتابي (الابداعي)” “والزمن الروائي” لقراءة القصائد، ويستخدم الأول كما هو، قاصدا به زمن كتابة القصيدة، ويستخدم الثاني للاشارة الى الزمن المصوغ شعرا، مستبدلا كلمة الروائي بكلمة الشعري. وكما هو معروف فان المقصود بالزمن الروائي هو الزمن الذي تجري فيه أحداث الرواية(5) .
ويحيل الدارس النص الشعري إلى ما هو خارجه، فيقرأه بما يعرفه عن كاتبه وبما كتب عنه أيضا، وان كان هذا يجعل من الدراسة دراسة أدبية سياسية في الوقت نفسه.
ويفيد الدارس من قراءاته للمنهج البنيوي في أثناء قراءة النصوص. وهو بذلك يربط بعضها ببعض لملاحظة الصلة بينها. حقا إنه لا يبحث عن بنية النص وصلتها ببنى النصوص الأخرى- كما فعل (ريفاتيري) الفرنسي حين درس قصيدتين لـ (بودلير) الفرنسي قاصدا تتبع بنية كل منهما لملاحظة التشابه بين بنيتيهما (6) – ولكنه يحاول استنطاق النصوص باحثا عما يدور بخلد الشاعر ولا وعيه، من أجل تعزيز ما يذهب الدارس اليه.
موقف النقاد من هذه الاشكالية في حالة محمود درويش :
يقول الدكتور غالي شكري في دراسة له عن محمود درويش :
” ليس من شاعر ظلمته السياسة قدر ما ظلمت محمود درويش، فقد لعبت في حياته دور الغمامة التي حجبت احيانا وجهه الشعري الأهم.. فبالرغم من نبالة القضية الفلسطينية وشرف الانتماء اليها، الا أن درويش صاحب الموهبة الاستثنائية كان يدرك الحدود الفاصلة بين الابداع والموقف السياسي. كان يعطي ما لقيصر لقيصر وما للشعر للشعر، فإذا تطلب الكفاح من أجل القضية حزبا أو أيديولوجية أو سجونا أو معتقلات لا يتردد في اتخاذ الموقف الصحيح الى جانب شعبه. أما الابداع فشيء آخر لا يخلط بين متطلباته ومقتضيات السياسة، حتى ولو كان في السياسة ما يغري بالجماهيرية والذيوع وسعة الانتشار”.
ويتابع :
“لذلك كان شعره من قبل أن يغادر الأرض المحتلة الى اليوم بحاجة الى رؤى لاعادة التقييم في ضوء الشعر لا تحت أضواء السياسة” (7) .
ومطلب غالي شكري هو مطلب محمود درويش الملح. يقول محمود درويش في مقابلة أجريت معه على إثر نشر قصيدته “أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي” :
“لقد ركز بعضهم على عبارة “معاهدة الصلح” وأضاف: “ولو كنت أعرف أن هذه العبارة سوف تسرق اهتمام القارئ الحديث أو المراقب الصحفي والمجتمع السياسي العربي الى هذا الحد لكنت تخليت عنها. وسأسمح لنفسي، في أية طبعة جديدة، بتغييرها، ليس تنصلا من المدلول، ولكن حرصاً مني على إبقاء القارئ في الحقل الإجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها، وليس لعبارة واحدة سمح التأويل بتحويلها الى لافتة أو شعار” (8) .
ويتساءل المرء، ومعه حق في ذلك، ان كان قارئ محمود درويش يستطيع ان يفصل فصلا مطلقا بين شعره ومواقفه السياسية من ناحية، وبين محمود الشاعر ومحمود السياسي من ناحية ثانية، ويعتمد في ذلك على أمور عديدة أبرزها :
أولا : لقد اختلط في أشعار الشاعر الأولى الخطاب الشعري بالخطاب السياسي، ونظر الى محمود على أنه شاعر وسياسي معا. وقد وصل الأمر ببعض دارسيه الى إسقاط الواو دون إسقاط ما بعدها.
ثانيا : واستمرت هذه النغمة في أشعار الشاعر التي كتبها حتى فترة متأخرة تقريبا. ولا يستطيع أي قارئ لديوان “حصار لمدائح البحر” إغفال ذلك، وتحديدا في قصائد “بيروت” و”مديح الظل العالي” و “اللقاء الاخير في روما”.
وقد نعت درويش قصيدة “مديح الظل العالي”، في طبعة المجلد الثاني من أعماله الصادر عام 1984 عن دار العودة، نعتها على انها “قصيدة تسجيلية”.
ثالثا : لم يبتعد درويش في فترات حياته عن الساحة السياسية، فقد قبل، لفترة من الزمن، عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت . ف، وكتب غير مقالة تدرج تحت باب الأدب السياسي.
وفوق ذلك كله لا يخفى على غالي شكري ومحمود درويش معا أن النص هو، في نهاية الأمر، مثير يستجيب له القراء استجابات متعددة. ولا أعتقد أن درويش قادر أن يبقي “القارئ في الحقل الجمالي والتــاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”. وهو إن فعل ذلك فانما يحيل القراء جميعا إلى زمن اخر، زمن واحـد، وهو ما لا يستطيع عليه أي شاعر، فزمن القارئ، كما هو معروف، زمن متعدد بتعدد ثقافات القراء في الزمن نفسه.
ويذهب الدارس الى ما هو أبعد من ذلك. لم يستطع درويش حتى وهو يقرأ من ناقد أديب مثقف، هو ادوارد سعيد، أن يبقيه “في الحقل الجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”، ولنقرأ ما يكتبه ادوارد سعيد حول القصيدة :
“القصيدة المترجمة في هذا العدد “أحد عشر كوكبا على الأندلس” كتبت ونشرت في عام 1992. ولقد انبثقت من ثبات مناسبات متباعدة: الذكرى الـ 500 للعام 1492 [سقوط غرناطة، رحلة كولومبوس]، سفر درويش إلى اسبانيا للمرة الأولى، وأخيرا قرار م. ت. ف الاشتراك في عملية السلام تحت رعاية روسية – أمريكية وانعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول 1991″.
ويتابع :
“والحق أن هذه المقطوعات الشعرية تنطوي على نغمة الكلل وهبوط الروح والتسليم بالقدر، والتي تلتقط – عند العديد من الفلسطينيين – مؤشر الانحدار في أقدار فلسطين التي، مثل الأندلس، هبطت من ذروة ثقافية كبرى إلى حضيض قطيع من النقد، على صعيد الواقعة والاستعارة معا. لكن هذا يفسر جانبا واحدا من جوانب القصيدة. فالعنوان في الأصل العربي هو ببساطة “أحد عشر كوكبا” ولقد أضيفت عبارة “على الأندلس” لايضاح الخلفية المعاصرة للقصيدة” (9).
ولا يستغرب القارئ، بعد قراءة رأي سعيد، أن يرى القارئ العربي أو المراقب الصحفي أو المجتمع السياسي العربي أن درويش يعبر في القصيدة عما يجري، الآن، على الساحة الفلسطينية.
وثمة قضية أخرى يجدر، الآن، الإشارة إليها، لأنها ستوضح نقطتين سيؤتى على ذكرهما بوضوح أكثر وهما: تأثير النص على القارئ واستجابة الأخير له، وصوت المتكلم في القصيدة وأعني بذلك: من هو المتكلم في القصيدة ؟.
لقد كتب محمود درويش في عامي 86/1987 العديد من القطع الشعرية الساخرة، ونشرها على صفحات مجلة “اليوم السابع” الصادرة، في حينه، في باريس، تحت عنوان ” من خطب الدكتاتور الموزونة”، ولم يجمعها، حتى الآن، في كتاب (10).
وقد التفتت إلى إحداها بعض الصحف العربية ونشرتها على صفحاتها، دون أن تلتفت إلى تاريخ كتابتها أو تحديد الشخص المتكلم فيها. وقدم معيد نشرها إليها بما يلي:
“الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش الذي استقال من عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف احتجاجا على الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي كتب قصيدة جديدة بعنوان “خطاب السلام” عبر فيها عن موقف الرافض من اتفاق غزة أريحا بأسلوب تهكمي لاذع”(11) .
وقد قرأ حسن عبد الله المحرر الأدبي في جريدة “كنعان” القصيدة، دون أن يلتفت أيضا إلى زمن نشرها ولسان المتكلم فيها، وعقب عليها قائلا :
“أعرب محمود درويش كبير الشعراء الفلسطينيين عن موقفه الرافض لاتفاق غزة اريحا خلال قصيدته الأخيرة” خطاب السلام” التي تهكم فيها على الحكم الذاتي، ونسج من حروفها وشاح المرحلة السوداء…”
وتابع : “وقد تضمنت القصيدة مفارقات غاية في الغرابة، تستند إلى معرفة دقيقة لطبيعة التفكير القيادي الذي لم يكن درويش بعيدا عن أجوائه” (12) .
وقد عقب الشاعر على سوء الفهم الناجم عن قراءة النص، وأوضح أن الخطاب ليس ذا صلة إطلاقا بالاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي. وأكد “أن اجتزاء بعض تلك الخطابات والادعاء بأنها كتبت بعد اتفاق أيلول يفتقد إلى النزاهة، وينبغي الإشارة إلى سياق الخطاب وزمنه، وبعكس ذلك يصبح تزويرا” (13)
وعلى الرغم من أن ما يقوله الشاعر صحيح إلا أن نشر النص وفهمه يعكسان، بوضوح أهمية المقولات النقدية السابقة. فقد استجاب له القراء استجابات مختلفة (14) وترك زمن القراءة أثره عليه. وهو فوق ذلك يلقي بالظلال على نفسية الشاعر.
لقد رفض درويش اتفاقيات (كامب ديفيد)، في حينها، وسخر من أنور السادات سخرية مرةً . وهو برفضه هذا كان يرفض الحكم الذاتي الذي وافق عليه الفلسطينيون، فيما بعد، واستقال درويش، على إثر قبوله، من عضوية اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف.
والسؤال الذي يثار هنا: ما الذي يحدو بدرويش، إذن، رفض نشر الخطاب “خطاب السلام” الآن؟
رضوخ الثقافي للسياسي :
ذهبت بعض الدوريات(15) إلى أن قصيدة “للحقيقة وجهان والثلج أسود” أثارت غضب السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف ، في حينه، وأنه، تبعا لذلك، استدعى الشاعر الذي كان يقيم في باريس ليستفسر منه عما يقصده في القصيدة.
ولا يستغرب المرء، ما ذكر أعلاه، فقد أبدى الشاعر استعداده لحذف كلمات من القصيدة واستبدالها بأخرى، وهو ما لاحظناه في عبارته السابقة. وهذا ما أقدم عليه درويش فيما بعد. وهكذا يرضخ الثقافي للسياسي.
وقد يرد الشاعر على هذا الرأي، ويذهب إلى أنه يفعل ذلك دائما. وثمة ما يؤكد ذلك. فمن يقرأ بعض قصائده التي نشرها على صفحات “شؤون فلسطينية” أولا ثم أعاد نشرها، فيما بعد، في مجموعات شعرية، يلحظ أن الشاعر يفعل ذلك دون ضغط من أحد. وخير مثال على ذلك قصيدة “بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا” التي نشرت في ديوان “محاولة رقم 7” (1974). لقد نشرها الشاعر على صفحات “شؤون فلسطينية” تحت عنوان “حوار مع مدينة” (16) ولم تبد في الديوان كما ما بدت على صفحات المجلة. ثمة تغيير واضح يلحظه المرء، وهو ما يبدو أيضا في قصيدة “الرمل” التي نشرت على صفحات “شؤون فلسطينية” ثم أعيد نشرها على صفحات ديوان “أعراس” (1977).
ويتكلم المرء، هنا، عن ثلاثة أنواع من التغيير في أشعار الشاعر. التغيير الجمالي والتغيير السياسي والتغيير الديني، وما يهمنا هنا هو الثاني، وان كان في هذا ظلم للشاعر(17).
ومن يقرأ قصيدة “للحقيقة وجهان والثلج أسود” في الطبعة الصادرة عام 1994 عن دار الآداب، ويقارنها بطبعات ديوان “احد عشر كوكبا”، يلحظ أن الشاعر أبر بوعده.
فما هي مواطن التغيير ؟ وما دلالة ذلك؟
أولا : يلاحظ الدارس لدواوين الشاعر في طبعاتها المختلفة أن هناك اختلافا في طبعتي ديوان ” أحد عشر كوكبا” الصادرتين في الأرض المحتلة. وكانت إحداهما تصويرا عن طبعة صدرت في المشرق العربي، وثانيتهما تصويراً عن طبعة صدرت في المغرب العربي. ويبرز موطن الاختلاف في السطر الخامس عشر من القصيدة المذكورة “للحقيقة وجهان..” إذ يرد السطر في طبعة دار العربي (18).
“إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار”
في حين يرد في طبعة دار الجديد (19):
“إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار”
ثانيا : تختلف الصيغة الواردة في طبعة دار العودة عنها في الطبعتين المذكورتين ويصبح السطر الناص
“… يتلو علينا” معاهدة الصلح ” يا ملك الاحتضار”
على النحو التالي :
” … يتلو علينا ” معاهدة اليأس” يا ملك الاحتضار”
ويصبح السطر الناص :
” فلماذا تطيل التفاوض، يا ملك الاحتضار؟ ”
على النحو التالي :
“فلماذا تطيل النهاية، يا ملك الاحتضار؟ ”
وتلتزم طبعة دار العودة بما ورد في طبعة دار العربي – أي طبعة المغرب العربي – في السطر الناص:
“إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار”.
ثالثا : تجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن الشاعر أعاد نشر قصيدة “عابرون في كلام عابر” في كتاب يحمل عنوان القصيدة، ويحتوي على مقالات نثرية فقط، منها ما له صلة بالقصيدة، ومنها ما لاصلة له بها.
وقد تيسر لي، مؤخراً، الاطلاع على الطبعة الثانية الصادرة عام 1994 عن دار العودة التي لم يشر صاحبها إلى تاريخ الطبعة الأولى. وبناء على ذلك فإنني لا أستطيع أن اجزم إن كان الشاعر اطلع على الدراسة المنشورة عام 1993، والمشار إليها في بداية هذه الدراسة. ومع ذلك يظل سلوك الشاعر موضع سؤال، ويحتاج إلى دراسة. فما معنى أن ينشر قصيدة شعرية في كتاب نثري؟ وليست القصيدة هذه هي الأسوأ فنيا في شعر الشاعر. وهي لا تختلف في لهجتها ووضوحها عن قصيدة “مديح الظل العالي” وعن قصائد أخرى كتبها الشاعر تحت وطأة لحظة زمنية قاسية مرعبة.
وهنا يتساءل الدارس : ما هي الإشكاليات العديدة التي تثار جراء تغيير الشاعر بعض المفردات واستبدالها بأخرى ؟
يثير التغيير، كما يرى الدارس، عدة إشكالات أهمها :
أولا : تبعية الأديب للسياسي والرضوخ لأوامره.
ثانيا : تخلي الشاعر عن مواقفه والتراجع عما يراه ويعتقده. ويقوده الرضوخ: إلى تعزيز ظاهرة الشاعر التابع وتقويض ظاهرة الشاعر الشهيد؛ الشاعر الملتزم بالكلمة. وتصبح المقولة التي كررها “الشعر لا يكذب” مقولة مفرغة من محتواها، وتحتل مكانها مقولة أخرى هي: “أجمل الشعر أكذبه”، وتحيلنا هذه العبارة إلى تفسيرات محمود درويش المبهمة لها:
“إذا كذب الشعر أو الشاعر فهو كذب جمالي يقدم مبررات جمالية لوجود مهدد أحيانا. قول العرب القديم الذي قابلناه بسخرية: “إن أعذب الشعر أكذبه” يجب ألا نتعامل معه تعاملا بسيطا، فالكذبة الجمالية ذات ملابسات ومبررات أعمق بكثير من الكذبة الأخلاقية لارتباطها بطبيعة الإبداع الخاصة، لأن كل صورة شعرية،إذ قارنا بينها وبين الواقع فهي كذبة أو هي واقع محور.
وقد نقول أيضا “إن أعمق الشعر أصدقه”، فالصدق هنا له معنى آخر غير المعنى الأخلاقي. الشاعر في هذه الحالة لم يكذب. لا الشاعر كذب على القصيدة، ولا القصيدة كذبت على الشاعر، ولا الشعر كذب على الشعر”(20).
ثالثا : ويتحول الأديب هنا إلى سياسي يتعامل مع الراهن، فيتغاضى عن الحقيقة ويتجاهل ذكرها ولا يجرؤ على إشهارها، وذلك من أجل تسيير أموره، وهو الحلقة الأضعف في عالم يقمع فيه السياسي كل من يخالفه الرأي مباشرة. وهكذا يرضخ من لا يملك سوى الكلمات إلى من يملك المسدس والمال. ويؤكد هذا الرأي – بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل رغبة الشاعر في التنقل من مكان إلى آخر وحصوله على إقامة في هذا البلد أو ذاك – عدم جمع خطب الدكتاتور الموزونة، حتى الآن، في كتاب، وعدم ضم بعض المقالات النثرية المهمة، مثل المقال الذي نشره درويش تعقيبا على خطاب الملك حسين بعد فشل التنسيق مع م. ت. ف في النصف الثاني من الثمانينيات، إلى ما نشره نثرا في كتاب(21).
وأقف الآن عند نقطة مهمة كانت موضع جدل مع الشاعر في أثناء حديثه، في اللقاء المذكور، وهي أنه لم يكن، في قصيدته “أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي”، يعبر عن الواقع الراهن.
لا يذهب كثير من الدارسين النقاد، وبخاصة الآن، إلى الأخذ بالمقولة النقدية القديمة “المعنى في بطن الشاعر”، معتمدين على مقولات نقدية معاصرة أبرزها ما ذكرته، ابتداء، من أن النص مثير والقارئ متعدد، وأن المعنى غير مغلق، بمعنى آخر: ليس هناك تفسير نهائي لنص من النصوص (22).
وتقتضي الضرورة، هنا، التركيز على مصطلحي الزمن الكتابي والزمن الشعري.
يكتب درويش نصه الشعري، عام 1992، عن سقوط غرناطة الذي تم قبل 500 عام. وهو يكتب ما يكتبه وفق رؤية معاصرة اعتمدت على ما كتب حتى هذه اللحظة. ومن المؤكد أن النص ما كان ليكون على ما هو عليه لو كتب قبل 500 عام. وهذا ما يؤكده لنا شكل القصيدة الذي ينتمي إلى ما بعد عام 1947. ويعزز ذلك أيضا ظهور مفردات ما كانت معروفة عام 1492 مثل (كولومبوس، لوركا، غيتار). وان كان (كولومبوس) عاش في ذلك العام، إلا أنه، على ما يرجح، لم يكن معروفا للشعراء العرب، في حينه .
واذا كانت هذه المفردات قد سقطت، في القصيدة، سهوا، فلماذا لا تسقط ايضا رؤية الشاعر لما يجري الآن في فلسطين على ما جرى، من قبل، في الأندلس؟ ويعتبر محمود درويش واحدا من كثيرين يرون في فلسطين أندلساً جديدة (23) .
ويمكن أن يوضح الدارس هذا من خلال قراءة لقصيدتين وردتا في ديوان “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” (1995) هما: “من روميات أبي فراس” و “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” . وكما هو واضح فان القصيدتين تتمحوران حول شخصيتين تاريخيتين تنتميان إلى العصر الجاهلي والعصر العباسي. وهكذا يختلف فيهما الزمنان: الكتابي والشعري. فهل استطاع درويش فيهما أن يتمثل العصرين تمثلا كليا ليعبر عن الشخصيتين دون إسقاط رؤية معاصرة، هي رؤيته الخاصة ؟
يدرج الشاعر قصيدة “من روميات أبي فراس” مع قصائد آخر تحت عنوان فرعي هو “غرفة للكلام مع النفس”، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قصيدة “تدابير شعرية” لتليها، على التوالي، القصائد التالية: “من سماء الى أختها يعبر الحالمون” و “قال المسافر للمسافر .. لن نعود كما ” و “قافية من أجل المعلقات” و “الدوري كما هو، كما هو”.
وليس اختيار العنوان اختيارا عشوائيا، ويمكن قول الشيء نفسه عن إدراج القصائد تحته. ولا يخطئ حســين حمودة الذي قرأ الديوان حين كتب عنه “تستقل، ظاهريا، كل قصيدة، وكل قســـم، من قصائــد الديوان وأقسامه، بملامح خاصة، ولكن هذا الاستقلال الظاهري ينطوي على عالم فني واحد، يربط هذه القصائد والأقسام في سياق متصل، إذ تلتف كلها حول دلالات الغياب، وحول مستويات الوعي به.. (24).
” تتردد هذه العناصر والمفردات، خلال القصائد، وتتكرر تكرارا لافتا، لتسهم في صياغة “أسطورة” خاصة بالشاعر، خفية، كامنة، متجذرة في قصائد الديوان جميعا، مما يجعل من عوالم هذه القصائد عالما ممتدا، ومن نصوصها نصا متصلا، برغم تنوع هذه القصائد، وبرغم تباين مراحل الغياب التي تلتقطها وترصدها على مستويات الوعي والذاكرة والزمن جميعا.. (25).
وبناء عليه يشير أيضا إلى ترابط قصائد “غرفة للكلام مع النفس” واتصالها فيما بينها. وأرى أن ثمة رابطاً يربط بين قصائد هذا القسم، فدرويش، في القصيدة الأولى، يكتب، وفي الثانية ينطق شاعرا أسيرا، ويصور، في الثالثة، الفراشة المتنقلة بلا قيود، ويطلب المسافر، في الرابعة، من المسافر أن يكتب حكايته، وأتي، في الخامسة، على ذكر المعلقات التي ينبغي أن يخلفها نثر الهي لينتصر الرسول، في حين يشكل الدوري، في السادسة، النقيض للمتكلم الجالس في منزله مأهولا بالوقت. ويبدو فضاء القصائد فضاء واحدا: تنتظم القصائد الستة حالة واحدة للمتكلم/ الشاعر هي “غرفة للكلام مع النفس”.
وبناء على ما سبق تبدو أية قراءة لأية قصيدة منعزلة عن بقية القصائد، قراءة ناقصة غير مكتملة، وان بدت “من روميات أبي فراس” ذات خصوصية معينة، إذ يستحضر درويش فيها شاعرا عربيا عاش في القرن الرابع الهجري، ويتقمص شخصيته، ليعبر من خلالها، عما يجول في خاطره، وهو في منفاه في الأسر – أي الحمداني هنا -، بطريقة يكتب فيها الشاعر العربي المعاصر الذي ينتمي إلى ما بعد عام 1947، عام بزوع القصيدة الحديثة الشكل.
ولا يرى المرء كبير فرق بين حالتي الحمداني ودرويش: كلاهما يعيش منفيا عن وطنه، وإن اختلف سبب النفي: الأسر في حالة الأول، والهجرة في حالة الثاني، وهي هجرة بدت طوعية، ولكنها سرعان ما أصبحت قسرية، فقد أصبح الشاعر في وضع لا يستطيع فيه العودة إلى مسقط رأسه، إن رغب في ذلك. ويسترجع درويش، وهو في منفاه، بعض ماضيه في حيفا، وبخاصة تجربته في السجن، وهنا تتشابه تجربته وتجربة الحمداني.
ويثار، في أثناء قراءة هذه القصيدة التي صيغت بضمير المتكلم، سؤال مهم هو: من هو المتكلم في هذه القصيدة؟ هل هو الحمداني أم هو محمود درويش؟ ويتلو هذا السؤال سؤال أخر هو: عم يتكلم ؟ (26).
إذا قيل ان المتكلم في قصيدة “من روميات أبي فراس” هو الحمداني، فهناك ما يؤيد ذلك، وهناك ما ينفيه أيضا. يستحضر “أنا المتكلم” مفردات تاريخية ارتبطت بأبي فراس وتجربته، ووردت في أشعاره:”الحمامة وحلب وابن عمي وروميات، و فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى، والخيل والغزوات”. ولكن المتكلم يورد كلمات لا تنتمي إلى عصر الحمداني. وورودها – إن أصر الشاعر على أن الناطق هو أبو فراس – يجعل في النص مفارقة تاريخية تتمثل في وضع شيء في غير زمانه الصحيح (استعمال يوليوس قيصر التلفون أو ركوبه الطيارة)، وهو هنا، في حالة أبي فراس، وجود القطار وشكل القصيدة.
ومن يقرأ النص، مستعينا بما هو خارجه، أي بناء على معرفته لحياة محمود درويش وما مر فيه من تجارب، وما قاله هو شخصياً بهذا الخصوص، يعرف أن درويش، في القصيدة، يعبر عن ذاته.
وتبين النصوص المقتبسة من القصيدة تأثير الزمن الكتابي على الزمن الشعري، وتشير الى أن أنا المتكلم هو درويش لا الحمداني(27).
يرد في القصيدة :
ثمة أهل يزورننـا
غدا في خميس الزيارات . ثمة ظل
لنا في الممر . وشمس لنا في سلال
الفواكه ثمة أم تعاتب سجاننا :
لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا
شقي ؟
و :
وزنزانتي اتسعت، في الصدى، شرفة
كثوب الفتاة التي رافقتني سدى
الى شرفات القطار، وقالت : أبي
لا يحبك. أمي تحبك . فاحذر سدوم غدا .
يكتب الشاعر نصه الآن (1995) عن شاعر عاش في القرن الرابع الهجري، حيث لم يكن القطار موجودا، ولم تكن القهوة مكتشفة. وهنا يبدو تأثير الزمن الكتابي على الزمن الشعري واضحا. ويعزز هذا ما يذكره الشاعر في المقابلة التي أجراها معه عباس بيضون :
” وأنا في السادسة عشرة من عمري زارتني أمي في السجن، وحملت لي قهوة وفواكه، واحتضنتني وقبلتني” (28).
ويقول أيضا :
“أحببت مرة فتاة لأب بولندي وأم روسية. قبلتني الأم ورفضني الأب. لم يكن الرفض لمجرد كوني عربيا. ذلك الحين لم أشعر كثيرا بالعنصرية والكره الغريزي. لكن حرب 1967 غيرت الأمور “(29).
ونعود إلى عبارة الشاعر التي فسر فيها إقدامه على استبدال كلمات بأخر: “ولكن حرصا مني على إبقاء القارئ في الحقل الجمالي والتاريخي والثقافي للقصيدة بأسرها”، فهل نجح الشاعر في ذلك؟ وهل سيقرأ القارئ القصيدة وذهنه منصرف إلى ما حدث، في حينه، في الاندلس؟ أم أنه سيرى سقوط فلسطين في سقوط غرناطة. وهذا ما رآه ادوارد سعيد؟
هنا يمكن أن نقف عند قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” فقد تسعفنا قراءتها في الاجابة عن السؤال وتوضيح فكرتنا، أكثر مما تسعفنا القصيدة السابقة، وذلك لأنها ذات بعد سياسي واضح.
لا تختلف هذه القصيدة عن السابقة وعن قصائد أخرى عبر فيها الشاعر عما يجول في خاطره من خلال قناع، أبرزها – أي القصائد – “رحلة المتنبي إلى مصر” التي كتبها عام 1978 ونشرها في مجموعة “حصار لمدائح البحر”(30).
وتشير ظاهرة اللجوء إلى قناع للتعبير من خلاله، بوضوح، إلى إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني بخاصة، وفي الأدب المكتوب في ظل أنظمة قمعية بعامة. وهي في الأدب الفلسطيني ذات بعد خاص، وذلك لأن الشعر الفلسطيني في جانب منه كان شعرا سياسيا وكتب تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يحارب الشعر المعادي للسلطة الإسرائيلية، ولم يكن الأمر، على هذه الشاكلة، فيما يخص الشاعر والمؤسسة الفلسطينية لأن الانسجام بينهما، إلا في حالات نادرة، كان كبيرا. وهو في حالة درويش خير دليل على ذلك، فالعلاقة بين القيادة السياسية وبينه علاقة جيدة عموما، ولم تعتورها إشكالات الا في حالات قليلة هي التي سنقف عندها، وأشار اليها محمود درويش أحيانا (31) .
ويدرج الشاعر قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس” مع قصائد أخرى هي “شهادة من برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية 1967” و “متتاليات لزمن آخر” و “عندما يبتعد “يدرجها تحت عنوان فرعي هو : “أغلقوا المشهد”.
ويتساءل القارئ عن الضمير في أغلقوا وعن المشهد الذي أغلق. ويجد الإجابة عموما من خلال القصائد الأربعة معا (32)، وان بدت الإجابة أوضح ما تكون في قصيدة “خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس”.
ويوصل تحليل القصائد والبحث عن الثنائيات الأساسية فيها، يوصل القارئ في النهاية إلى أن هناك رابطا بينها، والى أن الشاعر يرمي، في النهاية، إلى التعبير عن المشهد الشرق أوسطي. وأن بريخت، مثله مثل امرئ القيس، ليس سوى قناع يختفي وراءه شخص محدد . وكما هو معروف، فإن (بريخت) الألماني، وهو كاتب مسرحي مشهور، توفي عام 1956، ولم يشهد حرب 1967، ليكون شاهدا عليها.
تقوم قصيدة “شهادة من برتولد بريخت أمام محكمة عسكرية 1967” على ثنائية الضحية التي تحولت إلى جلاد والضحية الجديدة – أي عرب فلسطين. وليس المتكلم في النص، وهو، كما يشير العنوان، (برتولد بريخت)، سوى قناع للشاعر الذي يشهد عما جرى في حرب 1967، ويدلي، بناء على ذلك، بشهادته أمام المحكمة التي هي محكمة عسكرية. وتعبر القصيدة عما يفعله الإسرائيليون بالعرب الفلسطينيين.
لقد بدأ المشهد، في الديوان كله الذي أرى أنه كتاب متكامل، باطلالة الشاعر المنفى على ما يريد، وبتأريخه لمأساته – مأساة شعبه منذ التهجير عام 1948. وبدأ المشهد في “أغلقوا المشهد” بحرب حزيران 1967 وانتهى بتوقيع الصلح وبغناء الشاعر لزمن آخر “متتاليات لزمن آخر”. وعاد الشاعر – المتكلم في نص “خلاف، غير لغوي … ” إلى غده ناقصا، وهي عبارة وردت على لسان محمود درويش في الكلمة التي ألقاها، في حيفا، في تأبين الراحل إميل حبيبي (33) بتاريخ 4/5/1996. وهكذا إذا استعنا بما هو خارج النص لنفهم النص أدركنا أن صوت درويش هو المسموع في القصيدة :
” … ثم انحنينا نسلم
أسماءنا للمشاة على الجانبين. وعدنا
إلى غدنا ناقصين”
وتقوم قصيدة “خلاف …” على ثنائية المنتصر والمهزوم. الأول الذي أخذ ما يريد والثاني الذي لم يجد نجمة للشمال ولا خيمة للجنوب، ولم يتعرف على صوته أبداً.
وتبرز هذه الثنائية، بوضوح، في قصيدة “عندما يبتعد”، إذ لا يختفي الشاعر فيها وراء قناع، وبالتالي فان القارئ لا يتساءل عمن يكمن وراء القناع.
يقول درويش فيها :
“للعدو الذي يشرب الشاي في كوخنا
فرس للدخان … ”
“لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض
فينا تدور على نفسها !
فلنكن طيبين إذا . كان يسألنا
أن نكون طيبين. ويقرأ شعرا
لطيار “ييتس” : أنا لا أحب الذين
أدافع عنهم، كما أنني لا أعادي
الذين أحاربهم” .
والكلام الذي يرد على لسان الطيار هو كلام صديق الشاعر الذي عرفه قبل حرب 1967 (34) .
ونعود لنثير السؤال من جديد: من هو امرؤ القيس في القصيدة؟ وما هو موقف المتكلم منه حقيقة؟ ومن هم أيضا الذين أغلقوا المشهد ؟ ومن هم الذين عادوا إلى غدهم ناقصين؟
تتكون القصيدة من خمسة مقاطع، تبدأ ثلاثة منها بعبارة ” أغلقوا المشهد” وهي المقاطع 1، 2،4، ويقابل الضمير (هم) الضمير (نحن). والضمير الأول (هم) الفاعل القوي في حين أن الضمير (نحن) يمثل المهزومين الذين سمح لهم العودة إلى غدهم ناقصين. وهم، في المقطع الثاني، الذين انتصروا، وهم الذين عبروا أمسنا كله. وينتهي المقطع الأول بهزيمة النحن، في حين ينتهي المقطع الثاني بانتصار (هم) بعد أن غيروا جرس الوقت. ويركز المقطع الثالث على اعتذار (النحن) عن المفردات التي اهترأت مثل وصف حرية لم تجد خبزها ووصف خبز بلا ملح حرية. ويقول المقطع الرابع ما أصبحوا (هم) عليه: لقد انتصروا وصوروا ما يريدونه من سماوات الـ (نحن) نجمة نجمة حاصلين على ما يريدونه. ويكثف المقطع الخامس شعور الـ (نحن) بالهزيمة، فقد خسر(نا) كل شيء ولم نعد كما كنا (لم نتعرف على صوتنا أبدا). ويوجه الخطاب الى امرئ القيس الذي اتكأ، يوم وقع، على لغة بعثرت قلبها عندما غيرت دربها – أي تغيير الدرب الثوري الى درب الاستسلام – ، وتنتهي القصيدة بالمقطع التالي :
لم يقل أحد لامرىء القيس : ماذا صنعت
بنا وبنفسك ؟ فاذهب على درب
قيصر، خلف دخان يطل من
الوقت أسود، وحدك، وحدك، وحدك
واترك لنا، هــهنا، لغتك.
وقد يقول محمود درويش هناك من قال للقيادة التي وقعت: ماذا صنعت بنا وبنفسك؟ وأن ياسر عرفات لا يجيد اللغة ليتركها لنا. والجواب واضح: لم يقل من يسير في فلك القيادة للقيادة ما يخالف رأيها، ومن قال وخالف عاد وسار في الركب. وليس بالضرورة، هنا أن يكون المقصود باللغة اللغة الفصيحة، فقد تكون اللغة الثورية التي سمعها الشاعر من القائد قبل توقيع الاتفاق. وعدا ذلك فالخلاف، كما يقول عنوان القصيدة، ليس خلافا لغويا.
ويتساءل المرء: أليس ذهاب امرئ القيس على درب قيصر موازيا لذهاب القائد على درب (كلينتون) ؟
الخلاصة :
يتوصل المتأمل لعلاقة الثقافي بالسياسي إلى النتيجة التالية :
تظل هذه العلاقة علاقة تصالح ما دام الثقافي والسياسي يسيران معا فكرا وممارسة، فإذا ما اختلفا وجب على الثقافي أن يختار أحد الحلول التالية: المواجهة وما يترتب عليها من قمع وسجن واضطهاد وربما القتل، أو الخضوع وما يترتب عليه من تذويب الذات الثقافية في الذات السياسية وترداد خطاب الثانية وهي لا تؤمن به، أو المحافظة على وضع فيه قدر من التصالح مع الذات والآخر، وهنا لا يلجأ الثقافي إلى التعبير، عن وجهة نظرة، بأسلوب مباشر وإنما يحاور ويناور ويرتدي قناعا يختفي وراءه، أو العيش في المنفى، وهنا يتصالح المرء مع الذات فقط، وينجم عن ذلك حالات قد تكون أقسى من البقاء في الوطن مثل الغربة والاغتراب والوحدة، أو الصمت.
وإذا كان ما سبق ينطبق على المثقف الذي يعيش في ظل أنظمة دكتاتورية، وهو عموما ما لم يعرفه المثقف الفلسطيني، من قبل، إلا نادراً، فإن المرحلة الحالية، مرحلة تحول الثورة إلى سلطة، قد تضع المثقف أمام واحد من الخيارات السابقة، وهو ما لا نأمله، وان كان ما حدث مع محمود درويش، وما جرى، مؤخرا، من منع كتب ادوارد سعيد، يشير إلى أننا نسير في الاتجاه نفسه الذي سارت فيه العلاقة بين الثقافي والسياسي في العالم العربي ودول العالم الثالث وربما أيضا بعض دول العالم الأول .
([1]) ثمة إشكالية أثارها دارسو محمود درويش يوم صدرت مجموعته الشعرية الكاملة عن دار العودة خالية من بعض المفردات مثل “الشيوعية” في عبارة “يحبون الشيوعية” . واختلف الدارسون إن كان الحذف من الشاعر أو من دار العودة نفسها. حول ذلك انظر: حسين جميل البرغوثي، أزمة الشعر المحلي، القدس، 1979. ص 51 وما بعدها. وانظر دراستي “ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية” مجلة النجاح للأبحاث ، آيار 1995.
(2) حول ذلك انظر مقالتي “الابداعي والسياسي” في كتاب “تأملات في المشهد الثقافي” نابلس 1995. ص 67 – ص 73. وانظر ما نشرته مجلة “مشارف” في العدد السابع وبخاصة افتتاحية إميل حبيبي، (آذار 1996) وفي العدد الثامن تحت “ملف العدد” (نيسان 1996). وقد خاض أكثر من كاتب فلسطيني في موضوع هموم السياسي وهموم المبدع ، ونشرت الاراء في أعداد مشارف التالية: العدد الثامن، نيسان 1996، والعدد الثاني عشر، تشرين الثاني 1996، والعدد الرابع عشر، شباط 1997، والعدد الخامس عشر، آذار ونيسان 1997.
(3) أنظر الفصل الأول من كتابه المذكور، وتحديدا الصفحات 29-66. وما تنجزه دراستي هذه يكمن في انعكاس العلاقة بين السياسي والشاعر على النص الشعري مباشرة، وهي تتجاوز تتبع مواقف درويش السياسية والتغيرات التي تطرأ عليها، كما تبدو من خلال المقالات النثرية السياسية، والمقابلات التي يجريها الصحفيون معه .
(4) حول القصيدة وما آثارته انظر دراستي “ظواهر سلبية”، ص 255، وتحديدا احالات هامش (40)، و ص248 إحالات هامش 21.
(5) حول مصطلحات الزمن في الرواية انظر دراسة عبد العالي بوطيب “إشكالية الزمن في النص السردي” مجلة فصول، صيف 1993. ص 129 وما بعدها .
(6) حول ذلك انظر : مارين جريزباخ، مناهج الدراسة الآدبية، توبنغن، 1985 ط 9 ، ص 104 (بالألمانية) .
(7) غالي شكري، القاهرة، العدد 151حزيران 1995. ص 9. (محمود درويش : عصفور الجنة أم طائر النار).
(8) مجلة “تكوين”، عكا، 1993. ص 15. وقد صدر عدد واحد من المجلة .
(9) ادوارد سعيد، تلاحم عسير للشعر وللذاكرة الجمعية، مجلة القاهرة، العدد 151 حزيران 1995. ص 22 وما بعدها.
(10) لا أدري اذا كان الاستاذ طلعت الشايب اطلع على دراستي هذه، وهي دراسة أنجزت قسما منها في تموز 1996، وأنهيتها في ايلول 1996، وقدمتها لتنشر في مجلة النجاح للأبحاث، وللحصول على جائزة توفيق زياد التي تمنحها وزارة الثقافة ، وبناء على ذلك عمل على جمع خطب الدكتاتور الموزونة ونشرها في مجلة أدب ونقد المصرية، عدد 141، آيار 1997.
(11) جريد النهار المقدسية ، 6/1/1994.
(12) جريدة كنعان، 11/1/1994.
(13) النهار، 26/1/1994 نقلا عن الدستور الاردنية.
(14) عادل الاسطة، نابلس (جريدة نابلس)، 4/2/1994.ر
(15) حول ذلك انظر دراستي “ظواهر سلبية ..” .
(16) شؤون فلسطينية، العدد الخامس عشر، تشرين الثاني، 1972. ص 58 وما بعدها .
(17) ثمة مقاطع قليلة جدا في أشعار الشاعر، كتبت في فترات عصيبة، يبدو فيها ضرب من التمرد على الذات الالهية، ومنها ما ورد في قصيدة “مديح الظل العالي” التي نظمت إثر الخروج الفلسطيني من بيروت عام 1982، ومما ورد في نصها الأول :
“الله أكبر
هذه آياتنا، فاقرأ
باسم الفدائي الذي خلقا
من جزمة أفقا.”
وقد غير الشاعر السطر الأخير ليصبح المقطع في الطبعة الصادرة عن دار العودة عام 1994 (الأعمال الكاملة، المجلد الثاني) على النحو التالي :
” الله أكبر
هذه آياتنا ، فاقرأ
باسم الفدائي الذي خلقا
من جرحه شفقا”
وحول الصيغة الأولى للنص أنظر: محمود درويش ، حصار لمدائح البحر، دار الاسوار، عكا، 1984، ص 130.
(18) عكا، 1993. عن طبعة المغرب العربي .
(19) د . م ، 1993. عن طبعة المشرق العربي في بيروت .
(20) أجريت المقابلة في باريس ، ونشرتها رفيف فتوح على صفحات مجلة “الوطن العربي” الصادرة في باريس. وأعيد نشرها، هنا، على صفحات جريدة “الشعب” المقدسية في 12/8/1986.
(21) انظر جريدة “الشعب” المقدسية 21/3/1986. وأرى أن شاعرا كبيرا مثل محمود درويش يستحق أن تطبع أعماله كلها، شعرها ونثرها، دون انتقاء، وذلك لأنها لم تعد ملكا شخصيا له. وانظر ملاحظة 9 من هذه الدراسة.
(22) حول ذلك انظر حسن ناظم، مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، بيروت، 1994. ص 133 وما بعدها .
وانظر أيضا : كمال أبو ديب، الواحد / المتعدد، البنية المعرفية والعلاقة بين النص والعالم، مجلة فصول، المجلد 15، العدد 2، صيف 1996، ص 40 وما بعدها. وتحديدا المقطع الثالث في الصفحتين 42 و 43 حيث يناقش مقولة المعنى الواحد وتعدد المعنى ويقف أمام مقولات الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني بهذا الخصوص.
(23) انظر دراستي “ظواهر سلبية ..”، ص 239. وانظر مقالة ادوارد سعيد المشار اليها في هامش 8. وانظر ايضا مقالة فخري صالح، لماذا تركت الحصان وحيدا: عن اللحظة الفلسطينية الملتبسة، مجلة “فصول” المصرية، المجلد 15، العدد 2، صيف 1996. حيث يرى أن درويش ينطق المحرومين في نصوصه “في محاولة لخلق تعبير مواز وغير مباشر عن التجربة الفلسطينية” (ص 243) . ويعترف محمود درويش بأن قصيدته “أحد عشر كوكبا” التي تصور سقوط غرناطه، قصيرة تستوحي مرحلة تاريخية” وتتسرب منها دلالات الى الراهن، فلا بد لفكرتها أن تنفضح، لكنني أحسب أن بنية القصيدة تحتمل ذلك” (انظر : مشارف، عدد3، تشرين أول 1995، ص 92).
(24) حول ذلك انظر دراسة حسين حمودة “مسار النأي، مدار الغياب” مجلة القاهرة، حزيران 1995. ص 44.
(25) السابق ص 45 وما بعدها .
(26) حول ذلك انظر مقالة (إيفا هورن) في كتاب “مدخل الى علم الأدب” إعداد (ميلتوس بشليفانوس) وآخرين، شتوتجارت، 1995. ص 299 وما بعدها .
(27) يقر الشاعر بأن مجموعة “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” هي محاولة لكتابة سيرته الذاتية شعرا، وعليه ، إذا أحلنا النص الى ما هو خارج النص، فان درويش كان يتخفى وراء أبي فراس، وأن الاخير ليس سوى قناع، حول ذلك أنظر اللقاء الذي أجرته معه رلى الزين ونشرته جريدة الأيام بتاريخ 26 و 27/5/1997.
وكان درويش ، من قبل، قد ذهب الى هذا، وذلك في اللقاء الذي أجراه معه عباس بيضون. انظر مشارف 3، تشرين 1995، ص 109. وفي اللقاء المذكور يوافق درويش بيضون من أن “لماذا تركت الحصان وحيدا” ليس سيرة فرديه له وحسب، بل سيرة شعرية، ويرى أن قصيدتي “شهادة برتولت بريخت” مكتوبة بلغة الستينات ، وكذلك تقفيه القصيدة عن أبي فراس الحمداني. “اذن تجد هذا المستوى من السيرة الشعرية الذي يرافق السيرة الذاتية، لقد عدت الى ماضي ذاتي، ماضي في الكتابة، ذاتي الشعرية”.
(28) مشارف، العدد 3، تشرين الأول، 1995. ص 72.
(29) السابق ، ص 75.
(30) محمود درويش، حصار لمدائح البحر، حيفا وعكا، 1984.
(31) محمود درويش وسميح القاسم، الرسائل، حيفا، 1990. ط2. رسالة “حاضر سابق” ص 93.
(32) حسين حموده، مسار النأي، ص 50 وما بعدها .
(33) مشارف، العدد 9، حزيران 1996. ص 32. ويقول درويش في ص 34 :
“واغفر لنا يا معلمنا ما صنعت بنا وبنفسك. اغفر لنا أننا سنعود بعد قليل الى أنفسنا ناقصين”.
(34) مشارف، العدد الثالث ، تشرين الأول، 1995. ص 76. يقول محمود درويش :
“في قصيدتي” جندي يحلم بالزنابق البيضاء” كتبت عن هذا الصديق الذي جاءني بعد الحرب ليقول لي انه قرر أن يغادر البلاد نهائيا. لأنه لا يستطيع أن يبقى ترسا في آلة حربية. كانت انسانيته عالية، وتربيته قائمة على التعدد والانفتاح على الاخر. جاء الى اسرائيل وفي باله مشروع انساني فوجد ان الحقيقة غير ذلك. لذا هاجر ورحل….” .
* عن

اد. عادل الأسطة : إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني: محمود درويش نموذجاً (ملف/6) - الناقد العراقي
إشارة : بمناسبة ذكرى رحيل شاعر فلسطين والعروبة؛ الشاعر الكبير “محمود درويش” ، تفتتح أسرة موقع الناقد العراقي هذا الملف عن الراحل الكبير وتدعو الأحبة الكتاب والقراء للمساهمة فيه بالمقالات والصور والوثائق. تحية لروح شاعر فلسطين والعروبة في عليّين. المقالة : إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب...