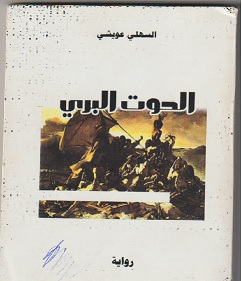قيل الكثير في رولان بارت" 1915-1980 " وعنوان كتابه الشهير" لذة النص Le plaisir du texte "، وأُخِذ العنوان مقولة جرى تقليبها على وجوهها عربياً، على أصعدة مختلفة: موالاة وممالأة، محاباة ومداراة، بحثاً عن اللذة التي لا بد أن الكاتب العربي بالذات، يريد الإقامة فيها بارتياً، أو يثبت معرفته بها، للمصادقة على صفة الاستقلالية فيه. إنما دون السؤال عن مغزى هذا العنوان: العبارة التي لا تترجَم أبداً، ولا تعاش أبداً بسهولة، لحظة انتقالها إلى لغة أخرى، لأن لكل لغة أنساقها الثقافية والمؤسسية الخاصة، أي متعها ولذائذها، والتي تعرّف بها السلطة التي تدير مجتمعها هنا وهناك.
لذة النص أكبر من لذة النص، وهو ما نتبينه من متنه البارتي. إن كل أشكال الحِكْمة المشرقية، والفلسفة اليونية، والهوى القيسي " مجنون ليلى " وعربدة النواسي، وزهد الناسك، والجنون المستباح، وسلوكية الأحمق، وشغف الرحالة بالجهات، واستغراق البوذي في تأمله حتى درجة الانطفاء" النيرفانا ". إن كلمة " plaisir " أكبر من أن يحاط بها، وقد وضِعت عنواناً، لاستدلاله على طابعه السياسي الذي يحكم نص بارت المتحرر من كل معرفة تخصصية. عنوانه يترجمه من الداخل. الكلمة تحمل أكثر من معنى" رضى، سرور، بهجة، انشراح، شهوة، متعة، حبور، غبطة، لذة، ملذة ". فحين أجيب على طلب أحدهم " بكل رضى- بكل سرور " تأتي العبارة الفرنسية " Avec plaisir" بالمقابل .
وقارىء " لذة النص " من المستحيل بمكان العثور على توصيف واحد لنص، للجسد الذي يعني النص، كما أشرنا. هل هناك اعتراف بالمجنون البارتي- الفوكوي إلى الآن ؟
إن هذه العبارات المقتطعة من الكتاب (لذة النص هي بابل السعيدة-ثغثغة النص ليست رغوة اللغة-الكتابة تكمن في هذا: علم متعة الكلام، إنه كاماسوترا- لذة القراءة- لذائذ اللغة- إننا باللغة لمغمورون- إن نص اللذة: هو النص الذي يرضي- اللذة تنطوي على المتعة تارة-لقد مات المؤلف بوصفه مؤسسة-جسد المتعة ذاتي التاريخية-لذة النص هي القيمة المنتقلة إلى قيمة الدال الفاخر...)، وما يغامر به الكتاب جهة التفريق بين المتعة التي تتخلل، واللذة التي تتصيد كل عبارة بيو-كيماوية في متن نص بارت ( اللذة قابلة للوصف، والمتعة غير قابلة لذلك)، تمضي بنا إلى حيث التيه.
الجسد بكل أفانين سلوكياته، كما لو أنه مشرَّح حياً في مختبر المخيال البارتي، ودون نسيان هوسه بالمنظفّات ومهمتها في " تلميع " مفردته ، كما في " رغوة اللغة "، ليكون الكاتب صابوناً، أو حامله الرمزي، كما يلاحَظ، ولا بد أن الماء المخصب، الماء المكثف الذي يذكّر بالمني في الحال، هو هذا النص الذي يلتقي به كاتبه بالجسد المتخيل. هل أقول في ضوء ذلك، ما يصدم ذائقة من ينفر من عبارات وصفية كهذه، بأن كاتباً كهذا هو " ثنائي الجنس ". إنه من جهة المعايشة الإطلاقية، وتبعاً لهواه شيطاني النزعة الذي يقال في الميثولوجيا العربية – الإسلامية، بأنه ينكح نفسه " لوطي الذات "؟
لا بد أن اعتراضاً يسمّي قائله على معايشة كهذه مع استهواءات بارت التي تلقى أصداء متعة ولذة، كما يُستنتَج من قبل قارئها العربي الذي يبحث في ركن ذاتي له، عما يجنّبه استبداد السلطوي: من البيت إلى المسماة بـ" المؤسسة ".
قدَّم بارت ما لا يمكن التجاوب معه بيسر، لانتمائه إلى ثقافة أجازت له ذلك. ثقافة أباحث للجسد، ومن خلال المعنيين بأموره، وتقلبات أطواره، ومفاجآته، بغموضه المهيب، وملمسه الناعم والخشن ذي المسامات النافرة لحظة قشعريرة، وسطحه البالغ العمق، ببرّيته، وغابيته، مكبوحاته...الخ، لكنه المعروض بالطريقة هذه، إيذاناً بحدَاد قضي له أن يكون الإعلان الأخير عن موت الجسد المحتكَر، الجسد الفقهي المحروس، الجسد المشمول بالوصايا، أو المثقَل بأوزار الإيديولوجية التي لا تنفك تخضعه للمراقبة والمعاقبة، الجسد الذي ينفجر من داخله منبعثاً بأسماء جديدة كل الجدة، لا قبَل للمقبِل عليها بما سبقها من أسماء متعالية، أسماء أرضية يسهل الكشف عنها، جسد يقول ما لا ينفد فيه، في صمته تمور لغة بحركات كوكبية، مجراتية، بعوالم لا يحاط بها، حيث يكون اللاشعور الذي ما أن تُتهجى المؤسسة، أي مؤسسة قريباً منه، حتى يتوارى عن أنظار التسميات اللغوية. ذلك هو الدرس اللغوي، الفلسفي، التحليلنفسي، الثقافي الذي يعرّفنا برموزه الكبار " ديكارت، فرويد، دي سوسير، باشلار، بارت، لاكان، شتراوس، فوكو، دولوز، دريدا...الخ ".
ماالذي ينوبنا من كل ذلك؟ لا شيء، وكل شيء. في الحالة الأولى، لأن لا أعمق وأوسع وأخطر من المسافة التاريخية بيننا إجمالاً، ككتّاب، وهذه الثقافة التي منحت الجسد كل هذه الامتيازات، بينما أعيش بجسدي رهينة السلطاني، الحُكْماني، الفقيه المغبَّر منذ عصور، الوصي بالوكالة، الرقيب، المجتمعي الأمعي الذي يسجّل علي حركاتي وأقوالي، وأمامي وخلفي، وعلى جانبي، أكثر من الوصايا العشر في المحظور والمسموح بالإتيان به، وللتاريخ المشهدي على مستوى السيستام الثقافي القائم، وما هو قائم سلطوياً، حيث مشاهد القتل والاستباحات شغالة في جهاتنا كافة، يفصح عن ذلك.
في الحالة الثانية، لأن الثقافة التي تمخضت عما هو بارتي" ما قبله وما بعده، وإلى الآن " عبرت شفاف المتوسط، وصحارى المنطقة، وأثارت الكوامن بطرق شتى، خصوصاً وأن هناك من بات معروفاً بلغات تلك، ومقيماً في متروبولوباتها، عدا عن المواقع الكثيرة جداً : الشخصية وخلافها، والسرعة الهائلة لأجيال ثقافية عالمياً.
بالطريقة هذه، يمكن الحديث عن بابل معكوسة، يتحدى عبرها الكاتب القيّم عليه، ويطال سدرة المنتهى مستجوباً خالقه بالذات " أليست مكاشفات الدين بنصوصه الكبرى دالة على التوجه هذا ومفصحة عنه في الصميم؟ "
وهذه البلبلة المدماة تعزّز مقولة الجسد المقاوم، والذي يقول ما فيه، ولم يعد يخفيه.
هذا إيذان بما يتطلبه كل مسلك تفاعلي مع نص كهذا، نص يقوله جسد كاتبه، ونوعية الضريبة التي عليها دفْعها، وكيفية إبداع جسده المغاير، وليس " الببغائي ": أن يردد بمتعة محاكاتية، ولذة محاكاتية، ما سلف لبارت أن عبّر عنها عبر تطوافات كلامية- كتابية، لغوية قائمة، وتجاوزية لها.
فبارت ترجم لذاته، لجسده، وهو يطلق لعنان له خارج أي امتهان خاص، أو حرفة تخصصية تقزّم فيه قواه، فاتحاً جبهات تترى في مفاصل ثقافته منذ أيام اليونان إلى وقته، ليشهد ولادة آتيه " اللذة المستدامة ": أي بداية الإنسان المنتظر على أنقاض الإنسان الذي لم يعد يصلح للتعامل معه، وقد فقد كل صلاحية تعامل معه، وهو مجرور بسواه.
استغرق بارت في نص هو لذة، ودونها،ـ لأن اللذة نقيض الصحوة، نقيض التفاعل مع الآخرين، إنما هي معانقة الجسد في أعمق مكوناته، جسد يتآمر بطريقة بارت على اسمه، ونفسه، وثقافته، نافضاً عنه غبار ما كان، مدشناً أولمبه فوق كل أولمب آخر، إنه بطريقته سيزيف المنتصر، وبرميثيوس الذي تعجز الآلهة في جموعها عن القبض عليه وصلْبه أو رميه بالنار، إنه إبراهيم العصري الذي تكون ناره برداً، ليس لهداية من حوله، وإنما ليخرج هو نفسه من ظلام، لطالما بولغ في مديح نهاره الحالك السواد، ولكنها اللذة التي تقود إلى الآخر الطالب بالتحرر، للخروج إلى النور. وتلك هي المتعة التي تستبقي جسد الكاتب في اللحظة، في الشبق الذي يتملك كامل الجسد، واللذة إفراغ من جهة الصلب لشاهد المعايشة، وإخصاب لواقعة وليدها النص الذي يحمل اسم كاتبه، عرّابه، توقيعه، سجله، معموديته، وليس مختار الحي، أو دائرة البوليس، أو موظف السجل المدني.
لعلنا بالطريقة هذه، نحسن التعرف على بارت الذي مضى سنوات تترى وهو يبحث عن اسمه المؤجَّل، لأنه دفن اسم مؤلفه فيه سريعاً، كي يتهيأ للاسم الذي لا يُسمي أباه أو مجمعه الأهلي، عصبته وخلافها، رداً على أعصبة المجتمع في زمانه، وأفاض في متعة نصه لينسى أن لديه ذاكرة تمكر به، وتبث لمجتمعه ما يقوم به جرّاء تربية مؤسساتية، وليطوح بها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويقيم في لذة، يموت إثرها ، ودونها لا قيمة تسجَّل لنصه ، له باسمه الثلاثي.
أي زمن طللي، زمن تمنعه من التنقيب في طبقاته، واستنطاق تراكماته ومساءلتها كذلك، لازال يشد إليه جموعاً غفيرة من الكتاب هنا وهناك، حيث الأثافي تثير خيالاتها، وأطياف المحبوب الوهمي، وعزيف الجن في المكان، وبوم النهار الذي " يقهقه " على طريقته من هذا الجاري، والعواصف الهوجاء تحول بينه ورؤية حتى أرنبة أنفه...!
لذة النص أكبر من لذة النص، وهو ما نتبينه من متنه البارتي. إن كل أشكال الحِكْمة المشرقية، والفلسفة اليونية، والهوى القيسي " مجنون ليلى " وعربدة النواسي، وزهد الناسك، والجنون المستباح، وسلوكية الأحمق، وشغف الرحالة بالجهات، واستغراق البوذي في تأمله حتى درجة الانطفاء" النيرفانا ". إن كلمة " plaisir " أكبر من أن يحاط بها، وقد وضِعت عنواناً، لاستدلاله على طابعه السياسي الذي يحكم نص بارت المتحرر من كل معرفة تخصصية. عنوانه يترجمه من الداخل. الكلمة تحمل أكثر من معنى" رضى، سرور، بهجة، انشراح، شهوة، متعة، حبور، غبطة، لذة، ملذة ". فحين أجيب على طلب أحدهم " بكل رضى- بكل سرور " تأتي العبارة الفرنسية " Avec plaisir" بالمقابل .
وقارىء " لذة النص " من المستحيل بمكان العثور على توصيف واحد لنص، للجسد الذي يعني النص، كما أشرنا. هل هناك اعتراف بالمجنون البارتي- الفوكوي إلى الآن ؟
إن هذه العبارات المقتطعة من الكتاب (لذة النص هي بابل السعيدة-ثغثغة النص ليست رغوة اللغة-الكتابة تكمن في هذا: علم متعة الكلام، إنه كاماسوترا- لذة القراءة- لذائذ اللغة- إننا باللغة لمغمورون- إن نص اللذة: هو النص الذي يرضي- اللذة تنطوي على المتعة تارة-لقد مات المؤلف بوصفه مؤسسة-جسد المتعة ذاتي التاريخية-لذة النص هي القيمة المنتقلة إلى قيمة الدال الفاخر...)، وما يغامر به الكتاب جهة التفريق بين المتعة التي تتخلل، واللذة التي تتصيد كل عبارة بيو-كيماوية في متن نص بارت ( اللذة قابلة للوصف، والمتعة غير قابلة لذلك)، تمضي بنا إلى حيث التيه.
الجسد بكل أفانين سلوكياته، كما لو أنه مشرَّح حياً في مختبر المخيال البارتي، ودون نسيان هوسه بالمنظفّات ومهمتها في " تلميع " مفردته ، كما في " رغوة اللغة "، ليكون الكاتب صابوناً، أو حامله الرمزي، كما يلاحَظ، ولا بد أن الماء المخصب، الماء المكثف الذي يذكّر بالمني في الحال، هو هذا النص الذي يلتقي به كاتبه بالجسد المتخيل. هل أقول في ضوء ذلك، ما يصدم ذائقة من ينفر من عبارات وصفية كهذه، بأن كاتباً كهذا هو " ثنائي الجنس ". إنه من جهة المعايشة الإطلاقية، وتبعاً لهواه شيطاني النزعة الذي يقال في الميثولوجيا العربية – الإسلامية، بأنه ينكح نفسه " لوطي الذات "؟
لا بد أن اعتراضاً يسمّي قائله على معايشة كهذه مع استهواءات بارت التي تلقى أصداء متعة ولذة، كما يُستنتَج من قبل قارئها العربي الذي يبحث في ركن ذاتي له، عما يجنّبه استبداد السلطوي: من البيت إلى المسماة بـ" المؤسسة ".
قدَّم بارت ما لا يمكن التجاوب معه بيسر، لانتمائه إلى ثقافة أجازت له ذلك. ثقافة أباحث للجسد، ومن خلال المعنيين بأموره، وتقلبات أطواره، ومفاجآته، بغموضه المهيب، وملمسه الناعم والخشن ذي المسامات النافرة لحظة قشعريرة، وسطحه البالغ العمق، ببرّيته، وغابيته، مكبوحاته...الخ، لكنه المعروض بالطريقة هذه، إيذاناً بحدَاد قضي له أن يكون الإعلان الأخير عن موت الجسد المحتكَر، الجسد الفقهي المحروس، الجسد المشمول بالوصايا، أو المثقَل بأوزار الإيديولوجية التي لا تنفك تخضعه للمراقبة والمعاقبة، الجسد الذي ينفجر من داخله منبعثاً بأسماء جديدة كل الجدة، لا قبَل للمقبِل عليها بما سبقها من أسماء متعالية، أسماء أرضية يسهل الكشف عنها، جسد يقول ما لا ينفد فيه، في صمته تمور لغة بحركات كوكبية، مجراتية، بعوالم لا يحاط بها، حيث يكون اللاشعور الذي ما أن تُتهجى المؤسسة، أي مؤسسة قريباً منه، حتى يتوارى عن أنظار التسميات اللغوية. ذلك هو الدرس اللغوي، الفلسفي، التحليلنفسي، الثقافي الذي يعرّفنا برموزه الكبار " ديكارت، فرويد، دي سوسير، باشلار، بارت، لاكان، شتراوس، فوكو، دولوز، دريدا...الخ ".
ماالذي ينوبنا من كل ذلك؟ لا شيء، وكل شيء. في الحالة الأولى، لأن لا أعمق وأوسع وأخطر من المسافة التاريخية بيننا إجمالاً، ككتّاب، وهذه الثقافة التي منحت الجسد كل هذه الامتيازات، بينما أعيش بجسدي رهينة السلطاني، الحُكْماني، الفقيه المغبَّر منذ عصور، الوصي بالوكالة، الرقيب، المجتمعي الأمعي الذي يسجّل علي حركاتي وأقوالي، وأمامي وخلفي، وعلى جانبي، أكثر من الوصايا العشر في المحظور والمسموح بالإتيان به، وللتاريخ المشهدي على مستوى السيستام الثقافي القائم، وما هو قائم سلطوياً، حيث مشاهد القتل والاستباحات شغالة في جهاتنا كافة، يفصح عن ذلك.
في الحالة الثانية، لأن الثقافة التي تمخضت عما هو بارتي" ما قبله وما بعده، وإلى الآن " عبرت شفاف المتوسط، وصحارى المنطقة، وأثارت الكوامن بطرق شتى، خصوصاً وأن هناك من بات معروفاً بلغات تلك، ومقيماً في متروبولوباتها، عدا عن المواقع الكثيرة جداً : الشخصية وخلافها، والسرعة الهائلة لأجيال ثقافية عالمياً.
بالطريقة هذه، يمكن الحديث عن بابل معكوسة، يتحدى عبرها الكاتب القيّم عليه، ويطال سدرة المنتهى مستجوباً خالقه بالذات " أليست مكاشفات الدين بنصوصه الكبرى دالة على التوجه هذا ومفصحة عنه في الصميم؟ "
وهذه البلبلة المدماة تعزّز مقولة الجسد المقاوم، والذي يقول ما فيه، ولم يعد يخفيه.
هذا إيذان بما يتطلبه كل مسلك تفاعلي مع نص كهذا، نص يقوله جسد كاتبه، ونوعية الضريبة التي عليها دفْعها، وكيفية إبداع جسده المغاير، وليس " الببغائي ": أن يردد بمتعة محاكاتية، ولذة محاكاتية، ما سلف لبارت أن عبّر عنها عبر تطوافات كلامية- كتابية، لغوية قائمة، وتجاوزية لها.
فبارت ترجم لذاته، لجسده، وهو يطلق لعنان له خارج أي امتهان خاص، أو حرفة تخصصية تقزّم فيه قواه، فاتحاً جبهات تترى في مفاصل ثقافته منذ أيام اليونان إلى وقته، ليشهد ولادة آتيه " اللذة المستدامة ": أي بداية الإنسان المنتظر على أنقاض الإنسان الذي لم يعد يصلح للتعامل معه، وقد فقد كل صلاحية تعامل معه، وهو مجرور بسواه.
استغرق بارت في نص هو لذة، ودونها،ـ لأن اللذة نقيض الصحوة، نقيض التفاعل مع الآخرين، إنما هي معانقة الجسد في أعمق مكوناته، جسد يتآمر بطريقة بارت على اسمه، ونفسه، وثقافته، نافضاً عنه غبار ما كان، مدشناً أولمبه فوق كل أولمب آخر، إنه بطريقته سيزيف المنتصر، وبرميثيوس الذي تعجز الآلهة في جموعها عن القبض عليه وصلْبه أو رميه بالنار، إنه إبراهيم العصري الذي تكون ناره برداً، ليس لهداية من حوله، وإنما ليخرج هو نفسه من ظلام، لطالما بولغ في مديح نهاره الحالك السواد، ولكنها اللذة التي تقود إلى الآخر الطالب بالتحرر، للخروج إلى النور. وتلك هي المتعة التي تستبقي جسد الكاتب في اللحظة، في الشبق الذي يتملك كامل الجسد، واللذة إفراغ من جهة الصلب لشاهد المعايشة، وإخصاب لواقعة وليدها النص الذي يحمل اسم كاتبه، عرّابه، توقيعه، سجله، معموديته، وليس مختار الحي، أو دائرة البوليس، أو موظف السجل المدني.
لعلنا بالطريقة هذه، نحسن التعرف على بارت الذي مضى سنوات تترى وهو يبحث عن اسمه المؤجَّل، لأنه دفن اسم مؤلفه فيه سريعاً، كي يتهيأ للاسم الذي لا يُسمي أباه أو مجمعه الأهلي، عصبته وخلافها، رداً على أعصبة المجتمع في زمانه، وأفاض في متعة نصه لينسى أن لديه ذاكرة تمكر به، وتبث لمجتمعه ما يقوم به جرّاء تربية مؤسساتية، وليطوح بها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويقيم في لذة، يموت إثرها ، ودونها لا قيمة تسجَّل لنصه ، له باسمه الثلاثي.
أي زمن طللي، زمن تمنعه من التنقيب في طبقاته، واستنطاق تراكماته ومساءلتها كذلك، لازال يشد إليه جموعاً غفيرة من الكتاب هنا وهناك، حيث الأثافي تثير خيالاتها، وأطياف المحبوب الوهمي، وعزيف الجن في المكان، وبوم النهار الذي " يقهقه " على طريقته من هذا الجاري، والعواصف الهوجاء تحول بينه ورؤية حتى أرنبة أنفه...!