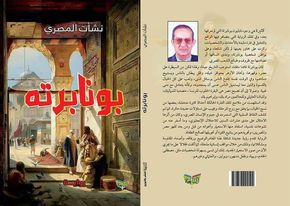طلب مني، في المدة الأخيرة، وفي إطار مهرجان موسيقي، أن أقدم مقامات الهمذاني لجمهور يتكون من فرنسيين خاصة. اعتقدت في البداية أن الأمر سيكون سهلاً ومريحاً: يكفي أن أتحدث عن الكدية التي تشكل الموضوع الرئيسي للمقامات، وأن أبدي ملاحظات عامة حول السجع والمحسنات البديعية. على كل حال لن يحاسبني أحد، فالجمهور الذي سأخاطبه يجهل جهلاً تاماً أدب المقامات، بل الأدب العربي برمته. إنه جمهور هين: ألقي محاضرة تنتهي بتصفيق مهذب، ثم يذهب كل واحد الى حال سبيله، ربما بعد أسئلة وأجوبة شكلية.
إلا أنه مع مرور الوقت أخذت تنتابني بعض الشكوك، واتضح لي أن المسألة صعبة للغاية. مثلاً قد أفتتح عرضي بالجملة التالية: في القرن الرابع، ألف الهمذاني المقامات. لكن ماذا سيفهم الجمهور من عبارة "القرن الرابع"؟ إنها تحيل على عناصر تاريخية، أدبية، عقائدية، بل جغرافية أيضاً، وكلها عناصر غائبة تاماً عن الجمهور الذي سأخاطبه.
قلت لنفسي: ما عليّ، والحالة هذه، إلا أن أذكر التاريخ الميلاديّ عوض التاريخ الهجري. هكذا صارت العبارة الإفتتاحية: في القرن العاشر الميلادي، ألف الهمذاني المقامات. بالانتقال الى التاريخ الميلادي سوف أربط الهمذاني بفترة يعرفها الجمهور، سوف أعقد صلة بينه وبين كتّاب أوروبيين معاصرين لبديع الزمان منشىء المقامات. ولا شك أن الجمهور سيحمد لي هذه الإلتفاتة، فقد علمتني التجربة المرة أن الآخر لن يهتم بي إلا إذا اهتممت به. من المستبعد أن أوفق إلى تقديم الأدب العربي للجمهور المفترض، إذا لم أبدأ بالإعتناء بأدبة، ولو من باب المجاملة.
هكذا رسخ في ذهني أن من الواجب إثبات قرابة ما بين الهمذاني وكتّاب أوروبيين من نفس الفترة. لكن سؤالاً لم يكن في الحسبان فاجأني: أي كتاب؟ بكامل الدهشة تبين لي أنني لا أعرف ولو كاتباً واحداً من القرن العاشر الميلادي، سواء كان أديباً أو متكلماً أو فيلسوفاً... بعد بحث طويل وممل في القواميس والموسوعات، عثرت على اسم يتيم، روسفيتا، اسم كاتبة عاشت في المانيا، وألفت باللاتينية حوارات موزونة، كما نظمت أشعاراً في مدح الإمبراطور أوطو الأول... الحوار، النثر الموزون، المديح: كلها عناصر تقرب روسفيتا هذه من الهمذاني. تحولت افتتاحيتي حينئذ الى ما يلي: في القرن العاشر، بينما كانت روسفيتا تصوغ حوارات موزونة، ألف الهمذاني مقاماته.
لكن من داخل الجمهور سمع بروسفيتا؟ لا أحد. روسفيتا غريبة عن جمهوري غرابة الهمذاني. لن أقدم ولن أؤخر شيئاً بذكرها. ولعلي سأعقد الأمور بالإحالة عليها وسأترك شعوراً بالإمتعاض لدى المخاطبين، سأبدو كمدعٍ ينبش في أشياء غابرة عتيقة بغية إيهام الناس أنه عالم...
إن ما سعيت إليه من خلال ما تقدم هو الإشارة إلى أن الذاكرة الأدبية مختلفة عند العربي وعند الأوروبي. شيء بديهي، ولكن الذي ينبغي تأكيده أن الذاكرة تستند إلى أصل، إلى نموذج بدئي، وتعتمد على تصور لفضاء ما ولزمن ما. الأوروبي يرجع بذاكرته إلى أثينا والعربي إلى البيداء. من ناحية أخرى، وإذا اعتبرنا العامل اللغوي. فإننا نلاحظ أن ذاكرة العربي "أطول" من ذاكرة الأوروبي: إنها تخترق خمسة عشر قرناً وتمتد الى المعلقات، وإلى مهلهل بن ربيعة والشنفري، بينما لا تتجاوز ذاكرة الأوروبي اللغوية - الأدبية خمسة قرون. فبالنسبة للفرنسي، مثلاً، يبدأ الأدب الفرنسي مع فييون، شاعر القرن الخامس عشر، ويتواصل هذا الأدب مع رابلي ومونطيني. أما كتاب القرون الوسطى، كآدم الأحدب الذي عاش في القرن الثالث عشر، فلن يستطيع الفرنسي قراءتهم إلا مترجمين إلى الفرنسية الحديثة، بل لن يستطيع قراءة رابلي ومونطيني إلا مصحوبين بشرح مستفيض. لكن العربي لن يجد صعوبة تذكر عند قراءة ابن المقفع أو التوحيدي. صحيح ان قراءة أبي تمام ليست هينة، بيد أنه عند التدقيق نلاحظ أن هذا الشاعر كان يبدو عسير الفهم لمعاصريه أيضاً، ولهذا قام المعري والتبريزي بشرحه فيما بعد. ومن المعلوم أن العربية المكتوبة، خلافاً للعربية المنطوقة، لم تتغير في العمق ولم تطرأ عليها عبر التاريخ إلا تغييرات طفيفة وثانوية، بحيث إن من يستطيع اليوم قراءة نزار قباني يستطيع قراءة العباس بن الأحنف، ومن يقدر على قراءة صلاح عبد الصبور يقدر على قراءة صالح بن عبدالقدوس، ومن بوسعه قراءة زقاق المدق بوسعه قراءة كتاب البخلاء. وهذه ظاهرة غريبة عجيبة، قلّ أن نجد لها مثيلاً لدى شعوب أخرى.
لنعد الى المحاضرة التي تحدثت عنها في البداية. بدا لي، والحالة هذه، أن أنجع وسيلة لتقديم مقامات الهمذاني هي مقارنتها بالرواية التشردية أو التسكعية الإسبانية التي ازدهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر، فأحلت، عند الكلام عن أبي الفتح الإسكندري، إلى سيرة لازاريو التي يجهل مؤلفها وإلى رواية المحتال لكيفيدو، وإلى غيرهما من النماذج. بعبارة أخرى، قمت بعملية ترجمة، ترجمت المقامات، ليس بمعنى نقلها من لغة إلى لغة، وإنما بمعنى تقديمها وكأنها تنتمي إلى الرواية التشردية، فنقلتها إلى نوع مختلف، إلى أدب مغاير. قمت بترجمة ثقافية، إن صح التعبير.
يمكن اعتبار هذا عملاً بيداغوجيا محموداً وخليقاً بالثناء، لأنه مبني على التفتح وعلى احترام الآخر ومراعاة إحالاته الثقافية، لكن تبين لي فيما بعد أنه لم يكن عملاً بريئاً، وأن النهج الذي اتبعت نهج شائع لدى معظم الدارسين العرب.
غني عن القول إن ما قمت به يندرج ضمن الأدب المقارن. وربما يمكن أن نفترض أن كل قارىء عربي مقارن محنك" ليست المقارنة وقفاً على بعض المتخصصين، وإنما تعم كل من يقترب من الأدب العربي، قديمه وحديثه. أقصد أن القارىء الذي يطلع على نص عربي يربطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنص أوروبي. إنه مقارن ضرورة، أو إذا شئنا مترجم.
لتوضيح هذه المسألة، سأعرج قليلاً على المؤلف العربي القديم. لم يكن ابن رشد، كما هو شائع، يعرف اليونانية. كان اطلاعه على فلسفة أرسطو وغيره من الفلاسفة مبنياً على ترجمات لأعمال لم تكن كلها منقولة مباشرة من اليونانية. ترى هل عبّر يوماً عن أسفه لكونه يجهل اليونانية؟ هل أعرب عن رغبة في تعلمها؟ هل تمنى أن يقرأ أرسطو مباشرة ودون المرور حتماً بالترجمات؟
من جهة أخرى، ترجم ابن رشد، كما هو معروف أيضاً، الى العبرية واللاتينية، ثم إلى لغات أخرى؟ هل كان يتوقع أن يتم ذلك؟ هل كان يكتب وفي ذهنه أن من المحتمل أن تترجم مؤلفاته يوماً ما؟ وقد نضع السؤال بصيغة أخرى: هل كان ابن رشد يتمنى أن يترجم؟
بصفة عامة، وبغض النظر عن حالة ابن رشد، هل كان المؤلفون العرب يدخلون في حسابهم أن أعمالهم قد تنقل إلى لغة أو لغات أجنبية؟ كيف كانوا ينظرون الى الترجمة؟ يظهر أنهم كانوا ينظرون إليها كعملية من جانب واحد، عملية تنطلق من اللغات الأخرى الفارسية واليونانية والسريانية إلى العربية. أما العكس، فلم يكن على الأرجح يخطر لهم ببال، أو على الأقل لم يكن هماً يقض مضجعهم، ربما لأنهم كانوا يفترضون أن طالب العلم والحكمة والراغب في المشاركة فيهما لا مندوحة له من إتقان العربية، وذلك ما كان حاصلاً بالفعل.
من هو الأديب العربي الكلاسيكي الذي أحس برغبة في الإطلاع على أدب غير الأدب العربي باستثناء ما نقل ابن المقفع من الفارسية؟ من هو الأديب العربي الذي فكر يوماً أن أعماله قد تجد طريقها الى الترجمة؟ تطرح مسألة الترجمة عندما يكون هناك تجاور، مزاحمة، منافسة بين أدبين، أو عدة آداب، والحال أن الأدب العربي كان يصول ويجول في غياب تام عن أي منافس، ودون الإصطدام بأي خصم؟ لم يكن الأدباء العرب يخاطبون الا قراء يتقنون العربية، والترجمة الوحيدة التي كانوا يتصورونها هي الشرح والتعليق والحاشية، أي ترجمة داخل اللغة نفسها. هل كان أبو العلاء المعري، مثلاً، يفترض أن تترجم رسالة الغفران؟ وإلى أي لغة؟ ولمن؟ ولأي غرض وغاية؟
إن القدماء لم يكتفوا بالإستهانة بالترجمة ونبذها من تفكيرهم، بل حرصوا على جعل مؤلفاتهم غير قابلة للتحويل اللغوي، فطوروا صياغات وطرقاً في التعبير وأساليب تستعصي على النقل. ولعل أحسن مثال على ذلك مقامات الحريري، فهو كتاب تقول كل فقرة من فقره: لن يستطيع أحد ترجمتي. فكأن الحريري بذل كل ما في وسعه ليحمي كتابه ويقيه من تسلط لسان آخر. فمن يا ترى يقدم على ترجمة رسالة تقرأ طرداً وعكساً دون أن يطرأ عليها تغيير، أو رسالة تقرأ من أولها بوجه ومن آخرها بوجه آخر؟ ومن يتجاسر على ترجمة رسالة إحدى كلماتها معجمة والأخرى مهملة؟ لقد قيل إن الحريري كان يهدف الى إظهار براعته، وشبه بالبهلوان، وهذا صحيح الى حد ما، لكن الأكيد أنه كان يهدف الى استنفاد الإمكانيات الكامنة في اللغة العربية ونقلها من القوة الى الفعل. والنتيجة أن مقاماته لا يمكن تصورها مكتوبة بلغة غير العربية، وبالتالي تستحيل ترجمتها. ولا ينطبق فقط على مقامات الحريري، وإنما على سائر الكتابات القديمة.
تفحص القدماء كل الإحتمالات البلاغية واستوفوها ووظفوها، بل ذهب بهم الأمر الى حد ذم الأدب والتقليل من شأنه واستفاضوا في الحديث عن بطلانه وعدم جدواه، ولكنهم فعلوا ذلك في إطاره وداخل نسقه وحدوده. لم يعن لهم لحظة أن ينظروا إليه من الخارج، من خلال أدب آخر. لم يدر بخلدهم أن مسألة ترجمته قد تطرح في يوم من الأيام. وهذا ما حدث بالفعل في القرن التاسع عشر، ولعل الشدياق يشكل نقطة تحول تؤشر إلى صدمة اكتشاف مرير، اكتشاف أن الأدب العربي غير قابل للترجمة، ولا يهم في مجمله إلا العرب.
منذ ذلك الوقت، صار الأديب العربي، عن شعور أو بدون شعور، يدخل الترجمة في اعتباره، الترجمة بمعنى المقارنة، الموازنة، أو التحويل من أدب إلى أدب. كل دراسة عن أديب عربي معاصر هي في الواقع دراسة في الأدب المقارن. لقد أبدعنا طريقة خاصة في القراءة: نقرأ نصاً عربياً وفي ذهننا احتمال نقله أو تحويله إلى لغة أوروبية، أي في ذهننا نصوص من الأدب الفرنسي أو الإنجليزي. من يستطيع اليوم أن يقرأ شاعراً أو روائياً عربياً دون أن يقيم علاقة بينه وبين أنداده الأوروبيين؟ إن ما تغير جوهرياً في العصر الحديث بالنسبة لنا هو أن عملية القراءة والكتابة مصحوبة حتماً بترجمة محتملة، بمحاولة نقل إلى آداب أخرى، وهو ما لم يكن يدور إطلاقاً بخلد القدماء الذين لم يكونوا يرون الترجمة إلا داخل الأدب العربي.
وقد اكتسحت الترجمة أفقنا بحيث إنها تعمل حتى عندما نقرأ القدماء. نقرأ حي بن يقظان فيشرد ذهننا جهة روبنسون كروزو، نقرأ المتنبي فيذهب تفكيرنا إلى نيتشه وارادة القوة، نقرأ رسالة الغفران فإذا بالكويديا الإلهية تنبعث أمامنا شئنا أم أبينا، نقرأ اللزوميات فإذا بشوبنهاور أو شيوران يفرض نفسه علينا، نقرأ عبد القاهر الجرجاني فنلتقي فجأة بصوسير، نقرأ المنقذ من الضلال فيطل ديكارت ليخلصنا من حيرتنا. وويل للمؤلفين الذين لا نجد من يقابلهم عند الأوروبيين: إننا بكل بساطة لا نلتفت إليهم، فيقبعون في برزخ مظلم مهجور، برزخ بلا مرايا تعكس ظلهم وتنقذهم من الضياع ومن وحدة تشبه الموت.
تغيّرتالازمنة اولظروف، ولكن هناك شيئاً لم يتغير: ما أن يسمع العرب بيتاً من الشعر إلا ويطربون وتدركهم الأريحية ويهزهم الحبور، تماماً كما كان الحال بالنسبة للسلف. ولعلهم قد يضحون بكل شيء إلا بشعرهم، إنهم يعتبرون نفوسهم شعراء قبل كل شيء، ومع ذلك لم يجد شعرهم طريقه الى أوروبا، فباستثناء المتخصصين لن تجد أوروبياً يجري اسم شاعر عربي على لسانه. ولا ينطبق هذا على أوروبيي اليوم فحسب، وإنما أيضاً على أوروبيي الأمس. ماذا كان دانتي مثلاً يعرف عن الثقافة العربية؟ إنه يذكر في الكوميديا الإلهية ابن سينا وابن رشد، ولا يفوته أن يناقش بعض أفكار هذا الأخير، ومن علامات إعجابه العلني أو الخفي به، أنه خص سيجي دي برابان، أحد المتحمسين الرشديين، بمكان محترم في الفردوس. لكن دانتي، كمعظم معاصريه، لم يهتم بالأدب العربي، وعلى الأرجح لم يتعد فضوله في هذا المجال كتاب المعراج، من خلال ترجمة لاتينية. لقاءه الوحيد بالأدب العربي تم بواسطة نص سردي.
أما سيرفانتيس، فإنه كان يتصور أن العرب رواة حكايات قبل كل شيء، ولا أدل على ذلك من كونه نسب تأليف روايته دون كيخوطي لمؤرخ عربي مزعوم هو السيد حامد الأيلي أو الباذنجاني. هذه النسبة تعني أن سيرفانتيس كان يعتقد أن أصل الحكي، أصل السرد، أصل الرواية، عربي. إلا أن اللافت في رواية سيرفانتيس، علاوة على إضافة الحكي لكاتب عربي، وسم العرب بالكذب، أجل، العرب مطبوعون على الكذب، على اختلاق الروايات، إنهم يكذبون كما يتنفسون، وهذه الخاصية أهلتهم لإحراز قصب السبق في فن الحكي.
وليس هذا الاعتقاد مقصوراً على رواية سيرفانتيس، إنه قاسم مشترك بين عدة مؤلفين أوروبيين. في القرن السابع عشر، بعد زمن قصير من تأليف دون كيخوطي، نشر الأب هويي الفرنسي كتاباً تحت عنوان بحث في أصل الروايات، أكد فيه أن العرب مصدر الحكي ومنبعه. وطبعاً فسر هذه الظاهرة بكونهم أكذب خلق الله.
بناء على هذا التصور كان من الحتمي أن يهتم الأوروبيون بالسرد العربي. وفعلاً قام غالان، في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، بترجمة ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية. لم يقم بترجمة شاعر عربي، وإنما ترجم نصاً سردياً. بل إنه في ترجمته - وهذا شيء له دلالته - لم يعر أي اهتمام للمقطوعات الشعرية الموجودة في الكتاب، فلم يكلف نفسه عناء ترجمتها. كل القرائن تشير إلى أنه كان يرى أن الشعر العربي فن طارىء وعارض، قد يكون وقد لا يكون، وأن السرد هو الفن العربي الجوهري والأصيل. وبصفة عامة فإن إقبال الأوروبيين وغيرهم، من غالان إلى بورخيس، على ألف ليلة وليلة، يوطد الاعتقاد أن ما يميز العرب هو السرد، والسرد وحده.
ربما هناك قاعدة عامة وهي عدم التطابق بين تصور شعب لأدبه وتصور شعوب أخرى لهذا الأدب. ترى كيف كان ابن رشد ينظر إلى الأدب اليوناني؟ في هذا الصدد، من الطريف أن نذكر بما كتبه عبدالرحمن بدوي في مقدمته لفن الشعر لأرسطو. فبعد أن عبر عن شعور أليم بالخيبة أمام رداءة ترجمة متى بن يونس كما هو معروف، ترجم مأساة بمديح وملهاة بهجاء، وما ترتب عنها من سوء الفهم الشنيع الذي سقط فيه الفارابي وابن سينا وابن رشد، أضاف قائلاً: "يخيل إليّ أنه لو قدر لهذا الكتاب، كتاب فن الشعر، أن يفهم على حقيقته، وأن يستثمر ما فيه من موضوعات وآراء ومبادىء، لعني الأدب العربي بإدخال الفنون الشعرية العليا فيه، وهي المأساة والملهاة، منذ عهد ازدهاره في القرن الثالث الهجري، ولتغير وجه الأدب كله".
إذا كانت المأساة والملهاة هي "الفنون الشعرية العليا"، فهذا يعني أن الفنون الشعرية العربية سفلى، منحطة. من هذا المنظور، يتصف الأدب العربي بالدونية والسقوط. لم يكن هذا ليحدث لو ترجم فن الشعر ترجمة أمينة وجيدة" لو لم يخفق متى بن يونس في ترجمته، "لتغير وجه الأدب العربي كله". كان من الواجب أن يتغير الأدب العربي، إلا أنه، ويا لسوء الحظ، احتفظ بوجهه، لسبب تافه، لعلة كان بالإمكان تداركها وتلافيها. هكذا وبجرة قلم، بقلم لا يعرف السخرية، يتم التشطيب على عشرة قرون من الأدب العربي. ولا يكتفي صاحبنا بهذا بل يضيف: "ومن يدري، لعل وجه الحضارة العربية كله أن يتغير طابعه الأدبي كما تغيرت أوروبا في عصر النهضة". وجه الأدب العربي، وجه الحضارة العربية: كاد هذا الوجه أن يتغير، أن يمسخ، أن يمحى. كاد العرب أن يفقدوا هويتهم، كاد العرب أن يكونوا أوروبيين. إذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية أخرى، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول أن العرب مدينون بالكثير لمتى بن يونس، فهو الذي أنقذهم، بسبب بفضل ترجمته الرديئة والمشوّهة لكتاب أرسطو، من الخطر العظيم الذي كان يتهددهم: فقدان الوجه. بفضله لم يبتعدوا عما ألفوه من فنون وأنماط أدبية، ولم يقبلوا على دراسة الأدب اليوناني من أجل تقليده والنسج على منواله. لقد أنقذهم بصفة عفوية، دون أن ينوي ذلك أو يخطط له، ودون أن يعلم أنه خلصهم من كارثة مهولة. دون أن يعلم؟ هل حقاً كان يجهل ما قصده أرسطو بالمأساة والملهاة؟ إن هذه النقطة الشائكة تستحق أن تفصل في رواية، رواية تحكي أن متى بن يونس كان على علم تام بالمأساة والملهاة، وأنه تعمد ترجمتهما بالمديح والهجاء... لغرض في نفسه.
إلا أنه مع مرور الوقت أخذت تنتابني بعض الشكوك، واتضح لي أن المسألة صعبة للغاية. مثلاً قد أفتتح عرضي بالجملة التالية: في القرن الرابع، ألف الهمذاني المقامات. لكن ماذا سيفهم الجمهور من عبارة "القرن الرابع"؟ إنها تحيل على عناصر تاريخية، أدبية، عقائدية، بل جغرافية أيضاً، وكلها عناصر غائبة تاماً عن الجمهور الذي سأخاطبه.
قلت لنفسي: ما عليّ، والحالة هذه، إلا أن أذكر التاريخ الميلاديّ عوض التاريخ الهجري. هكذا صارت العبارة الإفتتاحية: في القرن العاشر الميلادي، ألف الهمذاني المقامات. بالانتقال الى التاريخ الميلادي سوف أربط الهمذاني بفترة يعرفها الجمهور، سوف أعقد صلة بينه وبين كتّاب أوروبيين معاصرين لبديع الزمان منشىء المقامات. ولا شك أن الجمهور سيحمد لي هذه الإلتفاتة، فقد علمتني التجربة المرة أن الآخر لن يهتم بي إلا إذا اهتممت به. من المستبعد أن أوفق إلى تقديم الأدب العربي للجمهور المفترض، إذا لم أبدأ بالإعتناء بأدبة، ولو من باب المجاملة.
هكذا رسخ في ذهني أن من الواجب إثبات قرابة ما بين الهمذاني وكتّاب أوروبيين من نفس الفترة. لكن سؤالاً لم يكن في الحسبان فاجأني: أي كتاب؟ بكامل الدهشة تبين لي أنني لا أعرف ولو كاتباً واحداً من القرن العاشر الميلادي، سواء كان أديباً أو متكلماً أو فيلسوفاً... بعد بحث طويل وممل في القواميس والموسوعات، عثرت على اسم يتيم، روسفيتا، اسم كاتبة عاشت في المانيا، وألفت باللاتينية حوارات موزونة، كما نظمت أشعاراً في مدح الإمبراطور أوطو الأول... الحوار، النثر الموزون، المديح: كلها عناصر تقرب روسفيتا هذه من الهمذاني. تحولت افتتاحيتي حينئذ الى ما يلي: في القرن العاشر، بينما كانت روسفيتا تصوغ حوارات موزونة، ألف الهمذاني مقاماته.
لكن من داخل الجمهور سمع بروسفيتا؟ لا أحد. روسفيتا غريبة عن جمهوري غرابة الهمذاني. لن أقدم ولن أؤخر شيئاً بذكرها. ولعلي سأعقد الأمور بالإحالة عليها وسأترك شعوراً بالإمتعاض لدى المخاطبين، سأبدو كمدعٍ ينبش في أشياء غابرة عتيقة بغية إيهام الناس أنه عالم...
إن ما سعيت إليه من خلال ما تقدم هو الإشارة إلى أن الذاكرة الأدبية مختلفة عند العربي وعند الأوروبي. شيء بديهي، ولكن الذي ينبغي تأكيده أن الذاكرة تستند إلى أصل، إلى نموذج بدئي، وتعتمد على تصور لفضاء ما ولزمن ما. الأوروبي يرجع بذاكرته إلى أثينا والعربي إلى البيداء. من ناحية أخرى، وإذا اعتبرنا العامل اللغوي. فإننا نلاحظ أن ذاكرة العربي "أطول" من ذاكرة الأوروبي: إنها تخترق خمسة عشر قرناً وتمتد الى المعلقات، وإلى مهلهل بن ربيعة والشنفري، بينما لا تتجاوز ذاكرة الأوروبي اللغوية - الأدبية خمسة قرون. فبالنسبة للفرنسي، مثلاً، يبدأ الأدب الفرنسي مع فييون، شاعر القرن الخامس عشر، ويتواصل هذا الأدب مع رابلي ومونطيني. أما كتاب القرون الوسطى، كآدم الأحدب الذي عاش في القرن الثالث عشر، فلن يستطيع الفرنسي قراءتهم إلا مترجمين إلى الفرنسية الحديثة، بل لن يستطيع قراءة رابلي ومونطيني إلا مصحوبين بشرح مستفيض. لكن العربي لن يجد صعوبة تذكر عند قراءة ابن المقفع أو التوحيدي. صحيح ان قراءة أبي تمام ليست هينة، بيد أنه عند التدقيق نلاحظ أن هذا الشاعر كان يبدو عسير الفهم لمعاصريه أيضاً، ولهذا قام المعري والتبريزي بشرحه فيما بعد. ومن المعلوم أن العربية المكتوبة، خلافاً للعربية المنطوقة، لم تتغير في العمق ولم تطرأ عليها عبر التاريخ إلا تغييرات طفيفة وثانوية، بحيث إن من يستطيع اليوم قراءة نزار قباني يستطيع قراءة العباس بن الأحنف، ومن يقدر على قراءة صلاح عبد الصبور يقدر على قراءة صالح بن عبدالقدوس، ومن بوسعه قراءة زقاق المدق بوسعه قراءة كتاب البخلاء. وهذه ظاهرة غريبة عجيبة، قلّ أن نجد لها مثيلاً لدى شعوب أخرى.
لنعد الى المحاضرة التي تحدثت عنها في البداية. بدا لي، والحالة هذه، أن أنجع وسيلة لتقديم مقامات الهمذاني هي مقارنتها بالرواية التشردية أو التسكعية الإسبانية التي ازدهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر، فأحلت، عند الكلام عن أبي الفتح الإسكندري، إلى سيرة لازاريو التي يجهل مؤلفها وإلى رواية المحتال لكيفيدو، وإلى غيرهما من النماذج. بعبارة أخرى، قمت بعملية ترجمة، ترجمت المقامات، ليس بمعنى نقلها من لغة إلى لغة، وإنما بمعنى تقديمها وكأنها تنتمي إلى الرواية التشردية، فنقلتها إلى نوع مختلف، إلى أدب مغاير. قمت بترجمة ثقافية، إن صح التعبير.
يمكن اعتبار هذا عملاً بيداغوجيا محموداً وخليقاً بالثناء، لأنه مبني على التفتح وعلى احترام الآخر ومراعاة إحالاته الثقافية، لكن تبين لي فيما بعد أنه لم يكن عملاً بريئاً، وأن النهج الذي اتبعت نهج شائع لدى معظم الدارسين العرب.
غني عن القول إن ما قمت به يندرج ضمن الأدب المقارن. وربما يمكن أن نفترض أن كل قارىء عربي مقارن محنك" ليست المقارنة وقفاً على بعض المتخصصين، وإنما تعم كل من يقترب من الأدب العربي، قديمه وحديثه. أقصد أن القارىء الذي يطلع على نص عربي يربطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنص أوروبي. إنه مقارن ضرورة، أو إذا شئنا مترجم.
لتوضيح هذه المسألة، سأعرج قليلاً على المؤلف العربي القديم. لم يكن ابن رشد، كما هو شائع، يعرف اليونانية. كان اطلاعه على فلسفة أرسطو وغيره من الفلاسفة مبنياً على ترجمات لأعمال لم تكن كلها منقولة مباشرة من اليونانية. ترى هل عبّر يوماً عن أسفه لكونه يجهل اليونانية؟ هل أعرب عن رغبة في تعلمها؟ هل تمنى أن يقرأ أرسطو مباشرة ودون المرور حتماً بالترجمات؟
من جهة أخرى، ترجم ابن رشد، كما هو معروف أيضاً، الى العبرية واللاتينية، ثم إلى لغات أخرى؟ هل كان يتوقع أن يتم ذلك؟ هل كان يكتب وفي ذهنه أن من المحتمل أن تترجم مؤلفاته يوماً ما؟ وقد نضع السؤال بصيغة أخرى: هل كان ابن رشد يتمنى أن يترجم؟
بصفة عامة، وبغض النظر عن حالة ابن رشد، هل كان المؤلفون العرب يدخلون في حسابهم أن أعمالهم قد تنقل إلى لغة أو لغات أجنبية؟ كيف كانوا ينظرون الى الترجمة؟ يظهر أنهم كانوا ينظرون إليها كعملية من جانب واحد، عملية تنطلق من اللغات الأخرى الفارسية واليونانية والسريانية إلى العربية. أما العكس، فلم يكن على الأرجح يخطر لهم ببال، أو على الأقل لم يكن هماً يقض مضجعهم، ربما لأنهم كانوا يفترضون أن طالب العلم والحكمة والراغب في المشاركة فيهما لا مندوحة له من إتقان العربية، وذلك ما كان حاصلاً بالفعل.
من هو الأديب العربي الكلاسيكي الذي أحس برغبة في الإطلاع على أدب غير الأدب العربي باستثناء ما نقل ابن المقفع من الفارسية؟ من هو الأديب العربي الذي فكر يوماً أن أعماله قد تجد طريقها الى الترجمة؟ تطرح مسألة الترجمة عندما يكون هناك تجاور، مزاحمة، منافسة بين أدبين، أو عدة آداب، والحال أن الأدب العربي كان يصول ويجول في غياب تام عن أي منافس، ودون الإصطدام بأي خصم؟ لم يكن الأدباء العرب يخاطبون الا قراء يتقنون العربية، والترجمة الوحيدة التي كانوا يتصورونها هي الشرح والتعليق والحاشية، أي ترجمة داخل اللغة نفسها. هل كان أبو العلاء المعري، مثلاً، يفترض أن تترجم رسالة الغفران؟ وإلى أي لغة؟ ولمن؟ ولأي غرض وغاية؟
إن القدماء لم يكتفوا بالإستهانة بالترجمة ونبذها من تفكيرهم، بل حرصوا على جعل مؤلفاتهم غير قابلة للتحويل اللغوي، فطوروا صياغات وطرقاً في التعبير وأساليب تستعصي على النقل. ولعل أحسن مثال على ذلك مقامات الحريري، فهو كتاب تقول كل فقرة من فقره: لن يستطيع أحد ترجمتي. فكأن الحريري بذل كل ما في وسعه ليحمي كتابه ويقيه من تسلط لسان آخر. فمن يا ترى يقدم على ترجمة رسالة تقرأ طرداً وعكساً دون أن يطرأ عليها تغيير، أو رسالة تقرأ من أولها بوجه ومن آخرها بوجه آخر؟ ومن يتجاسر على ترجمة رسالة إحدى كلماتها معجمة والأخرى مهملة؟ لقد قيل إن الحريري كان يهدف الى إظهار براعته، وشبه بالبهلوان، وهذا صحيح الى حد ما، لكن الأكيد أنه كان يهدف الى استنفاد الإمكانيات الكامنة في اللغة العربية ونقلها من القوة الى الفعل. والنتيجة أن مقاماته لا يمكن تصورها مكتوبة بلغة غير العربية، وبالتالي تستحيل ترجمتها. ولا ينطبق فقط على مقامات الحريري، وإنما على سائر الكتابات القديمة.
تفحص القدماء كل الإحتمالات البلاغية واستوفوها ووظفوها، بل ذهب بهم الأمر الى حد ذم الأدب والتقليل من شأنه واستفاضوا في الحديث عن بطلانه وعدم جدواه، ولكنهم فعلوا ذلك في إطاره وداخل نسقه وحدوده. لم يعن لهم لحظة أن ينظروا إليه من الخارج، من خلال أدب آخر. لم يدر بخلدهم أن مسألة ترجمته قد تطرح في يوم من الأيام. وهذا ما حدث بالفعل في القرن التاسع عشر، ولعل الشدياق يشكل نقطة تحول تؤشر إلى صدمة اكتشاف مرير، اكتشاف أن الأدب العربي غير قابل للترجمة، ولا يهم في مجمله إلا العرب.
منذ ذلك الوقت، صار الأديب العربي، عن شعور أو بدون شعور، يدخل الترجمة في اعتباره، الترجمة بمعنى المقارنة، الموازنة، أو التحويل من أدب إلى أدب. كل دراسة عن أديب عربي معاصر هي في الواقع دراسة في الأدب المقارن. لقد أبدعنا طريقة خاصة في القراءة: نقرأ نصاً عربياً وفي ذهننا احتمال نقله أو تحويله إلى لغة أوروبية، أي في ذهننا نصوص من الأدب الفرنسي أو الإنجليزي. من يستطيع اليوم أن يقرأ شاعراً أو روائياً عربياً دون أن يقيم علاقة بينه وبين أنداده الأوروبيين؟ إن ما تغير جوهرياً في العصر الحديث بالنسبة لنا هو أن عملية القراءة والكتابة مصحوبة حتماً بترجمة محتملة، بمحاولة نقل إلى آداب أخرى، وهو ما لم يكن يدور إطلاقاً بخلد القدماء الذين لم يكونوا يرون الترجمة إلا داخل الأدب العربي.
وقد اكتسحت الترجمة أفقنا بحيث إنها تعمل حتى عندما نقرأ القدماء. نقرأ حي بن يقظان فيشرد ذهننا جهة روبنسون كروزو، نقرأ المتنبي فيذهب تفكيرنا إلى نيتشه وارادة القوة، نقرأ رسالة الغفران فإذا بالكويديا الإلهية تنبعث أمامنا شئنا أم أبينا، نقرأ اللزوميات فإذا بشوبنهاور أو شيوران يفرض نفسه علينا، نقرأ عبد القاهر الجرجاني فنلتقي فجأة بصوسير، نقرأ المنقذ من الضلال فيطل ديكارت ليخلصنا من حيرتنا. وويل للمؤلفين الذين لا نجد من يقابلهم عند الأوروبيين: إننا بكل بساطة لا نلتفت إليهم، فيقبعون في برزخ مظلم مهجور، برزخ بلا مرايا تعكس ظلهم وتنقذهم من الضياع ومن وحدة تشبه الموت.
تغيّرتالازمنة اولظروف، ولكن هناك شيئاً لم يتغير: ما أن يسمع العرب بيتاً من الشعر إلا ويطربون وتدركهم الأريحية ويهزهم الحبور، تماماً كما كان الحال بالنسبة للسلف. ولعلهم قد يضحون بكل شيء إلا بشعرهم، إنهم يعتبرون نفوسهم شعراء قبل كل شيء، ومع ذلك لم يجد شعرهم طريقه الى أوروبا، فباستثناء المتخصصين لن تجد أوروبياً يجري اسم شاعر عربي على لسانه. ولا ينطبق هذا على أوروبيي اليوم فحسب، وإنما أيضاً على أوروبيي الأمس. ماذا كان دانتي مثلاً يعرف عن الثقافة العربية؟ إنه يذكر في الكوميديا الإلهية ابن سينا وابن رشد، ولا يفوته أن يناقش بعض أفكار هذا الأخير، ومن علامات إعجابه العلني أو الخفي به، أنه خص سيجي دي برابان، أحد المتحمسين الرشديين، بمكان محترم في الفردوس. لكن دانتي، كمعظم معاصريه، لم يهتم بالأدب العربي، وعلى الأرجح لم يتعد فضوله في هذا المجال كتاب المعراج، من خلال ترجمة لاتينية. لقاءه الوحيد بالأدب العربي تم بواسطة نص سردي.
أما سيرفانتيس، فإنه كان يتصور أن العرب رواة حكايات قبل كل شيء، ولا أدل على ذلك من كونه نسب تأليف روايته دون كيخوطي لمؤرخ عربي مزعوم هو السيد حامد الأيلي أو الباذنجاني. هذه النسبة تعني أن سيرفانتيس كان يعتقد أن أصل الحكي، أصل السرد، أصل الرواية، عربي. إلا أن اللافت في رواية سيرفانتيس، علاوة على إضافة الحكي لكاتب عربي، وسم العرب بالكذب، أجل، العرب مطبوعون على الكذب، على اختلاق الروايات، إنهم يكذبون كما يتنفسون، وهذه الخاصية أهلتهم لإحراز قصب السبق في فن الحكي.
وليس هذا الاعتقاد مقصوراً على رواية سيرفانتيس، إنه قاسم مشترك بين عدة مؤلفين أوروبيين. في القرن السابع عشر، بعد زمن قصير من تأليف دون كيخوطي، نشر الأب هويي الفرنسي كتاباً تحت عنوان بحث في أصل الروايات، أكد فيه أن العرب مصدر الحكي ومنبعه. وطبعاً فسر هذه الظاهرة بكونهم أكذب خلق الله.
بناء على هذا التصور كان من الحتمي أن يهتم الأوروبيون بالسرد العربي. وفعلاً قام غالان، في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، بترجمة ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية. لم يقم بترجمة شاعر عربي، وإنما ترجم نصاً سردياً. بل إنه في ترجمته - وهذا شيء له دلالته - لم يعر أي اهتمام للمقطوعات الشعرية الموجودة في الكتاب، فلم يكلف نفسه عناء ترجمتها. كل القرائن تشير إلى أنه كان يرى أن الشعر العربي فن طارىء وعارض، قد يكون وقد لا يكون، وأن السرد هو الفن العربي الجوهري والأصيل. وبصفة عامة فإن إقبال الأوروبيين وغيرهم، من غالان إلى بورخيس، على ألف ليلة وليلة، يوطد الاعتقاد أن ما يميز العرب هو السرد، والسرد وحده.
ربما هناك قاعدة عامة وهي عدم التطابق بين تصور شعب لأدبه وتصور شعوب أخرى لهذا الأدب. ترى كيف كان ابن رشد ينظر إلى الأدب اليوناني؟ في هذا الصدد، من الطريف أن نذكر بما كتبه عبدالرحمن بدوي في مقدمته لفن الشعر لأرسطو. فبعد أن عبر عن شعور أليم بالخيبة أمام رداءة ترجمة متى بن يونس كما هو معروف، ترجم مأساة بمديح وملهاة بهجاء، وما ترتب عنها من سوء الفهم الشنيع الذي سقط فيه الفارابي وابن سينا وابن رشد، أضاف قائلاً: "يخيل إليّ أنه لو قدر لهذا الكتاب، كتاب فن الشعر، أن يفهم على حقيقته، وأن يستثمر ما فيه من موضوعات وآراء ومبادىء، لعني الأدب العربي بإدخال الفنون الشعرية العليا فيه، وهي المأساة والملهاة، منذ عهد ازدهاره في القرن الثالث الهجري، ولتغير وجه الأدب كله".
إذا كانت المأساة والملهاة هي "الفنون الشعرية العليا"، فهذا يعني أن الفنون الشعرية العربية سفلى، منحطة. من هذا المنظور، يتصف الأدب العربي بالدونية والسقوط. لم يكن هذا ليحدث لو ترجم فن الشعر ترجمة أمينة وجيدة" لو لم يخفق متى بن يونس في ترجمته، "لتغير وجه الأدب العربي كله". كان من الواجب أن يتغير الأدب العربي، إلا أنه، ويا لسوء الحظ، احتفظ بوجهه، لسبب تافه، لعلة كان بالإمكان تداركها وتلافيها. هكذا وبجرة قلم، بقلم لا يعرف السخرية، يتم التشطيب على عشرة قرون من الأدب العربي. ولا يكتفي صاحبنا بهذا بل يضيف: "ومن يدري، لعل وجه الحضارة العربية كله أن يتغير طابعه الأدبي كما تغيرت أوروبا في عصر النهضة". وجه الأدب العربي، وجه الحضارة العربية: كاد هذا الوجه أن يتغير، أن يمسخ، أن يمحى. كاد العرب أن يفقدوا هويتهم، كاد العرب أن يكونوا أوروبيين. إذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية أخرى، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول أن العرب مدينون بالكثير لمتى بن يونس، فهو الذي أنقذهم، بسبب بفضل ترجمته الرديئة والمشوّهة لكتاب أرسطو، من الخطر العظيم الذي كان يتهددهم: فقدان الوجه. بفضله لم يبتعدوا عما ألفوه من فنون وأنماط أدبية، ولم يقبلوا على دراسة الأدب اليوناني من أجل تقليده والنسج على منواله. لقد أنقذهم بصفة عفوية، دون أن ينوي ذلك أو يخطط له، ودون أن يعلم أنه خلصهم من كارثة مهولة. دون أن يعلم؟ هل حقاً كان يجهل ما قصده أرسطو بالمأساة والملهاة؟ إن هذه النقطة الشائكة تستحق أن تفصل في رواية، رواية تحكي أن متى بن يونس كان على علم تام بالمأساة والملهاة، وأنه تعمد ترجمتهما بالمديح والهجاء... لغرض في نفسه.