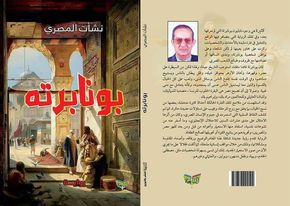في رسالة الغفران للمعري، وهو المؤلَّف الذي يصف فيه الآخرة، يُخَصَّصُ مقطع مثير لِلُغة الإنسان الأول، نعلم من خلاله أن آدم كان يتكلم اللغة العربية في الجنة، كما نقرأ أنه عندما هبط من الفردوس، نسي العربية فأخذ يتكلم السريانية. وهكذا اقترن عنده تغيير المكان بفقدان لغة واكتساب أخرى، ندرك أن نسيان اللغة الأصلية يعتبر عقاباً. وبطبيعة الحال، بعد البعث والعودة إلى الجنة، سينسى آدم السريانية ويستعيد اللغة العربية...
لا تغيير للمكان من دون عقاب: فقد ينسى المرء لغته، وبعبارة أخرى، قد يصبح آخر. كثير من المغاربيين، وكثير من العرب يمكنهم اليوم أن يتعرفوا على أنفسهم في قصة آدم. فهم، بكيفية أو بأخرى، تعلموا لغة أجنبية «فنسوا» لغتهم.
LLL
حتى سِن السابعة، لم أكن أعرف إلا العربية، وبما أنني لا أذْكر كيف اكتسبتها (فمن منا يذكر كيف تعلم التكلم؟)، أميل إلى الاعتقاد أن هذه اللغة فطرية، وأنني جئت إلى الدنيا معها. كانت في انسجام مع العالم الذي ترعرعت فيه، عالمِ المنزل، والأسرة، والحيّ. كان العالم حينئذ مكتفياً بذاته، منغلقاً مكتملاً. كنت أعلم شبه علم أن أفراداً ينتمون إلى ديانة مخالفة كانوا يتكلمون الفرنسية والإسبانية.
درست اللغة الفرنسية بسبب عثرة من عثرات التاريخ، أو الجغرافية بالأحرى. لو أنني ولدت شمال المغرب، لكنت درست لغة ثيرفانطيس، وأعتقد أن مساري العلمي وقدَري كانا سيتخذان منحى آخر. توجهت نحو اللغة الفرنسية، لأنني ولدت في الرباط، في المنطقة التي تخضع لحماية فرنسا.
ذات صباح، أخذني أبي إلى المدرسة من غير أن يسألني رأيي. كانت رحلةً بحق: كان ينبغي الخروج من البيت، ومغادرة المدينة العتيقة، والذهاب إلى ما وراء الأسوار، ووطْء أرض لم أجرؤ قط على اقتحامها فيما سبق، أرض المدينة الجديدة. رأيت للمرة الأولى عربات تجرها خيول، كما رأيت بعض السيارات النادرة. في فناء المدرسة، كانت هناك جماعة من الأطفال يصيحون ويجْرون في كل الجهات. وبما أنني لم أكن أعرفهم، كان يُخَيل إليّ أنهم يناصبونني العداء. وسط البلبلة بحثت عن أبي كي أحتمي به: كان قد اختفى. كنت قد تُركت لوحدي ضالاً تائهاً (لم أكن أعرف بعدُ حكاية الصغير بوسي). ومع ذلك، فبعد الدرس، الذي لم أعد أذكر منه شيئاً على الإطلاق، وُفّقت بأعجوبة في العودة إلى البيت. التقيتُ أهلي، وعلى عكس آدم، لم أنس العربية.
غدت الرحلة فيما بعد رحلة يومية، من المدينة العتيقة إلى ما وراء السور، من الفضاء الأسروي المألوف إلى الفضاء الأجنبيّ الغريب. وهي أيضاً رحلة من الشفويّ إلى المكتوب: فَرَضت الفرنسية عليّ نفسها كلغة لا تنفصل عن الكتابة. تعلمتها عن طريق تهجّي الحروف وتدوينها. درستها، لا لأتكلمها، وإنما لأقرأها وأكتبها. ما أن كنت أغادر القسم، حتى كانت تمّحي، إذ لم تكن لي فرصة لاستخدامها. صحيح أنني تمكنتُ تدريجياً من التحدّث بها، إلا أنني لم تُتَح لي فرصة استعمالها، اللهم إلا مع معلمي المدرسة. خارج المؤسسة التعليمية، لم يكن يجري بها العمل: التلاميذ لا يتكلمون بها فيما بينهم، وفي البيت، كانت منبوذة. كانت لغة الانفصال: ربما لأول مرة في تاريخ المغرب، تلَقى الأطفال لغة لا يعرفها آباؤهم.
كنا ننجز إملاءات صحيحة، وإنشاءات لا تخلو من جودة، إلا أننا كنا لا نستطيع التحدث باللغة الفرنسية بطلاقة: وعلى أية حال، فقد كنا عاجزين عن التكلم مثل الفرنسيين. وقد استمرت الحال، فيما يخصني، على هذا النحو حتى اليوم. لا أستطيع أن أتكلم إلا لغة الكتب، لغة الأدب، وخارج هذا النطاق أجدني في فاقة وعجز. أتكلم الفرنسية كما أكتبها، مع هذا الفارق، أنني لا أستطيع فحْص ما أقول لتصحيحه عند الحاجة.
كانت الفصحى، التي كنت أدْرُسها في الوقت نفسه مع الفرنسية، مقصورةً هي أيضاً على المدرسة، على الكِتاب. كنا نتعلمها من أجل قراءتها وكتابتها، مثل الفرنسية. رغم التقارب بين الدارجة والفصحى، هناك اقتسام للوظائف: الدارجة للتواصل اليومي، أما الفصحى فمرتبطة بالدين والسياسة، وبما هو نبيل ورسمي وفخم. لأجل ذلك، فهي تبعث على الخوف بعض الشيء، خصوصاً وأنها تتحول بسهولة إلى لغة متخشبة. لا يُتحدث بها، بل إن مناسبات التحدث بها أقل من الفرنسية. وفي استطاعتنا أن نذهب حتى الزعم بأنه بعيداً عن بعض المناسبات، فمن المحرّم التحدّث بها، وإلا العُرضة للاستهزاء: فلا أحد، على سبيل المثال، قد يتجرأ على استعمالها وهو يتسوّق ويقضي مهامّه اليومية. إنها لغة المقدس، لغة الإنشاد الشعري، وخطابات التبجيل، لغة الأدب. فيما يخصني هي أساساً لغة الندوات واللقاءات: في هذه المناسبات يغدو التكلم بالنسبة إليّ نوعاً من المسخ. أشعر بتحول ينتابني، فأغدو خطيباً مذهولاً، وممثِلاً خجولاً، متردداً مُعَرّضاً لأن أتعثر في أية لحظة في هذه الصيغة أو تلك.
أتكلم الدارجة، أقرأ الفصحى. عوَّدني التكوين الذي تلقيته على ألا أقرأ إلا النصوص التي كُتبت بالفرنسية أو بالفصحى. صحيح أن هناك أشعاراً وحكايات وأمثالاً بالدارجة، إلا أنها تظل بالنسبة إليّ مرتبطة أساساً بالشفوي. عندما يحصل لي أن أقرأها، أحس بانطباع غريب: فبسبب النقص في التعوّد، آخذ في تهجّيها كما لو كانت مكتوبة بلغة أجنبية. بقدر ما يكون التكلم بالدارجة يسيراً، بقدر ما تكون قراءتها شاقة مملوءة بالفخاخ. مما يدل على أن للّغتين الفرنسية والفصحى نقطة مشتركة وهي كونهما لغتَي التدوين، وبالتالي لغتي الأدب. عن طريقهما تمكنت من الاستمتاع بلذة قراءة النصوص الأدبية.
هما لغتا لذة، ولكن أيضاً لغتا الخطأ، من حيث إنني أخشى على الدوام ألا أكون قد استعملتهما «على الوجه الصحيح». لا يُطرح عليّ هذا المشكل عندما أتكلم الدارجة: حينها يمكنني أن استعمل لفظاً بدل آخر، إلا أنني لا أرتكب أخطاء على الإطلاق، من ثمة ذلك الشعور بالأمن والطمأنينة. لقد تعلمت ما تعلمته من الدارجة دفعة واحدة. يمكن أن نقول إنني لم أتقدم في معرفتها منذ سن الثالثة. وظللت أتصور أن ليس فيها مناطق غامضة، أو جانب مجهول. ليس الأمر على النحو نفسه، فيما يخص الفرنسية والفصحى، فقد تعلمتهما، وما زلت. بما أن علاقتي بهما قائمة بالأساس على المكتوب، فإنني أقول في نفسي، كلما صغت جملة من الجمل، ربما أتيت خطأ متعلقاً بالتركيب، وتوافق الأزمنة أو الإعراب. لا شك أنني تقدمت مع مر السنين في معرفتهما، إلا أنني لن أتمكن منهما تمام التمكّن. لذا فإن عليّ أن أراقب نفسي دون هوادة، وأن أكون شديد الاحتراس على الدوام. الأخطار متعددة، ومن شأن الخطأ أن يكلف ثمناً باهظاً. أنا معرّض دوماً لأن أتعثر، وقد يصعب في بعض الأحيان استئناف السير بعد السقطة.(1)
ترجمة: عبدالسلام بن عبدالعالي
1. هناك ملاحظة لإيـمي سيزير أدهشتني بعض الشيء: «عندما بدأنا في كتابة لغة الكريول(CRÉOLE) وعندما قررنا تعليمها، لم يتلق الشعب ذلك بارتياح. مؤخرا التقيت امرأة وسألتها: «سيدتي، سجلتِ أبناءك في المدرسة، أتعلمين أن إجراء بالغ الأهمية قد اتخذ: إننا سنعلم الكريول في المدرسة. فهل يرضيك ذلك؟» أجابتني: «كيف يرضيني؟ كلا، لأنني إذا أرسلت ابني إلى المدرسة - قالتها بالكريول - فليس لتعلم الكريول، وإنما لتعلم الفرنسية. الكريول أنا التي أتكفل بتعليمه إياه، وفي البيت». أثارني حسها السليم. وفي ما قالته كان هناك شيء من الحقيقة». زنجي أنا، زنجي سأبقى.
لا تغيير للمكان من دون عقاب: فقد ينسى المرء لغته، وبعبارة أخرى، قد يصبح آخر. كثير من المغاربيين، وكثير من العرب يمكنهم اليوم أن يتعرفوا على أنفسهم في قصة آدم. فهم، بكيفية أو بأخرى، تعلموا لغة أجنبية «فنسوا» لغتهم.
LLL
حتى سِن السابعة، لم أكن أعرف إلا العربية، وبما أنني لا أذْكر كيف اكتسبتها (فمن منا يذكر كيف تعلم التكلم؟)، أميل إلى الاعتقاد أن هذه اللغة فطرية، وأنني جئت إلى الدنيا معها. كانت في انسجام مع العالم الذي ترعرعت فيه، عالمِ المنزل، والأسرة، والحيّ. كان العالم حينئذ مكتفياً بذاته، منغلقاً مكتملاً. كنت أعلم شبه علم أن أفراداً ينتمون إلى ديانة مخالفة كانوا يتكلمون الفرنسية والإسبانية.
درست اللغة الفرنسية بسبب عثرة من عثرات التاريخ، أو الجغرافية بالأحرى. لو أنني ولدت شمال المغرب، لكنت درست لغة ثيرفانطيس، وأعتقد أن مساري العلمي وقدَري كانا سيتخذان منحى آخر. توجهت نحو اللغة الفرنسية، لأنني ولدت في الرباط، في المنطقة التي تخضع لحماية فرنسا.
ذات صباح، أخذني أبي إلى المدرسة من غير أن يسألني رأيي. كانت رحلةً بحق: كان ينبغي الخروج من البيت، ومغادرة المدينة العتيقة، والذهاب إلى ما وراء الأسوار، ووطْء أرض لم أجرؤ قط على اقتحامها فيما سبق، أرض المدينة الجديدة. رأيت للمرة الأولى عربات تجرها خيول، كما رأيت بعض السيارات النادرة. في فناء المدرسة، كانت هناك جماعة من الأطفال يصيحون ويجْرون في كل الجهات. وبما أنني لم أكن أعرفهم، كان يُخَيل إليّ أنهم يناصبونني العداء. وسط البلبلة بحثت عن أبي كي أحتمي به: كان قد اختفى. كنت قد تُركت لوحدي ضالاً تائهاً (لم أكن أعرف بعدُ حكاية الصغير بوسي). ومع ذلك، فبعد الدرس، الذي لم أعد أذكر منه شيئاً على الإطلاق، وُفّقت بأعجوبة في العودة إلى البيت. التقيتُ أهلي، وعلى عكس آدم، لم أنس العربية.
غدت الرحلة فيما بعد رحلة يومية، من المدينة العتيقة إلى ما وراء السور، من الفضاء الأسروي المألوف إلى الفضاء الأجنبيّ الغريب. وهي أيضاً رحلة من الشفويّ إلى المكتوب: فَرَضت الفرنسية عليّ نفسها كلغة لا تنفصل عن الكتابة. تعلمتها عن طريق تهجّي الحروف وتدوينها. درستها، لا لأتكلمها، وإنما لأقرأها وأكتبها. ما أن كنت أغادر القسم، حتى كانت تمّحي، إذ لم تكن لي فرصة لاستخدامها. صحيح أنني تمكنتُ تدريجياً من التحدّث بها، إلا أنني لم تُتَح لي فرصة استعمالها، اللهم إلا مع معلمي المدرسة. خارج المؤسسة التعليمية، لم يكن يجري بها العمل: التلاميذ لا يتكلمون بها فيما بينهم، وفي البيت، كانت منبوذة. كانت لغة الانفصال: ربما لأول مرة في تاريخ المغرب، تلَقى الأطفال لغة لا يعرفها آباؤهم.
كنا ننجز إملاءات صحيحة، وإنشاءات لا تخلو من جودة، إلا أننا كنا لا نستطيع التحدث باللغة الفرنسية بطلاقة: وعلى أية حال، فقد كنا عاجزين عن التكلم مثل الفرنسيين. وقد استمرت الحال، فيما يخصني، على هذا النحو حتى اليوم. لا أستطيع أن أتكلم إلا لغة الكتب، لغة الأدب، وخارج هذا النطاق أجدني في فاقة وعجز. أتكلم الفرنسية كما أكتبها، مع هذا الفارق، أنني لا أستطيع فحْص ما أقول لتصحيحه عند الحاجة.
كانت الفصحى، التي كنت أدْرُسها في الوقت نفسه مع الفرنسية، مقصورةً هي أيضاً على المدرسة، على الكِتاب. كنا نتعلمها من أجل قراءتها وكتابتها، مثل الفرنسية. رغم التقارب بين الدارجة والفصحى، هناك اقتسام للوظائف: الدارجة للتواصل اليومي، أما الفصحى فمرتبطة بالدين والسياسة، وبما هو نبيل ورسمي وفخم. لأجل ذلك، فهي تبعث على الخوف بعض الشيء، خصوصاً وأنها تتحول بسهولة إلى لغة متخشبة. لا يُتحدث بها، بل إن مناسبات التحدث بها أقل من الفرنسية. وفي استطاعتنا أن نذهب حتى الزعم بأنه بعيداً عن بعض المناسبات، فمن المحرّم التحدّث بها، وإلا العُرضة للاستهزاء: فلا أحد، على سبيل المثال، قد يتجرأ على استعمالها وهو يتسوّق ويقضي مهامّه اليومية. إنها لغة المقدس، لغة الإنشاد الشعري، وخطابات التبجيل، لغة الأدب. فيما يخصني هي أساساً لغة الندوات واللقاءات: في هذه المناسبات يغدو التكلم بالنسبة إليّ نوعاً من المسخ. أشعر بتحول ينتابني، فأغدو خطيباً مذهولاً، وممثِلاً خجولاً، متردداً مُعَرّضاً لأن أتعثر في أية لحظة في هذه الصيغة أو تلك.
أتكلم الدارجة، أقرأ الفصحى. عوَّدني التكوين الذي تلقيته على ألا أقرأ إلا النصوص التي كُتبت بالفرنسية أو بالفصحى. صحيح أن هناك أشعاراً وحكايات وأمثالاً بالدارجة، إلا أنها تظل بالنسبة إليّ مرتبطة أساساً بالشفوي. عندما يحصل لي أن أقرأها، أحس بانطباع غريب: فبسبب النقص في التعوّد، آخذ في تهجّيها كما لو كانت مكتوبة بلغة أجنبية. بقدر ما يكون التكلم بالدارجة يسيراً، بقدر ما تكون قراءتها شاقة مملوءة بالفخاخ. مما يدل على أن للّغتين الفرنسية والفصحى نقطة مشتركة وهي كونهما لغتَي التدوين، وبالتالي لغتي الأدب. عن طريقهما تمكنت من الاستمتاع بلذة قراءة النصوص الأدبية.
هما لغتا لذة، ولكن أيضاً لغتا الخطأ، من حيث إنني أخشى على الدوام ألا أكون قد استعملتهما «على الوجه الصحيح». لا يُطرح عليّ هذا المشكل عندما أتكلم الدارجة: حينها يمكنني أن استعمل لفظاً بدل آخر، إلا أنني لا أرتكب أخطاء على الإطلاق، من ثمة ذلك الشعور بالأمن والطمأنينة. لقد تعلمت ما تعلمته من الدارجة دفعة واحدة. يمكن أن نقول إنني لم أتقدم في معرفتها منذ سن الثالثة. وظللت أتصور أن ليس فيها مناطق غامضة، أو جانب مجهول. ليس الأمر على النحو نفسه، فيما يخص الفرنسية والفصحى، فقد تعلمتهما، وما زلت. بما أن علاقتي بهما قائمة بالأساس على المكتوب، فإنني أقول في نفسي، كلما صغت جملة من الجمل، ربما أتيت خطأ متعلقاً بالتركيب، وتوافق الأزمنة أو الإعراب. لا شك أنني تقدمت مع مر السنين في معرفتهما، إلا أنني لن أتمكن منهما تمام التمكّن. لذا فإن عليّ أن أراقب نفسي دون هوادة، وأن أكون شديد الاحتراس على الدوام. الأخطار متعددة، ومن شأن الخطأ أن يكلف ثمناً باهظاً. أنا معرّض دوماً لأن أتعثر، وقد يصعب في بعض الأحيان استئناف السير بعد السقطة.(1)
ترجمة: عبدالسلام بن عبدالعالي
1. هناك ملاحظة لإيـمي سيزير أدهشتني بعض الشيء: «عندما بدأنا في كتابة لغة الكريول(CRÉOLE) وعندما قررنا تعليمها، لم يتلق الشعب ذلك بارتياح. مؤخرا التقيت امرأة وسألتها: «سيدتي، سجلتِ أبناءك في المدرسة، أتعلمين أن إجراء بالغ الأهمية قد اتخذ: إننا سنعلم الكريول في المدرسة. فهل يرضيك ذلك؟» أجابتني: «كيف يرضيني؟ كلا، لأنني إذا أرسلت ابني إلى المدرسة - قالتها بالكريول - فليس لتعلم الكريول، وإنما لتعلم الفرنسية. الكريول أنا التي أتكفل بتعليمه إياه، وفي البيت». أثارني حسها السليم. وفي ما قالته كان هناك شيء من الحقيقة». زنجي أنا، زنجي سأبقى.