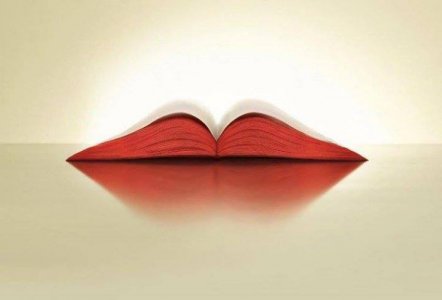كان الهجوم على الثقافة اليونانية، في فروع الآداب والفلسفة، تعبيراً عن هيمنة تيار سائد في العصور التي غلب عليها "أهل النقل" فكرياً. وهي عصور سادت فيها أقوال كتلك التي رواها السيوطي في كتابه "صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام". ومنها ذلك القول المنسوب إلى الشافعي: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العربي وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس"، وهو قول كان نموذجاً لأقاويل. وكان ذلك في حالات من العداء تتزايد مع تزايد نفوذ المتشددين، أولئك الذين ظلوا ينظرون نظرة الاتهام الى هؤلاء الذين قيل في أحدهم:
فارقت علم الشافعيِّ ومالكٍ = وشَرَعتَ في الإسلام رأي دِقلّسِ
وقد نسب إلى ابن أبي الحديد قوله:
فلتخسأ الحكماءُ عن = حرَمٍ له الأملاكُ تَشْهَد
مَنْ أنتَ يا رِسْطُوُ ومَن = أَفْلاَطُ قَبـْلَكَ يا مُبَلّد
ومَن ابنِ سينا حين قَرَّ = رَ ما هَذِيـتَ به وشَـيد
ووصل الأمر إلى درجة أن كل من كان يظهر أية عناية بالعلوم اليونانية يتهم في دينه، ويسعى الساعون إلى عقابه كي يكون عبرة لأمثاله. وكان حرص على الكشف عن المارقين من المتأثرين أو المتعاطفين أو المتعاطين لعلوم الأوائل في فروع المعرفة المختلفة، حتى بين المشتغلين بعلوم الدىن الذين اتبعوا هذا المذهب أو ذاك من مذاهب الفقه، على نحو ما أوضح تفصىلاً المستشرق الألماني غولدتسيهر في بحثه "موقف أهل السنّة القدماء بإزاء علوم الأوائل". وهو البحث الذي ترجمه عبدالرحمن بدوي ونشره ضمن كتابه "التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية".
وقد تتبع غولدتسيهر الآثار المدمرة لتشدد المتطرفين في التعامل مع التراث الإنساني غير العربي عموماً، والتراث الفلسفي خصوصاً. ومن النماذج الدالة على ذلك - في ما يذكره - إحراق كتب الأوائل التي كانت عند عبدالسلام بن عبدالوهاب الملقَّب بركن الدىن المتوفى سنة 611هـ حفيد المتصوف الحنبلي عبدالقادر الجيلاني. وقد أحرقت كتبه في نار عظيمة أمام مسجد مجاور لجامع الخليفة، وجلس القضاة والعلماء - ومن بينهم ابن الجوزي - على سطح المسجد، وتجمَّع عدد كبير من الناس، وقفوا أمام المسجد في صفوف. وهو منظر ىمكن تخيل فظاعة تأثيره في الذين كانوا لا يزالون متعلقين بالفلسفة والتفلسف، مؤمنىن بأن العقل حجة الله على خلقه، وأن إعماله علامة الاجتهاد الحقيقي التي يتمىز بها الإنسان المؤمن.
وأتصور أن حرق الكتب على هذا النحو كان نوعاً من الشعيرة الرمزية التي سعى الفاعلون لها إلى تطهير العالم من رجس الاجتهادات العقلية التي خالفت اجتهاداتهم. وكانت شعيرة الحرق في ذاتها، من هذا المنظور، استئصالاً رمزياً لحضور الآخر المختلف الذي أنتج هذه الكتب، سواء أكان "آخر" أجنبياً أو محلىاً، فلا فارق بين الاثنين في إثم الاختلاف، واستحقاق الاستئصال.
وقد تكررت حوادث الحرق على امتداد العالم الإسلامى بما في ذلك الأندلس، حتى قبل الوقائع التي يذكرها غولدتسيهر، فتاريخ القمع الفكري له جذوره الأقدم من القرن السادس بقرون. ومما له دلالة خاصة، في متواليات هذا السياق القمعي، ما قام به الوزير المنصور ابن أبي عامر في الأندلس، حين أحرق كتب الفلاسفة كترضية بعد انقلابه على البيت الأموي. وورد خبر ذلك تفصيلاً في كتاب القاضي صاعد الأندلسي المتوفى سنة 462هـ "طبقات الأمم" خلال عرضه تاريخ العلم في الأندلس، وكيف أن الأمىر الحكم المستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصر أظهر في أيام أبيه عناية ملحوظة بالعلوم وإيثار أهلها، فاستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار الشرق عيون التواليف الجليلة في العلوم القديمة والحديثة، وجمع منها في بقىة أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ما كاد يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة، وتهيأ له ذلك لسمو نفسه إلى التشبّه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحرك الناس في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذهبهم، وظل كذلك إلى أن توفي سنة 366، فولي بعده ابنه هشام الذي كان غلاماً لم ىحتلم بعد، فتغلب على تدبىر ملكه حاجبه أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبي عامر، وتحالف مع كارهي التيار العقلي ليؤازروا انفراده بالحكم، وكان من لوازم هذا التحالف ما أصدره من أوامر بإخراج خزائن كتب العلوم القديمة المؤلفة في المنطق وغيره من علوم الأوائل، وأمر بإحراقها وإفسادها، فأحرق بعضها وطرح البعض الباقي في آبار القصر، وهِيلَ التراب والحجارة على الكتب، وغُيرَتْ بضروب من التغايير، فيما يقول صاعد الذي يوضح أن الحاجب فعل ذلك تحبباً إلى عوام الأندلس الذين كانوا متأثرين بأفكار الفقهاء المعادين للعلوم العقلية. وكان من نتائج فعلته البشعة أن سَكَنَ أكثر من كان تحرك للحكمة وخملت نفوسهم في ما يقول صاعد، وتستروا بما كان عندهم من تلك العلوم، ولم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها إلى أن انقرضت دولة بني أمية في الأندلس.
وبالطبع، لم يكن الحاجب هو الوحيد في فعلته البشعة، وإنما كان حلقة في سلسلة العداء للأفكار العقلىة الوافدة وغير الوافدة، حلقة كان قبح فعل الإحراق نتيجة لما سبقها من مقدمات في السىاق القمعي الذي بدأ، حتى من قبل انكسار المعتزلة مع انقلاب الخليفة المتوكل على أهل العقل، وما ترتَّب على ذلك من مطاردة النزعات العقلانية وكتبها. وهي المطاردة التي أنتجت شعار "من تمنطق تزندق"، كما تسببت في نصب محارق الكتب التي كانت مرادفة لتهم التكفير التي انهمرت على رؤوس كل من حاولوا التطلع إلى علوم الأوائل، أو الإفادة منها في جوانب الممارسات الثقافية المختلفة. ولذلك تزايدت موجات القمع للفكر المختلف الذي ظل يوصم ببدعة الضلالة المفضية إلى النار، والتي تحتم عقاب أصحابها لاستئصال تأثيرهم الضار. وكان واضحاً أن زندقة المنطق الموصول بالثقافة اليونانية هي الوجه الملازم لضلالة الابتداع العقلاني الذي اقترن بالإفادة من ثقافات الآخر وإنجازاته الفكرية.
ويمكن النظر إلى بدع الضلالة من هذا المنظور الذي يقرن بين اختلاف الاجتهاد والاستعانة بأفكار الآخر التي أصبحت موصومة بأبشع التهم، وذلك في السياق الذي تزايد نفوره من الاختلاف، فتصاعدت وسائل قمعه لهذا الاختلاف، وذلك ضمن شروط تارىخية وصلت أسبابها ما بىن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في توجه متعدد الأبعاد، ظل حرىصاً على تبرير مبادئه وأفعاله بتأويلات دينية تخدم مصالح أصحاب هذا التوجه. وهم - في الأساس - عناصر التحالف التي جمعت ما بين الاستبداد السياسي للأسر الحاكمة التي بررت حضورها الباطش باسم الين، ورجال الدين الذين انحازوا إلى هذه الأسر وارتبطوا بمصالحها، ودافعوا عن ضرورة اتِّباعها دفاعهم عن ضرورة الاتِّباع عموماً، ومن ثم تبرير قمع المختلف سياسياً بوصله ببدع الضلالة التي تستوجب الاستئصال.
وقد سبق لي أن أوضحت - في كتابات سابقة - أن الدولة العباسية بقدر ما شهدت من ازدهار فكري وانفتاح على ثقافات العالم القديم كله، ما ظل ذلك يتوافق مع مصالحها، كانت تتولى قمع المعارضين لها من مثقفي التيارات المخالفة بالجلْد أو السجن أو القتل أو بها جميعاً. وكان هذا القمع يمارس أقصى درجات عنفه على الطوائف التي تجمع بينها صفة "الحداثة"، من الذين صاغوا رؤى متعددة العوالم، تجاوز الواقع المتحقق في العصر العباسي الأول. وكانت هذه الطوائف تضم المبدعين والمفكرين في جبهة مقابلة لجبهة الدولة ومؤسساتها منذ القرن الثاني للهجرة، وهي جبهة كانت، على رغم خلافاتها الذاتية وصراعاتها الداخلية، تطرح من البدائل ما يغاير ما تطرحه الدولة بفقهائها وشعرائها وكتابها.
وقد ضمت هذه الطوائف الكتّاب الذين رادوا طرائق جديدة في الكتابة من أمثال ابن المقفع، والشعراء الذين وصلوا القصيدة المحدثة بالفكر الفلسفي الذي نأى عن الغنائية البسيطة للشعر القديم أمثال بشار وصالح بن عبدالقدوس، ومبدعي الغناء الجدىد الذين وصلوا بين ما قاله الفلاسفة عن أحوال الغناء، وما صاغه الشعراء من رؤى جديدة... وقد ظل الصراع مستمراً بين الإنسان "المحدث" الذي شكلته حواضر الخلافة العباسية، وتشكل بثقافاتها الواعدة، والمجموعات المحافظة التي ظلت متمسكة على نحو جامد بالمبدأ القائل: "اتّبِعوا ولا تبتدعوا". وكانت هذه الجماعات حرباً متصلة على المثقف الواعد الذي أخذ يتمثل من إبداع المحدثين، ما فتح أمامه أفقاً جديداً من الوعي، فوصل بين مبدأ "الشك" الذي أصّله المتكلمون من المعتزلة، ومبدأ "التطور" الذي أسسه فلاسفة من أمثال أبي زكريا الرازي وجابر بن حيان، في صيغ جديدة، زلزلت المأثور من علاقة الخلف بالسلف، والعارف بموضوع معرفته. وساعده على ذلك أن الطليعة التي كان يتعلم منها لم تكن تعرف فارقاً بىن عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا ميزة لحاكم على محكوم إلا بتحقيق العدل، ولا تسليم أو تصديق بشيء إلا بما ىثبته "التحسين والتقبيح" الذاتيان في العقل، وذلك في سياق من مطالبة الحاكم المطلق بالانصياع إلى الحكماء، وتحقيق العدل بواسطتهم، وفي الوقت نفسه التخلص من حاشيته الفاسدة أو من "الصحابة" الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواجبة من العقل والعدل والعفة والشجاعة، وغيرها من الفضائل الأفلاطونية التي كانت تدور في خاطر ابن المقفع، عندما كتب رسالته عن "الصحابة". وانتهى ذلك إلى مهاجمة استبداد السلاطين. وقد ارتبطت هذه الأفكار بالآخر بأكثر من معنى، سواء "الآخر" الأجنبي الذي نقلت الطليعة كتبه تحقىقاً لأهدافها، ونشراً لأفكارها، أو حتى تنكراً بواسطتها، أو "الآخر" المحلي، أو المختلف الذي خرج على الإجماع والتقليد، ومضى في المغامرة الخلاّقة للعقل الذي انطلق بحثاً عن عالم لا تنقضي عجائبه ووعوده. وكان من الطبيعي أن تصطدم هذه الأفكار بسلطة الاتِّباع والتقليد، وذلك ضمن رفضها ما طلبته الدولة العباسية من رعاياها، حرصاً على إبقاء سطوتها واستمرار هيبتها وحماية للأفكار التي كانت مؤسسات الدولة وفقهاؤها يعملون على إشاعتها. وبقدر المدى الذي وصلت إليه أفكار "الآخر" - الطليعة في صياغة عوالم جديدة، وشعور الدولة العباسية بالخطر، كان عنف الاستجابة إلى أصحاب هذه الأفكار الذين اتهمتهم الدولة بتهم الكفر والإلحاد و"الزندقة" و"الشعوبية"، لتعكر هذه التهم على دعاواهم، وتستفز العامة ضدهم. ونحن نعرف ما فعلته خلافة أبي العباس السفاح 132 - 136هـ بخصومها، وما فعله عهد المنصور 136 - 158هـ بأمثال أبي حنىفة النعمان الفقىه، وابن المقفع الكاتب، وسدىف الشاعر، من جلْد وسجن للأول، وقتل للثاني والثالث. ونعرف ما حدث من قتل لبشار بن برد، وحماد عجرد، وعبدالكرىم بن أبي العوجاء، وسجن لأبي العتاهية، في خلافة المهدي 158 - 159هـ وما وقع من حبس لبشر بن المعتمر الهلالي شيخ معتزلة بغداد لميوله العلوية، وقتل صالح بن عبدالقدوس، ومروان بن أبي حفصة، في خلافة الرشىد 170 - 193هـ. أضف إلى ذلك مقتل علي بن جبلة الشاعر، وسجن أحمد بن حنبل الفقيه، وما قيل عن قتل أبي نواس، في عهد المأمون 198 - 218هـ ومقتل دعبل في عهد المعتصم 218 - 227هـ ونفي مروان بن أبي الجنوب، وتعذيب أحمد بن حائط المعتزلي، وسجن ذي النون المصري المتصوف، ومصادرة كتب الكندي الفيلسوف وضربه، في عهد الواثق 227 - 272هـ وقتل ابن الزيات الكاتب بالتنور، وحبس علي بن الجهم ومحمد بن صالح العلوي والجماني العلوي من الشعراء، ووفاة ابن البعيث الشاعر في السجن، واضطهاد المعتزلة ومطاردتهم منذ عهد المتوكل 232 - 247هـ. ونعرف مقتل أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ الكندي في عهد المعتضد 279 - 289هـ وما ىقال عن دس السم لابن الرومي في عهد المكتفي 289 - 295هـ ومقتل محمد بن داود الجراح، والتمثيل بجثة الحلاج بعد قتله عام 309هـ، وتعذيب أبي الفضل البلخي بتهمة الابتداع، وهياج العامة على ابن جرير الطبري، ومنعهم من دفنه حين أدركته الوفاة عام 310هـ فاضطر أهله إلى دفنه في منزله ليلاً.

فارقت علم الشافعيِّ ومالكٍ = وشَرَعتَ في الإسلام رأي دِقلّسِ
وقد نسب إلى ابن أبي الحديد قوله:
فلتخسأ الحكماءُ عن = حرَمٍ له الأملاكُ تَشْهَد
مَنْ أنتَ يا رِسْطُوُ ومَن = أَفْلاَطُ قَبـْلَكَ يا مُبَلّد
ومَن ابنِ سينا حين قَرَّ = رَ ما هَذِيـتَ به وشَـيد
ووصل الأمر إلى درجة أن كل من كان يظهر أية عناية بالعلوم اليونانية يتهم في دينه، ويسعى الساعون إلى عقابه كي يكون عبرة لأمثاله. وكان حرص على الكشف عن المارقين من المتأثرين أو المتعاطفين أو المتعاطين لعلوم الأوائل في فروع المعرفة المختلفة، حتى بين المشتغلين بعلوم الدىن الذين اتبعوا هذا المذهب أو ذاك من مذاهب الفقه، على نحو ما أوضح تفصىلاً المستشرق الألماني غولدتسيهر في بحثه "موقف أهل السنّة القدماء بإزاء علوم الأوائل". وهو البحث الذي ترجمه عبدالرحمن بدوي ونشره ضمن كتابه "التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية".
وقد تتبع غولدتسيهر الآثار المدمرة لتشدد المتطرفين في التعامل مع التراث الإنساني غير العربي عموماً، والتراث الفلسفي خصوصاً. ومن النماذج الدالة على ذلك - في ما يذكره - إحراق كتب الأوائل التي كانت عند عبدالسلام بن عبدالوهاب الملقَّب بركن الدىن المتوفى سنة 611هـ حفيد المتصوف الحنبلي عبدالقادر الجيلاني. وقد أحرقت كتبه في نار عظيمة أمام مسجد مجاور لجامع الخليفة، وجلس القضاة والعلماء - ومن بينهم ابن الجوزي - على سطح المسجد، وتجمَّع عدد كبير من الناس، وقفوا أمام المسجد في صفوف. وهو منظر ىمكن تخيل فظاعة تأثيره في الذين كانوا لا يزالون متعلقين بالفلسفة والتفلسف، مؤمنىن بأن العقل حجة الله على خلقه، وأن إعماله علامة الاجتهاد الحقيقي التي يتمىز بها الإنسان المؤمن.
وأتصور أن حرق الكتب على هذا النحو كان نوعاً من الشعيرة الرمزية التي سعى الفاعلون لها إلى تطهير العالم من رجس الاجتهادات العقلية التي خالفت اجتهاداتهم. وكانت شعيرة الحرق في ذاتها، من هذا المنظور، استئصالاً رمزياً لحضور الآخر المختلف الذي أنتج هذه الكتب، سواء أكان "آخر" أجنبياً أو محلىاً، فلا فارق بين الاثنين في إثم الاختلاف، واستحقاق الاستئصال.
وقد تكررت حوادث الحرق على امتداد العالم الإسلامى بما في ذلك الأندلس، حتى قبل الوقائع التي يذكرها غولدتسيهر، فتاريخ القمع الفكري له جذوره الأقدم من القرن السادس بقرون. ومما له دلالة خاصة، في متواليات هذا السياق القمعي، ما قام به الوزير المنصور ابن أبي عامر في الأندلس، حين أحرق كتب الفلاسفة كترضية بعد انقلابه على البيت الأموي. وورد خبر ذلك تفصيلاً في كتاب القاضي صاعد الأندلسي المتوفى سنة 462هـ "طبقات الأمم" خلال عرضه تاريخ العلم في الأندلس، وكيف أن الأمىر الحكم المستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصر أظهر في أيام أبيه عناية ملحوظة بالعلوم وإيثار أهلها، فاستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار الشرق عيون التواليف الجليلة في العلوم القديمة والحديثة، وجمع منها في بقىة أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ما كاد يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة، وتهيأ له ذلك لسمو نفسه إلى التشبّه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحرك الناس في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذهبهم، وظل كذلك إلى أن توفي سنة 366، فولي بعده ابنه هشام الذي كان غلاماً لم ىحتلم بعد، فتغلب على تدبىر ملكه حاجبه أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبي عامر، وتحالف مع كارهي التيار العقلي ليؤازروا انفراده بالحكم، وكان من لوازم هذا التحالف ما أصدره من أوامر بإخراج خزائن كتب العلوم القديمة المؤلفة في المنطق وغيره من علوم الأوائل، وأمر بإحراقها وإفسادها، فأحرق بعضها وطرح البعض الباقي في آبار القصر، وهِيلَ التراب والحجارة على الكتب، وغُيرَتْ بضروب من التغايير، فيما يقول صاعد الذي يوضح أن الحاجب فعل ذلك تحبباً إلى عوام الأندلس الذين كانوا متأثرين بأفكار الفقهاء المعادين للعلوم العقلية. وكان من نتائج فعلته البشعة أن سَكَنَ أكثر من كان تحرك للحكمة وخملت نفوسهم في ما يقول صاعد، وتستروا بما كان عندهم من تلك العلوم، ولم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها إلى أن انقرضت دولة بني أمية في الأندلس.
وبالطبع، لم يكن الحاجب هو الوحيد في فعلته البشعة، وإنما كان حلقة في سلسلة العداء للأفكار العقلىة الوافدة وغير الوافدة، حلقة كان قبح فعل الإحراق نتيجة لما سبقها من مقدمات في السىاق القمعي الذي بدأ، حتى من قبل انكسار المعتزلة مع انقلاب الخليفة المتوكل على أهل العقل، وما ترتَّب على ذلك من مطاردة النزعات العقلانية وكتبها. وهي المطاردة التي أنتجت شعار "من تمنطق تزندق"، كما تسببت في نصب محارق الكتب التي كانت مرادفة لتهم التكفير التي انهمرت على رؤوس كل من حاولوا التطلع إلى علوم الأوائل، أو الإفادة منها في جوانب الممارسات الثقافية المختلفة. ولذلك تزايدت موجات القمع للفكر المختلف الذي ظل يوصم ببدعة الضلالة المفضية إلى النار، والتي تحتم عقاب أصحابها لاستئصال تأثيرهم الضار. وكان واضحاً أن زندقة المنطق الموصول بالثقافة اليونانية هي الوجه الملازم لضلالة الابتداع العقلاني الذي اقترن بالإفادة من ثقافات الآخر وإنجازاته الفكرية.
ويمكن النظر إلى بدع الضلالة من هذا المنظور الذي يقرن بين اختلاف الاجتهاد والاستعانة بأفكار الآخر التي أصبحت موصومة بأبشع التهم، وذلك في السياق الذي تزايد نفوره من الاختلاف، فتصاعدت وسائل قمعه لهذا الاختلاف، وذلك ضمن شروط تارىخية وصلت أسبابها ما بىن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في توجه متعدد الأبعاد، ظل حرىصاً على تبرير مبادئه وأفعاله بتأويلات دينية تخدم مصالح أصحاب هذا التوجه. وهم - في الأساس - عناصر التحالف التي جمعت ما بين الاستبداد السياسي للأسر الحاكمة التي بررت حضورها الباطش باسم الين، ورجال الدين الذين انحازوا إلى هذه الأسر وارتبطوا بمصالحها، ودافعوا عن ضرورة اتِّباعها دفاعهم عن ضرورة الاتِّباع عموماً، ومن ثم تبرير قمع المختلف سياسياً بوصله ببدع الضلالة التي تستوجب الاستئصال.
وقد سبق لي أن أوضحت - في كتابات سابقة - أن الدولة العباسية بقدر ما شهدت من ازدهار فكري وانفتاح على ثقافات العالم القديم كله، ما ظل ذلك يتوافق مع مصالحها، كانت تتولى قمع المعارضين لها من مثقفي التيارات المخالفة بالجلْد أو السجن أو القتل أو بها جميعاً. وكان هذا القمع يمارس أقصى درجات عنفه على الطوائف التي تجمع بينها صفة "الحداثة"، من الذين صاغوا رؤى متعددة العوالم، تجاوز الواقع المتحقق في العصر العباسي الأول. وكانت هذه الطوائف تضم المبدعين والمفكرين في جبهة مقابلة لجبهة الدولة ومؤسساتها منذ القرن الثاني للهجرة، وهي جبهة كانت، على رغم خلافاتها الذاتية وصراعاتها الداخلية، تطرح من البدائل ما يغاير ما تطرحه الدولة بفقهائها وشعرائها وكتابها.
وقد ضمت هذه الطوائف الكتّاب الذين رادوا طرائق جديدة في الكتابة من أمثال ابن المقفع، والشعراء الذين وصلوا القصيدة المحدثة بالفكر الفلسفي الذي نأى عن الغنائية البسيطة للشعر القديم أمثال بشار وصالح بن عبدالقدوس، ومبدعي الغناء الجدىد الذين وصلوا بين ما قاله الفلاسفة عن أحوال الغناء، وما صاغه الشعراء من رؤى جديدة... وقد ظل الصراع مستمراً بين الإنسان "المحدث" الذي شكلته حواضر الخلافة العباسية، وتشكل بثقافاتها الواعدة، والمجموعات المحافظة التي ظلت متمسكة على نحو جامد بالمبدأ القائل: "اتّبِعوا ولا تبتدعوا". وكانت هذه الجماعات حرباً متصلة على المثقف الواعد الذي أخذ يتمثل من إبداع المحدثين، ما فتح أمامه أفقاً جديداً من الوعي، فوصل بين مبدأ "الشك" الذي أصّله المتكلمون من المعتزلة، ومبدأ "التطور" الذي أسسه فلاسفة من أمثال أبي زكريا الرازي وجابر بن حيان، في صيغ جديدة، زلزلت المأثور من علاقة الخلف بالسلف، والعارف بموضوع معرفته. وساعده على ذلك أن الطليعة التي كان يتعلم منها لم تكن تعرف فارقاً بىن عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا ميزة لحاكم على محكوم إلا بتحقيق العدل، ولا تسليم أو تصديق بشيء إلا بما ىثبته "التحسين والتقبيح" الذاتيان في العقل، وذلك في سياق من مطالبة الحاكم المطلق بالانصياع إلى الحكماء، وتحقيق العدل بواسطتهم، وفي الوقت نفسه التخلص من حاشيته الفاسدة أو من "الصحابة" الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواجبة من العقل والعدل والعفة والشجاعة، وغيرها من الفضائل الأفلاطونية التي كانت تدور في خاطر ابن المقفع، عندما كتب رسالته عن "الصحابة". وانتهى ذلك إلى مهاجمة استبداد السلاطين. وقد ارتبطت هذه الأفكار بالآخر بأكثر من معنى، سواء "الآخر" الأجنبي الذي نقلت الطليعة كتبه تحقىقاً لأهدافها، ونشراً لأفكارها، أو حتى تنكراً بواسطتها، أو "الآخر" المحلي، أو المختلف الذي خرج على الإجماع والتقليد، ومضى في المغامرة الخلاّقة للعقل الذي انطلق بحثاً عن عالم لا تنقضي عجائبه ووعوده. وكان من الطبيعي أن تصطدم هذه الأفكار بسلطة الاتِّباع والتقليد، وذلك ضمن رفضها ما طلبته الدولة العباسية من رعاياها، حرصاً على إبقاء سطوتها واستمرار هيبتها وحماية للأفكار التي كانت مؤسسات الدولة وفقهاؤها يعملون على إشاعتها. وبقدر المدى الذي وصلت إليه أفكار "الآخر" - الطليعة في صياغة عوالم جديدة، وشعور الدولة العباسية بالخطر، كان عنف الاستجابة إلى أصحاب هذه الأفكار الذين اتهمتهم الدولة بتهم الكفر والإلحاد و"الزندقة" و"الشعوبية"، لتعكر هذه التهم على دعاواهم، وتستفز العامة ضدهم. ونحن نعرف ما فعلته خلافة أبي العباس السفاح 132 - 136هـ بخصومها، وما فعله عهد المنصور 136 - 158هـ بأمثال أبي حنىفة النعمان الفقىه، وابن المقفع الكاتب، وسدىف الشاعر، من جلْد وسجن للأول، وقتل للثاني والثالث. ونعرف ما حدث من قتل لبشار بن برد، وحماد عجرد، وعبدالكرىم بن أبي العوجاء، وسجن لأبي العتاهية، في خلافة المهدي 158 - 159هـ وما وقع من حبس لبشر بن المعتمر الهلالي شيخ معتزلة بغداد لميوله العلوية، وقتل صالح بن عبدالقدوس، ومروان بن أبي حفصة، في خلافة الرشىد 170 - 193هـ. أضف إلى ذلك مقتل علي بن جبلة الشاعر، وسجن أحمد بن حنبل الفقيه، وما قيل عن قتل أبي نواس، في عهد المأمون 198 - 218هـ ومقتل دعبل في عهد المعتصم 218 - 227هـ ونفي مروان بن أبي الجنوب، وتعذيب أحمد بن حائط المعتزلي، وسجن ذي النون المصري المتصوف، ومصادرة كتب الكندي الفيلسوف وضربه، في عهد الواثق 227 - 272هـ وقتل ابن الزيات الكاتب بالتنور، وحبس علي بن الجهم ومحمد بن صالح العلوي والجماني العلوي من الشعراء، ووفاة ابن البعيث الشاعر في السجن، واضطهاد المعتزلة ومطاردتهم منذ عهد المتوكل 232 - 247هـ. ونعرف مقتل أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ الكندي في عهد المعتضد 279 - 289هـ وما ىقال عن دس السم لابن الرومي في عهد المكتفي 289 - 295هـ ومقتل محمد بن داود الجراح، والتمثيل بجثة الحلاج بعد قتله عام 309هـ، وتعذيب أبي الفضل البلخي بتهمة الابتداع، وهياج العامة على ابن جرير الطبري، ومنعهم من دفنه حين أدركته الوفاة عام 310هـ فاضطر أهله إلى دفنه في منزله ليلاً.