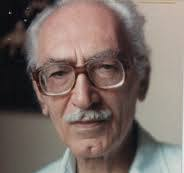"لكل إنسان حق في حياته، لأن الحرب تدمر حياة الإنسان المحملة بالوعود، وتضع الفرد في مواقف تسيء إليه، وتجبره على قتل جاره ضده إرادته، وتدمر القيم المادية الثمينة، منتجات النشاط البشري، إلخ."
تمهيد:
كيف فهم المحلل النفسي سيغموند فرويد (1879-1955)، وعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين (1879-1955)، ظاهرة الحرب خاصة وانهما شهدا مجريات حربين عالميتين ولاحظا ما عانته الكثير من شعوب ودول العالم من وحشية وويلات ودمار واستيلاء وغزو ونهب للثروات وتشريد للسكان وهدم للعمران والتجهيزات؟
الجدير بالملاحظة أن علاقة أينشتاين بالحرب هي علاقة إشكالية فهو من جهة مسؤول عن تفجير الذرة ووصول الإنسانية الى صناعة القنبلة النووية وما تسببت فيه من ضرر للكون عندما استعملت في القتال، ولكنه من ناحية ثانية عارض بشدة الحرب وتحول الى داعية سلام ورفض أي عدوان لدولة على أخرى.
من ناحية ثانية عمل فرويد على تشريح الطبيعة البشرية والبحث في خفاياها عن أسباب كامنة للعدوان وفتش بطرق منهجية تحليلية عن العوامل النفسية والثقافية التي تدفع الناس الى الحرب وحاول إيجاد مسالك تنويرية للوقاية من هذه الظاهرة المرضية وتشييد علاقات سليمة بين الفراد والمجموعات ضمن حياة انسية تصالحية.
فما الفرق بين المقاربة الفيزيائية عند أينشتاين والمقاربة التحليلية النفسية عند فرويد لظاهرة الحرب؟ وهل وفقا في إيقاف هذه السلوك العدواني الجماعي؟ ولماذا بقيت الحرب هي اللغة الوحيدة للتخاطب بين القوى؟
الترجمة:
"1) ألبرت أينشتاين
بوتسدام ، 30 يوليو 1932.
صديقي العزيز،
يسعدني أنه من خلال دعوتي للتبادل الحر للآراء مع شخص من اختياري في موضوع معين حسب تقديري، أعطتني عصبة الأمم ومعهدها الدولي للتعاون الفكري في باريس، بطريقة ما، مع إعطاء الفرصة الثمينة لمناقشة السؤال الذي يبدو لي، في الحالة الراهنة للأشياء، أنه الأهم في ترتيب الحضارة: هل وسيلة لتحرير الرجال من خطر الحرب؟
بشكل عام، نتفق الآن على الاعتراف بأن التقدم التقني قد جعل مثل هذه المسألة حيوية حقًا للإنسانية المتحضرة، ومع ذلك فإن الجهود الحثيثة المكرسة لحل هذه المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن تقطعت بهم السبل بنسب مخيفة. أعتقد أنه من بين أولئك المنشغلين بهذه المشكلة عمليًا ومهنيًا، تظهر الرغبة نفسها، الناشئة عن شيء معين. الشعور بالعجز، لطلب النصيحة من الناس حول هذه النقطة الذين وُضِعوا على مسافة سعيدة من العمل المعتاد للعلم في جميع أمور الحياة. بالنسبة لي، فإن الاتجاه المعتاد لفكري ليس هو الاتجاه الذي يفتح لمحات في أعماق إرادة الإنسان وشعوره، ولهذا السبب، في تبادل الآراء الذي أبدأ به هنا، بالكاد أستطيع أن أفكر في القيام بأكثر من مجرد محاولة طرح المشكلة، مع ترك المزيد أو أقل من المحاولات الخارجية للتوصل إلى حل مقدمًا جانباً، مما يتيح لك الفرصة لإلقاء الضوء على السؤال من وجهة نظر معرفتك العميقة بالحياة الغريزية للإنسان. أنا مقتنع بأنك ستكون قادرًا على الإشارة إلى الوسائل التعليمية التي، بطريقة ما، إلى حد ما، غريبة عن السياسة، ستكون ذات طبيعة لإزالة العقبات النفسية، التي قد يشك بها الشخص العادي في هذه المسألة، ولكن هو غير قادر على قياس التطابقات والاختلافات.
بالنسبة لي، أنا متحرر من التحيزات الوطنية، فإن الوجه الخارجي للمشكلة - في هذه الحالة، عنصر التنظيم - يبدو لي بسيطًا: تنشئ الدول سلطة تشريعية وقضائية لتهدئة جميع النزاعات التي قد تنشأ بينهما.
يتعهدون بالخضوع للقوانين التي تضعها السلطة التشريعية، والاستئناف أمام المحكمة في جميع القضايا المتنازع عليها، والامتثال دون تحفظ لقراراتها وتنفيذها وضمان تطبيقها، الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية. هنا أصل إلى الصعوبة الأولى: المحكمة هي مؤسسة بشرية تكون قادرة على إظهار نفسها، في قراراتها، في متناول جميع الطلبات الخارجة عن القانون لأنها ستكون أقل قوة لتنفيذ أحكامها. إنها حقيقة لا يستهان بها: القانون والقوة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأحكام هيئة قانونية تقترب من نموذج عدالة المجتمع الذي يُنطق القانون باسمه ولمصلحته، إلى الحد الذي يمكن لهذا المجتمع أن يجمع القوى اللازمة لدعم مثله المثالي للعدالة. لكننا الآن بعيدون جدًا عن وجود منظمة فوق دولة قادرة على إعطاء محكمتها سلطة مطلقة وضمان الخضوع المطلق لتنفيذ أحكامها. وهنا هو المبدأ الأول الذي يلفت انتباهي: الطريق إلى الأمن الدولي يتطلب من الدول أن تتنازل دون قيد أو شرط عن جزء من حريتهم في التصرف، وبعبارة أخرى، من سيادتهم، وليس هناك شك في أنه لا توجد طريقة أخرى لهذا الأمن.
تكشف نظرة خاطفة على الجهود الفاشلة، المخلصة بالتأكيد، خلال السنوات العشر الماضية عن وجود قوى نفسية قوية تعمل على شل هذه الجهود. يمكن ملاحظة بعضها بسهولة. إن شهية السلطة التي تظهرها الطبقة الحاكمة في دولة ما تحبط تقييد حقوقها السيادية. غالبًا ما تجد هذه "الشهية السياسية للسلطة" طعامًا في ادعاءات فئة أخرى يتجلى جهدها الاقتصادي بطريقة مادية للغاية. أفكر هنا على وجه الخصوص في تلك المجموعة التي يجدها المرء داخل كل شخص والتي، قليلة العدد ولكنها مصممة، قليلة الاهتمام بالخبرات والعوامل الاجتماعية، تتكون من الأفراد الذين لهم الحرب وتصنيعهم والاتجار بهم. لا تمثل الأسلحة أكثر من فرصة لاكتساب مزايا خاصة، لتوسيع نطاق قوتها الشخصية.
هذه الملاحظة البسيطة، مع ذلك، ليست سوى الخطوة الأولى في فهم الوضع الاقتصادي. يطرح سؤال على الفور: كيف يمكن لهذه الأقلية أن تستعبد لشهواتها الجماهير العظيمة من الناس الذين لا يجنون سوى المعاناة والفقر من الحرب؟ (عندما أتحدث عن جماهير الشعب، لا أنوي استبعاد أولئك الذين جعلوا الحرب مهنة ، جنودًا من جميع الرتب، بقناعة العمل من أجل الدفاع عن أثمن الأشياء. من شعبهم واعتقادًا منهم أن الهجوم هو أفضل دفاع في بعض الأحيان.) إليكم ما أعتقده هو الإجابة الأولى الضرورية: هذه الأقلية من قادة الساعة في يدها أولاً وقبل كل شيء المدرسة والصحافة والمنظمات الدينية دائمًا تقريبًا. وبهذه الوسائل تسيطر وتوجه مشاعر الكتلة الهائلة التي تصنع منها أداة عمياء.
لكن هذه الإجابة لا تشرح بعد سلسلة العوامل المعنية لأن سؤالًا آخر يطرح نفسه: كيف يمكن أن تسمح الكتلة، بالوسائل التي أشرنا إليها، بإشعال نفسها إلى درجة الجنون والتضحية؟ لا أرى إجابة أخرى غير هذا: الإنسان فيه حاجة للكراهية والدمار. في الأوقات العادية، يوجد هذا التصرف في حالة كامنة ولا يظهر إلا في فترات غير طبيعية؛ ولكن يمكن إيقاظها ببعض السهولة وتتحول إلى ذهان جماعي. هنا، على ما يبدو، تكمن المشكلة الأساسية والأكثر سرية لهذه المجموعة من العوامل. هذه هي النقطة التي لا يسلط الضوء عليها إلا المتذوق العظيم للغرائز البشرية.
وهكذا نأتي إلى سؤال أخير: هل هناك إمكانية لتوجيه التطور النفسي للإنسان بطريقة تجعله أفضل تسليحا ضد عقليات الكراهية والدمار؟ وبعيدًا عني فكرة التفكير هنا فقط فيما يسمى بالكائنات غير المتعلمة. لقد استطعت أن أجرب بنفسي أنه بالأحرى ما يسمى بـ "الذكاء" الذي يصادف أنه أسهل فريسة للاقتراحات الجماعية القاتلة، لأنه ليس من عادة الاستقاء من مصادر الخبرة. عاش، وهذا، على العكس من ذلك، من خلال وسيط الورق المطبوع يسهل فهمه بشكل كامل.
وأخيرًا، هذا مرة أخرى: لقد تحدثت حتى الآن فقط عن الحرب بين الدول، وبعبارة أخرى، عما يسمى بالصراعات الدولية. إنني أدرك أن العدوان البشري يتجلى أيضًا في أشكال أخرى وتحت ظروف أخرى (على سبيل المثال الحرب الأهلية، التي كانت سببها سابقًا دوافع دينية، واليوم بدوافع اجتماعية، - اضطهاد الأقليات القومية). لكن عن قصد قدمت أكثر أشكال الصراع الجامحة التي تتجلى داخل المجتمعات البشرية، لأنه من خلال البدء من هذا الشكل سنكتشف بسهولة وسائل تجنب الصراع المسلح.
أعلم أنك أجبت في أعمالك، بشكل مباشر أو غير مباشر، على جميع الأسئلة المتعلقة بالمشكلة التي تهمنا وتحثنا. ولكن سيكون من المفيد جدًا أن نراكم تطورون مشكلة تهدئة العالم في ضوء تحقيقاتكم الجديدة، لأن مثل هذا العرض يمكن أن يكون مصدر جهود مثمرة.
صديقك المخلص.
ألبرت أينشتاين
+++++++++++++++++++++++++++++
2) سيغموند فرويد
فيينا ، سبتمبر 1932.
عزيزي السيد أينشتاين،
عندما علمت أنك تنوي دعوتي إلى تبادل وجهات النظر حول موضوع تمنح فيه اهتمامك وتعتقد أنه يستحق اهتمام الآخرين أيضًا، لم أتردد في إقناع نفسي بهذا. مقابلة. لقد افترضت أنك ستختار مشكلة تقع على حدود ما يمكننا معرفته اليوم، والتي يمكن لكل منا، الفيزيائي وطبيب النفس، الوصول إليها بطريقة ما. للالتقاء على نفس الأرضية، بدءًا من مناطق مختلفة. لذلك فاجأتموني بسؤالي ما الذي يمكن فعله لتحرير البشر من خطر الحرب. في البداية كنت خائفة من عدم كفاءتي - كنت سأقول - لأنني كنت أعتبرها مهمة عملية كانت من اختصاص رجال الدولة. لكنني أدركت أنك لم تطرح السؤال كعالم وفيزيائي، ولكن كصديق للبشر، استجابة لدعوة عصبة الأمم، مثل المستكشف فريدجوف نانسن عندما تعهد بمساعدة الجياع وضحايا الحرب العالمية المحرومين من وطن. فكرت أيضًا أنه لم يكن من المتوقع أن أطرح مقترحات عملية، ولكن كان على ببساطة أن أطرح مشكلة حماية السلام، في ضوء الفحص النفسي.
لكن في هذا الصدد مرة أخرى، قلت الأساسيات في رسالتك وفي نفس الوقت أخذت الريح من أشرعتي، لكنني عن طيب خاطر أقرض نفسي للإبحار في أعقابك وسأكتفي بتأكيد ما تقول، بينما أحضر استطراداتي هناك، أقرب ما يمكن إلى معرفتي - أو تخميناتي.
تبدأ بطرح السؤال بين الحق والقوة. هذه، بالطبع، نقطة البداية الصحيحة لتحقيقنا. هل يمكنني السماح لنفسي باستبدال كلمة "قوة" بمصطلح "عنف" أكثر ثباتًا وقسوة؟ القانون والعنف حاليا نقيض بالنسبة لنا. من السهل إظهار أن أحدهما مشتق من الآخر، وإذا عدنا إلى الأصول البدائية لنتفحص كيف نشأت الظاهرة أولاً، فإن حل المشكلة يظهر لنا دون صعوبة. إذا رأيتني، فيما يلي، أشرح، مثل العديد من العناصر الجديدة، حقائق معروفة ومعترف بها بشكل عام، فسوف تسامحني على هذا، فإن الانتماء للبيانات يتطلب مني القيام بذلك.
لذلك فإن تضارب المصالح الذي ينشأ بين الرجال يتم حله من حيث المبدأ عن طريق العنف. هكذا في جميع أنحاء مملكة الحيوان، حيث لا يستطيع الإنسان استبعاد نفسه منها؛ بالنسبة للبشر، لا تزال هناك بالطبع صراعات إضافية في الرأي تصل إلى أعلى قمم التجريد ويبدو أن حلها يتطلب أسلوبًا مختلفًا. لكن هذا التعقيد لم يظهر إلا في وقت لاحق. في الأصل، في حشد صغير، كان تفوق القوة العضلية هو الذي يقرر ما يجب أن ينتمي إليه، أو من هو الشخص الذي سيتم تطبيق إرادته، وتم إعارة القوة العضلية واستبدالها قريبًا. من خلال استخدام الأدوات؛ يذهب النصر لمن لديه أفضل الأسلحة أو يستخدمها بمهارة. يمثل تدخل السلاح اللحظة التي بدأت فيها السيادة الفكرية بالفعل تحل محل القوة العضلية؛ يبقى الهدف النهائي للنضال كما هو: يجب إجبار أحد أطراف القبضة، بسبب الضرر الذي يعاني منه وخنق قواته، على التخلي عن مطالبه أو معارضته. هذه النتيجة تتحقق بشكل أفضل عندما يقضي العنف على الخصم بطريقة دائمة، وبالتالي يقتله. تقدم هذه العملية ميزتين: لن يتمكن الخصم من استئناف القتال في مناسبة جديدة ومصيره سيثني الآخرين عن الاقتداء بمثاله. علاوة على ذلك، فإن قتل العدو يرضي نزعة غريزية علينا العودة إليها.
في بعض الأحيان تصطدم خطة قتل الاشتباكات بحساب أنه يمكن استخدام العدو لتقديم خدمة مفيدة، إذا تم السماح بإنقاذ حياته، مع مراعاة الاحترام. في مثل هذه الحالة يكون العنف قانعاً بالاستعباد بدلاً من القتل. هذه هي الطريقة التي يبدأ بها المرء في تجنيب العدو، ولكن على المنتصر بالتالي أن يأخذ في الحسبان شهوة الانتقام الكامنة في الانتظار في المهزوم، ويتخلى عن جزء من أمنه.
إذن هذه هي الحالة الأصلية ، حكم القوة الأعلى ، العنف الوحشي أو العنف المبرهن فكريًا. نحن نعلم أن هذا النظام قد تغير في سياق التطور ، وأن الطريق قد أدى من العنف إلى القانون ، ولكن أيهما؟ هناك واحد فقط ، في رأيي ، وهو الذي ينتج عنه حقيقة أنه يمكن للمرء أن ينافس أقوى من خلال اتحاد العديد من الضعفاء. " الوحدة هي قوة. "
إن الوحدة تكسر العنف، لذا فإن قوة هذه العناصر الموحدة تمثل الحق، في مقابل عنف الفرد. لذلك نرى أن القانون هو قوة المجتمع. لا يزال عنفًا، ومستعدًا دائمًا للانقلاب على أي فرد يقاومه، ويعمل بنفس الوسائل، مرتبطًا بنفس الأهداف؛ يكمن الاختلاف، في الواقع، فقط في حقيقة أنه لم يعد عنف الفرد هو الذي ينتصر، بل عنف المجتمع. ولكن من أجل تحقيق هذا الانتقال من العنف إلى القانون الجديد، يجب تلبية حالة نفسية.
يجب أن يكون اتحاد الأرقام مستقرًا ودائمًا. إذا خلقت نفسها لغرض وحيد هو محاربة أقوى فقط لتذوب نفسها بمجرد هزيمتها، فإن النتيجة ستكون لا شيء. أول من أصبح بعد ذلك يشعر بأنه أقوى سيسعى مرة أخرى إلى فرض هيمنة العنف، وستكرر اللعبة نفسها مرارًا وتكرارًا. يجب الحفاظ على المجتمع في جميع الأوقات، وتنظيم نفسه، ووضع اللوائح التي تمنع التمرد من الخوف، وتعيين الهيئات التي تضمن الحفاظ على اللوائح، والقوانين، والتي تضمن تنفيذ أعمال العنف وفقًا للقوانين. من خلال الاعتراف بمجتمع المصالح المتشابه، فإنه يشكل، داخل أعضاء مجموعة من الأشخاص المتحدين، روابط عاطفية، ومشاعر المجتمع، والتي تقوم عليها، بالمعنى الدقيق للكلمة، قوة هذا المجتمع.
أعتقد أنني أشرت بالتالي إلى جميع العناصر الأساسية ؛ الانتصار على العنف من خلال نقل السلطة إلى وحدة أكبر ، هي نفسها مدمجة بعلاقات المشاعر. كل شيء آخر هو مجرد تعليقات وتكرار. الوضع بسيط ، طالما أن المجتمع يتكون من عدد من الأفراد من نفس القوة. ثم تحدد قوانين هذه الجمعية ، فيما يتعلق بمظاهر القوة العنيفة ، جزء الحرية الشخصية الذي يجب على الفرد التخلي عنه حتى تستمر الحياة معًا في أمان. لكن مثل هذه الحالة من الهدوء لا يمكن تصورها إلا من الناحية النظرية. في الواقع ، يصبح مسار الأمور أكثر تعقيدًا ، لأن المجتمع ، منذ البداية ، يحتوي على عناصر قوة غير متكافئة - الرجال والنساء ، والآباء والأطفال - وسرعان ما تخلق الحرب والقهر منتصرين و مهزوم ، الذين يتحولون إلى أسياد وعبيد. وبالتالي فإن قانون المجتمع سيكون تعبيرا عن عدم المساواة في السلطة، وسوف يتم وضع القوانين من قبل الحكام ومن أجلهم، وسوف يتم ترك القليل من الامتيازات للرعايا. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، تعرض النظام القانوني للاضطرابات من مصدرين: أولاً وقبل كل محاولات أحد أو الآخر من اللوردات للتغلب على القيود المطبقة على جميع نظرائه، للعودة، بالتالي، من حكم القانون إلى عهد العنف؛ في المقام الثاني، الجهود المستمرة التي يبذلها الأفراد لتوسيع سلطتهم ورؤية هذه التعديلات معترف بها في القانون، وبالتالي المطالبة، على العكس من ذلك، بتمرير الحق غير المتساوي في الحق المتساوي للجميع.
سيتم تمييز هذا الاتجاه الأخير بشكل خاص عندما تكون هناك بالفعل تغييرات في صلاحيات السلطة داخل المجتمع، كما يحدث نتيجة لعوامل تاريخية مختلفة. يمكن للقانون بعد ذلك أن يتكيف بشكل غير محسوس مع هذه الظروف الجديدة، أو ما هو أكثر شيوعًا، أن الطبقة الحاكمة ليست مستعدة لأخذ هذا التغيير في الاعتبار: إنه تمرد، حرب أهلية، ومن ثم القمع المؤقت للقانون، والانقلابات الجديدة، التي يتم في نهايتها تأسيس حكم القانون الجديد. هناك مصدر آخر لتغيير القانون، لا يتجلى إلا بالوسائل السلمية، وهو تغيير الثقافة الذي يحدث بين أفراد المجتمع؛ لكنها تدخل في ترتيب الظواهر التي لا يمكن معالجتها إلا لاحقًا.
لذلك نرى أنه، حتى داخل المجتمع، لا يمكن تجنب استخدام العنف في حل تضارب المصالح. لكن الضرورات، مجتمعات المصالح الناشئة عن الوجود المشترك على نفس الأرض، تسرع من تهدئة هذه النضالات، وتحت هذه الرعاية، تتزايد باستمرار احتمالات الحلول السلمية. لكن يكفي أن نلقي نظرة على تاريخ الإنسانية لتشهد عرضًا غير منقطع للصراعات، سواء كان مجتمعًا يتصارع مع مجموعة أو أكثر من التجمعات الأخرى، سواء كان ذلك بين وحدات واسعة وأحيانًا أكثر مختزلة، بين المدن والبلدان والقبائل والشعوب والإمبراطوريات والصراعات التي يتم حلها دائمًا تقريبًا عن طريق اختبار القوى أثناء الحرب. تؤدي هذه الحروب إما إلى النهب أو الخضوع التام أو الفتح لأحد الطرفين.
لا يمكننا إصدار حكم شامل على حروب الفتح. كثير منهم، مثل المغول والأتراك، لم يجلبوا سوى الحظ السيئ. من ناحية أخرى، ساهم البعض الآخر في تحويل العنف إلى قانون، من خلال إنشاء وحدات أكبر تم فيها القضاء على إمكانية اللجوء إلى القوة وتهدئة النزاعات من خلال سيادة القانون الجديدة. الفتوحات الرومانية التي جلبت باكس رومانا الثمين إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الطموحات الإقليمية لملوك فرنسا مملكة موحدة في سلام وازدهار. كما قد يبدو متناقضًا، علينا أن نعترف بأن الحرب قد لا تكون وسيلة غير مناسبة لتأسيس السلام "الأبدي"، لأنها تثبت أنها قادرة على تشكيل وحدات واسعة يمكن من خلالها القوة المركزية تجعل الحروب الجديدة مستحيلة. ومع ذلك، فإنه لا يؤدي إلى هذه النتيجة، لأن نجاحات الغزو، كقاعدة عامة، قصيرة الأجل، والوحدات المنشأة حديثًا تتفكك بدورها دائمًا تقريبًا بسبب عدم التماسك بين الأطراف المتحدين بالقيود. علاوة على ذلك، لم يكن الغزو حتى الآن قادراً إلا على خلق اتحادات جزئية - على نطاق واسع صحيح - وصراعات تتطلب حلولاً قاسية. كانت نتيجة كل هذه الجهود الحربية ببساطة أن البشرية استبدلت عددًا لا يحصى من المناوشات المستمرة تقريبًا من أجل حروب كبرى، وكانت أكثر تدميراً لأنها كانت نادرة.
فيما يتعلق بزمننا، تبرز نفس النتيجة، التي توصلت إليها في طريق أقصر. لا يمكن تجنب الحرب بشكل مؤكد إلا إذا وافق الرجال على إنشاء سلطة مركزية نعتمد عليها في كل تضارب المصالح. في مثل هذه الحالة، هناك ضرورتان حتميتان بنفس القدر: ضرورة إنشاء مثل هذه السلطة العليا وضرورة منحها القوة المناسبة. بدون الثانية، الأول لا فائدة منه. لقد تم بالفعل تصور عصبة الأمم على أنها سلطة عليا من هذا النوع، لكن الشرط الثاني لم يتحقق. ليس لعصبة الأمم قوتها الخاصة ولا يمكنها الحصول عليها إلا إذا منحها أعضاء الرابطة الجديدة - الدول المختلفة - إياها. وهناك أمل ضئيل في الوقت الحالي بحدوث ذلك. لكننا لن نفهم سبب إنشاء هذه المؤسسة، إذا لم نكن نعلم أنها تمثل، في تاريخ البشرية، محاولة نادرًا ما يتم تصورها، ولم يتم تنفيذها أبدًا بمثل هذه النسب. محاولة لاكتساب السلطة، أي التأثير القسري، الذي يعتمد عادة على امتلاك القوة، من خلال اللجوء إلى مبادئ مثالية معينة. هناك عاملان، كما رأينا، يكفلان تماسك المجتمع: قيود العنف وعلاقات المشاعر. - التعريفات، كما نسميها بلغة تقنية، - بين أعضاء نفس الهيئة. إذا ذهب أحد العوامل بعيدًا، فقد يحافظ الآخر على المجتمع. بالطبع، لا يمكن أن يكون لمثل هذه المفاهيم معنى إلا إذا كانت تتوافق مع عناصر مهمة في المجتمع. يبقى أن نرى مدى قوتها. يعلمنا التاريخ أن هذه المفاهيم عملت حقًا. فكرة عموم اليونان، على سبيل المثال، الوعي بأن تكون شيئًا أفضل من البرابرة المجاورين، والتي يجد المرء تعبيراً قوياً جداً عنها في الاتحادات البرمائية، في الأوراكل وفي الألعاب، كانت قوية بما يكفي لتليين النظام. الحرب بين الإغريق، لكنها ليست كافية، بالطبع، لقمع النزاعات المسلحة بين مختلف فصائل الشعب اليوناني أو حتى لثني مدينة أو اتحاد مدن عن التحالف مع الفرس الأعداء من أجل إنزال الخصم. كما أن شعور المجتمع المسيحي الذي نعرف قوته في عصر النهضة، لم يمنع الدول المسيحية الصغيرة والكبيرة من الاستعانة بالسلطان في الحروب التي خاضتها فيما بينها. في عصرنا أيضًا، لا توجد فكرة عمن يمكن منحه مثل هذه السلطة التصالحية. المثل الوطنية التي تحكم الشعوب اليوم - وهذا واضح للغاية -. الضغط من أجل فعل المعارضة. لا يوجد نقص في الناس للتنبؤ بأن الاختراق العالمي للأيديولوجية البلشفية فقط هو الذي سيكون قادرًا على إنهاء الحروب، لكننا ما زلنا بعيدين جدًا عن مثل هذه النتيجة على أي حال، وربما لا نفعل ذلك. هل يمكن تحقيق ذلك فقط بعد حروب أهلية رهيبة؟ لذلك يبدو أن محاولة استبدال القوة المادية بقوة الأفكار، في الوقت الحالي، محكوم عليها بالفشل؛ نحن نرتكب خطأ في التقدير من خلال إهمال حقيقة أن القانون كان في الأصل، القوة الغاشمة والتي لا تستطيع الاستغناء عنها بعد باستخدام القوة.
لا يمكنني أن أفعل الآن أفضل من التعليق على اقتراح آخر. تتساءل عن مدى سهولة إثارة الرجال للحرب ، وتفترض أن لديهم مبدأ نشطًا في داخلهم ، غريزة للكراهية والدمار جاهزة للترحيب بهذا النوع من الإثارة. نعتقد أن هناك مثل هذا الاتجاه ، وقد بذلنا جهودًا خاصة في السنوات الأخيرة لدراسة مظاهره. في هذا الصدد ، هل لي أن أشرح لكم بعض قوانين الغريزة التي توصلنا إليها ، بعد الكثير من التجربة والخطأ والتردد؟ نعترف بأن الغرائز البشرية يمكن اختزالها حصريًا إلى فئتين: من ناحية، أولئك الذين يريدون الحفاظ والتوحيد؛ نحن نسميها الإيروتيكية - بالضبط بمعنى الأيروس في ندوة أفلاطون - أو الجنسية، ونعطي هذا المصطلح صراحة امتدادًا للمفهوم الشائع للجنس؛ من ناحية أخرى، أولئك الذين يريدون التدمير والقتل؛ نقوم بتضمينها ضمن شروط القيادة العدوانية أو القيادة التدميرية. باختصار، كما ترى، فإن التحويل النظري للتضاد المعروف عالميًا للحب والكراهية، والذي ربما يكون شكلاً من أشكال قطبية الجاذبية والتنافر هو الذي يلعب دورًا. في مجال عملك. لكن لا تدفعنا بسرعة إلى مفاهيم الصواب والخطأ. - هذه الدوافع أساسية مثل الأخرى؛ تنشأ ظواهر الحياة من عملهم المشترك أو العدائي. ومع ذلك، يبدو أنه من النادر أن يتم تأكيد غريزة إحدى الفئتين بمعزل عن غيرها. إنه "مرتبط" دائمًا، حسب تعبيرنا، بكمية معينة من الفئة الأخرى، مما يعدل هدفه، أو، حسب الحالة، يسمح بتحقيقه وحده. لذا، على سبيل المثال، غريزة الحفاظ على الذات هي بالتأكيد شهوانية بطبيعتها؛ ولكن هذه هي الغريزة نفسها التي يجب أن تكون قادرة على اللجوء إلى العدوان، إذا كان لها أن تنتصر نواياها. وبالمثل، فإن غريزة الحب، المرتبطة بالأشياء، تحتاج إلى جرعة من غريزة الامتلاك، إذا أرادت في نهاية المطاف امتلاك موضوعها. والصعوبة التي نواجهها تحديدًا في عزل هذين النوعين من الغرائز، في مظاهرهما، هي التي منعتنا لفترة طويلة من التعرف عليها.
إذا كنت ستستمر معي لفترة أطول قليلاً، سترى أن الأفعال البشرية تكشف عن تعقيد واحد لآخر وبالتالي من النادر جدًا أن يكون الفعل من عمل تحريض غريزي واحد، والذي يجب أن يكون بالفعل في حد ذاته مركبًا من الأيروس والدمار. كقاعدة عامة، يجب أن تتطابق العديد من الدوافع، المركبة بالمثل، لإحداث الفعل. لاحظ أحد زملائك بالفعل - أعني هنا الأستاذ ج. تش. ليشتنبرغ، الذي قام بتدريس الفيزياء في غوتنغو خلال فترة كلاسيكياتنا؛ لكن معه، ربما كان عالم النفس أكثر أهمية من الفيزيائي. كان قد اكتشف ازدهار الدوافع عندما أعلن أن "الدوافع التي نتصرف على أساسها يمكن أن توزع مثل اثنين وثلاثين رياحًا وتصاغ أسمائها خبز - خبز - شهرة أو شهرة - شهرة - ألم. ".
لذلك عندما يتم تحريض البشر على الحرب، يمكن لسلسلة كاملة من الدوافع أن تردد صدى هذه الدعوة فيهم، بعضها نبيل، والبعض الآخر مبتذل، وبعضنا نتحدث بصراحة والبعض الآخر أننا صامتون. ليس لدينا سبب لإدراجهم جميعًا. إن الميل إلى العدوان والدمار واضح من بين هذه: فظائع لا حصر لها أبلغنا بها التاريخ والحياة اليومية تؤكد وجودها. من خلال إثارة هذه الميول المدمرة مع الميول الجنسية والروحية الأخرى، يتم إعطاؤهم بشكل طبيعي الوسائل للتدفق بحرية أكبر. أحيانًا عندما نسمع عن قسوة التاريخ، يكون لدينا انطباع بأن الدوافع المثالية لم تكن إلا بمثابة شاشة ضد الشهية المدمرة؛ في حالات أخرى، إذا كان الأمر يتعلق على سبيل المثال بقسوة محاكم التفتيش المقدسة، فإننا نعتقد أن الدوافع المثالية توضع في المقدمة، في الوعي، وأن الدوافع الهدامة قد أعطتها لهم، في اللاوعي، قوة إضافية. كلا الاحتمالين معقول.
لدي مخاوف بشأن إساءة استخدام تركيزك على كيفية منع الحرب وليس على نظرياتنا. ومع ذلك ، أود أن أتحدث لحظة أطول عن غريزة التدمير التي لا تُقارن شعبيتها بأهميتها. بقليل من التكهنات ، توصلنا إلى فهم أن هذا الدافع يعمل داخل جميع الكائنات الحية وأنه يميل إلى تدميرها ، وإعادة الحياة إلى حالة المادة غير الحية. مثل هذا الميل يستحق حقًا تسمية غريزة الموت ، بينما الدوافع الإيروتيكية تمثل السعي نحو الحياة. تصبح غريزة الموت دافعًا مدمرًا من خلال حقيقة أنها تخترق نفسها ، بمساعدة أعضاء معينة ، ضد الأشياء. يحمي الكائن الحي ، إذا جاز التعبير ، وجوده من خلال تدمير العنصر الأجنبي. لكن جزء من الغريزة. يظل الموت نشطًا داخل الكائن الحي وقد حاولنا استنباط سلسلة كاملة من الظواهر الطبيعية والمرضية من هذا الارتداد الداخلي للدافع التدميري. لقد التزمنا حتى بميراث تفسير أصل وعينا بإحدى هذه الانعكاسات للعدوان إلى الداخل. لذلك لا يمكننا، كما ترى، النظر إلى هذه الظاهرة باستخفاف، عندما تتجلى على نطاق واسع للغاية؛ يصبح غير صحي بشكل صحيح، في حين أن تطبيق هذه القوى الغريزية للتدمير في العالم الخارجي يريح الكائن الحي ويجب أن يكون له عمل مفيد. يمكن أن يكون بمثابة ذريعة بيولوجية لجميع الإدمان البغيض والخطير الذي نكافح ضده. لذلك علينا أن نعترف بأنها أقرب إلى الطبيعة من مقاومتنا لها والتي ما زلنا بحاجة إلى إيجاد تفسير لها. ربما تشعر أن نظرياتنا هي نوع من الأساطير التي، في هذه الحالة، ليست مريحة. لكن ألا ينزل كل العلم إلى هذا النوع من الأساطير؟ هل هو مختلف بالنسبة لك في مجال الفيزياء؟
هذا يسمح لنا أن نستنتج، بالعودة إلى موضوعنا، أنه سيكون من غير المجدي أن ندعي قمع الميول المدمرة للرجال. في الأراضي السعيدة على الأرض، حيث تقدم الطبيعة بوفرة كل ما يحتاجه الإنسان، يجب أن تكون هناك شعوب تتدفق حياتها بسلاسة ولا تعرف أي قيود أو عدوان. بالكاد أستطيع تصديق ذلك وسأكون سعيدًا بمعرفة المزيد عن هذه الكائنات المباركة. يأمل البلاشفة أيضًا في النجاح في قمع العدوان البشري من خلال ضمان إشباع الحاجات المادية مع تحقيق المساواة بين المستفيدين من المجتمع. أعتقد أن هذا مجرد وهم. إنهم، في الوقت الحالي، مسلحون بعناية، والكراهية التي يحملونها تجاه كل من ليس منهم ليست أدنى مساعدة في تأمين تماسك أنصارهم. علاوة على ذلك، كما أشرت أنت نفسك، لا يتعلق الأمر بقمع ميل الإنسان للعدوان؛ يمكن للمرء أن يحاول توجيهه حتى لا يجد طريقة تعبيره في الحرب.
بدءًا من قوانيننا الأسطورية الخاصة بالفطرة، نصل بسهولة إلى صيغة تمهد الطريق بشكل غير مباشر لمحاربة الحرب. إذا كان الميل إلى الحرب هو نتاج الدافع الهدام، فمن المناسب إذن أن نناشد خصم هذا الميل، إلى الأيروس. أي شيء يولد أواصر المشاعر بين الرجال يجب أن يكون رد فعل ضد الحرب. يمكن أن تكون هذه الروابط من نوعين. في المقام الأول، العلاقات مثل تلك التي تتعلق بموضوع الحب، حتى بدون نوايا جنسية. لا يجب أن يخجل التحليل النفسي من الحديث عن الحب، في هذه الحالة، لأن الدين يستخدم نفس اللغة: أحب قريبك كنفسك. التزام يسهل النطق به ولكن يصعب الوفاء به. الفئة الثانية من الروابط العاطفية هي تلك التي تنطلق من الهوية. يقع على عاتقهم جزء كبير من صرح المجتمع البشري.
أجد ، في انتقادك لإساءة استخدام السلطة ، مؤشرًا ثانيًا للنضال غير المباشر ضد الميل إلى الحرب. هذا هو أحد وجوه عدم المساواة البشرية - عدم المساواة المحلية التي لا يمكن مكافحتها - من يشاء ، هذا التقسيم إلى قادة ورعايا. ويشكل الأخيرون الأغلبية العظمى ؛ يحتاجون إلى سلطة لاتخاذ قرارات نيابة عنهم والتي يصادقون عليها دائمًا دون تحفظات. ينبغي ملاحظة، في سياق الأفكار هذه، أنه ينبغي على المرء أن يسعى، أفضل مما تم القيام به حتى الآن، لتدريب فئة عليا من المفكرين المستقلين، من الرجال الذين لا يمكن الوصول إليهم. للترهيب والمدمنين على البحث عن الحقيقة، الذين سيتولون قيادة جماهير خالية من المبادرة. أن الإمبراطورية التي استولت عليها سلطات الدولة وتحريم الفكر الكنسي لا تصلح لمثل هذا التدريب، فلا داعي لإثبات ذلك. من الطبيعي أن تكون الحالة المثالية في مجتمع من الرجال الذين أخضعوا حياتهم الغريزية لديكتاتورية العقل. لا شيء يمكن أن يخلق مثل هذا الاتحاد المثالي والمرن بين البشر، حتى لو اضطروا إلى التخلي عن روابط المشاعر البعض تجاه البعض الآخر.
ولكن هناك فرصة كبيرة في أن يكون هذا أملًا خياليًا. إن الطرق والوسائل الأخرى لمنع الحرب هي بالتأكيد أكثر عملية، لكنها لا تستطيع الاعتماد على النجاحات السريعة. من الصعب تخيل مطاحن تطحن ببطء شديد بحيث يكون لديك وقت للتجويع قبل الحصول على الدقيق. كما ترى، لم نحقق تقدمًا كبيرًا في الرغبة في استشارة المنظرين من خارج العالم عندما يتعلق الأمر بالمهام العملية والعاجلة. سيكون من الأفضل السعي، في كل حالة على حدة، لمواجهة الخطر بالوسائل المتاحة. ومع ذلك، أود التعامل مع مشكلة أخرى لم تثرها في رسالتك والتي تهمني بشكل خاص. لماذا نقف بقوة ضد الحرب، أنت وأنا والعديد من الآخرين معنا، لماذا لا نأخذ جانبنا كواحد من تقلبات الحياة التي لا تعد ولا تحصى؟ ومع ذلك، يبدو أنه يتوافق مع الطبيعة، وهو قائم على أساس بيولوجي للغاية، وعمليًا، لا مفر منه تقريبًا. لا تصدم من السؤال الذي أطرحه هنا. لأغراض التحقيق، ربما يكون من الجائز تخيل قناع السكون الذي لا يكاد يكون في الواقع. وستكون هذه هي الإجابة: لأن لكل إنسان حق في حياته، لأن الحرب تدمر حياة الإنسان المحملة بالوعود، وتضع الفرد في مواقف تسيء إليه، وتجبره على قتل جاره ضده إرادته، تدمر القيم المادية الثمينة، منتجات النشاط البشري، إلخ. سنضيف أيضًا أن الحرب، في شكلها الحالي، لم تعد تعطي أي فرصة لإظهار المثل الأعلى القديم للبطولة وأن حرب الغد، نتيجة لتحسين أدوات التدمير، ستكون بمثابة إبادة أحد المعارضين، أو ربما كلاهما.
كل هذا صحيح، ويبدو أنه لا جدال فيه لدرجة أن المرء يتحول إلى دهشة من أن اتفاقًا بالإجماع بين البشر لم يحظر الحرب بعد. من الواضح أنه يمكننا مناقشة واحدة أو أخرى من هذه النقاط ونسأل، على سبيل المثال، ما إذا كان يجب ألا يكون للمجتمع المحلي أيضًا حق في حياة الفرد؛ لا يمكننا إدانة كل بذور الحرب بنفس الطريقة. طالما أن هناك إمبراطوريات وأمم عازمة على إنهاء حكم الآخرين دون رحمة، يجب أن تكون هذه الدول الأخرى مجهزة للحرب. لكن لا يسعنا الانتظار حتى نتجاوز كل هذه القضايا، فهذه ليست المناقشة التي كنت تنوي المشاركة فيها. أريد أن أصل إلى شيء آخر. أعتقد أن السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتحدث ضد الحرب هو أننا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك. نحن دعاة سلام، لأننا يجب أن نكون بحكم دوافع عضوية. أصبح من السهل علينا الآن تبرير موقفنا بالحجج.
هذا ليس بدون تفسير. وهذا ما أضيفه منذ الأزل، فالإنسانية تمر بظاهرة تطور الثقافة. (بعض الناس يفضلون، كما أعلم، استخدام مصطلح الحضارة هنا). لهذه الظاهرة نحن مدينون بأفضل ما نتكون منه والكثير مما نعاني منه. أسبابه وأصوله غامضة، ونتائجه غير مؤكدة، وبعض خصائصه يمكن تمييزها بسهولة. ربما يؤدي إلى انقراض الجنس البشري، لأنه يضر في أكثر من جانب بالوظيفة الجنسية، وفي الوقت الحالي تزداد الأجناس غير المزروعة والطبقات المتخلفة من السكان بنسب أكبر من الفئات المكررة. ربما ينبغي أيضًا مقارنة هذه الظاهرة بتدجين أنواع حيوانية معينة؛ لا يمكن إنكار أنه يسبب تغيرات جسدية؛ نحن لسنا على دراية بفكرة أن تطور الثقافة يمكن أن يكون ظاهرة عضوية. التحولات النفسية التي تصاحب ظاهرة الثقافة واضحة لا لبس فيها. وهي تتكون من تجنب تدريجي للنهايات الغريزية، إلى جانب الحد من ردود الفعل الاندفاعية. أحاسيس مشحونة باللذة بالنسبة لأسلافنا، أصبحت غير مبالية بنا وحتى لا تطاق؛ هناك أسباب عضوية للتحول تحملنا تطلعاتنا الأخلاقية والجمالية. من بين الخصائص النفسية للثقافة، هناك سمتان يبدو أنهما الأكثر أهمية: تقوية الفكر الذي يميل إلى التحكم في الحياة الغريزية، والرجوع الداخلي للميل العدواني، بكل ما يترتب عليه من نتائج إيجابية ومواتية. خطير. والآن نجد أن المفاهيم النفسية التي يقودنا إليها تطور الثقافة تتأثر بشدة بالحرب، ولهذا السبب يجب أن ننهض ضدها؛ لا يمكننا أخذها على الإطلاق؛ إنها ليست مجرد اشمئزاز فكري وعاطفي، ولكن في الواقع، بيننا من دعاة السلام، تعصب دستوري، وخصوصية بطريقة ما تتضخم إلى أقصى الحدود. ويبدو أن الانحطاط الجمالي للحرب لا يعول كثيرًا، في سخطنا، على الفظائع التي تثيرها.
والآن، كم من الوقت سيستغرق الآخرون ليصبحوا من دعاة السلام بدورهم؟ لا يمكننا أن نقول ذلك، لكن ربما ليس من المثالية أن نأمل في عمل هذين العنصرين، المفهوم الثقافي والخوف المبرر من تداعيات حريق مستقبلي ، - لوضع نهاية الحرب في المستقبل القريب. بأي مسارات أو منعطفات، لا يمكننا التخمين. في غضون ذلك، يمكننا أن نقول لأنفسنا: كل ما يعمل من أجل تطوير الثقافة يعمل أيضًا ضد الحرب.
أحييكم من صميم القلب، وإذا كان عرضي قد خيب أملك، يرجى أن تسامحني.
سيغموند فرويد."
نهاية النص
الرابط:
https://squiggle.be/PDF_Matiere/Pourquoi la guerre_Freud et Einstein.pdf
* المصدر:
المراسلات بين ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد. هذه هي النسخة المنشورة بمبادرة من المعهد الدولي للتعاون الفكري - جمعية الأمم ، في عام 1933.
تمهيد:
كيف فهم المحلل النفسي سيغموند فرويد (1879-1955)، وعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين (1879-1955)، ظاهرة الحرب خاصة وانهما شهدا مجريات حربين عالميتين ولاحظا ما عانته الكثير من شعوب ودول العالم من وحشية وويلات ودمار واستيلاء وغزو ونهب للثروات وتشريد للسكان وهدم للعمران والتجهيزات؟
الجدير بالملاحظة أن علاقة أينشتاين بالحرب هي علاقة إشكالية فهو من جهة مسؤول عن تفجير الذرة ووصول الإنسانية الى صناعة القنبلة النووية وما تسببت فيه من ضرر للكون عندما استعملت في القتال، ولكنه من ناحية ثانية عارض بشدة الحرب وتحول الى داعية سلام ورفض أي عدوان لدولة على أخرى.
من ناحية ثانية عمل فرويد على تشريح الطبيعة البشرية والبحث في خفاياها عن أسباب كامنة للعدوان وفتش بطرق منهجية تحليلية عن العوامل النفسية والثقافية التي تدفع الناس الى الحرب وحاول إيجاد مسالك تنويرية للوقاية من هذه الظاهرة المرضية وتشييد علاقات سليمة بين الفراد والمجموعات ضمن حياة انسية تصالحية.
فما الفرق بين المقاربة الفيزيائية عند أينشتاين والمقاربة التحليلية النفسية عند فرويد لظاهرة الحرب؟ وهل وفقا في إيقاف هذه السلوك العدواني الجماعي؟ ولماذا بقيت الحرب هي اللغة الوحيدة للتخاطب بين القوى؟
الترجمة:
"1) ألبرت أينشتاين
بوتسدام ، 30 يوليو 1932.
صديقي العزيز،
يسعدني أنه من خلال دعوتي للتبادل الحر للآراء مع شخص من اختياري في موضوع معين حسب تقديري، أعطتني عصبة الأمم ومعهدها الدولي للتعاون الفكري في باريس، بطريقة ما، مع إعطاء الفرصة الثمينة لمناقشة السؤال الذي يبدو لي، في الحالة الراهنة للأشياء، أنه الأهم في ترتيب الحضارة: هل وسيلة لتحرير الرجال من خطر الحرب؟
بشكل عام، نتفق الآن على الاعتراف بأن التقدم التقني قد جعل مثل هذه المسألة حيوية حقًا للإنسانية المتحضرة، ومع ذلك فإن الجهود الحثيثة المكرسة لحل هذه المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن تقطعت بهم السبل بنسب مخيفة. أعتقد أنه من بين أولئك المنشغلين بهذه المشكلة عمليًا ومهنيًا، تظهر الرغبة نفسها، الناشئة عن شيء معين. الشعور بالعجز، لطلب النصيحة من الناس حول هذه النقطة الذين وُضِعوا على مسافة سعيدة من العمل المعتاد للعلم في جميع أمور الحياة. بالنسبة لي، فإن الاتجاه المعتاد لفكري ليس هو الاتجاه الذي يفتح لمحات في أعماق إرادة الإنسان وشعوره، ولهذا السبب، في تبادل الآراء الذي أبدأ به هنا، بالكاد أستطيع أن أفكر في القيام بأكثر من مجرد محاولة طرح المشكلة، مع ترك المزيد أو أقل من المحاولات الخارجية للتوصل إلى حل مقدمًا جانباً، مما يتيح لك الفرصة لإلقاء الضوء على السؤال من وجهة نظر معرفتك العميقة بالحياة الغريزية للإنسان. أنا مقتنع بأنك ستكون قادرًا على الإشارة إلى الوسائل التعليمية التي، بطريقة ما، إلى حد ما، غريبة عن السياسة، ستكون ذات طبيعة لإزالة العقبات النفسية، التي قد يشك بها الشخص العادي في هذه المسألة، ولكن هو غير قادر على قياس التطابقات والاختلافات.
بالنسبة لي، أنا متحرر من التحيزات الوطنية، فإن الوجه الخارجي للمشكلة - في هذه الحالة، عنصر التنظيم - يبدو لي بسيطًا: تنشئ الدول سلطة تشريعية وقضائية لتهدئة جميع النزاعات التي قد تنشأ بينهما.
يتعهدون بالخضوع للقوانين التي تضعها السلطة التشريعية، والاستئناف أمام المحكمة في جميع القضايا المتنازع عليها، والامتثال دون تحفظ لقراراتها وتنفيذها وضمان تطبيقها، الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية. هنا أصل إلى الصعوبة الأولى: المحكمة هي مؤسسة بشرية تكون قادرة على إظهار نفسها، في قراراتها، في متناول جميع الطلبات الخارجة عن القانون لأنها ستكون أقل قوة لتنفيذ أحكامها. إنها حقيقة لا يستهان بها: القانون والقوة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأحكام هيئة قانونية تقترب من نموذج عدالة المجتمع الذي يُنطق القانون باسمه ولمصلحته، إلى الحد الذي يمكن لهذا المجتمع أن يجمع القوى اللازمة لدعم مثله المثالي للعدالة. لكننا الآن بعيدون جدًا عن وجود منظمة فوق دولة قادرة على إعطاء محكمتها سلطة مطلقة وضمان الخضوع المطلق لتنفيذ أحكامها. وهنا هو المبدأ الأول الذي يلفت انتباهي: الطريق إلى الأمن الدولي يتطلب من الدول أن تتنازل دون قيد أو شرط عن جزء من حريتهم في التصرف، وبعبارة أخرى، من سيادتهم، وليس هناك شك في أنه لا توجد طريقة أخرى لهذا الأمن.
تكشف نظرة خاطفة على الجهود الفاشلة، المخلصة بالتأكيد، خلال السنوات العشر الماضية عن وجود قوى نفسية قوية تعمل على شل هذه الجهود. يمكن ملاحظة بعضها بسهولة. إن شهية السلطة التي تظهرها الطبقة الحاكمة في دولة ما تحبط تقييد حقوقها السيادية. غالبًا ما تجد هذه "الشهية السياسية للسلطة" طعامًا في ادعاءات فئة أخرى يتجلى جهدها الاقتصادي بطريقة مادية للغاية. أفكر هنا على وجه الخصوص في تلك المجموعة التي يجدها المرء داخل كل شخص والتي، قليلة العدد ولكنها مصممة، قليلة الاهتمام بالخبرات والعوامل الاجتماعية، تتكون من الأفراد الذين لهم الحرب وتصنيعهم والاتجار بهم. لا تمثل الأسلحة أكثر من فرصة لاكتساب مزايا خاصة، لتوسيع نطاق قوتها الشخصية.
هذه الملاحظة البسيطة، مع ذلك، ليست سوى الخطوة الأولى في فهم الوضع الاقتصادي. يطرح سؤال على الفور: كيف يمكن لهذه الأقلية أن تستعبد لشهواتها الجماهير العظيمة من الناس الذين لا يجنون سوى المعاناة والفقر من الحرب؟ (عندما أتحدث عن جماهير الشعب، لا أنوي استبعاد أولئك الذين جعلوا الحرب مهنة ، جنودًا من جميع الرتب، بقناعة العمل من أجل الدفاع عن أثمن الأشياء. من شعبهم واعتقادًا منهم أن الهجوم هو أفضل دفاع في بعض الأحيان.) إليكم ما أعتقده هو الإجابة الأولى الضرورية: هذه الأقلية من قادة الساعة في يدها أولاً وقبل كل شيء المدرسة والصحافة والمنظمات الدينية دائمًا تقريبًا. وبهذه الوسائل تسيطر وتوجه مشاعر الكتلة الهائلة التي تصنع منها أداة عمياء.
لكن هذه الإجابة لا تشرح بعد سلسلة العوامل المعنية لأن سؤالًا آخر يطرح نفسه: كيف يمكن أن تسمح الكتلة، بالوسائل التي أشرنا إليها، بإشعال نفسها إلى درجة الجنون والتضحية؟ لا أرى إجابة أخرى غير هذا: الإنسان فيه حاجة للكراهية والدمار. في الأوقات العادية، يوجد هذا التصرف في حالة كامنة ولا يظهر إلا في فترات غير طبيعية؛ ولكن يمكن إيقاظها ببعض السهولة وتتحول إلى ذهان جماعي. هنا، على ما يبدو، تكمن المشكلة الأساسية والأكثر سرية لهذه المجموعة من العوامل. هذه هي النقطة التي لا يسلط الضوء عليها إلا المتذوق العظيم للغرائز البشرية.
وهكذا نأتي إلى سؤال أخير: هل هناك إمكانية لتوجيه التطور النفسي للإنسان بطريقة تجعله أفضل تسليحا ضد عقليات الكراهية والدمار؟ وبعيدًا عني فكرة التفكير هنا فقط فيما يسمى بالكائنات غير المتعلمة. لقد استطعت أن أجرب بنفسي أنه بالأحرى ما يسمى بـ "الذكاء" الذي يصادف أنه أسهل فريسة للاقتراحات الجماعية القاتلة، لأنه ليس من عادة الاستقاء من مصادر الخبرة. عاش، وهذا، على العكس من ذلك، من خلال وسيط الورق المطبوع يسهل فهمه بشكل كامل.
وأخيرًا، هذا مرة أخرى: لقد تحدثت حتى الآن فقط عن الحرب بين الدول، وبعبارة أخرى، عما يسمى بالصراعات الدولية. إنني أدرك أن العدوان البشري يتجلى أيضًا في أشكال أخرى وتحت ظروف أخرى (على سبيل المثال الحرب الأهلية، التي كانت سببها سابقًا دوافع دينية، واليوم بدوافع اجتماعية، - اضطهاد الأقليات القومية). لكن عن قصد قدمت أكثر أشكال الصراع الجامحة التي تتجلى داخل المجتمعات البشرية، لأنه من خلال البدء من هذا الشكل سنكتشف بسهولة وسائل تجنب الصراع المسلح.
أعلم أنك أجبت في أعمالك، بشكل مباشر أو غير مباشر، على جميع الأسئلة المتعلقة بالمشكلة التي تهمنا وتحثنا. ولكن سيكون من المفيد جدًا أن نراكم تطورون مشكلة تهدئة العالم في ضوء تحقيقاتكم الجديدة، لأن مثل هذا العرض يمكن أن يكون مصدر جهود مثمرة.
صديقك المخلص.
ألبرت أينشتاين
+++++++++++++++++++++++++++++
2) سيغموند فرويد
فيينا ، سبتمبر 1932.
عزيزي السيد أينشتاين،
عندما علمت أنك تنوي دعوتي إلى تبادل وجهات النظر حول موضوع تمنح فيه اهتمامك وتعتقد أنه يستحق اهتمام الآخرين أيضًا، لم أتردد في إقناع نفسي بهذا. مقابلة. لقد افترضت أنك ستختار مشكلة تقع على حدود ما يمكننا معرفته اليوم، والتي يمكن لكل منا، الفيزيائي وطبيب النفس، الوصول إليها بطريقة ما. للالتقاء على نفس الأرضية، بدءًا من مناطق مختلفة. لذلك فاجأتموني بسؤالي ما الذي يمكن فعله لتحرير البشر من خطر الحرب. في البداية كنت خائفة من عدم كفاءتي - كنت سأقول - لأنني كنت أعتبرها مهمة عملية كانت من اختصاص رجال الدولة. لكنني أدركت أنك لم تطرح السؤال كعالم وفيزيائي، ولكن كصديق للبشر، استجابة لدعوة عصبة الأمم، مثل المستكشف فريدجوف نانسن عندما تعهد بمساعدة الجياع وضحايا الحرب العالمية المحرومين من وطن. فكرت أيضًا أنه لم يكن من المتوقع أن أطرح مقترحات عملية، ولكن كان على ببساطة أن أطرح مشكلة حماية السلام، في ضوء الفحص النفسي.
لكن في هذا الصدد مرة أخرى، قلت الأساسيات في رسالتك وفي نفس الوقت أخذت الريح من أشرعتي، لكنني عن طيب خاطر أقرض نفسي للإبحار في أعقابك وسأكتفي بتأكيد ما تقول، بينما أحضر استطراداتي هناك، أقرب ما يمكن إلى معرفتي - أو تخميناتي.
تبدأ بطرح السؤال بين الحق والقوة. هذه، بالطبع، نقطة البداية الصحيحة لتحقيقنا. هل يمكنني السماح لنفسي باستبدال كلمة "قوة" بمصطلح "عنف" أكثر ثباتًا وقسوة؟ القانون والعنف حاليا نقيض بالنسبة لنا. من السهل إظهار أن أحدهما مشتق من الآخر، وإذا عدنا إلى الأصول البدائية لنتفحص كيف نشأت الظاهرة أولاً، فإن حل المشكلة يظهر لنا دون صعوبة. إذا رأيتني، فيما يلي، أشرح، مثل العديد من العناصر الجديدة، حقائق معروفة ومعترف بها بشكل عام، فسوف تسامحني على هذا، فإن الانتماء للبيانات يتطلب مني القيام بذلك.
لذلك فإن تضارب المصالح الذي ينشأ بين الرجال يتم حله من حيث المبدأ عن طريق العنف. هكذا في جميع أنحاء مملكة الحيوان، حيث لا يستطيع الإنسان استبعاد نفسه منها؛ بالنسبة للبشر، لا تزال هناك بالطبع صراعات إضافية في الرأي تصل إلى أعلى قمم التجريد ويبدو أن حلها يتطلب أسلوبًا مختلفًا. لكن هذا التعقيد لم يظهر إلا في وقت لاحق. في الأصل، في حشد صغير، كان تفوق القوة العضلية هو الذي يقرر ما يجب أن ينتمي إليه، أو من هو الشخص الذي سيتم تطبيق إرادته، وتم إعارة القوة العضلية واستبدالها قريبًا. من خلال استخدام الأدوات؛ يذهب النصر لمن لديه أفضل الأسلحة أو يستخدمها بمهارة. يمثل تدخل السلاح اللحظة التي بدأت فيها السيادة الفكرية بالفعل تحل محل القوة العضلية؛ يبقى الهدف النهائي للنضال كما هو: يجب إجبار أحد أطراف القبضة، بسبب الضرر الذي يعاني منه وخنق قواته، على التخلي عن مطالبه أو معارضته. هذه النتيجة تتحقق بشكل أفضل عندما يقضي العنف على الخصم بطريقة دائمة، وبالتالي يقتله. تقدم هذه العملية ميزتين: لن يتمكن الخصم من استئناف القتال في مناسبة جديدة ومصيره سيثني الآخرين عن الاقتداء بمثاله. علاوة على ذلك، فإن قتل العدو يرضي نزعة غريزية علينا العودة إليها.
في بعض الأحيان تصطدم خطة قتل الاشتباكات بحساب أنه يمكن استخدام العدو لتقديم خدمة مفيدة، إذا تم السماح بإنقاذ حياته، مع مراعاة الاحترام. في مثل هذه الحالة يكون العنف قانعاً بالاستعباد بدلاً من القتل. هذه هي الطريقة التي يبدأ بها المرء في تجنيب العدو، ولكن على المنتصر بالتالي أن يأخذ في الحسبان شهوة الانتقام الكامنة في الانتظار في المهزوم، ويتخلى عن جزء من أمنه.
إذن هذه هي الحالة الأصلية ، حكم القوة الأعلى ، العنف الوحشي أو العنف المبرهن فكريًا. نحن نعلم أن هذا النظام قد تغير في سياق التطور ، وأن الطريق قد أدى من العنف إلى القانون ، ولكن أيهما؟ هناك واحد فقط ، في رأيي ، وهو الذي ينتج عنه حقيقة أنه يمكن للمرء أن ينافس أقوى من خلال اتحاد العديد من الضعفاء. " الوحدة هي قوة. "
إن الوحدة تكسر العنف، لذا فإن قوة هذه العناصر الموحدة تمثل الحق، في مقابل عنف الفرد. لذلك نرى أن القانون هو قوة المجتمع. لا يزال عنفًا، ومستعدًا دائمًا للانقلاب على أي فرد يقاومه، ويعمل بنفس الوسائل، مرتبطًا بنفس الأهداف؛ يكمن الاختلاف، في الواقع، فقط في حقيقة أنه لم يعد عنف الفرد هو الذي ينتصر، بل عنف المجتمع. ولكن من أجل تحقيق هذا الانتقال من العنف إلى القانون الجديد، يجب تلبية حالة نفسية.
يجب أن يكون اتحاد الأرقام مستقرًا ودائمًا. إذا خلقت نفسها لغرض وحيد هو محاربة أقوى فقط لتذوب نفسها بمجرد هزيمتها، فإن النتيجة ستكون لا شيء. أول من أصبح بعد ذلك يشعر بأنه أقوى سيسعى مرة أخرى إلى فرض هيمنة العنف، وستكرر اللعبة نفسها مرارًا وتكرارًا. يجب الحفاظ على المجتمع في جميع الأوقات، وتنظيم نفسه، ووضع اللوائح التي تمنع التمرد من الخوف، وتعيين الهيئات التي تضمن الحفاظ على اللوائح، والقوانين، والتي تضمن تنفيذ أعمال العنف وفقًا للقوانين. من خلال الاعتراف بمجتمع المصالح المتشابه، فإنه يشكل، داخل أعضاء مجموعة من الأشخاص المتحدين، روابط عاطفية، ومشاعر المجتمع، والتي تقوم عليها، بالمعنى الدقيق للكلمة، قوة هذا المجتمع.
أعتقد أنني أشرت بالتالي إلى جميع العناصر الأساسية ؛ الانتصار على العنف من خلال نقل السلطة إلى وحدة أكبر ، هي نفسها مدمجة بعلاقات المشاعر. كل شيء آخر هو مجرد تعليقات وتكرار. الوضع بسيط ، طالما أن المجتمع يتكون من عدد من الأفراد من نفس القوة. ثم تحدد قوانين هذه الجمعية ، فيما يتعلق بمظاهر القوة العنيفة ، جزء الحرية الشخصية الذي يجب على الفرد التخلي عنه حتى تستمر الحياة معًا في أمان. لكن مثل هذه الحالة من الهدوء لا يمكن تصورها إلا من الناحية النظرية. في الواقع ، يصبح مسار الأمور أكثر تعقيدًا ، لأن المجتمع ، منذ البداية ، يحتوي على عناصر قوة غير متكافئة - الرجال والنساء ، والآباء والأطفال - وسرعان ما تخلق الحرب والقهر منتصرين و مهزوم ، الذين يتحولون إلى أسياد وعبيد. وبالتالي فإن قانون المجتمع سيكون تعبيرا عن عدم المساواة في السلطة، وسوف يتم وضع القوانين من قبل الحكام ومن أجلهم، وسوف يتم ترك القليل من الامتيازات للرعايا. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، تعرض النظام القانوني للاضطرابات من مصدرين: أولاً وقبل كل محاولات أحد أو الآخر من اللوردات للتغلب على القيود المطبقة على جميع نظرائه، للعودة، بالتالي، من حكم القانون إلى عهد العنف؛ في المقام الثاني، الجهود المستمرة التي يبذلها الأفراد لتوسيع سلطتهم ورؤية هذه التعديلات معترف بها في القانون، وبالتالي المطالبة، على العكس من ذلك، بتمرير الحق غير المتساوي في الحق المتساوي للجميع.
سيتم تمييز هذا الاتجاه الأخير بشكل خاص عندما تكون هناك بالفعل تغييرات في صلاحيات السلطة داخل المجتمع، كما يحدث نتيجة لعوامل تاريخية مختلفة. يمكن للقانون بعد ذلك أن يتكيف بشكل غير محسوس مع هذه الظروف الجديدة، أو ما هو أكثر شيوعًا، أن الطبقة الحاكمة ليست مستعدة لأخذ هذا التغيير في الاعتبار: إنه تمرد، حرب أهلية، ومن ثم القمع المؤقت للقانون، والانقلابات الجديدة، التي يتم في نهايتها تأسيس حكم القانون الجديد. هناك مصدر آخر لتغيير القانون، لا يتجلى إلا بالوسائل السلمية، وهو تغيير الثقافة الذي يحدث بين أفراد المجتمع؛ لكنها تدخل في ترتيب الظواهر التي لا يمكن معالجتها إلا لاحقًا.
لذلك نرى أنه، حتى داخل المجتمع، لا يمكن تجنب استخدام العنف في حل تضارب المصالح. لكن الضرورات، مجتمعات المصالح الناشئة عن الوجود المشترك على نفس الأرض، تسرع من تهدئة هذه النضالات، وتحت هذه الرعاية، تتزايد باستمرار احتمالات الحلول السلمية. لكن يكفي أن نلقي نظرة على تاريخ الإنسانية لتشهد عرضًا غير منقطع للصراعات، سواء كان مجتمعًا يتصارع مع مجموعة أو أكثر من التجمعات الأخرى، سواء كان ذلك بين وحدات واسعة وأحيانًا أكثر مختزلة، بين المدن والبلدان والقبائل والشعوب والإمبراطوريات والصراعات التي يتم حلها دائمًا تقريبًا عن طريق اختبار القوى أثناء الحرب. تؤدي هذه الحروب إما إلى النهب أو الخضوع التام أو الفتح لأحد الطرفين.
لا يمكننا إصدار حكم شامل على حروب الفتح. كثير منهم، مثل المغول والأتراك، لم يجلبوا سوى الحظ السيئ. من ناحية أخرى، ساهم البعض الآخر في تحويل العنف إلى قانون، من خلال إنشاء وحدات أكبر تم فيها القضاء على إمكانية اللجوء إلى القوة وتهدئة النزاعات من خلال سيادة القانون الجديدة. الفتوحات الرومانية التي جلبت باكس رومانا الثمين إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الطموحات الإقليمية لملوك فرنسا مملكة موحدة في سلام وازدهار. كما قد يبدو متناقضًا، علينا أن نعترف بأن الحرب قد لا تكون وسيلة غير مناسبة لتأسيس السلام "الأبدي"، لأنها تثبت أنها قادرة على تشكيل وحدات واسعة يمكن من خلالها القوة المركزية تجعل الحروب الجديدة مستحيلة. ومع ذلك، فإنه لا يؤدي إلى هذه النتيجة، لأن نجاحات الغزو، كقاعدة عامة، قصيرة الأجل، والوحدات المنشأة حديثًا تتفكك بدورها دائمًا تقريبًا بسبب عدم التماسك بين الأطراف المتحدين بالقيود. علاوة على ذلك، لم يكن الغزو حتى الآن قادراً إلا على خلق اتحادات جزئية - على نطاق واسع صحيح - وصراعات تتطلب حلولاً قاسية. كانت نتيجة كل هذه الجهود الحربية ببساطة أن البشرية استبدلت عددًا لا يحصى من المناوشات المستمرة تقريبًا من أجل حروب كبرى، وكانت أكثر تدميراً لأنها كانت نادرة.
فيما يتعلق بزمننا، تبرز نفس النتيجة، التي توصلت إليها في طريق أقصر. لا يمكن تجنب الحرب بشكل مؤكد إلا إذا وافق الرجال على إنشاء سلطة مركزية نعتمد عليها في كل تضارب المصالح. في مثل هذه الحالة، هناك ضرورتان حتميتان بنفس القدر: ضرورة إنشاء مثل هذه السلطة العليا وضرورة منحها القوة المناسبة. بدون الثانية، الأول لا فائدة منه. لقد تم بالفعل تصور عصبة الأمم على أنها سلطة عليا من هذا النوع، لكن الشرط الثاني لم يتحقق. ليس لعصبة الأمم قوتها الخاصة ولا يمكنها الحصول عليها إلا إذا منحها أعضاء الرابطة الجديدة - الدول المختلفة - إياها. وهناك أمل ضئيل في الوقت الحالي بحدوث ذلك. لكننا لن نفهم سبب إنشاء هذه المؤسسة، إذا لم نكن نعلم أنها تمثل، في تاريخ البشرية، محاولة نادرًا ما يتم تصورها، ولم يتم تنفيذها أبدًا بمثل هذه النسب. محاولة لاكتساب السلطة، أي التأثير القسري، الذي يعتمد عادة على امتلاك القوة، من خلال اللجوء إلى مبادئ مثالية معينة. هناك عاملان، كما رأينا، يكفلان تماسك المجتمع: قيود العنف وعلاقات المشاعر. - التعريفات، كما نسميها بلغة تقنية، - بين أعضاء نفس الهيئة. إذا ذهب أحد العوامل بعيدًا، فقد يحافظ الآخر على المجتمع. بالطبع، لا يمكن أن يكون لمثل هذه المفاهيم معنى إلا إذا كانت تتوافق مع عناصر مهمة في المجتمع. يبقى أن نرى مدى قوتها. يعلمنا التاريخ أن هذه المفاهيم عملت حقًا. فكرة عموم اليونان، على سبيل المثال، الوعي بأن تكون شيئًا أفضل من البرابرة المجاورين، والتي يجد المرء تعبيراً قوياً جداً عنها في الاتحادات البرمائية، في الأوراكل وفي الألعاب، كانت قوية بما يكفي لتليين النظام. الحرب بين الإغريق، لكنها ليست كافية، بالطبع، لقمع النزاعات المسلحة بين مختلف فصائل الشعب اليوناني أو حتى لثني مدينة أو اتحاد مدن عن التحالف مع الفرس الأعداء من أجل إنزال الخصم. كما أن شعور المجتمع المسيحي الذي نعرف قوته في عصر النهضة، لم يمنع الدول المسيحية الصغيرة والكبيرة من الاستعانة بالسلطان في الحروب التي خاضتها فيما بينها. في عصرنا أيضًا، لا توجد فكرة عمن يمكن منحه مثل هذه السلطة التصالحية. المثل الوطنية التي تحكم الشعوب اليوم - وهذا واضح للغاية -. الضغط من أجل فعل المعارضة. لا يوجد نقص في الناس للتنبؤ بأن الاختراق العالمي للأيديولوجية البلشفية فقط هو الذي سيكون قادرًا على إنهاء الحروب، لكننا ما زلنا بعيدين جدًا عن مثل هذه النتيجة على أي حال، وربما لا نفعل ذلك. هل يمكن تحقيق ذلك فقط بعد حروب أهلية رهيبة؟ لذلك يبدو أن محاولة استبدال القوة المادية بقوة الأفكار، في الوقت الحالي، محكوم عليها بالفشل؛ نحن نرتكب خطأ في التقدير من خلال إهمال حقيقة أن القانون كان في الأصل، القوة الغاشمة والتي لا تستطيع الاستغناء عنها بعد باستخدام القوة.
لا يمكنني أن أفعل الآن أفضل من التعليق على اقتراح آخر. تتساءل عن مدى سهولة إثارة الرجال للحرب ، وتفترض أن لديهم مبدأ نشطًا في داخلهم ، غريزة للكراهية والدمار جاهزة للترحيب بهذا النوع من الإثارة. نعتقد أن هناك مثل هذا الاتجاه ، وقد بذلنا جهودًا خاصة في السنوات الأخيرة لدراسة مظاهره. في هذا الصدد ، هل لي أن أشرح لكم بعض قوانين الغريزة التي توصلنا إليها ، بعد الكثير من التجربة والخطأ والتردد؟ نعترف بأن الغرائز البشرية يمكن اختزالها حصريًا إلى فئتين: من ناحية، أولئك الذين يريدون الحفاظ والتوحيد؛ نحن نسميها الإيروتيكية - بالضبط بمعنى الأيروس في ندوة أفلاطون - أو الجنسية، ونعطي هذا المصطلح صراحة امتدادًا للمفهوم الشائع للجنس؛ من ناحية أخرى، أولئك الذين يريدون التدمير والقتل؛ نقوم بتضمينها ضمن شروط القيادة العدوانية أو القيادة التدميرية. باختصار، كما ترى، فإن التحويل النظري للتضاد المعروف عالميًا للحب والكراهية، والذي ربما يكون شكلاً من أشكال قطبية الجاذبية والتنافر هو الذي يلعب دورًا. في مجال عملك. لكن لا تدفعنا بسرعة إلى مفاهيم الصواب والخطأ. - هذه الدوافع أساسية مثل الأخرى؛ تنشأ ظواهر الحياة من عملهم المشترك أو العدائي. ومع ذلك، يبدو أنه من النادر أن يتم تأكيد غريزة إحدى الفئتين بمعزل عن غيرها. إنه "مرتبط" دائمًا، حسب تعبيرنا، بكمية معينة من الفئة الأخرى، مما يعدل هدفه، أو، حسب الحالة، يسمح بتحقيقه وحده. لذا، على سبيل المثال، غريزة الحفاظ على الذات هي بالتأكيد شهوانية بطبيعتها؛ ولكن هذه هي الغريزة نفسها التي يجب أن تكون قادرة على اللجوء إلى العدوان، إذا كان لها أن تنتصر نواياها. وبالمثل، فإن غريزة الحب، المرتبطة بالأشياء، تحتاج إلى جرعة من غريزة الامتلاك، إذا أرادت في نهاية المطاف امتلاك موضوعها. والصعوبة التي نواجهها تحديدًا في عزل هذين النوعين من الغرائز، في مظاهرهما، هي التي منعتنا لفترة طويلة من التعرف عليها.
إذا كنت ستستمر معي لفترة أطول قليلاً، سترى أن الأفعال البشرية تكشف عن تعقيد واحد لآخر وبالتالي من النادر جدًا أن يكون الفعل من عمل تحريض غريزي واحد، والذي يجب أن يكون بالفعل في حد ذاته مركبًا من الأيروس والدمار. كقاعدة عامة، يجب أن تتطابق العديد من الدوافع، المركبة بالمثل، لإحداث الفعل. لاحظ أحد زملائك بالفعل - أعني هنا الأستاذ ج. تش. ليشتنبرغ، الذي قام بتدريس الفيزياء في غوتنغو خلال فترة كلاسيكياتنا؛ لكن معه، ربما كان عالم النفس أكثر أهمية من الفيزيائي. كان قد اكتشف ازدهار الدوافع عندما أعلن أن "الدوافع التي نتصرف على أساسها يمكن أن توزع مثل اثنين وثلاثين رياحًا وتصاغ أسمائها خبز - خبز - شهرة أو شهرة - شهرة - ألم. ".
لذلك عندما يتم تحريض البشر على الحرب، يمكن لسلسلة كاملة من الدوافع أن تردد صدى هذه الدعوة فيهم، بعضها نبيل، والبعض الآخر مبتذل، وبعضنا نتحدث بصراحة والبعض الآخر أننا صامتون. ليس لدينا سبب لإدراجهم جميعًا. إن الميل إلى العدوان والدمار واضح من بين هذه: فظائع لا حصر لها أبلغنا بها التاريخ والحياة اليومية تؤكد وجودها. من خلال إثارة هذه الميول المدمرة مع الميول الجنسية والروحية الأخرى، يتم إعطاؤهم بشكل طبيعي الوسائل للتدفق بحرية أكبر. أحيانًا عندما نسمع عن قسوة التاريخ، يكون لدينا انطباع بأن الدوافع المثالية لم تكن إلا بمثابة شاشة ضد الشهية المدمرة؛ في حالات أخرى، إذا كان الأمر يتعلق على سبيل المثال بقسوة محاكم التفتيش المقدسة، فإننا نعتقد أن الدوافع المثالية توضع في المقدمة، في الوعي، وأن الدوافع الهدامة قد أعطتها لهم، في اللاوعي، قوة إضافية. كلا الاحتمالين معقول.
لدي مخاوف بشأن إساءة استخدام تركيزك على كيفية منع الحرب وليس على نظرياتنا. ومع ذلك ، أود أن أتحدث لحظة أطول عن غريزة التدمير التي لا تُقارن شعبيتها بأهميتها. بقليل من التكهنات ، توصلنا إلى فهم أن هذا الدافع يعمل داخل جميع الكائنات الحية وأنه يميل إلى تدميرها ، وإعادة الحياة إلى حالة المادة غير الحية. مثل هذا الميل يستحق حقًا تسمية غريزة الموت ، بينما الدوافع الإيروتيكية تمثل السعي نحو الحياة. تصبح غريزة الموت دافعًا مدمرًا من خلال حقيقة أنها تخترق نفسها ، بمساعدة أعضاء معينة ، ضد الأشياء. يحمي الكائن الحي ، إذا جاز التعبير ، وجوده من خلال تدمير العنصر الأجنبي. لكن جزء من الغريزة. يظل الموت نشطًا داخل الكائن الحي وقد حاولنا استنباط سلسلة كاملة من الظواهر الطبيعية والمرضية من هذا الارتداد الداخلي للدافع التدميري. لقد التزمنا حتى بميراث تفسير أصل وعينا بإحدى هذه الانعكاسات للعدوان إلى الداخل. لذلك لا يمكننا، كما ترى، النظر إلى هذه الظاهرة باستخفاف، عندما تتجلى على نطاق واسع للغاية؛ يصبح غير صحي بشكل صحيح، في حين أن تطبيق هذه القوى الغريزية للتدمير في العالم الخارجي يريح الكائن الحي ويجب أن يكون له عمل مفيد. يمكن أن يكون بمثابة ذريعة بيولوجية لجميع الإدمان البغيض والخطير الذي نكافح ضده. لذلك علينا أن نعترف بأنها أقرب إلى الطبيعة من مقاومتنا لها والتي ما زلنا بحاجة إلى إيجاد تفسير لها. ربما تشعر أن نظرياتنا هي نوع من الأساطير التي، في هذه الحالة، ليست مريحة. لكن ألا ينزل كل العلم إلى هذا النوع من الأساطير؟ هل هو مختلف بالنسبة لك في مجال الفيزياء؟
هذا يسمح لنا أن نستنتج، بالعودة إلى موضوعنا، أنه سيكون من غير المجدي أن ندعي قمع الميول المدمرة للرجال. في الأراضي السعيدة على الأرض، حيث تقدم الطبيعة بوفرة كل ما يحتاجه الإنسان، يجب أن تكون هناك شعوب تتدفق حياتها بسلاسة ولا تعرف أي قيود أو عدوان. بالكاد أستطيع تصديق ذلك وسأكون سعيدًا بمعرفة المزيد عن هذه الكائنات المباركة. يأمل البلاشفة أيضًا في النجاح في قمع العدوان البشري من خلال ضمان إشباع الحاجات المادية مع تحقيق المساواة بين المستفيدين من المجتمع. أعتقد أن هذا مجرد وهم. إنهم، في الوقت الحالي، مسلحون بعناية، والكراهية التي يحملونها تجاه كل من ليس منهم ليست أدنى مساعدة في تأمين تماسك أنصارهم. علاوة على ذلك، كما أشرت أنت نفسك، لا يتعلق الأمر بقمع ميل الإنسان للعدوان؛ يمكن للمرء أن يحاول توجيهه حتى لا يجد طريقة تعبيره في الحرب.
بدءًا من قوانيننا الأسطورية الخاصة بالفطرة، نصل بسهولة إلى صيغة تمهد الطريق بشكل غير مباشر لمحاربة الحرب. إذا كان الميل إلى الحرب هو نتاج الدافع الهدام، فمن المناسب إذن أن نناشد خصم هذا الميل، إلى الأيروس. أي شيء يولد أواصر المشاعر بين الرجال يجب أن يكون رد فعل ضد الحرب. يمكن أن تكون هذه الروابط من نوعين. في المقام الأول، العلاقات مثل تلك التي تتعلق بموضوع الحب، حتى بدون نوايا جنسية. لا يجب أن يخجل التحليل النفسي من الحديث عن الحب، في هذه الحالة، لأن الدين يستخدم نفس اللغة: أحب قريبك كنفسك. التزام يسهل النطق به ولكن يصعب الوفاء به. الفئة الثانية من الروابط العاطفية هي تلك التي تنطلق من الهوية. يقع على عاتقهم جزء كبير من صرح المجتمع البشري.
أجد ، في انتقادك لإساءة استخدام السلطة ، مؤشرًا ثانيًا للنضال غير المباشر ضد الميل إلى الحرب. هذا هو أحد وجوه عدم المساواة البشرية - عدم المساواة المحلية التي لا يمكن مكافحتها - من يشاء ، هذا التقسيم إلى قادة ورعايا. ويشكل الأخيرون الأغلبية العظمى ؛ يحتاجون إلى سلطة لاتخاذ قرارات نيابة عنهم والتي يصادقون عليها دائمًا دون تحفظات. ينبغي ملاحظة، في سياق الأفكار هذه، أنه ينبغي على المرء أن يسعى، أفضل مما تم القيام به حتى الآن، لتدريب فئة عليا من المفكرين المستقلين، من الرجال الذين لا يمكن الوصول إليهم. للترهيب والمدمنين على البحث عن الحقيقة، الذين سيتولون قيادة جماهير خالية من المبادرة. أن الإمبراطورية التي استولت عليها سلطات الدولة وتحريم الفكر الكنسي لا تصلح لمثل هذا التدريب، فلا داعي لإثبات ذلك. من الطبيعي أن تكون الحالة المثالية في مجتمع من الرجال الذين أخضعوا حياتهم الغريزية لديكتاتورية العقل. لا شيء يمكن أن يخلق مثل هذا الاتحاد المثالي والمرن بين البشر، حتى لو اضطروا إلى التخلي عن روابط المشاعر البعض تجاه البعض الآخر.
ولكن هناك فرصة كبيرة في أن يكون هذا أملًا خياليًا. إن الطرق والوسائل الأخرى لمنع الحرب هي بالتأكيد أكثر عملية، لكنها لا تستطيع الاعتماد على النجاحات السريعة. من الصعب تخيل مطاحن تطحن ببطء شديد بحيث يكون لديك وقت للتجويع قبل الحصول على الدقيق. كما ترى، لم نحقق تقدمًا كبيرًا في الرغبة في استشارة المنظرين من خارج العالم عندما يتعلق الأمر بالمهام العملية والعاجلة. سيكون من الأفضل السعي، في كل حالة على حدة، لمواجهة الخطر بالوسائل المتاحة. ومع ذلك، أود التعامل مع مشكلة أخرى لم تثرها في رسالتك والتي تهمني بشكل خاص. لماذا نقف بقوة ضد الحرب، أنت وأنا والعديد من الآخرين معنا، لماذا لا نأخذ جانبنا كواحد من تقلبات الحياة التي لا تعد ولا تحصى؟ ومع ذلك، يبدو أنه يتوافق مع الطبيعة، وهو قائم على أساس بيولوجي للغاية، وعمليًا، لا مفر منه تقريبًا. لا تصدم من السؤال الذي أطرحه هنا. لأغراض التحقيق، ربما يكون من الجائز تخيل قناع السكون الذي لا يكاد يكون في الواقع. وستكون هذه هي الإجابة: لأن لكل إنسان حق في حياته، لأن الحرب تدمر حياة الإنسان المحملة بالوعود، وتضع الفرد في مواقف تسيء إليه، وتجبره على قتل جاره ضده إرادته، تدمر القيم المادية الثمينة، منتجات النشاط البشري، إلخ. سنضيف أيضًا أن الحرب، في شكلها الحالي، لم تعد تعطي أي فرصة لإظهار المثل الأعلى القديم للبطولة وأن حرب الغد، نتيجة لتحسين أدوات التدمير، ستكون بمثابة إبادة أحد المعارضين، أو ربما كلاهما.
كل هذا صحيح، ويبدو أنه لا جدال فيه لدرجة أن المرء يتحول إلى دهشة من أن اتفاقًا بالإجماع بين البشر لم يحظر الحرب بعد. من الواضح أنه يمكننا مناقشة واحدة أو أخرى من هذه النقاط ونسأل، على سبيل المثال، ما إذا كان يجب ألا يكون للمجتمع المحلي أيضًا حق في حياة الفرد؛ لا يمكننا إدانة كل بذور الحرب بنفس الطريقة. طالما أن هناك إمبراطوريات وأمم عازمة على إنهاء حكم الآخرين دون رحمة، يجب أن تكون هذه الدول الأخرى مجهزة للحرب. لكن لا يسعنا الانتظار حتى نتجاوز كل هذه القضايا، فهذه ليست المناقشة التي كنت تنوي المشاركة فيها. أريد أن أصل إلى شيء آخر. أعتقد أن السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتحدث ضد الحرب هو أننا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك. نحن دعاة سلام، لأننا يجب أن نكون بحكم دوافع عضوية. أصبح من السهل علينا الآن تبرير موقفنا بالحجج.
هذا ليس بدون تفسير. وهذا ما أضيفه منذ الأزل، فالإنسانية تمر بظاهرة تطور الثقافة. (بعض الناس يفضلون، كما أعلم، استخدام مصطلح الحضارة هنا). لهذه الظاهرة نحن مدينون بأفضل ما نتكون منه والكثير مما نعاني منه. أسبابه وأصوله غامضة، ونتائجه غير مؤكدة، وبعض خصائصه يمكن تمييزها بسهولة. ربما يؤدي إلى انقراض الجنس البشري، لأنه يضر في أكثر من جانب بالوظيفة الجنسية، وفي الوقت الحالي تزداد الأجناس غير المزروعة والطبقات المتخلفة من السكان بنسب أكبر من الفئات المكررة. ربما ينبغي أيضًا مقارنة هذه الظاهرة بتدجين أنواع حيوانية معينة؛ لا يمكن إنكار أنه يسبب تغيرات جسدية؛ نحن لسنا على دراية بفكرة أن تطور الثقافة يمكن أن يكون ظاهرة عضوية. التحولات النفسية التي تصاحب ظاهرة الثقافة واضحة لا لبس فيها. وهي تتكون من تجنب تدريجي للنهايات الغريزية، إلى جانب الحد من ردود الفعل الاندفاعية. أحاسيس مشحونة باللذة بالنسبة لأسلافنا، أصبحت غير مبالية بنا وحتى لا تطاق؛ هناك أسباب عضوية للتحول تحملنا تطلعاتنا الأخلاقية والجمالية. من بين الخصائص النفسية للثقافة، هناك سمتان يبدو أنهما الأكثر أهمية: تقوية الفكر الذي يميل إلى التحكم في الحياة الغريزية، والرجوع الداخلي للميل العدواني، بكل ما يترتب عليه من نتائج إيجابية ومواتية. خطير. والآن نجد أن المفاهيم النفسية التي يقودنا إليها تطور الثقافة تتأثر بشدة بالحرب، ولهذا السبب يجب أن ننهض ضدها؛ لا يمكننا أخذها على الإطلاق؛ إنها ليست مجرد اشمئزاز فكري وعاطفي، ولكن في الواقع، بيننا من دعاة السلام، تعصب دستوري، وخصوصية بطريقة ما تتضخم إلى أقصى الحدود. ويبدو أن الانحطاط الجمالي للحرب لا يعول كثيرًا، في سخطنا، على الفظائع التي تثيرها.
والآن، كم من الوقت سيستغرق الآخرون ليصبحوا من دعاة السلام بدورهم؟ لا يمكننا أن نقول ذلك، لكن ربما ليس من المثالية أن نأمل في عمل هذين العنصرين، المفهوم الثقافي والخوف المبرر من تداعيات حريق مستقبلي ، - لوضع نهاية الحرب في المستقبل القريب. بأي مسارات أو منعطفات، لا يمكننا التخمين. في غضون ذلك، يمكننا أن نقول لأنفسنا: كل ما يعمل من أجل تطوير الثقافة يعمل أيضًا ضد الحرب.
أحييكم من صميم القلب، وإذا كان عرضي قد خيب أملك، يرجى أن تسامحني.
سيغموند فرويد."
نهاية النص
الرابط:
https://squiggle.be/PDF_Matiere/Pourquoi la guerre_Freud et Einstein.pdf
* المصدر:
المراسلات بين ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد. هذه هي النسخة المنشورة بمبادرة من المعهد الدولي للتعاون الفكري - جمعية الأمم ، في عام 1933.