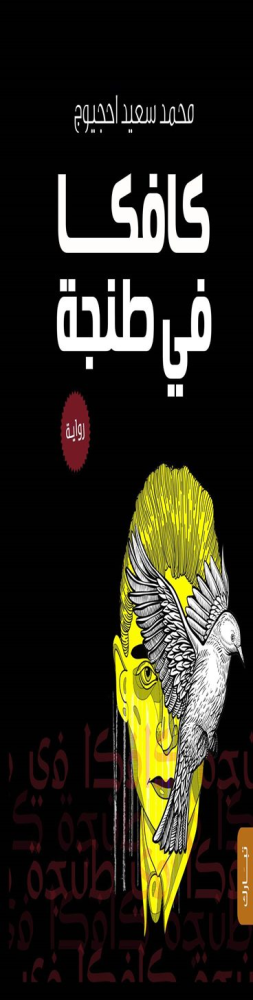في البداية تجب الإشارة إلى أن مصطلح "علمانية" ترجمة غير موفقة ل"لائيكية" laïcité . فالجذر "ع ل م" الذي بني عليه يحمله دلالة بعيدة عن دلالة مصدره الأصلي laïc التي تعني عدم الانتماء لأعضاء الكنيسة، أو laikos التي تدل على العامة في مقابل الخاصة؛ وبعيدة عن دلالته العصرية التي تعني الفصل بين الدولة والدين. وكان من الأفضل الاكتفاء ب"دنيوية" كمقابل للائيكية ولسيكولاريزم sécularisme (كما في الإنجليزية) والسياق هو الذي يحدد المجال الذي ترمز إليه: السياسي أو الاجتماعي. ولهذا فإني لن أستعمل في هذا المقال إلا مصطلح دنيوية.
مفهوم الدنيوية يصف ذلك التحول التاريخي الذي جعل الإنسانية تنتقل من وضع كان فيه الدين يلف كل جوانب الحياة إلى وضع تقلص فيه دوره وصار ينحصر في الشؤون الروحية والأخروية، على الأقل في المجتمعات الذي وصل فيها هذا المسار إلى أبعد حدوده.
ودعم هذا التحول على المستوى الفكري عاملين: كون الفتوحات العلمية صارت قادرة على إعطاء تفسير موضوعي للظواهر يعارض أحيانا التفسير الديني لها والذي التحق بالتفسير الأسطوري؛ واستقلال الأخلاق عن الدين بتأثير من المذهب الإنسي. فدنيوية الأخلاق تعني الإقرار بوجود منظومة للقيم مستقلة عن الدين، وأن الاخلاق الحسنة ليست حكرا على دين معين ولا على شعب معين. وعندما تستقل الاخلاق عن الدين فإن السياسة لا محالة تتبع.
وعلى المستوى الاجتماعي صارت النفعية (بمعناها الواسع الذي يتجاوز المذهب الذي يحمل هذا الاسم) تدريجيا هي معيار المعاملات، الأمر الذي يجعل كل القيم والعادات التي تستند إلى قواعد أخرى في موقف دفاعي. فالدنيوية تحمل قيما محايثة لها وليست محايدة. ولكونها متشبعة بالخصوصية الثقافية الغربية فإن بعض الثقافات تجد صعوبة في التكيف معها، خاصة تلك التي توجد في بداية المسار مثل المجتمعات العربية. وما يسمى بأسلمة الحداثة هو في أحد وجوهه مجرد محاولة للتكيف مع الدنيوية بأقل تكلفة نفسية.
كل هذه العوامل جعلت الدولة تستمد شرعيتها تدريجيا من الوظيفة المنوطة بها وليس من اعتبارات مفارقة: تحقيق الأمن، السهر على تطبيق القانون، التأطير الإداري، توفير الخدمات العامة... ونتج عن دنيوية الدولة مفهوم المواطن، أي الفرد الذي تجمعه مع الأخرين علاقة الانتماء لوطن واحد عوض رابطة العرق أو الدم أو الدين.
إلا أن الانتقال من الشرعية القديمة القائمة على أسس دينية إلى الشرعية الجديدة حمل السمات التاريخية الخاصة بكل بلد. وهذا يعطينا طيفا من الدنيويات يتدرج من أكثرها صداما مع الدين إلى التي تضمن حياد الدولة وحرية المعتقد مع الحفاظ على مسحة دينية رمزية؛ وبجانبها دول لها دين دولة وهي بدورها متفاوتة في درجة هيمنة الدين على الحياة العامة.
على المستوى التاريخي، طرحت الدنيوية كمبدأ مؤسس في الثورتين الأمريكية والفرنسية. إلا أن هناك اختلافا معتبرا بين المقاربتين:
النموذج الأمريكي يعطي الأسبقية للحرية. ورغم أن هذا النموذج ينتمي إلى قارة "جديدة" إلا أنه متأثر بالتجربة الأوروبية، منها الدروس المستخلصة من الحروب الدينية والتي تتلخص في عدة مبادئ: التسامح الديني وحرية المعتقد والتعبير التي لا يضمنها إلا حياد الدولة. هذا لا يعني أن الدين ليس له تأثير، فوزنه في الحياة العامة كبير لكنه يمارس من خلال المؤسسات السياسية وليس كمرجعية مفروضة على الدولة. وكانت الحياة الدينية عند استقلال البلد عن بريطانيا تتميز بتعايش طوائف مسيحية، غالبيها بروتستانتية، ما أعطى تجانسا دينيا للبلد.
النموذج الفرنسي حكمه منذ البداية هاجس تحجيم دور الكنيسة الكاثوليكية بصفتها مؤسسة مهيمنة وقوية في مجالات حيوية مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والملكية العقارية. وكانت من الناحية الأيديولوجية الركيزة الأساس للقوى المحافظة التي تصطدم بها القوى السياسية المنافسة. فكان الصراع ضد اليمين السياسي صراعا ضد الكنيسة أيضا. وهذا التشنج في العلاقة مع الدين مازال يطبع الدنيوية الفرنسية إلى اليوم، ولأنها ترى حياد الدولة في منع موظفي المصالح العمومية من التعبير عن انتماءاتهم الدينية فإنها تحد من حريتهم الروحية. وهذا الحد يعاني منه أكثر المواطنون الذين لا ينتمون إلى الديانة الكاثوليكية. فرغم الكونية التي تدعيها الدنيوية الفرنسية إلا أنها متشبعة بالخصوصيات الثقافية للمجتمع الذي ما زال يحمل آثار قرون من الهيمنة الكاثوليكية، ويتجلى ذلك في كون التنظيم الإداري يلائم الشعائر الكاثوليكية؛ فيوم العطلة الأسبوعية هو الأحد والأعياد الكاثوليكية معطلة، والمدارس الكاثوليكية ممولة من قبل الدولة، وحتى المطاعم الجماعية تقدم السمك يوم الجمعة (وهو تقليد كاثوليكي). في حين أن أتباع الديانات الأخرى يجدون صعوبة في التوفيق بين شعائر ديانتهم وحياتهم المهنية. ما يجعل المسلم أو اليهودي في حالة "ذمية"، فهو مقبول بشرط ألا يفصح عن هويته الدينية أكثر من اللزوم. مع الإشارة إلى أن الخلاف في البداية بين الكنيسة ومعارضيها كان في الأساس سياسي وليس مجتمعي، فباستثناء مسألة الطلاق لم يكن هناك خلاف جوهري في القيم الاجتماعية بين الطرفين. يشهد على ذلك وضع المرأة التي لم تحصل على حق الانتخاب إلا في سنة 1944، وعلى الحق في العمل وفتح حساب بنكي دون رخصة زوجها إلا في 1965، والحق في استعمال موانع الحمل والاجهاض في السبعينات؛ ولم يلغ القانون الذي يمنعها من لبس البنطلون إلا في سنة 2012 (هذا يعني ان تقنين لباس المرأة ليس حكرا لثقافة دون غيرها). كل هذا بعد أجيال من الحكم الدنيوي للبلد.1
لكن الدنيوية، كبند دستوري، ليست شرطا لقيام نظام ديموقراطي تشهد على ذلك الدول الديموقراطية الأخرى التي لم تضمن قوانينها الأساسية هذا المبدأ إلا بعد أن تشبعت به كل جوانب الحياة. أو التي تمنح للملك دورا دينيا (بريطانيا) أو التي أبقت على رباط رمزي مع دين معين (إيطاليا ودول كاثوليكية أخرى مع الفاتيكان) ... لكن حرية المعتقد مضمونة فيها بشكل عام. وإن كان من بينها دول تحد من إمكانية البروز في الفضاء العام لدين ما (سويسرا التي يمنع فيها بناء الصوامع إثر استفتاء شعبي والتي لم تمنح حق الانتخاب للنساء إلا في سنة 1971).
النموذج الهندي يتميز عن غيره من الأنظمة الدنيوية بكونه لا يفرض قوانين موحدة فيما يخص الأحوال الشخصية فهو يعطي لأتباع كل دين حرية الاحتكام لشرائعهم.
الأمثلة السابقة هي لدول ديموقراطية، أما الأمثلة التالية فهي لدول تشكل فيها الدنيوية ركيزة لنظام غير ديموقراطي.
النموذج التركي ومحركه هو الوطنية وهوس التحديث، بمعنى التغريب؛ وإعادة تشكيل هوية تركية جديدة على أساس عرقي توراني، ومنسلخة عن "الشرق" بالمعنى الثقافي والمظهري والرمزي وليس الديني فحسب، مع كبت وقمع للأقليات المحلية دينية كانت أو لغوية. وكانت تركيا أثناء حرب التحرير في الجزائر تصوت دائما لصالح فرنسا (اعتذرت رسميا عن ذلك للجزائر سنة 1984). ومن خصائص الدنيوية التركية أن الدولة مستقلة عن الدين لكن العكس غير صحيح. وفرضت الدنيوية الاجتماعية من فوق. وكان الضامن لهذا النظام هو الجيش وليس المؤسسات الديموقراطية.
النموذج البورقيبي، رغم أنه ليس دنيويا بصريح النص الدستوري، إلا أنه قريب من النموذج التركي ولكنه لم يغال في مسألة الانسلاخ عن الانتماء العربي الإسلامي، بل حاول أن يجد غطاء دينيا لمشروعه الذي اعتبره جهادا في سبيل التنمية. وأقصى ما ذهب إليه من الناحية الدستورية هو اعتبار الإسلام دين البلد وليس دين الدولة (وهو بند احتفظ به مشروع الدستور الجديد). وفيما يخص حقوق المرأة بقيت حصتها في الإرث كما هي عليها في الشريعة. لكن سياسة بورقيبة التحديثية، وريثة خير الدين والحداد، وضعته ضمن الدنيويين. واعتبر بعض المثقفين التونسيين شربه لكأس من العصير في شهر رمضان مباشرة على شاشة التلفزيون حدثا فاصلا ومؤسسا في تاريخ الدنيوية العربية.
إلحاد الدولة، وهذا في الواقع ليس مجرد فصل بين للدين والدولة بل إخضاع الدولة ل"دين" جديد لا يحتمل "الشرك". وقد وصل الأمر في بعض الأنظمة الملحدة إلى حد منع الدين، كما حدث في البانيا سنة 1967.
عرضت لهذه النماذج لإبراز الفوارق التي تكمن تحت نعت واحد. لكن هذه النماذج لا تستغرق كل الدنيوية، فهذا التحول التاريخي عم اليوم كل بلدان العالم بدرجات متفاوتة، وانحصرت المسألة الدينية في المجال السياسي في بضع مواضيع: هوية الدولة، الأحوال الشخصية، وضع الأقليات الدينية، زيادة على مسألة الشريعة في الإسلام.
هوية الدولة. عندما ننظر إلى قائمة الدول التي لها دين دولة نلاحظ أن غالبيها دول إسلامية. فما هو السر في ذلك؟ وهل لأن الإسلام "دين ودنيا" كما يكرر البعض.2
الادعاء الأخير مردود لأن كل دين (أو أيديولوجيا)، عندما يهيمن في مجتمع ما فإن هيمنته تشمل كل الأبعاد، الروحية منها والدنيوية. والدولة لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلا من الثقافة السائدة فيها. وإن كانت هناك حالات شاذة تتمثل في بعض الأنظمة التي فرضتها نخبة مثقفنة acculturée من فوق (وبعضها، إن لم يكن جلها، كان تجارب كارثية). خاصية الدول الإسلامية هذه لها أسباب تاريخية ونفسية إذ يمكن أن نرجعها إلى البعد الطائفي الشامل méga-communautarisme في الإسلام المعاصر (حسب غسان سلامة الذي يرى ان الرابطة الأقوى في الإسلام ليست تلك التي تربط عموديا الانسان بالمتعالي بل تلك التي تربط أفقيا أعضاء الأمة بعضهم ببعض، فلا تترك مجالا للحرية الفردية)3. أي أن الإسلام صار مؤشرا هوياتيا ومكون أساسي في الهوية الذاتية، فهو إسلام عاطفي نجده حتى عند الغير متدينين. ويمكن أن نلاحظ هذا في موقف اليسار العربي – بما فيه الشيوعي-من الدين، فرغم أن مرجعيته مادية إلا أنه تجنب الصراع مع الدين، سياسيا وفكريا. البعض فسر ذلك برغبة المناضلين في عدم الانفصال عن الشعب المتدين، لكن ليس إلا.... وبما أن الهوية تتحدد بالعلاقة مع الآخر، فيمكن أن نفسر هذا التقوقع على الذات بالشعور بالحصار الذي يعاني منه المسلم.
الأحوال الشخصية. يلاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية في كل البلدان هي أكثر القوانين مقاومة للتغيير، بحيث أنها شكلت بؤرا من المحافظة حتى في أكثر المجتمعات اندماجا في الحضارة العصرية. لكنها تمثل بالنسبة لفئة من نخب البلدان التي تعتبر نفسها متخلفة البعد الذي يجب تحريكه باستعجال، في مستوييه الواقعي والرمزي، لتتحرك كل الأبعاد الأخرى. إلا أن التجارب التي ركزت على هذا البعد لم تذهب بعيدا، فالتغيير بقي سطحيا وعندما ارتفع الضغط على المجتمع طفح المكبوت. وهكذا عاد الألباني "الملحد" بقرار سياسي إلى "قانونه" (أعراف تقوم على الثأر).
وتغيير قوانين الأحوال الشخصية إما يتم بشكل فوقي متعسف، وهذا لا يجوز في نظام ديموقراطي؛ وإما أنه يخضع للإجراءات الديموقراطية وهو بذلك يستجيب لإرادة الشعب، وهذا يعني أن القانون عدل ليوافق الأعراف الجديدة. وكثير من القوانين الدينية نفلت لأنها فقدت مفعولها في المجتمع أو اختفى موضوعها. حتى قوانين الإرث مقبلة على التغيير لأن الواقع الاقتصادي الذي كان يعلل حرمان الأنثى منه (العرف) أو يعطيها النصف (الشريعة) تغير، ولا محالة أن تتبع القوانين. وسنجد آنذاك من "سيجتهد" ليسوغ شرعيا ذلك.
وضع الأقليات. الأقلية عندما لا تعيش في غيتو (ملاح)، هو وطنها الصغير الذي تملأه بخصوصياتها ورموزها الثقافية، فإنها تجد نفسها في مواجهة عالم الأغلبية الذي يمنحها نسبة ما من حرية التعبير عن ذاتها. ورغم اتساع رقعة الدنيوية الاجتماعية وخضوع نسبة كبيرة من المواطنين لمعاييرها، إلا أن ثقل التاريخ ما زال يخيم على العلاقة بين الأديان حتى بالنسبة لأفراد تخلوا عن الممارسة الدينية أو لا دينيين. ولحد الساعة ليس لدينا العمق التاريخي الكافي للحكم على ما ستؤول إليه الأنظمة الدنيوية الحديثة. فقد عرف العالم نظامين لسياسة الأقليات: الأول يترك للأقلية حق تسيير أحوالها الشخصية(الإسلام)؛ والثاني يقوم على مبدأ "الشعوب على دين أمرائها"، الذي عرفته أوروبا إثر الحروب الدينية التي أعقبت حركة الإصلاح (أو الملك على دين شعبه، كما حدث لهنري الرابع الذي ارتد عن البروتستانتية لاعتلاء عرش فرنسا). فباستثناء الهند، تميل الأنظمة الدنيوية إلى مبدأ فرض قانون الأغلبية، أي أن الشعوب صارت على دين أغلبيتها الذي بشكل الوجه الحديث "للشعوب على دين أمرائها". لكن وجود قوانين دنيوية في الأحوال الشخصية يسهل العلاقات بين الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة، ولا يبقى كل فرد سجين دينه أو طائفته.
تطبيق الشريعة في البلدان الإسلامية، ومن قبل الأقليات المسلمة، صار البعبع الذي يهش به البعض لإفزاع الذين يجهلون او يتجاهلون ما هو مطبق فعلا في غالبية الدول الإسلامية. فإذا كان التدين حاضرا بقوة في هذه البلدان فهذا لا يعني أن الدول الإسلامية، عدا السعودية وإيران، ثيوقراطيات (مع فرق شاسع بين النظامين). لأنه إذا استثنينا بعض قوانين الأحوال الشخصية فإن باقي القوانين وضعية، بل مستمدة من الخارج. وبما ان جل حكومات الدول الإسلامية جمهوريات فإنها لا تحتاج، ولا تستطيع، أن تستند إلى حق إلهي بل وضعي: شرعية النضال ضد الاستعمار، الشرعية الثورية، الشرعية الانتخابية...
والمغرب؟ ما قلته عن الدول الإسلامية يصح أيضا على المغرب الذي تكمن خصوصيته في كون الملك شريفا وأميرا للمؤمنين، وهما أساسان للشرعية السياسية التقليدية في المغرب. والدساتير السابقة زادت على ذلك أن "شخص الملك مقدس ولا يجوز انتهاك حرمته" وهو بند مستمد من الدساتير الملكية الفرنسية. أما تطبيق الشريعة فقد كان محل نقاش بين العلماء منذ الدولة السعدية، وقد أفتى بعضهم بجواز العقوبة بالمال عوض الحدود، مشرعا بذلك الأعراف المعمول بها في المجتمع (لطفي بوشنتوف: العالم والسلطان). لكن هذا لا يكفي ليجعل من المغرب دولة ثيوقراطية.
نستنتج مما عرضناه أنه لا يمكن اختزال الدنيوية في نموذج واحد. وأن دنيوية الدولة ليست شرطا للديموقراطية، إذا كان هذا هو الهدف. بل العكس، يمكن ان تكون مطية للتعسف. وتحت ستار حداثة وتغريب سطحيين تعطي نفسا جديدا لاستبداد "شرقي" (صدام حسين والدولة الأسدية يحسبان على الدنيوية). وإذا كان الغرض هو بناء نظام ديموقراطي، التي هي حكم الشعب بنفسه، فإن القوانين المعمول بها هي التي يصادق عليها ممثلو الشعب. وهذه القوانين قد تكون مطابقة للدين أو قد لا تكون، مراعية لحقوق الأقليات أو لا (مهما كانت طبيعة الأقلية: دينية، لغوية، جنسية). وهذا أيضا يبين حدود الديموقراطية التي قد تتحول إلى تعسف للأغلبية، أو لأقلية نافذة (نصف النواب الأمريكيين مليونيرات، فأي شعب يمثلون؟).
يبقى أن نطرح سؤالا نظريا أساسيا: فعندما تطرح مسألة فصل الدين عن الدولة، فماذا يفصل بالضبط؟
الأمر واضح عندما يكون الدين ممثلا في مؤسسة مهيكلة مثل الكنيسة الكاثوليكية. لكن كيف يمكن فصل الدين كثقافة وقيم؟ وحتى لو منعت الأحزاب ذات المرجعية الدينية (بأي حق في نظام ديموقراطي؟) فهل هذا يمنع القيم الدينية من اختراق الأحزاب الأخرى؟ ولنفترض أن الناخبين وافقوا، في استفتاء بمبادرة شعبية، على قانون ذي مرجعية دينية (قطع يد السارق مثلا)، فهل ترفض نتيجة الاستفتاء، وعلى أي أساس ما دام الشعب مصدر السلطة في الديموقراطية؟
وعندما نتأمل في مسألة القيم ندرك أن هناك قيما دينية (هي غالبا طقوس) أو أخلاقية بحتة، لكن هناك قيم هجينة. فرفض الإجهاض يمكن أن يكون لوازع ديني أو أخلافي، أو هما معا. لأن السؤال هو: متى تبدأ الحياة؟ وإذا كان المبدأ هو حق المرأة في التصرف بحرية في جسدها، فهل هذا يعطيها حق الحياة أو الموت على جنينها، ولما لا طفلها؟
والأمر سواء فيما يخص الأفكار، إذ توجد أفكار هجينة. فما الفرق بين موقف الإمامة الكبرى الذي يقضي بعدم جواز الثورة على الحاكم إلا إذا كفر (وهذا لا ينطبق في تاريخ الإسلام إلا على الملك الماغولي أكبر) لأن الظلم أهون من الفتنة؛ وبين موقف هوبس الذي يرى ان الناس تنازلوا عن حريتهم الطبيعية لحاكم مستبد مقابل السلم الذي يضمن لهم؟ فالهاجس الأساس لكلا الموقفين هو الاستقرار (هوبس يخطئ الرأي القائل: "لتكن العدالة ويفنى العالم")، رغم اختلاف المرجعية الفكرية للرأيين. كما أن بعض شروط الإمامة (الكفاءة والعدل) ليست دينية محضة.
لقد كان القصد من الدنيوية السياسية تحقيق مبدأين: التسامح، الذي يعني القبول بكل الأفكار والمذاهب والديانات؛ والمساواة بينها، الناتجة عن المبدأ السابق، بغاية التعايش السلمي بين المواطنين. لكن البعض فهمها بمنطق إقصائي، وصيرها بذلك أيديولوجية من بين الايديولوجيات المتصارعة.
وللخروج من تعسف الأغلبية الديموقراطية والدنيوية الأيديولوجية يجب الاحتكام إلى مبدأ: حرية الشخص تنتهي عند بداية حرية الآخرين. فهذا مبدأ كلي يسمح بتعايش المذاهب الفكرية والثقافات فيما بينها، بغض النظر عن المحتوى لأنه يعكس التعدد والاختلاف الملازمين للثقافات الإنسانية.
1- الحقيقة ما حرر المرأة هو العمل المأجور الذي أعطاها الاستقلالية المادية والطب الحديث الذي مكنها من التحكم في الانجاب.
2- هناك رأي يدعي أن المسيحية هي التي أسست للدنيوية السياسية لأنه ورد في الانجيل: اعط لله ما هو لله ولقيصر ما هو لقيصر. والأمر يتعلق بالضرائب وليس بالسياسة. وحتى لو سلمنا أن المقصود سياسي، فكيف نفسر القرون التي تحكمت فيها المسيحية في الشرعية السياسية؟ وهو أمر طبيعي لأن الشرعية تستند إلى الثقافة السائدة. والأمر سواء في الإسلام، والدليل على ذلك "السهولة" التي نسف بها علي عبد الرازق السياسة الشرعية، مبينا أن سندها في القرآن والسنة هزيل.
3- أتفق جزئيا فقط مع أطروحة غسان سلامة، لأنه يبالغ إلى درجة نفي صفة الدين عن الإسلام (الدين كعلاقة أولية مع الله) لأن العلاقة الأولية في الإسلام هي التي تربط أفراد الأمة بينهم، ما يعيق انعتاق الفرد.
مفهوم الدنيوية يصف ذلك التحول التاريخي الذي جعل الإنسانية تنتقل من وضع كان فيه الدين يلف كل جوانب الحياة إلى وضع تقلص فيه دوره وصار ينحصر في الشؤون الروحية والأخروية، على الأقل في المجتمعات الذي وصل فيها هذا المسار إلى أبعد حدوده.
ودعم هذا التحول على المستوى الفكري عاملين: كون الفتوحات العلمية صارت قادرة على إعطاء تفسير موضوعي للظواهر يعارض أحيانا التفسير الديني لها والذي التحق بالتفسير الأسطوري؛ واستقلال الأخلاق عن الدين بتأثير من المذهب الإنسي. فدنيوية الأخلاق تعني الإقرار بوجود منظومة للقيم مستقلة عن الدين، وأن الاخلاق الحسنة ليست حكرا على دين معين ولا على شعب معين. وعندما تستقل الاخلاق عن الدين فإن السياسة لا محالة تتبع.
وعلى المستوى الاجتماعي صارت النفعية (بمعناها الواسع الذي يتجاوز المذهب الذي يحمل هذا الاسم) تدريجيا هي معيار المعاملات، الأمر الذي يجعل كل القيم والعادات التي تستند إلى قواعد أخرى في موقف دفاعي. فالدنيوية تحمل قيما محايثة لها وليست محايدة. ولكونها متشبعة بالخصوصية الثقافية الغربية فإن بعض الثقافات تجد صعوبة في التكيف معها، خاصة تلك التي توجد في بداية المسار مثل المجتمعات العربية. وما يسمى بأسلمة الحداثة هو في أحد وجوهه مجرد محاولة للتكيف مع الدنيوية بأقل تكلفة نفسية.
كل هذه العوامل جعلت الدولة تستمد شرعيتها تدريجيا من الوظيفة المنوطة بها وليس من اعتبارات مفارقة: تحقيق الأمن، السهر على تطبيق القانون، التأطير الإداري، توفير الخدمات العامة... ونتج عن دنيوية الدولة مفهوم المواطن، أي الفرد الذي تجمعه مع الأخرين علاقة الانتماء لوطن واحد عوض رابطة العرق أو الدم أو الدين.
إلا أن الانتقال من الشرعية القديمة القائمة على أسس دينية إلى الشرعية الجديدة حمل السمات التاريخية الخاصة بكل بلد. وهذا يعطينا طيفا من الدنيويات يتدرج من أكثرها صداما مع الدين إلى التي تضمن حياد الدولة وحرية المعتقد مع الحفاظ على مسحة دينية رمزية؛ وبجانبها دول لها دين دولة وهي بدورها متفاوتة في درجة هيمنة الدين على الحياة العامة.
على المستوى التاريخي، طرحت الدنيوية كمبدأ مؤسس في الثورتين الأمريكية والفرنسية. إلا أن هناك اختلافا معتبرا بين المقاربتين:
النموذج الأمريكي يعطي الأسبقية للحرية. ورغم أن هذا النموذج ينتمي إلى قارة "جديدة" إلا أنه متأثر بالتجربة الأوروبية، منها الدروس المستخلصة من الحروب الدينية والتي تتلخص في عدة مبادئ: التسامح الديني وحرية المعتقد والتعبير التي لا يضمنها إلا حياد الدولة. هذا لا يعني أن الدين ليس له تأثير، فوزنه في الحياة العامة كبير لكنه يمارس من خلال المؤسسات السياسية وليس كمرجعية مفروضة على الدولة. وكانت الحياة الدينية عند استقلال البلد عن بريطانيا تتميز بتعايش طوائف مسيحية، غالبيها بروتستانتية، ما أعطى تجانسا دينيا للبلد.
النموذج الفرنسي حكمه منذ البداية هاجس تحجيم دور الكنيسة الكاثوليكية بصفتها مؤسسة مهيمنة وقوية في مجالات حيوية مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والملكية العقارية. وكانت من الناحية الأيديولوجية الركيزة الأساس للقوى المحافظة التي تصطدم بها القوى السياسية المنافسة. فكان الصراع ضد اليمين السياسي صراعا ضد الكنيسة أيضا. وهذا التشنج في العلاقة مع الدين مازال يطبع الدنيوية الفرنسية إلى اليوم، ولأنها ترى حياد الدولة في منع موظفي المصالح العمومية من التعبير عن انتماءاتهم الدينية فإنها تحد من حريتهم الروحية. وهذا الحد يعاني منه أكثر المواطنون الذين لا ينتمون إلى الديانة الكاثوليكية. فرغم الكونية التي تدعيها الدنيوية الفرنسية إلا أنها متشبعة بالخصوصيات الثقافية للمجتمع الذي ما زال يحمل آثار قرون من الهيمنة الكاثوليكية، ويتجلى ذلك في كون التنظيم الإداري يلائم الشعائر الكاثوليكية؛ فيوم العطلة الأسبوعية هو الأحد والأعياد الكاثوليكية معطلة، والمدارس الكاثوليكية ممولة من قبل الدولة، وحتى المطاعم الجماعية تقدم السمك يوم الجمعة (وهو تقليد كاثوليكي). في حين أن أتباع الديانات الأخرى يجدون صعوبة في التوفيق بين شعائر ديانتهم وحياتهم المهنية. ما يجعل المسلم أو اليهودي في حالة "ذمية"، فهو مقبول بشرط ألا يفصح عن هويته الدينية أكثر من اللزوم. مع الإشارة إلى أن الخلاف في البداية بين الكنيسة ومعارضيها كان في الأساس سياسي وليس مجتمعي، فباستثناء مسألة الطلاق لم يكن هناك خلاف جوهري في القيم الاجتماعية بين الطرفين. يشهد على ذلك وضع المرأة التي لم تحصل على حق الانتخاب إلا في سنة 1944، وعلى الحق في العمل وفتح حساب بنكي دون رخصة زوجها إلا في 1965، والحق في استعمال موانع الحمل والاجهاض في السبعينات؛ ولم يلغ القانون الذي يمنعها من لبس البنطلون إلا في سنة 2012 (هذا يعني ان تقنين لباس المرأة ليس حكرا لثقافة دون غيرها). كل هذا بعد أجيال من الحكم الدنيوي للبلد.1
لكن الدنيوية، كبند دستوري، ليست شرطا لقيام نظام ديموقراطي تشهد على ذلك الدول الديموقراطية الأخرى التي لم تضمن قوانينها الأساسية هذا المبدأ إلا بعد أن تشبعت به كل جوانب الحياة. أو التي تمنح للملك دورا دينيا (بريطانيا) أو التي أبقت على رباط رمزي مع دين معين (إيطاليا ودول كاثوليكية أخرى مع الفاتيكان) ... لكن حرية المعتقد مضمونة فيها بشكل عام. وإن كان من بينها دول تحد من إمكانية البروز في الفضاء العام لدين ما (سويسرا التي يمنع فيها بناء الصوامع إثر استفتاء شعبي والتي لم تمنح حق الانتخاب للنساء إلا في سنة 1971).
النموذج الهندي يتميز عن غيره من الأنظمة الدنيوية بكونه لا يفرض قوانين موحدة فيما يخص الأحوال الشخصية فهو يعطي لأتباع كل دين حرية الاحتكام لشرائعهم.
الأمثلة السابقة هي لدول ديموقراطية، أما الأمثلة التالية فهي لدول تشكل فيها الدنيوية ركيزة لنظام غير ديموقراطي.
النموذج التركي ومحركه هو الوطنية وهوس التحديث، بمعنى التغريب؛ وإعادة تشكيل هوية تركية جديدة على أساس عرقي توراني، ومنسلخة عن "الشرق" بالمعنى الثقافي والمظهري والرمزي وليس الديني فحسب، مع كبت وقمع للأقليات المحلية دينية كانت أو لغوية. وكانت تركيا أثناء حرب التحرير في الجزائر تصوت دائما لصالح فرنسا (اعتذرت رسميا عن ذلك للجزائر سنة 1984). ومن خصائص الدنيوية التركية أن الدولة مستقلة عن الدين لكن العكس غير صحيح. وفرضت الدنيوية الاجتماعية من فوق. وكان الضامن لهذا النظام هو الجيش وليس المؤسسات الديموقراطية.
النموذج البورقيبي، رغم أنه ليس دنيويا بصريح النص الدستوري، إلا أنه قريب من النموذج التركي ولكنه لم يغال في مسألة الانسلاخ عن الانتماء العربي الإسلامي، بل حاول أن يجد غطاء دينيا لمشروعه الذي اعتبره جهادا في سبيل التنمية. وأقصى ما ذهب إليه من الناحية الدستورية هو اعتبار الإسلام دين البلد وليس دين الدولة (وهو بند احتفظ به مشروع الدستور الجديد). وفيما يخص حقوق المرأة بقيت حصتها في الإرث كما هي عليها في الشريعة. لكن سياسة بورقيبة التحديثية، وريثة خير الدين والحداد، وضعته ضمن الدنيويين. واعتبر بعض المثقفين التونسيين شربه لكأس من العصير في شهر رمضان مباشرة على شاشة التلفزيون حدثا فاصلا ومؤسسا في تاريخ الدنيوية العربية.
إلحاد الدولة، وهذا في الواقع ليس مجرد فصل بين للدين والدولة بل إخضاع الدولة ل"دين" جديد لا يحتمل "الشرك". وقد وصل الأمر في بعض الأنظمة الملحدة إلى حد منع الدين، كما حدث في البانيا سنة 1967.
عرضت لهذه النماذج لإبراز الفوارق التي تكمن تحت نعت واحد. لكن هذه النماذج لا تستغرق كل الدنيوية، فهذا التحول التاريخي عم اليوم كل بلدان العالم بدرجات متفاوتة، وانحصرت المسألة الدينية في المجال السياسي في بضع مواضيع: هوية الدولة، الأحوال الشخصية، وضع الأقليات الدينية، زيادة على مسألة الشريعة في الإسلام.
هوية الدولة. عندما ننظر إلى قائمة الدول التي لها دين دولة نلاحظ أن غالبيها دول إسلامية. فما هو السر في ذلك؟ وهل لأن الإسلام "دين ودنيا" كما يكرر البعض.2
الادعاء الأخير مردود لأن كل دين (أو أيديولوجيا)، عندما يهيمن في مجتمع ما فإن هيمنته تشمل كل الأبعاد، الروحية منها والدنيوية. والدولة لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلا من الثقافة السائدة فيها. وإن كانت هناك حالات شاذة تتمثل في بعض الأنظمة التي فرضتها نخبة مثقفنة acculturée من فوق (وبعضها، إن لم يكن جلها، كان تجارب كارثية). خاصية الدول الإسلامية هذه لها أسباب تاريخية ونفسية إذ يمكن أن نرجعها إلى البعد الطائفي الشامل méga-communautarisme في الإسلام المعاصر (حسب غسان سلامة الذي يرى ان الرابطة الأقوى في الإسلام ليست تلك التي تربط عموديا الانسان بالمتعالي بل تلك التي تربط أفقيا أعضاء الأمة بعضهم ببعض، فلا تترك مجالا للحرية الفردية)3. أي أن الإسلام صار مؤشرا هوياتيا ومكون أساسي في الهوية الذاتية، فهو إسلام عاطفي نجده حتى عند الغير متدينين. ويمكن أن نلاحظ هذا في موقف اليسار العربي – بما فيه الشيوعي-من الدين، فرغم أن مرجعيته مادية إلا أنه تجنب الصراع مع الدين، سياسيا وفكريا. البعض فسر ذلك برغبة المناضلين في عدم الانفصال عن الشعب المتدين، لكن ليس إلا.... وبما أن الهوية تتحدد بالعلاقة مع الآخر، فيمكن أن نفسر هذا التقوقع على الذات بالشعور بالحصار الذي يعاني منه المسلم.
الأحوال الشخصية. يلاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية في كل البلدان هي أكثر القوانين مقاومة للتغيير، بحيث أنها شكلت بؤرا من المحافظة حتى في أكثر المجتمعات اندماجا في الحضارة العصرية. لكنها تمثل بالنسبة لفئة من نخب البلدان التي تعتبر نفسها متخلفة البعد الذي يجب تحريكه باستعجال، في مستوييه الواقعي والرمزي، لتتحرك كل الأبعاد الأخرى. إلا أن التجارب التي ركزت على هذا البعد لم تذهب بعيدا، فالتغيير بقي سطحيا وعندما ارتفع الضغط على المجتمع طفح المكبوت. وهكذا عاد الألباني "الملحد" بقرار سياسي إلى "قانونه" (أعراف تقوم على الثأر).
وتغيير قوانين الأحوال الشخصية إما يتم بشكل فوقي متعسف، وهذا لا يجوز في نظام ديموقراطي؛ وإما أنه يخضع للإجراءات الديموقراطية وهو بذلك يستجيب لإرادة الشعب، وهذا يعني أن القانون عدل ليوافق الأعراف الجديدة. وكثير من القوانين الدينية نفلت لأنها فقدت مفعولها في المجتمع أو اختفى موضوعها. حتى قوانين الإرث مقبلة على التغيير لأن الواقع الاقتصادي الذي كان يعلل حرمان الأنثى منه (العرف) أو يعطيها النصف (الشريعة) تغير، ولا محالة أن تتبع القوانين. وسنجد آنذاك من "سيجتهد" ليسوغ شرعيا ذلك.
وضع الأقليات. الأقلية عندما لا تعيش في غيتو (ملاح)، هو وطنها الصغير الذي تملأه بخصوصياتها ورموزها الثقافية، فإنها تجد نفسها في مواجهة عالم الأغلبية الذي يمنحها نسبة ما من حرية التعبير عن ذاتها. ورغم اتساع رقعة الدنيوية الاجتماعية وخضوع نسبة كبيرة من المواطنين لمعاييرها، إلا أن ثقل التاريخ ما زال يخيم على العلاقة بين الأديان حتى بالنسبة لأفراد تخلوا عن الممارسة الدينية أو لا دينيين. ولحد الساعة ليس لدينا العمق التاريخي الكافي للحكم على ما ستؤول إليه الأنظمة الدنيوية الحديثة. فقد عرف العالم نظامين لسياسة الأقليات: الأول يترك للأقلية حق تسيير أحوالها الشخصية(الإسلام)؛ والثاني يقوم على مبدأ "الشعوب على دين أمرائها"، الذي عرفته أوروبا إثر الحروب الدينية التي أعقبت حركة الإصلاح (أو الملك على دين شعبه، كما حدث لهنري الرابع الذي ارتد عن البروتستانتية لاعتلاء عرش فرنسا). فباستثناء الهند، تميل الأنظمة الدنيوية إلى مبدأ فرض قانون الأغلبية، أي أن الشعوب صارت على دين أغلبيتها الذي بشكل الوجه الحديث "للشعوب على دين أمرائها". لكن وجود قوانين دنيوية في الأحوال الشخصية يسهل العلاقات بين الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة، ولا يبقى كل فرد سجين دينه أو طائفته.
تطبيق الشريعة في البلدان الإسلامية، ومن قبل الأقليات المسلمة، صار البعبع الذي يهش به البعض لإفزاع الذين يجهلون او يتجاهلون ما هو مطبق فعلا في غالبية الدول الإسلامية. فإذا كان التدين حاضرا بقوة في هذه البلدان فهذا لا يعني أن الدول الإسلامية، عدا السعودية وإيران، ثيوقراطيات (مع فرق شاسع بين النظامين). لأنه إذا استثنينا بعض قوانين الأحوال الشخصية فإن باقي القوانين وضعية، بل مستمدة من الخارج. وبما ان جل حكومات الدول الإسلامية جمهوريات فإنها لا تحتاج، ولا تستطيع، أن تستند إلى حق إلهي بل وضعي: شرعية النضال ضد الاستعمار، الشرعية الثورية، الشرعية الانتخابية...
والمغرب؟ ما قلته عن الدول الإسلامية يصح أيضا على المغرب الذي تكمن خصوصيته في كون الملك شريفا وأميرا للمؤمنين، وهما أساسان للشرعية السياسية التقليدية في المغرب. والدساتير السابقة زادت على ذلك أن "شخص الملك مقدس ولا يجوز انتهاك حرمته" وهو بند مستمد من الدساتير الملكية الفرنسية. أما تطبيق الشريعة فقد كان محل نقاش بين العلماء منذ الدولة السعدية، وقد أفتى بعضهم بجواز العقوبة بالمال عوض الحدود، مشرعا بذلك الأعراف المعمول بها في المجتمع (لطفي بوشنتوف: العالم والسلطان). لكن هذا لا يكفي ليجعل من المغرب دولة ثيوقراطية.
نستنتج مما عرضناه أنه لا يمكن اختزال الدنيوية في نموذج واحد. وأن دنيوية الدولة ليست شرطا للديموقراطية، إذا كان هذا هو الهدف. بل العكس، يمكن ان تكون مطية للتعسف. وتحت ستار حداثة وتغريب سطحيين تعطي نفسا جديدا لاستبداد "شرقي" (صدام حسين والدولة الأسدية يحسبان على الدنيوية). وإذا كان الغرض هو بناء نظام ديموقراطي، التي هي حكم الشعب بنفسه، فإن القوانين المعمول بها هي التي يصادق عليها ممثلو الشعب. وهذه القوانين قد تكون مطابقة للدين أو قد لا تكون، مراعية لحقوق الأقليات أو لا (مهما كانت طبيعة الأقلية: دينية، لغوية، جنسية). وهذا أيضا يبين حدود الديموقراطية التي قد تتحول إلى تعسف للأغلبية، أو لأقلية نافذة (نصف النواب الأمريكيين مليونيرات، فأي شعب يمثلون؟).
يبقى أن نطرح سؤالا نظريا أساسيا: فعندما تطرح مسألة فصل الدين عن الدولة، فماذا يفصل بالضبط؟
الأمر واضح عندما يكون الدين ممثلا في مؤسسة مهيكلة مثل الكنيسة الكاثوليكية. لكن كيف يمكن فصل الدين كثقافة وقيم؟ وحتى لو منعت الأحزاب ذات المرجعية الدينية (بأي حق في نظام ديموقراطي؟) فهل هذا يمنع القيم الدينية من اختراق الأحزاب الأخرى؟ ولنفترض أن الناخبين وافقوا، في استفتاء بمبادرة شعبية، على قانون ذي مرجعية دينية (قطع يد السارق مثلا)، فهل ترفض نتيجة الاستفتاء، وعلى أي أساس ما دام الشعب مصدر السلطة في الديموقراطية؟
وعندما نتأمل في مسألة القيم ندرك أن هناك قيما دينية (هي غالبا طقوس) أو أخلاقية بحتة، لكن هناك قيم هجينة. فرفض الإجهاض يمكن أن يكون لوازع ديني أو أخلافي، أو هما معا. لأن السؤال هو: متى تبدأ الحياة؟ وإذا كان المبدأ هو حق المرأة في التصرف بحرية في جسدها، فهل هذا يعطيها حق الحياة أو الموت على جنينها، ولما لا طفلها؟
والأمر سواء فيما يخص الأفكار، إذ توجد أفكار هجينة. فما الفرق بين موقف الإمامة الكبرى الذي يقضي بعدم جواز الثورة على الحاكم إلا إذا كفر (وهذا لا ينطبق في تاريخ الإسلام إلا على الملك الماغولي أكبر) لأن الظلم أهون من الفتنة؛ وبين موقف هوبس الذي يرى ان الناس تنازلوا عن حريتهم الطبيعية لحاكم مستبد مقابل السلم الذي يضمن لهم؟ فالهاجس الأساس لكلا الموقفين هو الاستقرار (هوبس يخطئ الرأي القائل: "لتكن العدالة ويفنى العالم")، رغم اختلاف المرجعية الفكرية للرأيين. كما أن بعض شروط الإمامة (الكفاءة والعدل) ليست دينية محضة.
لقد كان القصد من الدنيوية السياسية تحقيق مبدأين: التسامح، الذي يعني القبول بكل الأفكار والمذاهب والديانات؛ والمساواة بينها، الناتجة عن المبدأ السابق، بغاية التعايش السلمي بين المواطنين. لكن البعض فهمها بمنطق إقصائي، وصيرها بذلك أيديولوجية من بين الايديولوجيات المتصارعة.
وللخروج من تعسف الأغلبية الديموقراطية والدنيوية الأيديولوجية يجب الاحتكام إلى مبدأ: حرية الشخص تنتهي عند بداية حرية الآخرين. فهذا مبدأ كلي يسمح بتعايش المذاهب الفكرية والثقافات فيما بينها، بغض النظر عن المحتوى لأنه يعكس التعدد والاختلاف الملازمين للثقافات الإنسانية.
1- الحقيقة ما حرر المرأة هو العمل المأجور الذي أعطاها الاستقلالية المادية والطب الحديث الذي مكنها من التحكم في الانجاب.
2- هناك رأي يدعي أن المسيحية هي التي أسست للدنيوية السياسية لأنه ورد في الانجيل: اعط لله ما هو لله ولقيصر ما هو لقيصر. والأمر يتعلق بالضرائب وليس بالسياسة. وحتى لو سلمنا أن المقصود سياسي، فكيف نفسر القرون التي تحكمت فيها المسيحية في الشرعية السياسية؟ وهو أمر طبيعي لأن الشرعية تستند إلى الثقافة السائدة. والأمر سواء في الإسلام، والدليل على ذلك "السهولة" التي نسف بها علي عبد الرازق السياسة الشرعية، مبينا أن سندها في القرآن والسنة هزيل.
3- أتفق جزئيا فقط مع أطروحة غسان سلامة، لأنه يبالغ إلى درجة نفي صفة الدين عن الإسلام (الدين كعلاقة أولية مع الله) لأن العلاقة الأولية في الإسلام هي التي تربط أفراد الأمة بينهم، ما يعيق انعتاق الفرد.