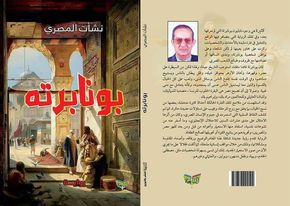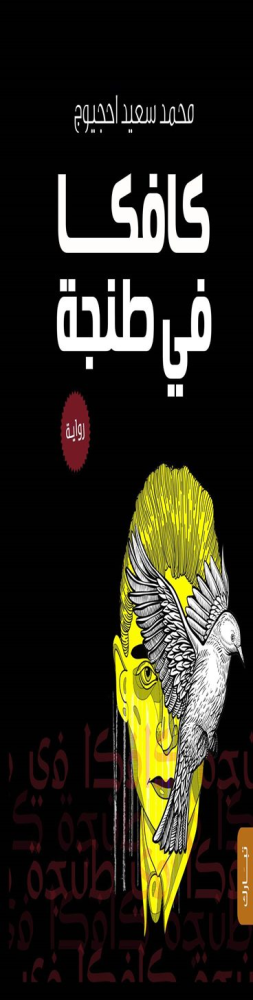وعندي أن السر في أن شعر علي محمود طه المهندس قد نال شيئا من التقدير والثناء مرجعه لإجادة الصنعة والصقل، ولو أن مواده تافهة بدائية المعنى ، غير صادقة يعوزها الشعور الفردي القوي، والنظر الأصيل الواحد.
ثم لأن العرف الدارج والعقل الشعبي قد تعود أن يقرن الشعر بمظاهر الطبيعة المعروفة فيقول الناس عن ليلة مقمرة: إنها ليلة شعرية، أو عن روضة فيحاء: إنها تبعث على النشوة والسرور، وإنهما لكذلك. غير أن الشاعر الذي لا يتعدى في نغمه ووعيه الشعري سوى ترديد ما تواضع عليه الناس وأقروا به, إنما يدل على أن المحاكاة والتقليد والعرف الدارج هي أميز خواص فكره, وأخص ميادين لعبه الفكري.
وعلي محمود طه يكتب عن الطبيعة ويستوحي النهر والبحر والغدير والقمر والأشباح والرياض والشفق, ولايفهم بأن "الطبيعة" التي يجدربأن تنظم شعراً هي الطبيعة في أضخم مظاهرها وأعظمها, وأوقعها في الحس, وأشدها رائحة، وأهولها منظراً , وهو لا يفهم هذا الفهم ويتجه إليه لأن مزاجه هكذا, ولكن لأن هذه الأشياء قد كثرت في الشعر وأصبحت معروفة معترفاً بها على أنها تصلح موضوعاً للشعر، ولو لم يحس الأديب تجاهها بأي شعور غريب أو نظر حديث.
وبديهي أن الشاعر المعاصر الذي لا يلتفت في عالم الطبيعة إلا إلى المظاهر التي التفت إليها خلافة من عهد آدم ، يدل أولاً على أن تقدمه الذهني وقف هناك, وأن وعيه الفني لم يتطور، ففي الطبيعة خلاف البحر الذي يقف عنده القروي. وفي الطبيعة خلاف الشواطيء التي تقف عندها سفن البحارة، أشياء أخرى أدق وربما كانت ألصق بحياتنا واجدر بالتفات الشاعر... فالحجر الصلد الذي يقف في طريقك, و "الشارع" الذي تصقله مصلحة التنظيم حيث يعمل جماعة المهندسين, والفأر الهارب من سفينة خربة، والذباب الذي يطن على جيفة عنفة، وقطعة الحديد التي أكلها الصدأ، والخشب الذي تأكل عليه، والزرع الذي نلبسه ثياباً، والعصفور الوحيد الذي ينتقل من بيت لأخر، والنمل، والنحل، وصوت الباخرة، وضجيج الترام, وخلافها من المظاهر التي نراها ونسمعها في غدونا ورواحنا هي أجزاء حية في الطبيعة، والإلتفات إليها في وضع جديد أتي به نظام حياتنا الراهنة وحضارتنا المعاصرة، لأدل على فهم الطبيعة من آلاف القصائد عن البحر والشفق والنجوم !.
ويجب ألا يفهم من هذا أننا ننكر على الشاعر أن يعني بمظاهر الطبيعة الكبرى البدائية الجميلة أو المتوحشة، ولكن هنا يقل الإبداع، ولا يسلم الشاعر من الإسفاف والتفاهة، إلا إذا كان عملاقاً عظيم النظر فريد الشاعرية، كما أننا لا ننكر الإلتفات إلى "المظاهر الرومانتيكية" التي يولع بها المهندس، ولكن هذا الإلتفات وهذه العناية "بالربيعيات" يسهل فيها الغش، وتندر به الإجادة والتفرد ، وهو أقرب طريق يلجه الأدب القليل الحيلة، المقلد الأسلوب، الذي لا تميزه شارة، ولا يستشف في تكوينه أصالة نظر أو عمق تفكير.
وكثير من شعراء أوروبا المعاصرين اقتربوا من الموضوعات "الرومانتيكية" بأسلوب جديد. فبدلاً من الحديث عن سحرها وخوفها وهولها، تراهم يحاولون تفسيرها والنظر إليها من خلال شعور وعقلية رأت وسمعت وقرأت ما يجعلها تنظر إلى هذا الجمال والهول والخوف من زوايا جديدة ليس فيها ذلك الجهل الناطق. فإن كل شيء لا يعرفه الإنسان يبدو له سراً تحار له الأذهان، ولو كان من أبسط البسائط !.
فالقروي الذي يزور القاهرة لأول مرة ويشاهد المصعد لا يمكنه إلا أن يذكر الله والأسرار، وتتملكه الحيرة والعجب، فإذا حاول مثل هذا الرجل أن ينظم قصيدة عن "المصعد" فقد تروق لأمثالة الذين لا يعرفون الميكانيكيات "وقوانين الطبيعيات" ولكن القاريء المتحضر لا يستطيع قراءة قصيدة تنسب إلى هذا المصعد أهوال الجن وأعمال الشياطين!.
فالثقافة ووعي العصر الذي نعيش فيه لابد منهما لأي فنان يكتب ليقرأه الجيل الذي يعيش بينه، وذلك لأن الشاعر المصري المعاصر لا يعيش في "شبرد" أو "ديوان حكومي" ولكنه قبل ذلك إنسان حي يعيش في كل العالم، ويحس ببعض ما يدفع بالنفوس الآدمية إلى مناجاة النفس، والذي يستطيع أن يرى في شارع عماد الدين مثلاً وجوها وأجساماً وثياباً و آلات كاملة الصنعة مصقولة المظهر, يخبر مظهرها عن السكون والإطمئنان، غير أنها تفتح عوالم داخلية مروعة. وبالإختصار فإن الفنان الذي لم يحس بقبس أو لمحة أو ناحية من "تيار الوعي" كامل يمكنه من رؤية التشابة في أشياء ومظاهر بادية الإختلاف، أو بالعناصر والقوى والفكر التي تذهب جميعها لإخراج فكرة أو مظهر عادي مما نراه في حياتنا اليومية، ليس لديه تلك الملكة الشاعرة التي تستطيع أن تبني القصور من الرماد والهواء، أو تحلل السيارة الجيدة الصنع ، الجميلة المظهر إلى عناصر حلم وغفوة إنسان وعصب حيوان، أو فقرات مادة سنجابية وجرح عامل فقير، ليس له ذلك الإحساس النافذ القديرالذي يجبر القاريء على الإنصات والإستماع لنغمة الشعري.
وإني لأعجب كيف يعجب أي قاريء له حظ من الثقافة ودقة الحس بكلام مثل هذا .
رب ليل مر أمضيناه ضماً وعناقاً
وأدرنا من حديث الحب خمراً نتساقى
في طريق ضرب الزهر حوالية نطاقاً
وتجلى البدر فيه، وصفا الجو وراقا
فإذا كان هنالك حب وضم وعناق، وزهر وبدر وجو رائق. فالإنسان العادي قادر على الإحساس بهذه النشوة الحسية من غير أن ينظم لها هذا الكلام شعراً. وأن أي إفريقي في أدغال أفريقيا، حينما يصفو الجو ، وينمو الزهر، ويشرق البدر، ويحب أمرأة يستطيع أن يقول هذا الكلام.
وعند علي محمود طه أيضاً شعور غير محمود بأنه شاعر، ذلك لأنه قد ضم كل الشعريات وأحصاها في ديوانه . فقصيدة ميلاد شاعر مثلاً كلها تمجيد لهذا الرجل الذي يحسب نفسه شاعراً . لأن لفظة الشعر والشاعر والزهور والألحان تكثر في كلامه.
والرجل الذي يستطيع أن يكتب – بعد معرفتنا الحاضرة وشعورنا المحدود الذي أتاحه لنا العلم والبحث العصري مثل هذه الأبيات الآتية، إنما أحسده لبساطته التي لا تحسد.
وتجلى الصدى الهتوف الساحر في محيط من الأشعة غامر
وسكون يبث في الكون روعاً وقفت عنده الدوائر (كذا)
واستكان الوجود والتفت الدهر وأصغت إلى صداه المقادر (كذا)
وقد يتورط محمود طه في غرامه "بالشعريات" برسمه صوراً مضحكة إذا لم تكن مستحيلة كقوله:
ماؤه ذوب خمرة وسنا شمس وربا ورد وألحان طائر
وعنده إذا لم يجعل هذا الماء ذوب خمر وسنا شمس وربا ورد وألحان طائر في آن واحد فهو ليس بشاعر. وأي منطق يستطيع أن يفهم شيئاً يكون سنا شمس محرقة وربا وردة ، ثم يكون في نفس الوقت صوت طائر ؟ ! اللهم إن هذا خلط قبيح لا نرضاه لصديقنا الشاعر.
وليس أدل على فهم شاعرنا لطبيعة الشعر من قوله في رثاء شاعر:
وهو شعر صورت ألوانه بهجة الفجر وأحزان الشفق
ونشيد مثلت ألحانه همسات النجم في أذن الغسق
وفي قصيدة (الله والشاعر) بساطة مؤلمة :
مدى لعينيه الرحاب الفساح ورقرقى الأضواء في جفنه
وامسكي يا أرض عصف الرياح والرعد المغضب عن أذنه
فهذا كلام لا يشرف أي طالب في مدرسة ثانوية، فضلاً عن شاعر عصري. والقصيدة ملأى بهذه الأشياء التي تواضع البسطاء على أنها الطبيعة التي لا طبيعة غيرها:
مر بنهر دافق سلسبيل تهفو القماري حوله شادية
في ضفتيه باسقات النخيل ترعى الشياه تحتها غانية
فإذا كان هذا النهر ملحاً مثلاً. وكانت هنالك ضفادع على حوافه، وأحجار تدمي الأقدام بدل النخيل، فليس هنالك طبيعة جديرة بالشاعر والشعر !:
حتى إذا شارف ظل الشجر في روضة غناء ريا الأديم
قد ضحكت للنور فيها الزهر وصفقت أوراقها للنسيم
فهذا الشاعر لا يكفيه أن تكون هنالك روضة غناء رياء الأديم ولكن لابد أن يضحك الزهر ويصفق النسيم لأول مرة ! أما المسائل الفكرية التي أثارها الشاعر في حواره مع الله فهي أول ما يقرأه الطالب في العلوم الدينية في باب القضاء والقدر. إن مسألة الإثم والشر لا يعالجها فنان عارف بمثل هذه البساطة.
وفي قصيدة "قيثارتي" مثل قوي لهذه النزعة نحو "الشعريات" التي حاولنا إيضاحها وهذه هي أواخر الأبيات من غير تحوير ولا مبالغة، ولو أنها أشبة بالمبالغة والتحوير
والغور والآكام للشعر والإلهام مودتي
وذمامي قديم هيامي قلبي الدامي دمعي
الهامي حبيسة الأنغام.
أن مثل هذا الشعر ليوحي إلى القاريء الدقيق الحس كراهية للآكام والزهور والبحار والأنغام وما إليها بفعل هذه النغمة المبتذلة الكثيرة التكرار، التي لا تحس معها بواقعة حال صحيحة، أو شعور نضر مباشر!.
وإنما أتينا بهذه الإستشهادات لندل القاريء على أننا لا نتعسف، وإلا فإن الديوان كله يصح أن يستشهد به، فلا يخرج في ألفاظه ومعانيه عن هذه الألفاظ والأمثلة والمعاني.
وقد كنا نظن أن أصدقاءنا من الجيل الجديد الذين يشتغلون بالشعر، يفهمون الشعر على حقيقته، وأنه ليس ألفاظاً ومبالغات عن عالم الطبيعة والزهر والحب وما إليه من الألفاظ والأخيلة التي يسهل على أي يد تحرك القلم أن تأتي بها.
أصدقائي الشعراء، أقولها لكم مخلصاً: أن هذا عبث قبيح بالكبار. وأقبح ما فيه أن يأتي من جيل جديد له دعوى كبيرة نسمع عنها في الصحف، وهو على هذا التخلف المعيب في فهم الفنون والحياة. ولو أننا رأينا الإتجاه صحيحاً، وأن الطريق الذي تسلكونه قويماً، مهما كانت النظرة زائغة والنغم غير منسجم لتساهلنا وكانت معالجتنا للموضوع غير هذه.
غير أن الطريق من أوله خاطيء، وأن الفهم من أساسه غير صحيح وأن هذه الطريق لا يؤدي أبداً الى الشيء الذي نسميه شعراً هو خلاف هذا في جملته وتفصيله، فمن شاء منكم فليرجع إلى نفسه يحاسبها، وينظر من جديد، ويقرأ ما يقول خلافه من الشعراء الفحول، وخاصة المعاصرين في أوربا ليرى في أي طريق تسير الأقدام، وأي عوالم يستكشفها الفنان المعاصر.
المصدر السابق ص 228 الى 232

ثم لأن العرف الدارج والعقل الشعبي قد تعود أن يقرن الشعر بمظاهر الطبيعة المعروفة فيقول الناس عن ليلة مقمرة: إنها ليلة شعرية، أو عن روضة فيحاء: إنها تبعث على النشوة والسرور، وإنهما لكذلك. غير أن الشاعر الذي لا يتعدى في نغمه ووعيه الشعري سوى ترديد ما تواضع عليه الناس وأقروا به, إنما يدل على أن المحاكاة والتقليد والعرف الدارج هي أميز خواص فكره, وأخص ميادين لعبه الفكري.
وعلي محمود طه يكتب عن الطبيعة ويستوحي النهر والبحر والغدير والقمر والأشباح والرياض والشفق, ولايفهم بأن "الطبيعة" التي يجدربأن تنظم شعراً هي الطبيعة في أضخم مظاهرها وأعظمها, وأوقعها في الحس, وأشدها رائحة، وأهولها منظراً , وهو لا يفهم هذا الفهم ويتجه إليه لأن مزاجه هكذا, ولكن لأن هذه الأشياء قد كثرت في الشعر وأصبحت معروفة معترفاً بها على أنها تصلح موضوعاً للشعر، ولو لم يحس الأديب تجاهها بأي شعور غريب أو نظر حديث.
وبديهي أن الشاعر المعاصر الذي لا يلتفت في عالم الطبيعة إلا إلى المظاهر التي التفت إليها خلافة من عهد آدم ، يدل أولاً على أن تقدمه الذهني وقف هناك, وأن وعيه الفني لم يتطور، ففي الطبيعة خلاف البحر الذي يقف عنده القروي. وفي الطبيعة خلاف الشواطيء التي تقف عندها سفن البحارة، أشياء أخرى أدق وربما كانت ألصق بحياتنا واجدر بالتفات الشاعر... فالحجر الصلد الذي يقف في طريقك, و "الشارع" الذي تصقله مصلحة التنظيم حيث يعمل جماعة المهندسين, والفأر الهارب من سفينة خربة، والذباب الذي يطن على جيفة عنفة، وقطعة الحديد التي أكلها الصدأ، والخشب الذي تأكل عليه، والزرع الذي نلبسه ثياباً، والعصفور الوحيد الذي ينتقل من بيت لأخر، والنمل، والنحل، وصوت الباخرة، وضجيج الترام, وخلافها من المظاهر التي نراها ونسمعها في غدونا ورواحنا هي أجزاء حية في الطبيعة، والإلتفات إليها في وضع جديد أتي به نظام حياتنا الراهنة وحضارتنا المعاصرة، لأدل على فهم الطبيعة من آلاف القصائد عن البحر والشفق والنجوم !.
ويجب ألا يفهم من هذا أننا ننكر على الشاعر أن يعني بمظاهر الطبيعة الكبرى البدائية الجميلة أو المتوحشة، ولكن هنا يقل الإبداع، ولا يسلم الشاعر من الإسفاف والتفاهة، إلا إذا كان عملاقاً عظيم النظر فريد الشاعرية، كما أننا لا ننكر الإلتفات إلى "المظاهر الرومانتيكية" التي يولع بها المهندس، ولكن هذا الإلتفات وهذه العناية "بالربيعيات" يسهل فيها الغش، وتندر به الإجادة والتفرد ، وهو أقرب طريق يلجه الأدب القليل الحيلة، المقلد الأسلوب، الذي لا تميزه شارة، ولا يستشف في تكوينه أصالة نظر أو عمق تفكير.
وكثير من شعراء أوروبا المعاصرين اقتربوا من الموضوعات "الرومانتيكية" بأسلوب جديد. فبدلاً من الحديث عن سحرها وخوفها وهولها، تراهم يحاولون تفسيرها والنظر إليها من خلال شعور وعقلية رأت وسمعت وقرأت ما يجعلها تنظر إلى هذا الجمال والهول والخوف من زوايا جديدة ليس فيها ذلك الجهل الناطق. فإن كل شيء لا يعرفه الإنسان يبدو له سراً تحار له الأذهان، ولو كان من أبسط البسائط !.
فالقروي الذي يزور القاهرة لأول مرة ويشاهد المصعد لا يمكنه إلا أن يذكر الله والأسرار، وتتملكه الحيرة والعجب، فإذا حاول مثل هذا الرجل أن ينظم قصيدة عن "المصعد" فقد تروق لأمثالة الذين لا يعرفون الميكانيكيات "وقوانين الطبيعيات" ولكن القاريء المتحضر لا يستطيع قراءة قصيدة تنسب إلى هذا المصعد أهوال الجن وأعمال الشياطين!.
فالثقافة ووعي العصر الذي نعيش فيه لابد منهما لأي فنان يكتب ليقرأه الجيل الذي يعيش بينه، وذلك لأن الشاعر المصري المعاصر لا يعيش في "شبرد" أو "ديوان حكومي" ولكنه قبل ذلك إنسان حي يعيش في كل العالم، ويحس ببعض ما يدفع بالنفوس الآدمية إلى مناجاة النفس، والذي يستطيع أن يرى في شارع عماد الدين مثلاً وجوها وأجساماً وثياباً و آلات كاملة الصنعة مصقولة المظهر, يخبر مظهرها عن السكون والإطمئنان، غير أنها تفتح عوالم داخلية مروعة. وبالإختصار فإن الفنان الذي لم يحس بقبس أو لمحة أو ناحية من "تيار الوعي" كامل يمكنه من رؤية التشابة في أشياء ومظاهر بادية الإختلاف، أو بالعناصر والقوى والفكر التي تذهب جميعها لإخراج فكرة أو مظهر عادي مما نراه في حياتنا اليومية، ليس لديه تلك الملكة الشاعرة التي تستطيع أن تبني القصور من الرماد والهواء، أو تحلل السيارة الجيدة الصنع ، الجميلة المظهر إلى عناصر حلم وغفوة إنسان وعصب حيوان، أو فقرات مادة سنجابية وجرح عامل فقير، ليس له ذلك الإحساس النافذ القديرالذي يجبر القاريء على الإنصات والإستماع لنغمة الشعري.
وإني لأعجب كيف يعجب أي قاريء له حظ من الثقافة ودقة الحس بكلام مثل هذا .
رب ليل مر أمضيناه ضماً وعناقاً
وأدرنا من حديث الحب خمراً نتساقى
في طريق ضرب الزهر حوالية نطاقاً
وتجلى البدر فيه، وصفا الجو وراقا
فإذا كان هنالك حب وضم وعناق، وزهر وبدر وجو رائق. فالإنسان العادي قادر على الإحساس بهذه النشوة الحسية من غير أن ينظم لها هذا الكلام شعراً. وأن أي إفريقي في أدغال أفريقيا، حينما يصفو الجو ، وينمو الزهر، ويشرق البدر، ويحب أمرأة يستطيع أن يقول هذا الكلام.
وعند علي محمود طه أيضاً شعور غير محمود بأنه شاعر، ذلك لأنه قد ضم كل الشعريات وأحصاها في ديوانه . فقصيدة ميلاد شاعر مثلاً كلها تمجيد لهذا الرجل الذي يحسب نفسه شاعراً . لأن لفظة الشعر والشاعر والزهور والألحان تكثر في كلامه.
والرجل الذي يستطيع أن يكتب – بعد معرفتنا الحاضرة وشعورنا المحدود الذي أتاحه لنا العلم والبحث العصري مثل هذه الأبيات الآتية، إنما أحسده لبساطته التي لا تحسد.
وتجلى الصدى الهتوف الساحر في محيط من الأشعة غامر
وسكون يبث في الكون روعاً وقفت عنده الدوائر (كذا)
واستكان الوجود والتفت الدهر وأصغت إلى صداه المقادر (كذا)
وقد يتورط محمود طه في غرامه "بالشعريات" برسمه صوراً مضحكة إذا لم تكن مستحيلة كقوله:
ماؤه ذوب خمرة وسنا شمس وربا ورد وألحان طائر
وعنده إذا لم يجعل هذا الماء ذوب خمر وسنا شمس وربا ورد وألحان طائر في آن واحد فهو ليس بشاعر. وأي منطق يستطيع أن يفهم شيئاً يكون سنا شمس محرقة وربا وردة ، ثم يكون في نفس الوقت صوت طائر ؟ ! اللهم إن هذا خلط قبيح لا نرضاه لصديقنا الشاعر.
وليس أدل على فهم شاعرنا لطبيعة الشعر من قوله في رثاء شاعر:
وهو شعر صورت ألوانه بهجة الفجر وأحزان الشفق
ونشيد مثلت ألحانه همسات النجم في أذن الغسق
وفي قصيدة (الله والشاعر) بساطة مؤلمة :
مدى لعينيه الرحاب الفساح ورقرقى الأضواء في جفنه
وامسكي يا أرض عصف الرياح والرعد المغضب عن أذنه
فهذا كلام لا يشرف أي طالب في مدرسة ثانوية، فضلاً عن شاعر عصري. والقصيدة ملأى بهذه الأشياء التي تواضع البسطاء على أنها الطبيعة التي لا طبيعة غيرها:
مر بنهر دافق سلسبيل تهفو القماري حوله شادية
في ضفتيه باسقات النخيل ترعى الشياه تحتها غانية
فإذا كان هذا النهر ملحاً مثلاً. وكانت هنالك ضفادع على حوافه، وأحجار تدمي الأقدام بدل النخيل، فليس هنالك طبيعة جديرة بالشاعر والشعر !:
حتى إذا شارف ظل الشجر في روضة غناء ريا الأديم
قد ضحكت للنور فيها الزهر وصفقت أوراقها للنسيم
فهذا الشاعر لا يكفيه أن تكون هنالك روضة غناء رياء الأديم ولكن لابد أن يضحك الزهر ويصفق النسيم لأول مرة ! أما المسائل الفكرية التي أثارها الشاعر في حواره مع الله فهي أول ما يقرأه الطالب في العلوم الدينية في باب القضاء والقدر. إن مسألة الإثم والشر لا يعالجها فنان عارف بمثل هذه البساطة.
وفي قصيدة "قيثارتي" مثل قوي لهذه النزعة نحو "الشعريات" التي حاولنا إيضاحها وهذه هي أواخر الأبيات من غير تحوير ولا مبالغة، ولو أنها أشبة بالمبالغة والتحوير
والغور والآكام للشعر والإلهام مودتي
وذمامي قديم هيامي قلبي الدامي دمعي
الهامي حبيسة الأنغام.
أن مثل هذا الشعر ليوحي إلى القاريء الدقيق الحس كراهية للآكام والزهور والبحار والأنغام وما إليها بفعل هذه النغمة المبتذلة الكثيرة التكرار، التي لا تحس معها بواقعة حال صحيحة، أو شعور نضر مباشر!.
وإنما أتينا بهذه الإستشهادات لندل القاريء على أننا لا نتعسف، وإلا فإن الديوان كله يصح أن يستشهد به، فلا يخرج في ألفاظه ومعانيه عن هذه الألفاظ والأمثلة والمعاني.
وقد كنا نظن أن أصدقاءنا من الجيل الجديد الذين يشتغلون بالشعر، يفهمون الشعر على حقيقته، وأنه ليس ألفاظاً ومبالغات عن عالم الطبيعة والزهر والحب وما إليه من الألفاظ والأخيلة التي يسهل على أي يد تحرك القلم أن تأتي بها.
أصدقائي الشعراء، أقولها لكم مخلصاً: أن هذا عبث قبيح بالكبار. وأقبح ما فيه أن يأتي من جيل جديد له دعوى كبيرة نسمع عنها في الصحف، وهو على هذا التخلف المعيب في فهم الفنون والحياة. ولو أننا رأينا الإتجاه صحيحاً، وأن الطريق الذي تسلكونه قويماً، مهما كانت النظرة زائغة والنغم غير منسجم لتساهلنا وكانت معالجتنا للموضوع غير هذه.
غير أن الطريق من أوله خاطيء، وأن الفهم من أساسه غير صحيح وأن هذه الطريق لا يؤدي أبداً الى الشيء الذي نسميه شعراً هو خلاف هذا في جملته وتفصيله، فمن شاء منكم فليرجع إلى نفسه يحاسبها، وينظر من جديد، ويقرأ ما يقول خلافه من الشعراء الفحول، وخاصة المعاصرين في أوربا ليرى في أي طريق تسير الأقدام، وأي عوالم يستكشفها الفنان المعاصر.
المصدر السابق ص 228 الى 232