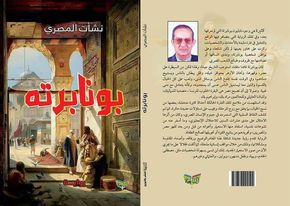محاضرة حول “المشهد الثقافي المغربي” قدمها الأديب والناقد المغربي “العربي بنجلون” وذلك خلال احتضان نادي الرواد الكبار في العاصمة الأردنية عمّان مؤخرا لهذه المحاضرة، حيث قدمه فيها الروائي المعروف صبحي فحماوي، والذي استعرض السيرة الذاتية للكاتب بنجلون، في مقر النادي وبحضور عدد كبير من الأردنيين والعرب.
وتحدث بنجلون قائلا: لو يُقَدَّر أن تعود بنا آلةُ الزمن إلى فجر القرن الْماضي، فنسألَ قارئا عن حال الأدب الْمغربي، فسيجيبنا فورا: إنّ الْمِصْريين يكتبون، والْمغاربة يُصَحِّحون، واللبنانيين يطبعون، والسودانيين يقرؤون!
هذه المقولة التي كانت تتردد على ألسنة القراء، وأصبحت الآن خبرَ كانَ، تدل على مسألتين: الأولى أن الْمغاربة، وسائرَ سكان دول الْمغرب العربي، لَمْ يشهَدوا ـ إلى حد كبير ـ نَهضةً أدبيةً قائمةً بذاتِها، على شاكلة شقيقتها في الْمشرق العربي. وإنْ كانت هناك مُحاولات، إلا أنَّها لَمْ تتطور لتصبح تيارا متميزا، أو مدرسة تؤسس لِهذه النهضة. فقد ظلتِ (الْمُحاولاتُ) حبيسةَ الشعر في أغراضه الضيقة؛ الْمَدحي والديني والغزَلِي والإخوانِي، والقصة في شكلها الْمَقامي، فضلا عن الأدب الشعبي. وإن نضِجَتْ ـ في بعض الْحُقول الْمعرفية والعلمية والصوفية ـ ثَمراتٌ كان لَها أثر كبير في الفكر العالَمي، كرحلة ابن بطوطة، ومؤلفات الإدريسي في الْجُغرافية والفلك، وابن البَنّاء في الرياضيات، وابن خلدون في علم الاجتماع، والْحَسَن الوزّان في الطب النفسي والْجُغْرافية. وهل يغفُل عنا أن الأمير سيلفيسْترْ الثاني، درس بِجامعة القرويين، ومنها نقل الأرقام العربية إلى أنْحاء العالَم في القرن التاسع الْميلادي، ومازال هذا العالَمُ يعتَمِدُها في رياضياته؟!..وسواها من الْمُحاولات التي أشاد بِها الْمُفكر أرنست كلنر بقوله: “إن الْمغرب أفاد أوروبا بِما ساعدها على إدراك الْمُجتمع الإنساني، وأن الْمغرب يُعتبر حقا مرآةً للعالَم”. غير أن هذه الْمساهَمات القليلة، تنحصر في مَجالات العلوم الإنسانية، ولاتَمتد لتشمَل الأدب، كما أنّها لَمْ تستمرَّ وتتطورْ لترتقي بالفكر والْمُجتمع.
والْمسألة الثانية، هي تَوَجُّهُ الْمغاربة إلى خدمة قواعد اللغة في النحو والصرف والإعراب، فألفوا فيها العديد من الْمؤلفات، ولَمْ يكتفوا بذلك، بل كانوا يضعون لَها الْحَواشيَ، تعليقا عليها، أوتشذيبا وتَهذيبا لَها، أوتكملة وسَدّا لنقص فيها، وقَلّما نَجد كتابا يَخْلو من حاشية، وحاشية على الْحاشية. وهنا أستشهد بقَوْلة للكاتب الرائد الراحل مُحمد التّازي في كتابه “يوميات صِحافي”:” لعلنا من أبرع الشعوب الْمُتكلمة باللغة العربية في معرفة القواعد النحوية والصَّرفية لِهَذه اللغة، وبراعتُنا أغْرَتْ كثيرا من مؤرِّخي الأدب على الزَّعم بأن وضْعَنا الْجغرافي والاجتماعي صَدَّنا عن النُّبوغ في الأدبيات، وأهَّلَنا لنكون نوابغَ الفقه والنحو والصرف”.
لكن الأدب بأجناسه الْمتنوعة، بقي في منطقة الظل، مقصورا على الْمشارقة. ولِهَذا قالوا (يصححون) ولَمْ يقولوا (يقرأون) فلو قرأوا لتأثروا وأبدعوا أدبا. وحتى إذا سَرَحْنا البصرَ في التاريخ القديـم، فإننا سنلحظ أن الْهجراتِ البشريةَ الْمتعاقبةَ، لَمْ تساعدْ على ذلك لأسباب شتى؛ فهي من جهة، لَمْ تنْعَم بالاستقرار، ومن جهة أخرى، لَمْ تَحْمل معها ـ تلك الْهِجرات ـ بُذورا أدبية، لتنمو وتتطور في التربة الْمغربية، وإنّما نقلت بذورا لأشجار ونباتات، وعادات وتقاليد وحرفا، سواء تلك الْهِجرات الأولى، الْمُتمثلة في الأفارقة السود الذين سكنوا الصحراء، أوالْهِجرات الثانية للفينيقيين الوافدين من عُمانَ ولبنان وسورية، الذين سكنوا الشواطئ الشمالية. أوالْهِجْرات الثالثة للكنعانيين في عهد الفراعنة، الذين سكنوا الْمِنطقة الشرقية، أو الْهِجْراة الرابعة للأمازيغ من اليمن، أوالْخامسة للعرب من البحرين ومصر، أوالسادسة للموريسْكِيين…ومن الْمُفارقات، أن الأندلس التي فتحها الْمغاربة، وحَمَوْها من الغارات الصليبية، عرفت تطورا حضاريا وعمرانيا، وحركة أدبية وفنية، ذلك أن العرب الْمشارقة الذين هاجروا إليها، حوّلوا معهم كلَّ أرْصِدَتِهم الأدبية والثقافية ليستغلوها هناك، بينما الْمغاربة، وإن عاينوا بأعينهم تلك الْحركة، ظلوا يتَهَيّبونَها زمنا طويلا، حتى إن الْمرابطين، مثلا، أحرقوا كتابَ أبي حامد الغزالي ((الإحياء)) وكتابَ ابنِ العربي، وكلَّ ماله صلة بالفكر، بل بذَلوا الْجُهدَ للقضاء على الْحِسِّ الشعري بالأندلس، وهَمّشوا العلوم والفنون والشعر. وهناك مَنْ حاول من الْمؤرخين والباحثين، أن يُثْبِتوا حضورَ الأدب الْمغربي عبر العصور، فاستدلوا بأسْماء شعراء. لكن السؤال الذي يُثار في هذا الصدد، هو كيف يكون هناك شعراء بدون نصوص يُسْتَشْهَد بِها، أوبالنَّزْر الْيَسير من الْمُتون؟..ثُمَّ كيف نستحضر حركة أدبية، والألسنة لَمْ تتعود على العربية؟..ويستشهدون بالْخُطبة الرائعة للقائد طارق بن زياد في الْجيش الْمُتّجه لفتح الأندلس، فيتصدّى الأمير شكيبُ أرْسَلان متسائلا: وأنّى لطارق مثل هذه العربية؟!..فيرد العلامة عبد الله كنون بأنّ طارقا نشأ في الشرق العربي!..وهذا الرد يُخرِس كلَّ لسان يُردد بأن الأدب العربي، آنذاك، لايأتي إلا من الشرق، وأن أي أديب مغاربي لاينبغ إلا من بين أحضانه. ويُدْلِي الْمُؤرخ عبد الله عنان برأيه، فيقول: يَجوز أن نشك في نسبة الْخطبة إلى طارق، لأن الْمُؤرخين لايشيرون إليها!..والنتيجة التي نستـخلصها من هذه الآراء مُجْتمعة، هي أننا لانستـطيع أن نستدل على بداية الأدب بالْمغرب بِخطبة يتيمة، ولا بنصوص قليلة، قيلتْ في مناسبات دينية أووطنية أوإخوانية، وفي أغراض ضيقة، لَمْ تُشَكِّلْ تراكُما فرديا ولاجَمعيا، ولاإبداعا فنيا متميزا. ولعل هذا من الأسباب التي جعلتِ الكاتبَ أحْمد حسن الزيات يتجاهل الأدب الْمغربي في كتابه الرائد ((تاريخ الأدب العربي)) وكذلك كُلٌّ من أنيس الْمَقدسي وطه حسين وإحسان عباس، والقائمة طويلة!
وكل هذا الْجَدَل، يدل على أن الْمغاربة عاشوا مَخاضا عسيرا وطويلا في سبيل الْحياة والوجود والكينونة، وكانوا يُدْركون جيدا ألاّ أدبَ ولافكرَ ولاثقافة ولاعلم بدون توحيد الألسنة أولا، والأفئدة والأنفس حول القيم الدينية والوطنية ثانيا!
وإذا كان لنا أن نستحضر الْمَثل العربي السائر (مصائبُ قومٍ عند قوم فوائدُ) فإن سقوط الأندلس كان له دور كبير في بداية النهضة الأدبية والفنية والْحضارية. فبعد زوال مُلْك العرب من الأندلس في القرنِ السادسَ عشرَ، تفرق أهلُها الثَّلاثُمِئَةِ ألفٍ في الْمَغرب، فيقول أحْمد الْمَقَرِّي في كتابه ((نَفْح الطِّيب)) : ((لَمّا نُفِّذ قضاءُ الله تعالى على أهل الأندلس بِخُروج أكثرهم عنها، تفرّقوا ببلاد الْمغرب الأقصى وإفريقية، فأمّا أهل البادية فمالوا إلى البوادي، فاسْتَنْبَطوا الْمياهَ، وغرسوا الأشجار. وأما أهلُ الْحواضر فمالوا إلى الْمدن، فكان منهم أهلُ الأدب، والوزراء والكُتّاب..وفاق أهْلُ الأندلس أهلَ البلادِ في الصَّنائعِ…)). وهكذا نشأتْ حضارةٌ، زَها فيها العمران من قصورٍ ودورٍ ومدارسَ، وحدائقَ مازالت لِحَدِّ الساعة ناطقةً بتلك الْخُطى الأولى للأندلسيين، وتَجَسّمتْ فيها هندسةُ البناء والتشييد، وآياتُ الزّخرفة والنّقش والرسم والْخَط في الْخَشَب والْجِبْص. وهذه موسيقى (الآلة) أو الأندلسية، التي لَمْ تكن فنا للمتعة والتسلية، ولكن، كانت علاجا للأمراض النفسية والعقلية في مستشفى سيدي (فَرَجٍ) بسوق الْعَطّارينَ في فاس، حتى إن دولا أروبية وأمريكية أرسلتْ أطباء وصِحافِيَّين وجواسيسَ لِـ(قَرْصَنة) الطرق والوسائل الْمستعملة في العمليات العلاجية. ونُمَثِّل باخْتطاف الطبيب والْجُغْرافي (الْحسن الوَزّانْ) من قِبَل الإيطاليين، قصد تزويدهم بِمَعلومات في مَجالَيِ الطِّبِّ النفسي والْجُغرافية. وفي الشعر، نقلوا فنَ (التَّوْشيح) الذي كان ثورة على النظام الشعري السائد. وفي النثر، نَجِد فنَّ القصة (الفلسفية) و(الدينية) و(الشعبية) و(الاجتماعية) وفن (الْمَقامة) و(الرحلة) وفن (التراجم) و(الفهارس) التي تَحْتضن سِيَرَ الشخصيات الأندلسية، والعائلات العريقة، والكتب والْمُؤلفات، والْمُنوعات الأدبية. ويبدو أن الغاية من هذه التآليف، هي صيانة تراث الفكر الأندلسي، خِشْيةَ ضياعه، مثلَ الفردوس الْمفقود، فتكون الصدمة مضاعفة: فقدان الأرض، وفقدان الفكر…إلا أن هذه الإشراقاتِ الأولى، لَمْ تكن إلا إرهاصا على أن شيئا ما سيظهر في الأفق قريبا، ولَمْ تتخطّ حدودَ بدايات التأسيس..لِماذا؟..لأن هجرة الأندلسيين كانت على مراحلَ، تقدَّر بِمِائة وعشرين سنةً، أي أنّهم كانوا يفتقدون الاستقرار والتّأَقْلُمَ مع الوضع الْجديد، والتخلصَ من أثر الصدمة، ولَمْ يستفيقوا من هَوْل النكبة إلا بعد عقود طويلة!
فإلى الثلاثينيات من القرن الْماضي، والأدب الْمَغربي مازال نسخةً طِبْقَ الأصْل من الأدب الأندلسي، لَمْ يستطع أن يساير سُنّةَ الْحياة فيتطور، كسائر الآداب العربية والعالَمِية. وحتى نبين ذلك التشابه أوِالتطابق بين الأدبين، الأندلسي والْمَغْربي، سواء في الْمَضامين، أوِالأشكال والأساليب والأدوات الفنية، نورِد طُرْفةً، كمثال، وهي أن كاتبا مشرقيا، غفر الله له، كان يشتغل أستاذا في الْمغرب، فأراد أن يؤلف كتابا عن الأدب الْمَغربي، لأن كتابه الأول عن القصة الْمَغربية لقِيَ رَواجا كبيرا، ماديا ومعنويا، فماذا فعل؟..أحضر معه من مصرَ كتابَ الدكتور أحْمَد هيكل “الأدب الأندلسي” وسلخه سلْخا، إذْ عَوَّض، فقط، أسْماءَ شعراء الأندلس، ونصوصَهم بأسْماءِ الشعراء الْمَغاربة ونصوصِهم، وكفى الله الْمؤمنين شرَّ القتال!
وأصدر كتابه، فلقي ترحيبا من الأدباء الْمَغاربة، لأن الكتاب الأول لَمْ يكن موزعا في الْمَغرب. وتَمُرّ الأيام والشهور والسِّنون، وإذا بطالبين مغربيين يعودان من مصر إلى الْمَغرب، فيتفاجآن به، وعندما تأكدا من التَّناص أوالتّلاص، لا أدري، أصدرا بيانا توضيحيا، يفضحان فيه هذه السرقة. وما كان من صاحبنا إلا أن حزم حقائبه، ورحل إلى دولة مغاربية أخرى. وهذا يعطي دليلا على ألاَّفرْقَ بين خصائص الأدب الأندلسي والْمَغربِي آنذاك، لأن الثانِيَ نسخة من الأول. غيْر أن ذلك يبين من جهة ثانية، أن الْهِجـرة الأندلسية، كانت عاملا قويا في ولادة الأدب الْمَغربي.
ويُحَدِّد العلامة عبد الله كَنّونْ البدايات الأولى للأدب الْمَغربي الْحديث في كتابه، الذي ضَمّ مُحاضراتٍ معنونةً بـ”أحاديث عن الأدب الْمَغربي الْحَديث” فيذكر أنه”إذا كان تاريخ نَهْضة الأدب العربي في الشرق يبدأ من منتصف القرنِ التاسعَ عشرَ، فإنه في الْمَغرب قد تأخر إلى ماقبل نُشوبِ الْحَرب العالَمِية الأولى بقليل”..وعندما نسأله عن عِلّة هذا التأخير، يُجيب قائلا: إن الْمَغرب كان في عزلة تامّة”عن العالَمِ القديـم والْجَديد، عن أصدقائه في الشرق وجيرانه في الغرب..”!
وأمّا العوامل الأخرى، فتتجلى في هجرة بعض الأدباء إلى الدول الغربية، مثل جعفر الناصري إلى فرنسا، ومُحمد كَنّون ومُحَمد الْمَهدي الْحَجْوي إلى إسبانيا، وعبد الرحْمان حجِّي إلى إنْجلترّا…ولَمّا عادوا سَخّروا شعرَهم لقضايا الوطن، وتناولوا فيه مظاهر التقدم والتطور في كل مناحي الْحياة، ودَعَوْا إلى العِلْم والْمَعرفة والنَّهْل من الأدب الآخر. وأستشهد بِمَقْطع من نص شعري للحَجْوي بعنوان” نَحْوَ النُّهوض”:
إلـى متَى نترك التعليمَ مهجـورا
ونَحسِب العِلمَ في الإفْرَنْجِ مَحْصورا
متَى نَفيقُ وعينُ الدَّهرِ شاخِصةٌ
تقضي على كلِّ مَنْ قدْ باتَ مغرورا
هَيّوا إلى الْمَجْد يَأبْناءَ مَنْ رفعوا
للمجدِ صَرْحا بِعِلْمٍ كـان مَنْشورا
وهجرة البعض الآخر إلى الدول العربية، كالعراق وسوريا ومصر، لكن الأغلبية منهم، كانت مصرُ قِبْلَتَهُمْ. وفضْلاً عن هذين العاملين، ظهر من يدعو إلى النّهضة والإصلاح، وتطوير التعليم، السبيل الوحيد إلى الازدهار الأدبي والثقافي والْمَعْرِفي والاقتصادي. يقول مُحَمد كَنّونْ الذي جال في عدد من الدول الأروبية، وأدرك سِرَّ نَهْضَتِها وتقدمِّها وحضارتِها:
بَني قَوْمي أجيـبوا مَنْ دَعاكُمْ ولَبّوا دَعْوَتـي فالْـجَهْلُ أرْدى
نرى أمَمَ التَّـمَدُّنِ في ارْتِقـاءٍ ونَحْنُ كَأنّـنا نَنْحَـطُّ عَمْـدا
ثُمّ لاننسى الشعور الوطني العامّ بصيانة الْهوية الْعربية من مُؤامرات الْمُسْتَعْمِر، كان عاملا قويا في رحيل الطلبة إلى مصرَ لإكمال دراستهم، لأن الْمُستعمر كان يَحْظُر على طالب اللغة العربية أن يتابع تعليمه العالي، بل الْحُصول على شهادة الباكالوريا، مِمّا يعني أنه كان يسعى إلى صناعة دمى تلهَج بلسانِها وثقافتها، وتقوي شَوْكتها! وهناك في الشرق، تلقى الطلبة الْمَغاربة مبادئَ القومية العربية، التي كان الْمُستعْمِر يَهابُها، ويَعْمل على تنحيتها، ووجدوا الظرفَ مُلائِما للاحتكاك بالزعماء والأدباء والْمُفكِّرين الرواد، الْمَشارقة والْمَغاربة، كعباس مَحْمود العقاد وطه حسين…وفتحوا عيونَهُم على الصحافة والنوادي الأدبية، بل ساهَموا في أنشطتها الْمُتَنوعة، وفي الإذاعة والْجَرائد والْمَجلات، وفي الْمُحاضرات والندوات والْمُؤتَمَرات، التي كان مكتب الْمَغرب العربي ينظمها. وبالإضافة إلى كل ذلك، كانت الساحة الثقافية الْمَغربية، تشهد يوميا وأسبوعيا وشهريا نزولَ سلاسلَ من الكتب الثقافية الْمِصرية، وعروضَ رواد الأدب والفكر والفن، مثل طه حسين في مُحاضرته بتطوان عن أزمة القراءة في العالَمِ الْعربي، ومُحَمد سعيد العريان عن تطور الدراسات الإسلامية العليا في الْمَركز الثقافي العربي بـمدينة فاس، وفاطمة رشدي ويوسف وهبي في عروض مسرحية…ونظرا لقِلّة أُطُرِ التدريس في فجر الاستقلال، فقد أعارتْ مصرُ كثيرا من أساتذتِها، الذين بدورهِمْ ساهَموا في تَحْديث الأدب الْمَغربي، وأذكر مِنْهُم مُحَمّد الصادق عفيفي وعبد العزيز الأهواني ونَجيب مُحمد البهبيتي وعبد الْحَميد يونس وعائشة عبد الرحْمان (بنت الشاطئ)..فألفوا كتبا عن الأدب الْمَغربي، وعن القصة الْمَغربية الْحَديثة. وأشرف على أطاريحَ جامعية. وكان لعائشة عبد الرحْمن الفضل في اكْتِشاف الكنوز الْمَدْفونة في مكتبة القرويين، فلولاها لبقيتْ مؤلفاتٌ قيمةٌ موضوعةً على الرفوف يكسوها الغبار، كـ”رسالة الصّاهل والشاحج” للشاعر أبي العلاء الْمَعَرِّي. غير أن هذه العوامل، وإن كانت لَها أهَمِّيتها الْقُصْوى، فإنّها لن تُجْدِي نَفْعا، أوتُؤْتِيَ أكْلَها، مالَمْ تَكُنْ هناك (مطبعة) تُخْرِج عُصارةَ الفكر من الظلمات إلى النور، وتُحْيي الكتابة والتأليف والبحث. وهذا هو العامل الرابع؛ ففي سنة 1859 نقل السيد إدريس العمري مطبعةً من باريس إلى فاس، طَبعتْ في البداية الكتبَ الدينية واللغوية، ثم أحضر القاضي مُحمد الرّوداني سنة 1865 مطبعةً حَجَريةً من مصر، وصَحِبَه تقني مصري لتسييرها وتدريب عُمّال مغاربة عليها. وتبعتهما مطابع أخرى مِمّا ساهم في طبع ونشر كتب متنوعة، وظهور جرائد ومَجَلات سياسية ودينية وأدبية. فكانت حركة الطباعة، كما يقول الأستاذ زين العابدين الْكَتّاني في كتابه الرائد”الصحافة الْمَغربية: نشأتُها وتطوُّرُها”:((حافزا لكثير من أهل العلم على التأليف والنشر، فزخرتِ الْمَكْتبة العربية في كل مكان بنتاج هذه الْمَطابع)). وبدأنا نرى الْجَرائد والْمَجلات تنهَمِر تباعا على الساحة الثقافية الْمَغربية، لتفسحَ الْمَجالَ للعديد من الأقلام، سواء في الشعر أوالقصة أوالنقد أوالفن أوأحوال الْمُجتمع الْمَغربي. ومن بين الْجَرائد “العَلَم” التي تعتبر مدرسة إعلامية، لَها الفضل في تكوين صِحافيين وكتاب ونقاد كبار. ويكفي أن نشير إلى مُلْحقِها الثقافي، الذي نشر أهَمَّ الأعْمال الأدبية، وأوحى لآخرين بإصدار ملاحقَ ثقافيةٍ، مِمّا شَحَذ الأقلام، وأحْدثَ تنافسا بينها، فازدهرتِ الْحَركة الأدبية والثقافية والفكرية بصفة عامة. ولِمُناقشة كلِّ ماكان يُنْشَر في الكتب والْمجلات والْجرائد، تأسست نوادٍ أدبيةٌ في جُلِّ الْمُدن الْمغربية الكبرى، وترأسها الأدباء الكِبار. وغالبا ماكانت هذه النوادي تَحْتضن جلساتٍ ومناظراتٍ ومطارحاتٍ نقديةً، ساهَمَتْ بدورها في تَجْديد أساليب الكتابة والتفكير لدى الأدباء الذين كانوا يَحْتذون الأندلسيين. ويكفي أن نشير إلى أن الكتابة الْمغربية الْمرسلة، الْخالية من الْمُحَسِّنات البديعية، خرجت من (جلباب هذه الأندية) على غِرار (خرجت القصة من معطف كوكول) وهي قولة تتردد على الألسن، تولّدتْ عن القولة الأُمِّ للروائي ديستويفسكي:((كلنا خرجنا من معطف جوجول)) ويقابل الْمِعطف الروسي الْجِلْبابُ الْمَغربي!
لكن، ينبغي أن ننظر إلى هذه الْحركة عَميقا، فإنْ كانت تبدو في الظاهر علميةً، أدبيةً، أي مُجَرّد مُسامرات، فإنّها في باطنها كانت تسعى إلى لَمْلَمة الأدباء والعلماء، وتوحيد آرائهم وآمالِهم، للذود عن الوطن وحِماية اللغة العربية، لأنّها تُلْحِم أبناء الوطن الواحد، وتوحِّد أحاسيسَهم. ولاينبغي أن نغفُل عاملا آخر، تَمثّل في تأثُّر الْمَغاربة بالأدباء الْمَشارقة، إذ كانوا مثالا حيا يُقْتدى، بل إذا توفِّي أحدُهم هناك، يُقامُ له تأبينٌ هنا. وعن هذه الْخِصِّيصة، يقول الدكتور مُحمد السولامي في كتابه”النثر الأدبي الْمَغربي في عهد الْحِماية:((ظل الشرق العربي، وخاصّة مصرَ، رافدا هاما من روافد الثقافة الْمَغربية، وظلت الْجامعات والْمَجالس العلمية والْمَكْتبات قِبْلةَ الْمُهتمين بالثقافة من طلاب وأدباء وعلماء مغاربة. ولَمْ تَخْلُ جُلُّ الرحلات من حديث عن لقاءات ثقافية مع علماء الْمَشْرق، بل قد يكون الْهَدف من الرحلة كُلِّها علميا بَحْثا “. وكان اهْتِمام الْمَغاربة بِما يصدُر عن إخْوانِهِم بِالْمَشْرق كبيرا جدا، حتى قيل إنه”لاتَمُرُّ عشرة أيام على طبع أي كتاب بِمِصرَ إلا وتَجِده لدى الكتبيين بسائر الْمُدُن وخُصوصا فاسَ والرباطَ ومُرّاكشَ، أما جَرائد مصر ومَجلاتُها فهي مِلْءُ الأيْدي والْخَزائنِ”وبذلك، بدأ الْمَغاربة يُدْركون أن الأدب لاينحصر في نظْمِ الشعر فقط، إنّما يشمل القصة والرواية والْمَسرحية والنقد، وأن قضايا الأدب لاتقتصر على الروحانيات والإخوانيات والغراميات والوصفيات فقط، إنّما تشمل الذاتيات والوطنيات والاجْتِماعيات والإنسانيات، وسواها كثير…وبدأ الشعراء يرحلون من وادي عبقر إلى ليالي شهرزاد، أي من الشعر إلى القصة، بل إلى فنون ماكان لنا بِها صلة، ولَمْ نكنْ نَسْمَع بِها كأدب الأطفال. وتَحَوّلت العناية بقواعد اللغة العربية إلى النقد الأدبي والفني، عبر تدريس مناهج النقد العربي القديـم والْحَديث، والنقد الغربي الْمُعاصر في الْمَدارس الثانوية والْمُؤسّسات الْجامعية، ولا يعنِي هذا أن الشعراء تَخَلّوْا عن نظْم الشعر، بل بالعكس، نَجِدُهُمْ تأثروا
بدورهم بالْحَركة الشعرية الْحَديثة في الشرق، وواكبوا اتِّجاهاتِها.
أصبح عالَمُ الإحيائيين بالنسبة لشعرائنا قِبْلةً يَحُجّون إليها كلَّ حين. فالعالَم الإحْيائي في نظرهم يَمْتاز ببعْثٍ حقيقي لأساليب الشعر، وعناصر اللغة، بعد فترة طويلة من الْجُمود. كما يَمْتاز بكسْر الْحاجِز بين القديـم والْجَديد. فما فعله البارودي وحافظ وشوقي هو إعادة النَّبْض إلى عروق الشعر، والْحَيَويّة إلى اللغة والبلاغة بعد عصور من الْجُمود والتَّحَجُّر”. وخير مانستشهد به قصائد الشاعر الكبير مُحمد الْحَلْوي، التي عانقت الإنسان وقضاياه الذاتية والاجتماعية والوطنية موضوعا، وتلفّحتْ بالتّخييل والتّصوير والترميز، والسرد والْحَكْي والتعبير الرقيق والأسلوب القوي شكلا، حتى إن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، قال عنه مُعْجبا: “ماسَمِعتُ مثْلَ هذا الشعر لافي الشرق ولافي الغرب”!..وبعد الاستقلال، ستزدهر حركة الترجَمة بشكل كبير، فترجم الدكتور مُحمّد بَرّادَة كتبا لرولان بارْثْ وميخائيلْ باخْتينْ، وساهم في الْحَركة النقدية والقصصية والروائية والسيرية بنصوص أثارتْ جَدَلا ونقاشا بين الأدباء والباحثين، ومنهم من عَدّها نَماذجَ تطبيقية للمنهج النقدي الذي يتبنّاه، فكأنه يكتب ويترجم نظريات نقدية، ويستشهد عليها بنصوصه!…وإلى جانبه، ظهرتْ كوكبة من القصاصين والروائيين والنقاد الذين يتبنّون الاتِّجاهاتِ الْحَديثةَ في الأدب، فرأينا الأستاذ نَجيب الْعُوفي في”درجة الوعي في الكتابة” يَرْصُد الوعي الأيديولوجي عبر الْمَنهج الواقعي الْجَدلي في نصوص شعرية وقصصية وروائية ونقدية، والأستاذ إدريس النَّاقوري، قبل أن يُطلِّق النقد ويُؤْثِر العزلة، في”الْمُصطلح الْمُشترك” يَحْذو حَذْوَ الأول، والناقدين إبراهيم الْخَطيب وعبد القادر الشَّاوي يسلكان النقدَ الاجْتِماعي التاريـخي، والأستاذ سعيد يَقْطين في كتابه”الْخِطاب الروائي” يشتغل على أدبية النص ودلالاته السردية. وفي الشعر، قاد الشعراء عبد الكريـم بن ثابت ومصطفى الْمَعْداوي وأحْمد الْمَجّاطي ومُحَمّد الْخَمّار الْكَنّوني وعبد الكريـم الطَّبّال…حركةَ الشعر الْجَديد بِما لَها وماعليها!…وفي القصة والرواية والسيرة الذاتية، برز الأدباءُ عبد الكريـم غَلاَّب وعبد الْجَبار السْحيمي ومُحَمّد زَفْزاف وأحْمد بوزْفورْ ومُحمّد عز الدين التَّازي وخناثة بَنّونَة…وفي أدب الأطفال شَهِدنا أعمالا لكلٍّ من أحْمد عبد السلام الْبَقَّالي، وبَنْسالَمْ الدَّمْناتي، وحَميد السَّمْلالي، وعبد الفتَّاح الأزْرق، وعلي الصْقَلِّي، وأبوبكر الْمَريني..وفي الكتابة الْمَسرحية عبد الكريـم بَرْشيدْ وعبد الرحْمان بن زيدان وحسن الْمنيعي ومُحمّد تيمْدْ ومُحمّد مَسْكين وحوري الْحُسَيْن..وبطبيعة الْحال، فإن القائمة طويلة، لَمْ نذكر منها إلاالقليل القليل، وإلا لو أردنا أن نوردَ كافة الأسْماء، لَمَا اتَّسَعَتْ لَها صَفحات!..ويبدو أن دورا آخر لـ”دار الفكر”التـي كان يسيرها الدكتور مُحمّد عزيز الْحبابي، سيساهم في تَجديد الأدب الْمَغربي، إذ كانت جَنَباتُها تَحْتضن لَفيفاً من الأدباء والْمُفكرين، يلتقون كل أسبوع ليناقشوا القضايا والإشكاليات التي تُجابه النّهضة الثقافية بالبلاد. وستتطور هذه الدار لتصبح في عام 1961 (اتِّحادَ كُتاب الْمَغرب) يترأسه الْحْبابي نفسه، ويُصدر مَجلة”آفاق”مِمّا أتاح فرصا لأدباء الْمَغرب للالتقاء بأدباء الْمَشرق، والاطلاع على تَجاربِهِم، وعَقْد شراكات واتِّفاقيات تبادل الزيارات، وتنظيم الأنشطة الثقافية، هنا وهناك!
والْخُلاصة أنّ الأدب الْمَغربي شَهِد ثلاث مراحل طورته: الأولى، من بداية القرن الْماضي إلى 1956 كان فيها، من حيث الْمَضمون، الصوتَ الْمُعبِّرَ عن قضايا الوطن في التحرر من الْمُستعمِر، ومن حيث الشكل الفني، لَمْ يشُذَّ عن السائد في الكتابات الْمَشرِقية؛ ففي القصة والرواية والْمَسرحية، تبنّى حضورَ البطل الْمِحوري، وصراعَه مع قوى الشر، وتنامي الْحادثة من مدخل إلى أزمة إلى نِهاية مضيئة. وفي الشعر، غلبتِ الْخَطابة والْحَماسة والتشبيه والْمُباشَرة في الأداء. كما أن النقدَ انصبّ على إظهار توظيف اللغة والصياغة والتعبير البلاغي في النصوص النثرية والشعرية، فكأن الأدب الْمغربي في تلك الْمَرحلة كان يتتلمذ على الأدب الْمَشرقي. وبعد الاستقلال، وخصوصا منذ 1960 بدأ الأدب يَجْنَح نَحْوَ القضايا الاجْتِماعية والقومية العربية، كالقضية الفلسطينية. ويبتعد مسافة عن الأدب الْمَشرقي، ليقترب مسافة من الأدب الغربي، فنَجِد بعض الأدباء يستعيرون منه طرائق الكتابة، والْمَناهج النقدية، والأساطير، ويُحاوِل أنْ يُمَغْرِبَها، كأسطورة سيزيف، مثلا، ليوظفها في تصوير كَدْح الْعامل في توفير لقمة عيشه، وهكذا..أو يستلهِمَ من التراث الشعبي مواقفَ بطولية، فيُضَمِّنَها نصَّه الشعري، وكَمِثالٍ، قصيدة رائعة للشاعر أحْمَد الْمَجَّاطي بعنوان: الفروسية. ونتيجة لِهَذا الْمَيْل للأدب الغربي، نشأ صراع بين أدباء ما قبل الاستقلال وأدباء ما بعده، وكلٌّ منهم يُكيل للآخر تُهَما، لا داعِيَ لسردِها. وحاليا، فَتَرَ الصِّراع، ولَمْ تعُدْ تلك القضايا تشكِّل هَمّا أساسيا، كما أن غالبية الأدباء الْمُؤَسِّسين، إما رحلوا وإما صمتوا، ولَمْ يَفْضُلْ منهم في ساحة الكتابة إلا القليل، وظهر جيل آخر من الأدباء، يُبْحِر في ذاته، عبر التخيل الْمُلْتحِم بالواقع، ليبرز رؤيتَه للعالَمِ، ويعتني باللغة، أساسا، باعْتبارها حَمّالَةَ رُؤى فكرية ونفسية. وأستشهد بالكاتب النشيط مصطفى لغتيري الذي قال عن تَجْربته في الكتابة: كلما توغلت في ذاتي أكثرَ، عرفت العالَمَ من حولي بشكل أفضل!.
العربي بنجلون
أديب وناقد مغربي
وتحدث بنجلون قائلا: لو يُقَدَّر أن تعود بنا آلةُ الزمن إلى فجر القرن الْماضي، فنسألَ قارئا عن حال الأدب الْمغربي، فسيجيبنا فورا: إنّ الْمِصْريين يكتبون، والْمغاربة يُصَحِّحون، واللبنانيين يطبعون، والسودانيين يقرؤون!
هذه المقولة التي كانت تتردد على ألسنة القراء، وأصبحت الآن خبرَ كانَ، تدل على مسألتين: الأولى أن الْمغاربة، وسائرَ سكان دول الْمغرب العربي، لَمْ يشهَدوا ـ إلى حد كبير ـ نَهضةً أدبيةً قائمةً بذاتِها، على شاكلة شقيقتها في الْمشرق العربي. وإنْ كانت هناك مُحاولات، إلا أنَّها لَمْ تتطور لتصبح تيارا متميزا، أو مدرسة تؤسس لِهذه النهضة. فقد ظلتِ (الْمُحاولاتُ) حبيسةَ الشعر في أغراضه الضيقة؛ الْمَدحي والديني والغزَلِي والإخوانِي، والقصة في شكلها الْمَقامي، فضلا عن الأدب الشعبي. وإن نضِجَتْ ـ في بعض الْحُقول الْمعرفية والعلمية والصوفية ـ ثَمراتٌ كان لَها أثر كبير في الفكر العالَمي، كرحلة ابن بطوطة، ومؤلفات الإدريسي في الْجُغرافية والفلك، وابن البَنّاء في الرياضيات، وابن خلدون في علم الاجتماع، والْحَسَن الوزّان في الطب النفسي والْجُغْرافية. وهل يغفُل عنا أن الأمير سيلفيسْترْ الثاني، درس بِجامعة القرويين، ومنها نقل الأرقام العربية إلى أنْحاء العالَم في القرن التاسع الْميلادي، ومازال هذا العالَمُ يعتَمِدُها في رياضياته؟!..وسواها من الْمُحاولات التي أشاد بِها الْمُفكر أرنست كلنر بقوله: “إن الْمغرب أفاد أوروبا بِما ساعدها على إدراك الْمُجتمع الإنساني، وأن الْمغرب يُعتبر حقا مرآةً للعالَم”. غير أن هذه الْمساهَمات القليلة، تنحصر في مَجالات العلوم الإنسانية، ولاتَمتد لتشمَل الأدب، كما أنّها لَمْ تستمرَّ وتتطورْ لترتقي بالفكر والْمُجتمع.
والْمسألة الثانية، هي تَوَجُّهُ الْمغاربة إلى خدمة قواعد اللغة في النحو والصرف والإعراب، فألفوا فيها العديد من الْمؤلفات، ولَمْ يكتفوا بذلك، بل كانوا يضعون لَها الْحَواشيَ، تعليقا عليها، أوتشذيبا وتَهذيبا لَها، أوتكملة وسَدّا لنقص فيها، وقَلّما نَجد كتابا يَخْلو من حاشية، وحاشية على الْحاشية. وهنا أستشهد بقَوْلة للكاتب الرائد الراحل مُحمد التّازي في كتابه “يوميات صِحافي”:” لعلنا من أبرع الشعوب الْمُتكلمة باللغة العربية في معرفة القواعد النحوية والصَّرفية لِهَذه اللغة، وبراعتُنا أغْرَتْ كثيرا من مؤرِّخي الأدب على الزَّعم بأن وضْعَنا الْجغرافي والاجتماعي صَدَّنا عن النُّبوغ في الأدبيات، وأهَّلَنا لنكون نوابغَ الفقه والنحو والصرف”.
لكن الأدب بأجناسه الْمتنوعة، بقي في منطقة الظل، مقصورا على الْمشارقة. ولِهَذا قالوا (يصححون) ولَمْ يقولوا (يقرأون) فلو قرأوا لتأثروا وأبدعوا أدبا. وحتى إذا سَرَحْنا البصرَ في التاريخ القديـم، فإننا سنلحظ أن الْهجراتِ البشريةَ الْمتعاقبةَ، لَمْ تساعدْ على ذلك لأسباب شتى؛ فهي من جهة، لَمْ تنْعَم بالاستقرار، ومن جهة أخرى، لَمْ تَحْمل معها ـ تلك الْهِجرات ـ بُذورا أدبية، لتنمو وتتطور في التربة الْمغربية، وإنّما نقلت بذورا لأشجار ونباتات، وعادات وتقاليد وحرفا، سواء تلك الْهِجرات الأولى، الْمُتمثلة في الأفارقة السود الذين سكنوا الصحراء، أوالْهِجرات الثانية للفينيقيين الوافدين من عُمانَ ولبنان وسورية، الذين سكنوا الشواطئ الشمالية. أوالْهِجْرات الثالثة للكنعانيين في عهد الفراعنة، الذين سكنوا الْمِنطقة الشرقية، أو الْهِجْراة الرابعة للأمازيغ من اليمن، أوالْخامسة للعرب من البحرين ومصر، أوالسادسة للموريسْكِيين…ومن الْمُفارقات، أن الأندلس التي فتحها الْمغاربة، وحَمَوْها من الغارات الصليبية، عرفت تطورا حضاريا وعمرانيا، وحركة أدبية وفنية، ذلك أن العرب الْمشارقة الذين هاجروا إليها، حوّلوا معهم كلَّ أرْصِدَتِهم الأدبية والثقافية ليستغلوها هناك، بينما الْمغاربة، وإن عاينوا بأعينهم تلك الْحركة، ظلوا يتَهَيّبونَها زمنا طويلا، حتى إن الْمرابطين، مثلا، أحرقوا كتابَ أبي حامد الغزالي ((الإحياء)) وكتابَ ابنِ العربي، وكلَّ ماله صلة بالفكر، بل بذَلوا الْجُهدَ للقضاء على الْحِسِّ الشعري بالأندلس، وهَمّشوا العلوم والفنون والشعر. وهناك مَنْ حاول من الْمؤرخين والباحثين، أن يُثْبِتوا حضورَ الأدب الْمغربي عبر العصور، فاستدلوا بأسْماء شعراء. لكن السؤال الذي يُثار في هذا الصدد، هو كيف يكون هناك شعراء بدون نصوص يُسْتَشْهَد بِها، أوبالنَّزْر الْيَسير من الْمُتون؟..ثُمَّ كيف نستحضر حركة أدبية، والألسنة لَمْ تتعود على العربية؟..ويستشهدون بالْخُطبة الرائعة للقائد طارق بن زياد في الْجيش الْمُتّجه لفتح الأندلس، فيتصدّى الأمير شكيبُ أرْسَلان متسائلا: وأنّى لطارق مثل هذه العربية؟!..فيرد العلامة عبد الله كنون بأنّ طارقا نشأ في الشرق العربي!..وهذا الرد يُخرِس كلَّ لسان يُردد بأن الأدب العربي، آنذاك، لايأتي إلا من الشرق، وأن أي أديب مغاربي لاينبغ إلا من بين أحضانه. ويُدْلِي الْمُؤرخ عبد الله عنان برأيه، فيقول: يَجوز أن نشك في نسبة الْخطبة إلى طارق، لأن الْمُؤرخين لايشيرون إليها!..والنتيجة التي نستـخلصها من هذه الآراء مُجْتمعة، هي أننا لانستـطيع أن نستدل على بداية الأدب بالْمغرب بِخطبة يتيمة، ولا بنصوص قليلة، قيلتْ في مناسبات دينية أووطنية أوإخوانية، وفي أغراض ضيقة، لَمْ تُشَكِّلْ تراكُما فرديا ولاجَمعيا، ولاإبداعا فنيا متميزا. ولعل هذا من الأسباب التي جعلتِ الكاتبَ أحْمد حسن الزيات يتجاهل الأدب الْمغربي في كتابه الرائد ((تاريخ الأدب العربي)) وكذلك كُلٌّ من أنيس الْمَقدسي وطه حسين وإحسان عباس، والقائمة طويلة!
وكل هذا الْجَدَل، يدل على أن الْمغاربة عاشوا مَخاضا عسيرا وطويلا في سبيل الْحياة والوجود والكينونة، وكانوا يُدْركون جيدا ألاّ أدبَ ولافكرَ ولاثقافة ولاعلم بدون توحيد الألسنة أولا، والأفئدة والأنفس حول القيم الدينية والوطنية ثانيا!
وإذا كان لنا أن نستحضر الْمَثل العربي السائر (مصائبُ قومٍ عند قوم فوائدُ) فإن سقوط الأندلس كان له دور كبير في بداية النهضة الأدبية والفنية والْحضارية. فبعد زوال مُلْك العرب من الأندلس في القرنِ السادسَ عشرَ، تفرق أهلُها الثَّلاثُمِئَةِ ألفٍ في الْمَغرب، فيقول أحْمد الْمَقَرِّي في كتابه ((نَفْح الطِّيب)) : ((لَمّا نُفِّذ قضاءُ الله تعالى على أهل الأندلس بِخُروج أكثرهم عنها، تفرّقوا ببلاد الْمغرب الأقصى وإفريقية، فأمّا أهل البادية فمالوا إلى البوادي، فاسْتَنْبَطوا الْمياهَ، وغرسوا الأشجار. وأما أهلُ الْحواضر فمالوا إلى الْمدن، فكان منهم أهلُ الأدب، والوزراء والكُتّاب..وفاق أهْلُ الأندلس أهلَ البلادِ في الصَّنائعِ…)). وهكذا نشأتْ حضارةٌ، زَها فيها العمران من قصورٍ ودورٍ ومدارسَ، وحدائقَ مازالت لِحَدِّ الساعة ناطقةً بتلك الْخُطى الأولى للأندلسيين، وتَجَسّمتْ فيها هندسةُ البناء والتشييد، وآياتُ الزّخرفة والنّقش والرسم والْخَط في الْخَشَب والْجِبْص. وهذه موسيقى (الآلة) أو الأندلسية، التي لَمْ تكن فنا للمتعة والتسلية، ولكن، كانت علاجا للأمراض النفسية والعقلية في مستشفى سيدي (فَرَجٍ) بسوق الْعَطّارينَ في فاس، حتى إن دولا أروبية وأمريكية أرسلتْ أطباء وصِحافِيَّين وجواسيسَ لِـ(قَرْصَنة) الطرق والوسائل الْمستعملة في العمليات العلاجية. ونُمَثِّل باخْتطاف الطبيب والْجُغْرافي (الْحسن الوَزّانْ) من قِبَل الإيطاليين، قصد تزويدهم بِمَعلومات في مَجالَيِ الطِّبِّ النفسي والْجُغرافية. وفي الشعر، نقلوا فنَ (التَّوْشيح) الذي كان ثورة على النظام الشعري السائد. وفي النثر، نَجِد فنَّ القصة (الفلسفية) و(الدينية) و(الشعبية) و(الاجتماعية) وفن (الْمَقامة) و(الرحلة) وفن (التراجم) و(الفهارس) التي تَحْتضن سِيَرَ الشخصيات الأندلسية، والعائلات العريقة، والكتب والْمُؤلفات، والْمُنوعات الأدبية. ويبدو أن الغاية من هذه التآليف، هي صيانة تراث الفكر الأندلسي، خِشْيةَ ضياعه، مثلَ الفردوس الْمفقود، فتكون الصدمة مضاعفة: فقدان الأرض، وفقدان الفكر…إلا أن هذه الإشراقاتِ الأولى، لَمْ تكن إلا إرهاصا على أن شيئا ما سيظهر في الأفق قريبا، ولَمْ تتخطّ حدودَ بدايات التأسيس..لِماذا؟..لأن هجرة الأندلسيين كانت على مراحلَ، تقدَّر بِمِائة وعشرين سنةً، أي أنّهم كانوا يفتقدون الاستقرار والتّأَقْلُمَ مع الوضع الْجديد، والتخلصَ من أثر الصدمة، ولَمْ يستفيقوا من هَوْل النكبة إلا بعد عقود طويلة!
فإلى الثلاثينيات من القرن الْماضي، والأدب الْمَغربي مازال نسخةً طِبْقَ الأصْل من الأدب الأندلسي، لَمْ يستطع أن يساير سُنّةَ الْحياة فيتطور، كسائر الآداب العربية والعالَمِية. وحتى نبين ذلك التشابه أوِالتطابق بين الأدبين، الأندلسي والْمَغْربي، سواء في الْمَضامين، أوِالأشكال والأساليب والأدوات الفنية، نورِد طُرْفةً، كمثال، وهي أن كاتبا مشرقيا، غفر الله له، كان يشتغل أستاذا في الْمغرب، فأراد أن يؤلف كتابا عن الأدب الْمَغربي، لأن كتابه الأول عن القصة الْمَغربية لقِيَ رَواجا كبيرا، ماديا ومعنويا، فماذا فعل؟..أحضر معه من مصرَ كتابَ الدكتور أحْمَد هيكل “الأدب الأندلسي” وسلخه سلْخا، إذْ عَوَّض، فقط، أسْماءَ شعراء الأندلس، ونصوصَهم بأسْماءِ الشعراء الْمَغاربة ونصوصِهم، وكفى الله الْمؤمنين شرَّ القتال!
وأصدر كتابه، فلقي ترحيبا من الأدباء الْمَغاربة، لأن الكتاب الأول لَمْ يكن موزعا في الْمَغرب. وتَمُرّ الأيام والشهور والسِّنون، وإذا بطالبين مغربيين يعودان من مصر إلى الْمَغرب، فيتفاجآن به، وعندما تأكدا من التَّناص أوالتّلاص، لا أدري، أصدرا بيانا توضيحيا، يفضحان فيه هذه السرقة. وما كان من صاحبنا إلا أن حزم حقائبه، ورحل إلى دولة مغاربية أخرى. وهذا يعطي دليلا على ألاَّفرْقَ بين خصائص الأدب الأندلسي والْمَغربِي آنذاك، لأن الثانِيَ نسخة من الأول. غيْر أن ذلك يبين من جهة ثانية، أن الْهِجـرة الأندلسية، كانت عاملا قويا في ولادة الأدب الْمَغربي.
ويُحَدِّد العلامة عبد الله كَنّونْ البدايات الأولى للأدب الْمَغربي الْحديث في كتابه، الذي ضَمّ مُحاضراتٍ معنونةً بـ”أحاديث عن الأدب الْمَغربي الْحَديث” فيذكر أنه”إذا كان تاريخ نَهْضة الأدب العربي في الشرق يبدأ من منتصف القرنِ التاسعَ عشرَ، فإنه في الْمَغرب قد تأخر إلى ماقبل نُشوبِ الْحَرب العالَمِية الأولى بقليل”..وعندما نسأله عن عِلّة هذا التأخير، يُجيب قائلا: إن الْمَغرب كان في عزلة تامّة”عن العالَمِ القديـم والْجَديد، عن أصدقائه في الشرق وجيرانه في الغرب..”!
وأمّا العوامل الأخرى، فتتجلى في هجرة بعض الأدباء إلى الدول الغربية، مثل جعفر الناصري إلى فرنسا، ومُحمد كَنّون ومُحَمد الْمَهدي الْحَجْوي إلى إسبانيا، وعبد الرحْمان حجِّي إلى إنْجلترّا…ولَمّا عادوا سَخّروا شعرَهم لقضايا الوطن، وتناولوا فيه مظاهر التقدم والتطور في كل مناحي الْحياة، ودَعَوْا إلى العِلْم والْمَعرفة والنَّهْل من الأدب الآخر. وأستشهد بِمَقْطع من نص شعري للحَجْوي بعنوان” نَحْوَ النُّهوض”:
إلـى متَى نترك التعليمَ مهجـورا
ونَحسِب العِلمَ في الإفْرَنْجِ مَحْصورا
متَى نَفيقُ وعينُ الدَّهرِ شاخِصةٌ
تقضي على كلِّ مَنْ قدْ باتَ مغرورا
هَيّوا إلى الْمَجْد يَأبْناءَ مَنْ رفعوا
للمجدِ صَرْحا بِعِلْمٍ كـان مَنْشورا
وهجرة البعض الآخر إلى الدول العربية، كالعراق وسوريا ومصر، لكن الأغلبية منهم، كانت مصرُ قِبْلَتَهُمْ. وفضْلاً عن هذين العاملين، ظهر من يدعو إلى النّهضة والإصلاح، وتطوير التعليم، السبيل الوحيد إلى الازدهار الأدبي والثقافي والْمَعْرِفي والاقتصادي. يقول مُحَمد كَنّونْ الذي جال في عدد من الدول الأروبية، وأدرك سِرَّ نَهْضَتِها وتقدمِّها وحضارتِها:
بَني قَوْمي أجيـبوا مَنْ دَعاكُمْ ولَبّوا دَعْوَتـي فالْـجَهْلُ أرْدى
نرى أمَمَ التَّـمَدُّنِ في ارْتِقـاءٍ ونَحْنُ كَأنّـنا نَنْحَـطُّ عَمْـدا
ثُمّ لاننسى الشعور الوطني العامّ بصيانة الْهوية الْعربية من مُؤامرات الْمُسْتَعْمِر، كان عاملا قويا في رحيل الطلبة إلى مصرَ لإكمال دراستهم، لأن الْمُستعمر كان يَحْظُر على طالب اللغة العربية أن يتابع تعليمه العالي، بل الْحُصول على شهادة الباكالوريا، مِمّا يعني أنه كان يسعى إلى صناعة دمى تلهَج بلسانِها وثقافتها، وتقوي شَوْكتها! وهناك في الشرق، تلقى الطلبة الْمَغاربة مبادئَ القومية العربية، التي كان الْمُستعْمِر يَهابُها، ويَعْمل على تنحيتها، ووجدوا الظرفَ مُلائِما للاحتكاك بالزعماء والأدباء والْمُفكِّرين الرواد، الْمَشارقة والْمَغاربة، كعباس مَحْمود العقاد وطه حسين…وفتحوا عيونَهُم على الصحافة والنوادي الأدبية، بل ساهَموا في أنشطتها الْمُتَنوعة، وفي الإذاعة والْجَرائد والْمَجلات، وفي الْمُحاضرات والندوات والْمُؤتَمَرات، التي كان مكتب الْمَغرب العربي ينظمها. وبالإضافة إلى كل ذلك، كانت الساحة الثقافية الْمَغربية، تشهد يوميا وأسبوعيا وشهريا نزولَ سلاسلَ من الكتب الثقافية الْمِصرية، وعروضَ رواد الأدب والفكر والفن، مثل طه حسين في مُحاضرته بتطوان عن أزمة القراءة في العالَمِ الْعربي، ومُحَمد سعيد العريان عن تطور الدراسات الإسلامية العليا في الْمَركز الثقافي العربي بـمدينة فاس، وفاطمة رشدي ويوسف وهبي في عروض مسرحية…ونظرا لقِلّة أُطُرِ التدريس في فجر الاستقلال، فقد أعارتْ مصرُ كثيرا من أساتذتِها، الذين بدورهِمْ ساهَموا في تَحْديث الأدب الْمَغربي، وأذكر مِنْهُم مُحَمّد الصادق عفيفي وعبد العزيز الأهواني ونَجيب مُحمد البهبيتي وعبد الْحَميد يونس وعائشة عبد الرحْمان (بنت الشاطئ)..فألفوا كتبا عن الأدب الْمَغربي، وعن القصة الْمَغربية الْحَديثة. وأشرف على أطاريحَ جامعية. وكان لعائشة عبد الرحْمن الفضل في اكْتِشاف الكنوز الْمَدْفونة في مكتبة القرويين، فلولاها لبقيتْ مؤلفاتٌ قيمةٌ موضوعةً على الرفوف يكسوها الغبار، كـ”رسالة الصّاهل والشاحج” للشاعر أبي العلاء الْمَعَرِّي. غير أن هذه العوامل، وإن كانت لَها أهَمِّيتها الْقُصْوى، فإنّها لن تُجْدِي نَفْعا، أوتُؤْتِيَ أكْلَها، مالَمْ تَكُنْ هناك (مطبعة) تُخْرِج عُصارةَ الفكر من الظلمات إلى النور، وتُحْيي الكتابة والتأليف والبحث. وهذا هو العامل الرابع؛ ففي سنة 1859 نقل السيد إدريس العمري مطبعةً من باريس إلى فاس، طَبعتْ في البداية الكتبَ الدينية واللغوية، ثم أحضر القاضي مُحمد الرّوداني سنة 1865 مطبعةً حَجَريةً من مصر، وصَحِبَه تقني مصري لتسييرها وتدريب عُمّال مغاربة عليها. وتبعتهما مطابع أخرى مِمّا ساهم في طبع ونشر كتب متنوعة، وظهور جرائد ومَجَلات سياسية ودينية وأدبية. فكانت حركة الطباعة، كما يقول الأستاذ زين العابدين الْكَتّاني في كتابه الرائد”الصحافة الْمَغربية: نشأتُها وتطوُّرُها”:((حافزا لكثير من أهل العلم على التأليف والنشر، فزخرتِ الْمَكْتبة العربية في كل مكان بنتاج هذه الْمَطابع)). وبدأنا نرى الْجَرائد والْمَجلات تنهَمِر تباعا على الساحة الثقافية الْمَغربية، لتفسحَ الْمَجالَ للعديد من الأقلام، سواء في الشعر أوالقصة أوالنقد أوالفن أوأحوال الْمُجتمع الْمَغربي. ومن بين الْجَرائد “العَلَم” التي تعتبر مدرسة إعلامية، لَها الفضل في تكوين صِحافيين وكتاب ونقاد كبار. ويكفي أن نشير إلى مُلْحقِها الثقافي، الذي نشر أهَمَّ الأعْمال الأدبية، وأوحى لآخرين بإصدار ملاحقَ ثقافيةٍ، مِمّا شَحَذ الأقلام، وأحْدثَ تنافسا بينها، فازدهرتِ الْحَركة الأدبية والثقافية والفكرية بصفة عامة. ولِمُناقشة كلِّ ماكان يُنْشَر في الكتب والْمجلات والْجرائد، تأسست نوادٍ أدبيةٌ في جُلِّ الْمُدن الْمغربية الكبرى، وترأسها الأدباء الكِبار. وغالبا ماكانت هذه النوادي تَحْتضن جلساتٍ ومناظراتٍ ومطارحاتٍ نقديةً، ساهَمَتْ بدورها في تَجْديد أساليب الكتابة والتفكير لدى الأدباء الذين كانوا يَحْتذون الأندلسيين. ويكفي أن نشير إلى أن الكتابة الْمغربية الْمرسلة، الْخالية من الْمُحَسِّنات البديعية، خرجت من (جلباب هذه الأندية) على غِرار (خرجت القصة من معطف كوكول) وهي قولة تتردد على الألسن، تولّدتْ عن القولة الأُمِّ للروائي ديستويفسكي:((كلنا خرجنا من معطف جوجول)) ويقابل الْمِعطف الروسي الْجِلْبابُ الْمَغربي!
لكن، ينبغي أن ننظر إلى هذه الْحركة عَميقا، فإنْ كانت تبدو في الظاهر علميةً، أدبيةً، أي مُجَرّد مُسامرات، فإنّها في باطنها كانت تسعى إلى لَمْلَمة الأدباء والعلماء، وتوحيد آرائهم وآمالِهم، للذود عن الوطن وحِماية اللغة العربية، لأنّها تُلْحِم أبناء الوطن الواحد، وتوحِّد أحاسيسَهم. ولاينبغي أن نغفُل عاملا آخر، تَمثّل في تأثُّر الْمَغاربة بالأدباء الْمَشارقة، إذ كانوا مثالا حيا يُقْتدى، بل إذا توفِّي أحدُهم هناك، يُقامُ له تأبينٌ هنا. وعن هذه الْخِصِّيصة، يقول الدكتور مُحمد السولامي في كتابه”النثر الأدبي الْمَغربي في عهد الْحِماية:((ظل الشرق العربي، وخاصّة مصرَ، رافدا هاما من روافد الثقافة الْمَغربية، وظلت الْجامعات والْمَجالس العلمية والْمَكْتبات قِبْلةَ الْمُهتمين بالثقافة من طلاب وأدباء وعلماء مغاربة. ولَمْ تَخْلُ جُلُّ الرحلات من حديث عن لقاءات ثقافية مع علماء الْمَشْرق، بل قد يكون الْهَدف من الرحلة كُلِّها علميا بَحْثا “. وكان اهْتِمام الْمَغاربة بِما يصدُر عن إخْوانِهِم بِالْمَشْرق كبيرا جدا، حتى قيل إنه”لاتَمُرُّ عشرة أيام على طبع أي كتاب بِمِصرَ إلا وتَجِده لدى الكتبيين بسائر الْمُدُن وخُصوصا فاسَ والرباطَ ومُرّاكشَ، أما جَرائد مصر ومَجلاتُها فهي مِلْءُ الأيْدي والْخَزائنِ”وبذلك، بدأ الْمَغاربة يُدْركون أن الأدب لاينحصر في نظْمِ الشعر فقط، إنّما يشمل القصة والرواية والْمَسرحية والنقد، وأن قضايا الأدب لاتقتصر على الروحانيات والإخوانيات والغراميات والوصفيات فقط، إنّما تشمل الذاتيات والوطنيات والاجْتِماعيات والإنسانيات، وسواها كثير…وبدأ الشعراء يرحلون من وادي عبقر إلى ليالي شهرزاد، أي من الشعر إلى القصة، بل إلى فنون ماكان لنا بِها صلة، ولَمْ نكنْ نَسْمَع بِها كأدب الأطفال. وتَحَوّلت العناية بقواعد اللغة العربية إلى النقد الأدبي والفني، عبر تدريس مناهج النقد العربي القديـم والْحَديث، والنقد الغربي الْمُعاصر في الْمَدارس الثانوية والْمُؤسّسات الْجامعية، ولا يعنِي هذا أن الشعراء تَخَلّوْا عن نظْم الشعر، بل بالعكس، نَجِدُهُمْ تأثروا
بدورهم بالْحَركة الشعرية الْحَديثة في الشرق، وواكبوا اتِّجاهاتِها.
أصبح عالَمُ الإحيائيين بالنسبة لشعرائنا قِبْلةً يَحُجّون إليها كلَّ حين. فالعالَم الإحْيائي في نظرهم يَمْتاز ببعْثٍ حقيقي لأساليب الشعر، وعناصر اللغة، بعد فترة طويلة من الْجُمود. كما يَمْتاز بكسْر الْحاجِز بين القديـم والْجَديد. فما فعله البارودي وحافظ وشوقي هو إعادة النَّبْض إلى عروق الشعر، والْحَيَويّة إلى اللغة والبلاغة بعد عصور من الْجُمود والتَّحَجُّر”. وخير مانستشهد به قصائد الشاعر الكبير مُحمد الْحَلْوي، التي عانقت الإنسان وقضاياه الذاتية والاجتماعية والوطنية موضوعا، وتلفّحتْ بالتّخييل والتّصوير والترميز، والسرد والْحَكْي والتعبير الرقيق والأسلوب القوي شكلا، حتى إن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، قال عنه مُعْجبا: “ماسَمِعتُ مثْلَ هذا الشعر لافي الشرق ولافي الغرب”!..وبعد الاستقلال، ستزدهر حركة الترجَمة بشكل كبير، فترجم الدكتور مُحمّد بَرّادَة كتبا لرولان بارْثْ وميخائيلْ باخْتينْ، وساهم في الْحَركة النقدية والقصصية والروائية والسيرية بنصوص أثارتْ جَدَلا ونقاشا بين الأدباء والباحثين، ومنهم من عَدّها نَماذجَ تطبيقية للمنهج النقدي الذي يتبنّاه، فكأنه يكتب ويترجم نظريات نقدية، ويستشهد عليها بنصوصه!…وإلى جانبه، ظهرتْ كوكبة من القصاصين والروائيين والنقاد الذين يتبنّون الاتِّجاهاتِ الْحَديثةَ في الأدب، فرأينا الأستاذ نَجيب الْعُوفي في”درجة الوعي في الكتابة” يَرْصُد الوعي الأيديولوجي عبر الْمَنهج الواقعي الْجَدلي في نصوص شعرية وقصصية وروائية ونقدية، والأستاذ إدريس النَّاقوري، قبل أن يُطلِّق النقد ويُؤْثِر العزلة، في”الْمُصطلح الْمُشترك” يَحْذو حَذْوَ الأول، والناقدين إبراهيم الْخَطيب وعبد القادر الشَّاوي يسلكان النقدَ الاجْتِماعي التاريـخي، والأستاذ سعيد يَقْطين في كتابه”الْخِطاب الروائي” يشتغل على أدبية النص ودلالاته السردية. وفي الشعر، قاد الشعراء عبد الكريـم بن ثابت ومصطفى الْمَعْداوي وأحْمد الْمَجّاطي ومُحَمّد الْخَمّار الْكَنّوني وعبد الكريـم الطَّبّال…حركةَ الشعر الْجَديد بِما لَها وماعليها!…وفي القصة والرواية والسيرة الذاتية، برز الأدباءُ عبد الكريـم غَلاَّب وعبد الْجَبار السْحيمي ومُحَمّد زَفْزاف وأحْمد بوزْفورْ ومُحمّد عز الدين التَّازي وخناثة بَنّونَة…وفي أدب الأطفال شَهِدنا أعمالا لكلٍّ من أحْمد عبد السلام الْبَقَّالي، وبَنْسالَمْ الدَّمْناتي، وحَميد السَّمْلالي، وعبد الفتَّاح الأزْرق، وعلي الصْقَلِّي، وأبوبكر الْمَريني..وفي الكتابة الْمَسرحية عبد الكريـم بَرْشيدْ وعبد الرحْمان بن زيدان وحسن الْمنيعي ومُحمّد تيمْدْ ومُحمّد مَسْكين وحوري الْحُسَيْن..وبطبيعة الْحال، فإن القائمة طويلة، لَمْ نذكر منها إلاالقليل القليل، وإلا لو أردنا أن نوردَ كافة الأسْماء، لَمَا اتَّسَعَتْ لَها صَفحات!..ويبدو أن دورا آخر لـ”دار الفكر”التـي كان يسيرها الدكتور مُحمّد عزيز الْحبابي، سيساهم في تَجديد الأدب الْمَغربي، إذ كانت جَنَباتُها تَحْتضن لَفيفاً من الأدباء والْمُفكرين، يلتقون كل أسبوع ليناقشوا القضايا والإشكاليات التي تُجابه النّهضة الثقافية بالبلاد. وستتطور هذه الدار لتصبح في عام 1961 (اتِّحادَ كُتاب الْمَغرب) يترأسه الْحْبابي نفسه، ويُصدر مَجلة”آفاق”مِمّا أتاح فرصا لأدباء الْمَغرب للالتقاء بأدباء الْمَشرق، والاطلاع على تَجاربِهِم، وعَقْد شراكات واتِّفاقيات تبادل الزيارات، وتنظيم الأنشطة الثقافية، هنا وهناك!
والْخُلاصة أنّ الأدب الْمَغربي شَهِد ثلاث مراحل طورته: الأولى، من بداية القرن الْماضي إلى 1956 كان فيها، من حيث الْمَضمون، الصوتَ الْمُعبِّرَ عن قضايا الوطن في التحرر من الْمُستعمِر، ومن حيث الشكل الفني، لَمْ يشُذَّ عن السائد في الكتابات الْمَشرِقية؛ ففي القصة والرواية والْمَسرحية، تبنّى حضورَ البطل الْمِحوري، وصراعَه مع قوى الشر، وتنامي الْحادثة من مدخل إلى أزمة إلى نِهاية مضيئة. وفي الشعر، غلبتِ الْخَطابة والْحَماسة والتشبيه والْمُباشَرة في الأداء. كما أن النقدَ انصبّ على إظهار توظيف اللغة والصياغة والتعبير البلاغي في النصوص النثرية والشعرية، فكأن الأدب الْمغربي في تلك الْمَرحلة كان يتتلمذ على الأدب الْمَشرقي. وبعد الاستقلال، وخصوصا منذ 1960 بدأ الأدب يَجْنَح نَحْوَ القضايا الاجْتِماعية والقومية العربية، كالقضية الفلسطينية. ويبتعد مسافة عن الأدب الْمَشرقي، ليقترب مسافة من الأدب الغربي، فنَجِد بعض الأدباء يستعيرون منه طرائق الكتابة، والْمَناهج النقدية، والأساطير، ويُحاوِل أنْ يُمَغْرِبَها، كأسطورة سيزيف، مثلا، ليوظفها في تصوير كَدْح الْعامل في توفير لقمة عيشه، وهكذا..أو يستلهِمَ من التراث الشعبي مواقفَ بطولية، فيُضَمِّنَها نصَّه الشعري، وكَمِثالٍ، قصيدة رائعة للشاعر أحْمَد الْمَجَّاطي بعنوان: الفروسية. ونتيجة لِهَذا الْمَيْل للأدب الغربي، نشأ صراع بين أدباء ما قبل الاستقلال وأدباء ما بعده، وكلٌّ منهم يُكيل للآخر تُهَما، لا داعِيَ لسردِها. وحاليا، فَتَرَ الصِّراع، ولَمْ تعُدْ تلك القضايا تشكِّل هَمّا أساسيا، كما أن غالبية الأدباء الْمُؤَسِّسين، إما رحلوا وإما صمتوا، ولَمْ يَفْضُلْ منهم في ساحة الكتابة إلا القليل، وظهر جيل آخر من الأدباء، يُبْحِر في ذاته، عبر التخيل الْمُلْتحِم بالواقع، ليبرز رؤيتَه للعالَمِ، ويعتني باللغة، أساسا، باعْتبارها حَمّالَةَ رُؤى فكرية ونفسية. وأستشهد بالكاتب النشيط مصطفى لغتيري الذي قال عن تَجْربته في الكتابة: كلما توغلت في ذاتي أكثرَ، عرفت العالَمَ من حولي بشكل أفضل!.
العربي بنجلون
أديب وناقد مغربي