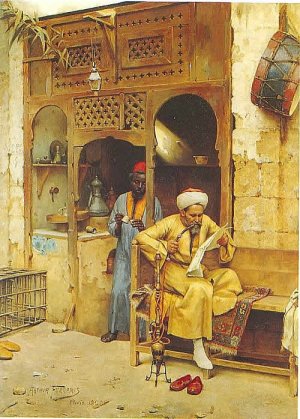الإهداء إلى صاحب الصبوات والكبوات الليلي النهاري إلى من حَوَّلَ جراح الذات إلى جراح للكتابة الكاتب الراحل محمد شكري
وقت للوقت أيها الذاهب في طريق لا جدوى من ذهاب في طريق. لا حاجة لبكاء على حريق. لا ربيع ولا خريف فالأزمنة كلها والفصول كلها والتواريخ كلها تأتي إلى زمن الكتابة. ولا حاجة للندم على شيء، أو تبرير ما لا تبرير له، أو الدفاع عن "زمن الأخطاء"، فقد مضى الوقت فلا أرباح ولا أرباح ولا خسارات، ولا هزائم ولا انتصارات، وما بقي من شيء غير وجوه الصحاب، أراها الآن في البرازخ، بكل الكلمات المبعثرة وأحاسيس الحسرة وطفرات الدموع، ناصعة لا تزول في وقت هذا الزوال، فلا حاجة إلى المراثي، ولا حاجة إلى تفلسف لا جدوى منه لمعنى الحياة، فهي الحياة على بساطتها تستحق أن تعاش. هكذا العمر الجميل يقصر في سويعات الدهشة التي تحاول أن تسترجعه، مبشرة بزهو محتمل بميلاد مدن وتعايش أصحاب وقرع أجراس أو هو وخز عذاب ذاكرة خصبة تشهد على الذات ومعيشها الذي يتبدد لحظة بعد أخرى فلا تبقى منه غير الذكريات. وقت للكتابة هو الأطول لا بطول العمر أو بقصره، وإنما لأن الكتابة لا تستغرق وقتها وحسب، بل أوقاتا أخرى من قبل ومن بعد، محسوبة عليها، وهي أوقات خارج الوقت. وقت للبذخ والضحك والطعام والشراب والحديث والثرثرة، يتخلله وقت للموت دون أن نشعر به وهو يحل في ذلك الوقت. وقت للكتابة من خلاله نعيد للعالم نصاعته ومضاء حد السيف الذي به انحفرت الطعنة في أماكن حساسة وليس لذلك الوقت غير أن يجعل من الكتابة قلقا يوميا، باعتبارها كتابة قلقة، وباعتبارها استرجاع واستحضار للأنا ومجتمعها وتاريخها وانحدارات كل ذلك نحو المغيب. وقت للكتب بما هي مستودع للأسرار. وقت للريح والعواصف والأعاصير. وقت للمدن باكتشافها وشهواتها وتصدعاتها التاريخية وأسطوريتها التي تتماهى مع الواقع، فيها نعيش، نذمها ونحبها كثيرا، وفيها نختلس زمننا الضائع، سواء في معيشنا فيها أو في جعلنا لها موضوعا للكتابة. وقت للبرهنة على لاشيء يبرهن عليه بمنطق فهو وقت للمعيش الغفل، البسيط والعادي، وحيث لا يمكن أن نبرهن على أنه زمن للأخطاء، لأننا ما كنا نعيش في زمن غير زمن الأخطاء. وقت للطفولة وحيث يحسب كل أحد أنه قد عاش قسوة الحياة في الطفولة فيتنافس المتنافسون في سرد أنواع العذاب التي لاقوها في طفولتهم، لكنهم يتنافسون أيضا في أن أي عيش قد عاشوه بعد ذلك لم يكن أغنى وأبهى وأكثر تأثيرا على الحياة والذكريات. وقت للعبور، وحيث امرأة خائنة أو كتاب فاشل أو حانة منذورة للصمت وحيث لا صحاب ولا موسيقى، فهو وقت للعبور، بعده يأتي وقت الحضور. وقت يسكن في المحن، وفي الجراح الشخصية التي نكابر من أجل ألا تعطفنا فتحول إلى أناس غير فاعلين، غير ممارسين للوقت. وقت للذات، فذواتنا نحن، رتبتها المحن، فأعدنا ترتيبها في الكتابة، لا عبر البوح وحده، ولكن عبر القبض على تجليات المحن في الذاكرة الجمعية، والتاريخ، ورصيد القلق الممكن رغم الضحك والسخرية وحب الحياة. وقت للمدينة والمقبرة، وللرسائل والصور وللبحر والبر. وقت لموت الأصدقاء، محمد تيمد، محمد الكغاط، ومحمد زفزاف، كما عاشع محمد شكري فعاش فيه موته، ولذلك كان يضحك، ويقول لنا الموت طائر، لابد أن يتخطفنا ولكن آخر من سيتخطفه منا هو هذا، ويشير إلى صديقنا القديم العربي اليعقوبي، ليقول إنه قديم قدم الطوفان وهامان. وقت لاستشراف الموت، وحيث تبقى المدن شاهدة علينا، وحيث لا أثر على الطريق إلا ما تراه عيون تتجاوز رؤية المرئي إلى رؤيا الكشف والتجلي. وقت للطفولة التي نتجاوز بؤسها بطفولة أخرى نعيشها في الكهولة أو الشيخوخة. وقت لسطوة الكتابة، بما هي آثار خطى على طريق، أزمنة في زمن واحد، عنف للواقع والتخييل، لغة للغات المتعددة، أصوات نجد فيها الذات حتى وإن لم تكن أصواتنا نحن. أمر غريب يحدث في الكتابة السردية، وهو أنها بقدر ما تضاعف من ياة أبطالها فهي تذهب بهم نحو الموت. بخلاف المنطق الشائع، فالكتابة تجعل من موتهم حياة، كما كانت قد جعلت من حياتهم موتا، ربما، وهذا هو حال قصة محمد شكري "بشير حيا وميتا". شكري ليس كأبطاله، فقد عاش الحياة في الحياة وهو يعيش الحياة في الموت، لأنه أسطورة شخصية، ولأن المقبرة في كتاباته كفضاء كانت فضاء للعيش واختلاس المتع، وحتى "التابوت" كما في قصته التي تحمل نفس العنوان، لم يصنع إلا لموتى أحياء، أو لأحياء أموات، أما هو فقد عاش متمردا على التوابيت، فهو البطل الحقيقي ل "مجنون الورد"، وهو صديق الحيوانات والنباتات الجميلة، وهو الطاهي الفنان، وهو فنان الحكاية، ومبدع الوقت ليكون لصالحه مهما عصفت الريح أو أعصرت الأعاصير. هل يأتي الوقت ليناسب وقتا غير الوقت، وحتى أقول فيه كلاما كهذا لمحمد شكري، فيقول رأيه فيه، متى وأين، وكيف، ولماذا لا يقول رأيه حتى وقد تركني وحيدا؟ تلك هي محنة الوقت، التي تضاف إلى محن الذات بتفردها وجمعيتها، وذلك هو قلق الكتابة الذي تحاول أن تقبض عليه، لتؤجج من نار الأسئلة.
المذكــــــــــــــــــــــرات
(1)
محمد شكري
كاتب من زماننا
سيرة للوقت
وقت أول
تعرفت على محمد شكري في نهاية الستينات، وفي سنة 1969 بالتحديد، وأنا طالب بكلية الآداب بفاس، في مهرجان ثقافي كانت قد نظمته إحدى الجمعيات بمدينة القصر الكبير. قبل ذلك اللقاء الأول كنت قد قرأت له بعض القصص القصيرة التي كان قد نشرها بجريدة العلم، وحسبته كاتبا تونسيا من كتاب الموجة الجديدة في تونس، وحيث كان بعض الكتاب التونسيين ينشرون قصصهم بنفس الجريدة، وكانت القصة القصيرة العربية يومها تعرف تحديثا على مستوى الأشكال وارتيادا لممكنات تخييلية جديدة. لكن محمد شكري وأنا ألتقي به لأول مرة وسط حشد من الكتاب المتظاهرين بمدينة القصر الكبير، بدا وكأنه يعرفني من زمان، فلم نحتج إلى مقدمات، بل صرنا صديقين ومنذ أول وهلة. والمظاهرة كان سببها احتجاج على باشا مدينة القصر الكبير الذي كان قد اعترض على دخول الكاتبين اللامعين الأستاذين عبد الكريم غلاب ومحمد إبراهيم بوعلو لتراب المدينة ومشاركتهما في (المهرجان) الثقافي، فنظمنا المظاهرة، وسرنا فيها محتجين على هذا المنع، متجهين نحو مقر باشوية المدينة، وفي الطريق كان لقائي الأول بمحمد شكري، الذي فاجأني بجرأته وهو يقول لي: ـ يمكنك أن تمرض، وأنا أدلك على العلاج. لم أفهم أي مرض يقصد، فنبهني إلى وجود حي للبغايا في المدينة، وقال لي: ـ إذا ذهبت إليه ومرضت، فلا تخف، أنا أعرف الدواء الذي يشفي من تلك الأمراض التي نلتقطها من البغايا. والحقيقة أنني لم أكن على رغبة أو تجربة بالموضوع. لكن محمد شكري كان ضحوكا، حيويا، يسير في المظاهرة قليلا ثم يتوقف ليتبادل الحديث الصاخب مع هذا أو ذاك من الكتاب، وخاصة مع العزيز الراحل محمد الخمار الكنوني ، الذي كان أستاذا لنا بكلية الآداب بفاس، وكان خجولا مثلي، فتجرأ عليه محمد شكري بحديثه عن البغايا، ذاكرا نتفا مما قرأه في الأدب العالمي عن نساء الشوارع وعن المواخير.
وقت لليليين والنهاريين
في صيف سنة 1970 جئت إلى طنجة فأقمت في فندق بالسوق الداخل، والتقيت بمحمد، فأخذني إلى عالم الليليين في المدينة، كما كان يسميهم، فهم أناس لا تراهم إلا بالليل، ينامون نهارا ويسهرون ليلا. واقترح علي أن أشتري فراشا وغطاء ومخدة وحصيرا من (سوق بره) بعد أن حسب كم سأدفعه للفندق خلال إقامتي وكم سيكلفني شراء هذه اللوازم فوجد أنني سوف أستفيد، فسأقيم في بيته، وذكر لي إنه كان قد فعل نفس الشيء مع الراحل العزيز محمد زفزاف، الذي جاء إلى طنجة في صيف مضي، فلما عاد في صيف آخر بعده ليستثمر ما كان قد اشتراه من فراش وغيره وجد شكري قد باع تلك الأشياء، ونبهني إلى أنه سيبيع ما سأشتريه خلال السنة، إذا ما احتاج إلى مال ليشرب به، وهكذا اشتريت تلك الأشياء وأقمت معه في شقته إياها بحي الروكسي، يوم كانت سطيحتها تطل على البحر، وقبل أن تصعد عمارات الإسمنت لتجبه عن السطيحة. كان شكري قد قدم لي في "مقهى الرقاصة" الرجل العجوز صاحب المقهي، السي العلوي، الذي كان يسميه الأب الروحي، وفي كل صباح كنا نزور السي العلوي ليتكلم معه محمد بأدب جم، ويأخذ منه ورقة عشرة دراهم، كما كنا نمر في المساء على فندق بجوار مقهى السنطرال يصعد لوحده أدراجه قافزا بخفة جسده المعهودة فيعود بعشرة دراهم أخرى، فهي عشرون درهما في اليوم يستدينه من السي العلوي ومن صاحب الفندق يسددها في نهاية الشهر عندما يستلم حوالته، وبالعشرين درهما، إضافة إلى ما أخصصه لمصروف كل يوم، جبنا طنجة حتى لم يبق فيها مكان لم نره.
رياح طنجة
زرت محمد شكري عدة مرات في فصل الشتاء، فكنت أكتشف شتاء طنجة الذي يختلف عن صيفها. لكن ما أذكره هو أننا عندما كنا نعود للمبيت في شقته، فقد كانت الرياح تزلزل العمارة. ريح عاصفة تصيب بالفجع وتؤرق حتى بعد سهر وسمر، فيستعصي علي النوم بينما أجد محمدا بجواري نائما فإن أشعلت الضوء أرى على وجهه سمات طفولية وكأنه لا يستعيدها إلا وهو نائم، وحيث يتحول وجهه إلى وجه طفل. وكنت أضطر للسفر في الصباح الباكر، غير نائم ولو للحظة، فينصحني محمد بأن آخذ معي مفتاح باب العمارة، لأفتح الباب، ثم أضعه في صندوق بريده، فأخرج لمواجهة رياح طنجة في ذلك الفجر، وكأني أسمع صوت محمد يقول لي: ـ إذا أردت أن تواجه هذه الرياح، فعليك بأحد أمرين: إما أن تحاول نسيانها، تماما وكأنها غير موجودة، أو أن تصبح ريحا مثلها فلا تنال منك.
محمد لا يحب النصائح من أحد
وأٍمعه يقول هذه ليست نصيحة، فلا أحد ينصح أحدا في رأيي. كل الذين نصحوني رميت بنصائحهم في القمامة. بعضهم أغضبوني برسائل تحتوي على نصائح. علي أن أكف عن السهر. علي أن أسافر. علي أن أنظم علاقتي برفاق الليل. علي أن... هؤلاء يمثلون دور الأب في حياة الآخرين، ,أنا قتلت أبي بالمعنى الرمزي، ولا أسمع إلا إلى تلك القطط التي تموء داخل رأسي. وقت لتأمل الكتابة وتذكر الأصدقاء الكتاب وكنا نجلس في السطيحة في بعض الأصباح، نشرب القهوة وندخن، ونتحدث في قضايا الأدب والكتابة، وكان محمد يدقق معي في مسألة الكثافة اللغوية، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب البرقي، فلما عرضت أمامه ما كان قد كتبه الناقد الأمريكي (كارلوس بايكر) عن أسلوب (همنغواي) الذي يعتمد على الاقتصاد اللغوي، والجمل التلغرافية. وجدته وقد قرأ الكتاب. وكتاب (بايكر) كنت قد استعرته من المكتبة المصرية بالبطحاء، فجاء من استعاره مني وسطا عليه فلم أتمكن من رده للمكتبة. وخلال تلك الجلسات وجدت في محمد شكري قارئا حصيف الذاكرة، فقد قرأ ثلاثية سارتر دروب الحرية، إضافة إلى متن روائي كبير مترجم، وكان يعلق على حياة محمد زفزاف ونصوصه، فيسلم جسده للفراش في حركة تمثيلية وينام نومة يُدخِل من خلالها ركبتيه في بطنه ويحمي رأسه بكفيه، فيقول لي: ـ هكذا كان ينام محمد زفزاف. ثم يعلق: ـ هي نومة من عانوا من اليتم، ومن الخوف من الاغتصاب خلال النوم. أظل أنظر إليه فيقول: ـ هكذا كنت أنام في الطرنكات، بجوار الفرن. ثم يضحك ، ويرسل ذراعيه في الهواء، ويقول: ـ ولكن محمد زفزاف كان لا يقترب من الماء. كان لديه خوف من الماء، فهو إن أراد غسل وجهه يبلل رفي إبهاميه من الصنبور ويضعهما على عينيه محاولا إزالة ما قد يكون عمشا. ويضحك، فأذكره بجوارب الأصدقاء، وأحذيتهم، فيقهقه ويقول لي: ـ كنتُ صارما. إما أن يغسلوا أرجلهم أو يغادروا البيت. وأُذكره بالديودرون الذي كان يرش منه على أقدام بعض الكتاب من زواره، فيضحك ويقول: ـ لا أحب الروائح الكريهة. أنا أستحم أحيانا مرتين أو ثلاثا في اليوم، وأتعطر، من أجل ألا أشم رائحة كريهة من جسدي، فلماذا يجبرني الآخرون على أن أشم روائحهم الكريهة؟
أبطالي تجريديون
كنا نقرأ لبعضنا نصوصنا الجديدة، وكان يضحك، ويقول لي: ـ أبطالك تجريديون، لا يأكلون ولا يخرأون، ليست لهم أسماء كباقي كعباد الله. وكنت أرد عليه: ـ إن أبطالك لا يفعلون شيئا غير أنهم يأكلون ويمارسون الجنس ويخرأون. فكان يعجبه جوابي، ونضحك، ونستحضر كتابات محمد زفزاف وعبد الجبار السحيمي وذكرياتنا معهما ومع غيرهما، فكنت إذا ما ذهب اسما يقول لي : ـ لا. هداك بخيل سقرام. فيحدثني عن الكاتب الأمريكي وليام بوروز الذي جاء إلى أصيلة فاكترى بيتا أراد أن يملأه بماء البحر ليستحم فيه، فاكترى من بنى سورا على الباب وهو في الداخل، كما اكترى فتيانا كانوا يملأون السطول من ماء البحر ويصبونها في الداخل، لكن البيت تهدم قبل أن يسبح وليام بوروز في ماء البحر وهو في غرفته. حكايات كانت تبدو لي من قبيل الخيال، وكان محمد يحلف بالله العظيم أنها وقعت بالفعل.
وقت للصداقة
في ذلك الصيف، صيف سنة 1969 ، أحسست أنني قد كسبت صديقا مغايرا لأصدقائي في فاس والرباط والقنيطرة، وأذكر أننا لم نتخاصم، وخلافاتنا كانت صغيرة، ولما كان ينفد ما معي من مال كنا نذهب إلى (الروبيو) يوم كان صاحب دكان بقالة رائج في حومة الروكسي، فأعطيه شيكا مؤجلا وفي الحال ينظر (الروبيو) في مبلغ الشيك فيصرفه لي. لم يبتزني محمد أبدا، ولا كان لئيما فلم نمل من أيامنا مع بعضنا، وكان قد حدثني عن جرحه العائلي، بتفاصيل كثيرة لم يذكر منها غير القليل في (الخبز الحافي) الذي كتبه فيما بعد، وحدثته عن جرحي العائلي أنا أيضا، فحدثني عن حرج محمد زفزاف العائلي، وقال لي: ـ هل كان قدرنا هو أن نولد هكذا، بآباء ولكننا أيتام؟ ثم كان يستدرك، ويستمد قوة من الكائن وهو يستقل ويعيش والآن صار يكتب، فيحدثني عن قتل الأب، رمزيا، وكان يكررها ويشدد عليها، وكان والدي وقتها ما يزال حيا ولكني لا أراه ولا يراني، وأما محمد فكانت أخته (رحيمو) تشغل حديثه، وكان يحدثني عن أخيه عبد العزيز، وعن أخته الصغرى مليكة. بعد ذلك الصيف تبادلنا كثيرا من الرسائل، فكان في رسائله يكتب ما هو أشبه باليوميات، ولأنها ضاعت مني، فأنا أتذكر منها أنه كان يبدأ من الصباح، وبتاريخ اليوم، فيقول إنه خرج إلى السوق الداخل والتقى بفلان وذهب معه إلى المكان الفلاني ثم يحكي عن سكره وعمن التقى بهم من الرجال والنساء، وإن ضاجع امرأة فهو يصف كل شيء عن لحظة المضاجعة، ويجعلني أتذكر عبارته التي كان يحلو له أن يرددها: ـ قضينا ليلة ملوكية. ليلة أسطورية. ومن ذلك ما رواه عن امرأة تعرت له فملأ ما بين نهديها بفواكه كان قد قطعها قطعا صغيرة ثم صب عليها من الخمر فأخذ يأكل الفواكه ويشرب الخمر من نهدي المرأة، والخمر تندلق إلى ما يقارب سرتها، وهو يشرب.
وقت للرسائل
والرسائل كانت تتحدث عن أيام الإملاق، فكان يبعث لي بصور له مع كلاب استأجره صاحبها الأجنبي ليجعلها تتجول على الشاطئ، لكنه كان يكتب على الصورة: ـ أنا وكلابي. ثم يقول في الرسالة إن الكلاب أفضل من صاحبها.
وقت لــ "جوبا"
بعد ذلك سوف أفهم لماذا كان قد عاش قصة طويلة مع كلبه "جوبا". فقد اصطاده من شاطئ طنجة فطوقه من عنقه بحزام سرواله الجلدي وجاء به إلى شقته. أطعمه وطلب من فتحية أن تغسله بماء دافئ كان قد أذاب فيه محلولا صيدليا لمحاربة الطفيليات، وألفه "جوبا" الذي كان يُخرجه معه أحيانا إلى شارع باسطور، وهو يُعَوِّدُه على أوامره: ـ اجلس. ـ انهض. ـ تعلم كيف تكون هادئا حينما أتكلم مع الآخرين. ـ هيا بنا. لم يكن "جوبا" تعويضا في حياة محمد، بل جزء من علاقة ممكنة، تتحقق في أرفع مستوياتها مع حيوان، أو نبات، أو موسيقى. فشكري كان يحب النباتات التي طفحت في سطيحة منزله، وكان له كنار يسميه "موزار"، وأما السناجب التي وضعها في قفص كبير فكانت تنط وهو يتكلم معها. لذلك فقد غضبت من أحد مرسي الفلسفة وهو يحلل علاقة شكري ب"جوبا" على أساس أنها علاقة تعويضية، وسألته بماذا يعوض هو، وعن ماذا، ومن كلفه بتحليل شخصية محمد شكري.
تذكرة في القطار
وخلال السنة الدراسية، اتفقنا على أن أبعث له بحوالة بمبلغ مائة درهم، ليشتري تذكرة القطار، وشرب في حانة القطار، فيومها كانت بالقطار حانة، عل أساس أن أستقبله في المحطة، ونعيش عيشا آخر في فاس. وبالفعل، فقد خرج محمد من المحطة وهو يثرثر معي كأني كنت معه، ودون أن يسلم، فقد بدأ يحكي عن الرحلة، وأنه التقى في العربة بالحاجة (حاء) المعروفة بأغانيها الشعبية التي كنا نراها على شاشة التلفزيون بالأبيض والأسود، فانتقل معها إلى الحانة، وهناك قبلها في فمها، بالرغم من أنها عجوز فقد قبلها.
وقت لجدتي لالة أم كلثوم
وفي بيتي بحومة الدوح بفاس كانت جدتي (لالة أم كلثوم) تزورني من حين لآخر، فتعرف عليها وكانا يقضيان الساعات في الحديث وتبادل السجائر، فقد كانت تدخن (فافوريت) وكان هو يدخن (كازا سبور)، تعطيه من سجائرها ويعطيها من سجائره، وهو يحدثها عن هجرة أسرته من الريف في أعوام الجوع، وهي تحدثه عن أمها التي كانت قد قطعت بمص أهدابها الطويلة حتى لا يراها زوج أمها فيطمع فيها، فكنت فرحا بحديثهما وإن أشعرني بأنني لاشيء في وجودهما، ولقد ظل محمد وحتى آخر وقت من حياته يسألني عن جدتي (لالة أم كلثوم)، وفي مرات كثيرة كنت أخبره بأنها كانت قد ماتت، فتبدو الفجيعة على وجهه، وحالما نلتقي مرة أخرى يسألني عنها فأخبره من جديد بأنها ماتت، فيعود لتظهر الفجيعة على وجهه من جديد.
السي الطنجاوي
كنت خلال زيارته تلك أذهب إلى العمل في ثانوية النهضة، وأتركه في البيت، ومرة قبل خروجي سألني عن الطريق إلى الثانوية، فوصفته له، وحال خروجي من الثانوية وهي ثانوية للبنات، وجدته واقفا ينتظرني، فتجمعت حوله التلميذات، وقلن له: ـ أهلا بالسي الطنجاوي. وهي عبارة سحرته فأخذ يرددها لسنوات حينما نلتقي. لم يعجبه شعراء فاس وكتابها الذين عرفته عليهم، فكان يبدو متضايقا ومتبرما منهم، وكان يقول لي عن شاعر التقينا معه في حانة فطلب مني أن أدفع عنه ما شرب : ـ قد شعره قد خلاصه.
جون جونيه في "المنزل".
قبل ذلك، وفي بداية السنة الدراسية لعام 1970، كنت قد عينت مدرسا بقرية المنزل، فجاءتني رسالة من محمد شكري يخبرني فيها بأن (جان جونيه) يوجد في المنزل. وبالفعل، فقد كنت قد انتبهت خلال المساءات التي كنت أتجول فيها في الحقول إلى ذلك الأجنبي الكبير الرأس البارز العينين، فعلمت أنه هو (جان جونيه) فلما بحثت عنه لدى أقارب عز الدين، سميي، أخبرت بأنه غادر. وسنلتقي أنا ومحمد ليحدثني عن مذكراته التي كتبها عن (جان جونيه) وكيف التقاه صدفة في طنجة، وفي السوق الداخل بالتحديد. ثم حدثني عن لقاء آخر له تم بالصدفة، مع (تينسي وليامز) الذي وصفه بأنه كان مترفعا بينما زوجته هي التي كانت تتعاطف مع الشاب محمد شكري وتصغي إلى أسئلته الأدبية، وقال لي إنه قد نفذ إلى قلبها ومن حيث طلب منها أن تمد له راحتها، فقرأ لها ما فيها من غيب، وبشرها ببعض البشارات، وأما (تينسي) فكان لا يعيره اهتماما، لكنه تعقبهما، حتى وصل إلى مبتغاه.
الشاعر خوليو في طنجة
وكان يحفل كثيرا بشاعر إسباني يقيم في بيت يوجد في الزنقة المقابلة تماما لمقهى السنطرال، اسمه خوليو، وقال لي إنه قد أخذ إلى بيته كلا من زفزاف ومحمد بوخراز وآخرين، ووعدني بأننا سنزوره، لنتحدث عن الشعر العالمي، ونشرب، وإن وجدنا بنات من عادة المضيف أن يزهد فيهن فقد نضاجعهن وهو يدفع. لكن حينما دخلنا الزنقة وطرق محمد شكري الباب أطل علينا رأس كبير من النافذة، لرجل لعله كان حليقا أو أصلع، فتبادل كلمات بالإسبانية مع شكري، وقال لي محمد: ـ هيا بنا. إنه لن يستقبلنا، فلديه حفل خاص. قلت: ـ وما هو هذا الحفل الخاص؟ قال: ـ سبق لي أن حضرته، فهو يدعو فحولا لمجلسه، ليمارس من الخلف معهم واحدا بعد الآخر. وسألته: ـ وأنت، هل كنت من الفحول. بدا غاضبا وقال : ـ لا. أبدا. كنت شاهدا على الحفل.
قابلية المعاشرة
وبالرغم من الأجواء الإباحية التي كان قد عاش فيها وتحدث عنها، فقد عرفته متخلقا بأخلاق أهل الريف، كرامته هي دائما موضوع تشدد وهي ما لا يتسامح فيه، على لطف في المعاشرة وحب للحياة وصخب في الذاكرة، فما كان بخيلا ولا لئيما بل كان ضاحكا للحياة التي افتقد الفرح بها في صباه وبداية شبابه، فكأنه كان يعوض ما افتقده باستثمار كل اللحظات للمباهج والنقاشات الثقافية والإبداعية، وهو يتحدث، ثم يتوقف عن الكلام مغمضا عينيه لبعض الوقت، ليستحضر الفكرة أو يدقق في التعبير عنها بالكلمات المناسبة، وإذا كنا نمشي ففي مشيه استباق إلى الأمام، يتحدث وهو يستدير لمحدثه مستعجلا في خطاه وكأنه يريد أن يصل قبل الموعد.
الكاتب العالمي
وأذكر أنه كان يفخر بلقب (الكاتب العالمي) ليصفني ب ( الكاتب المحلي) بين مزاح وجد، وكان يذكر(الكاتب الكبير) بمحبة خالصة بينما كان لا يخفي بغضه لآخرين الذي وصل إلى حد القطيعة. وكان يصارحني قائلا: ـ أشعر أن ما تكتبه هو أعمق من كتاباتي، ولكني كاتب عالمي، وهو حظ ساقته الظروف إلي.
مقهى السنطرال
في بداية السبعينات، كنا نجلس في مقهى (سنطرال) بالسوق الداخل، مكانه الذي كان أثيرا لديه في تلك الفترة، ففي الصباح كنت أجلس بجواره إلى مائدة داخل المقهى، فأراه يكتب بسلاسة واندفاع وكأنه يستعرض من ذاكرته ما يكتب بعد أن كان قد حفظه. كان يكتب (من أجل الخبز وحده)، بعد أن أخبرني بأنه قد اتفق مع (بول بولز) على ترجمتها إلى الأمريكية، فكان يذهب إليه في المساء لترجمة ما كان قد كتبه في الصباح. وقد أوضح لي أن الترجمة تتم باستعمال شيء من الفرنسية والأنجليزية لتقريب المعنى إلى (بول). فخلافا للشائع، لم يكن محمد شكري قد حكى سيرته ل(بول بولز) شفويا لأن نصها العربي كان مكتوبا بين يديه، ووسائط الترجمة هي التي كانت شفوية.
وقت للسفر
في سنة 1973 وصلتني رسالة من محمد برادة من باريس يحدد معي فيها موعدا للقاء به في الرباط، فالتقينا أنا ومحمد شكري في فاس، على طريقتنا في تنظيم ذلك اللقاء، ثم ذهبنا إلى القنيطرة، فأقمنا في بيت أهلي وجالسنا المرحوم مبارك الدريبي ثم انتقلنا إلى الرباط، فجلنا في المكتبات وزنا أصدقاءنا في السفارة العراقية الذين حملونا بالكثير من الكتب، ثم ذهبنا إلى موعد محمد برادة بعد أن أكدت معه الموعد، وأخبرته بأن محمد شكري سيرافقني في ذلك اللقاء. جلسنا في مقهى يطل على الشاطئ، فأخرج محمد دفتره المدرسي الذي كان قد كتب فيه سيرته، وبدأ يقرأ على برادة لوقت طال كثيرا، وما مل برادة من الاستماع، وصوت محمد شكري يعلو بالقراءة ويتفصح في إخراج الحروف من مخارجها، والدفتر راعش بين يديه، مكتوب بحروف كبيرة وعليه تسويدات وتنقيحات. وفي الغد التقينا محمد برادة والطاهر بنجلون صدفة وهما يجلسان في مقهى السلام المقابل لمحطة القطار، لمحناهما من وراء الزجاج، وكنا محملين بالكتب التي لم نجد أكياسا تسهل علينا حملها، فبدا منظرنا مضحكا، ولم يفلتنا برادة من سخريته فشبهنا ببدويين في باريس.
وقت للثقافة
بعد نشر (الخبز الخافي)، وقبيل منعه، نظمنا لسيرة محمد شكري جلسة نقدية في إطار فرع اتحاد كتاب المغرب بفاس. انتظرت وصوله فتأخر، وحينما وصل أخبرني بأنه تعرض لحادثة سير أصيب فيه برضوض بسيطة. لن برادة كان قبل ليلة قد اتصل بي بالهاتف، وطلب مني آخذ الحذر وحساب كل شيء في تنظيم اللقاء مع شكري، متوقعا أن يحضر إلى القاعة جمهور غفير فوق ما تستوعبه القاعة، كما حدث في لقاء بالرباط. وما كان بيدي أن أفعل شيئا، وبالفعل، فقد وجدنا أزيد من ألف شخص قد ملأوا القاعة ومداخلها فلم نجد طريقا للدخول إلا بصعوبة كبيرة، ولما قدمته للجمهور وقدمت المتدخلين وأعطيت الكلمة لأولهم، احتج الجمهور وقال: ـ لا نريد سماعكم. نريد سماع محمد شكري. فطوينا أوراقنا وتقاطرت عليه الأسئلة فما وجدت سبيلا إلى إنهاء الجلسة تحت كثرة المتدخلين.
قناع تجميلي للكاتبة الآنسة (خ.ب) في سطيحة بيته أحيينا عدة سهرات حضر بعضها الطاهر بنجلون. ولا أدري من أين جاءه الاهتمام بالأقنعة التجميلية، فقد كان يأتي بطين مدعوك ناعم، يعجنه بأنامله في إناء مع عسل النحل وقرنفل وزيوت وأشياء أخرى، يقول: ـ سأُحَضِّرُ قناعا. عندما أسأله عن بعض التفاصيل يقول لي: ـ اسكت آ الأمي. شف واسكت. ذات صباح زارته الأديبة (خ. ب) وأنا في بيته فكان بينهما حديث عن الزعيم علال الفاسي، وأخذ شكري يتحدث عن لقاءاته معه عندما كان يزور طنجة، ومن ذلك أ،ه ذهب ذات يوم للقاء الزعيم، وكان شعره مسترسلا، فالموضة آنذاك كانت تقتضي إرسال الشعر على طريقة الخنافس، فسأله الزعيم السي علال: ـ وما هذا الشعر؟ ارتبك وما أراد أن يفصح للزعيم عن نيته في إرسال شعره، ثم أجاب: ـ لم أجد ما أدفعه للحلاق. فأخرج الزعيم من جيبه ورقة مائة درهم وقال له: ـ هاك ما تحلق به شعرك. وإرضاء للزعيم خرج من المكان وذهب إلى أقرب حلاق فحلق شعره وعاد إلى مجلس الزعيم. بدت الكاتبة (خ.ب) معجبة بما يحكيه، فأخذ كفها وبسطه بين يديه. نظر في الخطوط والتعاريج وهي تُسْلِمُ له كفها وعيناها تتطلعان إلى عينيه. بشرها بعريس. شهقت وقالت: ـ أعوذ بالله. ثم عادت تشهق وقالت: ـ يا إلاهي. بعد أن أعد لنا القهوة، صنع لها قناعا من الطين والمراهم والعسل. بأنامله سواه على وجهها حتى لم يعد يظهر من وجهها سوى العينين. ظلت مستسلمة لما يفعل. أخذها برفق وأجلسها على كرسي في السطيحة، قبالة الشمس، وطلب منها أن تبقى هناك لساعتين، حتى يجف القناع. قال لي: ـ اتركها نستحضر ذكرياتها مع الزعيم علال وتعال لنبدأ شغلنا. علينا أن نذهب إلى السوق ونعود لإعداد طعام الغذاء. أعجب الآنسة (خ.ب) ما أعددناه من طعام، ودخلت معها في حديث حول الطبخ الفاسي. لم يعجب ذلك شكري فقال: ـ هو طعام الله، يطعم به عباده الصالحين، أينما وجدوا. عندما ذهبت الآنسة (خ.ب) خرج محمد إلى السطيحة ونظر إلى الإناء الذي يقي فيه شيء من ذلك المعجون الذي أعد منه قناع الآنسة، فقال لي: ـ ماذا نصنع بهذه البقية؟ قلت: ـ هي بقية ولا يمكن أن نصنع منها شيئا. قال وهو ينظر إلى الشمس المتوهجة في ذلك اليوم من شهر غشت: ـ الشمس ما تزال متوهجة،. يمكن أن نصنع من هذه البقية قناعين، لي ولك، ولنأخذ قيلولتنا قبالة الشمس.
وقت للجنون
كان يحدثني عن إصابته في وقت سابق بصدمة نفسية أودت به إلى المصحة العقلية، فكان يعالج بالصدمة الكهربائية، وقد وصف لي الصناجات التي كان تلصق على رأسه، وأنه بعد خروجه من المصحة كان قد حمل كتب مكتبته في صناديق وعرضها على الشارع للبيع، بسعر عشر فرنكات للكتاب، فجاء أحد أصدقائنا الذي اشترى منه الكتب جميعا بذلك السعر، فلما ندم محمد وأراد استرجاع كتبه لم يقبل ذلك الصديق الشاعر أن يرجعها إليه، فبقيت الحسرة في نفسه. لكنه عندما دخل مصحة (مايوركا) راسلني من هناك، فبادرت بنشر مقال بعنوان (اهتزاز أرواح الكتاب) تعرضت فيه لقلق الكاتب والكتابة والحياة، معتبرا أن حالة محمد شكري هي حالة جمعية، فالكتابة وضعية لصيقة بالجنون، وإن كان ذلك الجنون يختلف من كاتب لآخر. وصلتني منه رسالة يعتب علي فيها على فضح حالته الخاصة بنشر المقال، وقال إنه لن يحظى بثقة الناس بعد خروجه، وما كنت أقصد التشنيع بحالته بل كنت أتعاطف معها وأجد فيها شيئا من ذاتي.
وقت للبلبل
لكنه وهو المعلم القديم، كان يطرب أحيانا فيرسم بيديه حركة المايسترو، ويبدأ في ترديد ذلك النشيد الذي كان يعلمه للأطفال : قد كان عندي بلبل في قفص من ذهب وقت لدنيا الدمع والابتسام ومرة لما زارتي في فاس، أقام المرحوم أحمد المجاطي سهرة في بيته، دعانا لها أنا ومحمد، وكان من بين الحاضرين محمد سبيلا وأحمد الطريبق وأحمد يبوري، فكان محمد باسما يلقي الكلمات وكأنه يلقي بحجر في بركة ماء، يتحدث عن ألبير كامي وسارتر ومورافيا والإلياذة والأوديسة، وعن نصوصه التي كتبها بعنوان (البطل والخلاص)، وبجدية أستاذنا أحمد اليابوري المعروفة، ونبل أخلاقه وتساميه، كان يصغي إلى شكري، الذي قام فجأة فسحب الأطعمة من فوق المائدة، وصعد فوقها، فأخذ يغني: يادنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي وما كان ذلك يليق بجلسة جادة فبهت المرحوم المجاطي وطلب مني أن أعيد شكري إلى صوابه. والحق أنه كان على صواب، فقد كان يغني لدنياه التي اجتمع فيها الدمع بالابتسام، وهكذا كان.
وقت للذاكرة
حدثنا عن غنائه في مقهى كان يعمل به نادلا، وقد زرت معه ذلك المقهى في تطوان بعين الخباز، كما زرنا معا مراتع طفولته وأنا أصغي إلى تعليقاته وأرى الشجن في عينيه وهو يقول لي في الطرنكات: ـ هنا كانت أمي تبيع الخضر. ثم نسير قليلا فيتوقف عند قوس ويقول : ـ وهنا كان الفرن الذي كنت أنام بجواره. قبل ذلك بسنوات خلت، زرته في طنجة فكان يتهيأ للذهاب إلى تطوان لحضور عرس أخته الصغرى، وأطلعني على هديته للعروس التي كان يحبها حبا شديدا، وهي ساعة ذهبية وقارورة عطر، وطلب مني أن أرافقه لحضور العرس، فلما دخلنا بيتهم في تطوان لم تكن هناك علامات للعرس، وقالت له أخته (رحيمو) إن العرس قد أقيم قبل يومين، وهو نفسه كان قد نسي الهدية في بيته في طنجة، فعدنا ليلا وهو حزين ومرتبك، يؤكد لي أن الرسالة التي وصلته لتحدد موعد العرس لم يخطئ قراءتها، وكان عليهم أن يقولوا له لقد قدمنا العرس.
وقت للأم
بعد ذلك وجدته مرة في حالة عصبية وهو يحدثني عن مكالمة هاتفية تلقاها من زوج أخته الصغرى، الذي اقتحمه بسؤال : ـ هل صحيح ما كتبته عن أمك؟ فغضب محمد ورد عليه : ـ أنا لا أعرف أمك ولم أسأل عنها، فلماذا لا تتركني وشأني مع أمي؟ وقطع المكالمة. في بداية التسعينات، وجدته مرة في أحد شوارع طنجة وهو يقف مستندا إلى حائط، في حالة ذهول، فسألته : ـ ماذا تفعل هنا ؟ قال : ـ شايط. فهمت أنه ضائع فاقترحت عليه أن يقضي معي مدة في بيتي في مرتيل، وذهبنا إلى بيته فحمل بعضا من ملابسه وأوصى بوصاياه فتحية، حول كلبه (جوبا) وألا يدخل البيت أحد في غيابه، وما عليها أن ترد به على الهاتف إن تكلم فلان أو فلان.
وقت لرحيل البحر
في بيتي بمرتيل أقام عدة مرات ولأيام، كان خلالها، وعندما أذهب للعمل، قد تفرق لقراءة ما أصدرته من روايات، فقرأ (المباءة) و(رحيل البحر) وروايات أخرى، وكان يعلق على ما يقرأ، ففي (رحيل البحر) أثاره وصف إحدى الشخصيات ب : (ازرقت عيناه من كثرة التحديق في البحر)، وقال لي إنك تكتب الشعر في الرواية. كان يقرأ في مقهى (الشمس والبحر)، وقد دللته زوجتي كثيرا وهي تجبر خاطره وتعد له ما يشتهيه من طعام، وقد سألته: ـ لماذا لا تتزوج ؟ فرد عليها : ـ لم أجد امرأة مثلك. وتذكرت أنني كنت قد طرحت عليه نفس السؤال، وكان قد أجابني: ـ لم أجد امرأة حمقاء مثلي. كنا نبدع تفاصيل جميلة لليومي، وهو نفسه كان يقول: ـ الحياة قبيحة وعلينا أن نعرف كيف نجعلها جميلة. كان يتحدث عن الكتابة نفسها، معتبرا وظيفتها هي تجميل القبح. أتذكر أيام السبعينات التي كنا نتبارى خلالها أنا وإياه في إعداد الأطعمة، فكان بارعا في إعداد الأرنب بالزبيب والبصل، أكلته المفضلة، وكنت أبرع في إعداد أطعمة أخرى من الذوق الفاسي، يشهد لي بتفوقي عليه فيها، لكنه يستدرجني لإعداد الأرنب بالزبيب والبصل، عارفا أنني لن أتفوق فيه، وحتى يتفوق علي ويهزمني. في أصيلة كان (ألبيرتو مورافيا) قد طلب اللقاء مع شكري، فتحلقنا جماعة في مقهى القصبة ننتظر مجيء (ألبيرتو)، ودار حوار بينه وبين شكري حول علاقة بالجنس والسياسة بالأدب.
وقت للإقتراض
ذات مرة ذهبت إليه في رمضان وطلبت منه أن يقرضني مبلغ خمسة آلاف درهم، فبدا مترددا وقال لي: ـ لدي في البنك أحد عشر ألف درهم، وهي كل ما عندي، ومستقبلي المالي غامض. ثم من غير أن ألح عليه قبل السلفة، وفي الطريق إلى البنك حدثني عن أموال كثيرة قرضها لأناس كثيرين فلم يرجعوها. لما دخلنا البنك وطلب الكشف وجد في حسابه مبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، فتحير في أمره، وبعد السؤال تبين أنها حقوق أرسلتها إليه الشركة الإيطالية التي كان قد أمضى معها عقد لإنجاز (الخبز الحافي) إلى السينما. تأخرت عليه بضعة شهور ثم اتصلت به بالهاتف أخبره بأنني سوف آتي لتسديد الدين، فلما جلسنا في شقته سألني : ـ هل أتيت بالخمسة آلاف درهم؟ أخرجتها من جيبي وسلمتها له، لكنها لم يمد يده إليها وقال: ـ أنا متردد في أخذها. قلت: ـ لماذا: قال: ـ لقد تأخرت علي بها لخمسة أشهر، وأنا شكوتك لمحمد برادة، لكنه طلب مني أن أتخلى لك عنها، ووعدته بذلك. بدا مترددا وقال: ـ نقتسمها بالتساوي، ليبقى برادة على خاطره. لكني ألححت عليه في أخذها كاملة، فأخذها وهو يلح علي في ألا أتحدث مع برادة في الموضوع. قلت له : ـ هو مالك أنت، واسترجاعه مني حق لك، فلا تتحرج من برادة.
وقت للكاتب العالمي
وأذكر مرة أن الروائي الكبير حليم بركات كان قد زارني في فاس، قادما إليها من (جورج تاون) حيث يُدرس بجامعتها، فطلب مني أن أرافقه إلى صفرو حيث توجد أسرة طالب مغربي يدرس لديه، وكان حليم يحمل لها مالا ورسالة، فركبنا سيارة نقل عمومية وجلسنا في مؤخرتها بعد أن كانت قد امتلأت بالركاب، وكان بجوارنا شاب أمريكي يعمل مصورا فوتوغرافيا لصالح إحدى المجلات، فتبادل الحديث مع حليم، وسأله حليم عمن يعرف من الكتاب العرب، فقال الأمريكي : ـ أعرف كاتبا واحدا هو محمد شكري. هذه هي عالميته، وكأن ضحكته، وأحاديثه، ومرضه، وكتبه وصوره مع المبدعين، كلها حكايات عاشها بطل أسطوري ملعون بلعنة الحياة التي أحبها. قبل أن يصاب بالمرض بفترة قصيرة جدا، مررنا أنا وزوجتي وولدي في نفس الشارع الذي يوجد فيه(الريتز) مكانه الأخير، فسمعت صوته يناديني. كان قد رآني من داخل المقهى وخرج يناديني، وألح علينا في أن نشرب معه شيئا. كان في وضع عصبي سيئ، وهو يتحدث عن سقوطه في الشارع، وتخلي أحد أصدقائه عنه، وسرعان ما جاءت فتحية إلى المقهى فطلب منها أن تقدم شهادتها أمامي وأمام زوجتي.
وقت للمزاح العكر
ولقد أصبح مزاحه عكرا على الدوام في السنوات الأخيرة، وكان في السنوات الأخيرة كلما جالسته يطلب مني أن أدفع ثمن ما نشرب، ويخرج من جيبه نقودا كثيرة فيقول: ـ بإمكاني أن أدفع، ولكني أحس بمتعة أن تدفع أنت، فكلهم، أدفع عليهم ولا أحد منهم يدفع علي. حينما كلمته بالهاتف وهو في المستشفى كنت لا أعرف ما أقول، وكان رابط الجأش. أخبرته بأنني سوف أزوره بعد يومين، وسألته إن كان في حاجة إلى شيء، فرد علي: ـ شكرا. لا أحتاج إلى شيء. في إهداء (زمن الأخطاء) كتب لي: ( الأخ محمد عز الدين إن الأصدقاء الحقيقيين لا يشكرون على عنايتهم بنا وتشجيعهم لنا. . . . . . . ) طنجة : 26 ـ 7 ـ 1992
وقت للموت
موت محمد كان فاجعة لي، ففي موته أحسست بعميق ذهابي مع ذهابه، ولما وقف على قبره في ساعة الدفن، كنت أراه واقفا بجواري يتابع المشهد، وكأن من يوارى في التراب هو بؤس الطفولة وشقاوة الأيام وقبح الحياة الذي جملناه كثيرا فلم يتجمل. كان محمد شكري نفسه يواري في قبره زمن أخطائه، وزمن أخطاء جيلنا، وأما نظرته وضحكته وصخبه ومحبه للحياة، فستبقى كلها ملكا للذاكرة، كما ستبقى كتبه مصدر اغتناء للقراء.
وقت للحلم
في ليلة يوم الأحد، السابع من ديسمبر 2003، أصابني اختناق شديد صعب علي معه التنفس، لم ينفع معه الشراب الطبي. وخلال نوم قصير رأيت فيما يرى النائم أنني أنا ومحمد شكري ننام بثيابنا على الأرض في ساحة من ساحات باريس، والناس يمرون من حولنا فينظرون إلينا كما يُنظر إلى المهمشين الذين ينامون في الشوارع. مددت يدي إلى معصمه وجسست نبضه فرفع عينيه نحوي
وقال: ـ لا تخف. ما زال قلبي ينبض.
تركته ومشيت إلى مكان يشبه محطة القطار، فوقفت وسط الزحام وشاهدت أناسا كثيرين أعرفهم، كان من بينهم الروائي الفلسطيني الراحل إيميل حبيبي، وقد بدا عليه الفزع، فقلت له :
ـ لا تفزع على محمد فقلبه ما يزال نابضا. ورأيت حسن نجمي يقطع ورقة تذكرة ويقول لي:
ـ بها سنعيده إلى المغرب.
فقلت له:
ـ وهذا الحشد من الكتاب والصحفيين هل سيعود معه بنفس التذكرة؟ بدا مستغربا سؤالي.
فقلت له :
ـ قلب محمد ما يزال نابضا، فلماذا تستعجلون دفنه وهو حي ما يزال؟
قال: ـ نخشى عليه من أن نبدأه تلك الدرجات القصوى من الألم.
رجعت إلى الساحة الباريسية التي كان ينام فيها محمد على الأرض، فوجدته ينتظرني. أخرج من جيبه أوراقا مالية كثيرة وقال لي:
ـ هذا المال أريد أن أكافئ به عاهرة كانت قد خدمتني في الفراش جيدا.
قلت له: ـ من هي؟
قال: ـ إنك تعرفها جيدا.
ـ أين هي؟
ـ في طنحة. إنها طنجة نفسها. تدعي الآن أنك لا تعرفها، حتى وقد كتبت عنها روايتين؟ هل أذكرك ب(مغارات) و(ضحكة زرقاء).
قلت:
ـ كافئها به أنت ، فأنت لم تمت بعد.
قال :
ـ هي التي لا تموت. هرقل لا يموت. ثم اختبأ في حضني فأعادني إلى تلك اللحظات اللذيذة التي كنت أنيم فيها أولادي في حضني وهم صبيان، فأقص عليهم أحسن القصص. بدأ يتألم، فتزحزح وشكا من حنجرته، فأحسست الألم في صدري وحنجرتي. نهضت من تلك النومة الخفيفة وأخذت أقص على نفسي ذلك الحلم، وأنا أسعل سعالا حادا وصدري يتصدع، ودموع لا إرادية تتهاوى على خدي، والليل موحش والحمى الباردة تسكن بين الضلوع.
وقت للشهادة على الموت والحياة
تذكرت أنني كنت قد ختمت شهادتي عن محمد شكري في أصيلة، خلال الندوة التي خصصها له اتحاد كتاب المغرب، بأنني حينما علمت بمرضه، فقد أحسست المرض في جسدي. وكان ذلك اعترافا بصوفية الجسد، وبقدرته على الحلول. فلم يكن الأمر يعني شكوى من جسدي، بل هي شكوى من جسد محمد وأنا أشعر بجسده ينخره المرض، من خلال جسدي. تماما كما كان محمد قد دخل مصحة مايوركا، بعد اضطراب عصبي، فوجدت أن في ذلك ما يعني اهتزاز أرواح الكتاب، الكتاب الذين لهم أرواح.
وقت للوقت أيها الذاهب في طريق لا جدوى من ذهاب في طريق. لا حاجة لبكاء على حريق. لا ربيع ولا خريف فالأزمنة كلها والفصول كلها والتواريخ كلها تأتي إلى زمن الكتابة. ولا حاجة للندم على شيء، أو تبرير ما لا تبرير له، أو الدفاع عن "زمن الأخطاء"، فقد مضى الوقت فلا أرباح ولا أرباح ولا خسارات، ولا هزائم ولا انتصارات، وما بقي من شيء غير وجوه الصحاب، أراها الآن في البرازخ، بكل الكلمات المبعثرة وأحاسيس الحسرة وطفرات الدموع، ناصعة لا تزول في وقت هذا الزوال، فلا حاجة إلى المراثي، ولا حاجة إلى تفلسف لا جدوى منه لمعنى الحياة، فهي الحياة على بساطتها تستحق أن تعاش. هكذا العمر الجميل يقصر في سويعات الدهشة التي تحاول أن تسترجعه، مبشرة بزهو محتمل بميلاد مدن وتعايش أصحاب وقرع أجراس أو هو وخز عذاب ذاكرة خصبة تشهد على الذات ومعيشها الذي يتبدد لحظة بعد أخرى فلا تبقى منه غير الذكريات. وقت للكتابة هو الأطول لا بطول العمر أو بقصره، وإنما لأن الكتابة لا تستغرق وقتها وحسب، بل أوقاتا أخرى من قبل ومن بعد، محسوبة عليها، وهي أوقات خارج الوقت. وقت للبذخ والضحك والطعام والشراب والحديث والثرثرة، يتخلله وقت للموت دون أن نشعر به وهو يحل في ذلك الوقت. وقت للكتابة من خلاله نعيد للعالم نصاعته ومضاء حد السيف الذي به انحفرت الطعنة في أماكن حساسة وليس لذلك الوقت غير أن يجعل من الكتابة قلقا يوميا، باعتبارها كتابة قلقة، وباعتبارها استرجاع واستحضار للأنا ومجتمعها وتاريخها وانحدارات كل ذلك نحو المغيب. وقت للكتب بما هي مستودع للأسرار. وقت للريح والعواصف والأعاصير. وقت للمدن باكتشافها وشهواتها وتصدعاتها التاريخية وأسطوريتها التي تتماهى مع الواقع، فيها نعيش، نذمها ونحبها كثيرا، وفيها نختلس زمننا الضائع، سواء في معيشنا فيها أو في جعلنا لها موضوعا للكتابة. وقت للبرهنة على لاشيء يبرهن عليه بمنطق فهو وقت للمعيش الغفل، البسيط والعادي، وحيث لا يمكن أن نبرهن على أنه زمن للأخطاء، لأننا ما كنا نعيش في زمن غير زمن الأخطاء. وقت للطفولة وحيث يحسب كل أحد أنه قد عاش قسوة الحياة في الطفولة فيتنافس المتنافسون في سرد أنواع العذاب التي لاقوها في طفولتهم، لكنهم يتنافسون أيضا في أن أي عيش قد عاشوه بعد ذلك لم يكن أغنى وأبهى وأكثر تأثيرا على الحياة والذكريات. وقت للعبور، وحيث امرأة خائنة أو كتاب فاشل أو حانة منذورة للصمت وحيث لا صحاب ولا موسيقى، فهو وقت للعبور، بعده يأتي وقت الحضور. وقت يسكن في المحن، وفي الجراح الشخصية التي نكابر من أجل ألا تعطفنا فتحول إلى أناس غير فاعلين، غير ممارسين للوقت. وقت للذات، فذواتنا نحن، رتبتها المحن، فأعدنا ترتيبها في الكتابة، لا عبر البوح وحده، ولكن عبر القبض على تجليات المحن في الذاكرة الجمعية، والتاريخ، ورصيد القلق الممكن رغم الضحك والسخرية وحب الحياة. وقت للمدينة والمقبرة، وللرسائل والصور وللبحر والبر. وقت لموت الأصدقاء، محمد تيمد، محمد الكغاط، ومحمد زفزاف، كما عاشع محمد شكري فعاش فيه موته، ولذلك كان يضحك، ويقول لنا الموت طائر، لابد أن يتخطفنا ولكن آخر من سيتخطفه منا هو هذا، ويشير إلى صديقنا القديم العربي اليعقوبي، ليقول إنه قديم قدم الطوفان وهامان. وقت لاستشراف الموت، وحيث تبقى المدن شاهدة علينا، وحيث لا أثر على الطريق إلا ما تراه عيون تتجاوز رؤية المرئي إلى رؤيا الكشف والتجلي. وقت للطفولة التي نتجاوز بؤسها بطفولة أخرى نعيشها في الكهولة أو الشيخوخة. وقت لسطوة الكتابة، بما هي آثار خطى على طريق، أزمنة في زمن واحد، عنف للواقع والتخييل، لغة للغات المتعددة، أصوات نجد فيها الذات حتى وإن لم تكن أصواتنا نحن. أمر غريب يحدث في الكتابة السردية، وهو أنها بقدر ما تضاعف من ياة أبطالها فهي تذهب بهم نحو الموت. بخلاف المنطق الشائع، فالكتابة تجعل من موتهم حياة، كما كانت قد جعلت من حياتهم موتا، ربما، وهذا هو حال قصة محمد شكري "بشير حيا وميتا". شكري ليس كأبطاله، فقد عاش الحياة في الحياة وهو يعيش الحياة في الموت، لأنه أسطورة شخصية، ولأن المقبرة في كتاباته كفضاء كانت فضاء للعيش واختلاس المتع، وحتى "التابوت" كما في قصته التي تحمل نفس العنوان، لم يصنع إلا لموتى أحياء، أو لأحياء أموات، أما هو فقد عاش متمردا على التوابيت، فهو البطل الحقيقي ل "مجنون الورد"، وهو صديق الحيوانات والنباتات الجميلة، وهو الطاهي الفنان، وهو فنان الحكاية، ومبدع الوقت ليكون لصالحه مهما عصفت الريح أو أعصرت الأعاصير. هل يأتي الوقت ليناسب وقتا غير الوقت، وحتى أقول فيه كلاما كهذا لمحمد شكري، فيقول رأيه فيه، متى وأين، وكيف، ولماذا لا يقول رأيه حتى وقد تركني وحيدا؟ تلك هي محنة الوقت، التي تضاف إلى محن الذات بتفردها وجمعيتها، وذلك هو قلق الكتابة الذي تحاول أن تقبض عليه، لتؤجج من نار الأسئلة.
المذكــــــــــــــــــــــرات
(1)
محمد شكري
كاتب من زماننا
سيرة للوقت
وقت أول
تعرفت على محمد شكري في نهاية الستينات، وفي سنة 1969 بالتحديد، وأنا طالب بكلية الآداب بفاس، في مهرجان ثقافي كانت قد نظمته إحدى الجمعيات بمدينة القصر الكبير. قبل ذلك اللقاء الأول كنت قد قرأت له بعض القصص القصيرة التي كان قد نشرها بجريدة العلم، وحسبته كاتبا تونسيا من كتاب الموجة الجديدة في تونس، وحيث كان بعض الكتاب التونسيين ينشرون قصصهم بنفس الجريدة، وكانت القصة القصيرة العربية يومها تعرف تحديثا على مستوى الأشكال وارتيادا لممكنات تخييلية جديدة. لكن محمد شكري وأنا ألتقي به لأول مرة وسط حشد من الكتاب المتظاهرين بمدينة القصر الكبير، بدا وكأنه يعرفني من زمان، فلم نحتج إلى مقدمات، بل صرنا صديقين ومنذ أول وهلة. والمظاهرة كان سببها احتجاج على باشا مدينة القصر الكبير الذي كان قد اعترض على دخول الكاتبين اللامعين الأستاذين عبد الكريم غلاب ومحمد إبراهيم بوعلو لتراب المدينة ومشاركتهما في (المهرجان) الثقافي، فنظمنا المظاهرة، وسرنا فيها محتجين على هذا المنع، متجهين نحو مقر باشوية المدينة، وفي الطريق كان لقائي الأول بمحمد شكري، الذي فاجأني بجرأته وهو يقول لي: ـ يمكنك أن تمرض، وأنا أدلك على العلاج. لم أفهم أي مرض يقصد، فنبهني إلى وجود حي للبغايا في المدينة، وقال لي: ـ إذا ذهبت إليه ومرضت، فلا تخف، أنا أعرف الدواء الذي يشفي من تلك الأمراض التي نلتقطها من البغايا. والحقيقة أنني لم أكن على رغبة أو تجربة بالموضوع. لكن محمد شكري كان ضحوكا، حيويا، يسير في المظاهرة قليلا ثم يتوقف ليتبادل الحديث الصاخب مع هذا أو ذاك من الكتاب، وخاصة مع العزيز الراحل محمد الخمار الكنوني ، الذي كان أستاذا لنا بكلية الآداب بفاس، وكان خجولا مثلي، فتجرأ عليه محمد شكري بحديثه عن البغايا، ذاكرا نتفا مما قرأه في الأدب العالمي عن نساء الشوارع وعن المواخير.
وقت لليليين والنهاريين
في صيف سنة 1970 جئت إلى طنجة فأقمت في فندق بالسوق الداخل، والتقيت بمحمد، فأخذني إلى عالم الليليين في المدينة، كما كان يسميهم، فهم أناس لا تراهم إلا بالليل، ينامون نهارا ويسهرون ليلا. واقترح علي أن أشتري فراشا وغطاء ومخدة وحصيرا من (سوق بره) بعد أن حسب كم سأدفعه للفندق خلال إقامتي وكم سيكلفني شراء هذه اللوازم فوجد أنني سوف أستفيد، فسأقيم في بيته، وذكر لي إنه كان قد فعل نفس الشيء مع الراحل العزيز محمد زفزاف، الذي جاء إلى طنجة في صيف مضي، فلما عاد في صيف آخر بعده ليستثمر ما كان قد اشتراه من فراش وغيره وجد شكري قد باع تلك الأشياء، ونبهني إلى أنه سيبيع ما سأشتريه خلال السنة، إذا ما احتاج إلى مال ليشرب به، وهكذا اشتريت تلك الأشياء وأقمت معه في شقته إياها بحي الروكسي، يوم كانت سطيحتها تطل على البحر، وقبل أن تصعد عمارات الإسمنت لتجبه عن السطيحة. كان شكري قد قدم لي في "مقهى الرقاصة" الرجل العجوز صاحب المقهي، السي العلوي، الذي كان يسميه الأب الروحي، وفي كل صباح كنا نزور السي العلوي ليتكلم معه محمد بأدب جم، ويأخذ منه ورقة عشرة دراهم، كما كنا نمر في المساء على فندق بجوار مقهى السنطرال يصعد لوحده أدراجه قافزا بخفة جسده المعهودة فيعود بعشرة دراهم أخرى، فهي عشرون درهما في اليوم يستدينه من السي العلوي ومن صاحب الفندق يسددها في نهاية الشهر عندما يستلم حوالته، وبالعشرين درهما، إضافة إلى ما أخصصه لمصروف كل يوم، جبنا طنجة حتى لم يبق فيها مكان لم نره.
رياح طنجة
زرت محمد شكري عدة مرات في فصل الشتاء، فكنت أكتشف شتاء طنجة الذي يختلف عن صيفها. لكن ما أذكره هو أننا عندما كنا نعود للمبيت في شقته، فقد كانت الرياح تزلزل العمارة. ريح عاصفة تصيب بالفجع وتؤرق حتى بعد سهر وسمر، فيستعصي علي النوم بينما أجد محمدا بجواري نائما فإن أشعلت الضوء أرى على وجهه سمات طفولية وكأنه لا يستعيدها إلا وهو نائم، وحيث يتحول وجهه إلى وجه طفل. وكنت أضطر للسفر في الصباح الباكر، غير نائم ولو للحظة، فينصحني محمد بأن آخذ معي مفتاح باب العمارة، لأفتح الباب، ثم أضعه في صندوق بريده، فأخرج لمواجهة رياح طنجة في ذلك الفجر، وكأني أسمع صوت محمد يقول لي: ـ إذا أردت أن تواجه هذه الرياح، فعليك بأحد أمرين: إما أن تحاول نسيانها، تماما وكأنها غير موجودة، أو أن تصبح ريحا مثلها فلا تنال منك.
محمد لا يحب النصائح من أحد
وأٍمعه يقول هذه ليست نصيحة، فلا أحد ينصح أحدا في رأيي. كل الذين نصحوني رميت بنصائحهم في القمامة. بعضهم أغضبوني برسائل تحتوي على نصائح. علي أن أكف عن السهر. علي أن أسافر. علي أن أنظم علاقتي برفاق الليل. علي أن... هؤلاء يمثلون دور الأب في حياة الآخرين، ,أنا قتلت أبي بالمعنى الرمزي، ولا أسمع إلا إلى تلك القطط التي تموء داخل رأسي. وقت لتأمل الكتابة وتذكر الأصدقاء الكتاب وكنا نجلس في السطيحة في بعض الأصباح، نشرب القهوة وندخن، ونتحدث في قضايا الأدب والكتابة، وكان محمد يدقق معي في مسألة الكثافة اللغوية، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب البرقي، فلما عرضت أمامه ما كان قد كتبه الناقد الأمريكي (كارلوس بايكر) عن أسلوب (همنغواي) الذي يعتمد على الاقتصاد اللغوي، والجمل التلغرافية. وجدته وقد قرأ الكتاب. وكتاب (بايكر) كنت قد استعرته من المكتبة المصرية بالبطحاء، فجاء من استعاره مني وسطا عليه فلم أتمكن من رده للمكتبة. وخلال تلك الجلسات وجدت في محمد شكري قارئا حصيف الذاكرة، فقد قرأ ثلاثية سارتر دروب الحرية، إضافة إلى متن روائي كبير مترجم، وكان يعلق على حياة محمد زفزاف ونصوصه، فيسلم جسده للفراش في حركة تمثيلية وينام نومة يُدخِل من خلالها ركبتيه في بطنه ويحمي رأسه بكفيه، فيقول لي: ـ هكذا كان ينام محمد زفزاف. ثم يعلق: ـ هي نومة من عانوا من اليتم، ومن الخوف من الاغتصاب خلال النوم. أظل أنظر إليه فيقول: ـ هكذا كنت أنام في الطرنكات، بجوار الفرن. ثم يضحك ، ويرسل ذراعيه في الهواء، ويقول: ـ ولكن محمد زفزاف كان لا يقترب من الماء. كان لديه خوف من الماء، فهو إن أراد غسل وجهه يبلل رفي إبهاميه من الصنبور ويضعهما على عينيه محاولا إزالة ما قد يكون عمشا. ويضحك، فأذكره بجوارب الأصدقاء، وأحذيتهم، فيقهقه ويقول لي: ـ كنتُ صارما. إما أن يغسلوا أرجلهم أو يغادروا البيت. وأُذكره بالديودرون الذي كان يرش منه على أقدام بعض الكتاب من زواره، فيضحك ويقول: ـ لا أحب الروائح الكريهة. أنا أستحم أحيانا مرتين أو ثلاثا في اليوم، وأتعطر، من أجل ألا أشم رائحة كريهة من جسدي، فلماذا يجبرني الآخرون على أن أشم روائحهم الكريهة؟
أبطالي تجريديون
كنا نقرأ لبعضنا نصوصنا الجديدة، وكان يضحك، ويقول لي: ـ أبطالك تجريديون، لا يأكلون ولا يخرأون، ليست لهم أسماء كباقي كعباد الله. وكنت أرد عليه: ـ إن أبطالك لا يفعلون شيئا غير أنهم يأكلون ويمارسون الجنس ويخرأون. فكان يعجبه جوابي، ونضحك، ونستحضر كتابات محمد زفزاف وعبد الجبار السحيمي وذكرياتنا معهما ومع غيرهما، فكنت إذا ما ذهب اسما يقول لي : ـ لا. هداك بخيل سقرام. فيحدثني عن الكاتب الأمريكي وليام بوروز الذي جاء إلى أصيلة فاكترى بيتا أراد أن يملأه بماء البحر ليستحم فيه، فاكترى من بنى سورا على الباب وهو في الداخل، كما اكترى فتيانا كانوا يملأون السطول من ماء البحر ويصبونها في الداخل، لكن البيت تهدم قبل أن يسبح وليام بوروز في ماء البحر وهو في غرفته. حكايات كانت تبدو لي من قبيل الخيال، وكان محمد يحلف بالله العظيم أنها وقعت بالفعل.
وقت للصداقة
في ذلك الصيف، صيف سنة 1969 ، أحسست أنني قد كسبت صديقا مغايرا لأصدقائي في فاس والرباط والقنيطرة، وأذكر أننا لم نتخاصم، وخلافاتنا كانت صغيرة، ولما كان ينفد ما معي من مال كنا نذهب إلى (الروبيو) يوم كان صاحب دكان بقالة رائج في حومة الروكسي، فأعطيه شيكا مؤجلا وفي الحال ينظر (الروبيو) في مبلغ الشيك فيصرفه لي. لم يبتزني محمد أبدا، ولا كان لئيما فلم نمل من أيامنا مع بعضنا، وكان قد حدثني عن جرحه العائلي، بتفاصيل كثيرة لم يذكر منها غير القليل في (الخبز الحافي) الذي كتبه فيما بعد، وحدثته عن جرحي العائلي أنا أيضا، فحدثني عن حرج محمد زفزاف العائلي، وقال لي: ـ هل كان قدرنا هو أن نولد هكذا، بآباء ولكننا أيتام؟ ثم كان يستدرك، ويستمد قوة من الكائن وهو يستقل ويعيش والآن صار يكتب، فيحدثني عن قتل الأب، رمزيا، وكان يكررها ويشدد عليها، وكان والدي وقتها ما يزال حيا ولكني لا أراه ولا يراني، وأما محمد فكانت أخته (رحيمو) تشغل حديثه، وكان يحدثني عن أخيه عبد العزيز، وعن أخته الصغرى مليكة. بعد ذلك الصيف تبادلنا كثيرا من الرسائل، فكان في رسائله يكتب ما هو أشبه باليوميات، ولأنها ضاعت مني، فأنا أتذكر منها أنه كان يبدأ من الصباح، وبتاريخ اليوم، فيقول إنه خرج إلى السوق الداخل والتقى بفلان وذهب معه إلى المكان الفلاني ثم يحكي عن سكره وعمن التقى بهم من الرجال والنساء، وإن ضاجع امرأة فهو يصف كل شيء عن لحظة المضاجعة، ويجعلني أتذكر عبارته التي كان يحلو له أن يرددها: ـ قضينا ليلة ملوكية. ليلة أسطورية. ومن ذلك ما رواه عن امرأة تعرت له فملأ ما بين نهديها بفواكه كان قد قطعها قطعا صغيرة ثم صب عليها من الخمر فأخذ يأكل الفواكه ويشرب الخمر من نهدي المرأة، والخمر تندلق إلى ما يقارب سرتها، وهو يشرب.
وقت للرسائل
والرسائل كانت تتحدث عن أيام الإملاق، فكان يبعث لي بصور له مع كلاب استأجره صاحبها الأجنبي ليجعلها تتجول على الشاطئ، لكنه كان يكتب على الصورة: ـ أنا وكلابي. ثم يقول في الرسالة إن الكلاب أفضل من صاحبها.
وقت لــ "جوبا"
بعد ذلك سوف أفهم لماذا كان قد عاش قصة طويلة مع كلبه "جوبا". فقد اصطاده من شاطئ طنجة فطوقه من عنقه بحزام سرواله الجلدي وجاء به إلى شقته. أطعمه وطلب من فتحية أن تغسله بماء دافئ كان قد أذاب فيه محلولا صيدليا لمحاربة الطفيليات، وألفه "جوبا" الذي كان يُخرجه معه أحيانا إلى شارع باسطور، وهو يُعَوِّدُه على أوامره: ـ اجلس. ـ انهض. ـ تعلم كيف تكون هادئا حينما أتكلم مع الآخرين. ـ هيا بنا. لم يكن "جوبا" تعويضا في حياة محمد، بل جزء من علاقة ممكنة، تتحقق في أرفع مستوياتها مع حيوان، أو نبات، أو موسيقى. فشكري كان يحب النباتات التي طفحت في سطيحة منزله، وكان له كنار يسميه "موزار"، وأما السناجب التي وضعها في قفص كبير فكانت تنط وهو يتكلم معها. لذلك فقد غضبت من أحد مرسي الفلسفة وهو يحلل علاقة شكري ب"جوبا" على أساس أنها علاقة تعويضية، وسألته بماذا يعوض هو، وعن ماذا، ومن كلفه بتحليل شخصية محمد شكري.
تذكرة في القطار
وخلال السنة الدراسية، اتفقنا على أن أبعث له بحوالة بمبلغ مائة درهم، ليشتري تذكرة القطار، وشرب في حانة القطار، فيومها كانت بالقطار حانة، عل أساس أن أستقبله في المحطة، ونعيش عيشا آخر في فاس. وبالفعل، فقد خرج محمد من المحطة وهو يثرثر معي كأني كنت معه، ودون أن يسلم، فقد بدأ يحكي عن الرحلة، وأنه التقى في العربة بالحاجة (حاء) المعروفة بأغانيها الشعبية التي كنا نراها على شاشة التلفزيون بالأبيض والأسود، فانتقل معها إلى الحانة، وهناك قبلها في فمها، بالرغم من أنها عجوز فقد قبلها.
وقت لجدتي لالة أم كلثوم
وفي بيتي بحومة الدوح بفاس كانت جدتي (لالة أم كلثوم) تزورني من حين لآخر، فتعرف عليها وكانا يقضيان الساعات في الحديث وتبادل السجائر، فقد كانت تدخن (فافوريت) وكان هو يدخن (كازا سبور)، تعطيه من سجائرها ويعطيها من سجائره، وهو يحدثها عن هجرة أسرته من الريف في أعوام الجوع، وهي تحدثه عن أمها التي كانت قد قطعت بمص أهدابها الطويلة حتى لا يراها زوج أمها فيطمع فيها، فكنت فرحا بحديثهما وإن أشعرني بأنني لاشيء في وجودهما، ولقد ظل محمد وحتى آخر وقت من حياته يسألني عن جدتي (لالة أم كلثوم)، وفي مرات كثيرة كنت أخبره بأنها كانت قد ماتت، فتبدو الفجيعة على وجهه، وحالما نلتقي مرة أخرى يسألني عنها فأخبره من جديد بأنها ماتت، فيعود لتظهر الفجيعة على وجهه من جديد.
السي الطنجاوي
كنت خلال زيارته تلك أذهب إلى العمل في ثانوية النهضة، وأتركه في البيت، ومرة قبل خروجي سألني عن الطريق إلى الثانوية، فوصفته له، وحال خروجي من الثانوية وهي ثانوية للبنات، وجدته واقفا ينتظرني، فتجمعت حوله التلميذات، وقلن له: ـ أهلا بالسي الطنجاوي. وهي عبارة سحرته فأخذ يرددها لسنوات حينما نلتقي. لم يعجبه شعراء فاس وكتابها الذين عرفته عليهم، فكان يبدو متضايقا ومتبرما منهم، وكان يقول لي عن شاعر التقينا معه في حانة فطلب مني أن أدفع عنه ما شرب : ـ قد شعره قد خلاصه.
جون جونيه في "المنزل".
قبل ذلك، وفي بداية السنة الدراسية لعام 1970، كنت قد عينت مدرسا بقرية المنزل، فجاءتني رسالة من محمد شكري يخبرني فيها بأن (جان جونيه) يوجد في المنزل. وبالفعل، فقد كنت قد انتبهت خلال المساءات التي كنت أتجول فيها في الحقول إلى ذلك الأجنبي الكبير الرأس البارز العينين، فعلمت أنه هو (جان جونيه) فلما بحثت عنه لدى أقارب عز الدين، سميي، أخبرت بأنه غادر. وسنلتقي أنا ومحمد ليحدثني عن مذكراته التي كتبها عن (جان جونيه) وكيف التقاه صدفة في طنجة، وفي السوق الداخل بالتحديد. ثم حدثني عن لقاء آخر له تم بالصدفة، مع (تينسي وليامز) الذي وصفه بأنه كان مترفعا بينما زوجته هي التي كانت تتعاطف مع الشاب محمد شكري وتصغي إلى أسئلته الأدبية، وقال لي إنه قد نفذ إلى قلبها ومن حيث طلب منها أن تمد له راحتها، فقرأ لها ما فيها من غيب، وبشرها ببعض البشارات، وأما (تينسي) فكان لا يعيره اهتماما، لكنه تعقبهما، حتى وصل إلى مبتغاه.
الشاعر خوليو في طنجة
وكان يحفل كثيرا بشاعر إسباني يقيم في بيت يوجد في الزنقة المقابلة تماما لمقهى السنطرال، اسمه خوليو، وقال لي إنه قد أخذ إلى بيته كلا من زفزاف ومحمد بوخراز وآخرين، ووعدني بأننا سنزوره، لنتحدث عن الشعر العالمي، ونشرب، وإن وجدنا بنات من عادة المضيف أن يزهد فيهن فقد نضاجعهن وهو يدفع. لكن حينما دخلنا الزنقة وطرق محمد شكري الباب أطل علينا رأس كبير من النافذة، لرجل لعله كان حليقا أو أصلع، فتبادل كلمات بالإسبانية مع شكري، وقال لي محمد: ـ هيا بنا. إنه لن يستقبلنا، فلديه حفل خاص. قلت: ـ وما هو هذا الحفل الخاص؟ قال: ـ سبق لي أن حضرته، فهو يدعو فحولا لمجلسه، ليمارس من الخلف معهم واحدا بعد الآخر. وسألته: ـ وأنت، هل كنت من الفحول. بدا غاضبا وقال : ـ لا. أبدا. كنت شاهدا على الحفل.
قابلية المعاشرة
وبالرغم من الأجواء الإباحية التي كان قد عاش فيها وتحدث عنها، فقد عرفته متخلقا بأخلاق أهل الريف، كرامته هي دائما موضوع تشدد وهي ما لا يتسامح فيه، على لطف في المعاشرة وحب للحياة وصخب في الذاكرة، فما كان بخيلا ولا لئيما بل كان ضاحكا للحياة التي افتقد الفرح بها في صباه وبداية شبابه، فكأنه كان يعوض ما افتقده باستثمار كل اللحظات للمباهج والنقاشات الثقافية والإبداعية، وهو يتحدث، ثم يتوقف عن الكلام مغمضا عينيه لبعض الوقت، ليستحضر الفكرة أو يدقق في التعبير عنها بالكلمات المناسبة، وإذا كنا نمشي ففي مشيه استباق إلى الأمام، يتحدث وهو يستدير لمحدثه مستعجلا في خطاه وكأنه يريد أن يصل قبل الموعد.
الكاتب العالمي
وأذكر أنه كان يفخر بلقب (الكاتب العالمي) ليصفني ب ( الكاتب المحلي) بين مزاح وجد، وكان يذكر(الكاتب الكبير) بمحبة خالصة بينما كان لا يخفي بغضه لآخرين الذي وصل إلى حد القطيعة. وكان يصارحني قائلا: ـ أشعر أن ما تكتبه هو أعمق من كتاباتي، ولكني كاتب عالمي، وهو حظ ساقته الظروف إلي.
مقهى السنطرال
في بداية السبعينات، كنا نجلس في مقهى (سنطرال) بالسوق الداخل، مكانه الذي كان أثيرا لديه في تلك الفترة، ففي الصباح كنت أجلس بجواره إلى مائدة داخل المقهى، فأراه يكتب بسلاسة واندفاع وكأنه يستعرض من ذاكرته ما يكتب بعد أن كان قد حفظه. كان يكتب (من أجل الخبز وحده)، بعد أن أخبرني بأنه قد اتفق مع (بول بولز) على ترجمتها إلى الأمريكية، فكان يذهب إليه في المساء لترجمة ما كان قد كتبه في الصباح. وقد أوضح لي أن الترجمة تتم باستعمال شيء من الفرنسية والأنجليزية لتقريب المعنى إلى (بول). فخلافا للشائع، لم يكن محمد شكري قد حكى سيرته ل(بول بولز) شفويا لأن نصها العربي كان مكتوبا بين يديه، ووسائط الترجمة هي التي كانت شفوية.
وقت للسفر
في سنة 1973 وصلتني رسالة من محمد برادة من باريس يحدد معي فيها موعدا للقاء به في الرباط، فالتقينا أنا ومحمد شكري في فاس، على طريقتنا في تنظيم ذلك اللقاء، ثم ذهبنا إلى القنيطرة، فأقمنا في بيت أهلي وجالسنا المرحوم مبارك الدريبي ثم انتقلنا إلى الرباط، فجلنا في المكتبات وزنا أصدقاءنا في السفارة العراقية الذين حملونا بالكثير من الكتب، ثم ذهبنا إلى موعد محمد برادة بعد أن أكدت معه الموعد، وأخبرته بأن محمد شكري سيرافقني في ذلك اللقاء. جلسنا في مقهى يطل على الشاطئ، فأخرج محمد دفتره المدرسي الذي كان قد كتب فيه سيرته، وبدأ يقرأ على برادة لوقت طال كثيرا، وما مل برادة من الاستماع، وصوت محمد شكري يعلو بالقراءة ويتفصح في إخراج الحروف من مخارجها، والدفتر راعش بين يديه، مكتوب بحروف كبيرة وعليه تسويدات وتنقيحات. وفي الغد التقينا محمد برادة والطاهر بنجلون صدفة وهما يجلسان في مقهى السلام المقابل لمحطة القطار، لمحناهما من وراء الزجاج، وكنا محملين بالكتب التي لم نجد أكياسا تسهل علينا حملها، فبدا منظرنا مضحكا، ولم يفلتنا برادة من سخريته فشبهنا ببدويين في باريس.
وقت للثقافة
بعد نشر (الخبز الخافي)، وقبيل منعه، نظمنا لسيرة محمد شكري جلسة نقدية في إطار فرع اتحاد كتاب المغرب بفاس. انتظرت وصوله فتأخر، وحينما وصل أخبرني بأنه تعرض لحادثة سير أصيب فيه برضوض بسيطة. لن برادة كان قبل ليلة قد اتصل بي بالهاتف، وطلب مني آخذ الحذر وحساب كل شيء في تنظيم اللقاء مع شكري، متوقعا أن يحضر إلى القاعة جمهور غفير فوق ما تستوعبه القاعة، كما حدث في لقاء بالرباط. وما كان بيدي أن أفعل شيئا، وبالفعل، فقد وجدنا أزيد من ألف شخص قد ملأوا القاعة ومداخلها فلم نجد طريقا للدخول إلا بصعوبة كبيرة، ولما قدمته للجمهور وقدمت المتدخلين وأعطيت الكلمة لأولهم، احتج الجمهور وقال: ـ لا نريد سماعكم. نريد سماع محمد شكري. فطوينا أوراقنا وتقاطرت عليه الأسئلة فما وجدت سبيلا إلى إنهاء الجلسة تحت كثرة المتدخلين.
قناع تجميلي للكاتبة الآنسة (خ.ب) في سطيحة بيته أحيينا عدة سهرات حضر بعضها الطاهر بنجلون. ولا أدري من أين جاءه الاهتمام بالأقنعة التجميلية، فقد كان يأتي بطين مدعوك ناعم، يعجنه بأنامله في إناء مع عسل النحل وقرنفل وزيوت وأشياء أخرى، يقول: ـ سأُحَضِّرُ قناعا. عندما أسأله عن بعض التفاصيل يقول لي: ـ اسكت آ الأمي. شف واسكت. ذات صباح زارته الأديبة (خ. ب) وأنا في بيته فكان بينهما حديث عن الزعيم علال الفاسي، وأخذ شكري يتحدث عن لقاءاته معه عندما كان يزور طنجة، ومن ذلك أ،ه ذهب ذات يوم للقاء الزعيم، وكان شعره مسترسلا، فالموضة آنذاك كانت تقتضي إرسال الشعر على طريقة الخنافس، فسأله الزعيم السي علال: ـ وما هذا الشعر؟ ارتبك وما أراد أن يفصح للزعيم عن نيته في إرسال شعره، ثم أجاب: ـ لم أجد ما أدفعه للحلاق. فأخرج الزعيم من جيبه ورقة مائة درهم وقال له: ـ هاك ما تحلق به شعرك. وإرضاء للزعيم خرج من المكان وذهب إلى أقرب حلاق فحلق شعره وعاد إلى مجلس الزعيم. بدت الكاتبة (خ.ب) معجبة بما يحكيه، فأخذ كفها وبسطه بين يديه. نظر في الخطوط والتعاريج وهي تُسْلِمُ له كفها وعيناها تتطلعان إلى عينيه. بشرها بعريس. شهقت وقالت: ـ أعوذ بالله. ثم عادت تشهق وقالت: ـ يا إلاهي. بعد أن أعد لنا القهوة، صنع لها قناعا من الطين والمراهم والعسل. بأنامله سواه على وجهها حتى لم يعد يظهر من وجهها سوى العينين. ظلت مستسلمة لما يفعل. أخذها برفق وأجلسها على كرسي في السطيحة، قبالة الشمس، وطلب منها أن تبقى هناك لساعتين، حتى يجف القناع. قال لي: ـ اتركها نستحضر ذكرياتها مع الزعيم علال وتعال لنبدأ شغلنا. علينا أن نذهب إلى السوق ونعود لإعداد طعام الغذاء. أعجب الآنسة (خ.ب) ما أعددناه من طعام، ودخلت معها في حديث حول الطبخ الفاسي. لم يعجب ذلك شكري فقال: ـ هو طعام الله، يطعم به عباده الصالحين، أينما وجدوا. عندما ذهبت الآنسة (خ.ب) خرج محمد إلى السطيحة ونظر إلى الإناء الذي يقي فيه شيء من ذلك المعجون الذي أعد منه قناع الآنسة، فقال لي: ـ ماذا نصنع بهذه البقية؟ قلت: ـ هي بقية ولا يمكن أن نصنع منها شيئا. قال وهو ينظر إلى الشمس المتوهجة في ذلك اليوم من شهر غشت: ـ الشمس ما تزال متوهجة،. يمكن أن نصنع من هذه البقية قناعين، لي ولك، ولنأخذ قيلولتنا قبالة الشمس.
وقت للجنون
كان يحدثني عن إصابته في وقت سابق بصدمة نفسية أودت به إلى المصحة العقلية، فكان يعالج بالصدمة الكهربائية، وقد وصف لي الصناجات التي كان تلصق على رأسه، وأنه بعد خروجه من المصحة كان قد حمل كتب مكتبته في صناديق وعرضها على الشارع للبيع، بسعر عشر فرنكات للكتاب، فجاء أحد أصدقائنا الذي اشترى منه الكتب جميعا بذلك السعر، فلما ندم محمد وأراد استرجاع كتبه لم يقبل ذلك الصديق الشاعر أن يرجعها إليه، فبقيت الحسرة في نفسه. لكنه عندما دخل مصحة (مايوركا) راسلني من هناك، فبادرت بنشر مقال بعنوان (اهتزاز أرواح الكتاب) تعرضت فيه لقلق الكاتب والكتابة والحياة، معتبرا أن حالة محمد شكري هي حالة جمعية، فالكتابة وضعية لصيقة بالجنون، وإن كان ذلك الجنون يختلف من كاتب لآخر. وصلتني منه رسالة يعتب علي فيها على فضح حالته الخاصة بنشر المقال، وقال إنه لن يحظى بثقة الناس بعد خروجه، وما كنت أقصد التشنيع بحالته بل كنت أتعاطف معها وأجد فيها شيئا من ذاتي.
وقت للبلبل
لكنه وهو المعلم القديم، كان يطرب أحيانا فيرسم بيديه حركة المايسترو، ويبدأ في ترديد ذلك النشيد الذي كان يعلمه للأطفال : قد كان عندي بلبل في قفص من ذهب وقت لدنيا الدمع والابتسام ومرة لما زارتي في فاس، أقام المرحوم أحمد المجاطي سهرة في بيته، دعانا لها أنا ومحمد، وكان من بين الحاضرين محمد سبيلا وأحمد الطريبق وأحمد يبوري، فكان محمد باسما يلقي الكلمات وكأنه يلقي بحجر في بركة ماء، يتحدث عن ألبير كامي وسارتر ومورافيا والإلياذة والأوديسة، وعن نصوصه التي كتبها بعنوان (البطل والخلاص)، وبجدية أستاذنا أحمد اليابوري المعروفة، ونبل أخلاقه وتساميه، كان يصغي إلى شكري، الذي قام فجأة فسحب الأطعمة من فوق المائدة، وصعد فوقها، فأخذ يغني: يادنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي وما كان ذلك يليق بجلسة جادة فبهت المرحوم المجاطي وطلب مني أن أعيد شكري إلى صوابه. والحق أنه كان على صواب، فقد كان يغني لدنياه التي اجتمع فيها الدمع بالابتسام، وهكذا كان.
وقت للذاكرة
حدثنا عن غنائه في مقهى كان يعمل به نادلا، وقد زرت معه ذلك المقهى في تطوان بعين الخباز، كما زرنا معا مراتع طفولته وأنا أصغي إلى تعليقاته وأرى الشجن في عينيه وهو يقول لي في الطرنكات: ـ هنا كانت أمي تبيع الخضر. ثم نسير قليلا فيتوقف عند قوس ويقول : ـ وهنا كان الفرن الذي كنت أنام بجواره. قبل ذلك بسنوات خلت، زرته في طنجة فكان يتهيأ للذهاب إلى تطوان لحضور عرس أخته الصغرى، وأطلعني على هديته للعروس التي كان يحبها حبا شديدا، وهي ساعة ذهبية وقارورة عطر، وطلب مني أن أرافقه لحضور العرس، فلما دخلنا بيتهم في تطوان لم تكن هناك علامات للعرس، وقالت له أخته (رحيمو) إن العرس قد أقيم قبل يومين، وهو نفسه كان قد نسي الهدية في بيته في طنجة، فعدنا ليلا وهو حزين ومرتبك، يؤكد لي أن الرسالة التي وصلته لتحدد موعد العرس لم يخطئ قراءتها، وكان عليهم أن يقولوا له لقد قدمنا العرس.
وقت للأم
بعد ذلك وجدته مرة في حالة عصبية وهو يحدثني عن مكالمة هاتفية تلقاها من زوج أخته الصغرى، الذي اقتحمه بسؤال : ـ هل صحيح ما كتبته عن أمك؟ فغضب محمد ورد عليه : ـ أنا لا أعرف أمك ولم أسأل عنها، فلماذا لا تتركني وشأني مع أمي؟ وقطع المكالمة. في بداية التسعينات، وجدته مرة في أحد شوارع طنجة وهو يقف مستندا إلى حائط، في حالة ذهول، فسألته : ـ ماذا تفعل هنا ؟ قال : ـ شايط. فهمت أنه ضائع فاقترحت عليه أن يقضي معي مدة في بيتي في مرتيل، وذهبنا إلى بيته فحمل بعضا من ملابسه وأوصى بوصاياه فتحية، حول كلبه (جوبا) وألا يدخل البيت أحد في غيابه، وما عليها أن ترد به على الهاتف إن تكلم فلان أو فلان.
وقت لرحيل البحر
في بيتي بمرتيل أقام عدة مرات ولأيام، كان خلالها، وعندما أذهب للعمل، قد تفرق لقراءة ما أصدرته من روايات، فقرأ (المباءة) و(رحيل البحر) وروايات أخرى، وكان يعلق على ما يقرأ، ففي (رحيل البحر) أثاره وصف إحدى الشخصيات ب : (ازرقت عيناه من كثرة التحديق في البحر)، وقال لي إنك تكتب الشعر في الرواية. كان يقرأ في مقهى (الشمس والبحر)، وقد دللته زوجتي كثيرا وهي تجبر خاطره وتعد له ما يشتهيه من طعام، وقد سألته: ـ لماذا لا تتزوج ؟ فرد عليها : ـ لم أجد امرأة مثلك. وتذكرت أنني كنت قد طرحت عليه نفس السؤال، وكان قد أجابني: ـ لم أجد امرأة حمقاء مثلي. كنا نبدع تفاصيل جميلة لليومي، وهو نفسه كان يقول: ـ الحياة قبيحة وعلينا أن نعرف كيف نجعلها جميلة. كان يتحدث عن الكتابة نفسها، معتبرا وظيفتها هي تجميل القبح. أتذكر أيام السبعينات التي كنا نتبارى خلالها أنا وإياه في إعداد الأطعمة، فكان بارعا في إعداد الأرنب بالزبيب والبصل، أكلته المفضلة، وكنت أبرع في إعداد أطعمة أخرى من الذوق الفاسي، يشهد لي بتفوقي عليه فيها، لكنه يستدرجني لإعداد الأرنب بالزبيب والبصل، عارفا أنني لن أتفوق فيه، وحتى يتفوق علي ويهزمني. في أصيلة كان (ألبيرتو مورافيا) قد طلب اللقاء مع شكري، فتحلقنا جماعة في مقهى القصبة ننتظر مجيء (ألبيرتو)، ودار حوار بينه وبين شكري حول علاقة بالجنس والسياسة بالأدب.
وقت للإقتراض
ذات مرة ذهبت إليه في رمضان وطلبت منه أن يقرضني مبلغ خمسة آلاف درهم، فبدا مترددا وقال لي: ـ لدي في البنك أحد عشر ألف درهم، وهي كل ما عندي، ومستقبلي المالي غامض. ثم من غير أن ألح عليه قبل السلفة، وفي الطريق إلى البنك حدثني عن أموال كثيرة قرضها لأناس كثيرين فلم يرجعوها. لما دخلنا البنك وطلب الكشف وجد في حسابه مبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، فتحير في أمره، وبعد السؤال تبين أنها حقوق أرسلتها إليه الشركة الإيطالية التي كان قد أمضى معها عقد لإنجاز (الخبز الحافي) إلى السينما. تأخرت عليه بضعة شهور ثم اتصلت به بالهاتف أخبره بأنني سوف آتي لتسديد الدين، فلما جلسنا في شقته سألني : ـ هل أتيت بالخمسة آلاف درهم؟ أخرجتها من جيبي وسلمتها له، لكنها لم يمد يده إليها وقال: ـ أنا متردد في أخذها. قلت: ـ لماذا: قال: ـ لقد تأخرت علي بها لخمسة أشهر، وأنا شكوتك لمحمد برادة، لكنه طلب مني أن أتخلى لك عنها، ووعدته بذلك. بدا مترددا وقال: ـ نقتسمها بالتساوي، ليبقى برادة على خاطره. لكني ألححت عليه في أخذها كاملة، فأخذها وهو يلح علي في ألا أتحدث مع برادة في الموضوع. قلت له : ـ هو مالك أنت، واسترجاعه مني حق لك، فلا تتحرج من برادة.
وقت للكاتب العالمي
وأذكر مرة أن الروائي الكبير حليم بركات كان قد زارني في فاس، قادما إليها من (جورج تاون) حيث يُدرس بجامعتها، فطلب مني أن أرافقه إلى صفرو حيث توجد أسرة طالب مغربي يدرس لديه، وكان حليم يحمل لها مالا ورسالة، فركبنا سيارة نقل عمومية وجلسنا في مؤخرتها بعد أن كانت قد امتلأت بالركاب، وكان بجوارنا شاب أمريكي يعمل مصورا فوتوغرافيا لصالح إحدى المجلات، فتبادل الحديث مع حليم، وسأله حليم عمن يعرف من الكتاب العرب، فقال الأمريكي : ـ أعرف كاتبا واحدا هو محمد شكري. هذه هي عالميته، وكأن ضحكته، وأحاديثه، ومرضه، وكتبه وصوره مع المبدعين، كلها حكايات عاشها بطل أسطوري ملعون بلعنة الحياة التي أحبها. قبل أن يصاب بالمرض بفترة قصيرة جدا، مررنا أنا وزوجتي وولدي في نفس الشارع الذي يوجد فيه(الريتز) مكانه الأخير، فسمعت صوته يناديني. كان قد رآني من داخل المقهى وخرج يناديني، وألح علينا في أن نشرب معه شيئا. كان في وضع عصبي سيئ، وهو يتحدث عن سقوطه في الشارع، وتخلي أحد أصدقائه عنه، وسرعان ما جاءت فتحية إلى المقهى فطلب منها أن تقدم شهادتها أمامي وأمام زوجتي.
وقت للمزاح العكر
ولقد أصبح مزاحه عكرا على الدوام في السنوات الأخيرة، وكان في السنوات الأخيرة كلما جالسته يطلب مني أن أدفع ثمن ما نشرب، ويخرج من جيبه نقودا كثيرة فيقول: ـ بإمكاني أن أدفع، ولكني أحس بمتعة أن تدفع أنت، فكلهم، أدفع عليهم ولا أحد منهم يدفع علي. حينما كلمته بالهاتف وهو في المستشفى كنت لا أعرف ما أقول، وكان رابط الجأش. أخبرته بأنني سوف أزوره بعد يومين، وسألته إن كان في حاجة إلى شيء، فرد علي: ـ شكرا. لا أحتاج إلى شيء. في إهداء (زمن الأخطاء) كتب لي: ( الأخ محمد عز الدين إن الأصدقاء الحقيقيين لا يشكرون على عنايتهم بنا وتشجيعهم لنا. . . . . . . ) طنجة : 26 ـ 7 ـ 1992
وقت للموت
موت محمد كان فاجعة لي، ففي موته أحسست بعميق ذهابي مع ذهابه، ولما وقف على قبره في ساعة الدفن، كنت أراه واقفا بجواري يتابع المشهد، وكأن من يوارى في التراب هو بؤس الطفولة وشقاوة الأيام وقبح الحياة الذي جملناه كثيرا فلم يتجمل. كان محمد شكري نفسه يواري في قبره زمن أخطائه، وزمن أخطاء جيلنا، وأما نظرته وضحكته وصخبه ومحبه للحياة، فستبقى كلها ملكا للذاكرة، كما ستبقى كتبه مصدر اغتناء للقراء.
وقت للحلم
في ليلة يوم الأحد، السابع من ديسمبر 2003، أصابني اختناق شديد صعب علي معه التنفس، لم ينفع معه الشراب الطبي. وخلال نوم قصير رأيت فيما يرى النائم أنني أنا ومحمد شكري ننام بثيابنا على الأرض في ساحة من ساحات باريس، والناس يمرون من حولنا فينظرون إلينا كما يُنظر إلى المهمشين الذين ينامون في الشوارع. مددت يدي إلى معصمه وجسست نبضه فرفع عينيه نحوي
وقال: ـ لا تخف. ما زال قلبي ينبض.
تركته ومشيت إلى مكان يشبه محطة القطار، فوقفت وسط الزحام وشاهدت أناسا كثيرين أعرفهم، كان من بينهم الروائي الفلسطيني الراحل إيميل حبيبي، وقد بدا عليه الفزع، فقلت له :
ـ لا تفزع على محمد فقلبه ما يزال نابضا. ورأيت حسن نجمي يقطع ورقة تذكرة ويقول لي:
ـ بها سنعيده إلى المغرب.
فقلت له:
ـ وهذا الحشد من الكتاب والصحفيين هل سيعود معه بنفس التذكرة؟ بدا مستغربا سؤالي.
فقلت له :
ـ قلب محمد ما يزال نابضا، فلماذا تستعجلون دفنه وهو حي ما يزال؟
قال: ـ نخشى عليه من أن نبدأه تلك الدرجات القصوى من الألم.
رجعت إلى الساحة الباريسية التي كان ينام فيها محمد على الأرض، فوجدته ينتظرني. أخرج من جيبه أوراقا مالية كثيرة وقال لي:
ـ هذا المال أريد أن أكافئ به عاهرة كانت قد خدمتني في الفراش جيدا.
قلت له: ـ من هي؟
قال: ـ إنك تعرفها جيدا.
ـ أين هي؟
ـ في طنحة. إنها طنجة نفسها. تدعي الآن أنك لا تعرفها، حتى وقد كتبت عنها روايتين؟ هل أذكرك ب(مغارات) و(ضحكة زرقاء).
قلت:
ـ كافئها به أنت ، فأنت لم تمت بعد.
قال :
ـ هي التي لا تموت. هرقل لا يموت. ثم اختبأ في حضني فأعادني إلى تلك اللحظات اللذيذة التي كنت أنيم فيها أولادي في حضني وهم صبيان، فأقص عليهم أحسن القصص. بدأ يتألم، فتزحزح وشكا من حنجرته، فأحسست الألم في صدري وحنجرتي. نهضت من تلك النومة الخفيفة وأخذت أقص على نفسي ذلك الحلم، وأنا أسعل سعالا حادا وصدري يتصدع، ودموع لا إرادية تتهاوى على خدي، والليل موحش والحمى الباردة تسكن بين الضلوع.
وقت للشهادة على الموت والحياة
تذكرت أنني كنت قد ختمت شهادتي عن محمد شكري في أصيلة، خلال الندوة التي خصصها له اتحاد كتاب المغرب، بأنني حينما علمت بمرضه، فقد أحسست المرض في جسدي. وكان ذلك اعترافا بصوفية الجسد، وبقدرته على الحلول. فلم يكن الأمر يعني شكوى من جسدي، بل هي شكوى من جسد محمد وأنا أشعر بجسده ينخره المرض، من خلال جسدي. تماما كما كان محمد قد دخل مصحة مايوركا، بعد اضطراب عصبي، فوجدت أن في ذلك ما يعني اهتزاز أرواح الكتاب، الكتاب الذين لهم أرواح.