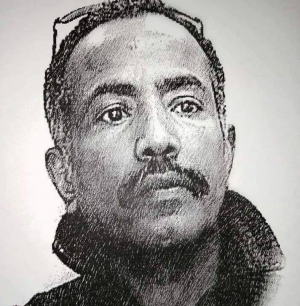يا الله! وفي الدنيا هذا الجمال؟
فتاة، وما اعرف مثلها فيمن رأيت!
أتراها كانت تعرف أين هي من أحلام فتيان الحي؟
وكان لها من جاه أبيها جمالٌ إلى جمال، فاجتمعت لها أسباب الفتنة والإغراء. . .
ورآها صديقي فتبدل غير ما كان، وأنه لشاب وإنها لفتاة، ولكنها. . . ولكنه. . .
وجاءني ذات مساء وفي عينيه دموع. . . يا لي مما أرى! صديقي يبكي! هذا الذي كنت أظنه لا يحمل من هم الدنيا إلا مثل ما تحمل نعله من تراب الأرض! يا عجباً!
وفتحت له صدري فآوى إليه، ومضى يحدثني بخبره
(. . . وما يليق أن أبقى اليوم عزباً. . . وقد جاوزت الخامسة والعشرين!)
وابتسمت؛ فما سمعت صديقي يتحدث قبل عن الزواج بمثل هذا الوقار المحتشم. لقد استطاعت امرأة واحدة أن تحمله على رأي لم يكن واحد من أصاحبه جميعاً يستطيع أن يحمله على الإيمان به.
ويا طالما قلنا ويا طالما أجاب. . .!
ومضى صديقي في حديثه:
(وأجمعت أمري على أن تكون لي؛ فما يرضيني أن لي بها كلّ متاع الدنيا. لقد وجدتها، وهي حسبي من دنياي!
(وراح الرسول عن أمري يؤامرها ويرود لي الطريق؛ وكتم عنها أسمي وخبري ومكاني بين الناس؛ فما كان إلا أن سألته: وكم جنيهاً يقبض في كل شهر؟
(وأجابها الرسول بما أجاب، فضحكت ساخرة وقالت: أثني عشر جنيهاً؟ ياله من عروس! فكم يعطي الطباخ وكم يعطي السوّاق. . .؟
(وعاد إليّ الرسول بجوابها. . .!)
واطرق صديقي برهة، ثم رفع رأسه وشفته تختلج وفي عينيه بريق. وابتسمت ثانية، وقالت: فما غضبك يا صديقي مما قالت؟ أن لها في الحياة ميزانها الذي تقيس به أقدار الرجال؛ وأن للحياة موازينها؛ فما ضرك أن تكون في ميزانها ما تكون وأنت أنت.
إن معك الشباب والقوة، وأن لك غداً يبتسم ويرفّ، وإن دماً في أعراقك يتحدث به التاريخ؛ فهل يخدعك عن كل أولئك أن فتاة تقول. . .؟
وأمسكت عن تمام الحديث؛ فقد رأيت في عيني صاحبي ما قطعني وردني إلى الصمت!
وعاد إلى حديثه:
(وددت يا صاحبي لو لم يكن كل أولئك وكانت هي. . .؟)
ورأيتني منه على حال لا يجدي معها إلا أن أسكت؛ فسكت! وودّعني صديقي بالوجه الذي لقيني به، ومضى لشأنه
يا لقلوب الشباب من سلطان الحب!
ولقيته بعد ذلك مرات؛ ولكنه كان شابّاً غير من أعرف
هذا الذي كان لا يعرف من فروض الحياة على الحي إلا أن يبتسم ويضحك، ويعبث بكل شيء، ويسخر من كل شيء - قد عاد في عبوسه وتزّمته وصرامة نظرته إلى الحياة خلقاً آخر!
يا عجباً! أين ما صار مما كان؟
تمرُّ به الجملية الفاتنة قد أخذت زخرفتها وأزَّينت، فما تظفر منه إلا بالنظرة العابرة!
ويسمع النكتة البكر تضجّ لها جنبات المجلس بالضحك والتهليل فما تنال منه إلا بسمةً خاطفة!
وتتداعى أمانيُّ الشباب في معترك الحديث من حوله فما تسمع منه إلا أنةً خافته!
ويتبارى الفتيان فيما يحكون من أقاصيص الحب وغزوات الشباب فما ترى على وجهه من دلائل يقظة الوجدان إلا سبْحة لطيفة من سبحات الذكرى، ثم خفقة طرف وخلجة شفة!
ثم يسمع أحاديث الزواج والخطبة. . . فتراه كما ترى جنديَّاً في إجازة يتلقى أخبار معركة حربية مظفرة وبينه وبين الميدان أبعاد وأبعاد!
ترى ماذا يتوقع أن يسمع؟
شئ واحد لم يغيِّره الزمن من أخلاق صاحبي: هو سخاء يده؛ فما عرفت في أصحابي من قبل ومن بعد أكرم يداً منه بما يملك!
وترادفت الأعوام، ولم يتزوج صديقي. . . ولم تتزوج صاحبته!
أتراها كانت تعلم من خبره ما أعلم؟ ومن أين لها؟. . . أن لصاحبي من الكبرياء ما يمنعه أن يلتمس إليها الوسيلة بعد ما كان. . . وإن. . . وأن الخطاب لتزدحم أقدامهم على بابها فما تعرف كم ردّت بالخيبة والخذلان!
أم تراها تعرف أسمه؟. . . هذا الذي لا تذكر من صفاته - إن ذكرتْ - إلا أنه شاب يبلغ دخله في الشهر اثني عشر جنيهاً، بعث إليها مرة يخطبها فردّته. . . وكم في خدمة الدولة من شبان يبلغ دخلهم ما يبلغ دخله؛ وحسبه هذا تعريفاً بين آلاف من النكرات!
ولكن صديقي اليوم في منصب رفيع. لقد سماه به جده وعمله إلى ما لم يبلغ أحد من نظرائه! أتراه يوازن اليوم بين ماضيه وحاضره؟
لقد مضى منذ تلك الليلة التي زارني فيها صديقي زيارته خمس عشرة سنة!
ياه. . .! ما أسرع ما تمرّ السنون!. . . أين أنا اليوم مما كنت يومئذ؟
لقد كنت يومئذ فتىً في باكر الشباب، ولم يجر حدّ الموسى على عارضه بعد؛ وأنني اليوم لزوجٌ وأب، وإن في رأسي لشعرات بيضاً ما أن يخفيها ميل الطربوش ولا صنعة الحلاق!. . .
وصديقي لم يزل عزباً. . . صديقي الذي كان يخشى أن تفوته سن الزواج، منذ خمس عشرة سنة!
أين هو اليوم؟ وأين حاضره وماضيه؟
لقد ضربت بيني وبينه ضربات الدهر فلم ألقه منذ أعوام. وددت لو أعرف من خبره!
وخرجت أمس من داري على ميعاد. فأني لفي طريقي إذ لقيته! يا للحظ!
وأقبلت عليه وأقبل عليّ؛ وهممت أن أسأله حين بادرني بقوله: (إنني أدعوك بعد غد إلى داري. . . . . .)
- تدعوني؟. . .
- نعم، لقد اتفقنا أن يكون الزفاف بعد غد!
- بمن؟ - وهل حسبتني أرضى يوماً أن لي بها كلَّ متاع الدنيا!
إنها هي. . . لقد ضرب القدر بيننا موعداً فلم يخلفه. إن لكل شئ أوانه!
. . . وكما جلس صديقي مني مجلسه ذات مساء، منذ خمس عشرة سنة ليحدثني بخبره - كان مجلسه الليلة مني. . .
وكان في عينيه غير البريق، ولصوته لحن ورنين، وفي عينيه دموع؛ وكانت الكلمات ترتعش على شفتيه؛ لأن فيها نبضات قلب حي. وصعّدت نظري إليه؛ فرأيت في فوديه شعرات سوداء في شعر أبيض، كأنما كانت لتشير إلى أنه مازال هنا بقية من شباب.
ومضى صديقي في حديثه. . .
(. . . ولم يعد إليها رسولي منذ كان ما كان؛ وما عرفت أسمي ولا جاءها خبر من خبري بعد؛ وكأنما كان يدخرها لي القدر، فلم تتزوج، وأرتد الخطاب جميعاً عن بابها مخذولين، وآن الأوان. . . . . .
(هل جاءك يا صديقي أن مرتبي اليوم في الحكومة ثلاثون جنيهاً في الشهر، غير ما أكسب من أعمالي الخاصة؟. . . . . . . . .
وبعثت إليها رسولاً آخر يؤامرها للمرة الثانية. . .)
وضحك صديقي ضحكة مرحة، ثم عاد يقول:
- أتذكر ليلة جلست إليك أحدثك مثل حديث الليلة، منذ. . . منذ كم. . .؟
(. . . وقالت للرسول وقال لها؛ ثم سألته: وكم دخل صاحبك في الشهر؟ فأجابها. . . وكان القدر قد هيأ أسبابه، فأجابت. . . وزرتها من بعد، وتم الاتفاق!)
قلت لصاحبي:
- فهل عرفت هي أنك أنت أنت،. . . هل عرفت أنك سعيت لخطبتها مرة منذ خمس عشرة سنة فردتك؟
فقال:
(وماذا يعنيني، عرفت أو لم تعرف؟ حسبي إنها اليوم لي؛ وأن ما أرادته قد كان!)
ووجد المسكين تعبير رؤياه بعد خمس عشرة سنة من عمر الشباب، ووجدت تعبير أمانيها. وباعت المسكينة شبابها وشبابه بثمن بخس، حين تأبتْ عليه، ومعه حرارة الشباب ونضارة العمر وسعادة الحب لترضاه من بعد وهو شبابٌ مدبر، ونجم آفل، وشعلة إلى رماد!. . .
محمد سعيد العريان
مجلة الرسالة - العدد 341
بتاريخ: 15 - 01 - 1940
فتاة، وما اعرف مثلها فيمن رأيت!
أتراها كانت تعرف أين هي من أحلام فتيان الحي؟
وكان لها من جاه أبيها جمالٌ إلى جمال، فاجتمعت لها أسباب الفتنة والإغراء. . .
ورآها صديقي فتبدل غير ما كان، وأنه لشاب وإنها لفتاة، ولكنها. . . ولكنه. . .
وجاءني ذات مساء وفي عينيه دموع. . . يا لي مما أرى! صديقي يبكي! هذا الذي كنت أظنه لا يحمل من هم الدنيا إلا مثل ما تحمل نعله من تراب الأرض! يا عجباً!
وفتحت له صدري فآوى إليه، ومضى يحدثني بخبره
(. . . وما يليق أن أبقى اليوم عزباً. . . وقد جاوزت الخامسة والعشرين!)
وابتسمت؛ فما سمعت صديقي يتحدث قبل عن الزواج بمثل هذا الوقار المحتشم. لقد استطاعت امرأة واحدة أن تحمله على رأي لم يكن واحد من أصاحبه جميعاً يستطيع أن يحمله على الإيمان به.
ويا طالما قلنا ويا طالما أجاب. . .!
ومضى صديقي في حديثه:
(وأجمعت أمري على أن تكون لي؛ فما يرضيني أن لي بها كلّ متاع الدنيا. لقد وجدتها، وهي حسبي من دنياي!
(وراح الرسول عن أمري يؤامرها ويرود لي الطريق؛ وكتم عنها أسمي وخبري ومكاني بين الناس؛ فما كان إلا أن سألته: وكم جنيهاً يقبض في كل شهر؟
(وأجابها الرسول بما أجاب، فضحكت ساخرة وقالت: أثني عشر جنيهاً؟ ياله من عروس! فكم يعطي الطباخ وكم يعطي السوّاق. . .؟
(وعاد إليّ الرسول بجوابها. . .!)
واطرق صديقي برهة، ثم رفع رأسه وشفته تختلج وفي عينيه بريق. وابتسمت ثانية، وقالت: فما غضبك يا صديقي مما قالت؟ أن لها في الحياة ميزانها الذي تقيس به أقدار الرجال؛ وأن للحياة موازينها؛ فما ضرك أن تكون في ميزانها ما تكون وأنت أنت.
إن معك الشباب والقوة، وأن لك غداً يبتسم ويرفّ، وإن دماً في أعراقك يتحدث به التاريخ؛ فهل يخدعك عن كل أولئك أن فتاة تقول. . .؟
وأمسكت عن تمام الحديث؛ فقد رأيت في عيني صاحبي ما قطعني وردني إلى الصمت!
وعاد إلى حديثه:
(وددت يا صاحبي لو لم يكن كل أولئك وكانت هي. . .؟)
ورأيتني منه على حال لا يجدي معها إلا أن أسكت؛ فسكت! وودّعني صديقي بالوجه الذي لقيني به، ومضى لشأنه
يا لقلوب الشباب من سلطان الحب!
ولقيته بعد ذلك مرات؛ ولكنه كان شابّاً غير من أعرف
هذا الذي كان لا يعرف من فروض الحياة على الحي إلا أن يبتسم ويضحك، ويعبث بكل شيء، ويسخر من كل شيء - قد عاد في عبوسه وتزّمته وصرامة نظرته إلى الحياة خلقاً آخر!
يا عجباً! أين ما صار مما كان؟
تمرُّ به الجملية الفاتنة قد أخذت زخرفتها وأزَّينت، فما تظفر منه إلا بالنظرة العابرة!
ويسمع النكتة البكر تضجّ لها جنبات المجلس بالضحك والتهليل فما تنال منه إلا بسمةً خاطفة!
وتتداعى أمانيُّ الشباب في معترك الحديث من حوله فما تسمع منه إلا أنةً خافته!
ويتبارى الفتيان فيما يحكون من أقاصيص الحب وغزوات الشباب فما ترى على وجهه من دلائل يقظة الوجدان إلا سبْحة لطيفة من سبحات الذكرى، ثم خفقة طرف وخلجة شفة!
ثم يسمع أحاديث الزواج والخطبة. . . فتراه كما ترى جنديَّاً في إجازة يتلقى أخبار معركة حربية مظفرة وبينه وبين الميدان أبعاد وأبعاد!
ترى ماذا يتوقع أن يسمع؟
شئ واحد لم يغيِّره الزمن من أخلاق صاحبي: هو سخاء يده؛ فما عرفت في أصحابي من قبل ومن بعد أكرم يداً منه بما يملك!
وترادفت الأعوام، ولم يتزوج صديقي. . . ولم تتزوج صاحبته!
أتراها كانت تعلم من خبره ما أعلم؟ ومن أين لها؟. . . أن لصاحبي من الكبرياء ما يمنعه أن يلتمس إليها الوسيلة بعد ما كان. . . وإن. . . وأن الخطاب لتزدحم أقدامهم على بابها فما تعرف كم ردّت بالخيبة والخذلان!
أم تراها تعرف أسمه؟. . . هذا الذي لا تذكر من صفاته - إن ذكرتْ - إلا أنه شاب يبلغ دخله في الشهر اثني عشر جنيهاً، بعث إليها مرة يخطبها فردّته. . . وكم في خدمة الدولة من شبان يبلغ دخلهم ما يبلغ دخله؛ وحسبه هذا تعريفاً بين آلاف من النكرات!
ولكن صديقي اليوم في منصب رفيع. لقد سماه به جده وعمله إلى ما لم يبلغ أحد من نظرائه! أتراه يوازن اليوم بين ماضيه وحاضره؟
لقد مضى منذ تلك الليلة التي زارني فيها صديقي زيارته خمس عشرة سنة!
ياه. . .! ما أسرع ما تمرّ السنون!. . . أين أنا اليوم مما كنت يومئذ؟
لقد كنت يومئذ فتىً في باكر الشباب، ولم يجر حدّ الموسى على عارضه بعد؛ وأنني اليوم لزوجٌ وأب، وإن في رأسي لشعرات بيضاً ما أن يخفيها ميل الطربوش ولا صنعة الحلاق!. . .
وصديقي لم يزل عزباً. . . صديقي الذي كان يخشى أن تفوته سن الزواج، منذ خمس عشرة سنة!
أين هو اليوم؟ وأين حاضره وماضيه؟
لقد ضربت بيني وبينه ضربات الدهر فلم ألقه منذ أعوام. وددت لو أعرف من خبره!
وخرجت أمس من داري على ميعاد. فأني لفي طريقي إذ لقيته! يا للحظ!
وأقبلت عليه وأقبل عليّ؛ وهممت أن أسأله حين بادرني بقوله: (إنني أدعوك بعد غد إلى داري. . . . . .)
- تدعوني؟. . .
- نعم، لقد اتفقنا أن يكون الزفاف بعد غد!
- بمن؟ - وهل حسبتني أرضى يوماً أن لي بها كلَّ متاع الدنيا!
إنها هي. . . لقد ضرب القدر بيننا موعداً فلم يخلفه. إن لكل شئ أوانه!
. . . وكما جلس صديقي مني مجلسه ذات مساء، منذ خمس عشرة سنة ليحدثني بخبره - كان مجلسه الليلة مني. . .
وكان في عينيه غير البريق، ولصوته لحن ورنين، وفي عينيه دموع؛ وكانت الكلمات ترتعش على شفتيه؛ لأن فيها نبضات قلب حي. وصعّدت نظري إليه؛ فرأيت في فوديه شعرات سوداء في شعر أبيض، كأنما كانت لتشير إلى أنه مازال هنا بقية من شباب.
ومضى صديقي في حديثه. . .
(. . . ولم يعد إليها رسولي منذ كان ما كان؛ وما عرفت أسمي ولا جاءها خبر من خبري بعد؛ وكأنما كان يدخرها لي القدر، فلم تتزوج، وأرتد الخطاب جميعاً عن بابها مخذولين، وآن الأوان. . . . . .
(هل جاءك يا صديقي أن مرتبي اليوم في الحكومة ثلاثون جنيهاً في الشهر، غير ما أكسب من أعمالي الخاصة؟. . . . . . . . .
وبعثت إليها رسولاً آخر يؤامرها للمرة الثانية. . .)
وضحك صديقي ضحكة مرحة، ثم عاد يقول:
- أتذكر ليلة جلست إليك أحدثك مثل حديث الليلة، منذ. . . منذ كم. . .؟
(. . . وقالت للرسول وقال لها؛ ثم سألته: وكم دخل صاحبك في الشهر؟ فأجابها. . . وكان القدر قد هيأ أسبابه، فأجابت. . . وزرتها من بعد، وتم الاتفاق!)
قلت لصاحبي:
- فهل عرفت هي أنك أنت أنت،. . . هل عرفت أنك سعيت لخطبتها مرة منذ خمس عشرة سنة فردتك؟
فقال:
(وماذا يعنيني، عرفت أو لم تعرف؟ حسبي إنها اليوم لي؛ وأن ما أرادته قد كان!)
ووجد المسكين تعبير رؤياه بعد خمس عشرة سنة من عمر الشباب، ووجدت تعبير أمانيها. وباعت المسكينة شبابها وشبابه بثمن بخس، حين تأبتْ عليه، ومعه حرارة الشباب ونضارة العمر وسعادة الحب لترضاه من بعد وهو شبابٌ مدبر، ونجم آفل، وشعلة إلى رماد!. . .
محمد سعيد العريان
مجلة الرسالة - العدد 341
بتاريخ: 15 - 01 - 1940