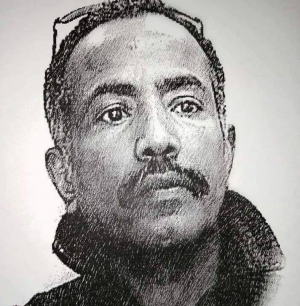حين غادروا منزلها، وخلت لنفسها، انفرد بها السؤال المرّ الذي حار الشباب في معالجته مثلما حارت هي أيضاً: “وماذا لو لقطوني؟!”.
قبل قليل كانوا هنا، معها، يفيضون بالشرح، وتفيض بالإصغاء. حكوا لها عن ضرورات إيصال الرسالة. عن الأوضاع القلقة، وعن حيرتهم في اعتماد طريقة، ثمّ عجزهم عن إيجاد بديل عنها: “ليس لنا غيرك. أنت صلتنا الوحيدة، المباشرة، به” وعرضوا مخاطر عدم وصول الرسالة، المخاطر المترتّبة عليهم، وعلى زوجها، في ظلّ الحملات الجديدة، عن تقديرهم لوعيها وحرصها. وحكت لهم بإسهاب عن تفاصيل زياراتها، والسجن، والحراس، والوقت… “باليد، قالوا لها، لا تغامري بطريقة أخرى” واستفهمت منهم عمّا عساها تفعل إن فشلت “حاولي أقصى جهدك” وعمّا إذا كانوا يريدون ردّاً منه، وطريقة الاتصال بهم، وإذا كان من الأفضل استشارة زوجها قبلاً: “لا وقت أبداً. أوصلي الرسالة إليه مباشرة، ودون جواب منه”.
بحثوا، وبحثتْ، كل التفاصيل والترتيبات. نقطة واحدة حاولوا، بداية، الاتفاق عليها، ثم فضّل الشباب أن يتركوا لها اختيارها لكونها الأعلم بدقائق الزيارة، حيثياتها، ومستجداتها: كيف ستسلّمه الرسالة؟
– “هذه اتركوها لي، قالت ساهمة، لا بدّ أن أجد طريقة”.
عند الباب، وفيما يصافحونها بحرارة ويشدّون على يديها مودّعين، كان لا مناص للسؤال المرّ، السؤال المعلّق طوال اللقاء، والذي جهدوا في تأجيله رغم هجسهم به، وجاهدت في كتمه رغم ما يمضّها منه.. من أن ينبجس كزلّة لسان: “وماذا لو لقطوني!؟”.
– “إياك…”
اندفع أحدهم محذّراً، ثم دارى اندفاعه:
– “أعني.. حاذري. فإذا حدث…”
والتفت إلى صديقيه فاركاً أصابعه، متنحنحاً، كمن يبحث عن منفذ أو معين.
لحظتها، لا تدري كيف، قالت بنبرةٍ استغربت فيما بعد صدورها عنها، كأنما إحساسها بحرصهم الشديد عليها دفعها لإبداء جرأة على نحو ما: “وهذه، أيضاً، اتركوها لي”، ثمّ التفتت، بعد أن غادروا، لتواجه، وحدها، غول السؤال، دون أن تجد له جواباً قطّ، أو مؤنساً لها على مواجهته، لكأنما بعض الأسئلة خُلِقَتْ لتبقى هكذا أبداً، تقضُّ الروح دون ملاذ.
* * *
كانت الرسالة بحجم سلاميتين من إصبع!
على ورق رقيق، من نوع ورق الرسائل، كُتِبَتْ بعضُ الجمل على الوجهين بحبر أسود وأحرف صغيرة واضحة. انتحت ركناً في غرفتها، وشرعت تقلّب الورقة مرات ومرات، شادّة معظم خيوط تفكيرها إلى نقطة بعينها: كيف يمكن تسليمه الرسالة باليد؟
استعرضت زياراتها كلها، عبر السنوات الماضية، وتفحّصت أدقّ التفاصيل فيها… لم تجد طريقة آمنة. كلّ أغراض الزوّار من أطعمة وملبوسات تُنبش وتُفتش في غرفة خاصـة قبل تسـليمهـا للسـجين. حتـى بعــض أقــراص الكبة -لاحظت ذلك مرة- تُفلق ويُنظر في جوفها. بعض الملبوسات، الداخلية أو الخارجية، تفتق أطرافها إثر وشاية أو ارتياب خاطر. تُفتح الأوعية المغلقة وتفرّغ في أطباق…. سجل حافل مدهش من المناورات المبتكرة والتقصي الدقيق ترويه جدران تلك الغرفة “وفوق هذا، قالت لنفسها، ما أدراني إن كانت ستصله الأغراض أم لا؟! فما من مرة إلاّ وبلعوا نصفها!!”.
فكَّرت أن تخفي الرسالة في يدها، ثمّ استخفّت بفكرتها. إذ كيف تهربها له عبر شبكين– كشباك خم الدجاج– يفصلهما شرطي رقيب؟! وحتى حفظ كلماتها لا يجدي. فإذا كانت تحار طوال الزيارة كيف تبوح بكلمة واحدة في قلبها خجلاً من الرقيب المبحلق، فكيف لها أن تسرد رسالة بهذه الخطورة؟!.
أتراها عجزت حقاً، خلال الأيام التي سبقت زيارتها، في العثور على طريقة… أم هو الخوف راح يرشح إلى قلبها حتى انكشفت أمامها، دفعة واحدة، كل المخاطر، وجعلتها تقلع عن المهمة، بل وتمضي في تأنيب ذاتها: “مجنونة يا سوسن حتى ترمي بنفسك وبزوجك في هاوية لا يعلم قرارها إلاّ الشيطان! ما الذي حدث لعقلك كي توافقي؟! أتظنين الزيارة نزهة! ألف عين بصّاصة حولك. ثمّ فكّري بنفسك قليلاً. ذابت عافيتك وأنت تنتظرينه. بلى. ولِمَ الكذب؟! أَوَلَمْ تعدّي الأيام عدّاً؟ كم مرة، في الليل، نهضت من فراش وحدتك، فتحتِ النافذة، وندهتِ: يا عدنان، ثم عدت مكسورة من خيبتك؟! كم مرة، حين دلف السقف ولوى درابزون الحديد وتخلّعت مفاصل الباب وثُقبت المغسلة وثقلت عليك أسطوانة الغاز.. كنت تلعنين الساعة وعمرك والدنيا، وتتمنين: آه لو كان عدنان معي! أَبَعْدَ هذا تدفعين به وبنفسك إلى غياب لا أحد في الدنيا يعرف نهايته؟!”.
ويأفل النهار ليسطو الليل عليها..
ما مرت ليلة، من الليالي السابقة على زيارتها تلك، إلاّ ونهزت من فراشها إثر كبسة منامات موحشة تدوسها كقطيع ثيران هائجة. تصحو لدقائق، ثمّ تعاود نومها ليعاودها قطيع الهواجس. في الليلة الأخيرة، استوت عازمة: “يا جماعة اعذروني. أُقدّر أوضاعكم.. وأقدّر ظروفكم.. ولكن اعذروني. فليس في استطاعتي أبداً”.
كادت في الصباح أن تمضي إلى زيارته مطمئنة في ظلّ تساؤل بسيط: “وما ذنبي أنا إذا لم يكن من مجال لتسليمه الرسالة باليد؟!” لولا أن تعثّرت في الساعة الأخيرة بتساؤل معاكس، وبسيط هو الآخر: “وما أدراكِ؟! ربما كان عدنان بأمسِّ الحاجة إلى الرسالة!”. وبين تساؤليها طفقت، ببطء ورويّة، توضّب أغراضه وتحزمها علَّها تفيء إلى قرار وترتاح. بعد أن انتهت، أخذت القرنفلة البيضاء، ضمّتها إلى شفتيها وهمست لها – كعادتها قبل كل زيارة – مندّية وريقاتها بقبلات اشتياق لا تفتر. لحظتها، خطفتْ خاطرَها فكرةٌ مدهشة. صاحت: “وجدتها يا شيطانة” وطفقتْ تلوب وتتقافز في البيت: “والله وجدتها!”.
كان أول ما فكّرت به، إحداث تغيير فيما اعتاد عليه لتثير اهتمامه وتشدّ انتباهه، ولذا اختارت قرنفلة حمراء عوضاً عن تلك البيضاء التي درجت على حملها له في كل زيارة “أتراه سيلحظ هذا التغيير؟” تساءلت في سرّها وهي تجلب الرسالة من درج الخزانة وتسلّ دبّوساً من ياقة ثوبها. قلّبت الورقة، فلمحت في نهايتها مساحة نصف سطر فارغة. وَمَضَ خاطر لهوف: “لِمَ لا أكتب له؟” دون طويل تفكُّر كتبت بلون حبر مختلف: “شو اشتقتلك”. لاحظت أن بالإمكان إضافة كلمة أخرى، فأضافت: “يا ملعون” ثم لفَّت الرسالة بدقّة حول الدبوس. باعدت أولاً بين وريقات القرنفلة، وطفقت، داخل الكأس على امتداد الساق، تغرز الدبّوس شيئاً بعد شيء حتى اختفى. أعادت لملمة الوريقات. حرّكت الزهرة ورجَّتها.. رفعتها وخفضتها بشيء من الشدّة.. أدارتها وقلّبتها.. لم يفتضح السرّ!
* * *
لو حمَّلوها جبلاً لكان أخفّ عليها من مهمتها تلك! غير أنها مضت، تداخلها مشاعر بكر لم تذقها من قبل. ورغم أن الشيطان الأزرق– كما سرّت لنفسها– لن يكتشف خطتها.. فإن تفكيرها لم يكف، طوال الطريق، عن تحذيرها: “لا ترتبكي. كوني طبيعية. طبيعية جداً. لا تلحي على الشرطي زيادة. ابقي الزهرة، كعادتك، إلى آخر الزيارة. إن أتيح لك قدّميها.. وإن لم يتح فليكن. أقلّ اضطراب سيرتابون. تعرفين أن الزائر والسجين مشبوهان خلقة..”
كان المساعد الأول، المشرف العام على السجن، يوزِّع رجال مناوبته، حين وصلت. قال وهو ينظر إليها بعينين نصف مغمضتين استياء: “كم مرة قلنا لك، يا ست سوسن، لا تبكّري؟!” والتفتَ قبل أن تردّ متوجهاً إلى شرطي قربه: “هات لنا السيد عدنان أفندي!” وتابع شغله.
سلّمت الأغراض لغرفة التفتيش، مبقية الزهرة في يدها، ثم انتحت جانباً.
في كل زياراتها السابقة كانت تنهض على رؤوس أصابع قدميها مرسلة بصرها إلى أقصى نقطة داخل السجن تمكّنها من رؤيته لتسرق لحظات إضافية إلى الوقت المخصص. في هذه المرة لَبَدَتْ عند زاوية الشبك لائبة بنظرها في الأنحاء حولها مثل أمّ تبحث عن ابنها الضائع. المشهد ذاته: المساعد الأول يجول في الطرف الآخر من الشبك، رجاله يهرعون لأخذ أماكن توزّعهم، فيما يدلف أحدهم إلى الفسحة بين الشبكين متّخذاً هيئة الحريص.
– سلامات..
بوغتت بزوجها كما لو لم تكن تنتظره!
– سلامات. كيفك؟ طمّني؟
وارتبك الكلام.
في دقائق كان عليها أن تحادث زوجها، وتُسكتَ قلقها الفوّار، وتتفرس في الوجوه المحيطة، وتقتنص غفلات الشرطي الحاجز.. بحيث راحت تقدّم جملة وتؤخّر أخرى، تجيب عمّا لم يسلها وتكرر ما استفهمت عنه.. حتى استكان لها الأمر. برهتها، شرعت تتفنَّن في الإلماح له: غمزت بجفنها تارة. لعَّبت حدقتيها مع ابتسامة دالّة تارة أخرى. مرّرت أصابعها على الوريقات ذاكرة أسماء وكلمات أغنيات تحمل معنى إلماحها. صمتت بغتة لتلفته. مسحت على الكأس والساق الأخضر… بذلت ما في وسعها كلّه ليعلم أن في قرنفلتها، هذه المرة، رسالة له.
وما كانت لتستسلم للاطمئنان إلى كونه فهم ما ألمحت إليه لولا أن لاحظتْ رفَّات جفنيه، وهزّاتٍ من رأسه، وابتساماته، وغمزاته أحياناً، بل وتعليقه المندهش “حمراء هذه المرّة على غير العادة!”.
ولكن من عساه، في حمّى الانزلاق السريع المتتالي لدقائق الزيارة.. وغمرة التوق المحجَّز.. وسط مستنقعٍ من الريبة والحذر.. واستدعاءٍ لهوف لذاكرة فارّة… من عساه يوقن اليقين كله أأدرك زوجها تمام مقصدها أم هو لم يدرك!؟ من عساه يفهم، في لحظات محروقة كتلك، السرّ المغلَّف بالقرنفل!؟ إذ ما كاد يودّع أحدهما الآخر، ويستديران ماضيين باتجاهين متعاكسين، وتلتفتْ، كعادتها، لتقطف آخر قطفة من مرآه.. حتى عوى الجنون في كيانها كلّه! كادت تهجم صارخة أَنْ لا، متجاوزة المسافة الفاصلة بينهما ورجال الشرطة والحاجز المشبّك، غير أن المباغتة شلَّت روحها وجسدها حين رأت المشرف العام وهو يشكل زهرة سرّها الحمراء على صدره.
*من مجموعة “الوعر الأزرق”
قبل قليل كانوا هنا، معها، يفيضون بالشرح، وتفيض بالإصغاء. حكوا لها عن ضرورات إيصال الرسالة. عن الأوضاع القلقة، وعن حيرتهم في اعتماد طريقة، ثمّ عجزهم عن إيجاد بديل عنها: “ليس لنا غيرك. أنت صلتنا الوحيدة، المباشرة، به” وعرضوا مخاطر عدم وصول الرسالة، المخاطر المترتّبة عليهم، وعلى زوجها، في ظلّ الحملات الجديدة، عن تقديرهم لوعيها وحرصها. وحكت لهم بإسهاب عن تفاصيل زياراتها، والسجن، والحراس، والوقت… “باليد، قالوا لها، لا تغامري بطريقة أخرى” واستفهمت منهم عمّا عساها تفعل إن فشلت “حاولي أقصى جهدك” وعمّا إذا كانوا يريدون ردّاً منه، وطريقة الاتصال بهم، وإذا كان من الأفضل استشارة زوجها قبلاً: “لا وقت أبداً. أوصلي الرسالة إليه مباشرة، ودون جواب منه”.
بحثوا، وبحثتْ، كل التفاصيل والترتيبات. نقطة واحدة حاولوا، بداية، الاتفاق عليها، ثم فضّل الشباب أن يتركوا لها اختيارها لكونها الأعلم بدقائق الزيارة، حيثياتها، ومستجداتها: كيف ستسلّمه الرسالة؟
– “هذه اتركوها لي، قالت ساهمة، لا بدّ أن أجد طريقة”.
عند الباب، وفيما يصافحونها بحرارة ويشدّون على يديها مودّعين، كان لا مناص للسؤال المرّ، السؤال المعلّق طوال اللقاء، والذي جهدوا في تأجيله رغم هجسهم به، وجاهدت في كتمه رغم ما يمضّها منه.. من أن ينبجس كزلّة لسان: “وماذا لو لقطوني!؟”.
– “إياك…”
اندفع أحدهم محذّراً، ثم دارى اندفاعه:
– “أعني.. حاذري. فإذا حدث…”
والتفت إلى صديقيه فاركاً أصابعه، متنحنحاً، كمن يبحث عن منفذ أو معين.
لحظتها، لا تدري كيف، قالت بنبرةٍ استغربت فيما بعد صدورها عنها، كأنما إحساسها بحرصهم الشديد عليها دفعها لإبداء جرأة على نحو ما: “وهذه، أيضاً، اتركوها لي”، ثمّ التفتت، بعد أن غادروا، لتواجه، وحدها، غول السؤال، دون أن تجد له جواباً قطّ، أو مؤنساً لها على مواجهته، لكأنما بعض الأسئلة خُلِقَتْ لتبقى هكذا أبداً، تقضُّ الروح دون ملاذ.
* * *
كانت الرسالة بحجم سلاميتين من إصبع!
على ورق رقيق، من نوع ورق الرسائل، كُتِبَتْ بعضُ الجمل على الوجهين بحبر أسود وأحرف صغيرة واضحة. انتحت ركناً في غرفتها، وشرعت تقلّب الورقة مرات ومرات، شادّة معظم خيوط تفكيرها إلى نقطة بعينها: كيف يمكن تسليمه الرسالة باليد؟
استعرضت زياراتها كلها، عبر السنوات الماضية، وتفحّصت أدقّ التفاصيل فيها… لم تجد طريقة آمنة. كلّ أغراض الزوّار من أطعمة وملبوسات تُنبش وتُفتش في غرفة خاصـة قبل تسـليمهـا للسـجين. حتـى بعــض أقــراص الكبة -لاحظت ذلك مرة- تُفلق ويُنظر في جوفها. بعض الملبوسات، الداخلية أو الخارجية، تفتق أطرافها إثر وشاية أو ارتياب خاطر. تُفتح الأوعية المغلقة وتفرّغ في أطباق…. سجل حافل مدهش من المناورات المبتكرة والتقصي الدقيق ترويه جدران تلك الغرفة “وفوق هذا، قالت لنفسها، ما أدراني إن كانت ستصله الأغراض أم لا؟! فما من مرة إلاّ وبلعوا نصفها!!”.
فكَّرت أن تخفي الرسالة في يدها، ثمّ استخفّت بفكرتها. إذ كيف تهربها له عبر شبكين– كشباك خم الدجاج– يفصلهما شرطي رقيب؟! وحتى حفظ كلماتها لا يجدي. فإذا كانت تحار طوال الزيارة كيف تبوح بكلمة واحدة في قلبها خجلاً من الرقيب المبحلق، فكيف لها أن تسرد رسالة بهذه الخطورة؟!.
أتراها عجزت حقاً، خلال الأيام التي سبقت زيارتها، في العثور على طريقة… أم هو الخوف راح يرشح إلى قلبها حتى انكشفت أمامها، دفعة واحدة، كل المخاطر، وجعلتها تقلع عن المهمة، بل وتمضي في تأنيب ذاتها: “مجنونة يا سوسن حتى ترمي بنفسك وبزوجك في هاوية لا يعلم قرارها إلاّ الشيطان! ما الذي حدث لعقلك كي توافقي؟! أتظنين الزيارة نزهة! ألف عين بصّاصة حولك. ثمّ فكّري بنفسك قليلاً. ذابت عافيتك وأنت تنتظرينه. بلى. ولِمَ الكذب؟! أَوَلَمْ تعدّي الأيام عدّاً؟ كم مرة، في الليل، نهضت من فراش وحدتك، فتحتِ النافذة، وندهتِ: يا عدنان، ثم عدت مكسورة من خيبتك؟! كم مرة، حين دلف السقف ولوى درابزون الحديد وتخلّعت مفاصل الباب وثُقبت المغسلة وثقلت عليك أسطوانة الغاز.. كنت تلعنين الساعة وعمرك والدنيا، وتتمنين: آه لو كان عدنان معي! أَبَعْدَ هذا تدفعين به وبنفسك إلى غياب لا أحد في الدنيا يعرف نهايته؟!”.
ويأفل النهار ليسطو الليل عليها..
ما مرت ليلة، من الليالي السابقة على زيارتها تلك، إلاّ ونهزت من فراشها إثر كبسة منامات موحشة تدوسها كقطيع ثيران هائجة. تصحو لدقائق، ثمّ تعاود نومها ليعاودها قطيع الهواجس. في الليلة الأخيرة، استوت عازمة: “يا جماعة اعذروني. أُقدّر أوضاعكم.. وأقدّر ظروفكم.. ولكن اعذروني. فليس في استطاعتي أبداً”.
كادت في الصباح أن تمضي إلى زيارته مطمئنة في ظلّ تساؤل بسيط: “وما ذنبي أنا إذا لم يكن من مجال لتسليمه الرسالة باليد؟!” لولا أن تعثّرت في الساعة الأخيرة بتساؤل معاكس، وبسيط هو الآخر: “وما أدراكِ؟! ربما كان عدنان بأمسِّ الحاجة إلى الرسالة!”. وبين تساؤليها طفقت، ببطء ورويّة، توضّب أغراضه وتحزمها علَّها تفيء إلى قرار وترتاح. بعد أن انتهت، أخذت القرنفلة البيضاء، ضمّتها إلى شفتيها وهمست لها – كعادتها قبل كل زيارة – مندّية وريقاتها بقبلات اشتياق لا تفتر. لحظتها، خطفتْ خاطرَها فكرةٌ مدهشة. صاحت: “وجدتها يا شيطانة” وطفقتْ تلوب وتتقافز في البيت: “والله وجدتها!”.
كان أول ما فكّرت به، إحداث تغيير فيما اعتاد عليه لتثير اهتمامه وتشدّ انتباهه، ولذا اختارت قرنفلة حمراء عوضاً عن تلك البيضاء التي درجت على حملها له في كل زيارة “أتراه سيلحظ هذا التغيير؟” تساءلت في سرّها وهي تجلب الرسالة من درج الخزانة وتسلّ دبّوساً من ياقة ثوبها. قلّبت الورقة، فلمحت في نهايتها مساحة نصف سطر فارغة. وَمَضَ خاطر لهوف: “لِمَ لا أكتب له؟” دون طويل تفكُّر كتبت بلون حبر مختلف: “شو اشتقتلك”. لاحظت أن بالإمكان إضافة كلمة أخرى، فأضافت: “يا ملعون” ثم لفَّت الرسالة بدقّة حول الدبوس. باعدت أولاً بين وريقات القرنفلة، وطفقت، داخل الكأس على امتداد الساق، تغرز الدبّوس شيئاً بعد شيء حتى اختفى. أعادت لملمة الوريقات. حرّكت الزهرة ورجَّتها.. رفعتها وخفضتها بشيء من الشدّة.. أدارتها وقلّبتها.. لم يفتضح السرّ!
* * *
لو حمَّلوها جبلاً لكان أخفّ عليها من مهمتها تلك! غير أنها مضت، تداخلها مشاعر بكر لم تذقها من قبل. ورغم أن الشيطان الأزرق– كما سرّت لنفسها– لن يكتشف خطتها.. فإن تفكيرها لم يكف، طوال الطريق، عن تحذيرها: “لا ترتبكي. كوني طبيعية. طبيعية جداً. لا تلحي على الشرطي زيادة. ابقي الزهرة، كعادتك، إلى آخر الزيارة. إن أتيح لك قدّميها.. وإن لم يتح فليكن. أقلّ اضطراب سيرتابون. تعرفين أن الزائر والسجين مشبوهان خلقة..”
كان المساعد الأول، المشرف العام على السجن، يوزِّع رجال مناوبته، حين وصلت. قال وهو ينظر إليها بعينين نصف مغمضتين استياء: “كم مرة قلنا لك، يا ست سوسن، لا تبكّري؟!” والتفتَ قبل أن تردّ متوجهاً إلى شرطي قربه: “هات لنا السيد عدنان أفندي!” وتابع شغله.
سلّمت الأغراض لغرفة التفتيش، مبقية الزهرة في يدها، ثم انتحت جانباً.
في كل زياراتها السابقة كانت تنهض على رؤوس أصابع قدميها مرسلة بصرها إلى أقصى نقطة داخل السجن تمكّنها من رؤيته لتسرق لحظات إضافية إلى الوقت المخصص. في هذه المرة لَبَدَتْ عند زاوية الشبك لائبة بنظرها في الأنحاء حولها مثل أمّ تبحث عن ابنها الضائع. المشهد ذاته: المساعد الأول يجول في الطرف الآخر من الشبك، رجاله يهرعون لأخذ أماكن توزّعهم، فيما يدلف أحدهم إلى الفسحة بين الشبكين متّخذاً هيئة الحريص.
– سلامات..
بوغتت بزوجها كما لو لم تكن تنتظره!
– سلامات. كيفك؟ طمّني؟
وارتبك الكلام.
في دقائق كان عليها أن تحادث زوجها، وتُسكتَ قلقها الفوّار، وتتفرس في الوجوه المحيطة، وتقتنص غفلات الشرطي الحاجز.. بحيث راحت تقدّم جملة وتؤخّر أخرى، تجيب عمّا لم يسلها وتكرر ما استفهمت عنه.. حتى استكان لها الأمر. برهتها، شرعت تتفنَّن في الإلماح له: غمزت بجفنها تارة. لعَّبت حدقتيها مع ابتسامة دالّة تارة أخرى. مرّرت أصابعها على الوريقات ذاكرة أسماء وكلمات أغنيات تحمل معنى إلماحها. صمتت بغتة لتلفته. مسحت على الكأس والساق الأخضر… بذلت ما في وسعها كلّه ليعلم أن في قرنفلتها، هذه المرة، رسالة له.
وما كانت لتستسلم للاطمئنان إلى كونه فهم ما ألمحت إليه لولا أن لاحظتْ رفَّات جفنيه، وهزّاتٍ من رأسه، وابتساماته، وغمزاته أحياناً، بل وتعليقه المندهش “حمراء هذه المرّة على غير العادة!”.
ولكن من عساه، في حمّى الانزلاق السريع المتتالي لدقائق الزيارة.. وغمرة التوق المحجَّز.. وسط مستنقعٍ من الريبة والحذر.. واستدعاءٍ لهوف لذاكرة فارّة… من عساه يوقن اليقين كله أأدرك زوجها تمام مقصدها أم هو لم يدرك!؟ من عساه يفهم، في لحظات محروقة كتلك، السرّ المغلَّف بالقرنفل!؟ إذ ما كاد يودّع أحدهما الآخر، ويستديران ماضيين باتجاهين متعاكسين، وتلتفتْ، كعادتها، لتقطف آخر قطفة من مرآه.. حتى عوى الجنون في كيانها كلّه! كادت تهجم صارخة أَنْ لا، متجاوزة المسافة الفاصلة بينهما ورجال الشرطة والحاجز المشبّك، غير أن المباغتة شلَّت روحها وجسدها حين رأت المشرف العام وهو يشكل زهرة سرّها الحمراء على صدره.
*من مجموعة “الوعر الأزرق”