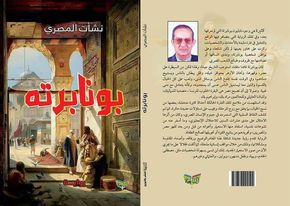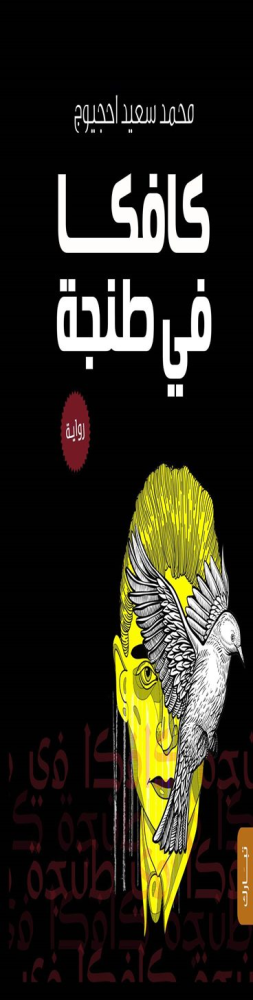مقـــدمة:
في مقابل النـزعة الذاتية التي ركن لها الاتجاه الرومانسي نتيجة عيشة في أبراج عاجية، ظهر الاتجاه الواقعي – في قمة نضجه – بالمغرب، أواسط الستينيات من القرن المنصرم.. فقد دعا هذا الاتجاه إلى الاهتمام بكل ما يحيط بالكاتب من مظاهر اجتماعية وسياسية واقعية، إذ عليه أن يختار مادة اشتغاله من مشكلات العصر: ( مشكلة الفقر، البطالة، الانحلال، الفساد، البيروقراطية، الخ… ).. فالأهم عند هذه المدرسة أن يكون الموضوع واقعيا وأن تكون آليات معالجته كذلك.. وما دام موضوعنا يتعلق ببداية تشكل القصة الواقعية بالمغرب، فمن الضروري، قبل المرور إلى ذلك، إلقاء الضوء، ولو بإيجاز، على بداية المخاض عبر الحديث عن ظروف وكيفية نشأة فن القص بالمغرب بشكل عام وعن كيفية تطوره.. فكيف كان ذلك؟ وكيف هو حال القصة القصيرة الواقعية بالمغرب؟ كيف ينظر إليها روادها؟ وإلى أي حد يمكن الحديث عن استمرار تألقها؟
المراحل التي مرت منها القصة المغربية:
كان ظهور الفن القصصي بالمغرب متأخرا مقارنة بنظيره في المشرق العربي الذي احتك بالغرب ونهل من ثقافته وعلومه منذ ما يسمى بمرحلة التقليد والاحتكاك التي امتدت هناك منذ سنة 1870 إلى حدود الحرب العالمية الأولى.. ولعل أبرز المحاولات المبكرة في هذا المجال كانت قصة المويلحي: “حديث عيسى بن هشام”، ثم عرفت بعض التطور بعد سنة 1925 مع مجموعة من الأسماء… أما عن سر تأخر ظهورها بالمغرب فيتمثل في مجموعة من الأسباب منها عدم الاستفادة من النهضتين الغربية والمشرقية، والاستعمار الذي سعى بكل جهوده لأجل إقبار الهوية المغربية ثقافيا ولغويا وحضاريا بغية تكريس التبعية المطلقة.. وهكذا، لم يتم الانتباه إلى أهمية الأدب إلا بعد ظهور الحركة الوطنية وتبلور الوعي الوطني، إذ انتبهت الحركة الوطنية إلى خطورة المخطط الاستعماري وإلى أهمية الأدب في الانخراط في معركة المقاومة.. من هذا المنطلق ظهرت الإرهاصات الأولى للفن القصصي بالمغرب عن طريق التقليد وهي المرحلة التي يمكن وصفها ب: “المرحلة الجنينية” للقصة المغربية ( 1905 – 1930 )، إذ طغى عليها الطابع التوجيهي التربوي وعدم احترام تقنيات وشروط الكتابة القصصية، ولم تعرف القصة المغربية تطورا مهما إلا في المرحلة الممتدة ما بين 1920 و 1955، إذ ارتبط هذا الفن بما هو واقعي معيش، وبانعكاسات الاحتلال الأجنبي على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية، ونمثل هنا بالمجموعة القصصية الذائعة الصيت “وادي الدماء” لعبد المجيد بن جلون، و “انتصار الحق على الباطل” لعبد الخالق الطريس و “عمي بوشناق” لعيد الرحمن الفاسي، التي اعتمدت بالأساس التأريخ، في قالب قصصي فني، لأمجاد وبطولات ونضالات الشعب المغربي ضد الاحتلال… أما المرحلة الثالثة فتتمثل في مرحلة ما بعد الاستقلال ( 1956 + … ) حيث تميز فن القص في هذه المرحلة بالغنى والثراء نتيجة الاختلاف والتنوع في طرائق اختيار وتناول المواضيع القصصية وفي قوالب بقدر ما اختلفت بقدر ما توحدت في احترام شروط وتقنيات الكتابة القصصية، وهكذا ظهر الاتجاه الرومانسي، والاتجاه الواقعي، مثلما ظهر اتجاه ثالث حاول المزج بين الواقعي والرومانسي…
الكتـابـــة الـواقـعـيـــــة:
... والكتابة الواقعية هي تلك الكتابة التي تصدق عليها صفة: “السهل الممتنع”.. وهي الكتابة التي تؤدي وظيفة تواصلية بامتياز، إذ هي كتابة من المتلقي وإليه، وهي كتابة تحترم – أولا – شروط الكتابة القصصية وجمالية النص القصصي كمنجز فني، وهي، ثانيا، كتابة تتعب صاحبها لإبداع “لغة ثالثة” تفهمها وتستوعبها كل الشرائح والفئات… لغة يكفي المرء أن يعرف كيف يفك الحروف والكلمات ليفك ألغازها وليغوص في أعماقها..ونظرا لكثرة الأسماء التي اهتمت بالقصة الواقعية القصيرة في المغرب وتألقت في هذا النوع القصصي، سأكتفي في هذا السياق يذكر مميزات الكتابة لدى ثلاثة من أبرز روادها المؤسسين، وبذكر وجهات نظرهم الخاصة حول هذا الاتجاه الذي أرسوا أسسه وبنيانه، مع الإشارة، على سبيل التقريب، إلى عينات قليلة من التيمات الكثيرة جدا التي تناولوها بالقص رغم الاختلاف البسيط في طريقة كل واحد منهم في ذلك.
محمد شكري حصاد الكتابة او كتابة الحصاد
... محمد شكري هو ذاك الكاتب الذي قال عن نفسه إن شهرة سيرته الذاتية “الخبز الحافي” سحقته سحقا.. والواقع أنها لم تسحقه كإنسان صارت الشهرة تجلب له بعض المتاعب، وإنما كقاص قدم روائع في مجال القصة القصيرة، وتحديدا في مجموعتيه القصصيتين: “مجنون الورد” و “الخيمة”.. ف: “الخبز الحافي” كادت تلتهم حصة المجموعتين القصصيتين من الانتشار، ولكن، وعلى الرغم من كل ما قيل حول هذا الموضوع، فإن الواقع أكد أن المجموعتين وزعتا على نطاق واسع مقارنة بباقي المجاميع القصصية لقصاصين مغاربة آخرين… واقعية الكتابة القصصية عند محمد شكري شيء مسلم به، وهي تكاد تتقاطع، من حيث الأسلوب، والواقعية الفوتوغرافية التي عهدناها لديه في مجال كتابة السيرة الذاتية.. فالكتابة عنده بمثابة “حصاد” لما تراكم لدى الذات الكاتبة من تجارب حياتية ومن التصاق باليومي المعيش.. يقول محمد شكري في هذا الصدد: “لقد علمتني الحياة أن أعي لعبة الزمن وأن أنتظر، بدون أن أتنازل عن عمق ما استحصدته.. قل كلمتك قبل أن تموت، فإنها حتما سوف تعرف طريقها” .
ومحمد شكري من فصيلة الكتاب الواقعيين الذين يكرهون الهلوسات وأحلام اليقظة، والذين يأبون إلا أن يظلوا ملتصقين بقضايا الهامش والمهمشين، أو كما يحلو له تسمية ذلك، بقضايا الفئة غير المصنفة طبقيا… يقول في هذا الصدد: “أنا عندي قضية وطبقة، أو قل طبقة بدون طبيعة، لأنه لتكون طبقة لا بد لها من مهنة أو عمل تؤطر الدفاع عنه نقابة أو حزب… ليس لطبقتي هوية، فهي سائبة” … إنها فئة تجمع بين ماسحي الأحذية والنشالين والمجانين والمتسكعين والعاطلين والعاهرات والحشاشين، الخ… وقد كانت أول قصة كتبها محمد شكري هي قصة: “العنف على الشاطئ” التي نشرتها له مجلة “الآداب البيروتية” منذ 42 سنة والتي تلقى عنها رسالة من الدكتور والأديب سهيل إدريس يحثه فيها على مزيد من ممارسة شغب الكتابة، وهي قصة تحكي عن فئة المختلين عقليا في شخص بطلها ميمون الذي اختل عقله بسبب السائحة الأسترالية “جوني”.. سائحة جاءت لتستمتع بدفء الصيف في المغرب وبدفء جسد ميمون، إذ كان ميمون بالنسبة إليها مجرد وسيلة لتحقيق المتعة فيما كانت “جوني” وسيلته للخلاص والهجرة إلى أستراليا.. تستمتع به “جوني” وتهجرة.. لكن بيت القصيد ليس هنا فحسب، بل، أيضا، في الطريقة التي يتعامل بها عامة الناس مع المختلين عقليا والتي لا تليق حتى ب: “الحيوان”.. إنه الاحتقار المطلق والتهميش المطلق، بل وأحيانا الإهانة والتعذيب كسبيل لوضع حد ل: “الاستفزازات” التي تصدر عنهم.. يتواصل احتقار الناس لميمون ويتواصل عدم قدرة تحمل ميمون – نفسه – لجنونه وتمرده على الذات وعلى الآخرين لينتهي به الحال إلى “الانتحار” غرقا في البحر وعلى مرآى من الناس: “غاص… بعد لحظة عام فوق الماء… إنه يستغمي… غاص… ثم…”.
نفس العلاقة غير المتوازنة بين “العقلاء العاديين” و “الشواذ المجانين” يمثل لها شكري في قصته القصيرة: “بشير حيا أو ميتا”.. فبشير الأحمق “يزعج” الآخرين، لذلك يتمنون موته وإن كان في نفس الوقت وسيلة تسلية بالنسبة إليهم.. يصاب بشير بغيبوبة فيتحلقون حوله متمنين وفاته، إلا أنهم يصابون بخيبة الأمل حد الصدمة وهم يرونه يستيقظ من غيبوبته: “سينظرون إليه كشبح يسير بينهم”.. إنه سخط عبر عنه السارد تجاه موقف عامة الناس. سارد ما هو في الواقع سوى محمد شكري نفسه خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تراكم لديه من تجارب شخصية في هذا السياق استثمرها بشكل صريح في الجزء الثاني من سبرته الذاتية: “زمن الأخطاء”.. أليس محمد شكري هو من قال عن المجانين وهو يسرد تجربته في مستشفى الأمراض العقلية والعصبية “مايوركا” بمدينة تطوان : "كلما نظرت إلى مجنون إلا ورأيت فيه شعلة ذكاء خابية عمرها عمر البشرية نفسها.. هنا يتجلى منتهى شقاء الإنسان"..
... مكانة الطفولة، في نظر شكري، عند “الكبار العقلاء” شأنها في ذلك شأن مكانة “المختلين عقليا”، فهي شريحة مهمشة وأفعالها تتخذ دائما بمنطق الاستخفاف حتى وإن كانت في بعض الأحيان تنم عن نورانية معينة، إذ سيتمكن الأطفال في قصته القصيرة: "الأطفال ليسوا دائما حمقى” من فضح زيف “عقلانية” وأيضا “إنسانية” “الكبار”، بل وانتزاع اعتراف هؤلاء “الكبار” برزانتهم وإنسانيتهم، فعالمهم مبني على البراءة والنوايا الحسنة عكس عالم “الكبار” الزائف والقائم على الصخب والضوضاء والكلام المجاني والمشاعر الزائفة والمفتعلة.. هم، على العكس من ذلك تماما، يقترحون الصمت ومنح الحرية للحيوانات الأليفة عن طريق مسيرة سلمية قاموا بها أمام انبهار واندهاش الكبار: “كل الناس، الآن، يبتسمون ويضحكون.. تعطلت حركة مرور السيارات.. لم يسمع أي صفير سيارة احتجاجا على تعطل حركة المرور.. يتأملون جميعا العصافير والحمائم المحلقة، والحيوانات التي لا تطير تقفز بين أرجلهم دون أن يمسها أحد.. بدأ الأطفال يتفرقون فرحين هاتفين: عاشت الحمائم.. عاشت العصافير.. عاش الدجاج.. عاشت الأرانب.. عاشت القطط.. عاشت الكلاب”.
... دائما، وفي سياق التوجه الواقعي في مسار الكتابة القصصية لدى محمد شكري، يأبى هذا الأخير إلى أن يغوص في نفسية المهمشين والمنبوذين من أبناء العالم السفلي من المجتمع ( باعتباره عاش التجربة وسطهم في طفولته ومراهقته وشبابه )، مفسرا السلوكات الجنسية الشاذة عندهم، حيث يعتبر الشهوة عندهم تختلط بما هو حيواني.. الرغبة عندهم، بالنسبة إليه، لا تختلف عن “طنين الذباب والقيء والموت” يقول في قصته القصيرة: “القيء” : “يتأملها أرسلان.. هي تستريح مغمى عليها وهو يستريح لاهثا (…) تمتزج الرغبة في ذهن أرسلان بطنين الذباب والخبز اليابس الأسود.. تمتزج الرغبة في حواسه برائحة القيء والموت والصمت الطويل”…
... وهناك العديد من المواضيع التي تتصل بواقع الإنسان المغربي التي تناولها شكري بالقص والتي تهم جميعها عالم أبناء العالم السفلي، نكتفي بهاته العينات منها، لتظل العلاقة عند شكري قائمة على ثلاثة عناصر: الكتابة والذات والواقع.. يقول الناقد المغربي محمد برادة في شهادة له عن شكري: “ولم يستطع أن يقاوم وحده قساوة العيش على الهامش، فأصيب بانهيار عصبي ومكث بمستشفى الأمراض العصبية أربعة أشهر خلال سنة 1964.. تبدو له الكتابة الآن نوعا من الإدمان لتهدئة حساسيته المرهفة ومواجهة فوضى الأشياء والمجتمع، ولن تعوزه “المادة”، فقد اختزنت ذاكرته وأعصابه وجسده ما لا تستطيع اللغة تشخيصه".
محمد زفزاف: الكتابة معايشة لليومي
إن كتابة القصة القصيرة عند محمد زفزاف هي كتابة “من المجتمع وإليه”.. هي كتابة ملتصقة باليومي والمعيش لدى الشرائح الاجتماعية المهمشة … يقول في هذا الصدد: “أن يعرف الإنسان مجتمعه الحقيقي لا بد وأن يعيش داخله، وأن يعود إلى نفسه، وأن يتأمل ما رآه وعايشه وشاهده، وإذاك يستطيع هذا الكاتب استخلاص ما يمكن استخلاصه من التجربة الحياتية اليومية، لأن روح الكتابة هو محايتثها لليومي والمعيش” .
ومحمد زفزاف ليس من فصيلة الكتاب الذين يقولون ما لا يكتبون، ويكتبون ما لا يقولون.. فنحن إذا عدنا إلى كتاباته القصصية ( وأيضا الروائية ) وحاولنا تطبيق ما يصرح به عليها فإننا سنجدنا أمام كاتب يعي جيدا ما يقول وما يكتب.. فهو في كتاباته يأبى إلا أن يظل ملتصقا بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه وبأبناء هذا المجتمع وتحديدا المهمشون والمقصيون اجتماعيا منهم مستمدا فضاءاته من الفضاءات الخلفية.. فظاهرة “الفساد والانحراف الجنسي” الناجم عن أسباب اجتماعية واقتصادية، مثلا، ضحيتها الأساسية هي العنصر النسوي.. كما أن هذه الظاهرة ليست وليدة العقود الأخيرة ولا وليدة أجيال اليوم بقدر ما هي موغلة في أعماق عقود سالفة ( ما يؤشر أيضا على الدور التسجيلي والتأريخي للكتابة القصصية عند زفزاف ) ..
يقول في قصته القصيرة: “الكابوس لرجلين” المنشورة في مطلع التسعينيات من الألفية المنصرمة واصفا التعامل والفهم السلبيين والمنحلين للجنس لدى الشباب قائلا: “وكان يوم السبت، وبعد ساعات قليلة سيكثر الهرج والمرج، وتتخلص التلميذات من المحافظ، ويظهرن في الشوارع أنيقات، وتظهر بوضوح وتناسق أردافهن، وسينظرن كثيرا في الشباب، خصوصا ذوي الشعور الطويلة والسراويل والأقمصة الملونة، وينظرن لكل راكب سيارة، وتتزعم تلميذة مغامرة رفيقاتها، وينحشرن في السيارة” ، ثم يواصل حكيه إلى أن يصل إلى ما بعد الانحشار في السيارة.. وهناك فصيلة أخرى من النساء يلجأن على الدعارة لسبب بسيط يتمثل في الفقر المدقع، إذ إن هاته الفصيلة من النساء لم تخترن ذلك عن طواعية وإنما هو، وكما سبق وعبر عن ذلك الكاتب نفسه، الضغط الاجتماعي هو الذي عهرها، فهو في نفس القصة، وفي إطار حادثة جزئية، يحكي لنا قصة فتاة بدوية لم يسبق لها قط أن دخلت المدرسة..
تهاجر رفقة والدتها إلى المدينة كي تشتغل خادمة في البيوت.. يجلبهما السارد الأعزب إلى بيته لأجل تنظيفه وترتيبه: “كانت الخادمة التي جلبتها من الشارع حيث تكثر الخادمات مكومات على الأرصفة بانتظار الزبائن منهمكة في تنظيف الغرفة بالجفاف وماء جافيل” .. يدخل السارد ( وهو نموذج للمثقف المتفهم لوضعية ومشاكل هاته الفصيلة من النساء ) إلى غرفته ريثما تنتهي الخادمة وابنتها من تنظيف البيت.. وهو منهمك في قراءة الجرائد تلج الطفلة غرفته.. تقول له وعيناها دامعتان دليل إرغامها على فعل شيء قد يدر على والدتها دخلا إضافيا: “هل تسمح لي أن اجلس إلى جانيك يا السي حسن؟”.. تبكي الطفلة لتضيف بعد أن سألها السارد عن سر بكائها: “أمي قالت لي ذلك.. إذا لم أفعل ذلك ستطردني وستسخط علي”.. هنا يعير زفزاف عن موقفه الساخط عبر السارد: “وفكرت أن أمها قاسية حقا.. مثلما تفعل معي تفعل مع كل الزبائن من غير شك.. وأمرت رشيدة أن تنصرف.. أنا لست حيوانا.. صحيح أنني أشتهي النساء، لكن ليس إلى هذا الحد".
وقد تناول فزاف، بالإضافة إلى الانحراف الجنسي والفساد المستشريان في المجتمع، مجموعة من الاختلالات الاجتماعية الأخرى التي تكاد تنخره والتي يعد المهمشون والمنبوذون أبرز “أبطالها” .. ولأنه من الصعب جدا تناولها مجتمعة في هذا الحيز، أختتم الحديث عن رصد الكاتب لليومي والمعيش عن الطفولة المشردة التي تضطر بفعل ضغط الواقع الاجتماعي القاسي إلى امتهان أي حرفة مهما كانت مهينة ومذلة من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية في الوقت الذي يعد مقعد بالمدرسة هو مكانها المناسب .. يصف لنا نموذجا منها في شخص ماسح للأحذية في قصته القصيرة بيوت واطئة: “تحت ذراع الطفل علبة خشبية شكلها غير محدد، علبة قذرة عليها سواد وعليها احمرار باهت وألوان أخرى لا يمكن تمييزها.. قد يبلغ الطفل الحادية أو الثانية عشر"…
ومحمد زفزاف، عكس بعض الكتاب السلبيين، لا يكتفي، في كتاباته فقط بالتعرية عن الواقع وتشخيصه، بل يتجاوز ذلك إلى طرح البدائل: يقول على لسان أحد “أبطال” قصصه في قصة: “الديدان التي تنحني”: “غادرت المدرسة الثانوية وأنا أحمل أفكارا مثالية لا حدود لها ولا فاصل.. أوهام إنسان مريض لا يعرف عن واقعه شيئا.. يتخيل الحياة بشكل سيارات متنوعة الألوان والأشكال وفتيات كثيرات ثم أمسيات على الكورنيش.. كل هاته الأشياء لم تكن سوى مرض.. عرفت فيما بعد ألا شيء أشد واقعية وارتباطا بالحقيقة، على مرارتها، أكثر من العمل.. العمل وحده هو الذي يصنع الرجال"
إدريس الخوري: الكتابة نميمة مقروءة
إدريس الخوري، قاص يأبى في قصصه إلا أن يرهق نفسه في سبيل فك حبل من العقد، فهو يأبى إلا أن ينبش في إشكاليات اجتماعية متعددة هي، في الواقع، نتاج وضع معقد للغاية.. الكتابة عنده إعادة لصياغة الواقع المعيش وحديث عن نماذج بشرية لا تعرف سوى التيه.. ومن هنا يحلو له وصف كتاباته ب: “النميمة المقروءة”، لكنها طبعا ليست نميمة ذميمة بقدر ما هي نميمة مستحبة ولصاحبها أجر في ذلك..
فالخوري نمام، لكنه نمام إنساني محب للخير.. يقول في مقدمة مجموعته القصصية “ظلال” : “الكتابة، إذن، في جانبها الحكائي القصصي، والروائي أيضا، نميمة مقروءة لأنها تقوم بعملية الإخبار عن أشخاص كناهم وسيكونون في زمان ومكان محددين ذهنيا (…) وهي تستمد مشروعيتها من واقعها، ولأن هذا الواقع جد متشابك، تصبح الكتابة - النميمة وسيطا بيننا وبين واقع كان وسيكون.. هذا هو الاحتمال الممكن لعملية الكتابة التي تتأرجح بين الصدق والاحتمال.. إنها تصبح ممكنا لما ينبغي أن يكون” … لذلك، فمواضيع الخوري تسير في نفس اتجاه زفزاف وشكري مع اختلاف – طيعا – في طريقة المعالجة، وشخصيات قصصه جلها أيضا من الحالات الشاذة في المجتمع.. فببراعة الكتاب الذين يعون ما يكتبون تمكن الخوري من الإمساك بالخيط الرئيسي لموضوع الوضع المزري والاستغلال الفاحش اللذين تعانيهما فئة من النساء، ومن إعادة صياغته وتشكيله ضمن رؤية نقدية حادة وغير محايدة للواقع..
نعم: فالرؤية الإنسانية حاضرة لكنها لا تكفي لتجاوز الكتابة القصصية لصفتي: “الاحتشام” و “السذاجة” ولذلك لا بد لها من رؤية نقدية مصاحبة على اعتبار أن الكتابة القصصية هي عملية حوار متبادل بالدرجة الأولى.. ففي قصته القصيرة: "من كل حدب وصوب" ، مثلا، نجده يحكي قصة طفلة اضطرت في سن الثامنة إلى الخروج من البيت والهجرة إلى الرباط بعد وفاة والدتها وزواج والدها من امرأة قاسية حاولت دفعه إلى إرغامها على الزواج من رجل في سنه، لكن الطفلة تضطر إلى الهجرة من جديد إلى مدينة أغادير ( جنوب المغرب ) لتشتغل عند عائلة غنية، ثم تعود من جديد إلى الرباط لتعيش إلى حدود سن المراهقة.. ولم تكن رحمة ( وهذا هو اسمها ) لتنجو من محاولة مشغليها النيل من جسدها الفتي فتهرب إلى مدينة الدار البيضاء وتشتغل بمعمل للنسيج..
هناك، تتعرف إلى شاب في مثل عمرها وتغرم به، غير أنه سرعان ما سيهجرها بعد أن اغتصبها لتصير عرضة للاستغلال الجنسي والإدمان على المخدرات والكحول مع جماعة من الحشاشين والسكيرين… هناك أيضا حالة خديجة في قصته القصيرة “أيام خديجة البيضاوية” التي لم تكن أحلام اليقظة تفارقها من فرط العوز. كانت تشتغل بأحد المعامل وتحلم أن تصير مطربة مشهورة، لكن واقعها الاجتماعي سرعان ما يدفعها لتلبية الرغبة الجنسية لصاحب المعمل الذي وعدها بالزيادة في أجرتها، ولم تكن خديجة تملك، بعد أن ساورها الندم، سوى أن تقول: "مالي يا ربي مالي؟".
تناول إدريس الخوري، أيضا، بالقص ظاهرة اجتماعية جد متفشية في الأوساط الشعبية من المجتمع المغربي تتمثل في الارتزاق عن طريق الدين.. فهناك من “الفقهاء” من لا يفقهون في أمور الدين شيئا، وإنما هم جماعة من المرتزقة يستغلون جهل وأمية الآخرين بمناسبة بعض المناسبات الاجتماعية، وأيضا حفظهم للقرآن الكريم، كوسيلة للارتزاق.. يصفهم لنا القاص في قصته القصيرة: “الرجال لا يتشابهون” قائلا: “من جديد ترتفع الأصوات مرتلة القرآن.. لا تناسق في الأصوات، بل ترتيل مشوش ينبه عن عقليتهم ورغباتهم (…) وهكذا انتهوا من الترتيل بسرعة، ليأكلوا بسرعة، ويقتسموا الغنيمة بسرعة، ففي مكان آخر زردة ( أي وليمة ) أخرى تنتظرهم.. وانتفخ الحاج موسى كالديك، فالحاج موسى أحسن مرتل للقرآن، وأحسن شراب للخمر، وأكبر مدمن للكيف، وأشهر تابع للغلمان في الحي”.
... من بين الظواهر الاجتماعية الأخرى التي استأثرت باهتمام الخوري نجد ظاهرة فصيلة من الشواذ الذين يشتغلون، متشبهين بأزياء وشعور وأصباغ النساء، راقصين بالملاهي المتنقلة المعروفة ب: “حلقات السويرتي” .. يصف لنا أحدهم في قصته القصيرة: “نرسيس” قائلا: “ومن جديد وقف أمام المرآة … مشط شعره الغزير المرسل فوق عنقه، وبدا مثل امرأة تنتظر زوجها.. لماذا لا يهتم بنفسه؟.. أمام المرآة رأى نفسه من جديد وتحقق من أن كل شيء على ما يرام (…) كانت اللحظات تطول وتهرب وكان هو أكثر فرحا.. سيطرق الجيلالي الباب، وسيطلب منه قضاء الليلة عنده".
قصص الخوري عالم من التيمات المغرية بالالتهام، ولعل خير عصارة يمكن استخلاصها من عوالمه القصصية شهادة الكاتب العربي الراحل جبرا إبراهيم جبرا الذي كتب على ظهر غلاف مجموعته القصصية: “ظلال” ما يلي: “قصص الحزن هاته، فيما أرى، هي قصص رفض مستمر أكثر منها اضطهاد.. كلما توغل البطل في ذاته وتجربته كلما ازداد رفضه للآخرين إلى أن يرفض ذاته في النهاية أيضا.. وقد سألتني يوما عن الغربة فيما أكتب، وغربتك هي الرهيبة".
ســــــــــؤال:
.. إن السؤال الذي يطرح نفسه، والذي سيظل قائما هو: هل هناك – حقا – اليوم من أقلام الجيل الجديد من يكتب ببراعة هؤلاء حتى يستحق تسلم المشعل منهم، ويضمن، بالتالي، الاستمرارية لهذا النوع من الكتابة القصصية؟ هناك، فعلا، أقلام واعدة تنشر بمختلف الصحف والمجلات تجعلنا نطمئن على ذلك، غير أن هذا الاطمئنان سرعان ما يبدأ في التلاشي حين نستحضر الواقع المزري للنشر والنقد أيضا بالمغرب، ليبقى السؤال معلقا وتبقى الإجابة عنه مؤجلة إلى حين.
في مقابل النـزعة الذاتية التي ركن لها الاتجاه الرومانسي نتيجة عيشة في أبراج عاجية، ظهر الاتجاه الواقعي – في قمة نضجه – بالمغرب، أواسط الستينيات من القرن المنصرم.. فقد دعا هذا الاتجاه إلى الاهتمام بكل ما يحيط بالكاتب من مظاهر اجتماعية وسياسية واقعية، إذ عليه أن يختار مادة اشتغاله من مشكلات العصر: ( مشكلة الفقر، البطالة، الانحلال، الفساد، البيروقراطية، الخ… ).. فالأهم عند هذه المدرسة أن يكون الموضوع واقعيا وأن تكون آليات معالجته كذلك.. وما دام موضوعنا يتعلق ببداية تشكل القصة الواقعية بالمغرب، فمن الضروري، قبل المرور إلى ذلك، إلقاء الضوء، ولو بإيجاز، على بداية المخاض عبر الحديث عن ظروف وكيفية نشأة فن القص بالمغرب بشكل عام وعن كيفية تطوره.. فكيف كان ذلك؟ وكيف هو حال القصة القصيرة الواقعية بالمغرب؟ كيف ينظر إليها روادها؟ وإلى أي حد يمكن الحديث عن استمرار تألقها؟
المراحل التي مرت منها القصة المغربية:
كان ظهور الفن القصصي بالمغرب متأخرا مقارنة بنظيره في المشرق العربي الذي احتك بالغرب ونهل من ثقافته وعلومه منذ ما يسمى بمرحلة التقليد والاحتكاك التي امتدت هناك منذ سنة 1870 إلى حدود الحرب العالمية الأولى.. ولعل أبرز المحاولات المبكرة في هذا المجال كانت قصة المويلحي: “حديث عيسى بن هشام”، ثم عرفت بعض التطور بعد سنة 1925 مع مجموعة من الأسماء… أما عن سر تأخر ظهورها بالمغرب فيتمثل في مجموعة من الأسباب منها عدم الاستفادة من النهضتين الغربية والمشرقية، والاستعمار الذي سعى بكل جهوده لأجل إقبار الهوية المغربية ثقافيا ولغويا وحضاريا بغية تكريس التبعية المطلقة.. وهكذا، لم يتم الانتباه إلى أهمية الأدب إلا بعد ظهور الحركة الوطنية وتبلور الوعي الوطني، إذ انتبهت الحركة الوطنية إلى خطورة المخطط الاستعماري وإلى أهمية الأدب في الانخراط في معركة المقاومة.. من هذا المنطلق ظهرت الإرهاصات الأولى للفن القصصي بالمغرب عن طريق التقليد وهي المرحلة التي يمكن وصفها ب: “المرحلة الجنينية” للقصة المغربية ( 1905 – 1930 )، إذ طغى عليها الطابع التوجيهي التربوي وعدم احترام تقنيات وشروط الكتابة القصصية، ولم تعرف القصة المغربية تطورا مهما إلا في المرحلة الممتدة ما بين 1920 و 1955، إذ ارتبط هذا الفن بما هو واقعي معيش، وبانعكاسات الاحتلال الأجنبي على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية، ونمثل هنا بالمجموعة القصصية الذائعة الصيت “وادي الدماء” لعبد المجيد بن جلون، و “انتصار الحق على الباطل” لعبد الخالق الطريس و “عمي بوشناق” لعيد الرحمن الفاسي، التي اعتمدت بالأساس التأريخ، في قالب قصصي فني، لأمجاد وبطولات ونضالات الشعب المغربي ضد الاحتلال… أما المرحلة الثالثة فتتمثل في مرحلة ما بعد الاستقلال ( 1956 + … ) حيث تميز فن القص في هذه المرحلة بالغنى والثراء نتيجة الاختلاف والتنوع في طرائق اختيار وتناول المواضيع القصصية وفي قوالب بقدر ما اختلفت بقدر ما توحدت في احترام شروط وتقنيات الكتابة القصصية، وهكذا ظهر الاتجاه الرومانسي، والاتجاه الواقعي، مثلما ظهر اتجاه ثالث حاول المزج بين الواقعي والرومانسي…
الكتـابـــة الـواقـعـيـــــة:
... والكتابة الواقعية هي تلك الكتابة التي تصدق عليها صفة: “السهل الممتنع”.. وهي الكتابة التي تؤدي وظيفة تواصلية بامتياز، إذ هي كتابة من المتلقي وإليه، وهي كتابة تحترم – أولا – شروط الكتابة القصصية وجمالية النص القصصي كمنجز فني، وهي، ثانيا، كتابة تتعب صاحبها لإبداع “لغة ثالثة” تفهمها وتستوعبها كل الشرائح والفئات… لغة يكفي المرء أن يعرف كيف يفك الحروف والكلمات ليفك ألغازها وليغوص في أعماقها..ونظرا لكثرة الأسماء التي اهتمت بالقصة الواقعية القصيرة في المغرب وتألقت في هذا النوع القصصي، سأكتفي في هذا السياق يذكر مميزات الكتابة لدى ثلاثة من أبرز روادها المؤسسين، وبذكر وجهات نظرهم الخاصة حول هذا الاتجاه الذي أرسوا أسسه وبنيانه، مع الإشارة، على سبيل التقريب، إلى عينات قليلة من التيمات الكثيرة جدا التي تناولوها بالقص رغم الاختلاف البسيط في طريقة كل واحد منهم في ذلك.
محمد شكري حصاد الكتابة او كتابة الحصاد
... محمد شكري هو ذاك الكاتب الذي قال عن نفسه إن شهرة سيرته الذاتية “الخبز الحافي” سحقته سحقا.. والواقع أنها لم تسحقه كإنسان صارت الشهرة تجلب له بعض المتاعب، وإنما كقاص قدم روائع في مجال القصة القصيرة، وتحديدا في مجموعتيه القصصيتين: “مجنون الورد” و “الخيمة”.. ف: “الخبز الحافي” كادت تلتهم حصة المجموعتين القصصيتين من الانتشار، ولكن، وعلى الرغم من كل ما قيل حول هذا الموضوع، فإن الواقع أكد أن المجموعتين وزعتا على نطاق واسع مقارنة بباقي المجاميع القصصية لقصاصين مغاربة آخرين… واقعية الكتابة القصصية عند محمد شكري شيء مسلم به، وهي تكاد تتقاطع، من حيث الأسلوب، والواقعية الفوتوغرافية التي عهدناها لديه في مجال كتابة السيرة الذاتية.. فالكتابة عنده بمثابة “حصاد” لما تراكم لدى الذات الكاتبة من تجارب حياتية ومن التصاق باليومي المعيش.. يقول محمد شكري في هذا الصدد: “لقد علمتني الحياة أن أعي لعبة الزمن وأن أنتظر، بدون أن أتنازل عن عمق ما استحصدته.. قل كلمتك قبل أن تموت، فإنها حتما سوف تعرف طريقها” .
ومحمد شكري من فصيلة الكتاب الواقعيين الذين يكرهون الهلوسات وأحلام اليقظة، والذين يأبون إلا أن يظلوا ملتصقين بقضايا الهامش والمهمشين، أو كما يحلو له تسمية ذلك، بقضايا الفئة غير المصنفة طبقيا… يقول في هذا الصدد: “أنا عندي قضية وطبقة، أو قل طبقة بدون طبيعة، لأنه لتكون طبقة لا بد لها من مهنة أو عمل تؤطر الدفاع عنه نقابة أو حزب… ليس لطبقتي هوية، فهي سائبة” … إنها فئة تجمع بين ماسحي الأحذية والنشالين والمجانين والمتسكعين والعاطلين والعاهرات والحشاشين، الخ… وقد كانت أول قصة كتبها محمد شكري هي قصة: “العنف على الشاطئ” التي نشرتها له مجلة “الآداب البيروتية” منذ 42 سنة والتي تلقى عنها رسالة من الدكتور والأديب سهيل إدريس يحثه فيها على مزيد من ممارسة شغب الكتابة، وهي قصة تحكي عن فئة المختلين عقليا في شخص بطلها ميمون الذي اختل عقله بسبب السائحة الأسترالية “جوني”.. سائحة جاءت لتستمتع بدفء الصيف في المغرب وبدفء جسد ميمون، إذ كان ميمون بالنسبة إليها مجرد وسيلة لتحقيق المتعة فيما كانت “جوني” وسيلته للخلاص والهجرة إلى أستراليا.. تستمتع به “جوني” وتهجرة.. لكن بيت القصيد ليس هنا فحسب، بل، أيضا، في الطريقة التي يتعامل بها عامة الناس مع المختلين عقليا والتي لا تليق حتى ب: “الحيوان”.. إنه الاحتقار المطلق والتهميش المطلق، بل وأحيانا الإهانة والتعذيب كسبيل لوضع حد ل: “الاستفزازات” التي تصدر عنهم.. يتواصل احتقار الناس لميمون ويتواصل عدم قدرة تحمل ميمون – نفسه – لجنونه وتمرده على الذات وعلى الآخرين لينتهي به الحال إلى “الانتحار” غرقا في البحر وعلى مرآى من الناس: “غاص… بعد لحظة عام فوق الماء… إنه يستغمي… غاص… ثم…”.
نفس العلاقة غير المتوازنة بين “العقلاء العاديين” و “الشواذ المجانين” يمثل لها شكري في قصته القصيرة: “بشير حيا أو ميتا”.. فبشير الأحمق “يزعج” الآخرين، لذلك يتمنون موته وإن كان في نفس الوقت وسيلة تسلية بالنسبة إليهم.. يصاب بشير بغيبوبة فيتحلقون حوله متمنين وفاته، إلا أنهم يصابون بخيبة الأمل حد الصدمة وهم يرونه يستيقظ من غيبوبته: “سينظرون إليه كشبح يسير بينهم”.. إنه سخط عبر عنه السارد تجاه موقف عامة الناس. سارد ما هو في الواقع سوى محمد شكري نفسه خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تراكم لديه من تجارب شخصية في هذا السياق استثمرها بشكل صريح في الجزء الثاني من سبرته الذاتية: “زمن الأخطاء”.. أليس محمد شكري هو من قال عن المجانين وهو يسرد تجربته في مستشفى الأمراض العقلية والعصبية “مايوركا” بمدينة تطوان : "كلما نظرت إلى مجنون إلا ورأيت فيه شعلة ذكاء خابية عمرها عمر البشرية نفسها.. هنا يتجلى منتهى شقاء الإنسان"..
... مكانة الطفولة، في نظر شكري، عند “الكبار العقلاء” شأنها في ذلك شأن مكانة “المختلين عقليا”، فهي شريحة مهمشة وأفعالها تتخذ دائما بمنطق الاستخفاف حتى وإن كانت في بعض الأحيان تنم عن نورانية معينة، إذ سيتمكن الأطفال في قصته القصيرة: "الأطفال ليسوا دائما حمقى” من فضح زيف “عقلانية” وأيضا “إنسانية” “الكبار”، بل وانتزاع اعتراف هؤلاء “الكبار” برزانتهم وإنسانيتهم، فعالمهم مبني على البراءة والنوايا الحسنة عكس عالم “الكبار” الزائف والقائم على الصخب والضوضاء والكلام المجاني والمشاعر الزائفة والمفتعلة.. هم، على العكس من ذلك تماما، يقترحون الصمت ومنح الحرية للحيوانات الأليفة عن طريق مسيرة سلمية قاموا بها أمام انبهار واندهاش الكبار: “كل الناس، الآن، يبتسمون ويضحكون.. تعطلت حركة مرور السيارات.. لم يسمع أي صفير سيارة احتجاجا على تعطل حركة المرور.. يتأملون جميعا العصافير والحمائم المحلقة، والحيوانات التي لا تطير تقفز بين أرجلهم دون أن يمسها أحد.. بدأ الأطفال يتفرقون فرحين هاتفين: عاشت الحمائم.. عاشت العصافير.. عاش الدجاج.. عاشت الأرانب.. عاشت القطط.. عاشت الكلاب”.
... دائما، وفي سياق التوجه الواقعي في مسار الكتابة القصصية لدى محمد شكري، يأبى هذا الأخير إلى أن يغوص في نفسية المهمشين والمنبوذين من أبناء العالم السفلي من المجتمع ( باعتباره عاش التجربة وسطهم في طفولته ومراهقته وشبابه )، مفسرا السلوكات الجنسية الشاذة عندهم، حيث يعتبر الشهوة عندهم تختلط بما هو حيواني.. الرغبة عندهم، بالنسبة إليه، لا تختلف عن “طنين الذباب والقيء والموت” يقول في قصته القصيرة: “القيء” : “يتأملها أرسلان.. هي تستريح مغمى عليها وهو يستريح لاهثا (…) تمتزج الرغبة في ذهن أرسلان بطنين الذباب والخبز اليابس الأسود.. تمتزج الرغبة في حواسه برائحة القيء والموت والصمت الطويل”…
... وهناك العديد من المواضيع التي تتصل بواقع الإنسان المغربي التي تناولها شكري بالقص والتي تهم جميعها عالم أبناء العالم السفلي، نكتفي بهاته العينات منها، لتظل العلاقة عند شكري قائمة على ثلاثة عناصر: الكتابة والذات والواقع.. يقول الناقد المغربي محمد برادة في شهادة له عن شكري: “ولم يستطع أن يقاوم وحده قساوة العيش على الهامش، فأصيب بانهيار عصبي ومكث بمستشفى الأمراض العصبية أربعة أشهر خلال سنة 1964.. تبدو له الكتابة الآن نوعا من الإدمان لتهدئة حساسيته المرهفة ومواجهة فوضى الأشياء والمجتمع، ولن تعوزه “المادة”، فقد اختزنت ذاكرته وأعصابه وجسده ما لا تستطيع اللغة تشخيصه".
محمد زفزاف: الكتابة معايشة لليومي
إن كتابة القصة القصيرة عند محمد زفزاف هي كتابة “من المجتمع وإليه”.. هي كتابة ملتصقة باليومي والمعيش لدى الشرائح الاجتماعية المهمشة … يقول في هذا الصدد: “أن يعرف الإنسان مجتمعه الحقيقي لا بد وأن يعيش داخله، وأن يعود إلى نفسه، وأن يتأمل ما رآه وعايشه وشاهده، وإذاك يستطيع هذا الكاتب استخلاص ما يمكن استخلاصه من التجربة الحياتية اليومية، لأن روح الكتابة هو محايتثها لليومي والمعيش” .
ومحمد زفزاف ليس من فصيلة الكتاب الذين يقولون ما لا يكتبون، ويكتبون ما لا يقولون.. فنحن إذا عدنا إلى كتاباته القصصية ( وأيضا الروائية ) وحاولنا تطبيق ما يصرح به عليها فإننا سنجدنا أمام كاتب يعي جيدا ما يقول وما يكتب.. فهو في كتاباته يأبى إلا أن يظل ملتصقا بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه وبأبناء هذا المجتمع وتحديدا المهمشون والمقصيون اجتماعيا منهم مستمدا فضاءاته من الفضاءات الخلفية.. فظاهرة “الفساد والانحراف الجنسي” الناجم عن أسباب اجتماعية واقتصادية، مثلا، ضحيتها الأساسية هي العنصر النسوي.. كما أن هذه الظاهرة ليست وليدة العقود الأخيرة ولا وليدة أجيال اليوم بقدر ما هي موغلة في أعماق عقود سالفة ( ما يؤشر أيضا على الدور التسجيلي والتأريخي للكتابة القصصية عند زفزاف ) ..
يقول في قصته القصيرة: “الكابوس لرجلين” المنشورة في مطلع التسعينيات من الألفية المنصرمة واصفا التعامل والفهم السلبيين والمنحلين للجنس لدى الشباب قائلا: “وكان يوم السبت، وبعد ساعات قليلة سيكثر الهرج والمرج، وتتخلص التلميذات من المحافظ، ويظهرن في الشوارع أنيقات، وتظهر بوضوح وتناسق أردافهن، وسينظرن كثيرا في الشباب، خصوصا ذوي الشعور الطويلة والسراويل والأقمصة الملونة، وينظرن لكل راكب سيارة، وتتزعم تلميذة مغامرة رفيقاتها، وينحشرن في السيارة” ، ثم يواصل حكيه إلى أن يصل إلى ما بعد الانحشار في السيارة.. وهناك فصيلة أخرى من النساء يلجأن على الدعارة لسبب بسيط يتمثل في الفقر المدقع، إذ إن هاته الفصيلة من النساء لم تخترن ذلك عن طواعية وإنما هو، وكما سبق وعبر عن ذلك الكاتب نفسه، الضغط الاجتماعي هو الذي عهرها، فهو في نفس القصة، وفي إطار حادثة جزئية، يحكي لنا قصة فتاة بدوية لم يسبق لها قط أن دخلت المدرسة..
تهاجر رفقة والدتها إلى المدينة كي تشتغل خادمة في البيوت.. يجلبهما السارد الأعزب إلى بيته لأجل تنظيفه وترتيبه: “كانت الخادمة التي جلبتها من الشارع حيث تكثر الخادمات مكومات على الأرصفة بانتظار الزبائن منهمكة في تنظيف الغرفة بالجفاف وماء جافيل” .. يدخل السارد ( وهو نموذج للمثقف المتفهم لوضعية ومشاكل هاته الفصيلة من النساء ) إلى غرفته ريثما تنتهي الخادمة وابنتها من تنظيف البيت.. وهو منهمك في قراءة الجرائد تلج الطفلة غرفته.. تقول له وعيناها دامعتان دليل إرغامها على فعل شيء قد يدر على والدتها دخلا إضافيا: “هل تسمح لي أن اجلس إلى جانيك يا السي حسن؟”.. تبكي الطفلة لتضيف بعد أن سألها السارد عن سر بكائها: “أمي قالت لي ذلك.. إذا لم أفعل ذلك ستطردني وستسخط علي”.. هنا يعير زفزاف عن موقفه الساخط عبر السارد: “وفكرت أن أمها قاسية حقا.. مثلما تفعل معي تفعل مع كل الزبائن من غير شك.. وأمرت رشيدة أن تنصرف.. أنا لست حيوانا.. صحيح أنني أشتهي النساء، لكن ليس إلى هذا الحد".
وقد تناول فزاف، بالإضافة إلى الانحراف الجنسي والفساد المستشريان في المجتمع، مجموعة من الاختلالات الاجتماعية الأخرى التي تكاد تنخره والتي يعد المهمشون والمنبوذون أبرز “أبطالها” .. ولأنه من الصعب جدا تناولها مجتمعة في هذا الحيز، أختتم الحديث عن رصد الكاتب لليومي والمعيش عن الطفولة المشردة التي تضطر بفعل ضغط الواقع الاجتماعي القاسي إلى امتهان أي حرفة مهما كانت مهينة ومذلة من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية في الوقت الذي يعد مقعد بالمدرسة هو مكانها المناسب .. يصف لنا نموذجا منها في شخص ماسح للأحذية في قصته القصيرة بيوت واطئة: “تحت ذراع الطفل علبة خشبية شكلها غير محدد، علبة قذرة عليها سواد وعليها احمرار باهت وألوان أخرى لا يمكن تمييزها.. قد يبلغ الطفل الحادية أو الثانية عشر"…
ومحمد زفزاف، عكس بعض الكتاب السلبيين، لا يكتفي، في كتاباته فقط بالتعرية عن الواقع وتشخيصه، بل يتجاوز ذلك إلى طرح البدائل: يقول على لسان أحد “أبطال” قصصه في قصة: “الديدان التي تنحني”: “غادرت المدرسة الثانوية وأنا أحمل أفكارا مثالية لا حدود لها ولا فاصل.. أوهام إنسان مريض لا يعرف عن واقعه شيئا.. يتخيل الحياة بشكل سيارات متنوعة الألوان والأشكال وفتيات كثيرات ثم أمسيات على الكورنيش.. كل هاته الأشياء لم تكن سوى مرض.. عرفت فيما بعد ألا شيء أشد واقعية وارتباطا بالحقيقة، على مرارتها، أكثر من العمل.. العمل وحده هو الذي يصنع الرجال"
إدريس الخوري: الكتابة نميمة مقروءة
إدريس الخوري، قاص يأبى في قصصه إلا أن يرهق نفسه في سبيل فك حبل من العقد، فهو يأبى إلا أن ينبش في إشكاليات اجتماعية متعددة هي، في الواقع، نتاج وضع معقد للغاية.. الكتابة عنده إعادة لصياغة الواقع المعيش وحديث عن نماذج بشرية لا تعرف سوى التيه.. ومن هنا يحلو له وصف كتاباته ب: “النميمة المقروءة”، لكنها طبعا ليست نميمة ذميمة بقدر ما هي نميمة مستحبة ولصاحبها أجر في ذلك..
فالخوري نمام، لكنه نمام إنساني محب للخير.. يقول في مقدمة مجموعته القصصية “ظلال” : “الكتابة، إذن، في جانبها الحكائي القصصي، والروائي أيضا، نميمة مقروءة لأنها تقوم بعملية الإخبار عن أشخاص كناهم وسيكونون في زمان ومكان محددين ذهنيا (…) وهي تستمد مشروعيتها من واقعها، ولأن هذا الواقع جد متشابك، تصبح الكتابة - النميمة وسيطا بيننا وبين واقع كان وسيكون.. هذا هو الاحتمال الممكن لعملية الكتابة التي تتأرجح بين الصدق والاحتمال.. إنها تصبح ممكنا لما ينبغي أن يكون” … لذلك، فمواضيع الخوري تسير في نفس اتجاه زفزاف وشكري مع اختلاف – طيعا – في طريقة المعالجة، وشخصيات قصصه جلها أيضا من الحالات الشاذة في المجتمع.. فببراعة الكتاب الذين يعون ما يكتبون تمكن الخوري من الإمساك بالخيط الرئيسي لموضوع الوضع المزري والاستغلال الفاحش اللذين تعانيهما فئة من النساء، ومن إعادة صياغته وتشكيله ضمن رؤية نقدية حادة وغير محايدة للواقع..
نعم: فالرؤية الإنسانية حاضرة لكنها لا تكفي لتجاوز الكتابة القصصية لصفتي: “الاحتشام” و “السذاجة” ولذلك لا بد لها من رؤية نقدية مصاحبة على اعتبار أن الكتابة القصصية هي عملية حوار متبادل بالدرجة الأولى.. ففي قصته القصيرة: "من كل حدب وصوب" ، مثلا، نجده يحكي قصة طفلة اضطرت في سن الثامنة إلى الخروج من البيت والهجرة إلى الرباط بعد وفاة والدتها وزواج والدها من امرأة قاسية حاولت دفعه إلى إرغامها على الزواج من رجل في سنه، لكن الطفلة تضطر إلى الهجرة من جديد إلى مدينة أغادير ( جنوب المغرب ) لتشتغل عند عائلة غنية، ثم تعود من جديد إلى الرباط لتعيش إلى حدود سن المراهقة.. ولم تكن رحمة ( وهذا هو اسمها ) لتنجو من محاولة مشغليها النيل من جسدها الفتي فتهرب إلى مدينة الدار البيضاء وتشتغل بمعمل للنسيج..
هناك، تتعرف إلى شاب في مثل عمرها وتغرم به، غير أنه سرعان ما سيهجرها بعد أن اغتصبها لتصير عرضة للاستغلال الجنسي والإدمان على المخدرات والكحول مع جماعة من الحشاشين والسكيرين… هناك أيضا حالة خديجة في قصته القصيرة “أيام خديجة البيضاوية” التي لم تكن أحلام اليقظة تفارقها من فرط العوز. كانت تشتغل بأحد المعامل وتحلم أن تصير مطربة مشهورة، لكن واقعها الاجتماعي سرعان ما يدفعها لتلبية الرغبة الجنسية لصاحب المعمل الذي وعدها بالزيادة في أجرتها، ولم تكن خديجة تملك، بعد أن ساورها الندم، سوى أن تقول: "مالي يا ربي مالي؟".
تناول إدريس الخوري، أيضا، بالقص ظاهرة اجتماعية جد متفشية في الأوساط الشعبية من المجتمع المغربي تتمثل في الارتزاق عن طريق الدين.. فهناك من “الفقهاء” من لا يفقهون في أمور الدين شيئا، وإنما هم جماعة من المرتزقة يستغلون جهل وأمية الآخرين بمناسبة بعض المناسبات الاجتماعية، وأيضا حفظهم للقرآن الكريم، كوسيلة للارتزاق.. يصفهم لنا القاص في قصته القصيرة: “الرجال لا يتشابهون” قائلا: “من جديد ترتفع الأصوات مرتلة القرآن.. لا تناسق في الأصوات، بل ترتيل مشوش ينبه عن عقليتهم ورغباتهم (…) وهكذا انتهوا من الترتيل بسرعة، ليأكلوا بسرعة، ويقتسموا الغنيمة بسرعة، ففي مكان آخر زردة ( أي وليمة ) أخرى تنتظرهم.. وانتفخ الحاج موسى كالديك، فالحاج موسى أحسن مرتل للقرآن، وأحسن شراب للخمر، وأكبر مدمن للكيف، وأشهر تابع للغلمان في الحي”.
... من بين الظواهر الاجتماعية الأخرى التي استأثرت باهتمام الخوري نجد ظاهرة فصيلة من الشواذ الذين يشتغلون، متشبهين بأزياء وشعور وأصباغ النساء، راقصين بالملاهي المتنقلة المعروفة ب: “حلقات السويرتي” .. يصف لنا أحدهم في قصته القصيرة: “نرسيس” قائلا: “ومن جديد وقف أمام المرآة … مشط شعره الغزير المرسل فوق عنقه، وبدا مثل امرأة تنتظر زوجها.. لماذا لا يهتم بنفسه؟.. أمام المرآة رأى نفسه من جديد وتحقق من أن كل شيء على ما يرام (…) كانت اللحظات تطول وتهرب وكان هو أكثر فرحا.. سيطرق الجيلالي الباب، وسيطلب منه قضاء الليلة عنده".
قصص الخوري عالم من التيمات المغرية بالالتهام، ولعل خير عصارة يمكن استخلاصها من عوالمه القصصية شهادة الكاتب العربي الراحل جبرا إبراهيم جبرا الذي كتب على ظهر غلاف مجموعته القصصية: “ظلال” ما يلي: “قصص الحزن هاته، فيما أرى، هي قصص رفض مستمر أكثر منها اضطهاد.. كلما توغل البطل في ذاته وتجربته كلما ازداد رفضه للآخرين إلى أن يرفض ذاته في النهاية أيضا.. وقد سألتني يوما عن الغربة فيما أكتب، وغربتك هي الرهيبة".
ســــــــــؤال:
.. إن السؤال الذي يطرح نفسه، والذي سيظل قائما هو: هل هناك – حقا – اليوم من أقلام الجيل الجديد من يكتب ببراعة هؤلاء حتى يستحق تسلم المشعل منهم، ويضمن، بالتالي، الاستمرارية لهذا النوع من الكتابة القصصية؟ هناك، فعلا، أقلام واعدة تنشر بمختلف الصحف والمجلات تجعلنا نطمئن على ذلك، غير أن هذا الاطمئنان سرعان ما يبدأ في التلاشي حين نستحضر الواقع المزري للنشر والنقد أيضا بالمغرب، ليبقى السؤال معلقا وتبقى الإجابة عنه مؤجلة إلى حين.