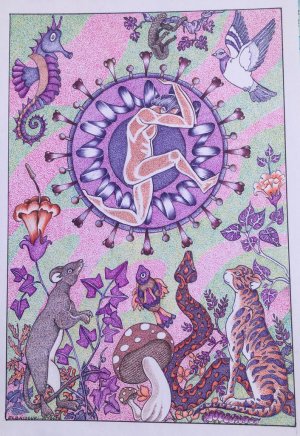ليس موضوع تاريخ الأوبئة بجديد. فعلى مر العصور اهتم مؤرخون وباحثون وعلماء برصد ووصف وتفسير انتشار الأوبئة، وما أدت إليه من هلاك النسل وبث الرعب والهلع في النفوس والأفئدة، رغم أن انتشار أخبارها لم يكن بهول ما نعيشه اليوم مع جائحة كورونا بسبب محدودية وبطئ وسائل وطرق التواصل والاتصال، وغياب وسائط الإعلام السريع مثلما هو متاح اليوم في زمننا. ولعل من أشهر الأوبئة التي ضربت بقوة في أمكنة مختلفة من أنحاء المعمور، وأدت في بعضها إلى نزيف ديمغرافي، نجد الطاعون بأسمائه وأوصافه المتعددة، كما وردت إلينا من المصادر والحوليات الأجنبية والعربية، وقد كان من أشدها فتكا وسرعة في الانتشار والانتقال، كما أنه ظل يتردد ويزور المناطق التي يضربها كلما سنحت له الفرصة ذلك، أو وجد الأسباب المهيأة والبيئة الحاضنة. ولن يكون وباء كورونا المستجد، متزايد الانتشار اليوم في العالم، بالأخير في سلسلة الأوبئة التي ظهرت في التاريخ الحديث للبشرية، كما أنه ليس من المستعبد أن تعاود الأوبئة القديمة، التي اعتقد الانسان أنه قضى عليها إلى الأبد بفضل اكتشاف اللقاحات المضادة لها(الوقاية)، الظهور أو تظهر سلالات جديدة منها، خاصة أمام الغموض الذي يلف اليوم التعاطي مع فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، والتضارب المتصاعد بشأن تحديد نشاطه، والاشتباه الوارد بخصوص التكتم على معلومات حساسة تخص المصاب صفر(ولا علاقة طبعا لهذا الأمر بأي نظرية مؤامرة مزعومة)، أو احتمال خطأ بشري أدى إلى تسرب فيروس مختبري، دون أن نذكر ما يتعلق بمزاعم حرب بيولوجية وجرثومية قد تكون انطلقت نسختها التجريبية الأولى. هكذا يبدو المستقبل محفوفا بكل الشكوك التي يمكن أن تخطر على بال أي شخص في العالم، سواء جاء ذلك نتيجة ضغط الخوف والرهاب الذي يولده التعاطي الإعلامي مع الانتشار السريع للوباء وارتفاع عدد ضحاياه في كل مكان، وهو ما يزيد من حدته وتهويله الانتشار السريع للمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت اليوم أكبر منصة لترويج الإشاعات والأخبار الزائفة على أوسع نطاق، أو كان ذلك مرتبطا بطبيعة الوباء نفسه الذي أثبت قدرته حتى الآن على الإفلات من السيطرة وخرج عن التحكم، رغم التقدم العلمي والتقني المذهل الذي بلغته الانسانية على مشارف الألفية الثالثة. ولعل تحول أوروبا وأمريكا الشمالية إلى بؤرتي وباء كورونا المستجد يكشف عن هشاشة واضحة في مواجهة الفيروس الوحش، سواء من ناحية القدرات على حصر الوباء وتضييق نطاق انتشاره، أو من ناحية ضعف الأنظمة الصحية من حيث البنيات الاستقبالية والموارد المادية والكوادر البشرية في التصدي للحائجة وعلاج المرضى، فما بالك بالبلدان الفقيرة التي تشكو من نقص حاد الامكانيات الدنيا في مجال التطبيب والصحة العمومية، رغم أن بعضها قد يتوفر على أفضل الأنظمة الصحية من حيث الأداء وتأمين العلاج للجميع.
صحيح أن وسائل الرصد والتشخيص تطورت كثيرا، وبالمثل طرق العلاج والإيواء الطبي، وتطور الوعي الصحي لدى الناس وطرق الوقاية، إلا أننا ما نزال نشهد الصعوبات نفسها تقريبا في مواجهة الجائحة على مستوى فعالية التطويق وسرعة ابتكار الدواء الفعال للعلاج أو اللقاح المضاد للوقاية والحماية من الإصابة بالمرض، ما عدا بالطبع ما يتعلق بتطور البحث الطبي في إيجاد العلاجات واللقاحات على المدى المتوسط أو البعيد، بحسب نوع الفيروسات وظروف ظهورها. فالأكيد، وهذا هو ربما الفارق الكبير الذي يفصلنا عن العصور الماضية، أن قدرة العلم اليوم على فهم الظواهر الفيروسية وتفسير أسباب ظهورها، وفهم الطريقة التي تعمل وتهاجم بها الأجسام، لا تقارن مطلقا مع تعثر العلماء والأطباء في تفسير النشاط الفيروسي عامة، وتحديد أسباب وطرق انتقال العدوى بالنسبة لبعضها، كما حدث مع الطاعون، والذي ظل لقرون يراوح دائرة الفرضيات والتكهنات، قبل أن يحسم التطور اللاحق للعلوم البيولوجية والطبية الأمر، ويتوصل العلماء إلى السيطرة على بعض الفيروسات الشهيرة من خلال تحديد مصدرها وفهم سلوكها بدقة كبيرة، وبالتالي إيجاد اللقاحات والأمصال المضادة لها، لكن دون أن يعني أنهم نجحوا بالفعل في [بعادها إلى الأبد من قائمة الأمراض المعدية والمتفشية، ما يفتح المجال لاحتمال عودة بعضها إلى الوجود.
إشارات سريعة ومفيدة من التاريخ
للمرض تاريخ يتداخل فيه الاجتماعي مع السياسي والديمغرافي والإيكولوجي والعلمي، مثلما له من التأثيرات الخطيرة على المستويات الاجتماعية والديمغرافية والنفسية(نتحدث في الغالب عن عدد الإصابات بالفيروس ولا نتحدث إلا نادرا أو لا نستطيع إحصاء عدد الإصابات النفسية الناجمة عن الإصابة بالمرض نفسه أو الخوف من الإصابة) بالنسبة للمجتمعات المتضررة. وعلى مر التاريخ شكل المرض، وخاصة العدوى الوبائية، هاجسا ألقى بظلاله على حياة الأفراد والجماعات، وأثقل كاهل المجتمعات بالأعباء والجهود لمكافحته والحد من آثاره التدميرية على الصحة العامة والاستقرار الديمغرافي. وفي ارتباط بذلك، شكل المرض منطلق نشوء ليس فقط علوم الطب، وبعدها علوم التمريض وهيئات التمريض المنظمة في وقت متـأخر من القرن التاسع عشر، بل وأيضا عاملا حاسما لظهور سياسات تنظيمية جديدة(الحجر الصحي، حملات التلقيح...إلخ ) في مجال الصحة العامة. لكن ما لا يمكن تجاهله أيضا في هذا الإطار أن المرض شكل عنصرا مهما في تشكيل التصور الامبريالي للمجتمعات المستعمرة، كما بينت ذلك بوضوح دراسات حول الامبريالية في الجامعات الغربية، وبشكل خاص ما انتظم منها في إطار دراسات تاريخ المرض والطب أو الأنتروبولوجيا الطبية، بينما ظلت إلى وقت غير بعيد خارج اهتمامات المؤسسات البحثية أو في حدود مجهودات فردية. ونحن اليوم نتوفر على تراكم مهم في هذا الباب لا شك أنه سيكون مفيدا في فهم ما يجري من حولنا من نقاشات وجدالات حول الجائحة المتمددة في أقطار العالم، ومنها بالخصوص ما يتعلق بتوصيف علاقات القوة والسلطة التي تعمل خلف سلوك المؤسسات الطبية العالمية وهيئات الصناعة الدوائية، ومختلف الأفكار الرائجة حول الوباء. فقد كشفت دراسات عديدة في السياق المشار إليه أعلاه أن تاريخ المرض هو أكثر من مجرد رواية لتاريخ ظهور واختفاء الميكروبات والفيروسات، وجرد أعداد الوفيات وطرق العلاج ووصف خريطة الانتشار الوبائي، إذ يكتسي أهمية فائقة من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية. وقد يكون حاسما، ليس بالنسبة لتصورات الأفراد للمرض وتفسيره فحسب، بل وأيضا لقراءة المعنى في المآسي الناجمة عن تفشي المرض على أوسع نطاق بالنسبة للمجتمعات والجماعات المختلفة. ومن هنا يبرز الاختلاف على مستوى تصورات المرض، وبالتالي للممارسات الطبية وللتنظيم الاجتماعي في فترات الانتشار الوبائي، كلما انتقلنا من بيئة إلى أخرى، ومن ثقافة مسيطرة لأمم قوية-استعمارية وامبريالية إلى ثقافة مسيطر عليها لأمم ضعيفة، تابعة كانت أو مقاومة.
كان الأستاذ هيجل(وقد قضى نحبه بسبب وباء الكوليرا) يعتقد أن التاريخ يعيد نفسه من خلال الشخصيات التاريخية، غير أن تلميذه المتمرد ماركس سيسخر من اعتقاده هذا مؤكدا أن التاريخ لا يفعل ذلك إلا في شكل مأساة أو مهزلة. وما نعيشه منذ شهور قليلة من دراما تفشي وباء كورونا، ونتابعه من أخبار فتكه بالبشر في عدد من البلدان التي استقوى فيها على النظام الصحي والتدخلات الطبية، هو الشكل الأول الذي يعيد فيه تاريخ الوباء القاتل نفسه، ولعلنا نكون في بداية مأساة حقيقية قد تؤدي إلى حصد الملايين من البشر إذا لم ينجح العلماء والأطباء في تطوير علاجات فعالة تقلل من عدد الضحايا بين المصابين، أو إنتاج لقاحات في مدة أقل من المتوقع، وإلا ننتظر معجزة بحيث يتراجع ارتفاع عدد الإصابات عن المعدلات المتوقعة في ضوء القراءات الحالية لخريطة الانتشار وانتقال العدوى، أو في أحسن الحالات تأتي تدابير الحجر الصحي أكلها، على الأقل في البلدان التي تطبقها بجدية وصرامة.
إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات في مواجهة الوباء الجديد يعيد للذاكرة وقائع وأحداث من التاريخ القديم والحديث كان لا بد وأن تأخذ منها العبر والدروس، لو أن أمر تدبير شأن الأمم أسند لمن يمتلكون الحس التاريخي ويحيطون بتطور المجتمعات من جميع الأبعاد والمستويات، بدل أن يتولاها رأسماليون جشعون بمعاونة "تقنيين" محدودي الرؤية معتدين بمعرفتهم المتخصصة التي لا تتعدى عندهم في الغالب فرعا أو مادة من فرع معرفي لا يغني ولا يسمن من علم.
ولعله من المهم أن نأخذ من التاريخ بعض الإشارات الجديرة بالتأمل:
1- فقد لفت الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بكل من إيطاليا وفرنسا واسبانيا، وعدد الإصابات المؤكدة المرتفع وفي تزايد متواصل، بعد مغادرته لموطنه الأصلي المفترض الصين، انتباه العديد من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بموضوع الأوبئة والكوارث الطبيعية والآفات العظمى، لوجود سوابق تاريخية بهذه الدول والمناطق من حيث الابتلاء بالأوبئة القاتلة والمجاعات والكوارث الطبيعية من زلازل وفياضات مهولة وغيرها. ولعل ما عرف بالطاعون الأسود La peste noire الذي حل بها في أواسط القرن الرابع عشر (م)، وخلف وراءه أعدادا هائلة من الضحايا، يعتبر من أسوء ذكريات شعوب هذه الدول التي كادت تنقرض بسبب هذا الوباء اللعين، وهو ما يزال إلى أيامنا موضوع أبحاث وتحريات ونقاشات بين الباحثين والعلماء والمؤرخين، ولم يستنفذ بعد دراسة وبحثا.
2 - رصدت تقارير علمية ما يقارب 350 مرضا معديا ظهر ما بين سنتي 1940 و2004، معظمها يأتي من دول الجنوب الفقيرة، وتقول دراسات في المجال أن 90 بالمائة من الفيروسات والبكتيريا لم تكن معروفة إلى حدود العقد الثامن من القرن الماضي، بينما تتسبب الأمراض المعدية في وفاة ما يناهز أربعة عشر مليونا كل سنة في العالم التي تنحصر أغلبها في بلدان جنوب الكرة الأرضية، منها بالطبع أمراض وفايروسات قديمة تعاود الظهور. ويرى بعض الباحثين أن تجدد ظهور الأمراض المعدية والأوبئة هو ظاهرة تندرج ضمن منطق الحي Le vivant نفسه.
3- في جميع الأزمات المرتبطة بانتشار الوباء تنشط تجارة الخوف، فيظهر تجار الأزمات على حقيقتهم من المضاربين بالأسعار والمحتكرين للسلع، ومعهم تجار المشاعر، الدينية بالخصوص، الذين يستغلون حالة الهلع والخوف لممارسة الابتزاز الروحي على الناس واستدراجهم إلى مواقعهم الغامضة كي يتسنى لهم ممارسة سلطتهم الروحية. هكذا تتسيد الخرافات ويكثر الدجالون والمشعوذون من كل صنف، وتطفو إلى السطح من جديد الممارسات التقليدية للتداوي الشعبي والطقوس الغريبة، أو البحث عن الخلاص عن طريق الروحانيات، بينما تكون مثل هذه الممارسات منحصرة في فئة قليلة جدا في الأوقات العادية مع وجود الطب العصري. كل ذلك سيطرح من جديد أسئلة محرجة حول قدرة الحداثة على احتواء مخلفات العصور القديمة، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة، أي حول الشعور بالاطمئنان الزائد الذي يوفره الإيمان الأعمى بالقدرات الخارقة للحداثة على تفادي الأخطار المحدقة بالجنس البشري، بينما نرى كيف تتخبط مجتمعاتها في عجز واضح على احتواء الوباء ومحاصرة الهلع الذي يولده يوما بعد يوم. صحيح، كما يقول البعض، أنه رغم الخوف وهول ما يحدث، فإن الانسانية لم تكن يوما ما مسلحة في مواجهة الأمراض والأوبئة والمجاعات أفضل مما عليه اليوم، بفضل التقدم العلمي والطبي، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الفشل الذريع الذي كشفته الأزمة الحالية لوضع الحداثة في خدمة الرأسمالية الشاملة التي لا يهمها لا الانسان ولا بقاء الجنس البشري، بقدر ما تحرص على تعظيم الأرباح والاستثمار في المآسي كما في التسلية.
4- نعيش اليوم في ظل عالم تعولمت فيه الممارسات والمفاهيم الطبية بحيث لم يعد هناك إلا القليل من المفاهيم والممارسات الطبية المحلية التي تقاوم من أجل البقاء وترفض الخضوع للأمر الواقع، أي القبول بوحدة الطب العصري، وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع حتى العقد الخامس من القرن الماضي حين أدخلت القوى الاستعمارية لأول مرة خلاصات وتقنيات وتجهيزات الطب الغربي وسعت إلى فرضه بالقوة على شعوب المستعمرات، مروجة لفكرة أن الجهل والفقر، وليس النهب والاستغلال، هما سبب انتشار الأمراض والأوبئة بالمجتمعات المستعمرة(بفتح الميم)، فكانت مقاومة الأهالي للمفاهيم الطبية "الدخيلة"، ورفض الامتثال لقواعد التطبيب العصري، شكل من أشكال مقاومة السياسات الاستعمارية عامة. أما اليوم فلم يعد مكان لهذا النوع من الرفض بعدما صار صارت المعرفة الطبية متقاسمة ومشتركة، بل حتى أنواع من الطب البديل صار شريكا للطب العصري في البحث عن علاجات فعالة لبعض الأمراض المستعصية، ولا يطرح المشكل إلا مع الممارسات السحرية والشعوذة وبعض الممارسات الطقوسية المهددة للصحة والغريبة.
5- مرة أخرى يتأكد أن حركة الانسان وتنقله بين الأقاليم والبلدان، وسفره عبر مختلف وسائل النقل، هو أهم سبب في انتشار الأوبئة وتفشيها. فتاريخيا ثبت أن تنقل الناس لأغراض التجارة أو أغراض أخرى أدى إلى نقل الوباء من موطنه الأصلي إلى مناطق جديدة، مثلما ظهر مع الوقت أن ناقلو الوباء كثيرا من يكتسبون أوبئة جديدة من البيئة التي حلوا بها ونقلوا إليها الوباء من البلدان التي جاؤوا منها أومروا بها، مثلما حدث مع الطاعون في أواسط القرن الرابع عشر . ونحن اليوم تعيش في عالم لم يسبق أن بلغت فيه الحركة والتنقل بين المناطق والقارات والمدن ما بلغته البشرية في الزمن المعاصر، بفضل التطور المذهل لوسائل التنقل، وارتفاع سريع في مستوى الاحتكاك بين الحضارات والثقافات، ولكن أيضا لأن الرأسمالية صنعت عالما يوافق متطلبات نشاط الرأسمال الذي لا يرضى بغير الحركة الدائمة بحثا عن الأسواق والأرباح في كل مكان.
(يتبع)
صحيح أن وسائل الرصد والتشخيص تطورت كثيرا، وبالمثل طرق العلاج والإيواء الطبي، وتطور الوعي الصحي لدى الناس وطرق الوقاية، إلا أننا ما نزال نشهد الصعوبات نفسها تقريبا في مواجهة الجائحة على مستوى فعالية التطويق وسرعة ابتكار الدواء الفعال للعلاج أو اللقاح المضاد للوقاية والحماية من الإصابة بالمرض، ما عدا بالطبع ما يتعلق بتطور البحث الطبي في إيجاد العلاجات واللقاحات على المدى المتوسط أو البعيد، بحسب نوع الفيروسات وظروف ظهورها. فالأكيد، وهذا هو ربما الفارق الكبير الذي يفصلنا عن العصور الماضية، أن قدرة العلم اليوم على فهم الظواهر الفيروسية وتفسير أسباب ظهورها، وفهم الطريقة التي تعمل وتهاجم بها الأجسام، لا تقارن مطلقا مع تعثر العلماء والأطباء في تفسير النشاط الفيروسي عامة، وتحديد أسباب وطرق انتقال العدوى بالنسبة لبعضها، كما حدث مع الطاعون، والذي ظل لقرون يراوح دائرة الفرضيات والتكهنات، قبل أن يحسم التطور اللاحق للعلوم البيولوجية والطبية الأمر، ويتوصل العلماء إلى السيطرة على بعض الفيروسات الشهيرة من خلال تحديد مصدرها وفهم سلوكها بدقة كبيرة، وبالتالي إيجاد اللقاحات والأمصال المضادة لها، لكن دون أن يعني أنهم نجحوا بالفعل في [بعادها إلى الأبد من قائمة الأمراض المعدية والمتفشية، ما يفتح المجال لاحتمال عودة بعضها إلى الوجود.
إشارات سريعة ومفيدة من التاريخ
للمرض تاريخ يتداخل فيه الاجتماعي مع السياسي والديمغرافي والإيكولوجي والعلمي، مثلما له من التأثيرات الخطيرة على المستويات الاجتماعية والديمغرافية والنفسية(نتحدث في الغالب عن عدد الإصابات بالفيروس ولا نتحدث إلا نادرا أو لا نستطيع إحصاء عدد الإصابات النفسية الناجمة عن الإصابة بالمرض نفسه أو الخوف من الإصابة) بالنسبة للمجتمعات المتضررة. وعلى مر التاريخ شكل المرض، وخاصة العدوى الوبائية، هاجسا ألقى بظلاله على حياة الأفراد والجماعات، وأثقل كاهل المجتمعات بالأعباء والجهود لمكافحته والحد من آثاره التدميرية على الصحة العامة والاستقرار الديمغرافي. وفي ارتباط بذلك، شكل المرض منطلق نشوء ليس فقط علوم الطب، وبعدها علوم التمريض وهيئات التمريض المنظمة في وقت متـأخر من القرن التاسع عشر، بل وأيضا عاملا حاسما لظهور سياسات تنظيمية جديدة(الحجر الصحي، حملات التلقيح...إلخ ) في مجال الصحة العامة. لكن ما لا يمكن تجاهله أيضا في هذا الإطار أن المرض شكل عنصرا مهما في تشكيل التصور الامبريالي للمجتمعات المستعمرة، كما بينت ذلك بوضوح دراسات حول الامبريالية في الجامعات الغربية، وبشكل خاص ما انتظم منها في إطار دراسات تاريخ المرض والطب أو الأنتروبولوجيا الطبية، بينما ظلت إلى وقت غير بعيد خارج اهتمامات المؤسسات البحثية أو في حدود مجهودات فردية. ونحن اليوم نتوفر على تراكم مهم في هذا الباب لا شك أنه سيكون مفيدا في فهم ما يجري من حولنا من نقاشات وجدالات حول الجائحة المتمددة في أقطار العالم، ومنها بالخصوص ما يتعلق بتوصيف علاقات القوة والسلطة التي تعمل خلف سلوك المؤسسات الطبية العالمية وهيئات الصناعة الدوائية، ومختلف الأفكار الرائجة حول الوباء. فقد كشفت دراسات عديدة في السياق المشار إليه أعلاه أن تاريخ المرض هو أكثر من مجرد رواية لتاريخ ظهور واختفاء الميكروبات والفيروسات، وجرد أعداد الوفيات وطرق العلاج ووصف خريطة الانتشار الوبائي، إذ يكتسي أهمية فائقة من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية. وقد يكون حاسما، ليس بالنسبة لتصورات الأفراد للمرض وتفسيره فحسب، بل وأيضا لقراءة المعنى في المآسي الناجمة عن تفشي المرض على أوسع نطاق بالنسبة للمجتمعات والجماعات المختلفة. ومن هنا يبرز الاختلاف على مستوى تصورات المرض، وبالتالي للممارسات الطبية وللتنظيم الاجتماعي في فترات الانتشار الوبائي، كلما انتقلنا من بيئة إلى أخرى، ومن ثقافة مسيطرة لأمم قوية-استعمارية وامبريالية إلى ثقافة مسيطر عليها لأمم ضعيفة، تابعة كانت أو مقاومة.
كان الأستاذ هيجل(وقد قضى نحبه بسبب وباء الكوليرا) يعتقد أن التاريخ يعيد نفسه من خلال الشخصيات التاريخية، غير أن تلميذه المتمرد ماركس سيسخر من اعتقاده هذا مؤكدا أن التاريخ لا يفعل ذلك إلا في شكل مأساة أو مهزلة. وما نعيشه منذ شهور قليلة من دراما تفشي وباء كورونا، ونتابعه من أخبار فتكه بالبشر في عدد من البلدان التي استقوى فيها على النظام الصحي والتدخلات الطبية، هو الشكل الأول الذي يعيد فيه تاريخ الوباء القاتل نفسه، ولعلنا نكون في بداية مأساة حقيقية قد تؤدي إلى حصد الملايين من البشر إذا لم ينجح العلماء والأطباء في تطوير علاجات فعالة تقلل من عدد الضحايا بين المصابين، أو إنتاج لقاحات في مدة أقل من المتوقع، وإلا ننتظر معجزة بحيث يتراجع ارتفاع عدد الإصابات عن المعدلات المتوقعة في ضوء القراءات الحالية لخريطة الانتشار وانتقال العدوى، أو في أحسن الحالات تأتي تدابير الحجر الصحي أكلها، على الأقل في البلدان التي تطبقها بجدية وصرامة.
إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات في مواجهة الوباء الجديد يعيد للذاكرة وقائع وأحداث من التاريخ القديم والحديث كان لا بد وأن تأخذ منها العبر والدروس، لو أن أمر تدبير شأن الأمم أسند لمن يمتلكون الحس التاريخي ويحيطون بتطور المجتمعات من جميع الأبعاد والمستويات، بدل أن يتولاها رأسماليون جشعون بمعاونة "تقنيين" محدودي الرؤية معتدين بمعرفتهم المتخصصة التي لا تتعدى عندهم في الغالب فرعا أو مادة من فرع معرفي لا يغني ولا يسمن من علم.
ولعله من المهم أن نأخذ من التاريخ بعض الإشارات الجديرة بالتأمل:
1- فقد لفت الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بكل من إيطاليا وفرنسا واسبانيا، وعدد الإصابات المؤكدة المرتفع وفي تزايد متواصل، بعد مغادرته لموطنه الأصلي المفترض الصين، انتباه العديد من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بموضوع الأوبئة والكوارث الطبيعية والآفات العظمى، لوجود سوابق تاريخية بهذه الدول والمناطق من حيث الابتلاء بالأوبئة القاتلة والمجاعات والكوارث الطبيعية من زلازل وفياضات مهولة وغيرها. ولعل ما عرف بالطاعون الأسود La peste noire الذي حل بها في أواسط القرن الرابع عشر (م)، وخلف وراءه أعدادا هائلة من الضحايا، يعتبر من أسوء ذكريات شعوب هذه الدول التي كادت تنقرض بسبب هذا الوباء اللعين، وهو ما يزال إلى أيامنا موضوع أبحاث وتحريات ونقاشات بين الباحثين والعلماء والمؤرخين، ولم يستنفذ بعد دراسة وبحثا.
2 - رصدت تقارير علمية ما يقارب 350 مرضا معديا ظهر ما بين سنتي 1940 و2004، معظمها يأتي من دول الجنوب الفقيرة، وتقول دراسات في المجال أن 90 بالمائة من الفيروسات والبكتيريا لم تكن معروفة إلى حدود العقد الثامن من القرن الماضي، بينما تتسبب الأمراض المعدية في وفاة ما يناهز أربعة عشر مليونا كل سنة في العالم التي تنحصر أغلبها في بلدان جنوب الكرة الأرضية، منها بالطبع أمراض وفايروسات قديمة تعاود الظهور. ويرى بعض الباحثين أن تجدد ظهور الأمراض المعدية والأوبئة هو ظاهرة تندرج ضمن منطق الحي Le vivant نفسه.
3- في جميع الأزمات المرتبطة بانتشار الوباء تنشط تجارة الخوف، فيظهر تجار الأزمات على حقيقتهم من المضاربين بالأسعار والمحتكرين للسلع، ومعهم تجار المشاعر، الدينية بالخصوص، الذين يستغلون حالة الهلع والخوف لممارسة الابتزاز الروحي على الناس واستدراجهم إلى مواقعهم الغامضة كي يتسنى لهم ممارسة سلطتهم الروحية. هكذا تتسيد الخرافات ويكثر الدجالون والمشعوذون من كل صنف، وتطفو إلى السطح من جديد الممارسات التقليدية للتداوي الشعبي والطقوس الغريبة، أو البحث عن الخلاص عن طريق الروحانيات، بينما تكون مثل هذه الممارسات منحصرة في فئة قليلة جدا في الأوقات العادية مع وجود الطب العصري. كل ذلك سيطرح من جديد أسئلة محرجة حول قدرة الحداثة على احتواء مخلفات العصور القديمة، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة، أي حول الشعور بالاطمئنان الزائد الذي يوفره الإيمان الأعمى بالقدرات الخارقة للحداثة على تفادي الأخطار المحدقة بالجنس البشري، بينما نرى كيف تتخبط مجتمعاتها في عجز واضح على احتواء الوباء ومحاصرة الهلع الذي يولده يوما بعد يوم. صحيح، كما يقول البعض، أنه رغم الخوف وهول ما يحدث، فإن الانسانية لم تكن يوما ما مسلحة في مواجهة الأمراض والأوبئة والمجاعات أفضل مما عليه اليوم، بفضل التقدم العلمي والطبي، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الفشل الذريع الذي كشفته الأزمة الحالية لوضع الحداثة في خدمة الرأسمالية الشاملة التي لا يهمها لا الانسان ولا بقاء الجنس البشري، بقدر ما تحرص على تعظيم الأرباح والاستثمار في المآسي كما في التسلية.
4- نعيش اليوم في ظل عالم تعولمت فيه الممارسات والمفاهيم الطبية بحيث لم يعد هناك إلا القليل من المفاهيم والممارسات الطبية المحلية التي تقاوم من أجل البقاء وترفض الخضوع للأمر الواقع، أي القبول بوحدة الطب العصري، وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع حتى العقد الخامس من القرن الماضي حين أدخلت القوى الاستعمارية لأول مرة خلاصات وتقنيات وتجهيزات الطب الغربي وسعت إلى فرضه بالقوة على شعوب المستعمرات، مروجة لفكرة أن الجهل والفقر، وليس النهب والاستغلال، هما سبب انتشار الأمراض والأوبئة بالمجتمعات المستعمرة(بفتح الميم)، فكانت مقاومة الأهالي للمفاهيم الطبية "الدخيلة"، ورفض الامتثال لقواعد التطبيب العصري، شكل من أشكال مقاومة السياسات الاستعمارية عامة. أما اليوم فلم يعد مكان لهذا النوع من الرفض بعدما صار صارت المعرفة الطبية متقاسمة ومشتركة، بل حتى أنواع من الطب البديل صار شريكا للطب العصري في البحث عن علاجات فعالة لبعض الأمراض المستعصية، ولا يطرح المشكل إلا مع الممارسات السحرية والشعوذة وبعض الممارسات الطقوسية المهددة للصحة والغريبة.
5- مرة أخرى يتأكد أن حركة الانسان وتنقله بين الأقاليم والبلدان، وسفره عبر مختلف وسائل النقل، هو أهم سبب في انتشار الأوبئة وتفشيها. فتاريخيا ثبت أن تنقل الناس لأغراض التجارة أو أغراض أخرى أدى إلى نقل الوباء من موطنه الأصلي إلى مناطق جديدة، مثلما ظهر مع الوقت أن ناقلو الوباء كثيرا من يكتسبون أوبئة جديدة من البيئة التي حلوا بها ونقلوا إليها الوباء من البلدان التي جاؤوا منها أومروا بها، مثلما حدث مع الطاعون في أواسط القرن الرابع عشر . ونحن اليوم تعيش في عالم لم يسبق أن بلغت فيه الحركة والتنقل بين المناطق والقارات والمدن ما بلغته البشرية في الزمن المعاصر، بفضل التطور المذهل لوسائل التنقل، وارتفاع سريع في مستوى الاحتكاك بين الحضارات والثقافات، ولكن أيضا لأن الرأسمالية صنعت عالما يوافق متطلبات نشاط الرأسمال الذي لا يرضى بغير الحركة الدائمة بحثا عن الأسواق والأرباح في كل مكان.
(يتبع)