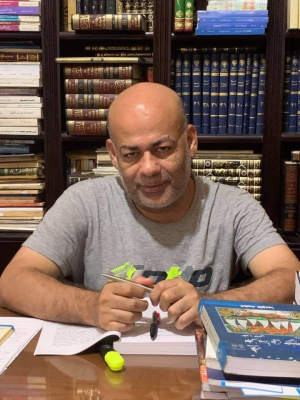معشوق الفلاح ، طعامه الرّخيص ، ووجبته السّهلة ، اطلق عليهِ أبناء الطّين والشّقاء " المقسوم " و" رزقه الموجود " ، إنّها ثمرة " الباذنجان " أو " أبو سمرة" كما ألِف البسطاء تدليله .
الباذنجان في الرِّيفِ محبة لا تنتهي ، لا يترك الفلاحُ أكله في البيتِ او الحقلِ ، يتعقّبه ايّنما ذهب ، ألفة غريبة وعلاقة وثيقة ، مُنذ عرف الأنسان طريقه إلى فمهِ، وتحركت أسنانه تطحن ما يُلقى إليها ، وشعر بلدغةِ الجوع في بطنهِ الخاوي ، شاعَ في الرِّيفِ وقُرانا الفقيرة في مواسمٍ ، اعتبرها القوم مهرجان الباذنجان السنوي ، في قريتنا التي رزحت حتى وقتٍ قريب ، تحت نيّر الفقر والفاعل منذ تكوينها ، كنت أجوب الدّروبِ كدوابِ الأرض الهاملة ، ابحثُ عن مجاميع اللّعب واللهو المتناثرة تحت الحيطانِ ، أو بجوارِ الأزقةِ المعتمة ، هناك في ساعةِ الظهيرةِ ، أو عند تسللِ خيوط الظلام في دخلةِ المساء ، تتلاقى في أنفي المتلصص خليط الروائح ، يهب بقوةٍ من خلفِ الجدر ، أو من بين الواحِ الأبوابِ المترنحة ، كنت كغيري من أبناء ِ الحرمان ؛ نميّز بتلقائية رائحته النفاذة ، من بينِ ألف صنفٍ ، وإن كان الوحيد المتسلل في خبثٍ من البيوتِ.
فضيق ذات اليّدِ ، وكساد سوق العمل ، وتلاقي الناس على موائدِ الحاجة ، جعل من هذا الأسمر ، معشوقا حتى وأن لم يكن .
أكلناهُ في أزمنتنا الغابرة ، مقليا ومشويا ، وغارقا في مرقِ التخديعة ، وفي مراتٍ نيئا حتى بهت طعمه في حلوقنا ، لكنّه القدر والظروف التي ألزمتنا صداقته ، وزاوجت بين بطون أبناء التعب وبينه ، زواجا أبديا لا خُلع فيه ولا طلاق .
تفيضُ بهِ الحقول ، ويكثر باعته على رؤوسِ النواصي والدروبِ في موسمهِ، صغيرا كنت احفظ ترنيمة الغلابة ، التي تندفعُ من حلوق أهالينا ، عندما نتململ من وجوهِ ؛ ضيفا شرفيا في كُلّ وجباتنا ، تقذف الأمُ بالطبقِ أو الطاسة ، فوق الطبليةِ ، وهي تُغرِقُ المعترض بكلامها ، فيخرس على الفورِ ، بعد شعوره بالإثم وتأنيب الضمير جراء ذنبه : دا المقسوم .. الموجود .. أللي عطاه ربنا .. الحاضر يسدّ.
يظلّ الصّغار على عداوتهِ ، يخفونها تقية في صدورهم ، ونفوسهم من وراء ذلك ، تفيض زجرا وتوبيخا للأسمرِ اللعين ، في ثورةٍ تتمنى الخروج يوم ، من تحت وصايتهِ التي أرهقتهم.
وما إن ينقضي موسمه ؛ حتى يتنفس الجميع الصّعداء ، ويحمدوا الله أن أمدّ في أعمارهم ، وافرغ عليهم صبرا واحتمالا ، وأياديهم مرفوعة تلهج بالدعاءِ ، ألا يجمع بينهم وبينه في قابلٍ .
في اوقاتٍ كثيرة ، يتحول الباذنجان قسمة الله في فم البائسِ المضطر ، لعدوٍ غادر ، يوشك أن يفتك بخصمهِ بلا رحمةٍ أو شفقة ، بل يصبحُ في أحيانٍ مصدرَ شؤومٍ وخطر ، لابد من صرفهِ بأيةٍ وسيلة،
عانيت منذ صغري ألما في عيني ، كبقيةِ أبناء التراب ، جرّبت أمي وصفات عدة ، على يدِ حلاق القرية المعروف ، وفي مراتٍ تجرني ونذهب بي لكنيسةٍ في فريةٍ مجاورة ، هناك بعثة طبية أجنبية ، يطلق عليهم " الرُّهاب" تُخصص يوما للكشفِ على الفقراء بأجرٍ زهيد ، تتكرر الزيارة حتى يُكتب لي من عندهِ سبحانه التعافي .
كانت عيني تتعبني على فتراتٍ ، وينساب الدّمعُ الحار غزيرا على خدي، ويصطبغ بياضها حمرةً مخيفة ، وبعد معاناة كُتِب لي الذهاب لطبيبِ العيون بالبندرِ ، تخوّف الأهل من مضاعفاتٍ قد لا تُحمد عواقبها ، رغم الفقر وضيقِ الحال .
في هذه الأثناء كان ذِكر الباذنجان ، رجسٌ من عملِ الشيطان ، وعلة تفوق علة عيني ، فقد سرت في النّاسِ مُنذ قديم الأزلِ ؛ أن الباذنجان يضرّ بمرضى العين ، وهو الوحيد القادر على إصابةِ عين المريض بالحولِ ، وقد يفقد نور عينه بسببهِ ، فما إن تمرض عينك ، حتى ينادي منادٍ : ابعدوا عنا الباذنجان ، هو مُحرَمٌ علينا .. لا يدخل بيتنا مادام المرض، حتى الآن لا نعرف العلاقة بين المرضِ وحبيب الملايين .
لا أخفيكم سرا ، كانت ساعتئذٍ ، وبرغم المرض والألم ، فترة استجمامٍ ، ارتاح فيها من رؤيةِ ضيفنا الثقيل ولو قليلا .
عندئذٍ يستبدل طعامي بالحلاوةِ الطحينية ، أو علبة من مربى " قها" ، أو يكون فُتات الخبز المسكّر ، مغمورا في الحليبِ ( السقاوة) ، كنت احسب ليومِ عودته ثانيةً لبيتنا ألف حساب .
مرّت أيام فقرنا المصبوغة بالعوزِ ، وأصبح الناس الآن يسبحون في بحار ِ النعمةِ ورغد العيش ، وعرف الفلاح ابن الطّين ، أجير الأمسِ صنوفا من طيباتِ الموائد ، وتردد بين جنباتِ أزقتنا التي طالما اكتظت بروائح " ابو سمرة" الغالي ، أسماء وجباتٍ من بدع القوم وتقاليعهم التي لم تكن في سننِ الأولين ، من " الكنتاكي" و " البرجر" والبيدزا" وخلافه ، والتي لو رآها أسلافنا لجلدوا متعاطيها حدا .
وسبحانه العاطي ....
الباذنجان في الرِّيفِ محبة لا تنتهي ، لا يترك الفلاحُ أكله في البيتِ او الحقلِ ، يتعقّبه ايّنما ذهب ، ألفة غريبة وعلاقة وثيقة ، مُنذ عرف الأنسان طريقه إلى فمهِ، وتحركت أسنانه تطحن ما يُلقى إليها ، وشعر بلدغةِ الجوع في بطنهِ الخاوي ، شاعَ في الرِّيفِ وقُرانا الفقيرة في مواسمٍ ، اعتبرها القوم مهرجان الباذنجان السنوي ، في قريتنا التي رزحت حتى وقتٍ قريب ، تحت نيّر الفقر والفاعل منذ تكوينها ، كنت أجوب الدّروبِ كدوابِ الأرض الهاملة ، ابحثُ عن مجاميع اللّعب واللهو المتناثرة تحت الحيطانِ ، أو بجوارِ الأزقةِ المعتمة ، هناك في ساعةِ الظهيرةِ ، أو عند تسللِ خيوط الظلام في دخلةِ المساء ، تتلاقى في أنفي المتلصص خليط الروائح ، يهب بقوةٍ من خلفِ الجدر ، أو من بين الواحِ الأبوابِ المترنحة ، كنت كغيري من أبناء ِ الحرمان ؛ نميّز بتلقائية رائحته النفاذة ، من بينِ ألف صنفٍ ، وإن كان الوحيد المتسلل في خبثٍ من البيوتِ.
فضيق ذات اليّدِ ، وكساد سوق العمل ، وتلاقي الناس على موائدِ الحاجة ، جعل من هذا الأسمر ، معشوقا حتى وأن لم يكن .
أكلناهُ في أزمنتنا الغابرة ، مقليا ومشويا ، وغارقا في مرقِ التخديعة ، وفي مراتٍ نيئا حتى بهت طعمه في حلوقنا ، لكنّه القدر والظروف التي ألزمتنا صداقته ، وزاوجت بين بطون أبناء التعب وبينه ، زواجا أبديا لا خُلع فيه ولا طلاق .
تفيضُ بهِ الحقول ، ويكثر باعته على رؤوسِ النواصي والدروبِ في موسمهِ، صغيرا كنت احفظ ترنيمة الغلابة ، التي تندفعُ من حلوق أهالينا ، عندما نتململ من وجوهِ ؛ ضيفا شرفيا في كُلّ وجباتنا ، تقذف الأمُ بالطبقِ أو الطاسة ، فوق الطبليةِ ، وهي تُغرِقُ المعترض بكلامها ، فيخرس على الفورِ ، بعد شعوره بالإثم وتأنيب الضمير جراء ذنبه : دا المقسوم .. الموجود .. أللي عطاه ربنا .. الحاضر يسدّ.
يظلّ الصّغار على عداوتهِ ، يخفونها تقية في صدورهم ، ونفوسهم من وراء ذلك ، تفيض زجرا وتوبيخا للأسمرِ اللعين ، في ثورةٍ تتمنى الخروج يوم ، من تحت وصايتهِ التي أرهقتهم.
وما إن ينقضي موسمه ؛ حتى يتنفس الجميع الصّعداء ، ويحمدوا الله أن أمدّ في أعمارهم ، وافرغ عليهم صبرا واحتمالا ، وأياديهم مرفوعة تلهج بالدعاءِ ، ألا يجمع بينهم وبينه في قابلٍ .
في اوقاتٍ كثيرة ، يتحول الباذنجان قسمة الله في فم البائسِ المضطر ، لعدوٍ غادر ، يوشك أن يفتك بخصمهِ بلا رحمةٍ أو شفقة ، بل يصبحُ في أحيانٍ مصدرَ شؤومٍ وخطر ، لابد من صرفهِ بأيةٍ وسيلة،
عانيت منذ صغري ألما في عيني ، كبقيةِ أبناء التراب ، جرّبت أمي وصفات عدة ، على يدِ حلاق القرية المعروف ، وفي مراتٍ تجرني ونذهب بي لكنيسةٍ في فريةٍ مجاورة ، هناك بعثة طبية أجنبية ، يطلق عليهم " الرُّهاب" تُخصص يوما للكشفِ على الفقراء بأجرٍ زهيد ، تتكرر الزيارة حتى يُكتب لي من عندهِ سبحانه التعافي .
كانت عيني تتعبني على فتراتٍ ، وينساب الدّمعُ الحار غزيرا على خدي، ويصطبغ بياضها حمرةً مخيفة ، وبعد معاناة كُتِب لي الذهاب لطبيبِ العيون بالبندرِ ، تخوّف الأهل من مضاعفاتٍ قد لا تُحمد عواقبها ، رغم الفقر وضيقِ الحال .
في هذه الأثناء كان ذِكر الباذنجان ، رجسٌ من عملِ الشيطان ، وعلة تفوق علة عيني ، فقد سرت في النّاسِ مُنذ قديم الأزلِ ؛ أن الباذنجان يضرّ بمرضى العين ، وهو الوحيد القادر على إصابةِ عين المريض بالحولِ ، وقد يفقد نور عينه بسببهِ ، فما إن تمرض عينك ، حتى ينادي منادٍ : ابعدوا عنا الباذنجان ، هو مُحرَمٌ علينا .. لا يدخل بيتنا مادام المرض، حتى الآن لا نعرف العلاقة بين المرضِ وحبيب الملايين .
لا أخفيكم سرا ، كانت ساعتئذٍ ، وبرغم المرض والألم ، فترة استجمامٍ ، ارتاح فيها من رؤيةِ ضيفنا الثقيل ولو قليلا .
عندئذٍ يستبدل طعامي بالحلاوةِ الطحينية ، أو علبة من مربى " قها" ، أو يكون فُتات الخبز المسكّر ، مغمورا في الحليبِ ( السقاوة) ، كنت احسب ليومِ عودته ثانيةً لبيتنا ألف حساب .
مرّت أيام فقرنا المصبوغة بالعوزِ ، وأصبح الناس الآن يسبحون في بحار ِ النعمةِ ورغد العيش ، وعرف الفلاح ابن الطّين ، أجير الأمسِ صنوفا من طيباتِ الموائد ، وتردد بين جنباتِ أزقتنا التي طالما اكتظت بروائح " ابو سمرة" الغالي ، أسماء وجباتٍ من بدع القوم وتقاليعهم التي لم تكن في سننِ الأولين ، من " الكنتاكي" و " البرجر" والبيدزا" وخلافه ، والتي لو رآها أسلافنا لجلدوا متعاطيها حدا .
وسبحانه العاطي ....