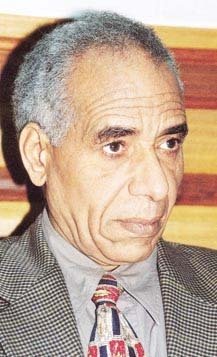ليس هناك شاعر حديث واحد، لأنه ليست هناك وصفة واحدة جاهزة لمفهوم الحداثة الشعرية، بحيث تنطبق - أو لا تنطبق - على هذا الشاعر أو ذاك. من العبث البحث إذن عن تعريف جامع، وإني لأتوقع أن تكون هناك تعريفات بقدر عدد الشعراء المشاركين في هذا الاستفتاء، كل حسب ثقافته وتجربته ووجهة نظره. ومن ناحيتي، فإني أرى أن الإنجاز الذي حققه رواد الشعر الحر لم يعد كافياً لتحقيق الحداثة الآن. لقد تم استبدال وحدة القصيدة بوحدة البيت وعلينا - إن أردنا أن نكون أنفسنا - أن نستبدل وحدة المشروع الشعري بوحدة القصيدة، إنني لا أستطيع أن أطمئن إلى حداثة قصيدة مفردة، أو حتى إلى امتيازها، بعيداً عن السياق الذي ينتظمها في المشروع الاستراتيجي للشاعر، لابد إذن لكل كتاب شعري، من أن يكون ديواناً حقيقياً يطرح هماً تشكيلياً خاصاً، ورؤية جمالية وفكرية متسقة مع ذاتها، ولا مكان في هذه النظرة، للمجموعة الشعرية التقليدية التي تضم قصائد لا يجمع بينها إلا غلافا الكتاب. وقد حاولت أن أتجنب ذلك في أكثر من مشروع شعري - بغض النظر عن النجاح والفضل - منها ديوان سيرة البنفسج ثم ديوان زمان الزبرجد، ثم الديوان المخطوط : آية جيم. ويقتضي ذلك أن يكون الشاعر الحداثي مهندساً من الطراز الأول، الهندسة هنا بمعنى التخطيط والتصميم والتنظيم، والسيطرة التامة على الأداة، بغير هذه السيطرة لا نستطيع أن نلعب ونبتكر قواعد وأفكاراً جديدة من خلال عفوية اللعب وبراعة التخطيط، فحتى ونحن منهمكون في اللعب، يمكننا بناء أروع الكاتدرائيات.
اللعب الحر بملكات الخيال كما قال كانط، وإنسانية الإنسان التي لا تتحقق إلا باللعب كما قال فردريك شيلر، كل هذه الرؤى الفلسفية الجمالية وغيرها، تمدنا بالأساس الذي يمكن أن نفرق عليه بين اللعب والألاعيب التي ينشئها لهو الحواة من أشباه الشعراء. الشاعر الحديث عندي.. مهندس ولاعب، مخطط وصانع، عفويته في اللعب هي الوجه الآخر لصرامته في التشكيل والبناء، وفوق ذلك فهو طفل وفيلسوف، صعلوك ونبي، وعليه لكي يظل كذلك ألا يقع في أسر النمط أو النموذج على أن تكون نماذجه هي أول ما يتمرد عليه إذا ما أحس أن مشروعه الشعري الحالي قد اكتمل.
عن مخيلة الشاعر الحداثي، علينا ألا نتوقع أكثر ما قيل، المخيلة المفتوحة على كافة المتناقضات : الواقع والحلم، المحسوس والغيبي.. الخ، على ألا يعني ذلك إيماناً بالحدود بين هذه الثنائيات، ففي الخيال الخلاق، يكون الحلم أكثر واقعية فتكون الوسائل قادرة على أن تتبادل مواقعها مع الغايات. والمجردات مع المجسدات. لا تعجبني المخيلة التي تبقى سجينة حدودها، فلا أوافق مثلاً على ما أراه في كثير من الشعر الحداثي من عبودية للصورة، بحيث لا يخرج الشعر حينئذ عن كونه مجرد متحف للصور، وراء ذلك بالتأكيد خيال قاصر لا يرى إلا بعين واحدة.
الحديث عن نظرة الشاعر الحداثي يخضع أيضاً لهذا التصور، أما فكرة الموضوع في الشعر أو في الفن عامة، فلا أظنها قابلة للتطبيق على الشعر الذي نكتبه الآن.
لا نستطيع أن نستدل ببساطة، ولأول وهلة، على الفرق بين عمل شعري أصيل، وآخر غير أصيل، وليس هذا مهماً، لأنه لا يقدح في الحداثة نفسها، بقدر ما يقدح في عجز الحركة النقدية - حتى الآن - عن تطوير أدواتها لتكون في مستوى الإبداع، والتهمة التي توجه للشعر الحديث، بأنه سهل التقليد، وأن الأدعياء بين شعرائه أكثر من المبدعين الحقيقيين، تهمة غبية، لأن أي عمل فني يمكن تقليده، فللتقليد أيضاَ ذكاؤه الخارق، ونسمع كل يوم عن تزوير لوحات فنية لمصورين عالميين مشهورين، ونكتشف أن التزوير جاز على كثير من أهل الاختصاص لفترة طويلة من الزمن، وإلى أن ينجح نقاد الحداثة في اكتشاف أسس نظرية وتطبيقية صالحة للتعامل مع الإبداع الشعري الحالي، ستظل هذه المشكلة قائمة.
لست في موقع يسمح لي - عربياً - بالحديث عن الآثار الشعرية التي ظهرت في الثمانينات، لأنني لا أملك من وسائل الاتصال الشخصي ما أستطيع به أن أخترق حصار الكتب المضروب من حولنا، وما أعرفه من الآثار هو ما وقع في يدي بالصدفة أو ما ساعدتني الظروف على الحصول عليه، ولأن هناك شعراء آخرين كثيرين أسمع عنهم دون أن أقرأ لهم إلا قصيدة هنا أو هناك، فليس من العدل الحكم بمن أعرف على من لا أعرف، وأعتقد أن معظم الشعراء العرب الحديثين - ليسوا في وضع أفضل كثيراً، باستثناء من تسير لهم ظروفهم ومواقع عملهم في الصحافة مثلاً، ظروفاً أفضل وقنوات أكثر للاتصال.
ومع ذلك، يمكنني القول بشيء من الاطمئنان، وقياساً على ما أعرفه، أن هناك خصوبة وحيوية بدأت تتخلق في القصيدة العربية لتخرجها من أسر النمط الحادثاي الذي ساد في العقود السابقة، كالنمط الإندونيسي مثلاً، وأعمال حلمي سالم وعبدالمنعم رمضان وقاسم حداد وعباس بيضون، مؤشر حقيقي إلى ذلك.
دعنا من الصيغ النقدية التي تتعامل مع الشعر الحديث انطلاقاً من أفكار أيديولوجية مسبقة، ماركسية أو دينية، ولنتكلم مباشرة عن النقاد الذين يتخذون من الحداثة نهجاً ومن التجديد هدفاً، وهؤلاء تجدهم مشغولين فقط بالتنظير عبدالمنعم تليمة مثلاً، أو تجدهم واقفين في تطبيقاتهم عند نماذج الحداثة المشهودة لدى الرواد، وحتى في هذه النماذج، لا تزال أدواتهم غير كافية لمعالجة الكثير من قضايا الحداثة الشعرية، لغوياً وإيقاعياً وتشكيلياً، خذ مثلاً معضلة قصيدة النثر، هل تجد حولها رؤية نقدية واحدة حديثة بمعنى الكلمة ؟ رؤية تستطيع أن تستقرئ الآفاق الأبعد للإيقاع النثري وتكتشف أسسه وجمالياته ؟ لا أعتقد ذلك. ربما كان الشعراء المصريون الحديثون، هم أكثر من زملائهم العرب معاناة لهذا الواقع النقدي، فكثير من النقاد في مصر، مشغولون بتوطيد علاقاتهم مع المؤسسات الثقافية والصحافية العربية، وغالباً ما يكون هذا الانشغال غير خالص لوجه الشعر وحده، ومع ذلك، فلا نملك إلا أن نتشبث بالآحاد المعدودة من النقاد المخلصين، الذين ننتظر منهم أكثر مما قدموا بالفعل : صلاح فضل، جابر عصفور، كما أبوديب، يمنى العيد، محمد بنيس، صبري حافظ، ولا أوافق - نظرياً على أنه لا مفر أمام كل جيل من إنجاب نقاده، فهذه قسمة زمنية لا يعترف بها تاريخ الفن ولا يقرها التاريخ.
ما كان يفعله أبو تمام أو المتنبي في تطوير تجربتي وذوقي للشعر، مطلع الصبا، أصبح يفعله السياب والبياتي وعبدالصبور في مرحلة تالية، ثم أدونيس وسعدي يوسف وعفيفي مطر وأمل دنقل في مرحل أحدث، وهكذا أجد أنه من الصعب تحديد مجموعة واحدة تكون هي التي لعبت دوراً أساسياً في تذوقي للشعر وبلورة نظرتي إليه، فهذا التطوير مستمر حتى الآن، وأستطيع أن أتعلم شيئاً حتى من تجارب الشعراء الشباب الذين ظهروا خلال العقد الثمانيني، ليس هناك قرار على شيء، ولا قناعة نهائية متوقعة، ونظرتي للشعر أمس ليست هي اليوم بالضبط، ولن تكون غداً على ما هي عليه.
كنت واحداً من جماعة إضاءة 77 الشعرية، ظلت هذه الجماعة تعمل من خلال شوقها الواحد وصبواتها المتعددة، طيلة عشر سنوات، أصبح من الضروري بعدها أن يتسع الطريق للتمايزات والاجتهادات الفردية التي يستقل بها كل شاعر. وعلى الرغم من توقف صدور مجلة إضاءة 77 منذ عامين، إلا أن الجماعة نفسها لا تزال فاعلة، ولو من خلال ما تشكله نصوص أعضائها - على اختلاف قيمتها الفنية والحداثية - من جبهة واحدة في وجه الإنتاج الشعري البليد الذي يملأ صفحات المطبوعات الرسمية وتتبناه المؤسسات الحكومية. وقد تركت مجلة إضاءة - إبداعا ونظراً - أثراً بالغاً على الجيل الشعري التالي.
لقد كان الاتفاق العام في الرؤية الفكرية والشوق الجمالي، هو الذي جمع أعضاء إضاءة ثم أعضاء أصوات، ولكن هل هذا يكفي ؟ لا أظنه يكفي، لابد من أن تكون هناك ظروف موضوعية أخرى، فعندما تسيطر القوى المتزمتة المعادية للتحديث على مؤسسات المجتمع، يكون العمل الجماعي هو الحل الأمثل، ولكن العمل الثقافي الجماعي، يحتاج إلى إمكانات مادية وجهد متواصل لا تسمح به الظروف التي نعيشها، ولذا فإني أرى أن يتم هذا العمل في إطار مرحلي، وعليه ألا يكون متطهراً إلى الحد الذي يقضي فيه على نفسه، لا مانع إذن من اختراق المؤسسات الثقافية الرسمية والتعامل معها على أساس أن أي مساحة نكسبها - دون أي تنازل - هي في صالح الشعر، وهي انتصار للحديث.
أوافق على صيغة المشروع الكياني، ولكن على مضض.
الجيل الشعري، الرواد، الآباء الشعريون، التمرد على السالف، هذه التعبيرات النقدية السارية وغيرها، لا أتعامل معها إلا من خلال السياق الذي تستخدم فيه، فقد أوافق في سياق ما، على تقسيم زمني عقدي للأجيال الشعرية، خاصة عندما يكون الزمر مرتبطا بالبحث عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تفاعلت مع العوامل الثقافية وظهر تفاعلها واضحاً في إنتاج جيل من الشعراء، وقد لا أقبل هذا التقسيم للأجيال في سياق آخر، تكون فيه الرؤى الجمالية والتقنية الشعرية هي مدار البحث، وكذلك، بقدر ما يكون ضرورياً في مقام ما، التأكيد على التمرد، قد يكون مضحكاً في مقام آخر، وبالتحديد عندما يطلق على شاعر لا يعرف أسلافه أصلاً كما يجب.
أقراني الحقيقيون هم كل من يستطيعون أن يجعلوني أحب أعمالهم، وهي مختلفة عن أعمالي، وأن أحترمهم، وهم مختلفون معي.
اللعب الحر بملكات الخيال كما قال كانط، وإنسانية الإنسان التي لا تتحقق إلا باللعب كما قال فردريك شيلر، كل هذه الرؤى الفلسفية الجمالية وغيرها، تمدنا بالأساس الذي يمكن أن نفرق عليه بين اللعب والألاعيب التي ينشئها لهو الحواة من أشباه الشعراء. الشاعر الحديث عندي.. مهندس ولاعب، مخطط وصانع، عفويته في اللعب هي الوجه الآخر لصرامته في التشكيل والبناء، وفوق ذلك فهو طفل وفيلسوف، صعلوك ونبي، وعليه لكي يظل كذلك ألا يقع في أسر النمط أو النموذج على أن تكون نماذجه هي أول ما يتمرد عليه إذا ما أحس أن مشروعه الشعري الحالي قد اكتمل.
عن مخيلة الشاعر الحداثي، علينا ألا نتوقع أكثر ما قيل، المخيلة المفتوحة على كافة المتناقضات : الواقع والحلم، المحسوس والغيبي.. الخ، على ألا يعني ذلك إيماناً بالحدود بين هذه الثنائيات، ففي الخيال الخلاق، يكون الحلم أكثر واقعية فتكون الوسائل قادرة على أن تتبادل مواقعها مع الغايات. والمجردات مع المجسدات. لا تعجبني المخيلة التي تبقى سجينة حدودها، فلا أوافق مثلاً على ما أراه في كثير من الشعر الحداثي من عبودية للصورة، بحيث لا يخرج الشعر حينئذ عن كونه مجرد متحف للصور، وراء ذلك بالتأكيد خيال قاصر لا يرى إلا بعين واحدة.
الحديث عن نظرة الشاعر الحداثي يخضع أيضاً لهذا التصور، أما فكرة الموضوع في الشعر أو في الفن عامة، فلا أظنها قابلة للتطبيق على الشعر الذي نكتبه الآن.
لا نستطيع أن نستدل ببساطة، ولأول وهلة، على الفرق بين عمل شعري أصيل، وآخر غير أصيل، وليس هذا مهماً، لأنه لا يقدح في الحداثة نفسها، بقدر ما يقدح في عجز الحركة النقدية - حتى الآن - عن تطوير أدواتها لتكون في مستوى الإبداع، والتهمة التي توجه للشعر الحديث، بأنه سهل التقليد، وأن الأدعياء بين شعرائه أكثر من المبدعين الحقيقيين، تهمة غبية، لأن أي عمل فني يمكن تقليده، فللتقليد أيضاَ ذكاؤه الخارق، ونسمع كل يوم عن تزوير لوحات فنية لمصورين عالميين مشهورين، ونكتشف أن التزوير جاز على كثير من أهل الاختصاص لفترة طويلة من الزمن، وإلى أن ينجح نقاد الحداثة في اكتشاف أسس نظرية وتطبيقية صالحة للتعامل مع الإبداع الشعري الحالي، ستظل هذه المشكلة قائمة.
لست في موقع يسمح لي - عربياً - بالحديث عن الآثار الشعرية التي ظهرت في الثمانينات، لأنني لا أملك من وسائل الاتصال الشخصي ما أستطيع به أن أخترق حصار الكتب المضروب من حولنا، وما أعرفه من الآثار هو ما وقع في يدي بالصدفة أو ما ساعدتني الظروف على الحصول عليه، ولأن هناك شعراء آخرين كثيرين أسمع عنهم دون أن أقرأ لهم إلا قصيدة هنا أو هناك، فليس من العدل الحكم بمن أعرف على من لا أعرف، وأعتقد أن معظم الشعراء العرب الحديثين - ليسوا في وضع أفضل كثيراً، باستثناء من تسير لهم ظروفهم ومواقع عملهم في الصحافة مثلاً، ظروفاً أفضل وقنوات أكثر للاتصال.
ومع ذلك، يمكنني القول بشيء من الاطمئنان، وقياساً على ما أعرفه، أن هناك خصوبة وحيوية بدأت تتخلق في القصيدة العربية لتخرجها من أسر النمط الحادثاي الذي ساد في العقود السابقة، كالنمط الإندونيسي مثلاً، وأعمال حلمي سالم وعبدالمنعم رمضان وقاسم حداد وعباس بيضون، مؤشر حقيقي إلى ذلك.
دعنا من الصيغ النقدية التي تتعامل مع الشعر الحديث انطلاقاً من أفكار أيديولوجية مسبقة، ماركسية أو دينية، ولنتكلم مباشرة عن النقاد الذين يتخذون من الحداثة نهجاً ومن التجديد هدفاً، وهؤلاء تجدهم مشغولين فقط بالتنظير عبدالمنعم تليمة مثلاً، أو تجدهم واقفين في تطبيقاتهم عند نماذج الحداثة المشهودة لدى الرواد، وحتى في هذه النماذج، لا تزال أدواتهم غير كافية لمعالجة الكثير من قضايا الحداثة الشعرية، لغوياً وإيقاعياً وتشكيلياً، خذ مثلاً معضلة قصيدة النثر، هل تجد حولها رؤية نقدية واحدة حديثة بمعنى الكلمة ؟ رؤية تستطيع أن تستقرئ الآفاق الأبعد للإيقاع النثري وتكتشف أسسه وجمالياته ؟ لا أعتقد ذلك. ربما كان الشعراء المصريون الحديثون، هم أكثر من زملائهم العرب معاناة لهذا الواقع النقدي، فكثير من النقاد في مصر، مشغولون بتوطيد علاقاتهم مع المؤسسات الثقافية والصحافية العربية، وغالباً ما يكون هذا الانشغال غير خالص لوجه الشعر وحده، ومع ذلك، فلا نملك إلا أن نتشبث بالآحاد المعدودة من النقاد المخلصين، الذين ننتظر منهم أكثر مما قدموا بالفعل : صلاح فضل، جابر عصفور، كما أبوديب، يمنى العيد، محمد بنيس، صبري حافظ، ولا أوافق - نظرياً على أنه لا مفر أمام كل جيل من إنجاب نقاده، فهذه قسمة زمنية لا يعترف بها تاريخ الفن ولا يقرها التاريخ.
ما كان يفعله أبو تمام أو المتنبي في تطوير تجربتي وذوقي للشعر، مطلع الصبا، أصبح يفعله السياب والبياتي وعبدالصبور في مرحلة تالية، ثم أدونيس وسعدي يوسف وعفيفي مطر وأمل دنقل في مرحل أحدث، وهكذا أجد أنه من الصعب تحديد مجموعة واحدة تكون هي التي لعبت دوراً أساسياً في تذوقي للشعر وبلورة نظرتي إليه، فهذا التطوير مستمر حتى الآن، وأستطيع أن أتعلم شيئاً حتى من تجارب الشعراء الشباب الذين ظهروا خلال العقد الثمانيني، ليس هناك قرار على شيء، ولا قناعة نهائية متوقعة، ونظرتي للشعر أمس ليست هي اليوم بالضبط، ولن تكون غداً على ما هي عليه.
كنت واحداً من جماعة إضاءة 77 الشعرية، ظلت هذه الجماعة تعمل من خلال شوقها الواحد وصبواتها المتعددة، طيلة عشر سنوات، أصبح من الضروري بعدها أن يتسع الطريق للتمايزات والاجتهادات الفردية التي يستقل بها كل شاعر. وعلى الرغم من توقف صدور مجلة إضاءة 77 منذ عامين، إلا أن الجماعة نفسها لا تزال فاعلة، ولو من خلال ما تشكله نصوص أعضائها - على اختلاف قيمتها الفنية والحداثية - من جبهة واحدة في وجه الإنتاج الشعري البليد الذي يملأ صفحات المطبوعات الرسمية وتتبناه المؤسسات الحكومية. وقد تركت مجلة إضاءة - إبداعا ونظراً - أثراً بالغاً على الجيل الشعري التالي.
لقد كان الاتفاق العام في الرؤية الفكرية والشوق الجمالي، هو الذي جمع أعضاء إضاءة ثم أعضاء أصوات، ولكن هل هذا يكفي ؟ لا أظنه يكفي، لابد من أن تكون هناك ظروف موضوعية أخرى، فعندما تسيطر القوى المتزمتة المعادية للتحديث على مؤسسات المجتمع، يكون العمل الجماعي هو الحل الأمثل، ولكن العمل الثقافي الجماعي، يحتاج إلى إمكانات مادية وجهد متواصل لا تسمح به الظروف التي نعيشها، ولذا فإني أرى أن يتم هذا العمل في إطار مرحلي، وعليه ألا يكون متطهراً إلى الحد الذي يقضي فيه على نفسه، لا مانع إذن من اختراق المؤسسات الثقافية الرسمية والتعامل معها على أساس أن أي مساحة نكسبها - دون أي تنازل - هي في صالح الشعر، وهي انتصار للحديث.
أوافق على صيغة المشروع الكياني، ولكن على مضض.
الجيل الشعري، الرواد، الآباء الشعريون، التمرد على السالف، هذه التعبيرات النقدية السارية وغيرها، لا أتعامل معها إلا من خلال السياق الذي تستخدم فيه، فقد أوافق في سياق ما، على تقسيم زمني عقدي للأجيال الشعرية، خاصة عندما يكون الزمر مرتبطا بالبحث عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تفاعلت مع العوامل الثقافية وظهر تفاعلها واضحاً في إنتاج جيل من الشعراء، وقد لا أقبل هذا التقسيم للأجيال في سياق آخر، تكون فيه الرؤى الجمالية والتقنية الشعرية هي مدار البحث، وكذلك، بقدر ما يكون ضرورياً في مقام ما، التأكيد على التمرد، قد يكون مضحكاً في مقام آخر، وبالتحديد عندما يطلق على شاعر لا يعرف أسلافه أصلاً كما يجب.
أقراني الحقيقيون هم كل من يستطيعون أن يجعلوني أحب أعمالهم، وهي مختلفة عن أعمالي، وأن أحترمهم، وهم مختلفون معي.