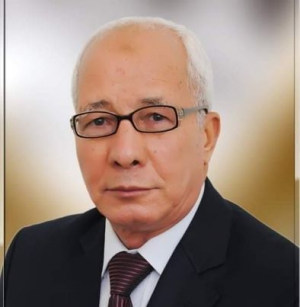كان مصنوعاً من خشب الأبنوس ومزخرفاً.
الجسدُ التي توكّأ عليه رَفِلَ في النعيم،
ثم سقطَ في مكانٍ ما على الطريقِ،
وبقي العكّاز، آخر ذكرى من حياة مجهولة.
تساءلتُ أين دُفن صاحبه
أيّ دروب سلكَ؟
ما الذي دار في ذهنه وهو يسيرُ متوكئاً عليه؟
هل رفع جَفْنيه الثقيلين،
قوَّمَ ظهره ونظرَ إلى الأفق؟
هل استطاع أن يرى الوجوه،
أن يهضم الصور، ويتذكر طريق العودة؟
خيّل لي أن العكاز غصنٌ يورقُ وأنا أتفحصه بين يديّ،
تفتحتْ في ذهني الزهرة الأنثوية المتفردة لشجرة الأبنوس
والأزهار الذكورية التي تحتشد معاً.
اشتريتُ العكاز من محل الأنتيكات رغم أنني لم أكن بحاجة إليه،
تعكزتُ عليه طوال الطريق إلى البيت.
واكبتْني نظرات استغراب
واستهدفني ضحكٌ ساخر
غير أنني لم أكترث
واصلتُ طريقي
شاعراً بثقلي عليه
وبأن شيئاً حقيقياً يسندني
وفهمتُ لماذا سمّاه السكان الأصليون لأمريكا
الحفيد الحقيقي الدائم.
تبخّرَ مني إحساسي بالفراغ
وأيقنتُ بأن في يدي شيئاً ملموساً
وأن المسألة ليست وهماً.
صارتْ خطواتي إلى البيت أكثر ثقة،
وحين وصلتُ قرعتُ الباب بالعكاز
رغم أنه لم يكن فيه أحد
لأنني أردت التأكد أنه في يدي
وأنه ليس وهماً آخر.
وبعد أن فتحتُ الباب
وصفقتهُ خلفي
في وَجْه مدينةٍ بلا عينين وبلا أذنين
تعيشُ في مدار ينغلقُ على نفسه
وضعتُ العكاز في الزاوية
وبدلاً من أدير التلفاز
وأثبت بصري على شاشته
انصرفتُ إلى تأمل العكاز
فرأيتُ فيه شجرة
تسيلُ دموعها على البشرة الخشبية.
تصاعد النشيج حتى كاد يُصمّ أذنيّ
نادباً ذراعاً نُشرت بأداة حادة
ثم نُجرت وبُردخت وعُولجت بالنار
خاصة انحناء المقبض الناعم
والذي له عرفٌ في أعلاه كعرف الديك.
نظرتُ إلى العكاز كمنحوتة، ووضعته في زاوية الصالون،
شعرت بأن له هيبة،
ثم فكرت أنه بعد أن يسند اليد،
بعد أن يتعوّد عليها،
وتفارقه يتهاوى في فراغ النسيان،
وحين يحين الوقت
يُجْمع مع قطع الأثاث الأخرى
ويُرْمى في أقرب مكبّ للنفايات
واليد التي كانت تمسك به بثقة وحنوّ،
والتي، حين تضغط تبين عروقها الزرقاء
وجلدها المتقشر
والغضون التي مر فيها الزمن،
تبخرت كالماء الذي يتصاعد من إبريق ماءٍ يغلي،
كضبابٍ ينجلي فجأة
كاشفاً اسمنت وجْه المدينة
وإسفلت جلدها،
دُفنت تحت التراب
وفقدت لحمها
وأعصابها
والأسلاك التي تصلها بغيرها
ونعومة ملمس خشب الأبنوس.
استيقظتُ من إيحاءات العكاز
وخرجتُ من متاهاتها
ثم خطرت لي فكرة كي أبعد شبح الشيخوخة
وأطرده من النافذة
فمددتُ يدي إلى زجاجة فودكا وصببتُ كأساً
رفعتهُ إلى شفتيّ وتناولت جرعةً
ثم شغّلتُ شريط موسيقى راقصة
فتأججت النار في رأسي
ودبت حماسة الحياة
وقلتُ لنفسي: تحتاج يدي الآن إلى شيء آخر،
إلى أن تلمس يداً أخرى،
وتعبر إلى ما هو أبعد
فتوهّج رقم هاتفكِ في ذهني
كما لو أن شموساً تضيء ظلام الكون
وجاء صوتكِ متفتحاً كأزهار الأبنوس الأنثوية
في صحراء جسدي، الذي بدأ يخضرّ خلية خلية
ويولد من جديد فتياً من أجل لقائي معكِ.
وشعرتُ وأنا أضمكِ
بأنني غصنٌ يورق في شجرة الكون
والثمار تتدلّى مني
وأنني أقطفُ من نفسي لنفسي
فيما حرارة أنفاسكِ تولدُ في أنفاسي
فيما يداي تطردان فراغاً يمتلئُ بي وبكِ.
وفي الزاوية، فيما كانت ذراعانا تتشابكان
وتتحولان إلى ريش في أجنحةٍ تنفرد وتعلو
في فضاء الرغبة
رأيتُ شجرة تنمو وتتفرع
ومع كل قبلة كنت أزرعها في بشرتكِ
كانت تتفتح زهرة أبنوس
فقلتُ لنفسي وأنا أطبعُ المزيد من القبل على خديكِ وشفتيك:
أحياناً يولدُ الربيع تحت الشراشف
وتنمو الأشجار داخل البيت.
الجسدُ التي توكّأ عليه رَفِلَ في النعيم،
ثم سقطَ في مكانٍ ما على الطريقِ،
وبقي العكّاز، آخر ذكرى من حياة مجهولة.
تساءلتُ أين دُفن صاحبه
أيّ دروب سلكَ؟
ما الذي دار في ذهنه وهو يسيرُ متوكئاً عليه؟
هل رفع جَفْنيه الثقيلين،
قوَّمَ ظهره ونظرَ إلى الأفق؟
هل استطاع أن يرى الوجوه،
أن يهضم الصور، ويتذكر طريق العودة؟
خيّل لي أن العكاز غصنٌ يورقُ وأنا أتفحصه بين يديّ،
تفتحتْ في ذهني الزهرة الأنثوية المتفردة لشجرة الأبنوس
والأزهار الذكورية التي تحتشد معاً.
اشتريتُ العكاز من محل الأنتيكات رغم أنني لم أكن بحاجة إليه،
تعكزتُ عليه طوال الطريق إلى البيت.
واكبتْني نظرات استغراب
واستهدفني ضحكٌ ساخر
غير أنني لم أكترث
واصلتُ طريقي
شاعراً بثقلي عليه
وبأن شيئاً حقيقياً يسندني
وفهمتُ لماذا سمّاه السكان الأصليون لأمريكا
الحفيد الحقيقي الدائم.
تبخّرَ مني إحساسي بالفراغ
وأيقنتُ بأن في يدي شيئاً ملموساً
وأن المسألة ليست وهماً.
صارتْ خطواتي إلى البيت أكثر ثقة،
وحين وصلتُ قرعتُ الباب بالعكاز
رغم أنه لم يكن فيه أحد
لأنني أردت التأكد أنه في يدي
وأنه ليس وهماً آخر.
وبعد أن فتحتُ الباب
وصفقتهُ خلفي
في وَجْه مدينةٍ بلا عينين وبلا أذنين
تعيشُ في مدار ينغلقُ على نفسه
وضعتُ العكاز في الزاوية
وبدلاً من أدير التلفاز
وأثبت بصري على شاشته
انصرفتُ إلى تأمل العكاز
فرأيتُ فيه شجرة
تسيلُ دموعها على البشرة الخشبية.
تصاعد النشيج حتى كاد يُصمّ أذنيّ
نادباً ذراعاً نُشرت بأداة حادة
ثم نُجرت وبُردخت وعُولجت بالنار
خاصة انحناء المقبض الناعم
والذي له عرفٌ في أعلاه كعرف الديك.
نظرتُ إلى العكاز كمنحوتة، ووضعته في زاوية الصالون،
شعرت بأن له هيبة،
ثم فكرت أنه بعد أن يسند اليد،
بعد أن يتعوّد عليها،
وتفارقه يتهاوى في فراغ النسيان،
وحين يحين الوقت
يُجْمع مع قطع الأثاث الأخرى
ويُرْمى في أقرب مكبّ للنفايات
واليد التي كانت تمسك به بثقة وحنوّ،
والتي، حين تضغط تبين عروقها الزرقاء
وجلدها المتقشر
والغضون التي مر فيها الزمن،
تبخرت كالماء الذي يتصاعد من إبريق ماءٍ يغلي،
كضبابٍ ينجلي فجأة
كاشفاً اسمنت وجْه المدينة
وإسفلت جلدها،
دُفنت تحت التراب
وفقدت لحمها
وأعصابها
والأسلاك التي تصلها بغيرها
ونعومة ملمس خشب الأبنوس.
استيقظتُ من إيحاءات العكاز
وخرجتُ من متاهاتها
ثم خطرت لي فكرة كي أبعد شبح الشيخوخة
وأطرده من النافذة
فمددتُ يدي إلى زجاجة فودكا وصببتُ كأساً
رفعتهُ إلى شفتيّ وتناولت جرعةً
ثم شغّلتُ شريط موسيقى راقصة
فتأججت النار في رأسي
ودبت حماسة الحياة
وقلتُ لنفسي: تحتاج يدي الآن إلى شيء آخر،
إلى أن تلمس يداً أخرى،
وتعبر إلى ما هو أبعد
فتوهّج رقم هاتفكِ في ذهني
كما لو أن شموساً تضيء ظلام الكون
وجاء صوتكِ متفتحاً كأزهار الأبنوس الأنثوية
في صحراء جسدي، الذي بدأ يخضرّ خلية خلية
ويولد من جديد فتياً من أجل لقائي معكِ.
وشعرتُ وأنا أضمكِ
بأنني غصنٌ يورق في شجرة الكون
والثمار تتدلّى مني
وأنني أقطفُ من نفسي لنفسي
فيما حرارة أنفاسكِ تولدُ في أنفاسي
فيما يداي تطردان فراغاً يمتلئُ بي وبكِ.
وفي الزاوية، فيما كانت ذراعانا تتشابكان
وتتحولان إلى ريش في أجنحةٍ تنفرد وتعلو
في فضاء الرغبة
رأيتُ شجرة تنمو وتتفرع
ومع كل قبلة كنت أزرعها في بشرتكِ
كانت تتفتح زهرة أبنوس
فقلتُ لنفسي وأنا أطبعُ المزيد من القبل على خديكِ وشفتيك:
أحياناً يولدُ الربيع تحت الشراشف
وتنمو الأشجار داخل البيت.