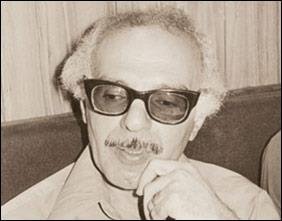على الباب نقرٌ خفيفْ
على الباب نقرٌ بصوتٍ خفيض ولكنّ شديد الوضوحْ
يعاود ليلاً، أراقبه
أتوقّعه ليلة بعد ليلهْ
أصيخ إليه بإيقاعه المتماثلِ
يعلو قليلاً قليلا ويخفت
أفتح بابي وليس هناك أحدْ
من الطارق المتخفي؟
تُرى شبح عائدٌ من ظلام المقابرْ
ضحيّة ماضٍ مضى وحياة خلتْ
هل يمكن أن تكون هذه القصيدة رؤية للمستقبل؟ وما الذي فكَّر به حينها الشاعر الرائد محمود البريكان حينما بدأ بكتابتها، وسرد حكايتها حتى آخر دقة باب من الطارق الغريب الذي جاء من الماضي، ومن ظلام المقابر؟
كل ما رواه البريكان في قصيدته «الطارق» حدث بتفاصيله الدقيقة، في إحدى الليالي من عام 2002 سمع طرقاً خفيفاً على الباب الخارجي، ليجد أمامه حينما فتح الباب ابن أخت زوجته يحمل سكيناً لمعت مع المصباح الذي أضاءه البريكان لمعرفة الطارق، لكنه لم يتمكن من رؤية السكين كاملة، فقد غارت في صدره ليقع صريع أطماع لم تعرف ما هي حتى الآن. غير أن هذا الطارق لم يمكث كثيراً في السجن، فقد بقي فيه شهوراً قليلة ليخرج بعدها ويعيش حياته حراً ضمن قرار العفو العام الذي أصدره نظام صدام حسين أواخر عام 2002، بعدما قتل شاعرا يعد من أهم رواد الحداثة الشعرية العراقية والعربية.
محمود البريكان المولود عام 1931 في مدينة الزبير لأبوينْ نجدييْن، أُعجب محمود في صباه، بجدّه لأمّه، واسمه أحمد الخال. كانت له مكتبة بيتية كبيرة تضم بالإضافة إلى المراجع، وطالما استشهد بأقوال جدّه، حسبما يروي الشاعر صلاح نيازي.
ويسرد نيازي حكاية عن القاص الراحل محمود عبد الوهاب الذي كان زميلاً للبريكان في الدراسة المتوسطة، قائلاً: «انتزع المدرّس عن قصدٍ مسبق، دفتراً بغلاف أنيق من بين مجموعة دفاتر الإنشاء التي بين يديه، ونادى: محمود داود البريكان.. نهض من مقعده في الزاوية اليسرى من الصفّ، طالب معتدل القامة، يتدثر بمعطفٍ خفيف. مشى نحو المدرس إزاء السبورة. ناوله المدرّس الدفتر، وطلب منه أن يقرأ الإنشاء الذي كتبه. فجأة أصبح الصفّ مكاناً آخر، وارتعشت في وجوهنا كلماتُ محمود وصورُهُ وجملهُ كأنها تتواثب تحت جلودنا». عاش البريكان معتزلاً في بيته، وعلى مدى حياته الطويلة، غير أنه لم يطبع مجموعة شعرية واحدة، رغم النصوص الكثيرة التي نشرها في الصحف والمجلات المهمة، ما نشره لا يتجاوز بضع عشرات نصوص نسبة لخزينه الكبير الذي سرق قبل رحيله بمدة قصيرة، ولم يعرف حتى هذه اللحظة مصير نصوصه المسروقة.
بعد ثلاثة عشر عاماً من رحيله، ما الذي تبقى من البريكان، شاعراً ورائداً للحداثة الشعرية؟ وكيف يمكن أن نعيد قراءته رغم التغيرات التي طرأت على القصيدة العربية؟
سرقة معلنة
الناقد جميل الشبيبي يقول إن البريكان عاش في عزلة وصمت بعيداً عن الأضواء والنشر، ولكنه لم يكن صامتاً مع ذاته ومع المقربين إليه من الشعراء وأدباء المدينة، كما أنه خلال هذه الفترة الطويلة لم ينشر سوى عدد من القصائد لا يتجاوز خمسا وثمانين قصيدة ولكنه – كما يؤكد بعض أصدقائه – أنجز العديد من القصائد التي لم تر النور، وكان الشاعر متريثاً في نشرها، غير أنها اختفت بعد وفاته، بشكل لافت للنظر، ومنذ ذلك التاريخ لم تعمد أي مؤسسة ثقافية إلى التحري عن هذه القصائد، ولذا ينبغي تفعيل البحث والتحري في هذه المناسبة الأليمة، ولعل ذلك يسهم في إعادتها إلى المشهد الشعري العراقي، لتصبح تجربة الشاعر حاملة لكل مقوماتها ولكي لا يصبح الشاعر المعاصر محمود البريكان (يشبه الشعراء القدامى الذين ضاعت بعض أشعارهم أو أغلبها فأصبح النقاد يرددون القول في أن معرفتهم بهم تستند إلى ما وصل من أشعارهم من جوف الماضي، ونحن نعرف شاعرنا ممّا وصل إلينا من أشعاره من جوف ذاته) كما يقول الناقد حسن ناظم.
لحظات السؤال
حين يتحدث الكاتب لؤي حمزة عباس عن الشاعر البريكان، يطرح أكثر من تساؤل بعد البحث عن حالته الخاصة، ليقدم سؤالاً جوهرياً عن أيهما أقدر على توجيه الآخر، مشاغلته وترويضه: الشعر أم الحياة؟ وهما يعيشان، معاً، زمن سيرورة واتصال، إنها العلاقة مع الوحش والإنصات العميق للهاوية التي ظلت تنادي الشاعر طويلاً، تسحبه إلى عتمتها، فيما تحدّق قصائده في ضرب من إيقاع متماثل صوب عوالم بعيدة متداخلة، مكمّلة مشهد صاحبها وهو يعدّ حياته لموت طالما تصوّره وهو يُطيل النظر، حيث لا يتراءى أحد، لقد كان محمود البريكان يهيئ نفسه بدأب صامت، يتنفس بعمق مع كلِّ قصيدة محدّثاً الإنسان: «أيها الإنسان تنفس بعمق فإنك محاط بالعدم»، ذلك العدم الذي يقرّر أخيراً انتصار الشعر على الحياة وقد تلاشت في غيبوبة الذكرى.
إنها الفكرة التي تعيد دارس شعر البريكان لظلال الميتافيزيقيا وهي تأخذه على الدوام إلى ما وراء قلقه الحياتي، عابراً لحظته الراهنة، مترقّباً اللحظة التي «ينطوي فيها مهرجان الحياة، كما تتلاشى الظلال على شاشة خالية»، فالحياة التي تنطوي هنا، تطفئ أنوارها، تتفتح هناك، في قوّة السؤال الذي يغذّي القصيدة، ينقلها لزمن مقبل لا حياة فيه سوى حياة الشعر، وقد أعدَّ الشاعر منذ زمن بعيد مائدته وهيأ كؤوسه.
الشاعر الذي أخذته لحظات السؤال طويلاً ستمحو صورته لحظة واحدة، لتبقى قصيدته حيّةً، حيث يمتد تيه البياض السحيق، وحيث يسعى الشعر في دوره الأساس إلى مساعدة العقل على اكتشاف الوجود، لا بوصفه درساً مبهماً، بل لأن الوجود حافظ منذ أولى القصائد على سمته الفارقة في أن يكون وجوداً متجدّداً وفي تجدّده تتكامل مقولتا الحياة والموت، تؤازر كلٌ منهما الأخرى، تبنيها وتهدمها في آن. يحلم الشاعر بأن يُنتج معرفته أمام دراما الوجود التي يغدو هو جزءاً منها، أن يُقيم دراماه الخاصة في نوع من معرفة فرحة تمنحها اللغة فرصة للاحتفاء بنفسها وهي تحدّق بعيداً نحو مجرى حياتنا وقد أثقلتها أعباء السنوات.
قصيدة مستقبل
في حين يؤكد الشاعر باسم المرعبي، الذي جمع بعض قصائد البريكان وقدمها في كتابه المهم «متاهة الفراشة»، على أن شعر البريكان ناشب جذوره في المستقبل، انتماءً، وقراءةً (للمستقبل) حتى ليغدو شيئاً منه. ولم يجانب الحقيقة الشاعر حين قال إن قصائدي لن تُفهم إلا بعد عشرين سنة، كما يورد عنه ذلك الأديب إحسان وفيق السامرائي.
مضيفاً: إنه يتحدث عن المستقبل بغضّ النظر عن الرقم الذي اقترحه. وهو شيء جدير بكل فن حقيقي. ليس، بالضرورة باستعصاء فهمه في لحظته، بل بمعنى سريانه في الزمن ومعه. من هنا فإن في استعادة شعر البريكان استعادة للدهشة البكر المزامنة لكل قراءة. وهو شأن كل شعر وفن عظيم يحمل صفة خلوده معه. ولا تكتمل أي قراءة للشاعر البريكان بمعزل عن رياديته، فدور البريكان الريادي أساسي لا يقلّل من أثره وخطورته أن سطحية النقد السائد لم تعره اهتماماً يُذكر، على حد تعبير الشاعر رشيد ياسين. ولذلك مقام آخر أرحب وأخطر!
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أنجز الناقد أسامة الشحماني رسالته في الماجستير عن شعر البريكان، لهذا فقد غاص عميقاً في هذا الشاعر، وعلى الرغم من لقاءاته الكثيرة معه، في محاولة للاستفادة منه لإنجاز رسالته، غير أن البريكان كان صامتاً عن أي تفسير يريده الشحماني.
الشحماني يرى أن هناك عدة تساؤلات حول منجز البريكان، يكمن التساؤل الأول في العزلة الإرادية التي جعل منها البريكان حاضنة لحياته، ماهيِّة أو مسوغات تلك العزلة القصدية التي شكلت بالنسبة له موقفاً وجودياً عميقاً حدد على أساسه مجمل مساراته الحياتية، إذ نأى بنفسه عن تمظهرات الفعل الاستعراضي اليومي، فضلاً عمَّا يدعو للشهرة والشيوع؟ أما التساؤل الثاني فيقع في انعكاس هذا الموقف الوجودي عليه مبدعاً، والعلاقة بين نصه وسيرته الذاتية، حيث حرص على نسج شعريته بتفرد، ثمَّ حكم عليها بالابتعاد عن دوائر الضوء، على الرغم من كونها تجربة مهمة ترك القليل الذي ظهر منها آثاراً واضحة المعالم على خريطة المشهد الشعري العراقي.
أما عن تفسير قوله: «أكتب لقارئ على غراري وأعلم أن الآخرين أحرار» فقد أجابني مرَّة: «أنا لا أكتب بشعرية سائدة أو بشعرية خالية من المغامرة الفنية، وينحصر عندي مفهوم الحداثة بمدى قدرته على استيعاب المواقف الشاملة، الأكثر تعبيراً عن تلك المسؤولية الكونية الواقعة على عاتق الإنسان في هذا العالم، ولذا لا يلبي العديد من نصوصي الكثير من حاجات المتلقي العادي، لأنني لا أكتب للإجابة عن التساؤلات وإنما لطرحها، وقد لا يروق هذا لمن يقرأ لكي يقضي وقت الفراغ». ومن هنا فإن قراءة بعض نصوص البريكان الآن تخلف انطباعاً بأنَّها ذات بنية ونظام لغوي يتقدم كثيراً على ما يكتب الآن تحت عباءة الحداثة.
سطوة إبداعية
ينظر الشاعر هيثم عيسى إلى البريكان من خلال ما رآه الأخير، وما أحس به من ظلم إنساني، غير أنه بخلاف الجميع كان قد فعل شيئاً إزاءه.. الفعل الذي تجسد كسطوة إبداعية على الأجيال. ويضيف عيسى: كان لعزلته نداء يقول «التجديد الشعري أعمق من مجرد إيثار لهذا الضرب أو ذاك من ضروب النظم.. أن تبدع أو لا تبدع، هذه هي المسألة». يوماً بعد آخر يكتسب نص البريكان حيوات جديدة، يخلد ويعبر عن إمكاناته الكامنة، ويراهن على استمراره عبر عملية إعادة التفكير وإعادة القراءة.
ربما في ثلاثة محاور يمكن لنص البريكان أن يظهر ببراعة تأثيره على الشعر العراقي: المحور الأول: يتصف نص البريكان بالانتقائية الصارمة، وهي تكشف عن الأصوات الفردية التي أريد لها أن تنتمي إلى مشروع جماعي.. إنه الأساس الصلب الذي يعلن لنا عن اللغة وهي تمارس دوراً بارزاً في مواجهة الثقافات السائدة. كما يعلن نص «هواجس عيسى بن أزرق في الطريق إلى الأشغال الشاقة».
المحور الثاني: يؤكد نص «إنسان المدينة الحجرية» على نزع المركزية ويعيد من جديد وضع الحدود والمراكز موضع تساؤل وفحص، إذ يدفع بالتناظر الوظيفي للخطاب الشعري إلى المقعد الخلفي، ليضع الشد والجذب والمراوغة في المقعد الأمامي متخذاً من الهامش مركزاً جديداً له.
المحور الثالث: اشتغال نص «أسطورة السائر في نومه» على نمط من المراقبة الحادة والرصد العنيف لفكرة التمزق السياسي والاجتماعي والثقافي، دائمة التحول، والسعي إلى تطويعها على أنها حقيقة شعرية كبرى.
صفاء ذياب
على الباب نقرٌ بصوتٍ خفيض ولكنّ شديد الوضوحْ
يعاود ليلاً، أراقبه
أتوقّعه ليلة بعد ليلهْ
أصيخ إليه بإيقاعه المتماثلِ
يعلو قليلاً قليلا ويخفت
أفتح بابي وليس هناك أحدْ
من الطارق المتخفي؟
تُرى شبح عائدٌ من ظلام المقابرْ
ضحيّة ماضٍ مضى وحياة خلتْ
هل يمكن أن تكون هذه القصيدة رؤية للمستقبل؟ وما الذي فكَّر به حينها الشاعر الرائد محمود البريكان حينما بدأ بكتابتها، وسرد حكايتها حتى آخر دقة باب من الطارق الغريب الذي جاء من الماضي، ومن ظلام المقابر؟
كل ما رواه البريكان في قصيدته «الطارق» حدث بتفاصيله الدقيقة، في إحدى الليالي من عام 2002 سمع طرقاً خفيفاً على الباب الخارجي، ليجد أمامه حينما فتح الباب ابن أخت زوجته يحمل سكيناً لمعت مع المصباح الذي أضاءه البريكان لمعرفة الطارق، لكنه لم يتمكن من رؤية السكين كاملة، فقد غارت في صدره ليقع صريع أطماع لم تعرف ما هي حتى الآن. غير أن هذا الطارق لم يمكث كثيراً في السجن، فقد بقي فيه شهوراً قليلة ليخرج بعدها ويعيش حياته حراً ضمن قرار العفو العام الذي أصدره نظام صدام حسين أواخر عام 2002، بعدما قتل شاعرا يعد من أهم رواد الحداثة الشعرية العراقية والعربية.
محمود البريكان المولود عام 1931 في مدينة الزبير لأبوينْ نجدييْن، أُعجب محمود في صباه، بجدّه لأمّه، واسمه أحمد الخال. كانت له مكتبة بيتية كبيرة تضم بالإضافة إلى المراجع، وطالما استشهد بأقوال جدّه، حسبما يروي الشاعر صلاح نيازي.
ويسرد نيازي حكاية عن القاص الراحل محمود عبد الوهاب الذي كان زميلاً للبريكان في الدراسة المتوسطة، قائلاً: «انتزع المدرّس عن قصدٍ مسبق، دفتراً بغلاف أنيق من بين مجموعة دفاتر الإنشاء التي بين يديه، ونادى: محمود داود البريكان.. نهض من مقعده في الزاوية اليسرى من الصفّ، طالب معتدل القامة، يتدثر بمعطفٍ خفيف. مشى نحو المدرس إزاء السبورة. ناوله المدرّس الدفتر، وطلب منه أن يقرأ الإنشاء الذي كتبه. فجأة أصبح الصفّ مكاناً آخر، وارتعشت في وجوهنا كلماتُ محمود وصورُهُ وجملهُ كأنها تتواثب تحت جلودنا». عاش البريكان معتزلاً في بيته، وعلى مدى حياته الطويلة، غير أنه لم يطبع مجموعة شعرية واحدة، رغم النصوص الكثيرة التي نشرها في الصحف والمجلات المهمة، ما نشره لا يتجاوز بضع عشرات نصوص نسبة لخزينه الكبير الذي سرق قبل رحيله بمدة قصيرة، ولم يعرف حتى هذه اللحظة مصير نصوصه المسروقة.
بعد ثلاثة عشر عاماً من رحيله، ما الذي تبقى من البريكان، شاعراً ورائداً للحداثة الشعرية؟ وكيف يمكن أن نعيد قراءته رغم التغيرات التي طرأت على القصيدة العربية؟
سرقة معلنة
الناقد جميل الشبيبي يقول إن البريكان عاش في عزلة وصمت بعيداً عن الأضواء والنشر، ولكنه لم يكن صامتاً مع ذاته ومع المقربين إليه من الشعراء وأدباء المدينة، كما أنه خلال هذه الفترة الطويلة لم ينشر سوى عدد من القصائد لا يتجاوز خمسا وثمانين قصيدة ولكنه – كما يؤكد بعض أصدقائه – أنجز العديد من القصائد التي لم تر النور، وكان الشاعر متريثاً في نشرها، غير أنها اختفت بعد وفاته، بشكل لافت للنظر، ومنذ ذلك التاريخ لم تعمد أي مؤسسة ثقافية إلى التحري عن هذه القصائد، ولذا ينبغي تفعيل البحث والتحري في هذه المناسبة الأليمة، ولعل ذلك يسهم في إعادتها إلى المشهد الشعري العراقي، لتصبح تجربة الشاعر حاملة لكل مقوماتها ولكي لا يصبح الشاعر المعاصر محمود البريكان (يشبه الشعراء القدامى الذين ضاعت بعض أشعارهم أو أغلبها فأصبح النقاد يرددون القول في أن معرفتهم بهم تستند إلى ما وصل من أشعارهم من جوف الماضي، ونحن نعرف شاعرنا ممّا وصل إلينا من أشعاره من جوف ذاته) كما يقول الناقد حسن ناظم.
لحظات السؤال
حين يتحدث الكاتب لؤي حمزة عباس عن الشاعر البريكان، يطرح أكثر من تساؤل بعد البحث عن حالته الخاصة، ليقدم سؤالاً جوهرياً عن أيهما أقدر على توجيه الآخر، مشاغلته وترويضه: الشعر أم الحياة؟ وهما يعيشان، معاً، زمن سيرورة واتصال، إنها العلاقة مع الوحش والإنصات العميق للهاوية التي ظلت تنادي الشاعر طويلاً، تسحبه إلى عتمتها، فيما تحدّق قصائده في ضرب من إيقاع متماثل صوب عوالم بعيدة متداخلة، مكمّلة مشهد صاحبها وهو يعدّ حياته لموت طالما تصوّره وهو يُطيل النظر، حيث لا يتراءى أحد، لقد كان محمود البريكان يهيئ نفسه بدأب صامت، يتنفس بعمق مع كلِّ قصيدة محدّثاً الإنسان: «أيها الإنسان تنفس بعمق فإنك محاط بالعدم»، ذلك العدم الذي يقرّر أخيراً انتصار الشعر على الحياة وقد تلاشت في غيبوبة الذكرى.
إنها الفكرة التي تعيد دارس شعر البريكان لظلال الميتافيزيقيا وهي تأخذه على الدوام إلى ما وراء قلقه الحياتي، عابراً لحظته الراهنة، مترقّباً اللحظة التي «ينطوي فيها مهرجان الحياة، كما تتلاشى الظلال على شاشة خالية»، فالحياة التي تنطوي هنا، تطفئ أنوارها، تتفتح هناك، في قوّة السؤال الذي يغذّي القصيدة، ينقلها لزمن مقبل لا حياة فيه سوى حياة الشعر، وقد أعدَّ الشاعر منذ زمن بعيد مائدته وهيأ كؤوسه.
الشاعر الذي أخذته لحظات السؤال طويلاً ستمحو صورته لحظة واحدة، لتبقى قصيدته حيّةً، حيث يمتد تيه البياض السحيق، وحيث يسعى الشعر في دوره الأساس إلى مساعدة العقل على اكتشاف الوجود، لا بوصفه درساً مبهماً، بل لأن الوجود حافظ منذ أولى القصائد على سمته الفارقة في أن يكون وجوداً متجدّداً وفي تجدّده تتكامل مقولتا الحياة والموت، تؤازر كلٌ منهما الأخرى، تبنيها وتهدمها في آن. يحلم الشاعر بأن يُنتج معرفته أمام دراما الوجود التي يغدو هو جزءاً منها، أن يُقيم دراماه الخاصة في نوع من معرفة فرحة تمنحها اللغة فرصة للاحتفاء بنفسها وهي تحدّق بعيداً نحو مجرى حياتنا وقد أثقلتها أعباء السنوات.
قصيدة مستقبل
في حين يؤكد الشاعر باسم المرعبي، الذي جمع بعض قصائد البريكان وقدمها في كتابه المهم «متاهة الفراشة»، على أن شعر البريكان ناشب جذوره في المستقبل، انتماءً، وقراءةً (للمستقبل) حتى ليغدو شيئاً منه. ولم يجانب الحقيقة الشاعر حين قال إن قصائدي لن تُفهم إلا بعد عشرين سنة، كما يورد عنه ذلك الأديب إحسان وفيق السامرائي.
مضيفاً: إنه يتحدث عن المستقبل بغضّ النظر عن الرقم الذي اقترحه. وهو شيء جدير بكل فن حقيقي. ليس، بالضرورة باستعصاء فهمه في لحظته، بل بمعنى سريانه في الزمن ومعه. من هنا فإن في استعادة شعر البريكان استعادة للدهشة البكر المزامنة لكل قراءة. وهو شأن كل شعر وفن عظيم يحمل صفة خلوده معه. ولا تكتمل أي قراءة للشاعر البريكان بمعزل عن رياديته، فدور البريكان الريادي أساسي لا يقلّل من أثره وخطورته أن سطحية النقد السائد لم تعره اهتماماً يُذكر، على حد تعبير الشاعر رشيد ياسين. ولذلك مقام آخر أرحب وأخطر!
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أنجز الناقد أسامة الشحماني رسالته في الماجستير عن شعر البريكان، لهذا فقد غاص عميقاً في هذا الشاعر، وعلى الرغم من لقاءاته الكثيرة معه، في محاولة للاستفادة منه لإنجاز رسالته، غير أن البريكان كان صامتاً عن أي تفسير يريده الشحماني.
الشحماني يرى أن هناك عدة تساؤلات حول منجز البريكان، يكمن التساؤل الأول في العزلة الإرادية التي جعل منها البريكان حاضنة لحياته، ماهيِّة أو مسوغات تلك العزلة القصدية التي شكلت بالنسبة له موقفاً وجودياً عميقاً حدد على أساسه مجمل مساراته الحياتية، إذ نأى بنفسه عن تمظهرات الفعل الاستعراضي اليومي، فضلاً عمَّا يدعو للشهرة والشيوع؟ أما التساؤل الثاني فيقع في انعكاس هذا الموقف الوجودي عليه مبدعاً، والعلاقة بين نصه وسيرته الذاتية، حيث حرص على نسج شعريته بتفرد، ثمَّ حكم عليها بالابتعاد عن دوائر الضوء، على الرغم من كونها تجربة مهمة ترك القليل الذي ظهر منها آثاراً واضحة المعالم على خريطة المشهد الشعري العراقي.
أما عن تفسير قوله: «أكتب لقارئ على غراري وأعلم أن الآخرين أحرار» فقد أجابني مرَّة: «أنا لا أكتب بشعرية سائدة أو بشعرية خالية من المغامرة الفنية، وينحصر عندي مفهوم الحداثة بمدى قدرته على استيعاب المواقف الشاملة، الأكثر تعبيراً عن تلك المسؤولية الكونية الواقعة على عاتق الإنسان في هذا العالم، ولذا لا يلبي العديد من نصوصي الكثير من حاجات المتلقي العادي، لأنني لا أكتب للإجابة عن التساؤلات وإنما لطرحها، وقد لا يروق هذا لمن يقرأ لكي يقضي وقت الفراغ». ومن هنا فإن قراءة بعض نصوص البريكان الآن تخلف انطباعاً بأنَّها ذات بنية ونظام لغوي يتقدم كثيراً على ما يكتب الآن تحت عباءة الحداثة.
سطوة إبداعية
ينظر الشاعر هيثم عيسى إلى البريكان من خلال ما رآه الأخير، وما أحس به من ظلم إنساني، غير أنه بخلاف الجميع كان قد فعل شيئاً إزاءه.. الفعل الذي تجسد كسطوة إبداعية على الأجيال. ويضيف عيسى: كان لعزلته نداء يقول «التجديد الشعري أعمق من مجرد إيثار لهذا الضرب أو ذاك من ضروب النظم.. أن تبدع أو لا تبدع، هذه هي المسألة». يوماً بعد آخر يكتسب نص البريكان حيوات جديدة، يخلد ويعبر عن إمكاناته الكامنة، ويراهن على استمراره عبر عملية إعادة التفكير وإعادة القراءة.
ربما في ثلاثة محاور يمكن لنص البريكان أن يظهر ببراعة تأثيره على الشعر العراقي: المحور الأول: يتصف نص البريكان بالانتقائية الصارمة، وهي تكشف عن الأصوات الفردية التي أريد لها أن تنتمي إلى مشروع جماعي.. إنه الأساس الصلب الذي يعلن لنا عن اللغة وهي تمارس دوراً بارزاً في مواجهة الثقافات السائدة. كما يعلن نص «هواجس عيسى بن أزرق في الطريق إلى الأشغال الشاقة».
المحور الثاني: يؤكد نص «إنسان المدينة الحجرية» على نزع المركزية ويعيد من جديد وضع الحدود والمراكز موضع تساؤل وفحص، إذ يدفع بالتناظر الوظيفي للخطاب الشعري إلى المقعد الخلفي، ليضع الشد والجذب والمراوغة في المقعد الأمامي متخذاً من الهامش مركزاً جديداً له.
المحور الثالث: اشتغال نص «أسطورة السائر في نومه» على نمط من المراقبة الحادة والرصد العنيف لفكرة التمزق السياسي والاجتماعي والثقافي، دائمة التحول، والسعي إلى تطويعها على أنها حقيقة شعرية كبرى.
صفاء ذياب