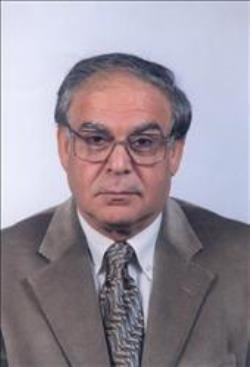ليس في هذا السؤال إساءة للأدباء الفلسطينيين، سواء انتموا إلى جيل قديم معروف الأسماء، أو إلى جيل لاحق يبحث عن ملامحه.
فلا يزال هناك شعر جيد، يكتبه مريد البرغوثي وعز الدين المناصرة وغسان زقطان، ورواية تجدّدها سحر خليفة، وقصة قصيرة أخلص لها محمود شقير... هذه أسماء على سبيل المثال لا أكثر، يمكن للقارئ المجتهد أن يضيف إليها غيرها، في حقول أدبية متنوعة.
وإذا كان الأمر كذلك، وفيه من الرضا أكثر مما فيه من الحسرة، فمن أين تأتي شرعية السؤال، ولماذا يبدو متأسيًّا، كما لو كان يرثي شيئًا جميلاً ذهب؟ تأتي الشرعية من اتجاهين على الأقل، يتضمن أحدهما المقارنة ويتمحور الثاني حول القائم وأعلامه. فلا يمتلك الأدب الفلسطيني اليوم ما يستأنف به تراث جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني وإميل حبيبي في الرواية، ولا ما يقترب من إبداع درويش الشاب، ولو بقدر، وليس لديه حتى الآن ما يشير إلى وعد كبير يتلامح في الأفق.
أما الإبداع القائم اليوم فلا يرتبط بجيل جديد، فالبرغوثي يكتب الشعر من أربعة عقود، وليست سحر خليفة روائية ولدت أمس، وينطبق القول على محمود شقير الذي يجدّد قصة قصيرة لامعة، بدأها في سبعينيات القرن الماضي على الأقل. لا يعني هذا إنكار مساهمات إبداعية مشتتة، لم تستطع الصعود إلى مستوى الظاهرة على أية حالة. كان عزمي بشارة، المتعدد في الكتابة والتساؤل، قد أعطى اقتراحًا روائيا لامعا، في عملية "الحاجز" و"الحب في منطقة الظل"، قبل أن يعود إلى قضاياه النظرية السياسية، التي لم يفارقها أبدًا.
تحولات الزمن
وقد يأتي، من حقل الأسئلة والإجابات، ما يفسّر وضعًا أدبيا فلسطينيا لا يبعث على المسرة، وقد يوجد "قلم رحيم" يعطف تحوّلات هذا الأدب على تحوّلات الزمان. ولا عيب في التفسير وليس هناك ما يؤخذ على كتابة رحيمة. والتفسير المقترح، رحيمًا كان أو شحيح الرحمة، يمر على مبدأ نظري شهير، قبل أن يتوقف أمام وضع مشخص يخص الفلسطينيين لا غيرهم. أما ما هو نظري فيتمثل بالمبدأ القائل: لا يولد الأدب من الأدب ولا تشتق الثقافة من الثقافة ذلك أن صعود الطرفين، أو تراجعهما، لا ينفصل عن الشروط الاجتماعية التي تنتج الكتابة والقراءة. والقول صحيح تماما، وهذه الصحة، التي لا يماري فيها أحد، تمنع الباحث الرصين من قراءة الأدب الفلسطيني بمعيار حضور المواهب أو غيابها.
أما ما يرتبط بالوضع المشخص فيبدو أكثر تعقيدًا ومأساوية معًا، وذلك لسببين: لا يعيش الفلسطينيون في مجتمع موحّد، فهم متناثرون في منافيهم المتناثرة، وبعضهم رهين المخيمات، التي تدفع بساكنها إلى البحث عن الرغيف قبل التوقف أمام "بطر القراءة". ينتج عن ذلك ويلتصق به موضوع: الدولة، التي تجانس أجهزتها المدرسية والتعليمية عملية القراءة والكتابة، والتي تشجّع، إن كان لها سياسة أدبية، على الإبداع ومكافأة المبدعين. وواقع الأمر أن "دولة الفلسطينيين" لا تزال حلمًا، أو كيانًا مرتهنًا إلى "عملية السلام" التي تقبل بنوع محدد من أنواع الكتابة.
ما سبق يقنع قليلاً ولا يقنع كثيرًا، لا اعتمادًا على ما تقول به نظريات "علم اجتماع الأدب"، بل على التجربة الأدبية الفلسطينية ذاتها، التي ازدهرت قبل "عملية السلام"، وقبل أن يكون للفلسطينيين أجهزة تشبه الدولة.
ولعل وضع الإبداع الأدبي الفني الفلسطيني، في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، الذي صعد في المنفى أو ما يشبه المنفى، هو الذي يدعو إلى الحديث عن "المنفى المزهر"، الذي أعطى كوكبة من الشعراء والروائيين والنقّاد ورسامًا كاريكاتوريًّا فاتنًا مثل: ناجي العلي. ومع أن في كلمة المنفى ما يحيل، لغة، على التساقط، فقد رَدّ الأدباء الفلسطينيون على التساقط بالصعود وجلاء الصوت، إذ غسان حاضر في دمشق وبيروت، وفي الأدب وخارجه، وإذ جبرا إبراهيم جبرا يسهم في ثورة فنية في العراق، وإذ معين بسيسو يستأنف صورة "شاعر القبيلة"، الذي يصوغ قصيدته من الكلمات والغضب. وكان لذلك "المنفى الأليف" في فلسطين المحتلة شعراء وروائيون وكتّاب قصة قصيرة، وكان له مؤرخه الراحل إميل توما.
صمود وهوية
لماذا لم يتساقط الأدباء الفلسطينيون في منفى يحض على التساقط ويدعو إليه؟ جاء الجواب من خصوصية الوضع الفلسطيني، أو بشكل أكثر دقة من وعي خصوصيته، هذا الوعي الذي يتضمن الحفاظ على الهوية وبناء الذات وبطولة البقاء، وذلك اليقين القائل بأن ما احتُل واغتُصب عائد إلى أهله بعد حين. ولعل هذا الوضع المعقد، الذي يغوي بأدب تبشيري بسيط، هو الذي ألزم الأدباء الفلسطينيين المؤمنين بقضيتهم أن يواجهوا المنفى بأدب فلسطيني كبير، يبشّر ويحرّض ويحفظ للأدب كرامته في آن.
عامل هؤلاء المنفيون أنفسهم بالشدة والعنف، بلغة طه حسين، فابتعدوا عن النماذج الأدبية الجاهزة وخلقوا نماذجهم الجديدة. استأنس غسان كنفاني في رواياته، التي واجهت عار الخروج بكرامة القتال، بوليم فوكنر وبريشت ومكسيم جوركي، وأعاد صوغ أعمالهم بشكل جديد، واعتمد جبرا على ثقافته الإنجليزية الواسعة المركبة، واستلهم حبيبي التراث لغة وتاريخًا، وصاغ محمود درويش قصيدة الأمل بلغة شبه فريدة، شعرها نثر ونثرها شعر..
واجه الأدباء الفلسطينيون المنفى بالأمل والعمل وخلقوا لأعمالهم جمهورًا واسعًا، فلسطينيًّا وعربيًّا معًا. ومع أن "المقاومة الفلسطينية"، أو مرحلة الكفاح المسلح بلغة أخرى، لم تنتج أدبًا يحتضن ثقافة جبرا وقلق غسان وفضول إميل حبيبي، مزيلة الحدود بين الأدب والتبشير الإعلاني، فقد خلقت فضاء ثقافيًّا، وأسهمت في توليد جمهور أدبي احترافي، إن صح القول، اعتمادًا على وعي سياسي يحاصر الأمية اللغوية والأدبية معًا. كان الفلسطينيون، آنذاك، منصرفين إلى أحلام مزهرة، وإلى تكريس الأمل، الذي يحتاجه هؤلاء الذين خدعهم الطريق..
ترجمت أحلام الفلسطينيين، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، التي شهدت أدبًا فلسطينيًّا كبيرًا، العلاقة الشهيرة بين الأدبي والسياسي، بالمعنى الإيجابي، ذلك أن السياسة كانت ولا تزال مرجعًا للأدب، في الحالة الفلسطينية على الأقل. فوجود الفضاء السياسي، بالمعنى النبيل، هو وجود المتعدد والحواري والمحتمل وتأمل البديل. والمتعدد هو صوغ معنى فلسطين شعرًا ورواية ومسرحية ورسمًا، والحواري هو تعدد الأصوات الشعرية، والمحتمل هو ما يقول به جبرا في نهايات رواياته، والبديل هو الذي عالجه غسان بأكثر من شكل وأشار إلى أفق،... بيد أن هذا لم يكن ممكنًا من دون قلق ثقافي، يؤكد أن للفلسطيني حقًّا في الوجود والانتصار، ومن دون يقين يصقله العمل وتعيد خلقه المساءلة والاختبار على مقربة شديدة من حديقة الأمل المكسوّة بألوان الفردوس.
الخيبة والوطن
تشكّل الأفكار السابقة مقدمة لسؤال الاستهلال: لماذا الأدب الفلسطيني لم يعد كما كان؟ ربما هي الخيبة، التي برهنت للفلسطينيين أن ما يتلو المنفى ليس هو الوطن تمامًا، وأن ما يعقب اليقين هو ضياع اليقين، وأن الأحلام المزهرة تستقر في لامكان. والواضح بلغة أخرى أكثر تماسكًا وأقل تأسيًّا قائم في عنصرين أساسيين: غياب السياسة، بعد أن اختصر زمن الفلسطينيين السياسي إلى "جماعة" لا تحتاج إلى سياسة ولا مكان فيها للأفراد، ذلك أن الأفراد هم "المؤمنون"، وإلى إدارة لها شكل السلطة، تعتنق الجمود والعادات، إذ كل مسؤول يستأنف ممارسات سابقيه، دون أن يسائل ذاته أو أن يحاور غيره.
أما العنصر الثاني فيتمثل في غياب الجمهور "القارئ الموسع" المحمول على الفضول والإيمان بالمستقبل، فلا أدب بلا جمهور يُقبل عليه، ولا جمهور للأدب إلا في فضاء سياسي قوامه الحوار.
ولكن كيف يستمر الأدب الفلسطيني اليوم؟
يستمر بما كان، وبما تشكّل أيام المنفى المزهر، فلم يبدأ زكريا محمد ويحيى يخلف وأحمد دحبور ومحمود شقير ومجايلوهم الكتابة مع "اتفاقية أوسلو"، بل كانوا هناك متوقعين اتفاقية أكثر عدلاً. إنها استمرارية "البنية التحتية"، كما يقال، ولو إلى حين. ويستمر أيضا بمنطق الحياة، أو منطق المركز والهامش، إذ المركز الفارغ لا يزال يبحث عمّا يملؤه، وإذ للهامش أسماء تحاول الوقوف مثل عدنية شبلي وأكرم مسلم صاحب "العقرب الذي يتصبّب عرقًا"، وأسماء مجتهدة قليلة أخرى تنشر دار الآداب في بيروت بعضًا من نتاجها.
غير أن هذا الاستمرار، في شكليه، لا يسمح إلا بمقارنة مؤسية بين ما كانه الأدب الفلسطيني وما صار إليه، ذلك أن الاستمرارية لا يراهن عليها، فالأدباء يشيخون ويموتون، مثلما أن العلاقة بين المركز والهامش خاضعة للاحتمال، فقد يظل الهامش على ما هو عليه، في انتظار جمهور قارئ جديد لا ينفصل، في الحالة الفلسطينية، عن بديل وطني جديد.
كيف يغيّر الأدب الفلسطيني أحواله؟ لا جواب. قد يكون في سياسة ثقافية يقترحها مثقفون جاؤوا بعد "اتفاقية السلام"، وقد يكون في "طليعة ما" تجمع بين الثقافة والسياسة، آمن بها غسان في مطلع دراسته عن "الأدب الصهيوني"، وقد يكون في الانسحاب من اللحظة الموجعة الخائبة والانفتاح على فلسطين، كما كانت في تاريخها البعيد، وكما ستكون بعد الإدارة السلطوية الشغوفة بالعادات.
فلا يزال هناك شعر جيد، يكتبه مريد البرغوثي وعز الدين المناصرة وغسان زقطان، ورواية تجدّدها سحر خليفة، وقصة قصيرة أخلص لها محمود شقير... هذه أسماء على سبيل المثال لا أكثر، يمكن للقارئ المجتهد أن يضيف إليها غيرها، في حقول أدبية متنوعة.
وإذا كان الأمر كذلك، وفيه من الرضا أكثر مما فيه من الحسرة، فمن أين تأتي شرعية السؤال، ولماذا يبدو متأسيًّا، كما لو كان يرثي شيئًا جميلاً ذهب؟ تأتي الشرعية من اتجاهين على الأقل، يتضمن أحدهما المقارنة ويتمحور الثاني حول القائم وأعلامه. فلا يمتلك الأدب الفلسطيني اليوم ما يستأنف به تراث جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني وإميل حبيبي في الرواية، ولا ما يقترب من إبداع درويش الشاب، ولو بقدر، وليس لديه حتى الآن ما يشير إلى وعد كبير يتلامح في الأفق.
أما الإبداع القائم اليوم فلا يرتبط بجيل جديد، فالبرغوثي يكتب الشعر من أربعة عقود، وليست سحر خليفة روائية ولدت أمس، وينطبق القول على محمود شقير الذي يجدّد قصة قصيرة لامعة، بدأها في سبعينيات القرن الماضي على الأقل. لا يعني هذا إنكار مساهمات إبداعية مشتتة، لم تستطع الصعود إلى مستوى الظاهرة على أية حالة. كان عزمي بشارة، المتعدد في الكتابة والتساؤل، قد أعطى اقتراحًا روائيا لامعا، في عملية "الحاجز" و"الحب في منطقة الظل"، قبل أن يعود إلى قضاياه النظرية السياسية، التي لم يفارقها أبدًا.
تحولات الزمن
وقد يأتي، من حقل الأسئلة والإجابات، ما يفسّر وضعًا أدبيا فلسطينيا لا يبعث على المسرة، وقد يوجد "قلم رحيم" يعطف تحوّلات هذا الأدب على تحوّلات الزمان. ولا عيب في التفسير وليس هناك ما يؤخذ على كتابة رحيمة. والتفسير المقترح، رحيمًا كان أو شحيح الرحمة، يمر على مبدأ نظري شهير، قبل أن يتوقف أمام وضع مشخص يخص الفلسطينيين لا غيرهم. أما ما هو نظري فيتمثل بالمبدأ القائل: لا يولد الأدب من الأدب ولا تشتق الثقافة من الثقافة ذلك أن صعود الطرفين، أو تراجعهما، لا ينفصل عن الشروط الاجتماعية التي تنتج الكتابة والقراءة. والقول صحيح تماما، وهذه الصحة، التي لا يماري فيها أحد، تمنع الباحث الرصين من قراءة الأدب الفلسطيني بمعيار حضور المواهب أو غيابها.
أما ما يرتبط بالوضع المشخص فيبدو أكثر تعقيدًا ومأساوية معًا، وذلك لسببين: لا يعيش الفلسطينيون في مجتمع موحّد، فهم متناثرون في منافيهم المتناثرة، وبعضهم رهين المخيمات، التي تدفع بساكنها إلى البحث عن الرغيف قبل التوقف أمام "بطر القراءة". ينتج عن ذلك ويلتصق به موضوع: الدولة، التي تجانس أجهزتها المدرسية والتعليمية عملية القراءة والكتابة، والتي تشجّع، إن كان لها سياسة أدبية، على الإبداع ومكافأة المبدعين. وواقع الأمر أن "دولة الفلسطينيين" لا تزال حلمًا، أو كيانًا مرتهنًا إلى "عملية السلام" التي تقبل بنوع محدد من أنواع الكتابة.
ما سبق يقنع قليلاً ولا يقنع كثيرًا، لا اعتمادًا على ما تقول به نظريات "علم اجتماع الأدب"، بل على التجربة الأدبية الفلسطينية ذاتها، التي ازدهرت قبل "عملية السلام"، وقبل أن يكون للفلسطينيين أجهزة تشبه الدولة.
ولعل وضع الإبداع الأدبي الفني الفلسطيني، في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، الذي صعد في المنفى أو ما يشبه المنفى، هو الذي يدعو إلى الحديث عن "المنفى المزهر"، الذي أعطى كوكبة من الشعراء والروائيين والنقّاد ورسامًا كاريكاتوريًّا فاتنًا مثل: ناجي العلي. ومع أن في كلمة المنفى ما يحيل، لغة، على التساقط، فقد رَدّ الأدباء الفلسطينيون على التساقط بالصعود وجلاء الصوت، إذ غسان حاضر في دمشق وبيروت، وفي الأدب وخارجه، وإذ جبرا إبراهيم جبرا يسهم في ثورة فنية في العراق، وإذ معين بسيسو يستأنف صورة "شاعر القبيلة"، الذي يصوغ قصيدته من الكلمات والغضب. وكان لذلك "المنفى الأليف" في فلسطين المحتلة شعراء وروائيون وكتّاب قصة قصيرة، وكان له مؤرخه الراحل إميل توما.
صمود وهوية
لماذا لم يتساقط الأدباء الفلسطينيون في منفى يحض على التساقط ويدعو إليه؟ جاء الجواب من خصوصية الوضع الفلسطيني، أو بشكل أكثر دقة من وعي خصوصيته، هذا الوعي الذي يتضمن الحفاظ على الهوية وبناء الذات وبطولة البقاء، وذلك اليقين القائل بأن ما احتُل واغتُصب عائد إلى أهله بعد حين. ولعل هذا الوضع المعقد، الذي يغوي بأدب تبشيري بسيط، هو الذي ألزم الأدباء الفلسطينيين المؤمنين بقضيتهم أن يواجهوا المنفى بأدب فلسطيني كبير، يبشّر ويحرّض ويحفظ للأدب كرامته في آن.
عامل هؤلاء المنفيون أنفسهم بالشدة والعنف، بلغة طه حسين، فابتعدوا عن النماذج الأدبية الجاهزة وخلقوا نماذجهم الجديدة. استأنس غسان كنفاني في رواياته، التي واجهت عار الخروج بكرامة القتال، بوليم فوكنر وبريشت ومكسيم جوركي، وأعاد صوغ أعمالهم بشكل جديد، واعتمد جبرا على ثقافته الإنجليزية الواسعة المركبة، واستلهم حبيبي التراث لغة وتاريخًا، وصاغ محمود درويش قصيدة الأمل بلغة شبه فريدة، شعرها نثر ونثرها شعر..
واجه الأدباء الفلسطينيون المنفى بالأمل والعمل وخلقوا لأعمالهم جمهورًا واسعًا، فلسطينيًّا وعربيًّا معًا. ومع أن "المقاومة الفلسطينية"، أو مرحلة الكفاح المسلح بلغة أخرى، لم تنتج أدبًا يحتضن ثقافة جبرا وقلق غسان وفضول إميل حبيبي، مزيلة الحدود بين الأدب والتبشير الإعلاني، فقد خلقت فضاء ثقافيًّا، وأسهمت في توليد جمهور أدبي احترافي، إن صح القول، اعتمادًا على وعي سياسي يحاصر الأمية اللغوية والأدبية معًا. كان الفلسطينيون، آنذاك، منصرفين إلى أحلام مزهرة، وإلى تكريس الأمل، الذي يحتاجه هؤلاء الذين خدعهم الطريق..
ترجمت أحلام الفلسطينيين، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، التي شهدت أدبًا فلسطينيًّا كبيرًا، العلاقة الشهيرة بين الأدبي والسياسي، بالمعنى الإيجابي، ذلك أن السياسة كانت ولا تزال مرجعًا للأدب، في الحالة الفلسطينية على الأقل. فوجود الفضاء السياسي، بالمعنى النبيل، هو وجود المتعدد والحواري والمحتمل وتأمل البديل. والمتعدد هو صوغ معنى فلسطين شعرًا ورواية ومسرحية ورسمًا، والحواري هو تعدد الأصوات الشعرية، والمحتمل هو ما يقول به جبرا في نهايات رواياته، والبديل هو الذي عالجه غسان بأكثر من شكل وأشار إلى أفق،... بيد أن هذا لم يكن ممكنًا من دون قلق ثقافي، يؤكد أن للفلسطيني حقًّا في الوجود والانتصار، ومن دون يقين يصقله العمل وتعيد خلقه المساءلة والاختبار على مقربة شديدة من حديقة الأمل المكسوّة بألوان الفردوس.
الخيبة والوطن
تشكّل الأفكار السابقة مقدمة لسؤال الاستهلال: لماذا الأدب الفلسطيني لم يعد كما كان؟ ربما هي الخيبة، التي برهنت للفلسطينيين أن ما يتلو المنفى ليس هو الوطن تمامًا، وأن ما يعقب اليقين هو ضياع اليقين، وأن الأحلام المزهرة تستقر في لامكان. والواضح بلغة أخرى أكثر تماسكًا وأقل تأسيًّا قائم في عنصرين أساسيين: غياب السياسة، بعد أن اختصر زمن الفلسطينيين السياسي إلى "جماعة" لا تحتاج إلى سياسة ولا مكان فيها للأفراد، ذلك أن الأفراد هم "المؤمنون"، وإلى إدارة لها شكل السلطة، تعتنق الجمود والعادات، إذ كل مسؤول يستأنف ممارسات سابقيه، دون أن يسائل ذاته أو أن يحاور غيره.
أما العنصر الثاني فيتمثل في غياب الجمهور "القارئ الموسع" المحمول على الفضول والإيمان بالمستقبل، فلا أدب بلا جمهور يُقبل عليه، ولا جمهور للأدب إلا في فضاء سياسي قوامه الحوار.
ولكن كيف يستمر الأدب الفلسطيني اليوم؟
يستمر بما كان، وبما تشكّل أيام المنفى المزهر، فلم يبدأ زكريا محمد ويحيى يخلف وأحمد دحبور ومحمود شقير ومجايلوهم الكتابة مع "اتفاقية أوسلو"، بل كانوا هناك متوقعين اتفاقية أكثر عدلاً. إنها استمرارية "البنية التحتية"، كما يقال، ولو إلى حين. ويستمر أيضا بمنطق الحياة، أو منطق المركز والهامش، إذ المركز الفارغ لا يزال يبحث عمّا يملؤه، وإذ للهامش أسماء تحاول الوقوف مثل عدنية شبلي وأكرم مسلم صاحب "العقرب الذي يتصبّب عرقًا"، وأسماء مجتهدة قليلة أخرى تنشر دار الآداب في بيروت بعضًا من نتاجها.
غير أن هذا الاستمرار، في شكليه، لا يسمح إلا بمقارنة مؤسية بين ما كانه الأدب الفلسطيني وما صار إليه، ذلك أن الاستمرارية لا يراهن عليها، فالأدباء يشيخون ويموتون، مثلما أن العلاقة بين المركز والهامش خاضعة للاحتمال، فقد يظل الهامش على ما هو عليه، في انتظار جمهور قارئ جديد لا ينفصل، في الحالة الفلسطينية، عن بديل وطني جديد.
كيف يغيّر الأدب الفلسطيني أحواله؟ لا جواب. قد يكون في سياسة ثقافية يقترحها مثقفون جاؤوا بعد "اتفاقية السلام"، وقد يكون في "طليعة ما" تجمع بين الثقافة والسياسة، آمن بها غسان في مطلع دراسته عن "الأدب الصهيوني"، وقد يكون في الانسحاب من اللحظة الموجعة الخائبة والانفتاح على فلسطين، كما كانت في تاريخها البعيد، وكما ستكون بعد الإدارة السلطوية الشغوفة بالعادات.