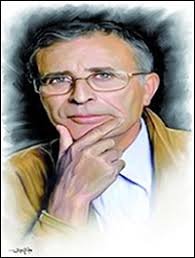طلائع الفن العربي المعاصر
يتطلب هذا العنوان العام والتركيبي بعض الإيضاحات؛ ذلك أن المعاصرة، باعتبارها حاضرا خاضعا للتأجيل المستمر، هي تعايش بين أنماط عديدة من الحضارات، تمتلك كل واحدة منها ماضيا تليدا متفاوتا في القدم والتبجيل، متميزا بقوة الابتكار والحفاظ على تراثه.
إن ما نقوم به عادة من تمييز بين الفن "الحديث" والفن "المعاصر" يظل مثار غموض. فأين يبدأ الفن الحديث؟ هل يبدأ مع الانطباعية؟ أم مع التجريدية؟ وأي تجريدية نعني؟ يقال بأن الفن المعاصر قد انبثق في الخمسينيات بعد حرب بالغة الضراوة، باعتباره بالتأكيد نظرة جديدة على عالم منهار ويعاني من التقلبات.
إن هذا التقطيع التاريخي أمر لا يقبل النكران؛ بيد أنه بتمركزه حول التجربة الأوروبية والأمريكية الشمالية، لا يقدم نظرة مكتملة عن ابتكار الحداثة والمستقبل في دوائر حضارية أخرى. إن هذا يعني بأننا نسعى إلى التفكير في الزمن والفضاء في أبعادهما المتعددة المركز، أي في تاريخهما وجغرافيتهما وفنهما متداخلةً ومجتمعةً. فبعد أن تكون الخصائص الكبرى لحضارة معينة قد مُنحت قيمتها الحقة، آنذاك يمكننا مقارنتها بحضارات أخرى، وإبراز القيمة المتبادلة للحضارات الفاعلة في مسألة الفن، وتماثلاتها وأصالتها، وحوارها أيضا. فالمقارنة تأتي بالتمييز. تلك هي مقاربتنا في هذا البحث.
حين استعلن الفن العربي الإسلامي في الحداثة كان قد اكتسب، من زمن، مهارات وموروثا غدت كلاسيكية. وإذا كان لنا أن نحدد الخصائص المميزة لهذا الفن الكلاسيكي، فإننا سنجد أنه موسوم بالمزيّات التالية: استقلال اللون، وصفاء الأشكال، وهندسة "مطلقة" (حسب عبارة مفعمة بالإعجاب للوكوربيزييه)، وقوة الزّخرفي سواء في العمارة أو التوريق أو الزِّواقة، أو المنمنمات والخط والفنون والحرف الاستعمالية بتنوع موادها، من حجر و معادن ونحاس وجلد وورق وحرير... الخ. إنها فضاءات عديدة للنظر والمعاينة، يعاد نسخها من قرن لآخر تبعا لصيغ تتميز بهذا القدر أو ذاك من الثبات والتغير. ومن ثمة، فهي وفرة من العلامة والتآليف لا ينقصها الجمال ولا تخلو من قوة غامضة محيرة.
هكذا بدأت أوروبا تكتشف تدريجيا هذا التراث الكلاسيكي العربي الإسلامي. ونحن لا ننسى هنا المعرض العالمي بفيينا (1873) الذي كان مسرحا لاكتشاف حضارة مغايرة. من ثم أيضا ينبع سحر الفنانين الذي رحلوا نحو شرقهم، "كإميل غراسي (إلى مصر سنة 1869)، وكلود رونوار* (إلى الجزائر سنتي 1879 و 1882)، وفاسيلي كاندانسكي* (إلى تونس بين 1904 و 1905 وإلى مصر وسوريا وتركيا سنة 1931)، وموريس دوني (إلى الجزائر وتونس والشرق الأوسط في ما بين 1907 و 1910)، وألبير ماركي (الذي قام بزيارات عديدة للمغرب والجزائر بين 1911 و 1945)، وبول سينياك (إلى تركيا سنة 1907)، وهنري ماتيس* (الذي زار المغرب لعدة مرات منذ 1912)، وبول كلي* (إلى تونس عام 1914، ومصر عام 1928)، وأوجست ماك (مع بول كلي إلى تونس)، ودايرك ووترز (إلى المغرب في 1913)، وراوول دوفي* (إلى المغرب سنة 1925) وأوسكار كوكوشكا (إلى تونس والجزائر ومصر والشرق الأوسط بين 1928 و 1930)، وعدة فنانين آخرين مثل ه. بايير، ومارك شاجال*، ودو ستيل، الخ، حتى فناني الأجيال الحالية. وبلوحة "نساء الجزائر العاصمة حسب دولاكروا*" (مجموعة بيكاسو*)، كان بيكاسو يحتفي سنة 1955 بقرن كامل من الاستشراق في مجال التشكيل" (1).
تبعا لذلك، يظل الفن العربي الكلاسيكي، بشكل مّا، يخترق حداثتنا. فقيمة الفن ذي الأشكال الثابتة، الذي يخضع للرغبة في الخلود، لم تكفَّ عن بصم نظرة التشكيليين وذاكرتهم البصرية، كما لو تعلق الأمر بسفينة ثيزي Thésée التي يتم تغيير بعض عناصرها خلال الرحلة. وهذه التقنية المتمثلة في تغيير المنظور هي المبدأ الثاني لمنهجنا.
لهذا تشكل المعاصرة في ذاتها شبكة مكونة من عدة هويات تشكيلية. إنها نسيج من الصور والعلامات. لنأخذ مثلا "التجريدية" التي يتسم بها الفن العربي الإسلامي، والذي رسمنا ملامحه الأساسية. إن هذه التجريدية نابعة من حضارة للعلامة، حيث ظل الكتاب، بخطه وقوته الزخرفية، المعبد الكتابي الذي يمنح لكل معاينة visualisation أخرى معناها الفعلي؛ وهي بأشكالها الخالصة والهندسية، ليس لها نفس التاريخ ولا نفس التأليف الجمالي الذي يتميز به الفن التجريدي الغربي. فالنظر إلى العالم "بعيون" الكتاب والتوريق، يفترض فكرا متوحدا مع تلك الرغبة في الخلود. وقد أسرّ لنا بول فاليري، هو الذي تأمل في الحضارات وموتها، بما يلي عن الفن العربي الإسلامي: "إن المخيلة الاستنباطية الأكثر تحررا، والتي واءمت بشكل باهر بين الصرامة الجبرية ومبادئ الإسلام التي تحرم دينيا كل بحث عن محاكاة الكائنات في النظام التشكيلي، هي التي ابتكرت التوريق. وأنا أحب هذا التحريم. فهو يجرد الفن من عبادة الأصنام، ومن الخيالات الزائفة والحكي والاعتقاد الساذج ومحاكاة الطبيعة والحياة، أي من كل ما ليس خالصا ومن كل ما لا يكون خصبا بذاته، بحيث إنه يطور مصادره الباطنية، ويكتشف بذاته حدوده الخاصة، ساعيا إلى بناء نسق من الأشكال يكون مستنبطا فقط من الضرورة والحرية الواقعيين التي يقوم بإعمالهما"(2).
إن هذه الحضارة هي حضارة العلامة التي تغدو صورة، بينما الحضارة الأوروبية، منذ الإغريق، منحت الاستقلال للصورة في علاقتها بالعلامة وسلطتها، بالشكل نفسه الذي تحقق به ذلك قبلها في مصر الفرعونية، خاصة في مضمار النحت. إنه الاختلاف الحضاري الذي يحمل في طياته الإمكانات الإبداعية الخلاقة، كما يمكنه أن يغدو مجالا لاضطرابات الهوية إذا نحن انتقلنا من هذه التراث لذاك. ربما لم يكن الرجوع المنتظم للفن الإسلامي القديم من قِبل التشكيليين العرب (بل أيضا من قِبل فنانين عديدين غير عرب) كعنصر ومقطع من أعمالهم، فقط تعبيرا عن الحنين الانطوائي وتقديسا للرُّقع والأطلال؛ ربما كان ذلك الرجوع يخفي السر التشكيلي لكل حضارة تستمر، في موروثها البصري، في الحجب الدائم للحياة والموت بفن الأوهام. لكن ربما كان على الفنان أيضا أن يروّض الماضي وهو يبتكر المستقبل حتى يتجرد العمل الفني وينفلت من الزمن، وحتى يتسامى في سباته المغناطيسي عبر تلك الاستعادة الدائمة للزمن، التي تدعو إلى العمل والمحبة والمعاناة .إن كل فنان جدير بهذا الاسم، منذور إلى الوحدة والصمت والنظرة الجريحة.
بيد أن هذه العودة إلى التوريق والخط والعمارة والفسيفساء والفتنة العدنية للزربية يظل مصحوبا باكتشاف الفن الغربي وتجريديته. وهي عودة لا تمثل في حد ذاتها أمرا مستحسنا أو مستهجنا، وإنما هي وعد ورهان على تحويل الماضي وقواه الباطنية.
ثمة فنانون عرب آخرون تبنوا بشكل قاطع الفن الغربي من حيث هو كذلك، بتشخيصيته وتجريديته،، من غير اهتمام بالرهان الخفي للأصل والذاكرة الذي تفترضه استمرارية الحضارة في الزمن. فقد اكتسبوا المهارة والتقنية وقضايا التوقيع والسوق ورهان المعارض الدولية، وهي لعبة مرايا يجرب فيها كل فنان عربي حظه ويبيع أعماله. إنه يشارك في الحضارة العولمية لتفاعل العلامات intersigne، باعتبارها حضارة تقترح فيها الصورة والعلامة والتقنوعلوم مختبرا جديدا يتجاور ويتنافس فيها اللامادي مع حب الفنان التقديسي للمادة و للمواد والحوامل التقليدية .
إن ما يميز الفن الكلاسيكي العربي الإسلامي في هندسة البيوت والقصور والجوامع هو صفاء الأشكال وعراء الجدران التي تزينها زخرفة خفيفة . وفي الخط، يتبدى ذلك في الصفحة التي نجد فيها كتابة من درجة ثانية تمنح للنص تموجات بين فن الخط واللون والإنشاد الصامت الذي ينبثق من الورقة ومن الفضاء بكامله، كما لو كنا نقرأ من خلال ملفوظ النص حوارا بين صوت منحن هو صوت القارىء، ونظرة مترنمة، أو أيضا في المنمنمة، الإيهام المسطح حيث تغدو الشخصيات الموجّهة في فضاء من غير منظور، العلامات المتحركة والمتحولة للمادة نفسها، من ورق وحرير ومداد وألوان... وإذا كان ثمة العديد من الفنانين المفتونين بالخط الصيني الياباني والعربي، فذلك لأنه يغني مخيلتنا الفضائية، مجبرا خطية الكتابة على أن تصير أكثر حركية وأكثر انطلاقا. وقد أصاب كلود ليفي ستراوس بقوله بأن الموسيقى والخط يمتلكان خاصية تجريدية رائعة للفضاء/الزمن.
ويتمثل ما تمنحنا إياه هذه الفنون ذات الأشكال القارة أيضا في أوزان الشعر العربي، الذي ما فتئ نبره الغنائي يلهم الشعر الغنائي المتوسطي والأوروبي بدءا من الشعر العذري، وفي الترادف بين الكلمات المنشَدة والآلات الموسيقية الأولى المجلوبة من المشرق الخاضع لقاعدة القافية، باعتبار أن ذلك قد شكّل كشفا كبيرا بالنسبة للشعر الأوروبي في الفرون الوسطى.
ويعتبر التوريق طريقا آخر للتجريدية، أو بالأدق، لترجمة العلامة إلى صورة. فهنا، لسنا أمام وهم الطبيعة والجسم الإنساني الذي تمنحنا إياه المحاكاة، وإنما أمام الهندسي المتداخل مع العناصر النباتية والحيوانية. إنها هندسية مرتبطة بالترقيم الجبري الذي استخلصت منه، منذ القرن السابع، نقط وإعجام حروف الهجاء العربية، التي بني الخط فيها على ثلاث مبادئ بسيطة: الخط الأفقي للصوائت والصوامت والحركات الإعرابية. وانطلاقا من هذه القواعد، أصبح بإمكان يد الخطاط بلورة وارتجال لوحة علاماته، مثله في ذلك مثل الشاعر في علاقته بالوزن. ويستحضر الفنان الفلسطيني كمال بلاطة (المزداد سنة 1942) هذا الأمر حين يحلل العلاقة الخفية بين بلاغة اللغة العربية والتوريق، أي تصنيف الألفاظ حسب ثنائية الجذر وثلاثيته لدى النحاة، وتحويلها بالقلب والنقص والإضافة واستبدال الحروف، أي كل هذا التشجير للجسم اللساني الذي عليه ينبني التوريق. فما نسميه مثلا ومجازا توريق ماتيس لا أصل له في اللغة وتقسيمها إلى علامات مكتوبة، وإنما أساسه في فن الخط واللون، والانزلاق الدقيق بين مستويات التأليف.
وسوف يُدخِل الفن الحديث والمعاصر، سواء من صلب هذه الحضارة أو خارجها، معطيات جديدة إلى صلب هذه المكتسبات العتيدة التي لا نقوم هنا سوى برسم بعض منظوماتها الأساس. هل يوجد لدينا فعلا مجموعة متآلفة من الفنانين؟ فالعربي، في نظرنا هو ذلك الذي يقدم نفسه على أنه كذلك، هناك حيث يوجد، في مرسمه وفي طرف ما من أطراف المعمور، مهما كان أصله الجغرافي والديني والعرقي، ومهما كان بلده وأعماله نفسها. فهو باعتباره وريثا لموروث هائل وتراث يحظى بالقداسة، جاهليا وتوحيديا، يتساءل بقلق عن نسيج أصوله العربية والبربرية والإسلامية واليهودية والقبطية والفرعونية والآشورية والسومرية والكلدانية... الخ، باعتبارها صفات حضارية متنوعة طبعت هذه المنطقة بهذا القدر أو ذاك من القوة والاستمرار. بإمكاننا إذن أن نكتفي فقط بصفة "عربي" كما بإمكاننا أن نركب هوية اسمية أكثر تمفصلا: عربي بربري، عربي إسلامي، عربي يهودي، عربي مسيحي، عربي قبطي، وهكذا دواليك تبعا لقاموس غير مكتمل وشامل يعود بنا لتاريخ الفن الطويل الذي يهمنا هنا. وإذا ما نحن أضفنا الفنانين الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية فإننا سنقيم مدونة أكمل وأكثر معاصرة. فهذا الذي يعيش في برلين، وذاك في باريس والآخر في نيويورك... كلهم ينتمون بذلك إلى المجموعة الدولية للفنانين.
فالعربي هو ذلك الذي يقدم نفسه من حيث هو كذلك. وليس لدينا من معيار آخر غير الانتماء الموسوم والمعلن لهذه الحضارة التعددية، وطبعا للعمل الفني الذي هو مصير الفنان. كثيرون هم الفنانون الذين يسبغون على أنفسهم هذه الصفة. وبدل أن نعرض مقدمتنا للفن العربي المعاصر بلدا بلدا، تبعا للتوالي الزمني أو توالي الأسماء (لكن أين نقف آنذاك؟)، اخترنا جزافا منهجية متحركة، منصاعين لإيقاع فكري معين قادر على الإمساك بمواطن قوة الفن العربي المعاصر. لقد كتب بول فاليري عن كاميي كورو: "علينا دوما الاعتذار عن الحديث عن التشكيل". ما الذي سنقوله نحن، الذين علينا صياغة مقدمة لأعمال آلاف التشكيليين؟ فليعذر لنا الفنانون الذين سهونا عن ذكرهم منهجيتنا هذه، ومعها ربما ما قد ينقصنا من إمكانات توثيقية.
من الاستشراق الى الاستغراب
حين زار دولاكروا* المغرب سنة 1832، كان يُعتَبر في ذلك العصر مبتكر الحداثة. إنها حداثة مؤرخة، فقد شدّ اهتمامه لوقت طويل نور البلاد ومشاهد الحياة اليومية والعمارة والأشياء، ولم يفتأ يحلم بها حتى نهاية حياته. بيد أنه لم يهتم بحضارة البلاد المحلية ولا بمنظومات فنها. فما كان يلتقط، حين كان يشتغل على مذكرات سفره المرسومة، هي لعبة الأنوار والخطوط والأشكال الملائمة آنئذ للمشهدية الشاسعة التي سوف يبلورها في لوحاته الخالدة، بأسلوبه الجامح المنتزع من عنف الخارج. كان هوسه يتمثل في استنبات جوهر هذا العالم الغريب ومعطاه المباشر، بنوره وشخصياته ومواقعه ومشاهده، وتكييفها مع أجواء عمله الفني المتجدد. ولم يكن ذلك همّا من هموم بول كلي* وهنري ماتيس*، على سبيل المثال.
فما كان يثير اهتمام هذين الأخيرين هي الملامح الفنية لحضارة العلامة هذه، واستقلال اللون وقوة الزخرفة والخطاطات المعمارية والحيطان واستعمال المواد، والبعد الثنائي والتوازن بين التوازي واللاتوازي أو بين المنظورات المتعددة التي تنسج الفضاء، وهي عناصر سوف يجربان فاعليتها بدورهما ويمتلكانها ليدمجاها في أعمالهما. هكذا سوف يتم التفكير في التوريق ضمن سجل واحد هو الخط trait ، "فالتوريق، كما يقول برنار نويل، هو خط الحوافي. فهو يظهر لنا الشكل ليتركه مع ذلك فارغا. لكن هذا الفراغ يقترح بالمقابل الامتلاء".
إن أعجوبة التوريق تكمن في نهلها من خزان لا ينضب من الأشكال الهندسية والمتاهية. وإذا كان ذلك أكيدا فإنهما قد اعتبرا مع ذلك، وهو ما كتباه، تأليفا جديدا بين اللون والعلامة والمادة. فالجديد كان هو الآخر، والحضارات الأخرى، ونسق أشكالها، أي الفنون الصينية واليابانية والإسلامية والإفريقية.
والتنقيطية والتلطيخية التجريدية أو المنحى الهندسي في الفن كلها قائمة تشهد على هذا التقاطع الحضاري عبر الفن. وهو تقاطع من الخصوبة بحيث يبرهن لوحده على الحوار السري، لكن المرئي، بين المنتوجات الثقافية للإنسان. ففنان كغوستاف كليمت*، الذي تمارس عليه الوضعيات الشبقية للجسد والاستبدال المتوالي لزينته بقوة الزخرفي الأنثوي جاذبية خاصة، أو حركة النموذج والزخرفة التي تمتاز بها أعمال كوهنر وآخرين، سوف لن تنسى الممكنات التي لم يتم استكشافها بعد في تنويع المظاهر التي تحركها هذه القوى الزخرفية. فنحن نأخذ محمل الجد نسق الأشكال الزخرفية ومرصّعاته وسحره.
ما الذي كان يحدث في الجانب الآخر من المشهد بين الشرق والغرب؟ يقدم لنا جون كارزويل، أحد المختصين في هذا المضمار، معلومات قـيِّمة عن ظهور التشكيل الصباغي في المشرق، وذلك بفضل تجار الحرير الفارسيين. ويبدو أننا مَدينون لهم باستخدامهم لفنان هولندي لزخرفة بعض الكنائس بأصفهان في القرن السابع عشر(3). ومن ثم ينبع اهتمام الشاه عباس والسلطان العثماني محمد الثاني بالفن الأوروبي. بل أكثر من ذلك، أقام بلّيني0 في إسطنبول ورسم بها الصورة المشهورة لذاك السلطان. كانت تلك مرحلة مبادلات مكثفة بين الغرب والمشرق عرفت استيراد وتصدير التحف والأشياء الثمينة. وحسب الرحالة تونوفور، فقد "تم اكتشاف كل التحف الشرقية في الغرب، وغدت التحف الغربية عناصر زخرفية وتزيينية جديدة في المشرق". هكذا تم اكتشاف التشكيل في المشرق بفضل العثمانيين والأقلية الأرمينية المهاجرة في بلاد فارس. وقد ظل هذا التشكيل لمدة طويلة مكوّنا تزيينيا في البيوت والقصور الفخمة، مؤثرا بذلك على فن المنمنمات الشرقية قبل أن يصبح حرفة وفنا قائما بذاته، يتم تعليمه في المدارس المخصصة لذلك، كمدرسة الفنون الجميلة التي أسست بمصر سنة 1908.
وقد كان لهذه المبادلات في مجال التحف التزيينية نتيجتان أثرتا في المشرق: تطور التشكيل الأيقوني والتمثيلي (من صور شخصية ومناظر طبيعية) في الكنائس المحلية والبيوت والقصور البورجوازية آنذاك من جهة، والتأثير الواضح للتشكيل والفوتوغرافيا على المنمنمة العثمانية والفارسية. ويكفينا هنا ذكر اسمين: داوود قرم وخليل صليبا اللذين كانا رسامي بورتريهات أكاديمية ممتازين.
وهنا يكمن الاختلاف في التطور. ففي الحين الذي كان فيه الفن الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يبتكر حداثته، كان الشرق يدخل، عبر لعبة مرايا دائمة ومِدْواخة، في التشخيص ويعود باستمرار للتجريد. كان ذلك تجريدا مضطربا يندرج بين حضارة الصورة وحضارة العلامة. يجسد هذه المرحلة بعض الفنانين من أمثال النحات المصري الرائد محمود مختار (1891-1934)، ومحمود سعيد ومحمد ناجي المصريين أيضا، وكذا رسامو المنمنمات الجدد كالجزائري محمد راسم، والتونسي يحيى تركي، والفنانان العراقيان جواد سليم وفائق حسن، أو السوري إسماعيل عضام.
وفي 1938، شكل الشاعر جورج حنين والتشكيليون رمسيس يونان وفؤاد كامل وكامل التلمساني محموعة "الفن والحرية". وقد دخلت هذه المجموعة في تجربة سوريالية ذات أبعاد فنية وسياسية. وهو ما سنعود إليه لاحقا.
تحولات
لقد مثلت المنمنمة والأيقونة وتصويريتهما، والتشكيل على المسند chevalet والنحت ذو الطابع الأكاديمي ضربا من التصوير المزدوج bi-pictura الذي يأخذ لدى رسام المنمنمات الجزائري محمد راسم مثلا، وبفعل تدخل المسند، طابع تصوير مزدوج تتحاور فيه الحضارات. إنه حوار زخرفي تقوم فيه كل حضارة بحجب أو إعادة حجب الأخرى عبر فنانين من هنا وهناك، كل واحدة حسب نظام قيمها ومعتقداتها. بل هو حوار مرح في فراديسه الضائعة. فلماذا نحرم أنفسنا منه؟ لنقم، على سبيل التمثيل، بزيارة لأعمال محمد راسم.
إن هذه الأعمال عبارة عن احتفال مشتعل تترجمها حدة الألوان. إنها مشتعلة وأحيانا جموحة ومتنافرة وكئيبة؛ لكن ثمة يكمن سحرها، حيث يكون الأحمر والبرتقالي، باعتبارهما لوني النار، في أصل تركيبة من النبرات تدين بالكثير للمنمنمة التي درسها راسم على يد أبيه. فما يضيفه راسم في هذه التصاوير التي تشبه النذور الإسلامية، وهذه المشاهد الخرافية (انظر مثلا لوحة أسطول باربروس الشهيرة بالغواش على الورق)، وخاصة مشاهد الأزقة والمدينة، يتمثل في أنه يولّد من المنظور الخطي منظورا أكثر جوية، مما يمنح للمتفرج وهْم التجول من سطح منزل إلى آخر، مثلما نتجول في المدينة ونحن "نستمدن بها"**. هكذا يستبدل النظر سجله وطابقه، ويصعد أو ينزل بين القبب والصوامع والسطوح والباحات. ففي لوحة ليالي رمضان، يبدو أن إعلان الإفطار يحرر الحكي لدى راسم بشهيته في الألوان والشهوات البصرية.
ربما كان مجهود إنتاج العجائبي exotique الراقي قد أصيب اليوم بالعقم، بعد الحداد غير المكتمل الذي تمَّ إزاء فن المنمنمات العظيم الذي كان الواسطي (القرن 13 م) نموذجه الأكبر. أليست هذه السعادة الغامرة التي تنبعث من فن المنمنمات المتأخرة، والتي تبدو قيمتها مغالية، في
** يشتق المؤلف هنا من كلمة "médina" فعل " médiner " (م).
صلب قوة الزخرفة التي لا نستطيع القياس الكامل لدقائقها التشكيلية. إن لوحة الحرب البحرية لراسم لا تخلو من الجاذبية والعنف والمهارة التعبيرية التي وسمت ترصيع غوستاف كليمت* للجسد الأنثوي. فلدى الفنان المسلم محمد راسم تبدو المرأة منمنمة بشكل كامل ومزخرفة في زينتها. وبين هذا الفنان وذاك، من الجسد العاري المشخص والمتحول في أعمال فنان مدينة فيينّا إلى حجبه المحتشم في المنمنمة، تتبدى لعبة وضعية صورة المرأة في ملتقى الحضارات ونُظم أشكالها. وعلينا ألا ننسى أن المنمنمة الصينية والهندية والفارسية في العصور الكلاسيكية تحتوي على كنز من المشاهد الشبقية إن لم نقل أحيانا الماجنة (البرنوغرافية). فالمرأة نفسها يتم تناولها باعتبارها بهجة تشكيلية، يتماهى فيها الفن والرغبة في صراع شهواني تقوم فيه الوصيفات والغلمان والخصيان باللهو والمرح. فملامسة البصر لهذا الكنز من المنمنمات الذي يوجد بحوزة جـمّاعي الفنون، يمنح وقعا عاطفيا للعلامات والأشكال التي تجعلنا نحيا الفن الشبقي الماضي.
من جهة أخرى، فالأيقونة –سواء في الكنائس الشرقية أو خارجها- تعتبر صورة ورمزا وأمثولة allégorie وحكاية مناقب، أي عالما قائما بذاته منذورا للتأمل والصلاة، في صمتٍ تكون فيه الصورة جنب الإله وقديسيه.
وبعد أن كان الفنان السوري إلياس زيات (المولود سنة 1935) مُرمِّـما للأيقونات القديمة فهو، على غرار الفنانين المتخصصين في الأيقونة، قد تطورنحو اتجاه أيقوني جديد ذي طابع علماني وعربي منفتح على مكتسبات التجريد الأوروبي، محافظا على ما تتميز به الأيقونة من ثبات عمودي. ففي الأطفال والعصافير والمدينة (1971)، قام الفنان ببناء ثلاثية داخلية حيث كل عنصر مستقل يمثل مشهدا بكامله. ومن الأكيد أن هذا المنزع الأيقوني الجديد، في مواجهته للفن العالمي الحديث، قد ساعده في جمع شتات موروث الأجداد في داخله. وهكذا، فالأجداد لم يندثروا، بل ظلت آثارهم ماثلة حية وذاكرتهم تعيش بين الناس. ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على السينوغرافية المتكررة من قرن لآخر للثقافة الشعبية وإنتاجها للعلامات. وقد ظل الفنان العربي موسوما في عمقه بها، فهي تشكل حظه الفني ورهانه أمام إكراهات الماضي وتراثه الحي والمتواتر.
ويقوم الفنان السوري فاتح المدرس (المولود سنة 1922) بالتعامل مع هذه الأيقونة التي غدت دنيوية ونَظْما خالصا من الألوان، بتقسيمها إلى رقعة مربعات منسقة يذكرنا أسعد عرابي ببعدها الرمزي الجوهري: "تنبني الشخصية بين ملامح شبح مشخَّص ورسم علامة فتيشية تكاد تكون هندسية، وتشبه وجها غريبا تقع ملامحه بين البيولوجي والعقلاني، منحدرا من الثنائية الشهيرة للمربع والدائرة. تخط الدائرة الوجه الإنساني واستدارة القمر والشمس، وترسم في الآن نفسه الهلال الليلي وقرني ثور مقدس. أما المربع فيرمز بالمقابل للمذبح والمعبد والأرض والفضاء الافتراضي داخل الإطار. وعبر تراكب المربع والدائرة يتشذر الفضاء إلى حدود لانهائيةِ السّديم. وهنا تضيع البنية الإيقاعية في اللاتحدد والعرضي الزائل. وهنا أيضا يغدو التجريد معبرا ضروريا"(4).
لنتوقف عند هذا العمل الذي نستحضره على سبيل المثال. إنه عمل فنان متعدد الاهتمامات، باعتباره تشكيليا وكاتبا وموسيقيا. وفاتح المدرس يتحدث عن نفسه بوصفه حاسوبا شخصيا ومختبرا تتم فيه معالجة عواطف الفنان الأساسية من خلال منظومة نحوية من العلامات والمفاتيح السحرية. ويبدو أن المدينة الآرامية "معلولة" القابعة بين الجبال قد أغنت في ذاكرته البصرية نظرته ،ومن ثمَّ تصوره لتشكيل معمار تلك المدينة وتراتبيتها الكهنوتية المعلقة بين السماء والأرض.
إن شخصياته في الغالب منعزلة، وأحيانا مُدْمَجة في ما يشبه الخمّ ومحنطة، فيما تبدو شخصيات أخرى محيَّدة شيئا ما عن محورها، كما لو كانت تريد بحركتها أن تزعزع العمودية التجابهية عن مكانها وتتحرر في ذاكرتها العتيقة رموزا تمثلها الحضارة الآرامية.
يحدث أن لا تعرف المواجهة frontalité الإشباع عبر هذا التأليف المتراتب، وبدل ذلك أن تصبح مشبعة باللون وحده. فالراقص في لوحة الدرويش والغجر (1978)، بالرغم من كثرة ألوانه فهو يحيل على الصورة المظلمة والنظرة الفارغة اللذين يذكّران بسكينة الصوفي الجوال بعد دوخته وطوافه، الذي تتخلله الموسيقى والذكْر. كيف يمكن تمثيل الحب؟ أعني الحب بين الناس وبين الله والبشر؟
يبقى مع ذلك أننا نحلم من خلال هذا العمل، بالولع بالآثار الذي يسكن كل فنان، وبمشهد من الذاكرة حيث علينا تخليص الإنسان من السديم. آنذاك يظهر لدى هذا الفنان المتعدد الموضوعات نفس ساخر في حدّ الخط واللمسة اللونية؛ فيما وراء المنزع الثقافي والإحالة إلى بلده الأصلي و موروثه وحضارته العتيقة.
هذه المجاوزة للمنزع الثقافي، يستكشفها بكثير من السخرية واللطف التعبيري فنان سوري آخر (من مواليد 1934) يعيش في برلين هو مروان. وقد كتبنا عنه لتقديمه للجمهور الباريسي: "ليس ثمة في عمله من حنين برهاني، ولا من إحالات عجائبية. لا شيء غير صرامة التشكيل، سواء كان ذلك في لوحاته التشخيصية التي تعبر فيها الشخصيات، حين تكون حاضرة، عن وحدة قاتلة، أو في تلك السلسلة الملغزة من الدمى أو أيضا في تلك البورتريهات أو البورتريهات الشخصية التي تحكي قصة فنان أمام انعكاسات المرآة على وجهه وعينيه وملامحه"(5).
إنها أعمال مثيرة كانت في أصل الكثير من التعاليق. وقد صنفت أعماله في ثلاث مراحل: المرحلة التشخيصية، التي تلتها مرحلة الرؤوس المشاهد، ثم الدمى. كما تم الربط بين أعماله وأسماء من قبيل إدفار مونش وجورج بازليتز وشوينباك، والتأكيد على تعبيريته الخاصة، فيما أنشد الشاعر أدونيس، من جهته، الوجه وتحولاته في قلب الوجود. لنتوقف لحظة عند تلك المتوالية من الدمى.
يتعلق الأمر بدمية مقطبة ومكشرة تقوم بحركات صامتة، وتبتكر لنفسها الأوضاع والوضعيات. والمتوالية عبارة عن موكب من الكائنات البـُدّية (الفتيشية) التي يتم التعرف عليها الواحد بالعلاقة مع الأخرى، في حكاية تزداد انغلاقا بين الفنان والمسرح التشكيلي الذي يقدم مشهديته. أما البناء الدرامي فيجد مرتعه بين تعابير الوجه واللون، لكن الدراما بين الألوان هي التي تغدو الغالبة، إلى درجة تأخذ معها الدمية شكلها أمام المشهد تارة، أو تنمحي وتغيب في اللوحة أو الحفرية gravure تارة أخرى. أين تختفي إذن؟ أفي ما وراء المشهد حيث يقوم الفنان بتأملاته؟ إنه صمت المرسم من حيث ستنبثق سلسلة من الرؤوس والبورتريهات الشخصية . ثمة سلسلتان إذن، نخالهما زوجا من التشكيليين يتماسكان بالأيدي، أو مرآتين موضوعتين بشكل متواز تتماسّان في يد الفنان.
ربما كان من اللازم أن نوضح بأن هذا التشكيلي "غريب محترف" قام بزحزحة المنزع الثقافي من مكانه. ففي الفن، يتمثل الغريب المحترف في ابتكار عمله الفني باعتباره أرضا وذاكرة محمولة. إن مروان يمارس التشكيل بالشكل نفسه الذي يكتب به العربية، من اليمين إلى اليسار. وهذه الوجهة هي تخطيط الجسد. ومن هذا الموروث الفضائي يحتفظ بإيقاع معين، وذلك بموقعة عمله في الفن المعاصر "العالمي". هل هو يمارس العنف على نفسه؟ نعم، عبر كآبة رقيقة يمكننا تأملها في هذا الوجه/المنظر الذي رسمه سنة 1974، الذي ينقش برشاقة وقلق بالغين قدَر الفنان الذي أصبح علامة ولقاحا ومنظرا وتجاعيد وأشواكا وكآبة، وترابا وحجرا وأخاديد. والوجه في مجمله، في إعادة تجسيده ذاك، يحدق فينا بعمق ممهور بالارتياب.
إن إيثار اليمينية في التشكيل، والكتابة أو الرسم كما هو الأمر في الخط العربي، هو الملمح المميز لحضارة توجه نفسها تبعا لنمطها في إضفاء الطابع الفضائي على إدراك الأشياء والكائنات والزمن. وقد مارست هذه اليمينية التشكيلية جاذبية كبرى على العديد من الفنانين، كالأمريكي برايان جايزن، صديق وليام بورّو*، ذي الاهتمامات الفنية المتعددة، وفنان "الشرق "الممنوع"، الذي أقام بالمغرب من 1950 إلى 1973. فقد اكتشف هذا الأخير فن الخط الذي يمتاز به البلد وموسيقاه الشعبية وجاجوكة جبال الشمال. وبالرقة المضطربة للتخطيط، قام بتأليف ما يشبه الكتابة العربية، كما لو أن لغة الآخر وخياله عن العلامة كانا بالنسبة للفنان عودة للسحر البدئي للغة سابقة على الأمومة.
لقد كانت لعبة اللغة والتشكيل، والوجهة الفضائية وتأليفها في علامات غريبة أو يتم التظاهر بغرابتها، مصدرا لإلهام جان دوغوتيكس في سياق آخر يتعلق بفن الخط الياباني، الذي يدين ببنيته الأساس، كما نعلم، للخط الصيني. هكذا أقام دو غوتيكس ما سماه علامات فوق العلامات، أي لغة عمودية في البدء، ثم أفقية أو مؤلفة تأليفا تزامنيا.وقد اكتشف مجددا في الحركة المسكونة بالكتابة الرمزية idéographie عجائب الإيقاع الذي يحرك هذه الكتابة المشكلة صورا. وليس من قبيل الصدفة أن يكون فنانون من شمال أمريكا قبله، من قبيل جاكسون بولوك* ومارك طوبي* وغيرهما، قد دخلا في تجربة حركية مطلقة باضطراباتها ودوخاتها وإشراقات ألوانها المشدودة إلى قوة الحركة. إنها لحظة وجْد ينبثق فيها كل شيء في حلم يقظة، في إيقاع وارتجال يذكر بحركية موسيقى الجاز، خاصة وأن الجسد يقوي من دوره كوسيط بين الفنون.
اولوية العلامة
يقول بعض العارفين بأن ثمة ثلاثة نماذج كبرى للحضارات: حضارات الصورة (الحضارة الأوروبية وامتداداتها في أمريكا الشمالية والجنوبية)، وحضارات العلامة (الحضارة الهندية والصينية، والإسلامية التي تُقيم قوتُها الرمزية في القرآن باعتباره معبد الكتاب)، وحضارات الإيقاع، كالحضارة الإفريقية التي تتمتع بأسطوريات وتصورات عن أصل العالم رائعة لا تخلو من عبقرية تشكيلية، وهو ما ألهم فنانين مبدعين كبيكاسو وجياكوميتي*(6).
هذا التصنيف إذا كان يبسط الأمور، فله مع ذلك فضل إبراز بعض الاختلافات الحضارية. ولنأخذ فن الخط العربي. فالعلامة تحيل أولا على فن التخطيط الحروفي، وهو فن من العتاقة بحيث يضمن الديمومة والاستمرار الحضاري للكتاب.
ومع ذلك كثيرا ما نتناسى، حتى في عالم التشكيليين والرسامين، بأن فن الخط العربي مهارة تقنية متطورة جدا. فهو يمتلك سُنَنه وأساليبه وتقاليده الكبرى. وهو يكتب على حوامل متعددة، من رقّ وورق وحجر، أي على كل مادة قابلة لأن تحتضن تآليفه. وبما أن الخط كتابة من الدرجة الثانية، فهي تعمد إلى تحويل دلالة النص إلى زينة وزخرفة، مضعفة من مداخل ومخارج القراءة. فهي تمنح الحروف للقراءة معيدة نسج معاني النص وملفوظه. إن التوزيع الذي تقوم به للعلامات يدخل القارئ أو المتفرج في فضاء شعري ليس خطيا البتة، بل يقوم بتعليق مسار القراءة في جدول للعلامات ينمحي فيه التعارض بين الشكل والمحتوى وبين الدال والمدلول. إنه ينتظم لوحا آخر للقراءة، وفضاء غير محدد، منفصما بين الكتابة والحرية الخطية، وبين الخطية والتشكيل، إلى درجة: "يكف معها مسار الخط عن أن يكون هدفا في ذاته. لأنه إيقاع وحجم معا، والحركة الأولى لصورة آتية لا ريب فيها، إن آجلا أو عاجلا، هي العلامة. فمن خلال العلامة ينكشف الإنسان للامنتهى رغبته..."، كما يوضح ذلك فرانسوا شانغ. إنها سطوة رائعة لفن الخط على مستويين: فهو من جهة يقوم بتحويل اللغة إلى فضاء ذي حرية شعرية؛ وهو من جهة ثانية وفي الآن نفسه يقوم بإعادة تأليف الفضاء المجرّد لتحويله إلى أشكال زخرفية.
أما في التشكيل (أو أبداله)، فإن الخط يغير من مشهديته ومن سجلّه البصري. إنه يغدو متعلقا بالتأليف التصويري نفسه. وفي ما يهمنا هنا، فإن المجال شاسع جدا. فإذا نحن رغبنا في التحليل ولو المختزل لمسألة الحرف في الفن العربي المعاصر، فإننا سنتبين فيها سلسلة محدودة وإن قابلة للتوسيع. فقد كتبنا في مكان آخر ما يلي: "يمكننا التمييز في التشكيل الذي يستوحي مادته من اللغة العربية، عدا فن الخط بمعناه الحصري، بين ثلاث مستويات:
· الحرْفية الهندسية، حيث يبدو الفنان، انطلاقا من التشذير التشكيلي للحروف، مسكونا بحلم ترجمة تلاوة القرآن إلى صور. هكذا يغدو ما يشبه الأنشودة (أو الصلاة) مرئيا في الخط والحركة (انظر مثلا جزءا هاما من أعمال الإيراني الزندرودي).
· تجريد الخط المشكل: أي أن الحرف المتناضد على مساحة الألوان يعيد تخطيط اللوحة، ويمنحها من ثمة هويتها الثقافية وسمتها الحضارية المبتكِرة للعلامات (انظر أعمال العراقي شاكر حسن، أو أعمال منير، التشكيلي الحفري البنغلاديشي المقيم بلندن).
· الحرْفية الرمزية، حيث يغدو التشكيل مشهدية مشبعة بالعلامات والكتابات، من حروف عربية وبربرية تيفيناغ، وأرقام سحرية أو طلسمية.كما نجد في أعمال الجزائري رشيد قريشي اهتماما عجيبا بفنون الخط الصينية واليابانية.
· الحرْفية الزخرفية (وهي الأكثر تداولا)، حيث تخضع الكلمة أو الجملة أو النص إلى بناء مقروء يمثل الحرف المخطوط، وذلك استمرارا للتوريق والخط الكوفي بالأخص"(7).
يذكرنا جبرا إبراهيم جبرا كيف يقوم الفنان العراقي شاكر حسن (المولود سنة 1925) بتفتيت الحرف، وكيف يقوم فنانون آخرون بتحويل التمثيل التشخيصي إلى تأليف بين الحروف(8). كما قام التركي أمنتو جرنيزي بإخراج فيلم قصير شخصياته من حروف، وهو عبارة عن قصة حب وتماهٍ مطلق بين الإنسان والعلامة المكتوبة.
لكن الثورة التي قادها الفنان الإيراني الزنده رودي (المولود سنة 1937) ذات أهمية بالغة على مستويات عدة. فقد قام بتجذير رسم وتشكيل الحرف، وتطويعه لضرورات التخطيطية وإيقاعها، وللون ولهندسية إعجامية حركية، ثمة حيث تغدو شكلا خالصا، وتقدم نفسها في أشكال هندسية، وعبارة عن أرقام وخرائطية، وعن رموز وتمائم، بل وفتيشهات وشذرات حلمية، وفي شكل كلمات وحروف مستلهمة من التقليد الكتابي للفن الإسلامي. فالزنده رودي، باعتباره فنانا مسكونا بالتصوف، يعرف جيدا فن الخط قدر معرفته بالفن العالمي المعاصر.
إنها جرأة نادرة حقا؛ ذلك أن فن الخط الاحترافي عادة ما يتم تعويضه بأبدال له. والخط النسخي أو الكوفي ذو الهندسة الجامدة غالبا ما يستعملان كزخرفة مرسلة libre، بالشكل نفسه الذي نتحدث به عن "تشخيص مرسل"، خارج ضرورة المشابهة أو تناظر الأشكال. كما أن إتيل عدنان (المولودة سنة 1925)، وهي شاعرة وتشكيلية عاشقة للكتاب والكتب الجميلة، ترسم أو تمارس التشكيل بكتابة سريعة شخصية يمكننا قراءتها من خلال الشطبات الملونة التي تزخرف النص. وإذا كان النص مقروءا هنا، فذلك ليس هو الحال المعروف لتفتيت الحرف الخطي وملفوظه.
ويذكرنا بلند الحيدري، وهو مصدر معلوماتنا بهذا الصدد، بأن العديد من الفنانين كالعراقيين حسن المسعودي وسعيد الصكار وعثمان واقي الله، قد ظلوا أوفياء لتقاليد فن الخط، بمهاراته وتقنيته الملائمة ومقروئيته، واحترام الأساليب القديمة، بما فيها التأليفات الخطية.
ويعتبر كمال بلاطة في كتاباته النظرية، مستوحيا نماذج الكوفي بهندسته وثباته، بأن ثمة وحدة حميمة وصارمة بين الحرف العربي وشكل الرقم والتوريق. وقد أشرنا سابقا إلى النتائج التي يمكننا استخلاصها في تحليل أشكال الحضارة العربية الإسلامية (9).
بيد أن سياق هذا التقليد العظيم في فن الخط قد تغير. فقد تجرد الحرف من قداسته. وهو الأمر الذي يتجلى واضحا لدى العراقي رافع الناصري (المولود سنة 1940)، بتحويل شكل العلامات وتحويل الصفات الدينية المرتبطة بدلالاتها الأصلية.
هكذا يتعرض الحرف إلى تغييرات متعددة. فإما يتم إعادة تأليفه بعد تفتيته، كما هو الأمر لدى الفنان التونسي نجا مهداوي (من مواليد 1937)، أو أنه يتوالد بحيث يتكرر الحرف نفسه إلى ما لانهاية بغزارة وحيوية نجد أنفسنا معها أمام هوس بالعلامة المكتوبة المليئة حتى الإشباع والفارغة في الآن نفسه، كما هو الحال مع المغربي المهدي قطبي. هذا التضييق والوخز يبثه الجزائري رشيد قريشي (من مواليد 1947) بمحْورته حول وحدة كتابية تذكر بشكل ساطع بالكتابة الرمزية idéographieالصينية. إنها وحدة كتابية محاطة، تبعا للتآليف، بكتابة سريعة تشبه كتابة الفقهاء المغاربيين. وبما أن قريشي متأثر بتقاطع الحضارات الفنية، فإنه يجعلها تتحاور في نسيج من العلامات المكتوبة. إنه انفتاح نحو الآخر، مصحوب بعودة للينابيع المتمثلة في الكتابة البربرية تيفيناغ، التي يربطها أهل الاختصاص بالكتابة الليبية القديمة. فهو خط يجعل التشكيليين والفنانين يحلمون باللغة البربرية الأم. هذه العودة إلى العلامة ما قبل الإسلامية هي معطى من معطيات الذاكرة والنسيان نجده في كل حضارة. فهنالك، لدى المصري آدم حنين (المولود سنة 1929) ولدى آخرين غيره، تشتغل الإحالة إلى الفن الفرعوني والكتابة الهيروغليفية والنحت والعمارة معا. وهنالك في الأبعد، لدى اليمني علي الغداف، ثمة حروف الهجاء الحميرية وذكرى ملكة سبأ، أو أيضا في أعمال الكثير من الفنانين العراقيين، ذلك الحوار المفتوح مع الحضارة الآشورية والبابلية. إنها مسارات تستعيد الزمن، وضربٌ من الحكاية واقتفاء أثر الأصل خاصة وأن الأساطير، باعتبارها إبداعات جماعية، تشكل بالنسبة للفنان نوعا من المذكرة الحلمية.
إنها مذكرة تثرى بفضل الحوار مع حضارات أخرى نائية. ويصرح الفنان المغربي عبد الكبير ربيع (المولود سنة 1944) بأنه قد تعلم، من خلال التأمل في الفن الصيني والياباني، التأليف المتوازن والمستخلص بين الأبيض والأسود، والفراغ والامتلاء الذي يميز التشكيل الإيديوغرافي الرمزي. كما يوضح أن ليس ثمة من علاقة بين التعبير التجريدي قائلا: " حركتي انطلاقة وإيقاع وصلاة لأنها تبصّر، والإحساس بها عميق وامتلاكها كامل مكتمل". إنه أثر ذكرى البوذية الزين على هذا الفنان. فعملية التشكيل وصيرورة المرء موضوعا لعمله التشكيلي عملية واحدة.
ربما علينا أن نضيف أن هذه الاستعادة للزمن، باعتبارها أيضا توسعا حلميا في الفضاء، ذات طابع إشكالي أكيد. بل إن أحد الفنانين التشكيليين قد غامر بإنشاء بنايات معمارية في شكل حروف. لكن، ربما علينا أن نبني في المستقبل مخططا هندسيا لمدينة بكاملها في شكل رقعة ضامة بخط كوفي. وهي ستكون لا محالة مدينة كتابا.
إن فتنة المنزع الثقافي تتبدى هنا، فهي تنجم عن العودة إلى الأصول. لهذا يشتغل هؤلاء الفنانون إما بتفكيك هذا الموروث أو بإعادة تركيبه، لكن على حوامل مغايرة وتبعا لأنماط في التشكيل والرسم والحفر والسيريغرافيا مختلفة. من ثمة ينبع عائق آخر. وهو يتمثل في الشكل الذي يمنح للعمل، والذي يلزم أن يحيل على هذا الموروث ويتجاوزه في الآن نفسه من خلال التجديد المتوافق مع مكتسبات الحضارة العربية الإسلامية من جهة، ومع مبتكرات الفن المعاصر العالمي من جهة ثانية. إن ذلك الشكل يتطلب من هؤلاء الفنانين تجربة جديدة للجدارية muralité والمواجهة والتأليف بين الألوان، ولتدخل العلامات وأشباحها.
عمل الفنان العراقي ضياء العزاوي (من مواليد 1939) على تجاوز هذا العائق بطريقة أشبه بطريقة التكعيبيين، وذلك عبر هندسية يتم ضبطها من خلال إشراق الألوان والمشهدية الحركية: "فالحروف تتجمع في شكل دائري حول فضاء مركزي كعقد من الثعابين المتواشجة بدينامية، في حركة لها طابع الوجد والتشنج"(10).
يتحاور شاكر حسن مع الموروث في فن الخط بقوة الأثر والبصمة، المصحوبة بكتابات متنوعة على لوحة/جدار محزوزة ومرشوشة، تارة بنوع من المواجهة القاسية، وتارة بإدخال المنظور فيها بحيث تضطرب وتنصاع وتشطب. إنه اختبار لنموذجين في التجريدية نلمسهما، ويشكلان توحّدا بين الهوية الثقافية للفنان وخاصية الفن العالمي.
كثيرون هم الفنانون الذين تمارس عليهم العلامة المكتوبة جاذبية كبرى، باعتبارها شاهدا citation زخرفيا يتساكن مع تشخيصية مرسلة، طبيعانية أو ما فوق طبيعية (خرافات شعبية، أساطير، أماثيل allégoriess ...)، أو مع توابع تزيينية كالمقاطع العمرانية والفسيفسائية ورسوم الزرابي...
إن مسألة الاستشهاد القائم بين الحضارات المختلفة وبين أعمالها الفنية مسألة شاسعة. إنه حوار لا متناه، بل هو أيضا أساس كل فن. هكذا يمكننا وضع جنيالوجية للشاهد، وبإمكاننا أيضا وصف مراحله وتتبع الإحالات والتأثيرات والمحاكاة الجزئية. وسنكون قادرين، في التاريخ العالمي للفنون، على تشجيع إقامة مدونة ودائرة معارف مقارنة بين أنماط الشاهد. وفي هذا يكمن أساس علم جديد من اللازم تطويره، أي سيميائيات جامعة intersémiotique بمناهجها وأنظمتها الإحالية. ونحن هنا لا نقوم سوى برسم معالم هذه الفكرة.
وحتى نظل قريبين من الخيال الفعال للفنانين، نرى بأن الحلم التخطيطي المشتغل بين الحرف واللون والمادة، يتضمن تفاعلا بين العلامات المبَنْيَنة لحرية تداعيات الفنان وولعه بالأثر في روحه السحرية. والتخطيطية graphisme هي التي تمسك بالإيقاع المباشر لذاك السحر، وذلك في صيغة مبلورة سلفا. أما تلك التخطيطية فهي ارتجال تحت المراقبة تتبلور بتسلسل إيقاعي، بالشكل الذي تحقق به ذلك في مجال آخر هو المجال المتفرد لموسيقى الجاز.
هكذا يحدث لخطاط الحروف هذا أن يصاحب الكتابة بالألوان فوق ورقة تترنّم مساحتها وتتماوج في القراءة ومعزوفتها المتكونة من علامات مقطوعة عن دلالاتها. آنذاك يتلون نظر القارئ أو المتفرج الذي ينبثق في فورة الألوان هذه وجاذبيتها. وعبر هذه المقاربة يمكننا الإمساك الأفضل بالخطوط المتماوجة خلف اللوحة التي يرسمها فنان حركي بالشكل الذي نعنيه.
وفي فن الخط الفارسي كانت هذه التحولات للعلامات عميقة في إبداعها. فالكتاب شاهد من شواهد التشكيل، وإطاره يتغير في بعده، وحاملُه يتنفس بشكل مغاير من ورقة لأخرى. لقد كان فن الخط الفارسي وراء اضطراب وحيرة معنى القراءة، إذ رمى بها خارجه بطريقة يلزمنا معها لقراءة قصيدة أن نقلب الأوراق في وجهات متعددة. فقد أغنى التخطيط المعاصر الكتاب الدائري بابتكارات التشكيل المعاصر. هكذا تملأ يد مليحة أفنان (وهي فنانة لبنانية ولدت سنة 1935) الصفحة ملءً عبر حفرية الصفحة، ويقوم الفنان العراقي صلاح الجميّع (المولود سنة 1931) باستيحاء مخطوطات قديمة عبر استعمال الألوان المائية على الورق ومقاطع من الكتابة المسمارية، فيما يربط آخرون الحرف بالحركة التي تصفيه تارة وتارة أخرى تحيله على الغموض، وكل هذا يبين عن قيمة فن الخط وقوته الباهرة بوسائل متعددة.
بعض حضارات العلامة أرست قواعد لخلود هذا الفن عبر الطابع الهندسي المحسوس، الشفاف لكل المواد كما هو حال فن الخط العربي الإسلامي، أو عبر التوازن بين الفراغ والامتلاء كما هو الأمر في الخط الصيني والياباني. وهذه القواعد لا تزال حية مثلا في أعمال زاو ووكي Zao-Wouki ، وهو ما يمكن اعتباره علامة على الاستمرارية ومكتسبا كبيرا. بيد أن تطور الفن المعاصر في العالم العربي، فيما وراء الشاهد الزخرفي، يلاقي عائقين يحدّان من مدى العلامة: المنزع الثقافي والمنزع الشكلاني. لهذا السبب تستدعينا أعمال الفنان المغربي أحمد الشرقاوي (1934-1967) وتثير اهتمامنا. فقد منح للتشكيل العربي إشراقا فريدا عبر حركة فنية خاصة به.
ليس ثمة في أعمال الشرقاوي من تعبيرية تجريدية، ولا من لطْخية أو حركية وإنما ثمة صرامة الخطوط والعلامة التي تغدو شكلا ولونا. إنها وحدة في التأليف وتوازن ونقاء وتعديل مستمر للمجموع في أسلوب لم يكف عن التوضُّح فيما هو يعمق رهافته. وبما أن الشرقاوي اشتغل كاتبا عموميا بالدار البيضاء فقد خبر مهنة الخط المغربي وممكناته. لكنه في الستينيات دخل في بحث شكلي وكتابي تصويري متبلور جدا.
يعمد الشرقاوي إلى عزل مساحة قريبة من البيضاوية أو في شكل مستطيل، وهي ضرب من التخطيط الأحادي المركزي يستحيل أمام عين الناظر إلى لوحة داخل اللوحة، أي لعبة مرايا وتنويعات على العلامات والألوان والتغيرات المفترضة. وثمة أيضا تقنية أخرى تتمثل في قماش القنب المتراكب الذي يتماوج حتى حوافيه، فيمنح للوحة إيقاعا وتراكبا بين مستويين، ومعادلة من التناغم والاستبدالات المتوالية بين العلامات والتلاوين والمواد. تجري العين في هذا الفضاء، تتوقف، تأخذ وقتها أمام تحولات هذا الفضاء الذي هو نفسه والآخر. وثمة تكمن حرية الفن باعتباره استكشافا لرغباتنا الدفينة.
ليست الهندسية الرمزية والكتابية التصويرية التي تعتمدها أعماله هنا لكي تبهرنا، وإنما كي تلطف من انبهارنا. من ثمة يأتي ذلك النسيج وتلك الرؤية الملموسة التي تنبثق بخفة ورهافة بالغتين. ولنا أن نتخيل ما يلي: حين نجد أنفسنا في العتمة المدلهمة لغرفة ما، يكفي استلاب هذه اللوحة من الليل كي نستعيد الضوء. فالفن يخرج الإنسان من كارثته الأصلية، ويضعه مجددا في حركة فعل الحياة، يعيده للعبة العلامات والأشكال المتناسجة مع حركة الجسد وحكاية حياته، كما حكاية بقائه على قيد الحياة. إن الأمر يتعلق في أعمال الشرقاوي بالتحولات النورانية.
بعد مرحلة أكثر عتمة (1962-1964) يعمل الشرقاوي على تلطيف شغب الألوان (تلاوين الأحمر الغامق، والأغمر والبنفسجي، والأسمر الممهور بالأخضر الغامق وبأزرق النيلة) بخفة لا تقاوم. هكذا يحقق الفنان حالة المواجهة عبر حرقها من الداخل بخطوط ناضحة سميكة، ممحْورا توازن المجموع حول المساحة المحدودة، باعتبارها بنية وشكلا وعلامة ولونا في الآن نفسه. وعن طريق أثر التوالد الحلمي تظل اللوحة بكاملها مفتوحة على كل الدلالات والتمثيلات، بما فيها تلك المتعلقة بالبورتريهات والوجوه والمناظر، من دون أن ننسى تمثيل الحيواني السحري. هكذا يمتلئ المشهد حركة حين يعطل الفنان السم القاتل بإيقاع اللون في لوحة رقصة الثعبان (1964)، أو في الحنفية الحمراء (1964) وباب الفتح (أيضا سنة 1964)، وهي أبواب تدخل منها الألوان البهيجة وتخرج، فيما يعمد الفنان إلى تحويل الشارع إلى جدار وحيد من الألوان. أو كما يتم ذلك في لوحة محبة القطط (1964)، وهي حيوانات نعرف نظرتها المغناطيسية، وقفزتها المطاطية في رغبة الفنانين وحركتهم. وبذلك يتابع الشرقاوي عملية بحث صارمة، بصرامة تستهدف الالتقاط والإمساك. إنه لا يمثل لأي شيء تبعا لمبدأ المشابهة، وإنما تبعا لنقل علامة نحو أخرى، تاركا للنظرة حرية ممارسة أحلام يقظتها النشيطة.
يتعلق الأمر هنا بتوحّد بين المواجهة والحركة. وهو ما تشهد عليه اللوحات الغواشية المرسومة على شرائح الخشب contre-plqué كمرايا (1965)حيث يهيمن اللون الخبازي البنفسجي والرمادي المزرق على هذه المرحلة. وبذلك يغدو اللون هو الغالب، ملتحما بشكل صميم، لكنه في الآن نفسه يبدو كما لو كان منتزعا من الأشكال الهندسية والوحدات التخطيطية ومن عناوين تلك اللوحات الغواشية نفسها.
في لوحات الشرقاوي عدد محدود من الأشكال التخطيطية، بحيث استعملها استعمالا مضبوطا. وفي منحى آخر يقوم الفنان التونسي قويدر التريكي (المولود سنة 1947) بتعميم تطبيقها. فسواء كان التريكي يرسم أو يحفر على الورق فهو يظل دائما خطاطا مصورا (بكتوغرافيّا) يمارس الكتابة التصويرية بشكل كامل. لكن ما هي البكتوغرافيا؟ إنها في معناها الأولي الذي يمنحها لها المؤرخون، كتابة من الإشارات تبث للغائبين هذا الخبر المهم أو ذاك الذي يتعلق بحياتهم اليومية. وفي معنى ثان، فهي تنتمي أصلا لفن الخط trait ، وإلى لاتحدد أصلي بين الرسم والكتابة. إنها كتابة عتيقة، تحتفظ في ذاكرتها بتخطيطات الهيروغليفيا والكتابة التصويرية الصينية واليابانية. وبفضل هذه الكتابات استطاعت الحضارة الصينية والفرعونية، كل منها حسب نسق أشكالها، الإمساك بسر القدرة على انتشال وحدتها المحاكاتية من التمثيل التشخيصي. فقد حولتا المكتوب إلى تصاوير، تارة ذات طابع تجريدي وأخرى ذات طابع إشاري تعييني. إنه سَنَن لتبسيط ومفْهَمة الواقع والمتخيل، إلى درجة تغدو معها الكتابة المرسومة (البكتوغرافيا) مدخلا لفن الخط والتشكيل في الآن نفسه.
إن الكتابة التصويرية للفنانين، كما هو حال قويدر التريكي أو ميشو، ترتجل العلامات وتغازلها، محركة إياها في زمن المرتجلة أو التأمل المشجع على حلم اليقظة النشيط. ويتمثل معجمها التصويري في أشكال إنسانية وحيوانية ونباتية تتناسل وتتكاثر عبر العدوى الحلمية. لكن كما هو حال بعض أنواع الموسيقى، تلك عناصر أساسية يطرز عليها الفنان العلامة ويقطعها وينتقص منها ويفصلها ويدفعها إلى التوالد، في ما يشبه الدعوة إلى الترحال.
فالخطاط التصويري هو بالتأكيد حاكي عالم ساحر وحنيني. إنها حكاية بلا بداية ولا نهاية، تمنح لنا هنا في وِجهاتها المتعددة في الفضاء وفي تنويعات مختلفة تمسك بها العين حسب متعتها. وإذا كانت ألف ليلة وليلة تسري بتمازج قصصها، فإن التريكي يفك التمازج ويعزل العناصر بعضها عن بعض ويمسرحها، ويعيد تأليف المشهد المتْعي والتكرار بأناة وصبر. إن الخطاط التصويري يكرر العناصر التصويرية نفسها وينوعها بحثا عن سعادة بسيطة، فذلك سعي وجودي على حدّ البراءة والجرح. آنذاك يحلم بيده بالشكل نفسه الذي نحلم به بأعيننا.
يقترح علينا فنان تونسي آخر هو محمد بن مفتاح (من مواليد 1946)، وهو رسام وحفار ذو حساسية كبرى تجاه المادة، عنقودا من العلامات والوحدات الخطية، يلفها ويبنيها في شكل متاهة. والحال أن الدخول في المتاهة أصعب من الخروج منها. فالمتاهة صورة مركزية من صور الفن عموما ومن الحياة باعتبارها شبكات مكثفة من التعقيدات. لا يختار المرء أن يكون متاهيا(11)، لكن تردُّد اليد (التي تقوم بالرسم أو الحفر هنا) تقودك وتدلك على الطريق، أي على طرق متعددة في الآن نفسه. هكذا نتعرف هنا على صورة شمس، وهناك على صورة عين ، وهنالك على شبح حيوان، لكن تلك التمظهرات لا تلبث أن يختطفها المنطق السادر للعلامة الكبرى، التي لا تتبع إلا هواها وتتركنا تحت رحمة سلطانها.
هذا العنقود من العلامات (كإحالة للموروث الشعبي) توجهه مليحة أفنان تبعا لخط منكسر ومضطرب بحيث يترك الورقة تنساب مع نفسها.
إن العالم الحلمي للكتابات والتخطيط على الجدران graffiti في الأحياء الشعبية يعتبر مختبرا للمعيِّنات الاجتماعية. فقد شكلت دائما تضعيفا للزخرفة الداخلية للبيوتات الفخمة. إنها لسان حال العامة والمنبوذين والصامتين والمحرومين من مفهوم الكتاب والتشكيل. تعلمنا تلك المعيّنات كيفية إدراك الفن الذي ينزل للشارع، خارج المتاحف ووسط صخب الحياة. وليس من قبيل الصدفة أن يقوم بعض الفنانين المعاصرين بترويض التخطيط على الجدران من خلال استعادته لحسابهم الخاص. فقد شكلوا منه لوحات وحفريات، ومشْهدوه خارج ساحة معركته. من لا يعرف بمدينة فاس ظهور واختفاء ذلك الشخص الغريب المسمى عبد الله غريّو، الذي بعد أن بصم حيطان المدينة وأشجارها بتخاطيطه وكتاباته ترك المدينة مثل مختلس للعلامات، لم يمسك التحقيق (الفني والبوليسي) منها غير آثار آيلة للانمحاء.
بيد أن علاقة الفنان الجزائري محجوب بنبلة (المولود عام 1946) بصورة العلامة علاقة مغايرة، فهو يعالجها بحوامل متنوعة بائدة إلى هذا الحد أو ذاك، لكن تأكيدا بألوان غاية في الإشراق، وغالبا على مساحات كبرى. وهو نفسه يتحدث عن "كتاباته التشكيلية". ما الذي تعنيه هذه العبارة؟ هل تحيل إلى شيء آخر غير ما يتحقق في فن الخط؟ لنقل بأن الفنان يبعث برسالة لم تعد تنتمي إلى مجال المقروء. هل هي كتابة لا تحمل إمكانية القراءة ؟ نعم، وأكثر من ذلك.
وإذا كان يتم هنا تفعيل المكتوب graphie في دفعة هندسية وتشكيلية خالصة، فعلينا تبديل المنظور، وتتبع الإنتاج المتعدد للعلامات ومشهد تناسلها المفرط. إنه تناسل يملأ الفضاء حتى حوافي الإطار، بحيث نجد أنفسنا أمام حفل للبصر ممتلئ وجْدا وحـمّى. وما أن يمر الانطباع الذي يخلفه أثر الدّوار هذا، حتى نبدأ في التفكير في تلك الطاقة الأرضية التي تفرضها على ذهننا، وعلى روح بصرنا. ثم ما تلبث العين أن تتوقف طويلا عند عنصر من عناصر اللوحة ، وعند هذه العلامة أو تلك لنتعرف عليها باعتبارها ذكرى، ثم تتحرك العين نحو عنصر آخر لا يستوحي غير حركة الفنان، إلى درجة نجد أنفسنا معها أمام مذكرة نفك فيها بعض العلامات، وهي علامات آتية من بعيد، من قلب ثقافة جهوية، بوفرة طلاسمها، وآثارها ونقوشها الزخرفية، ووفرة أخاييل الرسوم المنسوجة. هذه المذكرة، باعتبارها دليل الهوية الرمزية، يتم الزجّ بها بشكل مستمر ومتجدد في لعبة التنقل والتحول. إنها ذاكرة في طور التشكل والتحول، وسرعة وآلة لإنتاج العلامة. فهي ليست كتابة تصويرية بالرغم من حضورها الأكيد، بل ليست فن خط بالمعنى الحصري، وإنما هي انطباع لبنية متحركة تتماوج، أي أن الدوار الاصطناعي الذي تنتجه تلك الآثار وسرعتها يجعل اهتمام الناظر يتجه نحو لامكانٍ ليس له بعد من تسمية.
هذا اللامكان هو ضرب من الطوباوية تغدو فيه راحة الفنان بسهولة ذات بعد فردوسي. إنها حيوية بالغة تعيشها العلامة وعملية بنائها واجتماع شملها من لون لآخر بنوع من الإكراه. هكذا يعشق بن بلة المادة في حالة تحول وامتلاء. فمن أولى أوراق لف السجائر إلى الشوارع المبلطة بباريس-روبي التي كلّف بزخرفتها، لا يزال فناننا مستمرا في استكشاف عدد كبير ومتنوع من الحوامل والمواد. وها هو يخرج إلى قارعة الطريق، ناذرا نفسه للقوة التقنية وللضوء والريح في هذا المشهد الطبيعي. بيد أن الطبيعة تمتلك وتتصرف، فيما يكتفي الفنان بالاقتراح. إنه يترك الآثار التي غالبا ما تمحوها الطبيعة، وهو يبني أعمالا فنية تعمل الحياة على تغيير ملامحها. ويتساءل م-ج برنار بصدد الفنان الجزائري محمد خدة (1930-1991)، وهو فنان متعدد التوجهات ومعروف بتخطيطاته: "كيف للإنسان أن يمارس التشكيل بالرغم من وجود الحياة؟"(12). هل يتعلق الأمر بواجب أم برغبة مجروحة؟ كيف السبيل إلى ممارسة التشكيل من غير أن يتحول المرء إلى قربان؟
المتفردون في الفن
يقال عنه إنه فن ساذج وعفوي، وأساسي وشعبي، إن لم يكن فنا بدائيا أو عتاقيا وغريزيا. إن فن الارتجال هذا يدعونا لأن ننظر إليه ونفكه بالشكل الذي يقدم لنا به نفسه، سواء كانت له خصائص السحر أو العجب العجاب أو اختزل نفسه في الترداد والاجترار.
قد يحدث لنا أن نفتتن بتصاوير هذا الفن، الذي يمتلك قيمة تكون في الغالب هشة، مثل طفل لا يرغب في أن ينمو ويكبر، يرى أمامه ألوان العالم تتناثر على يديه فيصاب بالبهجة والحبور. ومن ثم تنبع تلك الدهشة الناجمة عن ضرورة السهر في إغفاءة خفيفة في الفردوس المفقود والبدايات الساذجة للفن.
لكن هذه المقاربة تظل محدودة وبالغة الاختزالية. وعلينا أن نلائم بينها وبين هذا الفن الذي، مع ذلك، يسعى إلى التحويل transfigurer بطريقته الخاصة. إنه تحويل عجائبي كما هو الأمر لدى الجزائرية بايا (المولودة سنة 1931)، والتي حظيت أعمالها بإعجاب الكاتب الفرنسي أندري بروتون. فقد اكتشف بروطون في هذه الأعمال، بدل التداعي الحرّ الذي يحدد الشعر السوريالي في أساسه الأصلي، تداعيا للأشكال والألوان يشكل في لاوعي الفنانة آثارا أصلية عتيقة معادلة لذكرى من ذكريات الجنة. بيد أنها جنة لحقت بها بعض الرتوشات انطلاقا من مسار حياة امرأة تنزَّلت، كما يقال، من السماء.
من ثم تنبع تلك النباتات والحيوانات الأسطورية، وتلك النساء المرتديات أزياء منسوجة بالزهور، وتلك الفساتين والأشياء الجميلة التي تزين الحياة بشكل فردوسي. إن هذه الحرية المجنحة التي تذكرنا بعالم الملائكة وقد تحول إلى علامات، تحكي خرافة وأمثولة وذكرى دفينة، وقصة استيهامية، بالشكل الذي تصوغها به وتغير ذبذباتها حاكية مسحورة. إنها حكاية تلامس اللون، وتحلم به نابعا من الأنامل، كمادة ننقلها حتى أبواب البصر. الملامسة بالنظرة، والفتنة بالنسيان، والانفصام: إنها "الملِكة، الملكة التي تمسك بالغصن الذهبي"، كما يعترف بذلك أندريه بروتون. هكذا يتخبل الشاعر يوتوبيا أو بالأحرى لامكانا**، تجمدت فيه حركة العالم في صفاء أصلي حيث كل شيء يمكنه أن يستعيد البدء من جديد: "وهاهو شبح بايا الكهنوتي، المرسوم على قماش ابن عذراء المستقبل، وهي تنزع عن وجهها جزءا من الحجاب، لتكتشف ما هو عليه العالم الجديد الموحد والمتناغم والمحب لذاته. نعم، صحيح أن يدها لا تزال مسلحة. ولا يمكن النفي بأن عُدَّتها من العجائب والمستحضرات والمصائر تتنازع العجائبية مع مستحضرات العطور التي تحبل بها ألف ليلة وليلة. فالرغبة الإنسانية لديها في طورها الخالص، لا تقبل بأي عائق أمام الإشباع، ناذرة نفسها بلا قيود للتحقق. واليد التي تمسك بالبلّورة الموشورية، تراها وهي تصدأ وتتجه نحو العشب والإبرة محمولة في ذلك على مصير غائر في الزمن" (13).
وقد صرحت بايا قائلة: "حين أمارس التشكيل أكون سعيدة. أحس نفسي في عالم آخر وأنسى كل شيء". التشكيل ونسيان كل شيء هو أحد أسرار الفن ومُتَعه. وحين اشتغلت في فالّوريس على النحت، كان يزورها بيكاسو* ، الذي كان يأتي بدوره لينسى جنبها عمله الذي يشغله وقلقه المستديم: تلك كانت عملية بناء وتفكيك التشكيل المعاصر. وهي حكاية تحمل عبرة على شاكلة الحكاية الملائكية.
هذا اللقاء بين الفن المسمى ساذجا والفن الحديث قد تمت إثارته أيضا بخصوص حركة كوبرا*، وبصدد الفنانة المغربية الشعيبية (المولودة سنة 1929)، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية قد خلفت آثارها، وكان فيه أعضاء هذه الحركة الفنية العالمية قد تشتتوا منذ زمن.
لنذكر بأن الشعيبية ذات الأصول القروية كانت عرافة. وعوض أن تكشف الأوراق، بدأت في التلوين. وفي إحدى الليالي عاشت حلما تقول عنه: "لقد حلمت هناك، في الغرفة المجاورة التي تفضي إلى الحديقة. كنت في بيتي، وكانت السماء زرقاء ومدرعة بالأعلام التي تصفق مع الرياح، كما لو كان ثمة عاصفة. وكان ثمة شموع منيرة تنتشر من الغرفة التي كنت بها حتى الحديقة بكاملها. انفتح الباب، ودخل رجال متلفعون بالأبيض، وقدموا لي قماشا وريشات. كان من بينهم شباب وعجوزان بلحيتين طويلتين. ثم قالوا لي: "من هنا فصاعدا هذا هو مصدر قوتك". كيف كنت أكسب قوتي وقتها؟ ما هي حظوظ وممكنات امرأة أمية؟ أنت تضحكينني.
-------
** هنا يلعب المؤلف على الجناس بين كلمتي: utopie وa-topie (م).
كنت أقوم بأعمال البيوت، وتنظيف الغسيل وتلميع الأرضية. لكني كنت أقوم بجدية بمهمتي تلك. ثم جاءني ذاك الحلم. وفي الغد قصصت حلمي على أختي. وقد كان علي تحقيقه. وفي اليوم الموالى، توجهت إلى المدينة القديمة، واشتريت الصباغة، الصباغة التي تستعمل لصبغ الأبواب، لم يكن الأمر مهما. المهم كان بالنسبة لي هو الخلق والإبداع، والبدء في العمل والإنجاز. وكان لابني طلال استوديو، وقد رأيته فيه يمارس التشكيل"(14).
لم تكن الشعيبية ترسم "الواقع" كما قال الناقد أندريه لود عن هذه الفنانة من الشعب، ذلك أن التشكيل يكون دائما ترجمة، ونقلا متقاطعا بين الفعل وصياغة الشكل والإمساك الخفي بقوى الخارج، وهو ما تجعل منه الشعيبية لعبة أوراق. وفي الحقيقة، فإن الشعيبية تشتغل على الألوان وتحولها إلى رسوم وكتابة تصويرية. وثمَّ تكمن متعتها.
إن هذه الوحدة في المساحة بين العلامة والخط، يحققها مغربي آخر هو مولاي أحمد الإدريسي (1923-1973) بشكل رائع. فهذا التلويني العجيب، والأخ البصري لروثكو*، مؤلف يملك بساطة تشكيلية لا تخلو من جرأة. فخلف المشاهد اليومية، ثمة دائما خطاطة خرافة أو أسطورة. ونحن معجبون لديه بذلك التواضع الجم، والحس الإنساني والصفاء المسكون بالرغبة في الجوهري. وذلك هو شغف كل فنان، أي أن يبني من أجل متعتنا المفارقة عوالم خلود هاربة. فالفنان يسعى إلى تحويل الصور لا إلى التصوير والتمثيل، وذلك بفضل التنويع في المظاهر التي تنسجها العلامة والشكل واللون والمادة. والواقع الذي يتماوج في طرف عينيه هو أوّلا واقعه، بعاطفيته وحسيته المشدودة في الغالب إلى الحنين والكآبة وجاذبية الوحدة. "فالإبداع يقاوم الموت بإعادة ابتكار الحياة، وهو ما يسمى بعثا"، كما يقول الفيلسوف مشيل سيرّ.
لقد تم في الغالب اختزال هذا الفن المسمى "ساذجا" في الغرابة والعجائبية، والنظر إليه كما لو كان ضربا من الدمى الروسية؛ فتارة يستخرج منه البدائي، وأخرى الأحمق، وطورا الطفل المتخلف عقليا. وبهذا، فهو يعتبر صندوق عجائب إثنولوجي، يمكن من العودة إلى أسطورة "الهمجي الطيب" العزيزة على جان جاك روسو. بيد أننا نعلم، منذ اكتشاف الفنون الزنجية، بأن هذا الفن كان بشكل كبير وراء ابتكار الحداثة في مجال النحت والتشكيل.
تنتمي ثلاثية الإثنولوجيا التقليدية (الطفل-البدائي-الأحمق) إلى معارف عن الإنسان وحضارات ولّى زمنها. فدوار "الأحمق" يعتبر الآن هو نفسه حاملا للإبداع والابتكار.
ذلك هو أمر الفنان المغربي عباس صلادي (1950-1995) الذي ظل يسكنه السديم. فالدخول في السديم يفترض تغييرا عجيبا في توازن المشهد الذي تحوله إلى حلم إن لم يكن إلى كابوس أمامنا. إن أعمال صلادي تحمل عنف الظل. إنها تحتمي وراء حجاب من الوحدة والتوحد، وهو ما شكل جدارا متحركا، يجد الفنان المتكىء عليه، بضربة صنوج، في الجانب الآخر من الحياة، في قلب مسكن الـمُفْرَدين. ومدينة مراكش لا تزال ماثلة هناك كي تضيعنا في ذاكرتها ومتاهتها وجُزَيْئات سعادتها. مدينة يأتي منها عائد من عوالم أخرى كي يستدعينا لذكرا ه.
ونحن لا نزال نتذكره كرجل هجره الزمن. فكما عاش كان يعيش في أعماله التشكيلية. وما أن ينقطع عن الرسم حتى يستبد به الصرع مرة أخرى. ظل صامتا ومنقطعا عن الحركة بحيث كان من اللازم الرجوع معه إلى فجر الكلام. كلامه كان مثل تشكيله، جوهريا وحلميا. كان يمارس الحلم سواء تحدث أو أحجم عن الكلام. أعماله التشكيلية، التي تبدو في الظاهر حكائية، تصور خرافات وحكايات سحرة بطلاسمها ومدنها الخيالية، وهي هندسات معمارية لا تجد مشروعيتها إلا في ذهنية مسحورة فعلا بنقطة اقترانها العاطفية والعجيبة. فكل شيء يتبدى في لحظة بصر.
عن التجريد
النقد الفني سَنَنٌ تكون تدريجيا تبعا للتطورات التي عرفها تاريخ الفن والجماليات الفلسفية والأدبية كما لدى هيجل وبودلير. وتعتبر ألفاظ من قبيل "التمثيل" والتشخيص" و"التجريد" ألفاظها الأساسية، مثلها مثل تصنيف الفن إلى عصور ومراحل... وخلف هذا السَّنن ثمة عمل الفنان (حين يكون جديرا بهذا الاسم) وفرادته، المنتمية تاريخيا إلى هذه الحضارة أو تلك، أو إلى تقاطع لتجارب ثقافية مختلفة. لهذا تفصح العبارة الشائعة "الفن العالمي" عن لبس بيِّن. فهي تحيل في الظاهر إلى الهوية، وإلى تعريف مجموعة من الفنانين الذين يتجاوزون الحدود القطرية. بيد أننا إذا تمعنّا في هذه المجموعة من الفنانين فإننا سنجد أنها تتوزع ضرورةً إلى فرديات تتقارب في ما بينها غير أنها تظل غير قابلة للجمع في مفهوم واحد. ففي كل عمل فني يفرض نفسه، يتعلق الرهان بالأصالة المحددة والحصرية للفنان وبأسلوبه وموقعه الاجتماعي. ففي الوحدة التي تسم تلك التجربة، يستمر العمل الفني في الانتماء إلى فضاء حضاري معين. وهو لا يصبح عالميا إلا في هذه الشروط، وبما يفرضه السوق.
لقد اخترنا مسارا موجها ونحن نتناول مسألة "التجريد" تبعا للمنظومات المرجعية paradigmes للفن العربي الإسلامي، وذلك قصد أن نقدم للقارئ تحليلا ملائما لرهانات "الفن العربي المعاصر". وقد ذكرنا أن هذا الفن يفترض مرجعا يتمثل في حضارة العلامة التي تملك قيمة سامية وموروثا رفيعا. لهذا فقد تركت بصمات واضحة على التشكيليين الغربيين المشهورين، الذين يعتبرون المؤسسين الفعليين للحداثة. وقد أبنّا عن خصائص الفن العربي الإسلامي ونسق أشكاله، المتمثلة في قوة الجوانب الزخرفية، واستقلال اللون، وتصويرية المنمنمات المبنية من غير اعتماد على تقنية المنظور، والهندسية المطلقة، هذا فيما أن "التجريدية" في الغرب كانت منتهى لتحول حضاري مغاير: "لقد نشأ العمل الفني والصورة غير التشخيصية بعد سلسلة مدهشة من التفكيك، والتخلي المتتالي عن المرجعيات التي نهض عليها الفن الأوروبي منذ قرون، أو على الأقل التيار المهيمن داخله. فقد تم التخلي أولا عن الجمال، الذي لا يمكن تصوره إلا داخل فلسفة شاملة أو ديانة معينة، ثم عن مفهمة الفضاء عبر نظام المنظور الذي لم يعد يمارس أي جاذبية على الفنانين، وعن تنظيم إدراك الألوان، وعن المحيط الضوئي، والضوء الطبيعي والضوء الاصطناعي (الكهربائي)، وأخيرا انفتاح المتحف على كل الأساليب وكل العصور وفي كل مكان من المعمور، بحيث هبت على العالم الفني الغربي موجة عاتية من الصور أغرقته في لـجّتها"(15).
تعود فكرة "المتحف" وتاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر. ويعود ذلك إلى ما توارثته العائلات الأرستقراطية والبورجوازية من تحف وأشياء جميلة. أما في العالم الإسلامي فإن الورثة يحوزون أيضا على الحلي والمجوهرات والكتب، وتظل المنقولات لذلك غير معروفة عند غير مالكيها. وعن هذا "الكتمان" نجم تبذير موروث ذي قيمة نادرة، وتشتته بين متاحف أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان غنية أخرى. وهكذا تم تصنيف الأشياء الجميلة المنقولة من الحضارة الإسلامية في أقسام "الفنون الجميلة" أو المتاحف الإثنوغرافية ومتاحف الحضارات العجائبية. فهذه القسمة التي تسم مواطن الفن جاءت على الصورة التي اقتسم بها العالم.
ثمة إذن مدخل مزدوج لعالم هذه الحضارة. المدخل المفضي إلى تراثها وحضارتها ومنظومات فنها، من جهة؛ والمدخل الذي من خلاله ظهر فيه الفن غير التشخيصي في العالم العربي بعد أن تبلور سابقا في الغرب، من غير أن يتلاشى الاستشراق التصويري الأوروبي ومنزعه الأكاديمي وحبه العجائبي.
وسوف تتغير الوضعية حين تم إنشاء مجموعة الفن والحرية سنة 1938 من قِبل الكاتب المصري جورج حنين (1914-1973) برفقة الفنانين التشكيليين رمسيس يونان (1913-1966) وفؤاد كمال (1919-1973) وكامل التلمساني (1910-1962)؛ لكن أيضا برفقة كتاب آخرين كألبير كوسّيري وهنري كورييل وإدمون جابيس. وقد نفثتت هذه المجموعة دينامية خاصة في الحياة الثقافية والفنية، من خلال المقالات والمجلات والكتب المصورة والمعارض والمحاضرات والبيانات المعادية للامتثالية. كما غذّت المجموعة ميولا خاصة للاستفزاز وتقاليد الفوضوية، وتسييس قومي ويساري في الآن نفسه. فقد امتزج الفن بالسياسة، وهو ما جعل من هذه المجموعة مؤشرا للثورة.
وحين ظهر هذا التوجه السوريالي، الأصيل والهامشي في الآن ذاته، في الحياة العامة المصرية، كان الفن الأوروبي قد تطور حثيثا نحو أسلوب غير تشخيصي منهجي ونحو تفكيك نشيط. كان هذا التفكيك، الذي فكّ أوصال نظام التمثيل عبر هزات عنيفة، يقترح على المتفرج في ذلك الوقت عالما جديدا من العلامات والتقنيات التجريبية التي لا يلزم أن ننسى أنها كانت تصاحب التاريخ الممزق لأوروبا وشرعيتها. هل كان الأمر يتعلق بسوء تفاهم؟ ألم تقم مجموعة "الفن والحرية" فقط، عبر المحاكاة، بإعادة إنتاج التداعي الحر بين الكلمات والصور الذي كان عزيزا على السوريالية في سنواتها الأولى؟ نعم، من دون شك، فقد استمر رمسيس يونان، وهو أحد أعضاء المجموعة المؤسسين، في طريقه ذاك: "فإذا كانت أعماله قد تطورت، بين 1938 و1966 من التشخيصية المتمردة على طريقة فريدي، نحو عفوية غير تشخيصية، فإن الانطباعية التي تبدو مهيمنة لأول وهلة على لوحاته في السنوات العشر الأولى لا يلزمها أن تموه على المتفرج. فقد ظل نفس تيار الرفض والحرية مستمرا خلف المظهر. فسواء لديه أو لدى جورج حنين "لا يوجد إلا ما ليس له من اسم""(16).
وسوف تعمل إنجي أفلاطون (1924-1989)، وهي تلميذة للتلمساني، على تحقيق هذا الاتحاد المحلوم به بين الفن والتمرد السياسي. وقد مكنها الاعتقال، حسب زعْمها (وعلينا تصديقها)، من الاشتغال أفضل على لعبة الأنوار. إن جعل الاعتقال رافعا لتحويل وتطوير العمل الفني يعتبر درسا من الدروس الكبرى للحياة، والتزاما مطلقا في الفن تجسده تقاليد الانشقاق التي يمكننا أن نذكر الأمثلة المشهورة منها كساد وجان جوني. تنتظم مناظر إنجي أفلاطون برشاقة وميل نحو المنمنة، وتشبيك الرسم واللون على خلفية موحدة. هذه الأعمال ذات المنزع النسوي واليساري والمسلحة بثقافة كونية تعتبر في الآن نفسه راهنة ولازمنية في بلد مثل مصر يتهدد الاندثار أعمدة حضارته العتيقة.
في الخمسينيات والستينيات، كان تكوين الفنانين يتمّ إما في القلّة القليلة من المدارس الوطنية للفنون الجميلة أو في الخارج، ولا سيما في أوروبا الغربية والشرقية. وعن الفنانين الذين تلقوا تكوينهم بالخارج والذين يعتبر بعضهم من أهم الفنانين العرب، يمكننا القول بأن الفن، في جميع الأحوال، ظل وطنا لهم. بل إن استقرارهم النهائي في البلدان المستقبلة لهم، أو رجوع بعضهم الآخر إلى البلد، أو أيضا الترحال بين الوطن والخارج، هي عبارة** وتعبير للأعمال الفنية عن تنقلاتها من المرسم إلى الأروقة، إلى المجموعات الخاصة، ثم المتاحف. فالعمل الفني يرحل في الزمن والمكان مصحوبا بذاكرته المحمولة. وأنا الذي أكتب هذا النص، أقتفي أثر بعض تحولات الفن التجريدي تبعا لطريق يخضع لمسيرٍ مضلّع. لنتابع.
----------
** والعبارة عُبور كما يقول ابن عربي (م).
يقال بأن شفيق عبود (المولود سنة 1926)، الذي ارتاد مرسم فرنان ليجي*، وأندري الحوت وآخرين، ينتمي لمدرسة باريس. لكنه، فيما وراء هذا الانتماء، يمتلك أسلوبه الخاص الذي يجد مرجعيته في ما بعد الحرب وابتكاراتها. فالتجريد الذي نتحدث عنه موقف ذهني وفعل يعيد هيكلة العلاقة بين المرئي واللامرئي.
يبلور هذا الفن نظرة معزولة عن الواقع تجعل الروح في موقع المترجم والواهب للأشكال والعلامات على المساحة المتموجة للعالم الحي. إنه خط للهروب في اندفاعة التاريخ، وفي هذه الحالة علينا التذكير بأن ذلك كان بعد الحرب العالمية الثانية.
كثيرة هي الحركات التي وجدت أصلها في ابتكارات كاندانسكي* وبول كلي* وموندريان* ومالفيتش* وماتيس* ودولونيي*، فيما كان الأمريكيون يكتشفون في بلادهم، بحماسة وحتى الدّوار، الحرية الحركية أو حرية الفن اللامتحدد informel ، ومنحى تجريديا يدين بالكثير لفن الخط الصيني والياباني.
هكذا سوف يتم حوار مزدوج مع حضارات أخرى وأنظمة أشكالها. ففي جانب، كان هناك في أوروبا منحى تجريدي يمكن اعتباره منظورا ذهنيا في خدمة إنتاج المصطنع، ذو طابع لهْوي ومفكك لعالم التمثيل القديم، ومن جانب آخر ثمة الحرية الممنوحة للتجريبيين ومستكشفي الحدود القصوى بين الشكل واللاشكل، والشيء وحطامه، والعمل الفني وانمحائه، والمواد وأبدالها السحرية، والفن الحركي وانفلاتاته... لكن بين عنصري هذا المشهد الفائر، يوجد فن تجريدي يسير في اتجاهات غامضة كثيرة، إلى درجة سمعنا معها من أفواه مفكرين كبار بأن الفن حرفة آيلة للموت.
ولد شفيق عبود، بشكل ما، في ملتقى الطرق هذا. ففي لعبة الطفل (1961) مثلا، فإن لمسة النظر، الذي يملك رؤية لمسية، تبدو محمولة على توازن بين النبرات والتناغمات، مانحة لهذه اللوحة إشراقا يظل اللون محتفظا بمقياسه. وهو الإشراق الذي يبدو بديهيا في أعماله الأخيرة.
ولأن أعمال الفنان الجزائري عبد الله بنعنتر (المولود سنة 1931) مرتبطة أصلا بالتجريد الحركي السائد في الستينيات، قبل أن تتطور باتجاه أسلوب مستقبلي وتجريبي، فإنها تمتاز باستمرارية رائعة. فقد امتلك هذا الفنان بعض مكتسبات التجريدية الغربية بسعادة غامرة، باعتباره حفارا ورساما ومصورا لأكثر من سبعين كتابا فاخرا مهداة لشعراء مرموقين. إن طقس الكتاب والتنويرية هذا موروث عن حضارته. وقد ظل واقعا تحت فتنته مثله في ذلك مثل الكثير من الفنانين التشكيليين العرب.
بيد أن بنعنتر يتحدث أيضا عن نور من نوع آخر، أي عن نور محلي تستضيء به جهة معينة ومواقع ومناظر معينة. إنها لفكرة رائعة أن يقوم بشخْصنة الضوء الطبيعي والإقامة فيه باعتباره شعاعا متحولا. وبالرغم من أن بنعنتر ولد بالجزائر فإنه يعشق منطقة بروطانيا الفرنسية. وهو ما تجسده اللوحة المتعددة المسماة الفصول الأربعة. ثمة مناظر طبيعية ونباتات وحيوانات وشخصيات محجّبة جامدة، وكل شيء يتم في تلوين تتحكم في جموحه وتسلسله في الآن ذاته قوة منظمة ونيرة تسكن جسد الفنان ومويْجاته الحسية.
حين يقوم فنان ميتَّم من وطنه بإعادة بنائه في منطقة نور تنسجها ممارسة اللون، فإن الطبيعة تكشف خلف كل مظهر جذاب من مشهدها قيم الرموز السرية والهوية التعليمية. ومن حينها يبدأ النظر المتأمل لهذه اللوحة أو تلك في السعي إلى الترحال خارج الزمن، انطلاقا من انطباعاته الأولية. ونحن نعتقد أن اللون الأكثر تمزقا والأكثر اجتراحا يحافظ على تأليف أخير يزرع في غرائزنا أو يخاط عليها. وثمة يكمن لغز الفن الذي يصطدم باستعصائه "التجريد" و"التشخيص" معا: إلى أي حد تملك الطبيعة والفن، انطلاقا من ألفتهما، نفس الإنتاج للأشكال؟ ولقد اعتقد الفنانون والمفكرون لزمن طويل في هذا المماهاة، لكن نظام الطبيعة وفوضاها منذوران بالمقابل لقوى الصمت. وربما كان تشكيل الصمت، فيما تحت الصمت الحقيقة الهوجاء للفن.
وعلى كل حال، فإن كل فنان يبدأ من جديد كما لو كان ملاكا منفيا في هالة النور. وبهذا الصدد تدعونا مونيك بوشي، بعمقها الشاعري، إلى تأمل سلسلة الزائرات لبنعنتر: "أحيانا، وبالرغم من عتمة الليل، تصل الزائرة الملهمة إلى مرتبة جمال لا يضاهى، وأحيانا أخرى تبدو الكتلة المقشرة كما لو أنها تتماوج، فيصبح التشكيل خفيفا وهوائيا، بمنحدرات مفضضة بنعومة العسل. كل شيء مشع، واللمسة الحركية تمسك بالنور عبر عصارات راتنجية نباتية حمراء قانية، فتنمو الأشكال بجلالة رائعة ورشاقة كبرى يحيط بها الغموض كما لو كانت أشخاصا عزيزة علينا نجهل في العمق حياتهم. وهذا ما يبدو بجلاء في الزائرات السوابع، حيث تتدخل الثنائية بقوة بين رقة الشخصيات المجتمعة في نصف دائرة تحيل إلى صخور منطقة "بيل إيل" بفرنسا، وكأن الأمر يتعلق باجتماع سري، والالتواء والتمطُّط المرضي للشكلين اللذين يتحركان فوقها"(17).
فمنذ أكثر من نصف قرن والفنان العربي الحديث لا يكف عن تملك تراثه ونظام أشكاله ومعه بعض مكتسبات الفن التجريدي العالمي. وهو أحيانا يستدرج نفسه نحو تجريدية ذات طابع غربي، حيث لا أولوية للعلامة ولا عودة للأقانيم التقليدية. لقد عنون الفنان التونسي رفيق الكامل (المولود سنة 1944) أعماله لسنة 1987: تحويلات. التحويل انطلاقا من تقنية التغطية، وبما أن الخلفية ذات لون واحد فإنها تصعد إلى السطح، هنا وهناك، في تأليف دينامي، يترجم الألوان والأشكال إلى عوارض قاطعة.
إن عبود وبنعنتر وآخرين من الذين سنعود إليهم، عشاق للاستقلالية المحسوسة للون. وقد كانت هذه الاستقلالية في الغرب عبارة عن فتح تدريجي، وذلك عبر أعمال غوغان* وفان غوخ* وسيزان* والانطباعيين. أما في المجال الحضاري العربي الإسلامي فإن تلك الاستقلالية تندرج في نسق من الأشكال وتعادل التنويع في المظاهر التي تتلاعب بها قوى الزخرفية من خلال الهندسية المطلقة وأشكالها التوريقية ذات المنحى المتاهي.
لم ينمح هذا النسق أبدا، فهو يعود إلينا في أعمال الفنانين العرب المعاصرين، متحولا ومجاورا لأنساق أخرى من الأشكال.
لنتوقف عند التجريدية الهندسية التي يتم التعبير عنها بعناصر متعددة، كالمويْجة والمربع السحري، والمضلع النجمي، وأشكال أخرى مستقاة من الفسيفساء والمعمار وفن الخط والفنون والـحِرف.
لكن في ما وراء هذه العودة إلى التراث المتسمة بهذا القدر أو ذاك من المرح، قام فنانون معينون ببناء نظامهم المرجعي الخاص. وربما كان الفنان اللبناني صليبا الدويهي (المولود سنة 1912)، الأول الذي فتح الطريق نحو فن هندسي صارم، مغتنٍ بمؤثرات جديدة. إن ممارسته للفن الجداري وللزجاجيات، التي تحتفظ كما نعلم ببعض أسرار اللاهوت والتصوف، وعشقه للوحات الكبرى التي يمتد على مساحتها لون طاغٍ لا يكف عن صياغة عصابات رقيقة في جوانبها، كل هذا التمازج الصميم بين اللون والهندسية، وبين التناوبات النبرية والمفارقات اللونية جعلت غاستون دييل يصرح، هو العارف بفنون الحضارات الأخرى: "يكفينا أن نستعيد باختصار جوهر أبحاثه المستمرة المتمثلة في تقطيعاته الطموحة، التي لا يمكن لمظهرها الشامخ إلا أن يقنعنا، وضروب ألوانه الفخمة وذات الطابع الشخصي العميق، المستعملة بوجاهة كي تشد البصر من أول نظرة، وتحويلاته الرمزية المتدرجة الهادفة إلى بلوغ جوهر إدراكي مؤثر في كل الناس. ولنضف أيضا الممكنات التي يقترح قصد زرع جوهر فن الخط العربي التقليدي في إطار مبنْين وملوّن يتغيا هنا أيضا كما في أبحاثه الأخرى، الانفتاح على العالمية"(18).
لكن التشكيل المتعرج للمغربي محمد المليحي (المولود سنة 1936) من طبيعة أخرى. ثمة المويجة والمويجة على الدوام، بالرغم من أنه قد استدعى، في الستينيات، سلسلة من المربعات الصغيرة باعتبارها تمارين في الإيقاع بين الهندسية واللون، ملتحمة في الحركة نفسها. ربما كان علينا أن نذكر بأن هذه الهندسية التي يتحدث عنها الفنان بعبارات تنتمي للتصوف الياباني (زين) مسكونة بقوى الزخرفية النابعة من الفن العربي الإسلامي، سواء منه الأرستقراطي أو الشعبي. فهو وريث لها بالشكل نفسه الذي كان به تلميذا للحركة البصرية (بريدج رايلي) في الستينيات. فالهندسية، باعتبارها بناء ذهنيا، تشكل بقوتها الخاصة موطنا روحيا (كما نظَّر لذلك فاسيلي كاندانسكي*)، هناك حيث يبصر العقل برسم الروح.
إن هذه الهندسية الحسية هي منحى من مناحي النزعة البنائية constructivisme التي يمكنها أن تراهن على أحد عناصر هذا التشكيل كاللون أو العلامة أو الشكل المتوالي أو خصائص المادة. وتكون البنائية هادئة أو محايدة حين تبرز تأليفا حصريا وواضحا، إما ذا صبغة هندسية أو سيميائية. وعادة ما يصنف هذا التوجه ضمن الزخرفية وفي إطار الفن الزخرفي التزويقي. وهو ينصاع لهذا التصنيف، كما أنه أمر معتاد في السريغرافيا. إن نمط تأليفه ذو طابع مواجهة، بحيث يكشف للناظر عن شكله ومضمونه في التناظم نفسه للعناصر التي تكونه. وسوف نسمي بنائية دينامية الوضعية التي يُبين فيها التأليف عن نفسه تارة، وتارة أخرى يتوارى عن النظر. لنأخذ مثلا بنائية الفنان المغربي فريد بلكاهية (المولود سنة 1934). إنها أعمال رائعة لفنان بحّاثة، مرتبط بالاستقلال الخيميائي للمادة، مستكشف الفنون الاستعمالية ومعها الفضاء اللامحدد بين التشكيل والنحت. يواجه بلكاهية النحاس، ثم الجلد المبسوط على ألواح خشبية، بطاقة كبرى بحيث إن شفافيتها القليلة المعالجة تقنيا تلطّف بعض الشيء من حدتها وتوترها. وهو يزخرفها بالعلامات والرموز والشعاريات الرمزية والأشكال الواضحة وعناصر منسية من الكتابة التصويرية والتخاطيط الجنسية أو الكوكبية. إنها مذكرة يستخدمها الفنان كتصاوير وأحلام يقظة على آثار لها طابع النماذج المتخيلة العتيقة، فيصنع منها صورا مفككة puzzle أو متوالية من الصور، حيث يكون اللاعب (أي الفنان) في الآن نفسه جزءا من اللعبة . أما شخصيته البانية للصور الرمزية فهي التي تقوم بمشْهَدة نفسها وقد تحولت إلى بُدٍّ بفعل كثرة أقنعتها. إنه يرمي أيضا بنفسه في مهاوي الخطر، عبر تطويع صلابة المادة وتكييفها بشكل منهجي مع طاقته الخاصة، ومع الأشكال التي تتألف وتتفكك أمامكم. كل شيء هنا معطى للنظر من غير تحفظ. واللون (بتنويعاته المغراء والحمراء والصفراء والصهباء والسوداء والزرقاء أيضا) محاكاة لألاعيب جسد الفنان وحبه المنصاغ في تحولات المادة.
وعلينا أن نذكر هنا أعمال الفنانة الفرنسية المغربية نجية المحاجي (المولودة سنة 1950). إنها تتابع بحثها عبر تجريدية هندسية مؤسلبة حتى يغدو الرسم البياني خالصا برموزه العتيقة، المصرية والإغريقية والمتوسطية. إنه تشكيل بالغ التقنية، فهي تأمّلٌ في الصمت الذي تجسده تنويعات الصور الهندسية باعتبارها مظاهر للنظام والكمال والمعمارية الحسية ذات الأبعاد الرفيعة. وبين الراقصة التي كانتها، والفنانة التشكيلية المرموقة التي أصبحت، ثمة سر هيروغليفي ينطبع على أثر خطوة راقصة حركية. إنها هندسة متحركة. صمتا، ولنعاود الكَرَّة.
أما التحويلات التي تحدثنا عنها بصدد بلكاهية، فيحققها بشكل دقيق الفنان المصري آدم حنين (المولود سنة 1929) بين ورق البردي والتمثال، من خلال الحجر والبرونز والجبص. ربما لم نكن على وعي كامل بأننا فقدنا السر القديم لصناعة ورق البردي. والآن تتم صناعته بطرق حديثة. من ثم نجد في أعمال حنين ذلك النسيج ذا الألياف المتشابكة، والمظهر المحبَّب، الذي وهو يمتص اللون المائي (من كستنائي وأزرق نيلي، وأخضر وأحمر خاثر وأصفر كبريتي...) يزج بنا في تناغم متجانس بين النبرات الدافئة. وبهذا الصدد يصرح الشاعر الفرنسي ألان بوسكي: "ثمة إحساس بالهشاشة المدموغة وذات المدى لطويل، كما لو أن كل ورقة قد تأكْسَدت بفعل توالي القرون. إنه فن مكتمل ومتكامل".
إن بنائية آدم حنين تنظم اللون المبلل بهذه الطريقة مع أطياف شمسية تتراصف بشكل مائل أو بشكل متواز. فينبثق إحساس بالتوازن والاستقرار والصمت والأبدية الهاربة من تراصف المساحات هذه، حيث تتسلل خفية هذه العلامة أو تلك النابعة من ذاكرة تليدة. إن هذا التحويل يكون فاعلا أيضا في التماثيل الصغيرة للفنان التي تستوحي التراث الفرعوني، والتي تأخذ تارة طابعا تجريديا وأخرى تشخيصيا، لكن من غير أن تتخلى عن بساطتها وصفائها، تبعا لأسلوب إقلالي minimaliste في الشكل والبنية المرتكزة على قواعد ومكعبات وأسطوانات. فبفضل تلك التماثيل الصغيرة نتمكن من استعادة زمن الفراعنة. من سيقول لنا يوما من الذي يسكن الآخر، هل هو الكائن الحي أم شبح الميت الصامت المنبعث من قلب الصحراء الكبرى؟
فشبح الميت هو ضيف ذاكرتنا، وهو يأتي ليسكن علاقتنا بالماضي وبالتراث، هناك حيث يوجد ذلك الإحساس بالفراغ الذي يعيد فيه الفنان، في عزلته، إقامة الحوار غير المكتمل أبدا مع الأجداد.
وما حققه آدم حنين في النحت، مقارنة مع التشكيل، تقوم به الفنانة الأردنية منى السعودي (المولودة سنة 1945) في النحت مقارنة مع فن العمارة (في المدينة العربية)، من حيث هو نحت عتيق وشامل. إن اعتماد هذه النحاتة المتميزة على مواد متنوعة، من الحجر الجيري الوردي لإربيد حتى رخام كارّار كي ينهض تمثالها على قاعدة من الأشكال والأساطير، يظهر كيف تضع امرأة مسلمة موهبتها في خدمة خيال مادي فعلي وحداثة ابتكارية، متماشية مع التحولات العميقة التي تخترق المجتمعات العربية. ونحن الذين نمارس الكتابة بالحديث عن النحت، علينا أن نحس بأن كل كلمة مطالبة بالتلاؤم مع الشكل الأندروجيني الذي تنظمه منى السعودي بطريقتها الخاصة باتجاه الملمس اللين للحجر.
لنتابع عرضنا للفن التجريدي مغيرين منظورنا، لا بالعلاقة هذه المرة مع البنائية والنسيجية، وإنما بالعلاقة مع الإيقاع، حيث يتم تعليق البناء بالحركة وارتجالاتها البينة. وما اكتشفه فن الخط العربي، تبعا لسَنَنه الخاضع لقيم القياس والتوازن، لم يكن سوى تجريد محسوب الأبعاد ومتحرر من التمثيل على فضاء افتراضي، تقترحه هذه الجملة الشهيرة لفكتور هوغو: "الشكل هو المضمون الذي يصعد إلى السطح".
في الحركة كما في التجريدية الحركية يجرب التأليف حظه بين اللاشكل والشكل. ويتمثل الرهان في التحكم اللحظي في سيادة الاعتباط الذي يتهدد العمل الفني باستمرار، لمعانقة قوة الحركة التي تترجم نفسها بين الانطباعات الأساسية (الإحساسات) والتحويلات الهندسيية والأشكال المتحركة. يقال عن الفنان المغربي الجيلالي الغرباوي (1930_1971) بأنه فنان حركي، أي فنان مشدود إلى الرؤية المباشرة والدوار والعاصفة، والدخول السريع في اندفاعية الألوان. هكذا هو يحول ألمه (الذي كان عميقا وكبيرا) إلى صور و"تجريد غنائي"، إلى درجة غدا معها المكروه الذي صاحبه واضحا أمام أعيننا. إنه تحول يتحقق بفضل ملاءمة فورية بين الرؤية والحركة واللون. وفي لوحاته الغواشية على الورق، نظل معجبين بالقوة الجامحة والصمت المخملي، والطقوس السحرية للصدفة والتخلص من وطأة الفتنة، والعافية التشكيلية المنفصلة عن الماضي. وبهذا الصدد قال الغرباوي: "لقد شكل التراث بالنسبة لي رافدا بصريا أكيدا. فلا يمكننا أن ننفلت من بيئتنا. لكننا لا يمكننا دائما وصف ما نحمله في داخلنا. لقد ظل عملي الشخصي دائما مجهودا باتجاه المجاوزة. وبإمكان تجربتي أن تخدم أيضا الصانع والفنان الحديث".
هذه الخطوة نحو الحداثة، خارج التعارض الهلامي بين التراث والحداثة التطورية، يعبر عنها الفنان المغربي محمد القاسمي (المولود سنة 1942) بقوة. "أنا أفك وأكتب بالمقلوب التوريقات والزخارف النباتية والعقدة التجريدية للإسلامي". إنها مطالب فنان ذي موهبة كبرى ومثقف بالمعنى الكامل، انطلاقا من موطنه، لتدويل الفن. لتتصوروا إنسانا يرسم ويمارس التشكيل والكتابة ويستكشف، انطلاقا من تعدديته الفنية تلك، الممكنات الجديدة للوحة والجدار أيضا والمنشآت والأعلام على شاطئ المحيط الأطلسي، إلى درجة لا يمكننا إلا أن نفكر معها هنا بصورة الأطلانط، وهي صورة أسطورية قد ننساها حين يجد هذا الفنان نفسه يواجه بانتظام مفهومين لوصف هذا النشاط القوي، التي رأى البعض أنها تقترب من تيار الفعل التشكيلي (Action Painting ) الأمريكية وكاهنها الأكبر جاكسون بولوك*. بيد أن القاسمي يظل مهووسا بمسعاه الخاص، باعتباره بحثا عن الحد والأثر، وهما مفهومان أساسيان لديه.
وعن الحدّ، نستطيع القول إنه يشتغل داخل وخارج هذا الفضاء التشكيلي. وحين يجمع بين المحلولات الكيميائية وضروب الخضاب كي يخلق خيالا ماديا نشيطا، فما يجمع بينها بهذا الشكل هي بالتأكيد الآثار المدهشة لمادة محترقة يتحرك وسطها الجسد، لكن أيضا الأمكنة التي يتجذر فيها الإيروس من جديد ويستعيد فيها مرتكزاته واستقراره المتحرك، وقدراته الروحية المفكرة. الحدّ هو ما يشد الفنان إلى هويته وقد تحولت إلى صورة وعلامة ومفهوم. وعلينا متابعة انكسار هذه الطاقة بلمحة بصر. فكل شيء فيها أثر: الذاكرة والموروث البصري والكتابة، ووسم الحركة وإيقاعها القاطع المتراكب فرشة على الأخرى، وذلك حتى نهاية اللوحة، أي بدئها من جديد في مكان آخر صامت: "يتمثل عمل الفنان من دون شك عبر أفعاله المتتالية، في تحويل كل لوحة إلى فضاء تنوسم فيه الآثار وتنمحي، حيث تستمر في الوجود متحجرات الأصول، وحيث تتحرك الألوان والدلالات والفرشات اللونية (مثل كثبان رملية). وقد تأتي أحيانا (من حيث لا ندري) رياح لكنس الفضاء التصويري" (جلبير لاسكو).
أما أعمال الفنان المغربي فؤاد بلامين (المولود سنة 1950) فهي أكثر تركيزا على المادة ولعبة الذاكرة التي تفرزها في حياة الفنان. وبعد أن كانت ذات منحى تصوري وإقلالي، بدأت تلح على التوافق الذي يربط بين الحركة وتحولات المادة وبين خلقٍ للأشكال يمكنه أن ينبثق من التوتر الفضائي ومأساته. إنها مأساة اللون الذي تنتثر عليه عناصر الرمادي والأسمر والأسود، عبر التراكم والجمع بين الفرشات اللونية، في ضرب من "الجيولوجيا ذات الطابع العمودي"، كما يفسر لنا ذلك الفنان. وهو يوضح لنا أيضا بأن بحثه المحيط بمختلف التيارات العالمية يستهدف العلامة والمكان والذاكرة: فما موقع الأثر التجريدي من مدينة فاس، مسقط رأسه؟ إن هذه الثلاثية يوظفها كتراكم لاستكشاف ابتكارات ما نسميه "ما بعد الحداثة".
لقد وضعنا بين قوسين الكثير من المفاهيم الرائجة في النقد الفني قصد بلورة، إن لم نقل تأكيد العلائق اللامفكر فيها بين التمثيل والتجريد والتشخيص والعلامة والشكل واللاشكل. وبهذا لا نعمل سوى على بلورة مدخل للفن العربي المعاصر.
من النحت الى الفيديو
إن التشكيل، ومفهوم التشكيل يتغير تبعا لفنٍّ متعدد التقنيات، يحركه هاجس الشاهد والتوليف: التوليف بين التشكيل والتصوير الضوئي (الفوتوغرافيا)، وبين الدّيزاين والفوتوغرافيا، والمنْجَزَة performance والفوتوغرافيا والسينما، والتشكيل والنحت، والنحت والعمارة، والديزاين والعمارة، والمواد واللامواد حتى التيه. إن هذا التوليف يندرج ضمن ثقافة لـهْوية جديدة، وضمن ميل واضح للسينوغرافيا (المشهدية). فما يتغياه العمل الفني في الغالب هو المشهد وامتلاك الفضاء، لا مدة ذلك في الزمن. من ثمّ، لا وجود لأوهام عن الخلود الهارب التي يجسدها حظ العمل الفني، ولا للاختمار الطويل الذي يغذي تكونه، وإنما فقط إكراهات فن ذي طابع عالمي، وسوقه وبثه التقني العلمي.
من ثمة تنبع عزلة الفنانين العرب في حركة "العالمية" هذه. فنحن بداية هذا القرن، لا نزال نسعى للتعرف بدقة على دور الفنان في علاقته بثقافته ودينه ونقط هويته المتوسعة في الزمن الآتي، وقدراته على ابتكار المستقبل. إنها نقطة الهروب، والسرعة، ودوخة الأصوات والصور والذاكرات.
منذ أعمال محمود مختار مؤسس النحت المصري الجديد، لم يكف النحت العربي عن إعادة تملّك ماضيه، ذلك الماضي الثقيل الذي كبته التراث الإسلامي وأنساقه الفقهية الصارمة. ومن وقتها، تكيّف النحت مع جمالية ذات منحى صوفي، سواء كانت تشخيصية أو تجريدية. ذلك هو حال أعمال اللبناني شوقي الشوكيني (المولود سنة 1946)، ورقع الضامة ولعب الحظ، وتماثيله الصغيرة المتاهية. وقد صرح الشاعر صلاح ستيتيه قائلا: "ومن حينها، عرفت أعمال الشوكيني البساطة لصالح المنحنيات والخطاطات: وبما أنه يتعامل مع المادة، من خشب ورخام، كما لو كانت مِرْقَنا clavier ، فإنه يستخرج منها تنظيمات شكلية قوية ورفيعة ينطبق عليها من فوق الاقتراح التشخيصي. إن كلمة "مرقن" هنا تبدو لي الأصوب في هذه الحالة لترجمة الأثر المتوخى المتمثل في موسيقى تكون أحيانا بسيطة وخالصة على شاكلة أنشودة، وأحيانا أخرى معقدة وذات منحى جِواقي. إن الموسيقى الصامتة لمنحوتات الشوكيني تشكل تحديا للمدفع العبثي الذي يفرقع هنا كي يقتل (وهو ما لن يتم له) جسم وروح لبنان، باعتبارهما جبلا صلبا ولطيفا مثله مثل المنحوتات والنحات الذي أتحدث عنه"(19).
هذه الرسالة، يقوم نحات لبناني آخر هو ندا رعد (المولود سنة 1934) بإضفاء طابع درامي حاد عليه، وذلك بتآليف لأشكال مجزأة، وتجميع لصفائح وقضبان الحديد، كما لو كان يرغب في تخليص لبنان من دماره.
أما مهدي موتشار (من مواليد 1943)، فإنه يفضل الـمُنْشَأة installation ، وهي مفهوم وسط بين التجريد الهندسي الإقلالي (المربع، المضلع النجمي المعروف في الإسلام) والبساطة الكبرى للمواد، كما يبدو ذلك مثلا في تلك السلسلة من الآجر أو العواميد الخشبية. إن توالد الفضاء والزمن عبر المربع السحري يتميز بخاصية أنه يكشف للمكان الذي يحتضن مؤقتا تلك المنشآت وهْم تحوله هو نفسه إلى مشهد زخرفي.
إنها جمالية وظيفية دقيقة يزينها فنانو الديزاين بالتنويع في الأسلوب والموضوع والموضة ودرجة البهلوانية في توالي الأشياء الموحدة بواسطة عناصر خاضعة للتحكم والمراقبة. وهو ما يشهد عليه التعبير الشكلي الذي يعدُّنا لفن معين للحياة؛ ففي كل الأحوال تشكل الفنون تبريرا للحياة المثلى، وللقيمة السامية لحضارة ما ونشاطاتها الترفيهية، ومواقعها في الأمكنة التي تؤثث نظرنا ولمسنا. ويقدم لنا ثلاثة مواهب من أصول جزائرية، هم يمّو وعبدي وشريف، منحوتاتهم من الزجاج والحبال والخشب والمعدن، فيما يقدم لنا المغربي محمد حجلاني، بمرتجلاته التي تمتح من الذاكرة الحية لصناع مراكش باقة من المواد، من خشب نادر عطِر وفضة وعظام وحبال القنب، ليدعونا إلى مظاهر زخرفية أخرى منسوجة في الأثاث، من ضمنها أيضا فن الخط والتمائم والأرقام، يقدمها كخليط مرح وبلا ادعاء. يتعلق الأمر بسهولة زخرفية تقدم نفسها كخلق للحياة عبر تنويع مظاهرها.
قد تكون هذه المظاهر مغالية، كما هو الحال في الأعمال الفتوغرافية للمغربي التهامي الناضر (المولود سنة 1953). إنها حدٌّ لتمثيل الجسد. لكن بأي جسد يتعلق الأمر هنا؟ وإذا كانت الفتوغرافيا، حسب رولان بارث، تمكن من عودة الميت والشبح، فإن المشهدية الدرامية العميقة لهذا الفنان تملك ما يجعلنا في حيرة. هكذا يقدم لنا، في طواف غير منتظم وتبعا "للمواضيع" المطروقة، أجسادا متحجرة وأطفالا يكبرون منذ ولادتهم وأياد غريبة (آسيوية أو مغربية) مشدودة وظهورا متجعدة بل مثلومة، وأجسادا مفتوحة ومجزرة ودوابا مذبوحة، وكلَّ شيء مقترح علينا وعليكم في لمح البصر. كما لو أن المصور يبحث عن "حقيقة" الحياة والموت في قلب المادة نفسها، ويرغب في قلب الداخل نحو الخارج. إنها عملية قصوى، فالناضر لا يستعمل مصوبا آليا ولا التأطير، ثم إنه يستخرج صوره الشمسية على مقاسات 120 x 160. إضافة إلى ذلك، فالإخراج المشهدي الذي يقترح علينا ليس مأخوذا بالضرورة من الواقع، بل هو بالأحرى شاهد يصرح بوضعية إنسانية أخرى وبمأساة أخرى: فصور المجازر مهداة لصبرا وشاتيلا. هكذا يتجسد الميت والحيوان، وربما كان روح التجسُّد هذا هو المنفوث في هذه التجربة العجيبة للأسود، بالمعنى التقني. فالمصور يحتفل بالقربان: "إن أعماله العنيفة والسرية، بالرغم من الاعتراف الرسمي بها، هي البصمة المباشرة لخراب الوجود على الأرض. إنها تتجاوز أفق الفن المعاصر، من غير أن نحتاج لتفسير أسباب هذا التجاوز" (ألان جوفروا).
وتجرب اللبنانية منى حطوم (المولودة سنة 1952) هذا الأفق عل جسدها وعلى المتفرج، انطلاقا من المنْجزة والفيديو. فكل جسد ينظر إلى نفسه كمختبر يتجه نحو اللامادي: "ففي الجسد الغريب، تقوم كاميرا دقيقة بتفحص المظهر الخارجي للجسد والبشرة، قبل أن تلج إلى باطن الجسد لتتفحص مناطق أكثر غورا ويستحيل الوصول إليها. وعبر حركة تصويرية دائرية أمامية نشاهد جسدا بلا مقاومة موضوعا تحت المراقبة الطبية، وفضاء غامضا وغريبا معروضا على شاشة دائرية. ويظهر الجسد المركب من جديد كعالم مصغّر يسجن نفسه في "غرفة" مخروطية الشكل يُستَدعى المتفرج لولوجها. وتغزو الفضاء أصوات حميمة، فيما يُدفع بالمتفرج إلى السير على الصور، والمرور في الشعاع المضيء كي يغدو بدوره شاشة (20).
بمثابة خـاتمة
ربما كنا نرغب في تقديم هذا النص في شكل توريق يكون ذا مداخل ومخارج متعددة للقراءة. نعم، نحن ندخل بلا سحر تقريبا في هذا القرن الذي يحتفي به كل بلد وكل أمة بهذا القدر أو ذاك من المجد. إلى أين يسير العالم العربي؟ ما سيكون مآل فنونه في السرعة المعلوماتية للصور والأصوات والعلم التقني الخاصة بالتذكر؟
كان الكتاب، والكتب المقدسة بالأخص، المجال الأمثل للمعرفة والقداسة. فلكي تكون القراءة جيدة يلزم الكثير من الخيال. وذلك كان هو دور فن الخط المتمثل في منح النص إيقاعا خاصا وتركه يتنفس ويغرس جذوره في خلايا مخيالنا؟؟؟؟. فقد حول الخطية إلى مقطوعة من العلامات تقلع بالنص نحو مشهده التشكيلي: الزمن المرسوم والمنشود للحرف وتقفّيه بين الصوت والمعنى اللذين يتناسجان فيه. ونخال الأمر عنكبوتا، وهندسة متحركة ومأسورة تبني ما تراه. وبما أن فن الخط صورة للتضعيف والتكرار، فإنه يمسرح نهاية الكتاب وخطيته. وهو قد حظي باهتمام كبير من قبل الفنانين، سواء كانوا عربا أو أجانب. ولا شيء يمنعنا من الاعتقاد بأن حضارة تفاعل العلامات، التي تتطور بسطوة قوية تكبت معها اختلاف الحضارات ومواطنها، تمنح لفن الخط حياة جديدة في فضاء العلم التقني ووسائطه المتعددة. وليس هنا مجال الإجابة عن هذه المسألة الكبرى، أو توضيح الكيفية التي بها تتطور حضارات العلامة، الصينية واليابانية والعربية الإسلامية، في هذه الذاكرات الجديدة التي تتحكم فيها الإعلاميات والتقنيات الجديدة للتواصل، لكن من حقنا إلقاء نظرة على ما حدث.
ففي العقدين الأولين من هذا القرن، اكتشف العالم العربي التشكيل والفوتوغرافيا، والسينما التي جعلت منها مصر في وقت قصير صناعة للصورة، والتي لا تزال مزدهرة الآن في التلفزيون. وقد سبق الاستشراق التصويري تملك العرب للتشكيل على المسند الذي تعايش مع ظاهرة التشكيليين السذج المحليين، كما لو كان هؤلاء نتاجا لذاك. واستمرت ممارسة المنمنمات، غير أنها تعرضت للتطور وأعادت صياغتها الفوتوغرافيا والتشكيل. ولقد أحس الفنان العربي في بداية القرن أن هويته وصورته عن ذاته سوف تأخذ مواقع أخرى على السجلات الجديدة للمجال البصري. هذه الرحلة في الزمن والفضاء والذاكرة، هي التي حاولنا عرضها سعيا منا إلى استخراج نقط استدلال في صلب الحضارة العربية الإسلامية ونظام أشكالها ومسارات استمرارها وقطائعها.
الهوامش
1- Toni MARAINI, Ecrits sur l’art, Al Kalam, Rabat, 1990.
2- Oeuvres, Tome II, La Pléiade.
3- John CARSWELL, in Le Liban-le regard des peintres, catalogue exposition IMA, Paris, 1989.
4- Matière de l’oubli et de la mémoire, in catalogue MOUDARRES, IMA, Paris, 1996.
5- MARWAN, catalogue d’exposition juin-août 1993, IMA, Paris, p. 28.
6- Cf. article de Abdelkébir KHATIBI, « Paradigmes de Civilisation », in Civilisation marocaine, éditions Oum (Casablanca) et Actes-Sud, Arles, 1996.
7- Cf. article de Abdelkébir KHATIBI, « Interférences », catalogue de l’exposition Croisements de signes (24 avril – 25 août 1989), IMA, Paris.
8- Jabra IBRAHIM JABRA, « Calligraphie et art moderne dans le monde arabe », Cf. le catalogue précédent.
9- Cf. l’ouvrage L’art calligraphique de l’Islam, de A. KHATIBI et M. SIJELMASSI, Gallimard, 1994.
10- Buland EL HAIDARI, « La Lettre arabe dans l’art pictural contemporain arabe », in catalogue Art contemporain arabe (collection du Musée), IMA, Paris, 1987.
11- Cf. en particulier les essais et les livres d’art de Jean-Clarence LAMBERT.
12- Les effets du voyage (25 artistes algériens), Amsaoui, 1995.
13- BAYA, in Trois femmes peintres, catalogue IMA, 1990.
14- Interview de CHAIBIA dans le même catalogue.
15- J.-C. Lambert, « L’image dans la peinture non figurative », dans l’ouvrage collectif Comment vivre avec l’image, PUF, 1989, p. 269.
16- Ramsès Younane, par Edouard JAGUER.
17- Benanteur, catalogue d’exposition, 3 avril – 4 mai 1977, Palais des arts et de la culture de Brest.
18- Catalogue d’exposition (12 février – 28 juin 1993), IMA, Paris.
19- Gilbert Lascaut.
20- Salah STETIEH, catalogue Art contemporain arabe (collection du Musée), IMA.
21- Mona Hatoum, Centre Georges Pompidou, 1994.
يتطلب هذا العنوان العام والتركيبي بعض الإيضاحات؛ ذلك أن المعاصرة، باعتبارها حاضرا خاضعا للتأجيل المستمر، هي تعايش بين أنماط عديدة من الحضارات، تمتلك كل واحدة منها ماضيا تليدا متفاوتا في القدم والتبجيل، متميزا بقوة الابتكار والحفاظ على تراثه.
إن ما نقوم به عادة من تمييز بين الفن "الحديث" والفن "المعاصر" يظل مثار غموض. فأين يبدأ الفن الحديث؟ هل يبدأ مع الانطباعية؟ أم مع التجريدية؟ وأي تجريدية نعني؟ يقال بأن الفن المعاصر قد انبثق في الخمسينيات بعد حرب بالغة الضراوة، باعتباره بالتأكيد نظرة جديدة على عالم منهار ويعاني من التقلبات.
إن هذا التقطيع التاريخي أمر لا يقبل النكران؛ بيد أنه بتمركزه حول التجربة الأوروبية والأمريكية الشمالية، لا يقدم نظرة مكتملة عن ابتكار الحداثة والمستقبل في دوائر حضارية أخرى. إن هذا يعني بأننا نسعى إلى التفكير في الزمن والفضاء في أبعادهما المتعددة المركز، أي في تاريخهما وجغرافيتهما وفنهما متداخلةً ومجتمعةً. فبعد أن تكون الخصائص الكبرى لحضارة معينة قد مُنحت قيمتها الحقة، آنذاك يمكننا مقارنتها بحضارات أخرى، وإبراز القيمة المتبادلة للحضارات الفاعلة في مسألة الفن، وتماثلاتها وأصالتها، وحوارها أيضا. فالمقارنة تأتي بالتمييز. تلك هي مقاربتنا في هذا البحث.
حين استعلن الفن العربي الإسلامي في الحداثة كان قد اكتسب، من زمن، مهارات وموروثا غدت كلاسيكية. وإذا كان لنا أن نحدد الخصائص المميزة لهذا الفن الكلاسيكي، فإننا سنجد أنه موسوم بالمزيّات التالية: استقلال اللون، وصفاء الأشكال، وهندسة "مطلقة" (حسب عبارة مفعمة بالإعجاب للوكوربيزييه)، وقوة الزّخرفي سواء في العمارة أو التوريق أو الزِّواقة، أو المنمنمات والخط والفنون والحرف الاستعمالية بتنوع موادها، من حجر و معادن ونحاس وجلد وورق وحرير... الخ. إنها فضاءات عديدة للنظر والمعاينة، يعاد نسخها من قرن لآخر تبعا لصيغ تتميز بهذا القدر أو ذاك من الثبات والتغير. ومن ثمة، فهي وفرة من العلامة والتآليف لا ينقصها الجمال ولا تخلو من قوة غامضة محيرة.
هكذا بدأت أوروبا تكتشف تدريجيا هذا التراث الكلاسيكي العربي الإسلامي. ونحن لا ننسى هنا المعرض العالمي بفيينا (1873) الذي كان مسرحا لاكتشاف حضارة مغايرة. من ثم أيضا ينبع سحر الفنانين الذي رحلوا نحو شرقهم، "كإميل غراسي (إلى مصر سنة 1869)، وكلود رونوار* (إلى الجزائر سنتي 1879 و 1882)، وفاسيلي كاندانسكي* (إلى تونس بين 1904 و 1905 وإلى مصر وسوريا وتركيا سنة 1931)، وموريس دوني (إلى الجزائر وتونس والشرق الأوسط في ما بين 1907 و 1910)، وألبير ماركي (الذي قام بزيارات عديدة للمغرب والجزائر بين 1911 و 1945)، وبول سينياك (إلى تركيا سنة 1907)، وهنري ماتيس* (الذي زار المغرب لعدة مرات منذ 1912)، وبول كلي* (إلى تونس عام 1914، ومصر عام 1928)، وأوجست ماك (مع بول كلي إلى تونس)، ودايرك ووترز (إلى المغرب في 1913)، وراوول دوفي* (إلى المغرب سنة 1925) وأوسكار كوكوشكا (إلى تونس والجزائر ومصر والشرق الأوسط بين 1928 و 1930)، وعدة فنانين آخرين مثل ه. بايير، ومارك شاجال*، ودو ستيل، الخ، حتى فناني الأجيال الحالية. وبلوحة "نساء الجزائر العاصمة حسب دولاكروا*" (مجموعة بيكاسو*)، كان بيكاسو يحتفي سنة 1955 بقرن كامل من الاستشراق في مجال التشكيل" (1).
تبعا لذلك، يظل الفن العربي الكلاسيكي، بشكل مّا، يخترق حداثتنا. فقيمة الفن ذي الأشكال الثابتة، الذي يخضع للرغبة في الخلود، لم تكفَّ عن بصم نظرة التشكيليين وذاكرتهم البصرية، كما لو تعلق الأمر بسفينة ثيزي Thésée التي يتم تغيير بعض عناصرها خلال الرحلة. وهذه التقنية المتمثلة في تغيير المنظور هي المبدأ الثاني لمنهجنا.
لهذا تشكل المعاصرة في ذاتها شبكة مكونة من عدة هويات تشكيلية. إنها نسيج من الصور والعلامات. لنأخذ مثلا "التجريدية" التي يتسم بها الفن العربي الإسلامي، والذي رسمنا ملامحه الأساسية. إن هذه التجريدية نابعة من حضارة للعلامة، حيث ظل الكتاب، بخطه وقوته الزخرفية، المعبد الكتابي الذي يمنح لكل معاينة visualisation أخرى معناها الفعلي؛ وهي بأشكالها الخالصة والهندسية، ليس لها نفس التاريخ ولا نفس التأليف الجمالي الذي يتميز به الفن التجريدي الغربي. فالنظر إلى العالم "بعيون" الكتاب والتوريق، يفترض فكرا متوحدا مع تلك الرغبة في الخلود. وقد أسرّ لنا بول فاليري، هو الذي تأمل في الحضارات وموتها، بما يلي عن الفن العربي الإسلامي: "إن المخيلة الاستنباطية الأكثر تحررا، والتي واءمت بشكل باهر بين الصرامة الجبرية ومبادئ الإسلام التي تحرم دينيا كل بحث عن محاكاة الكائنات في النظام التشكيلي، هي التي ابتكرت التوريق. وأنا أحب هذا التحريم. فهو يجرد الفن من عبادة الأصنام، ومن الخيالات الزائفة والحكي والاعتقاد الساذج ومحاكاة الطبيعة والحياة، أي من كل ما ليس خالصا ومن كل ما لا يكون خصبا بذاته، بحيث إنه يطور مصادره الباطنية، ويكتشف بذاته حدوده الخاصة، ساعيا إلى بناء نسق من الأشكال يكون مستنبطا فقط من الضرورة والحرية الواقعيين التي يقوم بإعمالهما"(2).
إن هذه الحضارة هي حضارة العلامة التي تغدو صورة، بينما الحضارة الأوروبية، منذ الإغريق، منحت الاستقلال للصورة في علاقتها بالعلامة وسلطتها، بالشكل نفسه الذي تحقق به ذلك قبلها في مصر الفرعونية، خاصة في مضمار النحت. إنه الاختلاف الحضاري الذي يحمل في طياته الإمكانات الإبداعية الخلاقة، كما يمكنه أن يغدو مجالا لاضطرابات الهوية إذا نحن انتقلنا من هذه التراث لذاك. ربما لم يكن الرجوع المنتظم للفن الإسلامي القديم من قِبل التشكيليين العرب (بل أيضا من قِبل فنانين عديدين غير عرب) كعنصر ومقطع من أعمالهم، فقط تعبيرا عن الحنين الانطوائي وتقديسا للرُّقع والأطلال؛ ربما كان ذلك الرجوع يخفي السر التشكيلي لكل حضارة تستمر، في موروثها البصري، في الحجب الدائم للحياة والموت بفن الأوهام. لكن ربما كان على الفنان أيضا أن يروّض الماضي وهو يبتكر المستقبل حتى يتجرد العمل الفني وينفلت من الزمن، وحتى يتسامى في سباته المغناطيسي عبر تلك الاستعادة الدائمة للزمن، التي تدعو إلى العمل والمحبة والمعاناة .إن كل فنان جدير بهذا الاسم، منذور إلى الوحدة والصمت والنظرة الجريحة.
بيد أن هذه العودة إلى التوريق والخط والعمارة والفسيفساء والفتنة العدنية للزربية يظل مصحوبا باكتشاف الفن الغربي وتجريديته. وهي عودة لا تمثل في حد ذاتها أمرا مستحسنا أو مستهجنا، وإنما هي وعد ورهان على تحويل الماضي وقواه الباطنية.
ثمة فنانون عرب آخرون تبنوا بشكل قاطع الفن الغربي من حيث هو كذلك، بتشخيصيته وتجريديته،، من غير اهتمام بالرهان الخفي للأصل والذاكرة الذي تفترضه استمرارية الحضارة في الزمن. فقد اكتسبوا المهارة والتقنية وقضايا التوقيع والسوق ورهان المعارض الدولية، وهي لعبة مرايا يجرب فيها كل فنان عربي حظه ويبيع أعماله. إنه يشارك في الحضارة العولمية لتفاعل العلامات intersigne، باعتبارها حضارة تقترح فيها الصورة والعلامة والتقنوعلوم مختبرا جديدا يتجاور ويتنافس فيها اللامادي مع حب الفنان التقديسي للمادة و للمواد والحوامل التقليدية .
إن ما يميز الفن الكلاسيكي العربي الإسلامي في هندسة البيوت والقصور والجوامع هو صفاء الأشكال وعراء الجدران التي تزينها زخرفة خفيفة . وفي الخط، يتبدى ذلك في الصفحة التي نجد فيها كتابة من درجة ثانية تمنح للنص تموجات بين فن الخط واللون والإنشاد الصامت الذي ينبثق من الورقة ومن الفضاء بكامله، كما لو كنا نقرأ من خلال ملفوظ النص حوارا بين صوت منحن هو صوت القارىء، ونظرة مترنمة، أو أيضا في المنمنمة، الإيهام المسطح حيث تغدو الشخصيات الموجّهة في فضاء من غير منظور، العلامات المتحركة والمتحولة للمادة نفسها، من ورق وحرير ومداد وألوان... وإذا كان ثمة العديد من الفنانين المفتونين بالخط الصيني الياباني والعربي، فذلك لأنه يغني مخيلتنا الفضائية، مجبرا خطية الكتابة على أن تصير أكثر حركية وأكثر انطلاقا. وقد أصاب كلود ليفي ستراوس بقوله بأن الموسيقى والخط يمتلكان خاصية تجريدية رائعة للفضاء/الزمن.
ويتمثل ما تمنحنا إياه هذه الفنون ذات الأشكال القارة أيضا في أوزان الشعر العربي، الذي ما فتئ نبره الغنائي يلهم الشعر الغنائي المتوسطي والأوروبي بدءا من الشعر العذري، وفي الترادف بين الكلمات المنشَدة والآلات الموسيقية الأولى المجلوبة من المشرق الخاضع لقاعدة القافية، باعتبار أن ذلك قد شكّل كشفا كبيرا بالنسبة للشعر الأوروبي في الفرون الوسطى.
ويعتبر التوريق طريقا آخر للتجريدية، أو بالأدق، لترجمة العلامة إلى صورة. فهنا، لسنا أمام وهم الطبيعة والجسم الإنساني الذي تمنحنا إياه المحاكاة، وإنما أمام الهندسي المتداخل مع العناصر النباتية والحيوانية. إنها هندسية مرتبطة بالترقيم الجبري الذي استخلصت منه، منذ القرن السابع، نقط وإعجام حروف الهجاء العربية، التي بني الخط فيها على ثلاث مبادئ بسيطة: الخط الأفقي للصوائت والصوامت والحركات الإعرابية. وانطلاقا من هذه القواعد، أصبح بإمكان يد الخطاط بلورة وارتجال لوحة علاماته، مثله في ذلك مثل الشاعر في علاقته بالوزن. ويستحضر الفنان الفلسطيني كمال بلاطة (المزداد سنة 1942) هذا الأمر حين يحلل العلاقة الخفية بين بلاغة اللغة العربية والتوريق، أي تصنيف الألفاظ حسب ثنائية الجذر وثلاثيته لدى النحاة، وتحويلها بالقلب والنقص والإضافة واستبدال الحروف، أي كل هذا التشجير للجسم اللساني الذي عليه ينبني التوريق. فما نسميه مثلا ومجازا توريق ماتيس لا أصل له في اللغة وتقسيمها إلى علامات مكتوبة، وإنما أساسه في فن الخط واللون، والانزلاق الدقيق بين مستويات التأليف.
وسوف يُدخِل الفن الحديث والمعاصر، سواء من صلب هذه الحضارة أو خارجها، معطيات جديدة إلى صلب هذه المكتسبات العتيدة التي لا نقوم هنا سوى برسم بعض منظوماتها الأساس. هل يوجد لدينا فعلا مجموعة متآلفة من الفنانين؟ فالعربي، في نظرنا هو ذلك الذي يقدم نفسه على أنه كذلك، هناك حيث يوجد، في مرسمه وفي طرف ما من أطراف المعمور، مهما كان أصله الجغرافي والديني والعرقي، ومهما كان بلده وأعماله نفسها. فهو باعتباره وريثا لموروث هائل وتراث يحظى بالقداسة، جاهليا وتوحيديا، يتساءل بقلق عن نسيج أصوله العربية والبربرية والإسلامية واليهودية والقبطية والفرعونية والآشورية والسومرية والكلدانية... الخ، باعتبارها صفات حضارية متنوعة طبعت هذه المنطقة بهذا القدر أو ذاك من القوة والاستمرار. بإمكاننا إذن أن نكتفي فقط بصفة "عربي" كما بإمكاننا أن نركب هوية اسمية أكثر تمفصلا: عربي بربري، عربي إسلامي، عربي يهودي، عربي مسيحي، عربي قبطي، وهكذا دواليك تبعا لقاموس غير مكتمل وشامل يعود بنا لتاريخ الفن الطويل الذي يهمنا هنا. وإذا ما نحن أضفنا الفنانين الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية فإننا سنقيم مدونة أكمل وأكثر معاصرة. فهذا الذي يعيش في برلين، وذاك في باريس والآخر في نيويورك... كلهم ينتمون بذلك إلى المجموعة الدولية للفنانين.
فالعربي هو ذلك الذي يقدم نفسه من حيث هو كذلك. وليس لدينا من معيار آخر غير الانتماء الموسوم والمعلن لهذه الحضارة التعددية، وطبعا للعمل الفني الذي هو مصير الفنان. كثيرون هم الفنانون الذين يسبغون على أنفسهم هذه الصفة. وبدل أن نعرض مقدمتنا للفن العربي المعاصر بلدا بلدا، تبعا للتوالي الزمني أو توالي الأسماء (لكن أين نقف آنذاك؟)، اخترنا جزافا منهجية متحركة، منصاعين لإيقاع فكري معين قادر على الإمساك بمواطن قوة الفن العربي المعاصر. لقد كتب بول فاليري عن كاميي كورو: "علينا دوما الاعتذار عن الحديث عن التشكيل". ما الذي سنقوله نحن، الذين علينا صياغة مقدمة لأعمال آلاف التشكيليين؟ فليعذر لنا الفنانون الذين سهونا عن ذكرهم منهجيتنا هذه، ومعها ربما ما قد ينقصنا من إمكانات توثيقية.
من الاستشراق الى الاستغراب
حين زار دولاكروا* المغرب سنة 1832، كان يُعتَبر في ذلك العصر مبتكر الحداثة. إنها حداثة مؤرخة، فقد شدّ اهتمامه لوقت طويل نور البلاد ومشاهد الحياة اليومية والعمارة والأشياء، ولم يفتأ يحلم بها حتى نهاية حياته. بيد أنه لم يهتم بحضارة البلاد المحلية ولا بمنظومات فنها. فما كان يلتقط، حين كان يشتغل على مذكرات سفره المرسومة، هي لعبة الأنوار والخطوط والأشكال الملائمة آنئذ للمشهدية الشاسعة التي سوف يبلورها في لوحاته الخالدة، بأسلوبه الجامح المنتزع من عنف الخارج. كان هوسه يتمثل في استنبات جوهر هذا العالم الغريب ومعطاه المباشر، بنوره وشخصياته ومواقعه ومشاهده، وتكييفها مع أجواء عمله الفني المتجدد. ولم يكن ذلك همّا من هموم بول كلي* وهنري ماتيس*، على سبيل المثال.
فما كان يثير اهتمام هذين الأخيرين هي الملامح الفنية لحضارة العلامة هذه، واستقلال اللون وقوة الزخرفة والخطاطات المعمارية والحيطان واستعمال المواد، والبعد الثنائي والتوازن بين التوازي واللاتوازي أو بين المنظورات المتعددة التي تنسج الفضاء، وهي عناصر سوف يجربان فاعليتها بدورهما ويمتلكانها ليدمجاها في أعمالهما. هكذا سوف يتم التفكير في التوريق ضمن سجل واحد هو الخط trait ، "فالتوريق، كما يقول برنار نويل، هو خط الحوافي. فهو يظهر لنا الشكل ليتركه مع ذلك فارغا. لكن هذا الفراغ يقترح بالمقابل الامتلاء".
إن أعجوبة التوريق تكمن في نهلها من خزان لا ينضب من الأشكال الهندسية والمتاهية. وإذا كان ذلك أكيدا فإنهما قد اعتبرا مع ذلك، وهو ما كتباه، تأليفا جديدا بين اللون والعلامة والمادة. فالجديد كان هو الآخر، والحضارات الأخرى، ونسق أشكالها، أي الفنون الصينية واليابانية والإسلامية والإفريقية.
والتنقيطية والتلطيخية التجريدية أو المنحى الهندسي في الفن كلها قائمة تشهد على هذا التقاطع الحضاري عبر الفن. وهو تقاطع من الخصوبة بحيث يبرهن لوحده على الحوار السري، لكن المرئي، بين المنتوجات الثقافية للإنسان. ففنان كغوستاف كليمت*، الذي تمارس عليه الوضعيات الشبقية للجسد والاستبدال المتوالي لزينته بقوة الزخرفي الأنثوي جاذبية خاصة، أو حركة النموذج والزخرفة التي تمتاز بها أعمال كوهنر وآخرين، سوف لن تنسى الممكنات التي لم يتم استكشافها بعد في تنويع المظاهر التي تحركها هذه القوى الزخرفية. فنحن نأخذ محمل الجد نسق الأشكال الزخرفية ومرصّعاته وسحره.
ما الذي كان يحدث في الجانب الآخر من المشهد بين الشرق والغرب؟ يقدم لنا جون كارزويل، أحد المختصين في هذا المضمار، معلومات قـيِّمة عن ظهور التشكيل الصباغي في المشرق، وذلك بفضل تجار الحرير الفارسيين. ويبدو أننا مَدينون لهم باستخدامهم لفنان هولندي لزخرفة بعض الكنائس بأصفهان في القرن السابع عشر(3). ومن ثم ينبع اهتمام الشاه عباس والسلطان العثماني محمد الثاني بالفن الأوروبي. بل أكثر من ذلك، أقام بلّيني0 في إسطنبول ورسم بها الصورة المشهورة لذاك السلطان. كانت تلك مرحلة مبادلات مكثفة بين الغرب والمشرق عرفت استيراد وتصدير التحف والأشياء الثمينة. وحسب الرحالة تونوفور، فقد "تم اكتشاف كل التحف الشرقية في الغرب، وغدت التحف الغربية عناصر زخرفية وتزيينية جديدة في المشرق". هكذا تم اكتشاف التشكيل في المشرق بفضل العثمانيين والأقلية الأرمينية المهاجرة في بلاد فارس. وقد ظل هذا التشكيل لمدة طويلة مكوّنا تزيينيا في البيوت والقصور الفخمة، مؤثرا بذلك على فن المنمنمات الشرقية قبل أن يصبح حرفة وفنا قائما بذاته، يتم تعليمه في المدارس المخصصة لذلك، كمدرسة الفنون الجميلة التي أسست بمصر سنة 1908.
وقد كان لهذه المبادلات في مجال التحف التزيينية نتيجتان أثرتا في المشرق: تطور التشكيل الأيقوني والتمثيلي (من صور شخصية ومناظر طبيعية) في الكنائس المحلية والبيوت والقصور البورجوازية آنذاك من جهة، والتأثير الواضح للتشكيل والفوتوغرافيا على المنمنمة العثمانية والفارسية. ويكفينا هنا ذكر اسمين: داوود قرم وخليل صليبا اللذين كانا رسامي بورتريهات أكاديمية ممتازين.
وهنا يكمن الاختلاف في التطور. ففي الحين الذي كان فيه الفن الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يبتكر حداثته، كان الشرق يدخل، عبر لعبة مرايا دائمة ومِدْواخة، في التشخيص ويعود باستمرار للتجريد. كان ذلك تجريدا مضطربا يندرج بين حضارة الصورة وحضارة العلامة. يجسد هذه المرحلة بعض الفنانين من أمثال النحات المصري الرائد محمود مختار (1891-1934)، ومحمود سعيد ومحمد ناجي المصريين أيضا، وكذا رسامو المنمنمات الجدد كالجزائري محمد راسم، والتونسي يحيى تركي، والفنانان العراقيان جواد سليم وفائق حسن، أو السوري إسماعيل عضام.
وفي 1938، شكل الشاعر جورج حنين والتشكيليون رمسيس يونان وفؤاد كامل وكامل التلمساني محموعة "الفن والحرية". وقد دخلت هذه المجموعة في تجربة سوريالية ذات أبعاد فنية وسياسية. وهو ما سنعود إليه لاحقا.
تحولات
لقد مثلت المنمنمة والأيقونة وتصويريتهما، والتشكيل على المسند chevalet والنحت ذو الطابع الأكاديمي ضربا من التصوير المزدوج bi-pictura الذي يأخذ لدى رسام المنمنمات الجزائري محمد راسم مثلا، وبفعل تدخل المسند، طابع تصوير مزدوج تتحاور فيه الحضارات. إنه حوار زخرفي تقوم فيه كل حضارة بحجب أو إعادة حجب الأخرى عبر فنانين من هنا وهناك، كل واحدة حسب نظام قيمها ومعتقداتها. بل هو حوار مرح في فراديسه الضائعة. فلماذا نحرم أنفسنا منه؟ لنقم، على سبيل التمثيل، بزيارة لأعمال محمد راسم.
إن هذه الأعمال عبارة عن احتفال مشتعل تترجمها حدة الألوان. إنها مشتعلة وأحيانا جموحة ومتنافرة وكئيبة؛ لكن ثمة يكمن سحرها، حيث يكون الأحمر والبرتقالي، باعتبارهما لوني النار، في أصل تركيبة من النبرات تدين بالكثير للمنمنمة التي درسها راسم على يد أبيه. فما يضيفه راسم في هذه التصاوير التي تشبه النذور الإسلامية، وهذه المشاهد الخرافية (انظر مثلا لوحة أسطول باربروس الشهيرة بالغواش على الورق)، وخاصة مشاهد الأزقة والمدينة، يتمثل في أنه يولّد من المنظور الخطي منظورا أكثر جوية، مما يمنح للمتفرج وهْم التجول من سطح منزل إلى آخر، مثلما نتجول في المدينة ونحن "نستمدن بها"**. هكذا يستبدل النظر سجله وطابقه، ويصعد أو ينزل بين القبب والصوامع والسطوح والباحات. ففي لوحة ليالي رمضان، يبدو أن إعلان الإفطار يحرر الحكي لدى راسم بشهيته في الألوان والشهوات البصرية.
ربما كان مجهود إنتاج العجائبي exotique الراقي قد أصيب اليوم بالعقم، بعد الحداد غير المكتمل الذي تمَّ إزاء فن المنمنمات العظيم الذي كان الواسطي (القرن 13 م) نموذجه الأكبر. أليست هذه السعادة الغامرة التي تنبعث من فن المنمنمات المتأخرة، والتي تبدو قيمتها مغالية، في
** يشتق المؤلف هنا من كلمة "médina" فعل " médiner " (م).
صلب قوة الزخرفة التي لا نستطيع القياس الكامل لدقائقها التشكيلية. إن لوحة الحرب البحرية لراسم لا تخلو من الجاذبية والعنف والمهارة التعبيرية التي وسمت ترصيع غوستاف كليمت* للجسد الأنثوي. فلدى الفنان المسلم محمد راسم تبدو المرأة منمنمة بشكل كامل ومزخرفة في زينتها. وبين هذا الفنان وذاك، من الجسد العاري المشخص والمتحول في أعمال فنان مدينة فيينّا إلى حجبه المحتشم في المنمنمة، تتبدى لعبة وضعية صورة المرأة في ملتقى الحضارات ونُظم أشكالها. وعلينا ألا ننسى أن المنمنمة الصينية والهندية والفارسية في العصور الكلاسيكية تحتوي على كنز من المشاهد الشبقية إن لم نقل أحيانا الماجنة (البرنوغرافية). فالمرأة نفسها يتم تناولها باعتبارها بهجة تشكيلية، يتماهى فيها الفن والرغبة في صراع شهواني تقوم فيه الوصيفات والغلمان والخصيان باللهو والمرح. فملامسة البصر لهذا الكنز من المنمنمات الذي يوجد بحوزة جـمّاعي الفنون، يمنح وقعا عاطفيا للعلامات والأشكال التي تجعلنا نحيا الفن الشبقي الماضي.
من جهة أخرى، فالأيقونة –سواء في الكنائس الشرقية أو خارجها- تعتبر صورة ورمزا وأمثولة allégorie وحكاية مناقب، أي عالما قائما بذاته منذورا للتأمل والصلاة، في صمتٍ تكون فيه الصورة جنب الإله وقديسيه.
وبعد أن كان الفنان السوري إلياس زيات (المولود سنة 1935) مُرمِّـما للأيقونات القديمة فهو، على غرار الفنانين المتخصصين في الأيقونة، قد تطورنحو اتجاه أيقوني جديد ذي طابع علماني وعربي منفتح على مكتسبات التجريد الأوروبي، محافظا على ما تتميز به الأيقونة من ثبات عمودي. ففي الأطفال والعصافير والمدينة (1971)، قام الفنان ببناء ثلاثية داخلية حيث كل عنصر مستقل يمثل مشهدا بكامله. ومن الأكيد أن هذا المنزع الأيقوني الجديد، في مواجهته للفن العالمي الحديث، قد ساعده في جمع شتات موروث الأجداد في داخله. وهكذا، فالأجداد لم يندثروا، بل ظلت آثارهم ماثلة حية وذاكرتهم تعيش بين الناس. ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على السينوغرافية المتكررة من قرن لآخر للثقافة الشعبية وإنتاجها للعلامات. وقد ظل الفنان العربي موسوما في عمقه بها، فهي تشكل حظه الفني ورهانه أمام إكراهات الماضي وتراثه الحي والمتواتر.
ويقوم الفنان السوري فاتح المدرس (المولود سنة 1922) بالتعامل مع هذه الأيقونة التي غدت دنيوية ونَظْما خالصا من الألوان، بتقسيمها إلى رقعة مربعات منسقة يذكرنا أسعد عرابي ببعدها الرمزي الجوهري: "تنبني الشخصية بين ملامح شبح مشخَّص ورسم علامة فتيشية تكاد تكون هندسية، وتشبه وجها غريبا تقع ملامحه بين البيولوجي والعقلاني، منحدرا من الثنائية الشهيرة للمربع والدائرة. تخط الدائرة الوجه الإنساني واستدارة القمر والشمس، وترسم في الآن نفسه الهلال الليلي وقرني ثور مقدس. أما المربع فيرمز بالمقابل للمذبح والمعبد والأرض والفضاء الافتراضي داخل الإطار. وعبر تراكب المربع والدائرة يتشذر الفضاء إلى حدود لانهائيةِ السّديم. وهنا تضيع البنية الإيقاعية في اللاتحدد والعرضي الزائل. وهنا أيضا يغدو التجريد معبرا ضروريا"(4).
لنتوقف عند هذا العمل الذي نستحضره على سبيل المثال. إنه عمل فنان متعدد الاهتمامات، باعتباره تشكيليا وكاتبا وموسيقيا. وفاتح المدرس يتحدث عن نفسه بوصفه حاسوبا شخصيا ومختبرا تتم فيه معالجة عواطف الفنان الأساسية من خلال منظومة نحوية من العلامات والمفاتيح السحرية. ويبدو أن المدينة الآرامية "معلولة" القابعة بين الجبال قد أغنت في ذاكرته البصرية نظرته ،ومن ثمَّ تصوره لتشكيل معمار تلك المدينة وتراتبيتها الكهنوتية المعلقة بين السماء والأرض.
إن شخصياته في الغالب منعزلة، وأحيانا مُدْمَجة في ما يشبه الخمّ ومحنطة، فيما تبدو شخصيات أخرى محيَّدة شيئا ما عن محورها، كما لو كانت تريد بحركتها أن تزعزع العمودية التجابهية عن مكانها وتتحرر في ذاكرتها العتيقة رموزا تمثلها الحضارة الآرامية.
يحدث أن لا تعرف المواجهة frontalité الإشباع عبر هذا التأليف المتراتب، وبدل ذلك أن تصبح مشبعة باللون وحده. فالراقص في لوحة الدرويش والغجر (1978)، بالرغم من كثرة ألوانه فهو يحيل على الصورة المظلمة والنظرة الفارغة اللذين يذكّران بسكينة الصوفي الجوال بعد دوخته وطوافه، الذي تتخلله الموسيقى والذكْر. كيف يمكن تمثيل الحب؟ أعني الحب بين الناس وبين الله والبشر؟
يبقى مع ذلك أننا نحلم من خلال هذا العمل، بالولع بالآثار الذي يسكن كل فنان، وبمشهد من الذاكرة حيث علينا تخليص الإنسان من السديم. آنذاك يظهر لدى هذا الفنان المتعدد الموضوعات نفس ساخر في حدّ الخط واللمسة اللونية؛ فيما وراء المنزع الثقافي والإحالة إلى بلده الأصلي و موروثه وحضارته العتيقة.
هذه المجاوزة للمنزع الثقافي، يستكشفها بكثير من السخرية واللطف التعبيري فنان سوري آخر (من مواليد 1934) يعيش في برلين هو مروان. وقد كتبنا عنه لتقديمه للجمهور الباريسي: "ليس ثمة في عمله من حنين برهاني، ولا من إحالات عجائبية. لا شيء غير صرامة التشكيل، سواء كان ذلك في لوحاته التشخيصية التي تعبر فيها الشخصيات، حين تكون حاضرة، عن وحدة قاتلة، أو في تلك السلسلة الملغزة من الدمى أو أيضا في تلك البورتريهات أو البورتريهات الشخصية التي تحكي قصة فنان أمام انعكاسات المرآة على وجهه وعينيه وملامحه"(5).
إنها أعمال مثيرة كانت في أصل الكثير من التعاليق. وقد صنفت أعماله في ثلاث مراحل: المرحلة التشخيصية، التي تلتها مرحلة الرؤوس المشاهد، ثم الدمى. كما تم الربط بين أعماله وأسماء من قبيل إدفار مونش وجورج بازليتز وشوينباك، والتأكيد على تعبيريته الخاصة، فيما أنشد الشاعر أدونيس، من جهته، الوجه وتحولاته في قلب الوجود. لنتوقف لحظة عند تلك المتوالية من الدمى.
يتعلق الأمر بدمية مقطبة ومكشرة تقوم بحركات صامتة، وتبتكر لنفسها الأوضاع والوضعيات. والمتوالية عبارة عن موكب من الكائنات البـُدّية (الفتيشية) التي يتم التعرف عليها الواحد بالعلاقة مع الأخرى، في حكاية تزداد انغلاقا بين الفنان والمسرح التشكيلي الذي يقدم مشهديته. أما البناء الدرامي فيجد مرتعه بين تعابير الوجه واللون، لكن الدراما بين الألوان هي التي تغدو الغالبة، إلى درجة تأخذ معها الدمية شكلها أمام المشهد تارة، أو تنمحي وتغيب في اللوحة أو الحفرية gravure تارة أخرى. أين تختفي إذن؟ أفي ما وراء المشهد حيث يقوم الفنان بتأملاته؟ إنه صمت المرسم من حيث ستنبثق سلسلة من الرؤوس والبورتريهات الشخصية . ثمة سلسلتان إذن، نخالهما زوجا من التشكيليين يتماسكان بالأيدي، أو مرآتين موضوعتين بشكل متواز تتماسّان في يد الفنان.
ربما كان من اللازم أن نوضح بأن هذا التشكيلي "غريب محترف" قام بزحزحة المنزع الثقافي من مكانه. ففي الفن، يتمثل الغريب المحترف في ابتكار عمله الفني باعتباره أرضا وذاكرة محمولة. إن مروان يمارس التشكيل بالشكل نفسه الذي يكتب به العربية، من اليمين إلى اليسار. وهذه الوجهة هي تخطيط الجسد. ومن هذا الموروث الفضائي يحتفظ بإيقاع معين، وذلك بموقعة عمله في الفن المعاصر "العالمي". هل هو يمارس العنف على نفسه؟ نعم، عبر كآبة رقيقة يمكننا تأملها في هذا الوجه/المنظر الذي رسمه سنة 1974، الذي ينقش برشاقة وقلق بالغين قدَر الفنان الذي أصبح علامة ولقاحا ومنظرا وتجاعيد وأشواكا وكآبة، وترابا وحجرا وأخاديد. والوجه في مجمله، في إعادة تجسيده ذاك، يحدق فينا بعمق ممهور بالارتياب.
إن إيثار اليمينية في التشكيل، والكتابة أو الرسم كما هو الأمر في الخط العربي، هو الملمح المميز لحضارة توجه نفسها تبعا لنمطها في إضفاء الطابع الفضائي على إدراك الأشياء والكائنات والزمن. وقد مارست هذه اليمينية التشكيلية جاذبية كبرى على العديد من الفنانين، كالأمريكي برايان جايزن، صديق وليام بورّو*، ذي الاهتمامات الفنية المتعددة، وفنان "الشرق "الممنوع"، الذي أقام بالمغرب من 1950 إلى 1973. فقد اكتشف هذا الأخير فن الخط الذي يمتاز به البلد وموسيقاه الشعبية وجاجوكة جبال الشمال. وبالرقة المضطربة للتخطيط، قام بتأليف ما يشبه الكتابة العربية، كما لو أن لغة الآخر وخياله عن العلامة كانا بالنسبة للفنان عودة للسحر البدئي للغة سابقة على الأمومة.
لقد كانت لعبة اللغة والتشكيل، والوجهة الفضائية وتأليفها في علامات غريبة أو يتم التظاهر بغرابتها، مصدرا لإلهام جان دوغوتيكس في سياق آخر يتعلق بفن الخط الياباني، الذي يدين ببنيته الأساس، كما نعلم، للخط الصيني. هكذا أقام دو غوتيكس ما سماه علامات فوق العلامات، أي لغة عمودية في البدء، ثم أفقية أو مؤلفة تأليفا تزامنيا.وقد اكتشف مجددا في الحركة المسكونة بالكتابة الرمزية idéographie عجائب الإيقاع الذي يحرك هذه الكتابة المشكلة صورا. وليس من قبيل الصدفة أن يكون فنانون من شمال أمريكا قبله، من قبيل جاكسون بولوك* ومارك طوبي* وغيرهما، قد دخلا في تجربة حركية مطلقة باضطراباتها ودوخاتها وإشراقات ألوانها المشدودة إلى قوة الحركة. إنها لحظة وجْد ينبثق فيها كل شيء في حلم يقظة، في إيقاع وارتجال يذكر بحركية موسيقى الجاز، خاصة وأن الجسد يقوي من دوره كوسيط بين الفنون.
اولوية العلامة
يقول بعض العارفين بأن ثمة ثلاثة نماذج كبرى للحضارات: حضارات الصورة (الحضارة الأوروبية وامتداداتها في أمريكا الشمالية والجنوبية)، وحضارات العلامة (الحضارة الهندية والصينية، والإسلامية التي تُقيم قوتُها الرمزية في القرآن باعتباره معبد الكتاب)، وحضارات الإيقاع، كالحضارة الإفريقية التي تتمتع بأسطوريات وتصورات عن أصل العالم رائعة لا تخلو من عبقرية تشكيلية، وهو ما ألهم فنانين مبدعين كبيكاسو وجياكوميتي*(6).
هذا التصنيف إذا كان يبسط الأمور، فله مع ذلك فضل إبراز بعض الاختلافات الحضارية. ولنأخذ فن الخط العربي. فالعلامة تحيل أولا على فن التخطيط الحروفي، وهو فن من العتاقة بحيث يضمن الديمومة والاستمرار الحضاري للكتاب.
ومع ذلك كثيرا ما نتناسى، حتى في عالم التشكيليين والرسامين، بأن فن الخط العربي مهارة تقنية متطورة جدا. فهو يمتلك سُنَنه وأساليبه وتقاليده الكبرى. وهو يكتب على حوامل متعددة، من رقّ وورق وحجر، أي على كل مادة قابلة لأن تحتضن تآليفه. وبما أن الخط كتابة من الدرجة الثانية، فهي تعمد إلى تحويل دلالة النص إلى زينة وزخرفة، مضعفة من مداخل ومخارج القراءة. فهي تمنح الحروف للقراءة معيدة نسج معاني النص وملفوظه. إن التوزيع الذي تقوم به للعلامات يدخل القارئ أو المتفرج في فضاء شعري ليس خطيا البتة، بل يقوم بتعليق مسار القراءة في جدول للعلامات ينمحي فيه التعارض بين الشكل والمحتوى وبين الدال والمدلول. إنه ينتظم لوحا آخر للقراءة، وفضاء غير محدد، منفصما بين الكتابة والحرية الخطية، وبين الخطية والتشكيل، إلى درجة: "يكف معها مسار الخط عن أن يكون هدفا في ذاته. لأنه إيقاع وحجم معا، والحركة الأولى لصورة آتية لا ريب فيها، إن آجلا أو عاجلا، هي العلامة. فمن خلال العلامة ينكشف الإنسان للامنتهى رغبته..."، كما يوضح ذلك فرانسوا شانغ. إنها سطوة رائعة لفن الخط على مستويين: فهو من جهة يقوم بتحويل اللغة إلى فضاء ذي حرية شعرية؛ وهو من جهة ثانية وفي الآن نفسه يقوم بإعادة تأليف الفضاء المجرّد لتحويله إلى أشكال زخرفية.
أما في التشكيل (أو أبداله)، فإن الخط يغير من مشهديته ومن سجلّه البصري. إنه يغدو متعلقا بالتأليف التصويري نفسه. وفي ما يهمنا هنا، فإن المجال شاسع جدا. فإذا نحن رغبنا في التحليل ولو المختزل لمسألة الحرف في الفن العربي المعاصر، فإننا سنتبين فيها سلسلة محدودة وإن قابلة للتوسيع. فقد كتبنا في مكان آخر ما يلي: "يمكننا التمييز في التشكيل الذي يستوحي مادته من اللغة العربية، عدا فن الخط بمعناه الحصري، بين ثلاث مستويات:
· الحرْفية الهندسية، حيث يبدو الفنان، انطلاقا من التشذير التشكيلي للحروف، مسكونا بحلم ترجمة تلاوة القرآن إلى صور. هكذا يغدو ما يشبه الأنشودة (أو الصلاة) مرئيا في الخط والحركة (انظر مثلا جزءا هاما من أعمال الإيراني الزندرودي).
· تجريد الخط المشكل: أي أن الحرف المتناضد على مساحة الألوان يعيد تخطيط اللوحة، ويمنحها من ثمة هويتها الثقافية وسمتها الحضارية المبتكِرة للعلامات (انظر أعمال العراقي شاكر حسن، أو أعمال منير، التشكيلي الحفري البنغلاديشي المقيم بلندن).
· الحرْفية الرمزية، حيث يغدو التشكيل مشهدية مشبعة بالعلامات والكتابات، من حروف عربية وبربرية تيفيناغ، وأرقام سحرية أو طلسمية.كما نجد في أعمال الجزائري رشيد قريشي اهتماما عجيبا بفنون الخط الصينية واليابانية.
· الحرْفية الزخرفية (وهي الأكثر تداولا)، حيث تخضع الكلمة أو الجملة أو النص إلى بناء مقروء يمثل الحرف المخطوط، وذلك استمرارا للتوريق والخط الكوفي بالأخص"(7).
يذكرنا جبرا إبراهيم جبرا كيف يقوم الفنان العراقي شاكر حسن (المولود سنة 1925) بتفتيت الحرف، وكيف يقوم فنانون آخرون بتحويل التمثيل التشخيصي إلى تأليف بين الحروف(8). كما قام التركي أمنتو جرنيزي بإخراج فيلم قصير شخصياته من حروف، وهو عبارة عن قصة حب وتماهٍ مطلق بين الإنسان والعلامة المكتوبة.
لكن الثورة التي قادها الفنان الإيراني الزنده رودي (المولود سنة 1937) ذات أهمية بالغة على مستويات عدة. فقد قام بتجذير رسم وتشكيل الحرف، وتطويعه لضرورات التخطيطية وإيقاعها، وللون ولهندسية إعجامية حركية، ثمة حيث تغدو شكلا خالصا، وتقدم نفسها في أشكال هندسية، وعبارة عن أرقام وخرائطية، وعن رموز وتمائم، بل وفتيشهات وشذرات حلمية، وفي شكل كلمات وحروف مستلهمة من التقليد الكتابي للفن الإسلامي. فالزنده رودي، باعتباره فنانا مسكونا بالتصوف، يعرف جيدا فن الخط قدر معرفته بالفن العالمي المعاصر.
إنها جرأة نادرة حقا؛ ذلك أن فن الخط الاحترافي عادة ما يتم تعويضه بأبدال له. والخط النسخي أو الكوفي ذو الهندسة الجامدة غالبا ما يستعملان كزخرفة مرسلة libre، بالشكل نفسه الذي نتحدث به عن "تشخيص مرسل"، خارج ضرورة المشابهة أو تناظر الأشكال. كما أن إتيل عدنان (المولودة سنة 1925)، وهي شاعرة وتشكيلية عاشقة للكتاب والكتب الجميلة، ترسم أو تمارس التشكيل بكتابة سريعة شخصية يمكننا قراءتها من خلال الشطبات الملونة التي تزخرف النص. وإذا كان النص مقروءا هنا، فذلك ليس هو الحال المعروف لتفتيت الحرف الخطي وملفوظه.
ويذكرنا بلند الحيدري، وهو مصدر معلوماتنا بهذا الصدد، بأن العديد من الفنانين كالعراقيين حسن المسعودي وسعيد الصكار وعثمان واقي الله، قد ظلوا أوفياء لتقاليد فن الخط، بمهاراته وتقنيته الملائمة ومقروئيته، واحترام الأساليب القديمة، بما فيها التأليفات الخطية.
ويعتبر كمال بلاطة في كتاباته النظرية، مستوحيا نماذج الكوفي بهندسته وثباته، بأن ثمة وحدة حميمة وصارمة بين الحرف العربي وشكل الرقم والتوريق. وقد أشرنا سابقا إلى النتائج التي يمكننا استخلاصها في تحليل أشكال الحضارة العربية الإسلامية (9).
بيد أن سياق هذا التقليد العظيم في فن الخط قد تغير. فقد تجرد الحرف من قداسته. وهو الأمر الذي يتجلى واضحا لدى العراقي رافع الناصري (المولود سنة 1940)، بتحويل شكل العلامات وتحويل الصفات الدينية المرتبطة بدلالاتها الأصلية.
هكذا يتعرض الحرف إلى تغييرات متعددة. فإما يتم إعادة تأليفه بعد تفتيته، كما هو الأمر لدى الفنان التونسي نجا مهداوي (من مواليد 1937)، أو أنه يتوالد بحيث يتكرر الحرف نفسه إلى ما لانهاية بغزارة وحيوية نجد أنفسنا معها أمام هوس بالعلامة المكتوبة المليئة حتى الإشباع والفارغة في الآن نفسه، كما هو الحال مع المغربي المهدي قطبي. هذا التضييق والوخز يبثه الجزائري رشيد قريشي (من مواليد 1947) بمحْورته حول وحدة كتابية تذكر بشكل ساطع بالكتابة الرمزية idéographieالصينية. إنها وحدة كتابية محاطة، تبعا للتآليف، بكتابة سريعة تشبه كتابة الفقهاء المغاربيين. وبما أن قريشي متأثر بتقاطع الحضارات الفنية، فإنه يجعلها تتحاور في نسيج من العلامات المكتوبة. إنه انفتاح نحو الآخر، مصحوب بعودة للينابيع المتمثلة في الكتابة البربرية تيفيناغ، التي يربطها أهل الاختصاص بالكتابة الليبية القديمة. فهو خط يجعل التشكيليين والفنانين يحلمون باللغة البربرية الأم. هذه العودة إلى العلامة ما قبل الإسلامية هي معطى من معطيات الذاكرة والنسيان نجده في كل حضارة. فهنالك، لدى المصري آدم حنين (المولود سنة 1929) ولدى آخرين غيره، تشتغل الإحالة إلى الفن الفرعوني والكتابة الهيروغليفية والنحت والعمارة معا. وهنالك في الأبعد، لدى اليمني علي الغداف، ثمة حروف الهجاء الحميرية وذكرى ملكة سبأ، أو أيضا في أعمال الكثير من الفنانين العراقيين، ذلك الحوار المفتوح مع الحضارة الآشورية والبابلية. إنها مسارات تستعيد الزمن، وضربٌ من الحكاية واقتفاء أثر الأصل خاصة وأن الأساطير، باعتبارها إبداعات جماعية، تشكل بالنسبة للفنان نوعا من المذكرة الحلمية.
إنها مذكرة تثرى بفضل الحوار مع حضارات أخرى نائية. ويصرح الفنان المغربي عبد الكبير ربيع (المولود سنة 1944) بأنه قد تعلم، من خلال التأمل في الفن الصيني والياباني، التأليف المتوازن والمستخلص بين الأبيض والأسود، والفراغ والامتلاء الذي يميز التشكيل الإيديوغرافي الرمزي. كما يوضح أن ليس ثمة من علاقة بين التعبير التجريدي قائلا: " حركتي انطلاقة وإيقاع وصلاة لأنها تبصّر، والإحساس بها عميق وامتلاكها كامل مكتمل". إنه أثر ذكرى البوذية الزين على هذا الفنان. فعملية التشكيل وصيرورة المرء موضوعا لعمله التشكيلي عملية واحدة.
ربما علينا أن نضيف أن هذه الاستعادة للزمن، باعتبارها أيضا توسعا حلميا في الفضاء، ذات طابع إشكالي أكيد. بل إن أحد الفنانين التشكيليين قد غامر بإنشاء بنايات معمارية في شكل حروف. لكن، ربما علينا أن نبني في المستقبل مخططا هندسيا لمدينة بكاملها في شكل رقعة ضامة بخط كوفي. وهي ستكون لا محالة مدينة كتابا.
إن فتنة المنزع الثقافي تتبدى هنا، فهي تنجم عن العودة إلى الأصول. لهذا يشتغل هؤلاء الفنانون إما بتفكيك هذا الموروث أو بإعادة تركيبه، لكن على حوامل مغايرة وتبعا لأنماط في التشكيل والرسم والحفر والسيريغرافيا مختلفة. من ثمة ينبع عائق آخر. وهو يتمثل في الشكل الذي يمنح للعمل، والذي يلزم أن يحيل على هذا الموروث ويتجاوزه في الآن نفسه من خلال التجديد المتوافق مع مكتسبات الحضارة العربية الإسلامية من جهة، ومع مبتكرات الفن المعاصر العالمي من جهة ثانية. إن ذلك الشكل يتطلب من هؤلاء الفنانين تجربة جديدة للجدارية muralité والمواجهة والتأليف بين الألوان، ولتدخل العلامات وأشباحها.
عمل الفنان العراقي ضياء العزاوي (من مواليد 1939) على تجاوز هذا العائق بطريقة أشبه بطريقة التكعيبيين، وذلك عبر هندسية يتم ضبطها من خلال إشراق الألوان والمشهدية الحركية: "فالحروف تتجمع في شكل دائري حول فضاء مركزي كعقد من الثعابين المتواشجة بدينامية، في حركة لها طابع الوجد والتشنج"(10).
يتحاور شاكر حسن مع الموروث في فن الخط بقوة الأثر والبصمة، المصحوبة بكتابات متنوعة على لوحة/جدار محزوزة ومرشوشة، تارة بنوع من المواجهة القاسية، وتارة بإدخال المنظور فيها بحيث تضطرب وتنصاع وتشطب. إنه اختبار لنموذجين في التجريدية نلمسهما، ويشكلان توحّدا بين الهوية الثقافية للفنان وخاصية الفن العالمي.
كثيرون هم الفنانون الذين تمارس عليهم العلامة المكتوبة جاذبية كبرى، باعتبارها شاهدا citation زخرفيا يتساكن مع تشخيصية مرسلة، طبيعانية أو ما فوق طبيعية (خرافات شعبية، أساطير، أماثيل allégoriess ...)، أو مع توابع تزيينية كالمقاطع العمرانية والفسيفسائية ورسوم الزرابي...
إن مسألة الاستشهاد القائم بين الحضارات المختلفة وبين أعمالها الفنية مسألة شاسعة. إنه حوار لا متناه، بل هو أيضا أساس كل فن. هكذا يمكننا وضع جنيالوجية للشاهد، وبإمكاننا أيضا وصف مراحله وتتبع الإحالات والتأثيرات والمحاكاة الجزئية. وسنكون قادرين، في التاريخ العالمي للفنون، على تشجيع إقامة مدونة ودائرة معارف مقارنة بين أنماط الشاهد. وفي هذا يكمن أساس علم جديد من اللازم تطويره، أي سيميائيات جامعة intersémiotique بمناهجها وأنظمتها الإحالية. ونحن هنا لا نقوم سوى برسم معالم هذه الفكرة.
وحتى نظل قريبين من الخيال الفعال للفنانين، نرى بأن الحلم التخطيطي المشتغل بين الحرف واللون والمادة، يتضمن تفاعلا بين العلامات المبَنْيَنة لحرية تداعيات الفنان وولعه بالأثر في روحه السحرية. والتخطيطية graphisme هي التي تمسك بالإيقاع المباشر لذاك السحر، وذلك في صيغة مبلورة سلفا. أما تلك التخطيطية فهي ارتجال تحت المراقبة تتبلور بتسلسل إيقاعي، بالشكل الذي تحقق به ذلك في مجال آخر هو المجال المتفرد لموسيقى الجاز.
هكذا يحدث لخطاط الحروف هذا أن يصاحب الكتابة بالألوان فوق ورقة تترنّم مساحتها وتتماوج في القراءة ومعزوفتها المتكونة من علامات مقطوعة عن دلالاتها. آنذاك يتلون نظر القارئ أو المتفرج الذي ينبثق في فورة الألوان هذه وجاذبيتها. وعبر هذه المقاربة يمكننا الإمساك الأفضل بالخطوط المتماوجة خلف اللوحة التي يرسمها فنان حركي بالشكل الذي نعنيه.
وفي فن الخط الفارسي كانت هذه التحولات للعلامات عميقة في إبداعها. فالكتاب شاهد من شواهد التشكيل، وإطاره يتغير في بعده، وحاملُه يتنفس بشكل مغاير من ورقة لأخرى. لقد كان فن الخط الفارسي وراء اضطراب وحيرة معنى القراءة، إذ رمى بها خارجه بطريقة يلزمنا معها لقراءة قصيدة أن نقلب الأوراق في وجهات متعددة. فقد أغنى التخطيط المعاصر الكتاب الدائري بابتكارات التشكيل المعاصر. هكذا تملأ يد مليحة أفنان (وهي فنانة لبنانية ولدت سنة 1935) الصفحة ملءً عبر حفرية الصفحة، ويقوم الفنان العراقي صلاح الجميّع (المولود سنة 1931) باستيحاء مخطوطات قديمة عبر استعمال الألوان المائية على الورق ومقاطع من الكتابة المسمارية، فيما يربط آخرون الحرف بالحركة التي تصفيه تارة وتارة أخرى تحيله على الغموض، وكل هذا يبين عن قيمة فن الخط وقوته الباهرة بوسائل متعددة.
بعض حضارات العلامة أرست قواعد لخلود هذا الفن عبر الطابع الهندسي المحسوس، الشفاف لكل المواد كما هو حال فن الخط العربي الإسلامي، أو عبر التوازن بين الفراغ والامتلاء كما هو الأمر في الخط الصيني والياباني. وهذه القواعد لا تزال حية مثلا في أعمال زاو ووكي Zao-Wouki ، وهو ما يمكن اعتباره علامة على الاستمرارية ومكتسبا كبيرا. بيد أن تطور الفن المعاصر في العالم العربي، فيما وراء الشاهد الزخرفي، يلاقي عائقين يحدّان من مدى العلامة: المنزع الثقافي والمنزع الشكلاني. لهذا السبب تستدعينا أعمال الفنان المغربي أحمد الشرقاوي (1934-1967) وتثير اهتمامنا. فقد منح للتشكيل العربي إشراقا فريدا عبر حركة فنية خاصة به.
ليس ثمة في أعمال الشرقاوي من تعبيرية تجريدية، ولا من لطْخية أو حركية وإنما ثمة صرامة الخطوط والعلامة التي تغدو شكلا ولونا. إنها وحدة في التأليف وتوازن ونقاء وتعديل مستمر للمجموع في أسلوب لم يكف عن التوضُّح فيما هو يعمق رهافته. وبما أن الشرقاوي اشتغل كاتبا عموميا بالدار البيضاء فقد خبر مهنة الخط المغربي وممكناته. لكنه في الستينيات دخل في بحث شكلي وكتابي تصويري متبلور جدا.
يعمد الشرقاوي إلى عزل مساحة قريبة من البيضاوية أو في شكل مستطيل، وهي ضرب من التخطيط الأحادي المركزي يستحيل أمام عين الناظر إلى لوحة داخل اللوحة، أي لعبة مرايا وتنويعات على العلامات والألوان والتغيرات المفترضة. وثمة أيضا تقنية أخرى تتمثل في قماش القنب المتراكب الذي يتماوج حتى حوافيه، فيمنح للوحة إيقاعا وتراكبا بين مستويين، ومعادلة من التناغم والاستبدالات المتوالية بين العلامات والتلاوين والمواد. تجري العين في هذا الفضاء، تتوقف، تأخذ وقتها أمام تحولات هذا الفضاء الذي هو نفسه والآخر. وثمة تكمن حرية الفن باعتباره استكشافا لرغباتنا الدفينة.
ليست الهندسية الرمزية والكتابية التصويرية التي تعتمدها أعماله هنا لكي تبهرنا، وإنما كي تلطف من انبهارنا. من ثمة يأتي ذلك النسيج وتلك الرؤية الملموسة التي تنبثق بخفة ورهافة بالغتين. ولنا أن نتخيل ما يلي: حين نجد أنفسنا في العتمة المدلهمة لغرفة ما، يكفي استلاب هذه اللوحة من الليل كي نستعيد الضوء. فالفن يخرج الإنسان من كارثته الأصلية، ويضعه مجددا في حركة فعل الحياة، يعيده للعبة العلامات والأشكال المتناسجة مع حركة الجسد وحكاية حياته، كما حكاية بقائه على قيد الحياة. إن الأمر يتعلق في أعمال الشرقاوي بالتحولات النورانية.
بعد مرحلة أكثر عتمة (1962-1964) يعمل الشرقاوي على تلطيف شغب الألوان (تلاوين الأحمر الغامق، والأغمر والبنفسجي، والأسمر الممهور بالأخضر الغامق وبأزرق النيلة) بخفة لا تقاوم. هكذا يحقق الفنان حالة المواجهة عبر حرقها من الداخل بخطوط ناضحة سميكة، ممحْورا توازن المجموع حول المساحة المحدودة، باعتبارها بنية وشكلا وعلامة ولونا في الآن نفسه. وعن طريق أثر التوالد الحلمي تظل اللوحة بكاملها مفتوحة على كل الدلالات والتمثيلات، بما فيها تلك المتعلقة بالبورتريهات والوجوه والمناظر، من دون أن ننسى تمثيل الحيواني السحري. هكذا يمتلئ المشهد حركة حين يعطل الفنان السم القاتل بإيقاع اللون في لوحة رقصة الثعبان (1964)، أو في الحنفية الحمراء (1964) وباب الفتح (أيضا سنة 1964)، وهي أبواب تدخل منها الألوان البهيجة وتخرج، فيما يعمد الفنان إلى تحويل الشارع إلى جدار وحيد من الألوان. أو كما يتم ذلك في لوحة محبة القطط (1964)، وهي حيوانات نعرف نظرتها المغناطيسية، وقفزتها المطاطية في رغبة الفنانين وحركتهم. وبذلك يتابع الشرقاوي عملية بحث صارمة، بصرامة تستهدف الالتقاط والإمساك. إنه لا يمثل لأي شيء تبعا لمبدأ المشابهة، وإنما تبعا لنقل علامة نحو أخرى، تاركا للنظرة حرية ممارسة أحلام يقظتها النشيطة.
يتعلق الأمر هنا بتوحّد بين المواجهة والحركة. وهو ما تشهد عليه اللوحات الغواشية المرسومة على شرائح الخشب contre-plqué كمرايا (1965)حيث يهيمن اللون الخبازي البنفسجي والرمادي المزرق على هذه المرحلة. وبذلك يغدو اللون هو الغالب، ملتحما بشكل صميم، لكنه في الآن نفسه يبدو كما لو كان منتزعا من الأشكال الهندسية والوحدات التخطيطية ومن عناوين تلك اللوحات الغواشية نفسها.
في لوحات الشرقاوي عدد محدود من الأشكال التخطيطية، بحيث استعملها استعمالا مضبوطا. وفي منحى آخر يقوم الفنان التونسي قويدر التريكي (المولود سنة 1947) بتعميم تطبيقها. فسواء كان التريكي يرسم أو يحفر على الورق فهو يظل دائما خطاطا مصورا (بكتوغرافيّا) يمارس الكتابة التصويرية بشكل كامل. لكن ما هي البكتوغرافيا؟ إنها في معناها الأولي الذي يمنحها لها المؤرخون، كتابة من الإشارات تبث للغائبين هذا الخبر المهم أو ذاك الذي يتعلق بحياتهم اليومية. وفي معنى ثان، فهي تنتمي أصلا لفن الخط trait ، وإلى لاتحدد أصلي بين الرسم والكتابة. إنها كتابة عتيقة، تحتفظ في ذاكرتها بتخطيطات الهيروغليفيا والكتابة التصويرية الصينية واليابانية. وبفضل هذه الكتابات استطاعت الحضارة الصينية والفرعونية، كل منها حسب نسق أشكالها، الإمساك بسر القدرة على انتشال وحدتها المحاكاتية من التمثيل التشخيصي. فقد حولتا المكتوب إلى تصاوير، تارة ذات طابع تجريدي وأخرى ذات طابع إشاري تعييني. إنه سَنَن لتبسيط ومفْهَمة الواقع والمتخيل، إلى درجة تغدو معها الكتابة المرسومة (البكتوغرافيا) مدخلا لفن الخط والتشكيل في الآن نفسه.
إن الكتابة التصويرية للفنانين، كما هو حال قويدر التريكي أو ميشو، ترتجل العلامات وتغازلها، محركة إياها في زمن المرتجلة أو التأمل المشجع على حلم اليقظة النشيط. ويتمثل معجمها التصويري في أشكال إنسانية وحيوانية ونباتية تتناسل وتتكاثر عبر العدوى الحلمية. لكن كما هو حال بعض أنواع الموسيقى، تلك عناصر أساسية يطرز عليها الفنان العلامة ويقطعها وينتقص منها ويفصلها ويدفعها إلى التوالد، في ما يشبه الدعوة إلى الترحال.
فالخطاط التصويري هو بالتأكيد حاكي عالم ساحر وحنيني. إنها حكاية بلا بداية ولا نهاية، تمنح لنا هنا في وِجهاتها المتعددة في الفضاء وفي تنويعات مختلفة تمسك بها العين حسب متعتها. وإذا كانت ألف ليلة وليلة تسري بتمازج قصصها، فإن التريكي يفك التمازج ويعزل العناصر بعضها عن بعض ويمسرحها، ويعيد تأليف المشهد المتْعي والتكرار بأناة وصبر. إن الخطاط التصويري يكرر العناصر التصويرية نفسها وينوعها بحثا عن سعادة بسيطة، فذلك سعي وجودي على حدّ البراءة والجرح. آنذاك يحلم بيده بالشكل نفسه الذي نحلم به بأعيننا.
يقترح علينا فنان تونسي آخر هو محمد بن مفتاح (من مواليد 1946)، وهو رسام وحفار ذو حساسية كبرى تجاه المادة، عنقودا من العلامات والوحدات الخطية، يلفها ويبنيها في شكل متاهة. والحال أن الدخول في المتاهة أصعب من الخروج منها. فالمتاهة صورة مركزية من صور الفن عموما ومن الحياة باعتبارها شبكات مكثفة من التعقيدات. لا يختار المرء أن يكون متاهيا(11)، لكن تردُّد اليد (التي تقوم بالرسم أو الحفر هنا) تقودك وتدلك على الطريق، أي على طرق متعددة في الآن نفسه. هكذا نتعرف هنا على صورة شمس، وهناك على صورة عين ، وهنالك على شبح حيوان، لكن تلك التمظهرات لا تلبث أن يختطفها المنطق السادر للعلامة الكبرى، التي لا تتبع إلا هواها وتتركنا تحت رحمة سلطانها.
هذا العنقود من العلامات (كإحالة للموروث الشعبي) توجهه مليحة أفنان تبعا لخط منكسر ومضطرب بحيث يترك الورقة تنساب مع نفسها.
إن العالم الحلمي للكتابات والتخطيط على الجدران graffiti في الأحياء الشعبية يعتبر مختبرا للمعيِّنات الاجتماعية. فقد شكلت دائما تضعيفا للزخرفة الداخلية للبيوتات الفخمة. إنها لسان حال العامة والمنبوذين والصامتين والمحرومين من مفهوم الكتاب والتشكيل. تعلمنا تلك المعيّنات كيفية إدراك الفن الذي ينزل للشارع، خارج المتاحف ووسط صخب الحياة. وليس من قبيل الصدفة أن يقوم بعض الفنانين المعاصرين بترويض التخطيط على الجدران من خلال استعادته لحسابهم الخاص. فقد شكلوا منه لوحات وحفريات، ومشْهدوه خارج ساحة معركته. من لا يعرف بمدينة فاس ظهور واختفاء ذلك الشخص الغريب المسمى عبد الله غريّو، الذي بعد أن بصم حيطان المدينة وأشجارها بتخاطيطه وكتاباته ترك المدينة مثل مختلس للعلامات، لم يمسك التحقيق (الفني والبوليسي) منها غير آثار آيلة للانمحاء.
بيد أن علاقة الفنان الجزائري محجوب بنبلة (المولود عام 1946) بصورة العلامة علاقة مغايرة، فهو يعالجها بحوامل متنوعة بائدة إلى هذا الحد أو ذاك، لكن تأكيدا بألوان غاية في الإشراق، وغالبا على مساحات كبرى. وهو نفسه يتحدث عن "كتاباته التشكيلية". ما الذي تعنيه هذه العبارة؟ هل تحيل إلى شيء آخر غير ما يتحقق في فن الخط؟ لنقل بأن الفنان يبعث برسالة لم تعد تنتمي إلى مجال المقروء. هل هي كتابة لا تحمل إمكانية القراءة ؟ نعم، وأكثر من ذلك.
وإذا كان يتم هنا تفعيل المكتوب graphie في دفعة هندسية وتشكيلية خالصة، فعلينا تبديل المنظور، وتتبع الإنتاج المتعدد للعلامات ومشهد تناسلها المفرط. إنه تناسل يملأ الفضاء حتى حوافي الإطار، بحيث نجد أنفسنا أمام حفل للبصر ممتلئ وجْدا وحـمّى. وما أن يمر الانطباع الذي يخلفه أثر الدّوار هذا، حتى نبدأ في التفكير في تلك الطاقة الأرضية التي تفرضها على ذهننا، وعلى روح بصرنا. ثم ما تلبث العين أن تتوقف طويلا عند عنصر من عناصر اللوحة ، وعند هذه العلامة أو تلك لنتعرف عليها باعتبارها ذكرى، ثم تتحرك العين نحو عنصر آخر لا يستوحي غير حركة الفنان، إلى درجة نجد أنفسنا معها أمام مذكرة نفك فيها بعض العلامات، وهي علامات آتية من بعيد، من قلب ثقافة جهوية، بوفرة طلاسمها، وآثارها ونقوشها الزخرفية، ووفرة أخاييل الرسوم المنسوجة. هذه المذكرة، باعتبارها دليل الهوية الرمزية، يتم الزجّ بها بشكل مستمر ومتجدد في لعبة التنقل والتحول. إنها ذاكرة في طور التشكل والتحول، وسرعة وآلة لإنتاج العلامة. فهي ليست كتابة تصويرية بالرغم من حضورها الأكيد، بل ليست فن خط بالمعنى الحصري، وإنما هي انطباع لبنية متحركة تتماوج، أي أن الدوار الاصطناعي الذي تنتجه تلك الآثار وسرعتها يجعل اهتمام الناظر يتجه نحو لامكانٍ ليس له بعد من تسمية.
هذا اللامكان هو ضرب من الطوباوية تغدو فيه راحة الفنان بسهولة ذات بعد فردوسي. إنها حيوية بالغة تعيشها العلامة وعملية بنائها واجتماع شملها من لون لآخر بنوع من الإكراه. هكذا يعشق بن بلة المادة في حالة تحول وامتلاء. فمن أولى أوراق لف السجائر إلى الشوارع المبلطة بباريس-روبي التي كلّف بزخرفتها، لا يزال فناننا مستمرا في استكشاف عدد كبير ومتنوع من الحوامل والمواد. وها هو يخرج إلى قارعة الطريق، ناذرا نفسه للقوة التقنية وللضوء والريح في هذا المشهد الطبيعي. بيد أن الطبيعة تمتلك وتتصرف، فيما يكتفي الفنان بالاقتراح. إنه يترك الآثار التي غالبا ما تمحوها الطبيعة، وهو يبني أعمالا فنية تعمل الحياة على تغيير ملامحها. ويتساءل م-ج برنار بصدد الفنان الجزائري محمد خدة (1930-1991)، وهو فنان متعدد التوجهات ومعروف بتخطيطاته: "كيف للإنسان أن يمارس التشكيل بالرغم من وجود الحياة؟"(12). هل يتعلق الأمر بواجب أم برغبة مجروحة؟ كيف السبيل إلى ممارسة التشكيل من غير أن يتحول المرء إلى قربان؟
المتفردون في الفن
يقال عنه إنه فن ساذج وعفوي، وأساسي وشعبي، إن لم يكن فنا بدائيا أو عتاقيا وغريزيا. إن فن الارتجال هذا يدعونا لأن ننظر إليه ونفكه بالشكل الذي يقدم لنا به نفسه، سواء كانت له خصائص السحر أو العجب العجاب أو اختزل نفسه في الترداد والاجترار.
قد يحدث لنا أن نفتتن بتصاوير هذا الفن، الذي يمتلك قيمة تكون في الغالب هشة، مثل طفل لا يرغب في أن ينمو ويكبر، يرى أمامه ألوان العالم تتناثر على يديه فيصاب بالبهجة والحبور. ومن ثم تنبع تلك الدهشة الناجمة عن ضرورة السهر في إغفاءة خفيفة في الفردوس المفقود والبدايات الساذجة للفن.
لكن هذه المقاربة تظل محدودة وبالغة الاختزالية. وعلينا أن نلائم بينها وبين هذا الفن الذي، مع ذلك، يسعى إلى التحويل transfigurer بطريقته الخاصة. إنه تحويل عجائبي كما هو الأمر لدى الجزائرية بايا (المولودة سنة 1931)، والتي حظيت أعمالها بإعجاب الكاتب الفرنسي أندري بروتون. فقد اكتشف بروطون في هذه الأعمال، بدل التداعي الحرّ الذي يحدد الشعر السوريالي في أساسه الأصلي، تداعيا للأشكال والألوان يشكل في لاوعي الفنانة آثارا أصلية عتيقة معادلة لذكرى من ذكريات الجنة. بيد أنها جنة لحقت بها بعض الرتوشات انطلاقا من مسار حياة امرأة تنزَّلت، كما يقال، من السماء.
من ثم تنبع تلك النباتات والحيوانات الأسطورية، وتلك النساء المرتديات أزياء منسوجة بالزهور، وتلك الفساتين والأشياء الجميلة التي تزين الحياة بشكل فردوسي. إن هذه الحرية المجنحة التي تذكرنا بعالم الملائكة وقد تحول إلى علامات، تحكي خرافة وأمثولة وذكرى دفينة، وقصة استيهامية، بالشكل الذي تصوغها به وتغير ذبذباتها حاكية مسحورة. إنها حكاية تلامس اللون، وتحلم به نابعا من الأنامل، كمادة ننقلها حتى أبواب البصر. الملامسة بالنظرة، والفتنة بالنسيان، والانفصام: إنها "الملِكة، الملكة التي تمسك بالغصن الذهبي"، كما يعترف بذلك أندريه بروتون. هكذا يتخبل الشاعر يوتوبيا أو بالأحرى لامكانا**، تجمدت فيه حركة العالم في صفاء أصلي حيث كل شيء يمكنه أن يستعيد البدء من جديد: "وهاهو شبح بايا الكهنوتي، المرسوم على قماش ابن عذراء المستقبل، وهي تنزع عن وجهها جزءا من الحجاب، لتكتشف ما هو عليه العالم الجديد الموحد والمتناغم والمحب لذاته. نعم، صحيح أن يدها لا تزال مسلحة. ولا يمكن النفي بأن عُدَّتها من العجائب والمستحضرات والمصائر تتنازع العجائبية مع مستحضرات العطور التي تحبل بها ألف ليلة وليلة. فالرغبة الإنسانية لديها في طورها الخالص، لا تقبل بأي عائق أمام الإشباع، ناذرة نفسها بلا قيود للتحقق. واليد التي تمسك بالبلّورة الموشورية، تراها وهي تصدأ وتتجه نحو العشب والإبرة محمولة في ذلك على مصير غائر في الزمن" (13).
وقد صرحت بايا قائلة: "حين أمارس التشكيل أكون سعيدة. أحس نفسي في عالم آخر وأنسى كل شيء". التشكيل ونسيان كل شيء هو أحد أسرار الفن ومُتَعه. وحين اشتغلت في فالّوريس على النحت، كان يزورها بيكاسو* ، الذي كان يأتي بدوره لينسى جنبها عمله الذي يشغله وقلقه المستديم: تلك كانت عملية بناء وتفكيك التشكيل المعاصر. وهي حكاية تحمل عبرة على شاكلة الحكاية الملائكية.
هذا اللقاء بين الفن المسمى ساذجا والفن الحديث قد تمت إثارته أيضا بخصوص حركة كوبرا*، وبصدد الفنانة المغربية الشعيبية (المولودة سنة 1929)، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية قد خلفت آثارها، وكان فيه أعضاء هذه الحركة الفنية العالمية قد تشتتوا منذ زمن.
لنذكر بأن الشعيبية ذات الأصول القروية كانت عرافة. وعوض أن تكشف الأوراق، بدأت في التلوين. وفي إحدى الليالي عاشت حلما تقول عنه: "لقد حلمت هناك، في الغرفة المجاورة التي تفضي إلى الحديقة. كنت في بيتي، وكانت السماء زرقاء ومدرعة بالأعلام التي تصفق مع الرياح، كما لو كان ثمة عاصفة. وكان ثمة شموع منيرة تنتشر من الغرفة التي كنت بها حتى الحديقة بكاملها. انفتح الباب، ودخل رجال متلفعون بالأبيض، وقدموا لي قماشا وريشات. كان من بينهم شباب وعجوزان بلحيتين طويلتين. ثم قالوا لي: "من هنا فصاعدا هذا هو مصدر قوتك". كيف كنت أكسب قوتي وقتها؟ ما هي حظوظ وممكنات امرأة أمية؟ أنت تضحكينني.
-------
** هنا يلعب المؤلف على الجناس بين كلمتي: utopie وa-topie (م).
كنت أقوم بأعمال البيوت، وتنظيف الغسيل وتلميع الأرضية. لكني كنت أقوم بجدية بمهمتي تلك. ثم جاءني ذاك الحلم. وفي الغد قصصت حلمي على أختي. وقد كان علي تحقيقه. وفي اليوم الموالى، توجهت إلى المدينة القديمة، واشتريت الصباغة، الصباغة التي تستعمل لصبغ الأبواب، لم يكن الأمر مهما. المهم كان بالنسبة لي هو الخلق والإبداع، والبدء في العمل والإنجاز. وكان لابني طلال استوديو، وقد رأيته فيه يمارس التشكيل"(14).
لم تكن الشعيبية ترسم "الواقع" كما قال الناقد أندريه لود عن هذه الفنانة من الشعب، ذلك أن التشكيل يكون دائما ترجمة، ونقلا متقاطعا بين الفعل وصياغة الشكل والإمساك الخفي بقوى الخارج، وهو ما تجعل منه الشعيبية لعبة أوراق. وفي الحقيقة، فإن الشعيبية تشتغل على الألوان وتحولها إلى رسوم وكتابة تصويرية. وثمَّ تكمن متعتها.
إن هذه الوحدة في المساحة بين العلامة والخط، يحققها مغربي آخر هو مولاي أحمد الإدريسي (1923-1973) بشكل رائع. فهذا التلويني العجيب، والأخ البصري لروثكو*، مؤلف يملك بساطة تشكيلية لا تخلو من جرأة. فخلف المشاهد اليومية، ثمة دائما خطاطة خرافة أو أسطورة. ونحن معجبون لديه بذلك التواضع الجم، والحس الإنساني والصفاء المسكون بالرغبة في الجوهري. وذلك هو شغف كل فنان، أي أن يبني من أجل متعتنا المفارقة عوالم خلود هاربة. فالفنان يسعى إلى تحويل الصور لا إلى التصوير والتمثيل، وذلك بفضل التنويع في المظاهر التي تنسجها العلامة والشكل واللون والمادة. والواقع الذي يتماوج في طرف عينيه هو أوّلا واقعه، بعاطفيته وحسيته المشدودة في الغالب إلى الحنين والكآبة وجاذبية الوحدة. "فالإبداع يقاوم الموت بإعادة ابتكار الحياة، وهو ما يسمى بعثا"، كما يقول الفيلسوف مشيل سيرّ.
لقد تم في الغالب اختزال هذا الفن المسمى "ساذجا" في الغرابة والعجائبية، والنظر إليه كما لو كان ضربا من الدمى الروسية؛ فتارة يستخرج منه البدائي، وأخرى الأحمق، وطورا الطفل المتخلف عقليا. وبهذا، فهو يعتبر صندوق عجائب إثنولوجي، يمكن من العودة إلى أسطورة "الهمجي الطيب" العزيزة على جان جاك روسو. بيد أننا نعلم، منذ اكتشاف الفنون الزنجية، بأن هذا الفن كان بشكل كبير وراء ابتكار الحداثة في مجال النحت والتشكيل.
تنتمي ثلاثية الإثنولوجيا التقليدية (الطفل-البدائي-الأحمق) إلى معارف عن الإنسان وحضارات ولّى زمنها. فدوار "الأحمق" يعتبر الآن هو نفسه حاملا للإبداع والابتكار.
ذلك هو أمر الفنان المغربي عباس صلادي (1950-1995) الذي ظل يسكنه السديم. فالدخول في السديم يفترض تغييرا عجيبا في توازن المشهد الذي تحوله إلى حلم إن لم يكن إلى كابوس أمامنا. إن أعمال صلادي تحمل عنف الظل. إنها تحتمي وراء حجاب من الوحدة والتوحد، وهو ما شكل جدارا متحركا، يجد الفنان المتكىء عليه، بضربة صنوج، في الجانب الآخر من الحياة، في قلب مسكن الـمُفْرَدين. ومدينة مراكش لا تزال ماثلة هناك كي تضيعنا في ذاكرتها ومتاهتها وجُزَيْئات سعادتها. مدينة يأتي منها عائد من عوالم أخرى كي يستدعينا لذكرا ه.
ونحن لا نزال نتذكره كرجل هجره الزمن. فكما عاش كان يعيش في أعماله التشكيلية. وما أن ينقطع عن الرسم حتى يستبد به الصرع مرة أخرى. ظل صامتا ومنقطعا عن الحركة بحيث كان من اللازم الرجوع معه إلى فجر الكلام. كلامه كان مثل تشكيله، جوهريا وحلميا. كان يمارس الحلم سواء تحدث أو أحجم عن الكلام. أعماله التشكيلية، التي تبدو في الظاهر حكائية، تصور خرافات وحكايات سحرة بطلاسمها ومدنها الخيالية، وهي هندسات معمارية لا تجد مشروعيتها إلا في ذهنية مسحورة فعلا بنقطة اقترانها العاطفية والعجيبة. فكل شيء يتبدى في لحظة بصر.
عن التجريد
النقد الفني سَنَنٌ تكون تدريجيا تبعا للتطورات التي عرفها تاريخ الفن والجماليات الفلسفية والأدبية كما لدى هيجل وبودلير. وتعتبر ألفاظ من قبيل "التمثيل" والتشخيص" و"التجريد" ألفاظها الأساسية، مثلها مثل تصنيف الفن إلى عصور ومراحل... وخلف هذا السَّنن ثمة عمل الفنان (حين يكون جديرا بهذا الاسم) وفرادته، المنتمية تاريخيا إلى هذه الحضارة أو تلك، أو إلى تقاطع لتجارب ثقافية مختلفة. لهذا تفصح العبارة الشائعة "الفن العالمي" عن لبس بيِّن. فهي تحيل في الظاهر إلى الهوية، وإلى تعريف مجموعة من الفنانين الذين يتجاوزون الحدود القطرية. بيد أننا إذا تمعنّا في هذه المجموعة من الفنانين فإننا سنجد أنها تتوزع ضرورةً إلى فرديات تتقارب في ما بينها غير أنها تظل غير قابلة للجمع في مفهوم واحد. ففي كل عمل فني يفرض نفسه، يتعلق الرهان بالأصالة المحددة والحصرية للفنان وبأسلوبه وموقعه الاجتماعي. ففي الوحدة التي تسم تلك التجربة، يستمر العمل الفني في الانتماء إلى فضاء حضاري معين. وهو لا يصبح عالميا إلا في هذه الشروط، وبما يفرضه السوق.
لقد اخترنا مسارا موجها ونحن نتناول مسألة "التجريد" تبعا للمنظومات المرجعية paradigmes للفن العربي الإسلامي، وذلك قصد أن نقدم للقارئ تحليلا ملائما لرهانات "الفن العربي المعاصر". وقد ذكرنا أن هذا الفن يفترض مرجعا يتمثل في حضارة العلامة التي تملك قيمة سامية وموروثا رفيعا. لهذا فقد تركت بصمات واضحة على التشكيليين الغربيين المشهورين، الذين يعتبرون المؤسسين الفعليين للحداثة. وقد أبنّا عن خصائص الفن العربي الإسلامي ونسق أشكاله، المتمثلة في قوة الجوانب الزخرفية، واستقلال اللون، وتصويرية المنمنمات المبنية من غير اعتماد على تقنية المنظور، والهندسية المطلقة، هذا فيما أن "التجريدية" في الغرب كانت منتهى لتحول حضاري مغاير: "لقد نشأ العمل الفني والصورة غير التشخيصية بعد سلسلة مدهشة من التفكيك، والتخلي المتتالي عن المرجعيات التي نهض عليها الفن الأوروبي منذ قرون، أو على الأقل التيار المهيمن داخله. فقد تم التخلي أولا عن الجمال، الذي لا يمكن تصوره إلا داخل فلسفة شاملة أو ديانة معينة، ثم عن مفهمة الفضاء عبر نظام المنظور الذي لم يعد يمارس أي جاذبية على الفنانين، وعن تنظيم إدراك الألوان، وعن المحيط الضوئي، والضوء الطبيعي والضوء الاصطناعي (الكهربائي)، وأخيرا انفتاح المتحف على كل الأساليب وكل العصور وفي كل مكان من المعمور، بحيث هبت على العالم الفني الغربي موجة عاتية من الصور أغرقته في لـجّتها"(15).
تعود فكرة "المتحف" وتاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر. ويعود ذلك إلى ما توارثته العائلات الأرستقراطية والبورجوازية من تحف وأشياء جميلة. أما في العالم الإسلامي فإن الورثة يحوزون أيضا على الحلي والمجوهرات والكتب، وتظل المنقولات لذلك غير معروفة عند غير مالكيها. وعن هذا "الكتمان" نجم تبذير موروث ذي قيمة نادرة، وتشتته بين متاحف أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان غنية أخرى. وهكذا تم تصنيف الأشياء الجميلة المنقولة من الحضارة الإسلامية في أقسام "الفنون الجميلة" أو المتاحف الإثنوغرافية ومتاحف الحضارات العجائبية. فهذه القسمة التي تسم مواطن الفن جاءت على الصورة التي اقتسم بها العالم.
ثمة إذن مدخل مزدوج لعالم هذه الحضارة. المدخل المفضي إلى تراثها وحضارتها ومنظومات فنها، من جهة؛ والمدخل الذي من خلاله ظهر فيه الفن غير التشخيصي في العالم العربي بعد أن تبلور سابقا في الغرب، من غير أن يتلاشى الاستشراق التصويري الأوروبي ومنزعه الأكاديمي وحبه العجائبي.
وسوف تتغير الوضعية حين تم إنشاء مجموعة الفن والحرية سنة 1938 من قِبل الكاتب المصري جورج حنين (1914-1973) برفقة الفنانين التشكيليين رمسيس يونان (1913-1966) وفؤاد كمال (1919-1973) وكامل التلمساني (1910-1962)؛ لكن أيضا برفقة كتاب آخرين كألبير كوسّيري وهنري كورييل وإدمون جابيس. وقد نفثتت هذه المجموعة دينامية خاصة في الحياة الثقافية والفنية، من خلال المقالات والمجلات والكتب المصورة والمعارض والمحاضرات والبيانات المعادية للامتثالية. كما غذّت المجموعة ميولا خاصة للاستفزاز وتقاليد الفوضوية، وتسييس قومي ويساري في الآن نفسه. فقد امتزج الفن بالسياسة، وهو ما جعل من هذه المجموعة مؤشرا للثورة.
وحين ظهر هذا التوجه السوريالي، الأصيل والهامشي في الآن ذاته، في الحياة العامة المصرية، كان الفن الأوروبي قد تطور حثيثا نحو أسلوب غير تشخيصي منهجي ونحو تفكيك نشيط. كان هذا التفكيك، الذي فكّ أوصال نظام التمثيل عبر هزات عنيفة، يقترح على المتفرج في ذلك الوقت عالما جديدا من العلامات والتقنيات التجريبية التي لا يلزم أن ننسى أنها كانت تصاحب التاريخ الممزق لأوروبا وشرعيتها. هل كان الأمر يتعلق بسوء تفاهم؟ ألم تقم مجموعة "الفن والحرية" فقط، عبر المحاكاة، بإعادة إنتاج التداعي الحر بين الكلمات والصور الذي كان عزيزا على السوريالية في سنواتها الأولى؟ نعم، من دون شك، فقد استمر رمسيس يونان، وهو أحد أعضاء المجموعة المؤسسين، في طريقه ذاك: "فإذا كانت أعماله قد تطورت، بين 1938 و1966 من التشخيصية المتمردة على طريقة فريدي، نحو عفوية غير تشخيصية، فإن الانطباعية التي تبدو مهيمنة لأول وهلة على لوحاته في السنوات العشر الأولى لا يلزمها أن تموه على المتفرج. فقد ظل نفس تيار الرفض والحرية مستمرا خلف المظهر. فسواء لديه أو لدى جورج حنين "لا يوجد إلا ما ليس له من اسم""(16).
وسوف تعمل إنجي أفلاطون (1924-1989)، وهي تلميذة للتلمساني، على تحقيق هذا الاتحاد المحلوم به بين الفن والتمرد السياسي. وقد مكنها الاعتقال، حسب زعْمها (وعلينا تصديقها)، من الاشتغال أفضل على لعبة الأنوار. إن جعل الاعتقال رافعا لتحويل وتطوير العمل الفني يعتبر درسا من الدروس الكبرى للحياة، والتزاما مطلقا في الفن تجسده تقاليد الانشقاق التي يمكننا أن نذكر الأمثلة المشهورة منها كساد وجان جوني. تنتظم مناظر إنجي أفلاطون برشاقة وميل نحو المنمنة، وتشبيك الرسم واللون على خلفية موحدة. هذه الأعمال ذات المنزع النسوي واليساري والمسلحة بثقافة كونية تعتبر في الآن نفسه راهنة ولازمنية في بلد مثل مصر يتهدد الاندثار أعمدة حضارته العتيقة.
في الخمسينيات والستينيات، كان تكوين الفنانين يتمّ إما في القلّة القليلة من المدارس الوطنية للفنون الجميلة أو في الخارج، ولا سيما في أوروبا الغربية والشرقية. وعن الفنانين الذين تلقوا تكوينهم بالخارج والذين يعتبر بعضهم من أهم الفنانين العرب، يمكننا القول بأن الفن، في جميع الأحوال، ظل وطنا لهم. بل إن استقرارهم النهائي في البلدان المستقبلة لهم، أو رجوع بعضهم الآخر إلى البلد، أو أيضا الترحال بين الوطن والخارج، هي عبارة** وتعبير للأعمال الفنية عن تنقلاتها من المرسم إلى الأروقة، إلى المجموعات الخاصة، ثم المتاحف. فالعمل الفني يرحل في الزمن والمكان مصحوبا بذاكرته المحمولة. وأنا الذي أكتب هذا النص، أقتفي أثر بعض تحولات الفن التجريدي تبعا لطريق يخضع لمسيرٍ مضلّع. لنتابع.
----------
** والعبارة عُبور كما يقول ابن عربي (م).
يقال بأن شفيق عبود (المولود سنة 1926)، الذي ارتاد مرسم فرنان ليجي*، وأندري الحوت وآخرين، ينتمي لمدرسة باريس. لكنه، فيما وراء هذا الانتماء، يمتلك أسلوبه الخاص الذي يجد مرجعيته في ما بعد الحرب وابتكاراتها. فالتجريد الذي نتحدث عنه موقف ذهني وفعل يعيد هيكلة العلاقة بين المرئي واللامرئي.
يبلور هذا الفن نظرة معزولة عن الواقع تجعل الروح في موقع المترجم والواهب للأشكال والعلامات على المساحة المتموجة للعالم الحي. إنه خط للهروب في اندفاعة التاريخ، وفي هذه الحالة علينا التذكير بأن ذلك كان بعد الحرب العالمية الثانية.
كثيرة هي الحركات التي وجدت أصلها في ابتكارات كاندانسكي* وبول كلي* وموندريان* ومالفيتش* وماتيس* ودولونيي*، فيما كان الأمريكيون يكتشفون في بلادهم، بحماسة وحتى الدّوار، الحرية الحركية أو حرية الفن اللامتحدد informel ، ومنحى تجريديا يدين بالكثير لفن الخط الصيني والياباني.
هكذا سوف يتم حوار مزدوج مع حضارات أخرى وأنظمة أشكالها. ففي جانب، كان هناك في أوروبا منحى تجريدي يمكن اعتباره منظورا ذهنيا في خدمة إنتاج المصطنع، ذو طابع لهْوي ومفكك لعالم التمثيل القديم، ومن جانب آخر ثمة الحرية الممنوحة للتجريبيين ومستكشفي الحدود القصوى بين الشكل واللاشكل، والشيء وحطامه، والعمل الفني وانمحائه، والمواد وأبدالها السحرية، والفن الحركي وانفلاتاته... لكن بين عنصري هذا المشهد الفائر، يوجد فن تجريدي يسير في اتجاهات غامضة كثيرة، إلى درجة سمعنا معها من أفواه مفكرين كبار بأن الفن حرفة آيلة للموت.
ولد شفيق عبود، بشكل ما، في ملتقى الطرق هذا. ففي لعبة الطفل (1961) مثلا، فإن لمسة النظر، الذي يملك رؤية لمسية، تبدو محمولة على توازن بين النبرات والتناغمات، مانحة لهذه اللوحة إشراقا يظل اللون محتفظا بمقياسه. وهو الإشراق الذي يبدو بديهيا في أعماله الأخيرة.
ولأن أعمال الفنان الجزائري عبد الله بنعنتر (المولود سنة 1931) مرتبطة أصلا بالتجريد الحركي السائد في الستينيات، قبل أن تتطور باتجاه أسلوب مستقبلي وتجريبي، فإنها تمتاز باستمرارية رائعة. فقد امتلك هذا الفنان بعض مكتسبات التجريدية الغربية بسعادة غامرة، باعتباره حفارا ورساما ومصورا لأكثر من سبعين كتابا فاخرا مهداة لشعراء مرموقين. إن طقس الكتاب والتنويرية هذا موروث عن حضارته. وقد ظل واقعا تحت فتنته مثله في ذلك مثل الكثير من الفنانين التشكيليين العرب.
بيد أن بنعنتر يتحدث أيضا عن نور من نوع آخر، أي عن نور محلي تستضيء به جهة معينة ومواقع ومناظر معينة. إنها لفكرة رائعة أن يقوم بشخْصنة الضوء الطبيعي والإقامة فيه باعتباره شعاعا متحولا. وبالرغم من أن بنعنتر ولد بالجزائر فإنه يعشق منطقة بروطانيا الفرنسية. وهو ما تجسده اللوحة المتعددة المسماة الفصول الأربعة. ثمة مناظر طبيعية ونباتات وحيوانات وشخصيات محجّبة جامدة، وكل شيء يتم في تلوين تتحكم في جموحه وتسلسله في الآن ذاته قوة منظمة ونيرة تسكن جسد الفنان ومويْجاته الحسية.
حين يقوم فنان ميتَّم من وطنه بإعادة بنائه في منطقة نور تنسجها ممارسة اللون، فإن الطبيعة تكشف خلف كل مظهر جذاب من مشهدها قيم الرموز السرية والهوية التعليمية. ومن حينها يبدأ النظر المتأمل لهذه اللوحة أو تلك في السعي إلى الترحال خارج الزمن، انطلاقا من انطباعاته الأولية. ونحن نعتقد أن اللون الأكثر تمزقا والأكثر اجتراحا يحافظ على تأليف أخير يزرع في غرائزنا أو يخاط عليها. وثمة يكمن لغز الفن الذي يصطدم باستعصائه "التجريد" و"التشخيص" معا: إلى أي حد تملك الطبيعة والفن، انطلاقا من ألفتهما، نفس الإنتاج للأشكال؟ ولقد اعتقد الفنانون والمفكرون لزمن طويل في هذا المماهاة، لكن نظام الطبيعة وفوضاها منذوران بالمقابل لقوى الصمت. وربما كان تشكيل الصمت، فيما تحت الصمت الحقيقة الهوجاء للفن.
وعلى كل حال، فإن كل فنان يبدأ من جديد كما لو كان ملاكا منفيا في هالة النور. وبهذا الصدد تدعونا مونيك بوشي، بعمقها الشاعري، إلى تأمل سلسلة الزائرات لبنعنتر: "أحيانا، وبالرغم من عتمة الليل، تصل الزائرة الملهمة إلى مرتبة جمال لا يضاهى، وأحيانا أخرى تبدو الكتلة المقشرة كما لو أنها تتماوج، فيصبح التشكيل خفيفا وهوائيا، بمنحدرات مفضضة بنعومة العسل. كل شيء مشع، واللمسة الحركية تمسك بالنور عبر عصارات راتنجية نباتية حمراء قانية، فتنمو الأشكال بجلالة رائعة ورشاقة كبرى يحيط بها الغموض كما لو كانت أشخاصا عزيزة علينا نجهل في العمق حياتهم. وهذا ما يبدو بجلاء في الزائرات السوابع، حيث تتدخل الثنائية بقوة بين رقة الشخصيات المجتمعة في نصف دائرة تحيل إلى صخور منطقة "بيل إيل" بفرنسا، وكأن الأمر يتعلق باجتماع سري، والالتواء والتمطُّط المرضي للشكلين اللذين يتحركان فوقها"(17).
فمنذ أكثر من نصف قرن والفنان العربي الحديث لا يكف عن تملك تراثه ونظام أشكاله ومعه بعض مكتسبات الفن التجريدي العالمي. وهو أحيانا يستدرج نفسه نحو تجريدية ذات طابع غربي، حيث لا أولوية للعلامة ولا عودة للأقانيم التقليدية. لقد عنون الفنان التونسي رفيق الكامل (المولود سنة 1944) أعماله لسنة 1987: تحويلات. التحويل انطلاقا من تقنية التغطية، وبما أن الخلفية ذات لون واحد فإنها تصعد إلى السطح، هنا وهناك، في تأليف دينامي، يترجم الألوان والأشكال إلى عوارض قاطعة.
إن عبود وبنعنتر وآخرين من الذين سنعود إليهم، عشاق للاستقلالية المحسوسة للون. وقد كانت هذه الاستقلالية في الغرب عبارة عن فتح تدريجي، وذلك عبر أعمال غوغان* وفان غوخ* وسيزان* والانطباعيين. أما في المجال الحضاري العربي الإسلامي فإن تلك الاستقلالية تندرج في نسق من الأشكال وتعادل التنويع في المظاهر التي تتلاعب بها قوى الزخرفية من خلال الهندسية المطلقة وأشكالها التوريقية ذات المنحى المتاهي.
لم ينمح هذا النسق أبدا، فهو يعود إلينا في أعمال الفنانين العرب المعاصرين، متحولا ومجاورا لأنساق أخرى من الأشكال.
لنتوقف عند التجريدية الهندسية التي يتم التعبير عنها بعناصر متعددة، كالمويْجة والمربع السحري، والمضلع النجمي، وأشكال أخرى مستقاة من الفسيفساء والمعمار وفن الخط والفنون والـحِرف.
لكن في ما وراء هذه العودة إلى التراث المتسمة بهذا القدر أو ذاك من المرح، قام فنانون معينون ببناء نظامهم المرجعي الخاص. وربما كان الفنان اللبناني صليبا الدويهي (المولود سنة 1912)، الأول الذي فتح الطريق نحو فن هندسي صارم، مغتنٍ بمؤثرات جديدة. إن ممارسته للفن الجداري وللزجاجيات، التي تحتفظ كما نعلم ببعض أسرار اللاهوت والتصوف، وعشقه للوحات الكبرى التي يمتد على مساحتها لون طاغٍ لا يكف عن صياغة عصابات رقيقة في جوانبها، كل هذا التمازج الصميم بين اللون والهندسية، وبين التناوبات النبرية والمفارقات اللونية جعلت غاستون دييل يصرح، هو العارف بفنون الحضارات الأخرى: "يكفينا أن نستعيد باختصار جوهر أبحاثه المستمرة المتمثلة في تقطيعاته الطموحة، التي لا يمكن لمظهرها الشامخ إلا أن يقنعنا، وضروب ألوانه الفخمة وذات الطابع الشخصي العميق، المستعملة بوجاهة كي تشد البصر من أول نظرة، وتحويلاته الرمزية المتدرجة الهادفة إلى بلوغ جوهر إدراكي مؤثر في كل الناس. ولنضف أيضا الممكنات التي يقترح قصد زرع جوهر فن الخط العربي التقليدي في إطار مبنْين وملوّن يتغيا هنا أيضا كما في أبحاثه الأخرى، الانفتاح على العالمية"(18).
لكن التشكيل المتعرج للمغربي محمد المليحي (المولود سنة 1936) من طبيعة أخرى. ثمة المويجة والمويجة على الدوام، بالرغم من أنه قد استدعى، في الستينيات، سلسلة من المربعات الصغيرة باعتبارها تمارين في الإيقاع بين الهندسية واللون، ملتحمة في الحركة نفسها. ربما كان علينا أن نذكر بأن هذه الهندسية التي يتحدث عنها الفنان بعبارات تنتمي للتصوف الياباني (زين) مسكونة بقوى الزخرفية النابعة من الفن العربي الإسلامي، سواء منه الأرستقراطي أو الشعبي. فهو وريث لها بالشكل نفسه الذي كان به تلميذا للحركة البصرية (بريدج رايلي) في الستينيات. فالهندسية، باعتبارها بناء ذهنيا، تشكل بقوتها الخاصة موطنا روحيا (كما نظَّر لذلك فاسيلي كاندانسكي*)، هناك حيث يبصر العقل برسم الروح.
إن هذه الهندسية الحسية هي منحى من مناحي النزعة البنائية constructivisme التي يمكنها أن تراهن على أحد عناصر هذا التشكيل كاللون أو العلامة أو الشكل المتوالي أو خصائص المادة. وتكون البنائية هادئة أو محايدة حين تبرز تأليفا حصريا وواضحا، إما ذا صبغة هندسية أو سيميائية. وعادة ما يصنف هذا التوجه ضمن الزخرفية وفي إطار الفن الزخرفي التزويقي. وهو ينصاع لهذا التصنيف، كما أنه أمر معتاد في السريغرافيا. إن نمط تأليفه ذو طابع مواجهة، بحيث يكشف للناظر عن شكله ومضمونه في التناظم نفسه للعناصر التي تكونه. وسوف نسمي بنائية دينامية الوضعية التي يُبين فيها التأليف عن نفسه تارة، وتارة أخرى يتوارى عن النظر. لنأخذ مثلا بنائية الفنان المغربي فريد بلكاهية (المولود سنة 1934). إنها أعمال رائعة لفنان بحّاثة، مرتبط بالاستقلال الخيميائي للمادة، مستكشف الفنون الاستعمالية ومعها الفضاء اللامحدد بين التشكيل والنحت. يواجه بلكاهية النحاس، ثم الجلد المبسوط على ألواح خشبية، بطاقة كبرى بحيث إن شفافيتها القليلة المعالجة تقنيا تلطّف بعض الشيء من حدتها وتوترها. وهو يزخرفها بالعلامات والرموز والشعاريات الرمزية والأشكال الواضحة وعناصر منسية من الكتابة التصويرية والتخاطيط الجنسية أو الكوكبية. إنها مذكرة يستخدمها الفنان كتصاوير وأحلام يقظة على آثار لها طابع النماذج المتخيلة العتيقة، فيصنع منها صورا مفككة puzzle أو متوالية من الصور، حيث يكون اللاعب (أي الفنان) في الآن نفسه جزءا من اللعبة . أما شخصيته البانية للصور الرمزية فهي التي تقوم بمشْهَدة نفسها وقد تحولت إلى بُدٍّ بفعل كثرة أقنعتها. إنه يرمي أيضا بنفسه في مهاوي الخطر، عبر تطويع صلابة المادة وتكييفها بشكل منهجي مع طاقته الخاصة، ومع الأشكال التي تتألف وتتفكك أمامكم. كل شيء هنا معطى للنظر من غير تحفظ. واللون (بتنويعاته المغراء والحمراء والصفراء والصهباء والسوداء والزرقاء أيضا) محاكاة لألاعيب جسد الفنان وحبه المنصاغ في تحولات المادة.
وعلينا أن نذكر هنا أعمال الفنانة الفرنسية المغربية نجية المحاجي (المولودة سنة 1950). إنها تتابع بحثها عبر تجريدية هندسية مؤسلبة حتى يغدو الرسم البياني خالصا برموزه العتيقة، المصرية والإغريقية والمتوسطية. إنه تشكيل بالغ التقنية، فهي تأمّلٌ في الصمت الذي تجسده تنويعات الصور الهندسية باعتبارها مظاهر للنظام والكمال والمعمارية الحسية ذات الأبعاد الرفيعة. وبين الراقصة التي كانتها، والفنانة التشكيلية المرموقة التي أصبحت، ثمة سر هيروغليفي ينطبع على أثر خطوة راقصة حركية. إنها هندسة متحركة. صمتا، ولنعاود الكَرَّة.
أما التحويلات التي تحدثنا عنها بصدد بلكاهية، فيحققها بشكل دقيق الفنان المصري آدم حنين (المولود سنة 1929) بين ورق البردي والتمثال، من خلال الحجر والبرونز والجبص. ربما لم نكن على وعي كامل بأننا فقدنا السر القديم لصناعة ورق البردي. والآن تتم صناعته بطرق حديثة. من ثم نجد في أعمال حنين ذلك النسيج ذا الألياف المتشابكة، والمظهر المحبَّب، الذي وهو يمتص اللون المائي (من كستنائي وأزرق نيلي، وأخضر وأحمر خاثر وأصفر كبريتي...) يزج بنا في تناغم متجانس بين النبرات الدافئة. وبهذا الصدد يصرح الشاعر الفرنسي ألان بوسكي: "ثمة إحساس بالهشاشة المدموغة وذات المدى لطويل، كما لو أن كل ورقة قد تأكْسَدت بفعل توالي القرون. إنه فن مكتمل ومتكامل".
إن بنائية آدم حنين تنظم اللون المبلل بهذه الطريقة مع أطياف شمسية تتراصف بشكل مائل أو بشكل متواز. فينبثق إحساس بالتوازن والاستقرار والصمت والأبدية الهاربة من تراصف المساحات هذه، حيث تتسلل خفية هذه العلامة أو تلك النابعة من ذاكرة تليدة. إن هذا التحويل يكون فاعلا أيضا في التماثيل الصغيرة للفنان التي تستوحي التراث الفرعوني، والتي تأخذ تارة طابعا تجريديا وأخرى تشخيصيا، لكن من غير أن تتخلى عن بساطتها وصفائها، تبعا لأسلوب إقلالي minimaliste في الشكل والبنية المرتكزة على قواعد ومكعبات وأسطوانات. فبفضل تلك التماثيل الصغيرة نتمكن من استعادة زمن الفراعنة. من سيقول لنا يوما من الذي يسكن الآخر، هل هو الكائن الحي أم شبح الميت الصامت المنبعث من قلب الصحراء الكبرى؟
فشبح الميت هو ضيف ذاكرتنا، وهو يأتي ليسكن علاقتنا بالماضي وبالتراث، هناك حيث يوجد ذلك الإحساس بالفراغ الذي يعيد فيه الفنان، في عزلته، إقامة الحوار غير المكتمل أبدا مع الأجداد.
وما حققه آدم حنين في النحت، مقارنة مع التشكيل، تقوم به الفنانة الأردنية منى السعودي (المولودة سنة 1945) في النحت مقارنة مع فن العمارة (في المدينة العربية)، من حيث هو نحت عتيق وشامل. إن اعتماد هذه النحاتة المتميزة على مواد متنوعة، من الحجر الجيري الوردي لإربيد حتى رخام كارّار كي ينهض تمثالها على قاعدة من الأشكال والأساطير، يظهر كيف تضع امرأة مسلمة موهبتها في خدمة خيال مادي فعلي وحداثة ابتكارية، متماشية مع التحولات العميقة التي تخترق المجتمعات العربية. ونحن الذين نمارس الكتابة بالحديث عن النحت، علينا أن نحس بأن كل كلمة مطالبة بالتلاؤم مع الشكل الأندروجيني الذي تنظمه منى السعودي بطريقتها الخاصة باتجاه الملمس اللين للحجر.
لنتابع عرضنا للفن التجريدي مغيرين منظورنا، لا بالعلاقة هذه المرة مع البنائية والنسيجية، وإنما بالعلاقة مع الإيقاع، حيث يتم تعليق البناء بالحركة وارتجالاتها البينة. وما اكتشفه فن الخط العربي، تبعا لسَنَنه الخاضع لقيم القياس والتوازن، لم يكن سوى تجريد محسوب الأبعاد ومتحرر من التمثيل على فضاء افتراضي، تقترحه هذه الجملة الشهيرة لفكتور هوغو: "الشكل هو المضمون الذي يصعد إلى السطح".
في الحركة كما في التجريدية الحركية يجرب التأليف حظه بين اللاشكل والشكل. ويتمثل الرهان في التحكم اللحظي في سيادة الاعتباط الذي يتهدد العمل الفني باستمرار، لمعانقة قوة الحركة التي تترجم نفسها بين الانطباعات الأساسية (الإحساسات) والتحويلات الهندسيية والأشكال المتحركة. يقال عن الفنان المغربي الجيلالي الغرباوي (1930_1971) بأنه فنان حركي، أي فنان مشدود إلى الرؤية المباشرة والدوار والعاصفة، والدخول السريع في اندفاعية الألوان. هكذا هو يحول ألمه (الذي كان عميقا وكبيرا) إلى صور و"تجريد غنائي"، إلى درجة غدا معها المكروه الذي صاحبه واضحا أمام أعيننا. إنه تحول يتحقق بفضل ملاءمة فورية بين الرؤية والحركة واللون. وفي لوحاته الغواشية على الورق، نظل معجبين بالقوة الجامحة والصمت المخملي، والطقوس السحرية للصدفة والتخلص من وطأة الفتنة، والعافية التشكيلية المنفصلة عن الماضي. وبهذا الصدد قال الغرباوي: "لقد شكل التراث بالنسبة لي رافدا بصريا أكيدا. فلا يمكننا أن ننفلت من بيئتنا. لكننا لا يمكننا دائما وصف ما نحمله في داخلنا. لقد ظل عملي الشخصي دائما مجهودا باتجاه المجاوزة. وبإمكان تجربتي أن تخدم أيضا الصانع والفنان الحديث".
هذه الخطوة نحو الحداثة، خارج التعارض الهلامي بين التراث والحداثة التطورية، يعبر عنها الفنان المغربي محمد القاسمي (المولود سنة 1942) بقوة. "أنا أفك وأكتب بالمقلوب التوريقات والزخارف النباتية والعقدة التجريدية للإسلامي". إنها مطالب فنان ذي موهبة كبرى ومثقف بالمعنى الكامل، انطلاقا من موطنه، لتدويل الفن. لتتصوروا إنسانا يرسم ويمارس التشكيل والكتابة ويستكشف، انطلاقا من تعدديته الفنية تلك، الممكنات الجديدة للوحة والجدار أيضا والمنشآت والأعلام على شاطئ المحيط الأطلسي، إلى درجة لا يمكننا إلا أن نفكر معها هنا بصورة الأطلانط، وهي صورة أسطورية قد ننساها حين يجد هذا الفنان نفسه يواجه بانتظام مفهومين لوصف هذا النشاط القوي، التي رأى البعض أنها تقترب من تيار الفعل التشكيلي (Action Painting ) الأمريكية وكاهنها الأكبر جاكسون بولوك*. بيد أن القاسمي يظل مهووسا بمسعاه الخاص، باعتباره بحثا عن الحد والأثر، وهما مفهومان أساسيان لديه.
وعن الحدّ، نستطيع القول إنه يشتغل داخل وخارج هذا الفضاء التشكيلي. وحين يجمع بين المحلولات الكيميائية وضروب الخضاب كي يخلق خيالا ماديا نشيطا، فما يجمع بينها بهذا الشكل هي بالتأكيد الآثار المدهشة لمادة محترقة يتحرك وسطها الجسد، لكن أيضا الأمكنة التي يتجذر فيها الإيروس من جديد ويستعيد فيها مرتكزاته واستقراره المتحرك، وقدراته الروحية المفكرة. الحدّ هو ما يشد الفنان إلى هويته وقد تحولت إلى صورة وعلامة ومفهوم. وعلينا متابعة انكسار هذه الطاقة بلمحة بصر. فكل شيء فيها أثر: الذاكرة والموروث البصري والكتابة، ووسم الحركة وإيقاعها القاطع المتراكب فرشة على الأخرى، وذلك حتى نهاية اللوحة، أي بدئها من جديد في مكان آخر صامت: "يتمثل عمل الفنان من دون شك عبر أفعاله المتتالية، في تحويل كل لوحة إلى فضاء تنوسم فيه الآثار وتنمحي، حيث تستمر في الوجود متحجرات الأصول، وحيث تتحرك الألوان والدلالات والفرشات اللونية (مثل كثبان رملية). وقد تأتي أحيانا (من حيث لا ندري) رياح لكنس الفضاء التصويري" (جلبير لاسكو).
أما أعمال الفنان المغربي فؤاد بلامين (المولود سنة 1950) فهي أكثر تركيزا على المادة ولعبة الذاكرة التي تفرزها في حياة الفنان. وبعد أن كانت ذات منحى تصوري وإقلالي، بدأت تلح على التوافق الذي يربط بين الحركة وتحولات المادة وبين خلقٍ للأشكال يمكنه أن ينبثق من التوتر الفضائي ومأساته. إنها مأساة اللون الذي تنتثر عليه عناصر الرمادي والأسمر والأسود، عبر التراكم والجمع بين الفرشات اللونية، في ضرب من "الجيولوجيا ذات الطابع العمودي"، كما يفسر لنا ذلك الفنان. وهو يوضح لنا أيضا بأن بحثه المحيط بمختلف التيارات العالمية يستهدف العلامة والمكان والذاكرة: فما موقع الأثر التجريدي من مدينة فاس، مسقط رأسه؟ إن هذه الثلاثية يوظفها كتراكم لاستكشاف ابتكارات ما نسميه "ما بعد الحداثة".
لقد وضعنا بين قوسين الكثير من المفاهيم الرائجة في النقد الفني قصد بلورة، إن لم نقل تأكيد العلائق اللامفكر فيها بين التمثيل والتجريد والتشخيص والعلامة والشكل واللاشكل. وبهذا لا نعمل سوى على بلورة مدخل للفن العربي المعاصر.
من النحت الى الفيديو
إن التشكيل، ومفهوم التشكيل يتغير تبعا لفنٍّ متعدد التقنيات، يحركه هاجس الشاهد والتوليف: التوليف بين التشكيل والتصوير الضوئي (الفوتوغرافيا)، وبين الدّيزاين والفوتوغرافيا، والمنْجَزَة performance والفوتوغرافيا والسينما، والتشكيل والنحت، والنحت والعمارة، والديزاين والعمارة، والمواد واللامواد حتى التيه. إن هذا التوليف يندرج ضمن ثقافة لـهْوية جديدة، وضمن ميل واضح للسينوغرافيا (المشهدية). فما يتغياه العمل الفني في الغالب هو المشهد وامتلاك الفضاء، لا مدة ذلك في الزمن. من ثمّ، لا وجود لأوهام عن الخلود الهارب التي يجسدها حظ العمل الفني، ولا للاختمار الطويل الذي يغذي تكونه، وإنما فقط إكراهات فن ذي طابع عالمي، وسوقه وبثه التقني العلمي.
من ثمة تنبع عزلة الفنانين العرب في حركة "العالمية" هذه. فنحن بداية هذا القرن، لا نزال نسعى للتعرف بدقة على دور الفنان في علاقته بثقافته ودينه ونقط هويته المتوسعة في الزمن الآتي، وقدراته على ابتكار المستقبل. إنها نقطة الهروب، والسرعة، ودوخة الأصوات والصور والذاكرات.
منذ أعمال محمود مختار مؤسس النحت المصري الجديد، لم يكف النحت العربي عن إعادة تملّك ماضيه، ذلك الماضي الثقيل الذي كبته التراث الإسلامي وأنساقه الفقهية الصارمة. ومن وقتها، تكيّف النحت مع جمالية ذات منحى صوفي، سواء كانت تشخيصية أو تجريدية. ذلك هو حال أعمال اللبناني شوقي الشوكيني (المولود سنة 1946)، ورقع الضامة ولعب الحظ، وتماثيله الصغيرة المتاهية. وقد صرح الشاعر صلاح ستيتيه قائلا: "ومن حينها، عرفت أعمال الشوكيني البساطة لصالح المنحنيات والخطاطات: وبما أنه يتعامل مع المادة، من خشب ورخام، كما لو كانت مِرْقَنا clavier ، فإنه يستخرج منها تنظيمات شكلية قوية ورفيعة ينطبق عليها من فوق الاقتراح التشخيصي. إن كلمة "مرقن" هنا تبدو لي الأصوب في هذه الحالة لترجمة الأثر المتوخى المتمثل في موسيقى تكون أحيانا بسيطة وخالصة على شاكلة أنشودة، وأحيانا أخرى معقدة وذات منحى جِواقي. إن الموسيقى الصامتة لمنحوتات الشوكيني تشكل تحديا للمدفع العبثي الذي يفرقع هنا كي يقتل (وهو ما لن يتم له) جسم وروح لبنان، باعتبارهما جبلا صلبا ولطيفا مثله مثل المنحوتات والنحات الذي أتحدث عنه"(19).
هذه الرسالة، يقوم نحات لبناني آخر هو ندا رعد (المولود سنة 1934) بإضفاء طابع درامي حاد عليه، وذلك بتآليف لأشكال مجزأة، وتجميع لصفائح وقضبان الحديد، كما لو كان يرغب في تخليص لبنان من دماره.
أما مهدي موتشار (من مواليد 1943)، فإنه يفضل الـمُنْشَأة installation ، وهي مفهوم وسط بين التجريد الهندسي الإقلالي (المربع، المضلع النجمي المعروف في الإسلام) والبساطة الكبرى للمواد، كما يبدو ذلك مثلا في تلك السلسلة من الآجر أو العواميد الخشبية. إن توالد الفضاء والزمن عبر المربع السحري يتميز بخاصية أنه يكشف للمكان الذي يحتضن مؤقتا تلك المنشآت وهْم تحوله هو نفسه إلى مشهد زخرفي.
إنها جمالية وظيفية دقيقة يزينها فنانو الديزاين بالتنويع في الأسلوب والموضوع والموضة ودرجة البهلوانية في توالي الأشياء الموحدة بواسطة عناصر خاضعة للتحكم والمراقبة. وهو ما يشهد عليه التعبير الشكلي الذي يعدُّنا لفن معين للحياة؛ ففي كل الأحوال تشكل الفنون تبريرا للحياة المثلى، وللقيمة السامية لحضارة ما ونشاطاتها الترفيهية، ومواقعها في الأمكنة التي تؤثث نظرنا ولمسنا. ويقدم لنا ثلاثة مواهب من أصول جزائرية، هم يمّو وعبدي وشريف، منحوتاتهم من الزجاج والحبال والخشب والمعدن، فيما يقدم لنا المغربي محمد حجلاني، بمرتجلاته التي تمتح من الذاكرة الحية لصناع مراكش باقة من المواد، من خشب نادر عطِر وفضة وعظام وحبال القنب، ليدعونا إلى مظاهر زخرفية أخرى منسوجة في الأثاث، من ضمنها أيضا فن الخط والتمائم والأرقام، يقدمها كخليط مرح وبلا ادعاء. يتعلق الأمر بسهولة زخرفية تقدم نفسها كخلق للحياة عبر تنويع مظاهرها.
قد تكون هذه المظاهر مغالية، كما هو الحال في الأعمال الفتوغرافية للمغربي التهامي الناضر (المولود سنة 1953). إنها حدٌّ لتمثيل الجسد. لكن بأي جسد يتعلق الأمر هنا؟ وإذا كانت الفتوغرافيا، حسب رولان بارث، تمكن من عودة الميت والشبح، فإن المشهدية الدرامية العميقة لهذا الفنان تملك ما يجعلنا في حيرة. هكذا يقدم لنا، في طواف غير منتظم وتبعا "للمواضيع" المطروقة، أجسادا متحجرة وأطفالا يكبرون منذ ولادتهم وأياد غريبة (آسيوية أو مغربية) مشدودة وظهورا متجعدة بل مثلومة، وأجسادا مفتوحة ومجزرة ودوابا مذبوحة، وكلَّ شيء مقترح علينا وعليكم في لمح البصر. كما لو أن المصور يبحث عن "حقيقة" الحياة والموت في قلب المادة نفسها، ويرغب في قلب الداخل نحو الخارج. إنها عملية قصوى، فالناضر لا يستعمل مصوبا آليا ولا التأطير، ثم إنه يستخرج صوره الشمسية على مقاسات 120 x 160. إضافة إلى ذلك، فالإخراج المشهدي الذي يقترح علينا ليس مأخوذا بالضرورة من الواقع، بل هو بالأحرى شاهد يصرح بوضعية إنسانية أخرى وبمأساة أخرى: فصور المجازر مهداة لصبرا وشاتيلا. هكذا يتجسد الميت والحيوان، وربما كان روح التجسُّد هذا هو المنفوث في هذه التجربة العجيبة للأسود، بالمعنى التقني. فالمصور يحتفل بالقربان: "إن أعماله العنيفة والسرية، بالرغم من الاعتراف الرسمي بها، هي البصمة المباشرة لخراب الوجود على الأرض. إنها تتجاوز أفق الفن المعاصر، من غير أن نحتاج لتفسير أسباب هذا التجاوز" (ألان جوفروا).
وتجرب اللبنانية منى حطوم (المولودة سنة 1952) هذا الأفق عل جسدها وعلى المتفرج، انطلاقا من المنْجزة والفيديو. فكل جسد ينظر إلى نفسه كمختبر يتجه نحو اللامادي: "ففي الجسد الغريب، تقوم كاميرا دقيقة بتفحص المظهر الخارجي للجسد والبشرة، قبل أن تلج إلى باطن الجسد لتتفحص مناطق أكثر غورا ويستحيل الوصول إليها. وعبر حركة تصويرية دائرية أمامية نشاهد جسدا بلا مقاومة موضوعا تحت المراقبة الطبية، وفضاء غامضا وغريبا معروضا على شاشة دائرية. ويظهر الجسد المركب من جديد كعالم مصغّر يسجن نفسه في "غرفة" مخروطية الشكل يُستَدعى المتفرج لولوجها. وتغزو الفضاء أصوات حميمة، فيما يُدفع بالمتفرج إلى السير على الصور، والمرور في الشعاع المضيء كي يغدو بدوره شاشة (20).
بمثابة خـاتمة
ربما كنا نرغب في تقديم هذا النص في شكل توريق يكون ذا مداخل ومخارج متعددة للقراءة. نعم، نحن ندخل بلا سحر تقريبا في هذا القرن الذي يحتفي به كل بلد وكل أمة بهذا القدر أو ذاك من المجد. إلى أين يسير العالم العربي؟ ما سيكون مآل فنونه في السرعة المعلوماتية للصور والأصوات والعلم التقني الخاصة بالتذكر؟
كان الكتاب، والكتب المقدسة بالأخص، المجال الأمثل للمعرفة والقداسة. فلكي تكون القراءة جيدة يلزم الكثير من الخيال. وذلك كان هو دور فن الخط المتمثل في منح النص إيقاعا خاصا وتركه يتنفس ويغرس جذوره في خلايا مخيالنا؟؟؟؟. فقد حول الخطية إلى مقطوعة من العلامات تقلع بالنص نحو مشهده التشكيلي: الزمن المرسوم والمنشود للحرف وتقفّيه بين الصوت والمعنى اللذين يتناسجان فيه. ونخال الأمر عنكبوتا، وهندسة متحركة ومأسورة تبني ما تراه. وبما أن فن الخط صورة للتضعيف والتكرار، فإنه يمسرح نهاية الكتاب وخطيته. وهو قد حظي باهتمام كبير من قبل الفنانين، سواء كانوا عربا أو أجانب. ولا شيء يمنعنا من الاعتقاد بأن حضارة تفاعل العلامات، التي تتطور بسطوة قوية تكبت معها اختلاف الحضارات ومواطنها، تمنح لفن الخط حياة جديدة في فضاء العلم التقني ووسائطه المتعددة. وليس هنا مجال الإجابة عن هذه المسألة الكبرى، أو توضيح الكيفية التي بها تتطور حضارات العلامة، الصينية واليابانية والعربية الإسلامية، في هذه الذاكرات الجديدة التي تتحكم فيها الإعلاميات والتقنيات الجديدة للتواصل، لكن من حقنا إلقاء نظرة على ما حدث.
ففي العقدين الأولين من هذا القرن، اكتشف العالم العربي التشكيل والفوتوغرافيا، والسينما التي جعلت منها مصر في وقت قصير صناعة للصورة، والتي لا تزال مزدهرة الآن في التلفزيون. وقد سبق الاستشراق التصويري تملك العرب للتشكيل على المسند الذي تعايش مع ظاهرة التشكيليين السذج المحليين، كما لو كان هؤلاء نتاجا لذاك. واستمرت ممارسة المنمنمات، غير أنها تعرضت للتطور وأعادت صياغتها الفوتوغرافيا والتشكيل. ولقد أحس الفنان العربي في بداية القرن أن هويته وصورته عن ذاته سوف تأخذ مواقع أخرى على السجلات الجديدة للمجال البصري. هذه الرحلة في الزمن والفضاء والذاكرة، هي التي حاولنا عرضها سعيا منا إلى استخراج نقط استدلال في صلب الحضارة العربية الإسلامية ونظام أشكالها ومسارات استمرارها وقطائعها.
الهوامش
1- Toni MARAINI, Ecrits sur l’art, Al Kalam, Rabat, 1990.
2- Oeuvres, Tome II, La Pléiade.
3- John CARSWELL, in Le Liban-le regard des peintres, catalogue exposition IMA, Paris, 1989.
4- Matière de l’oubli et de la mémoire, in catalogue MOUDARRES, IMA, Paris, 1996.
5- MARWAN, catalogue d’exposition juin-août 1993, IMA, Paris, p. 28.
6- Cf. article de Abdelkébir KHATIBI, « Paradigmes de Civilisation », in Civilisation marocaine, éditions Oum (Casablanca) et Actes-Sud, Arles, 1996.
7- Cf. article de Abdelkébir KHATIBI, « Interférences », catalogue de l’exposition Croisements de signes (24 avril – 25 août 1989), IMA, Paris.
8- Jabra IBRAHIM JABRA, « Calligraphie et art moderne dans le monde arabe », Cf. le catalogue précédent.
9- Cf. l’ouvrage L’art calligraphique de l’Islam, de A. KHATIBI et M. SIJELMASSI, Gallimard, 1994.
10- Buland EL HAIDARI, « La Lettre arabe dans l’art pictural contemporain arabe », in catalogue Art contemporain arabe (collection du Musée), IMA, Paris, 1987.
11- Cf. en particulier les essais et les livres d’art de Jean-Clarence LAMBERT.
12- Les effets du voyage (25 artistes algériens), Amsaoui, 1995.
13- BAYA, in Trois femmes peintres, catalogue IMA, 1990.
14- Interview de CHAIBIA dans le même catalogue.
15- J.-C. Lambert, « L’image dans la peinture non figurative », dans l’ouvrage collectif Comment vivre avec l’image, PUF, 1989, p. 269.
16- Ramsès Younane, par Edouard JAGUER.
17- Benanteur, catalogue d’exposition, 3 avril – 4 mai 1977, Palais des arts et de la culture de Brest.
18- Catalogue d’exposition (12 février – 28 juin 1993), IMA, Paris.
19- Gilbert Lascaut.
20- Salah STETIEH, catalogue Art contemporain arabe (collection du Musée), IMA.
21- Mona Hatoum, Centre Georges Pompidou, 1994.