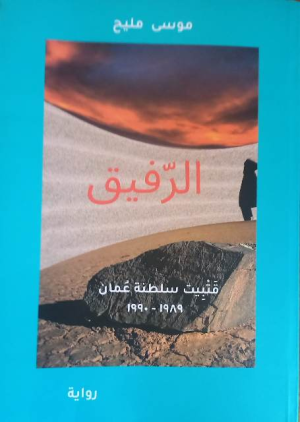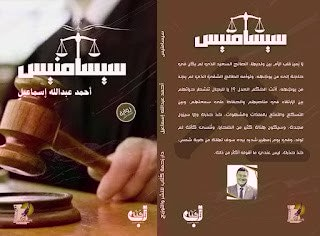نتصوّرُ أنّ المُنجز الشعري المغربي الرّاهن مُنجزٌ مصابٌ بشكل كبير بالتّنوُّع والكثرة .فما كُتب مباشرة بعد أوائل تسعينيات القرن العشرين، نقصد هنا طبعا الكتابة الصادرة عن وعي شعري جديد، لا مراء في أنّه يتميز بالاختلاف والمغايرة، حيث الإبداع يبدأ في التخلق بكثير من التحرر، التّحرر باعتباره فتحا للفجوات والأخاديد، بما يجعلُ الطريق سالكا أمام ماء الكتابة.
في السّابق كانت الفعالية النقدية تنظر إلى المنجز الشعري، في إطار ما يُسمى بالفترة التحقيبية، أي تحقيب ما تراكم من الشعر، انطلاقا من معيار الجيل، إلا أنه ابتداء من العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وبالنظر إلى خصوصية المرحلة، سيُستبدل هذا المفهوم بمفهوم آخر أكثر انسيابية وتموُّجا انسجاما مع التشابك والاختلاف الشعريَيْن اللذين عرفتهما هذه الكتابة، تلك التي تواشجت في وشيجة يُمكن نعتها، تجاوُزا، بالحساسية الشعرية الجديدة.
ولئن كان ما يميز مرحلة التجييل في السابق هو انتسابُ مجموعة من الشعراء إلى نفس الفترة الزمنية، وكذا انتظامُهم في نظيمة فنية عكست طبيعة المرحلة وخصوصياتها الإيديولوجية، بالأساس، فإن الأمر مختلفٌ تماما مع شعرائنا الجُدد. شعراء يُعبّرون بصدق عن التّفكُّك والتشقُّق اللذين طالا بُنى الحياة بشكل عام. إن الواحد من هؤلاء لا يكتب إلا ليمحو، للتدقيق نقول، يكتب بيد ويمحو بأخرى، لدرجة أن كل شاعر أصبح يسعى جاهداً إلى أن يتجاوز نفسه باستمرار؛ ومن ثمة يمكن الجزم بأن مرجعية التجاوز هي التي استحكمت في ناصية القول عند الشاعر. وإذن، هي حساسية شعرية، تروم فتح الشعر على أراضيه المُستباحة وتُخومه ومضايقه، شعريات تنفرد بأُفُقها، وباذخة بتجدُّدها المستمر، يُسمّيها أحدُهم بالشعريات التّماسِّيَة. لقد تحولت الرّيشة إلى إزميل يهدم عمارة النص فنيا وفكريا، وهي إذ تفعل ذلك، فلأنها لا تراهن على المعنى، بقدر ما تراهن على أثر الأثر la trace de la trace .
إن ما يميزُ القصيدة عند شعراء الحساسية الجديدة، وهم بالمناسبة شعراء ارتادُوا طريق المُغامرة والمُخاطرة، بالمعنى النيتشوي، كونُها كتابة تنبثق عن ذات مُتشظّية، ذات ترفُضُ بشكل مطلق الامتثال لشكل نمطي واحد، أو عمارة محدّدة سلفا، وعطفا، هي ذات جاحدة بكلّ تنميط أو تحنيط، ديدنُها الأبدي هو اللاثبات، حيث إنها لا تستقرُّ في شكل ثابت، دائمة التّجدُّد، عبر النبش والحفر في أراضي الشعر المُستباحة، بمعاول التجريب والتنقيب. وهذا البحث الأركيولوجي ليس عملية مؤقّتة، بل هي عملية دائمة ومستمرة، لأن الشاعر من هؤلاء لا يطمئنُّ إلى نتائجه وإنجازاته المؤقتّة، فالتخوم هنا مُشْرَعَة فقط على التخوم وهكذا…
هذا التذويت المُتشظّي، والذي كان الأصل في هذه الاندفاعة الحداثية في بلاد المغرب، سيتجلى لا محالة في مجموعة من المظاهر الفنية التي تَمَيَّزت بها هذه الكتابة الشعرية الجديدة، التي يُمكن اعتبارُها أسئلة فنية غنية عن كلّ جواب. والحق أن أغلب شعراء هذه الحساسية تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي جدا مع قصيدة النثر، لدرجة أن الكثير من المهتمين يربطون مفهوم الحساسية بهذه القصيدة.
ونحن إذ نلوح بمفهوم «قصيدة النثر» فإننا نتصدى للرأي القائل بأن هذه القصيدة مجرد ضرب من العشوائية الأسلوبية، وأنها تعلة للمتشاعرين الذين ليست لهم أية موهبة، أو رؤية شعرية، وأنها، عطفا على ذلك، قصيدة تستسهل الكتابة تحت يافطة الغموض. فالعطب والفتق اللذان قد يبدوان عند بعض المتطفلين على هذه الكتابة الجديدة، كانا موجودين، تاريخياً، في كل الأنماط الشعرية.
إن قصيدة النثر الأصيلة، تلك التي شكلت حساسية جديدة، بالقياس إلى ما سبقها من تجارب، مرهونة بتوفر اشتراطات إبداعية لا محيد عنها، كالخيال الخلاق، والتجربة الناضجة، بما أن «الإبداع تجربة، والتجربة أنا» على حد تعبير الشاعر المختلف محمد السرغيني، فضلا عن اشتراط حساسية كبيرة إزاء القيم الفنية والاختيارات الجمالية. فماذا عن تَبَدِّياتِ هذه القيم في المنجز الشعري لهذه الحساسية؟
1 – اللغة المنشرحة:
اللغة في الكتابة الشعرية الجديدة لغة مواربة وجانوسية (نسبة إلى جانوس إله الأبواب والعتبات). فالكلمة لم يعد لها معنى في ذاته، بل أصبحت تأخذ معناها انطلاقا من السياق. فترى شاعراً يتَّخِذُها وسيلة قشيبة وشفيفةً في نسيج نصيّ شفيف، وتجد شاعراً آخر، بالمقابل، يجعلها – الكلمة – مرمزة وملغزة، مُضْمِراً المعنى ببوح كتيم، متوسلا في هذا التقنيع بالرمز والغرابة في التصوير والتركيب.
وفي كلتا الحالتيْن فإن الخلفية التي كانت تتحكم في الشاعر هي الرغبة المُلِحَّة في إنتاج المرحلة اللغوية الأولى الاستعارية (التعبير لنورثروب فراي)، للدفع بالكتابة إلى ما بعد القصيدة.
2 – الكتابة الشذرية والرؤى المتشظية:
إن سَعْيَ شعراء الحساسية الدؤوب، كما تبين، إلى الدفع بالشعر إلى التخوم والأقاصي، جعل الكتابة الشعرية تتجه نحو تخوم الكتابة الشذرية، الموسومة بنفحتها الفلسفية والمغلفة بأسلوب رؤيوي معقد، أسلوب يُقلق كل توقع سطحي يتحصن بما تيسر من المواضعات خوفا من كل جديد. ووجبت الإشارة هنا إلى أن ما تتميز به هذه الكتابة من صعوبات يجعلها كتابة عصية ومتمنعة، عكس ما يعتقده البعض. فالشذرة، كما يقول نيتشه، نص جينيالوجي مصاب بالكثافة والتشظي والفجوات.
لقد ظلت الكتابة الشذرية أقل حُضوراً في مشهدنا الشعري المغربي، هي المعروفة، كما أسلفنا، بعمقها الفكري وروحها الشعرية، وذلك إما لصعوبتها تارة، وإما لعدم الاعتراف بها كقصيدة من قبل عَسَس الشعرية المحافظة تارة أخرى. والحق أنه في وقتنا الراهن أصبحت للقصيدة الشذرية مكانة مهمة لدى شعراء الحساسية الجديدة، لكونها ممارسة شعرية خلاقة، ولكونها تَسْتَبْطِن أفكاراً قد تبدو صبيانية وصغيرة، لكنها مضيئة ومشرقة في لحظات عابرة وبدون أي صرامة نسقية.
وليس من الغرابة أن يكون رواد هذا الصنف من الكتابة، قد قدموا من المبحث الفلسفي على شاكلة رائد الكتابة الشذرية الفيلسوف الألماني نيتشه. نذكر هنا، تمثيلا لا حصرا، بنسالم حميش، وجلال الحكماوي، وعبد الحميد بن داوود. لقد أصبحت الكتابة الشذرية أفقا شعريا جديدا في تدافع دائم نحو اللاقصيدة أو ما بعد القصيدة حيث التعتيم الأجناسي.
3 – الميولات الكونية:
لقد شكل انفتاحُ حساسيتنا (حساسياتنا) الشعرية الجديدة على التجارب الشعرية العالمية، هاجسا كبيرا، بسبب رغبتها الملحة في احتلال مواقع جد متقدمة، في المشهد الشعري العالمي، تحت يافطة الكونية، من خلال تبني بعض طرائق الكتابة الشعرية المتداولة عالميا، كتجربة الهايكو، والقصيدة الشذرية، فضلا عن استثمارها للعديد من القيم الجمالية والفنية المشتركة بين الشعراء كونيا.
لم يعد الحديث عن كونية الكتابة، من داخل الحساسية الجديدة، حديثا يوتوبياً، أو وهمياً، وإنما أصبح ضرورة تفرضها مقتضيات العصر. وما يحسب لهذا الأفق الشعري الجديد، في بعض من مستوياته الأصيلة، كونه يسعى إلى الكونية المنشودة، دون الانفصال عن الذات، كوعاء ثقافي، والقادرة وحدها على الحفاظ على جوهر الهوية الشعرية العربية (المغربية)، وإن بشكل قد يبدو مختلفا وصادما أحيانا، إلا أننا نلمس في عمقه، مقاومة شديدة لكل تنميط أو تذويب أو تماهٍ حتى؛ فترى الشعراء (ليس كلهم) يستثمرون روح الثقافة المحلية في قصائدهم، من حكايات شعبية، ومفارقات إنسانية محلية، وموروث ثقافي مغربي، بفنية ماكرة، تؤهل كل هذه العناصر المحلية لكي ترقى إلى اللحظة الكونية.
إن أسئلة الكتابة الشعرية الراهنة، في نظر شعراء الحساسية الجديدة ببلادنا، تمثل الأفق الشعري الممكن والقادر، وحده، على الدفع بالسيرورة الشعرية المغربية، ومن ثم العربية، إلى الكونية أو العالمية المنشودة؛ الكونية المنذورة للتعدد والاختلاف، لا الكونية المصابة بالتنميط والقولبة.
وتبقى الترجمة، في نظر هؤلاء الفرسان الجدد، سبيلهم الآمن لهجرة النص إلى الضفة الأخرى، بهدف استكمال استحقاق الكونية. والملاحظ أن ما يطبع هذا السعي الحثيث لتهجير الشعر المغربي وتصديره إلى الخارج، هو التشتت، والفوضى، والتسرع، والعفوية، على الأقل في عمومه، في انتظار استراتيجية مؤسسة وهادفة، إذ نجد محاولات فردية، هنا وهناك، تبدو للنظرة العجلى والمتأنية بئيسة؛ إلا أنها، على كل حال، تبقى محاولات تؤمن، على الأقل، بأن الترجمة هي قدر الشعر المغربي في سعيه إلى الكونية، مما يبشر بمستقبل قد يكون منصفا للكتابة الشعرية المغربية الراهنة.
تلكم بعض الملاحظات والرؤى بخصوص التحولات الكبرى الحاصلة في بنيات وجوهر الكتابة الشعرية عند شعراء الحساسية الجديدة ببلاد المغرب.
كلمة العدد
تجديد المعرفة هو نفسُه تجديدُ الخيال، أو ابْتِداعُه بالأحرى. لا يمكن للشِّعر، أو السَّرد، أو المسرح، أو السينما، أو التشكيل، أو غيرها من التعبيرات الفنية والجمالية أن تَبْلُغَ ذِرْوَتَها، أو ما يمكن اعتبارُهُ أفُقاً مفتوحاً للمُغامَرَة والتَّجريب، دون أن يكون الكَاتِب نفسه مُشْتَعِلاً بقَلَقِه الشَّخصيّ، الذي هو قَلَقُ البحث، وقلقُ التَّمَيُّز والفرادة، أو الإضافة والابتداع. وليس الابتداع، بالضَّرُورَة، أن نأتِيَ بالجديدِ، غير المسبوق، بل الابْتِداع كان، دائماً، شَقّ طُرُقٍ، أو الإشارة إلى بعض هذه الطُّرُق، التي هي طُرُق حافِلَة بالاستثناءاتِ، أو بالاختلافات، رغم ما يمكن أنْ يكُون علاقةً بما هو سائد ومعروف.
لا أحَدَ من الشُّعراء، ولا من الرِّوائيِّين، أو الفنانين التّشكِيلِيِّين، أو المسرحيِّين، ممن ابتدعوا طُرُقاً جديدةً في التَّعبير، كان خارِجَ الأشكال السَّائدة، أو خارِجَ التَّعبيراتِ التي ابْتَدَعَها من سبقوه. فهؤلاء، من داخِل هذا المُشْتَرَك، أو هذا الاستثنائيّ، الجديد، في زمنهم، والذي يكون اتَّخَذَ صورَةَ النَّمَط، بحكم التِّكرار والاستعادة، شَقُّوا أخادِيدَ، كانت بمثابة النَّهْر الذي لا تعترضُه العقباتُ، بل إنَّه يَسْرِي بمائِه في اتِّجاه العُشْبِ والخُضْرَة، وفي اتِّجاه الحياة، لأنَّ هذا الماء المُتَدفِّقَ في مَجارِيه هو الذي يمنح الحُقولَ حياتَها، ويُنْبِت فيها الزَّهْرَ والشَّجَر، كما يُتِيحُ فيها للطُّيورِ أن تَرْوِي ظَمأَها، وتشرع في الغِناء، بما في ريشِها من اختلاف في النَّشِيدِ، وفي الغناء.
المبدع هو مَنْ يُشيرُ إلى الطُّرُق، أو يُشْرِعُ السَّيْرَ فيها، ويَتْرُك للآخَرِينَ ابْتِداع شَكْل، ونَوْع النَّشِيد، الذي يبدو لهم هو مجْرى النَّهْرِ الذي لا شيْءَ يقف أمام دَفْقِه.
ذاكرة مدينة القصر الكبير الثقافية من خلال أعلامها
أسامة الزكاري
تستحق مدينة القصر الكبير أن تفخر بعطاء رجالها، وتستحق هذه المدينة أن تسجل اسمها بمداد الفخر داخل سجل الإبداع الحضاري، الذي ساهمت به حواضر المغرب وقراه في بناء صرح معالم النبوغ الفكري والثقافي، قديما وحديثا. وإذا كان واقع حال المدينة اليوم قد أضحى يمارس سلطة تخريبية رهيبة في وجه معالم البهاء الذي ارتبط بتاريخ المدينة، فإن الأمر لم يعمل – في المقابل- إلا على تحفيز همم نخب المدينة وإطاراتها المدنية المبادرة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل إعادة الاعتبار لوجه القصر الكبير المشرق ثقافيا، والمتوهج فكريا، والمتألق مدنيا. وفي هذا الإطار، استطاعت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير تحقيق تراكم نوعي غير مسبوق على صعيد مجمل مدن شمال المغرب، وربما على الصعيد الوطني، عن طريق توجيه التكوين الأكاديمي وجهته التأصيلية القائمة على أساس ربط نتائج هذا التكوين بتوجهات صقل المبادرات الجمعوية وتكثيفها مع ضرورات التوثيق لخصوبة الذاكرة المحلية المشتركة. لقد استطاعت هذه الجمعية الرائدة، وعلى امتداد عمرها القصير زمنيا والغزير عطاء، وضع قواعد إجرائية لتنظيم العمل الجماعي الهادف إلى الاحتفاء بمعالم المكان وبرموزه المشعة، سواء على مستوى الفضاءات التاريخية القائمة، أم على مستوى الشواهد المندثرة، أم على مستوى الخبايا الأركيولوجية الدفينة، أم على مستوى الوثائق والمدونات الغميسة، أم على مستوى البيبليوغرافيات الكلاسيكية والمجددة. فكانت النتيجة تحقيق تراكم هائل من المبادرات الجمعوية المؤسسة، توجتها بسلسلة إصدارات متواترة تحولت إلى مراجع لا يمكن القفز عليها في كل محاولات إعادة كتابة تاريخ مدينة القصر الكبير في مختلف عهوده المديدة، وهي الكتابات التي ساهمت بها نخبة من مثقفي المدينة ومن باحثيها ومن أعلام زمنها الثقافي الراهن، أمثال محمد أخريف ومحمد بنخليفة وبوسلهام المحمدي وعبد السلام القيسي…
في إطار هذا «المجرى الثابت»، يندرج صدور الجزء الثالث من كتاب «أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث: ملامح من حياة – مقاطع من نصوص»، لمؤلفه الأستاذ محمد العربي العسري، خلال السنة الجارية (2015)، في ما مجموعه 543 من الصفحات ذات الحجم الكبير. والكتاب، تعزيز لجهد كثيف بذله المؤلف، في الجزأين السابقين، بحثا في سير أعلام المدينة، وتوثيقا لعطاءاتهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والتربوية والمدنية والمهنية والإعلامية، وهي المساهمات التي كان لها صيت وطني واسع، بل دولي في بعض الأحيان، في مختلف مناحي العطاء الذي تستحق مدينة القصر الكبير أن تفخر به، وأن تعتبره قاعدة لتأسيس مطالبها المشروعة في دعم تحولات الراهن التنموي داخل محيطيها الإقليمي والوطني الواسعين. لقد استطاع الأستاذ العسري الانفتاح على تجارب مجالات عدة ومتكاملة في صنع معالم الهوية الثقافية لمدينة القصر الكبير الراهنة، معالم جمعت بين فروع شتى، نجد فيها تخصصات متقاطعة أو متضاربة، لكنها تلتقي في الوفاء لمعالم المكان ولخصوبة الإبداع ولآفاق التحول المنشود، تخصصات جمعت بين الشعر والنقد والقصة والرواية والصحافة والطب والموسيقى والتشكيل والسينما والترجمة وعلوم التربية والمسرح والتاريخ والفلسفة والسوسيولوجيا والحكي الشعبي والعمل الحقوقي والعمل الجمعوي والعمل الأكاديمي والعمل السياسي … إلى غير ذلك من التخصصات والاهتمامات التي أكسبت الأستاذ العسري الكثير من عناصر الجرأة لاختراق عوالمها الدفينة وجزئياتها الدقيقة، التي قد لا يعرف القارئ العادي إلا نتفا موزعة هنا وهناك عن إسهامات رجالات القصر الكبير داخلها.
والحقيقة، أن الكتاب، منذ صدور جزئه الأول، وكما سبق أن أكدت عليه في القراءة التقديمية المتواضعة التي كان لي شرف نشرها بهذا الخصوص، يشكل جزءا من مشروع ضخم، لا شك أن انطلاقته تأخرت طويلا، ولا شك أنه يظل من صميم مهام الدولة ومؤسساتها الرسمية، ولا شك – كذلك – أنه نقطة الزاوية في كل مشاريع الاشتغال على تلاوين «التنمية الثقافية» المحلية الضرورية لكل تطلعات النهوض، في الحال وفي الاستقبال. لذلك، فقد استطاع الأستاذ العسري أن يتحول إلى مؤسسة قائمة الذات، مؤسسة لا تكل ولا تتعب في سبيل تحويل الاشتغال على ذاكرة القصر الكبير إلى اهتمام جماعي لدى النخب ولدى المسؤولين. إلى جانب ذلك، وعلى المستوى الوطني، أمكن القول إن كتاب الأستاذ العسري يسمح بتصنيف السجل الإبداعي/ الحضاري/ الثقافي لمدينة القصر الكبير، جنبا إلى جنب، مع أعمال رائدة أنجزها مؤرخون كبار في مجال توثيقهم لسير الأعلام والرموز الثقافية عبر الجهات الأربع للبلاد. ولا أبالغ إذا قلت إن أعمال الأستاذ العسري بخصوص مدينة القصر الكبير، يمكن أن تصنف إلى جانب أقطاب كتب الأعلام والتراجم للقرنين 20 و21، مثلما هو الحال مع كتابات محمد داود وعبد الله كنون ومحمد حجي ومحمد المنوني وعبد الله المرابط الترغي…
لقد حاول الأستاذ العسري في الجزء الثالث من كتابه «أقلام وأعلام من القصر الكبير»، الذي وضع تقديمه الأستاذ أبو الخير الناصري، الاستجابة لنهم أجيال اليوم في الاحتفاء بمعالم نبوغ مدينة القصر الكبير، من خلال استحضار التجارب وتواتر الأجيال واختلاف الرؤى والمنطلقات. فبالكثير من عناصر النبل والوفاء كان الأستاذ العسري منفتحا على جميع الأصوات، نعم «جميع الأصوات» التي لها ظل تحت شمس مدينة القصر الكبير، أسماء تحولت بعطائها إلى نقاط ارتكازية في كل محاولات كتابة التاريخ الثقافي لمدينة القصر الكبير خلال زماننا الراهن، كل حسب مجال عطائه وفي سياق اختصاصه. في هذا الإطار، نجد أسماء رائدة في مجال العطاء الحقوقي والسياسي العام للدولة المغربية المعاصرة، مثلما هو الحال مع البروفيسور مصطفى المعزوزي والأساتذة بوغالب العطار وخالد السفياني وسلمى الطود وخديجة اليملاحي. كما نجد أسماء أخرى انشغلت بمجال الكتابة الفلسفية مثلما هو الحال مع الأستاذين محمد المصباحي ومصطفى حنفي، وأخرى في مجال الكتابة الشعرية مثلما هو الحال مع الأساتذة أحمد الطود ومحمد عفيف العرائشي وعبد السلام دخان ومحمد العناز وأنس الفيلالي ومصطفى الغرافي ووفاء العمراني ووداد بنموسى وسعاد الطود، ثم أسماء برزت في مجال الكتابة القصصية والروائية مثلما هو الحال مع الأساتذة مصطفى يعلى وبهاء الدين الطود ومحمد الهرادي وعبد الإله المويسي وحسن اليملاحي ويوسف خليل السباعي. وفي مجال الدراسات الأدبية، اهتم المؤلف بأعلام هذا الحقل أمثال الأساتذة أنور المرتجي وعبد الله بنعتو وأبو الخير الناصري. وفي مجال الصحافة، نجد الكثير من التجارب التي برز فيها أبناء مدينة القصر الكبير، مثل الأساتذة محمد أبو الوفاء وسليمان الريسوني ومحمد كماشين، وهو نفس المنحى الذي اشتغل عليه المؤلف بالنسبة لمجال الموسيقى والطرب من خلال رموزه الذين نذكر منهم الفنانين محمد السلاوي والحاج محمد بن حمان الطود وإحسان الرميقي. وفي باب الممارسة التشكيلية، اهتم المؤلف بأعلام هذا المجال من خلال تجارب أجياله المتواترة التي أنجبت أسماء وازنة في هذا الحقل، أمثال المبدعين محمد الحمري وأمينة الرميقي وشفيق الزكاري وعبد السلام القوسي وعبد الخالق قرمادي. ولم ينس المؤلف توسيع دوائر تنقيباته بالبحث في مخزونات التراث الشفوي المحلي من خلال تجارب الكتابة الزجلية والحكي الفكاهي لمبدعي المجال ولرواده المميزين أمثال الأساتذة بوغالب العسري وإدريس المريني وقاسم العطار.
.. وبعد، فلا شك أن كتاب «أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث» نجح، إلى جانب قيمته التوثيقية البيوغرافية الأكيدة، في ترسيخ قيمة الوفاء ومبدأ الإخلاص لأصحاب الفضل داخل مجهودات ترصيص معالم الهوية الثقافية لمدينة القصر الكبير. إنه مجهود شاق لكنه مثمر، ممتد في الزمن لكنه واعد. إنه مجهود لتشريح السير والتراجم، لا يستطيع اختراق مجاهله وتجاوز انزياحاته إلا كبار النفوس، وهي سمة أصيلة للأستاذ محمد العربي العسري، بل هي اختزال لقيم نكران الذات والوفاء والبذل والعطاء بلا حدود. باختصار، هي جوهر السيرة الذهنية للرائد محمد العربي العسري أولا وأخيرا.
«قراءات في التصوير المغربي المعاصر».. مدخل لإثبات الذات والهوية
شفيق الزكاري
كتاب «قراءات في التصوير المغربي المعاصر» هو أول كتاب أنجزه الفنان التشكيلي والناقد الفني بنيونس عميروش، بعد مدة طويلة من الكتابة والمتابعة للفن التشكيلي المغربي والعربي. وبهذا يكون قد استجمع كتاباته لكي يدون مسيرته ورؤيته النقدية، باعتباره أقرب إلى الكتابة بحكم ممارسته الفنية واشتغاله من داخل المطبخ الفني.
استهل الناقد بنيونس عميروش كتابه بقولة للموسيقار أرنست كيفي، يقول فيها: «ستبدأ الإنسانية بالتحسن عندما نأخذ الفن على محمل الجد كما الفيزياء والكيمياء والمال». قولة تحمل دلالات عميقة لما هو عليه الوضع الفني بالمغرب، خاصة عندما أصبح هذا الجنس التعبيري مهددا بالانقراض من المنظومة التعليمية المغربية مستقبلا، رغم ازدهار وتقدم التجارب الفنية، ممارسة وتنظيرا، مقارنة بالفترة السابقة، وبما يجري في العالم العربي في هذا الجانب.
ونظرا لأهمية الكتاب قدم له الكاتب والناقد والمسرحي والباحث حسن المنيعي، الذي صدرت له هو الآخر عدد من الكتب التنظيرية في مجال الفن التشكيلي، ثم العلاقة الممكنة بين الأجناس التعبيرية الأخرى، إذ يقول في مقطع من مقدمته : «… إن كل دراسة ترتبط بجوهر الجنس تعد مساهمة حقيقية في إثراء الثقافة البصرية ببلادنا. وهذا ما فعله الصديق بنيونس عميروش في كتابه القيم «قراءات في التصوير المغربي المعاصر»، حيث نجده يعقد علاقة حميمة مع عدد من الرسامين ليكشف لنا تجاربهم التصويرية…».
من هنا نفهم بأن هذا الكتاب لم يعتمد على الدراسة التحليلية المنفصلة عن المتابعة والمجاورة، أي أن الناقد بنيونس عميروش تعمد الاتصال بالفنانين ومعايشة تجاربهم عن قرب ومحاولة النفاذ إلى أغوار طريقة تفكيرهم ومعالجتهم للقضايا الكبرى في هذا المجال.
وقبل أن يتناول هذه التجارب في كتابه، أكد بنيونس عميروش على ضرورة الوقوف عند مرحلة مبكرة في تاريخ التشكيل المغربي المعاصر، وهي مرحلة أواسط الستينيات التي عرفت ولادة تكتل فني سمي بجماعة 65، التي كانت عبارة عن تظاهرة فنية واستعراضية للأعمال الفنية بفضاء جامع الفنا بمراكش كفضاء خارجي، في محاولة لربط الجسور بين الفن والمتلقي على مستوى شريحة اجتماعية شاسعة، لتأسيس تصور حول ثقافة مشهدية بمرجعية هندسية إسلامية، بما فيها الصناعة التقليدية وما تزخر به من أشكال وألوان وتكوينات تعددت أسندتها كالزرابي والجلد والنحاس والجبص والمرمر إلى آخره، فكان من بين المساهمين الأساسيين في تكوين هذه الجماعة التي صاغت بيانها الناقدة الفنية الإيطالية طوني مريني، محمد شبعة، محمد المليحي وفريد بلكاهية.
إن قراءة هذه التجارب لا تخضع لدراسة كرونولوجية أو تاريخية بالمفهوم التراتبي، كما أشار إلى ذلك الأستاذ حسن المنيعي، بل هي تجميع لعدد من النصوص المرتبطة براهنية التجربة في حد ذاتها لكل فنان على حدة، والتوثيق لها. ولهذا تناول بنيونس عميروش في الشطر الأول من الجزء الأول في هذا الكتاب حيثيات ولادة هذه الجماعة وأهدافها، قبل أن ينتقل للحديث عن التجارب المكونة لها لكل من محمد شبعة، الذي خصص له عنوانا مثيرا في تبويبه الأول هو : «من الميكانيكا إلى السحر»، مع جرد لبدايات اهتمام هذا الفنان وعمله على إصلاح المنظومة الفنية التي عملت على إعادة النظر في هيكلة المناهج التدريسية بالمدارس الفنية والانسلاخ عن التبعية والاستلاب الاستعماري، ثم الانتقال إلى تفكيك تجربته التي اعتمدت في نظر الناقد عميروش، انطلاقا من تصور الفنان محمد شبعة، على ضرورة إعادة صياغة التعامل مع الموروث الثقافي المغربي، وخاصة فن العمارة والهندسة والصناعة والتقليدية، إلى جانب مساهماته التنظيرية التي كان سندها مجلة «أنفاس»، بالإضافة إلى إبداعاته في مجالات أخرى كالكرافيك والإشهار وتصميم الملصقات وأغلفة الكتب وإنجاز برامج إذاعية وتلفزية باعتبارها الجسر الذي يمكن من خلاله اختراق ذوق المتلقي وتربيته وتحسيسه بأهمية وضرورة الجماليات.
وتحت عنوان «تعارض الشهوة والمقدس» ولج الناقد بنيونس عميروش عوالم الفنان فريد بلكاهية، متتبعا لمسيرته المهنية والفنية، بدءا بمنصبه كمدير لمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء سنة 1962، حين عمل على خلق محترفات لتعليم الصناعة التقليدية، بما فيها الفخار وصباغة الخشب والزربية والحلي…، وصولا إلى اشتغاله على النحاس وتطويعه في تجربته الشخصية، ثم انتقاله إلى سند الجلد واستعماله الألوان الطبيعية كالحناء والزعفران والكوبالت والأحماض وقشور الرمان…، مستعينا بنظرية حداثية لا تمت بصلة إلى الموروث الاستعماري، على مستوى المادة المستعملة، وعلى مستوى الشكل، حيث انطلق من فكرة بدائية لها علاقة بالموقع والفضاء المغربي، دون استيراد أي تقنية أو مواد خارج الرقعة الجغرافية التي تزخر بها إفريقيا، التي اعتبرها الناقد بنيونس عميروش جزءا مهما من مسار فني معاند وممتد عبر عدة عقود لهذا الفنان الحداثي الذي عقد على بانسجام روحه على الهوية في علاقتها بالتاريخ والحضارة.
بعده وتحت عنوان عجائبي «هندسة الفلك»، اختار الناقد بنيونس عميروش اسما مكملا للثالوث الإبداعي المحرك للحداثة التشكيلية بالمغرب في بداياتها، هو محد المليحي، الذي تلقى تعليمه بإيطاليا وأمريكا، محاولا توضيح تأثير بعض معالم هذه المدارس في تجربته منذ أواخر الخمسينيات إلى أواسط الستينيات، مع مساءلته الموروث البصري هو الآخر انطلاقا من التاريخ والذاكرة، وظهور موجاته بألوانها الصارخة، كما هو الحال في الزربية الأطلسية والزمورية بوسط المغرب، كاشتقاق نوراني من جذر الطبيعة على حد قول بنيونس عميروش، في بعدها الرمزي بمرجعيته الطفولية المستمد من محيط مسقط رأسه «أصيلة»، معتمدا في تكويناته على عناصر أربعة تعتبر مصدر الحياة ووجود الكون هي «النار والماء والتراب والهواء».
أما في الشطر الثاني من الكتاب، فاستهل الناقد بنيونس عميروش حديثه عن الفنان محمد القاسمي، حيث ذهب في وصف «حدود التلقي في ثنائية اللغوي والتشكيلي» كعنوان، إلى التوغل في تجربة هذا الفنان وانبهاره بها في إطار مشروع مكتمل جمع بين الممارسة والتفكير والكتابة، انطلاقا من قول الفنان القاسمي: «أن أمارس الفن، معناه أن أفكر»، تبعا لنظرية ديكارت الفلسفية، التي تسمى الكوجيطو.
ثم تحدث الناقد بنيونس عن بعض التظاهرات التشكيلية التي تركت أثرا عميقا في المشهد الفني المغربي، لما طرحته من أسئلة جوهرية، منها «كهف الأزمنة الآتية» وعلاقتها بالزمان والمكان، ثم الإحالة والإيحاء فيها، مع وضع رسومات بيانية لتوضيح التداخل اللغوي والمرئي في عملية التلقي، التي عمل الفنان القاسمي على تطويرها في خطاباته التشكيلية، التي ترتكز على تصورات فكرية يصعب استيعابها، قبل أن ينتقل للحديث عن علاقة اللوحة بالجسد، ثم الانفلات من فضائها الضيق نحو فضاء خارجي يتيح إمكانية التنقل بحرية مطلقة من خلال التدخل في الطبيعة أو ما يسمى فن الأرض أو البيئة Land-art، باعتبارها جزءا من الكون، وطريقة لرفض المظهر التجاري في الفن.
وفي الشطر الثالث والأخير من تجميع هذه النصوص تطرق الكتاب، من خلال عنوان رئيسي هو : «العلامات وإبدالاتها الأيقونية»، إلى تجريدية الحرف، التي يمثلها في بداياتها الفنان عبد الله الحريري، ليصل الناقد إلى جرد للوضعية الثقافية والفنية منذ بداية الاستقلال وما شكله شعار «الأصالة والمعاصرة» من مواجهة بلغت ذروتها بين السياسة والثقافة، على إثر الحراك الاجتماعي الذي عبر عن ضيقه من قبضة النظام في نظر الناقد بنيونس عميروش.
بعد ذلك تحدث هذا الشطر من الكتاب عن تجربة الفنان مصطفى البوجمعاوي، باعتباره رحالة في الزمن الفني من خلال مشروعه الموسوم ب «القافلة»، الذي قدمه بالمغرب وفرنسا، كمشروع عالمي لا يقف عند حدود جغرافية معينة وكعمل محوري يحيط بأعمال فنانين شكلوا مختلف أقطاب الفن العالمي الحديث مثل جورج بازيليت، أنزو كوتشي، نام جون بايك، جون بيير راينو وولفغانغ لايب.
وختم الناقد كتابه بالحديث عن تجارب مغربية أخرى رسخت لمفهوم الحداثة انطلاقا من مستويات تعبيرية أخرى بمختلف مشاربها كتجربة الفنان عبد الحي الملاخ في بستنته للأيقونات الشعبية، وتجربة بوجمعة لخضر، إلى جانب كل من الراحلتين سعدية بيرو والفطرية بنحيلة الركراكية، بسحر علاماتهم المهاجرة، لينتهي بالحديث عن منمنمات الفنان الحاج عبد الكريم الوزاني، الذي زاوج بين رسوم المخطوطات والزخرفة والخط العربي.
قصيدة: محمد عريج
الثّامِنةْ
أكرهُ السّاعةَ الثّامنةْ..
إنّها تزرعُ الرُّعبَ تحتَ وسائدِنا
وتقصُّ شرائطَ أحلامنا المطمئنّةِ
تسرقُ حاجتنا للحياةِ بحريّةٍ
وتحدّدُ وجهتنا في الصباحِ
نسيرُ بلا أيّ وعيٍ
إلى سجننا
ونعودُ، وقدْ سرقَ الوقتُ من عمرنا
لا نحسُّ بما سرقَ الوقتُ
نهملُ أحلامنا اللمْ تزلْ طفلةً
ونسيرُ إلى غدنا سادرينَ
إلى أن تقولَ المراياَ لنا: قدْ كبُرتُمْ
فنضحكُ مستهزئينَ
وننكرُ أعمارنا الطاعِنَةْ
آهِ كم أكرهُ السّاعةَ الثّامِنَةْ.
قصة قصيرة
زياد خداش
سِيدِي
كان سِيدِي خليل في التّسعين من عمره يروح ويجيء في قطعة الأرض الواسعة التي خلْف بَيْتِنا في المُخيَّم، والتي ليست لنا بالطبع، لم يكن يفعل شيئاً مُحدَّداً هُناك، كان يبدو أنَّه يَشْعُر بالضَّجَر، كنتُ أراقِبُه من أعلى الجبل بقنبازه وحطّته وعقاله وهو يمشي ببطء وحزم، ناظراً إلينا بين الحين والآخر، كنتُ أشعُر أنَّه سيصعد إلينا بعد قليل كطفل في التسعين من عمُره ليقول لنا شيئاً ما ويهبط، كُنّا نحن أحفاده نتصايح ونحن نجرجر ألواح الزِّينْكو المُهْتَرِئَة، ذات الثُّقوب مِنْ أعلى الجبل، ونُحاوِل أن نصنع منها بُيوتاً فوق تلك الأرض الواسعة. كان سيدي خليل لا يتوقف عن المشي، رأسه في الأرض، ويداه تتحرَّكان بطريقة غريبة، كأنَّه يُكَلِّمُ أحداً، أو يُهدِّدُ أحداً، أو يُطَمْئِنُ أحداً.
هَجَم سيدي في لحظة غَضَبٍ غير مفهومة على أحفاده، وهُم يبنون بيوتاً من صفائح الزينكو المُهْترِئَة، تفرَّق الأحفاد مَرْعوبِينَ، كان سيدي يلحقهم وهو يصرخ خلفهم : «مش راح تزبط، مش راح تزبط»، ولم نكن نعرف ما المغزى من جُملته المُكَرَّرَة، أمْسَك سيدي بي، تباطَأتُ أمَامَه لأنِّي مطمئناً كنتُ أعرف أنه يُحِبُّنِي، وأنَّه لن يُؤْذِينِي، لكن صَفْعَةَ يَدِهِ الضّخْمَة والخشبية على وَجْهِي فَاجَأَتْ طُمَأْنِينَتِي، لم أفْهَم بالضبط لماذا صفعني سيدي، صاحب الخَمْس بيَّارات في قريته المخطوفة، لكني رَاقبْتُه طويلاً وهو يجلس على الأرض، مكسوراً ومُتَعَرِّقاً ولاهِثاً ومكْرُوراً : «مش راح تزبط، مش راح تزبط».
وتَذَكَّرْتُ حينها أنَّ لا أحد قال لي بوضوح ما معنى أنِّي لاجئ. صفعة جدي على وجهي، قالَتْها لِي بوضوح قاتل.
صلاح ستيتية.. الكائِنُ الشاعِر
نصوصه لا تنجو من الفكر ولا تنجو من البعد الفلسفي العميق
صلاح بوسريف
1 – كان كتاب «ليل المعنى» هو ما أتاح لي أن أتعرَّف على الشاعر اللبناني الأصل، صلاح ستيتية. الكتاب هو حوار مع الشاعر. من خلاله اسْتَطَعْتُ أن أكتشفَ عُمْق رؤية صلاح للشِّعر، وانشغاله الكبير بقلق الكتابة، أو ما كان يعتري هذا الشاعر من «تَقَشُّفٍ» وريبةٍ وتَرَدُّدٍ إزاء الشِّعر، الذي لم يكن يراه مُجرَّد حِبْر على وَرَقٍ، بقدر ما كان مشغولاً بما يمكن أن يُتيحَه العمل الشِّعري من قيمة شعرية، وما يمكن أن يفتحه من طُرُق ومسالك.
2 – قراءتي لبعض أعمال صلاح ستيتية أتاحتْ لي أن أتعرَّف على الشاعر في شعره، وأن أكتشف العمق المعرفي الذي كان صلاح يصدر عنه في رؤيته للشِّعر، وفي كتابته، والتنظير له، أيضاً. فما كتَبه من مقدماتٍ لدواوين، وأعمال فنية، تُتِيح لقارئه أن يضع يَدَه على معنى الشِّعر عند هذا الشاعِر، وما كان يَسْتَثْمِرُه من خبراتٍ ومعارف في كتابته. ولعلَّ في ثقافته التشكيلية، واشتغاله مع عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنان التشكيلي المغربي فريد بلكاهية، في أكثر من عمل، ما أتاح له أن ينقل معطيات هذه التجربة، من العمل الفني الصِّرف إلى الكتابة. عدد من نصوص الشاعر هي اشتغال على أعمال فنية، أو توسيع للغة الشِّعر، ب»لغة» التشكيل والرسم. فالفضاء هو جزء من اشتغال ستيتية، وجزء من وَعْيِه الكتابيّ، الذي فيه يُهَيْمِن المكتوب على الشَّفاهيّ، أو يُقَلِّص سلطته على النص.
3 – أعماله الشعرية «الكاملة» التي صدرت في جزء واحد سنة 2009 بعنوان دالّ وعميق Un lieu de brulure هي تعبير عن هذا الزَّواج الأبدي، في تجربة ستيتية، بين لغة الكتابة ولغة الألوان والمساحات والأحجام، أو التعبيرات الهندسية، التي تحضُر بشكل لافِتٍ في شعره. فهو لم يَكْتَف بالاشتغال على اللغة، بما قد تُتيحُه من مجازاتٍ، أو ما يمكن أن تتوسَّعَ فيه من تخْييلات، بل إنَّ تجربته اللغوية انْفَتَحَتْ على البُعد الرمزي، الذي يسمح للدَّوالّ أن تتناسخ وتتناسل في الصفحة، بما في ذلك ما كان يقترحُه عليه بعض الفنانين من رسومات، وأشكال هندسية، أو أحافير، لتكون جزءاً من بنية النص، أو أحد دَوالِّه التي بها كان يَبْتَنِي هذا المعنى الكثير والمُتَعدِّد، أو المفتوح على ما يتجاوز حدود المعنى نفسه، إلى رحابة وانْشِراح الدَّلالة.
4 – رغم أنَّ صلاح ستيتية يكتب بالفرنسية، ورغم إقامته بفرنسا أكثر من أربعين سنة، وعلاقته بشعراء فرنسيين من الذين كان لهم حضور قوي في المشهد الشِّعري الكوني، وما شهده من أحداث كبرى، كان لها تأثير في مجريات المعرفة والإبداع الفرنسيين، فهو لم يتنكَّر لثقافته العربية، ولم يُدِر ظهره لِلُّغَة العربية، التي ظلَّ يُقَدِّرُها، ويتكلَّم بها، لأنه هو من اخْتار العودة إليها، باعتبارها مصدراً من مصادر تكوينه الأوَّلي، الذي يعود به لوالده، ولِما تلقَّاه من تكوين في مراحل التَّعَلُّم الأولى. كان للعربية في هذه المرحلة من حياة الشاعر حضور لافِت، رغم ما يُكِنُّه للفرنسية من شَغَفٍ وحُبٍّ كبيريْن. فهو لم يخرج من معرفته الشِّعرية بالثقافة العربية الإسلامية، ومعرفته بتاريخ هذه الثقافة، وما راكَمَتْه من معارف وإبداعات، فحضور التراث الصُّوفي في شعره واضح، ولا يمكن لِمَن يعرف هذا الموروث، ويعرف بعض شعرائه الأساسيين أن يُخْطِئَ حضور هؤلاء في أعمال الشاعر، ليس من باب الاستشهاد، أو التوظيف التَّزْيينى الذي يكتفي بظاهر النص، أو بما فيه من إحالة، بل إنَّ ستيتية، كما حَرِص على تذويب ثقافته ومعرفته الفرنسيين في رؤيته، وفي ما له من خبرة في الكتابة، وفي علاقته باللون، وبالأشكال والأحجام الهندسية التي لها علاقة بفضاء اللوحة، أو العمل الفني، فقد ذَوَّب الموروث الصوفي في تجربته، بنوع من التركيب الخيميائي، الذي هو عنده ابْتِداع برؤية حداثية، وليس تقليداً، أو اتِّباعاً، لأنَّه، في طبيعة تكوينه، كان يرفض أن يكون ما يكتبُه سطحاً، أو قِشْرَةً، أو بالأحرى تنويعاً على نموذج سابقٍ، أو صَدًى لصوتٍ، أيّاً كانت قيمة هذا الصَّوْت.
5 - نصوصه لا تنجو من الفكر، ولا تنجو من البُعد الفلسفي العميق. فنيتشه، وهايدغر، بشكل خاص، حاضران في هذا البُعد، ولَهُما في رؤيته الفكرية مكانهما، بما يعنيه ذلك من امتلاك لزمام فكرهما، وتشغيل له، وفق مقتضيات الحال، كما يقول القدماء.
6 – فهو مُقٍلٌّ، «مُتَقَشِّفٌ»، لكنه، كان، دائماً، شديد الحرص على القيمة الشِّعرية، لا على الوفرة والكَمّ. وليس سهلاً على قارئ صلاح ستيتية أن يخترق تجربته بِيُسْر، أو أن يقرأها باسترخاء. تجربة كهذه، بما تحمله في طيَّاتِها من اشتغال شعري مدروس، وبما في ثناياها من مراجع، لا تكتفي بالتراث أو بالمعرفة النصية، تفرض وُجودَ قارئ مُثابر وصَبُور، يقرأ ويُعيد القراءة، ولا يُغْلِق على نفسه في شعر الشاعر، فقط، بل يخرج إلى عوالمه الأخرى، التي هي حاضرة في شعره، بنوع من التَّذْوِيب الإبداعي، الذي تبدو فيه رؤية الشاعر حاضرةً، بما فيها من عمق وخصوصية شعريين. وكما يقول عنه أحد الكُتَّاب، ف»شعر صلاح ستيتية شعر هندسي بنسب دقيقة، مبني بناءً عجيباً، قريباً من التجريد، وهو نحت في الضوء، أو نحت في المعنى الذي هو بدوره يدور في ذاته، أي في معنى المعنى «وغالباً ما هو استطراد»، ولكنه استطراد لمعنى قديم مبهم كأنَّه الأبدية (أي في بعده المعرفي) في ما يمكنه أن يُلامِسَ إشارات الصوفية، شيء يمحو شيئاً من حيث يشبهه أو يلغيه».
7 – الإلغاء،هنا، هو ذلك المحو الذي ظل صلاح ستيتية يمارسُه دون كَلَلٍ، دَرْءاً لحضور «الشبيه»، أو انْسِرابه في طيَّات النص. وهو تعبير عن التَّصَدّعات التي لا ينجو منها النص، مهما كان وعي الشاعِر بانشقاقاته. فنصوصه، دائماً، غير منتهية، وغير مكتملة، وهي «شيء يمحو شيئاً»، مثلما يحدث بين الليل والنَّهار.
8 – اللاَّمُدْرَك، واللامرئي، في تجربة صلاح ستيتية، هو بالذَّات، هذا الانصهار المرجعي في تجربة الشاعر، الذي هو انْفِلاتُ التجربة من التكرار والاستعادة، وانفرادها بذاتها، باعتبارها قيمة مُضافَةً، وطريقاً آخر، بين عدد من طُرُق الشِّعر، التي يستشعرها قارئ الشِّعر النَّبِيه والحصيف، بمجرد أن يفتح النص على مجهولاته، أعني على ما يُتيحُه من آفاق للتَّخْييل، ولوضع اللغة في أفق اشتعالها. في هذا اللامدرك واللامرئي تبدو تلك الشقوق والتَّصَدُّعات، التي تشي بالمحو، وبالنُّقصان.
اللغة التي لا تُفْضِي بقارئها إلى هذا النُّقْصان، أو اسْتِشْعار هذا النقصان، تبقى لغة قاصرةً، أو هي لغة لا تزال في طور التكوين، لأنَّ ثمَّة ما يجعل جمرَها يبقى كامناً في رماده. وصلاح ستيتية هو واحد من الشُّعراء الذين وضعوا الشِّعر في أوْج اشتعاله، أو بلغوا به شِدَّة هذا الاشتعال.
9 – في لقائي بصلاح ستيتية، بفرنسا، وفي ما جرى بيْننا من حوارات ونقاشات، رفقة أصدقاء آخرين من الشُّعراء، والحوار الطويل الذي أجريناه معه، على مدار أكثر من ثلاث ساعات، أدْرَكْتُ هذا المعنى العميق أو البعيد الذي يحمله الشاعر في نفسه، ويحيا به، كما يحيا بالماء والهواء. وسواء كان هذا المعنى عنده «ناراً» أعني اشتعالاً، أو «ماءً» بتعبيره «أن تدفن النَّار هو أن تحلم بالماء»، فهو يبقى حضوراً دائماً، واقتفاءً ل»ليل المعنى»، لهذا المُظْلِم، المُعْتِم، في كل كتابة عميقة، وبعيدة، ولِما يغمره من عمق وكثافة. وربما هذا ما حَذا بصلاح أن ينظر إلى الشِّعر باعتباره «غير المدرك» حين يصير، في شفافته وانْفِراطه، ربما، «غير مرئي»، لكنه يَلْفَحُ الرُّوحَ، ويُضفي عليها بعض انشراحه.
10 – في ترجمة شعر صلاح ستيتية إلى العربية ما قد يسمح باستعادتِه للغَتِه الأم التي بقي مُقيماً فيها، رغم تعذُّر الكتابة بها، بنفس مستوى الفرنسية، ولم يتنازل عن الكلام والحوار بها، بما سيؤكِّد فكرة ستيتية حول انتمائه لِضِفَّتَيْ البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الذي هو بحر الشِّعر والأنبياء، وهو بامتياز بحر المعرفة والإبداع الإنسانِيَيْن. والعربية باستعادتها لستيتية، من خلال ترجمته، قد تكون جَسَّرَتْ العلاقة بين الضِّفَتَيْن، وفتحت ماءَ، أو ملحَ المتوسط، على دَفْقِه الدَّائم والأبدي.
11- في المعرفة، وفي الشِّعر، تحديداً، لا مسافةً بين ماء وماء، لأنَّ لغة الخيال، ولغة الإبداع، هي لغة الكائن وهو ينحت مجراه في أفق الشِّعر، وفي أفق المعرفة التي هي إضافة واختلاق، مهما كانت اللغة التي يكتب بها الشاعر. وهذا ربما ما جعل أدونيس، في ما كتبه عن صلاح ستيتية، يقول عنه إنَّه شاعر عربي يكتب بالفرنسية.
الحساسية الشعرية الجديدة بالمغرب
في السّابق كانت الفعالية النقدية تنظر إلى المنجز الشعري، في إطار ما يُسمى بالفترة التحقيبية، أي تحقيب ما تراكم من الشعر، انطلاقا من معيار الجيل، إلا أنه ابتداء من العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وبالنظر إلى خصوصية المرحلة، سيُستبدل هذا المفهوم بمفهوم آخر أكثر انسيابية وتموُّجا انسجاما مع التشابك والاختلاف الشعريَيْن اللذين عرفتهما هذه الكتابة، تلك التي تواشجت في وشيجة يُمكن نعتها، تجاوُزا، بالحساسية الشعرية الجديدة.
ولئن كان ما يميز مرحلة التجييل في السابق هو انتسابُ مجموعة من الشعراء إلى نفس الفترة الزمنية، وكذا انتظامُهم في نظيمة فنية عكست طبيعة المرحلة وخصوصياتها الإيديولوجية، بالأساس، فإن الأمر مختلفٌ تماما مع شعرائنا الجُدد. شعراء يُعبّرون بصدق عن التّفكُّك والتشقُّق اللذين طالا بُنى الحياة بشكل عام. إن الواحد من هؤلاء لا يكتب إلا ليمحو، للتدقيق نقول، يكتب بيد ويمحو بأخرى، لدرجة أن كل شاعر أصبح يسعى جاهداً إلى أن يتجاوز نفسه باستمرار؛ ومن ثمة يمكن الجزم بأن مرجعية التجاوز هي التي استحكمت في ناصية القول عند الشاعر. وإذن، هي حساسية شعرية، تروم فتح الشعر على أراضيه المُستباحة وتُخومه ومضايقه، شعريات تنفرد بأُفُقها، وباذخة بتجدُّدها المستمر، يُسمّيها أحدُهم بالشعريات التّماسِّيَة. لقد تحولت الرّيشة إلى إزميل يهدم عمارة النص فنيا وفكريا، وهي إذ تفعل ذلك، فلأنها لا تراهن على المعنى، بقدر ما تراهن على أثر الأثر la trace de la trace .
إن ما يميزُ القصيدة عند شعراء الحساسية الجديدة، وهم بالمناسبة شعراء ارتادُوا طريق المُغامرة والمُخاطرة، بالمعنى النيتشوي، كونُها كتابة تنبثق عن ذات مُتشظّية، ذات ترفُضُ بشكل مطلق الامتثال لشكل نمطي واحد، أو عمارة محدّدة سلفا، وعطفا، هي ذات جاحدة بكلّ تنميط أو تحنيط، ديدنُها الأبدي هو اللاثبات، حيث إنها لا تستقرُّ في شكل ثابت، دائمة التّجدُّد، عبر النبش والحفر في أراضي الشعر المُستباحة، بمعاول التجريب والتنقيب. وهذا البحث الأركيولوجي ليس عملية مؤقّتة، بل هي عملية دائمة ومستمرة، لأن الشاعر من هؤلاء لا يطمئنُّ إلى نتائجه وإنجازاته المؤقتّة، فالتخوم هنا مُشْرَعَة فقط على التخوم وهكذا…
هذا التذويت المُتشظّي، والذي كان الأصل في هذه الاندفاعة الحداثية في بلاد المغرب، سيتجلى لا محالة في مجموعة من المظاهر الفنية التي تَمَيَّزت بها هذه الكتابة الشعرية الجديدة، التي يُمكن اعتبارُها أسئلة فنية غنية عن كلّ جواب. والحق أن أغلب شعراء هذه الحساسية تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي جدا مع قصيدة النثر، لدرجة أن الكثير من المهتمين يربطون مفهوم الحساسية بهذه القصيدة.
ونحن إذ نلوح بمفهوم «قصيدة النثر» فإننا نتصدى للرأي القائل بأن هذه القصيدة مجرد ضرب من العشوائية الأسلوبية، وأنها تعلة للمتشاعرين الذين ليست لهم أية موهبة، أو رؤية شعرية، وأنها، عطفا على ذلك، قصيدة تستسهل الكتابة تحت يافطة الغموض. فالعطب والفتق اللذان قد يبدوان عند بعض المتطفلين على هذه الكتابة الجديدة، كانا موجودين، تاريخياً، في كل الأنماط الشعرية.
إن قصيدة النثر الأصيلة، تلك التي شكلت حساسية جديدة، بالقياس إلى ما سبقها من تجارب، مرهونة بتوفر اشتراطات إبداعية لا محيد عنها، كالخيال الخلاق، والتجربة الناضجة، بما أن «الإبداع تجربة، والتجربة أنا» على حد تعبير الشاعر المختلف محمد السرغيني، فضلا عن اشتراط حساسية كبيرة إزاء القيم الفنية والاختيارات الجمالية. فماذا عن تَبَدِّياتِ هذه القيم في المنجز الشعري لهذه الحساسية؟
1 – اللغة المنشرحة:
اللغة في الكتابة الشعرية الجديدة لغة مواربة وجانوسية (نسبة إلى جانوس إله الأبواب والعتبات). فالكلمة لم يعد لها معنى في ذاته، بل أصبحت تأخذ معناها انطلاقا من السياق. فترى شاعراً يتَّخِذُها وسيلة قشيبة وشفيفةً في نسيج نصيّ شفيف، وتجد شاعراً آخر، بالمقابل، يجعلها – الكلمة – مرمزة وملغزة، مُضْمِراً المعنى ببوح كتيم، متوسلا في هذا التقنيع بالرمز والغرابة في التصوير والتركيب.
وفي كلتا الحالتيْن فإن الخلفية التي كانت تتحكم في الشاعر هي الرغبة المُلِحَّة في إنتاج المرحلة اللغوية الأولى الاستعارية (التعبير لنورثروب فراي)، للدفع بالكتابة إلى ما بعد القصيدة.
2 – الكتابة الشذرية والرؤى المتشظية:
إن سَعْيَ شعراء الحساسية الدؤوب، كما تبين، إلى الدفع بالشعر إلى التخوم والأقاصي، جعل الكتابة الشعرية تتجه نحو تخوم الكتابة الشذرية، الموسومة بنفحتها الفلسفية والمغلفة بأسلوب رؤيوي معقد، أسلوب يُقلق كل توقع سطحي يتحصن بما تيسر من المواضعات خوفا من كل جديد. ووجبت الإشارة هنا إلى أن ما تتميز به هذه الكتابة من صعوبات يجعلها كتابة عصية ومتمنعة، عكس ما يعتقده البعض. فالشذرة، كما يقول نيتشه، نص جينيالوجي مصاب بالكثافة والتشظي والفجوات.
لقد ظلت الكتابة الشذرية أقل حُضوراً في مشهدنا الشعري المغربي، هي المعروفة، كما أسلفنا، بعمقها الفكري وروحها الشعرية، وذلك إما لصعوبتها تارة، وإما لعدم الاعتراف بها كقصيدة من قبل عَسَس الشعرية المحافظة تارة أخرى. والحق أنه في وقتنا الراهن أصبحت للقصيدة الشذرية مكانة مهمة لدى شعراء الحساسية الجديدة، لكونها ممارسة شعرية خلاقة، ولكونها تَسْتَبْطِن أفكاراً قد تبدو صبيانية وصغيرة، لكنها مضيئة ومشرقة في لحظات عابرة وبدون أي صرامة نسقية.
وليس من الغرابة أن يكون رواد هذا الصنف من الكتابة، قد قدموا من المبحث الفلسفي على شاكلة رائد الكتابة الشذرية الفيلسوف الألماني نيتشه. نذكر هنا، تمثيلا لا حصرا، بنسالم حميش، وجلال الحكماوي، وعبد الحميد بن داوود. لقد أصبحت الكتابة الشذرية أفقا شعريا جديدا في تدافع دائم نحو اللاقصيدة أو ما بعد القصيدة حيث التعتيم الأجناسي.
3 – الميولات الكونية:
لقد شكل انفتاحُ حساسيتنا (حساسياتنا) الشعرية الجديدة على التجارب الشعرية العالمية، هاجسا كبيرا، بسبب رغبتها الملحة في احتلال مواقع جد متقدمة، في المشهد الشعري العالمي، تحت يافطة الكونية، من خلال تبني بعض طرائق الكتابة الشعرية المتداولة عالميا، كتجربة الهايكو، والقصيدة الشذرية، فضلا عن استثمارها للعديد من القيم الجمالية والفنية المشتركة بين الشعراء كونيا.
لم يعد الحديث عن كونية الكتابة، من داخل الحساسية الجديدة، حديثا يوتوبياً، أو وهمياً، وإنما أصبح ضرورة تفرضها مقتضيات العصر. وما يحسب لهذا الأفق الشعري الجديد، في بعض من مستوياته الأصيلة، كونه يسعى إلى الكونية المنشودة، دون الانفصال عن الذات، كوعاء ثقافي، والقادرة وحدها على الحفاظ على جوهر الهوية الشعرية العربية (المغربية)، وإن بشكل قد يبدو مختلفا وصادما أحيانا، إلا أننا نلمس في عمقه، مقاومة شديدة لكل تنميط أو تذويب أو تماهٍ حتى؛ فترى الشعراء (ليس كلهم) يستثمرون روح الثقافة المحلية في قصائدهم، من حكايات شعبية، ومفارقات إنسانية محلية، وموروث ثقافي مغربي، بفنية ماكرة، تؤهل كل هذه العناصر المحلية لكي ترقى إلى اللحظة الكونية.
إن أسئلة الكتابة الشعرية الراهنة، في نظر شعراء الحساسية الجديدة ببلادنا، تمثل الأفق الشعري الممكن والقادر، وحده، على الدفع بالسيرورة الشعرية المغربية، ومن ثم العربية، إلى الكونية أو العالمية المنشودة؛ الكونية المنذورة للتعدد والاختلاف، لا الكونية المصابة بالتنميط والقولبة.
وتبقى الترجمة، في نظر هؤلاء الفرسان الجدد، سبيلهم الآمن لهجرة النص إلى الضفة الأخرى، بهدف استكمال استحقاق الكونية. والملاحظ أن ما يطبع هذا السعي الحثيث لتهجير الشعر المغربي وتصديره إلى الخارج، هو التشتت، والفوضى، والتسرع، والعفوية، على الأقل في عمومه، في انتظار استراتيجية مؤسسة وهادفة، إذ نجد محاولات فردية، هنا وهناك، تبدو للنظرة العجلى والمتأنية بئيسة؛ إلا أنها، على كل حال، تبقى محاولات تؤمن، على الأقل، بأن الترجمة هي قدر الشعر المغربي في سعيه إلى الكونية، مما يبشر بمستقبل قد يكون منصفا للكتابة الشعرية المغربية الراهنة.
تلكم بعض الملاحظات والرؤى بخصوص التحولات الكبرى الحاصلة في بنيات وجوهر الكتابة الشعرية عند شعراء الحساسية الجديدة ببلاد المغرب.
كلمة العدد
تجديد المعرفة هو نفسُه تجديدُ الخيال، أو ابْتِداعُه بالأحرى. لا يمكن للشِّعر، أو السَّرد، أو المسرح، أو السينما، أو التشكيل، أو غيرها من التعبيرات الفنية والجمالية أن تَبْلُغَ ذِرْوَتَها، أو ما يمكن اعتبارُهُ أفُقاً مفتوحاً للمُغامَرَة والتَّجريب، دون أن يكون الكَاتِب نفسه مُشْتَعِلاً بقَلَقِه الشَّخصيّ، الذي هو قَلَقُ البحث، وقلقُ التَّمَيُّز والفرادة، أو الإضافة والابتداع. وليس الابتداع، بالضَّرُورَة، أن نأتِيَ بالجديدِ، غير المسبوق، بل الابْتِداع كان، دائماً، شَقّ طُرُقٍ، أو الإشارة إلى بعض هذه الطُّرُق، التي هي طُرُق حافِلَة بالاستثناءاتِ، أو بالاختلافات، رغم ما يمكن أنْ يكُون علاقةً بما هو سائد ومعروف.
لا أحَدَ من الشُّعراء، ولا من الرِّوائيِّين، أو الفنانين التّشكِيلِيِّين، أو المسرحيِّين، ممن ابتدعوا طُرُقاً جديدةً في التَّعبير، كان خارِجَ الأشكال السَّائدة، أو خارِجَ التَّعبيراتِ التي ابْتَدَعَها من سبقوه. فهؤلاء، من داخِل هذا المُشْتَرَك، أو هذا الاستثنائيّ، الجديد، في زمنهم، والذي يكون اتَّخَذَ صورَةَ النَّمَط، بحكم التِّكرار والاستعادة، شَقُّوا أخادِيدَ، كانت بمثابة النَّهْر الذي لا تعترضُه العقباتُ، بل إنَّه يَسْرِي بمائِه في اتِّجاه العُشْبِ والخُضْرَة، وفي اتِّجاه الحياة، لأنَّ هذا الماء المُتَدفِّقَ في مَجارِيه هو الذي يمنح الحُقولَ حياتَها، ويُنْبِت فيها الزَّهْرَ والشَّجَر، كما يُتِيحُ فيها للطُّيورِ أن تَرْوِي ظَمأَها، وتشرع في الغِناء، بما في ريشِها من اختلاف في النَّشِيدِ، وفي الغناء.
المبدع هو مَنْ يُشيرُ إلى الطُّرُق، أو يُشْرِعُ السَّيْرَ فيها، ويَتْرُك للآخَرِينَ ابْتِداع شَكْل، ونَوْع النَّشِيد، الذي يبدو لهم هو مجْرى النَّهْرِ الذي لا شيْءَ يقف أمام دَفْقِه.
ذاكرة مدينة القصر الكبير الثقافية من خلال أعلامها
أسامة الزكاري
تستحق مدينة القصر الكبير أن تفخر بعطاء رجالها، وتستحق هذه المدينة أن تسجل اسمها بمداد الفخر داخل سجل الإبداع الحضاري، الذي ساهمت به حواضر المغرب وقراه في بناء صرح معالم النبوغ الفكري والثقافي، قديما وحديثا. وإذا كان واقع حال المدينة اليوم قد أضحى يمارس سلطة تخريبية رهيبة في وجه معالم البهاء الذي ارتبط بتاريخ المدينة، فإن الأمر لم يعمل – في المقابل- إلا على تحفيز همم نخب المدينة وإطاراتها المدنية المبادرة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل إعادة الاعتبار لوجه القصر الكبير المشرق ثقافيا، والمتوهج فكريا، والمتألق مدنيا. وفي هذا الإطار، استطاعت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير تحقيق تراكم نوعي غير مسبوق على صعيد مجمل مدن شمال المغرب، وربما على الصعيد الوطني، عن طريق توجيه التكوين الأكاديمي وجهته التأصيلية القائمة على أساس ربط نتائج هذا التكوين بتوجهات صقل المبادرات الجمعوية وتكثيفها مع ضرورات التوثيق لخصوبة الذاكرة المحلية المشتركة. لقد استطاعت هذه الجمعية الرائدة، وعلى امتداد عمرها القصير زمنيا والغزير عطاء، وضع قواعد إجرائية لتنظيم العمل الجماعي الهادف إلى الاحتفاء بمعالم المكان وبرموزه المشعة، سواء على مستوى الفضاءات التاريخية القائمة، أم على مستوى الشواهد المندثرة، أم على مستوى الخبايا الأركيولوجية الدفينة، أم على مستوى الوثائق والمدونات الغميسة، أم على مستوى البيبليوغرافيات الكلاسيكية والمجددة. فكانت النتيجة تحقيق تراكم هائل من المبادرات الجمعوية المؤسسة، توجتها بسلسلة إصدارات متواترة تحولت إلى مراجع لا يمكن القفز عليها في كل محاولات إعادة كتابة تاريخ مدينة القصر الكبير في مختلف عهوده المديدة، وهي الكتابات التي ساهمت بها نخبة من مثقفي المدينة ومن باحثيها ومن أعلام زمنها الثقافي الراهن، أمثال محمد أخريف ومحمد بنخليفة وبوسلهام المحمدي وعبد السلام القيسي…
في إطار هذا «المجرى الثابت»، يندرج صدور الجزء الثالث من كتاب «أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث: ملامح من حياة – مقاطع من نصوص»، لمؤلفه الأستاذ محمد العربي العسري، خلال السنة الجارية (2015)، في ما مجموعه 543 من الصفحات ذات الحجم الكبير. والكتاب، تعزيز لجهد كثيف بذله المؤلف، في الجزأين السابقين، بحثا في سير أعلام المدينة، وتوثيقا لعطاءاتهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والتربوية والمدنية والمهنية والإعلامية، وهي المساهمات التي كان لها صيت وطني واسع، بل دولي في بعض الأحيان، في مختلف مناحي العطاء الذي تستحق مدينة القصر الكبير أن تفخر به، وأن تعتبره قاعدة لتأسيس مطالبها المشروعة في دعم تحولات الراهن التنموي داخل محيطيها الإقليمي والوطني الواسعين. لقد استطاع الأستاذ العسري الانفتاح على تجارب مجالات عدة ومتكاملة في صنع معالم الهوية الثقافية لمدينة القصر الكبير الراهنة، معالم جمعت بين فروع شتى، نجد فيها تخصصات متقاطعة أو متضاربة، لكنها تلتقي في الوفاء لمعالم المكان ولخصوبة الإبداع ولآفاق التحول المنشود، تخصصات جمعت بين الشعر والنقد والقصة والرواية والصحافة والطب والموسيقى والتشكيل والسينما والترجمة وعلوم التربية والمسرح والتاريخ والفلسفة والسوسيولوجيا والحكي الشعبي والعمل الحقوقي والعمل الجمعوي والعمل الأكاديمي والعمل السياسي … إلى غير ذلك من التخصصات والاهتمامات التي أكسبت الأستاذ العسري الكثير من عناصر الجرأة لاختراق عوالمها الدفينة وجزئياتها الدقيقة، التي قد لا يعرف القارئ العادي إلا نتفا موزعة هنا وهناك عن إسهامات رجالات القصر الكبير داخلها.
والحقيقة، أن الكتاب، منذ صدور جزئه الأول، وكما سبق أن أكدت عليه في القراءة التقديمية المتواضعة التي كان لي شرف نشرها بهذا الخصوص، يشكل جزءا من مشروع ضخم، لا شك أن انطلاقته تأخرت طويلا، ولا شك أنه يظل من صميم مهام الدولة ومؤسساتها الرسمية، ولا شك – كذلك – أنه نقطة الزاوية في كل مشاريع الاشتغال على تلاوين «التنمية الثقافية» المحلية الضرورية لكل تطلعات النهوض، في الحال وفي الاستقبال. لذلك، فقد استطاع الأستاذ العسري أن يتحول إلى مؤسسة قائمة الذات، مؤسسة لا تكل ولا تتعب في سبيل تحويل الاشتغال على ذاكرة القصر الكبير إلى اهتمام جماعي لدى النخب ولدى المسؤولين. إلى جانب ذلك، وعلى المستوى الوطني، أمكن القول إن كتاب الأستاذ العسري يسمح بتصنيف السجل الإبداعي/ الحضاري/ الثقافي لمدينة القصر الكبير، جنبا إلى جنب، مع أعمال رائدة أنجزها مؤرخون كبار في مجال توثيقهم لسير الأعلام والرموز الثقافية عبر الجهات الأربع للبلاد. ولا أبالغ إذا قلت إن أعمال الأستاذ العسري بخصوص مدينة القصر الكبير، يمكن أن تصنف إلى جانب أقطاب كتب الأعلام والتراجم للقرنين 20 و21، مثلما هو الحال مع كتابات محمد داود وعبد الله كنون ومحمد حجي ومحمد المنوني وعبد الله المرابط الترغي…
لقد حاول الأستاذ العسري في الجزء الثالث من كتابه «أقلام وأعلام من القصر الكبير»، الذي وضع تقديمه الأستاذ أبو الخير الناصري، الاستجابة لنهم أجيال اليوم في الاحتفاء بمعالم نبوغ مدينة القصر الكبير، من خلال استحضار التجارب وتواتر الأجيال واختلاف الرؤى والمنطلقات. فبالكثير من عناصر النبل والوفاء كان الأستاذ العسري منفتحا على جميع الأصوات، نعم «جميع الأصوات» التي لها ظل تحت شمس مدينة القصر الكبير، أسماء تحولت بعطائها إلى نقاط ارتكازية في كل محاولات كتابة التاريخ الثقافي لمدينة القصر الكبير خلال زماننا الراهن، كل حسب مجال عطائه وفي سياق اختصاصه. في هذا الإطار، نجد أسماء رائدة في مجال العطاء الحقوقي والسياسي العام للدولة المغربية المعاصرة، مثلما هو الحال مع البروفيسور مصطفى المعزوزي والأساتذة بوغالب العطار وخالد السفياني وسلمى الطود وخديجة اليملاحي. كما نجد أسماء أخرى انشغلت بمجال الكتابة الفلسفية مثلما هو الحال مع الأستاذين محمد المصباحي ومصطفى حنفي، وأخرى في مجال الكتابة الشعرية مثلما هو الحال مع الأساتذة أحمد الطود ومحمد عفيف العرائشي وعبد السلام دخان ومحمد العناز وأنس الفيلالي ومصطفى الغرافي ووفاء العمراني ووداد بنموسى وسعاد الطود، ثم أسماء برزت في مجال الكتابة القصصية والروائية مثلما هو الحال مع الأساتذة مصطفى يعلى وبهاء الدين الطود ومحمد الهرادي وعبد الإله المويسي وحسن اليملاحي ويوسف خليل السباعي. وفي مجال الدراسات الأدبية، اهتم المؤلف بأعلام هذا الحقل أمثال الأساتذة أنور المرتجي وعبد الله بنعتو وأبو الخير الناصري. وفي مجال الصحافة، نجد الكثير من التجارب التي برز فيها أبناء مدينة القصر الكبير، مثل الأساتذة محمد أبو الوفاء وسليمان الريسوني ومحمد كماشين، وهو نفس المنحى الذي اشتغل عليه المؤلف بالنسبة لمجال الموسيقى والطرب من خلال رموزه الذين نذكر منهم الفنانين محمد السلاوي والحاج محمد بن حمان الطود وإحسان الرميقي. وفي باب الممارسة التشكيلية، اهتم المؤلف بأعلام هذا المجال من خلال تجارب أجياله المتواترة التي أنجبت أسماء وازنة في هذا الحقل، أمثال المبدعين محمد الحمري وأمينة الرميقي وشفيق الزكاري وعبد السلام القوسي وعبد الخالق قرمادي. ولم ينس المؤلف توسيع دوائر تنقيباته بالبحث في مخزونات التراث الشفوي المحلي من خلال تجارب الكتابة الزجلية والحكي الفكاهي لمبدعي المجال ولرواده المميزين أمثال الأساتذة بوغالب العسري وإدريس المريني وقاسم العطار.
.. وبعد، فلا شك أن كتاب «أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث» نجح، إلى جانب قيمته التوثيقية البيوغرافية الأكيدة، في ترسيخ قيمة الوفاء ومبدأ الإخلاص لأصحاب الفضل داخل مجهودات ترصيص معالم الهوية الثقافية لمدينة القصر الكبير. إنه مجهود شاق لكنه مثمر، ممتد في الزمن لكنه واعد. إنه مجهود لتشريح السير والتراجم، لا يستطيع اختراق مجاهله وتجاوز انزياحاته إلا كبار النفوس، وهي سمة أصيلة للأستاذ محمد العربي العسري، بل هي اختزال لقيم نكران الذات والوفاء والبذل والعطاء بلا حدود. باختصار، هي جوهر السيرة الذهنية للرائد محمد العربي العسري أولا وأخيرا.
«قراءات في التصوير المغربي المعاصر».. مدخل لإثبات الذات والهوية
شفيق الزكاري
كتاب «قراءات في التصوير المغربي المعاصر» هو أول كتاب أنجزه الفنان التشكيلي والناقد الفني بنيونس عميروش، بعد مدة طويلة من الكتابة والمتابعة للفن التشكيلي المغربي والعربي. وبهذا يكون قد استجمع كتاباته لكي يدون مسيرته ورؤيته النقدية، باعتباره أقرب إلى الكتابة بحكم ممارسته الفنية واشتغاله من داخل المطبخ الفني.
استهل الناقد بنيونس عميروش كتابه بقولة للموسيقار أرنست كيفي، يقول فيها: «ستبدأ الإنسانية بالتحسن عندما نأخذ الفن على محمل الجد كما الفيزياء والكيمياء والمال». قولة تحمل دلالات عميقة لما هو عليه الوضع الفني بالمغرب، خاصة عندما أصبح هذا الجنس التعبيري مهددا بالانقراض من المنظومة التعليمية المغربية مستقبلا، رغم ازدهار وتقدم التجارب الفنية، ممارسة وتنظيرا، مقارنة بالفترة السابقة، وبما يجري في العالم العربي في هذا الجانب.
ونظرا لأهمية الكتاب قدم له الكاتب والناقد والمسرحي والباحث حسن المنيعي، الذي صدرت له هو الآخر عدد من الكتب التنظيرية في مجال الفن التشكيلي، ثم العلاقة الممكنة بين الأجناس التعبيرية الأخرى، إذ يقول في مقطع من مقدمته : «… إن كل دراسة ترتبط بجوهر الجنس تعد مساهمة حقيقية في إثراء الثقافة البصرية ببلادنا. وهذا ما فعله الصديق بنيونس عميروش في كتابه القيم «قراءات في التصوير المغربي المعاصر»، حيث نجده يعقد علاقة حميمة مع عدد من الرسامين ليكشف لنا تجاربهم التصويرية…».
من هنا نفهم بأن هذا الكتاب لم يعتمد على الدراسة التحليلية المنفصلة عن المتابعة والمجاورة، أي أن الناقد بنيونس عميروش تعمد الاتصال بالفنانين ومعايشة تجاربهم عن قرب ومحاولة النفاذ إلى أغوار طريقة تفكيرهم ومعالجتهم للقضايا الكبرى في هذا المجال.
وقبل أن يتناول هذه التجارب في كتابه، أكد بنيونس عميروش على ضرورة الوقوف عند مرحلة مبكرة في تاريخ التشكيل المغربي المعاصر، وهي مرحلة أواسط الستينيات التي عرفت ولادة تكتل فني سمي بجماعة 65، التي كانت عبارة عن تظاهرة فنية واستعراضية للأعمال الفنية بفضاء جامع الفنا بمراكش كفضاء خارجي، في محاولة لربط الجسور بين الفن والمتلقي على مستوى شريحة اجتماعية شاسعة، لتأسيس تصور حول ثقافة مشهدية بمرجعية هندسية إسلامية، بما فيها الصناعة التقليدية وما تزخر به من أشكال وألوان وتكوينات تعددت أسندتها كالزرابي والجلد والنحاس والجبص والمرمر إلى آخره، فكان من بين المساهمين الأساسيين في تكوين هذه الجماعة التي صاغت بيانها الناقدة الفنية الإيطالية طوني مريني، محمد شبعة، محمد المليحي وفريد بلكاهية.
إن قراءة هذه التجارب لا تخضع لدراسة كرونولوجية أو تاريخية بالمفهوم التراتبي، كما أشار إلى ذلك الأستاذ حسن المنيعي، بل هي تجميع لعدد من النصوص المرتبطة براهنية التجربة في حد ذاتها لكل فنان على حدة، والتوثيق لها. ولهذا تناول بنيونس عميروش في الشطر الأول من الجزء الأول في هذا الكتاب حيثيات ولادة هذه الجماعة وأهدافها، قبل أن ينتقل للحديث عن التجارب المكونة لها لكل من محمد شبعة، الذي خصص له عنوانا مثيرا في تبويبه الأول هو : «من الميكانيكا إلى السحر»، مع جرد لبدايات اهتمام هذا الفنان وعمله على إصلاح المنظومة الفنية التي عملت على إعادة النظر في هيكلة المناهج التدريسية بالمدارس الفنية والانسلاخ عن التبعية والاستلاب الاستعماري، ثم الانتقال إلى تفكيك تجربته التي اعتمدت في نظر الناقد عميروش، انطلاقا من تصور الفنان محمد شبعة، على ضرورة إعادة صياغة التعامل مع الموروث الثقافي المغربي، وخاصة فن العمارة والهندسة والصناعة والتقليدية، إلى جانب مساهماته التنظيرية التي كان سندها مجلة «أنفاس»، بالإضافة إلى إبداعاته في مجالات أخرى كالكرافيك والإشهار وتصميم الملصقات وأغلفة الكتب وإنجاز برامج إذاعية وتلفزية باعتبارها الجسر الذي يمكن من خلاله اختراق ذوق المتلقي وتربيته وتحسيسه بأهمية وضرورة الجماليات.
وتحت عنوان «تعارض الشهوة والمقدس» ولج الناقد بنيونس عميروش عوالم الفنان فريد بلكاهية، متتبعا لمسيرته المهنية والفنية، بدءا بمنصبه كمدير لمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء سنة 1962، حين عمل على خلق محترفات لتعليم الصناعة التقليدية، بما فيها الفخار وصباغة الخشب والزربية والحلي…، وصولا إلى اشتغاله على النحاس وتطويعه في تجربته الشخصية، ثم انتقاله إلى سند الجلد واستعماله الألوان الطبيعية كالحناء والزعفران والكوبالت والأحماض وقشور الرمان…، مستعينا بنظرية حداثية لا تمت بصلة إلى الموروث الاستعماري، على مستوى المادة المستعملة، وعلى مستوى الشكل، حيث انطلق من فكرة بدائية لها علاقة بالموقع والفضاء المغربي، دون استيراد أي تقنية أو مواد خارج الرقعة الجغرافية التي تزخر بها إفريقيا، التي اعتبرها الناقد بنيونس عميروش جزءا مهما من مسار فني معاند وممتد عبر عدة عقود لهذا الفنان الحداثي الذي عقد على بانسجام روحه على الهوية في علاقتها بالتاريخ والحضارة.
بعده وتحت عنوان عجائبي «هندسة الفلك»، اختار الناقد بنيونس عميروش اسما مكملا للثالوث الإبداعي المحرك للحداثة التشكيلية بالمغرب في بداياتها، هو محد المليحي، الذي تلقى تعليمه بإيطاليا وأمريكا، محاولا توضيح تأثير بعض معالم هذه المدارس في تجربته منذ أواخر الخمسينيات إلى أواسط الستينيات، مع مساءلته الموروث البصري هو الآخر انطلاقا من التاريخ والذاكرة، وظهور موجاته بألوانها الصارخة، كما هو الحال في الزربية الأطلسية والزمورية بوسط المغرب، كاشتقاق نوراني من جذر الطبيعة على حد قول بنيونس عميروش، في بعدها الرمزي بمرجعيته الطفولية المستمد من محيط مسقط رأسه «أصيلة»، معتمدا في تكويناته على عناصر أربعة تعتبر مصدر الحياة ووجود الكون هي «النار والماء والتراب والهواء».
أما في الشطر الثاني من الكتاب، فاستهل الناقد بنيونس عميروش حديثه عن الفنان محمد القاسمي، حيث ذهب في وصف «حدود التلقي في ثنائية اللغوي والتشكيلي» كعنوان، إلى التوغل في تجربة هذا الفنان وانبهاره بها في إطار مشروع مكتمل جمع بين الممارسة والتفكير والكتابة، انطلاقا من قول الفنان القاسمي: «أن أمارس الفن، معناه أن أفكر»، تبعا لنظرية ديكارت الفلسفية، التي تسمى الكوجيطو.
ثم تحدث الناقد بنيونس عن بعض التظاهرات التشكيلية التي تركت أثرا عميقا في المشهد الفني المغربي، لما طرحته من أسئلة جوهرية، منها «كهف الأزمنة الآتية» وعلاقتها بالزمان والمكان، ثم الإحالة والإيحاء فيها، مع وضع رسومات بيانية لتوضيح التداخل اللغوي والمرئي في عملية التلقي، التي عمل الفنان القاسمي على تطويرها في خطاباته التشكيلية، التي ترتكز على تصورات فكرية يصعب استيعابها، قبل أن ينتقل للحديث عن علاقة اللوحة بالجسد، ثم الانفلات من فضائها الضيق نحو فضاء خارجي يتيح إمكانية التنقل بحرية مطلقة من خلال التدخل في الطبيعة أو ما يسمى فن الأرض أو البيئة Land-art، باعتبارها جزءا من الكون، وطريقة لرفض المظهر التجاري في الفن.
وفي الشطر الثالث والأخير من تجميع هذه النصوص تطرق الكتاب، من خلال عنوان رئيسي هو : «العلامات وإبدالاتها الأيقونية»، إلى تجريدية الحرف، التي يمثلها في بداياتها الفنان عبد الله الحريري، ليصل الناقد إلى جرد للوضعية الثقافية والفنية منذ بداية الاستقلال وما شكله شعار «الأصالة والمعاصرة» من مواجهة بلغت ذروتها بين السياسة والثقافة، على إثر الحراك الاجتماعي الذي عبر عن ضيقه من قبضة النظام في نظر الناقد بنيونس عميروش.
بعد ذلك تحدث هذا الشطر من الكتاب عن تجربة الفنان مصطفى البوجمعاوي، باعتباره رحالة في الزمن الفني من خلال مشروعه الموسوم ب «القافلة»، الذي قدمه بالمغرب وفرنسا، كمشروع عالمي لا يقف عند حدود جغرافية معينة وكعمل محوري يحيط بأعمال فنانين شكلوا مختلف أقطاب الفن العالمي الحديث مثل جورج بازيليت، أنزو كوتشي، نام جون بايك، جون بيير راينو وولفغانغ لايب.
وختم الناقد كتابه بالحديث عن تجارب مغربية أخرى رسخت لمفهوم الحداثة انطلاقا من مستويات تعبيرية أخرى بمختلف مشاربها كتجربة الفنان عبد الحي الملاخ في بستنته للأيقونات الشعبية، وتجربة بوجمعة لخضر، إلى جانب كل من الراحلتين سعدية بيرو والفطرية بنحيلة الركراكية، بسحر علاماتهم المهاجرة، لينتهي بالحديث عن منمنمات الفنان الحاج عبد الكريم الوزاني، الذي زاوج بين رسوم المخطوطات والزخرفة والخط العربي.
قصيدة: محمد عريج
الثّامِنةْ
أكرهُ السّاعةَ الثّامنةْ..
إنّها تزرعُ الرُّعبَ تحتَ وسائدِنا
وتقصُّ شرائطَ أحلامنا المطمئنّةِ
تسرقُ حاجتنا للحياةِ بحريّةٍ
وتحدّدُ وجهتنا في الصباحِ
نسيرُ بلا أيّ وعيٍ
إلى سجننا
ونعودُ، وقدْ سرقَ الوقتُ من عمرنا
لا نحسُّ بما سرقَ الوقتُ
نهملُ أحلامنا اللمْ تزلْ طفلةً
ونسيرُ إلى غدنا سادرينَ
إلى أن تقولَ المراياَ لنا: قدْ كبُرتُمْ
فنضحكُ مستهزئينَ
وننكرُ أعمارنا الطاعِنَةْ
آهِ كم أكرهُ السّاعةَ الثّامِنَةْ.
قصة قصيرة
زياد خداش
سِيدِي
كان سِيدِي خليل في التّسعين من عمره يروح ويجيء في قطعة الأرض الواسعة التي خلْف بَيْتِنا في المُخيَّم، والتي ليست لنا بالطبع، لم يكن يفعل شيئاً مُحدَّداً هُناك، كان يبدو أنَّه يَشْعُر بالضَّجَر، كنتُ أراقِبُه من أعلى الجبل بقنبازه وحطّته وعقاله وهو يمشي ببطء وحزم، ناظراً إلينا بين الحين والآخر، كنتُ أشعُر أنَّه سيصعد إلينا بعد قليل كطفل في التسعين من عمُره ليقول لنا شيئاً ما ويهبط، كُنّا نحن أحفاده نتصايح ونحن نجرجر ألواح الزِّينْكو المُهْتَرِئَة، ذات الثُّقوب مِنْ أعلى الجبل، ونُحاوِل أن نصنع منها بُيوتاً فوق تلك الأرض الواسعة. كان سيدي خليل لا يتوقف عن المشي، رأسه في الأرض، ويداه تتحرَّكان بطريقة غريبة، كأنَّه يُكَلِّمُ أحداً، أو يُهدِّدُ أحداً، أو يُطَمْئِنُ أحداً.
هَجَم سيدي في لحظة غَضَبٍ غير مفهومة على أحفاده، وهُم يبنون بيوتاً من صفائح الزينكو المُهْترِئَة، تفرَّق الأحفاد مَرْعوبِينَ، كان سيدي يلحقهم وهو يصرخ خلفهم : «مش راح تزبط، مش راح تزبط»، ولم نكن نعرف ما المغزى من جُملته المُكَرَّرَة، أمْسَك سيدي بي، تباطَأتُ أمَامَه لأنِّي مطمئناً كنتُ أعرف أنه يُحِبُّنِي، وأنَّه لن يُؤْذِينِي، لكن صَفْعَةَ يَدِهِ الضّخْمَة والخشبية على وَجْهِي فَاجَأَتْ طُمَأْنِينَتِي، لم أفْهَم بالضبط لماذا صفعني سيدي، صاحب الخَمْس بيَّارات في قريته المخطوفة، لكني رَاقبْتُه طويلاً وهو يجلس على الأرض، مكسوراً ومُتَعَرِّقاً ولاهِثاً ومكْرُوراً : «مش راح تزبط، مش راح تزبط».
وتَذَكَّرْتُ حينها أنَّ لا أحد قال لي بوضوح ما معنى أنِّي لاجئ. صفعة جدي على وجهي، قالَتْها لِي بوضوح قاتل.
صلاح ستيتية.. الكائِنُ الشاعِر
نصوصه لا تنجو من الفكر ولا تنجو من البعد الفلسفي العميق
صلاح بوسريف
1 – كان كتاب «ليل المعنى» هو ما أتاح لي أن أتعرَّف على الشاعر اللبناني الأصل، صلاح ستيتية. الكتاب هو حوار مع الشاعر. من خلاله اسْتَطَعْتُ أن أكتشفَ عُمْق رؤية صلاح للشِّعر، وانشغاله الكبير بقلق الكتابة، أو ما كان يعتري هذا الشاعر من «تَقَشُّفٍ» وريبةٍ وتَرَدُّدٍ إزاء الشِّعر، الذي لم يكن يراه مُجرَّد حِبْر على وَرَقٍ، بقدر ما كان مشغولاً بما يمكن أن يُتيحَه العمل الشِّعري من قيمة شعرية، وما يمكن أن يفتحه من طُرُق ومسالك.
2 – قراءتي لبعض أعمال صلاح ستيتية أتاحتْ لي أن أتعرَّف على الشاعر في شعره، وأن أكتشف العمق المعرفي الذي كان صلاح يصدر عنه في رؤيته للشِّعر، وفي كتابته، والتنظير له، أيضاً. فما كتَبه من مقدماتٍ لدواوين، وأعمال فنية، تُتِيح لقارئه أن يضع يَدَه على معنى الشِّعر عند هذا الشاعِر، وما كان يَسْتَثْمِرُه من خبراتٍ ومعارف في كتابته. ولعلَّ في ثقافته التشكيلية، واشتغاله مع عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنان التشكيلي المغربي فريد بلكاهية، في أكثر من عمل، ما أتاح له أن ينقل معطيات هذه التجربة، من العمل الفني الصِّرف إلى الكتابة. عدد من نصوص الشاعر هي اشتغال على أعمال فنية، أو توسيع للغة الشِّعر، ب»لغة» التشكيل والرسم. فالفضاء هو جزء من اشتغال ستيتية، وجزء من وَعْيِه الكتابيّ، الذي فيه يُهَيْمِن المكتوب على الشَّفاهيّ، أو يُقَلِّص سلطته على النص.
3 – أعماله الشعرية «الكاملة» التي صدرت في جزء واحد سنة 2009 بعنوان دالّ وعميق Un lieu de brulure هي تعبير عن هذا الزَّواج الأبدي، في تجربة ستيتية، بين لغة الكتابة ولغة الألوان والمساحات والأحجام، أو التعبيرات الهندسية، التي تحضُر بشكل لافِتٍ في شعره. فهو لم يَكْتَف بالاشتغال على اللغة، بما قد تُتيحُه من مجازاتٍ، أو ما يمكن أن تتوسَّعَ فيه من تخْييلات، بل إنَّ تجربته اللغوية انْفَتَحَتْ على البُعد الرمزي، الذي يسمح للدَّوالّ أن تتناسخ وتتناسل في الصفحة، بما في ذلك ما كان يقترحُه عليه بعض الفنانين من رسومات، وأشكال هندسية، أو أحافير، لتكون جزءاً من بنية النص، أو أحد دَوالِّه التي بها كان يَبْتَنِي هذا المعنى الكثير والمُتَعدِّد، أو المفتوح على ما يتجاوز حدود المعنى نفسه، إلى رحابة وانْشِراح الدَّلالة.
4 – رغم أنَّ صلاح ستيتية يكتب بالفرنسية، ورغم إقامته بفرنسا أكثر من أربعين سنة، وعلاقته بشعراء فرنسيين من الذين كان لهم حضور قوي في المشهد الشِّعري الكوني، وما شهده من أحداث كبرى، كان لها تأثير في مجريات المعرفة والإبداع الفرنسيين، فهو لم يتنكَّر لثقافته العربية، ولم يُدِر ظهره لِلُّغَة العربية، التي ظلَّ يُقَدِّرُها، ويتكلَّم بها، لأنه هو من اخْتار العودة إليها، باعتبارها مصدراً من مصادر تكوينه الأوَّلي، الذي يعود به لوالده، ولِما تلقَّاه من تكوين في مراحل التَّعَلُّم الأولى. كان للعربية في هذه المرحلة من حياة الشاعر حضور لافِت، رغم ما يُكِنُّه للفرنسية من شَغَفٍ وحُبٍّ كبيريْن. فهو لم يخرج من معرفته الشِّعرية بالثقافة العربية الإسلامية، ومعرفته بتاريخ هذه الثقافة، وما راكَمَتْه من معارف وإبداعات، فحضور التراث الصُّوفي في شعره واضح، ولا يمكن لِمَن يعرف هذا الموروث، ويعرف بعض شعرائه الأساسيين أن يُخْطِئَ حضور هؤلاء في أعمال الشاعر، ليس من باب الاستشهاد، أو التوظيف التَّزْيينى الذي يكتفي بظاهر النص، أو بما فيه من إحالة، بل إنَّ ستيتية، كما حَرِص على تذويب ثقافته ومعرفته الفرنسيين في رؤيته، وفي ما له من خبرة في الكتابة، وفي علاقته باللون، وبالأشكال والأحجام الهندسية التي لها علاقة بفضاء اللوحة، أو العمل الفني، فقد ذَوَّب الموروث الصوفي في تجربته، بنوع من التركيب الخيميائي، الذي هو عنده ابْتِداع برؤية حداثية، وليس تقليداً، أو اتِّباعاً، لأنَّه، في طبيعة تكوينه، كان يرفض أن يكون ما يكتبُه سطحاً، أو قِشْرَةً، أو بالأحرى تنويعاً على نموذج سابقٍ، أو صَدًى لصوتٍ، أيّاً كانت قيمة هذا الصَّوْت.
5 - نصوصه لا تنجو من الفكر، ولا تنجو من البُعد الفلسفي العميق. فنيتشه، وهايدغر، بشكل خاص، حاضران في هذا البُعد، ولَهُما في رؤيته الفكرية مكانهما، بما يعنيه ذلك من امتلاك لزمام فكرهما، وتشغيل له، وفق مقتضيات الحال، كما يقول القدماء.
6 – فهو مُقٍلٌّ، «مُتَقَشِّفٌ»، لكنه، كان، دائماً، شديد الحرص على القيمة الشِّعرية، لا على الوفرة والكَمّ. وليس سهلاً على قارئ صلاح ستيتية أن يخترق تجربته بِيُسْر، أو أن يقرأها باسترخاء. تجربة كهذه، بما تحمله في طيَّاتِها من اشتغال شعري مدروس، وبما في ثناياها من مراجع، لا تكتفي بالتراث أو بالمعرفة النصية، تفرض وُجودَ قارئ مُثابر وصَبُور، يقرأ ويُعيد القراءة، ولا يُغْلِق على نفسه في شعر الشاعر، فقط، بل يخرج إلى عوالمه الأخرى، التي هي حاضرة في شعره، بنوع من التَّذْوِيب الإبداعي، الذي تبدو فيه رؤية الشاعر حاضرةً، بما فيها من عمق وخصوصية شعريين. وكما يقول عنه أحد الكُتَّاب، ف»شعر صلاح ستيتية شعر هندسي بنسب دقيقة، مبني بناءً عجيباً، قريباً من التجريد، وهو نحت في الضوء، أو نحت في المعنى الذي هو بدوره يدور في ذاته، أي في معنى المعنى «وغالباً ما هو استطراد»، ولكنه استطراد لمعنى قديم مبهم كأنَّه الأبدية (أي في بعده المعرفي) في ما يمكنه أن يُلامِسَ إشارات الصوفية، شيء يمحو شيئاً من حيث يشبهه أو يلغيه».
7 – الإلغاء،هنا، هو ذلك المحو الذي ظل صلاح ستيتية يمارسُه دون كَلَلٍ، دَرْءاً لحضور «الشبيه»، أو انْسِرابه في طيَّات النص. وهو تعبير عن التَّصَدّعات التي لا ينجو منها النص، مهما كان وعي الشاعِر بانشقاقاته. فنصوصه، دائماً، غير منتهية، وغير مكتملة، وهي «شيء يمحو شيئاً»، مثلما يحدث بين الليل والنَّهار.
8 – اللاَّمُدْرَك، واللامرئي، في تجربة صلاح ستيتية، هو بالذَّات، هذا الانصهار المرجعي في تجربة الشاعر، الذي هو انْفِلاتُ التجربة من التكرار والاستعادة، وانفرادها بذاتها، باعتبارها قيمة مُضافَةً، وطريقاً آخر، بين عدد من طُرُق الشِّعر، التي يستشعرها قارئ الشِّعر النَّبِيه والحصيف، بمجرد أن يفتح النص على مجهولاته، أعني على ما يُتيحُه من آفاق للتَّخْييل، ولوضع اللغة في أفق اشتعالها. في هذا اللامدرك واللامرئي تبدو تلك الشقوق والتَّصَدُّعات، التي تشي بالمحو، وبالنُّقصان.
اللغة التي لا تُفْضِي بقارئها إلى هذا النُّقْصان، أو اسْتِشْعار هذا النقصان، تبقى لغة قاصرةً، أو هي لغة لا تزال في طور التكوين، لأنَّ ثمَّة ما يجعل جمرَها يبقى كامناً في رماده. وصلاح ستيتية هو واحد من الشُّعراء الذين وضعوا الشِّعر في أوْج اشتعاله، أو بلغوا به شِدَّة هذا الاشتعال.
9 – في لقائي بصلاح ستيتية، بفرنسا، وفي ما جرى بيْننا من حوارات ونقاشات، رفقة أصدقاء آخرين من الشُّعراء، والحوار الطويل الذي أجريناه معه، على مدار أكثر من ثلاث ساعات، أدْرَكْتُ هذا المعنى العميق أو البعيد الذي يحمله الشاعر في نفسه، ويحيا به، كما يحيا بالماء والهواء. وسواء كان هذا المعنى عنده «ناراً» أعني اشتعالاً، أو «ماءً» بتعبيره «أن تدفن النَّار هو أن تحلم بالماء»، فهو يبقى حضوراً دائماً، واقتفاءً ل»ليل المعنى»، لهذا المُظْلِم، المُعْتِم، في كل كتابة عميقة، وبعيدة، ولِما يغمره من عمق وكثافة. وربما هذا ما حَذا بصلاح أن ينظر إلى الشِّعر باعتباره «غير المدرك» حين يصير، في شفافته وانْفِراطه، ربما، «غير مرئي»، لكنه يَلْفَحُ الرُّوحَ، ويُضفي عليها بعض انشراحه.
10 – في ترجمة شعر صلاح ستيتية إلى العربية ما قد يسمح باستعادتِه للغَتِه الأم التي بقي مُقيماً فيها، رغم تعذُّر الكتابة بها، بنفس مستوى الفرنسية، ولم يتنازل عن الكلام والحوار بها، بما سيؤكِّد فكرة ستيتية حول انتمائه لِضِفَّتَيْ البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الذي هو بحر الشِّعر والأنبياء، وهو بامتياز بحر المعرفة والإبداع الإنسانِيَيْن. والعربية باستعادتها لستيتية، من خلال ترجمته، قد تكون جَسَّرَتْ العلاقة بين الضِّفَتَيْن، وفتحت ماءَ، أو ملحَ المتوسط، على دَفْقِه الدَّائم والأبدي.
11- في المعرفة، وفي الشِّعر، تحديداً، لا مسافةً بين ماء وماء، لأنَّ لغة الخيال، ولغة الإبداع، هي لغة الكائن وهو ينحت مجراه في أفق الشِّعر، وفي أفق المعرفة التي هي إضافة واختلاق، مهما كانت اللغة التي يكتب بها الشاعر. وهذا ربما ما جعل أدونيس، في ما كتبه عن صلاح ستيتية، يقول عنه إنَّه شاعر عربي يكتب بالفرنسية.
الحساسية الشعرية الجديدة بالمغرب