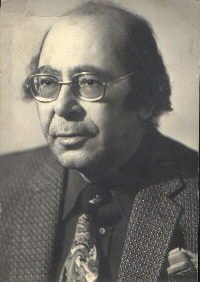على الرغم من كل ما عاناه «عبدالرحمن الخميسى» من أهوال وويلات، لم يُفارقه أبدًا إحساسه بدفق الوجود وإيقاع والحياة، ولا إقباله عليهما إقبال المشوق المُتعطش، ينهل منهما بكل ما يستطيع من طاقة على الحب والغناء، ويُعطيهما كل ما يملك من أمل ورجاء، فهو يحب، ويُنشد، ويتزوج، ويُنجب أطفالًا عديدين، ويفيض بكرمه الحاتمى على كل من حوله، حتى لُـقّبَ بـ«القديس» لفرط رهافة وجدانه، وتفانيه فى خدمة معارفه، بل حتى الغرباء، واعتياده على العطاء المطبوع لكل من حوله، حتى فى أيام العوز والإملاق فى حياته، وما أكثرها.
ويعجب المرء: كيف لمثل هذه الشخصية العجيبة، التى يخال لمن يعرفها، أو يسمع عنها، أنها فى إقبالها النهم هذا على ارتشاف كل معطيات الحياة لا تملك فائض وقت، أو باقى جهد لتقديم كل ما أنتجته وقدمته للثقافة والفكر والإبداع؟ فهو، إضافة إلى كتاباته التى تتناول قضايا الوطن والناس، ونضاله السياسى الذى دفع ثمنه من حبس لحريته فى السجون والمُعتقلات، يكتب ويُصدر فى نحو عقد واحد من السنين، «عقد الخمسينيات وبداية الستينيات»، ١٣ عملًا أدبيًا متنوعًا: «من الأعماق» «مجموعة قصصية»، «المُكافحون»، «سير لروّاد النضال»، «قمصان الدم»، «قصص قصيرة أهداها إلى الرفاق خلف الأسوار، أو أمام الأسوار، داخل السجن الكبير»، «يوميات مجنون»، «ترجمة لموباسان وتشيكوف وغيرهما»، «ألف ليلة وليلة الجديدة» «جزءان»، «مناخوليا» «قصص قصيرة»، «دماء لا تجف» «مجموعة قصصية»، «صيحات الشعب» «قصص قصيرة»، «رياح النيران» «قصص قصيرة»، «أمينة» «قصص قصيرة»، «البهلوان المُدهش» «مجموعة قصصية»، «أشواق إنسان» «ديوان الشعر الأول»، «دموع ونيران» «ديوان شعر».
ثم إنه لا يكتفى بذلك، بل يُقدّم للحياة الفنية والفكرية المصرية عددًا من أبرز رموزها الإبداعية: «يوسف إدريس»، «سعاد حسنى» و«محرم فؤاد» فى «حسن ونعيمة»، و«فؤاد المهندس» وغيرهم، ثم يبدع أعمالًا سينمائية: كتابةً وإخراجًا وتأليفًا للموسيقى: «الجزاء» ١٩٦٥، «عائلات محترمة» ١٩٦٨، «الحب والثمن» ١٩٧٠، «زهرة البنفسج» ١٩٧٢، ويمثل فى الأفلام «الشيخ يوسف فى فيلم يوسف شاهين الأرض»، ويؤلف ويُخرج ويكتب الموسيقى للمسرح التمثيلى «الحبّة قُبّة، القسط الأخير، حياة وحياة، عقدة نفسية»، وللمسرح الغنائى: «الأرملة الطروب».. إلخ. والمدهش أنه، كما ذكر الأستاذ «محمد عودة»: «حقق شيئًا لم يُحققه فى التاريخ البشرى إلّا أفراد قلائل، وهو أنه نبغَ فى جميع الأعمال الفنيّة التى أداها على تنوعها».
كان كاتبنا الكبير «يوسف إدريس» يقول ما معناه إن كل ما يوجد من حرية فى منطقتنا العربية لا يكفى لحياة مبدع واحد، وإن صح هذا القول على كائن، فإنما يصح على «الخميسى»، الذى ضاقت به مصر على رحابتها، فغادرها، بعد زيارة السادات للقدس المُحتلة، باكى العينين، موجوع الفؤاد، فارغ الجيوب، ليطوف بـ«أرض الله» الواسعة، حتى استقرَّ فى «الاتحاد السوفيتى» السابق، الذى سبقه إليه ابنه «أحمد الخميسى»، المثقف والكاتب البارز، وسرعان ما أصبح «القديس»، «عمدة» المصريين والعرب، وراعيهم فيه، وتعرَّف فى فترة إقامته به على أعيان الفكر والثقافة والسياسة السوفيت، وقرأ وكتب وترجم وأحبَّ، وجمع حوله العشرات من المحبين والمسحورين بشخصيته التى ندر أن يكون لها شبيه، لكنه أبدًا لم ينس محبوبته الأولى، التى تسكن شغاف القلب، وتُطل كل لحظة من تلافيف الوجدان، ومتاهات الذاكرة: مصر.
لقد حدد «الخميسى» مهمته التى حملها على عاتقه طوال أيام حياته: «إن لى رسالة إنسانية أريد أن أبلغها إلى الناس»، وكانت حياته، بكل تفاصيلها المُرّة والحلوة، هى أجمل وأكمل إنتاجه المُبدع، وهى جوهر رسالته المكتمل.
وكانت وصية «القديس» قبل رحيله لابنه «أحمد»: «إذا حلّت نهايتى، فقم بدفنى إلى جوار شجرة فى المنصورة (محل ميلاده)، أو ازرع لى شجرة إلى جوار قبرى، لأننى سأعود عصفورًا، ولا بد أن أجد مكانًا حتى أغنّى من فوق أغصانه».
وحتى يستمر غناء «القديس» يشجينا، اقترح المشاركون فى ندوة معرض القاهرة للكتاب، الأساتذة: «أسامة الرحيمى» و«طارق فهمى حسين» و«محمود عبدالشكور»، وكاتب هذه السطور، أن يُطلق اسمه على دورة المعرض المقبلة «٢٠٢١»، وأن تُعيد هيئة الكتاب أو الثقافة الجماهيرية طبع أعماله الكاملة، وأن يُطلق اسمه على قصر من قصور الثقافة أو مدرسة أو شارع أو مكتبة، فى مدينته «المنصورة»، التى وُلد بها، وفى ترابها يرقد جثمانه.. فهل يتحقق هذا الأمل؟
ويعجب المرء: كيف لمثل هذه الشخصية العجيبة، التى يخال لمن يعرفها، أو يسمع عنها، أنها فى إقبالها النهم هذا على ارتشاف كل معطيات الحياة لا تملك فائض وقت، أو باقى جهد لتقديم كل ما أنتجته وقدمته للثقافة والفكر والإبداع؟ فهو، إضافة إلى كتاباته التى تتناول قضايا الوطن والناس، ونضاله السياسى الذى دفع ثمنه من حبس لحريته فى السجون والمُعتقلات، يكتب ويُصدر فى نحو عقد واحد من السنين، «عقد الخمسينيات وبداية الستينيات»، ١٣ عملًا أدبيًا متنوعًا: «من الأعماق» «مجموعة قصصية»، «المُكافحون»، «سير لروّاد النضال»، «قمصان الدم»، «قصص قصيرة أهداها إلى الرفاق خلف الأسوار، أو أمام الأسوار، داخل السجن الكبير»، «يوميات مجنون»، «ترجمة لموباسان وتشيكوف وغيرهما»، «ألف ليلة وليلة الجديدة» «جزءان»، «مناخوليا» «قصص قصيرة»، «دماء لا تجف» «مجموعة قصصية»، «صيحات الشعب» «قصص قصيرة»، «رياح النيران» «قصص قصيرة»، «أمينة» «قصص قصيرة»، «البهلوان المُدهش» «مجموعة قصصية»، «أشواق إنسان» «ديوان الشعر الأول»، «دموع ونيران» «ديوان شعر».
ثم إنه لا يكتفى بذلك، بل يُقدّم للحياة الفنية والفكرية المصرية عددًا من أبرز رموزها الإبداعية: «يوسف إدريس»، «سعاد حسنى» و«محرم فؤاد» فى «حسن ونعيمة»، و«فؤاد المهندس» وغيرهم، ثم يبدع أعمالًا سينمائية: كتابةً وإخراجًا وتأليفًا للموسيقى: «الجزاء» ١٩٦٥، «عائلات محترمة» ١٩٦٨، «الحب والثمن» ١٩٧٠، «زهرة البنفسج» ١٩٧٢، ويمثل فى الأفلام «الشيخ يوسف فى فيلم يوسف شاهين الأرض»، ويؤلف ويُخرج ويكتب الموسيقى للمسرح التمثيلى «الحبّة قُبّة، القسط الأخير، حياة وحياة، عقدة نفسية»، وللمسرح الغنائى: «الأرملة الطروب».. إلخ. والمدهش أنه، كما ذكر الأستاذ «محمد عودة»: «حقق شيئًا لم يُحققه فى التاريخ البشرى إلّا أفراد قلائل، وهو أنه نبغَ فى جميع الأعمال الفنيّة التى أداها على تنوعها».
كان كاتبنا الكبير «يوسف إدريس» يقول ما معناه إن كل ما يوجد من حرية فى منطقتنا العربية لا يكفى لحياة مبدع واحد، وإن صح هذا القول على كائن، فإنما يصح على «الخميسى»، الذى ضاقت به مصر على رحابتها، فغادرها، بعد زيارة السادات للقدس المُحتلة، باكى العينين، موجوع الفؤاد، فارغ الجيوب، ليطوف بـ«أرض الله» الواسعة، حتى استقرَّ فى «الاتحاد السوفيتى» السابق، الذى سبقه إليه ابنه «أحمد الخميسى»، المثقف والكاتب البارز، وسرعان ما أصبح «القديس»، «عمدة» المصريين والعرب، وراعيهم فيه، وتعرَّف فى فترة إقامته به على أعيان الفكر والثقافة والسياسة السوفيت، وقرأ وكتب وترجم وأحبَّ، وجمع حوله العشرات من المحبين والمسحورين بشخصيته التى ندر أن يكون لها شبيه، لكنه أبدًا لم ينس محبوبته الأولى، التى تسكن شغاف القلب، وتُطل كل لحظة من تلافيف الوجدان، ومتاهات الذاكرة: مصر.
لقد حدد «الخميسى» مهمته التى حملها على عاتقه طوال أيام حياته: «إن لى رسالة إنسانية أريد أن أبلغها إلى الناس»، وكانت حياته، بكل تفاصيلها المُرّة والحلوة، هى أجمل وأكمل إنتاجه المُبدع، وهى جوهر رسالته المكتمل.
وكانت وصية «القديس» قبل رحيله لابنه «أحمد»: «إذا حلّت نهايتى، فقم بدفنى إلى جوار شجرة فى المنصورة (محل ميلاده)، أو ازرع لى شجرة إلى جوار قبرى، لأننى سأعود عصفورًا، ولا بد أن أجد مكانًا حتى أغنّى من فوق أغصانه».
وحتى يستمر غناء «القديس» يشجينا، اقترح المشاركون فى ندوة معرض القاهرة للكتاب، الأساتذة: «أسامة الرحيمى» و«طارق فهمى حسين» و«محمود عبدالشكور»، وكاتب هذه السطور، أن يُطلق اسمه على دورة المعرض المقبلة «٢٠٢١»، وأن تُعيد هيئة الكتاب أو الثقافة الجماهيرية طبع أعماله الكاملة، وأن يُطلق اسمه على قصر من قصور الثقافة أو مدرسة أو شارع أو مكتبة، فى مدينته «المنصورة»، التى وُلد بها، وفى ترابها يرقد جثمانه.. فهل يتحقق هذا الأمل؟