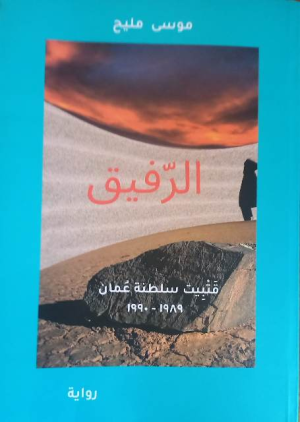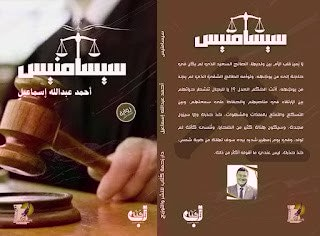يعد الناقد الفرنسي رولان بارت أحد أعمدة النقد العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين. وما زال تأثيره يثير جدلاً بين المؤيدين والمعارضين لتوجهاته النقدية والفكرية. ومع ذلك يبقى مرجعاً أساسياً، لا يمكن تجاوزه سواء اتفقنا معه أو خالفناه. وتعود مقالته التي أقدّم ترجمتها هنا، إلى منتصف الستينيات حيث كان الاتجاه البنيوي في النقد يمتد على مساحة واسعة من الحركة النقدية العالمية.
وهناك أكثر من ترجمة لهذه المقالة: منها ترجمة أنطوان أبو زيد المنشورة في كتاب بعنوان (النقد البنيوي للحكاية) ضمن منشورات عويدات في بيروت، في سلسلة (زدني علماً). أما الترجمة الأهم فهي ترجمة د. منذر عياشي الصادرة عن مركز الإنماء الحضاري، في حلب، عام 1993. وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلـه الدكتور منذر إلاّ أنه ابتعد أحياناً عن روح النص، وخرج بذلك عن المعنى المقصود، بالإضافة إلى بعض الأخطاء في تقديم المصطلح البديل للمصطلح الفرنسي.
وسأترك للقارئ أمر الموازنة، والتأكد من أهمية هذه الترجمة، والمادة العلمية التي تقدمها.
مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكيات*
لا يمكن حصر المحكيات في العالم. فهناك أولاً تنوع كبير في الأجناس، والتي تتوزع، هي نفسها، على ماهيات مختلفة كما لو أن كل مادة كانت مناسبة للإنسان لكي تمنحه محكياته: يمكن أن يدعم المحكى من خلال اللغة الواضحة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، ومن خلال الصورة الثابتة أو المتحركة، ومن خلال الحركة، أو من خلال خليط منظم من هذه المواد كلها، والمحكي حاضر في الأسطورة، والحكاية الخرافية، والحكاية، والقصة، والملحمة، والتاريخ، والتراجيديا، والدراما، والكوميديا، والمسرحية الإيمائية، واللوحة المرسومة (ونحن نفكر بالقديسة يورزول لكارباستو)، والرسم على الزجاج الملون، والسينما ومجالس الشعب*، والوقائع المختلفة، والمحادثة. بالإضافة إلى ذلك، وتحت هذه الأشكال التي لا تعد تقريباً، فإن المحكى حاضر في الأزمنة، والأمكنة، والمجتمعات كلها؛ لقد بدأت الحكاية مع تاريخ الإنسانية نفسه، لا يوجد، ولم يكن يوجد قط شعب من دون حكاية؛ فلكل الطبقات الاجتماعية، ولكل الجماعات البشرية حكاياتها الخاصة بها، وغالباً ما يتم التذوق الجماعي المشترك لهذه الحكايات من خلال ناس من ثقافات مختلفة، وحتى متناقضة1: المحكى يسخر من الأدب الجيد أو الأدب الضعيف: المحكى حاضر، مثل الحياة، فهو عالمي، ومتجاوز للتاريخ، والثقافات. أيجب أن تقود مثل هذه الشمولية للمحكي إلى ضياع معناه؟ وهل هو عام إلى هذا الحد الذي لا يبقى لنا فيه شيء نضيفه إلا وصف بعض أصنافه الخاصة جداً بصورة متواضعة، مثلما يفعل أحياناً التاريخ الأدبي؟ ولكن كيف يمكن السيطرة على هذه الأصناف نفسها، وكيف نؤسس قانوننا لتمييزها، والتعرف عليها؟ كيف نضع الرواية مقابل القصة، والحكاية مقابل الأسطورة، والدراما مقابل التراجيديا (وحدث ذلك ألف مرة) من دون العودة إلى نموذج عام؟ هذا النموذج مشترك في كل كلام عن الشيء الأكثر خصوصية، وتاريخية في الأشكال السردية. ولكي لا يقال إننا نهرب من الحديث عن المحكي، بحجة أن الأمر يتعلق بشيء عام، فإنه من المشروع، إذن، الاهتمام، بين حين وآخر، بالشكل المحكي (منذ أرسطو)؛ ومن الطبيعي أن تجعل البنيوية حديثة الولادة، من هذا الشكل من أوائل اهتماماتها: ألا يتعلق الأمر دائماً بالنسبة للمحكي، بحصرٍ مطلق أنواع الكلام، عبر الوصول إلى تحديد اللغة التي انبثقت منها هذه الأنواع، والتي يمكننا، انطلاقاً منها، توليدها (الأنواع)؟
أما العدد المطلق للمحكيات، وتعدد وجهات النظر التي يمكننا الحديث عنها في هذه المحكيات (تاريخية، ونفسية، واجتماعية، وعرقية، وجمالية، إلخ…)، يجد المحلل نفسه، تقريباً وبالتدريج، في موقع سوسور الذي وقف أمام الشاذ في اللسان وبحث عن استخلاص مبدأ تصنيف، ومكان للوصف ضمن هذه الفوضى الظاهرة للرسائل. منذ أجل الوقوف، في هذا المجال، عند المرحلة الحالية، لقد علمنا الشكلانيون الروس، وبروب، وكلود ليفي شتراوس، تحديد البرهان التالي:
المحكي إما مجرد كلام فارغ عن أحداث لا يمكننا، في أي حالة، الحديث عنها إلا إذا عدنا إلى الفن، والموهبة أو عبقرية السارد (المؤلف) وكل الأشكال الأسطورية للمصادفة2، أو أنه يمتلك بصورة عامة، مع محكيات أخرى، بنية قابلة للتحليل، وتحتاج إلى بعض الصبر لكشفها؛ لأن هناك هوة بين الشيء الصدفوي الأكثر تعقيداً، والشيء التركيبي الأكثر بساطة، ولا يستطيع أحد تركيب أو (إنتاج) حكاية من دون العودة إلى منظومة خفية من الوحدات والقواعد. أين نبحث، إذن، عن بنية الحكاية؟ الجواب هو، دون شك، في المحكيات. ولكن هل في المحكيات كلها؟ كثير من الشارحين الذين يوافقون على فكرة البنية السردية، لا يستطيعون، مع ذلك، التسليم بأبعاد التحليل الأدبي عن أنواع العلوم التجريبية: إنهم يطلبون، بجرأة، أن يطبق على السرد منهج استقرائي خالص، وأن يبدأ بدراسة كل المحكيات في جنس، وعصر، ومجتمع، من أجل الانتقال، بعد ذلك، إلى تقديم نموذج عام. هذه النظرة ذات المعنى الجيد مثالية. فاللسانيات نفسها التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف لغة لم تصل إلى هذا النموذج العام؛ وبعقلانية، جعلت اللسانيات من نفسها استنتاجية، بالإضافة إلى أنها لم تستطع إلا إلى اليوم أن تتشكل بصورة حقيقية، وأن تتطور، وأن تتنبأ بأشياء لم تكن معروفة من قبل3. ما الذي يقال، إذن، عن التحليل السردي، الموضوع أمام ملايين من المحكيات؟ إن التحليل محكوم عليه اللجوء إلى الطريقة الاستنتاجية، وهو مجبر، أولاً، على تصور نموذج افتراضي للوصف (والذي يسميه اللغويون الأمريكيون نظرية)، وعلى النزول، بعد ذلك، بالتدريج، وبالاعتماد على هذا النموذج، نحو الأنواع التي تسهم فيه، وتبتعد عنه في الوقت نفسه: وهو في مستوى هذه المطابقات والانزياحات فقط، سيجد تعددية المحكيات وتنوعها التاريخي، والجغرافي، والثقافي4، وهو يمتلك وسيلة وحيدة للوصف.
من أجل تحديد التنوع المطلق للمحكيات وتصنيفها، يجب، إذن، امتلاك نظرية (بالمعنى البراغماتي الذي تحدثنا عنه منذ قليل)، ويجب العمل أولاً على البحث عنها، ووضع خطوطها العريضة. يمكن أن يكون تأسيس هذه النظرية سهلاً جداً إذا خضعنا منذ البداية، لنموذج يقدم لها مصطلحاتها ومفهوماتها الأولى. ضمن الواقع الحالي للبحث، يبدو منطقياً، أن تقدم اللسانيات نفسها كنموذج مؤسس للتحليل البنيوي للحكاية.
1-لغة المحكي
1-1-ما وراء الجملة.
إننا نعرف أن اللسانيات توقفت عند الجملة: إنها الوحدة الأخيرة التي تعتقد اللسانيات بأحقية الاهتمام بها، في الواقع، إذا كانت الجملة منظومة وليست سلسلة، ولا يمكن اختزالها إلى مجموعة من الكلمات التي تؤلفها، وتشكل بذلك، وحدة أصيلة، فإن الملفوظ، بالعكس، ليس شيئاً آخر غير تتابع للجمل التي تؤلفه: من وجهة نظر اللسانيات، لا يمتلك الخطاب شيئاً خارج الجملة: “يقول مارتينيه: الجملة هي أصغر وحدة ممثلة للخطاب بصورة كاملة6. “لم تهتم اللسانيات بموضوع أعلى من الجملة، لأنه لا يوجد بعد الجملة إلا جمل أخرى: إن عالم النبات الذي يصف الزهرة، لا يستطيع الاهتمام بوصف الباقة. ومع ذلك، من الواضح أن الخطاب نفسه (بوصفه مجموعة من الجمل) منظم، ويبدو، من خلال هذا التنظيم، كرسالة من لغة أخرى متفوقة على لغة اللسانيين7: للخطاب وحداته، وقواعده، ونحوه: وفيما وراء الجملة، فإن على الخطاب أن يكون، على الرغم من تركيبه من جمل فقط، موضوع لسانيات ثانية بصورة طبيعية. كان للسانيات الخطاب هذه، وخلال حقبة طويلة عنوان معروف هو: البلاغة؛ ولكن، وكنتيجة للعبة تاريخية، انتقلت البلاغة إلى جانب الآداب الجميلة، وانفصلت الآداب الجميلة عن دراسة اللغة، ووجب حديثاً إعادة طرح المشكلة من جديد: لم تتطور لسانيات الخطاب الجديدة بعد، ولكنها، على الأقل، مسلم بها من قبل اللسانيين أنفسهم8. هذا الأمر ذو دلالة: على الرغم من أن الخطاب يشكل موضوعاً مستقلاً، إلا أنه يجب أن يدرس بالاعتماد على اللسانيات؛ إذا كان يجب تقديم فرضية عمل لتحليل مهمته كبيرة جداً، ومواده لا يمكن حصرها، فإنه من المنطقي أن نبحث عن علاقة متماثلة بين الجملة وبين الخطاب، إلى الحد الذي يكون فيه التنظيم الشكلي نفسه هو الذي يتحكم بكل المنظومات السيميائية، مهما تكن ماهياتها، وأبعادها: الخطاب هو جملة كبيرة (ليس بالضرورة أن تكون وحداتها جملاً)، مثلما أن الجملة تشكل خطاباً صغيراً.
تنسجم هذه الفرضية، جيداً، مع بعض مقترحات علم الإناسة الحالي، لاحظ جاكبسون، وكلود ليفي شتراوس أن الإنسانية تستطيع أن تعرف عن نفسها من خلال القدرة على خلق منظومات ثانوية “كابحة” (أدوات تفيد في صنع أدوات أخرى، لفظ مزدوج للسان، موضوع المحرم الذي يسمح بتفريع العائلات)، يفترض اللساني السوفياتي إيفانوف أنه لا يمكن اكتساب اللغات الاصطناعية إلا بعد اللغات الطبيعية: تكمن الأهمية بالنسبة للناس في القدرة على استخدام أنساق عديدة للمعنى وعلى مساعدة اللغة الطبيعية في تشكيل لغات اصطناعية. من المشروع، إذن، التسليم بوجود علاقة “ثانوية” بين الجملة والخطاب، وستسمى هذه العلاقة تماثلية، من أجل احترام الصفة الشكلية الخالصة للتطابقات. من الواضح أن اللغة العامة للمحكي ليست إلا إحدى الاصطلاحات اللسانية المقدمة للسانيات الخطاب9، وتخضع، بالنتيجة إلى الفرضية التماثلية: المحكي، بنيوياً، شريك الجملة، دون إمكانية أن يختزل إلى مجموعة من الجمل: المحكي جملة كبيرة، مثلما أن كل جملة محققة هي، بطريقة معينة، بداية حكاية قصيرة. على الرغم من أن الأنواع الرئيسية للفعل تمتلك في المحكي دوالاً أصيلة (وغالباً معقدة كثيراً) فإننا نجدها فيه، في الواقع، وهي متضخمة ومتحولة: مثل الأزمنة، والصيغ، والنماذج، والشخصيات، بالإضافة إلى ذلك، تعارض “الموضوعات” نفسها المحمولات الفعلية، ولا تترك نفسها للخضوع للنموذج الجملي (من الجملة): لقد وجد التصنيف الفاعلي الذي اقترحه غريماس10 وظائف أساسية للتحليل القواعدي عبر كثرة شخصيات الحكاية. إن التماثل الذي نشير إليه هنا لا يحمل فقط قيمة استكشافية: إنه يفترض وحدة الهوية بين اللغة والأدب (على الرغم من أنه نوع من الناقل المفضل للمحكي): لم يعد ممكناً تصور الأدب كفن لا يهتم بأي علاقة مع اللغة، منذ أن يستخدمها كأداة للتعبير عن الفكر، والعاطفة، أو الجمال: لا تتوقف اللغة عن مرافقة الخطاب عبر تغطيته بمرآة بنيتها الخاصة: ألا يصنع الأدب، خاصة اليوم، لغةً، بالشروط نفسها للغة؟
1-2-مستويات المعنى:
تقدم اللسانيات إلى التحليل البنيوي للمحكي، منذ البداية، تصوراً حاسماً، لأنها تهتم مباشرة بكل ما هو أساسي في أي نظام للمعنى، أي طريقة تنظيمه، وتسمح، في وقت واحد، بالتعبير عن كيفية أن المحكي ليس مجموعة بسيطة من العبارات، وبتصنيف الكمية الكبيرة من العناصر التي تدخل في تركيب المحكي. هذا التصور هو تصور مستوى الوصف12. إننا نعرف أن الجملة يمكن أن توصف على مستويات عديدة (صوتية، من حيث العناية بالأصوات الإنسانية شرحاً وتحليلاً، والقيام بالتجارب عليها دون نظر خاص إلى ما تنتمي إليه من لغات، وإلى أثر تلك الأصوات في اللغة من الناحية العملية، أو من حيث البحث في الأصوات ذات الوظيفة الدلالية في إحدى اللغات كالبحث في السين والصاد مثل سبر وصبر، ونحوية وسياقية)، تقع هذه المستويات ضمن علاقة تراتبية، لأنه إذا كان لكل مستوى وحداته وعلاقاته الخاصة به، مما يجبر كل مستوى من هذه المستويات على وصف مستقل، فإن أياً منها لا يستطيع لوحده أن ينتج معنى: كل وحدة تنتمي إلى مستوى معين لا تمتلك معنى إلا إذا استطاعت الاندماج بمستوى أعلى: الظاهرة في ذاتها، لا تدل على شيء على الرغم من أنها قابلة للوصف بصورة كاملة؛ وهي لا تشارك في المعنى المندمج في كلمة، وعلى الكلمة نفسها أن تندمج في الجملة13.
تقدم نظرية المستويات (مثلما عبر عنها بينفنست) نموذجين من العلاقات: العلاقات التوزيعية (إذا كانت العلاقات متموضعة على مستوى واحد)، والعلاقات الاندماجية (إذا كانت منقولة من مستوى إلى مستوى آخر). ينتج عن ذلك، أن العلاقات التوزيعية لا تكفي لإدراك المعنى. من أجل القيام بتحليل بنيوي، يجب أولاً، تمييز أحكام عديدة للوصف، ووضع هذه الأحكام ضمن منظور تراتبي (اندماجي). المستويات هي عمليات14. من الطبيعي، إذن، أن تحاول اللسانيات الإكثار منها، خلال عملية تطورها. ما زال تحليل الخطاب غير قادر على العمل إلا على مستويات أولية كانت البلاغة قد حددت للخطاب، بطريقتها، خطتي وصف: هما التنظيم والبيان.
قرر كلود ليفي شتراوس، في تحليله لبنية الأسطورة، أن الوحدات المكونة للخطاب الأسطوري لا تحمل دلالة إلا لأنها مجموعة ضمن مجموعات، وهذه المجموعات نفسها تتحد فيما بينها16، ويقترح تودوروف، وهو يعيد أخذ فكرة الشكلانيين الروس، العمل على مستويين كبيرين، ينقسمان بدورهما إلى أقسام صغرى: القصة (البرهان) المتضمنة لمنطق الأفعال، و “علم تركيب كلام” الشخصيات، والخطاب المشتمل على أزمنة الحكي، وصيغه،ونماذجه17.
مهما يكن عدد المستويات الذي نقترحه، والتعريفات التي نعطيها عنها، لا يمكن أن نثق إلا بأن المحكي هو ترتيب للأحكام. إن فهم حكاية معينة، لا يعني فقط متابعة فك خيط القصة، ولكنه يعني أيضاً التعرف على “الطبقات” فيها، وإسقاط العلاقات الأفقية “للخيط” السردي على محور عامودي ضمني، إن قراءة حكاية (أو الاستماع إليها) لا تعني فقط الانتقال من كلمة إلى كلمة أخرى، ولكنها تعني أيضاً الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر.
سأسمح لنفسي هنا بانتهاج نوع من الدفاع: في “الرسالة المسروقة” يحلل الشاعر الأمريكي “بو” بدقة فشل مدير الشرطة العاجز عن إيجاد الرسالة: كانت حملاته التفتيشية دقيقة وكاملة، مثلما يقول، “ضمن دائرة اختصاصه”: لم يهمل ضابط الشرطة أي مكان، و”أشبع بصورة كاملة مستوى التفتيش”، ولكن من أجل العثور على الرسالة التي يحميها بيقظته؛ كان يجب الانتقال إلى مستوى آخر، واستبدال حصافة رجل البوليس بحصافة مخفي الرسالة. وبالطريقة نفسها، إن “التفتيش” الذي تم على مجموعة أفقية من العلاقات السردية، لم يكتمل، ولكي يكون فعالاً، يجب أن يتوجه أيضاً، “عمودياً”: لا يتموضع المعنى في “نهاية الحكاية”، إنه يتجاوزها؛ وهو واضح أيضاً كالرسالة المسروقة، ولا يمكن أن يضيع إلا في البحث وحيد الجانب.
وهناك دراسات ما زالت ضرورية لكي يمكننا التأكد من مستويات المحكي. وما سنقترحه هنا يشكل صيغة مؤقتةً، وأهميتها تعليمية حصراً: إنها تسمح بتحديد المشكلات وتجميعها، من دون أن نختلف، كما نعتقد، مع بعض التحليلات السابقة. إننا نقترح التمييز بين ثلاثة مستويات للوصف ضمن العمل السردي: مستوى الوظائف (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند بروب وعند بريمون)، ومستوى الأفعال (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند غريماس عندما يتحدث عن الشخصيات كشخصيات فاعلة)، ومستوى “السرد” (الذي هو، بوضوح، مستوى الخطاب عند تودوروف). نريد أن نذكر أن هذه المستويات الثلاثة ترتبط فيما بينها وفق نموذج الاندماج التدريجي: لا معنى للوظيفة في ذاتها إلا إذا أخذت موقعها ضمن العمل العام لفاعل معين؛ وهذا العمل نفسه يأخذ معناه الأخير من حقيقة أنه مسرود، ومعهود به إلى خطاب له قانونه الخاص به.
2-الوظائف
2-1-تحديد الوحدات:
تتألف كل منظومة من وحدات طبقاتها معروفة، ولذلك يجب، أولاً، تقطيع الحكاية، وتحديد أقسام الخطاب السردي التي يمكننا توزيعها على عدد صغير من الطبقات؛ وبكلمة واحدة، يجب تعيين أصغر الوحدات السردية. ووفق المنظور الاندماجي الذي عرفناه هنا، لا يمكن للتحليل أن يكتفي بتعريف توزيعي خالص للوحدات: يجب أن يكون المعنى، منذ البداية، هو معيار الوحدة: إن السمة الوظيفية لبعض أجزاء القصة هي التي تصنع الوحدات فيها: من هنا يأتي اسم الوظائف الذي أعطي مباشرة لهذه الوحدات الأولى. يقسم كل جزء من القصة، منذ عهد الشكلانيين الروس18 إلى وحدة، ويقدم هذا الجزء كنهاية علاقة. إن روح كل وظيفة، هي بذرتها، إذا جاز التعبير، مما يسمح لها بزرع عنصر في الحكاية ينضج لاحقاً، على المستوى نفسه، أو على مستوى آخر: إذا كان فلوبير قد أخبرنا في عمله (قلب بسيط)، وفي لحظة معينة، أن بنات معاون قائد الشرطة في مدينة leveque Pont كن يمتلكن ببغاء، فذلك لأن هذا الببغاء سيكون له أهمية كبيرة، بعد ذلك، في حياة فيليسيتي: إن التعبير عن هذا التفصيل (مهما يكن الشكل اللساني)، يشكل، إذن، وظيفة، أو وحدة سردية. هل لكل شيء في الحكاية وظيفة؟ وهل لكل تفصيل مهما صغر معنى؟ هل يمكن أن تقسم الحكاية إلى وحدات وظيفية، بصورة كاملة؟ سنرى هذا لاحقاً، ولكن مما لا شك فيه أن هناك نماذج عديدة من الوظائف: لأن هناك نماذج عديدة من العلاقات. ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن بناء الحكاية يقوم دائماً على وظائف: وكل شيء فيها يحمل دلالة، بدرجات مختلفة. وهذه ليست مسألة فن (من قبل السارد) ولكنها مسألة بنية: إن ما يسجل، ضمن نظام الخطاب، يستحق الذكر، في الأصل، عندما يبدو تفصيل معين دون معنى، ومتمرداً على أي وظيفة، فإنه يحمل، على الأقل، معنى العبث أو اللا فائدة: إذا لم يكن للشيء معنى انتفى وجوده. يمكننا القول بطريقة أخرى إن الفن لا يعرف الضجيج (بالمعنى الإخباري للكلمة)19: إنه نظام خالص، ولا وجود للوحدات الضائعة20، وسواء كان الخيط طويلاً أم واهناً، أم متماسكاً، فإنه هو الذي يربطها بأحد مستويات القصة21. إن الوظيفة، من وجهة نظر لسانية، هي وحدة من المضمون: هذا يعني أن الملفوظ هو الذي يشكل المضمون ضمن وحدات وظيفية،22 وليس الطريقة التي عبر بها عن هذا المضمون. هذا المدلول التأسيسي يمكن أن يمتلك عدداً من الدوال المختلفة، مراوغة غالباً: إذا قيل لي في (غولدفينجر) إن جيمس بوند رأى رجلاً في الخمسين من عمره، فإن هذه المعلومة تنطوي على وظيفتين، في وقت واحد، وتأثيرهما غير متوازن: إن عمر الشخصية يندمج، من جهة، ضمن نوع من الصورة الشخصية (وفائدة ذلك ليست معدومة في الحكاية، ولكنها منتشرة، ومؤجلة)، ومن جهة أخرى، إن المدلول الآني للملفوظ هو أن بوند لا يعرف محاوره المستقبلي: تتطلب الوحدة، إذن، علاقة قوية جداً، (انفتاح خطر معين، وإلزام بالتحقق). من أجل تعيين الوحدات السردية الأولى، من الضروري، إذن، ألا نضيع، أبداً، من أمامنا السمة الوظيفية للأجزاء التي نفحصها، وأن نقبل، مسبقاً، أن هذه الأقسام لا تتطابق، بصورة قدرية، مع الأشكال التي نعرفها، تقليدياً، في مختلف الأقسام من الخطاب السردي (أفعال، مشاهد، مقاطع، حوارات، حوارات داخلية إلخ..)، وبصورة أقل، مع طبقات ((نفسية)) (مثل التصرفات، والمشاعر، والأهداف، والدوافع، وعقلانية الشخصيات).
وبالطريقة نفسها، عندما لا تكون لغة السرد هي لغة الكلام الملفوظ على الرغم من أنها تدعمها غالباً، فإن الوحدات السردية ستصبح جوهرياً مستقلة عن الوحدات اللسانية: من المؤكد أن هذه الوحدات يمكن أن تتطابق، ولكن ليس باستمرار؛ وستُقدم الوظائف، تارة، عبر وحدات أعلى من الجملة (مجموعات من الجمل بمقاييس مختلفة، وحتى إلى العمل في كليته)، وتارةً أخرى عبر وحدات أدنى من الجملة (مثل التركيب التعبيري، والكلمة، وحتى ضمن الكلمة بعض العناصر الأدبية فقط)؛23 عندما يقال لنا إن بوند يناوب في مكتبه، ويعمل في قسم سري، وفجأة يرن الهاتف (يرفع بوند إحدى السماعات الأربع)، فإن الرقم أربعة يشكل لوحده وحدة وظيفية، لأنه يحيل إلى تصور ضروري لمجموعة القصة (وهو التقنية البيروقراطية العالية)؛ في الواقع، إن الوحدة السردية هنا ليست هي الوحدة اللغوية (الكلمة) ولكن فقط قيمتها الدلالية (لغوياً، لا تهدف الكلمة أربعة أبداً التعبير عن ((الأربعة))؛ هذا يفسر أن بعض الوحدات الوظيفية يمكن أن يكون أدنى من الجملة، مع بقائها تابعة للخطاب، إنها تتجاوز، عندئذٍ، ليس الجملة التي تبقى مادياً أدنى منها، ولكنها تتجاوز مستوى الدلالة الذي ينتسب، مثل الجملة، للسانيات بالمعنى الدقيق للكلمة.
2-2-طبقات الوحدات:
يجب تقسيم هذه الوحدات الوظيفية إلى عدد قليل من الطبقات الشكلية. إذا أردنا تحديد هذه الطبقات دون العودة إلى جوهر المضمون (مثل الجوهر النفسي)، فإنه يجب، من جديد، النظر إلى مختلف مستويات المعنى: ترتبط بعض الوحدات بوحدات أخرى في المستوى نفسه، ولكي يتم إشباع الوحدات الأخرى، يجب على العكس من هذا، الانتقال إلى مستوى آخر. من هنا تأتي، منذ البداية، طبقتان كبيرتان من الوظائف، الوظائف الأولى هي وظائف توزيعية، والوظائف الأخرى هي وظائف اندماجية. تتطابق الأولى مع وظائف بروب، والتي أعاد بريمون أخذها، خاصة، ويطلق على هذه الوظائف التوزيعية اسم “وظائف” (على الرغم من أن الوحدات الأخرى هي أيضاً وظيفية)؛ ونموذجها كلاسيكي منذ تحليل توماشفسكي: إن شراء مسدس حربي يرتبط باللحظة التي سنستخدمه فيها، (وإذا لم نستخدمه، فإن الإشارة ترجع إلى علامة ضعف إرادة)، وإن رفع سماعة الهاتف مرتبط باللحظة التي نعيدها فيها إلى مكانها؛ وإدخال الببغاء إلى بيت فيليسيتي مرتبط بحادثة الحشو بالقش، والعشق الهيامي، الخ. تتضمن الطبقة الكبيرة الثانية من الوحدات، ذات الطبيعة الاندماجية، كل الإشارات (بالمعنى الشامل جداً للكلمة) 24، وبهذا لا تحيل الوحدة إلى فعل تكميلي يكون فيها نتيجة، ولكنها تحيل إلى تصور موسع، إلى حد ما، وضروري لمعنى القصة: مثل الإشارات الطبيعية المتعلقة بالشخصيات، والمعلومات النسبية عن هويتهم، وأخبار الطقس، الخ؛ إن علاقة الوحدة بلازمتها لم تعد علاقة توزيعية (تحيل إشارات عديدة غالباً إلى مدلول واحد، ولم يعد نظام ظهورها في الخطاب متعلقاً بالموضوع، بالضرورة) ولكنها علاقة اندماجية؛ ولكي نفهم فائدة العلامة الإشارية يجب الانتقال إلى مستوى أعلى (أفعال الشخصيات أو السرد)، لأنه هنا فقط يُفك رمز الإشارة، إن القوة المؤسساتية الداعمة لبوند، والواضحة من خلال عدد أجهزة الهاتف، ليس لها أي انعكاس على توالي الأفعال التي ينخرط فيها بوند عبر قبول الاتصال؛ ولا تأخذ معنى إلا على مستوى تصنيف عام للفاعلين (بوند من جهة النظام)؛ إن الإشارات هي وحدات دلالية حقيقية، من خلال الطبيعة العامودية، إلى حد ما، لعلاقاتها، لأن هذه الإشارات، وبعكس ((الوظائف)) بالمعنى الدقيق للكلمة، تحيل إلى مدلول، وليس إلى ((عملية))؛ إن صحة الإشارات ((أعلى))، وقد تكون أحياناً افتراضية، خارج التركيب التعبيري الواضح (يمكن ألا يسمى طبع شخصية معينة أبداً، ولكنه مع ذلك، يشار إليه باستمرار)، وهذه صحة نموذجية، في مقابل ذلك، إن صحة ((الوظائف)) بعيدة دائماً، فهي صحة تركيبية دلالية. تتضمن الوظائف والإشارات، إذن تمييزاً كلاسيكياً آخر: تتطلب الوظائف علاقات كنائية، وتفرض الإشارات العلاقات الاستعارية؛ تتطابق إحداها مع وظيفية العمل، وتتطابق الأخرى مع وظيفية الوجود.
يجب أن تسمح هاتان الطبقتان الكبيرتان المتعلقتان بالوظائف والإشارات بنوع من التصنيف للمحكيات.
بعض المحكيات وظيفية بقوة (مثل الحكايات الشعبية)، وفي مقابل ذلك، هناك محكيات إشاراتية بقوة (مثل الروايات النفسية)؛ وبين هذين المحورين، يوجد سلسلة من الأشكال الوسيطة، والمتعلقة بالقصة، والمجتمع، والجنس. ولكن هذا ليس كل شيء: داخل كل طبقة من هاتين الطبقتين، من الممكن، مباشرةً، تحديد طبقتين فرعيتين من الوحدات السردية.
إذا أخذنا طبقة الوظائف، ليس لوحداتهما الأهمية نفسها؛ فبعضها يشكل مفاصل حقيقية للمحكي (أو المقطع من المحكي)؛ وبعضها الآخر ((يملأ)) الفضاء السردي الذي يفصل الوظائف المفصلية: تسمى الأولى الوظائف الرئيسية (أو المركزية)، وتسمى الثانية وظائف تحضيرية، بالنظر إلى طبيعتها التكميلية. لكي تكون وظيفة معينة وظيفة رئيسية، يكفي أن يفتح الفعل الذي تستند إليه (أو يحافظ أو يغلق) نهاية متكررة بالنسبة إلى تتمة القصة، أي أن يدشن أو ينهي الشك؛ إذا كان الهاتف يرن في جزء من الحكاية، فإنه من الممكن أيضاً أن نجيب عليه أو لا نجيب، مما يقضي بتوجيه القصة ضمن طريقتين مختلفتين. في المقابل، من الممكن دائماً امتلاك إشارات تحضيرية، بين وظيفتين رئيسيتين، تتجمع حول قطب أو آخر دون تعديل طبيعتها التناوبية: إن الفضاء الذي يفصل ((الهاتف رن)) و ((بوند رفع السماعة)) يمكن أن يملأ بكمية كبيرة من الحوادث العرضية الصغيرة، والأوصاف الصغيرة: ((بوند يتوجه نحو المكتب، يتناول السماعة، ويضع سيكارته))، الخ. تبقى هذه المحفزات وظيفية، ضمن الحد الذي تدخل فيه بارتباط مع مركز معين، ولكن وظيفتها مخففة، وأحادية الجانب، وهامشية: يتعلق الأمر هنا بوظيفية تاريخية خالصة، (إننا نصف ما يفصل بين لحظتين من لحظات التاريخ)، في حين أنه في المكان الذي يجمع وظيفتين رئيسيتين، تتجلى وظيفية مزدوجة، فهي تاريخية ومنطقية، في وقت واحد: إن الوظائف التحضيرية ليست إلا وحدات تعاقبية، والوظائف الرئيسية هي وحدات تعاقبية ومنطقية في الوقت نفسه. في الواقع، كل شيء يبعث على الاعتقاد أن باعث النشاط السردي هو تداخل التعاقب والنتيجة، إن ما يأتي -بعد- يقرأ في المحكي على أنه حدث عبر…؛ يصبح المحكي، في هذه الحالة، تطبيقاً نظامياً للخطأ المنطقي، المفروض من الفلسفة المدرسية تحت صيغة (بعد هذا، بسبب قربه من هذا) والذي يمكن أن يكون شعار القدر والذي يكون فيه المحكي، بصورة عامة، هو ((اللغة))؛ وهذا (السحق) للمنطق وللزمن هو دعامة الوظائف الرئيسية التي تكملها، من النظرة الأولى، يمكن أن تكون هذه الوظائف عبر دلالية بقوة؛ وما يشكلها، ليس المشهد (الأهمية، والمجلد، والندرة وقوة الفعل الملفوظ)، ولكن، إذا أمكن القول، الخطر: إن الوظائف الرئيسية هي لحظات الخطر في الحكاية؛ بين هاتين النقطتين من التعاقب، وبين هذين المركزين للتوزيع، تمتلك المحفزات الفرعية مناطق أمان، واستراحة ورفاهية؛ مع ذلك، لهذه (الكماليات)) فائدة: من وجهة نظر القصة، يجب تكرار أن المحفّز يمكن أن يمتلك وظيفة ضعيفة ولكنها ليست قط معدومة: هل هو زائد (بالمقارنة مع مركزه)، ويشارك في اقتصاد الرسالة؛ ولكن ليست هذه هي الحالة: إن الإشارة الزائدة في الظاهر، تحمل دائماً وظيفة استدلالية: إنها تسرع الخطاب، أو تؤخره، أو تعمل على دفعه، وهي تلخص، وتستبق، وأحياناً تضيع27: يبدو المؤشّر إليه دائماً شيئاً يستحق الذكر، والمحفز يوقظ باستمرار التوتر الدلالي للخطاب المقول: وكان لهذا المؤشّر إليه، وسيكون له دائماً معنى في الخطاب؛ إن الوظيفة الدائمة للمحفّز، إذن، وفي كل الحالات، هي وظيفة تنبيهية (إذا استخدمنا تعبير جاكبسون)؛ فهي تحافظ على التواصل بين السارد والمسرود له. لنقل إنه لا يمكن إلغاء مركز معين دون تشويه القصة، ولا يمكن أيضاً إلغاء محفّز دون تشويه الخطاب. أما فيما يتعلق بالطبقة الكبيرة الثانية من الوحدات السردية (الإشارات)، الطبقة الاندماجية، فإن الوحدات التي توجد فيها تشترك في أنها لا تستطيع أن ترمم نفسها (أو أن تكتمل) إلا على مستوى الشخصيات أو على مستوى السرد؛ إنها تشكل جزءاً من علاقة معلمية28، يستمر تعبيرها الثاني الخفي، والتوسعي في حدث، أو شخصية، أو في العمل كله؛ مع ذلك، يمكن أن نميز في هذه الوحدات إشارات بالمعنى الدقيق للكلمة، تحيل إلى طبع، أو إحساس، أو جو معين (مثل الشك) أو فلسفة، أو معلومات، والذين يفيدون في التموضع ضمن الزمن والفضاء. إن القول بأن بوند مناوب في مكتب مفتوح النافذة يفسح المجال لرؤية القمر بين غيوم كثيفة تتحرك، وفي هذا إشارة إلى ليلة صيف عاصفة، ويشكل هذا الاستنتاج نفسه إشارة مناخية تحيل إلى المناخ الثقيل، والمقلق لفعل لم نعرفه بعد. تحمل الإشارات دائماً، إذن، مدلولات خفية؛ وفي المقابل، فإن المخبرين لا يحملون هذه المدلولات، على مستوى القصة على الأقل: وهذه معطيات خالصة، ودالة مباشرة. تتطلب الإشارات نشاطاً لفك الرموز: يتعلق الأمر بالنسبة للقارئ، بالتعرف على طبع ومناخ: يقدم المخبرون معرفة جاهزة؛ إن وظيفتهم، مثل وظيفة المحفزات، ضعيفة، إذن، ولكنها ليست عديمة الفائدة: إن الخبر، مهما كانت “كمدته” بالنسبة إلى بقية القصة، (مثل العمر الدقيق لشخصية معينة)، يفيد في إعطاء مصداقية لواقعية المرجع، وفي تجذير التخييل في الواقع: إنه عامل واقعي، وبهذه الصفة، يمتلك وظيفية أساسية، ليس على مستوى القصة، ولكن على مستوى الخطاب29.
يبدو أن النويات المركزية، والمحفزات، والإشارات، والمخبرين، يشكلون الطبقات الأولى التي يمكن أن نوزع عليها وحدات المستوى الوظيفي. يجب إلحاق هذا التصنيف بملاحظتين. أولاً، إن أي وحدة يمكن أن تنتمي، في الوقت نفسه، إلى طبقتين مختلفتين: إن شرب الويسكي (في سوق في مطار) هو فعل يمكن أن يفيد كمحفز للإشارة “الرئيسية” للانتظار، وهو أيضاً، وفي الوقت نفسه، إشارة إلى نوع من الوسط المكاني (مدنية، استرخاء، ذكريات، الخ): بقول آخر، يمكن أن تكون بعض الوحدات مختلطة. إنها لعبة الشكل الممكن في اقتصاد الحكاية؛ في رواية “غولدفينجر”، يتلقى بوند، قبل التفتيش في غرفة عدوه، موافقة على التفتيش من رئيسه: الإشارة هي وظيفة “رئيسية” خالصة؛ لقد تغيّر هذا التفصيل، في الفيلم: يختطف بوند صرة الخادمة وهو يداعبها، دون أن تعترض، لم تعد الإشارة وظيفية فقط، ولكنها علاماتية أيضاً، حيث تحيل إلى طبع بوند (مثل جرأته ونجاحه مع النساء).
وفي المكان الثاني، يجب ملاحظة أن الطبقات الأخرى التي تحدثنا عنها يمكن أن تخضع لتوزيع آخر، أكثر انسجاماً مع النموذج اللساني. في الواقع، تمتلك المحفزات، والإشارات، والمخبرون سمة مشتركة. فهم يشكلون امتدادات بالنسبة إلى النويات المركزية: تشكل النويات (مثلما سنرى) مجموعات منجزة من التعبيرات القليلة إلى حد ما، ويتحكم فيه منطق معين، فهي ضرورية وكافية، في الوقت نفسه؛ تأتي الوحدات الأخرى لملأ هذه البنية المعطاة، وفق نموذج التزايد المطلق، من حيث المبدأ؛ إننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالنسبة للجملة المكونة من جمل بسيطة، المركبة باستمرار من إضافات، وملأ فراغات، وتغليفات، إلخ…: والمحكي، مثل الجملة، قابل للتحفيز باستمرار.
علق مالارميه مثل هذه الأهمية على هذا النموذج من البنية الذي ألف وفقه قصيدته (jamais un coup de des) ، والتي يمكن أن نعتبرها، بعقدها، ودواخلها، وكلماتها العقدية، وكلماتها المخرَّمة، كرمز لكل محكي، وكل لسان.
2-3-النحو الوظيفي
كيف، ووفق أي قواعد ترتبط هذه الوحدات المختلفة، بعضها ببعض على طول التركيب التعبيري السردي؟ ما هي قواعد التأليف الوظيفي؟
يمكن للمخبرين والإشارات أن يتحدوا فيما بينهم بحرية: مثل الصورة الشخصية التي تقرب، دون خوف، معطيات الحالة العائلية، من السمات الشخصية. إن علاقة إشراك بسيطة تجمع بين المحفزات والمراكز: يتطلب المحفز، بالضرورة، وجود وظيفة رئيسية يرتبط بها، ولكن ليس بصورة متزامنة. أما بالنسبة للوظائف الرئيسية، فإن علاقة التضامن هي التي توحدها: تقود وظيفة من هذا النوع إلى وظيفة أخرى من النوع نفسه، وبصورة متزامنة يجب التوقف قليلاً عند هذه العلاقة الأخيرة: لأنها تحدد أولاً شكل المحكي (الامتدادات قابلة للإلغاء، والمراكز ليست كذلك)، ومن ثم لأنها تهم، أساساً، أولئك الذين يبحثون عن إعطاء المحكي بنية معينة. لقد أشرنا سابقاً إلى أنه عبر بنيته نفسها، يقيم المحكي خلطاً بين التتابع والنتيجة، بين الزمن والمنطق. وهذا الغموض هو الذي يشكل المشكلة المركزية للنحو السردي. هل هناك وراء المحكي منطق لا زماني؟ ما زالت هذه النقطة تباعد بين الباحثين إلى الوقت الحالي. يتمسك بروب الذي فتح تحليله، مثلما نعرف، الطريق للدراسات الحالية، بعدم قابلية اختزال نظام التسلسل الزمني: الزمن. مع ذلك، إن أرسطو نفسه وهو يعارض التراجيديا (المعروفة بوحدة الفعل) بالتاريخ (المعروف بتعددية الأفعال ووحدة الزمن) يعزو الأولوية إلى المنطق على حساب التسلسل الزمني30. هذا هو ما يفعله كل الباحثين الحاليين مثل (كلود ليفي شتراوس، وغريماس، وبريمون، وتودوروف)، والذين أبدوا جميعاً موافقتهم على اقتراح ليفي شتراوس (وإن كانوا يختلفون حول نقاط أخرى): “إن نظام التتابع الزمني يتلاشى ضمن بنية مسجلة لا زمنية”31. في الواقع، يحاول التحليل الحالي القيام “بالتقطيع الزمني” للمضمون السردي، وإخضاعه لما يسميه مالارميه، بخصوص اللغة الفرنسية، “الخزانات الكبيرة الأولية للمنطق”.32 أو بصورة أدق، إن المهمة، وهذه رغبتنا على الأقل، هي الوصول إلى إعطاء وصف بنيوي للوهم التاريخي؛ وعلى المنطق السردي أن يأخذ بعين الاعتبار الزمن السردي. يمكن القول، بطريقة أخرى، إن الزمنية ليست سوى طبقة بنيوية للمحكي “للخطاب”، مثلما أن الزمن، في اللغة، لا يوجد إلا على شكل منظومة؛ من وجهة نظر المحكي، لا وجود لما نسميه زمناً، أو على الأقل لا يوجد إلا وظيفياً، كعنصر من نظام سيميائي: لا ينتمي الزمن إلى الخطاب، بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنه ينتمي إلى المرجعية؛ المحكي واللغة لا يعرفان إلا زمناً سيميائياً؛ إن الزمن الحقيقي هو وهم مرجعي، “واقعي” مثلما يظهره تفسيره بروب، وتحت هذا العنوان يجب على الوصف البنيوي دراسته33.
ما هو، إذن، هذا المنطق الذي يخضع الوظائف الرئيسية للحكاية؟ هذا ما نسعى إلى إيضاحه بدقة، وهذا ما كان حتى الآن قد نوقش بصورة واسعة. سنرى، إذن، إسهامات أ. ج. غريماس، وبريمون، وتودوروف، في العدد الثامن من مجلة (اتصالات)، عام 1966، والذين درسوا منطق الوظائف كلها. ظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسية من البحث، عرضها تودوروف. الطريق الأول (بريمون)، هو الأكثر منطقية بالمعنى الدقيق: يتعلق الأمر بإعادة تأليف قواعد التصرفات الإنسانية التي تستخدمها الحكاية، وبسبر مسار “الخيارات” الذي تخضع له مثل هذه الشخصية بصورة قدرية 34، في كل نقطة من الحكاية، وباستخدام ما يمكن تسميته بالمنطق الخاص بالطاقة35، لأنه يمسك بالشخصيات في اللحظة التي يختارون فيها القيام بالفعل.
النموذج الثاني لساني (ليفي شتراوس، غريماس): إن الاهتمام الأساسي لهذا البحث هو العثور على تعارضات نموذجية في الوظائف، وانسجاماً مع مبدأ جاكبسون في (الشعرية)، تمتد هذه التعارضات على مسار السرد كله (مع ذلك، سنرى التطورات الجديدة التي صحح من خلالها غريماس نموذجية الوظائف أو أكملها).
الطريق الثالث الذي فتحه تودوروف مختلف قليلاً، لأنه يضع التحليل على مستوى “الأفعال” (أي الشخصيات) عبر محاولة تأسيس قواعد ينظم من خلالها المحكي عدداً من المحمولات الأساسية ويبدلها، ويحولها. ليس المقصود الاختيار بين فرضيات العمل هذه؛ فهي ليست متعارضة ولكنها متنافسة، وهي حالياً في مرحلة التشكل الكامل. إن الإضافة الوحيدة التي نسمح لأنفسنا بإضافتها إلى هذا الفرضيات تتعلق بأبعاد التحليل. حتى إذا نحينا جانباً الإشارات، والمخبرين، والمحفزات، يبقى أيضاً في المحكي (خاصة عندما يتعلق الأمر برواية، وليس بحكاية) عدد كبير من الوظائف الرئيسية؛ ولا يمكن السيطرة على عدد كبير منها إلا من خلال التحليلات التي ذكرناها سابقاً، والتي اشتغلت حتى الآن على مفاصل الحكاية الكبرى. مع ذلك، يجب توقع وصف دقيق بشدة، من أجل النظر في وحدات الحكاية كلها، وأصغر الأجزاء فيها؛ نذكر بأن الوظائف الكبرى لا يمكن تحديدها من خلال أهميتها، ولكن فقط من خلال طبيعة علاقاتها: إن “اتصالاً هاتفياً”، وإن بدا غير ذي أهمية، يشتمل، من جهة، على بعض الوظائف الرئيسية (صوت الجرس، رفع السماعة، الحديث، وضع السماعة) ويجب من جهة أخرى وجود قدرة على تعليقه، في مجمله، بالمفاصل الكبرى من الحكاية، بالتدريج، على الأقل. تتطلب التغطية الوظيفية للحكاية تنظيماً للبدائل التي لا تستطيع وحدة أساسها إلا أن تكون مجموعة صغيرة من الوظائف، التي ستسمى هنا متوالية (بحسب بريمون). إن المتوالية هي تتمة منطقية للنويات المركزية المتحدة فيما بينها عبر علاقة تضامن36، وتتفتح المتوالية عندما لا يكون لأحد تعبيراتها سابق متضامن، وتنغلق عندما لا يبقى لأحد تعبيراتها نتيجة. إذا أخذنا، قصداً، مثالاً، غير ذي معنى، إننا نطلب سلعة ما فنتلقاها، ونستهلكها وندفع ثمنها فإن هذه الوظائف المختلفة تشكل متوالية مغلقة، لأنه من غير الممكن تقديم الطلب، أو إلحاق الدفع دون الخروج من كل متجانس هو ((الاستهلاك)). إن المتوالية، في الواقع، قابلة دائماً للتسمية. إن بروب، ثم بريمون، وهما يحددان الوظائف الكبرى للحكاية، أجبرا مسبقاً على تسميتها (خداع، خيانة، نضال، عقد، إغراء، إلخ…)؛ إن عملية التسمية لا يمكن تجنبها، أيضاً بالنسبة للمتواليات عديمة الفائدة، وهذا ما يمكن تسميته ((المتواليات الصغيرة جداً))، وهي تشكل غالباً العقدة الأكثر صغراً من النسيج السردي. هل هذه التسميات هي فقط من اختصاص المحلل؟ بعبارة أخرى، هل هي لغة واصفة بصورة خالصة؟ مما لا شك فيه أنها كذلك لأنها تعالج قانون المحكي، ولكن يمكننا تخيل أنها تشكل جزءاً من لغة نقدية داخلية عند القارئ (أو الناشر) نفسه، الذي يقبض، مباشرة، على منطق الأفعال ككل اسمي: إن القراءة هي تسمية؛ والاستماع ليس فقط إدراك لغة، ولكنه يعني أيضاً بناءها. إن عنوانات المتوالية تشابه، إلى حد ما، هذه الكلمات الافتتاحية لآلات الترجمة، التي تغطي بطريقة مقبولة، تنوعاً كبيراً من المعاني والتباينات. تتضمن لغة الحكاية الموجودة فينا مسبقاً، هذه العنوانات الأساسية: يرتبط المنطق المغلق، الذي يشكل متوالية، باسمه: تفرض كل وظيفة تفتتح إغراء، منذ ظهورها في الاسم الذي تبعثه، القضية الكاملة للإغراء، مثلما فهمنا هذا الإغراء من كل الحكايات التي شكلت فينا لغة الحكي. وعلى الرغم من أهمية المتوالية القليلة، لأنها تتشكل من عدد قليل من النويات المركزية، فإنها تشتمل دائماً على لحظات خطر، وهذا ما يسوغ تحليلها: يمكن أن يبدو من غير المنطقي التشكيل في متواليات للتتمة المنطقية لأفعال صغيرة تشكل فعل تقديم السيكارة (تقديم، قبول، إشعال، تدخين)؛ ولكن، في كل نقطة من هذه النقاط، يمكن للمعنى أن يتبدل: يقدم رئيس جيمس بوند، دوبون، له النار من ولاعته، لكن بوند يرفض؛ إن معنى هذا التفريع هو أن بوند يخشى فخاً37.
المتوالية، إذن، هي وحدة منطقية خطرة: وهذا ما يسوغها بالحد الأدنى: وهي قائمة، أيضاً، بالحد الأقصى: فهي منغلقة على وظائفها، وتذوب تحت اسمها، وهي تشكل، هي نفسها، وحدة جديدة، جاهزة للعمل كتعبير بسيط عن متوالية أخرى أكثر سعة. إليكم متوالية صغيرة: مد اليد، ومصافحتها، وتركها؛ يصبح هذا السلام وظيفة بسيطة: فهو من جهة يأخذ دور إشارة (استرخاء دوبون، ونفور بوند)، ويشكل من جهة أخرى، تعبيراً عن متوالية أكثر سعة، تسمى اللقاء، وتعبيراتها الأخرى (اقتراب، وتوقف، ونداء، وسلام، وإقامة) ويمكن أن تكون هي نفسها متواليات صغيرة. إن شبكة متكاملة من البدائل هي التي تشكل الحكاية، بدءاً من أصغر القوالب وانتهاء بأكبر الوظائف. يتعلق الأمر هنا بطبقة تبقى داخلية على المستوى الوظيفي: وعندما تستطيع الحكاية أن تتنامى بالتدريج، من سيكار دوبون إلى معركة بوند ضد غولدفينجر، عندها فقط ينتهي التحليل الوظيفي: وعندئذ يمس هرم الوظائف المستوى التالي (وهو مستوى الأفعال). يوجد، إذن، نحو داخلي في المتواليات، وفي الوقت نفسه، يوجد نحو استبدالي للمتواليات فيما بينها. تأخذ الواقعة الأولى من غولدفينجر شكلاً هرمياً.
مساعدة طلب
يقظة أسر عقوبة لقاء التماس عقد
اقتراب نداء تسليم إقامة
مد اليد المصافحة ترك اليد
من الواضح أن هذا التمثيل تحليلي. يدرك القارئ نفسه، تتمة أفقية للتعبيرات. ولكن ما يجب الإشارة إليه، هو أن تعبيرات متواليات عديدة يمكن أن تتداخل فيما بينها بقوة: لا تنتهي المتوالية إلا بعد أن تظهر الكلمة الأولى من متوالية جديدة: تتبادل المتواليات الأمكنة؛38 تتبدل بنية المحكي وظيفياً: وبهذه الطريقة “يتماسك” المحكي و “يمتص” في الوقت نفسه. في الحقيقة، لا تتوقف عملية تداخل المتواليات داخل العمل الواحد، من خلال ظاهرة الانقطاع الجذري، إلا إذا جمعت بعض القوالب الكتيمة التي تشكل هذا التداخل في مستوى أعلى للأفعال (للشخصيات). يتألف عمل غولدفينجر من ثلاثة أحداث مستقلة وظيفياً لأن قوالبها الوظيفية تتوقف مرتين عن التواصل: لا يوجد أي علاقة تتابعية بين حادثة المسبح وحادثة فورت-كنوكس؛ ولكننا نرى في المقابل، استمرار علاقة فاعلية، لأن الشخصيات (وبالنتيجة بنية علاقاتهم) هي نفسها. إننا نعرف هنا الملحمة (مجموع الحكايات الخرافية المتنوعة): الملحمة هي حكاية منكسرة على المستوى الوظيفي ولكنها موحدة على المستوى الفعلي (يمكن أن يتأكد هذا في الأوديسا أو في مسرح بريخت). يجب، إذن، إحاطة مستوى الوظائف (الذي يقدم القسم الأكبر من التركيب التعبيري السردي)؛ بمستوى أعلى تستمد منه وحدات المستوى الأول، بالتدريج، معناها، وهو مستوى الأفعال.
3-الأفعال
3-1-نحو وضع بنيوي للشخصيات:
إن مفهوم الشخصية، في الشعرية الأرسطية، ثانوي، ويخضع بصورة كاملة لمفهوم الفعل: يمكن أن يوجد حكاية خرافية من دون “صفات”، هذا ما يقوله أرسطو، ولكنه لا يوجد صفات من دون حكاية خرافية. أخذ بعض المنظرين الكلاسيكيين مثل “فوسيوس” وجهة النظر هذه. بعد ذلك أخذت الشخصية سمة نفسية ثابتة، بعد أن كانت مجرد اسم، وممثلة للحدث39، لقد أصبحت فرداً، وشخصاً، لقد أصبحت، باختصار، كائناً كاملاً، حتى وإن لم يفعل شيئاً، أو قبل أن يتصرف40، لم تعد الشخصية تابعة للحدث، وبدأت تجسد، مسبقاً، جوهراً نفسياً؛ يمكن أن تخضع هذه الماهيات لإحصاء الذي كان شكله الأكثر وضوحاً القائمة التي يستخدمها المسرح البرجوازي (المغناج، والأب النبيل، الخ). كان التحليل البنيوي ينفر، منذ ظهوره، من دراسة الشخصيات بوصفها ماهية، وكان ذلك من أجل تصنيفها؛ ومثلما ذكر تودوروف، ذهب توماشيفسكي إلى حد إنكار أية أهمية سردية للشخصية، وقد تم التخفيف من وجهة النظر هذه، بعد ذلك. لم يصل بروب إلى حد إبعاد الشخصيات عن التحليل ولكنه اختزلها إلى تصنيف بسيط قائم، ليس على الدخيلة النفسية، ولكن على وحدة الأفعال التي يمنحها لها المحكي (فهي إما مانحة غرائبية، أو أنها تقدم المساعدة، أو أنها خبيثة، الخ..)
لم تتوقف الشخصية، منذ بروب، عن فرض المشكلة نفسها على التحليل البنيوي للمحكي: فمن جهة تشكل الشخصيات (مهما كان اسمها، درامية، شخصية، فاعلة) خطة وصف ضرورية، لا يمكن خارجها فهم “الأحداث” الصغيرة المروية، إلى حد أنه يمكن القول إنه لا توجد حكاية واحدة في العالم من دون “شخصيات”41، أو على الأقل من دون “ممثلين”؛ ولكن هؤلاء “الممثلين” الكثيرين، من جهة أخرى، لا يمكن وصفهم أو تصنيفهم بتعبيرات “الأشخاص”، سواء اعتبرنا “الشخص” شكلاً قصصياً خالصاً، محصوراً في بعض الأجناس (التي نعرفها جيداً)، وبالتالي فإنه يجب الاحتفاظ بالحالة الواسعة جداً، لكل المحكيات (حكايات شعبية، نصوص معاصرة) التي تشتمل على ممثلين، ولكن ليس على أشخاص؛ أم أعلنا أن الشخص ليس إلا عقلنة نقدية يفرضها عصرنا على مجرد ممثلين حكائيين. لقد جهد التحليل البنيوي، الحريص جداً على عدم تعريف الشخصية بتعبيرات الماهيات النفسية، لكي يعرف الشخصية، عبر فرضيات مختلفة، ليس بوصفها “كائناً” ولكن بوصفها “فاعلاً مشاركاً”. كل شخصية، بالنسبة لبريمون، يمكن أن تكون الممثلة لمتواليات الأفعال الخاصة بها (خداع، إغراء)؛ عندما تنطوي المتوالية الواحدة على شخصيتين (وهذه هي الحالة الطبيعة)، فإن هذه المتوالية تحمل منظورين، أو إذا فضلنا، تحمل اسمين (ما يعتبره أحدهم خداعاً، يعتبره الآخر تحايلاً)؛ بصورة عامة، تعد كل شخصية، حتى وإن كانت ثانوية، بطلة متواليتها. ينطلق تودوروف، وهو يحلل رواية نفسية (العلاقات الخطيرة)، ليس من الشخصيات -الأشخاص، ولكن من ثلاث علاقات كبيرة يمكن أن ينخرطوا فيها، والتي يسميها محمولات الأساس (وهي الحب، والتواصل، والمساعدة)؛ تخضع هذه العلاقات في التحليل لنوعين من القوانين: قانون الانحراف عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بعلاقات أخرى، وقانون الفعل عندما يتعلق الأمر بوصف تحول هذه العلاقات عبر مسار القصة: هنا كثير من الشخصيات في “العلاقات الخطيرة” ولكن “ما يقال عنها” (محمولاتها) يقبل التصنيف42. اقترح غريماس، أخيراً، وصف شخصيات الحكاية وتصنيفها، ليس وفق ما هم عليه، ولكن وفق ما يفعلون (من هنا يأتي اسم الفاعلين)، ولهذا السبب فهي تشترك بثلاثة محاور دلالية كبيرة، نجدها في الجملة (الفاعل، المفعول، المضاف إليه، والمفعول الظرفي) والتي هي الاتصال، والرغبة أو البحث، والاختبار؛43 ومثلما أن هذا الاشتراك ينتظم عبر ثنائيات، فإن العالم اللامتناهي للشخصيات يخضع، هو أيضاً، لبنية نموذجية (فاعل-مفعول، مرسل-مستقبل، مساعد-معارض) ترتسم على طول الحكاية؛ ومثلما أن الفاعل يحدد طبقة، فإنه يمكن وجود فاعلين مختلفين كثر، يستخدمون وفق قوانين التعدد، والإبدال، والنقص.
تشترك هذه المفهومات الثلاثة في نقاط عديدة. يجب أن نكرر أن النقطة الرئيسية هي تعريف الشخصية من خلال مشاركتها في دائرة الأفعال، وهذه الدوائر قليلة، ونموذجية، وقابلة للتصنيف؛ ولهذا نسمي مستوى الوصف الثاني هنا، وإن كان مستوى الشخصيات، مستوى الأفعال: يجب ألا تفهم هذه الكلمة هنا، إذن، بمعنى الأفعال الصغيرة التي تشكل نسيج المستوى الأول، ولكن بمعنى المفاصل الكبيرة للتطبيق العملي (الرغبة، التواصل، المكافحة).
3-2-مشكلة الفاعل.
إن المشكلات التي أثارها تصنيف شخصيات الحكاية لم تجد إلى الآن حلاً لها. من المؤكد أن هناك اتفاقاً حول إمكانية خضوع شخصيات الحكاية العديدة لقوانين الاستبدال، مثلما أن رمزاً معيناً، داخل عمل، يستطيع أن يستحوذ على شخصيات عديدة44؛ من جهة أخرى يبدو أن النموذج الفعلي الذي اقترحه غريماس (وأعاد تودوروف أخذه من منظور آخر) قد قاوم جيداً في اختبار عدد كبير من الحكايات: وكما في كل نموذج بنيوي، إن قيمته من خلال شكله القانوني (القالب بستة فواعل) أقل من قيمته من خلال التحولات الموزونة (نقص، غموض، ازدواجية، استبدال)، التي يتكيف معها، تاركاً بذلك الأمل في تصنيف فعلي للمحكيات45. مع ذلك، عندما يكون للقالب قدرة تصنيفية جيدة، (هذه هي حالة الفواعل عند غريماس)، فإنه لا ينظر جيداً إلى تعدد المشاركين، منذ أن يتم تحليلهم بتعبيرات المنظورات؛ وعندما نحترم هذه المنظورات (في وصف بريمون)، يبقى نظام الشخصيات مقسماً؛ يتجنب الاختصار الذي يقدمه تودوروف هذين العائقين، ولكنه لا يمس، إلى اليوم، إلا محكياً واحداً. يبدو أن هذا كله يمكن أن ينسق. إن الصعوبة الحقيقية التي يطرحها تصنيف الشخصيات هي مكانة الفاعل (ووجوده) ضمن كل قالب فعلي، مهما كانت صيغة ذلك. من هو الفاعل (البطل) في الحكاية؟ ألا يوجد طبقة مفضلة للفاعلين؟ لقد عودتنا روايتنا على التركيز، بطريقة أو بأخرى، على شخصية من بين شخصيات أخرى. ولكن التفضيل لا يشمل الأدب السردي كله. هناك كثير من الحكايات التي تعمل على إقامة علاقة بين عدوين، حول رهان، وتكون أعمالهما متساوية؛ عندئذ يكون الفاعل مزدوجاً، حقيقة، دون أن نستطيع اختزاله عبر استبداله؛ وربما، في هذا الشكل القديم السائد، كما لو أن المحكي، على شاكلة بعض اللغات، كان قد عرف هو أيضاً ثنائية الشخصيات. مع ذلك تبدو هذه الثنائية أكثر فائدة لأنها تقرب الحكاية من بنية بعض الرهانات (الحديثة جداً) والتي يرغب ضمنها عدوان متساويان كسب موضوع يعرضه حكم للتداول؛ يذكر هذا المخطط بالقالب الفعلي الذي اقترحه غريماس، وهذا لا يمكن أن يدهش إذا أردنا أن نقنع أنفسنا جيداً أن اللعبة، بوصفها لغة، تقوم، هي أيضاً على البنية الرمزية نفسها التي نجدها في اللغة وفي المحكي: اللعبة هي أيضاً جملة46.
إذا احتفظنا، إذن، بطبقة مفضلة للفواعل (موضوع البحث، والرغبة، والفعل)، فإنه، من الضروري، على الأقل، تلطيفها، عبر إخضاع هذا الفاعل لأصناف الشخص نفسها، ليس النفسية، ولكن القواعدية: ويجب مرة أخرى مقاربة اللسانيات من أجل القدرة على وصف القضية الشخصية للفعل وتصنيفها (أنا-أنت، je tu)، أو غير الشخصية (هو، il)، سواء كانت مفردة، أم ثنائية، أم جمعية. وربما تكون هذه الأصناف القواعدية للشخص (الممكن الوصول إليها بضمائرنا الشخصية) هي التي تعطي مفتاح المستوى الفعلي. ولكن بما أن هذه الأصناف لا يمكن أن تتحدد إلا بالمقارنة مع قضية الخطاب، وليس مع حكم الواقع، 47 كذلك لا تجد الشخصيات، بوصفها وحدات المستوى الفعلي، معناها إلا إذا دمجناها بالمستوى الثالث للوصف، والذي نسميه هنا مستوى السرد (معارضة للوظائف والأفعال).
4-السرد
4-1- التواصل السردي
مثلما يوجد، داخل الحكاية، وظيفة كبيرة للتبادل (المقسم بين مانح ومستفيد)، كذلك يكون المحكي، بوصفه موضوعاً، رهان تواصل معين: فهناك مرسل للمحكي، ومستقبل له. إننا نعرف أن (أنا و أنت je et tu) في التواصل اللغوي، يفترض أحدهما الآخر حكماً، وبالطريقة نفسها، لا يمكن أن يوجد حكاية من دون سارد، ومن دون مستمع (أو قارئ). وربما يكون هذا لا معنى له، ومع ذلك، فهو غير مستغل بصورة كافية. من المؤكد أن المرسل قد درس بإسهاب (ندرس مؤلف الرواية من دون التساؤل إذا كان هو الراوي)، ولكن عندما ننتقل إلى القارئ، فإن النظرية الأدبية مقصرة جداً. في الواقع، لا تكمن المشكلة في استبطان دوافع السارد، ولا في الآثار التي يتركها السرد على القارئ؛ ولكنها تكمن في وصف القانون الذي يكون وفقه السارد والقارئ مدلولين في الحكاية كلها. تبدو علامات السارد، من النظرة الأولى، أكثر وضوحاً، وأكثر عدداً من علامات القارئ (يستخدم المحكي تعبير أنا أكثر مما يستخدم تعبير أنت)؛ في الحقيقة، إن العلامات الثانية، أكثر مراوغة من الأولى؛ وهكذا، في كل مرة يتوقف فيها السارد عن التقديم، فإنه يعرض أحداثاً يعرفها جيداً ويجهلها القارئ، فإنه ينتج لنفسه، من خلال نقص دال، علامة قراءة، لأن إعطاء السارد لنفسه معلومة لا معنى لـه: كان ليو سيد هذا المكان، هذا ما تقولـه لنا رواية تقوم على الشخص الأول: هذه علامة للقارئ قريبة مما يسميها جاكبسون الوظيفة السباتية للتواصل. مع ذلك سنترك حالياً جانباً علامات الاستقبال، على أهميتها، بسبب نقص في الإحصاءات، من أجل أن نقول كلمة عن علامات السرد49.
من هو الذي يعطي المحكي؟ يبدو أن هناك ثلاثة تصورات، مقدمة حتى الآن. يعتبر التصور الأول أن المحكي يصدر عن شخص (بالمعنى النفسي الكامل للتعبير)؛ ولهذا الشخص اسم، إنه المؤلف، الذي تتغير في داخله الشخصية باستمرار، مثلما يتغير فن فرد محدد بصورة كاملة، يأخذ بين وقت وآخر، القلم ليكتب قصة: المحكي (خاصة في الرواية) ليس، إذن، إلا تعبيراً عن “أنا” خارجية عنه.
يجعل التصور الثاني من السارد شكلاً من الوعي الكامل، غير الشخصي ظاهرياً، يعبر عن القصة من وجهة نظر أعلى، هي وجهة الذات الإلهية:50 السارد داخلي بالنسبة إلى شخصياته (لأنه يعرف كل ما يدور في دواخلهم)، وهو في الوقت نفسه، خارجي (لأنه لا يتطابق أبداً مع شخصية أكثر من غيرها).
التصور الثالث، وهو الأكثر حداثة (هنري جيمس، سارتر) ينص على أنه من واجب السارد أن يحصر حكايته ضمن الحدود التي تستطيع فيها الشخصيات متابعة الحكاية والتعرف عليها: كل شيء يجري كما لو أن كل شخصية كانت هي التي تعبر عن الحكاية. هذه التصورات الثلاثة مزعجة أيضاً، إذ يبدو أنها ترى كلها، في السارد والشخصيات، أشخاصاً حقيقيين “أحياء” (ونحن نعرف القوة الدائمة لهذه الأسطورة الأدبية)، كما لو أن المحكي يتحدد في الأصل، بمستواه المرجعي (يتعلق الأمر أيضاً بتصورات واقعية). وعليه فإن السارد والشخصيات، من وجهة نظرنا على الأقل، هم أساساً، “كائنات على الورق”؛ لا يستطيع المؤلف “المادي” للسرد أن يذوب في سارد هذه الحكاية؛51 إن علامات السارد ثابتة في الحكاية، ونتيجة لذلك، فهي قابلة تماماً لتحليل سيميائي؛ ولكن من أجل الإقرار بأن المؤلف نفسه (الذي يظهر عن نفسه، ويختبئ، أو يتوارى) هو الذي ينظم “العلامات” التي يوحي بها عمله، فإنه يجب افتراض علاقة علاماتية بين الشخص وبين لغته، تجعل من المؤلف كائناً كاملاً، ومن الحكاية التعبير الذرائعي لهذا الكمال: وهذا ما لا يستطيع التحليل البنيوي البت فيه: إن الذي يتحدث في الحكاية ليس هو الذي يكتب “في الحياة”، والذي يكتب ليس هو…52.
في الواقع، إن السرد بالمعنى الدقيق للكلمة (أو قانون السارد) مثل اللغة، لا يعرف إلا نظامين من العلامات: وهما النظام الشخصي، والنظام اللاشخصي؛ لا يستفيد هذان النظامان، بالضرورة، من السمات اللغوية المتعلقة بالشخص “أنا”، واللا شخص “هو”: يمكن أن يوجد، مثلاً، محكيات، أو على الأقل، أحداث، كتبها شخص ثالث، وتكون قضيتها الحقيقية، مع ذلك، الشخص الأول. كيف نقرر ذلك؟ يكفي قلب المحكي (أو المقطع) من هو إلى أنا: باعتبار أن هذه العملية لا تسبب أي تشويه للخطاب غير تغيير الضمائر النحوية، فإنه من المؤكد أننا نبقى ضمن نظام الشخص: إن بداية غولدفينجر كلها محكية عبر جيمس بوند، وإن كانت مكتوبة بضمير الغائب؛ ولكي تتغير القضية، يجب أن تصبح إعادة الكتابة مستحيلة؛ وهكذا فالجملة “لاحظ رجلاً في الخمسين من عمره، ما زال شكله شكل شاب، الخ”. هي جملة شخصية بصورة كاملة، على الرغم من وجود الضمير هو “أنا جيمس بوند، لاحظت، الخ”. ولكن الملفوظ السردي “يبدو أن صوت الجليد على الزجاج أعطى إيحاءً مفاجئاً لبوند “لا يمكنه أن يكون شخصياً، بسبب الفعل “يبدو”، الذي أصبح علامة لا شخصية (وليس الضمير هو).
من المؤكد أن اللاشخصي هو النموذج التقليدي للمحكي، وشكلت اللغة نظاماً زمنياً كاملاً خاصاً بالحكاية (يتمحور حول ماض مبهم)53، ويهدف إلى إبعاد حاضر الشخص الذي يتكلم: “يقول بينفنست: في المحكي لا يتكلم أحد”، مع ذلك، فإن القضية الشخصية (بأشكال مقنّعة إلى حد ما) غزت الحكاية بالتدريج، وحملت السرد على زمانية التعبير ومكانيته (وهذا هو تعريف النظام الشخصي)؛ وهكذا فإننا نرى اليوم حكايات؛ تخلط غالباً، وبإيقاع سريع جداً، وضمن حدود الجملة الواحدة، بين الشخصي واللا شخصي؛ مثل هذه الجملة في غولدفينجر:
عيناه شيء شخصي، رمادية -زرقاء، شيء لا شخصي.
كانتا مثبتتين على عيني دوبون الذي لا يعرف الوضعية التي يأخذها، شيء شخصي لأن هذا النظر الثابت يحمل خليطاً من البراءة، والسخرية، والانتقاص الذاتي، شيء لا شخصي.
من الواضح أنه ينظر إلى خلط الأنظمة على أنه، نوع من السهولة. يمكن أن تصل هذه السهولة إلى حد التشويه: إن رواية أغاتا كريستي البوليسية (الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرون) لا تحافظ على لغزها إلا من خلال الخداع حول شخصية السارد: لقد تم وصف الشخصية من الداخل، في حين أنها هي القاتلة54: كل شيء يجري كما لو أن هناك داخل الشخصية الواحدة، وعي شاهد، ملازماً للخطاب، ووعي قاتل، ملازماً للمرجع: يسمح التناوب التعسفي للنظامين وحده بالإلغاز. إننا نفهم، إذن، أنه في القطب الآخر من الأدب، نجعل من صرامة النظام المختار الشرط الضروري للعمل، من دون القدرة، دائماً، على المفاخرة به إلى النهاية. هذه الصرامة، التي يصطنعها بعض الكتاب المعاصرين، ليست بالضرورة صيغة جمالية؛ إن ما نسميه رواية نفسية تتميز في الأصل بدمج النظامين، عبر التوظيف المتتابع لعلامات النظام اللاشخصي، وعلامات النظام الشخصي؛ في الواقع، لا يستطيع علم النفس، بصورة متناقضة، التكيف مع نظام خالص للشخص، لأن في إلحاق المحكي كله بالقضية الواحدة للخطاب، أو بفعل التعبير، من شأنه إلحاق الخطر بمضمون الشخص نفسه: إن الشخصية النفسية (ذات الطبيعة المرجعية) لا ترتبط أبداً مع الشخصية اللغوية التي لا تحدد من خلال الاستعدادات، والأهداف، أو السمات، ولكن من خلال مكانتها (الرمزية) في الخطاب، ونحاول اليوم الحديث عن هذه الشخصية الشكلية، يتعلق الأمر بتدمير هام (لدى الجمهور الانطباع بأننا لم نعد نكتب روايات اليوم) لأن هذا التدمير، يهدف إلى نقل الحكاية من الشكل المتعين الخالص (الذي يسيطر حتى الآن) إلى شكل قياسي، يكون فيه معنى الكلام هو الفعل نفسه الذي يلفظه55: إن الكتابة اليوم ليست هي فعل الحكي، أي أننا نحكي، وننقل المرجعية كلها (ما نقوله) إلى فعل التعبير هذا، ولهذا فإن قسماً من الأدب المعاصر لم يعد وصفياً، ولكنه متعد، يحاول أن يكمل في الكلام حاضراً خالصاً إلى حد أن الخطاب كله يتطابق مع الفعل الذي يحرره، حيث يحمل الوجود الكامل كله إلى حكم بالقوة.
4-2-وضع المحكي:
إن المستوى السردي مشغول، إذن، بعلامات السردية، وهي مجموع العوامل التي تعيد دمج الوظائف والأفعال في الاتصال السردي المرتكز على مانحه ومتلقيه. لقد درست بعض العلامات سابقاً: إننا نتعرف، في الآداب الشفوية، على بعض قوانين الإلقاء (مثل الصياغات العروضية، والقواعد الاصطلاحية للتقديم)، ونعرف أيضاً أن ((المؤلف)) ليس هو الذي يبدع أجمل القصص، ولكن الذي يبدع ذلك هو من يتقن بصورة أفضل الرمز الذي يتقاسم استخدامه مع المستمعين: إن المستوى السردي، في هذه الآداب، دقيق، وقواعده ملزمة، إلى حد أنه من الصعوبة تصور حكاية خالية من علامات مقننة للسردية (كان في مرة من المرات، الخ..) تم الكشف مبكراً، في آدابنا المكتوبة عن أشكال الخطاب (والتي هي، في الواقع، علامات سردية): مثل تصنيف طرق تدخل المؤلف، الذي بدأ به أفلاطون، وأعاد أخذه ديوميد57، وتقنين بدايات السرد ونهاياته، وتحديد مختلف أساليب التقديم (الخطابة المباشرة، والخطابة غير المباشرة مع مشاغلها، والخطابة الملتبسة)58، ودراسة وجهات النظر، الخ.. تشكل هذه العناصر كلها جزءاً من المستوى السردي. يجب أن نضيف إلى ذلك الكتابة في كليتها، لأن دورها ليس “نقل” الحكاية، ولكن إظهارها.
في الواقع، ضمن هذا الإظهار للحكاية تندمج وحدات المستويات الأدنى: يتجاوز الشكل الأخير للحكاية، بوصفها حكاية، مضموناتها، وأشكالها السردية الخالصة (الوظائف والأفعال). هذا يفسر أن التقنين السردي هو المستوى الأخير الذي يستطيع تحليلنا الوصول إليه، إلا إذا خرجنا عن موضوع الحكاية، أي إذا تجاوزنا القاعدة الكامنة التي يقوم عليها. في الحقيقة، لا يمكن للسرد أن يأخذ معناه إلا عند العالم الذي يستخدمه: يبدأ العالم مما وراء المستوى السردي، أي هناك أنظمة أخرى (اجتماعية، واقتصادية، وأيديولوجية) لم تعد التعبيرات عنها فقط المحكيات، ولكن عناصر لماهية أخرى (أحداث تاريخية، تحديدات، تصرفات، الخ..) ومثلما أن اللسانيات تتوقف عند الجملة، فإن تحليل المحكي يتوقف عند الخطاب: يجب بعد ذلك، الانتقال إلى سيميائية أخرى. عرفت اللسانيات هذا النوع من الحدود التي التمستها سابقاً، أو سبرتها، تحت عنوان موقف. حدد هاليدي “الموقف” (بالنسبة إلى الجملة) كمجموعة من الأفعال اللغوية غير المشتركة59، وحدده بريتو “كمجموعة من الأفعال التي يعرفها المتلقي في لحظة الفعل الإلقائي أو بصورة منفصلة عنه”60.
يمكن القول، بالطريقة نفسها، إن كل محكي متعلق “بوضع المحكي”، وهو مجموعة من القوانين التي يستخدم من خلالها المحكي. في المجتمعات القديمة، وضع المحكي شديد التقنين؛61 والأدب الطليعي في أيامنا، وحده، هو الذي ما زال يحلم بقوانين للقراءة، مثيرة عند مالارميه الذي أراد أن يقرأ الكتاب أمام الجمهور وفق ترتيب محدد، وطباعية عند بوتور الذي يحاول إرفاق الكتاب بعلاماته الخاصة. ولكن الشائع أن مجتمعنا يتجنب قدر الإمكان تقنين وضع السرد: لم نعد نحصي طرق السرد التي تحاول تطبيع المحكي الذي سيأتي لاحقاً، عبر التظاهر بإعطائه فرصة طبيعية، لسبب وجيه، أو إذا استطعنا القول، عبر التظاهر “بعدم افتتاحه”: مثل الروايات الترسلية، والمخطوطات التي يعثر عليها، والمؤلف الذي التقى السارد، والأفلام التي تفصح عن حكايتها قبل المقدمة. إن الاشمئزاز الذي يعبر عن نفسه، يطبع المجتمع البرجوازي وثقافة الجماهير التي تنبثق منه: ويجب، في المجتمع البرجوازي، وثقافة الجماهير، وجود علامات ليس فيها شكل العلامات. ومع ذلك، لا يمثل هذا إلا ظاهرة بنيوية ثانوية: على الرغم من أن فتح رواية، أو صحيفة، أو محطة تلفزيون، أصبح اليوم عملاً حميمياً، وسهلاً، فإن شيئاً لا يستطيع منع هذا الفعل البسيط من أجل أن يدخل فينا، فجأة، القانون السردي الذي سنحتاج إليه. للمستوى السردي دور غامض فهو ملازم لوضع المحكي، ويفتح على العالم الذي يتحلل فيه المحكي (يستنفد)؛ ولكنه، في الوقت نفسه، يغلق المحكي، ويشكله، بصورة نهائية ككلام عن لغة تحمل لغتها النقدية الخاصة بها، وذلك من خلال الإحاطة بالمستويات السابقة.
5-نظام المحكي:
يمكن أن تتحدد اللغة، بالمعنى الدقيق لها، عبر التنافس بين قضيتين رئيسيتين: هما التمفصل أو التقطيع الذي ينتج وحدات (وهذا هو الشكل من وجهة نظر بينفينست)، والدمج أو التوحيد الذي يستقبل هذه الوحدات ضمن وحدات في مرتبة أعلى (وهذا هو المعنى). هذه القضية المزدوجة توجد في لغة الحكاية، وتعرف هذه اللغة أيضاً بالتمفصل والاندماج، والشكل والمعنى.
5-1-الانحراف والتوسع
يتميز شكل المحكي بصورة أساسية بقوتين: قوة نشر علاماته على امتداد القصة، وقوة إدخال امتدادات غير متوقعة ضمن هذه الانحرافات. تتميز هاتان القوتان بالحرية؛ ولكن خصوصية المحكي هي تحديداً، في ضم هذه “الانحرافات” ضمن لغته62. إن انحراف العلامات موجود في اللغة حيث درسها بالي بخصوص اللغتين الفرنسية والألمانية63، ويحدث توقف من اللحظة التي لم تعد فيها علامات (رسالة) متقاربة، أو من اللحظة التي تضطرب فيها الأفقية المنطقية (عندما يسبق الخبر الفاعل مثلاً). هناك شكل بارز من التوقف نجده عندما تفصل أجزاء علامة واحدة بعلامات أخرى على مدى سلسلة الرسالة (مثل النفي بصيغة ليس قط ne jamais، والفعل سامح في لم يسامحنا قط): ولأن العلامة جزئت، فإن مدلولها قسم إلى دالات عديدة، يتباعد بعضها عن بعض، وإذا أخذ أي منه لوحده فإنه لا يمكن أن يفهم. لقد رأينا ذلك سابقاً، بخصوص المستوى الوظيفي، وهذا هو بدقة ما يحدث في الحكاية: إن وحدات متوالية، وإن كانت تشكل وحدة كلية على مستوى المتوالية نفسها، يمكن فصل بعضها عن بعض، من خلال إدخال وحدات قادمة من متواليات أخرى: لقد قلنا سابقاً إن بنية المستوى الوظيفي بنية متبدلة64. وبحسب مصطلح بالي الذي يقابل بين اللغات التركيبية التي يسيطر فيها الوقف (مثل اللغة الألمانية)، وبين اللغات التحليلية التي تحترم أكثر الأفقية المنطقية، وأحادية المعنى (مثل الفرنسية)، فإن المحكي هو لغة تركيبية بشدة، تقوم بصورة أساسية على قواعد التشابك والتضمين: كل نقطة من الحكاية تشع في اتجاهات عديدة، وفي وقت واحد: عندما يطلب جيمس بوند (ويسكي) وهو ينتظر الطائرة، فإن هذا الويسكي يحمل، بوصفه إشارة، قيمة متعددة المعاني، وهذا شكل من النواة الرمزية التي تجمع مدلولات عديدة (مثل الحداثة، والغنى، والبطالة)، ولكن طلب الويسكي، كوحدة وظيفية، يجب أن يتجاوز، بالتدريج، مراحل عديدة (الاستهلاك، والانتظار، والمغادرة، الخ..) لكي يجد معناه النهائي: تؤخذ الوحدة في الحكاية كلها، ولا تتماسك الحكاية أيضاً إلا من خلال انحراف المحكي وإشعاعه. يعطي الانحراف المعمّم إلى لغة الحكاية سمته الخاصة: فهو ظاهرة منطقية خالصة، لأنه يرتكز على علاقة بعيدة، غالباً، ويمنح نوعاً من الثقة بالذاكرة العقلية، ويضع، دائماً، المعنى مكان النسخ الخالص والبسيط للأحداث المروية؛ ووفق الحياة، من النادر ضمن لقاء ألاّ يأتي فعل الجلوس، مباشرة، بعد الدعوة إلى أخذ مكان؛ وفي المحكي، يمكن لهذه الوحدات المتقاربة من وجهة النظر المحاكاتية، أن تفصل من خلال سلسلة طويلة من الإدخالات التي تنتمي إلى مجالات وظيفية مختلفة، تماماً: وهكذا يتشكل نوع من الزمن المنطقي، الذي قلما يكون له علاقة مع الزمن الحقيقي، ولهذا فإن التحطيم الظاهر للوحدات يبقى دائماً تحت المنطق الذي يوحد نويات المتوالية. من الواضح أن التشويق ليس إلا شكلاً مفضلاً، أو إذا فضلنا، مثيراً، للانحراف: فهو من جهة، يحافظ على متوالية مفتوحة (عبر أفعال تفخيمية للتأخير والانطلاق)، مما يقوي الاتصال مع القارئ (المستمع)، ويقوم بوظيفة تنبيهية ظاهرياً، وهو من الجهة الأخرى، يقدم له تهديد متوالية أخرى غير كاملة، ونموذج مفتوح (كما لو أن كل متوالية تحمل قطبين، وهذا ما نعتقده)، أي تهديد اضطراب منطقي، وهذا الاضطراب هو الذي يستنفد بقلق ومتعة (مع أنه يصلح في النهاية)؛ “التشويق”، إذن، هو لعبة مع البنية، يهدف، إذا أمكن القول، إلى تهديدها وتعظيمها: إنه يشكل “رعباً” حقيقياً لما يدرك بالعقل: وهو يكمل فكرة اللغة نفسها، عبر تقديم النظام (وليس السلسلة) من خلال هشاشته: إن ما يبدو الأكثر إثارة هو الأكثر فكرياً أيضاً: يؤثر التشويق من خلال الروح وليس من خلال “الأمعاء”65.
إن ما يمكن تقسيمه، يمكن أيضاً ملؤه. وتمثل النويات الوظيفية الموسعة، فضاءات إضافية يمكن أن تملأ باستمرار تقريباً، على كل حال، يمكن أن يتدخل هنا تصنيف جديد، لأن حرية المحفز يمكن ضبطها وفق الوظائف (بعض الوظائف هي أفضل عرضاً من وظائف أخرى في المحفز: مثل الانتظار)66، ووفق جوهر الحكاية (تمتلك الكتابة القدرة على التفريق والتحفيز، وهذه القدرة أكبر من قدرة الفيلم: يمكن قص حركة تليت، بصورة أسهل من الحركة نفسها إذا رؤيت67.
تترافق القدرة التحفيزية للحكاية بقدرتها الإضمارية. فمن جهة، تستطيع وظيفة الجملة (يأخذ وجبة مغذية) اقتصاد كل المحفزات الافتراضية التي تنطوي عليها (تفصيل وجبة) 68، ومن جهة أخرى، يمكن اختزال متوالية معينة إلى نوياتها، ويمكن اختزال طبقة من المتواليات إلى تعبيراتها الأعلى، دون إفساد معنى القصة: يمكن تحديد الحكاية حتى إذا اختزلنا تركيبها التعبيري الشامل إلى عوامله الفاعلة، ووظائفه الكبيرة، مثلما تنتج من الاهتمام التدريجي، عن الوحدات الوظيفية69.
بعبارة أخرى، تقدم الحكاية نفسها للتلخيص (وهذا ما كان يسمى قديماً الدليل). وهو، من النظرة الأولى، قابل لذلك في كل خطاب، ولكن لكل خطاب نموذجه من التلخيص؛ فالقصيدة الغنائية، مثلاً، ليست إلا استعارة كبيرة لمدلول واحد70، وتلخيصها يعني امتلاك هذا المدلول، وهذه العملية فعالة إلى حد أنها تبدد هوية القصيدة (تختزل القصائد الغنائية إلى مدلولي الحب والموت): من هنا يأتي الاعتقاد بأنه يمكن تلخيص قصيدة. وبالعكس من ذلك، إن تلخيص الحكاية (إذا تم وفق معايير بنيوية) يحافظ على تفرد الرسالة. وبقول آخر، الحكاية قابلة للترجمة، دون ضرر كبير: إن ما يتعذر ترجمته لا يتحدد إلا في المستوى السردي الأخير: فدوال السردية، مثلاً، لا تستطيع بسهولة الانتقال من الرواية إلى الفيلم، الذي لا يعرف المعالجة الشخصية إلا نادراً جداً71، ولا تستطيع الطبقة الأخيرة من المستوى السردي، وهي الكتابة، الانتقال من لغة إلى لغة أخرى (أو أنها تنتقل بشكل مشوه). تنتج إمكانية ترجمة الحكاية عن البنية ولغتها؛ وبطريق معاكس، سيكون ممكناً، إذن، العثور على هذه البنية عبر تمييز العناصر القابلة وغير القابلة للترجمة في الحكاية، وتصنيفها: يسهّل الوجود الحالي لعلوم العلامات المختلفة والمتنافسة (مثل الأدب، والسينما، والمسرحيات الفكاهية، والبث الإذاعي)، هذه الطريقة من التحليل كثيراً.
5-2-المحاكاة والمعنى:
إن الفعل الثاني الهام، في لغة الحكاية، هو الاندماج: إن ما ينفصل في مستوى معين (مثل المتوالية) يندمج غالباً في مستوى أعلى (متوالية بدرجة تراتبية عالية، والمدلول الكامل لانحراف إشارات، وفعل طبقة من الشخصيات)؛ يمكن مقارنة تعقيد الحكاية بتعقيد* organigramme القادر على دمج الخطوات إلى الوراء بالقفزات إلى الأمام؛ أو بصورة أدق، إن الاندماج، تحت أشكال متعددة، هو الذي يسمح بالتعويض عن تعقيد وحدات مستوى معين: وهو الذي يسمح بتوجيه فهم عناصر متوقفة، ومتقاربة، ومتجانسة مثل العناصر التي يقدمها التركيب التعبيري، الذي لا يعرف إلا بعداً واحداً: هو التتابع، إذا سمينا مع غريماس وحدة الدلالة، بمتشابهة الخواص، (وهي الوحدة التي تطبع، مثلاً، علامة وسياقها) فإننا نقول إن الاندماج هو عامل تشابه: كل مستوى اندماجي يعطي خواصه إلى وحدات المستوى الأدنى، ويمنع المعنى من التذبذب، وهذا ما يحدث إذا لم ندرك الفارق بين المستويات. مع ذلك، لا يقدم الاندماج السردي بطريقة نظامية هادئة، مثل الهندسة المعمارية الجميلة التي تؤدي عبر ممرات متعرجة متشابهة، من عناصر بسيطة لا متناهية إلى بعض الكتل المعقدة؛ يمكن أن تمتلك الوحدة نفسها، غالباً، ارتباطين، الأول مع مستوى (وظيفة المتوالية)، والثاني مع (إشارة أخرى تحيل إلى فاعل)؛ بذلك تقدم الحكاية كتتمة لعناصر مباشرة، وغير مباشرة، متداخلة بقوة؛ الوقوف يوجه قراءة أفقية، ولكن الاندماج يلصق بها قراءة عامودية: هناك نوع من (التعرج) البنيوي، كلعبة مستمرة من القوى الكامنة، تعطي سقوطاته المختلفة للحكاية حيويتها أو طاقتها: تدرك كل وحدة من خلال ازدهارها، وعمقها، وبهذا الشكل تسير الحكاية: عبر التنافس بين هذين الطريقين، تتفرع البنية، وتتكاثر، وتكتشف ذاتها، وتتماسك: لا يتوقف المستوى السردي عن أن يكون نظامياً. من المؤكد أن هناك حرية للمحكي (كما هناك حرية لكل معبّر، أمام لغته)، ولكن هذه الحرية محدودة: هناك فجوة بين القانون القوي للغة، والقانون القوي للمحكي: هي الجملة. إذا حاولنا اختيار محكي مكتوب، فإننا نرى أنه ينطلق من المنطلق الأكثر تقنيناً (المستوى الصوتي)، ويخف بالتدريج إلى الجملة، وهي نقطة نهائية للحرية التركيبية، ثم يبدأ بالتمدد، عبر الانطلاق من مجموعات صغيرة من الجمل (متواليات صغيرة)، الحرة جداً أيضاً، حتى تصل إلى الأفعال الكبيرة التي تشكل قانوناً كبيراً ومحدوداً: إن إبداعية الحكاية (على الأقل تحت ظاهرة الأسطوري في الحياة) تكمن بين قانونين: قانون اللسانيات، والقانون فوق-اللساني. لهذا يمكننا القول بصورة متناقضة، إن الفن (بالمعنى الرومانسي للكلمة) هو عمل ملفوظات بالتفصيل، في حين أن الخيال هو سيطرة على القانون: “يقول بو، سنرى، إجمالاً، أن الإنسان البارع هو دائماً، مليء بالخيال، والإنسان الخيالي حقيقة هو محلل، قبل كل شيء..72” يجب إذن، التقليل من واقعية السرد. يقول لنا المؤلف، إن بوند الذي يتلقى اتصالاً هاتفياً في مكتبه الذي يناوب فيه “يتأمل”: “الاتصالات مع هونغ-كونغ، دائماً سيئة، وليس من السهل الحصول عليها. “وعليه، فإن “تأمل” بوند، والاتصال الهاتفي السيء ليسا هما المعلومة الحقيقية؛ ربما تكون هذه الحادثة “حيّة” ولكن المعلومة الحقيقية التي تتأكد بعد ذلك، هي تحديد موقع الاتصال الهاتفي، وهذا الموقع هو هونغ-كونغ.
وهذا فإن المحاكاة تبقى، في كل حكاية، ممكنة الحدوث؛73 إن وظيفة الحكاية ليست العرض، بل تشكيل متوالية تبقى، بالنسبة إلينا، غامضة، ولكن هذه المتوالية ليست ذات طبيعية محاكاتية؛ لا تكمن “واقعية” متوالية معينة في التتابع “الطبيعي” للأفعال التي تشكلها، ولكن في المنطق الذي يعرض فيها، ثم الذي يتعرض للخطر، ويشبع فيها؛ يمكن القول، بطريقة أخرى، إن أصل متوالية ليس ملاحظة الواقع، ولكن ضرورة تنويع الشكل الأول، وتجاوزه، والذي يقدّم للإنسان، وهو التكرار: المتوالية هي، بصورة أساسية، كل لا يتكرر فيه شيء؛ يحمل المنطق هنا قيمة تحريرية، وكل المحكي معه؛ يمكن أن يضع الناس في الحكاية ما عرفوه، وعايشوه. الحكاية تجعلنا نرى لأنها لا تحاكي؛ إن العاطفة التي تشتعل فينا عند قراءة رواية ليست هي عاطفة “رؤية” (في الواقع نحن لا نرى شيئاً)، ولكنها عاطفة معنى، أي ذات طبيعة أعلى من العلاقة التي تمتلك هي أيضاً انفعالاتها، وآمالها، ومخاطرها، وانتصاراتها: من وجهة نظر مرجعية (واقعية)، لا يحصل في الحكاية شيء بصورة دقيقة74، “إن ما يصل” هو اللغة وحدها، مغامرة اللغة التي يحتفى فيها باستمرار. على الرغم من أننا لا نعرف عن أصل الحكاية أكثر مما نعرفه عن أصل اللغة، يمكن القول، منطقياً، إن المحكي معاصر للمناجاة الداخلية، وهو فيما يبدو، إبداع لاحق للحوار؛ في كل الحالات، ودون إرادة فرض النظرية التطورية النوعية، يمكن أن يكون ذا دلالة أن الطفل الصغير يخترع الجملة، والحكاية، وأوديب، في الزمن نفسه (في الثالثة من العمر).
الحواشي
1-يجب أن نذكر أن هذا ليس هو حال الشعر أو البحث فهذه أمور تخضع للمستوى الثقافي للمستهلكين.
2-هناك “فن” للسارد: هو القدرة على توليد حكايات (رسائل) بالاعتماد على بنية (الرمز) وهذا الفن يتطابق مع مفهوم الكمال عند شومسكي؛ وهذا المفهوم بعيد عن عبقرية، تصوّر، رومانسياً، على أنها سر فردي صعب التفسير.
3-انظر الحرف الحثي أ الذي افترضه سوسور، وكشف عنه في الواقع، بعد خمسين سنة في (مشكلات اللسانيات العامة، بينفنست، غاليمار، 1966، ص 35).
4-لنذكّر بالشروط الحالية للوصف اللساني؛ “.. البنية اللغوية، نسبية دائماً، ليس فقط، بالنسبة إلى معطيات المادة العلمية ولكن أيضاً بالنسبة إلى النظرية النحوية التي تحدد هذه المعطيات “(باخ، مدخل إلى القواعد التحويلية، نيويورك، 1964، ص 29). وهذا أيضاً عند بينفنست (المصدر السابق، ص 1190): “.. لقد عرّفنا أنه على اللغة أن تكون محددة كبنية شكلية، ولكن هذا التحديد يفرض، مسبقاً، الإجراءات والمعايير المناسبة، وفي النهاية، لا يمكن فصل واقعية الموضوع عن المنهج الخاص لتحديده”.
5-ولكن ليس حتمياً، (انظر ك. بريمون؛- منطق الإمكانيات السردية-، اتصالات، ع. 8، 1966.)
6-“تأملات في الجملة”، في اللغة والمجتمع، (ميلانج جانسن، كوبنهاغن، 1961، ص 113.
7-من الطبيعي، مثلما لاحظ جاكبسون، أن هناك بين الجملة وما وراء الجملة مراحل وسيطة: يمكن للترتيب أن يؤثر أبعد من الجملة، مثلاً.
8-انظر خاصة، بينفنست، مصدر سابق، الفصل العاشر، ز. س. هاريس، “تحليلات الخطاب”، لغة، 28، 1952، ص10-30، و ن. روفيه، لغة، موسيقى، شعر، سوي، 1972، ص. 151-175.
9-هذه هي تحديداً إحدى مهمات لسانيات الخطاب، بدلاً من تشكيل تصنيف للخطابات، يمكننا، مؤقتاً، التعرف على ثلاثة نماذج من الخطابات: المجاز المرسل (الحكاية)، والنموذج، الاستعاري (اشسعر الغنائي، والخطاب الحكمي)، والنموذج القياسي الإضماري (الاستدلال العقلي).
10- CF.. infra
11-يجب هنا التذكير بأن هذا الحدس عند مالارميه تشكل في اللحظة التي بدأ فيها عملاً في اللسانيات: “تبدو اللغة له أداة التخييل: لقد اتبع منهج اللغة، وحدده. اللغة وسيلة نتأمل بواسطتها. ويبدو التخييل له، أخيراً، عمل الروح الإنسانية، والتخييل هو الذي يستعمل كل منهج، والإنسان يختزل إلى الإرادة فقط”، (الأعمال الكاملة، بلياد، ص 8510). إننا نذكر أنه بالنسبة إلى مالارميه: “التخييل أو الشعر”، المصدر السابق، ص3350.
12-“الأوصاف اللسانية ليست أبداً أحادية التكافؤ. الوصف ليس دقيقاً أو خاطئاً، إنه أفضل أو أسوأ، أو على الأقل مفيد. “(م. أ. ك. هاليدي، لسانيات عامة ولسانيات تطبيقية، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ج10، 1962، ص120)
13-قدمت مدرسة براغ مستويات الاندماج (ف. ج. فاشيك، قراءة مدرسة براغ في اللسانيات، مطابع جامعة أنديانا، 1964، ص4680)، وأعاد بعض اللغويين أخذها منذ مدة. وفي رأينا، إن بينفنست هو الذي أعطى التحليل الأوضح لهذه المستويات (مصدر سابق، الفصل العاشر).
14-بتعبيرات غامضة إلى حد ما، يمكن النظر إلى مستوى معين بوصفه نظاماً من الرموز والقواعد.. الخ، والتي يجب أن نستخدمها لكي نعرض التعبيرات (باخ، مصدر سابق، ص 570-58).
15-القسم الثالث من البلاغة، هو الإبداع، لا يتعلق باللغة: لأنه يحمل على الأشياء لا على الكلام.
16-أنتروبولوجيا بنيوية، ص 2330.
17-أصناف المحكيات الأدبية، مجلة اتصالات، عـ، 8، 1966.
18-انظر خاصة، ب. توماشفسكي، موضوعاتية، 1925، في نظرية الأدب، سوي، 1965، بعد ذلك بقليل، عرّف بروب الوظيفة بوصفها “فعل شخصية، معرّفاً من وجهة نظر دلالته ضمن مسار الحبكة”، (مورفولوجيا الحكاية، سوي، 1970، ص310). وسنرى أيضاً، تعريف تودوروف (إن معنى عنصر عمل ما، أو وظيفته، يكمنان في قدرة هذا العنصر على الدخول في علاقة مع عناصر أخرى من هذا العمل، ومع العمل كله، مصدر سابق)، والملاحظات التي قدمها غريماس الذي عرّف الوحدة في العمل، من خلال علاقتها النموذجية، وكذلك من خلال مكانتها داخل الوحدة التركيبية التعبيرية التي تشكل جزءاً منها.
19-وفي هذا، هو ليس “الحياة”، التي لا تعرف إلا اتصالات يشوبها الضبابية، ويمكن للضبابية (التي لا يمكن أن نرى وراءها)، أن توجد في الفن، ولكن على شكل عنصر مرمّز (واتو، Watteau، مثلاً)؛ وهذه الضبابية مجه
وهناك أكثر من ترجمة لهذه المقالة: منها ترجمة أنطوان أبو زيد المنشورة في كتاب بعنوان (النقد البنيوي للحكاية) ضمن منشورات عويدات في بيروت، في سلسلة (زدني علماً). أما الترجمة الأهم فهي ترجمة د. منذر عياشي الصادرة عن مركز الإنماء الحضاري، في حلب، عام 1993. وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلـه الدكتور منذر إلاّ أنه ابتعد أحياناً عن روح النص، وخرج بذلك عن المعنى المقصود، بالإضافة إلى بعض الأخطاء في تقديم المصطلح البديل للمصطلح الفرنسي.
وسأترك للقارئ أمر الموازنة، والتأكد من أهمية هذه الترجمة، والمادة العلمية التي تقدمها.
مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكيات*
لا يمكن حصر المحكيات في العالم. فهناك أولاً تنوع كبير في الأجناس، والتي تتوزع، هي نفسها، على ماهيات مختلفة كما لو أن كل مادة كانت مناسبة للإنسان لكي تمنحه محكياته: يمكن أن يدعم المحكى من خلال اللغة الواضحة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، ومن خلال الصورة الثابتة أو المتحركة، ومن خلال الحركة، أو من خلال خليط منظم من هذه المواد كلها، والمحكي حاضر في الأسطورة، والحكاية الخرافية، والحكاية، والقصة، والملحمة، والتاريخ، والتراجيديا، والدراما، والكوميديا، والمسرحية الإيمائية، واللوحة المرسومة (ونحن نفكر بالقديسة يورزول لكارباستو)، والرسم على الزجاج الملون، والسينما ومجالس الشعب*، والوقائع المختلفة، والمحادثة. بالإضافة إلى ذلك، وتحت هذه الأشكال التي لا تعد تقريباً، فإن المحكى حاضر في الأزمنة، والأمكنة، والمجتمعات كلها؛ لقد بدأت الحكاية مع تاريخ الإنسانية نفسه، لا يوجد، ولم يكن يوجد قط شعب من دون حكاية؛ فلكل الطبقات الاجتماعية، ولكل الجماعات البشرية حكاياتها الخاصة بها، وغالباً ما يتم التذوق الجماعي المشترك لهذه الحكايات من خلال ناس من ثقافات مختلفة، وحتى متناقضة1: المحكى يسخر من الأدب الجيد أو الأدب الضعيف: المحكى حاضر، مثل الحياة، فهو عالمي، ومتجاوز للتاريخ، والثقافات. أيجب أن تقود مثل هذه الشمولية للمحكي إلى ضياع معناه؟ وهل هو عام إلى هذا الحد الذي لا يبقى لنا فيه شيء نضيفه إلا وصف بعض أصنافه الخاصة جداً بصورة متواضعة، مثلما يفعل أحياناً التاريخ الأدبي؟ ولكن كيف يمكن السيطرة على هذه الأصناف نفسها، وكيف نؤسس قانوننا لتمييزها، والتعرف عليها؟ كيف نضع الرواية مقابل القصة، والحكاية مقابل الأسطورة، والدراما مقابل التراجيديا (وحدث ذلك ألف مرة) من دون العودة إلى نموذج عام؟ هذا النموذج مشترك في كل كلام عن الشيء الأكثر خصوصية، وتاريخية في الأشكال السردية. ولكي لا يقال إننا نهرب من الحديث عن المحكي، بحجة أن الأمر يتعلق بشيء عام، فإنه من المشروع، إذن، الاهتمام، بين حين وآخر، بالشكل المحكي (منذ أرسطو)؛ ومن الطبيعي أن تجعل البنيوية حديثة الولادة، من هذا الشكل من أوائل اهتماماتها: ألا يتعلق الأمر دائماً بالنسبة للمحكي، بحصرٍ مطلق أنواع الكلام، عبر الوصول إلى تحديد اللغة التي انبثقت منها هذه الأنواع، والتي يمكننا، انطلاقاً منها، توليدها (الأنواع)؟
أما العدد المطلق للمحكيات، وتعدد وجهات النظر التي يمكننا الحديث عنها في هذه المحكيات (تاريخية، ونفسية، واجتماعية، وعرقية، وجمالية، إلخ…)، يجد المحلل نفسه، تقريباً وبالتدريج، في موقع سوسور الذي وقف أمام الشاذ في اللسان وبحث عن استخلاص مبدأ تصنيف، ومكان للوصف ضمن هذه الفوضى الظاهرة للرسائل. منذ أجل الوقوف، في هذا المجال، عند المرحلة الحالية، لقد علمنا الشكلانيون الروس، وبروب، وكلود ليفي شتراوس، تحديد البرهان التالي:
المحكي إما مجرد كلام فارغ عن أحداث لا يمكننا، في أي حالة، الحديث عنها إلا إذا عدنا إلى الفن، والموهبة أو عبقرية السارد (المؤلف) وكل الأشكال الأسطورية للمصادفة2، أو أنه يمتلك بصورة عامة، مع محكيات أخرى، بنية قابلة للتحليل، وتحتاج إلى بعض الصبر لكشفها؛ لأن هناك هوة بين الشيء الصدفوي الأكثر تعقيداً، والشيء التركيبي الأكثر بساطة، ولا يستطيع أحد تركيب أو (إنتاج) حكاية من دون العودة إلى منظومة خفية من الوحدات والقواعد. أين نبحث، إذن، عن بنية الحكاية؟ الجواب هو، دون شك، في المحكيات. ولكن هل في المحكيات كلها؟ كثير من الشارحين الذين يوافقون على فكرة البنية السردية، لا يستطيعون، مع ذلك، التسليم بأبعاد التحليل الأدبي عن أنواع العلوم التجريبية: إنهم يطلبون، بجرأة، أن يطبق على السرد منهج استقرائي خالص، وأن يبدأ بدراسة كل المحكيات في جنس، وعصر، ومجتمع، من أجل الانتقال، بعد ذلك، إلى تقديم نموذج عام. هذه النظرة ذات المعنى الجيد مثالية. فاللسانيات نفسها التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف لغة لم تصل إلى هذا النموذج العام؛ وبعقلانية، جعلت اللسانيات من نفسها استنتاجية، بالإضافة إلى أنها لم تستطع إلا إلى اليوم أن تتشكل بصورة حقيقية، وأن تتطور، وأن تتنبأ بأشياء لم تكن معروفة من قبل3. ما الذي يقال، إذن، عن التحليل السردي، الموضوع أمام ملايين من المحكيات؟ إن التحليل محكوم عليه اللجوء إلى الطريقة الاستنتاجية، وهو مجبر، أولاً، على تصور نموذج افتراضي للوصف (والذي يسميه اللغويون الأمريكيون نظرية)، وعلى النزول، بعد ذلك، بالتدريج، وبالاعتماد على هذا النموذج، نحو الأنواع التي تسهم فيه، وتبتعد عنه في الوقت نفسه: وهو في مستوى هذه المطابقات والانزياحات فقط، سيجد تعددية المحكيات وتنوعها التاريخي، والجغرافي، والثقافي4، وهو يمتلك وسيلة وحيدة للوصف.
من أجل تحديد التنوع المطلق للمحكيات وتصنيفها، يجب، إذن، امتلاك نظرية (بالمعنى البراغماتي الذي تحدثنا عنه منذ قليل)، ويجب العمل أولاً على البحث عنها، ووضع خطوطها العريضة. يمكن أن يكون تأسيس هذه النظرية سهلاً جداً إذا خضعنا منذ البداية، لنموذج يقدم لها مصطلحاتها ومفهوماتها الأولى. ضمن الواقع الحالي للبحث، يبدو منطقياً، أن تقدم اللسانيات نفسها كنموذج مؤسس للتحليل البنيوي للحكاية.
1-لغة المحكي
1-1-ما وراء الجملة.
إننا نعرف أن اللسانيات توقفت عند الجملة: إنها الوحدة الأخيرة التي تعتقد اللسانيات بأحقية الاهتمام بها، في الواقع، إذا كانت الجملة منظومة وليست سلسلة، ولا يمكن اختزالها إلى مجموعة من الكلمات التي تؤلفها، وتشكل بذلك، وحدة أصيلة، فإن الملفوظ، بالعكس، ليس شيئاً آخر غير تتابع للجمل التي تؤلفه: من وجهة نظر اللسانيات، لا يمتلك الخطاب شيئاً خارج الجملة: “يقول مارتينيه: الجملة هي أصغر وحدة ممثلة للخطاب بصورة كاملة6. “لم تهتم اللسانيات بموضوع أعلى من الجملة، لأنه لا يوجد بعد الجملة إلا جمل أخرى: إن عالم النبات الذي يصف الزهرة، لا يستطيع الاهتمام بوصف الباقة. ومع ذلك، من الواضح أن الخطاب نفسه (بوصفه مجموعة من الجمل) منظم، ويبدو، من خلال هذا التنظيم، كرسالة من لغة أخرى متفوقة على لغة اللسانيين7: للخطاب وحداته، وقواعده، ونحوه: وفيما وراء الجملة، فإن على الخطاب أن يكون، على الرغم من تركيبه من جمل فقط، موضوع لسانيات ثانية بصورة طبيعية. كان للسانيات الخطاب هذه، وخلال حقبة طويلة عنوان معروف هو: البلاغة؛ ولكن، وكنتيجة للعبة تاريخية، انتقلت البلاغة إلى جانب الآداب الجميلة، وانفصلت الآداب الجميلة عن دراسة اللغة، ووجب حديثاً إعادة طرح المشكلة من جديد: لم تتطور لسانيات الخطاب الجديدة بعد، ولكنها، على الأقل، مسلم بها من قبل اللسانيين أنفسهم8. هذا الأمر ذو دلالة: على الرغم من أن الخطاب يشكل موضوعاً مستقلاً، إلا أنه يجب أن يدرس بالاعتماد على اللسانيات؛ إذا كان يجب تقديم فرضية عمل لتحليل مهمته كبيرة جداً، ومواده لا يمكن حصرها، فإنه من المنطقي أن نبحث عن علاقة متماثلة بين الجملة وبين الخطاب، إلى الحد الذي يكون فيه التنظيم الشكلي نفسه هو الذي يتحكم بكل المنظومات السيميائية، مهما تكن ماهياتها، وأبعادها: الخطاب هو جملة كبيرة (ليس بالضرورة أن تكون وحداتها جملاً)، مثلما أن الجملة تشكل خطاباً صغيراً.
تنسجم هذه الفرضية، جيداً، مع بعض مقترحات علم الإناسة الحالي، لاحظ جاكبسون، وكلود ليفي شتراوس أن الإنسانية تستطيع أن تعرف عن نفسها من خلال القدرة على خلق منظومات ثانوية “كابحة” (أدوات تفيد في صنع أدوات أخرى، لفظ مزدوج للسان، موضوع المحرم الذي يسمح بتفريع العائلات)، يفترض اللساني السوفياتي إيفانوف أنه لا يمكن اكتساب اللغات الاصطناعية إلا بعد اللغات الطبيعية: تكمن الأهمية بالنسبة للناس في القدرة على استخدام أنساق عديدة للمعنى وعلى مساعدة اللغة الطبيعية في تشكيل لغات اصطناعية. من المشروع، إذن، التسليم بوجود علاقة “ثانوية” بين الجملة والخطاب، وستسمى هذه العلاقة تماثلية، من أجل احترام الصفة الشكلية الخالصة للتطابقات. من الواضح أن اللغة العامة للمحكي ليست إلا إحدى الاصطلاحات اللسانية المقدمة للسانيات الخطاب9، وتخضع، بالنتيجة إلى الفرضية التماثلية: المحكي، بنيوياً، شريك الجملة، دون إمكانية أن يختزل إلى مجموعة من الجمل: المحكي جملة كبيرة، مثلما أن كل جملة محققة هي، بطريقة معينة، بداية حكاية قصيرة. على الرغم من أن الأنواع الرئيسية للفعل تمتلك في المحكي دوالاً أصيلة (وغالباً معقدة كثيراً) فإننا نجدها فيه، في الواقع، وهي متضخمة ومتحولة: مثل الأزمنة، والصيغ، والنماذج، والشخصيات، بالإضافة إلى ذلك، تعارض “الموضوعات” نفسها المحمولات الفعلية، ولا تترك نفسها للخضوع للنموذج الجملي (من الجملة): لقد وجد التصنيف الفاعلي الذي اقترحه غريماس10 وظائف أساسية للتحليل القواعدي عبر كثرة شخصيات الحكاية. إن التماثل الذي نشير إليه هنا لا يحمل فقط قيمة استكشافية: إنه يفترض وحدة الهوية بين اللغة والأدب (على الرغم من أنه نوع من الناقل المفضل للمحكي): لم يعد ممكناً تصور الأدب كفن لا يهتم بأي علاقة مع اللغة، منذ أن يستخدمها كأداة للتعبير عن الفكر، والعاطفة، أو الجمال: لا تتوقف اللغة عن مرافقة الخطاب عبر تغطيته بمرآة بنيتها الخاصة: ألا يصنع الأدب، خاصة اليوم، لغةً، بالشروط نفسها للغة؟
1-2-مستويات المعنى:
تقدم اللسانيات إلى التحليل البنيوي للمحكي، منذ البداية، تصوراً حاسماً، لأنها تهتم مباشرة بكل ما هو أساسي في أي نظام للمعنى، أي طريقة تنظيمه، وتسمح، في وقت واحد، بالتعبير عن كيفية أن المحكي ليس مجموعة بسيطة من العبارات، وبتصنيف الكمية الكبيرة من العناصر التي تدخل في تركيب المحكي. هذا التصور هو تصور مستوى الوصف12. إننا نعرف أن الجملة يمكن أن توصف على مستويات عديدة (صوتية، من حيث العناية بالأصوات الإنسانية شرحاً وتحليلاً، والقيام بالتجارب عليها دون نظر خاص إلى ما تنتمي إليه من لغات، وإلى أثر تلك الأصوات في اللغة من الناحية العملية، أو من حيث البحث في الأصوات ذات الوظيفة الدلالية في إحدى اللغات كالبحث في السين والصاد مثل سبر وصبر، ونحوية وسياقية)، تقع هذه المستويات ضمن علاقة تراتبية، لأنه إذا كان لكل مستوى وحداته وعلاقاته الخاصة به، مما يجبر كل مستوى من هذه المستويات على وصف مستقل، فإن أياً منها لا يستطيع لوحده أن ينتج معنى: كل وحدة تنتمي إلى مستوى معين لا تمتلك معنى إلا إذا استطاعت الاندماج بمستوى أعلى: الظاهرة في ذاتها، لا تدل على شيء على الرغم من أنها قابلة للوصف بصورة كاملة؛ وهي لا تشارك في المعنى المندمج في كلمة، وعلى الكلمة نفسها أن تندمج في الجملة13.
تقدم نظرية المستويات (مثلما عبر عنها بينفنست) نموذجين من العلاقات: العلاقات التوزيعية (إذا كانت العلاقات متموضعة على مستوى واحد)، والعلاقات الاندماجية (إذا كانت منقولة من مستوى إلى مستوى آخر). ينتج عن ذلك، أن العلاقات التوزيعية لا تكفي لإدراك المعنى. من أجل القيام بتحليل بنيوي، يجب أولاً، تمييز أحكام عديدة للوصف، ووضع هذه الأحكام ضمن منظور تراتبي (اندماجي). المستويات هي عمليات14. من الطبيعي، إذن، أن تحاول اللسانيات الإكثار منها، خلال عملية تطورها. ما زال تحليل الخطاب غير قادر على العمل إلا على مستويات أولية كانت البلاغة قد حددت للخطاب، بطريقتها، خطتي وصف: هما التنظيم والبيان.
قرر كلود ليفي شتراوس، في تحليله لبنية الأسطورة، أن الوحدات المكونة للخطاب الأسطوري لا تحمل دلالة إلا لأنها مجموعة ضمن مجموعات، وهذه المجموعات نفسها تتحد فيما بينها16، ويقترح تودوروف، وهو يعيد أخذ فكرة الشكلانيين الروس، العمل على مستويين كبيرين، ينقسمان بدورهما إلى أقسام صغرى: القصة (البرهان) المتضمنة لمنطق الأفعال، و “علم تركيب كلام” الشخصيات، والخطاب المشتمل على أزمنة الحكي، وصيغه،ونماذجه17.
مهما يكن عدد المستويات الذي نقترحه، والتعريفات التي نعطيها عنها، لا يمكن أن نثق إلا بأن المحكي هو ترتيب للأحكام. إن فهم حكاية معينة، لا يعني فقط متابعة فك خيط القصة، ولكنه يعني أيضاً التعرف على “الطبقات” فيها، وإسقاط العلاقات الأفقية “للخيط” السردي على محور عامودي ضمني، إن قراءة حكاية (أو الاستماع إليها) لا تعني فقط الانتقال من كلمة إلى كلمة أخرى، ولكنها تعني أيضاً الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر.
سأسمح لنفسي هنا بانتهاج نوع من الدفاع: في “الرسالة المسروقة” يحلل الشاعر الأمريكي “بو” بدقة فشل مدير الشرطة العاجز عن إيجاد الرسالة: كانت حملاته التفتيشية دقيقة وكاملة، مثلما يقول، “ضمن دائرة اختصاصه”: لم يهمل ضابط الشرطة أي مكان، و”أشبع بصورة كاملة مستوى التفتيش”، ولكن من أجل العثور على الرسالة التي يحميها بيقظته؛ كان يجب الانتقال إلى مستوى آخر، واستبدال حصافة رجل البوليس بحصافة مخفي الرسالة. وبالطريقة نفسها، إن “التفتيش” الذي تم على مجموعة أفقية من العلاقات السردية، لم يكتمل، ولكي يكون فعالاً، يجب أن يتوجه أيضاً، “عمودياً”: لا يتموضع المعنى في “نهاية الحكاية”، إنه يتجاوزها؛ وهو واضح أيضاً كالرسالة المسروقة، ولا يمكن أن يضيع إلا في البحث وحيد الجانب.
وهناك دراسات ما زالت ضرورية لكي يمكننا التأكد من مستويات المحكي. وما سنقترحه هنا يشكل صيغة مؤقتةً، وأهميتها تعليمية حصراً: إنها تسمح بتحديد المشكلات وتجميعها، من دون أن نختلف، كما نعتقد، مع بعض التحليلات السابقة. إننا نقترح التمييز بين ثلاثة مستويات للوصف ضمن العمل السردي: مستوى الوظائف (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند بروب وعند بريمون)، ومستوى الأفعال (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند غريماس عندما يتحدث عن الشخصيات كشخصيات فاعلة)، ومستوى “السرد” (الذي هو، بوضوح، مستوى الخطاب عند تودوروف). نريد أن نذكر أن هذه المستويات الثلاثة ترتبط فيما بينها وفق نموذج الاندماج التدريجي: لا معنى للوظيفة في ذاتها إلا إذا أخذت موقعها ضمن العمل العام لفاعل معين؛ وهذا العمل نفسه يأخذ معناه الأخير من حقيقة أنه مسرود، ومعهود به إلى خطاب له قانونه الخاص به.
2-الوظائف
2-1-تحديد الوحدات:
تتألف كل منظومة من وحدات طبقاتها معروفة، ولذلك يجب، أولاً، تقطيع الحكاية، وتحديد أقسام الخطاب السردي التي يمكننا توزيعها على عدد صغير من الطبقات؛ وبكلمة واحدة، يجب تعيين أصغر الوحدات السردية. ووفق المنظور الاندماجي الذي عرفناه هنا، لا يمكن للتحليل أن يكتفي بتعريف توزيعي خالص للوحدات: يجب أن يكون المعنى، منذ البداية، هو معيار الوحدة: إن السمة الوظيفية لبعض أجزاء القصة هي التي تصنع الوحدات فيها: من هنا يأتي اسم الوظائف الذي أعطي مباشرة لهذه الوحدات الأولى. يقسم كل جزء من القصة، منذ عهد الشكلانيين الروس18 إلى وحدة، ويقدم هذا الجزء كنهاية علاقة. إن روح كل وظيفة، هي بذرتها، إذا جاز التعبير، مما يسمح لها بزرع عنصر في الحكاية ينضج لاحقاً، على المستوى نفسه، أو على مستوى آخر: إذا كان فلوبير قد أخبرنا في عمله (قلب بسيط)، وفي لحظة معينة، أن بنات معاون قائد الشرطة في مدينة leveque Pont كن يمتلكن ببغاء، فذلك لأن هذا الببغاء سيكون له أهمية كبيرة، بعد ذلك، في حياة فيليسيتي: إن التعبير عن هذا التفصيل (مهما يكن الشكل اللساني)، يشكل، إذن، وظيفة، أو وحدة سردية. هل لكل شيء في الحكاية وظيفة؟ وهل لكل تفصيل مهما صغر معنى؟ هل يمكن أن تقسم الحكاية إلى وحدات وظيفية، بصورة كاملة؟ سنرى هذا لاحقاً، ولكن مما لا شك فيه أن هناك نماذج عديدة من الوظائف: لأن هناك نماذج عديدة من العلاقات. ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن بناء الحكاية يقوم دائماً على وظائف: وكل شيء فيها يحمل دلالة، بدرجات مختلفة. وهذه ليست مسألة فن (من قبل السارد) ولكنها مسألة بنية: إن ما يسجل، ضمن نظام الخطاب، يستحق الذكر، في الأصل، عندما يبدو تفصيل معين دون معنى، ومتمرداً على أي وظيفة، فإنه يحمل، على الأقل، معنى العبث أو اللا فائدة: إذا لم يكن للشيء معنى انتفى وجوده. يمكننا القول بطريقة أخرى إن الفن لا يعرف الضجيج (بالمعنى الإخباري للكلمة)19: إنه نظام خالص، ولا وجود للوحدات الضائعة20، وسواء كان الخيط طويلاً أم واهناً، أم متماسكاً، فإنه هو الذي يربطها بأحد مستويات القصة21. إن الوظيفة، من وجهة نظر لسانية، هي وحدة من المضمون: هذا يعني أن الملفوظ هو الذي يشكل المضمون ضمن وحدات وظيفية،22 وليس الطريقة التي عبر بها عن هذا المضمون. هذا المدلول التأسيسي يمكن أن يمتلك عدداً من الدوال المختلفة، مراوغة غالباً: إذا قيل لي في (غولدفينجر) إن جيمس بوند رأى رجلاً في الخمسين من عمره، فإن هذه المعلومة تنطوي على وظيفتين، في وقت واحد، وتأثيرهما غير متوازن: إن عمر الشخصية يندمج، من جهة، ضمن نوع من الصورة الشخصية (وفائدة ذلك ليست معدومة في الحكاية، ولكنها منتشرة، ومؤجلة)، ومن جهة أخرى، إن المدلول الآني للملفوظ هو أن بوند لا يعرف محاوره المستقبلي: تتطلب الوحدة، إذن، علاقة قوية جداً، (انفتاح خطر معين، وإلزام بالتحقق). من أجل تعيين الوحدات السردية الأولى، من الضروري، إذن، ألا نضيع، أبداً، من أمامنا السمة الوظيفية للأجزاء التي نفحصها، وأن نقبل، مسبقاً، أن هذه الأقسام لا تتطابق، بصورة قدرية، مع الأشكال التي نعرفها، تقليدياً، في مختلف الأقسام من الخطاب السردي (أفعال، مشاهد، مقاطع، حوارات، حوارات داخلية إلخ..)، وبصورة أقل، مع طبقات ((نفسية)) (مثل التصرفات، والمشاعر، والأهداف، والدوافع، وعقلانية الشخصيات).
وبالطريقة نفسها، عندما لا تكون لغة السرد هي لغة الكلام الملفوظ على الرغم من أنها تدعمها غالباً، فإن الوحدات السردية ستصبح جوهرياً مستقلة عن الوحدات اللسانية: من المؤكد أن هذه الوحدات يمكن أن تتطابق، ولكن ليس باستمرار؛ وستُقدم الوظائف، تارة، عبر وحدات أعلى من الجملة (مجموعات من الجمل بمقاييس مختلفة، وحتى إلى العمل في كليته)، وتارةً أخرى عبر وحدات أدنى من الجملة (مثل التركيب التعبيري، والكلمة، وحتى ضمن الكلمة بعض العناصر الأدبية فقط)؛23 عندما يقال لنا إن بوند يناوب في مكتبه، ويعمل في قسم سري، وفجأة يرن الهاتف (يرفع بوند إحدى السماعات الأربع)، فإن الرقم أربعة يشكل لوحده وحدة وظيفية، لأنه يحيل إلى تصور ضروري لمجموعة القصة (وهو التقنية البيروقراطية العالية)؛ في الواقع، إن الوحدة السردية هنا ليست هي الوحدة اللغوية (الكلمة) ولكن فقط قيمتها الدلالية (لغوياً، لا تهدف الكلمة أربعة أبداً التعبير عن ((الأربعة))؛ هذا يفسر أن بعض الوحدات الوظيفية يمكن أن يكون أدنى من الجملة، مع بقائها تابعة للخطاب، إنها تتجاوز، عندئذٍ، ليس الجملة التي تبقى مادياً أدنى منها، ولكنها تتجاوز مستوى الدلالة الذي ينتسب، مثل الجملة، للسانيات بالمعنى الدقيق للكلمة.
2-2-طبقات الوحدات:
يجب تقسيم هذه الوحدات الوظيفية إلى عدد قليل من الطبقات الشكلية. إذا أردنا تحديد هذه الطبقات دون العودة إلى جوهر المضمون (مثل الجوهر النفسي)، فإنه يجب، من جديد، النظر إلى مختلف مستويات المعنى: ترتبط بعض الوحدات بوحدات أخرى في المستوى نفسه، ولكي يتم إشباع الوحدات الأخرى، يجب على العكس من هذا، الانتقال إلى مستوى آخر. من هنا تأتي، منذ البداية، طبقتان كبيرتان من الوظائف، الوظائف الأولى هي وظائف توزيعية، والوظائف الأخرى هي وظائف اندماجية. تتطابق الأولى مع وظائف بروب، والتي أعاد بريمون أخذها، خاصة، ويطلق على هذه الوظائف التوزيعية اسم “وظائف” (على الرغم من أن الوحدات الأخرى هي أيضاً وظيفية)؛ ونموذجها كلاسيكي منذ تحليل توماشفسكي: إن شراء مسدس حربي يرتبط باللحظة التي سنستخدمه فيها، (وإذا لم نستخدمه، فإن الإشارة ترجع إلى علامة ضعف إرادة)، وإن رفع سماعة الهاتف مرتبط باللحظة التي نعيدها فيها إلى مكانها؛ وإدخال الببغاء إلى بيت فيليسيتي مرتبط بحادثة الحشو بالقش، والعشق الهيامي، الخ. تتضمن الطبقة الكبيرة الثانية من الوحدات، ذات الطبيعة الاندماجية، كل الإشارات (بالمعنى الشامل جداً للكلمة) 24، وبهذا لا تحيل الوحدة إلى فعل تكميلي يكون فيها نتيجة، ولكنها تحيل إلى تصور موسع، إلى حد ما، وضروري لمعنى القصة: مثل الإشارات الطبيعية المتعلقة بالشخصيات، والمعلومات النسبية عن هويتهم، وأخبار الطقس، الخ؛ إن علاقة الوحدة بلازمتها لم تعد علاقة توزيعية (تحيل إشارات عديدة غالباً إلى مدلول واحد، ولم يعد نظام ظهورها في الخطاب متعلقاً بالموضوع، بالضرورة) ولكنها علاقة اندماجية؛ ولكي نفهم فائدة العلامة الإشارية يجب الانتقال إلى مستوى أعلى (أفعال الشخصيات أو السرد)، لأنه هنا فقط يُفك رمز الإشارة، إن القوة المؤسساتية الداعمة لبوند، والواضحة من خلال عدد أجهزة الهاتف، ليس لها أي انعكاس على توالي الأفعال التي ينخرط فيها بوند عبر قبول الاتصال؛ ولا تأخذ معنى إلا على مستوى تصنيف عام للفاعلين (بوند من جهة النظام)؛ إن الإشارات هي وحدات دلالية حقيقية، من خلال الطبيعة العامودية، إلى حد ما، لعلاقاتها، لأن هذه الإشارات، وبعكس ((الوظائف)) بالمعنى الدقيق للكلمة، تحيل إلى مدلول، وليس إلى ((عملية))؛ إن صحة الإشارات ((أعلى))، وقد تكون أحياناً افتراضية، خارج التركيب التعبيري الواضح (يمكن ألا يسمى طبع شخصية معينة أبداً، ولكنه مع ذلك، يشار إليه باستمرار)، وهذه صحة نموذجية، في مقابل ذلك، إن صحة ((الوظائف)) بعيدة دائماً، فهي صحة تركيبية دلالية. تتضمن الوظائف والإشارات، إذن تمييزاً كلاسيكياً آخر: تتطلب الوظائف علاقات كنائية، وتفرض الإشارات العلاقات الاستعارية؛ تتطابق إحداها مع وظيفية العمل، وتتطابق الأخرى مع وظيفية الوجود.
يجب أن تسمح هاتان الطبقتان الكبيرتان المتعلقتان بالوظائف والإشارات بنوع من التصنيف للمحكيات.
بعض المحكيات وظيفية بقوة (مثل الحكايات الشعبية)، وفي مقابل ذلك، هناك محكيات إشاراتية بقوة (مثل الروايات النفسية)؛ وبين هذين المحورين، يوجد سلسلة من الأشكال الوسيطة، والمتعلقة بالقصة، والمجتمع، والجنس. ولكن هذا ليس كل شيء: داخل كل طبقة من هاتين الطبقتين، من الممكن، مباشرةً، تحديد طبقتين فرعيتين من الوحدات السردية.
إذا أخذنا طبقة الوظائف، ليس لوحداتهما الأهمية نفسها؛ فبعضها يشكل مفاصل حقيقية للمحكي (أو المقطع من المحكي)؛ وبعضها الآخر ((يملأ)) الفضاء السردي الذي يفصل الوظائف المفصلية: تسمى الأولى الوظائف الرئيسية (أو المركزية)، وتسمى الثانية وظائف تحضيرية، بالنظر إلى طبيعتها التكميلية. لكي تكون وظيفة معينة وظيفة رئيسية، يكفي أن يفتح الفعل الذي تستند إليه (أو يحافظ أو يغلق) نهاية متكررة بالنسبة إلى تتمة القصة، أي أن يدشن أو ينهي الشك؛ إذا كان الهاتف يرن في جزء من الحكاية، فإنه من الممكن أيضاً أن نجيب عليه أو لا نجيب، مما يقضي بتوجيه القصة ضمن طريقتين مختلفتين. في المقابل، من الممكن دائماً امتلاك إشارات تحضيرية، بين وظيفتين رئيسيتين، تتجمع حول قطب أو آخر دون تعديل طبيعتها التناوبية: إن الفضاء الذي يفصل ((الهاتف رن)) و ((بوند رفع السماعة)) يمكن أن يملأ بكمية كبيرة من الحوادث العرضية الصغيرة، والأوصاف الصغيرة: ((بوند يتوجه نحو المكتب، يتناول السماعة، ويضع سيكارته))، الخ. تبقى هذه المحفزات وظيفية، ضمن الحد الذي تدخل فيه بارتباط مع مركز معين، ولكن وظيفتها مخففة، وأحادية الجانب، وهامشية: يتعلق الأمر هنا بوظيفية تاريخية خالصة، (إننا نصف ما يفصل بين لحظتين من لحظات التاريخ)، في حين أنه في المكان الذي يجمع وظيفتين رئيسيتين، تتجلى وظيفية مزدوجة، فهي تاريخية ومنطقية، في وقت واحد: إن الوظائف التحضيرية ليست إلا وحدات تعاقبية، والوظائف الرئيسية هي وحدات تعاقبية ومنطقية في الوقت نفسه. في الواقع، كل شيء يبعث على الاعتقاد أن باعث النشاط السردي هو تداخل التعاقب والنتيجة، إن ما يأتي -بعد- يقرأ في المحكي على أنه حدث عبر…؛ يصبح المحكي، في هذه الحالة، تطبيقاً نظامياً للخطأ المنطقي، المفروض من الفلسفة المدرسية تحت صيغة (بعد هذا، بسبب قربه من هذا) والذي يمكن أن يكون شعار القدر والذي يكون فيه المحكي، بصورة عامة، هو ((اللغة))؛ وهذا (السحق) للمنطق وللزمن هو دعامة الوظائف الرئيسية التي تكملها، من النظرة الأولى، يمكن أن تكون هذه الوظائف عبر دلالية بقوة؛ وما يشكلها، ليس المشهد (الأهمية، والمجلد، والندرة وقوة الفعل الملفوظ)، ولكن، إذا أمكن القول، الخطر: إن الوظائف الرئيسية هي لحظات الخطر في الحكاية؛ بين هاتين النقطتين من التعاقب، وبين هذين المركزين للتوزيع، تمتلك المحفزات الفرعية مناطق أمان، واستراحة ورفاهية؛ مع ذلك، لهذه (الكماليات)) فائدة: من وجهة نظر القصة، يجب تكرار أن المحفّز يمكن أن يمتلك وظيفة ضعيفة ولكنها ليست قط معدومة: هل هو زائد (بالمقارنة مع مركزه)، ويشارك في اقتصاد الرسالة؛ ولكن ليست هذه هي الحالة: إن الإشارة الزائدة في الظاهر، تحمل دائماً وظيفة استدلالية: إنها تسرع الخطاب، أو تؤخره، أو تعمل على دفعه، وهي تلخص، وتستبق، وأحياناً تضيع27: يبدو المؤشّر إليه دائماً شيئاً يستحق الذكر، والمحفز يوقظ باستمرار التوتر الدلالي للخطاب المقول: وكان لهذا المؤشّر إليه، وسيكون له دائماً معنى في الخطاب؛ إن الوظيفة الدائمة للمحفّز، إذن، وفي كل الحالات، هي وظيفة تنبيهية (إذا استخدمنا تعبير جاكبسون)؛ فهي تحافظ على التواصل بين السارد والمسرود له. لنقل إنه لا يمكن إلغاء مركز معين دون تشويه القصة، ولا يمكن أيضاً إلغاء محفّز دون تشويه الخطاب. أما فيما يتعلق بالطبقة الكبيرة الثانية من الوحدات السردية (الإشارات)، الطبقة الاندماجية، فإن الوحدات التي توجد فيها تشترك في أنها لا تستطيع أن ترمم نفسها (أو أن تكتمل) إلا على مستوى الشخصيات أو على مستوى السرد؛ إنها تشكل جزءاً من علاقة معلمية28، يستمر تعبيرها الثاني الخفي، والتوسعي في حدث، أو شخصية، أو في العمل كله؛ مع ذلك، يمكن أن نميز في هذه الوحدات إشارات بالمعنى الدقيق للكلمة، تحيل إلى طبع، أو إحساس، أو جو معين (مثل الشك) أو فلسفة، أو معلومات، والذين يفيدون في التموضع ضمن الزمن والفضاء. إن القول بأن بوند مناوب في مكتب مفتوح النافذة يفسح المجال لرؤية القمر بين غيوم كثيفة تتحرك، وفي هذا إشارة إلى ليلة صيف عاصفة، ويشكل هذا الاستنتاج نفسه إشارة مناخية تحيل إلى المناخ الثقيل، والمقلق لفعل لم نعرفه بعد. تحمل الإشارات دائماً، إذن، مدلولات خفية؛ وفي المقابل، فإن المخبرين لا يحملون هذه المدلولات، على مستوى القصة على الأقل: وهذه معطيات خالصة، ودالة مباشرة. تتطلب الإشارات نشاطاً لفك الرموز: يتعلق الأمر بالنسبة للقارئ، بالتعرف على طبع ومناخ: يقدم المخبرون معرفة جاهزة؛ إن وظيفتهم، مثل وظيفة المحفزات، ضعيفة، إذن، ولكنها ليست عديمة الفائدة: إن الخبر، مهما كانت “كمدته” بالنسبة إلى بقية القصة، (مثل العمر الدقيق لشخصية معينة)، يفيد في إعطاء مصداقية لواقعية المرجع، وفي تجذير التخييل في الواقع: إنه عامل واقعي، وبهذه الصفة، يمتلك وظيفية أساسية، ليس على مستوى القصة، ولكن على مستوى الخطاب29.
يبدو أن النويات المركزية، والمحفزات، والإشارات، والمخبرين، يشكلون الطبقات الأولى التي يمكن أن نوزع عليها وحدات المستوى الوظيفي. يجب إلحاق هذا التصنيف بملاحظتين. أولاً، إن أي وحدة يمكن أن تنتمي، في الوقت نفسه، إلى طبقتين مختلفتين: إن شرب الويسكي (في سوق في مطار) هو فعل يمكن أن يفيد كمحفز للإشارة “الرئيسية” للانتظار، وهو أيضاً، وفي الوقت نفسه، إشارة إلى نوع من الوسط المكاني (مدنية، استرخاء، ذكريات، الخ): بقول آخر، يمكن أن تكون بعض الوحدات مختلطة. إنها لعبة الشكل الممكن في اقتصاد الحكاية؛ في رواية “غولدفينجر”، يتلقى بوند، قبل التفتيش في غرفة عدوه، موافقة على التفتيش من رئيسه: الإشارة هي وظيفة “رئيسية” خالصة؛ لقد تغيّر هذا التفصيل، في الفيلم: يختطف بوند صرة الخادمة وهو يداعبها، دون أن تعترض، لم تعد الإشارة وظيفية فقط، ولكنها علاماتية أيضاً، حيث تحيل إلى طبع بوند (مثل جرأته ونجاحه مع النساء).
وفي المكان الثاني، يجب ملاحظة أن الطبقات الأخرى التي تحدثنا عنها يمكن أن تخضع لتوزيع آخر، أكثر انسجاماً مع النموذج اللساني. في الواقع، تمتلك المحفزات، والإشارات، والمخبرون سمة مشتركة. فهم يشكلون امتدادات بالنسبة إلى النويات المركزية: تشكل النويات (مثلما سنرى) مجموعات منجزة من التعبيرات القليلة إلى حد ما، ويتحكم فيه منطق معين، فهي ضرورية وكافية، في الوقت نفسه؛ تأتي الوحدات الأخرى لملأ هذه البنية المعطاة، وفق نموذج التزايد المطلق، من حيث المبدأ؛ إننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالنسبة للجملة المكونة من جمل بسيطة، المركبة باستمرار من إضافات، وملأ فراغات، وتغليفات، إلخ…: والمحكي، مثل الجملة، قابل للتحفيز باستمرار.
علق مالارميه مثل هذه الأهمية على هذا النموذج من البنية الذي ألف وفقه قصيدته (jamais un coup de des) ، والتي يمكن أن نعتبرها، بعقدها، ودواخلها، وكلماتها العقدية، وكلماتها المخرَّمة، كرمز لكل محكي، وكل لسان.
2-3-النحو الوظيفي
كيف، ووفق أي قواعد ترتبط هذه الوحدات المختلفة، بعضها ببعض على طول التركيب التعبيري السردي؟ ما هي قواعد التأليف الوظيفي؟
يمكن للمخبرين والإشارات أن يتحدوا فيما بينهم بحرية: مثل الصورة الشخصية التي تقرب، دون خوف، معطيات الحالة العائلية، من السمات الشخصية. إن علاقة إشراك بسيطة تجمع بين المحفزات والمراكز: يتطلب المحفز، بالضرورة، وجود وظيفة رئيسية يرتبط بها، ولكن ليس بصورة متزامنة. أما بالنسبة للوظائف الرئيسية، فإن علاقة التضامن هي التي توحدها: تقود وظيفة من هذا النوع إلى وظيفة أخرى من النوع نفسه، وبصورة متزامنة يجب التوقف قليلاً عند هذه العلاقة الأخيرة: لأنها تحدد أولاً شكل المحكي (الامتدادات قابلة للإلغاء، والمراكز ليست كذلك)، ومن ثم لأنها تهم، أساساً، أولئك الذين يبحثون عن إعطاء المحكي بنية معينة. لقد أشرنا سابقاً إلى أنه عبر بنيته نفسها، يقيم المحكي خلطاً بين التتابع والنتيجة، بين الزمن والمنطق. وهذا الغموض هو الذي يشكل المشكلة المركزية للنحو السردي. هل هناك وراء المحكي منطق لا زماني؟ ما زالت هذه النقطة تباعد بين الباحثين إلى الوقت الحالي. يتمسك بروب الذي فتح تحليله، مثلما نعرف، الطريق للدراسات الحالية، بعدم قابلية اختزال نظام التسلسل الزمني: الزمن. مع ذلك، إن أرسطو نفسه وهو يعارض التراجيديا (المعروفة بوحدة الفعل) بالتاريخ (المعروف بتعددية الأفعال ووحدة الزمن) يعزو الأولوية إلى المنطق على حساب التسلسل الزمني30. هذا هو ما يفعله كل الباحثين الحاليين مثل (كلود ليفي شتراوس، وغريماس، وبريمون، وتودوروف)، والذين أبدوا جميعاً موافقتهم على اقتراح ليفي شتراوس (وإن كانوا يختلفون حول نقاط أخرى): “إن نظام التتابع الزمني يتلاشى ضمن بنية مسجلة لا زمنية”31. في الواقع، يحاول التحليل الحالي القيام “بالتقطيع الزمني” للمضمون السردي، وإخضاعه لما يسميه مالارميه، بخصوص اللغة الفرنسية، “الخزانات الكبيرة الأولية للمنطق”.32 أو بصورة أدق، إن المهمة، وهذه رغبتنا على الأقل، هي الوصول إلى إعطاء وصف بنيوي للوهم التاريخي؛ وعلى المنطق السردي أن يأخذ بعين الاعتبار الزمن السردي. يمكن القول، بطريقة أخرى، إن الزمنية ليست سوى طبقة بنيوية للمحكي “للخطاب”، مثلما أن الزمن، في اللغة، لا يوجد إلا على شكل منظومة؛ من وجهة نظر المحكي، لا وجود لما نسميه زمناً، أو على الأقل لا يوجد إلا وظيفياً، كعنصر من نظام سيميائي: لا ينتمي الزمن إلى الخطاب، بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنه ينتمي إلى المرجعية؛ المحكي واللغة لا يعرفان إلا زمناً سيميائياً؛ إن الزمن الحقيقي هو وهم مرجعي، “واقعي” مثلما يظهره تفسيره بروب، وتحت هذا العنوان يجب على الوصف البنيوي دراسته33.
ما هو، إذن، هذا المنطق الذي يخضع الوظائف الرئيسية للحكاية؟ هذا ما نسعى إلى إيضاحه بدقة، وهذا ما كان حتى الآن قد نوقش بصورة واسعة. سنرى، إذن، إسهامات أ. ج. غريماس، وبريمون، وتودوروف، في العدد الثامن من مجلة (اتصالات)، عام 1966، والذين درسوا منطق الوظائف كلها. ظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسية من البحث، عرضها تودوروف. الطريق الأول (بريمون)، هو الأكثر منطقية بالمعنى الدقيق: يتعلق الأمر بإعادة تأليف قواعد التصرفات الإنسانية التي تستخدمها الحكاية، وبسبر مسار “الخيارات” الذي تخضع له مثل هذه الشخصية بصورة قدرية 34، في كل نقطة من الحكاية، وباستخدام ما يمكن تسميته بالمنطق الخاص بالطاقة35، لأنه يمسك بالشخصيات في اللحظة التي يختارون فيها القيام بالفعل.
النموذج الثاني لساني (ليفي شتراوس، غريماس): إن الاهتمام الأساسي لهذا البحث هو العثور على تعارضات نموذجية في الوظائف، وانسجاماً مع مبدأ جاكبسون في (الشعرية)، تمتد هذه التعارضات على مسار السرد كله (مع ذلك، سنرى التطورات الجديدة التي صحح من خلالها غريماس نموذجية الوظائف أو أكملها).
الطريق الثالث الذي فتحه تودوروف مختلف قليلاً، لأنه يضع التحليل على مستوى “الأفعال” (أي الشخصيات) عبر محاولة تأسيس قواعد ينظم من خلالها المحكي عدداً من المحمولات الأساسية ويبدلها، ويحولها. ليس المقصود الاختيار بين فرضيات العمل هذه؛ فهي ليست متعارضة ولكنها متنافسة، وهي حالياً في مرحلة التشكل الكامل. إن الإضافة الوحيدة التي نسمح لأنفسنا بإضافتها إلى هذا الفرضيات تتعلق بأبعاد التحليل. حتى إذا نحينا جانباً الإشارات، والمخبرين، والمحفزات، يبقى أيضاً في المحكي (خاصة عندما يتعلق الأمر برواية، وليس بحكاية) عدد كبير من الوظائف الرئيسية؛ ولا يمكن السيطرة على عدد كبير منها إلا من خلال التحليلات التي ذكرناها سابقاً، والتي اشتغلت حتى الآن على مفاصل الحكاية الكبرى. مع ذلك، يجب توقع وصف دقيق بشدة، من أجل النظر في وحدات الحكاية كلها، وأصغر الأجزاء فيها؛ نذكر بأن الوظائف الكبرى لا يمكن تحديدها من خلال أهميتها، ولكن فقط من خلال طبيعة علاقاتها: إن “اتصالاً هاتفياً”، وإن بدا غير ذي أهمية، يشتمل، من جهة، على بعض الوظائف الرئيسية (صوت الجرس، رفع السماعة، الحديث، وضع السماعة) ويجب من جهة أخرى وجود قدرة على تعليقه، في مجمله، بالمفاصل الكبرى من الحكاية، بالتدريج، على الأقل. تتطلب التغطية الوظيفية للحكاية تنظيماً للبدائل التي لا تستطيع وحدة أساسها إلا أن تكون مجموعة صغيرة من الوظائف، التي ستسمى هنا متوالية (بحسب بريمون). إن المتوالية هي تتمة منطقية للنويات المركزية المتحدة فيما بينها عبر علاقة تضامن36، وتتفتح المتوالية عندما لا يكون لأحد تعبيراتها سابق متضامن، وتنغلق عندما لا يبقى لأحد تعبيراتها نتيجة. إذا أخذنا، قصداً، مثالاً، غير ذي معنى، إننا نطلب سلعة ما فنتلقاها، ونستهلكها وندفع ثمنها فإن هذه الوظائف المختلفة تشكل متوالية مغلقة، لأنه من غير الممكن تقديم الطلب، أو إلحاق الدفع دون الخروج من كل متجانس هو ((الاستهلاك)). إن المتوالية، في الواقع، قابلة دائماً للتسمية. إن بروب، ثم بريمون، وهما يحددان الوظائف الكبرى للحكاية، أجبرا مسبقاً على تسميتها (خداع، خيانة، نضال، عقد، إغراء، إلخ…)؛ إن عملية التسمية لا يمكن تجنبها، أيضاً بالنسبة للمتواليات عديمة الفائدة، وهذا ما يمكن تسميته ((المتواليات الصغيرة جداً))، وهي تشكل غالباً العقدة الأكثر صغراً من النسيج السردي. هل هذه التسميات هي فقط من اختصاص المحلل؟ بعبارة أخرى، هل هي لغة واصفة بصورة خالصة؟ مما لا شك فيه أنها كذلك لأنها تعالج قانون المحكي، ولكن يمكننا تخيل أنها تشكل جزءاً من لغة نقدية داخلية عند القارئ (أو الناشر) نفسه، الذي يقبض، مباشرة، على منطق الأفعال ككل اسمي: إن القراءة هي تسمية؛ والاستماع ليس فقط إدراك لغة، ولكنه يعني أيضاً بناءها. إن عنوانات المتوالية تشابه، إلى حد ما، هذه الكلمات الافتتاحية لآلات الترجمة، التي تغطي بطريقة مقبولة، تنوعاً كبيراً من المعاني والتباينات. تتضمن لغة الحكاية الموجودة فينا مسبقاً، هذه العنوانات الأساسية: يرتبط المنطق المغلق، الذي يشكل متوالية، باسمه: تفرض كل وظيفة تفتتح إغراء، منذ ظهورها في الاسم الذي تبعثه، القضية الكاملة للإغراء، مثلما فهمنا هذا الإغراء من كل الحكايات التي شكلت فينا لغة الحكي. وعلى الرغم من أهمية المتوالية القليلة، لأنها تتشكل من عدد قليل من النويات المركزية، فإنها تشتمل دائماً على لحظات خطر، وهذا ما يسوغ تحليلها: يمكن أن يبدو من غير المنطقي التشكيل في متواليات للتتمة المنطقية لأفعال صغيرة تشكل فعل تقديم السيكارة (تقديم، قبول، إشعال، تدخين)؛ ولكن، في كل نقطة من هذه النقاط، يمكن للمعنى أن يتبدل: يقدم رئيس جيمس بوند، دوبون، له النار من ولاعته، لكن بوند يرفض؛ إن معنى هذا التفريع هو أن بوند يخشى فخاً37.
المتوالية، إذن، هي وحدة منطقية خطرة: وهذا ما يسوغها بالحد الأدنى: وهي قائمة، أيضاً، بالحد الأقصى: فهي منغلقة على وظائفها، وتذوب تحت اسمها، وهي تشكل، هي نفسها، وحدة جديدة، جاهزة للعمل كتعبير بسيط عن متوالية أخرى أكثر سعة. إليكم متوالية صغيرة: مد اليد، ومصافحتها، وتركها؛ يصبح هذا السلام وظيفة بسيطة: فهو من جهة يأخذ دور إشارة (استرخاء دوبون، ونفور بوند)، ويشكل من جهة أخرى، تعبيراً عن متوالية أكثر سعة، تسمى اللقاء، وتعبيراتها الأخرى (اقتراب، وتوقف، ونداء، وسلام، وإقامة) ويمكن أن تكون هي نفسها متواليات صغيرة. إن شبكة متكاملة من البدائل هي التي تشكل الحكاية، بدءاً من أصغر القوالب وانتهاء بأكبر الوظائف. يتعلق الأمر هنا بطبقة تبقى داخلية على المستوى الوظيفي: وعندما تستطيع الحكاية أن تتنامى بالتدريج، من سيكار دوبون إلى معركة بوند ضد غولدفينجر، عندها فقط ينتهي التحليل الوظيفي: وعندئذ يمس هرم الوظائف المستوى التالي (وهو مستوى الأفعال). يوجد، إذن، نحو داخلي في المتواليات، وفي الوقت نفسه، يوجد نحو استبدالي للمتواليات فيما بينها. تأخذ الواقعة الأولى من غولدفينجر شكلاً هرمياً.
مساعدة طلب
يقظة أسر عقوبة لقاء التماس عقد
اقتراب نداء تسليم إقامة
مد اليد المصافحة ترك اليد
من الواضح أن هذا التمثيل تحليلي. يدرك القارئ نفسه، تتمة أفقية للتعبيرات. ولكن ما يجب الإشارة إليه، هو أن تعبيرات متواليات عديدة يمكن أن تتداخل فيما بينها بقوة: لا تنتهي المتوالية إلا بعد أن تظهر الكلمة الأولى من متوالية جديدة: تتبادل المتواليات الأمكنة؛38 تتبدل بنية المحكي وظيفياً: وبهذه الطريقة “يتماسك” المحكي و “يمتص” في الوقت نفسه. في الحقيقة، لا تتوقف عملية تداخل المتواليات داخل العمل الواحد، من خلال ظاهرة الانقطاع الجذري، إلا إذا جمعت بعض القوالب الكتيمة التي تشكل هذا التداخل في مستوى أعلى للأفعال (للشخصيات). يتألف عمل غولدفينجر من ثلاثة أحداث مستقلة وظيفياً لأن قوالبها الوظيفية تتوقف مرتين عن التواصل: لا يوجد أي علاقة تتابعية بين حادثة المسبح وحادثة فورت-كنوكس؛ ولكننا نرى في المقابل، استمرار علاقة فاعلية، لأن الشخصيات (وبالنتيجة بنية علاقاتهم) هي نفسها. إننا نعرف هنا الملحمة (مجموع الحكايات الخرافية المتنوعة): الملحمة هي حكاية منكسرة على المستوى الوظيفي ولكنها موحدة على المستوى الفعلي (يمكن أن يتأكد هذا في الأوديسا أو في مسرح بريخت). يجب، إذن، إحاطة مستوى الوظائف (الذي يقدم القسم الأكبر من التركيب التعبيري السردي)؛ بمستوى أعلى تستمد منه وحدات المستوى الأول، بالتدريج، معناها، وهو مستوى الأفعال.
3-الأفعال
3-1-نحو وضع بنيوي للشخصيات:
إن مفهوم الشخصية، في الشعرية الأرسطية، ثانوي، ويخضع بصورة كاملة لمفهوم الفعل: يمكن أن يوجد حكاية خرافية من دون “صفات”، هذا ما يقوله أرسطو، ولكنه لا يوجد صفات من دون حكاية خرافية. أخذ بعض المنظرين الكلاسيكيين مثل “فوسيوس” وجهة النظر هذه. بعد ذلك أخذت الشخصية سمة نفسية ثابتة، بعد أن كانت مجرد اسم، وممثلة للحدث39، لقد أصبحت فرداً، وشخصاً، لقد أصبحت، باختصار، كائناً كاملاً، حتى وإن لم يفعل شيئاً، أو قبل أن يتصرف40، لم تعد الشخصية تابعة للحدث، وبدأت تجسد، مسبقاً، جوهراً نفسياً؛ يمكن أن تخضع هذه الماهيات لإحصاء الذي كان شكله الأكثر وضوحاً القائمة التي يستخدمها المسرح البرجوازي (المغناج، والأب النبيل، الخ). كان التحليل البنيوي ينفر، منذ ظهوره، من دراسة الشخصيات بوصفها ماهية، وكان ذلك من أجل تصنيفها؛ ومثلما ذكر تودوروف، ذهب توماشيفسكي إلى حد إنكار أية أهمية سردية للشخصية، وقد تم التخفيف من وجهة النظر هذه، بعد ذلك. لم يصل بروب إلى حد إبعاد الشخصيات عن التحليل ولكنه اختزلها إلى تصنيف بسيط قائم، ليس على الدخيلة النفسية، ولكن على وحدة الأفعال التي يمنحها لها المحكي (فهي إما مانحة غرائبية، أو أنها تقدم المساعدة، أو أنها خبيثة، الخ..)
لم تتوقف الشخصية، منذ بروب، عن فرض المشكلة نفسها على التحليل البنيوي للمحكي: فمن جهة تشكل الشخصيات (مهما كان اسمها، درامية، شخصية، فاعلة) خطة وصف ضرورية، لا يمكن خارجها فهم “الأحداث” الصغيرة المروية، إلى حد أنه يمكن القول إنه لا توجد حكاية واحدة في العالم من دون “شخصيات”41، أو على الأقل من دون “ممثلين”؛ ولكن هؤلاء “الممثلين” الكثيرين، من جهة أخرى، لا يمكن وصفهم أو تصنيفهم بتعبيرات “الأشخاص”، سواء اعتبرنا “الشخص” شكلاً قصصياً خالصاً، محصوراً في بعض الأجناس (التي نعرفها جيداً)، وبالتالي فإنه يجب الاحتفاظ بالحالة الواسعة جداً، لكل المحكيات (حكايات شعبية، نصوص معاصرة) التي تشتمل على ممثلين، ولكن ليس على أشخاص؛ أم أعلنا أن الشخص ليس إلا عقلنة نقدية يفرضها عصرنا على مجرد ممثلين حكائيين. لقد جهد التحليل البنيوي، الحريص جداً على عدم تعريف الشخصية بتعبيرات الماهيات النفسية، لكي يعرف الشخصية، عبر فرضيات مختلفة، ليس بوصفها “كائناً” ولكن بوصفها “فاعلاً مشاركاً”. كل شخصية، بالنسبة لبريمون، يمكن أن تكون الممثلة لمتواليات الأفعال الخاصة بها (خداع، إغراء)؛ عندما تنطوي المتوالية الواحدة على شخصيتين (وهذه هي الحالة الطبيعة)، فإن هذه المتوالية تحمل منظورين، أو إذا فضلنا، تحمل اسمين (ما يعتبره أحدهم خداعاً، يعتبره الآخر تحايلاً)؛ بصورة عامة، تعد كل شخصية، حتى وإن كانت ثانوية، بطلة متواليتها. ينطلق تودوروف، وهو يحلل رواية نفسية (العلاقات الخطيرة)، ليس من الشخصيات -الأشخاص، ولكن من ثلاث علاقات كبيرة يمكن أن ينخرطوا فيها، والتي يسميها محمولات الأساس (وهي الحب، والتواصل، والمساعدة)؛ تخضع هذه العلاقات في التحليل لنوعين من القوانين: قانون الانحراف عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بعلاقات أخرى، وقانون الفعل عندما يتعلق الأمر بوصف تحول هذه العلاقات عبر مسار القصة: هنا كثير من الشخصيات في “العلاقات الخطيرة” ولكن “ما يقال عنها” (محمولاتها) يقبل التصنيف42. اقترح غريماس، أخيراً، وصف شخصيات الحكاية وتصنيفها، ليس وفق ما هم عليه، ولكن وفق ما يفعلون (من هنا يأتي اسم الفاعلين)، ولهذا السبب فهي تشترك بثلاثة محاور دلالية كبيرة، نجدها في الجملة (الفاعل، المفعول، المضاف إليه، والمفعول الظرفي) والتي هي الاتصال، والرغبة أو البحث، والاختبار؛43 ومثلما أن هذا الاشتراك ينتظم عبر ثنائيات، فإن العالم اللامتناهي للشخصيات يخضع، هو أيضاً، لبنية نموذجية (فاعل-مفعول، مرسل-مستقبل، مساعد-معارض) ترتسم على طول الحكاية؛ ومثلما أن الفاعل يحدد طبقة، فإنه يمكن وجود فاعلين مختلفين كثر، يستخدمون وفق قوانين التعدد، والإبدال، والنقص.
تشترك هذه المفهومات الثلاثة في نقاط عديدة. يجب أن نكرر أن النقطة الرئيسية هي تعريف الشخصية من خلال مشاركتها في دائرة الأفعال، وهذه الدوائر قليلة، ونموذجية، وقابلة للتصنيف؛ ولهذا نسمي مستوى الوصف الثاني هنا، وإن كان مستوى الشخصيات، مستوى الأفعال: يجب ألا تفهم هذه الكلمة هنا، إذن، بمعنى الأفعال الصغيرة التي تشكل نسيج المستوى الأول، ولكن بمعنى المفاصل الكبيرة للتطبيق العملي (الرغبة، التواصل، المكافحة).
3-2-مشكلة الفاعل.
إن المشكلات التي أثارها تصنيف شخصيات الحكاية لم تجد إلى الآن حلاً لها. من المؤكد أن هناك اتفاقاً حول إمكانية خضوع شخصيات الحكاية العديدة لقوانين الاستبدال، مثلما أن رمزاً معيناً، داخل عمل، يستطيع أن يستحوذ على شخصيات عديدة44؛ من جهة أخرى يبدو أن النموذج الفعلي الذي اقترحه غريماس (وأعاد تودوروف أخذه من منظور آخر) قد قاوم جيداً في اختبار عدد كبير من الحكايات: وكما في كل نموذج بنيوي، إن قيمته من خلال شكله القانوني (القالب بستة فواعل) أقل من قيمته من خلال التحولات الموزونة (نقص، غموض، ازدواجية، استبدال)، التي يتكيف معها، تاركاً بذلك الأمل في تصنيف فعلي للمحكيات45. مع ذلك، عندما يكون للقالب قدرة تصنيفية جيدة، (هذه هي حالة الفواعل عند غريماس)، فإنه لا ينظر جيداً إلى تعدد المشاركين، منذ أن يتم تحليلهم بتعبيرات المنظورات؛ وعندما نحترم هذه المنظورات (في وصف بريمون)، يبقى نظام الشخصيات مقسماً؛ يتجنب الاختصار الذي يقدمه تودوروف هذين العائقين، ولكنه لا يمس، إلى اليوم، إلا محكياً واحداً. يبدو أن هذا كله يمكن أن ينسق. إن الصعوبة الحقيقية التي يطرحها تصنيف الشخصيات هي مكانة الفاعل (ووجوده) ضمن كل قالب فعلي، مهما كانت صيغة ذلك. من هو الفاعل (البطل) في الحكاية؟ ألا يوجد طبقة مفضلة للفاعلين؟ لقد عودتنا روايتنا على التركيز، بطريقة أو بأخرى، على شخصية من بين شخصيات أخرى. ولكن التفضيل لا يشمل الأدب السردي كله. هناك كثير من الحكايات التي تعمل على إقامة علاقة بين عدوين، حول رهان، وتكون أعمالهما متساوية؛ عندئذ يكون الفاعل مزدوجاً، حقيقة، دون أن نستطيع اختزاله عبر استبداله؛ وربما، في هذا الشكل القديم السائد، كما لو أن المحكي، على شاكلة بعض اللغات، كان قد عرف هو أيضاً ثنائية الشخصيات. مع ذلك تبدو هذه الثنائية أكثر فائدة لأنها تقرب الحكاية من بنية بعض الرهانات (الحديثة جداً) والتي يرغب ضمنها عدوان متساويان كسب موضوع يعرضه حكم للتداول؛ يذكر هذا المخطط بالقالب الفعلي الذي اقترحه غريماس، وهذا لا يمكن أن يدهش إذا أردنا أن نقنع أنفسنا جيداً أن اللعبة، بوصفها لغة، تقوم، هي أيضاً على البنية الرمزية نفسها التي نجدها في اللغة وفي المحكي: اللعبة هي أيضاً جملة46.
إذا احتفظنا، إذن، بطبقة مفضلة للفواعل (موضوع البحث، والرغبة، والفعل)، فإنه، من الضروري، على الأقل، تلطيفها، عبر إخضاع هذا الفاعل لأصناف الشخص نفسها، ليس النفسية، ولكن القواعدية: ويجب مرة أخرى مقاربة اللسانيات من أجل القدرة على وصف القضية الشخصية للفعل وتصنيفها (أنا-أنت، je tu)، أو غير الشخصية (هو، il)، سواء كانت مفردة، أم ثنائية، أم جمعية. وربما تكون هذه الأصناف القواعدية للشخص (الممكن الوصول إليها بضمائرنا الشخصية) هي التي تعطي مفتاح المستوى الفعلي. ولكن بما أن هذه الأصناف لا يمكن أن تتحدد إلا بالمقارنة مع قضية الخطاب، وليس مع حكم الواقع، 47 كذلك لا تجد الشخصيات، بوصفها وحدات المستوى الفعلي، معناها إلا إذا دمجناها بالمستوى الثالث للوصف، والذي نسميه هنا مستوى السرد (معارضة للوظائف والأفعال).
4-السرد
4-1- التواصل السردي
مثلما يوجد، داخل الحكاية، وظيفة كبيرة للتبادل (المقسم بين مانح ومستفيد)، كذلك يكون المحكي، بوصفه موضوعاً، رهان تواصل معين: فهناك مرسل للمحكي، ومستقبل له. إننا نعرف أن (أنا و أنت je et tu) في التواصل اللغوي، يفترض أحدهما الآخر حكماً، وبالطريقة نفسها، لا يمكن أن يوجد حكاية من دون سارد، ومن دون مستمع (أو قارئ). وربما يكون هذا لا معنى له، ومع ذلك، فهو غير مستغل بصورة كافية. من المؤكد أن المرسل قد درس بإسهاب (ندرس مؤلف الرواية من دون التساؤل إذا كان هو الراوي)، ولكن عندما ننتقل إلى القارئ، فإن النظرية الأدبية مقصرة جداً. في الواقع، لا تكمن المشكلة في استبطان دوافع السارد، ولا في الآثار التي يتركها السرد على القارئ؛ ولكنها تكمن في وصف القانون الذي يكون وفقه السارد والقارئ مدلولين في الحكاية كلها. تبدو علامات السارد، من النظرة الأولى، أكثر وضوحاً، وأكثر عدداً من علامات القارئ (يستخدم المحكي تعبير أنا أكثر مما يستخدم تعبير أنت)؛ في الحقيقة، إن العلامات الثانية، أكثر مراوغة من الأولى؛ وهكذا، في كل مرة يتوقف فيها السارد عن التقديم، فإنه يعرض أحداثاً يعرفها جيداً ويجهلها القارئ، فإنه ينتج لنفسه، من خلال نقص دال، علامة قراءة، لأن إعطاء السارد لنفسه معلومة لا معنى لـه: كان ليو سيد هذا المكان، هذا ما تقولـه لنا رواية تقوم على الشخص الأول: هذه علامة للقارئ قريبة مما يسميها جاكبسون الوظيفة السباتية للتواصل. مع ذلك سنترك حالياً جانباً علامات الاستقبال، على أهميتها، بسبب نقص في الإحصاءات، من أجل أن نقول كلمة عن علامات السرد49.
من هو الذي يعطي المحكي؟ يبدو أن هناك ثلاثة تصورات، مقدمة حتى الآن. يعتبر التصور الأول أن المحكي يصدر عن شخص (بالمعنى النفسي الكامل للتعبير)؛ ولهذا الشخص اسم، إنه المؤلف، الذي تتغير في داخله الشخصية باستمرار، مثلما يتغير فن فرد محدد بصورة كاملة، يأخذ بين وقت وآخر، القلم ليكتب قصة: المحكي (خاصة في الرواية) ليس، إذن، إلا تعبيراً عن “أنا” خارجية عنه.
يجعل التصور الثاني من السارد شكلاً من الوعي الكامل، غير الشخصي ظاهرياً، يعبر عن القصة من وجهة نظر أعلى، هي وجهة الذات الإلهية:50 السارد داخلي بالنسبة إلى شخصياته (لأنه يعرف كل ما يدور في دواخلهم)، وهو في الوقت نفسه، خارجي (لأنه لا يتطابق أبداً مع شخصية أكثر من غيرها).
التصور الثالث، وهو الأكثر حداثة (هنري جيمس، سارتر) ينص على أنه من واجب السارد أن يحصر حكايته ضمن الحدود التي تستطيع فيها الشخصيات متابعة الحكاية والتعرف عليها: كل شيء يجري كما لو أن كل شخصية كانت هي التي تعبر عن الحكاية. هذه التصورات الثلاثة مزعجة أيضاً، إذ يبدو أنها ترى كلها، في السارد والشخصيات، أشخاصاً حقيقيين “أحياء” (ونحن نعرف القوة الدائمة لهذه الأسطورة الأدبية)، كما لو أن المحكي يتحدد في الأصل، بمستواه المرجعي (يتعلق الأمر أيضاً بتصورات واقعية). وعليه فإن السارد والشخصيات، من وجهة نظرنا على الأقل، هم أساساً، “كائنات على الورق”؛ لا يستطيع المؤلف “المادي” للسرد أن يذوب في سارد هذه الحكاية؛51 إن علامات السارد ثابتة في الحكاية، ونتيجة لذلك، فهي قابلة تماماً لتحليل سيميائي؛ ولكن من أجل الإقرار بأن المؤلف نفسه (الذي يظهر عن نفسه، ويختبئ، أو يتوارى) هو الذي ينظم “العلامات” التي يوحي بها عمله، فإنه يجب افتراض علاقة علاماتية بين الشخص وبين لغته، تجعل من المؤلف كائناً كاملاً، ومن الحكاية التعبير الذرائعي لهذا الكمال: وهذا ما لا يستطيع التحليل البنيوي البت فيه: إن الذي يتحدث في الحكاية ليس هو الذي يكتب “في الحياة”، والذي يكتب ليس هو…52.
في الواقع، إن السرد بالمعنى الدقيق للكلمة (أو قانون السارد) مثل اللغة، لا يعرف إلا نظامين من العلامات: وهما النظام الشخصي، والنظام اللاشخصي؛ لا يستفيد هذان النظامان، بالضرورة، من السمات اللغوية المتعلقة بالشخص “أنا”، واللا شخص “هو”: يمكن أن يوجد، مثلاً، محكيات، أو على الأقل، أحداث، كتبها شخص ثالث، وتكون قضيتها الحقيقية، مع ذلك، الشخص الأول. كيف نقرر ذلك؟ يكفي قلب المحكي (أو المقطع) من هو إلى أنا: باعتبار أن هذه العملية لا تسبب أي تشويه للخطاب غير تغيير الضمائر النحوية، فإنه من المؤكد أننا نبقى ضمن نظام الشخص: إن بداية غولدفينجر كلها محكية عبر جيمس بوند، وإن كانت مكتوبة بضمير الغائب؛ ولكي تتغير القضية، يجب أن تصبح إعادة الكتابة مستحيلة؛ وهكذا فالجملة “لاحظ رجلاً في الخمسين من عمره، ما زال شكله شكل شاب، الخ”. هي جملة شخصية بصورة كاملة، على الرغم من وجود الضمير هو “أنا جيمس بوند، لاحظت، الخ”. ولكن الملفوظ السردي “يبدو أن صوت الجليد على الزجاج أعطى إيحاءً مفاجئاً لبوند “لا يمكنه أن يكون شخصياً، بسبب الفعل “يبدو”، الذي أصبح علامة لا شخصية (وليس الضمير هو).
من المؤكد أن اللاشخصي هو النموذج التقليدي للمحكي، وشكلت اللغة نظاماً زمنياً كاملاً خاصاً بالحكاية (يتمحور حول ماض مبهم)53، ويهدف إلى إبعاد حاضر الشخص الذي يتكلم: “يقول بينفنست: في المحكي لا يتكلم أحد”، مع ذلك، فإن القضية الشخصية (بأشكال مقنّعة إلى حد ما) غزت الحكاية بالتدريج، وحملت السرد على زمانية التعبير ومكانيته (وهذا هو تعريف النظام الشخصي)؛ وهكذا فإننا نرى اليوم حكايات؛ تخلط غالباً، وبإيقاع سريع جداً، وضمن حدود الجملة الواحدة، بين الشخصي واللا شخصي؛ مثل هذه الجملة في غولدفينجر:
عيناه شيء شخصي، رمادية -زرقاء، شيء لا شخصي.
كانتا مثبتتين على عيني دوبون الذي لا يعرف الوضعية التي يأخذها، شيء شخصي لأن هذا النظر الثابت يحمل خليطاً من البراءة، والسخرية، والانتقاص الذاتي، شيء لا شخصي.
من الواضح أنه ينظر إلى خلط الأنظمة على أنه، نوع من السهولة. يمكن أن تصل هذه السهولة إلى حد التشويه: إن رواية أغاتا كريستي البوليسية (الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرون) لا تحافظ على لغزها إلا من خلال الخداع حول شخصية السارد: لقد تم وصف الشخصية من الداخل، في حين أنها هي القاتلة54: كل شيء يجري كما لو أن هناك داخل الشخصية الواحدة، وعي شاهد، ملازماً للخطاب، ووعي قاتل، ملازماً للمرجع: يسمح التناوب التعسفي للنظامين وحده بالإلغاز. إننا نفهم، إذن، أنه في القطب الآخر من الأدب، نجعل من صرامة النظام المختار الشرط الضروري للعمل، من دون القدرة، دائماً، على المفاخرة به إلى النهاية. هذه الصرامة، التي يصطنعها بعض الكتاب المعاصرين، ليست بالضرورة صيغة جمالية؛ إن ما نسميه رواية نفسية تتميز في الأصل بدمج النظامين، عبر التوظيف المتتابع لعلامات النظام اللاشخصي، وعلامات النظام الشخصي؛ في الواقع، لا يستطيع علم النفس، بصورة متناقضة، التكيف مع نظام خالص للشخص، لأن في إلحاق المحكي كله بالقضية الواحدة للخطاب، أو بفعل التعبير، من شأنه إلحاق الخطر بمضمون الشخص نفسه: إن الشخصية النفسية (ذات الطبيعة المرجعية) لا ترتبط أبداً مع الشخصية اللغوية التي لا تحدد من خلال الاستعدادات، والأهداف، أو السمات، ولكن من خلال مكانتها (الرمزية) في الخطاب، ونحاول اليوم الحديث عن هذه الشخصية الشكلية، يتعلق الأمر بتدمير هام (لدى الجمهور الانطباع بأننا لم نعد نكتب روايات اليوم) لأن هذا التدمير، يهدف إلى نقل الحكاية من الشكل المتعين الخالص (الذي يسيطر حتى الآن) إلى شكل قياسي، يكون فيه معنى الكلام هو الفعل نفسه الذي يلفظه55: إن الكتابة اليوم ليست هي فعل الحكي، أي أننا نحكي، وننقل المرجعية كلها (ما نقوله) إلى فعل التعبير هذا، ولهذا فإن قسماً من الأدب المعاصر لم يعد وصفياً، ولكنه متعد، يحاول أن يكمل في الكلام حاضراً خالصاً إلى حد أن الخطاب كله يتطابق مع الفعل الذي يحرره، حيث يحمل الوجود الكامل كله إلى حكم بالقوة.
4-2-وضع المحكي:
إن المستوى السردي مشغول، إذن، بعلامات السردية، وهي مجموع العوامل التي تعيد دمج الوظائف والأفعال في الاتصال السردي المرتكز على مانحه ومتلقيه. لقد درست بعض العلامات سابقاً: إننا نتعرف، في الآداب الشفوية، على بعض قوانين الإلقاء (مثل الصياغات العروضية، والقواعد الاصطلاحية للتقديم)، ونعرف أيضاً أن ((المؤلف)) ليس هو الذي يبدع أجمل القصص، ولكن الذي يبدع ذلك هو من يتقن بصورة أفضل الرمز الذي يتقاسم استخدامه مع المستمعين: إن المستوى السردي، في هذه الآداب، دقيق، وقواعده ملزمة، إلى حد أنه من الصعوبة تصور حكاية خالية من علامات مقننة للسردية (كان في مرة من المرات، الخ..) تم الكشف مبكراً، في آدابنا المكتوبة عن أشكال الخطاب (والتي هي، في الواقع، علامات سردية): مثل تصنيف طرق تدخل المؤلف، الذي بدأ به أفلاطون، وأعاد أخذه ديوميد57، وتقنين بدايات السرد ونهاياته، وتحديد مختلف أساليب التقديم (الخطابة المباشرة، والخطابة غير المباشرة مع مشاغلها، والخطابة الملتبسة)58، ودراسة وجهات النظر، الخ.. تشكل هذه العناصر كلها جزءاً من المستوى السردي. يجب أن نضيف إلى ذلك الكتابة في كليتها، لأن دورها ليس “نقل” الحكاية، ولكن إظهارها.
في الواقع، ضمن هذا الإظهار للحكاية تندمج وحدات المستويات الأدنى: يتجاوز الشكل الأخير للحكاية، بوصفها حكاية، مضموناتها، وأشكالها السردية الخالصة (الوظائف والأفعال). هذا يفسر أن التقنين السردي هو المستوى الأخير الذي يستطيع تحليلنا الوصول إليه، إلا إذا خرجنا عن موضوع الحكاية، أي إذا تجاوزنا القاعدة الكامنة التي يقوم عليها. في الحقيقة، لا يمكن للسرد أن يأخذ معناه إلا عند العالم الذي يستخدمه: يبدأ العالم مما وراء المستوى السردي، أي هناك أنظمة أخرى (اجتماعية، واقتصادية، وأيديولوجية) لم تعد التعبيرات عنها فقط المحكيات، ولكن عناصر لماهية أخرى (أحداث تاريخية، تحديدات، تصرفات، الخ..) ومثلما أن اللسانيات تتوقف عند الجملة، فإن تحليل المحكي يتوقف عند الخطاب: يجب بعد ذلك، الانتقال إلى سيميائية أخرى. عرفت اللسانيات هذا النوع من الحدود التي التمستها سابقاً، أو سبرتها، تحت عنوان موقف. حدد هاليدي “الموقف” (بالنسبة إلى الجملة) كمجموعة من الأفعال اللغوية غير المشتركة59، وحدده بريتو “كمجموعة من الأفعال التي يعرفها المتلقي في لحظة الفعل الإلقائي أو بصورة منفصلة عنه”60.
يمكن القول، بالطريقة نفسها، إن كل محكي متعلق “بوضع المحكي”، وهو مجموعة من القوانين التي يستخدم من خلالها المحكي. في المجتمعات القديمة، وضع المحكي شديد التقنين؛61 والأدب الطليعي في أيامنا، وحده، هو الذي ما زال يحلم بقوانين للقراءة، مثيرة عند مالارميه الذي أراد أن يقرأ الكتاب أمام الجمهور وفق ترتيب محدد، وطباعية عند بوتور الذي يحاول إرفاق الكتاب بعلاماته الخاصة. ولكن الشائع أن مجتمعنا يتجنب قدر الإمكان تقنين وضع السرد: لم نعد نحصي طرق السرد التي تحاول تطبيع المحكي الذي سيأتي لاحقاً، عبر التظاهر بإعطائه فرصة طبيعية، لسبب وجيه، أو إذا استطعنا القول، عبر التظاهر “بعدم افتتاحه”: مثل الروايات الترسلية، والمخطوطات التي يعثر عليها، والمؤلف الذي التقى السارد، والأفلام التي تفصح عن حكايتها قبل المقدمة. إن الاشمئزاز الذي يعبر عن نفسه، يطبع المجتمع البرجوازي وثقافة الجماهير التي تنبثق منه: ويجب، في المجتمع البرجوازي، وثقافة الجماهير، وجود علامات ليس فيها شكل العلامات. ومع ذلك، لا يمثل هذا إلا ظاهرة بنيوية ثانوية: على الرغم من أن فتح رواية، أو صحيفة، أو محطة تلفزيون، أصبح اليوم عملاً حميمياً، وسهلاً، فإن شيئاً لا يستطيع منع هذا الفعل البسيط من أجل أن يدخل فينا، فجأة، القانون السردي الذي سنحتاج إليه. للمستوى السردي دور غامض فهو ملازم لوضع المحكي، ويفتح على العالم الذي يتحلل فيه المحكي (يستنفد)؛ ولكنه، في الوقت نفسه، يغلق المحكي، ويشكله، بصورة نهائية ككلام عن لغة تحمل لغتها النقدية الخاصة بها، وذلك من خلال الإحاطة بالمستويات السابقة.
5-نظام المحكي:
يمكن أن تتحدد اللغة، بالمعنى الدقيق لها، عبر التنافس بين قضيتين رئيسيتين: هما التمفصل أو التقطيع الذي ينتج وحدات (وهذا هو الشكل من وجهة نظر بينفينست)، والدمج أو التوحيد الذي يستقبل هذه الوحدات ضمن وحدات في مرتبة أعلى (وهذا هو المعنى). هذه القضية المزدوجة توجد في لغة الحكاية، وتعرف هذه اللغة أيضاً بالتمفصل والاندماج، والشكل والمعنى.
5-1-الانحراف والتوسع
يتميز شكل المحكي بصورة أساسية بقوتين: قوة نشر علاماته على امتداد القصة، وقوة إدخال امتدادات غير متوقعة ضمن هذه الانحرافات. تتميز هاتان القوتان بالحرية؛ ولكن خصوصية المحكي هي تحديداً، في ضم هذه “الانحرافات” ضمن لغته62. إن انحراف العلامات موجود في اللغة حيث درسها بالي بخصوص اللغتين الفرنسية والألمانية63، ويحدث توقف من اللحظة التي لم تعد فيها علامات (رسالة) متقاربة، أو من اللحظة التي تضطرب فيها الأفقية المنطقية (عندما يسبق الخبر الفاعل مثلاً). هناك شكل بارز من التوقف نجده عندما تفصل أجزاء علامة واحدة بعلامات أخرى على مدى سلسلة الرسالة (مثل النفي بصيغة ليس قط ne jamais، والفعل سامح في لم يسامحنا قط): ولأن العلامة جزئت، فإن مدلولها قسم إلى دالات عديدة، يتباعد بعضها عن بعض، وإذا أخذ أي منه لوحده فإنه لا يمكن أن يفهم. لقد رأينا ذلك سابقاً، بخصوص المستوى الوظيفي، وهذا هو بدقة ما يحدث في الحكاية: إن وحدات متوالية، وإن كانت تشكل وحدة كلية على مستوى المتوالية نفسها، يمكن فصل بعضها عن بعض، من خلال إدخال وحدات قادمة من متواليات أخرى: لقد قلنا سابقاً إن بنية المستوى الوظيفي بنية متبدلة64. وبحسب مصطلح بالي الذي يقابل بين اللغات التركيبية التي يسيطر فيها الوقف (مثل اللغة الألمانية)، وبين اللغات التحليلية التي تحترم أكثر الأفقية المنطقية، وأحادية المعنى (مثل الفرنسية)، فإن المحكي هو لغة تركيبية بشدة، تقوم بصورة أساسية على قواعد التشابك والتضمين: كل نقطة من الحكاية تشع في اتجاهات عديدة، وفي وقت واحد: عندما يطلب جيمس بوند (ويسكي) وهو ينتظر الطائرة، فإن هذا الويسكي يحمل، بوصفه إشارة، قيمة متعددة المعاني، وهذا شكل من النواة الرمزية التي تجمع مدلولات عديدة (مثل الحداثة، والغنى، والبطالة)، ولكن طلب الويسكي، كوحدة وظيفية، يجب أن يتجاوز، بالتدريج، مراحل عديدة (الاستهلاك، والانتظار، والمغادرة، الخ..) لكي يجد معناه النهائي: تؤخذ الوحدة في الحكاية كلها، ولا تتماسك الحكاية أيضاً إلا من خلال انحراف المحكي وإشعاعه. يعطي الانحراف المعمّم إلى لغة الحكاية سمته الخاصة: فهو ظاهرة منطقية خالصة، لأنه يرتكز على علاقة بعيدة، غالباً، ويمنح نوعاً من الثقة بالذاكرة العقلية، ويضع، دائماً، المعنى مكان النسخ الخالص والبسيط للأحداث المروية؛ ووفق الحياة، من النادر ضمن لقاء ألاّ يأتي فعل الجلوس، مباشرة، بعد الدعوة إلى أخذ مكان؛ وفي المحكي، يمكن لهذه الوحدات المتقاربة من وجهة النظر المحاكاتية، أن تفصل من خلال سلسلة طويلة من الإدخالات التي تنتمي إلى مجالات وظيفية مختلفة، تماماً: وهكذا يتشكل نوع من الزمن المنطقي، الذي قلما يكون له علاقة مع الزمن الحقيقي، ولهذا فإن التحطيم الظاهر للوحدات يبقى دائماً تحت المنطق الذي يوحد نويات المتوالية. من الواضح أن التشويق ليس إلا شكلاً مفضلاً، أو إذا فضلنا، مثيراً، للانحراف: فهو من جهة، يحافظ على متوالية مفتوحة (عبر أفعال تفخيمية للتأخير والانطلاق)، مما يقوي الاتصال مع القارئ (المستمع)، ويقوم بوظيفة تنبيهية ظاهرياً، وهو من الجهة الأخرى، يقدم له تهديد متوالية أخرى غير كاملة، ونموذج مفتوح (كما لو أن كل متوالية تحمل قطبين، وهذا ما نعتقده)، أي تهديد اضطراب منطقي، وهذا الاضطراب هو الذي يستنفد بقلق ومتعة (مع أنه يصلح في النهاية)؛ “التشويق”، إذن، هو لعبة مع البنية، يهدف، إذا أمكن القول، إلى تهديدها وتعظيمها: إنه يشكل “رعباً” حقيقياً لما يدرك بالعقل: وهو يكمل فكرة اللغة نفسها، عبر تقديم النظام (وليس السلسلة) من خلال هشاشته: إن ما يبدو الأكثر إثارة هو الأكثر فكرياً أيضاً: يؤثر التشويق من خلال الروح وليس من خلال “الأمعاء”65.
إن ما يمكن تقسيمه، يمكن أيضاً ملؤه. وتمثل النويات الوظيفية الموسعة، فضاءات إضافية يمكن أن تملأ باستمرار تقريباً، على كل حال، يمكن أن يتدخل هنا تصنيف جديد، لأن حرية المحفز يمكن ضبطها وفق الوظائف (بعض الوظائف هي أفضل عرضاً من وظائف أخرى في المحفز: مثل الانتظار)66، ووفق جوهر الحكاية (تمتلك الكتابة القدرة على التفريق والتحفيز، وهذه القدرة أكبر من قدرة الفيلم: يمكن قص حركة تليت، بصورة أسهل من الحركة نفسها إذا رؤيت67.
تترافق القدرة التحفيزية للحكاية بقدرتها الإضمارية. فمن جهة، تستطيع وظيفة الجملة (يأخذ وجبة مغذية) اقتصاد كل المحفزات الافتراضية التي تنطوي عليها (تفصيل وجبة) 68، ومن جهة أخرى، يمكن اختزال متوالية معينة إلى نوياتها، ويمكن اختزال طبقة من المتواليات إلى تعبيراتها الأعلى، دون إفساد معنى القصة: يمكن تحديد الحكاية حتى إذا اختزلنا تركيبها التعبيري الشامل إلى عوامله الفاعلة، ووظائفه الكبيرة، مثلما تنتج من الاهتمام التدريجي، عن الوحدات الوظيفية69.
بعبارة أخرى، تقدم الحكاية نفسها للتلخيص (وهذا ما كان يسمى قديماً الدليل). وهو، من النظرة الأولى، قابل لذلك في كل خطاب، ولكن لكل خطاب نموذجه من التلخيص؛ فالقصيدة الغنائية، مثلاً، ليست إلا استعارة كبيرة لمدلول واحد70، وتلخيصها يعني امتلاك هذا المدلول، وهذه العملية فعالة إلى حد أنها تبدد هوية القصيدة (تختزل القصائد الغنائية إلى مدلولي الحب والموت): من هنا يأتي الاعتقاد بأنه يمكن تلخيص قصيدة. وبالعكس من ذلك، إن تلخيص الحكاية (إذا تم وفق معايير بنيوية) يحافظ على تفرد الرسالة. وبقول آخر، الحكاية قابلة للترجمة، دون ضرر كبير: إن ما يتعذر ترجمته لا يتحدد إلا في المستوى السردي الأخير: فدوال السردية، مثلاً، لا تستطيع بسهولة الانتقال من الرواية إلى الفيلم، الذي لا يعرف المعالجة الشخصية إلا نادراً جداً71، ولا تستطيع الطبقة الأخيرة من المستوى السردي، وهي الكتابة، الانتقال من لغة إلى لغة أخرى (أو أنها تنتقل بشكل مشوه). تنتج إمكانية ترجمة الحكاية عن البنية ولغتها؛ وبطريق معاكس، سيكون ممكناً، إذن، العثور على هذه البنية عبر تمييز العناصر القابلة وغير القابلة للترجمة في الحكاية، وتصنيفها: يسهّل الوجود الحالي لعلوم العلامات المختلفة والمتنافسة (مثل الأدب، والسينما، والمسرحيات الفكاهية، والبث الإذاعي)، هذه الطريقة من التحليل كثيراً.
5-2-المحاكاة والمعنى:
إن الفعل الثاني الهام، في لغة الحكاية، هو الاندماج: إن ما ينفصل في مستوى معين (مثل المتوالية) يندمج غالباً في مستوى أعلى (متوالية بدرجة تراتبية عالية، والمدلول الكامل لانحراف إشارات، وفعل طبقة من الشخصيات)؛ يمكن مقارنة تعقيد الحكاية بتعقيد* organigramme القادر على دمج الخطوات إلى الوراء بالقفزات إلى الأمام؛ أو بصورة أدق، إن الاندماج، تحت أشكال متعددة، هو الذي يسمح بالتعويض عن تعقيد وحدات مستوى معين: وهو الذي يسمح بتوجيه فهم عناصر متوقفة، ومتقاربة، ومتجانسة مثل العناصر التي يقدمها التركيب التعبيري، الذي لا يعرف إلا بعداً واحداً: هو التتابع، إذا سمينا مع غريماس وحدة الدلالة، بمتشابهة الخواص، (وهي الوحدة التي تطبع، مثلاً، علامة وسياقها) فإننا نقول إن الاندماج هو عامل تشابه: كل مستوى اندماجي يعطي خواصه إلى وحدات المستوى الأدنى، ويمنع المعنى من التذبذب، وهذا ما يحدث إذا لم ندرك الفارق بين المستويات. مع ذلك، لا يقدم الاندماج السردي بطريقة نظامية هادئة، مثل الهندسة المعمارية الجميلة التي تؤدي عبر ممرات متعرجة متشابهة، من عناصر بسيطة لا متناهية إلى بعض الكتل المعقدة؛ يمكن أن تمتلك الوحدة نفسها، غالباً، ارتباطين، الأول مع مستوى (وظيفة المتوالية)، والثاني مع (إشارة أخرى تحيل إلى فاعل)؛ بذلك تقدم الحكاية كتتمة لعناصر مباشرة، وغير مباشرة، متداخلة بقوة؛ الوقوف يوجه قراءة أفقية، ولكن الاندماج يلصق بها قراءة عامودية: هناك نوع من (التعرج) البنيوي، كلعبة مستمرة من القوى الكامنة، تعطي سقوطاته المختلفة للحكاية حيويتها أو طاقتها: تدرك كل وحدة من خلال ازدهارها، وعمقها، وبهذا الشكل تسير الحكاية: عبر التنافس بين هذين الطريقين، تتفرع البنية، وتتكاثر، وتكتشف ذاتها، وتتماسك: لا يتوقف المستوى السردي عن أن يكون نظامياً. من المؤكد أن هناك حرية للمحكي (كما هناك حرية لكل معبّر، أمام لغته)، ولكن هذه الحرية محدودة: هناك فجوة بين القانون القوي للغة، والقانون القوي للمحكي: هي الجملة. إذا حاولنا اختيار محكي مكتوب، فإننا نرى أنه ينطلق من المنطلق الأكثر تقنيناً (المستوى الصوتي)، ويخف بالتدريج إلى الجملة، وهي نقطة نهائية للحرية التركيبية، ثم يبدأ بالتمدد، عبر الانطلاق من مجموعات صغيرة من الجمل (متواليات صغيرة)، الحرة جداً أيضاً، حتى تصل إلى الأفعال الكبيرة التي تشكل قانوناً كبيراً ومحدوداً: إن إبداعية الحكاية (على الأقل تحت ظاهرة الأسطوري في الحياة) تكمن بين قانونين: قانون اللسانيات، والقانون فوق-اللساني. لهذا يمكننا القول بصورة متناقضة، إن الفن (بالمعنى الرومانسي للكلمة) هو عمل ملفوظات بالتفصيل، في حين أن الخيال هو سيطرة على القانون: “يقول بو، سنرى، إجمالاً، أن الإنسان البارع هو دائماً، مليء بالخيال، والإنسان الخيالي حقيقة هو محلل، قبل كل شيء..72” يجب إذن، التقليل من واقعية السرد. يقول لنا المؤلف، إن بوند الذي يتلقى اتصالاً هاتفياً في مكتبه الذي يناوب فيه “يتأمل”: “الاتصالات مع هونغ-كونغ، دائماً سيئة، وليس من السهل الحصول عليها. “وعليه، فإن “تأمل” بوند، والاتصال الهاتفي السيء ليسا هما المعلومة الحقيقية؛ ربما تكون هذه الحادثة “حيّة” ولكن المعلومة الحقيقية التي تتأكد بعد ذلك، هي تحديد موقع الاتصال الهاتفي، وهذا الموقع هو هونغ-كونغ.
وهذا فإن المحاكاة تبقى، في كل حكاية، ممكنة الحدوث؛73 إن وظيفة الحكاية ليست العرض، بل تشكيل متوالية تبقى، بالنسبة إلينا، غامضة، ولكن هذه المتوالية ليست ذات طبيعية محاكاتية؛ لا تكمن “واقعية” متوالية معينة في التتابع “الطبيعي” للأفعال التي تشكلها، ولكن في المنطق الذي يعرض فيها، ثم الذي يتعرض للخطر، ويشبع فيها؛ يمكن القول، بطريقة أخرى، إن أصل متوالية ليس ملاحظة الواقع، ولكن ضرورة تنويع الشكل الأول، وتجاوزه، والذي يقدّم للإنسان، وهو التكرار: المتوالية هي، بصورة أساسية، كل لا يتكرر فيه شيء؛ يحمل المنطق هنا قيمة تحريرية، وكل المحكي معه؛ يمكن أن يضع الناس في الحكاية ما عرفوه، وعايشوه. الحكاية تجعلنا نرى لأنها لا تحاكي؛ إن العاطفة التي تشتعل فينا عند قراءة رواية ليست هي عاطفة “رؤية” (في الواقع نحن لا نرى شيئاً)، ولكنها عاطفة معنى، أي ذات طبيعة أعلى من العلاقة التي تمتلك هي أيضاً انفعالاتها، وآمالها، ومخاطرها، وانتصاراتها: من وجهة نظر مرجعية (واقعية)، لا يحصل في الحكاية شيء بصورة دقيقة74، “إن ما يصل” هو اللغة وحدها، مغامرة اللغة التي يحتفى فيها باستمرار. على الرغم من أننا لا نعرف عن أصل الحكاية أكثر مما نعرفه عن أصل اللغة، يمكن القول، منطقياً، إن المحكي معاصر للمناجاة الداخلية، وهو فيما يبدو، إبداع لاحق للحوار؛ في كل الحالات، ودون إرادة فرض النظرية التطورية النوعية، يمكن أن يكون ذا دلالة أن الطفل الصغير يخترع الجملة، والحكاية، وأوديب، في الزمن نفسه (في الثالثة من العمر).
الحواشي
1-يجب أن نذكر أن هذا ليس هو حال الشعر أو البحث فهذه أمور تخضع للمستوى الثقافي للمستهلكين.
2-هناك “فن” للسارد: هو القدرة على توليد حكايات (رسائل) بالاعتماد على بنية (الرمز) وهذا الفن يتطابق مع مفهوم الكمال عند شومسكي؛ وهذا المفهوم بعيد عن عبقرية، تصوّر، رومانسياً، على أنها سر فردي صعب التفسير.
3-انظر الحرف الحثي أ الذي افترضه سوسور، وكشف عنه في الواقع، بعد خمسين سنة في (مشكلات اللسانيات العامة، بينفنست، غاليمار، 1966، ص 35).
4-لنذكّر بالشروط الحالية للوصف اللساني؛ “.. البنية اللغوية، نسبية دائماً، ليس فقط، بالنسبة إلى معطيات المادة العلمية ولكن أيضاً بالنسبة إلى النظرية النحوية التي تحدد هذه المعطيات “(باخ، مدخل إلى القواعد التحويلية، نيويورك، 1964، ص 29). وهذا أيضاً عند بينفنست (المصدر السابق، ص 1190): “.. لقد عرّفنا أنه على اللغة أن تكون محددة كبنية شكلية، ولكن هذا التحديد يفرض، مسبقاً، الإجراءات والمعايير المناسبة، وفي النهاية، لا يمكن فصل واقعية الموضوع عن المنهج الخاص لتحديده”.
5-ولكن ليس حتمياً، (انظر ك. بريمون؛- منطق الإمكانيات السردية-، اتصالات، ع. 8، 1966.)
6-“تأملات في الجملة”، في اللغة والمجتمع، (ميلانج جانسن، كوبنهاغن، 1961، ص 113.
7-من الطبيعي، مثلما لاحظ جاكبسون، أن هناك بين الجملة وما وراء الجملة مراحل وسيطة: يمكن للترتيب أن يؤثر أبعد من الجملة، مثلاً.
8-انظر خاصة، بينفنست، مصدر سابق، الفصل العاشر، ز. س. هاريس، “تحليلات الخطاب”، لغة، 28، 1952، ص10-30، و ن. روفيه، لغة، موسيقى، شعر، سوي، 1972، ص. 151-175.
9-هذه هي تحديداً إحدى مهمات لسانيات الخطاب، بدلاً من تشكيل تصنيف للخطابات، يمكننا، مؤقتاً، التعرف على ثلاثة نماذج من الخطابات: المجاز المرسل (الحكاية)، والنموذج، الاستعاري (اشسعر الغنائي، والخطاب الحكمي)، والنموذج القياسي الإضماري (الاستدلال العقلي).
10- CF.. infra
11-يجب هنا التذكير بأن هذا الحدس عند مالارميه تشكل في اللحظة التي بدأ فيها عملاً في اللسانيات: “تبدو اللغة له أداة التخييل: لقد اتبع منهج اللغة، وحدده. اللغة وسيلة نتأمل بواسطتها. ويبدو التخييل له، أخيراً، عمل الروح الإنسانية، والتخييل هو الذي يستعمل كل منهج، والإنسان يختزل إلى الإرادة فقط”، (الأعمال الكاملة، بلياد، ص 8510). إننا نذكر أنه بالنسبة إلى مالارميه: “التخييل أو الشعر”، المصدر السابق، ص3350.
12-“الأوصاف اللسانية ليست أبداً أحادية التكافؤ. الوصف ليس دقيقاً أو خاطئاً، إنه أفضل أو أسوأ، أو على الأقل مفيد. “(م. أ. ك. هاليدي، لسانيات عامة ولسانيات تطبيقية، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ج10، 1962، ص120)
13-قدمت مدرسة براغ مستويات الاندماج (ف. ج. فاشيك، قراءة مدرسة براغ في اللسانيات، مطابع جامعة أنديانا، 1964، ص4680)، وأعاد بعض اللغويين أخذها منذ مدة. وفي رأينا، إن بينفنست هو الذي أعطى التحليل الأوضح لهذه المستويات (مصدر سابق، الفصل العاشر).
14-بتعبيرات غامضة إلى حد ما، يمكن النظر إلى مستوى معين بوصفه نظاماً من الرموز والقواعد.. الخ، والتي يجب أن نستخدمها لكي نعرض التعبيرات (باخ، مصدر سابق، ص 570-58).
15-القسم الثالث من البلاغة، هو الإبداع، لا يتعلق باللغة: لأنه يحمل على الأشياء لا على الكلام.
16-أنتروبولوجيا بنيوية، ص 2330.
17-أصناف المحكيات الأدبية، مجلة اتصالات، عـ، 8، 1966.
18-انظر خاصة، ب. توماشفسكي، موضوعاتية، 1925، في نظرية الأدب، سوي، 1965، بعد ذلك بقليل، عرّف بروب الوظيفة بوصفها “فعل شخصية، معرّفاً من وجهة نظر دلالته ضمن مسار الحبكة”، (مورفولوجيا الحكاية، سوي، 1970، ص310). وسنرى أيضاً، تعريف تودوروف (إن معنى عنصر عمل ما، أو وظيفته، يكمنان في قدرة هذا العنصر على الدخول في علاقة مع عناصر أخرى من هذا العمل، ومع العمل كله، مصدر سابق)، والملاحظات التي قدمها غريماس الذي عرّف الوحدة في العمل، من خلال علاقتها النموذجية، وكذلك من خلال مكانتها داخل الوحدة التركيبية التعبيرية التي تشكل جزءاً منها.
19-وفي هذا، هو ليس “الحياة”، التي لا تعرف إلا اتصالات يشوبها الضبابية، ويمكن للضبابية (التي لا يمكن أن نرى وراءها)، أن توجد في الفن، ولكن على شكل عنصر مرمّز (واتو، Watteau، مثلاً)؛ وهذه الضبابية مجه