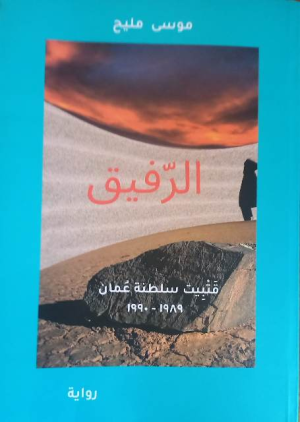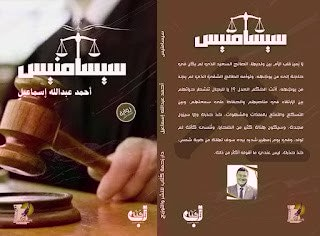( وكنت أخاله دوماً كخفير غير نظامي للقرية، خفير : سلاح قلمه وقلمه سلاحه ، تدب قدماه ـ ليل.. نهار ـ أرض الحارات والباحات والدور والمصاطب والغيطان والأسواق والموالد، فيكتب بعشق نادر ـ يقرب لحد الهوس ـ عن الناس والأرض. إنه " عبد الحكيم قاسم "، الذي بدا لي أحياناً كقروي ساذج ، حسن الظن بالقادرين علي الفعل، فيسطر لهم العرائض والشكاوى ، لكن قريته ، محبوبته ، كانت تنتهك منه بعنف وبلا هوادة ، وتتخلى عن عهد البراءة والصبا الأول ، وفي تلك الفترة التي سرقته منها المدن ، كانت قريته تتعرى وتلطخ وجهها بالأصباغ ، لكنه ظلَّ مخلصاً لها ، قادراً علي فعل الكتابة ، وعندما داهمه المرض اللعين لم يتوقف ، وإن فقدت كلماته فرحة الاكتشاف الأول ولذته المستحيلة ، كان تائهاً ما بين ميادين المدن وشوارعها الوحشية ويتعمد الفرار ، لأنه كان يراها علي البعد قرية مستباحة ..
فوداعاً " عبد الحكيم " ، لقد انتهى رصيدك من أيام الدنيا ، ما بين يناير 1935 م ونوفمبر 1990 م وبدأت أيامك الأولى في الآخرة ، فاحك لنا ـ بحق الله ـ طرفاً من طرف الآخرة .. وهانحن نسمع بآذان مصغية )
كنت قد كتبت هذه الكلمات في رثائه تحت عنوان " العاشق الذي رحل "(1) بعد رحيله المفاجئ صبيحة الثلاثاء 13 نوفمبر 1990 م في محاولة لقهر الحزن ، ذلك الحزن الذي خيم علي نفس كل من قرأ إبداع " قاسم " وعرف قدره .
ولد " عبد الحكيم قاسم " في أول يناير 1935 م في قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ، لكنه كان يعتقد أنه وُلد قبل هذا التاريخ بحوالي عام ، وأنه لم يسجل في دفتر المواليد في حينه علي عادة أهل القرى ، وفي كلية الحقوق التي حصل منها علي الليسانس عام 1946 م كتب أول قصة له بعنوان " العصا الصغيرة " عام 1957 م واشترك بها في مسابقة نادي القصة ولكنها رفضت ، لكن مشروعه الإبداعي الحقيقي بدأ برواية " أيام الإنسان السبعة " مروراً فيما بعد بأعماله الآتية : محاولة للخروج ـ قدر الغرف المقبضة ـ سطور من دفتر الأحوال ـ الأخت لأب ـ المهدي ـ الأشواق والأسى ـ طرف من خبر الآخرة ـ الظنون والرؤى ـ الهجرة إلي غير المألوف ـ ديوان الملحقات . ومسرحيته الوحيدة " ليل وفانوس ورجال " ، بالإضافة لأعماله التي مازالت مخطوطة أو نُشر بعض فصولها مثل رواية " عن كفر سيدي سليم " و " غريبان في الإسكندرية " وكتاب " مقهى وأحاديث " وبعض القصص القصيرة وغيرها ، وشاء القدر برحيله المفاجئ ألاَّ يكتمل هذا المشروع ، فبدت حياته التي امتزجت في قصصه كحكاية سطر بدايتها ولم يقدر لها أن تمضي في طريقها للنهاية .
* * *
يقول " عبد الحكيم قاسم " في إهدائه لقصته " المهدي " :
" ابنتي إيزيس .. ابني أمير .. أرجو أن تعيشا مصراً أحسن من تلك التي عاشها أبوكما وأن تذكراني " .
وإذا تأملنا الحياة القصيرة التي عاشها " قاسم " سنجدها مفعمة بإبداع عظيم له تميزه الخاص ، لقد ظل قارئ " عبد الحكيم " مع كل عمل جديد ينشر له ينتابه شعور بأنه لم يقل كل ما عنده ، وأن جعبة هذا المبدع ما زالت تخبئ الكثير ، تحالف المرض الذي داهمه في أخريات حياته مع ظروف حياتية لم تكن ميسرة في كثير من الأحيان .. تحالفا ضده ، ووقفا حائلاً دون رغبته في البوح بكل ما لديه .
عندما عاد من ألمانيا بعد عشر سنوات قضاها هناك ، سأله الأديب " فؤاد حجازي " عن طموحاته في المستقبل فقال : " أن أبني داراً في بلدنا المندرة .. داراً قدامها مصطبة وجميزة وزير .. وأن يكون في داري شاي وسكر لضيوفي .. وشباك بحري أجلس قبالته وأكتب " (2) ، وأظنه كان صادقاً كل الصدق في رغبته هذه ، رغبة الفلاح القراري في العودة لجذوره وأصوله ، لقد تشتت جهده ما بين أطروحته عن جيل الستينيات ، وما يتطلبه هذا العمل الأكاديمي من جهد وبحث وما بين قدرته علي الإبداع والتفرغ له ، وظل السؤال المحير : لماذا يتفرغ مبدع مثله ، وطوال هذه المدة لدراسة هذا الأمر؟! ، دراسة يمكن أن يتكفل بها آخرون ، وهنا في مصر ، وربما بصورة أفضل .. هل هي " محاولة للخروج " ـ وهانحن نستعير عنوان روايته ـ تلك المحاولة التي فعلها آخرون من قبل ؟ ، هؤلاء الكتَّاب الذين تاقت نفوسهم للهجرة صوب الشمال حيث حضارة الغرب بكل ما تعني ؟ .
كتابات عبد الحكيم قاسم تدور حول محور القرية : قريته " البندرة " التي كتبها بخصوصية شديدة في المذاق والطعم والنكهة إذا جاز لنا هذا التعبير ، ومن خلال إبداع عام لجيل الستينيات المتميز ، الذي تخصص بعض أفراد كتيبته في تناول القرية المصرية ، كتب قريته بتنوع وثراء ، وظل له ـ بينهم ـ صوته الخاص كماركة مسجلة تقترن باسمه ، صوت ملم بدقائق أمور القرية وأطوارها وحيواتها المختلفة ، وربما تأتى له ذلك لكونه يكتب بحب نادر عمن عرفهم من أهله وناسه . وكان عبد الحكيم أيضاً ـ في كل أعماله ـ مولعاً باللغة التي كان ينحت منها جملاً رصينة وجميلة في آن ، كلمات ينتقيها من المعجم تبدو عامية ولكنها فصيحة . ولكنه كان حريصاً في الوقت نفسه ألاَّ يسمح لجماليات اللغة التي عشقها أن تسطو منه علي المضمون فتهمشه أو ترهله أو تنفيه أو تبعده عن موقعه الذي يريده له وهو موقع القص ، ولم يلجأ للغموض أو الرمز ، ولم تغره محاولات التجديد التي من شأنها أن تفصم عُرى التزاوج الشرعي ما بين الشكل والمضمون .
كان المرض قد نال منه كما ذكرنا ، وعندما أفاق قليلاً من وطأته واستطاع العودة لقلمه ، كتب عدَّة قصص متفرقة ، نشر بعضها في مجلة الهلال ، قصص قصيرة ربما لا تزيد الواحدة منها عن صفحة أو صفحتين ، بدا من خلالها وكأنه يحاول باستماتة الإمساك بأشياء تفر منه رغم أنفه ، وكأنما كان يبكي أسى علي أشيائه الحميمة التي تنتزع منه بلا هوادة ، وقد جُمعت هذه القصص فيما بعد في مجموعته " ديوان الملحقات " .
كانت القرية التقليدية القديمة ، قرية الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات تتغير ، لم تعد أليفة كما كانت ، صدمة التغيير التي اصطدم بها كل الكتَّاب ذوي الأصول الريفية ومنهم عبد الحكيم ، حتى أن واحداً منهم هو صديقه " سعيد الكفراوي" قال ذات مرَّة : " إن القرية التي نكتب عنها لم تعد موجودة .. إننا فاشلون " .
* * *
لم يأخذ" عبد الحكيم قاسم " حقه من التكريم في حياته ، وأعتقد أن الأدب لم يجلب له سوى المتاعب ، ولم يوفر له حياة لائقة كان يستحقها هو وأبناء جيله ، يقول ساخراً في لقاء معه : " أنا حتى الآن كل ما حصلت عليه من أجر الكتابة لا يساوي ثمن جوز جزمة ومديون في ألمانيا " ، كان يكتب في أخريات أيامه زاوية أسبوعية بعنوان " قراءات ومشاهدات " في صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل ، وكتب فيما يكتب عن أبناء جيله ، جيل الستينيات ،كتب موضوعات أثارت البعض وألبت عليه مشاعر الآخرين ، لكنني أعتقد أنه لم يكن يرمي إلي ما يقوله صراحة ، بقدر ما كان يلقي بأحجاره في البحيرة الراكدة في البحيرة الراكدة علها تنشر دوامات من الجدل والنقاش، يقول : " أمَّا عن جيل الستينيات فقد كنت متحمساً جداً لهذا الجيل ، وكتبت عنهم بحماس شديد ، لكني بدأت في الفترة الأخيرة أسخط علي هذا الجيل وأريد أن أهاجمهم ، وأنني أرى بعد قراءة مدققة كثيراً من الفشل الرهيب في أعمالهم وأود أن أكشف هذا الفشل للناس "(3) ، وقال في مرَّة أخرى : " أدباء الستينيات خزنوا الأدب في بلاليص الجبن القديم ووضعوه علي سطح قهوة ريش وحولوه لشيء قميء جـدا ً"(4) ، وقال أيضاً : " أتساءل لمن يكتب هؤلاء ؟ ، إنهم يشربون البيرة طوال الليل وينامون طوال النهار ، إنهم منعزلون عن الحياة والمجتمع ، عليهم أن يبتعدوا عن القاهرة وأن يعيشوا في العـزب والكفور ، وأن يتفرجوا علي الناس وأن يعايشوهم "(5) . وعلي جانب آخر ربما أوحتْ له أطروحته التي كان يعدها في ألمانيا ببعض الآراء عن أدباء الستينيات وإنتاجهم وموقفهم من السلطة ، كان قد تقدم بها لمعهد الدراسات الإسلامية في برلين الغربية ، وعن تفسيره لموقف أدباء الستينيات من السلطة يقول : " لا أقصد طبعاً الموقف الفعلي المادي ولكن الموقف حينما يتحول الأدب إلي محتوى للأفكار السياسية التي لا يمكن أن تقال بأسلوب آخر ، ويظهر هذا الموقف من خلال الأدب علي أكثر من مستوى ، مثلاً حينما كانت لغة الثورة في هذا الوقت دعائية ورنَّانة كان أدباء الستينيات يكتبون ويستعملون لغة رصينة بعيدة عن المبالغة ، وفي الوقت التي كانت الثورة تتحدث عن الانتصارات كان الكتَّاب يتناولون الأشياء بشكل واقعي مجرد وبسيط ، أيضاً أدباء الستينيات لم يتحدثوا عن الجوع لأنه لم يكن هناك جوع حقيقي ، الثورة قدمت شخصية المتفائل ، حتى المعارضة لها لك تكن صارخة ومجلجلة ، ولكنها تأخذ صورة الجدل مع شخصية الأب ، شخصية عبد الناصر ، ولذلك نجد شخصية الأب هي المفتاح في أدب الستينيات وعند أدبائها "(6) . ولم يتمكن عبد الحكيم كما ذكرنا من إتمام رسالته ، وعاد إلي مصر بمبرر غير مقنع :
" لقد قطعت شوطاً طويلاً في هذه الرسالة ، وكنت موشكاً علي الانتهاء منها ، لكني فوجئت بابنتي تقول : إمَّا أن أذهب الآن إلي مصر وإمَّا لن أكون مصرية بعد اليوم فقد بدأت أحب ألمانيا "(7) .
* * *
كان قد بدأ يطرق أبواب النشر ، فنشر قصته الأولى " الصندوق" في الآداب البيروتية عام 1964 م ، لكن روايته الأولى " أيام الإنسان السبعة " (8) والتي نُشرت عام 1968 م كانت عملاً مميزاً وفريداً في أدبنا العربي ، قال عنها صلاح عبد الصبور عندما قرأها : " أحسن كتاب قرأته في الخمس سنوات الماضية " ، وقال عنها " عبد المحسن طه بدر " : " إنها رواية تقدم لنا في جملتها رؤية متكاملة للقرية المصرية ، رؤية يلتحم فيها الذات والموضوع " . هذا ويعتقد عبد الحكيم قاسم أن شهرة هذه الرواية ترجع إلي حظها في أنها أولى رواياته التي نُشرت ، وأنه لو نُشرت له أية رواية أخرى مثل " محاولة للخروج " أو " قدر الغرف المقبضة " لكان قد تحقق لها نفس الشيء ، لقد كتبتها بحب شديد لشخوصها من الريف ، وقد عبرت بصدق عن هموم الفلاَّح ، ولقد ظلَّت شهرتها مع هذا تؤرقه ككاتب ، فهو يقول في موضع آخر : " أنا كتبت غيرها وأكتب غيرها وسأكتب غيرها ، فأنا في سباق مع أيام الإنسان السبعة حتى أكتب رواية تهزمها " . تنسج الرواية قصة الزيارة السنوية التي تقوم بها قريته لضريح سيدي أحمد البدوي في طنطا ، وتتناول عالم هذه القرية بكل دقائقه وتفاصيله وأسراره من خلال رؤية عميقة ، ورغم احتفال الرواية بهذه التفاصيل التي تبدو تقريرية تدنو من أرض الواقع ، إلاَّ أنها واقعية ذات نسيج خاص يتطلبه العمل الفني الذي كُتب بطريقة غنائية أقرب إلي الوجد ، يحوم حول الواقع ويعود إليه بقدر ما يتطلب العمل ، يقول عبد الحكيم : " كتبت رواية أيام الإنسان السبعة في السجن .. ثم كتبتها بعد ذلك ثلاث مرَّات حتى خرجت بالشكل الذي نُشرت به في عام 1968م "(9)
* * *
أمَّا روايته " محاولة للخروج " (10) يشير غلافها في محاولة للتعريف بها أنها محاولة للخروج من الوطن تنتهي بمزيد من الدخول فيه . الرواية هي محاولة للتعرف علي الآخر القادم من الغرب : الفتاة السويسرية " إلزبث " التي قدمت لزيارة مصر مع فوج سياحي ، وتنشأ العلاقة ، تلك العلاقة التي عزف علي وترها من قبل آخرون : الطهطاوي وطه حسين وتوفيق الحكيم وإدريس وحقي والطيب صالح وغيرهم ، وفي مواجهة الآخر يعري عبد الحكيم قاسم مظاهر القبح والدمامة والرثاثة والفقر في الوطن ، يتحدث ـ مثلاً ـ عن صف الغرف علي السطح تحت الشمس حيث يقيم بطل القصة ، يتحدث عن البيوت الفقيرة : " كم هي فقيرة وقذرة هذه البيوت ، هؤلاء الناس الذين يحدقون أعين متسعة تقتحم خصوصية الآخرين : سائق التاكسي وصبي المراكبي وموظف البرج ، إنه لا يتوقف كثيراً أمام مشاهد الحضارة المصرية القديمة ، وما تمثله من عظمة تستدعي وجود الآخر وانبهاره ، هو يتناولها بلغة حيادية وصفية كأنما الحاضر لديه منقطع الصلة بالماضي ، وهاهي حيواته وتجاربه وذكرياته وقريته وأسرته والأب والأصدقاء من الدراويش وناس المدينة ، هاهو يستدعيهم في خطوط تتوازى أو تتقاطع وتقفز كل حين أثناء تجواله وصحبته لـ " إلزبث " .
هل الرواية تجدد العزف علي وتر التلاقي بين حضارتين : حضارة آنية وفتية ومسيطرة وقادرة في مواجهة أخرى تسترجع صورها من التاريخ ؟ ، الأمر لا يبدو هكذا برمته ، تسأله " إلزبث " : " لماذا تبقى في هذا البلد ؟ " ، ويجيبها : " إنها بلدي يا إلزبث " .
وتظل النظرة الروائية للآخر في العمل محيرة ، فلا الفقر قرين التعاسة في معظم الأحوال ، هاهو يصحب " إلزبث " إلي قريته ومجتمعه الذي ينشد البساطة الأثرة ، يرى سعادته في تلك الأشياء البسيطة : الترع والمساقي والخضرة وبيوت الطين وأكوام القش وقعدات السهر وشاي العصاري وارتياد المساجد ومجامعة الزوجات ومجاملات الأهل .
تلك الحياة الثرية بالتفاصيل المحببة والمرهقة لنفس الراوي في آن ، لا يعادلها لديه أية صورة من حياة أخرى مترفة بالمدينة بالنسبة لفلاَّح قراري ، ربما هو التطلع والتشوف لآفاق أفضل لبني جلدته .
* * *
" مازالت كلمات أبيه تعاوده بين آن وآن :
هذه الدار ريحها ثقيل .. " .
هكذا يقول " عبد العزيز " في رواية " قدر الغرف المقبضة " (11) في بداية روايته عن الغرف التي تلازمه كالقدر مع نمو وتوالي سنوات عمره ، تقبض علي روحه وتكبل جسده وهو مازال طفلاً في القرية ، ثم وهو ينتقل للمدن الصغيرة أو الكبيرة : ميت غمر وطنطا والإسكندرية والقاهرة وبرلين ، عشرات الأماكن الملآنة بالتفاصيل التي تبرز القبح والتشوه والروائح الكريهة ، تتشوه حياة الناس وتعـذب أبدانهم في سعيها الطبيعي لإشباع حاجاتها الفسيولوجية ، تتشوه النفوس فلا تظل سوية ، وتفرز ذواتهم أسوأ ما فيها من عدوانية وشذوذ وابتزاز وحقـد .
إنها الغرف المقبضة في البيت والمدرسة والجامعة والمسجد والزنزانة ، الغرف التي تمد مخالبها علي ساكنيها وتجعل حلم الفكاك من قدرها أمراً بعيد المنال ، وتظل الغرف الأخرى المريحة والنظيفة علي الجانب الآخر قليلة ، متفردة ، غريبة ، تنظر إليه باستعلاء مزدري ، هكذا يكتب عبد الحليم عنها بلغة بسيطة تناسب المعنى المقصود ، كأنه يرسم الصورة بأقل الكلمات وأكثرها وضوحاً ، لتتحدث الصورة عن نفسها بلا " رتوش " ، وتبدو في كثير من المواضع لغة محايدة وجافة تنصب علي الغرف وقدرها الكابوسي ، لتتوارى كثير من الأحداث التي تثير فضولنا وتساؤلنا : لماذا انخرط عبد العزيز في عمل ثوري قاده إلي الزنزانة ؟، من هم الذين تكتم ولم يفصح عنهم ممن كانوا معه ؟ ، وما هي ماهية العلاقة بينه وبين متغيرات المجتمع المصاحب للمد الثوري لثورة يوليو 1952 م ؟ ، لماذا هذه الديمومة في سكنى الغرف المقبضة ؟ ، هل كتب عبد الحكيم جزءاً من سيرته الذاتية مستخدماً الحيلة الروائية ، فحتم ذلك عليه عدم البوح بما يجب أن يفصح عنه إيثاراً لطبيعته الشرقية ، متجاهلاً ما وصل إليه الغربيون من صدق في سرد ذواتهم وتعرية نفوسهم بلا خجل ، كما تساءل أحد النقاد ؟ .. ربما .
* * *
في رواية " الأخت لأب " نفس العالم الأثير بالنسبة لقاسم : القرية ، لكننا هذه المرَّة مع مع هذا الطفل الوحيد " شوكت " في محاولاته الدءوبة للدخول لعالم أسرته لأبيه حاملاً علي كتفيه وطأة غرابة الاسم وبياض البشرة ونعومة الشعر وعائلة أمه التي ترتدي ملابس أخرى وتتحدث بلغة أخرى في مواجهة مسميات القرية وسحن ناسها الملوحة بالشمس ، وأهلها وهم يفلحون الأرض ولا يملكون من حطام الدنيا إلاَّ عافية البدن ، يبغضون أمه الغريبة عنهم ، تتعثر محاولاته في هزال بدنه ، والأب الغائب في معظم الأحوال . يتوقف حائراً أمام مظاهر النفور البادية من أخوته لأبيه والأعمام وزوجاتهم ، يحاول ويقترب من أخته لأبيه " مبروكة " ، ينتظر عودتها من الحقل ليلعب معها محاولاً الدخول لعالمها ، تدفعه في لعبة " العريس والعروسة " مع " عفت " الجميلة للاندماج في دوره والوصول لنهاية اللعبة ، يحزن ، ويتنامى الحزن في نقاط كثيرة من الرواية بأحداث متتالية علي القلب الطفلي .
أمَّا في " سطور من دفتر الأحوال " نجد أحوال القرية دوما علي مر الأجيال والعصور : فلاَّحين مقهورين ، معذبين ، مغروسين في طين الأرض ، أمَّا السادة فهم دوما السادة ، يأتون في حللهم النظيفة من العواصم والبنادر ، نقرأ ما بين السطور عن بيوت الطين والمساجد والمحاكم ونقاط الشرطة ، نقرأ ما بين السطور أيضاً عن قوة النفوس في مواجهة البطش والقسوة .
* * *
في رواية " المهدي " (12) يغوص عبد الحكيم بقلمه في عالم الجماعات الدينية ، ذلك العالم الشائك ، نحن معه بين مجموعة من شباب الإخوان المسلمين في القرية ، جماعة تدعو لصحيح الدين وتحاول تمثله في حياتها ومعاملاتها و اجتماعاتها وعباداتها ، بالخطابة والوعظ والمؤتمرات ولجان المساعدة وفرق الجوَّالة .. الخ .
لكنها بانكفائها علي ذاتها تتعثر حين تمد يد العون للمعلم " عوض" القبطي صانع الشماسي ، الذي جاء إلي القرية مأزوماً بمشاكله ، ثم تدعوه لهداية الإسلام ، ويستسلم صاحب الحاجة للأيدي التي تنتزعه من جذوره وتفصله عن جماعته التي التصق بها طوال عمره ، تتحطم نفسه ولا يستطيع المضي قدماً معهم ، ويسقط من بين أيديهم فاقداً وعيه ، بينما مظاهر الاحتفال بهدايته في ذروتها ، التهليل والتكبير ومكبرات الصوت الزاعقة التي طغت علي صوت الوطن الذي يحمل فوق أرضه وتحت سمائه كل أبنائه مهما اختلفتْ عقائدهم ، هل كانت تجربة قاسم كمسلم يعيش في مجتمع مسيحي بألمانيا دافعة له لكتابة " المهدي" ؟ ، هل تجنى قاسم علي الأخوان المسلمين في هذه الرواية ، خاصة أن مجتمعنا لا يعاني من مشكلة طائفية ؟ ، لا يوجد اضطهاد ديني أي مستوى حتى في أكثر الأوقات تصاعداً لحدة الإرهاب المستتر بعباءة الدين ، والذي وجَّه رصاصاته لصدور المسلمين والمسيحيين علي حد سواء ، يرد قاسم علي هذه التساؤلات في حديثه لمجلة الرافعي(13) بأنه قريب جداً من الفكر الإسلامي ، ولا يوجد فيرأسه فكرة غير إسلامية ، ويقول أيضاً : " أنا لست شيوعياً تائباً كما يرى البعض ، فأنا لم أكن أبداً ماركسياً أو شيوعياً بالمعنى الحرفي للكلمة ، كل ما هناك أن في الماركسية بعض الأفكار التقدمية من حق الناس أن يأخذوا بها حتى ولو لم يكونوا ماركسيين " ، ويقول أيضاً : " تلك هي حيرة الإنسان المخلص حين يكون في وسط عقائدي يزحمه بعقائديته " .
* * *
" الظنون والرؤى " (14) مجموعته القصصية الأولى التي تضم قصص : القضية ، تحت السقوف الساخنة ، عن البنات ، شجرة الحب ، الموت والحياة ـ حكايات حول حادث صغير ، البيع والشراء .
هي قريته التي مازال يكتب عنها ، يقول " إدوار الخراط " : " الظنون والرؤى هي القرية المصرية ، أفراحها وطقوسها ، أوجاعها وغضباتها ، ترديها ومجدها ، واقعها وحلمها " .
في قصة شجرة الحب ثمة مقاطع أو أقاصيص متصلة ومنفصلة في آن : الأم ـ الولد ـ شجرة الحب ـ عن الرجال ـ معلم الصبيان ـ يوم غير مجيد ـ ثمالات أحاديث .
يرسم قاسم صورة رائعة لبائعة البلح ، وهذا الولد الغريب ، والأولاد الذين رسموا علي جباههم شجرات الحب ، تنادي علي بضاعتها : " يا بن الطويلة يا بلح .. يا هز نخلتنا .. خسارة عليك في التراب يا نايح " . أيضاً عندما يختتم عبد الحكيم قصته وهو يناجي الصباح : " ما أشوق كل المخلوقات للصبح ، للنور تزدهي فيه أوراق النوار وأجنحة الفراش " .
* * *
تضم مجموعة " الأشواق والأسى " (15) ثمان قصص ، يبدأها قاسم بقصة " قريتي " : " اسمها البندرة ، قد تجدون الاسم ثقيلاً ، لكنه ـ لو تعلمون ـ كل متاعي حينما عرفت السفر إلي المدينة " . في قصة " الصندوق " : " صندوق مبروكة الذي يحتوي حاجاتها وأحلى ذكرياتها في أيام زواجها القليلة ، فالغالي قد رحل وتركها في دار أخيها ، يمضي العمر بها كليل الشتاء ، لا تجد سلواها سوى في الصعود وقت القيلولة للسطح حيث الصندوق ، تفتحه وتتلمس الأشياء وتروق نفسها قليلاً ، لكن ، حتى هذه المسرَّة الصغيرة لا يتركها لها أطفال أخيها وأمهم : " العيال وحاجاتهم للكساء " . أمَّا في قصص " ليلة شتوية " و " السفر " و " الخوف القديم " و " غسق" و " الصفارة " و الخوف " نمضي مع أناس قريته ، فمأساة " صديقة " ، في ليلة شتوية ، تلوكها الألسن علي أسطح الأفران الدافئة في ليالي الشتاء ، لقد أخذت بثأر محمد المسفوك دمه أمام عينيها ، هل هي قاتلة حقَّاً ؟ ، تمضي أيامها وحيدة وهي ترعى أغنامها وتستقبل نتاجها الوليد في عز الليل ، تضمه لصدرها المكدود المجدوب " : " تثغـو الشاة الأم ثغاءً فيه فرح " . وفي قصة " السفر " تمضي المرأة ساعية نحو الضريح : " جئتك حافية ورأسي عريانة " ، هي رحلة القرية للمدينة ، تلك المدينة الصاخبة بالمساومات والصياح والشتائم وزفرات المخدوعين ، مدينة قبيحة : " لولاك ما جينا يابو فرَّاج " .
* * *
" طرف من خبر الآخرة " (16) ، إنها الرواية الخامسة والتي تتناول علاقة الإنسان بالآخرة : الموت والقبر والملكان والحساب والنشور ، وتعرج الرواية علي تفاصيل الموت والغسل والتكفين ، عن ناكر ونكير ، قصة الحفيد وقصة الميت خطان يتلاقيان ويتباعدان ، يقول الناقد محمود عبد الوهاب : " رواية لا يعنيها تدهور وانحطاط التركيب العضوي لجسد الإنسان ، ولا يعنيها تقصي الطقوس المواكبة لذلك الموت البيولوجي طوال رحلة خروج الفرد من دنيا الأحياء ، إن ما يعنيها هو الكشف عن حركة دولاب الحياة والموت طوال سني العمر ، وعن مسافة الاقتراب أو الابتعاد عن دائرة التوافق والتناغم والانسجام مع قوانين الوجود " .
* * *
في " الهجرة إلي غير المألوف " (17) كتب قاسم علي غلافها : " ديوان قصص " ، وتضم : " الصوت ـ عطية أبو العينين داود ـ طبلة السحور ـ رجوع الشيخ ـ المهدي ..
إذا ما توقفنا قليلاً أمام قصته الفريدة " طبلة السحور " حيث تتشابه البداية والنهاية : " والرجل يمضي في ليل الحارات كتلة من الظل في شفيف العتامة .. " ، وما بين البداية والنهاية دوَّامات وتيارات من الذكريات والمشاعر ، وأناس عرفهم وأحبهم الراوي ، منهم " الشابوري " صديق الطفولة الذي يعيده للماضي الجميل ، حيث طقوس شهر رمضان القرى ، والقلب الطفلي الذي يتلقى الصدى ، " الشابوري " يحمل طبلة السحور ويدور ، والراوي يهمس متسائلاً كل حين : " ما هي طبلة السحور ؟ ، طبلة السحور ما هي ؟ " ، وهانحن نمضي خلف الشابوري في ليل الحارات ببحث عن لصدى ويقظة الروح .
* * *
وفي قصص " ديوان الملحقات " (18) ندرك أن الملحقات هنا إنما يعني بها قاسم ، أو ربما أراد أن يوحي لنا ، أن هذه القصص التي تضمها المجموعة هي ملحقات لأعماله السابقة ، وهي قصص كتبها تقريباً بعد محنة المرض ، كما أنها في معظمها تميل للقصر . ففي قصة " صاحبة النزل " نجد المرأة التي تسقط تحت وطأة الوحدة بين براثن الطالب الذي يسكن عندها ، كيف خدعها وهرب ؟ : " ثم نطحت الباب برأسها وسقطت والدم ينبجـس من جبينـها " .
* * *
مسرحية " ليل وفانوس ورجال " (19) هي مسرحيته الوحيدة ولا يبتعد عن عالم القرية ، المضيفة عليها أثار عز قديم ، والأب والابن والجد والضيف والصديقان والزوجة والحبيبة شخوص تلتقي في عالمين : عالم الأب والجد والابن في تواصله وامتداده ، متسلحاً بالحكمة والمعرفة والمثل العليا ، وعالم الضيف والصديقان وابن الأخ في التصاقه بالواقع المعاش ، بالأرض والرهن والمزاد ، الأب يبدو فوق أريكته تحت ضوء الفانوس ككائن أسطوري يعلو بمثله وقيمه وحكمته فوق البشر، غير آبه أو هيَّاب حتى بعد أن تجمعت حوله كل نذر الشر ، فالضيف يقرقع بسكينه في مخلاته ، وابن الأخ يحذره من القاتل بعد أن انصرف عنه الصديقان ، الخنجر يتجه للصدر المعزول المتقوقع في علوه ، يمضي الأب في صحبة الجد في صورة كأنها حلم ، بينما يعتلي الابن ذات الأريكة ، وتحت ضوء الفانوس ، في ديمومة مفارقة لدنيا الناس .
* * *
ويرحل عبد الحكيم قاسم كما يرحل كل الناس ، فقد كانت حياته قصته ، وقصته هي حياته ، وعندما توقفت حياته وانقصف عوده ، فإن قصته لم تكتمل ..
يقول شاعر العامية المصري مخاطباً إيَّاه :
تاخد قلمك من صدرك
أنا بكتب أهه ,, ألف باء ألف باء
وأنا الشمس في صدري بتتفتت
ولعت سيجارة وأخدت شهيقي
يضغط ع الشمس يجمعها
ونصبت الكلمة فوق صدري
وتبعتك " .
...
رحم الله عبد الحكيم قاسم بقدر ما أعطى .
ـــــــــــ
هوامش ومراجع
(1) جريدة المساء مقال للكاتب 9/12 / 1990م
(2) الستينات : جيل الحساسية المفرطة ـ مجلة الأقلام العراقية ـ أيلول 1985 م .
(3) حديث لمجلة الرافعي ـ العدد 7 ـ 1988 م لمحمد حمزة العزوني .
(4) نفس المصدر السابق.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) حديث لمجلة أدب ونقد ـ العدد 16 ـ أكتوبر 1985 ـ اعتماد عبد العزيز .
(7) المصدر رقم 3 .
(8) نشرت عام 1986م وأعيد طبعها في سلسلة مختارات فصول فيما بعد ومطبوعات مكتبة الأسرة 1996 م بالهيئة المصرية العامة الكتاب .
(9) المصدر رقم 6 .
(10) سلسلة الرواية العربية ـ هيئة الكتاب 1987م .
(11) مطبوعات القاهرة ـ الطبعة الأولى 1982 م .
(12) نشرت مجموعة " الهجرة إلي غير المألوف " بدار الفكر 1986م .
(13) نفس المصدر 3 .
(14) قصص ـ دار المستقبل العربي ـ طبعة أولى 1986م .
(15) قصص ـ مختارات فصول ـ هيئة الكتاب 1986م .
(16) رواية ـ مختارات فصول ـ هيئة الكتاب 1986 م .
(17) قصص ـ دار الفكر 1986م .
(18) قصص مختارات فصول ـ هيئة الكتاب ـ يناير 1990 م.
(19) مجلة إبداع ـ نوفمبر 1985 م .
(20) قصيدة مشوار الشمس إلي عبد الحكيم قاسم ـ الرافعي ـ العدد 4 ـ نوفمبر 1987 م .
ـــــــــــــــــــ
مجلة إبداع ـ نوفمبر 1999 م .
من كتاب ( عبد الناصر وذو القناع الجلدي ـ مقالات في الأدب ) ـ تحت الطبع .
فوداعاً " عبد الحكيم " ، لقد انتهى رصيدك من أيام الدنيا ، ما بين يناير 1935 م ونوفمبر 1990 م وبدأت أيامك الأولى في الآخرة ، فاحك لنا ـ بحق الله ـ طرفاً من طرف الآخرة .. وهانحن نسمع بآذان مصغية )
كنت قد كتبت هذه الكلمات في رثائه تحت عنوان " العاشق الذي رحل "(1) بعد رحيله المفاجئ صبيحة الثلاثاء 13 نوفمبر 1990 م في محاولة لقهر الحزن ، ذلك الحزن الذي خيم علي نفس كل من قرأ إبداع " قاسم " وعرف قدره .
ولد " عبد الحكيم قاسم " في أول يناير 1935 م في قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ، لكنه كان يعتقد أنه وُلد قبل هذا التاريخ بحوالي عام ، وأنه لم يسجل في دفتر المواليد في حينه علي عادة أهل القرى ، وفي كلية الحقوق التي حصل منها علي الليسانس عام 1946 م كتب أول قصة له بعنوان " العصا الصغيرة " عام 1957 م واشترك بها في مسابقة نادي القصة ولكنها رفضت ، لكن مشروعه الإبداعي الحقيقي بدأ برواية " أيام الإنسان السبعة " مروراً فيما بعد بأعماله الآتية : محاولة للخروج ـ قدر الغرف المقبضة ـ سطور من دفتر الأحوال ـ الأخت لأب ـ المهدي ـ الأشواق والأسى ـ طرف من خبر الآخرة ـ الظنون والرؤى ـ الهجرة إلي غير المألوف ـ ديوان الملحقات . ومسرحيته الوحيدة " ليل وفانوس ورجال " ، بالإضافة لأعماله التي مازالت مخطوطة أو نُشر بعض فصولها مثل رواية " عن كفر سيدي سليم " و " غريبان في الإسكندرية " وكتاب " مقهى وأحاديث " وبعض القصص القصيرة وغيرها ، وشاء القدر برحيله المفاجئ ألاَّ يكتمل هذا المشروع ، فبدت حياته التي امتزجت في قصصه كحكاية سطر بدايتها ولم يقدر لها أن تمضي في طريقها للنهاية .
* * *
يقول " عبد الحكيم قاسم " في إهدائه لقصته " المهدي " :
" ابنتي إيزيس .. ابني أمير .. أرجو أن تعيشا مصراً أحسن من تلك التي عاشها أبوكما وأن تذكراني " .
وإذا تأملنا الحياة القصيرة التي عاشها " قاسم " سنجدها مفعمة بإبداع عظيم له تميزه الخاص ، لقد ظل قارئ " عبد الحكيم " مع كل عمل جديد ينشر له ينتابه شعور بأنه لم يقل كل ما عنده ، وأن جعبة هذا المبدع ما زالت تخبئ الكثير ، تحالف المرض الذي داهمه في أخريات حياته مع ظروف حياتية لم تكن ميسرة في كثير من الأحيان .. تحالفا ضده ، ووقفا حائلاً دون رغبته في البوح بكل ما لديه .
عندما عاد من ألمانيا بعد عشر سنوات قضاها هناك ، سأله الأديب " فؤاد حجازي " عن طموحاته في المستقبل فقال : " أن أبني داراً في بلدنا المندرة .. داراً قدامها مصطبة وجميزة وزير .. وأن يكون في داري شاي وسكر لضيوفي .. وشباك بحري أجلس قبالته وأكتب " (2) ، وأظنه كان صادقاً كل الصدق في رغبته هذه ، رغبة الفلاح القراري في العودة لجذوره وأصوله ، لقد تشتت جهده ما بين أطروحته عن جيل الستينيات ، وما يتطلبه هذا العمل الأكاديمي من جهد وبحث وما بين قدرته علي الإبداع والتفرغ له ، وظل السؤال المحير : لماذا يتفرغ مبدع مثله ، وطوال هذه المدة لدراسة هذا الأمر؟! ، دراسة يمكن أن يتكفل بها آخرون ، وهنا في مصر ، وربما بصورة أفضل .. هل هي " محاولة للخروج " ـ وهانحن نستعير عنوان روايته ـ تلك المحاولة التي فعلها آخرون من قبل ؟ ، هؤلاء الكتَّاب الذين تاقت نفوسهم للهجرة صوب الشمال حيث حضارة الغرب بكل ما تعني ؟ .
كتابات عبد الحكيم قاسم تدور حول محور القرية : قريته " البندرة " التي كتبها بخصوصية شديدة في المذاق والطعم والنكهة إذا جاز لنا هذا التعبير ، ومن خلال إبداع عام لجيل الستينيات المتميز ، الذي تخصص بعض أفراد كتيبته في تناول القرية المصرية ، كتب قريته بتنوع وثراء ، وظل له ـ بينهم ـ صوته الخاص كماركة مسجلة تقترن باسمه ، صوت ملم بدقائق أمور القرية وأطوارها وحيواتها المختلفة ، وربما تأتى له ذلك لكونه يكتب بحب نادر عمن عرفهم من أهله وناسه . وكان عبد الحكيم أيضاً ـ في كل أعماله ـ مولعاً باللغة التي كان ينحت منها جملاً رصينة وجميلة في آن ، كلمات ينتقيها من المعجم تبدو عامية ولكنها فصيحة . ولكنه كان حريصاً في الوقت نفسه ألاَّ يسمح لجماليات اللغة التي عشقها أن تسطو منه علي المضمون فتهمشه أو ترهله أو تنفيه أو تبعده عن موقعه الذي يريده له وهو موقع القص ، ولم يلجأ للغموض أو الرمز ، ولم تغره محاولات التجديد التي من شأنها أن تفصم عُرى التزاوج الشرعي ما بين الشكل والمضمون .
كان المرض قد نال منه كما ذكرنا ، وعندما أفاق قليلاً من وطأته واستطاع العودة لقلمه ، كتب عدَّة قصص متفرقة ، نشر بعضها في مجلة الهلال ، قصص قصيرة ربما لا تزيد الواحدة منها عن صفحة أو صفحتين ، بدا من خلالها وكأنه يحاول باستماتة الإمساك بأشياء تفر منه رغم أنفه ، وكأنما كان يبكي أسى علي أشيائه الحميمة التي تنتزع منه بلا هوادة ، وقد جُمعت هذه القصص فيما بعد في مجموعته " ديوان الملحقات " .
كانت القرية التقليدية القديمة ، قرية الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات تتغير ، لم تعد أليفة كما كانت ، صدمة التغيير التي اصطدم بها كل الكتَّاب ذوي الأصول الريفية ومنهم عبد الحكيم ، حتى أن واحداً منهم هو صديقه " سعيد الكفراوي" قال ذات مرَّة : " إن القرية التي نكتب عنها لم تعد موجودة .. إننا فاشلون " .
* * *
لم يأخذ" عبد الحكيم قاسم " حقه من التكريم في حياته ، وأعتقد أن الأدب لم يجلب له سوى المتاعب ، ولم يوفر له حياة لائقة كان يستحقها هو وأبناء جيله ، يقول ساخراً في لقاء معه : " أنا حتى الآن كل ما حصلت عليه من أجر الكتابة لا يساوي ثمن جوز جزمة ومديون في ألمانيا " ، كان يكتب في أخريات أيامه زاوية أسبوعية بعنوان " قراءات ومشاهدات " في صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل ، وكتب فيما يكتب عن أبناء جيله ، جيل الستينيات ،كتب موضوعات أثارت البعض وألبت عليه مشاعر الآخرين ، لكنني أعتقد أنه لم يكن يرمي إلي ما يقوله صراحة ، بقدر ما كان يلقي بأحجاره في البحيرة الراكدة في البحيرة الراكدة علها تنشر دوامات من الجدل والنقاش، يقول : " أمَّا عن جيل الستينيات فقد كنت متحمساً جداً لهذا الجيل ، وكتبت عنهم بحماس شديد ، لكني بدأت في الفترة الأخيرة أسخط علي هذا الجيل وأريد أن أهاجمهم ، وأنني أرى بعد قراءة مدققة كثيراً من الفشل الرهيب في أعمالهم وأود أن أكشف هذا الفشل للناس "(3) ، وقال في مرَّة أخرى : " أدباء الستينيات خزنوا الأدب في بلاليص الجبن القديم ووضعوه علي سطح قهوة ريش وحولوه لشيء قميء جـدا ً"(4) ، وقال أيضاً : " أتساءل لمن يكتب هؤلاء ؟ ، إنهم يشربون البيرة طوال الليل وينامون طوال النهار ، إنهم منعزلون عن الحياة والمجتمع ، عليهم أن يبتعدوا عن القاهرة وأن يعيشوا في العـزب والكفور ، وأن يتفرجوا علي الناس وأن يعايشوهم "(5) . وعلي جانب آخر ربما أوحتْ له أطروحته التي كان يعدها في ألمانيا ببعض الآراء عن أدباء الستينيات وإنتاجهم وموقفهم من السلطة ، كان قد تقدم بها لمعهد الدراسات الإسلامية في برلين الغربية ، وعن تفسيره لموقف أدباء الستينيات من السلطة يقول : " لا أقصد طبعاً الموقف الفعلي المادي ولكن الموقف حينما يتحول الأدب إلي محتوى للأفكار السياسية التي لا يمكن أن تقال بأسلوب آخر ، ويظهر هذا الموقف من خلال الأدب علي أكثر من مستوى ، مثلاً حينما كانت لغة الثورة في هذا الوقت دعائية ورنَّانة كان أدباء الستينيات يكتبون ويستعملون لغة رصينة بعيدة عن المبالغة ، وفي الوقت التي كانت الثورة تتحدث عن الانتصارات كان الكتَّاب يتناولون الأشياء بشكل واقعي مجرد وبسيط ، أيضاً أدباء الستينيات لم يتحدثوا عن الجوع لأنه لم يكن هناك جوع حقيقي ، الثورة قدمت شخصية المتفائل ، حتى المعارضة لها لك تكن صارخة ومجلجلة ، ولكنها تأخذ صورة الجدل مع شخصية الأب ، شخصية عبد الناصر ، ولذلك نجد شخصية الأب هي المفتاح في أدب الستينيات وعند أدبائها "(6) . ولم يتمكن عبد الحكيم كما ذكرنا من إتمام رسالته ، وعاد إلي مصر بمبرر غير مقنع :
" لقد قطعت شوطاً طويلاً في هذه الرسالة ، وكنت موشكاً علي الانتهاء منها ، لكني فوجئت بابنتي تقول : إمَّا أن أذهب الآن إلي مصر وإمَّا لن أكون مصرية بعد اليوم فقد بدأت أحب ألمانيا "(7) .
* * *
كان قد بدأ يطرق أبواب النشر ، فنشر قصته الأولى " الصندوق" في الآداب البيروتية عام 1964 م ، لكن روايته الأولى " أيام الإنسان السبعة " (8) والتي نُشرت عام 1968 م كانت عملاً مميزاً وفريداً في أدبنا العربي ، قال عنها صلاح عبد الصبور عندما قرأها : " أحسن كتاب قرأته في الخمس سنوات الماضية " ، وقال عنها " عبد المحسن طه بدر " : " إنها رواية تقدم لنا في جملتها رؤية متكاملة للقرية المصرية ، رؤية يلتحم فيها الذات والموضوع " . هذا ويعتقد عبد الحكيم قاسم أن شهرة هذه الرواية ترجع إلي حظها في أنها أولى رواياته التي نُشرت ، وأنه لو نُشرت له أية رواية أخرى مثل " محاولة للخروج " أو " قدر الغرف المقبضة " لكان قد تحقق لها نفس الشيء ، لقد كتبتها بحب شديد لشخوصها من الريف ، وقد عبرت بصدق عن هموم الفلاَّح ، ولقد ظلَّت شهرتها مع هذا تؤرقه ككاتب ، فهو يقول في موضع آخر : " أنا كتبت غيرها وأكتب غيرها وسأكتب غيرها ، فأنا في سباق مع أيام الإنسان السبعة حتى أكتب رواية تهزمها " . تنسج الرواية قصة الزيارة السنوية التي تقوم بها قريته لضريح سيدي أحمد البدوي في طنطا ، وتتناول عالم هذه القرية بكل دقائقه وتفاصيله وأسراره من خلال رؤية عميقة ، ورغم احتفال الرواية بهذه التفاصيل التي تبدو تقريرية تدنو من أرض الواقع ، إلاَّ أنها واقعية ذات نسيج خاص يتطلبه العمل الفني الذي كُتب بطريقة غنائية أقرب إلي الوجد ، يحوم حول الواقع ويعود إليه بقدر ما يتطلب العمل ، يقول عبد الحكيم : " كتبت رواية أيام الإنسان السبعة في السجن .. ثم كتبتها بعد ذلك ثلاث مرَّات حتى خرجت بالشكل الذي نُشرت به في عام 1968م "(9)
* * *
أمَّا روايته " محاولة للخروج " (10) يشير غلافها في محاولة للتعريف بها أنها محاولة للخروج من الوطن تنتهي بمزيد من الدخول فيه . الرواية هي محاولة للتعرف علي الآخر القادم من الغرب : الفتاة السويسرية " إلزبث " التي قدمت لزيارة مصر مع فوج سياحي ، وتنشأ العلاقة ، تلك العلاقة التي عزف علي وترها من قبل آخرون : الطهطاوي وطه حسين وتوفيق الحكيم وإدريس وحقي والطيب صالح وغيرهم ، وفي مواجهة الآخر يعري عبد الحكيم قاسم مظاهر القبح والدمامة والرثاثة والفقر في الوطن ، يتحدث ـ مثلاً ـ عن صف الغرف علي السطح تحت الشمس حيث يقيم بطل القصة ، يتحدث عن البيوت الفقيرة : " كم هي فقيرة وقذرة هذه البيوت ، هؤلاء الناس الذين يحدقون أعين متسعة تقتحم خصوصية الآخرين : سائق التاكسي وصبي المراكبي وموظف البرج ، إنه لا يتوقف كثيراً أمام مشاهد الحضارة المصرية القديمة ، وما تمثله من عظمة تستدعي وجود الآخر وانبهاره ، هو يتناولها بلغة حيادية وصفية كأنما الحاضر لديه منقطع الصلة بالماضي ، وهاهي حيواته وتجاربه وذكرياته وقريته وأسرته والأب والأصدقاء من الدراويش وناس المدينة ، هاهو يستدعيهم في خطوط تتوازى أو تتقاطع وتقفز كل حين أثناء تجواله وصحبته لـ " إلزبث " .
هل الرواية تجدد العزف علي وتر التلاقي بين حضارتين : حضارة آنية وفتية ومسيطرة وقادرة في مواجهة أخرى تسترجع صورها من التاريخ ؟ ، الأمر لا يبدو هكذا برمته ، تسأله " إلزبث " : " لماذا تبقى في هذا البلد ؟ " ، ويجيبها : " إنها بلدي يا إلزبث " .
وتظل النظرة الروائية للآخر في العمل محيرة ، فلا الفقر قرين التعاسة في معظم الأحوال ، هاهو يصحب " إلزبث " إلي قريته ومجتمعه الذي ينشد البساطة الأثرة ، يرى سعادته في تلك الأشياء البسيطة : الترع والمساقي والخضرة وبيوت الطين وأكوام القش وقعدات السهر وشاي العصاري وارتياد المساجد ومجامعة الزوجات ومجاملات الأهل .
تلك الحياة الثرية بالتفاصيل المحببة والمرهقة لنفس الراوي في آن ، لا يعادلها لديه أية صورة من حياة أخرى مترفة بالمدينة بالنسبة لفلاَّح قراري ، ربما هو التطلع والتشوف لآفاق أفضل لبني جلدته .
* * *
" مازالت كلمات أبيه تعاوده بين آن وآن :
هذه الدار ريحها ثقيل .. " .
هكذا يقول " عبد العزيز " في رواية " قدر الغرف المقبضة " (11) في بداية روايته عن الغرف التي تلازمه كالقدر مع نمو وتوالي سنوات عمره ، تقبض علي روحه وتكبل جسده وهو مازال طفلاً في القرية ، ثم وهو ينتقل للمدن الصغيرة أو الكبيرة : ميت غمر وطنطا والإسكندرية والقاهرة وبرلين ، عشرات الأماكن الملآنة بالتفاصيل التي تبرز القبح والتشوه والروائح الكريهة ، تتشوه حياة الناس وتعـذب أبدانهم في سعيها الطبيعي لإشباع حاجاتها الفسيولوجية ، تتشوه النفوس فلا تظل سوية ، وتفرز ذواتهم أسوأ ما فيها من عدوانية وشذوذ وابتزاز وحقـد .
إنها الغرف المقبضة في البيت والمدرسة والجامعة والمسجد والزنزانة ، الغرف التي تمد مخالبها علي ساكنيها وتجعل حلم الفكاك من قدرها أمراً بعيد المنال ، وتظل الغرف الأخرى المريحة والنظيفة علي الجانب الآخر قليلة ، متفردة ، غريبة ، تنظر إليه باستعلاء مزدري ، هكذا يكتب عبد الحليم عنها بلغة بسيطة تناسب المعنى المقصود ، كأنه يرسم الصورة بأقل الكلمات وأكثرها وضوحاً ، لتتحدث الصورة عن نفسها بلا " رتوش " ، وتبدو في كثير من المواضع لغة محايدة وجافة تنصب علي الغرف وقدرها الكابوسي ، لتتوارى كثير من الأحداث التي تثير فضولنا وتساؤلنا : لماذا انخرط عبد العزيز في عمل ثوري قاده إلي الزنزانة ؟، من هم الذين تكتم ولم يفصح عنهم ممن كانوا معه ؟ ، وما هي ماهية العلاقة بينه وبين متغيرات المجتمع المصاحب للمد الثوري لثورة يوليو 1952 م ؟ ، لماذا هذه الديمومة في سكنى الغرف المقبضة ؟ ، هل كتب عبد الحكيم جزءاً من سيرته الذاتية مستخدماً الحيلة الروائية ، فحتم ذلك عليه عدم البوح بما يجب أن يفصح عنه إيثاراً لطبيعته الشرقية ، متجاهلاً ما وصل إليه الغربيون من صدق في سرد ذواتهم وتعرية نفوسهم بلا خجل ، كما تساءل أحد النقاد ؟ .. ربما .
* * *
في رواية " الأخت لأب " نفس العالم الأثير بالنسبة لقاسم : القرية ، لكننا هذه المرَّة مع مع هذا الطفل الوحيد " شوكت " في محاولاته الدءوبة للدخول لعالم أسرته لأبيه حاملاً علي كتفيه وطأة غرابة الاسم وبياض البشرة ونعومة الشعر وعائلة أمه التي ترتدي ملابس أخرى وتتحدث بلغة أخرى في مواجهة مسميات القرية وسحن ناسها الملوحة بالشمس ، وأهلها وهم يفلحون الأرض ولا يملكون من حطام الدنيا إلاَّ عافية البدن ، يبغضون أمه الغريبة عنهم ، تتعثر محاولاته في هزال بدنه ، والأب الغائب في معظم الأحوال . يتوقف حائراً أمام مظاهر النفور البادية من أخوته لأبيه والأعمام وزوجاتهم ، يحاول ويقترب من أخته لأبيه " مبروكة " ، ينتظر عودتها من الحقل ليلعب معها محاولاً الدخول لعالمها ، تدفعه في لعبة " العريس والعروسة " مع " عفت " الجميلة للاندماج في دوره والوصول لنهاية اللعبة ، يحزن ، ويتنامى الحزن في نقاط كثيرة من الرواية بأحداث متتالية علي القلب الطفلي .
أمَّا في " سطور من دفتر الأحوال " نجد أحوال القرية دوما علي مر الأجيال والعصور : فلاَّحين مقهورين ، معذبين ، مغروسين في طين الأرض ، أمَّا السادة فهم دوما السادة ، يأتون في حللهم النظيفة من العواصم والبنادر ، نقرأ ما بين السطور عن بيوت الطين والمساجد والمحاكم ونقاط الشرطة ، نقرأ ما بين السطور أيضاً عن قوة النفوس في مواجهة البطش والقسوة .
* * *
في رواية " المهدي " (12) يغوص عبد الحكيم بقلمه في عالم الجماعات الدينية ، ذلك العالم الشائك ، نحن معه بين مجموعة من شباب الإخوان المسلمين في القرية ، جماعة تدعو لصحيح الدين وتحاول تمثله في حياتها ومعاملاتها و اجتماعاتها وعباداتها ، بالخطابة والوعظ والمؤتمرات ولجان المساعدة وفرق الجوَّالة .. الخ .
لكنها بانكفائها علي ذاتها تتعثر حين تمد يد العون للمعلم " عوض" القبطي صانع الشماسي ، الذي جاء إلي القرية مأزوماً بمشاكله ، ثم تدعوه لهداية الإسلام ، ويستسلم صاحب الحاجة للأيدي التي تنتزعه من جذوره وتفصله عن جماعته التي التصق بها طوال عمره ، تتحطم نفسه ولا يستطيع المضي قدماً معهم ، ويسقط من بين أيديهم فاقداً وعيه ، بينما مظاهر الاحتفال بهدايته في ذروتها ، التهليل والتكبير ومكبرات الصوت الزاعقة التي طغت علي صوت الوطن الذي يحمل فوق أرضه وتحت سمائه كل أبنائه مهما اختلفتْ عقائدهم ، هل كانت تجربة قاسم كمسلم يعيش في مجتمع مسيحي بألمانيا دافعة له لكتابة " المهدي" ؟ ، هل تجنى قاسم علي الأخوان المسلمين في هذه الرواية ، خاصة أن مجتمعنا لا يعاني من مشكلة طائفية ؟ ، لا يوجد اضطهاد ديني أي مستوى حتى في أكثر الأوقات تصاعداً لحدة الإرهاب المستتر بعباءة الدين ، والذي وجَّه رصاصاته لصدور المسلمين والمسيحيين علي حد سواء ، يرد قاسم علي هذه التساؤلات في حديثه لمجلة الرافعي(13) بأنه قريب جداً من الفكر الإسلامي ، ولا يوجد فيرأسه فكرة غير إسلامية ، ويقول أيضاً : " أنا لست شيوعياً تائباً كما يرى البعض ، فأنا لم أكن أبداً ماركسياً أو شيوعياً بالمعنى الحرفي للكلمة ، كل ما هناك أن في الماركسية بعض الأفكار التقدمية من حق الناس أن يأخذوا بها حتى ولو لم يكونوا ماركسيين " ، ويقول أيضاً : " تلك هي حيرة الإنسان المخلص حين يكون في وسط عقائدي يزحمه بعقائديته " .
* * *
" الظنون والرؤى " (14) مجموعته القصصية الأولى التي تضم قصص : القضية ، تحت السقوف الساخنة ، عن البنات ، شجرة الحب ، الموت والحياة ـ حكايات حول حادث صغير ، البيع والشراء .
هي قريته التي مازال يكتب عنها ، يقول " إدوار الخراط " : " الظنون والرؤى هي القرية المصرية ، أفراحها وطقوسها ، أوجاعها وغضباتها ، ترديها ومجدها ، واقعها وحلمها " .
في قصة شجرة الحب ثمة مقاطع أو أقاصيص متصلة ومنفصلة في آن : الأم ـ الولد ـ شجرة الحب ـ عن الرجال ـ معلم الصبيان ـ يوم غير مجيد ـ ثمالات أحاديث .
يرسم قاسم صورة رائعة لبائعة البلح ، وهذا الولد الغريب ، والأولاد الذين رسموا علي جباههم شجرات الحب ، تنادي علي بضاعتها : " يا بن الطويلة يا بلح .. يا هز نخلتنا .. خسارة عليك في التراب يا نايح " . أيضاً عندما يختتم عبد الحكيم قصته وهو يناجي الصباح : " ما أشوق كل المخلوقات للصبح ، للنور تزدهي فيه أوراق النوار وأجنحة الفراش " .
* * *
تضم مجموعة " الأشواق والأسى " (15) ثمان قصص ، يبدأها قاسم بقصة " قريتي " : " اسمها البندرة ، قد تجدون الاسم ثقيلاً ، لكنه ـ لو تعلمون ـ كل متاعي حينما عرفت السفر إلي المدينة " . في قصة " الصندوق " : " صندوق مبروكة الذي يحتوي حاجاتها وأحلى ذكرياتها في أيام زواجها القليلة ، فالغالي قد رحل وتركها في دار أخيها ، يمضي العمر بها كليل الشتاء ، لا تجد سلواها سوى في الصعود وقت القيلولة للسطح حيث الصندوق ، تفتحه وتتلمس الأشياء وتروق نفسها قليلاً ، لكن ، حتى هذه المسرَّة الصغيرة لا يتركها لها أطفال أخيها وأمهم : " العيال وحاجاتهم للكساء " . أمَّا في قصص " ليلة شتوية " و " السفر " و " الخوف القديم " و " غسق" و " الصفارة " و الخوف " نمضي مع أناس قريته ، فمأساة " صديقة " ، في ليلة شتوية ، تلوكها الألسن علي أسطح الأفران الدافئة في ليالي الشتاء ، لقد أخذت بثأر محمد المسفوك دمه أمام عينيها ، هل هي قاتلة حقَّاً ؟ ، تمضي أيامها وحيدة وهي ترعى أغنامها وتستقبل نتاجها الوليد في عز الليل ، تضمه لصدرها المكدود المجدوب " : " تثغـو الشاة الأم ثغاءً فيه فرح " . وفي قصة " السفر " تمضي المرأة ساعية نحو الضريح : " جئتك حافية ورأسي عريانة " ، هي رحلة القرية للمدينة ، تلك المدينة الصاخبة بالمساومات والصياح والشتائم وزفرات المخدوعين ، مدينة قبيحة : " لولاك ما جينا يابو فرَّاج " .
* * *
" طرف من خبر الآخرة " (16) ، إنها الرواية الخامسة والتي تتناول علاقة الإنسان بالآخرة : الموت والقبر والملكان والحساب والنشور ، وتعرج الرواية علي تفاصيل الموت والغسل والتكفين ، عن ناكر ونكير ، قصة الحفيد وقصة الميت خطان يتلاقيان ويتباعدان ، يقول الناقد محمود عبد الوهاب : " رواية لا يعنيها تدهور وانحطاط التركيب العضوي لجسد الإنسان ، ولا يعنيها تقصي الطقوس المواكبة لذلك الموت البيولوجي طوال رحلة خروج الفرد من دنيا الأحياء ، إن ما يعنيها هو الكشف عن حركة دولاب الحياة والموت طوال سني العمر ، وعن مسافة الاقتراب أو الابتعاد عن دائرة التوافق والتناغم والانسجام مع قوانين الوجود " .
* * *
في " الهجرة إلي غير المألوف " (17) كتب قاسم علي غلافها : " ديوان قصص " ، وتضم : " الصوت ـ عطية أبو العينين داود ـ طبلة السحور ـ رجوع الشيخ ـ المهدي ..
إذا ما توقفنا قليلاً أمام قصته الفريدة " طبلة السحور " حيث تتشابه البداية والنهاية : " والرجل يمضي في ليل الحارات كتلة من الظل في شفيف العتامة .. " ، وما بين البداية والنهاية دوَّامات وتيارات من الذكريات والمشاعر ، وأناس عرفهم وأحبهم الراوي ، منهم " الشابوري " صديق الطفولة الذي يعيده للماضي الجميل ، حيث طقوس شهر رمضان القرى ، والقلب الطفلي الذي يتلقى الصدى ، " الشابوري " يحمل طبلة السحور ويدور ، والراوي يهمس متسائلاً كل حين : " ما هي طبلة السحور ؟ ، طبلة السحور ما هي ؟ " ، وهانحن نمضي خلف الشابوري في ليل الحارات ببحث عن لصدى ويقظة الروح .
* * *
وفي قصص " ديوان الملحقات " (18) ندرك أن الملحقات هنا إنما يعني بها قاسم ، أو ربما أراد أن يوحي لنا ، أن هذه القصص التي تضمها المجموعة هي ملحقات لأعماله السابقة ، وهي قصص كتبها تقريباً بعد محنة المرض ، كما أنها في معظمها تميل للقصر . ففي قصة " صاحبة النزل " نجد المرأة التي تسقط تحت وطأة الوحدة بين براثن الطالب الذي يسكن عندها ، كيف خدعها وهرب ؟ : " ثم نطحت الباب برأسها وسقطت والدم ينبجـس من جبينـها " .
* * *
مسرحية " ليل وفانوس ورجال " (19) هي مسرحيته الوحيدة ولا يبتعد عن عالم القرية ، المضيفة عليها أثار عز قديم ، والأب والابن والجد والضيف والصديقان والزوجة والحبيبة شخوص تلتقي في عالمين : عالم الأب والجد والابن في تواصله وامتداده ، متسلحاً بالحكمة والمعرفة والمثل العليا ، وعالم الضيف والصديقان وابن الأخ في التصاقه بالواقع المعاش ، بالأرض والرهن والمزاد ، الأب يبدو فوق أريكته تحت ضوء الفانوس ككائن أسطوري يعلو بمثله وقيمه وحكمته فوق البشر، غير آبه أو هيَّاب حتى بعد أن تجمعت حوله كل نذر الشر ، فالضيف يقرقع بسكينه في مخلاته ، وابن الأخ يحذره من القاتل بعد أن انصرف عنه الصديقان ، الخنجر يتجه للصدر المعزول المتقوقع في علوه ، يمضي الأب في صحبة الجد في صورة كأنها حلم ، بينما يعتلي الابن ذات الأريكة ، وتحت ضوء الفانوس ، في ديمومة مفارقة لدنيا الناس .
* * *
ويرحل عبد الحكيم قاسم كما يرحل كل الناس ، فقد كانت حياته قصته ، وقصته هي حياته ، وعندما توقفت حياته وانقصف عوده ، فإن قصته لم تكتمل ..
يقول شاعر العامية المصري مخاطباً إيَّاه :
تاخد قلمك من صدرك
أنا بكتب أهه ,, ألف باء ألف باء
وأنا الشمس في صدري بتتفتت
ولعت سيجارة وأخدت شهيقي
يضغط ع الشمس يجمعها
ونصبت الكلمة فوق صدري
وتبعتك " .
...
رحم الله عبد الحكيم قاسم بقدر ما أعطى .
ـــــــــــ
هوامش ومراجع
(1) جريدة المساء مقال للكاتب 9/12 / 1990م
(2) الستينات : جيل الحساسية المفرطة ـ مجلة الأقلام العراقية ـ أيلول 1985 م .
(3) حديث لمجلة الرافعي ـ العدد 7 ـ 1988 م لمحمد حمزة العزوني .
(4) نفس المصدر السابق.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) حديث لمجلة أدب ونقد ـ العدد 16 ـ أكتوبر 1985 ـ اعتماد عبد العزيز .
(7) المصدر رقم 3 .
(8) نشرت عام 1986م وأعيد طبعها في سلسلة مختارات فصول فيما بعد ومطبوعات مكتبة الأسرة 1996 م بالهيئة المصرية العامة الكتاب .
(9) المصدر رقم 6 .
(10) سلسلة الرواية العربية ـ هيئة الكتاب 1987م .
(11) مطبوعات القاهرة ـ الطبعة الأولى 1982 م .
(12) نشرت مجموعة " الهجرة إلي غير المألوف " بدار الفكر 1986م .
(13) نفس المصدر 3 .
(14) قصص ـ دار المستقبل العربي ـ طبعة أولى 1986م .
(15) قصص ـ مختارات فصول ـ هيئة الكتاب 1986م .
(16) رواية ـ مختارات فصول ـ هيئة الكتاب 1986 م .
(17) قصص ـ دار الفكر 1986م .
(18) قصص مختارات فصول ـ هيئة الكتاب ـ يناير 1990 م.
(19) مجلة إبداع ـ نوفمبر 1985 م .
(20) قصيدة مشوار الشمس إلي عبد الحكيم قاسم ـ الرافعي ـ العدد 4 ـ نوفمبر 1987 م .
ـــــــــــــــــــ
مجلة إبداع ـ نوفمبر 1999 م .
من كتاب ( عبد الناصر وذو القناع الجلدي ـ مقالات في الأدب ) ـ تحت الطبع .