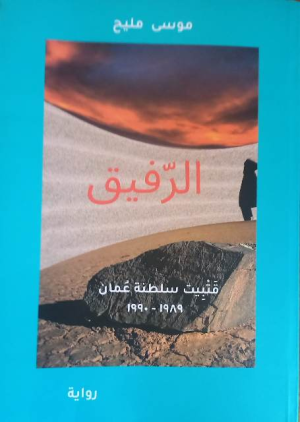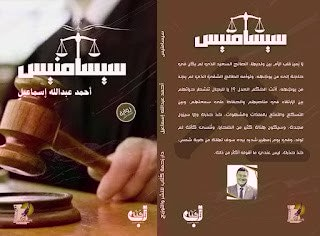اتجهتُ، بموسوعتي "الشعر النسويّ العربي" أن أُفْعِلَ سمات التفضيلَ الصوتي المختلف ببُعْدِهِ التنويريّ، من مبدأ متن اللغة الفنيّة المُركّبة الدالة على الاشتقاق اللفظيّ، من منطلق أهمّيّة اتّجاهاته وميله الإنسانيّ التطويريّ، إلى صحيح ملكة اللسان النحويّ، الذي وجدت فيه حداثة إشراق أدبيّ، يُشبع نهم القارئ الموضوعيّ، ويُوسّع من قدرات جيل الشباب ويَشدّهم إليه، وذلك في تنشيط الفكر والمعرفة والمشاعر، تلك التي يدركها من حَسُنتْ نيّته بلذّات المعرفة وجوابها المتقن، لا مَن يُحاور الخطأ بالخطأ ويدّعي الكمال. وهذا التناول ليس لأنهنّ شاعراتٌ وحسب، بل ما أثمرت مَلكاتهنّ الخصبة بالانفجاريّة الحسّيّة، القيّمة على التجديد الذي أبان الاختلاف في نصوصهنّ، وما ظهرت فيها من ملامحَ تُكثّف في ملمسها النشاط الفكريّ الحيويّ، فيكون النصّ ذا شأن، وقد تعدّدت ثقافاتهنّ وتنوّعت، فأصبحت الشاعرة منهنّ صورة شاملة للحركة الأدبيّة، حيث ساهمت كلّ واحدة منهنّ بنشاط فاعل، ومُؤثّر في تفعيل وتنوير المعالم الفكريّة التي اهتمّت بالطبيعة الإبداعيّة.
كذلك يمكننا أن نقول إنّ الشاعرات تنوّع تحصيلهنّ في أدب المقاومة، الذي ارتبط ارتباطًا عاطفيًّا بالثورة الفلسطينيّة، على اعتبارها تُمثّل الحقّ العربيّ في استرداد أرضه من المغتصب الصهيونيّ، كما عملت الكثيرات منهنّ بالإعلام والصفحات الثقافيّة الدوريّة، ومع ذلك، فإنّ ما تمّ تحصيله في هذا الميزان لا يُعّدُّ إحصاءً، بل ما تمثلت الشاعرة بقامتها التي ميّزها الاختلاف التنويريّ والثقافيّ والمعرفيّ بالغزارة والوفرة، على العكس من شاعراتِ الطرف اللا إبداعيّ، اللاتي وصلت نصوصهنّ للقارئ باردة لا حياة فيها.
صحيحٌ أنّ هناك شاعراتٌ موهوبات، لكنّ نصوصهنّ فاقدة للحيويّة والنشاط والرفعة.
تعتبر الشاعرة اللبنانيّة جمانة حداد، إحدى الشاعرات العربيّات المعاصرات، اللاتي أنجزن حداثويّة شعريّة فاعلة في تأثيرهنّ على الحركة الأدبيّة العربيّة، لذا؛ وبهذا التناول أجدني قد دخلت إلى بُنيةٍ شعريّة أتنقّل مع النصّ حيث يأخذني نبراسه. والشاعرة حدّاد جارية، تمارس لعبة الشعر من حيث رهصة دواخله، فتختار ما تنتجه نبضات نواصيه من فيض ميتافيزيقيا التداول ومُحسّناته المُتحرّكة، فقد وجدتها تُعاشر مَصبّات قصيدة النثر على هواها، وهي تتأمّل المصاحبة والمحاسنة في أحكام فنيّة كانت وما زالت سائدة، وقد اتّضح أنّ نصّ جمانة يحاور المعاصرة بإمعان، حيث عملت وبجدّيّة على تخطّي سير الاتجاه النثريّ المتعارف عليه عند الكثير من الشاعرات.
أمّا ما اختصّ بالمجرى العاطفيّ، فقد تواصلت الشاعرة جمانة حدّاد بإمتاع، يقيم لنصّها التفاعلَ مع شاعرات الإيروتيك، اللاتي تجاوزنَ المألوفَ التقليديّ لمجتمع عربيّ يدّعي العقلانيّة، كالحرص على العادات والتقاليد، مع أنّ هذه المجتمعات منقوعة في الخطايا حتى رأسها.
ومن هؤلاء الشواعر:
من الموروث: "ولادة بنت المستكفي، سلمى بنت القراطيس، برة العدوية*" والشاعرة رابعة العدوية، والشاعرة الايرانية فروغ فرخزاد.
ومن المعاصرات: غادة السمّان، مليكة مزان، عاتكة الخزرجي، لميعة عباس عمارة.
لكن؛ ولأنّ جمانة شاعرة ذكيّة، جعلت ظاهرتها الإبداعيّة تتمتّع بصيانة ذاتيّة، حريصة كلّ الحرص على أسلوبها الأدبيّ النوعيّ، خاصّة وأنّها تنتمي إلى أهمّ وأرقى مجتمع حضاريّ عربيّ، تبوّأ الحرّيّات منذ زمن مُبكّر من بداية القرن الماضي، حيث تنوّعت إبداعات الشاعرة بهاجس التنويع الأدبيّ، المرتبط بالثقافة الأوروربيّة المعاصرة، وخاصّة الثقافة الفرنسيّة، تلك الثقافة التي بشّرت بالتنوير الفكريّ والنفسيّ والاجتماعيّ، والذي أثّر تأثيرًا كمّيًّا في صناعة الذات اللبنانيّة، فتطبّع السلوك الفرنسيّ التبشيريّ في ذهنيّة الفرد البيروتيّ، طباقًا نوعيًّا. فقد أحلّت المدنيّة الفرنسيّة قفزاتٍ تطوريّة متغيّرة في الشخصيّة اللبنانيّة المُتحوّلة، التي بلغت نموًّا ثقافيًّا مُطّردًا، في حالات تعدّد طِباقها من جهة الإثبات، الذي تمظهرت فيه آليّة التجانس الأرستقراطيّ، فتشبّه الكثيرُ من أدباء لبنان بهذه التداوليّة المتغيّرة، التي أضافت للمراتب الأدبيّة والفكريّة طموحَها النوعيّ في مضامين النصّ المُركّب، ومن هؤلاء، الشاعرة جمانة حدّاد، فقد وجدتها تقدّم نصوصها على أنّها تشريق جديد يوسّع من المفاهيم الوجدانيّة. على إيقاع احساسها الموحى من سقاء طباقها الخفيّ، الدالّ على استنباط المبنى من الذات العارفة، المرتبطة بالعلوم البلاغيّة التي بُنيت على أساسها طبيعةُ العبور إلى مبانيها. ولأنّ الحركة الذهنيّة تتّخذ من تقسيماتها المصدريّة جوابًا، وإن اختلفت دلالة الاستيعاب للحضارة بين شعبَيْن، إلاّ أنّ بعض الشعراء استمدّوا يقظتهم الإبداعيّة من طبيعة الاختلاف، فأسّسوا لكلّ مبدع فيهم اتّجاهه الذي اختصّ فردًا بعينه.
تتكوّن خاصّيّة الإلهام المُولّدة للمشاعر الحسّيّة عند الشاعر النوعيّ، من كونه خالق غير مُنَظّر أو مؤلّف، حيث تعتمر بصيرة التجلّي واضحة بواسطة إدراك الحواسّ، الذي يُعتبَرُ المموّلَ الماديّ للحالة الإبداعيّة، غير الخاضعة للمُلقّن الذي يكمن خلف الستار، لأنّ المزج بما هو فطريّ وما هو مُلقنّ يتعارض مع فكرة الإشعاع الإبداعيّ. لهذا؛ نجد الشاعرة جمانة حدّاد على معرفةٍ واسعة في موضوعة الذات المبدعة وإجاباتها الحسّيّة، سواء ما جاء في علمها الفنتازي، أو في الإضافة التجديديّة في متغيّرات الأسلوب، ومن بيان هذه المعرفة قرأنا جمانة حدّاد من زوايا عديدة، اتّحدت على أنّ الشاعرة تُمثّل وعيًا متقدّمًا على ما تحتفي به بعض الشاعرات العربيّات، فهي بقدرتها اللغويّة والفنّيّة أغنت ذاتها، العارفة بتلقائيّة توالُدِ الصور الحسّيّة، التي تتماهى فيها الصور الحياتيّة، فجاءت قصائدها تُعبّر عن الأفكار التي تبني علاقة الحدس الإدراكيّ، من واعز الصورة المرتبطة بالذهن، وبلاغة البصيرة المتخيّلة، التي تنشأ في صميم الجوابات العقليّة.
يقول كانط: "إنّ الإدراكات الحسّيّة بغير الإدراكات العقليّة عمياء، وإنّ قوانين الفكر هي قوانين الأشياء*". في اعتقادي أن جمانه حدّاد نمَتْ نموًّا طرديًّا في أحضان الفلسفة الكانطيّة، فأمتعت قصيدتها بمزاوجة التنويع الملحميّ، وهو تفعيل معرفيّ، ربط بين الكانطيّة بوعيها الفلسفيّ، وبين المتصوّفة، والعلاقة الروحيّة المُترَفة بالميولات، والتوحّد المعنويّ مع الإلهام الواعز للمتخيّل الفنّيّ.
عن هذا عَبّر الحلاّج قائلاً: "إنّ الذات الإلهيّة تحلّ في الإنسان*"
فجاءت النتيجة أنّها مزجت الإحساسات المادّيّة عند كانط، بأفكار الحلاّج المثاليّة، إلى رؤية روحيّة تتساوى بالتباهي لعشق الفعل الإباحيّ المؤثّر بالصفات البشريّة، لا سيّما أنّ الشاعرة اشتغلت على محاكاة الحسّ الأنثويّ الذي يُثيرها منذ وعيها الأوّل، فأشبعت تجلّيات المقاصد برهصة العاطفة الفكريّة وتخضّبت في ألوانها.
ولأنّ جمانة عاشت قريبة من الحركة الشعريّة العربيّة التواتريّة، التي اجتمعت في بيروت عام 1980، نجد قصيدتها تومض بالمشاعر المُركّبة، حيث تفيض بوعي ثقافيّ شموليّ، وإبداع مُخصّب بتلك الثقافات، وهذه المزاوجة أدّت إلى هجين تفاعليّ مع ثقافتها الذاتيّة المُعبّرة عن أهدافها، وعن مقاصدها ولغتها الحريصة، التي تُكسبُ المزاوجة الفنّيّة التنامي والتلاقح والتنويع، هذا لكون الشعر عندها منسابًا من حيث مدركاتها الحسّيّة، التي تقوم على الاتصال الذكيّ بالثقافات الأخرى، من واعز نشاطها وغناها الفكريّ، ومن مَصبّاتها التي تعتني بها كـ: الإضافة، والإمالة، والتعجّب، والاستفهام.
مع أنّي لا أرى عيبًا في أن تُلاقح الشاعرة أدواتها بأدوات أكثر وعيًا وتطوّرًا أنموذجيًّا، لتحديث وتحصين وتلقين ألفاظها بوعي أكثر حيوية في نشاطه ورونقه، حتى يُسجّل انتشارًا أعَمَّ بين القرّاء، خاصّة وأنّ للشاعرة علاقات طيّبة ببعض القامات المتمرّدة على النظم المتخلّفة، وقد أبانت لمساتها تفيض بتلازم الصوت الهارمونيّ في الفعل الداخليّ، فكان للإيقاع نغميّته ورنّات أدواته، وشغفه في اختراق السماع إلى نشوة أبهى في شكلها ومنطقها، ومن أجل هذا الوعي النوعيّ، برز اسمها واضحًا وفاعلاً على الساحة العربيّة. وبهذا نقول إنّ العلم لا يتمثّل بالخيال، بينما الشعر كونه حُبّبَ بالبصيرة الباطنة، بعد أن كسا البصيرة الظاهرة فطنتها، التي استمدّت قيمتها من متعة المخيال، لأنّ في إدراكه وعيًا مختلفًا، ولكن هذا يختلف في طبيعة خاصّيّة المدرك وما يلائمه.
في هذا يقول الغزالي: "إنّ جَمال المعاني المدركة بالعقل، أعظمُ من جَمال الصورة الظاهرة للأبصار."*
ولا أدري لِمَ الغزالي ساوى بين العقل والبصر، لأنّ العقل هو الحاكم بأمر الجسم، فهو المُلقّن وهو المكتشف وهو الحياة وهو المُميت، إذن لا يمكن للخيال أن يخلق صورة إلاّ بالحسّ التفاعليّ مع البصيرة، التي يُفسّر العقل لها الأشياء، فلو قال الغزالي "والبصيرة وليس البصر"، لكان المعنى أكثر بلاغة ودقة. أمّا الشعر فيمكنه أن يبقى في حدود الخيال الإبداعيّ، خارج تفاعل البصيرة معه كقول السياب:
"عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر"*
لأنّ السيّاب بهذه الصورة تخيّل ولم يرَ، ومثل هذا الكثير عنده وعند غيره، إذن فالبصيرة الباطنة "الخيال الإدراكيّ" أتمُّ وأبلغُ من البصيرة الظاهرة على الأشياء، كونَ الباطنة ونُسمّيها الذهنيّة، هي تشكيلٌ إبداعيٌّ روحانيّ، أمّا الظاهرة فهي مشاهدة تنتج الحسّ الروائيّ، والقصصيّ، والبحثيّ، والعلميّ، والحركيّ، ومع هذا الاختلاف، إلاّ أنّهما يشتركان في ميْلهما لدوام الوجود، لأنّ العقل هو الذي يُحدّد المقاسات لوجودها وزوالها، فيقول هيغل: "إنّ كلّ ما هو عقليّ فهو واقعيّ، وكلّ ما هو واقعيّ فهو عقليّ."*
على ضوء ما تقدّم واستفاض من شرحنا حول قدرتنا على قراءة الكلام من أوّله، في سلطة "المفصل والطباق" كما عبّرَ عن هذا التبريزيّ، الذي أفضّله في قراءتي، بما أرغب أن تتمثّله الجماليّة التعبيريّة، تلك التي ينضج فيها محاسن الوعي الإبداعيّ. يقول ألبرت أينشتاين: "سيظلّ الخيال فوق المعرفة، لأنّ الخيال يحتضن الكون بأسره، ولا يختصّ بجزء منه*". إذن؛ من حيث هذه الإفاضة الجارية في مجال التفكير المنهجيّ، ندخل في حوار القصيدة مع الشاعرة جمانة، التي خلعت ثياب طقوس التقاليد الوعرة، ولبست ما لا يضيق عليها من رداء الرمزيّة بأشكالها المتعدّدة، ولا تتساقط من بين خياراتها الإبداعيّة أدواتها، ولا تؤلّف في الإبصار، ولا تلحن، بل على العكس من هذا كلّه، فحدّاد ذكيّة الملمح والبصيرة، وهي المُعبّرة عن التغيّرات الجديدة في تداعيات فهم جوهر الظواهر غير العلنيّة، المُدركة للعلوم الفنيّة التي تحكم مفهوم المعاني وتنقّلات مركّباتها من صورة إلى أخرى، عبر مصبّات أدوات متحرّكة التحصيل، وهي أيضًا ناقدة ذات لغة نقديّة مفهومة ومُحكمة.
سوف نختار من شعرها ما يمكننا أن نعالجه من صفاته الظاهرة والباطنة، من مسار صحّة بنية قصيدتها، أو من واقع ضعفها، لكي نتبيّن معيار القصيدة من احساسات مدركات طباقها. المبصر والمفتوح على إشراق جديد من نوعه، شعر يتفاعل بوعي مع العلوم اللغويّة والفنّيّة، تحضر فيها الأسطورة مُباحة مِن فيها، فإذا كانت القصيدة تُنتَج بهذا الوعي، نقول إنها بنية جمعت الحياة فيما يليق بالغايات التي تكتنز استقامة ترتيبها وحُسن نظامها، ولكي نتبيّن ما يليق بالرأي الحاصل في شرحنا أو عدمه، ندخل إلى لغة القصيدة، من حيث تناسل انزياح الخامة النوعيّة في رياض الشاعرة المختلف هذا النص:
مبتدأ أوّل
أنا ليليت المرأة القدر، لا يتملّص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملّص.
أنا المرأة القمران ليليت، لا يكتمل أسودهما إلا بأبيضهما، لأنّ طهارتي شرارة المجون، وتمنّعي أول الاحتمال.
أنا المرأة الجنّة التي سقطت من الجَنّة، وأنا السقوط الجنّة.
أنا العذراء ليليت، وجه الداعرة اللامرئيّ، الأمّ العشيقة والمرأة الرجل، الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال.
أنا المرأة المائدة وأنا المدعوّون إليها، لُقبّتُ بجنّيّة الليل المُجنّحة، وسمّائي أهل سومر وكنعان وشعوب الرافدين إلهة الاغراء والرغبة، وسمّوْني إلهة اللذّة المجانيّة وشفيعة الاستمناء، حرّروني من شرط الانجاب لأكون القدر الخالد.
أنا ليليت النهدان الأبيضان، لا يُقاوَم سحري لأنّ شَعري أسود طويل، وعينيّ عسليّتان، جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي من تراب خُلقتُ، وجُعِلتُ زوجة آدم الأولى فلم أخضع.
أنا الأولى التي لم تكتفِ لأنّها الوصال الكامل، الفعل والتلقّي، المرأة التمرّدُ لا المرأة ال نعم، سئمتُآدم الرجل، وسئمتُ آدم الجنّة، سئمتُ ورفضتُ وخرجتُ على الطاعةِ، عندما أرسل الله ملائكته لاستعادتي كنتُ ألهو، على شاطئ البحر الأحمر كنتُ ألهو، شاؤوني فلم أشأ، روّضوني لأتروّض فلم أتروّض، أنزلوني إلى المنفى لأكون وجع التشرّد، جعلوني الرهينة للقفر من الأرض، والفريسة للموحش من الظلال، وطريدة الكاسر من الحيوان جعلوني، عندما عثروا عليَّ كنتُ ألهو، لم أستجب فشرّدوني وطردوني لأنّي خرجتُ على المكتوب، وعندما طردوني بقي آدمُ زوجي وحيدًا، وحيدًا ومُتوحّشًا وشاكيًا ذهبت إلى ربّه، فخلق له ربّه امرأةً من ضلعه تُدعى حوّاء وسمّاها النموذج الثاني، لتطرد الموت عن قلبه خلقها، وتَضْمن استمرار الخلق.
أنا ليليت المرأة الأولى، شريكة آدم في الخلق لا ضلع الخضوع، من التراب خلقني إلهي لأكون الأصل، ومن ضلع آدم خلق حوّاء لتكون الظل، عندما سئمت زوجي خرجتُ لأرث حياتي، حرّضتُ رسولتي الأفعى على إغواء آدم بتفاح المعرفة، وعندما انتصرت أعدت فتنة الخطيئة إلى الخيال ولذّة المعصية إلى النصاب.
أنا المرأة المرأة، الإلهةُ الأمّ والإلهة الزوجة، تخصّبتُ لأمون الابنة وغواية كلّ زمان، تزوّجت الحقيقة والأسطورة لأكون الاثنين، أنا دليلة وسالومي ونفرتيتي بين النساء، وأنا ملكة سبأ وهيلانة طروادة ومريم المجدليّة.
أنا ليليت الزوجةُ المختارة والزوجةُ المطلقة، الليلُ وطائرُ الليل، المرأة الحقيقة والأسطورة، المرأة عشتار وأرتميس والرياح السومريّة، ترويني اللغات الأولى وتفسّرني الكتب، وعندما يَردُ ذِكري بين النساء تمطرني الأدعيةُ باللعنات.
أنا العتمة الأنثى لا الأنثى الضوء، لن يحصيني تفسيرٌ ولن أرضخ لمعنى، وصَمَتني الميتولوجيا بالشرور ورشقتني النساء بالرجولة، لكنّي لستُ المسترجلة ولا المرأة اللعبة، بل اكتمال الأنوثة الناقصة، لا أشنّ حربًا على الرجال ولا أسرق الأجنّة من أرحام النساء، فأنا الشيطانة المطلوبة، صولجان المعرفة وخاتم الحبّ والحرّيّة.
أنا الجنسان ليليت، أنا الجنس المنشود، آخذ لا أعطي، أعيد آدم إلى حقيقته، وإلى حواء ثديها الشرس ليستتبّ منطق الخلق.
أنا ليليت المخلوقة الندّ والزوجة الندّ
ما ينقص الرجل كي لا يندم
وما/ ينقص/ المرأة/ كي/ تكون
***
إذا حاورنا التراكم في الكيف النوعيّ في هُويّة النصّ الشعريّ عند جمانة حدّاد، سنجد أنفسنا أمام رؤية مُحيّرة في الكشف عن طبيعة العناصر المُكوّنة للبنية الجدليّة في دواخل النصّ، وعلى ضوء ما تقدّم، تطلّبَ منّا لمس مقياس الحوار المتحوّل من دلالة إلى دلالة مغايرة في ذات المعيار، تُلاقح التداوليّة الزمنيّة بصفاتها العرفانيّة، حين يتماهي النصّ مع سُلطة التفكير الميتافيزيقيّ، المُساق بذات الأدوات التي تحاور الأشياء، وتكشف عن ارتباط الشاعرة بالواعز المادّيّ، بالنظر إلى أنّ النصّ الذي نحاوره عَبّرَ عن هُويّته من الزوايا التي تتقاطع في طبيعتها المجسّات التأريخيّة، التي لعبت دورًا حسّيًّا في تكوين مقام عَبّرَ عن جوابات تؤدّي إلى المشاكلة بين السياقيْن المجازيّ والواقعيّ، لأنّ الاستعارة إذا صاحبها مساقُ المجاز، تفقد حيويّتها وماهيّتها الحقيقيّة، كونها لا تقوم على الإفاضة من المقصود، وقول الشاعرة في هذا:
- أنا ليليت المرأة القدر، ليليت: المستعار، والطباق المفترض الذي أصبح قدرًا على الشاعرة، هو الإحالة التي رتبتها لكي تستفيق ليليت في جمانة في قولها:
- لا يتملّص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملّص، "التملّص" بحالتيْه: هو مجاز، والمطلق في المعنى تأكّد في: أنّ العجز الذي يؤكّد على المجاز بيانه هو: "ولا يريد ذكر أن يتملّص." على اعتبار اللاّ واقعيّ. كان بإمكان الشاعرة تلافي هذا التصادم بين العلوم الفنّيّة، لو أخضعت النصّ إلى فنّيّة استقلاليّة التقطيع، فيكون على النحو التالي:
- أنا ليليت المرأة القدر/ لا يتملّص ذكرٌ مِن قدَري/ ولا يريد ذكَرٌ أن يتملّص
في السطر الأوّل كانت الاستعارة مستقلّة في دلالتها، وفي السطر الثاني والثالث اختصّا بالمجاز المستقلّ في دلالته، وبهذا تكون الشاعرة قد حقّقت للمكتسب الفنّيّ صنعة، فأصبح المعنى متلازمًا بفعل التساقي الحاصل في ميزات الرتب التقنيّة، وفي الوقت ذاته خلّصت مستهلّها الشعريّ من مجرّد كلام قابل للعرض والتباهي. وإذا قلنا إنّ الخلايا التي تتناغم تشظيّاتها الداخليّة بالمدهش الانفجاريّ، الحاصل في أنّ الذات أخذت تفاعلها التدريجيّ المتزامن من متغيّرين يتمّ قياسهما على المستوى النسبيّ، أحدهما مستعار لتخصيب الواقعيّ، والآخر مجازيّ كونه اللعبة الأدبيّة، فصارت المسافة تتماهى بواقع تخصّبت زواياه بتلاقحها المعنويّ. وهكذا يجنح الفكر إلى رؤيته الكاشفة عن دعم تخليص الذات من الأفكار الجاهزة، التي تكون في حالات عديدة تُعبّر عن اللاّوجود، بينما نجد الزمن المادّيّ هو المُحرّك الدلاليّ للفعل الناتج للتقنيّة المحصّنة بأدوات ذات لمع خاصّ، كقولها في التساقي الأوّل: "لا يتملّص" لفظة تجمع جماليّتها من سهل المحكيّ والفصيح، وهو قطع تناسليّ بين الخياليّ والواقعيّ في طبيعة مباني اللفظة، ولكون المجاز في هذه المحاصلة هو الفعل النشط، فالخيال هو الممتع للتصوّر.
نقرأ الشاعرة وهي تزخّ في لغتها الشعريّة التسهيم التقنيّ بين زمنيْن مختلفيْن، من واعز دلالات النصّ، الذي جعلت منه الشاعرة يدلّ أوّله على آخره، ألا وهو عنصر الزمن، وذلك باستدراج دراما الأسطورة وتحديثها باللغة المعاصرة، للنظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها، لتحقيق انسجام الأصوات في تفاعلات النصّ المتأمّل، وكأنّها تقود القارئ إلى تأويل استقرائيّ تحكمه هي، أي أنّ دلالات الحلول تذهب مع الرؤية، لخلق تأويلٍ يستثمر جماليّات المادّة من جانبها الوجدانيّ العاطفيّ، في قولها: أنا المرأة الجنّة التي سقطت من الجنّة.
من الوهلة الأولى نقرأ الوجوديّة الحاصلة في المبتغى التوصيليّ في مفهوم العبارة، كونها تطلب التشبيه في أنا الجنّة، أمّا البقاء أو الخروج من الجنّة فتَمثّل في السقوط، بإيعازٍ من الله بفعل الشهوة التي أسقطت الطاعة. أمّا الإضافة: "وأنا السقوط الجنّة"، فهي زائدة وخاليّة لا تستوفي التمثيل بشيء، على اعتبار أنّ المعنى تحقّق بدءًا.
يقول العلم إنّ الإنسان خُلق من خليّة الماء المهين، كما عُرف عن الأجنّة في القرآن، وإلاّ لا حياة بدونها. والإنسان في خلقه يتأثّر بالمكان حيث وُلد، أمّا الشاذّ في هذه القاعدة فهو الهجين، حيث يتأثّر الشكل والذكاء بما يقتضيه جمالُ الأبويْن والمكانيْن. لكن ومع هذا، ما أن نتعمّق في زوايا ومربّعات النصّ، ذات المجسّات الحسّيّة في جنوحه المتمّم، نجد أنّ السعة في التكرار تُضعف القيمة، فالكثير من الشعراء استعانوا بالأسطورة لتكون المُطيّب الاستعاريّ لمخيال التجسيد المشاعريّ، وجمانة استخدمت التعبير الوسطيّ بين عِلمها بالشيء، وبين تزويق الحكاية بغير الحقيقيّ في قولها: أنا العذراء ليليت، وجه الداعرة اللامرئيّ. ترى؛ هل هي المرأة التي لا تقبل اللقاح فتكون عاقرًا، أم أنّ استدعاء ليليت من الزمن باختلاف المكان، حرّك تقدير المقصود المحاصر أن يكشف عن أنوثتها بواسطة الرمز العامل في مفهوم التوجيه، الجسد المُستوحى إطلاق المشتهى في فضاءات تعدّدت غاياته؟ وحدّاد تفكّ عصيان الرجولة وتدخل مناخاته بإدراك واعٍ في: "لا يتملّص ذكَرٌ من قدري، ولا يريد ذكر أن يتملّص". لو أنّ الشاعرة لم تكرّر "ذكَر" في الجملة الشعريّة الثانية المُلحقة بمساقات الأولى، لكان البديع أكثر إيلافًا، حيث تكون صفات البنية موقعة شفافيّتها بيد التداوليّة بين اللغة والعلوم الفنّيّة، وهذا ما حقّق الفصاحة البنائيّة في تناسل التراكيب الصياغيّة فيما يساق بنية التعابير، بين العبور باللغة إلى الضفّة الأخرى في المعنى الباطن، وبين ما أبانَ في الشكل، لأنّ الشاعرة وظّفت الضمير المتكلّم أن يخرج عن صمته المادّيّ، أي أنّ هناك عناصر موجبة تحقّق الإقناع، والترويج لحرّيّتها المطلقة، وتقديرها "الأنا" في مشكاة التشبيه، بحالتيْن: التجانس والمزاوجة في المعنى الحاصل بين "القدر" وَ "التملّص". والقصد هو أنّ الرؤية التراكميّة عبّرت عن التكثيف والاختصار، في الخصوصيّة المُنتجة للدلالة، التي تتماهى فيها الصورة الحسّيّة في اتّجاهها، من مشاعر تنزع عن ذاتها السرد المباشر، وبهذا نستدلّ من قولنا على أنّ الشاعرة تبحث في بنية الدلالة الصوفيّة في حكمها الجلاليّ القاطع، لذلك فالرجل ما أن تقع عيناه على ليليت الشاعرة حتى ينصهر فيها، أي أنّه يقع في مفاتنها الغاوية موقع الأسير، والرجال أمامها لا تعني أسماءَها بل أفعالها، من حيث نجاعة الشخصيّة وجواباتها، ولكن ذلك لا يطرد، قد تسعى إليه هي إذا أحكمتها وسامته الذكوريّة وأساليبه الذكيّة، فيكون جسده الدفء، وهي الراجفة. وليليت المرأة الأولى، هكذا تقول الشاعرة، وهي الأفعى التي فعلت بآدم معصيته، وكانت هي التفاحة اللامعة المغرية قدسيّتها، وهي روح المرأة بجسد الشيطان، لأنّ الله عاجز على الإيقاع بالشيطان وبها، لأنّهما روحان في جسد واحد، مع أنّ الله خلق الشيطان من النار، وليليت من الطين، "وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين". والشاعرة تقول: حرضتُ رسولتي الأفعى على إغواء آدم بتفاح المعرفة.
هذا لأنّها تمرّدت على العرش وطغت، فرأت الشاعرة أن تجيء بالاعتبار الذي يستعير المعنى، وليس الشخصيّة "ليليت" بحدّ ذاتها، إذ المعنى يجوز، لأنّ تطابق الصفات المتمرّدة في الأحوال الخاصّة تتشابه محسوساتها، إذن؛ المعنى الذي تتشابهان به كلٌّ منهما، أن تُشبع عينيها قبل شهوتها، وفي الوقت ذاته فهي تتمتّع بطاعة الذكور لها بالجوابات الجنسيّة المتكرّرة بصخبها ومجونها وشقاوتها، لأنّها المرأة المجرّدة من جميع القوانين التي ألزمها الله بها، والشاعرة وظّفت ليليت وحاورتها وتقمّصتها وتفاعلت وتلاقحت ببصيرتها وصورتها، فصارت ليليت بالتمنّي، وقولها في هذا المعنى: أنا المرأة القمران ليليت، لا يكتمل أسودهما إلاّ بأبيضهما، لأنّ طهارتي شرارة المجون، وتمنّعي أوّل الاحتمال.
الرؤيا الانقساميّة بين الشاعرة وليليت هو امتداد الزمن، واستدعاء الظاهرة، وتلقين الآخر بتخطّي كلّ الاحتمالات، التي صيغت من شاعرات قبلها وخاصّة الشاعرة الإيرانية "فروغ فرخزاد"، التي تماهت معها جمانة الشاعرة بتناصّ تأثّريّ، في محاكاة لغة التمرّد على المألوف المجتمعيّ، ولكن جمانة توسّعت وتخطّت أحكام الترتيب الفنّيّ المُركّب، فأدخلت المناخ التاريخيّ والفلسفيّ الديالكتيكيّ، والتقاطع المفهوميّ في الجوابات المحصّنة بالفصاحة، وأشاعت في النصّ مصاحبة الانفجاريّة التحويليّة في المباني اللفظيّة وتعابيرها القاطعة، خاصّة إذا قرأنا التشبيه بجهة المعاني المقصودة: "أنا القمران لا يكتمل أسودهما إلا بأبيضهما".
أمام ليليت الشاعرة الأنثى كم يصعب الانتظار؟ بقبولها أو رفضها، ترى، مَن يزور سريرها؟ مَن هو ذاك الذكر؟ وكيف إذا كان تمنّعها أوّل الاحتمال؟
ومن هذا التوليف نتوقّف أمام:
أنا الذهنيّة.
أنا الذات.
أمّا الذهنيّة فهي مجرّدة من الأنانيّة، يحكمها التواضع والتسامح والهدوء والنسبيّة، بينما نجد الذات مُحكمة بالنرجسيّة والمغالاة والادّعاء والخوصيّة المطلقة، وبهذا اختارت الشاعرة شخصيّة ليليت، لأنّها ذاتيّة تستوعب قيمة الذات الإلهيّة في وجودها، فهي تغيب وتظهر في شمال الأرض ومن جنوبها، وفي الوقت ذاته هي الجنّة عذراؤها وشرورها وفسقها واستهتارها. ترى، هل هذا التمثّل يضيف الرغبة والعشق الناجع؟ وإذا كان هكذا، أين يقع الاشتقاق في التكوين الملحميّ الذي تبنّته الشاعرة؟ أهو الوصف أم الاقتباس، أم الحاسّة الإبداعيّة التي استمدّت فاعليّتها من مساق المُدرَكات المتشابهة بشخصيّة ليليت؟ هذا لا يعني أنّ ضياءَها من ضياء ليليت، ولا قدسيّة نفسها من قدسيّة ليليت، وبهذا يصبح التأثّر بالأسطورة ليليت لا معنى له، لأنّ ذات الشاعرة تُعبّر عن الظاهر لا عن الروح التي تظنّها مقدّسة، وهذا الفعل لا يخرج عن كون تداعي الحواسّ، ما هي إلاّ سوى تمنّي لا غير، أي أنّ الذات العرفانيّة لا تتقاطع بالاعتراف أمام العرش، الذي اجتمع الرأي على تسميته بالمقدّس، ومع هذا كلّه، لا ينفي الاعتراف بأنّ الشاعرة ملتقى المعارف، على اعتبار أنّ المبدع يبني كلامه على ما يعلم، ويتأمّل بالتدبير والاستدلال وليس العكس. أفليست هي التي جلست على مقعد شوقي أبو شقرا في الصفحة الثقافيّة في جريدة النهار؟ أمّا والأنوية التي تستكين في شخصيّة الشاعر/ الشاعرة فهو شرّ لا بدّ منه.
الكثير من الشعراء لقحوا قصائدهم بدلالات السفر المجازيّ، متأثّرين بالأسطورة ومواضع عيوبها وفوائدها، يرحلون إلى حيث عتق الزمن، إلى أمكنة لم يصلها العلم بعد، كالسومريّة والبابليّة والفرعونيّة والإغريقيّة، فتكون النصوص أحداثًا لا تفسير لها، مشبعة بالوهم والتقليد، وهكذا فالكثير من الشعراء حَمّلوا قصائدهم على أحد وجهَي الإضافة، فإمّا مُبهَمة، وإمّا تفسيرًا لا مراد فيه، وهذا يجعلنا نتوه في غايات النصّ، فتضيع المحاسنة ونضيع معها. وقد حاول السيّاب أن يطرق باب الفرديّة التشخيصيّة في الأسطورة بتناصّ معيّن، ويتماهى بأصواتها ونوازعها، مُتّبعًا طريقة التقليبات المثيرة مع اختلاف الترتيب، ووزّعها بأسلوب الأصوات التي اشتغل عليها الفراهيدي، كالإبدال والتدغيم، والفرض والتقدير، ونجح السيّاب في هذا. لكن، هل كلّ مَن تناول الأسطورة أصبح سيّابًا؟ سؤال مُحيّر إذا شخّصناه بنبأ المصدريّة ذات الملامح المُركّبة. أمّا إذا شخّصنا الخلل والإبهام والضعف عند شاعرة ما، فتقوم الدنيا على الدارس ولا تقعد، والقصد، أن لا يُفهم من ذلك نفي الشاعرة، فليس هو المُراد، إنّما مُرادنا تبيان جواب المعرفة ما بين المفهوميْن: "التقليد" أم الإبداع؟
ولكن الأمر مع جمانة شاعرة الإغراء والأنوثة المُحيّرة مختلف، من حيث وجوه الإمكان، فرغم نجاحها الانطباعيّ، إلاّ أنّها تتحوّل بفعل ثقافتها، فتكون البديل الآخر في فضاءات مختلفة، وهذا يعود إلى طبيعتها التداوليّة الفنّيّة، ولأنّنا في حوار مع الأسطورة والشاعرة، وما بينهما من دلالات، نحاول أن نكتشف أبعادها وميولها ومغازيها، حيث جاء النصّ الطويل أشبه بسِفر التكوين محفوظًا في دواخل الحكايات، مِزاجيًّا قابلاً للتحوير والمحاسنة، وبعضه غامض في تحوّلاته وانطباعاته، وكأنّي وجدت الشاعرة وقد وقعت فيها ليليت موقع النفس، خاصّة في ملازمة تكرار السياقات الدالّة على خصال المعاني وتفسيراتها، حيث يغدو القريب بعيدًا، والبعيد قريبًا، فلا مكان ولا زمان، أي أنّ "القرب والبعد واحد"، كما عبّر عن هذا الحلاّج، ومِن هذا المبدأ نقف على طبيعة التكرار، الذي يُجسّد الصيغة في اختبار ذات البنية لتوليف المجسّات التشكيليّة في الإيقاعات التي تحكم توافقات النصّ.
مثال:
" جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي مِن تراب خُلقتُ/ مِن التراب خلقني إلهي لأكون الأصل/ خلق الله المرأة مِن التراب في اليوم السابع".
تجسيد ثاني: " أنا ليليت العائدة من سجن النسيان الأبيض، لبؤة السيّد وإلهة الليْليْن / وأعود لأكون لبؤة الضائعين في الأرض / أنا ليليت اللبؤة المغوية / أنا اللبؤة المغوية أعود أعود لأهتك الأسرى وأهلك الأرض" .
تجسيد ثالث: " أنا ليليت إلهة الليْليْن العائدة من منفاها / لبؤة السيّد وإلهة الليليْن / إلهة الليْليْن وملتقى الأضداد / قدر العارفين إلهة الليْليْن".
لاحظ أن البحث عن الجَمال في الذات المبصرة، في حواريّة الصورة الباطنة المهتمّة بتداعيات الأسطورة، قد سوّقت مقصود حاصل التطبيق مشبّهًا مطلقًا، فألغت ذاتها من حقيقتها، وفي الوقت ذاته اِخْتَلَّ نسيج الصفات المستوحاة من بصيرة الحكاية التاريخيّة، التي جعلت منها الشاعرة مصدر الأفعال الدالّة على الإيحاء والإرشاد، من حيث ما أرادته أن يكون هو المراد المقنّع الذي تتصوّره هي حقيقيّة، أي الشكل المعنون بتطابق الإثارة على الأنوثة، من سياق تنظيم وعي إدراك تشابهات في تلاقح المعاني، وبتقديري هذا هو ناتج تكرار الصور الحسّيّة في مفهوم التداعي، الذي يُخصّب الرغبة الجنسيّة في لمعة سقاء الحواسّ، فيكون الجناس لصق بيولوجيّ غُيّب عن الوجود الفنتازيّ الذي تتمتّع به، وما تتّصفه الشاعرة: أي إنّها تعداد تصابي الإثارة الجامحة لما تبتغية الرغبة الأنثويّة، فالشرفة التي طلّت منها الشاعرة على الأسطورة، حقّقت موصوفاتها المتعالية على بنات جنسها، لتكون هي الأكثر معرفة بتداعيات الذكر، وفي الوقت ذاته فالذكر مهما تعالى لا يمكنه "التملّص" منها، فهي التي تمتلك قوّة الاحاطة برغباته عبر لعبتها الأنثويّة، وبهذا تكون قد شبّهت وجسّمت وصوّرت أن لا صورة إلاّ صورتها المرئيّة الملموسة بالحواسّ بين بنات ربيعها، فهي الطيف الذي يتجاوز إدراك الرجل حين يزوره شيطانها ليلاً، لأنّه مكشوف عليها في ظهور التمثيل والحلول، حيث غاياتها هي لا غاياته هو، وبهذا يكون الذكر قد غلبه الوجد وأحاط به الجوى، ولنا في الشعر مرجع في قول الشاعر أبى الحسن النوريّ:
"لا زلتُ أنزلُ من ودادكِ منزلاً/ تتحيّر الألباب عند نزوله".
إذا تأمّلنا أوج التواصل بما يحيط بأطراف الشبه بين مضمون الحكاية، وبين صورة الحدوس الحسّيّة وغاياتها، ترى، هل نحصل على التداخل البينيّ بين المعنى الحقيقيّ وبين المعنى المجازيّ؟ تأكيدًا لا. لماذا؟ أقول: لأنّنا نقرأ ما تكرّر في الكتب السماويّة جميعها في قولها:
جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي خُلقتُ من تراب.
وهذا لا يهزّ ولا يفاجئ القارئ، لأنّه معلوم للجميع، وأيضًا فهو يُضعف وعي مراتب تقنيّتها الدقيقة والحريصة على ميزان إبداعها، وكأنّه تشكيل تقليديّ خالٍ من الصدمة والاثارة، وقد لخّصتُها فيما تقدّم، بأكاديميّةٍ سهلة التعريف على شكل التجسيد في بنية الوحدة العضويّة، حيث كان باستطاعة الشاعرة العمل على تكثيف تقنيّة الصورة، خاصّة وأنّها اعتمدت التداخل الأسطوريّ، عن شخصيّةٍ مشكوك في وجودها المادّيّ، لأنّ لوليت لم تذكرها الكتب السماويّة، ولا الكتب القريبة من الأنبياء، ولا حتى الفلاسفة الأقربون إلى الأنبياء، كما أقرّته الشاعرة، حتى ممّن تناولها من قبلها مثل: فيكتور هيجو، بلند الحيدري، بودلير، أناتول فرانس، إميل حبيبي، طاغور، والبريكان، فالتكرار سواء كان في الشعر أو القصّة أو الرواية، يكون مذمومًا، لأنّه يُخِلّ من بلاغة النصّ.
ومع كلّ هذا التداخل الهارمونيّ بين التعليل التخييليّ وبين الواقعيّ، الذي يشير إلى إحاطة المعاني بتواصلها التشكيليّ، من خلال الترميزات والتشبيهات في خصوصيّة الأداء الذي يدعم قوّة فصاحة الصورة، نجد الشاعرة قد أماعت توازن بعض وحدات التراكيب الفنّيّة، فهي حذفت المضاف "هي"، وأضافت المضاف إليه، "ليليت"، فجاءت تلك التراكيب المحتدمة وكأنّها رسالة بحثيّة، تتطلّب معالجة الحكاية على أساس جمع خيوط الأحداث، باتّجاه أن تُحاك بمهارة، على مستوى تهذيب البنية الداخليّة للنصّ في تنوّع هذه النقاط:
أولاً: تقيم وحدة المساق التنظيميّ في بنية النصّ فاعليّتها التنظيميّة، على اعتبار أنّ الروى الصوتيّة أسهمت سلفًا، بتنظيم إقامة المعاني على أحوالها.
ثانيًا: من الأصحّ أن لا تخضع التقنيّة للمباشَرَة والتقرير العفويّ، الذي يُضعف من حيويّة الرمز، بل يجب مقايسة الشيء على الشيء بخاصّيّته.
ثالثًا: يجب مراقبة تصوير الشّبه بين المختلفيْن في الزمن والفكر على أساس الجنس، وانتقاله إلى التركيز على انسجام الأصوات والأفكار، التي تتبنّى ملاقحة الموصوف على ما وُصف عليه، لا أن تكون كما الذي يَقبض على الماء بكفّه. ومع هذا فقد حقّقت الشاعرة للتناص شهوته المبصرة بأدقّ التفاصيل، وحوّلت الصفات عند ليليت إلى مطلق جماليّ وفقهيّ، يتناسب مع ما قيل فيها، تتشبّه بالمرأة الناريّة المحوريّة ليليت، الذي ذكر اسمُها في الأساطير القديمة السومريّة منها والبابليّة، وهي تمثل التوحيد والخروج عن طاعة الربّ في قولها:
- أنا المرأة المرأة، الإلهةُ الأمّ والإلهة الزوجة، تخصّبتُ لأمون الابنة وغواية كلّ زمان، تزوّجت الحقيقة والأسطورة لأكون الاثنيْن، أنا دليلة وسالومي ونفرتيتي بين النساء، وأنا ملكة سبأ وهيلانة طروادة ومريم المجدليّة.
يبدو أنّ الشاعرة غفلت عن رابعة العدويّة، وسجاح بنت الحارث، وبرة العدويّة، وزليخة*"، ومع هذا، فالإله كما تقول الكتب هو الله، ولم أقرأ في هذه الكتب "الإلهة الأمّ والزوجة"، حتى إذا جاء الوصف في مجال التشبيه، فهو لا يتّفق لا في المجاز ولا في المستعار، مع أنّها أخذت على التناصّ، وكأنّها تتصوّر التشبيه بالحقيقة، ويحيى بن حمزة اليمني يقول: "حتى يُتَوَهّم أنّه ذو صورة تشاهد". وللتوضح أكثر نقرأ صوت الجلالة في كتاب القرآن، يقول: "قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد". سورة الإخلاص. وهذا في التوحيد والجلالة.
ويقول في مكان آخر يعني المعرفة في سورة القلم: "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)". سورة القلم.
ويقول ويعني اللاّمثيل له وهو في كلّ نفس في سورة الشورى: "ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير." سورة الشورى.
والشاعرة تقول: "الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال."
وتقول في الخلق والتوحيد: "أنا الجنسان ليليت، أنا الجنس المنشود، آخذ لا أعطي، أعيد آدم إلى حقيقته، وإلى حواء ثديها الشرس ليستتبّ منطق الخلق."
وتقول في المعرفة: "أنا الأولى التي لم تكتفِ لأنّها "الوصال الكامل، الفعل والتلقّي."
وتقول في الخلود: "أنا العتمة الأنثى لا الأنثى الضوء، لن يُحصيني تفسير ولن أرضخ لمعنى."
وكما هو معروف، ما ورد في الآيات أعلاه من تفضيل الذات الإلهيّة على الذات البشريّة، فالأولى مُطلقة بتميّزها في النظير والعُقبى والمصير والخلود والمطر والمكان والزمان والخير والشرّ والجهات والمائدة، أمّا المائدة: كان ذاك زمن الخلاف الذي دار بين عيسى المسيح ومخالفيه على المائدة، فقيلت تلك السورة، تُعبّر عن المتّفق مع الأمر الإلهيّ، وسمّيت بسورة المائدة. يقول فيها عن البيان والتنوير: "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ." سورة المائدة.
ويقول في سورة أخرى في الفرض والاخلاص، أي الترغيب والترهيب: "وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ." سورة المائدة.
ومن هذا المنطلق في التبيّن عن ذِكر المائدة، النطق باسم الجلالة والمُهنّد من الكلام وعزّة النور وانبلاج النهار من الليل، وما الأنبياء إلاّ عبيدًا عند الله لأنّه: "السميع البصير، عالم مريد، متكلم فاعل، حيّ قادر*" كما جاء في الذكر.
اتّضح لنا من قراءتنا لهذا النصّ، أنّ التناص تستجيب له المبالغة التي ازدحم بها التأوُّل المتّصل بالممدوح، فغمرت النصّ بعناصر التوهّم والتنزيل والزيادة، وكأنّ لوجود هذه العناصر حاجة لخلق قاعدة فنّيّة تستجيب لها اللعبة الفنّيّة، على اعتبار أنّ الشاعرة اتّخَذَتْ من الدلالة البيْنيّة مصدرًا تأويليًّا مُسْتَفِزًّا، وإن غلبت عليه علّة الطباع العربيّة، التي لا تمنح الصورة الشعريّة اكتساب المعنى مشروعيّته، بما تُمثّله الصور الذهنيّة من تعدّدٍ في قواعدها التشخيصيّة، كونها زخّت في تساقيها الفنّيّ شخصيّتها الانطباعيّة، لتطعيم وجودها التمرّديّ تأثيره المُعلَن، التي أرادت له أن تتّسق به روح المعاصرة، وتستيقظ فيه العناصر التالية:
أوّلاً: النظام الصوتيّ في حرّيّة التشبيه.
ثانيًا: التحرّر من هيمنة القواعد الوضعيّة التي تقيّد بيان التصوّف الروحيّ، بكلّ ما تنشده القناعة زيادة إيمانًا بالشيء.
ثالثًا: إطلاقُ حرّيّة التصرّف بالأصل في إثبات حرّيّة مرضاة التشبيه بالمتعة، وإذا تحقّقت هذه العناصر المُسندة في بُعدها الوجدانيّ المتخيّلة لمثليتها، يكون ناتج تأثير خلايا الجينات اللفظيّة فاعلاً في فيضها الصوتيّ، لأنّ تساقي الأصوات المتخيلة في العقل لا تقاس ببلاغتها اللغويّة، بقدر ما تقاس بتوصيلها الصوتيّ وتأثيره على العاطفة ليكون معقولاً، وهذا يمنحنا مفهوم أنّ الشبه بين جمانة وليليت ينصرف إلى مفهوم ما نستقبله من الأصوات، أمّا مدلول الألفاظ فهو ينصرف إلى بيان النحو، فيكون خال من القيمة في الحوار الروحيّ، والسؤال هنا:
هل البديع عند جمانة مكتسَب ذاتيّ، أم أنّه تساقي من الثقافات الموروثة من العائلة، ومن الجو المحيط، أم أنّ لغة القرآن ألهمت عقل الشاعرة، البلاغة والنجوى، والتكيّف، والموازنة، والتأثر، والمحاصلة، والتبحر، والاصغاء، والخضوع، فكان العشق الروحي، والعزة في المحاسنة، وبلوغ النبوغ في المعاني، والتطلع إلى الكمال. من فعال شخصيتها التي سخرت الأسطورة لتتخذ من جسدها إله يتناص فيه الهوى، بلغة أحصت كل المسوغات الوصفية للتبشير بتمرده، فخصت نثرها بالمشاكلة في المعنى التوليدي بأحوال صيّغها، وبهذا تكون قد وسعت التجنيس على حالتيه: الرمزية والدلالية، على اعتبار الجناس صورة مبصرة.
والجواب:
نعم هو حصيلة المساقات التصويريّة الثبوتيّة المتلاقحة مع المعاني، وليست التلاقي مع الشخصيّة، وإذا أردنا التبحر أكثر في مستقاة الصورة الحسّيّة وتوليفها المستوحى من العمق التعبيريّ المراد إيصال مفهومه بذات الطعم الفلسفيّ، نجد في منازل الكلام تحديد الطباق في قول القرآن: "رب المشرقين ورب المغربين". وممّا هو من قبيل التفسير اختلاف الوقت بين الصيف والشتاء، فإذا قلنا أنّ الشاعرة أخذت ما يناسب الاستعارة لتوليف صيغة معيّنة على رسلها، فلا بأس شرط أن لا يكون المُؤوَّل منه مباشرًا، في ذات السياق المحمول على معناه في قولها: "الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال".
هذا موضع يجب القبض على أبعاده، حتى إذا تلازم التناص فيه بشكل واضح، من حيث أفاد النصّ التأكيد على الملازمة، لكن السؤال هنا: هل كلّ الشعراء لديهم القدرة على تبيان موضعة الاستعارة في ميزانها، مثلما فعلت جمانة في هذه اللعبة التي اعتمدت الانزياح الدلاليّ، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الصيغ اللغويّة، والغاية من التميّز ممّا يحول دون المطابقة المباشرة والتكرار؟ اللغة بين النصّ القرآنيّ ونصّ الشاعرة موصول بالمعرفة، فإنها إن لم تدرك هذا لم تورده لأنّه مذهب بلاغي، لكن كلامها قد استبان في ملذّاته التي تنسجم مع الذات المعرفيّة في مدادها وعفويّتها.
ونرى تطبيقًا آخر يُناجي بيان التوجه ذاته، الذي يرمز إلى الليل والنهار، ولكن الشاعرة أخذت الحصيلة من المعنى ومزاوجته بتقنيّة حاورت نواصيه، ولكي نكون مُلمّين بفلسفة التناص، نقرأ هذه الآية ونستشرف مقصودها في قوله: "وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ". والشاعرة تقول: والجنوب لأنّي الشمال" مع بعض تبديل مُقنّن الترتيب في تقنيّة الاشتقاق الذي ساقته الشاعرة في قصيدة ليليت أشبه بالجرد التطبيقيّ لامرأة احتوتها الأسطورة، أخذت منه الشاعرة ما يتّفق وتصوّرات الجَمال والتمرّد والحرّيّة واللهو وعاشرته في نصّها، أمّا ما لم يتّفق مع تفكيرها التي حرصت أن لا تتّصف به، فقد أهملته أو غيّرت من سياقه، أمّا والشاعرة فقد برّأت ليليت كونها امرأة عاقرًا، مع أنّ الأسطورة تؤكّد هذا، وهو إحدى صفاتها القاتلة، ولكوْنها عاقرًا كانت "ليليت" تصبّ جام غضبها على الأجنّة، فدعونا نقرأ الشاعرة تتحدّث بحال لسان ليليت في قولها: ولا أسرق الأجنّة من أرحام النساء.
أمّا الخطأ التاريخيّ الزمنيّ في سياق النصّ، أنّ الله عندما خلق حوّاء من ضلع آدم، لم يكن هناك نساء في الحياة غير حواء، فكيف اتّفق أنّ ليليت لم تسرق الأجنّة من رحم النساء، وهي التي تقول: أنا المرأة الأولى" كما قالتها سجاح لقومها عندما ادّعت النبويّة: "أنا المرأة الأولى*"، وتعني أوّل نبيّة في الزمان والمكان ترى، هل هي محاكاة غير منطقيّة للحقيقة المادّيّة، أم تماشيًا مع منطق المثاليّة في الأسطورة؟ لإنّ حقيقة الخلق كما يقول القرآن بدأ بعد أن نزل آدم وحوّاء على الأرض، عندما غادرا الجنّة حتّى موتهما، فكيف تتّفق ثقافة الشاعرة بين قياسات الخطأ في الموروث التاريخيّ، وبين السرد الواقعيّ الذي يراه المؤمنون، إنّ الله مسيرة الحياة، أمّا أنا فبريء من هذا الاعتقاد، لأنّ النظريّة الداروينيّة أقرب إلى الواقع من الروحانيّات في الكتب: "التوراة، الإنجيل، والقرآن." واعتقادي أنّ ما جاء في الكتب السماويّة ما هو إلاّ: أوامر، وتخويف، وإنشاد، وطاعة، للغيب، ولكنّي أعترف في الجانب الآخر، أنّ الجوانب الخيّرة التي أولته تلك الكتب اهتمامًا، كان يَنشد المساواة الإنسانيّة، وعمل الخير، وإلغاء العبوديّة والظلم، وإطلاق حرّيّة الفرد للعيش بسلام، خاصّة في الجانب الذي يهتمّ بكرامة المرأة. إذن؛ ما الذي ينقص المرأة كي تكون ليليت؟
وفي حواريّة أخرى من مجموعة "دعوة إلى عشاء سرّيّ"، ضمّت عشرة قصائد اختلفت في سياقها البنيويّ والإيقاعيّ وهي: "عندما ثمرة صرتُ/ سأحدّثكم عن الطريق/ دعوة إلى عشاء سرّيّ/ على هوى جوعي/ ذات جنون/ تنتظر الملك/ عائدة إليك/ ثمّ أضعته/ امرأة/ حتماً سيأتي".
ومن هذه القصائد سوف أدخل على قصيدة: "عندما ثمرة صرت".
وجدت هذه القصيدة أكثر عمقًا شعريًّا، وأوسع بُعدًا بلاغيًّا، وأرشق فنّيّة. سوف نرى كيف كانت إرهاصات جمانة الشاعرة في زمن كتابة هذه القصيدة:
كنتُ بنتًا عندما ولدتني أمّي تحت ظلّ القمر
لم أبْكِ شأن الأطفال لكنّي أحببتُ أن أكون ذكرًا
ولكي تُطيّبَ خاطري
غسلتني بماء غامض وبأقمطة النقائض لفّتني
وضعتني على الحافّة من كلّ جبل
نذرتني إلى حوّاء الدهشة والتحوّل
وبالعتمة والضوء عجنتني
هيكلا لشياطين الجنّة
غريبة نشأت ولم ينشغل أحد بأفكاري
فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة على ورق ناصع
ثمّ شققتها وخرجت منها
بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض
لم أكن فقط داخل الزمن أو خارجه
في المكانيْن أقمتُ
وتذكّرتُ قبل أن أولد
أنّي أجساد جمّة
وأنّي طويلا نمتُ
وطويلاً عشتُ
وعندما ثمرةً صرتُ
عرفتُ ماذا ينتظرني.
إذا قلنا إنّ اللفظة تنتقل من سياق إلى سياق آخر، بسبب ما تدلّ عليه مراتبها الدلاليّة من طباق خفيّ، وتنتج معنى غير متضادّ بين التسهيم وردّ الإعجاز، فهذا يعني تنشيط العلاقة بين المُحسّنات المعنويّة وبين الصورة، من حيث ترتيب بنيتها الفنية، ومثالنا على هذا التكوين في بيئة الألفاظ، تلك التي استخدمها السيّاب في قصائده، ومنها قصيدة "مطر" من حيث ما اشاعته اللفظة من تعدّد الألق في ثيمة "عيناك .."، وكأنّها صيغت بمُحاسنة تنقّت كسريان الماء بلمعته من حيّز إلى آخر، بين التخيّل وما تتناسل فيه صفة الفعل في معناه، فنقول هذا التنسيق أدّى إلى طباق يُزوّد الدلالة وضوحًا في الخلق البلاغيّ، حيث نجد المعاني قد حقّقت فاعليّتها في ذاتها، لأنّ ما يصرف الكلام الفصيح هو دلالة ماهيّة المُحسّنات اللفظيّة، ومفارق إيقاعاتها، سواء كان في المشابهة، أو جزالة ارهاصاتها، أو مراتب أحوالها.
ورَدُّنا للأصل في قول الشاعرة في مستهلّ قصيدتها: "كنت بنتًا عندما ولدتني أمّي تحت ظل القمر"، نقول اللفظة المفردة، واللفظة الجملة أي "الجمع" بمعنى كامل الجملة، المُعبّرة عن وحدة الدلالة اللفظيّة، التي توعز للمعاني قيمتها مجتمعة في سلّة واحدة، فيكون أصل الدلالة فصلا تقنيًّا يليق بالجودة التعبيريّة على ردّ الإعجاز، فنقول ما يُحسّنه تكافؤ جناس الاشتقاق كـ: أرهف السمع، ووسع الانتباه، وأوجز، وكثف، وهذا ما تؤكّده الخبرة في التنصيص التقنيّ.
ورَدُّنا في المقصود هنا، أنّ كلّ المعاني في هذه الجملة الشعريّة تنحصر في أبعاد الدلالة المتوفّرة في "ظلّ القمر"، أي أنّ "الظلّ" هو المُسنَد إليه، وليس هو المسند، بمعنى أن تلك الولادة حدثت تحت ضوء القمر، في مكان ما به ظلّ، أي أنّنا أسندنا تناسب الظلّ لفعل الولادة، كون الظلّ مُتغيّر، فأصبح المكان والزمان يختصّان بحالة الولادة تلك، وعليه وجدنا المعنى وقد وُلد من باطن ثيمة تمثيل الظلّ، المُعبّر عن قولنا أنّ المُحسّنات اللفظيّة تُعبّر عن نفسها في المفرد وفي الجمع، أمّا ما أرادته الشاعرة من جعل الظلّ يتمثّل به الوعي، فهذا يدلّ على أنّها جعلت للظلّ خصوصيّة، تنشد منها أن تكون مركزًا يُزوّد دلالات الرمز حضوره. إذن؛ أين تكمن خصوصيّة فنون المعاني؟ أهي في النصّ "كيفما حصل"، أم فيما أوعزنا له من شروط تحتسب بها الشاعرة؟
كما قلتُ في بحثي السابق، إنّه "لا يوجد شاعر عظيم بل توجد قصيدة عظيمة"، وإلاّ قلنا إنّ نازك الملائكة هي إلهة الشعر، وبهذا نقول بوضوح إنّ جمانة حداد شاعرة، وأغلب نصوصها متشابهة التوليف، ومخلتفة المقاييس، فإذا خرج نصّ عندها عن سياقه وأسلوبه الأنويّ، فهذا يعني أنّ الشاعرة تفرّدت بذلك النصّ، فأصبحت له خصوصيّته المستقلّة، وإذا أردنا أن ندخل إلى حقيقة العلاقة بينهما، أي بين النصّ والشاعرة، نتبيّن انّهما يلتقيان في بعض النصوص ويبتعدان في أخرى، إمّا بفعل تكرار المجانسة، أو بفعل القوى الناعمة التي تجمع بينهما، فالشاعرة التي تبدأ بالأنويّة ولم تخرج منها، تبقى أسيرة الوجه الواحد للحدث، كقصّة التفاحة، أو الشياطين على أساس فعل التمرّد، أو الجنّة الحدّ الفاصل بين الخير والشرّ، وكأنّهما فرسخان لا يلتقيان، هذا لأنّ الأنويّة المباشرة حين تلبس جبّة التفاخر لا تودّ الخروج منها، لأنّها إمّا أن تُعبّر عن التميّز أو عن الادّعاء، وكِلا الفِعليْن مذمومان.
إذن؛ كيف نحصل على استقلالية النصّ؟ هل ندخل إليه من حيث فعل تمرّد الشاعرة، أم من نبراس ثقافتها التي تجاوزت العادات والتقاليد البدويّة الخانقة، أم هو التصريح بحريق الشهوة كما سارت عليه بعض شاعرات الإيروتيك؟
ولكي نتبيّن المفاضلة، نذهب إلى التعريف التالي في هذه النقاط:
أوّلاً: احتساب نظم البلاغة في حال أن تبلغ التورية مستواها، إذا حاز اللفظ على أكثر من معنى، واختلف في الجناس، واتفق في المقصود البعيد، فهو الذي يبني الصورة من ذاتها، في قولها: "أحببت أن أكون ذكرًا" طباق ظاهر. وقولها في مكان آخر يُزود الدلالة قيمتها: "غسلتني بماء غامض/ وبأقمطة النقائض لفّتني" طباق خفيّ، سياق وضعنا نحن القراء أمام محصّلة ذات تضادّ لاقَحَ المعنى وزوّده بنشاط تحوّلات القصد، ظاهر الكلام يدلّ الفتاة التي تمنّت أن تكون ذكرًا، وباطنه الأمّ المعنيّة بالفاعل، وهو المقصود البعيد.
ثانيًا: نقرأ النقيض في نصوص الشاعرة ومثالنا في قولها: "وبالعتمة والضوء عجنتني". يكون التعلّق المستعار واضحًا يستند إلى بعضه، فالقصد كونها أزاحت المعنى إلى ساح آخر، ألا وهو المثاليّة المُفرطة في صيغة "الروحانيّات" التي طغت على الشعر الصوفيّ، باستثناء الحلاّج فقد بقي يعاصرنا التجديد، في قولها: "هيكلاً لشياطين الجنة"، فالتكرار في الجنّة الغيبيّة، والتفاحة وأسطورتها، والشيطان وعصيانه، والملائكة وشذوذهم، والأنبياء وحجّتهم، والأساطير الكاذبة، والوهم الذي يسرح في خيال الشاعر/ الشاعرة، ربما أصبحت تلك الأدوات تُشكّل ثقلاً لا يتساوى وإبداع جمانة.
ثالثًا: المجانسة الحسنة في قولها: "فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة/ ثمّ شققتها وخرجتُ منها"، أمّا تكملة الصورة الأولى "على ورق ناصع"، هذا الطرف أخذ الصورة إلى تقرير الفكرة الفارغة، فلو جاءت الصورة دون هذا الطرف، لكان في التكثيف من الحسن ما يُغني، أمّا ما جانس الصورتيْن هو نشاط الروح الواثبة في المضمون الفلسفيّ، الذي عدّل التركيب في فصاحته.
وفي هذا المجال يقول الشاعر عمرو بن كلثوم:
بأنا نورد الرايات بيضا ... ونصدّرهن حمرًا قد روينا"،
والقصد في هذا المعنى الدخول إلى المعركة برايات بيضاء، والخروج من المعركة وقد ارتويت تلك الرايات بالدماء، والاستعارة جاءت بما يناسب الرايات إسنادًا، فإنّ بين "نورد" و "نصدّرهن" للراية تناسبًا في الإسناد، أي أنّ اللونيْن هما المُسند للراية، والشاعرة تقول: "بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض"، إذن؛ الأنوية بفِعلها المخفيّ "الذات" قد أسندت اللونيْن الأحمر والأبيض إلى ما تقدّم في النصّ وهو: "فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة/ ثمّ شققتها وخرجت منها/ بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض"، وبهذا تكون قد ردّت الإعجاز على الصدر الذي هو"رسم التفاحة"، حيث حصل تنامي الروح الشعريّة بفعل الإسناد الأوّل، وهو "الشقّ والخروج"، ولهذا السبب لاقحت الصورة بالفعل المُسند إليه باللونيْن كونهما غير متضادّين، وهو الإسناد الثاني، حين شقّت التفاحة الحمراء وخرجت منها بالأحمر دم المخاض، فالأبيض لون النور والشمس بيضاء، والتقديم والتأخير في اللونيْن يُعبّران عن فطنة وذكاء الشاعرة، لأنّها جسّمت المعرفة على أساسها المعنويّ بوعي متحد، وهيغل يرى "أنّ كلّ شيء هو في تناقض مع ذاته ووجوده، وطبيعة الشيء هي التي تدفعه إلى أن تتجدّد حالة وجوده الى حالة أخرى*"، لأنّ عِلم التعارض يقول، لكلّ فكرة هناك فكرة أخرى مناقضة لها، تؤدّي إلى تشريع صلة الافكار المرتبطة بافكارنا، التي تعمل على توازن المكوّنات بالاتفاق والابتعاد. تارة تلتقي بالمجانسة الحسّيّة، وتارة تلتقي في المعنى أو الفائدة. وهذا واضح في فصيح القول المبنيّ من معناه: " لم أكن فقط داخل الزمن أو خارجه/ في المكانيْن أقمتُ."
السمات التي تمتاز بها جمانة أنّها تميّزت بلغة الجمع المرتّب في المفرد، وقولها: "إنّي أجساد جمّة"، فهي تريد أن تستدعي أسطورة أهل الكهف وكلبهم، وثيمة جمّة تعني معان عديدة، أمّا ما تقصده الشاعرة فهو الجماعة، ولهذا هي أجساد جمّة، والمرادف هو تكملة للتفسير الذي من المفترض أن يجمله البيت الشعريّ، فالبيت الأوّل لفَّ بالبيت الشعريّ الثاني وقولها: "وإنّي طويلاً نمتُ" أي الجمّة، ولأنّ أهل الكهف نومهم لم يُحسب من العمر، فهم نهضوا كما ناموا في عزّ الشباب، وهو تفسير الإيضاح في قولها: "وعندما ثمرة صرتُ/ عرفت ما ينتظرني"، جاءت الجملتان الأخيرتان لكي تُعبّرا عن عطف البيان الذي اقتضى المغايرة في تفعيل المعنى، الذي تريد أن يكون هو حاصل التبيين.
يقول قدامة بن جعفر: "وهو أن يضع الشاعر مَعانيًا يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصفه، فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها، ولا يزيد أو ينقص*". أمّا متى تكون الصورة مجملة، نقول متى يكون القصد في هذه المزاوجة لا يفصل الإجمال في المعنى، فهي الأنا، التي أزاحت التلقّي إليها، لتكون دائمة الحسّ والفتنة والنضوج.
هامش:
1- كتاب بلاغات النساء، لابن طيفور.
2- اقرأ كتاب نقد العقل الخالص، إمانويل كانط
3- أنشودة المطر، بدر شاكر السياب.
4- اقرأ هيغل. كتاب: المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة \ بيروت.
5- اقرأ النظرية النسبية \ البرت انشتاين.
6- صحيح البخاري \ حركات الردة \ للبخاري.
7- اقرأ نقد الشعر ص 135 ، كمال مصطفى.
8- اقرأ كتاب علوم الدين للغزالي المجلد الخامس.
9- نفس المصدر.
10- اقرأ كتاب بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر طيفور.
11- اقرأ كتاب الطراز، الجزء الثالث، لحيى بن حمزة اليمني.
12- اقرأ كتاب علم المنطق، هيغل.
13- هيغل \ نفس المصدر.
14- اقرأ كتاب الخراج قدامة بن جعفر.
15- كتاب القرآن.
= = =

كذلك يمكننا أن نقول إنّ الشاعرات تنوّع تحصيلهنّ في أدب المقاومة، الذي ارتبط ارتباطًا عاطفيًّا بالثورة الفلسطينيّة، على اعتبارها تُمثّل الحقّ العربيّ في استرداد أرضه من المغتصب الصهيونيّ، كما عملت الكثيرات منهنّ بالإعلام والصفحات الثقافيّة الدوريّة، ومع ذلك، فإنّ ما تمّ تحصيله في هذا الميزان لا يُعّدُّ إحصاءً، بل ما تمثلت الشاعرة بقامتها التي ميّزها الاختلاف التنويريّ والثقافيّ والمعرفيّ بالغزارة والوفرة، على العكس من شاعراتِ الطرف اللا إبداعيّ، اللاتي وصلت نصوصهنّ للقارئ باردة لا حياة فيها.
صحيحٌ أنّ هناك شاعراتٌ موهوبات، لكنّ نصوصهنّ فاقدة للحيويّة والنشاط والرفعة.
تعتبر الشاعرة اللبنانيّة جمانة حداد، إحدى الشاعرات العربيّات المعاصرات، اللاتي أنجزن حداثويّة شعريّة فاعلة في تأثيرهنّ على الحركة الأدبيّة العربيّة، لذا؛ وبهذا التناول أجدني قد دخلت إلى بُنيةٍ شعريّة أتنقّل مع النصّ حيث يأخذني نبراسه. والشاعرة حدّاد جارية، تمارس لعبة الشعر من حيث رهصة دواخله، فتختار ما تنتجه نبضات نواصيه من فيض ميتافيزيقيا التداول ومُحسّناته المُتحرّكة، فقد وجدتها تُعاشر مَصبّات قصيدة النثر على هواها، وهي تتأمّل المصاحبة والمحاسنة في أحكام فنيّة كانت وما زالت سائدة، وقد اتّضح أنّ نصّ جمانة يحاور المعاصرة بإمعان، حيث عملت وبجدّيّة على تخطّي سير الاتجاه النثريّ المتعارف عليه عند الكثير من الشاعرات.
أمّا ما اختصّ بالمجرى العاطفيّ، فقد تواصلت الشاعرة جمانة حدّاد بإمتاع، يقيم لنصّها التفاعلَ مع شاعرات الإيروتيك، اللاتي تجاوزنَ المألوفَ التقليديّ لمجتمع عربيّ يدّعي العقلانيّة، كالحرص على العادات والتقاليد، مع أنّ هذه المجتمعات منقوعة في الخطايا حتى رأسها.
ومن هؤلاء الشواعر:
من الموروث: "ولادة بنت المستكفي، سلمى بنت القراطيس، برة العدوية*" والشاعرة رابعة العدوية، والشاعرة الايرانية فروغ فرخزاد.
ومن المعاصرات: غادة السمّان، مليكة مزان، عاتكة الخزرجي، لميعة عباس عمارة.
لكن؛ ولأنّ جمانة شاعرة ذكيّة، جعلت ظاهرتها الإبداعيّة تتمتّع بصيانة ذاتيّة، حريصة كلّ الحرص على أسلوبها الأدبيّ النوعيّ، خاصّة وأنّها تنتمي إلى أهمّ وأرقى مجتمع حضاريّ عربيّ، تبوّأ الحرّيّات منذ زمن مُبكّر من بداية القرن الماضي، حيث تنوّعت إبداعات الشاعرة بهاجس التنويع الأدبيّ، المرتبط بالثقافة الأوروربيّة المعاصرة، وخاصّة الثقافة الفرنسيّة، تلك الثقافة التي بشّرت بالتنوير الفكريّ والنفسيّ والاجتماعيّ، والذي أثّر تأثيرًا كمّيًّا في صناعة الذات اللبنانيّة، فتطبّع السلوك الفرنسيّ التبشيريّ في ذهنيّة الفرد البيروتيّ، طباقًا نوعيًّا. فقد أحلّت المدنيّة الفرنسيّة قفزاتٍ تطوريّة متغيّرة في الشخصيّة اللبنانيّة المُتحوّلة، التي بلغت نموًّا ثقافيًّا مُطّردًا، في حالات تعدّد طِباقها من جهة الإثبات، الذي تمظهرت فيه آليّة التجانس الأرستقراطيّ، فتشبّه الكثيرُ من أدباء لبنان بهذه التداوليّة المتغيّرة، التي أضافت للمراتب الأدبيّة والفكريّة طموحَها النوعيّ في مضامين النصّ المُركّب، ومن هؤلاء، الشاعرة جمانة حدّاد، فقد وجدتها تقدّم نصوصها على أنّها تشريق جديد يوسّع من المفاهيم الوجدانيّة. على إيقاع احساسها الموحى من سقاء طباقها الخفيّ، الدالّ على استنباط المبنى من الذات العارفة، المرتبطة بالعلوم البلاغيّة التي بُنيت على أساسها طبيعةُ العبور إلى مبانيها. ولأنّ الحركة الذهنيّة تتّخذ من تقسيماتها المصدريّة جوابًا، وإن اختلفت دلالة الاستيعاب للحضارة بين شعبَيْن، إلاّ أنّ بعض الشعراء استمدّوا يقظتهم الإبداعيّة من طبيعة الاختلاف، فأسّسوا لكلّ مبدع فيهم اتّجاهه الذي اختصّ فردًا بعينه.
تتكوّن خاصّيّة الإلهام المُولّدة للمشاعر الحسّيّة عند الشاعر النوعيّ، من كونه خالق غير مُنَظّر أو مؤلّف، حيث تعتمر بصيرة التجلّي واضحة بواسطة إدراك الحواسّ، الذي يُعتبَرُ المموّلَ الماديّ للحالة الإبداعيّة، غير الخاضعة للمُلقّن الذي يكمن خلف الستار، لأنّ المزج بما هو فطريّ وما هو مُلقنّ يتعارض مع فكرة الإشعاع الإبداعيّ. لهذا؛ نجد الشاعرة جمانة حدّاد على معرفةٍ واسعة في موضوعة الذات المبدعة وإجاباتها الحسّيّة، سواء ما جاء في علمها الفنتازي، أو في الإضافة التجديديّة في متغيّرات الأسلوب، ومن بيان هذه المعرفة قرأنا جمانة حدّاد من زوايا عديدة، اتّحدت على أنّ الشاعرة تُمثّل وعيًا متقدّمًا على ما تحتفي به بعض الشاعرات العربيّات، فهي بقدرتها اللغويّة والفنّيّة أغنت ذاتها، العارفة بتلقائيّة توالُدِ الصور الحسّيّة، التي تتماهى فيها الصور الحياتيّة، فجاءت قصائدها تُعبّر عن الأفكار التي تبني علاقة الحدس الإدراكيّ، من واعز الصورة المرتبطة بالذهن، وبلاغة البصيرة المتخيّلة، التي تنشأ في صميم الجوابات العقليّة.
يقول كانط: "إنّ الإدراكات الحسّيّة بغير الإدراكات العقليّة عمياء، وإنّ قوانين الفكر هي قوانين الأشياء*". في اعتقادي أن جمانه حدّاد نمَتْ نموًّا طرديًّا في أحضان الفلسفة الكانطيّة، فأمتعت قصيدتها بمزاوجة التنويع الملحميّ، وهو تفعيل معرفيّ، ربط بين الكانطيّة بوعيها الفلسفيّ، وبين المتصوّفة، والعلاقة الروحيّة المُترَفة بالميولات، والتوحّد المعنويّ مع الإلهام الواعز للمتخيّل الفنّيّ.
عن هذا عَبّر الحلاّج قائلاً: "إنّ الذات الإلهيّة تحلّ في الإنسان*"
فجاءت النتيجة أنّها مزجت الإحساسات المادّيّة عند كانط، بأفكار الحلاّج المثاليّة، إلى رؤية روحيّة تتساوى بالتباهي لعشق الفعل الإباحيّ المؤثّر بالصفات البشريّة، لا سيّما أنّ الشاعرة اشتغلت على محاكاة الحسّ الأنثويّ الذي يُثيرها منذ وعيها الأوّل، فأشبعت تجلّيات المقاصد برهصة العاطفة الفكريّة وتخضّبت في ألوانها.
ولأنّ جمانة عاشت قريبة من الحركة الشعريّة العربيّة التواتريّة، التي اجتمعت في بيروت عام 1980، نجد قصيدتها تومض بالمشاعر المُركّبة، حيث تفيض بوعي ثقافيّ شموليّ، وإبداع مُخصّب بتلك الثقافات، وهذه المزاوجة أدّت إلى هجين تفاعليّ مع ثقافتها الذاتيّة المُعبّرة عن أهدافها، وعن مقاصدها ولغتها الحريصة، التي تُكسبُ المزاوجة الفنّيّة التنامي والتلاقح والتنويع، هذا لكون الشعر عندها منسابًا من حيث مدركاتها الحسّيّة، التي تقوم على الاتصال الذكيّ بالثقافات الأخرى، من واعز نشاطها وغناها الفكريّ، ومن مَصبّاتها التي تعتني بها كـ: الإضافة، والإمالة، والتعجّب، والاستفهام.
مع أنّي لا أرى عيبًا في أن تُلاقح الشاعرة أدواتها بأدوات أكثر وعيًا وتطوّرًا أنموذجيًّا، لتحديث وتحصين وتلقين ألفاظها بوعي أكثر حيوية في نشاطه ورونقه، حتى يُسجّل انتشارًا أعَمَّ بين القرّاء، خاصّة وأنّ للشاعرة علاقات طيّبة ببعض القامات المتمرّدة على النظم المتخلّفة، وقد أبانت لمساتها تفيض بتلازم الصوت الهارمونيّ في الفعل الداخليّ، فكان للإيقاع نغميّته ورنّات أدواته، وشغفه في اختراق السماع إلى نشوة أبهى في شكلها ومنطقها، ومن أجل هذا الوعي النوعيّ، برز اسمها واضحًا وفاعلاً على الساحة العربيّة. وبهذا نقول إنّ العلم لا يتمثّل بالخيال، بينما الشعر كونه حُبّبَ بالبصيرة الباطنة، بعد أن كسا البصيرة الظاهرة فطنتها، التي استمدّت قيمتها من متعة المخيال، لأنّ في إدراكه وعيًا مختلفًا، ولكن هذا يختلف في طبيعة خاصّيّة المدرك وما يلائمه.
في هذا يقول الغزالي: "إنّ جَمال المعاني المدركة بالعقل، أعظمُ من جَمال الصورة الظاهرة للأبصار."*
ولا أدري لِمَ الغزالي ساوى بين العقل والبصر، لأنّ العقل هو الحاكم بأمر الجسم، فهو المُلقّن وهو المكتشف وهو الحياة وهو المُميت، إذن لا يمكن للخيال أن يخلق صورة إلاّ بالحسّ التفاعليّ مع البصيرة، التي يُفسّر العقل لها الأشياء، فلو قال الغزالي "والبصيرة وليس البصر"، لكان المعنى أكثر بلاغة ودقة. أمّا الشعر فيمكنه أن يبقى في حدود الخيال الإبداعيّ، خارج تفاعل البصيرة معه كقول السياب:
"عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر"*
لأنّ السيّاب بهذه الصورة تخيّل ولم يرَ، ومثل هذا الكثير عنده وعند غيره، إذن فالبصيرة الباطنة "الخيال الإدراكيّ" أتمُّ وأبلغُ من البصيرة الظاهرة على الأشياء، كونَ الباطنة ونُسمّيها الذهنيّة، هي تشكيلٌ إبداعيٌّ روحانيّ، أمّا الظاهرة فهي مشاهدة تنتج الحسّ الروائيّ، والقصصيّ، والبحثيّ، والعلميّ، والحركيّ، ومع هذا الاختلاف، إلاّ أنّهما يشتركان في ميْلهما لدوام الوجود، لأنّ العقل هو الذي يُحدّد المقاسات لوجودها وزوالها، فيقول هيغل: "إنّ كلّ ما هو عقليّ فهو واقعيّ، وكلّ ما هو واقعيّ فهو عقليّ."*
على ضوء ما تقدّم واستفاض من شرحنا حول قدرتنا على قراءة الكلام من أوّله، في سلطة "المفصل والطباق" كما عبّرَ عن هذا التبريزيّ، الذي أفضّله في قراءتي، بما أرغب أن تتمثّله الجماليّة التعبيريّة، تلك التي ينضج فيها محاسن الوعي الإبداعيّ. يقول ألبرت أينشتاين: "سيظلّ الخيال فوق المعرفة، لأنّ الخيال يحتضن الكون بأسره، ولا يختصّ بجزء منه*". إذن؛ من حيث هذه الإفاضة الجارية في مجال التفكير المنهجيّ، ندخل في حوار القصيدة مع الشاعرة جمانة، التي خلعت ثياب طقوس التقاليد الوعرة، ولبست ما لا يضيق عليها من رداء الرمزيّة بأشكالها المتعدّدة، ولا تتساقط من بين خياراتها الإبداعيّة أدواتها، ولا تؤلّف في الإبصار، ولا تلحن، بل على العكس من هذا كلّه، فحدّاد ذكيّة الملمح والبصيرة، وهي المُعبّرة عن التغيّرات الجديدة في تداعيات فهم جوهر الظواهر غير العلنيّة، المُدركة للعلوم الفنيّة التي تحكم مفهوم المعاني وتنقّلات مركّباتها من صورة إلى أخرى، عبر مصبّات أدوات متحرّكة التحصيل، وهي أيضًا ناقدة ذات لغة نقديّة مفهومة ومُحكمة.
سوف نختار من شعرها ما يمكننا أن نعالجه من صفاته الظاهرة والباطنة، من مسار صحّة بنية قصيدتها، أو من واقع ضعفها، لكي نتبيّن معيار القصيدة من احساسات مدركات طباقها. المبصر والمفتوح على إشراق جديد من نوعه، شعر يتفاعل بوعي مع العلوم اللغويّة والفنّيّة، تحضر فيها الأسطورة مُباحة مِن فيها، فإذا كانت القصيدة تُنتَج بهذا الوعي، نقول إنها بنية جمعت الحياة فيما يليق بالغايات التي تكتنز استقامة ترتيبها وحُسن نظامها، ولكي نتبيّن ما يليق بالرأي الحاصل في شرحنا أو عدمه، ندخل إلى لغة القصيدة، من حيث تناسل انزياح الخامة النوعيّة في رياض الشاعرة المختلف هذا النص:
مبتدأ أوّل
أنا ليليت المرأة القدر، لا يتملّص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملّص.
أنا المرأة القمران ليليت، لا يكتمل أسودهما إلا بأبيضهما، لأنّ طهارتي شرارة المجون، وتمنّعي أول الاحتمال.
أنا المرأة الجنّة التي سقطت من الجَنّة، وأنا السقوط الجنّة.
أنا العذراء ليليت، وجه الداعرة اللامرئيّ، الأمّ العشيقة والمرأة الرجل، الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال.
أنا المرأة المائدة وأنا المدعوّون إليها، لُقبّتُ بجنّيّة الليل المُجنّحة، وسمّائي أهل سومر وكنعان وشعوب الرافدين إلهة الاغراء والرغبة، وسمّوْني إلهة اللذّة المجانيّة وشفيعة الاستمناء، حرّروني من شرط الانجاب لأكون القدر الخالد.
أنا ليليت النهدان الأبيضان، لا يُقاوَم سحري لأنّ شَعري أسود طويل، وعينيّ عسليّتان، جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي من تراب خُلقتُ، وجُعِلتُ زوجة آدم الأولى فلم أخضع.
أنا الأولى التي لم تكتفِ لأنّها الوصال الكامل، الفعل والتلقّي، المرأة التمرّدُ لا المرأة ال نعم، سئمتُآدم الرجل، وسئمتُ آدم الجنّة، سئمتُ ورفضتُ وخرجتُ على الطاعةِ، عندما أرسل الله ملائكته لاستعادتي كنتُ ألهو، على شاطئ البحر الأحمر كنتُ ألهو، شاؤوني فلم أشأ، روّضوني لأتروّض فلم أتروّض، أنزلوني إلى المنفى لأكون وجع التشرّد، جعلوني الرهينة للقفر من الأرض، والفريسة للموحش من الظلال، وطريدة الكاسر من الحيوان جعلوني، عندما عثروا عليَّ كنتُ ألهو، لم أستجب فشرّدوني وطردوني لأنّي خرجتُ على المكتوب، وعندما طردوني بقي آدمُ زوجي وحيدًا، وحيدًا ومُتوحّشًا وشاكيًا ذهبت إلى ربّه، فخلق له ربّه امرأةً من ضلعه تُدعى حوّاء وسمّاها النموذج الثاني، لتطرد الموت عن قلبه خلقها، وتَضْمن استمرار الخلق.
أنا ليليت المرأة الأولى، شريكة آدم في الخلق لا ضلع الخضوع، من التراب خلقني إلهي لأكون الأصل، ومن ضلع آدم خلق حوّاء لتكون الظل، عندما سئمت زوجي خرجتُ لأرث حياتي، حرّضتُ رسولتي الأفعى على إغواء آدم بتفاح المعرفة، وعندما انتصرت أعدت فتنة الخطيئة إلى الخيال ولذّة المعصية إلى النصاب.
أنا المرأة المرأة، الإلهةُ الأمّ والإلهة الزوجة، تخصّبتُ لأمون الابنة وغواية كلّ زمان، تزوّجت الحقيقة والأسطورة لأكون الاثنين، أنا دليلة وسالومي ونفرتيتي بين النساء، وأنا ملكة سبأ وهيلانة طروادة ومريم المجدليّة.
أنا ليليت الزوجةُ المختارة والزوجةُ المطلقة، الليلُ وطائرُ الليل، المرأة الحقيقة والأسطورة، المرأة عشتار وأرتميس والرياح السومريّة، ترويني اللغات الأولى وتفسّرني الكتب، وعندما يَردُ ذِكري بين النساء تمطرني الأدعيةُ باللعنات.
أنا العتمة الأنثى لا الأنثى الضوء، لن يحصيني تفسيرٌ ولن أرضخ لمعنى، وصَمَتني الميتولوجيا بالشرور ورشقتني النساء بالرجولة، لكنّي لستُ المسترجلة ولا المرأة اللعبة، بل اكتمال الأنوثة الناقصة، لا أشنّ حربًا على الرجال ولا أسرق الأجنّة من أرحام النساء، فأنا الشيطانة المطلوبة، صولجان المعرفة وخاتم الحبّ والحرّيّة.
أنا الجنسان ليليت، أنا الجنس المنشود، آخذ لا أعطي، أعيد آدم إلى حقيقته، وإلى حواء ثديها الشرس ليستتبّ منطق الخلق.
أنا ليليت المخلوقة الندّ والزوجة الندّ
ما ينقص الرجل كي لا يندم
وما/ ينقص/ المرأة/ كي/ تكون
***
إذا حاورنا التراكم في الكيف النوعيّ في هُويّة النصّ الشعريّ عند جمانة حدّاد، سنجد أنفسنا أمام رؤية مُحيّرة في الكشف عن طبيعة العناصر المُكوّنة للبنية الجدليّة في دواخل النصّ، وعلى ضوء ما تقدّم، تطلّبَ منّا لمس مقياس الحوار المتحوّل من دلالة إلى دلالة مغايرة في ذات المعيار، تُلاقح التداوليّة الزمنيّة بصفاتها العرفانيّة، حين يتماهي النصّ مع سُلطة التفكير الميتافيزيقيّ، المُساق بذات الأدوات التي تحاور الأشياء، وتكشف عن ارتباط الشاعرة بالواعز المادّيّ، بالنظر إلى أنّ النصّ الذي نحاوره عَبّرَ عن هُويّته من الزوايا التي تتقاطع في طبيعتها المجسّات التأريخيّة، التي لعبت دورًا حسّيًّا في تكوين مقام عَبّرَ عن جوابات تؤدّي إلى المشاكلة بين السياقيْن المجازيّ والواقعيّ، لأنّ الاستعارة إذا صاحبها مساقُ المجاز، تفقد حيويّتها وماهيّتها الحقيقيّة، كونها لا تقوم على الإفاضة من المقصود، وقول الشاعرة في هذا:
- أنا ليليت المرأة القدر، ليليت: المستعار، والطباق المفترض الذي أصبح قدرًا على الشاعرة، هو الإحالة التي رتبتها لكي تستفيق ليليت في جمانة في قولها:
- لا يتملّص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملّص، "التملّص" بحالتيْه: هو مجاز، والمطلق في المعنى تأكّد في: أنّ العجز الذي يؤكّد على المجاز بيانه هو: "ولا يريد ذكر أن يتملّص." على اعتبار اللاّ واقعيّ. كان بإمكان الشاعرة تلافي هذا التصادم بين العلوم الفنّيّة، لو أخضعت النصّ إلى فنّيّة استقلاليّة التقطيع، فيكون على النحو التالي:
- أنا ليليت المرأة القدر/ لا يتملّص ذكرٌ مِن قدَري/ ولا يريد ذكَرٌ أن يتملّص
في السطر الأوّل كانت الاستعارة مستقلّة في دلالتها، وفي السطر الثاني والثالث اختصّا بالمجاز المستقلّ في دلالته، وبهذا تكون الشاعرة قد حقّقت للمكتسب الفنّيّ صنعة، فأصبح المعنى متلازمًا بفعل التساقي الحاصل في ميزات الرتب التقنيّة، وفي الوقت ذاته خلّصت مستهلّها الشعريّ من مجرّد كلام قابل للعرض والتباهي. وإذا قلنا إنّ الخلايا التي تتناغم تشظيّاتها الداخليّة بالمدهش الانفجاريّ، الحاصل في أنّ الذات أخذت تفاعلها التدريجيّ المتزامن من متغيّرين يتمّ قياسهما على المستوى النسبيّ، أحدهما مستعار لتخصيب الواقعيّ، والآخر مجازيّ كونه اللعبة الأدبيّة، فصارت المسافة تتماهى بواقع تخصّبت زواياه بتلاقحها المعنويّ. وهكذا يجنح الفكر إلى رؤيته الكاشفة عن دعم تخليص الذات من الأفكار الجاهزة، التي تكون في حالات عديدة تُعبّر عن اللاّوجود، بينما نجد الزمن المادّيّ هو المُحرّك الدلاليّ للفعل الناتج للتقنيّة المحصّنة بأدوات ذات لمع خاصّ، كقولها في التساقي الأوّل: "لا يتملّص" لفظة تجمع جماليّتها من سهل المحكيّ والفصيح، وهو قطع تناسليّ بين الخياليّ والواقعيّ في طبيعة مباني اللفظة، ولكون المجاز في هذه المحاصلة هو الفعل النشط، فالخيال هو الممتع للتصوّر.
نقرأ الشاعرة وهي تزخّ في لغتها الشعريّة التسهيم التقنيّ بين زمنيْن مختلفيْن، من واعز دلالات النصّ، الذي جعلت منه الشاعرة يدلّ أوّله على آخره، ألا وهو عنصر الزمن، وذلك باستدراج دراما الأسطورة وتحديثها باللغة المعاصرة، للنظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها، لتحقيق انسجام الأصوات في تفاعلات النصّ المتأمّل، وكأنّها تقود القارئ إلى تأويل استقرائيّ تحكمه هي، أي أنّ دلالات الحلول تذهب مع الرؤية، لخلق تأويلٍ يستثمر جماليّات المادّة من جانبها الوجدانيّ العاطفيّ، في قولها: أنا المرأة الجنّة التي سقطت من الجنّة.
من الوهلة الأولى نقرأ الوجوديّة الحاصلة في المبتغى التوصيليّ في مفهوم العبارة، كونها تطلب التشبيه في أنا الجنّة، أمّا البقاء أو الخروج من الجنّة فتَمثّل في السقوط، بإيعازٍ من الله بفعل الشهوة التي أسقطت الطاعة. أمّا الإضافة: "وأنا السقوط الجنّة"، فهي زائدة وخاليّة لا تستوفي التمثيل بشيء، على اعتبار أنّ المعنى تحقّق بدءًا.
يقول العلم إنّ الإنسان خُلق من خليّة الماء المهين، كما عُرف عن الأجنّة في القرآن، وإلاّ لا حياة بدونها. والإنسان في خلقه يتأثّر بالمكان حيث وُلد، أمّا الشاذّ في هذه القاعدة فهو الهجين، حيث يتأثّر الشكل والذكاء بما يقتضيه جمالُ الأبويْن والمكانيْن. لكن ومع هذا، ما أن نتعمّق في زوايا ومربّعات النصّ، ذات المجسّات الحسّيّة في جنوحه المتمّم، نجد أنّ السعة في التكرار تُضعف القيمة، فالكثير من الشعراء استعانوا بالأسطورة لتكون المُطيّب الاستعاريّ لمخيال التجسيد المشاعريّ، وجمانة استخدمت التعبير الوسطيّ بين عِلمها بالشيء، وبين تزويق الحكاية بغير الحقيقيّ في قولها: أنا العذراء ليليت، وجه الداعرة اللامرئيّ. ترى؛ هل هي المرأة التي لا تقبل اللقاح فتكون عاقرًا، أم أنّ استدعاء ليليت من الزمن باختلاف المكان، حرّك تقدير المقصود المحاصر أن يكشف عن أنوثتها بواسطة الرمز العامل في مفهوم التوجيه، الجسد المُستوحى إطلاق المشتهى في فضاءات تعدّدت غاياته؟ وحدّاد تفكّ عصيان الرجولة وتدخل مناخاته بإدراك واعٍ في: "لا يتملّص ذكَرٌ من قدري، ولا يريد ذكر أن يتملّص". لو أنّ الشاعرة لم تكرّر "ذكَر" في الجملة الشعريّة الثانية المُلحقة بمساقات الأولى، لكان البديع أكثر إيلافًا، حيث تكون صفات البنية موقعة شفافيّتها بيد التداوليّة بين اللغة والعلوم الفنّيّة، وهذا ما حقّق الفصاحة البنائيّة في تناسل التراكيب الصياغيّة فيما يساق بنية التعابير، بين العبور باللغة إلى الضفّة الأخرى في المعنى الباطن، وبين ما أبانَ في الشكل، لأنّ الشاعرة وظّفت الضمير المتكلّم أن يخرج عن صمته المادّيّ، أي أنّ هناك عناصر موجبة تحقّق الإقناع، والترويج لحرّيّتها المطلقة، وتقديرها "الأنا" في مشكاة التشبيه، بحالتيْن: التجانس والمزاوجة في المعنى الحاصل بين "القدر" وَ "التملّص". والقصد هو أنّ الرؤية التراكميّة عبّرت عن التكثيف والاختصار، في الخصوصيّة المُنتجة للدلالة، التي تتماهى فيها الصورة الحسّيّة في اتّجاهها، من مشاعر تنزع عن ذاتها السرد المباشر، وبهذا نستدلّ من قولنا على أنّ الشاعرة تبحث في بنية الدلالة الصوفيّة في حكمها الجلاليّ القاطع، لذلك فالرجل ما أن تقع عيناه على ليليت الشاعرة حتى ينصهر فيها، أي أنّه يقع في مفاتنها الغاوية موقع الأسير، والرجال أمامها لا تعني أسماءَها بل أفعالها، من حيث نجاعة الشخصيّة وجواباتها، ولكن ذلك لا يطرد، قد تسعى إليه هي إذا أحكمتها وسامته الذكوريّة وأساليبه الذكيّة، فيكون جسده الدفء، وهي الراجفة. وليليت المرأة الأولى، هكذا تقول الشاعرة، وهي الأفعى التي فعلت بآدم معصيته، وكانت هي التفاحة اللامعة المغرية قدسيّتها، وهي روح المرأة بجسد الشيطان، لأنّ الله عاجز على الإيقاع بالشيطان وبها، لأنّهما روحان في جسد واحد، مع أنّ الله خلق الشيطان من النار، وليليت من الطين، "وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين". والشاعرة تقول: حرضتُ رسولتي الأفعى على إغواء آدم بتفاح المعرفة.
هذا لأنّها تمرّدت على العرش وطغت، فرأت الشاعرة أن تجيء بالاعتبار الذي يستعير المعنى، وليس الشخصيّة "ليليت" بحدّ ذاتها، إذ المعنى يجوز، لأنّ تطابق الصفات المتمرّدة في الأحوال الخاصّة تتشابه محسوساتها، إذن؛ المعنى الذي تتشابهان به كلٌّ منهما، أن تُشبع عينيها قبل شهوتها، وفي الوقت ذاته فهي تتمتّع بطاعة الذكور لها بالجوابات الجنسيّة المتكرّرة بصخبها ومجونها وشقاوتها، لأنّها المرأة المجرّدة من جميع القوانين التي ألزمها الله بها، والشاعرة وظّفت ليليت وحاورتها وتقمّصتها وتفاعلت وتلاقحت ببصيرتها وصورتها، فصارت ليليت بالتمنّي، وقولها في هذا المعنى: أنا المرأة القمران ليليت، لا يكتمل أسودهما إلاّ بأبيضهما، لأنّ طهارتي شرارة المجون، وتمنّعي أوّل الاحتمال.
الرؤيا الانقساميّة بين الشاعرة وليليت هو امتداد الزمن، واستدعاء الظاهرة، وتلقين الآخر بتخطّي كلّ الاحتمالات، التي صيغت من شاعرات قبلها وخاصّة الشاعرة الإيرانية "فروغ فرخزاد"، التي تماهت معها جمانة الشاعرة بتناصّ تأثّريّ، في محاكاة لغة التمرّد على المألوف المجتمعيّ، ولكن جمانة توسّعت وتخطّت أحكام الترتيب الفنّيّ المُركّب، فأدخلت المناخ التاريخيّ والفلسفيّ الديالكتيكيّ، والتقاطع المفهوميّ في الجوابات المحصّنة بالفصاحة، وأشاعت في النصّ مصاحبة الانفجاريّة التحويليّة في المباني اللفظيّة وتعابيرها القاطعة، خاصّة إذا قرأنا التشبيه بجهة المعاني المقصودة: "أنا القمران لا يكتمل أسودهما إلا بأبيضهما".
أمام ليليت الشاعرة الأنثى كم يصعب الانتظار؟ بقبولها أو رفضها، ترى، مَن يزور سريرها؟ مَن هو ذاك الذكر؟ وكيف إذا كان تمنّعها أوّل الاحتمال؟
ومن هذا التوليف نتوقّف أمام:
أنا الذهنيّة.
أنا الذات.
أمّا الذهنيّة فهي مجرّدة من الأنانيّة، يحكمها التواضع والتسامح والهدوء والنسبيّة، بينما نجد الذات مُحكمة بالنرجسيّة والمغالاة والادّعاء والخوصيّة المطلقة، وبهذا اختارت الشاعرة شخصيّة ليليت، لأنّها ذاتيّة تستوعب قيمة الذات الإلهيّة في وجودها، فهي تغيب وتظهر في شمال الأرض ومن جنوبها، وفي الوقت ذاته هي الجنّة عذراؤها وشرورها وفسقها واستهتارها. ترى، هل هذا التمثّل يضيف الرغبة والعشق الناجع؟ وإذا كان هكذا، أين يقع الاشتقاق في التكوين الملحميّ الذي تبنّته الشاعرة؟ أهو الوصف أم الاقتباس، أم الحاسّة الإبداعيّة التي استمدّت فاعليّتها من مساق المُدرَكات المتشابهة بشخصيّة ليليت؟ هذا لا يعني أنّ ضياءَها من ضياء ليليت، ولا قدسيّة نفسها من قدسيّة ليليت، وبهذا يصبح التأثّر بالأسطورة ليليت لا معنى له، لأنّ ذات الشاعرة تُعبّر عن الظاهر لا عن الروح التي تظنّها مقدّسة، وهذا الفعل لا يخرج عن كون تداعي الحواسّ، ما هي إلاّ سوى تمنّي لا غير، أي أنّ الذات العرفانيّة لا تتقاطع بالاعتراف أمام العرش، الذي اجتمع الرأي على تسميته بالمقدّس، ومع هذا كلّه، لا ينفي الاعتراف بأنّ الشاعرة ملتقى المعارف، على اعتبار أنّ المبدع يبني كلامه على ما يعلم، ويتأمّل بالتدبير والاستدلال وليس العكس. أفليست هي التي جلست على مقعد شوقي أبو شقرا في الصفحة الثقافيّة في جريدة النهار؟ أمّا والأنوية التي تستكين في شخصيّة الشاعر/ الشاعرة فهو شرّ لا بدّ منه.
الكثير من الشعراء لقحوا قصائدهم بدلالات السفر المجازيّ، متأثّرين بالأسطورة ومواضع عيوبها وفوائدها، يرحلون إلى حيث عتق الزمن، إلى أمكنة لم يصلها العلم بعد، كالسومريّة والبابليّة والفرعونيّة والإغريقيّة، فتكون النصوص أحداثًا لا تفسير لها، مشبعة بالوهم والتقليد، وهكذا فالكثير من الشعراء حَمّلوا قصائدهم على أحد وجهَي الإضافة، فإمّا مُبهَمة، وإمّا تفسيرًا لا مراد فيه، وهذا يجعلنا نتوه في غايات النصّ، فتضيع المحاسنة ونضيع معها. وقد حاول السيّاب أن يطرق باب الفرديّة التشخيصيّة في الأسطورة بتناصّ معيّن، ويتماهى بأصواتها ونوازعها، مُتّبعًا طريقة التقليبات المثيرة مع اختلاف الترتيب، ووزّعها بأسلوب الأصوات التي اشتغل عليها الفراهيدي، كالإبدال والتدغيم، والفرض والتقدير، ونجح السيّاب في هذا. لكن، هل كلّ مَن تناول الأسطورة أصبح سيّابًا؟ سؤال مُحيّر إذا شخّصناه بنبأ المصدريّة ذات الملامح المُركّبة. أمّا إذا شخّصنا الخلل والإبهام والضعف عند شاعرة ما، فتقوم الدنيا على الدارس ولا تقعد، والقصد، أن لا يُفهم من ذلك نفي الشاعرة، فليس هو المُراد، إنّما مُرادنا تبيان جواب المعرفة ما بين المفهوميْن: "التقليد" أم الإبداع؟
ولكن الأمر مع جمانة شاعرة الإغراء والأنوثة المُحيّرة مختلف، من حيث وجوه الإمكان، فرغم نجاحها الانطباعيّ، إلاّ أنّها تتحوّل بفعل ثقافتها، فتكون البديل الآخر في فضاءات مختلفة، وهذا يعود إلى طبيعتها التداوليّة الفنّيّة، ولأنّنا في حوار مع الأسطورة والشاعرة، وما بينهما من دلالات، نحاول أن نكتشف أبعادها وميولها ومغازيها، حيث جاء النصّ الطويل أشبه بسِفر التكوين محفوظًا في دواخل الحكايات، مِزاجيًّا قابلاً للتحوير والمحاسنة، وبعضه غامض في تحوّلاته وانطباعاته، وكأنّي وجدت الشاعرة وقد وقعت فيها ليليت موقع النفس، خاصّة في ملازمة تكرار السياقات الدالّة على خصال المعاني وتفسيراتها، حيث يغدو القريب بعيدًا، والبعيد قريبًا، فلا مكان ولا زمان، أي أنّ "القرب والبعد واحد"، كما عبّر عن هذا الحلاّج، ومِن هذا المبدأ نقف على طبيعة التكرار، الذي يُجسّد الصيغة في اختبار ذات البنية لتوليف المجسّات التشكيليّة في الإيقاعات التي تحكم توافقات النصّ.
مثال:
" جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي مِن تراب خُلقتُ/ مِن التراب خلقني إلهي لأكون الأصل/ خلق الله المرأة مِن التراب في اليوم السابع".
تجسيد ثاني: " أنا ليليت العائدة من سجن النسيان الأبيض، لبؤة السيّد وإلهة الليْليْن / وأعود لأكون لبؤة الضائعين في الأرض / أنا ليليت اللبؤة المغوية / أنا اللبؤة المغوية أعود أعود لأهتك الأسرى وأهلك الأرض" .
تجسيد ثالث: " أنا ليليت إلهة الليْليْن العائدة من منفاها / لبؤة السيّد وإلهة الليليْن / إلهة الليْليْن وملتقى الأضداد / قدر العارفين إلهة الليْليْن".
لاحظ أن البحث عن الجَمال في الذات المبصرة، في حواريّة الصورة الباطنة المهتمّة بتداعيات الأسطورة، قد سوّقت مقصود حاصل التطبيق مشبّهًا مطلقًا، فألغت ذاتها من حقيقتها، وفي الوقت ذاته اِخْتَلَّ نسيج الصفات المستوحاة من بصيرة الحكاية التاريخيّة، التي جعلت منها الشاعرة مصدر الأفعال الدالّة على الإيحاء والإرشاد، من حيث ما أرادته أن يكون هو المراد المقنّع الذي تتصوّره هي حقيقيّة، أي الشكل المعنون بتطابق الإثارة على الأنوثة، من سياق تنظيم وعي إدراك تشابهات في تلاقح المعاني، وبتقديري هذا هو ناتج تكرار الصور الحسّيّة في مفهوم التداعي، الذي يُخصّب الرغبة الجنسيّة في لمعة سقاء الحواسّ، فيكون الجناس لصق بيولوجيّ غُيّب عن الوجود الفنتازيّ الذي تتمتّع به، وما تتّصفه الشاعرة: أي إنّها تعداد تصابي الإثارة الجامحة لما تبتغية الرغبة الأنثويّة، فالشرفة التي طلّت منها الشاعرة على الأسطورة، حقّقت موصوفاتها المتعالية على بنات جنسها، لتكون هي الأكثر معرفة بتداعيات الذكر، وفي الوقت ذاته فالذكر مهما تعالى لا يمكنه "التملّص" منها، فهي التي تمتلك قوّة الاحاطة برغباته عبر لعبتها الأنثويّة، وبهذا تكون قد شبّهت وجسّمت وصوّرت أن لا صورة إلاّ صورتها المرئيّة الملموسة بالحواسّ بين بنات ربيعها، فهي الطيف الذي يتجاوز إدراك الرجل حين يزوره شيطانها ليلاً، لأنّه مكشوف عليها في ظهور التمثيل والحلول، حيث غاياتها هي لا غاياته هو، وبهذا يكون الذكر قد غلبه الوجد وأحاط به الجوى، ولنا في الشعر مرجع في قول الشاعر أبى الحسن النوريّ:
"لا زلتُ أنزلُ من ودادكِ منزلاً/ تتحيّر الألباب عند نزوله".
إذا تأمّلنا أوج التواصل بما يحيط بأطراف الشبه بين مضمون الحكاية، وبين صورة الحدوس الحسّيّة وغاياتها، ترى، هل نحصل على التداخل البينيّ بين المعنى الحقيقيّ وبين المعنى المجازيّ؟ تأكيدًا لا. لماذا؟ أقول: لأنّنا نقرأ ما تكرّر في الكتب السماويّة جميعها في قولها:
جاء في تفسير الكتاب الأوّل أنّي خُلقتُ من تراب.
وهذا لا يهزّ ولا يفاجئ القارئ، لأنّه معلوم للجميع، وأيضًا فهو يُضعف وعي مراتب تقنيّتها الدقيقة والحريصة على ميزان إبداعها، وكأنّه تشكيل تقليديّ خالٍ من الصدمة والاثارة، وقد لخّصتُها فيما تقدّم، بأكاديميّةٍ سهلة التعريف على شكل التجسيد في بنية الوحدة العضويّة، حيث كان باستطاعة الشاعرة العمل على تكثيف تقنيّة الصورة، خاصّة وأنّها اعتمدت التداخل الأسطوريّ، عن شخصيّةٍ مشكوك في وجودها المادّيّ، لأنّ لوليت لم تذكرها الكتب السماويّة، ولا الكتب القريبة من الأنبياء، ولا حتى الفلاسفة الأقربون إلى الأنبياء، كما أقرّته الشاعرة، حتى ممّن تناولها من قبلها مثل: فيكتور هيجو، بلند الحيدري، بودلير، أناتول فرانس، إميل حبيبي، طاغور، والبريكان، فالتكرار سواء كان في الشعر أو القصّة أو الرواية، يكون مذمومًا، لأنّه يُخِلّ من بلاغة النصّ.
ومع كلّ هذا التداخل الهارمونيّ بين التعليل التخييليّ وبين الواقعيّ، الذي يشير إلى إحاطة المعاني بتواصلها التشكيليّ، من خلال الترميزات والتشبيهات في خصوصيّة الأداء الذي يدعم قوّة فصاحة الصورة، نجد الشاعرة قد أماعت توازن بعض وحدات التراكيب الفنّيّة، فهي حذفت المضاف "هي"، وأضافت المضاف إليه، "ليليت"، فجاءت تلك التراكيب المحتدمة وكأنّها رسالة بحثيّة، تتطلّب معالجة الحكاية على أساس جمع خيوط الأحداث، باتّجاه أن تُحاك بمهارة، على مستوى تهذيب البنية الداخليّة للنصّ في تنوّع هذه النقاط:
أولاً: تقيم وحدة المساق التنظيميّ في بنية النصّ فاعليّتها التنظيميّة، على اعتبار أنّ الروى الصوتيّة أسهمت سلفًا، بتنظيم إقامة المعاني على أحوالها.
ثانيًا: من الأصحّ أن لا تخضع التقنيّة للمباشَرَة والتقرير العفويّ، الذي يُضعف من حيويّة الرمز، بل يجب مقايسة الشيء على الشيء بخاصّيّته.
ثالثًا: يجب مراقبة تصوير الشّبه بين المختلفيْن في الزمن والفكر على أساس الجنس، وانتقاله إلى التركيز على انسجام الأصوات والأفكار، التي تتبنّى ملاقحة الموصوف على ما وُصف عليه، لا أن تكون كما الذي يَقبض على الماء بكفّه. ومع هذا فقد حقّقت الشاعرة للتناص شهوته المبصرة بأدقّ التفاصيل، وحوّلت الصفات عند ليليت إلى مطلق جماليّ وفقهيّ، يتناسب مع ما قيل فيها، تتشبّه بالمرأة الناريّة المحوريّة ليليت، الذي ذكر اسمُها في الأساطير القديمة السومريّة منها والبابليّة، وهي تمثل التوحيد والخروج عن طاعة الربّ في قولها:
- أنا المرأة المرأة، الإلهةُ الأمّ والإلهة الزوجة، تخصّبتُ لأمون الابنة وغواية كلّ زمان، تزوّجت الحقيقة والأسطورة لأكون الاثنيْن، أنا دليلة وسالومي ونفرتيتي بين النساء، وأنا ملكة سبأ وهيلانة طروادة ومريم المجدليّة.
يبدو أنّ الشاعرة غفلت عن رابعة العدويّة، وسجاح بنت الحارث، وبرة العدويّة، وزليخة*"، ومع هذا، فالإله كما تقول الكتب هو الله، ولم أقرأ في هذه الكتب "الإلهة الأمّ والزوجة"، حتى إذا جاء الوصف في مجال التشبيه، فهو لا يتّفق لا في المجاز ولا في المستعار، مع أنّها أخذت على التناصّ، وكأنّها تتصوّر التشبيه بالحقيقة، ويحيى بن حمزة اليمني يقول: "حتى يُتَوَهّم أنّه ذو صورة تشاهد". وللتوضح أكثر نقرأ صوت الجلالة في كتاب القرآن، يقول: "قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد". سورة الإخلاص. وهذا في التوحيد والجلالة.
ويقول في مكان آخر يعني المعرفة في سورة القلم: "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)". سورة القلم.
ويقول ويعني اللاّمثيل له وهو في كلّ نفس في سورة الشورى: "ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير." سورة الشورى.
والشاعرة تقول: "الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال."
وتقول في الخلق والتوحيد: "أنا الجنسان ليليت، أنا الجنس المنشود، آخذ لا أعطي، أعيد آدم إلى حقيقته، وإلى حواء ثديها الشرس ليستتبّ منطق الخلق."
وتقول في المعرفة: "أنا الأولى التي لم تكتفِ لأنّها "الوصال الكامل، الفعل والتلقّي."
وتقول في الخلود: "أنا العتمة الأنثى لا الأنثى الضوء، لن يُحصيني تفسير ولن أرضخ لمعنى."
وكما هو معروف، ما ورد في الآيات أعلاه من تفضيل الذات الإلهيّة على الذات البشريّة، فالأولى مُطلقة بتميّزها في النظير والعُقبى والمصير والخلود والمطر والمكان والزمان والخير والشرّ والجهات والمائدة، أمّا المائدة: كان ذاك زمن الخلاف الذي دار بين عيسى المسيح ومخالفيه على المائدة، فقيلت تلك السورة، تُعبّر عن المتّفق مع الأمر الإلهيّ، وسمّيت بسورة المائدة. يقول فيها عن البيان والتنوير: "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ." سورة المائدة.
ويقول في سورة أخرى في الفرض والاخلاص، أي الترغيب والترهيب: "وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ." سورة المائدة.
ومن هذا المنطلق في التبيّن عن ذِكر المائدة، النطق باسم الجلالة والمُهنّد من الكلام وعزّة النور وانبلاج النهار من الليل، وما الأنبياء إلاّ عبيدًا عند الله لأنّه: "السميع البصير، عالم مريد، متكلم فاعل، حيّ قادر*" كما جاء في الذكر.
اتّضح لنا من قراءتنا لهذا النصّ، أنّ التناص تستجيب له المبالغة التي ازدحم بها التأوُّل المتّصل بالممدوح، فغمرت النصّ بعناصر التوهّم والتنزيل والزيادة، وكأنّ لوجود هذه العناصر حاجة لخلق قاعدة فنّيّة تستجيب لها اللعبة الفنّيّة، على اعتبار أنّ الشاعرة اتّخَذَتْ من الدلالة البيْنيّة مصدرًا تأويليًّا مُسْتَفِزًّا، وإن غلبت عليه علّة الطباع العربيّة، التي لا تمنح الصورة الشعريّة اكتساب المعنى مشروعيّته، بما تُمثّله الصور الذهنيّة من تعدّدٍ في قواعدها التشخيصيّة، كونها زخّت في تساقيها الفنّيّ شخصيّتها الانطباعيّة، لتطعيم وجودها التمرّديّ تأثيره المُعلَن، التي أرادت له أن تتّسق به روح المعاصرة، وتستيقظ فيه العناصر التالية:
أوّلاً: النظام الصوتيّ في حرّيّة التشبيه.
ثانيًا: التحرّر من هيمنة القواعد الوضعيّة التي تقيّد بيان التصوّف الروحيّ، بكلّ ما تنشده القناعة زيادة إيمانًا بالشيء.
ثالثًا: إطلاقُ حرّيّة التصرّف بالأصل في إثبات حرّيّة مرضاة التشبيه بالمتعة، وإذا تحقّقت هذه العناصر المُسندة في بُعدها الوجدانيّ المتخيّلة لمثليتها، يكون ناتج تأثير خلايا الجينات اللفظيّة فاعلاً في فيضها الصوتيّ، لأنّ تساقي الأصوات المتخيلة في العقل لا تقاس ببلاغتها اللغويّة، بقدر ما تقاس بتوصيلها الصوتيّ وتأثيره على العاطفة ليكون معقولاً، وهذا يمنحنا مفهوم أنّ الشبه بين جمانة وليليت ينصرف إلى مفهوم ما نستقبله من الأصوات، أمّا مدلول الألفاظ فهو ينصرف إلى بيان النحو، فيكون خال من القيمة في الحوار الروحيّ، والسؤال هنا:
هل البديع عند جمانة مكتسَب ذاتيّ، أم أنّه تساقي من الثقافات الموروثة من العائلة، ومن الجو المحيط، أم أنّ لغة القرآن ألهمت عقل الشاعرة، البلاغة والنجوى، والتكيّف، والموازنة، والتأثر، والمحاصلة، والتبحر، والاصغاء، والخضوع، فكان العشق الروحي، والعزة في المحاسنة، وبلوغ النبوغ في المعاني، والتطلع إلى الكمال. من فعال شخصيتها التي سخرت الأسطورة لتتخذ من جسدها إله يتناص فيه الهوى، بلغة أحصت كل المسوغات الوصفية للتبشير بتمرده، فخصت نثرها بالمشاكلة في المعنى التوليدي بأحوال صيّغها، وبهذا تكون قد وسعت التجنيس على حالتيه: الرمزية والدلالية، على اعتبار الجناس صورة مبصرة.
والجواب:
نعم هو حصيلة المساقات التصويريّة الثبوتيّة المتلاقحة مع المعاني، وليست التلاقي مع الشخصيّة، وإذا أردنا التبحر أكثر في مستقاة الصورة الحسّيّة وتوليفها المستوحى من العمق التعبيريّ المراد إيصال مفهومه بذات الطعم الفلسفيّ، نجد في منازل الكلام تحديد الطباق في قول القرآن: "رب المشرقين ورب المغربين". وممّا هو من قبيل التفسير اختلاف الوقت بين الصيف والشتاء، فإذا قلنا أنّ الشاعرة أخذت ما يناسب الاستعارة لتوليف صيغة معيّنة على رسلها، فلا بأس شرط أن لا يكون المُؤوَّل منه مباشرًا، في ذات السياق المحمول على معناه في قولها: "الليلُ لأنّي النهار، والجهة اليمنى لأنّي الجهة اليسرى، والجنوب لأنّي الشمال".
هذا موضع يجب القبض على أبعاده، حتى إذا تلازم التناص فيه بشكل واضح، من حيث أفاد النصّ التأكيد على الملازمة، لكن السؤال هنا: هل كلّ الشعراء لديهم القدرة على تبيان موضعة الاستعارة في ميزانها، مثلما فعلت جمانة في هذه اللعبة التي اعتمدت الانزياح الدلاليّ، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الصيغ اللغويّة، والغاية من التميّز ممّا يحول دون المطابقة المباشرة والتكرار؟ اللغة بين النصّ القرآنيّ ونصّ الشاعرة موصول بالمعرفة، فإنها إن لم تدرك هذا لم تورده لأنّه مذهب بلاغي، لكن كلامها قد استبان في ملذّاته التي تنسجم مع الذات المعرفيّة في مدادها وعفويّتها.
ونرى تطبيقًا آخر يُناجي بيان التوجه ذاته، الذي يرمز إلى الليل والنهار، ولكن الشاعرة أخذت الحصيلة من المعنى ومزاوجته بتقنيّة حاورت نواصيه، ولكي نكون مُلمّين بفلسفة التناص، نقرأ هذه الآية ونستشرف مقصودها في قوله: "وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ". والشاعرة تقول: والجنوب لأنّي الشمال" مع بعض تبديل مُقنّن الترتيب في تقنيّة الاشتقاق الذي ساقته الشاعرة في قصيدة ليليت أشبه بالجرد التطبيقيّ لامرأة احتوتها الأسطورة، أخذت منه الشاعرة ما يتّفق وتصوّرات الجَمال والتمرّد والحرّيّة واللهو وعاشرته في نصّها، أمّا ما لم يتّفق مع تفكيرها التي حرصت أن لا تتّصف به، فقد أهملته أو غيّرت من سياقه، أمّا والشاعرة فقد برّأت ليليت كونها امرأة عاقرًا، مع أنّ الأسطورة تؤكّد هذا، وهو إحدى صفاتها القاتلة، ولكوْنها عاقرًا كانت "ليليت" تصبّ جام غضبها على الأجنّة، فدعونا نقرأ الشاعرة تتحدّث بحال لسان ليليت في قولها: ولا أسرق الأجنّة من أرحام النساء.
أمّا الخطأ التاريخيّ الزمنيّ في سياق النصّ، أنّ الله عندما خلق حوّاء من ضلع آدم، لم يكن هناك نساء في الحياة غير حواء، فكيف اتّفق أنّ ليليت لم تسرق الأجنّة من رحم النساء، وهي التي تقول: أنا المرأة الأولى" كما قالتها سجاح لقومها عندما ادّعت النبويّة: "أنا المرأة الأولى*"، وتعني أوّل نبيّة في الزمان والمكان ترى، هل هي محاكاة غير منطقيّة للحقيقة المادّيّة، أم تماشيًا مع منطق المثاليّة في الأسطورة؟ لإنّ حقيقة الخلق كما يقول القرآن بدأ بعد أن نزل آدم وحوّاء على الأرض، عندما غادرا الجنّة حتّى موتهما، فكيف تتّفق ثقافة الشاعرة بين قياسات الخطأ في الموروث التاريخيّ، وبين السرد الواقعيّ الذي يراه المؤمنون، إنّ الله مسيرة الحياة، أمّا أنا فبريء من هذا الاعتقاد، لأنّ النظريّة الداروينيّة أقرب إلى الواقع من الروحانيّات في الكتب: "التوراة، الإنجيل، والقرآن." واعتقادي أنّ ما جاء في الكتب السماويّة ما هو إلاّ: أوامر، وتخويف، وإنشاد، وطاعة، للغيب، ولكنّي أعترف في الجانب الآخر، أنّ الجوانب الخيّرة التي أولته تلك الكتب اهتمامًا، كان يَنشد المساواة الإنسانيّة، وعمل الخير، وإلغاء العبوديّة والظلم، وإطلاق حرّيّة الفرد للعيش بسلام، خاصّة في الجانب الذي يهتمّ بكرامة المرأة. إذن؛ ما الذي ينقص المرأة كي تكون ليليت؟
وفي حواريّة أخرى من مجموعة "دعوة إلى عشاء سرّيّ"، ضمّت عشرة قصائد اختلفت في سياقها البنيويّ والإيقاعيّ وهي: "عندما ثمرة صرتُ/ سأحدّثكم عن الطريق/ دعوة إلى عشاء سرّيّ/ على هوى جوعي/ ذات جنون/ تنتظر الملك/ عائدة إليك/ ثمّ أضعته/ امرأة/ حتماً سيأتي".
ومن هذه القصائد سوف أدخل على قصيدة: "عندما ثمرة صرت".
وجدت هذه القصيدة أكثر عمقًا شعريًّا، وأوسع بُعدًا بلاغيًّا، وأرشق فنّيّة. سوف نرى كيف كانت إرهاصات جمانة الشاعرة في زمن كتابة هذه القصيدة:
كنتُ بنتًا عندما ولدتني أمّي تحت ظلّ القمر
لم أبْكِ شأن الأطفال لكنّي أحببتُ أن أكون ذكرًا
ولكي تُطيّبَ خاطري
غسلتني بماء غامض وبأقمطة النقائض لفّتني
وضعتني على الحافّة من كلّ جبل
نذرتني إلى حوّاء الدهشة والتحوّل
وبالعتمة والضوء عجنتني
هيكلا لشياطين الجنّة
غريبة نشأت ولم ينشغل أحد بأفكاري
فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة على ورق ناصع
ثمّ شققتها وخرجت منها
بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض
لم أكن فقط داخل الزمن أو خارجه
في المكانيْن أقمتُ
وتذكّرتُ قبل أن أولد
أنّي أجساد جمّة
وأنّي طويلا نمتُ
وطويلاً عشتُ
وعندما ثمرةً صرتُ
عرفتُ ماذا ينتظرني.
إذا قلنا إنّ اللفظة تنتقل من سياق إلى سياق آخر، بسبب ما تدلّ عليه مراتبها الدلاليّة من طباق خفيّ، وتنتج معنى غير متضادّ بين التسهيم وردّ الإعجاز، فهذا يعني تنشيط العلاقة بين المُحسّنات المعنويّة وبين الصورة، من حيث ترتيب بنيتها الفنية، ومثالنا على هذا التكوين في بيئة الألفاظ، تلك التي استخدمها السيّاب في قصائده، ومنها قصيدة "مطر" من حيث ما اشاعته اللفظة من تعدّد الألق في ثيمة "عيناك .."، وكأنّها صيغت بمُحاسنة تنقّت كسريان الماء بلمعته من حيّز إلى آخر، بين التخيّل وما تتناسل فيه صفة الفعل في معناه، فنقول هذا التنسيق أدّى إلى طباق يُزوّد الدلالة وضوحًا في الخلق البلاغيّ، حيث نجد المعاني قد حقّقت فاعليّتها في ذاتها، لأنّ ما يصرف الكلام الفصيح هو دلالة ماهيّة المُحسّنات اللفظيّة، ومفارق إيقاعاتها، سواء كان في المشابهة، أو جزالة ارهاصاتها، أو مراتب أحوالها.
ورَدُّنا للأصل في قول الشاعرة في مستهلّ قصيدتها: "كنت بنتًا عندما ولدتني أمّي تحت ظل القمر"، نقول اللفظة المفردة، واللفظة الجملة أي "الجمع" بمعنى كامل الجملة، المُعبّرة عن وحدة الدلالة اللفظيّة، التي توعز للمعاني قيمتها مجتمعة في سلّة واحدة، فيكون أصل الدلالة فصلا تقنيًّا يليق بالجودة التعبيريّة على ردّ الإعجاز، فنقول ما يُحسّنه تكافؤ جناس الاشتقاق كـ: أرهف السمع، ووسع الانتباه، وأوجز، وكثف، وهذا ما تؤكّده الخبرة في التنصيص التقنيّ.
ورَدُّنا في المقصود هنا، أنّ كلّ المعاني في هذه الجملة الشعريّة تنحصر في أبعاد الدلالة المتوفّرة في "ظلّ القمر"، أي أنّ "الظلّ" هو المُسنَد إليه، وليس هو المسند، بمعنى أن تلك الولادة حدثت تحت ضوء القمر، في مكان ما به ظلّ، أي أنّنا أسندنا تناسب الظلّ لفعل الولادة، كون الظلّ مُتغيّر، فأصبح المكان والزمان يختصّان بحالة الولادة تلك، وعليه وجدنا المعنى وقد وُلد من باطن ثيمة تمثيل الظلّ، المُعبّر عن قولنا أنّ المُحسّنات اللفظيّة تُعبّر عن نفسها في المفرد وفي الجمع، أمّا ما أرادته الشاعرة من جعل الظلّ يتمثّل به الوعي، فهذا يدلّ على أنّها جعلت للظلّ خصوصيّة، تنشد منها أن تكون مركزًا يُزوّد دلالات الرمز حضوره. إذن؛ أين تكمن خصوصيّة فنون المعاني؟ أهي في النصّ "كيفما حصل"، أم فيما أوعزنا له من شروط تحتسب بها الشاعرة؟
كما قلتُ في بحثي السابق، إنّه "لا يوجد شاعر عظيم بل توجد قصيدة عظيمة"، وإلاّ قلنا إنّ نازك الملائكة هي إلهة الشعر، وبهذا نقول بوضوح إنّ جمانة حداد شاعرة، وأغلب نصوصها متشابهة التوليف، ومخلتفة المقاييس، فإذا خرج نصّ عندها عن سياقه وأسلوبه الأنويّ، فهذا يعني أنّ الشاعرة تفرّدت بذلك النصّ، فأصبحت له خصوصيّته المستقلّة، وإذا أردنا أن ندخل إلى حقيقة العلاقة بينهما، أي بين النصّ والشاعرة، نتبيّن انّهما يلتقيان في بعض النصوص ويبتعدان في أخرى، إمّا بفعل تكرار المجانسة، أو بفعل القوى الناعمة التي تجمع بينهما، فالشاعرة التي تبدأ بالأنويّة ولم تخرج منها، تبقى أسيرة الوجه الواحد للحدث، كقصّة التفاحة، أو الشياطين على أساس فعل التمرّد، أو الجنّة الحدّ الفاصل بين الخير والشرّ، وكأنّهما فرسخان لا يلتقيان، هذا لأنّ الأنويّة المباشرة حين تلبس جبّة التفاخر لا تودّ الخروج منها، لأنّها إمّا أن تُعبّر عن التميّز أو عن الادّعاء، وكِلا الفِعليْن مذمومان.
إذن؛ كيف نحصل على استقلالية النصّ؟ هل ندخل إليه من حيث فعل تمرّد الشاعرة، أم من نبراس ثقافتها التي تجاوزت العادات والتقاليد البدويّة الخانقة، أم هو التصريح بحريق الشهوة كما سارت عليه بعض شاعرات الإيروتيك؟
ولكي نتبيّن المفاضلة، نذهب إلى التعريف التالي في هذه النقاط:
أوّلاً: احتساب نظم البلاغة في حال أن تبلغ التورية مستواها، إذا حاز اللفظ على أكثر من معنى، واختلف في الجناس، واتفق في المقصود البعيد، فهو الذي يبني الصورة من ذاتها، في قولها: "أحببت أن أكون ذكرًا" طباق ظاهر. وقولها في مكان آخر يُزود الدلالة قيمتها: "غسلتني بماء غامض/ وبأقمطة النقائض لفّتني" طباق خفيّ، سياق وضعنا نحن القراء أمام محصّلة ذات تضادّ لاقَحَ المعنى وزوّده بنشاط تحوّلات القصد، ظاهر الكلام يدلّ الفتاة التي تمنّت أن تكون ذكرًا، وباطنه الأمّ المعنيّة بالفاعل، وهو المقصود البعيد.
ثانيًا: نقرأ النقيض في نصوص الشاعرة ومثالنا في قولها: "وبالعتمة والضوء عجنتني". يكون التعلّق المستعار واضحًا يستند إلى بعضه، فالقصد كونها أزاحت المعنى إلى ساح آخر، ألا وهو المثاليّة المُفرطة في صيغة "الروحانيّات" التي طغت على الشعر الصوفيّ، باستثناء الحلاّج فقد بقي يعاصرنا التجديد، في قولها: "هيكلاً لشياطين الجنة"، فالتكرار في الجنّة الغيبيّة، والتفاحة وأسطورتها، والشيطان وعصيانه، والملائكة وشذوذهم، والأنبياء وحجّتهم، والأساطير الكاذبة، والوهم الذي يسرح في خيال الشاعر/ الشاعرة، ربما أصبحت تلك الأدوات تُشكّل ثقلاً لا يتساوى وإبداع جمانة.
ثالثًا: المجانسة الحسنة في قولها: "فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة/ ثمّ شققتها وخرجتُ منها"، أمّا تكملة الصورة الأولى "على ورق ناصع"، هذا الطرف أخذ الصورة إلى تقرير الفكرة الفارغة، فلو جاءت الصورة دون هذا الطرف، لكان في التكثيف من الحسن ما يُغني، أمّا ما جانس الصورتيْن هو نشاط الروح الواثبة في المضمون الفلسفيّ، الذي عدّل التركيب في فصاحته.
وفي هذا المجال يقول الشاعر عمرو بن كلثوم:
بأنا نورد الرايات بيضا ... ونصدّرهن حمرًا قد روينا"،
والقصد في هذا المعنى الدخول إلى المعركة برايات بيضاء، والخروج من المعركة وقد ارتويت تلك الرايات بالدماء، والاستعارة جاءت بما يناسب الرايات إسنادًا، فإنّ بين "نورد" و "نصدّرهن" للراية تناسبًا في الإسناد، أي أنّ اللونيْن هما المُسند للراية، والشاعرة تقول: "بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض"، إذن؛ الأنوية بفِعلها المخفيّ "الذات" قد أسندت اللونيْن الأحمر والأبيض إلى ما تقدّم في النصّ وهو: "فضّلتُ أن أرسم تفاحة الحياة/ ثمّ شققتها وخرجت منها/ بعضي يرتدي الأحمر وبعضي الأبيض"، وبهذا تكون قد ردّت الإعجاز على الصدر الذي هو"رسم التفاحة"، حيث حصل تنامي الروح الشعريّة بفعل الإسناد الأوّل، وهو "الشقّ والخروج"، ولهذا السبب لاقحت الصورة بالفعل المُسند إليه باللونيْن كونهما غير متضادّين، وهو الإسناد الثاني، حين شقّت التفاحة الحمراء وخرجت منها بالأحمر دم المخاض، فالأبيض لون النور والشمس بيضاء، والتقديم والتأخير في اللونيْن يُعبّران عن فطنة وذكاء الشاعرة، لأنّها جسّمت المعرفة على أساسها المعنويّ بوعي متحد، وهيغل يرى "أنّ كلّ شيء هو في تناقض مع ذاته ووجوده، وطبيعة الشيء هي التي تدفعه إلى أن تتجدّد حالة وجوده الى حالة أخرى*"، لأنّ عِلم التعارض يقول، لكلّ فكرة هناك فكرة أخرى مناقضة لها، تؤدّي إلى تشريع صلة الافكار المرتبطة بافكارنا، التي تعمل على توازن المكوّنات بالاتفاق والابتعاد. تارة تلتقي بالمجانسة الحسّيّة، وتارة تلتقي في المعنى أو الفائدة. وهذا واضح في فصيح القول المبنيّ من معناه: " لم أكن فقط داخل الزمن أو خارجه/ في المكانيْن أقمتُ."
السمات التي تمتاز بها جمانة أنّها تميّزت بلغة الجمع المرتّب في المفرد، وقولها: "إنّي أجساد جمّة"، فهي تريد أن تستدعي أسطورة أهل الكهف وكلبهم، وثيمة جمّة تعني معان عديدة، أمّا ما تقصده الشاعرة فهو الجماعة، ولهذا هي أجساد جمّة، والمرادف هو تكملة للتفسير الذي من المفترض أن يجمله البيت الشعريّ، فالبيت الأوّل لفَّ بالبيت الشعريّ الثاني وقولها: "وإنّي طويلاً نمتُ" أي الجمّة، ولأنّ أهل الكهف نومهم لم يُحسب من العمر، فهم نهضوا كما ناموا في عزّ الشباب، وهو تفسير الإيضاح في قولها: "وعندما ثمرة صرتُ/ عرفت ما ينتظرني"، جاءت الجملتان الأخيرتان لكي تُعبّرا عن عطف البيان الذي اقتضى المغايرة في تفعيل المعنى، الذي تريد أن يكون هو حاصل التبيين.
يقول قدامة بن جعفر: "وهو أن يضع الشاعر مَعانيًا يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصفه، فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها، ولا يزيد أو ينقص*". أمّا متى تكون الصورة مجملة، نقول متى يكون القصد في هذه المزاوجة لا يفصل الإجمال في المعنى، فهي الأنا، التي أزاحت التلقّي إليها، لتكون دائمة الحسّ والفتنة والنضوج.
هامش:
1- كتاب بلاغات النساء، لابن طيفور.
2- اقرأ كتاب نقد العقل الخالص، إمانويل كانط
3- أنشودة المطر، بدر شاكر السياب.
4- اقرأ هيغل. كتاب: المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة \ بيروت.
5- اقرأ النظرية النسبية \ البرت انشتاين.
6- صحيح البخاري \ حركات الردة \ للبخاري.
7- اقرأ نقد الشعر ص 135 ، كمال مصطفى.
8- اقرأ كتاب علوم الدين للغزالي المجلد الخامس.
9- نفس المصدر.
10- اقرأ كتاب بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر طيفور.
11- اقرأ كتاب الطراز، الجزء الثالث، لحيى بن حمزة اليمني.
12- اقرأ كتاب علم المنطق، هيغل.
13- هيغل \ نفس المصدر.
14- اقرأ كتاب الخراج قدامة بن جعفر.
15- كتاب القرآن.
= = =