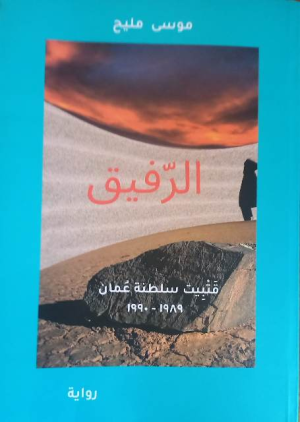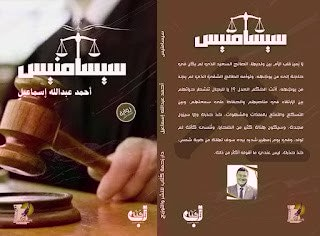غادر طه حسين عالمنا وسط أتون معارك حرب أكتوبر قبل ثلاثين عاماً. وقال عنه توفيق الحكيم, لقد غادرت روحه الحياة بعد أن غادر اليأس روح مصر. في ذكرى هذا الراحل العظيم تقدم (العربي) هذه الذكريات بقلم أديب لبناني كبير.
كنت في حوالي العاشرة من عمري حين قرأت للمرة الأولى كتاب (الأيام) لطه حسين. وقد عشت أسابيع وشهورا مع ذلك الصبي الذي كأنه المؤلف, أعاني ما يعانيه من حزن وألم, أو من رضا وفرح, وأسير إلى جانبه في عالمه الداكن الظلمة من خارج, الناصع الإشراق من داخل, وأتابعه في مراحله الأولى التي كان وعيه يكتمل فيها بالقدر الذي كتب له, فيقبل هذا القدر راضيا, ولكنه يصمم على النضال حتى يجعله قدرا بصيرا, يعوض به عن عاهة العمى التي أصيب بها في طفولته.
وبلغ من تأثير (الأيام) في نفسي وفكري أني تمنيت أن أعيش حداثة كحداثة طه حسين , وأن تتاح لي في المستقبل فرصة كتابة هذه الحداثة - وقد كتبتها بالفعل عام 1958 في روايتي الثانية (الخندق الغميق) - ولست أشك الآن في أن قبولي الالتحاق بالمعهد الديني الذي انتسبت إليه, وأنا في الحادية عشرة, كان مقودا برغبة مكنونة في النفس أن أعيش التجربة التي عاشها ذلك الفتى وأن أعاني معاناة حقيقية ظروفها ومؤثراتها. وكنت على وعي مبكر بأن نعمة البصر التي حُرمها صاحب (الأيام) ربما أتاحت لي من كنوز الأدب والعلم ما لم يكن متاحا له, فانصرفت أغذّي هذا الوهم بقراءات كثيفة في الأدبين العربي والفرنسي, حتى أن رفاقي في المعهد الديني لا يزالون يذكّرونني بأنهم قلّما كانوا يرونني في أوقات الفراغ خارج مكتبة المعهد.
تواصل الأجيال
وكنت أتابع بلهفة كل ما كان يكتبه طه حسين , وأجد فيه حافزا لمزيد من المعرفة أكتسبه, وعزفت عن الدراسة الدينية إلى الأدب الذي كنت أميل إليه. وقد بلغ من طموحي أني بدأت, وأنا بعد في الرابعة عشرة, ترجمة رواية فرنسية أعجبت بها إعجابا عظيما, هي رواية (مولن الكبير) لألين - فورنيه, وبذلت في ترجمتها طوال عام جهدا مضنيا لم تكن تلك السنّ لتحتمله, حتى إذا فرغت من الترجمة ومن تنقيحها, تجرأت فأرسلت بالمخطوطة إلى طه حسين الذي كان مشرفا آنذاك على إصدار (الكاتب المصري) ومنشورات (دار الكاتب المصري). وقد أصابني الذهول حين بلغني أن الدكتور طه وافق على نشر الترجمة, فملأني ذلك اعتزازاً وزهواً, ورحت أنتظر بفارغ الصبر الإعلان عن صدور الكتاب, ولكني فوجئت يوما باحتجاب مجلة (الكاتب المصري) وإغلاق فرع دارها الناشرة.
ولم يفتْ ذلك في عضدي, بل منحني شحنة جديدة من الحماسة لتعميق ثقافتي الأدبية .ولعل الحلم الذي كان يداعبني في السفر إلى فرنسا وإعداد أطروحة دكتوراه في الأدب والإقبال على مناهل الثقافة الفرنسية - لعل حلمي هذا إنما كان صدى خفيّا لرحلة طه حسين إلى فرنسا وفوزه بشهادة الدكتوراه فيها.
بل لعل الأصل في اعتزامي إصدار مجلة (الآداب) وأنا بعد في باريس, كان أملا عندي في أن تحل محل مجلة (الكاتب المصري) التي عنيت عناية خاصة بدراسة نظرية الالتزام في الأدب, هذه النظرية التي أتيح لي أن أتعمقها في العاصمة الفرنسية. وأذكر أني كتبت للدكتور طه حسين رسالة أبلغه فيها نيتي في إصدار المجلة وأورد له خطوطا عامة من سياستها التحريرية, فكتب لي مشجعا. والحق أنه استجاب, فيما بعد, لبضعة استفتاءات طلبت منه أن يشارك فيها, فازددت حبّا له, وجعلت أنتظر الفرصة التي تسمح لي بلقائه.
غير أني كنت أتهيّب مواجهة هذا الرجل العظيم الذي ملأ حداثتي بشخصيته وأدبه, وآثرت أن أنتظر مناسبة عفوية تجمعني به كنت أظنها ستسنح في المؤتمر الأول للأدباء العرب الذي عقد في مصيف بيت مري في لبنان عام 1954. ولكن ظني وظن الكثيرين من الأدباء خاب, حين أرسل الدكتور طه يعتذر عن حضور المؤتمر بسبب موقف غير كريم وقفته منه السفارة اللبنانية في القاهرة آنذاك, كما جاء في كتاب اعتذاره.
وساءني جدا ألا ألقاه, وأسفت لذلك الموقف الذي ربما كان ناشئا عن لبس أو سوء فهم, فاقترحت على جمعية المقاصد الإسلامية, التي كنت أشرف على لجنة المحاضرات فيها, توجيه دعوة خاصة إلى الدكتور طه لإجراء مناظرة مع الأستاذ رئيف خوري (رحمه الله). وقد وافقت الجمعية وأوفدتني إلى القاهرة لمقابلة عميد الأدب العربي.
اللقاء الأول
كان ذلك في أوائل عام 1955. وحين دخلت على الدكتور طه في غرفة مكتبه, كان جسمي يرتعش تهيبا. وزادتني رهبة ألوف المجلّدات التي كانت تكسو جدران مكتبته, وأشعرتني بأني لن أبلغ, مهما بذلت من جهد, ما كان هذا الرجل الجبّار قد بلغه من ثقافة ومعرفة. وبعد أن تحدّثنا قليلا, بحضور سكرتيره فريد شحاتة, قبل الدعوة إلى بيروت وإجراء المناظرة مع رئيف خوري في موضوع (أيكتب الأديب للعامة أم للخاصة). وحين استأذنته بالانصراف, وأنا ممتلئ فرحا بقبوله الدعوة, استوقفني قائلا لسكرتيره.
- فريد, أعد للأستاذ سهيل أمانته القديمة!
فلم أفهم قصده, إلى أن استخرج سكرتيره مغلفا فتحته والأمر ملتبس عليّ, فعرفت فيه مخطوطة ترجمة (مولن الكبير).
قال الدكتور طه وهو يبتسم ابتسامته الهادئة:
- إنني أحتفظ بها منذ أكثر من عشر سنوات. ولعلّك نسيتها, أو ظننت أنها ضاعت. لا يا أستاذ, إننا لا نضيّع جهود الأدباء!
شكرته وأنا أتمتم بعبارات التأثر, وخرجت وقد استطالت في عيني قامته.
كنت حريصا, بعد ذلك, على أن أقوم بزيارة طه حسين كلما قصدت القاهرة. وكان يلقاني دائما بالترحيب والمحبة. وقد توثقت أواصر الصداقة بيننا في أحاديث طويلة حضرت بعضها زوجتي. ولما عرف أنها ترجمت بعض الكتب, جعل يحدّثنا بفرنسية صافية لا تقلّ أناقة عن لغته الأم. ثم تعاقدت معه على بعض كتبه, وكان آخرها (مذكرات طه حسين ) التي يتم فيها جزأي (الأيام).
وأذكر أني قمت بزيارته بعد زيارة قمت بها لصديقي نجيب محفوظ وتعاقدت معه فيها على نشر روايته أولاد حارتنا, وكان يرافقني في هذه الزيارة وكيل مجلة الآداب عديلي السيد فتحي نوفل. ولكني حين زرت الدكتور طه حسين وفي النيّة أن أطلب منه الإذن بنشر مذكرات طه حسين التي كنت قد عثرت عليها منشورة مسلسلة في مجلة المصور المصرية, أبلغت الدكتور طه أني استطعت أن أقنع الأستاذ نجيب محفوظ أخيرا بالسماح بنشر رواية أولاد حارتنا التي كان قد نشرها مسلسلة في الأهرام, وكان يتأبّى إعادة نشرها في كتاب حرصاً على عدم إغضاب الأزهر الذي كانت له اعتراضات على بعض ما جاء فيها. إذ أخبرت الدكتور طه حسين دفعت للأستاذ نجيب محفوظ حقوق الطبعة الأولى من روايته بمبلغ خمسة آلاف جنيه. سألني الدكتور طه وهل دفعت له المبلغ? أجبت: طبعا. فقال طه حسين معلّقاً: يا بختُه! هنا تدخل وكيلي فتحي نوفل قائلا: نحن على استعداد يا سيادة الدكتور لدفع حقوق الطبعة الأولى من مذكرات طه حسين على الفور. فوافق طه حسين على نشر مذكراته هذه بالعنوان المذكور وأخرج من جيب سترته ختما خاصا كان يحمله وقد حفر عليه توقيعه بخط يده, وقال لسكرتيره: اختم للأستاذ سهيل على اتفاق بهذا الشأن مع دار الآداب وهكذا كان.
لقيت الدكتور طه في بعض المؤتمرات الأدبية, ولقيته أكثر من مرة على متن الباخرة التي كانت تقله صيف كل عام إلى أوربا وترسو ساعات في مرفأ بيروت. وكان لا يفتأ يسألني عن (الأصدقاء اللبنانيين) الذين لم يكن ينسى واحدا منهم, ولو لقيه مرة واحدة, بضع دقائق. وقد تأثر تأثرا شديدا لوفاة المرحوم رئيف خوري حين أبلغته إياه, وذكّرني بمناظرته معه قائلا إن أساسها غير صحي أصلا, لأن الأديب يكتب للخاصة والعامة في وقت واحد, وأنه إنما قبل الاشتراك فيها لأنه كان يرغب في زيارة لبنان الذي يحبه, فأجبته بأني كنت أنا كذلك أعي ما في موضوع المناظرة من تكلف, ولكننا كنا في مثل حرصه على أن يلقى المعجبين الكثيرين به في بلدنا.
وفي آخر لقاء به, كان الدكتور طه يتكلّم بجهد ومشقّة وقد اكتسى وجهه صفرة كبيرة. ولاحظت أن تلك الذاكرة العظيمة التي كانت إحدى مزاياه الكبيرة, قد بدأت تخونه, فلم أشأ أن أطيل زيارتي وأكلفه مشقة الحديث, فاستأذنته وأنا أشعر بأن هذا الإنسان الذي قضى حياته كلها في النضال الفكري والجسدي يستسلم أخيرا للقدر.
ولقد حرمتني حرب أكتوبر أن أمشي مع ألوف المحبين والمعجبين, وراء نعش هذا الأديب العظيم والإنسان النبيل, هذا الذي ملأ حياة جيلنا, منذ نعومة أظفاره, بحسّ الكفاح وروح الطموح.
كنت في حوالي العاشرة من عمري حين قرأت للمرة الأولى كتاب (الأيام) لطه حسين. وقد عشت أسابيع وشهورا مع ذلك الصبي الذي كأنه المؤلف, أعاني ما يعانيه من حزن وألم, أو من رضا وفرح, وأسير إلى جانبه في عالمه الداكن الظلمة من خارج, الناصع الإشراق من داخل, وأتابعه في مراحله الأولى التي كان وعيه يكتمل فيها بالقدر الذي كتب له, فيقبل هذا القدر راضيا, ولكنه يصمم على النضال حتى يجعله قدرا بصيرا, يعوض به عن عاهة العمى التي أصيب بها في طفولته.
وبلغ من تأثير (الأيام) في نفسي وفكري أني تمنيت أن أعيش حداثة كحداثة طه حسين , وأن تتاح لي في المستقبل فرصة كتابة هذه الحداثة - وقد كتبتها بالفعل عام 1958 في روايتي الثانية (الخندق الغميق) - ولست أشك الآن في أن قبولي الالتحاق بالمعهد الديني الذي انتسبت إليه, وأنا في الحادية عشرة, كان مقودا برغبة مكنونة في النفس أن أعيش التجربة التي عاشها ذلك الفتى وأن أعاني معاناة حقيقية ظروفها ومؤثراتها. وكنت على وعي مبكر بأن نعمة البصر التي حُرمها صاحب (الأيام) ربما أتاحت لي من كنوز الأدب والعلم ما لم يكن متاحا له, فانصرفت أغذّي هذا الوهم بقراءات كثيفة في الأدبين العربي والفرنسي, حتى أن رفاقي في المعهد الديني لا يزالون يذكّرونني بأنهم قلّما كانوا يرونني في أوقات الفراغ خارج مكتبة المعهد.
تواصل الأجيال
وكنت أتابع بلهفة كل ما كان يكتبه طه حسين , وأجد فيه حافزا لمزيد من المعرفة أكتسبه, وعزفت عن الدراسة الدينية إلى الأدب الذي كنت أميل إليه. وقد بلغ من طموحي أني بدأت, وأنا بعد في الرابعة عشرة, ترجمة رواية فرنسية أعجبت بها إعجابا عظيما, هي رواية (مولن الكبير) لألين - فورنيه, وبذلت في ترجمتها طوال عام جهدا مضنيا لم تكن تلك السنّ لتحتمله, حتى إذا فرغت من الترجمة ومن تنقيحها, تجرأت فأرسلت بالمخطوطة إلى طه حسين الذي كان مشرفا آنذاك على إصدار (الكاتب المصري) ومنشورات (دار الكاتب المصري). وقد أصابني الذهول حين بلغني أن الدكتور طه وافق على نشر الترجمة, فملأني ذلك اعتزازاً وزهواً, ورحت أنتظر بفارغ الصبر الإعلان عن صدور الكتاب, ولكني فوجئت يوما باحتجاب مجلة (الكاتب المصري) وإغلاق فرع دارها الناشرة.
ولم يفتْ ذلك في عضدي, بل منحني شحنة جديدة من الحماسة لتعميق ثقافتي الأدبية .ولعل الحلم الذي كان يداعبني في السفر إلى فرنسا وإعداد أطروحة دكتوراه في الأدب والإقبال على مناهل الثقافة الفرنسية - لعل حلمي هذا إنما كان صدى خفيّا لرحلة طه حسين إلى فرنسا وفوزه بشهادة الدكتوراه فيها.
بل لعل الأصل في اعتزامي إصدار مجلة (الآداب) وأنا بعد في باريس, كان أملا عندي في أن تحل محل مجلة (الكاتب المصري) التي عنيت عناية خاصة بدراسة نظرية الالتزام في الأدب, هذه النظرية التي أتيح لي أن أتعمقها في العاصمة الفرنسية. وأذكر أني كتبت للدكتور طه حسين رسالة أبلغه فيها نيتي في إصدار المجلة وأورد له خطوطا عامة من سياستها التحريرية, فكتب لي مشجعا. والحق أنه استجاب, فيما بعد, لبضعة استفتاءات طلبت منه أن يشارك فيها, فازددت حبّا له, وجعلت أنتظر الفرصة التي تسمح لي بلقائه.
غير أني كنت أتهيّب مواجهة هذا الرجل العظيم الذي ملأ حداثتي بشخصيته وأدبه, وآثرت أن أنتظر مناسبة عفوية تجمعني به كنت أظنها ستسنح في المؤتمر الأول للأدباء العرب الذي عقد في مصيف بيت مري في لبنان عام 1954. ولكن ظني وظن الكثيرين من الأدباء خاب, حين أرسل الدكتور طه يعتذر عن حضور المؤتمر بسبب موقف غير كريم وقفته منه السفارة اللبنانية في القاهرة آنذاك, كما جاء في كتاب اعتذاره.
وساءني جدا ألا ألقاه, وأسفت لذلك الموقف الذي ربما كان ناشئا عن لبس أو سوء فهم, فاقترحت على جمعية المقاصد الإسلامية, التي كنت أشرف على لجنة المحاضرات فيها, توجيه دعوة خاصة إلى الدكتور طه لإجراء مناظرة مع الأستاذ رئيف خوري (رحمه الله). وقد وافقت الجمعية وأوفدتني إلى القاهرة لمقابلة عميد الأدب العربي.
اللقاء الأول
كان ذلك في أوائل عام 1955. وحين دخلت على الدكتور طه في غرفة مكتبه, كان جسمي يرتعش تهيبا. وزادتني رهبة ألوف المجلّدات التي كانت تكسو جدران مكتبته, وأشعرتني بأني لن أبلغ, مهما بذلت من جهد, ما كان هذا الرجل الجبّار قد بلغه من ثقافة ومعرفة. وبعد أن تحدّثنا قليلا, بحضور سكرتيره فريد شحاتة, قبل الدعوة إلى بيروت وإجراء المناظرة مع رئيف خوري في موضوع (أيكتب الأديب للعامة أم للخاصة). وحين استأذنته بالانصراف, وأنا ممتلئ فرحا بقبوله الدعوة, استوقفني قائلا لسكرتيره.
- فريد, أعد للأستاذ سهيل أمانته القديمة!
فلم أفهم قصده, إلى أن استخرج سكرتيره مغلفا فتحته والأمر ملتبس عليّ, فعرفت فيه مخطوطة ترجمة (مولن الكبير).
قال الدكتور طه وهو يبتسم ابتسامته الهادئة:
- إنني أحتفظ بها منذ أكثر من عشر سنوات. ولعلّك نسيتها, أو ظننت أنها ضاعت. لا يا أستاذ, إننا لا نضيّع جهود الأدباء!
شكرته وأنا أتمتم بعبارات التأثر, وخرجت وقد استطالت في عيني قامته.
كنت حريصا, بعد ذلك, على أن أقوم بزيارة طه حسين كلما قصدت القاهرة. وكان يلقاني دائما بالترحيب والمحبة. وقد توثقت أواصر الصداقة بيننا في أحاديث طويلة حضرت بعضها زوجتي. ولما عرف أنها ترجمت بعض الكتب, جعل يحدّثنا بفرنسية صافية لا تقلّ أناقة عن لغته الأم. ثم تعاقدت معه على بعض كتبه, وكان آخرها (مذكرات طه حسين ) التي يتم فيها جزأي (الأيام).
وأذكر أني قمت بزيارته بعد زيارة قمت بها لصديقي نجيب محفوظ وتعاقدت معه فيها على نشر روايته أولاد حارتنا, وكان يرافقني في هذه الزيارة وكيل مجلة الآداب عديلي السيد فتحي نوفل. ولكني حين زرت الدكتور طه حسين وفي النيّة أن أطلب منه الإذن بنشر مذكرات طه حسين التي كنت قد عثرت عليها منشورة مسلسلة في مجلة المصور المصرية, أبلغت الدكتور طه أني استطعت أن أقنع الأستاذ نجيب محفوظ أخيرا بالسماح بنشر رواية أولاد حارتنا التي كان قد نشرها مسلسلة في الأهرام, وكان يتأبّى إعادة نشرها في كتاب حرصاً على عدم إغضاب الأزهر الذي كانت له اعتراضات على بعض ما جاء فيها. إذ أخبرت الدكتور طه حسين دفعت للأستاذ نجيب محفوظ حقوق الطبعة الأولى من روايته بمبلغ خمسة آلاف جنيه. سألني الدكتور طه وهل دفعت له المبلغ? أجبت: طبعا. فقال طه حسين معلّقاً: يا بختُه! هنا تدخل وكيلي فتحي نوفل قائلا: نحن على استعداد يا سيادة الدكتور لدفع حقوق الطبعة الأولى من مذكرات طه حسين على الفور. فوافق طه حسين على نشر مذكراته هذه بالعنوان المذكور وأخرج من جيب سترته ختما خاصا كان يحمله وقد حفر عليه توقيعه بخط يده, وقال لسكرتيره: اختم للأستاذ سهيل على اتفاق بهذا الشأن مع دار الآداب وهكذا كان.
لقيت الدكتور طه في بعض المؤتمرات الأدبية, ولقيته أكثر من مرة على متن الباخرة التي كانت تقله صيف كل عام إلى أوربا وترسو ساعات في مرفأ بيروت. وكان لا يفتأ يسألني عن (الأصدقاء اللبنانيين) الذين لم يكن ينسى واحدا منهم, ولو لقيه مرة واحدة, بضع دقائق. وقد تأثر تأثرا شديدا لوفاة المرحوم رئيف خوري حين أبلغته إياه, وذكّرني بمناظرته معه قائلا إن أساسها غير صحي أصلا, لأن الأديب يكتب للخاصة والعامة في وقت واحد, وأنه إنما قبل الاشتراك فيها لأنه كان يرغب في زيارة لبنان الذي يحبه, فأجبته بأني كنت أنا كذلك أعي ما في موضوع المناظرة من تكلف, ولكننا كنا في مثل حرصه على أن يلقى المعجبين الكثيرين به في بلدنا.
وفي آخر لقاء به, كان الدكتور طه يتكلّم بجهد ومشقّة وقد اكتسى وجهه صفرة كبيرة. ولاحظت أن تلك الذاكرة العظيمة التي كانت إحدى مزاياه الكبيرة, قد بدأت تخونه, فلم أشأ أن أطيل زيارتي وأكلفه مشقة الحديث, فاستأذنته وأنا أشعر بأن هذا الإنسان الذي قضى حياته كلها في النضال الفكري والجسدي يستسلم أخيرا للقدر.
ولقد حرمتني حرب أكتوبر أن أمشي مع ألوف المحبين والمعجبين, وراء نعش هذا الأديب العظيم والإنسان النبيل, هذا الذي ملأ حياة جيلنا, منذ نعومة أظفاره, بحسّ الكفاح وروح الطموح.