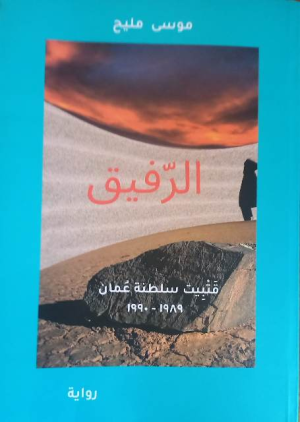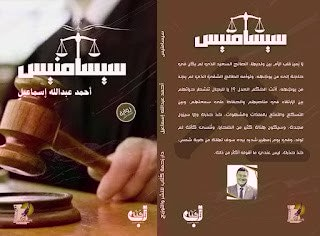من يقرأ دواوين الشاعر العراقي بدر شاكر السياب (1926- 1964)، لا يستطيع أن يخفي مشاعر الإعجاب بهذا «الشاعر الملهم»، كما لا يستطيع إغفال التجربة العميقة التي يتضمنها شعره. ولكن القارئ (أو المتابع) نفسه يشعر بالحيرة حين يقارن بين سيرة الشاعر الخاصة وقامته الشعرية، كأن كل ما كتبه كان تعويضاً عن نقص في حياته، خصوصاً لناحية المرأة والحب، حتى في مواقفه السياسية فقد كان ضائعاً بين الإنتساب الى مجلة «الآداب» والإلتحاق بمجلة «شعر» بين الولاء للشيوعية وتهمة التعامل مع الاستخبارات الأميركية، يعلق الشاعر السوري محمد الماغوط على تهمة السياب في المخابرات الاميركية ساخراً: «لا استطيع تخيل السياب يجلس على كرسي في مقهى بنظارات سود ويراقب المارة». على أن قراءة متأنية لشعر السياب تبيّن احساسه بـ«الحرمان الجنسي» «و«المرأة»، لعل المقال الذي كتبه الشاعر العراقي فاضل العزاوي (صديق السياب) عنه يشكل مدخلا إلى شخصيته.
مدينة غير عابئة بوجوده الشخصي
كتب العزاوي عن ضياع السياب الشخصي داخل مدينة «تعيش غير عابئة بوجوده». هو الآتي من جيكور (القرية) إلى بغداد (المدينة)، كان «يقاوم نظرات نساء بغداد اللواتي لم يكن ليأبهن به كان يدرك تماما أن حوريات البحر في غنائهن العميق لا ينشدن له إطلاقا» (فاضل العزاوي).
لكن ماذا كان يستطيع ان يفعل رجل مريض في قالب جص شبه محنط باعتراف مرافقه محمد الماغوط أمام رغباته الجامحة. فعندما تخرج السياب في المدرسة الإعدادية في البصرة/ الفرع العلمي عام 1942، كان لا يعرف سوى هذه المدينة التي ليست إلا قرية كبيرة، أما بغداد فتلك عالم آخر وقضيّة أخرى. لقد حلم السيّاب مرّة أنه رأى دجلة في المنام، وكتب رسالة إلى صديقه خالد الشواف في 26/3/1943 يتساءل فيها عما إذا كان «دجلة» كما رآه في المنام. وحين كتب إليه الشواف يطلب منه أن يأتي إلى بغداد أجابه بدر بأن «الصبايا العذارى الريفيات يتشبثن ببقائه». ولم يكن هذا هو السبب الحقيقي، فالصبايا الريفيات كنّ أكثر بعدًا عنه من بغداد، إلا أنه أراد أن يتعلل بـ«الوهم»، وأن يستر عجزه عن الذهاب بخدعة رومانسية. وحين جاء السياب إلى بغداد حمل معه حكاياته عن المرأة، إلا أن عالم المرأة في بغداد عالم جديد، والمرأة موجودة مع السياب على مقاعد الدراسة. لقد كان التعليم مختلطًا منذ سنة أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن وجود الفتيات على مقاعد الدراسة مع الشباب لم يكن يعني أن المجتمع تجاوز رواسبه وتقاليده وأعرافه. والحال أن الفتى الريفي - العراقي الحالم بات في بغداد على تماسّ مع امرأة من نوع آخر، تتكلم وتبتسم وتقرأ الشعر وتحب الغزل، ولكن. وإذا كانت صلة السياب بالمرأة الريفية صلة الرعي والحياة البدائية، فإن مدخله إلى المرأة المدنية كان الشعر. وأصبح ديوانه ينتقل إلى مخادع العذارى وينام تحت مخداتهن. لكن المرأة في المدينة ظلّت بعيدة عنه، ذلك إن البنات البرجوازيات و«المدينيات» اللواتي كن يحببن أن يتشبّث بهن شعراً وغزلاً وكلاماً معسولاً كنّ يردن أن يكون ذلك مجرد تسلية. كان بدر يبحث عن «حلم ضائع»، حلم بديل عن أمرأة مثالية هي أمه، لذلك ليس غريبًا أن يصرح بعد سنوات طويلة من المعاناة:
وما من عادتي نكران ماضيّ الذي كانا
ولكن... كل من أحببت قبلك ما أحبّوني
ولا عطفوا عليّ
ويكتب العام 1944 «الى مستعيرات ديوان شعره»: «ديوانُ شعرٍ ملؤه غَزَلُ/ بين العذارى باتَ ينتقلُ/ أنفاسيَ الحرّى تهيمُ على/صفحاتهِ، والحُبُّ والأملُ/ وستلتقي أنفاسُهنَّ بها/ وترفُّ في جنباته القُبَلُ».
هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن السياب وبرغم شعره الغزلي الغنائي الإيقاعي والنديّ والعابق بالصور والمعاني لكنه كان يعيش «عقدة النساء» و«الحرمان الجنسي» و«الحب» تماما كما العديد من الشعراء والشاعرات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ويعرض السياب في شعره قضية قد أثارها وعمق مأساتها وكأنما اراد أن يجعلها قضية تسويقية ليستجلب عطف كلّ من حوله وشفقتهم ومن بينهم النقاد وهي موت أمه. وحين كان يسأل عنها كانـوا يقولـون لـه «ستعود بعد غد»، والمرأة المثالية بالنسبة إليه هي الأم، وأمه بالذات، فلم تتسع حياة بدر وأمه لأن يكبر وتكبر، فلم تبق منها غير صورة الأمومة الرمزية تحيط بها هالة مقدسة تقابلها عند الشاعر صور الحبيبات والعشيقات الحقيقيات والوهميات. واللافت أن الحرمان كان أبدياً في حياة السياب، كان أشبه بالميتافيزيقي حيث نسمعه يقول: «فقدت أمي وما زلت طفلاً صغيراً فنشـأت محروماً من عطف المرأة وحنانها، وكانت حياتي وما تزال كلها بحثاً عمن تسد هذا الفراغ، وكان عمري انتظاراً للمرأة المنشودة، وكان حلمي في الحياة أن يكون لي بيت أجد فيه الراحة والطمأنية». ليس هناك مجال هنا للدخول في بحث مطول حول علاقة السياب بأمه، فقد نود أن نلمح إلى أن هذه العلاقة كان جزءا من محنته الكبيرة وهي علاقته بنفسه وعلاقته بالمرأة عموماً، وكان شعره انعكاسا لشخصيته وألمه ويأسه، فهو النحيل الهزيل في جسمه بينما شعره يتجلى كالمارد لدى القراء وعشاق الأدب، لكن بين سطور أبياته الشعرية نلمح شبح الألم والعذاب والنحيب واللوعة. والراجح ان هزالة جسم السياب انعكست على بعض مواقفه، فلما كتب نصوص كتب «كنت شيوعياً» (صدرت في كتاب عن دار الجمل) ونشرها في احدى الصحف العراقية، لم يتردد في التطرق الى العلاقات الشيوعية والنساء ووصفها بطريقة سخيفة تبرز عقدته النفسية من كل شخص له علاقة حب مع امرأة، كأن الشاعر في الحب يجعله يلقي الاتهامات على الآخرين جزافًا، لم ينتبه السياب أنّه كان يقول:
يا ليتني أصبحتُ ديواني
لأفرّ من حضنٍ الى ثاني
قد بتُّ من حسدٍ أقول له ياليتَ من تهواك تهواني
يقول «خصوم» السياب ان ماهية هذا البيت معروفة، اذ كان ديوان السياب يتنقل من فتاة الى فتاة في معهد المعلمين حيث كان صاحب «أنشودة المطر» طالباً، وهو لم يستطع البوح لاحدهنّ بأنه هو السياب بشخصه الجالس أمامها، حين أعطت رأيها أعجاباً بالديوان، لأنه كان ضعيفاً وعديم الثقة بنفسه امام النساء. ويرى الناقد إحسان عباس إن السياب «انفق حياته القصيرة منذ أن أدرك الحلم الى أن مات، وهو يبحث عن القلب الذي يخفق بحبه، دون أن يجده. كان في قرارة نفسه واعياً بأن الحب في كل مرة كان من جانب واحد». وقد كان جذر هذا الحضور المأزوم للمرأة هو انطلاقته الأولى يتيم الأم منذ الرابعة من عمره وزواج أبيه المبكر، اذ يقول: أبي منه قد جردتني النساء/
وأمي طواها الردى المعجل.
ومن ثم كانت الصدمة المكررة بوفاة جدته أيضا التي ربّته بعد أمه وهو في عمر الثامنة عشرة تقريباً. فخرج السياب إلى ميدان الحياة والشعر وهو يحمل علامة نفسية فارقة ألا وهي احتياجه للمرأة كتعويض وكقصيدة وهي التي «تأتي ولا تأتي» لأن هناك دائما حاجزاً او فاصلاً ما عمرياً وجمالياً وعجزياً بسبب المرض الكامن في الجسد أو وهمياً بانتظار «المرأة الحلم» ولكن كل هذه النساء، نساء الوهم والخيال كان لهن حاضنة نفسية في ذات الشاعر يستدعيها الشعر. ففي قصيدته «شناشيل ابنة الجلبي» يحاول السياب أن يجعل من ابنة الجلبي تلك فتاة حقيقية، فنراه يتغزل بها ويذكرها في شعره، تماماً كما لو كانت تنتمي الى عالم الواقع:
وأبرقتِ السماءُ.. . فَلاَح حيث تعرّجَ النهرُ،
وطاف معلَّقاً من دون اسٍّ يلثم الماءَ
شناشيل ابنة ألجلبي نوّر حوله الزَّهْرُ
(عقود ندىً من اللبْلاب تسطع منه بيضاء)
وآسية الجميلة كمّل الأحداق منها الوجدُ والسَّهَرُ
«ابنة الجلبي» كما يحلو للسياب أن يسميها، ليست امرأة حقيقية، ولا تنتمي إلى عالم السياب الواقعي بل هي من صنع خياله ومن بنات أفكاره، إذ انه كان يرقب من بعيد تلك الشناشيل المزخرفة التي تمثل الثراء والجاه بعين الفقير المحروم عندما كان طفلاً، فتبلورت في ذهن السياب فكرة، مفادها إن وراء هذه الشناشيل، فتاة جميلة، وربما توهم في قرارة نفسه إنها تنظر إليه كما ينظر إليها، وإنها تنتظر لقاءه كما ينتظر، ولعله في نهاية قصيدته، حاول أن يراجع حساباته مرة أخرى، فإذا به يخبرنا بما يشبه الإقرار بالواقع، بأن هذه الفتاة لا أساس لها في دنيا الواقع:
ثلاثون انقضَتّ، وكبرتُ: كم حبٍّ وكم وجدِ
توهج في فؤادي!
غيرَ أني كلما صفقت يدا الرَّعْدِ
مدَدّتُ الطرف أرقب: ربما ائتلق الشناشيلُ
فأبصرتُ ابنة الجلبي مقبلةً إلى وعدي!
ولم أرها، هواءٌ كل أشواقي، أباطيلُ
ونبت دونما ثمر ولا وَرْدِ!
فالسياب بعد مضي ثلاثين عاماً من حياته، يعترف إن هذه الفتاة لم تكن في حقيقتها، إلا وهماً عاشه الشاعر، ويتساءل الناقد إحسان عباس، عن حقيقة هذه الفتاة، ومدى ارتباطها بالواقع، فيقول «ترى أكان للجلبي ابنة أم ان أحلام بدر خلقتها». وهكذا فإن كل نساء السياب يقبعن خلف سور نفسي هو المرتع الشعري الخصب حيث يأتي الشعر من بؤرة العذاب حين تكون المرأة قريبة ولكن كفّ الشاعر لا تصل إليها.
يذكر السياب في قصيدته «أحبيني»(منشورة في ديوانه «شناشيل ابنة الجلبي»، كتبها في 19/3/1963 وهو في باريس في طريق عودته إلى العراق من بريطانيا، بعد أن فشل الأطباء في علاجه هناك). انه أحب قبل محبوبته الأخيرة التي يخاطبها «سبع نساء» ويستدرك قائلا: «ولكنْ ما أحبوني»... الأولى راعية كانت ترعى قطيع أهلها في جيكور (مسقط رأس السيّاب) وهي حبه الأول في الصبا، وعرّفنا الشاعر على اسمها في احدى قصائده المبكرة، وهو «هالة»... وينتهي هذا الحب بأن يعقد أهلها قرانها على رجل من القرية، في غيبة الحبيب الشاعر... ويسرد ببيتين سيرته معها فيقول:
«... آه... فتلك باعتني بمأفونِ/ لأجل المال... ثم صحا فطلقها وخلاّها»
وهناك فتاة تعرّف عليها السياب وهو طالب في دار المعلمين العالية ببغداد كانت تكبره بسبع سنوات فأسقط عليها حباً بنوياً وشملته بحب أمومي، لكن هذا الحب غير المتكافئ ما لبث ان انطفأ... يذكر الشاعر ذلك بقوله «... وتلك لأنها في العمر أكبر أم لأن الحُسن أغراها.../ فباعدت الخطى ونأيت عنها/ كان يلقبها الشاعر بـ«ذات المنديل الأحمر» لأنها تحب أن تضع منديلاً على رأسها، وحول عنقها. وفي سجله الغرامي فتاة يسميها «فتاة الغمازتين» تعرّف عليها في دار المعلمين العالية ايضا وخسرها وهو في نفس الدار، لتدخل سجل القصيدة. يقول «وتلك كأن في غمازتيها يفتح السحرُ/ عيون الفُل واللبلاب/ عافتني الى قصر وسيارة...». ولا ينتهي الأمر في اشكال النساء فيحب واحدة من أصحاب المال بعد انتقاله من قسم اللغة العربية الى قسم اللغة الانكليزية في دار المعلمين العالية، وسوء حظه يكشف له انها ثرية حبابة للمظاهر، وهو فقير وشاعر... فتزوجت من يشبهها. «وتلك وزوجها عبدا مظاهر ليلها سهرُ/ وخمر أو قمار»/ وهناك قصة السياب مع وفيقة والتي تعد من أبرز نماذج «نساء – الحلم» في شعر السياب. (الملاحظ أن المعلومات تتضارب حول أسماء عشيقات السياب بين ما تذكر لميعة عباس عمارة والناقد عيسى بلاطة أو غيرهما).
يرى عيسى بلاطه، إنّ وفيقة كانت قريبة للسياب فهي ابنة صالح السياب، ابن عم جده عبد الجبار، وكانت صبية جميلة في سن الزواج، عندما كان بدر يحلم بها أحلام المراهقة. وقد كانت علاقة السياب بها طيّ الكتمان، وفجأة في أواخر 1960 وبدايات 1961 وكما يقول الكاتب والمترجم جبرا إبراهيم جبرا، يتذكرها وكانت جارته، وشباكها الأزرق مطل على الطريق الذي هو بمحاذاة بيته، وقد أحبها في صباه، إلا أنها ماتت صبية، فأخذ يتصور إبان تلك المدة أن متاعبه سرعان ما ستتلاشى، وإذا بقصائده عن وفيقة تتبلور عن تلك الذكرى أو المعاناة.
لقد بحث السياب عن وفيقة بين طيات ذكرياته فوجدها ماثلة أمامه، فأظهرها في قصائده «شباك وفيقة» و«حدائق وفيقة». لقد رآها مطلّة من خلال شباكها الأزرق على العالم على الرغم من احترام الموت لها. وفي قصيدة «شباك وفيقة» الحّ السياب على وفيقة كي تطل من شباكها، وكأنه في إثناء ذلك يحاول جاهداً كبح جماح الألم، بالعودة نحو الماضي، من خلال حضور وفيقة للقائه مطلة من شباكها الأزرق:
اطلي فشباكك الأزرقُ
سماء تجوع،
تبينتهُ من خلال الدموع
كأني بيَ ارتجفَ الزورق
إذا انشقّ عن وجهك الأسمر
كما انشقّ عن عشتروت المحار
وسارت مع الرَّغو في مئزرِ.
يقول إحسان عباس «إن الحديث عن وفيقة إنما كان حديثاً عن أمه (أم السياب) بطريقة ايحائية، فوفيقة تجمع في طبيعة حياتها وموتها بين بدر وأمه، فهي فتاة ماتت أمها وتركتها يتيمة، كما حدث لبدر ثم توفيت في حال وضع وتركت طفلاً يتيماً، فهي في شخصها تمثل مشكلة بدر، وهي في موتها تمثل الأم». واذ كان احسان عباس قد رجح فرضية حديث السياب عن امه فالشاعرة لميعة عباس عمارة (وهي من «عشيقات» السياب) تقول أن وفيقة لا وجود لها في حياة السياب، ولم يذكر اسمها أمامها، وذكرت لميعة بأن بعض صفات وفيقة تنطبق على لميعة نفسها، «ذكر صفات امرأة تلبس الثوب الاسود وتقف على النهر»، ورجحت لميعة عدم بوح السياب باسمها بسبب غيرة زوجته «إقبال».
والنافل أن علاقة السياب بلميعة عمارة هي من ابرز العلاقات في حياته، فالشاعرة التي عشقها السياب والهمته كتابة العديد من القصائد وكانت من اخلص صديقاته حين بدأت علاقتها به في دار المعلمين العالية التي تخرجت فيها عام 1950 ودعاها لزيارة قريته جيكور وبقيت في ضيافته ثلاثة أيام كانا يخرجان سوية إلى بساتين قريته ويقرأ لها من شعره وهما في زورق صغير. يلتقي السياب بلميعة عمارة، فيحبها. لكن فرّق بينهما الدين، فهو مسلم وهي صابئية، وخصها في قصيدة «أحبيني» بأكبر عدد من الأدبيات: خمسة عشر سطراً يسرد فيها سيرة هذا الحب... الذي كاد يخرجه عن دينه، على الرغم من فشله في النهاية. يقول «... فتذكرني وتبكيني هنالك غير أني لست أبكيها/ كفرت بأمة الصحراء/ ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة او عند واديها».
والغريب في أمر حب السياب كما تقول لميعة عمارة في مقالها «بدر والمرأة» ان ملهمة الشاعر لم تسمع بحبه وشعره لها الا بعد سنوات طويلة من تخرجها. تضيف لميعة كنت ألومه على قسوته. وماذا يريد الشاعر من المرأة التي يحبها غير الالهام؟ وهي تشير إلى قصيدة «اقداح وأحلام» عن حبيبة كانت معه في الصف الأول وقد التحقت بالسفرة الطلابية التي كان فيها السياب. حيث كان الفاصل بينهما كما يراه بدر غناها النسبي وفقره النسبي. يقول سيمون جارجي في كتابه «الرجل والشاعر» ان لميعة كانت ملهمة بدر في اعظم فترة حب في حياته... ولكنها خيبت أمله أيضاً حين اكتشف أنها حلم عابر وأنها ضمن فضاء المستحيل فكتب عام 1948 :
لست انت التي بها تحلم الروح
ولست التي اغني هواها
ويتحدث الكاتب السوري الراحل عاصم الجندي عن لميعة عمارة دون أن يسميها فيقول عن علاقتها بالسيَّاب «ولأنه يوماً ما ذهب في رحلة نهرية مع صديقة، أوجعه حبها كثيراً، وقد استغلته في حياته ومماته، كانت توحي له بميلها إليه ليكتب فيها الشعر، طلباً للإدلال بذلك الشعر الذي قيل فيها وكان ما أسرع ما يلبي النداء ثم استغلته بعد موته. عجنت جسده الموجع بعد رحيله لتصنع منه شهرة سمجة، حتى لبلغ بها التبجّح بحبه لها وشعره فيها أن تقول: كل حبيبات السيَّاب هن من بقاياي». ويعلق الجندي في موضع ثان عن «الليبيدو» الفرويدية عند السيَّاب «وظلت سكين شبقه وحاجته إلى الحنان والحب تعمل في سويداء قلبه حتى الساعات الأخيرة من حياته المعذبة» وقد زعم عبد الوهاب البياتي بحسب الباحث عبد الإله الصايغ أن لميعة عمارة كانت تتغزل به وتعاكسه، وهو ادعاء لا يمكن تصديقه، فالثابت أن السيَّاب توهّم أن حباً يجمع لميعة والبياتي، وهما شيوعيان (كما يظن) فترك الحزب الشيوعي وكتب «المومس العمياء»!! أما عبد الوهاب البياتي فقد هجا لميعة مر الهجاء في ديوانه «ملائكة وشياطين». كان السياب حتى عودته لدار المعلمين «طاهراً» لا يعرف للجسد لذة إلا أن ذلك المجتمع قاده لتجارب الجسد... فزادته الخيانة ألما بل ذهبت به بعيدا لمزيد من الشك والريبة في كل أنثى واتهامها بأنها خائنة. وشاء حظه ان يلتقي بمومس عمياء اسمها (سليمة) فاكتشف من خلالها عالم الليل والبغاء واكتشف اسراراً غريبة واعطانا صورة صادقة لما كانت تعانيه هذه الطبقة من الناس، فكانت قصيدته «المومس العمياء» التي صوّر فيها الواقع الاجتماعي آنذاك وواقع المرأة بصورة خاصة، وتعد هذه القصيدة مرحلة هامه من مراحل حياة السياب يقول فيها: تفاحة عذراء، سوف يطوقان مع السنين
كالحيتين خصور آلاف الرجال المتعبين
الخارجين خروج آدم من نعيم في الحقول
تفاحة الدم والرغيف وجرعتان من الكحول
إلى أن يقول:
يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى
أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح
دفء الربيع وفرحة الحمل الغرير مع الصباح
السادسة من نساء السياب زوجته وقريبته إقبال طه العبد الجليل. اقترن بها العام 1955 وكانت معلمة من خريجات دار المعلمات الاولية. كان قد ترك الشيوعية... وكتب في إقبال مديحاً وهجاء. يقول لها: «ويا إقبال يا بعثي من العدم». ولكنه يشكو منها ويتهم طبعها الفوّار بهدم اعصابه «ولا زوجتي ومزاجها الفوّار لم تنهد أعصابي» ثم انه يتهمها بأنها قدرهُ وانها سبب مرضه: «... وآخرهن آه زوجتي قدري/ أكان الداء/ ليقعدني كأني ميّت سكران لولاها؟». وعندما عاد إلى بيروت في نيسان 1962 أدخل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وبعد محاولات فاشلة لتشخيص مرضه غادر المستشفى بعد أسبوعين من دخوله إليه بعد أن كتب قصيدته الوصية يخاطب فيها زوجته:
إقبال، يا زوجتي الحبيبه
لا تعذليني، ما المنايا بيدي
ولست، لو نجوت، بالمخلد
كوني لغيلان رضى وطيبه
كوني له أبا و أما وارحمي نحيبه
إقبال زوجة السياب الواقعية الوحيدة التي ساعدته على الوقوف بوجه المرض عكس نساء الوهم والخيال، لكن يجمع الباحثون على أن زوجة السياب الواقعية كانت أيضا أقرب إلى الخيال. فقد ارتبط بدر بإقبال في 19 - 6 - 1956 وفضلا عن الرسالة التي بعث بها السياب إلى صديقه الشاعر مؤيد العبد الواحد التي فيها ما يفشي سر ابتعاد الزوجة عن عالم الشاعر «يا مؤيد، نصيحتي اذا ما اردت الاقدام على الزواج ان تكون رفيقة مستقبلك ذات ميل إلى الادب على الأقل، لكي تفهم مشاعرك وتشاركك احساسك» ثم يصرح عن إقبال بقوله «انها لم تفهمني ولم تحاول ان تشاركني احساساتي ومشاعري انها تعيش غير العالم الذي اعيش فيه .. لأنها تجهل ما هو الانسان البائس الذي يمزق نفسه من اجل الغاية التي يطمح إلى تحقيقها الانسان الذي يسمونه الشاعر»... (من كتاب بدر شاكر السياب - حياته وشعره عيسى بلاطة).
كل ذلك كان مقدمات فاشلة وموصوفة في الحب والنساء وصولا إلى الحبيبة السابعة... تؤكد معظم الروايات، أن المخاطبة في قصيدة (أحبيني) هي الشاعرة البلجيكية لوك نوران التي يذكر عيسى بلاطة أنه تعرف إليها في بيروت سنة 1960، واهتمت بترجمة بعض قصائده إلى الفرنسية. وكان التقى بها المرة الأولى في مكتب مجلة «شعر»، ثم اجتمع بها على حدة في مقهى «أنكل سام» وسواه في بيروت ليترجم لها شعره إلى الإنكليزية كي تنقله هي إلى لغتها. وقد أعجبه منها ثقافتها ورقتها وذكاءها. لكنه لم يلتقِ بها ثانية إلاّ في باريس، في طريق عودته إلى العراق من بريطانيا (والقصيدة كتبها في باريس ومؤرخة في 19 /3 /1963) وقد مكث السياب في باريس أُسبوعاً قضى معظمه في الفندق، لأنه لم يكن يستطيع المشي ولم يرد أن يعرض نفسه للبرد الشديد في الخارج. فكان أصدقاؤه يزورونه في غرفته. وكانت الآنسة لوك تمرّ على مكتب الفندق كل صباح فتترك للسياب فيه باقة من الأزهار وهي في طريقها إلى عملها، ثم تزوره في المساء. وكان السياب يظن أن الأزهار من صاحبة الفندق. فلما علم انها من لوك أكبر لها هذا العمل، وكتب فيها قصيدة «ليلة في باريس» في تاريخ 18/3/1963. وعندما قرأها عليها مترجمة إلى الإنكليزية ووصل إلى نهايتها حيث يقول: «وذهبتِ فانسحب الضياء (...)/ لم يبق منك سوى عبير/ يبكي وغير صدى الوداع: «إلى اللقاء/ وتركتِ لي شفقاً من الزهرات جمّعها إناء».
أغرورقت عينا لوك نوران بالدموع، وعانقته وهي تردد: «أأستحقّ أنا كل هذا يا بدر؟» وتوهم في هذا الموقف حباً جديداً، أو دعوة إلى حب ليكتب بعد يوم واحد على «ليلة في باريس» قصيدة أخرى هي «أحبيني» وفيها يخاطب لوك نوران: «وما من عادتي نكرانُ ماضيَّ الذي كانا/ ولكنْ.. كلُّ من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني/ ولا عطفوا عليَّ، عشقت سبعاً كنّ أحياناً/ ترفّ شعورهنَّ عليَّ، تحملني إلى الصين/ (...) فأبحثُ بين أكوام المحار، لعل لؤلؤة ستبزغُ منه كالنجمهْ،/ وإذْ تدمى يدايَ وتُنزَعُ الأظفارُ عنها لا ينزّ هناك غيرُ الماء/ وغيرُ الطين من صَدَفِ المحار، فتقطرُ البسمةْ/ على ثغري دموعاً من قرار القلب تنبثقُ،/ لأن جميع من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني». وفي 15 مارس 1963 طار إلى باريس في طريق العودة إلى الوطن تحت إلحاح زوجته ورسائلها التي تصف الحالة المزرية التي ترزح تحت وطأتها العائلة، وفى باريس عرضه أصحابه بلا جـدوى على عـدد من الأطباء الفرنسيين، وفي 23 مارس 1963 غادر باريس على كرسي متحرك من مطار أورلي وقد ذكرت لوك نوران كيف جاءت هي وأدروار طربيه و ماري جورج وسيمون جارجي لتوديع بدر في المطار فبدا بدر لها وكأنه ذاهب ضد الزمن وضد الموت.
وفي ليلة 21 آب 1964 كتب السياب قصيدة عنوانها «ليلة وداع» أهداها إلى زوجته إقبال وفيها يعبر السياب عن حبه لها وعطفه عليها وشعوره معها في وحدتها ويتمنى لو كان بمقدورها أن تشعر معه ويقول :
آه لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم
ميت الساقين محموم الجبين
تأكل الظلماء عيناي ويحسوها فمي
تائها في واحة خلف دار من سنين
وأنين
من هنا يمكننا وصف السياب بأنه جسد محنط يشتعل برغبات حول نساء مستحيلات.
مدينة غير عابئة بوجوده الشخصي
كتب العزاوي عن ضياع السياب الشخصي داخل مدينة «تعيش غير عابئة بوجوده». هو الآتي من جيكور (القرية) إلى بغداد (المدينة)، كان «يقاوم نظرات نساء بغداد اللواتي لم يكن ليأبهن به كان يدرك تماما أن حوريات البحر في غنائهن العميق لا ينشدن له إطلاقا» (فاضل العزاوي).
لكن ماذا كان يستطيع ان يفعل رجل مريض في قالب جص شبه محنط باعتراف مرافقه محمد الماغوط أمام رغباته الجامحة. فعندما تخرج السياب في المدرسة الإعدادية في البصرة/ الفرع العلمي عام 1942، كان لا يعرف سوى هذه المدينة التي ليست إلا قرية كبيرة، أما بغداد فتلك عالم آخر وقضيّة أخرى. لقد حلم السيّاب مرّة أنه رأى دجلة في المنام، وكتب رسالة إلى صديقه خالد الشواف في 26/3/1943 يتساءل فيها عما إذا كان «دجلة» كما رآه في المنام. وحين كتب إليه الشواف يطلب منه أن يأتي إلى بغداد أجابه بدر بأن «الصبايا العذارى الريفيات يتشبثن ببقائه». ولم يكن هذا هو السبب الحقيقي، فالصبايا الريفيات كنّ أكثر بعدًا عنه من بغداد، إلا أنه أراد أن يتعلل بـ«الوهم»، وأن يستر عجزه عن الذهاب بخدعة رومانسية. وحين جاء السياب إلى بغداد حمل معه حكاياته عن المرأة، إلا أن عالم المرأة في بغداد عالم جديد، والمرأة موجودة مع السياب على مقاعد الدراسة. لقد كان التعليم مختلطًا منذ سنة أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن وجود الفتيات على مقاعد الدراسة مع الشباب لم يكن يعني أن المجتمع تجاوز رواسبه وتقاليده وأعرافه. والحال أن الفتى الريفي - العراقي الحالم بات في بغداد على تماسّ مع امرأة من نوع آخر، تتكلم وتبتسم وتقرأ الشعر وتحب الغزل، ولكن. وإذا كانت صلة السياب بالمرأة الريفية صلة الرعي والحياة البدائية، فإن مدخله إلى المرأة المدنية كان الشعر. وأصبح ديوانه ينتقل إلى مخادع العذارى وينام تحت مخداتهن. لكن المرأة في المدينة ظلّت بعيدة عنه، ذلك إن البنات البرجوازيات و«المدينيات» اللواتي كن يحببن أن يتشبّث بهن شعراً وغزلاً وكلاماً معسولاً كنّ يردن أن يكون ذلك مجرد تسلية. كان بدر يبحث عن «حلم ضائع»، حلم بديل عن أمرأة مثالية هي أمه، لذلك ليس غريبًا أن يصرح بعد سنوات طويلة من المعاناة:
وما من عادتي نكران ماضيّ الذي كانا
ولكن... كل من أحببت قبلك ما أحبّوني
ولا عطفوا عليّ
ويكتب العام 1944 «الى مستعيرات ديوان شعره»: «ديوانُ شعرٍ ملؤه غَزَلُ/ بين العذارى باتَ ينتقلُ/ أنفاسيَ الحرّى تهيمُ على/صفحاتهِ، والحُبُّ والأملُ/ وستلتقي أنفاسُهنَّ بها/ وترفُّ في جنباته القُبَلُ».
هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن السياب وبرغم شعره الغزلي الغنائي الإيقاعي والنديّ والعابق بالصور والمعاني لكنه كان يعيش «عقدة النساء» و«الحرمان الجنسي» و«الحب» تماما كما العديد من الشعراء والشاعرات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ويعرض السياب في شعره قضية قد أثارها وعمق مأساتها وكأنما اراد أن يجعلها قضية تسويقية ليستجلب عطف كلّ من حوله وشفقتهم ومن بينهم النقاد وهي موت أمه. وحين كان يسأل عنها كانـوا يقولـون لـه «ستعود بعد غد»، والمرأة المثالية بالنسبة إليه هي الأم، وأمه بالذات، فلم تتسع حياة بدر وأمه لأن يكبر وتكبر، فلم تبق منها غير صورة الأمومة الرمزية تحيط بها هالة مقدسة تقابلها عند الشاعر صور الحبيبات والعشيقات الحقيقيات والوهميات. واللافت أن الحرمان كان أبدياً في حياة السياب، كان أشبه بالميتافيزيقي حيث نسمعه يقول: «فقدت أمي وما زلت طفلاً صغيراً فنشـأت محروماً من عطف المرأة وحنانها، وكانت حياتي وما تزال كلها بحثاً عمن تسد هذا الفراغ، وكان عمري انتظاراً للمرأة المنشودة، وكان حلمي في الحياة أن يكون لي بيت أجد فيه الراحة والطمأنية». ليس هناك مجال هنا للدخول في بحث مطول حول علاقة السياب بأمه، فقد نود أن نلمح إلى أن هذه العلاقة كان جزءا من محنته الكبيرة وهي علاقته بنفسه وعلاقته بالمرأة عموماً، وكان شعره انعكاسا لشخصيته وألمه ويأسه، فهو النحيل الهزيل في جسمه بينما شعره يتجلى كالمارد لدى القراء وعشاق الأدب، لكن بين سطور أبياته الشعرية نلمح شبح الألم والعذاب والنحيب واللوعة. والراجح ان هزالة جسم السياب انعكست على بعض مواقفه، فلما كتب نصوص كتب «كنت شيوعياً» (صدرت في كتاب عن دار الجمل) ونشرها في احدى الصحف العراقية، لم يتردد في التطرق الى العلاقات الشيوعية والنساء ووصفها بطريقة سخيفة تبرز عقدته النفسية من كل شخص له علاقة حب مع امرأة، كأن الشاعر في الحب يجعله يلقي الاتهامات على الآخرين جزافًا، لم ينتبه السياب أنّه كان يقول:
يا ليتني أصبحتُ ديواني
لأفرّ من حضنٍ الى ثاني
قد بتُّ من حسدٍ أقول له ياليتَ من تهواك تهواني
يقول «خصوم» السياب ان ماهية هذا البيت معروفة، اذ كان ديوان السياب يتنقل من فتاة الى فتاة في معهد المعلمين حيث كان صاحب «أنشودة المطر» طالباً، وهو لم يستطع البوح لاحدهنّ بأنه هو السياب بشخصه الجالس أمامها، حين أعطت رأيها أعجاباً بالديوان، لأنه كان ضعيفاً وعديم الثقة بنفسه امام النساء. ويرى الناقد إحسان عباس إن السياب «انفق حياته القصيرة منذ أن أدرك الحلم الى أن مات، وهو يبحث عن القلب الذي يخفق بحبه، دون أن يجده. كان في قرارة نفسه واعياً بأن الحب في كل مرة كان من جانب واحد». وقد كان جذر هذا الحضور المأزوم للمرأة هو انطلاقته الأولى يتيم الأم منذ الرابعة من عمره وزواج أبيه المبكر، اذ يقول: أبي منه قد جردتني النساء/
وأمي طواها الردى المعجل.
ومن ثم كانت الصدمة المكررة بوفاة جدته أيضا التي ربّته بعد أمه وهو في عمر الثامنة عشرة تقريباً. فخرج السياب إلى ميدان الحياة والشعر وهو يحمل علامة نفسية فارقة ألا وهي احتياجه للمرأة كتعويض وكقصيدة وهي التي «تأتي ولا تأتي» لأن هناك دائما حاجزاً او فاصلاً ما عمرياً وجمالياً وعجزياً بسبب المرض الكامن في الجسد أو وهمياً بانتظار «المرأة الحلم» ولكن كل هذه النساء، نساء الوهم والخيال كان لهن حاضنة نفسية في ذات الشاعر يستدعيها الشعر. ففي قصيدته «شناشيل ابنة الجلبي» يحاول السياب أن يجعل من ابنة الجلبي تلك فتاة حقيقية، فنراه يتغزل بها ويذكرها في شعره، تماماً كما لو كانت تنتمي الى عالم الواقع:
وأبرقتِ السماءُ.. . فَلاَح حيث تعرّجَ النهرُ،
وطاف معلَّقاً من دون اسٍّ يلثم الماءَ
شناشيل ابنة ألجلبي نوّر حوله الزَّهْرُ
(عقود ندىً من اللبْلاب تسطع منه بيضاء)
وآسية الجميلة كمّل الأحداق منها الوجدُ والسَّهَرُ
«ابنة الجلبي» كما يحلو للسياب أن يسميها، ليست امرأة حقيقية، ولا تنتمي إلى عالم السياب الواقعي بل هي من صنع خياله ومن بنات أفكاره، إذ انه كان يرقب من بعيد تلك الشناشيل المزخرفة التي تمثل الثراء والجاه بعين الفقير المحروم عندما كان طفلاً، فتبلورت في ذهن السياب فكرة، مفادها إن وراء هذه الشناشيل، فتاة جميلة، وربما توهم في قرارة نفسه إنها تنظر إليه كما ينظر إليها، وإنها تنتظر لقاءه كما ينتظر، ولعله في نهاية قصيدته، حاول أن يراجع حساباته مرة أخرى، فإذا به يخبرنا بما يشبه الإقرار بالواقع، بأن هذه الفتاة لا أساس لها في دنيا الواقع:
ثلاثون انقضَتّ، وكبرتُ: كم حبٍّ وكم وجدِ
توهج في فؤادي!
غيرَ أني كلما صفقت يدا الرَّعْدِ
مدَدّتُ الطرف أرقب: ربما ائتلق الشناشيلُ
فأبصرتُ ابنة الجلبي مقبلةً إلى وعدي!
ولم أرها، هواءٌ كل أشواقي، أباطيلُ
ونبت دونما ثمر ولا وَرْدِ!
فالسياب بعد مضي ثلاثين عاماً من حياته، يعترف إن هذه الفتاة لم تكن في حقيقتها، إلا وهماً عاشه الشاعر، ويتساءل الناقد إحسان عباس، عن حقيقة هذه الفتاة، ومدى ارتباطها بالواقع، فيقول «ترى أكان للجلبي ابنة أم ان أحلام بدر خلقتها». وهكذا فإن كل نساء السياب يقبعن خلف سور نفسي هو المرتع الشعري الخصب حيث يأتي الشعر من بؤرة العذاب حين تكون المرأة قريبة ولكن كفّ الشاعر لا تصل إليها.
يذكر السياب في قصيدته «أحبيني»(منشورة في ديوانه «شناشيل ابنة الجلبي»، كتبها في 19/3/1963 وهو في باريس في طريق عودته إلى العراق من بريطانيا، بعد أن فشل الأطباء في علاجه هناك). انه أحب قبل محبوبته الأخيرة التي يخاطبها «سبع نساء» ويستدرك قائلا: «ولكنْ ما أحبوني»... الأولى راعية كانت ترعى قطيع أهلها في جيكور (مسقط رأس السيّاب) وهي حبه الأول في الصبا، وعرّفنا الشاعر على اسمها في احدى قصائده المبكرة، وهو «هالة»... وينتهي هذا الحب بأن يعقد أهلها قرانها على رجل من القرية، في غيبة الحبيب الشاعر... ويسرد ببيتين سيرته معها فيقول:
«... آه... فتلك باعتني بمأفونِ/ لأجل المال... ثم صحا فطلقها وخلاّها»
وهناك فتاة تعرّف عليها السياب وهو طالب في دار المعلمين العالية ببغداد كانت تكبره بسبع سنوات فأسقط عليها حباً بنوياً وشملته بحب أمومي، لكن هذا الحب غير المتكافئ ما لبث ان انطفأ... يذكر الشاعر ذلك بقوله «... وتلك لأنها في العمر أكبر أم لأن الحُسن أغراها.../ فباعدت الخطى ونأيت عنها/ كان يلقبها الشاعر بـ«ذات المنديل الأحمر» لأنها تحب أن تضع منديلاً على رأسها، وحول عنقها. وفي سجله الغرامي فتاة يسميها «فتاة الغمازتين» تعرّف عليها في دار المعلمين العالية ايضا وخسرها وهو في نفس الدار، لتدخل سجل القصيدة. يقول «وتلك كأن في غمازتيها يفتح السحرُ/ عيون الفُل واللبلاب/ عافتني الى قصر وسيارة...». ولا ينتهي الأمر في اشكال النساء فيحب واحدة من أصحاب المال بعد انتقاله من قسم اللغة العربية الى قسم اللغة الانكليزية في دار المعلمين العالية، وسوء حظه يكشف له انها ثرية حبابة للمظاهر، وهو فقير وشاعر... فتزوجت من يشبهها. «وتلك وزوجها عبدا مظاهر ليلها سهرُ/ وخمر أو قمار»/ وهناك قصة السياب مع وفيقة والتي تعد من أبرز نماذج «نساء – الحلم» في شعر السياب. (الملاحظ أن المعلومات تتضارب حول أسماء عشيقات السياب بين ما تذكر لميعة عباس عمارة والناقد عيسى بلاطة أو غيرهما).
يرى عيسى بلاطه، إنّ وفيقة كانت قريبة للسياب فهي ابنة صالح السياب، ابن عم جده عبد الجبار، وكانت صبية جميلة في سن الزواج، عندما كان بدر يحلم بها أحلام المراهقة. وقد كانت علاقة السياب بها طيّ الكتمان، وفجأة في أواخر 1960 وبدايات 1961 وكما يقول الكاتب والمترجم جبرا إبراهيم جبرا، يتذكرها وكانت جارته، وشباكها الأزرق مطل على الطريق الذي هو بمحاذاة بيته، وقد أحبها في صباه، إلا أنها ماتت صبية، فأخذ يتصور إبان تلك المدة أن متاعبه سرعان ما ستتلاشى، وإذا بقصائده عن وفيقة تتبلور عن تلك الذكرى أو المعاناة.
لقد بحث السياب عن وفيقة بين طيات ذكرياته فوجدها ماثلة أمامه، فأظهرها في قصائده «شباك وفيقة» و«حدائق وفيقة». لقد رآها مطلّة من خلال شباكها الأزرق على العالم على الرغم من احترام الموت لها. وفي قصيدة «شباك وفيقة» الحّ السياب على وفيقة كي تطل من شباكها، وكأنه في إثناء ذلك يحاول جاهداً كبح جماح الألم، بالعودة نحو الماضي، من خلال حضور وفيقة للقائه مطلة من شباكها الأزرق:
اطلي فشباكك الأزرقُ
سماء تجوع،
تبينتهُ من خلال الدموع
كأني بيَ ارتجفَ الزورق
إذا انشقّ عن وجهك الأسمر
كما انشقّ عن عشتروت المحار
وسارت مع الرَّغو في مئزرِ.
يقول إحسان عباس «إن الحديث عن وفيقة إنما كان حديثاً عن أمه (أم السياب) بطريقة ايحائية، فوفيقة تجمع في طبيعة حياتها وموتها بين بدر وأمه، فهي فتاة ماتت أمها وتركتها يتيمة، كما حدث لبدر ثم توفيت في حال وضع وتركت طفلاً يتيماً، فهي في شخصها تمثل مشكلة بدر، وهي في موتها تمثل الأم». واذ كان احسان عباس قد رجح فرضية حديث السياب عن امه فالشاعرة لميعة عباس عمارة (وهي من «عشيقات» السياب) تقول أن وفيقة لا وجود لها في حياة السياب، ولم يذكر اسمها أمامها، وذكرت لميعة بأن بعض صفات وفيقة تنطبق على لميعة نفسها، «ذكر صفات امرأة تلبس الثوب الاسود وتقف على النهر»، ورجحت لميعة عدم بوح السياب باسمها بسبب غيرة زوجته «إقبال».
والنافل أن علاقة السياب بلميعة عمارة هي من ابرز العلاقات في حياته، فالشاعرة التي عشقها السياب والهمته كتابة العديد من القصائد وكانت من اخلص صديقاته حين بدأت علاقتها به في دار المعلمين العالية التي تخرجت فيها عام 1950 ودعاها لزيارة قريته جيكور وبقيت في ضيافته ثلاثة أيام كانا يخرجان سوية إلى بساتين قريته ويقرأ لها من شعره وهما في زورق صغير. يلتقي السياب بلميعة عمارة، فيحبها. لكن فرّق بينهما الدين، فهو مسلم وهي صابئية، وخصها في قصيدة «أحبيني» بأكبر عدد من الأدبيات: خمسة عشر سطراً يسرد فيها سيرة هذا الحب... الذي كاد يخرجه عن دينه، على الرغم من فشله في النهاية. يقول «... فتذكرني وتبكيني هنالك غير أني لست أبكيها/ كفرت بأمة الصحراء/ ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة او عند واديها».
والغريب في أمر حب السياب كما تقول لميعة عمارة في مقالها «بدر والمرأة» ان ملهمة الشاعر لم تسمع بحبه وشعره لها الا بعد سنوات طويلة من تخرجها. تضيف لميعة كنت ألومه على قسوته. وماذا يريد الشاعر من المرأة التي يحبها غير الالهام؟ وهي تشير إلى قصيدة «اقداح وأحلام» عن حبيبة كانت معه في الصف الأول وقد التحقت بالسفرة الطلابية التي كان فيها السياب. حيث كان الفاصل بينهما كما يراه بدر غناها النسبي وفقره النسبي. يقول سيمون جارجي في كتابه «الرجل والشاعر» ان لميعة كانت ملهمة بدر في اعظم فترة حب في حياته... ولكنها خيبت أمله أيضاً حين اكتشف أنها حلم عابر وأنها ضمن فضاء المستحيل فكتب عام 1948 :
لست انت التي بها تحلم الروح
ولست التي اغني هواها
ويتحدث الكاتب السوري الراحل عاصم الجندي عن لميعة عمارة دون أن يسميها فيقول عن علاقتها بالسيَّاب «ولأنه يوماً ما ذهب في رحلة نهرية مع صديقة، أوجعه حبها كثيراً، وقد استغلته في حياته ومماته، كانت توحي له بميلها إليه ليكتب فيها الشعر، طلباً للإدلال بذلك الشعر الذي قيل فيها وكان ما أسرع ما يلبي النداء ثم استغلته بعد موته. عجنت جسده الموجع بعد رحيله لتصنع منه شهرة سمجة، حتى لبلغ بها التبجّح بحبه لها وشعره فيها أن تقول: كل حبيبات السيَّاب هن من بقاياي». ويعلق الجندي في موضع ثان عن «الليبيدو» الفرويدية عند السيَّاب «وظلت سكين شبقه وحاجته إلى الحنان والحب تعمل في سويداء قلبه حتى الساعات الأخيرة من حياته المعذبة» وقد زعم عبد الوهاب البياتي بحسب الباحث عبد الإله الصايغ أن لميعة عمارة كانت تتغزل به وتعاكسه، وهو ادعاء لا يمكن تصديقه، فالثابت أن السيَّاب توهّم أن حباً يجمع لميعة والبياتي، وهما شيوعيان (كما يظن) فترك الحزب الشيوعي وكتب «المومس العمياء»!! أما عبد الوهاب البياتي فقد هجا لميعة مر الهجاء في ديوانه «ملائكة وشياطين». كان السياب حتى عودته لدار المعلمين «طاهراً» لا يعرف للجسد لذة إلا أن ذلك المجتمع قاده لتجارب الجسد... فزادته الخيانة ألما بل ذهبت به بعيدا لمزيد من الشك والريبة في كل أنثى واتهامها بأنها خائنة. وشاء حظه ان يلتقي بمومس عمياء اسمها (سليمة) فاكتشف من خلالها عالم الليل والبغاء واكتشف اسراراً غريبة واعطانا صورة صادقة لما كانت تعانيه هذه الطبقة من الناس، فكانت قصيدته «المومس العمياء» التي صوّر فيها الواقع الاجتماعي آنذاك وواقع المرأة بصورة خاصة، وتعد هذه القصيدة مرحلة هامه من مراحل حياة السياب يقول فيها: تفاحة عذراء، سوف يطوقان مع السنين
كالحيتين خصور آلاف الرجال المتعبين
الخارجين خروج آدم من نعيم في الحقول
تفاحة الدم والرغيف وجرعتان من الكحول
إلى أن يقول:
يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى
أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح
دفء الربيع وفرحة الحمل الغرير مع الصباح
السادسة من نساء السياب زوجته وقريبته إقبال طه العبد الجليل. اقترن بها العام 1955 وكانت معلمة من خريجات دار المعلمات الاولية. كان قد ترك الشيوعية... وكتب في إقبال مديحاً وهجاء. يقول لها: «ويا إقبال يا بعثي من العدم». ولكنه يشكو منها ويتهم طبعها الفوّار بهدم اعصابه «ولا زوجتي ومزاجها الفوّار لم تنهد أعصابي» ثم انه يتهمها بأنها قدرهُ وانها سبب مرضه: «... وآخرهن آه زوجتي قدري/ أكان الداء/ ليقعدني كأني ميّت سكران لولاها؟». وعندما عاد إلى بيروت في نيسان 1962 أدخل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وبعد محاولات فاشلة لتشخيص مرضه غادر المستشفى بعد أسبوعين من دخوله إليه بعد أن كتب قصيدته الوصية يخاطب فيها زوجته:
إقبال، يا زوجتي الحبيبه
لا تعذليني، ما المنايا بيدي
ولست، لو نجوت، بالمخلد
كوني لغيلان رضى وطيبه
كوني له أبا و أما وارحمي نحيبه
إقبال زوجة السياب الواقعية الوحيدة التي ساعدته على الوقوف بوجه المرض عكس نساء الوهم والخيال، لكن يجمع الباحثون على أن زوجة السياب الواقعية كانت أيضا أقرب إلى الخيال. فقد ارتبط بدر بإقبال في 19 - 6 - 1956 وفضلا عن الرسالة التي بعث بها السياب إلى صديقه الشاعر مؤيد العبد الواحد التي فيها ما يفشي سر ابتعاد الزوجة عن عالم الشاعر «يا مؤيد، نصيحتي اذا ما اردت الاقدام على الزواج ان تكون رفيقة مستقبلك ذات ميل إلى الادب على الأقل، لكي تفهم مشاعرك وتشاركك احساسك» ثم يصرح عن إقبال بقوله «انها لم تفهمني ولم تحاول ان تشاركني احساساتي ومشاعري انها تعيش غير العالم الذي اعيش فيه .. لأنها تجهل ما هو الانسان البائس الذي يمزق نفسه من اجل الغاية التي يطمح إلى تحقيقها الانسان الذي يسمونه الشاعر»... (من كتاب بدر شاكر السياب - حياته وشعره عيسى بلاطة).
كل ذلك كان مقدمات فاشلة وموصوفة في الحب والنساء وصولا إلى الحبيبة السابعة... تؤكد معظم الروايات، أن المخاطبة في قصيدة (أحبيني) هي الشاعرة البلجيكية لوك نوران التي يذكر عيسى بلاطة أنه تعرف إليها في بيروت سنة 1960، واهتمت بترجمة بعض قصائده إلى الفرنسية. وكان التقى بها المرة الأولى في مكتب مجلة «شعر»، ثم اجتمع بها على حدة في مقهى «أنكل سام» وسواه في بيروت ليترجم لها شعره إلى الإنكليزية كي تنقله هي إلى لغتها. وقد أعجبه منها ثقافتها ورقتها وذكاءها. لكنه لم يلتقِ بها ثانية إلاّ في باريس، في طريق عودته إلى العراق من بريطانيا (والقصيدة كتبها في باريس ومؤرخة في 19 /3 /1963) وقد مكث السياب في باريس أُسبوعاً قضى معظمه في الفندق، لأنه لم يكن يستطيع المشي ولم يرد أن يعرض نفسه للبرد الشديد في الخارج. فكان أصدقاؤه يزورونه في غرفته. وكانت الآنسة لوك تمرّ على مكتب الفندق كل صباح فتترك للسياب فيه باقة من الأزهار وهي في طريقها إلى عملها، ثم تزوره في المساء. وكان السياب يظن أن الأزهار من صاحبة الفندق. فلما علم انها من لوك أكبر لها هذا العمل، وكتب فيها قصيدة «ليلة في باريس» في تاريخ 18/3/1963. وعندما قرأها عليها مترجمة إلى الإنكليزية ووصل إلى نهايتها حيث يقول: «وذهبتِ فانسحب الضياء (...)/ لم يبق منك سوى عبير/ يبكي وغير صدى الوداع: «إلى اللقاء/ وتركتِ لي شفقاً من الزهرات جمّعها إناء».
أغرورقت عينا لوك نوران بالدموع، وعانقته وهي تردد: «أأستحقّ أنا كل هذا يا بدر؟» وتوهم في هذا الموقف حباً جديداً، أو دعوة إلى حب ليكتب بعد يوم واحد على «ليلة في باريس» قصيدة أخرى هي «أحبيني» وفيها يخاطب لوك نوران: «وما من عادتي نكرانُ ماضيَّ الذي كانا/ ولكنْ.. كلُّ من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني/ ولا عطفوا عليَّ، عشقت سبعاً كنّ أحياناً/ ترفّ شعورهنَّ عليَّ، تحملني إلى الصين/ (...) فأبحثُ بين أكوام المحار، لعل لؤلؤة ستبزغُ منه كالنجمهْ،/ وإذْ تدمى يدايَ وتُنزَعُ الأظفارُ عنها لا ينزّ هناك غيرُ الماء/ وغيرُ الطين من صَدَفِ المحار، فتقطرُ البسمةْ/ على ثغري دموعاً من قرار القلب تنبثقُ،/ لأن جميع من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني». وفي 15 مارس 1963 طار إلى باريس في طريق العودة إلى الوطن تحت إلحاح زوجته ورسائلها التي تصف الحالة المزرية التي ترزح تحت وطأتها العائلة، وفى باريس عرضه أصحابه بلا جـدوى على عـدد من الأطباء الفرنسيين، وفي 23 مارس 1963 غادر باريس على كرسي متحرك من مطار أورلي وقد ذكرت لوك نوران كيف جاءت هي وأدروار طربيه و ماري جورج وسيمون جارجي لتوديع بدر في المطار فبدا بدر لها وكأنه ذاهب ضد الزمن وضد الموت.
وفي ليلة 21 آب 1964 كتب السياب قصيدة عنوانها «ليلة وداع» أهداها إلى زوجته إقبال وفيها يعبر السياب عن حبه لها وعطفه عليها وشعوره معها في وحدتها ويتمنى لو كان بمقدورها أن تشعر معه ويقول :
آه لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم
ميت الساقين محموم الجبين
تأكل الظلماء عيناي ويحسوها فمي
تائها في واحة خلف دار من سنين
وأنين
من هنا يمكننا وصف السياب بأنه جسد محنط يشتعل برغبات حول نساء مستحيلات.