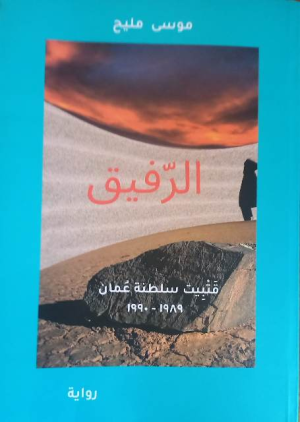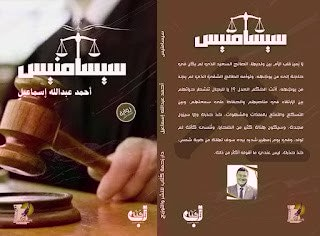النص
الوثن
قصة قصيرة للأديب محسن الطوخي
مساقاً كنت إلى الجنوب، كالأشياء القدرية كانت رحلتي، كالحياة والموت، نظًرتْ أمي فى عينيَ وتمتمت: ترحل وما أتيت إلا لنهارين وليلة؟
أشحت بعيني بعيداً: سألتقي بصديق. لم أقل لها شيئاً عن الأشياء القدرية .
................
عندما رأى أحد الرفاق عين الوثن الوحيدة، نصف مفتوحة، نصف مغمضة، عاد وحكى، حدد خط الطول، وحدد خط العرض، ولم يدر أن الوثن كان منذ الأمس صائماً، فسمح لعينه الوحيدة، أن تطل - حمراء واهنة - من فرجة بين التلال، فى تلك المرة، عند انبلاج الفجر، أفطر الوثن بمائة رجل، نصفهم من ذوي الدماء الحمراء، ونصفهم من ذوي الدماء الزرقاء، وصحن، وعجن، أطناناً من الصلب القوي، فالوثن، يهوى اللهو بالصلب القوي.
.............
كنتُ قد فارقتُ الرجال، لا أعرف مَنْ منهم سيبقى حياً حتى أعود، والقرابين لم تزل تقدم كل ليلة، والوثن لا يكاد يرتوي، يصحو فى عمق الليل، أما فى النهار فيغفو، يميل برأسه خلف التلال، ويتوارى فى بقع الظل، ينكمش، ويوزع نفسه فى الحفر، ويتمدد فى الوديان، وفى مجاري السيول، وعندما تميل الشمس للغروب، يفتح عينه الحمراء، يلملم نفسه من الحفر، وينهض بجوعه الأبدي، نراه على مدى البصر، هناك، بعيداً عند الأفق، كأطياف سرابٍ خيالية, ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر، وهو يتسلل متمسحاً بميول التباب المعتمة، تلتقي أعيننا عند مغيب الشمس، وللقرابينَ طقوس نعرفها كلنا، قبضة اليد على الصلب البارد، الضحكة المبتورة، نظرة تتمسح بالمكان، ويبتلع الليل الخطوات الحذرة فى رحلة للمجهول.
................
بالأمس فقط، كان " عبد الصمد " القربان الأخير، دفء جسدهِ في القلادة المعدنية، كان رفيقي وأنا أعبر الطريق الرملى الملتوى، أطبق كفي على دفء المعدن البارد، بينما تتزاحم فى رأسى الأفكار، هل قدر لى حقاً أن أرى الأهل ؟، الولد، والأب الضرير، والطاحون، والحقول.
.................
قبل أن أطلق كفه قلت له: كن على حذر.
معزوفة اللسان الطويلة ترَكَزَتْ فى نظرة العين، فالوقت قد أزف. الوثن باق، يؤكد ذلك عزم العين المسددة، لا يدرك الجنوبى أن الوثن باق، سيميل، ينزع شوكة من الطرف المتلكىء.
لو فعلت ذلك ياعبد الصمد، سيستدير الوثن، يلقم يمناك، ثم يطوحها مخضبة، مهتوكة الأنسجة، فهو لا يهتم باللقم الصغيرة،
فكن على حذر .. كن على حذر.
.........................
صوت القطار الصاخب كان هو الصوت الوحيد الذى رافقني طوال رحلتى إلى الجنوب، أعرف أنى ذاهب للقائه فى بلدته الجنوبية، أعرف أيضاً أنه ليس هناك. ودفءُ القلادة تسرب من يدي. حكى لي "عبد الصمد" فى الليالي القمرية، عن المعدية التى سأستخدمها عندما يصل القطار مع الغروب، حكى لي عن الأرض السمراء، وصفّ أشجار الجازورينا التي تحرس مدخل القرية، قال عنها :
- أربعون شجرة، كل واحدة لي معها حكاية، كل واحدة بينها وبيني سر صغير.
...................
صحت به: لا تفعل ... كُنْ على حذر... خرج الصوت كالفحيح، أما هو فلم يتوقف، صوب بندقيته وأطلق وابلاً من النيران، بينما كنت أجاهد لأرفع صوتي، كانت الغريزة والمران الطويل أقوى أثرا،ً فلم أقترب، ضاع الصوت المجروح، حملته الريح فى الاتجاه الآخر، في اللحظة التالية كان علي أن أنغرس فى الرمال الباردة .
إيه ياعبد الصمد .. كان يجب أن يسبق الفعل تدبير، وها نحن مكشوفو الصدور،
وأنت لم تكد تفيق من فورة الغضب، حتى اكتشفت أن أوان التدبير قد فات،
والأمتار القليلة التى تفصل بيننا، دونها الدم والحديد والنار. وأنا الذي وعيت الدرس، أين أذهب من نظراتك التى لا تفهم؟
ماذا يجدي الصدرَ العاري الصدرُ العاري ؟
...............
منذ فارقَتْ كفُ الرقيبِ كتفي مودعاً، وبين أصابعى قلادة معدنية تحمل رقماً، وفى جيبى صورة الولد، مهوش الشعر، يحملق فى عدسة المصور . سرت البرودة فى أطرافى، سيحملق فيَّ الولدُ بنفس العينين.
................
يأتي السعالُ من الداخل، والبيتُ يتصاعد فيه دُخْانُ الفرن، تحاصرني الأعينُ الذاهلة. وقع الخبر الجاثم فوق الأذهان يحلق كطيور البحر، الصرخةُ الملتاعة تذهب وتعود مضفورةٌ بحبال اليأس، والمرأةُ الشابة تحثو طين الأرض، والولدُ الغافلُ يلهو بقلادة.
جئتُ ياصديقي لكى ألقاكَ فى هذه العيون الذاهلة، والولد لم يعد يحبو، غافلكَ وسار على قدمين. لو أقدرُ أن أمضي عمري بسريرةِ طفلٍ لاهٍ، أن أنسى أحزان الأم، والأخت، والجدة.
..................
حين عدتُ إلى بلدتى، ويممتُ شطرَ الحقلِ، شممتُ رائحةَ عرقهِ فى الممرات الضيقة بين الزراعات، وحين أمسكتُ بفأسى، رأيتُ بصمات أصابعه، وحين ملتُ على ماءِ النهر، عكستْ المياه الخالية من الطمى صورته. على مدخل بيتي كان واقي الرأس المموه بالبقع الملونة يعلو فوهة البندقية المستندة إلى الجدار، بالقرب منها كان هو بجسده الضخم متمدداً فى استرخاء، عاقداً ذراعيه فوق صدره، مغمض العينين، يبتسم، شأنه حين يكتشف بعد لجاج أنه على خطأ. حين ملتُ عليه بدهشة، لم يعد هناك، كان مدخل بيتي أيضا قد اختفى، والطريقُ المترب الذى خلفته ورائي غاب فى الظلمة، وكل ماكنت أعتقد أنى أعرفه من معالم بلدتي الهادئة، بتُّ أُدرِكُ أنه شركٌ يستوجب الحذر، وأنى فى اللحظة التالية قد أرى الذيلَ ذا الحرافيش ينسحبُ بخفة، ينعكس على استدارة أجنابه ضوءُ القمرِ الشاحب.
****
الدراسة
الوثن
هذا هو النص الرمزي المذهل ذو الصورة السريالية الذي يتغلل في قارئه ليس كمنظومة سردية متناغمة ،فحسب بل كحالة إنسانية تستقصي فهمًا ذاتيًا لمعاناتها ضمن معاناة (الآخر ) ورمزية إسقاطه على الوجود الفلسفي للإنسان أولا وللوطن ثانيا ثم ارتباطه الباطني بإشكالية الرمز (الوثن) ودلالاته، حين يتجذر في مفاهيم مألوفة بشكل يجبر القارئ على استعادة النص بمذاقات تختلف عند كل قراءة جديدة ،تنتج نصًا شموليًا يلامس كل وجدان ويمر بشغاف كل روح لأنه يشحن الزخم البشري النفسي الملتصق بمفاهيم الموت والحياة والحروب والفقد.
براعة السرد ولغة الخطاب
لقد أبدع الكاتب في استهلاله خلق حالة الغموض الباطنية التي تشد القارئ إلى مفهوم التدخل القدري وتوقِعه في براثن التخبط بين ما هو معلن ( سارد غريب يزور مسقط رأسه) وبين ما هو على وشك الحدوث (مرتحل إلى الجنوب في مهمة) ، حيث يتفرد المونولوج الداخلي بترك أثر استثنائي وجدانيًا لأنه يغرز القارئ في فضاء غرائبي، تستحوذ عليه الصيغة الرمزية، إذ تتوالى مقاطع النص في دوائر مغلقة تتقاطع برموز متكررة، تخلق ثنائيات ضدية مع السارد، تعج بالتأويلات، وتستمر في دوران مبهم لتتغير التقاطعات بتغير وجدان القارئ
المسكون بالشك، والممتلئ باليقين حول هوية النص الإنساني. ولا سيما أن الزمن يستمر بالقفز بين الماضي والحاضر بلزوجة وانسيابية مذهلة. تتواءم
مع لغة شاعرية متمكنة، و مع ألم إنساني عميق يحتل المشهد، تستحوذ فيه السريالية على إدراك المتلقي الكامل فكأن القارئ خاضع لنوع من التعاويذ التي يطلقها سارد قد اختفى وراء ضد يرتبط به في تتابع الأحداث وتشابكها كما في مقاطع النص المتسلسلة:
(السارد، الوثن): الخير والشر
،(السارد ،عبد الصمد الحي):السارد وذكرياته الموجعة
(السارد، والشهيد عبد الصمد) السارد وجلد الذات
(السارد وقلادة عبد الصمد) طوطمية التعلق،
(السارد و شخصية المكان ) سطوة الأماكن المشخصنة و رهابها حين تتعلق بالموتى
(السارد، هوية الفقد) الحياة والموت
الإسقاط الملحمي للوثن رمزيا
استخدم الكاتب تصويرًا ملحميًا مفعمًا بإشكالات الحرب ودلالاتها ،حيث ينتصب مفهوم التأليه العكسي للوثن ضمن مشاهد طقسية يظهر فيها كوحش أسطوري ذو ملامح واضحة يذكرنا بآلهة الجحيم (ايرنيس) في الميثيولوجيا الإغريقية ، تتسم بالقبح ،وتضج بالمبالغة في تشخيص سافر وتتمتع ببنيوية متغيرة قوطية متحولة كما ورد في النص:
فسمح لعينه الوحيدة، أن تطل - حمراء واهنة -
ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر
يبدع الكاتب المذهل في طرح صورة غير نمطية تتحدى القوة العقلية لدى المتلقي، إذ لا يفرق إله الحرب الموضوعي بجبروته بين المتخاصمين، فدمويته الأزلية بعيدة عن معايير التمييز(دماء زرقاء وحمراء) ، فهو بوجوده الرخو المظلم متحيز لكل الضحايا، فهم في متناول جوعه الأبدي لسفك الدماء، و ما رغبته الحيوانية الخالية من التعقيد في افتراس الأحياء وطحن الصلب وإشعال حرائق الخراب إلا بدائية ساذجة لا يمكن محاكمتها ، كأنها واقع مجهول فرض على الأحياء و وجب عليهم الاستسلام له في قبول ورضوخ
، وكما ورد في النص
ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر، وهو يتسلل متمسحاً بميول التباب المعتمة، تلتقي أعيننا عند مغيب الشمس، وللقرابينَ طقوس نعرفها كلنا،
الضبط الثقافي للنص
ثم تتغير لغة الخطاب السردي لتشوبها حرارة و عاطفة خفيتين تحتدم بذكر صديق السارد (عبد الصمد) الذي يقاتل للحظة الأخيرة، فتفتك به شجاعته،رغم تحذيرات السارد، فهو يتحسس بقايا حرارة لجسد فارق الحياة في قلادة معدنية، لرفيق السلاح والجندية، فكأنه يرثي مصيره القادم أيضًا، في هذا الطرح استثنائية في تصوير
الموت وعبثيته فهل تختار شعورك حسب الموقف أم حسب حجم الخسارة وكيفيتها! هل ستقف احتراما للضحايا من كلا الطرفين دون استثناء أم ستفقد ولاءك أمام لعنة الفقدان ومرارته ؟ لأن عداءك مع الموت وحنقك عليه غدا شخصيًا ضمن إسقاط المعاناة الفردية؟ ،طالما أنك الضحية القادمة! ولا يمكننا ضمن هذا العمل المتكامل إلا خلق تناص مع أدب الحروب وفلسفة الموت فنتذكر
ملحمة الإلياذة والأوديسة وحرب طروادة، ثم تفاقم فكرة الموت وارتباطها بمفهوم العدمية والنهاية عبر التاريخ من الشعر الملحمي إلى المبالغات الأسطورية في الحروب الصليبية كمراثي الملاحم إلى تراجيديات شكسبير الشبحية القوطية ومن ثمة لإفرازات الثورة الفرنسية على عالم الأدب والأدباء في القارة الأوروبية جمعاء كروايات ستاندال وفكتورهيغو،و نتذكر رائعة البرتغالي ساراماغو (انقطاعات الموت) وتصويره المختلف لهيمنة الموت وسيطرته على الحياة، وحتى أساطير الأدب الهندي الخرافية حول آلهة الموت وفلسفتها.
بينما يتصالح سارد (الوثن) بفلسفته الوجودية مع رموز الموت العبثي، والمحاكمة الأخلاقية ،وطغيان الحرب الدموية، لتغدو كنوع من الارتقاء الفلسفي الروحي.
نهاية الرحلة وشخصنة الأمكنة
جعل الكاتب المبدع موت عبد الصمد بداية كشفية عن حياة البطل التراجيدي المغيب ،الذي خلق سقوطه اصطدامًا بالواقع، هدفه إرباك القارئ وتقديمه للشخصية
الفاعلة التراجيدية الثانية (القرية الجنوبية) بأشجارها الأربعينو رائحةشجرة الجازورينيا التي تبث شحنًا متأزمًا لضحايا (الوثن) الهامشيين،الزوجة المنكوبة المريضة والطفل الذي غافل أباه في الغياب فكبر،بما فيهم السارد نفسه الذي سيشاركنا هدف رحلته السرية في نقل خبر الوفاة المفجع كما ورد في النص:
وأنا الذي وعيت الدرس، أين أذهب من نظراتك التى لا تفهم؟
ماذا يجدي الصدرَ العاري الصدرُ العاري ؟
سيحملق الولد في بنفس العينين
جئت يا صديقي لكي ألقاك في هذه العيون الذاهلة
وتأتي النهاية الصاعقة، مترفة ناطقة، ،تجرنا مع السارد العائد لبيته، مخذولًا بالفقدان، يستحوذ عليه وجود (عبد الصمد) المتحد في موته مع المشهد الكلي لبلدة السارد ، الذي يلتصق فيه بالزمكان بدقة غير منفصل عن الحدث، بل متجذرًا في أعماق اختلاله النفسي، مترقرقًا في سيمياء المقطع الأخير، إذ يستبصر نهايته القادمة في استبصار حتمي للوثن وهو يستولي على حواس السارد ومحيطه وكيانه.
كما ورد في النص:
وأنى فى اللحظة التالية قد أرى الذيلَ ذا الحرافيش ينسحبُ بخفة، ينعكس على استدارة أجنابه ضوءُ القمرِ الشاحب
نص غرائبي مذهل قد ينتمي لما بعد الحداثة، يتعدى حدود الإتقان والتفرد،نص متعالق مبتكر يتلون بين الرمزية والسريالية، ،تناول مآساة الحرب خارج الحقب الزمنية وأضاء ارتباطه بعدمية الموت و وجود الإنسان المسحوق تحت وطأة واقع لا يمكن التفلت منه، بلغة شعرية اسثنائية كسرت القوالب وتحدَّت المألوف وتجذرت في قلب القارئ على اختلاف زمره وفئاته.
تحية كبيرة للأستاذ محسن الطوخي،نص خلق ليبقى للأبد كإيديولوجية حديثة تصلح لكل زمان ومكان كنوع من الرفض لمفهوم الحرب من منطلق الإنسان وحده، كخلاص يلتف ببراعة وتجريدية نحو الملموس والمؤلم في واقع مجتمعاتنا المنكوبة منذ الأزل بلعنة الحروب وقسوتها.
كنانة حاتم عيسى
الوثن
قصة قصيرة للأديب محسن الطوخي
مساقاً كنت إلى الجنوب، كالأشياء القدرية كانت رحلتي، كالحياة والموت، نظًرتْ أمي فى عينيَ وتمتمت: ترحل وما أتيت إلا لنهارين وليلة؟
أشحت بعيني بعيداً: سألتقي بصديق. لم أقل لها شيئاً عن الأشياء القدرية .
................
عندما رأى أحد الرفاق عين الوثن الوحيدة، نصف مفتوحة، نصف مغمضة، عاد وحكى، حدد خط الطول، وحدد خط العرض، ولم يدر أن الوثن كان منذ الأمس صائماً، فسمح لعينه الوحيدة، أن تطل - حمراء واهنة - من فرجة بين التلال، فى تلك المرة، عند انبلاج الفجر، أفطر الوثن بمائة رجل، نصفهم من ذوي الدماء الحمراء، ونصفهم من ذوي الدماء الزرقاء، وصحن، وعجن، أطناناً من الصلب القوي، فالوثن، يهوى اللهو بالصلب القوي.
.............
كنتُ قد فارقتُ الرجال، لا أعرف مَنْ منهم سيبقى حياً حتى أعود، والقرابين لم تزل تقدم كل ليلة، والوثن لا يكاد يرتوي، يصحو فى عمق الليل، أما فى النهار فيغفو، يميل برأسه خلف التلال، ويتوارى فى بقع الظل، ينكمش، ويوزع نفسه فى الحفر، ويتمدد فى الوديان، وفى مجاري السيول، وعندما تميل الشمس للغروب، يفتح عينه الحمراء، يلملم نفسه من الحفر، وينهض بجوعه الأبدي، نراه على مدى البصر، هناك، بعيداً عند الأفق، كأطياف سرابٍ خيالية, ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر، وهو يتسلل متمسحاً بميول التباب المعتمة، تلتقي أعيننا عند مغيب الشمس، وللقرابينَ طقوس نعرفها كلنا، قبضة اليد على الصلب البارد، الضحكة المبتورة، نظرة تتمسح بالمكان، ويبتلع الليل الخطوات الحذرة فى رحلة للمجهول.
................
بالأمس فقط، كان " عبد الصمد " القربان الأخير، دفء جسدهِ في القلادة المعدنية، كان رفيقي وأنا أعبر الطريق الرملى الملتوى، أطبق كفي على دفء المعدن البارد، بينما تتزاحم فى رأسى الأفكار، هل قدر لى حقاً أن أرى الأهل ؟، الولد، والأب الضرير، والطاحون، والحقول.
.................
قبل أن أطلق كفه قلت له: كن على حذر.
معزوفة اللسان الطويلة ترَكَزَتْ فى نظرة العين، فالوقت قد أزف. الوثن باق، يؤكد ذلك عزم العين المسددة، لا يدرك الجنوبى أن الوثن باق، سيميل، ينزع شوكة من الطرف المتلكىء.
لو فعلت ذلك ياعبد الصمد، سيستدير الوثن، يلقم يمناك، ثم يطوحها مخضبة، مهتوكة الأنسجة، فهو لا يهتم باللقم الصغيرة،
فكن على حذر .. كن على حذر.
.........................
صوت القطار الصاخب كان هو الصوت الوحيد الذى رافقني طوال رحلتى إلى الجنوب، أعرف أنى ذاهب للقائه فى بلدته الجنوبية، أعرف أيضاً أنه ليس هناك. ودفءُ القلادة تسرب من يدي. حكى لي "عبد الصمد" فى الليالي القمرية، عن المعدية التى سأستخدمها عندما يصل القطار مع الغروب، حكى لي عن الأرض السمراء، وصفّ أشجار الجازورينا التي تحرس مدخل القرية، قال عنها :
- أربعون شجرة، كل واحدة لي معها حكاية، كل واحدة بينها وبيني سر صغير.
...................
صحت به: لا تفعل ... كُنْ على حذر... خرج الصوت كالفحيح، أما هو فلم يتوقف، صوب بندقيته وأطلق وابلاً من النيران، بينما كنت أجاهد لأرفع صوتي، كانت الغريزة والمران الطويل أقوى أثرا،ً فلم أقترب، ضاع الصوت المجروح، حملته الريح فى الاتجاه الآخر، في اللحظة التالية كان علي أن أنغرس فى الرمال الباردة .
إيه ياعبد الصمد .. كان يجب أن يسبق الفعل تدبير، وها نحن مكشوفو الصدور،
وأنت لم تكد تفيق من فورة الغضب، حتى اكتشفت أن أوان التدبير قد فات،
والأمتار القليلة التى تفصل بيننا، دونها الدم والحديد والنار. وأنا الذي وعيت الدرس، أين أذهب من نظراتك التى لا تفهم؟
ماذا يجدي الصدرَ العاري الصدرُ العاري ؟
...............
منذ فارقَتْ كفُ الرقيبِ كتفي مودعاً، وبين أصابعى قلادة معدنية تحمل رقماً، وفى جيبى صورة الولد، مهوش الشعر، يحملق فى عدسة المصور . سرت البرودة فى أطرافى، سيحملق فيَّ الولدُ بنفس العينين.
................
يأتي السعالُ من الداخل، والبيتُ يتصاعد فيه دُخْانُ الفرن، تحاصرني الأعينُ الذاهلة. وقع الخبر الجاثم فوق الأذهان يحلق كطيور البحر، الصرخةُ الملتاعة تذهب وتعود مضفورةٌ بحبال اليأس، والمرأةُ الشابة تحثو طين الأرض، والولدُ الغافلُ يلهو بقلادة.
جئتُ ياصديقي لكى ألقاكَ فى هذه العيون الذاهلة، والولد لم يعد يحبو، غافلكَ وسار على قدمين. لو أقدرُ أن أمضي عمري بسريرةِ طفلٍ لاهٍ، أن أنسى أحزان الأم، والأخت، والجدة.
..................
حين عدتُ إلى بلدتى، ويممتُ شطرَ الحقلِ، شممتُ رائحةَ عرقهِ فى الممرات الضيقة بين الزراعات، وحين أمسكتُ بفأسى، رأيتُ بصمات أصابعه، وحين ملتُ على ماءِ النهر، عكستْ المياه الخالية من الطمى صورته. على مدخل بيتي كان واقي الرأس المموه بالبقع الملونة يعلو فوهة البندقية المستندة إلى الجدار، بالقرب منها كان هو بجسده الضخم متمدداً فى استرخاء، عاقداً ذراعيه فوق صدره، مغمض العينين، يبتسم، شأنه حين يكتشف بعد لجاج أنه على خطأ. حين ملتُ عليه بدهشة، لم يعد هناك، كان مدخل بيتي أيضا قد اختفى، والطريقُ المترب الذى خلفته ورائي غاب فى الظلمة، وكل ماكنت أعتقد أنى أعرفه من معالم بلدتي الهادئة، بتُّ أُدرِكُ أنه شركٌ يستوجب الحذر، وأنى فى اللحظة التالية قد أرى الذيلَ ذا الحرافيش ينسحبُ بخفة، ينعكس على استدارة أجنابه ضوءُ القمرِ الشاحب.
****
الدراسة
الوثن
هذا هو النص الرمزي المذهل ذو الصورة السريالية الذي يتغلل في قارئه ليس كمنظومة سردية متناغمة ،فحسب بل كحالة إنسانية تستقصي فهمًا ذاتيًا لمعاناتها ضمن معاناة (الآخر ) ورمزية إسقاطه على الوجود الفلسفي للإنسان أولا وللوطن ثانيا ثم ارتباطه الباطني بإشكالية الرمز (الوثن) ودلالاته، حين يتجذر في مفاهيم مألوفة بشكل يجبر القارئ على استعادة النص بمذاقات تختلف عند كل قراءة جديدة ،تنتج نصًا شموليًا يلامس كل وجدان ويمر بشغاف كل روح لأنه يشحن الزخم البشري النفسي الملتصق بمفاهيم الموت والحياة والحروب والفقد.
براعة السرد ولغة الخطاب
لقد أبدع الكاتب في استهلاله خلق حالة الغموض الباطنية التي تشد القارئ إلى مفهوم التدخل القدري وتوقِعه في براثن التخبط بين ما هو معلن ( سارد غريب يزور مسقط رأسه) وبين ما هو على وشك الحدوث (مرتحل إلى الجنوب في مهمة) ، حيث يتفرد المونولوج الداخلي بترك أثر استثنائي وجدانيًا لأنه يغرز القارئ في فضاء غرائبي، تستحوذ عليه الصيغة الرمزية، إذ تتوالى مقاطع النص في دوائر مغلقة تتقاطع برموز متكررة، تخلق ثنائيات ضدية مع السارد، تعج بالتأويلات، وتستمر في دوران مبهم لتتغير التقاطعات بتغير وجدان القارئ
المسكون بالشك، والممتلئ باليقين حول هوية النص الإنساني. ولا سيما أن الزمن يستمر بالقفز بين الماضي والحاضر بلزوجة وانسيابية مذهلة. تتواءم
مع لغة شاعرية متمكنة، و مع ألم إنساني عميق يحتل المشهد، تستحوذ فيه السريالية على إدراك المتلقي الكامل فكأن القارئ خاضع لنوع من التعاويذ التي يطلقها سارد قد اختفى وراء ضد يرتبط به في تتابع الأحداث وتشابكها كما في مقاطع النص المتسلسلة:
(السارد، الوثن): الخير والشر
،(السارد ،عبد الصمد الحي):السارد وذكرياته الموجعة
(السارد، والشهيد عبد الصمد) السارد وجلد الذات
(السارد وقلادة عبد الصمد) طوطمية التعلق،
(السارد و شخصية المكان ) سطوة الأماكن المشخصنة و رهابها حين تتعلق بالموتى
(السارد، هوية الفقد) الحياة والموت
الإسقاط الملحمي للوثن رمزيا
استخدم الكاتب تصويرًا ملحميًا مفعمًا بإشكالات الحرب ودلالاتها ،حيث ينتصب مفهوم التأليه العكسي للوثن ضمن مشاهد طقسية يظهر فيها كوحش أسطوري ذو ملامح واضحة يذكرنا بآلهة الجحيم (ايرنيس) في الميثيولوجيا الإغريقية ، تتسم بالقبح ،وتضج بالمبالغة في تشخيص سافر وتتمتع ببنيوية متغيرة قوطية متحولة كما ورد في النص:
فسمح لعينه الوحيدة، أن تطل - حمراء واهنة -
ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر
يبدع الكاتب المذهل في طرح صورة غير نمطية تتحدى القوة العقلية لدى المتلقي، إذ لا يفرق إله الحرب الموضوعي بجبروته بين المتخاصمين، فدمويته الأزلية بعيدة عن معايير التمييز(دماء زرقاء وحمراء) ، فهو بوجوده الرخو المظلم متحيز لكل الضحايا، فهم في متناول جوعه الأبدي لسفك الدماء، و ما رغبته الحيوانية الخالية من التعقيد في افتراس الأحياء وطحن الصلب وإشعال حرائق الخراب إلا بدائية ساذجة لا يمكن محاكمتها ، كأنها واقع مجهول فرض على الأحياء و وجب عليهم الاستسلام له في قبول ورضوخ
، وكما ورد في النص
ونلمح الضوء الباهت، المنعكس فوق ذنبه الشائك، المنفّر، وهو يتسلل متمسحاً بميول التباب المعتمة، تلتقي أعيننا عند مغيب الشمس، وللقرابينَ طقوس نعرفها كلنا،
الضبط الثقافي للنص
ثم تتغير لغة الخطاب السردي لتشوبها حرارة و عاطفة خفيتين تحتدم بذكر صديق السارد (عبد الصمد) الذي يقاتل للحظة الأخيرة، فتفتك به شجاعته،رغم تحذيرات السارد، فهو يتحسس بقايا حرارة لجسد فارق الحياة في قلادة معدنية، لرفيق السلاح والجندية، فكأنه يرثي مصيره القادم أيضًا، في هذا الطرح استثنائية في تصوير
الموت وعبثيته فهل تختار شعورك حسب الموقف أم حسب حجم الخسارة وكيفيتها! هل ستقف احتراما للضحايا من كلا الطرفين دون استثناء أم ستفقد ولاءك أمام لعنة الفقدان ومرارته ؟ لأن عداءك مع الموت وحنقك عليه غدا شخصيًا ضمن إسقاط المعاناة الفردية؟ ،طالما أنك الضحية القادمة! ولا يمكننا ضمن هذا العمل المتكامل إلا خلق تناص مع أدب الحروب وفلسفة الموت فنتذكر
ملحمة الإلياذة والأوديسة وحرب طروادة، ثم تفاقم فكرة الموت وارتباطها بمفهوم العدمية والنهاية عبر التاريخ من الشعر الملحمي إلى المبالغات الأسطورية في الحروب الصليبية كمراثي الملاحم إلى تراجيديات شكسبير الشبحية القوطية ومن ثمة لإفرازات الثورة الفرنسية على عالم الأدب والأدباء في القارة الأوروبية جمعاء كروايات ستاندال وفكتورهيغو،و نتذكر رائعة البرتغالي ساراماغو (انقطاعات الموت) وتصويره المختلف لهيمنة الموت وسيطرته على الحياة، وحتى أساطير الأدب الهندي الخرافية حول آلهة الموت وفلسفتها.
بينما يتصالح سارد (الوثن) بفلسفته الوجودية مع رموز الموت العبثي، والمحاكمة الأخلاقية ،وطغيان الحرب الدموية، لتغدو كنوع من الارتقاء الفلسفي الروحي.
نهاية الرحلة وشخصنة الأمكنة
جعل الكاتب المبدع موت عبد الصمد بداية كشفية عن حياة البطل التراجيدي المغيب ،الذي خلق سقوطه اصطدامًا بالواقع، هدفه إرباك القارئ وتقديمه للشخصية
الفاعلة التراجيدية الثانية (القرية الجنوبية) بأشجارها الأربعينو رائحةشجرة الجازورينيا التي تبث شحنًا متأزمًا لضحايا (الوثن) الهامشيين،الزوجة المنكوبة المريضة والطفل الذي غافل أباه في الغياب فكبر،بما فيهم السارد نفسه الذي سيشاركنا هدف رحلته السرية في نقل خبر الوفاة المفجع كما ورد في النص:
وأنا الذي وعيت الدرس، أين أذهب من نظراتك التى لا تفهم؟
ماذا يجدي الصدرَ العاري الصدرُ العاري ؟
سيحملق الولد في بنفس العينين
جئت يا صديقي لكي ألقاك في هذه العيون الذاهلة
وتأتي النهاية الصاعقة، مترفة ناطقة، ،تجرنا مع السارد العائد لبيته، مخذولًا بالفقدان، يستحوذ عليه وجود (عبد الصمد) المتحد في موته مع المشهد الكلي لبلدة السارد ، الذي يلتصق فيه بالزمكان بدقة غير منفصل عن الحدث، بل متجذرًا في أعماق اختلاله النفسي، مترقرقًا في سيمياء المقطع الأخير، إذ يستبصر نهايته القادمة في استبصار حتمي للوثن وهو يستولي على حواس السارد ومحيطه وكيانه.
كما ورد في النص:
وأنى فى اللحظة التالية قد أرى الذيلَ ذا الحرافيش ينسحبُ بخفة، ينعكس على استدارة أجنابه ضوءُ القمرِ الشاحب
نص غرائبي مذهل قد ينتمي لما بعد الحداثة، يتعدى حدود الإتقان والتفرد،نص متعالق مبتكر يتلون بين الرمزية والسريالية، ،تناول مآساة الحرب خارج الحقب الزمنية وأضاء ارتباطه بعدمية الموت و وجود الإنسان المسحوق تحت وطأة واقع لا يمكن التفلت منه، بلغة شعرية اسثنائية كسرت القوالب وتحدَّت المألوف وتجذرت في قلب القارئ على اختلاف زمره وفئاته.
تحية كبيرة للأستاذ محسن الطوخي،نص خلق ليبقى للأبد كإيديولوجية حديثة تصلح لكل زمان ومكان كنوع من الرفض لمفهوم الحرب من منطلق الإنسان وحده، كخلاص يلتف ببراعة وتجريدية نحو الملموس والمؤلم في واقع مجتمعاتنا المنكوبة منذ الأزل بلعنة الحروب وقسوتها.
كنانة حاتم عيسى