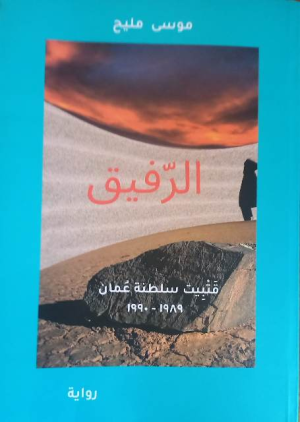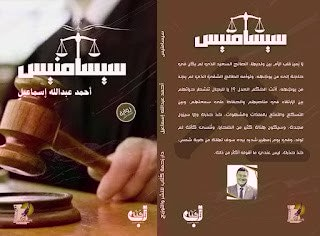لقد عرّفَ “ بومجارتن” عِلم الجمال ذات مرةٍ بأنه، “ فن التفكير بطريقة جميلة”، وأي شخصٍ له أذُن حساسة سوف يلاحظ على الفور أن هذا التعبير قد صيغ على غرار فن البلاغة، بأنه “فن الحديث بطريقةٍ حسنة “. ففن البلاغةِ هو الشكل العام للاتصال البشري الذي ما زال حتى يومنا هذا يحدد حياتَنا الاجتماعية بصورة أكثر عمقًا من العِلم بما لا يَقبل المقارَنة .
كما أن البلاغةَ لا تكون وصفًا للكلام، وتحمل البلاغةُ معاني كثيرةً في ألفاظ قليلة، فالبلاغة كلمة تستخدم لتكشف عن بقية الكلام بإيجازٍ وإيصال للمعنى، إلا أن البعض لا يفرّق بين البلاغة والفصاحة، حيث تقتصر الفصاحة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفًا للألفاظ مع المعاني، تلك البلاغة التي تحتوي على ثمانية أضرب، هي “الإيجاز، والاستعارة، والتشبيه، والبيان، والنظم، والتصرف، والمشاكَلة، والمثل”.
تكمن أهمية القصة القصيرة في أنها شكلٌ أدبي فني، قادر على طرح أعقد الرؤى وأخصب القضايا الاجتماعية في المجتمع، وبصورة دقيقة واعية، من خلال علاقة الحدث بالواقع، وما ينجم عنه من صراع، وما تمتاز به من تركيز وتكثيف في استخدام الدلالات اللغوية المناسبة لطبيعة الحدث، وأحوال الشخصية، وخصائص القص، وحركية الحوار والسرد، ومظاهر الخيال والحقيقة، وغير ذلك من القضايا التي تتوغل في هذا الفن الأدبي المتميز
((الأقصوصة أو القصة القصيرة ))، هي عبارة عن “سرد حكائي نثري أقصر من الرواية”. وتهدف إلى تقديم حدثٍ وحيد غالبًا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكانٍ محدود غالبًا؛ لتعبّر عن موقفٍ أو جانبٍ من جوانب الحياة ..
في حديثنا عن البلاغة التي هي هنا بلاغة القصة القصيرة، لا نجد ما يتناسب مع كونها بلاغة لموقف من الأمور تصحبه عادةً استجابةٌ خاصة، فهل هذا المعنى للموقف يمكن أن تناسبه بلاغة الصورة المجازية والكنائية بأنماطها العديدة، والذي نشأ في ظل البيئة الرعوية الصحراوية؟ أم أنها بلاغة درامية تتصف بتعارض الإرادات؟ قد يكون تعارضًا داخل النفس الواحدة، أو تعارضًا مع آخرين، نتيجة اختلاف الهوية الثقافية أو الدافع أو الهوى والرغبات .
في معرض حديثي عن القصة القصيرة، وحدودها الفنية، وجدت تباينًا ملحوظًا في الآراء التي استند مستنبطوها على وعيهم الجمالي بالنصوص الموجودة في عصرهم، منهم مَن اهتم بالحجم والتسمية، مثل “إدجار آلان بو”، حيث أوضح أن هناك جنسيْن للأدب، أحدهما يُقرأ في جلسة واحدة، والآخر يمكن تداوله على عدة جلسات، متأثرًا بنشاط الطباعة والصحافة الذى أتاح للسرد القصير أن ينتشر عبر الصحف والمجلات الأدبية .
آخرون اهتموا بتكوينها الدرامي، خلاف الرواية، فهي الصوت المتوحد، أو الصوت المنفرد، كما أوضح “فرانك أكونور” في كتابه (الصوت المتوحد) والذي أكّد للقصة القصيرة اليومية ألا تهتم إلا بالحدث المهم، أي ما كان ذا دلالةٍ، مما يدفعها للانزلاق نحو النهاية سريعًا، بخلاف الرواية، وما أكده “أرسطو” حول مفهوم الحبكة وكونها بداية ووسط ونهاية، ذلك الانزلاق المبني على وعي حادٍ باستيحاش الإنسان، أو كما قال “نجيب محفوظ” حول اهتمامه بالقصة القصيرة، كونها تمثل التفاعلَ المباشر مع مواقف الحياة، بخلاف الرواية التي تلزم كاتبَها بالاعتكاف لعامٍ كاملٍ لكتابتها، ذلك الوعي الاستيحاشي الذي يشير اليه “أكونور” يقوم على المفاجآت، حتى وإن كانت متوقعة؛ لأنه يعمل على الصدمة النابعة من أشياءَ نعرفها بالفعل، لكننا نكتشف أننا لا نعرفها من قبل، أو ما يضعنا أمام مسألة تخابث العالم والشعور بمدى تآمرِه على اللحظة السردية .
إلا أن اختلاف الظروف التي نشأت فيها القصة القصيرة، وسقوطها في براثن الاستغلال الأيدولوجي، لفتراتٍ زمنية طويلة، جعل منها منبرًا دعائيًا وخطابيًا في أحايينَ كثيرةٍ، ووسيلةً للتعبير عن التمرد السياسي والاجتماعي والأخلاقي، بل تشكلت ملامحها الخاصة بكونها سردًا معبرًا عن الطبقات المسحوقة والمهمّشة ضد الإقطاعيين والبرجوازيين، فكان لا بدّ أن تحدث ثورة ضد تلك الكتابة النمطية، حتى على مستوى البلاغة والوعي والتصور والطرح، نذكر ما قاله “الخراط” في كتابه (الحساسية الجديدة) عن تلك التقنيات المرادفة لهذا الفن الحديث، “هي كتابة تسعى لـ كسر الترتيب السردي الطردي، وفك العقدة التقليدية، والغوص في الداخل، لا التعلق بالظاهر، وتحطيم سلسلة الزمن السائر في خط مستقيم، وتراكب الأفعال، المضارع والماضي والمحتمل معًا، وتهديد بنية اللغة المكرسة، ورميها نهائيًا خارج متاحف القواميس، وتوسيع دلالة الواقع لكي يشمل أيضًا الحلم والأسطورة والشعر، ومساءلة إن لم تكن مداهمة الشكل الاجتماعي القائم، وتدمير سياق اللغة السائد المقبول، واقتحام مغاور ما تحت الوعي، واستخدام صيغة الأنا، لا للتعبير عن العاطفة والشحن، بل لتعرية أغوار الذات وصولا إلى تلك المنطقة الغامضة المشتركة التي يمكن تسميتها ما بين الذاتيات، هي رؤيا وموقف وليس انقلابًا شكليًا” .
ربما جاءت أغلب آراء النقاد القاسية في توصيفهم للقصة القصيرة، بأنها أصبحت نوعًا أدبيًا هامشيًا، وهي ميتة مجازًا وثقافيًا، وقد سلّمت الرايةَ إلى فن الرواية، حيث مِن الاستحالة على القصة القصيرة الارتقاء إلى رتبة النوع القابل لتحولات حقيقية في بنيتها ووظيفتها الدلالية؛ فهي ما زالت أسيرة أصلِها الحكائي وشكلها المغلق في عصرٍ أصبح كل شيء فيه مفتوحًا، ومحاولة الانفتاح فيها ستجعل منها مشهدًا سرديًا في نصٍ روائي.
إن الكتابةَ الإبداعية، لسببٍ أو لآخر، قد أصبحت اختراقًا لا تقليدًا، واستشكالا لا مطابقة، وإثارةً للسؤال لا تقديمًا للأجوبة، ومهاجمة للمجهول لا رضا عن الذات بالعرفان .
وقبل أن نتحدث عن أهمية حدود النوع في القصة القصيرة، أحِب أن أوضح خصائص ذلك النوع، والتي تميزها عن باقي الفنون: وهي وحدة الموضوع، التكثيف، الدراما.
أهمية حدود النوع الأدبي وأثره على التلقي
تحديد ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻨـﻭﻉ، ﺇﺫَﻥ،ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁًﺎ ﻭﺜﻴﻘًﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤﻁٍ ﻤﻌينٍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺩﺍﺌﻤًﺎ، ﻤﺠﺎلَ ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﻤﺤﻁ ﺨـﻼﻑٍ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏُ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ _ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ “ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ”، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
“ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻭﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ”. ﻭﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﻭﺭٍ
ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﱢل ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺇﺫ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻭﻋِﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ (ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ)!
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓٌ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺭﺴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ، “ﻏﻴﺭ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭِﻨﺔ، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻕ، ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗـﺎﺕ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤـﻲ ﺇﻟﻴـها، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﺭﻗًﺎ ﺠﺯﺀًﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ. ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.
ﻓﻤﺎ ﺩُﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﻗﺒِﻠﻨﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨـﻭﻉ، ﻓﻼ ﺒـﺩّ ﺃﻥ ﻨﻘﺒـل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤِﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﻭلُ ﺍﻟﻤﺒـﺩأَ ﺍﻷﺴﺎسي ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ (ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺭﻕ)؛ ﻓﺒﻘﺩْﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻤﺘﺎﺤًﺎ ﺒﻘﺩْﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌًﺎ؛ ﻓﻼ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍلاﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀً ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺇﻻ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺭﻕ؛ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﺭﻕ ﻨﻭﻋَﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔً ﺼﻐﺭﻯ ﻭﻤﻔﺘﺭَﻀـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ، ﺘﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ (ﺼﻐﺭﻯ)، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒّﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺨﺭﻕ ﺃﻜﺒﺭَ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ. ﺇﻥّ ﻨﺼًﺎ ﻗﺼﺼﻴًﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭَ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻭﺼﻔِﻪ ﻗﺼﺔ،، ﻷﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒّﻌِﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋِﻲ ﺍﻟﺩﺨﻴل ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔَ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ.
ويمكن ضرب مثل على ذلك، قصيدة “وجبة الصباح”، لــ جاك بريفير، والتي تعَد نموذجًا للقصيدة القصة، بمعنى أن هنا نسبة تشبّع العنصر النوعي للقصيدة أعلى من القصة، لذا فهي تنتمي لعنصر الشِّعر، يقول فيها:
وضعَ القهوةَ / في الفنجان
وضعَ الحليبَ في فنجانِ القهوة
وضعَ السكّرَ / في القهوةِ بالحليب
حرّكَها / بالملعقةِ الصغيرةِ / شربَ القهوةَ بالحليب
وضعَ الفنجانَ دون أن يكلِّمَني
أشعلَ سيجارةً / نفثَ دوائرَ من الدخان
ألقى الرمادَ / في المنفضةِ / دون أن يكلّمني
دون أن ينظرَ إليّ
نهضَ / وضعَ قبّعتَه على رأسِه
ارتدَى معطفَ الشتاء
لأن المطرَ كان يهطلُ
وانصرفَ تحت زخاتِ المطر
دون كلمةٍ
دون أن ينظرَ إليّ
وأنا وضعتُ رأسي بين يدَي
وبكيتُ ..
ربما فكرة اقتراب القصة من الشعر هي وحدة الأثر
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨـﻪ
ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠِﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤِﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭَ ﻨﻭﻋﻴﺔٍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺭِﺠﻪ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ؛ ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﺫﻟﻙ
ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻭﻜﺘّﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎلٍ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺩﺏ
ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺴﻴَﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻁﺒﻴﻌﺔُ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ؛ ﻓﺎلاﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻥ “ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺸﺭﻭﻁَ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻲ ﺒﻌﻴﻨﻪ…ﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﻭﺠًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ”. إذَن ليس هناك شكلٌ سابق محدد قالبي نمطي، نستطيع أن نقول بناءً عليه هذه قصة، وهذه ليست قصة، والذي يحدد هذا هو القاص بإبداعه الخاص، فهو ينظر إلى القوانين بعد كتابة العمل، وليس قبلَه، وبالتالي يمكن أن تكون هناك قصة ليس فيها أي حدثٍ على الإطلاق، وسوف نجد في داخل ميكانيزم التطور الداخلي لهذه اللوحة عقدةً وحَلاً، وكل ما نتلمسه من الطرائق والمواصفات المثيرة لخلق الدلالة المطلوب من القاري أيضًا أن يشارك فيه .
1- يقول الخراط، لماذا القصة القصيدة؟ ولماذا اللغات المتعددة؟
أشير هنا إلى الحفاوة باللغة؛ لأن هذا ردٌّ على جدل امتهان اللغة العربية في واقعها الذي نعيش فيه هذا الخليطَ الغريب من امتهان اللغة والذات القومية، أصبح له رد على مستو الحفاوة، كما احتفى “إبراهيم فهمي” ردًا على استلابه مِن فردوسه المفقود، “أرض النوبة القديمة”، قائلا في قصتِه:
” بحر النيل ، نيل وبحر “، أول صباح في بلد بلا بحر ، صباح بلا نهار ، صباح بلا ليل، وجبين بلا شمس ( كانت تزينه شمس البلاد )، وجبين كان يزينه في الليالي قمر ..أيام بلا وطن كبحر بلا منابع ، بلا مصب ..كانت البلاد بلاد ببحر ..جاءت بلاد بلا مطر ..يا جميلة من نصب المصائد للبنات في الشوارع وأبحر ..أساري من أرض ببحر إلى أرض بلا ! من بنى هالبلاد الجديدة لا يعرف حتى يرى بيت من البيوت يدق بالعشق قلبك يا بلد ..من بنى هالبلاد لا يعرف أن الناس تحب بحورها فتعشقها ..وتحب بحورها فتعشقها “
هذا توجع صراع الغنائية، تكثر فيه أساليب النداء، صدقَ “نجيب محفوظ” عندما قال إن القصة القصيرة هي شِعر النثر الحديث، عادت أيضًا اللوحة، والتي تم نقدها على أساس أنها قصة قصيرة ناقصة الفنيات، هذا ما تحدّث عنه نقاد الثلاثينيات عن قصص “محمود طاهر لاشين” ..عادت تلك اللوحات لتستغل الوصفَ والإحساس اللغوي، لتنتج نوعًا من القصص القصيرة المشهدية، لتؤكد مقولة “يحيي حقي” أن القصة هي فن التصوير الحسي، رغم تمايز اللوحة عن القصة القصيرة بالآتي:-
1. لا تحتوي بالضرورة على بناءٍ قصصي
2- تقدم شخصياتِها بطريقة مباشرة
3- تتناول أحداثًا “محلية ” وواقعية مباشرة
كَتب “توفيق الحكيم” في كتابه (أثواب الأدب العربي) أن القصة وسيلة الأدب للوصول إلى شيء عميق دقيق في حياة الإنسان، لا مجرد تسليةٍ ومتعة.
إذَن ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤًﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﺴﺎﺭﻴْﻥ
ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺼﺭﺍﻤﺔ ﺤـﺩﻭﺩ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ، ﺃﻱ إﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺸﻜﱢﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﻋﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭٌ ﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﺘـﺴﺎﺀل
ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜل ﻨﻭﻉ، ﺃﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﻡ ﺼﻠﺒﺔ؟ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻕ
مفهوم النوع الأدبي، وكيفية هيمنة إحدى الصيغ على الأخرى، ” يُعَد أر سطو واضعَ الأسس التي تقوم على نظرية الأنواع الأدبية، حيث قسّم الأدبَ في كتابه “الشعر” إلى ثلاثة أنواع، التراجيديا، والكوميديا، والملحمة، وحرصَ أن يبين أن كل نوع أدبي يختلف عن النوع الآخر من حيث الماهية والقيمة، ولذلك ينبغي أن يظل منفصلا عن الآخر، وقد عُرِف هذا فيما بعد بمذهب نقاء النوع
وقد دفعت مسألة نقاء النوع هذه بعضَ النقاد المحدَثين إلى رفض فكرة النوع كليةً، كردِّ فعلٍ متطرف ، مثل “كروتشه” على سبيل المثال، الذي يرى أن “الأدب مجموعة من القصائد المتفرقة والمسرحيات والروايات تشترك في اسمٍ واحد”. ولسنا في الواقع مع فكرة إلغاء الحدود بين الأنواع الأدبية، لأن تمايز الأنواع الأدبية يبقى حقيقةً قائمة، وهي حقيقة يكاد يجمِع عليها معظم النقاد الكبار كـ “جوته، وهيجل، وإليوت، وفراي، وعبد المنعم تليمة، وغيرهم .
إذَن فالتقسيم بين الأنواع الأدبية ضرورة، على الرغم من اتفاقنا التام مع نظريات النوع الحديثة التي تتعامل مع النوع الأدبي باعتباره مفهومًا مرِنًا ومفتوحًا، يسمح بالتعدد والتداخل، حتى ليمكن القول إنه مفهوم (أي النوع الأدبي) يطوّر نفسَه مع الزمن .
وقد وجد “تليمة” في هذا التداخل إفادةً وثراء للنوع الأدبي، فقال: “إن التطور العملي والاجتماعي في العصر الحديث أثر تأثيرًا عميقًا في التطور الفني، جعل الفنون تتنوع وتتعاون وتتداخل، وعقد الخبرة الجمالية وصقلها وأنشأ عاداتٍ ومداركَ في التلقي جديدة، ولهذا كله وجدنا أن الآداب الحديثة والمعاصرة تحقق بصورة واسعة تداخل المواقف الأدبية الثلاثة في كل أثرٍ أدبي ناجح، فتحققت الملحمية والدرامية في الشعر الغنائي، وتحققت الغنائية والملحمية في الأدب المسرحي، وتداخلت المواقف الثلاثة في الرواية … إلخ. ولم يتعارض هذا التداخل مع تمايز الأنواع الأدبية ، بل لقد أفاده وأغناه”
ونخلص مِن كلام إليوت وتليمة إلى أن النوع الأدبي يبقى قائمًا وقارًا بقواعده الأدبية (شعريته) وقيمِه، إلا أنه قد تُهيمِن عليه إحدى الصيغ الثلاثة: الملحمية، أو الدرامية، أو الغنائية، وهيمنة إحدى الصيغ لا يعد عيبًا أو ميزةً للعمل، ويُشترَط فقط في هذه الهيمنة، من وجهة نظرنا، ألا تخل هذه الهيمنة بثوابت أو قواعد النوع الأدبي، فعلى سبيل المثال عندما يطغى العنصر الدرامي على القصة القصيرة فيحوّلها إلى مجرد حوارٍ بين شخصين أو أكثر، دون وضوح وجهة نظر الراوي أو حتى المؤلف، يختل بناء العمل السردي. (مرجع: محمد عبد الحليم غنيم – القصة القصيرة وإشكالية النوع الأدبي – دراسة تطبيقية)
إن النوع الأدبي، مثله مثل الكائن الحي، له عناصر يعيش بها وعليها، يأتي مِن بينها ـ إن لم يكن في بدايتها ـ القدرة علي التواجد والتواؤم فيما يحيط به من بيئةٍ وظروف معيشية. فإذا اختل أحد هذه العناصر، تعرّض هذا الكائن/ النوع الأدبي لأزمةٍ قد تودي به وتدفع به إلى الانقراض أو التحول أو التحور. على أن هذا التطور أو التحور إنما يتم في الشكل الخارجي فقط، بينما جوهر الإبداع ثابتٌ لا يتغير، مثلما أن الإنسان يلبس لكل فصل من فصول السنة لباسَه، بينما الإنسان هو الإنسان في كل فصول السنة.
إننا إذا كنا نعيش عصر التسليع (تحويل كل شيء إلى سلعة)، فعلينا أن نسلّم بأن الأنواع الأدبية ليست إلا سلعًا متنوعة أيضًا، يسعى كل منتج لإحداها (المبدع) إلى اجتذاب المستهلِك (القارئ أو المتلقي) إلى سلعتِه. ووجبَ عليه أن يبحث عن الطريق الذي يوصّله لشراء أو استخدام أو استهلاك هذه السلعة دون سواها، وعليه يتوقف نجاح عملية التسويق في فهم العناصر الجاذبة لسلعتِه دون سواها.
وبنفس المنطق، يمكن تصور كل نوع أدبي كشِركةٍ منافسة لغيرها من الشركات، وما دُمنا نعيش عصر الشركات الكبيرة وعابرة القارات التي تبتلع الكبيرةُ فيها الصغيرةَ، أو تقضي عليها. فنستطيع تصور الرواية الآن شركةً كبيرة ابتلعت كل الأنواع الأدبية الأخرى – بلا استثناء – وترَكَتها تعاني الاختناقَ ومحاولة البحث عن قُبلةِ الحياة.
إن التاريخ يشهد بانقراض أنواعٍ أدبية – مثل الملحمة، وتوقف السيَر الشعبية عند ما عُرِف منها وأصبح تاريخا يُنقب عنه مثل الآثار – أو التحور مثل أشكال الأنواع الأدبية عامة، فتحورت الرواية من الخط الزمني المتصاعد، إلى الخط الأفقي المستقيم، والشعر من العمودي إلى أن وصل لقصيدة النثر، والقصة القصيرة لِمَا يسمّى بالقصة القصيدة والقصة القصيرة جدًا، وهي بيت القصيد في حديثنا.
فإذا ما سلّمنا بأن النوع الأدبي هو إحدى الشركات المتنافسة، فإنني عندما أرغب في الالتحاق بهذه الشركة، فإنني أقدّم أوراق اعتمادي على هدى، وبموافقة القواعد العامة التي تحكم هذه الشركة، وإذا ما أردتُ التغيير أو التطوير، فإن ذلك لا يتم إلا بعد قبول أوراقي وانضمامي لكتيبة العاملين بها. لذا فإنه على الرغم من عدم الاتفاق على تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لأي من الأنواع الأدبية، خاصةً القصة القصيرة، وانفتاح الحدود الفاصلة بين النوع والآخر، إلا أنه لا بدّ من الاتفاق على (دستور) يحدد الإطارَ العام لهذا النوع، لا بدّ من التسليم به في البداية، وبعدَها يمكن العمل علي التطوير والتجديد، أو وضْع (القانون) المنظّم لحركة النوع.
فإذا ما عرَضنا القصةَ القصيرة على هذه المفاهيم، لتبين لنا العِلة التي تعاني منها، وسَعَينا نحو البحث عن سبل الخروج منها، بل، وتبين لنا أنها ليست وحدَها التي تعاني العِلة، أو عدم القدرة علي المواءمة والعيش وسط غابات الإبداع، وأمامَ أسدِ الغابة الذي ابتلع مجموعةَ الخراف/ الأنواع وهو الرواية، حيث نجد الشعر أيضًا يعيش نفس الظروف البيئية والطبيعية التي تؤكد وجودَ الضائقة أو الأزمة.
ووصولاً لأسباب وظروف هذه الأزمة، دعنا نبدأ من البداية.
وبحثًا عن أنبوبة أكسجين متمثلةٍ في بقايا وسائل النشر وضيق مساحاتها. يلجأ الإبداع القصصي إلي وسيلة يستطيع بها التغلب علي ذلك الاختناق، ومنح تلك الوسائل الفرصة للنشر في حدود المتبقي من مساحة الإعلان، فيلجأ المبدعون إلى القصة القصيرة جدًا، والتي لا تتجاوز الصفحة الواحدة، ثم تقلصت فأصبحت بضع سطور، إلى أن وصلت إلى بعض الجُمَل، ثم أصبحت مثل رسائل الموبايل. فغاب عنها حوار الذات المبدعة، وغاب عنها الحكي، وغاب عنها التشويق، وغابت عنها المتعة واللذة، وغابت عنها القصة، أو غابت القصة عنها. فوصل الاختصار والاختزال إلى الحد الذي أصبح اسمها يشار إليه أيضًا بالاختزال، فباتت تُعرَف بـ (ق ق ج)
هل ضاعت الحدود بين الأنواع الأدبية في ظل طغيان ظاهرة العولمة؟ وهل نعيش بالفعل عصرَ تداخل الفنون والأشكال الإبداعية العابرة للأنواع والأجناس التي درَجنا عليها؟! فبدلاً من الرواية والقصة والشعر والمسرح، أصبحنا نجد المسراوية، والقصة القصيرة، والمتتالية القصصية، وتنويعات روائية، فهل أصبحت هذه الأنواع الجديدة تتماشى مع ظروف وإيقاع العصر الذي نعيشه؟ حيث تصب مجريات كافة الأنواع في نهرٍ واحد كما تبشّرنا العولمة!؟ وهل انقضى عصر التخصص الدقيق، وأصبح لِزامًا على المبدع تخطي الأطُر القديمة وتحطيمها؟!
تحولات هائلة
يؤكد الناقد والمترجم سامي خشبة في البداية، أن التحولاتِ الهائلةَ في الواقع الإنساني والاجتماعي والنفسي والمعرفي والفكري أملت ان تتغير وسائل التعبير الفني ذاتها، وأن تتغير طبائع وملامح وأساليب ووسائل ولغات التعبير وأبنية الإبداع إلى الدرجة التي أصبح مِن الممكن أن تبدو الرواية بحثًا معرفيًا، أو إشراقات غنائية، أو خيالات أسطورية متراكمة، وأن تتخذ البنية الخارجية لنص شعري طبيعةً سردية، أو طبيعةً درامية متعددة الأصوات والمداخل والأمزجة. ولا شك أن هذا التغيير متعدد الوجوه قد أزال الكثير من الفوارق بين الأنواع التي أصبحت معها كلمة النص تستخدَم لتوصيف أي عمل أدبي، وإلى الدرجة التي أصبحت فيها فكرة تقسيم الإبداع فكرةً بدائية إلى حدٍ ما. إذَن فالتعبير مِن حولنا يدفعنا إلى تأكيد تغيّر حدود العلاقة بين الأنواع الأدبية, ومن ناحيةٍ أخرى يضيف الناقد د. مصطفى عبد الغني، أن التغييراتِ الحادةَ التي شهدها عالمنا المعاصر، في العقد الأخير منه على وجه خاص، تدعنا ندرك أن الخلاف بين وجود الحدود الأدبية أو عدم وجودها، هو مِن قبيل لزوم ما لا يلزم، وهو بأية حال يعبر عن مناخنا الأدبي، فضلا عن وعينا الاجتماعي والمعرفي، فقد مضى عصر أفلاطون الذي قسّم جمهوريتَه بين ثلاثة أنواع من المحاكاة، وأرسطو الذي سعَى لتحديد أنواع أدبية بعينها، ومِن المعروف أن هذا التقسيم أعيدت صياغته مع الوقت بامتداد دوائر الأنواع الأدبية وتطورها، ولو عُدنا لكثير من النصوص التي ظهرت، على الأقل منذ عصر النهضة في الغرب، سنلاحظ أن أيًا من الأنواع الأدبية ليس جنسًا مغلَقًا، ولكنها في الوقت نفسه تخضع لمؤثرات الواقع حولها التي تدفع لتداخل الأجناس. وعلى هذا النحو، فإن الإبداع والتلقي محكومانِ بواقعٍ لغوي محدد، وعلاقاتٍ اجتماعية وثقافية مغايرة، ونحن نميل إلى الربط بين التطور الفني والتطور الاجتماعي الفكري، خصوصًا في العصر الحديث، بحيث تتنوع الفنون وتتداخل، وتنشأ عادات ومدارك جديدة في التلقي.
التداخل حقيقةً وليس خيالا
أمّا الأديب إدوار الخرّاط، صاحب العديد من المصطلحات، مثل الحساسية الجديدة، والمتتالية القصصية، فيقول، لا بدّ من التأكيد أولا أنني لا أستحدِث هذه المصطلحات، أو أطلِقها من فراغ، ولكنها توجد لتفسير العديد من الظواهر الفنية القائمة بالفعل في العمل الإبداعي، وقد وجدت أنه يوجد نوع من التجاوز للأنواع الأدبية بمفهومها التقليدي الذي استقر في الأذهان فترةً طويلة، بمعنى أن القصة القصيرة على سبيل المثال، وفْقَ مفهومِها القديم، لم تعد تلبي المواصفاتِ المعروفةَ للقصة القصيرة حاليًا؛ فالأنواع الأدبية قد تداخلت بالفعل، ليس لمجرد استعارة بعض التقنيات الموجودة في بقية الأجناس الفنية، أو استعارة بعض تقنيات الشعر، أو الدراما، بل التداخل أصبح لازمًا بشكل يوجد به استيعاب لهذه التقنيات وانصهارها داخل العمل في بوتقة واحدة، وهذا التداخل يكون في الشكل والمضمون، فالكتابة عبْر النوعية تقوم الآن على إسقاط الحدود بين الأنواع الأدبية التقليدية التي ترسخت على مَر العقود، والآن لا يوجد عائق أمام الأديب في تخطي هذه الحدود، فعملية الانصهار التي أشرت إليها آنفًا تتم بحيث تصبح الكتابة شيئًا آخر، لا هو بالقصة القصيرة أو الرواية، بل يستوعبهما ويتجاوزهما في الوقت نفسه، بل يمكن استيعاب تقنيات ورؤى من الفنون غير القولية، مِن الفن التشكيلي، والنحت، والموسيقى، على سبيل الاستعارة أو الإقحام أو التزيين، وبشكل ما تصبح هذه المنجزات كلها وحدةً واحدة متنوعة النغمات، ولكنها متسعة في الوقت نفسِه.
الحدود لا تسقط
على عكس ذلك يرفض الأديب الكبير سليمان فياض مقولةَ ضياعِ الحدود الأدبية، ويرى أن هذه الحدود تعني ببساطة جوهرَ كل نوع وخصوصيته المميزة، فإذا تم إسقاطها فهذا يعني أن الشيء المكتوب ليس أدبًا، ولا ينتمي إلى أي نوع من الأنواع الأدبية، ورغم ذلك قد يكون هناك تأثير وتأثر بين هذه الأجناس المختلفة، وهذا التأثير لا يلغي الحدود، وإنما يندرج تحتَها.
يتفق مع هذا الرأي الأديب إبراهيم أصلان الذي يؤكد أننا لا نستطيع إطلاق مسمّى القصة القصيرة مثلاً على القصة المكتوبة بلغة شاعرية، أو نقول عنها إنها كتابة عابرة للأنواع الأدبية، وإنما هي نصٌّ إبداعي مكتوب بلغةٍ راقية، وتسمى قصة، وليست قصيدة؛ لأنه تتوفر فيها أدوات الفن القصصي، وهكذا تكون الرواية وكافة الأنواع الأدبية.
ومن ناحيته يرفض الناقد إبراهيم فتحي إسقاطَ الحدود الأدبية، مؤكدًا أنه رغم وجود التداخل بين الأنواع الأدبية إلا أنه في النهاية سيظل لكل منها عالمه القائم بذاته، ويضيف، إننا قد نجد ملامح الشعر تدخل في نطاق القصة أو الرواية، والعكس صحيح، وتوجد كثير من القصص يمكن أن نطلِق عليها قصائد غنائية، مثل بعض قصص يوسف إدريس، ويحيي الطاهر عبد الله، ورغم ذلك فالحدود بين الأجناس الأدبية قائمة ولن تسقط؛ لأن كل جنسٍ أدبي يتم بناؤه على حسب التصورات والأخيلة لأنواع التجارب الإنسانية، وقد يكون هناك تداخل بين الأنواع الأدبية، فالحوار، والنمط الملحمي، يمكن وجودهما في الرواية، ولكن في النهاية سيظل لكل نوعٍ العالَم الخاص به والقائم بذاته، فيجب أن يكون هناك توازن، وأن يتوافر في كل فن خصائصه.
بينما يرى الناقد “صلاح فضل”، أن الأنواع الأدبية قد استقرت في ضمير الأجيال، ولا يمكن إلغاء المساحة فيما بينها دون أن يخرج المبدع عن القوانين التي يعرفها المتلقي، وهذا ليس معناه أن المبدعين يتعين عليهم أن يختاروا هذه القواعد المحددة سلفًا؛ فهُم يلعبون دائمًا بتوترٍ محسوب يتردد بين قطبيْن، قطب إشباع توقّع القراء من ناحية باستيفاء الشروط، وقطب إدهاشهم بابتكار تنويعة جديدة على قواعد اللعب يفهمها الجمهور ويستجيب لها، ومِن هذا الهامش يتطور الفن، وتنمو الأجناس الأدبية محافِظةً بشكلٍ ما على هذا الهامش من الحرية، وعلى خواصها المحددة، غير أن هناك محاولاتٍ أخرى يغلب عليها طابع التجريب، وهذه تعَد إضافةً وليس إلغاءً للأنواع السابقة، لذلك فالدعوة إلى إلغاء الفوارق دعوةٌ لا يَعترف بها التاريخ، ولا تستسيغها الذائقةُ الأدبية.
أما الناقد والشاعر الدكتور يوسف نوفل، فيري أنه في مجال تطور الأجناس الأدبية، عبْر مسيرتها الفنية من جيلٍ إلى جيل ومن عصرٍ إلى عصر، حدثَ نوع من التمازج أو التقارب بين بعض الأصول الفنية لتلك الأجناس الأدبية، وهذا التمازج قد وصل إلى الحد الذي تمت فيه استعاراتٌ فنية بين الأجناس الأدبية، بحيث أصبحنا نرى أديبًا يستعير بعض الملامح الفنية من جنسٍ آخر، وهذه الاستعارات دقيقة للغاية، ويؤدي الإسراف في استعمالها إلى نوع من الفوضى الفنية، حتى أصبحنا نصادف في كثير من القصص ما يستعصى على الفهم، ورأينا أن هذا الفن يجنح إلى الذهنية ومتاهات التعقيد والغموض، ومِن حق قارئ اليوم أن يتساءل، هل أدت موجة التراسل بين الفنون إلى تلاشي الحدود الفاصلة بينها؟
وإجابتي بالنفي؛ إذ لا يتيسر لعصر أدبي ما أن يذيب الفواصلَ الفنية بين الأجناس الأدبية، ويطمس معالمها، ومن الصواب أن نقول إنه يوجد استعارات شتّى تتم بين الأجناس الأدبية، وليس إلغاءً أو ضياعًا للحدود الأدبية، وهكذا تظل القضية بين إثبات الحدود وإلغائها غير أن الأشكال الجديدة ستظل رهنَ المستقبل في إثبات سيادتها أو انتفائها.
يشبّه بعضُ دارسي السرد الأدبي الروايةَ بالنهر الذي يسيل من منبعٍ إلى مصب، في حين أن القصة القصيرة تمثّل موجةً وسط النهر.. وهي ليست في الوقت نفسه جزءًا ولا فصلاً من الرواية، ففي القصة القصيرة يقارب الكاتب مشهدًا أو عدة مَشاهد متخيّلة، لها صلة وثيقة بالواقع، أو بما يحتمل وقوعه، ويقتصر على سرد حادثةٍ يتألف منها موضوع مستقل، لكن رغم قِصره يجب أن يكون كاملاً ناضجًا من وجهة التحليل والمعالجة. ولا يتهيأ هذا إلاّ ببراعةٍ يمتاز بها كاتبها، إذ إن المجال أمامه ضيّق محدود يتطلب التكثيف والتركيز الفني الدقيق.
ويرى دارسون آخرون، أن القصة القصيرة لا تحتمل غير حدثٍ واحد، وربما تكتفي بتصوير لحظة شعورية واحدة نتجت عن حدثٍ وقعَ بالفعل، أو كان متوقعًا حدوثه، ولا يدهش القارئ إذا انتهى من القصة، ولم يعثر فيها على حدث؛ إذ يمكن أن تكون مجرد صورةٍ أو تشخيصٍ لحالةٍ محددة، أو رحلة عابرة في أعماق شخصية.
القاص والشاعر الأميركي “إدغار آلان بو”، مِن أوائل الذين كَتبوا بعض المبادئ المتعلقة بالقصة القصيرة، مِن خلال تجربته في كتابة القصة البوليسية، فقد ذهب إلى أنها يجب أن تمتلك “وحدة التأثير أو الانطباع″، وأن تُقرأ في نصف ساعة، أي في جلسة واحدة، في تأكيده على أهمية التأثير الواحد، ووحدة الحبكة، والشخصية، والمزاج، واللغة. وبربطِه بين القصة والأغنية الشعرية وضع “بو” القولَ الفصل، الذي سيصبح حاسمًا للقصة القصيرة التي تدين بالكثير لكثافة الشعر الغنائي ووحدتِه.
يتفق شارلز ماي مع إيخنباوم -أحد أقطاب الشكلانية- على أن القصة القصيرة شكلٌ أساسي أوّلي، بل إنه يشير إلى أنها شكل له صلة وثيقة بالسرد البدائي الذي يجسد التصورَ الأسطوري ويلخصه، والذي يكون مِن سماته التكثيف لا التوسع، والتركيز لا التشتت. وبدلاً من تقديم التفاصيل بشكل خارجي تمامًا، وبطريقة ثابتة في الزمان والمكان، فإن القصة لا تستغل إلاّ تلك التفاصيل الضرورية والنافعة لها، ويبدو التقدم فيها وكأنه متجِهٌ إلى هدفٍ وحيد. وفي شكلها الفني يصبح التوتر بين المتطلبات الجمالية ومتطلبات مشابهة الحقيقة أكثر حسمًا منه في الرواية؛ ذلك أن قِصر القصة القصيرة يتطلب شكلاً جماليًا أكثر مما يتطلب شكلاً طبيعيًا أو أساسيًا. وهي تظل -أكثر من الرواية- أقربَ إلى أسلافها في بناء القصة الأسطورية، كما أنها أكثر ارتباطًا بصيغة الرومانس منها بالصيغة الواقعية، ومن ثَم فإن الشخصياتِ فيها أقرب إلى أن تكون – كما يشير الناقد الكندي نورثروب فراي – شخصياتٍ مؤسلبة، أكثر منها أناسًا حقيقيين، فهي تبدو كأنها تشتغل وفقًا لتقاليد مشابهة الحقيقة والمعقولية، لكن لأن قِصر الشكل يمنع من التقديم الواقعي للشخصية عن طريق التفاصيل الكنائية الشاملة، وبما أن تاريخ القصة القصيرة هو التاريخ الذي تلتقي فيه الشخصيةُ بحادثةٍ حاسمة أو أزمة أكثر مما تتطور عبر الزمن، فإن الشكل والتراث الخاصيْن بالقصة القصيرة يعملان بقوةٍ ضد التقاليد المحورية في الواقعية.
إن الشخصياتِ في القصة القصيرة، كما يذهب “ماي”، هي في الوقت نفسه أقنعةٌ اجتماعية في قصٍ واقعي، وتجليات رمزية في قصٍ رومانسي، وتتحول في عملية السرد إلى مجاز، أي إنها تصبح واقعةً في خطاب مِن صُنعِ مجازها وهاجسِها الخاص. وهذه هي العملية التي يحوّل بها التحفيز الواقعي والعرض الرومانتيكي قصةَ الرومانس القديمة إلى خطابٍ قصصي جديد.
أما النقاد، فإن أغلبهم يرى أن القصة القصيرة أصبحت نوعًا أدبيًا هامشيًا على أطراف الحياة الثقافية العربية، وأن وضْعها يدعو إلى التساؤل والقلق . ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك مؤكدًا أن القصة القصيرة ميتةٌ مجازيًا وثقافيًا، وقد سلّمت الرايةَ إلى فن الرواية، ويجد أن مِن الاستحالة على القصة القصيرة الارتقاء إلى رتبة النوع القابل لتحولاتٍ حقيقية في بنيتِه ووظيفته الدلالية، فهي ما زالت أسيرةَ أصلِها الحكائي وشكلِها المغلَق، في عصرٍ أصبح كل شيء فيه مفتوحًا، ومحاولة الانفتاح فيها ستجعل منها مشهدًا سرديًا في نصٍ روائي. ومسألة حدود الجنس أو النوع لا تخيف التجريبَ ولا تعيقه، ولا توقِف تطورَ النوع، ولا تحد من حرية الكاتب في الكتابة، إنها أشبَه ما تكون بملامح أجناس البشر وأنواع النبات. ليس هناك ما يمنع من مراعاتها والانطلاق منها، دون أن يحد ذلك من أي فرصٍ للتجديد، بل إن المحافَظةَ عليها حفاظٌ على خصائص النوع، مع الإقرار بأنها خصائصُ عامة كبرى، وليست قيودًا أو حدودًا مغلَقة تؤدي إلى التنميط والتكرار والتشابه.
المراجع :
– تجلي الجميل: مقالات هانز جورج غاديمير
– الحساسية الجديدة: إدوار الخرّاط
– المشهد القصصي: إدوار الخرّاط
– المعجم الوسط: تعريفات للموقف والبلاغة والفصاحة
– عِلم الجمال وفلسفة الفن: هيجل
– القاعدة والخرق: د. لؤي علي خليل
– ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ، ﺘﺯﻓﻴﺘﺎﻥ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒـﻭ ﻋـﻼﻡ، ﺩﺍﺭ
ﺸﺭﻗﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1994.
– ﺠﻴﻨﻴﺕ، ﺠﻴﺭﺍﺭ، ﻤﺩﺨل ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﻴﻭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، 1986.
– القصة القصيرة العربية .. ملاحظات على تاريخ الجنس الأدبي وتكونه: د محمد عبيد الله، مجلة الرأي الإلكترونية
– عِلم الأجناس الأدبية: إيف استالوني
– أثواب الأدب العربي: توفيق الحكيم
– القصة القصيرة وإشكالية النوع الأدبي، دراسة تطبيقية: محمد عبد الحليم غنيم
– قصة قصيرة..-.. ١٠:٠٤ ص ١٢ ديسمبر ٢٠١٧: دكتور محمد العنتبلي
– قائمة كتاّب القصة القصيرة العرب “، wikiwand، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019.
– مفهوم القصة وأنواعها”، stories-blog، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2019.
محمود السانوسي

 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
كما أن البلاغةَ لا تكون وصفًا للكلام، وتحمل البلاغةُ معاني كثيرةً في ألفاظ قليلة، فالبلاغة كلمة تستخدم لتكشف عن بقية الكلام بإيجازٍ وإيصال للمعنى، إلا أن البعض لا يفرّق بين البلاغة والفصاحة، حيث تقتصر الفصاحة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفًا للألفاظ مع المعاني، تلك البلاغة التي تحتوي على ثمانية أضرب، هي “الإيجاز، والاستعارة، والتشبيه، والبيان، والنظم، والتصرف، والمشاكَلة، والمثل”.
تكمن أهمية القصة القصيرة في أنها شكلٌ أدبي فني، قادر على طرح أعقد الرؤى وأخصب القضايا الاجتماعية في المجتمع، وبصورة دقيقة واعية، من خلال علاقة الحدث بالواقع، وما ينجم عنه من صراع، وما تمتاز به من تركيز وتكثيف في استخدام الدلالات اللغوية المناسبة لطبيعة الحدث، وأحوال الشخصية، وخصائص القص، وحركية الحوار والسرد، ومظاهر الخيال والحقيقة، وغير ذلك من القضايا التي تتوغل في هذا الفن الأدبي المتميز
((الأقصوصة أو القصة القصيرة ))، هي عبارة عن “سرد حكائي نثري أقصر من الرواية”. وتهدف إلى تقديم حدثٍ وحيد غالبًا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكانٍ محدود غالبًا؛ لتعبّر عن موقفٍ أو جانبٍ من جوانب الحياة ..
في حديثنا عن البلاغة التي هي هنا بلاغة القصة القصيرة، لا نجد ما يتناسب مع كونها بلاغة لموقف من الأمور تصحبه عادةً استجابةٌ خاصة، فهل هذا المعنى للموقف يمكن أن تناسبه بلاغة الصورة المجازية والكنائية بأنماطها العديدة، والذي نشأ في ظل البيئة الرعوية الصحراوية؟ أم أنها بلاغة درامية تتصف بتعارض الإرادات؟ قد يكون تعارضًا داخل النفس الواحدة، أو تعارضًا مع آخرين، نتيجة اختلاف الهوية الثقافية أو الدافع أو الهوى والرغبات .
في معرض حديثي عن القصة القصيرة، وحدودها الفنية، وجدت تباينًا ملحوظًا في الآراء التي استند مستنبطوها على وعيهم الجمالي بالنصوص الموجودة في عصرهم، منهم مَن اهتم بالحجم والتسمية، مثل “إدجار آلان بو”، حيث أوضح أن هناك جنسيْن للأدب، أحدهما يُقرأ في جلسة واحدة، والآخر يمكن تداوله على عدة جلسات، متأثرًا بنشاط الطباعة والصحافة الذى أتاح للسرد القصير أن ينتشر عبر الصحف والمجلات الأدبية .
آخرون اهتموا بتكوينها الدرامي، خلاف الرواية، فهي الصوت المتوحد، أو الصوت المنفرد، كما أوضح “فرانك أكونور” في كتابه (الصوت المتوحد) والذي أكّد للقصة القصيرة اليومية ألا تهتم إلا بالحدث المهم، أي ما كان ذا دلالةٍ، مما يدفعها للانزلاق نحو النهاية سريعًا، بخلاف الرواية، وما أكده “أرسطو” حول مفهوم الحبكة وكونها بداية ووسط ونهاية، ذلك الانزلاق المبني على وعي حادٍ باستيحاش الإنسان، أو كما قال “نجيب محفوظ” حول اهتمامه بالقصة القصيرة، كونها تمثل التفاعلَ المباشر مع مواقف الحياة، بخلاف الرواية التي تلزم كاتبَها بالاعتكاف لعامٍ كاملٍ لكتابتها، ذلك الوعي الاستيحاشي الذي يشير اليه “أكونور” يقوم على المفاجآت، حتى وإن كانت متوقعة؛ لأنه يعمل على الصدمة النابعة من أشياءَ نعرفها بالفعل، لكننا نكتشف أننا لا نعرفها من قبل، أو ما يضعنا أمام مسألة تخابث العالم والشعور بمدى تآمرِه على اللحظة السردية .
إلا أن اختلاف الظروف التي نشأت فيها القصة القصيرة، وسقوطها في براثن الاستغلال الأيدولوجي، لفتراتٍ زمنية طويلة، جعل منها منبرًا دعائيًا وخطابيًا في أحايينَ كثيرةٍ، ووسيلةً للتعبير عن التمرد السياسي والاجتماعي والأخلاقي، بل تشكلت ملامحها الخاصة بكونها سردًا معبرًا عن الطبقات المسحوقة والمهمّشة ضد الإقطاعيين والبرجوازيين، فكان لا بدّ أن تحدث ثورة ضد تلك الكتابة النمطية، حتى على مستوى البلاغة والوعي والتصور والطرح، نذكر ما قاله “الخراط” في كتابه (الحساسية الجديدة) عن تلك التقنيات المرادفة لهذا الفن الحديث، “هي كتابة تسعى لـ كسر الترتيب السردي الطردي، وفك العقدة التقليدية، والغوص في الداخل، لا التعلق بالظاهر، وتحطيم سلسلة الزمن السائر في خط مستقيم، وتراكب الأفعال، المضارع والماضي والمحتمل معًا، وتهديد بنية اللغة المكرسة، ورميها نهائيًا خارج متاحف القواميس، وتوسيع دلالة الواقع لكي يشمل أيضًا الحلم والأسطورة والشعر، ومساءلة إن لم تكن مداهمة الشكل الاجتماعي القائم، وتدمير سياق اللغة السائد المقبول، واقتحام مغاور ما تحت الوعي، واستخدام صيغة الأنا، لا للتعبير عن العاطفة والشحن، بل لتعرية أغوار الذات وصولا إلى تلك المنطقة الغامضة المشتركة التي يمكن تسميتها ما بين الذاتيات، هي رؤيا وموقف وليس انقلابًا شكليًا” .
ربما جاءت أغلب آراء النقاد القاسية في توصيفهم للقصة القصيرة، بأنها أصبحت نوعًا أدبيًا هامشيًا، وهي ميتة مجازًا وثقافيًا، وقد سلّمت الرايةَ إلى فن الرواية، حيث مِن الاستحالة على القصة القصيرة الارتقاء إلى رتبة النوع القابل لتحولات حقيقية في بنيتها ووظيفتها الدلالية؛ فهي ما زالت أسيرة أصلِها الحكائي وشكلها المغلق في عصرٍ أصبح كل شيء فيه مفتوحًا، ومحاولة الانفتاح فيها ستجعل منها مشهدًا سرديًا في نصٍ روائي.
إن الكتابةَ الإبداعية، لسببٍ أو لآخر، قد أصبحت اختراقًا لا تقليدًا، واستشكالا لا مطابقة، وإثارةً للسؤال لا تقديمًا للأجوبة، ومهاجمة للمجهول لا رضا عن الذات بالعرفان .
وقبل أن نتحدث عن أهمية حدود النوع في القصة القصيرة، أحِب أن أوضح خصائص ذلك النوع، والتي تميزها عن باقي الفنون: وهي وحدة الموضوع، التكثيف، الدراما.
أهمية حدود النوع الأدبي وأثره على التلقي
تحديد ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻨـﻭﻉ، ﺇﺫَﻥ،ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁًﺎ ﻭﺜﻴﻘًﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤﻁٍ ﻤﻌينٍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺩﺍﺌﻤًﺎ، ﻤﺠﺎلَ ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﻤﺤﻁ ﺨـﻼﻑٍ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏُ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ _ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ “ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ”، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
“ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻭﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ”. ﻭﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺼﻭﺭٍ
ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﱢل ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺇﺫ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻭﻋِﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ (ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ)!
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓٌ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺭﺴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ، “ﻏﻴﺭ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭِﻨﺔ، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻕ، ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗـﺎﺕ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤـﻲ ﺇﻟﻴـها، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﺭﻗًﺎ ﺠﺯﺀًﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ. ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.
ﻓﻤﺎ ﺩُﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﻗﺒِﻠﻨﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨـﻭﻉ، ﻓﻼ ﺒـﺩّ ﺃﻥ ﻨﻘﺒـل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤِﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﻭلُ ﺍﻟﻤﺒـﺩأَ ﺍﻷﺴﺎسي ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ (ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺭﻕ)؛ ﻓﺒﻘﺩْﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻤﺘﺎﺤًﺎ ﺒﻘﺩْﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌًﺎ؛ ﻓﻼ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍلاﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀً ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺇﻻ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺭﻕ؛ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﺭﻕ ﻨﻭﻋَﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔً ﺼﻐﺭﻯ ﻭﻤﻔﺘﺭَﻀـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﺹ، ﺘﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ (ﺼﻐﺭﻯ)، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒّﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺨﺭﻕ ﺃﻜﺒﺭَ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ. ﺇﻥّ ﻨﺼًﺎ ﻗﺼﺼﻴًﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭَ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻭﺼﻔِﻪ ﻗﺼﺔ،، ﻷﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒّﻌِﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋِﻲ ﺍﻟﺩﺨﻴل ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨـﺎﺯﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔَ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ.
ويمكن ضرب مثل على ذلك، قصيدة “وجبة الصباح”، لــ جاك بريفير، والتي تعَد نموذجًا للقصيدة القصة، بمعنى أن هنا نسبة تشبّع العنصر النوعي للقصيدة أعلى من القصة، لذا فهي تنتمي لعنصر الشِّعر، يقول فيها:
وضعَ القهوةَ / في الفنجان
وضعَ الحليبَ في فنجانِ القهوة
وضعَ السكّرَ / في القهوةِ بالحليب
حرّكَها / بالملعقةِ الصغيرةِ / شربَ القهوةَ بالحليب
وضعَ الفنجانَ دون أن يكلِّمَني
أشعلَ سيجارةً / نفثَ دوائرَ من الدخان
ألقى الرمادَ / في المنفضةِ / دون أن يكلّمني
دون أن ينظرَ إليّ
نهضَ / وضعَ قبّعتَه على رأسِه
ارتدَى معطفَ الشتاء
لأن المطرَ كان يهطلُ
وانصرفَ تحت زخاتِ المطر
دون كلمةٍ
دون أن ينظرَ إليّ
وأنا وضعتُ رأسي بين يدَي
وبكيتُ ..
ربما فكرة اقتراب القصة من الشعر هي وحدة الأثر
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨـﻪ
ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠِﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤِﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭَ ﻨﻭﻋﻴﺔٍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺭِﺠﻪ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ؛ ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﺫﻟﻙ
ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻭﻜﺘّﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎلٍ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺩﺏ
ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺴﻴَﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻁﺒﻴﻌﺔُ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ؛ ﻓﺎلاﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻥ “ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺸﺭﻭﻁَ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻲ ﺒﻌﻴﻨﻪ…ﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﻭﺠًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ”. إذَن ليس هناك شكلٌ سابق محدد قالبي نمطي، نستطيع أن نقول بناءً عليه هذه قصة، وهذه ليست قصة، والذي يحدد هذا هو القاص بإبداعه الخاص، فهو ينظر إلى القوانين بعد كتابة العمل، وليس قبلَه، وبالتالي يمكن أن تكون هناك قصة ليس فيها أي حدثٍ على الإطلاق، وسوف نجد في داخل ميكانيزم التطور الداخلي لهذه اللوحة عقدةً وحَلاً، وكل ما نتلمسه من الطرائق والمواصفات المثيرة لخلق الدلالة المطلوب من القاري أيضًا أن يشارك فيه .
1- يقول الخراط، لماذا القصة القصيدة؟ ولماذا اللغات المتعددة؟
أشير هنا إلى الحفاوة باللغة؛ لأن هذا ردٌّ على جدل امتهان اللغة العربية في واقعها الذي نعيش فيه هذا الخليطَ الغريب من امتهان اللغة والذات القومية، أصبح له رد على مستو الحفاوة، كما احتفى “إبراهيم فهمي” ردًا على استلابه مِن فردوسه المفقود، “أرض النوبة القديمة”، قائلا في قصتِه:
” بحر النيل ، نيل وبحر “، أول صباح في بلد بلا بحر ، صباح بلا نهار ، صباح بلا ليل، وجبين بلا شمس ( كانت تزينه شمس البلاد )، وجبين كان يزينه في الليالي قمر ..أيام بلا وطن كبحر بلا منابع ، بلا مصب ..كانت البلاد بلاد ببحر ..جاءت بلاد بلا مطر ..يا جميلة من نصب المصائد للبنات في الشوارع وأبحر ..أساري من أرض ببحر إلى أرض بلا ! من بنى هالبلاد الجديدة لا يعرف حتى يرى بيت من البيوت يدق بالعشق قلبك يا بلد ..من بنى هالبلاد لا يعرف أن الناس تحب بحورها فتعشقها ..وتحب بحورها فتعشقها “
هذا توجع صراع الغنائية، تكثر فيه أساليب النداء، صدقَ “نجيب محفوظ” عندما قال إن القصة القصيرة هي شِعر النثر الحديث، عادت أيضًا اللوحة، والتي تم نقدها على أساس أنها قصة قصيرة ناقصة الفنيات، هذا ما تحدّث عنه نقاد الثلاثينيات عن قصص “محمود طاهر لاشين” ..عادت تلك اللوحات لتستغل الوصفَ والإحساس اللغوي، لتنتج نوعًا من القصص القصيرة المشهدية، لتؤكد مقولة “يحيي حقي” أن القصة هي فن التصوير الحسي، رغم تمايز اللوحة عن القصة القصيرة بالآتي:-
1. لا تحتوي بالضرورة على بناءٍ قصصي
2- تقدم شخصياتِها بطريقة مباشرة
3- تتناول أحداثًا “محلية ” وواقعية مباشرة
كَتب “توفيق الحكيم” في كتابه (أثواب الأدب العربي) أن القصة وسيلة الأدب للوصول إلى شيء عميق دقيق في حياة الإنسان، لا مجرد تسليةٍ ومتعة.
إذَن ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤًﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﺴﺎﺭﻴْﻥ
ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺼﺭﺍﻤﺔ ﺤـﺩﻭﺩ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ، ﺃﻱ إﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺸﻜﱢﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﻋﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭٌ ﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﺘـﺴﺎﺀل
ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜل ﻨﻭﻉ، ﺃﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﻡ ﺼﻠﺒﺔ؟ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻕ
مفهوم النوع الأدبي، وكيفية هيمنة إحدى الصيغ على الأخرى، ” يُعَد أر سطو واضعَ الأسس التي تقوم على نظرية الأنواع الأدبية، حيث قسّم الأدبَ في كتابه “الشعر” إلى ثلاثة أنواع، التراجيديا، والكوميديا، والملحمة، وحرصَ أن يبين أن كل نوع أدبي يختلف عن النوع الآخر من حيث الماهية والقيمة، ولذلك ينبغي أن يظل منفصلا عن الآخر، وقد عُرِف هذا فيما بعد بمذهب نقاء النوع
وقد دفعت مسألة نقاء النوع هذه بعضَ النقاد المحدَثين إلى رفض فكرة النوع كليةً، كردِّ فعلٍ متطرف ، مثل “كروتشه” على سبيل المثال، الذي يرى أن “الأدب مجموعة من القصائد المتفرقة والمسرحيات والروايات تشترك في اسمٍ واحد”. ولسنا في الواقع مع فكرة إلغاء الحدود بين الأنواع الأدبية، لأن تمايز الأنواع الأدبية يبقى حقيقةً قائمة، وهي حقيقة يكاد يجمِع عليها معظم النقاد الكبار كـ “جوته، وهيجل، وإليوت، وفراي، وعبد المنعم تليمة، وغيرهم .
إذَن فالتقسيم بين الأنواع الأدبية ضرورة، على الرغم من اتفاقنا التام مع نظريات النوع الحديثة التي تتعامل مع النوع الأدبي باعتباره مفهومًا مرِنًا ومفتوحًا، يسمح بالتعدد والتداخل، حتى ليمكن القول إنه مفهوم (أي النوع الأدبي) يطوّر نفسَه مع الزمن .
وقد وجد “تليمة” في هذا التداخل إفادةً وثراء للنوع الأدبي، فقال: “إن التطور العملي والاجتماعي في العصر الحديث أثر تأثيرًا عميقًا في التطور الفني، جعل الفنون تتنوع وتتعاون وتتداخل، وعقد الخبرة الجمالية وصقلها وأنشأ عاداتٍ ومداركَ في التلقي جديدة، ولهذا كله وجدنا أن الآداب الحديثة والمعاصرة تحقق بصورة واسعة تداخل المواقف الأدبية الثلاثة في كل أثرٍ أدبي ناجح، فتحققت الملحمية والدرامية في الشعر الغنائي، وتحققت الغنائية والملحمية في الأدب المسرحي، وتداخلت المواقف الثلاثة في الرواية … إلخ. ولم يتعارض هذا التداخل مع تمايز الأنواع الأدبية ، بل لقد أفاده وأغناه”
ونخلص مِن كلام إليوت وتليمة إلى أن النوع الأدبي يبقى قائمًا وقارًا بقواعده الأدبية (شعريته) وقيمِه، إلا أنه قد تُهيمِن عليه إحدى الصيغ الثلاثة: الملحمية، أو الدرامية، أو الغنائية، وهيمنة إحدى الصيغ لا يعد عيبًا أو ميزةً للعمل، ويُشترَط فقط في هذه الهيمنة، من وجهة نظرنا، ألا تخل هذه الهيمنة بثوابت أو قواعد النوع الأدبي، فعلى سبيل المثال عندما يطغى العنصر الدرامي على القصة القصيرة فيحوّلها إلى مجرد حوارٍ بين شخصين أو أكثر، دون وضوح وجهة نظر الراوي أو حتى المؤلف، يختل بناء العمل السردي. (مرجع: محمد عبد الحليم غنيم – القصة القصيرة وإشكالية النوع الأدبي – دراسة تطبيقية)
إن النوع الأدبي، مثله مثل الكائن الحي، له عناصر يعيش بها وعليها، يأتي مِن بينها ـ إن لم يكن في بدايتها ـ القدرة علي التواجد والتواؤم فيما يحيط به من بيئةٍ وظروف معيشية. فإذا اختل أحد هذه العناصر، تعرّض هذا الكائن/ النوع الأدبي لأزمةٍ قد تودي به وتدفع به إلى الانقراض أو التحول أو التحور. على أن هذا التطور أو التحور إنما يتم في الشكل الخارجي فقط، بينما جوهر الإبداع ثابتٌ لا يتغير، مثلما أن الإنسان يلبس لكل فصل من فصول السنة لباسَه، بينما الإنسان هو الإنسان في كل فصول السنة.
إننا إذا كنا نعيش عصر التسليع (تحويل كل شيء إلى سلعة)، فعلينا أن نسلّم بأن الأنواع الأدبية ليست إلا سلعًا متنوعة أيضًا، يسعى كل منتج لإحداها (المبدع) إلى اجتذاب المستهلِك (القارئ أو المتلقي) إلى سلعتِه. ووجبَ عليه أن يبحث عن الطريق الذي يوصّله لشراء أو استخدام أو استهلاك هذه السلعة دون سواها، وعليه يتوقف نجاح عملية التسويق في فهم العناصر الجاذبة لسلعتِه دون سواها.
وبنفس المنطق، يمكن تصور كل نوع أدبي كشِركةٍ منافسة لغيرها من الشركات، وما دُمنا نعيش عصر الشركات الكبيرة وعابرة القارات التي تبتلع الكبيرةُ فيها الصغيرةَ، أو تقضي عليها. فنستطيع تصور الرواية الآن شركةً كبيرة ابتلعت كل الأنواع الأدبية الأخرى – بلا استثناء – وترَكَتها تعاني الاختناقَ ومحاولة البحث عن قُبلةِ الحياة.
إن التاريخ يشهد بانقراض أنواعٍ أدبية – مثل الملحمة، وتوقف السيَر الشعبية عند ما عُرِف منها وأصبح تاريخا يُنقب عنه مثل الآثار – أو التحور مثل أشكال الأنواع الأدبية عامة، فتحورت الرواية من الخط الزمني المتصاعد، إلى الخط الأفقي المستقيم، والشعر من العمودي إلى أن وصل لقصيدة النثر، والقصة القصيرة لِمَا يسمّى بالقصة القصيدة والقصة القصيرة جدًا، وهي بيت القصيد في حديثنا.
فإذا ما سلّمنا بأن النوع الأدبي هو إحدى الشركات المتنافسة، فإنني عندما أرغب في الالتحاق بهذه الشركة، فإنني أقدّم أوراق اعتمادي على هدى، وبموافقة القواعد العامة التي تحكم هذه الشركة، وإذا ما أردتُ التغيير أو التطوير، فإن ذلك لا يتم إلا بعد قبول أوراقي وانضمامي لكتيبة العاملين بها. لذا فإنه على الرغم من عدم الاتفاق على تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لأي من الأنواع الأدبية، خاصةً القصة القصيرة، وانفتاح الحدود الفاصلة بين النوع والآخر، إلا أنه لا بدّ من الاتفاق على (دستور) يحدد الإطارَ العام لهذا النوع، لا بدّ من التسليم به في البداية، وبعدَها يمكن العمل علي التطوير والتجديد، أو وضْع (القانون) المنظّم لحركة النوع.
فإذا ما عرَضنا القصةَ القصيرة على هذه المفاهيم، لتبين لنا العِلة التي تعاني منها، وسَعَينا نحو البحث عن سبل الخروج منها، بل، وتبين لنا أنها ليست وحدَها التي تعاني العِلة، أو عدم القدرة علي المواءمة والعيش وسط غابات الإبداع، وأمامَ أسدِ الغابة الذي ابتلع مجموعةَ الخراف/ الأنواع وهو الرواية، حيث نجد الشعر أيضًا يعيش نفس الظروف البيئية والطبيعية التي تؤكد وجودَ الضائقة أو الأزمة.
ووصولاً لأسباب وظروف هذه الأزمة، دعنا نبدأ من البداية.
وبحثًا عن أنبوبة أكسجين متمثلةٍ في بقايا وسائل النشر وضيق مساحاتها. يلجأ الإبداع القصصي إلي وسيلة يستطيع بها التغلب علي ذلك الاختناق، ومنح تلك الوسائل الفرصة للنشر في حدود المتبقي من مساحة الإعلان، فيلجأ المبدعون إلى القصة القصيرة جدًا، والتي لا تتجاوز الصفحة الواحدة، ثم تقلصت فأصبحت بضع سطور، إلى أن وصلت إلى بعض الجُمَل، ثم أصبحت مثل رسائل الموبايل. فغاب عنها حوار الذات المبدعة، وغاب عنها الحكي، وغاب عنها التشويق، وغابت عنها المتعة واللذة، وغابت عنها القصة، أو غابت القصة عنها. فوصل الاختصار والاختزال إلى الحد الذي أصبح اسمها يشار إليه أيضًا بالاختزال، فباتت تُعرَف بـ (ق ق ج)
هل ضاعت الحدود بين الأنواع الأدبية في ظل طغيان ظاهرة العولمة؟ وهل نعيش بالفعل عصرَ تداخل الفنون والأشكال الإبداعية العابرة للأنواع والأجناس التي درَجنا عليها؟! فبدلاً من الرواية والقصة والشعر والمسرح، أصبحنا نجد المسراوية، والقصة القصيرة، والمتتالية القصصية، وتنويعات روائية، فهل أصبحت هذه الأنواع الجديدة تتماشى مع ظروف وإيقاع العصر الذي نعيشه؟ حيث تصب مجريات كافة الأنواع في نهرٍ واحد كما تبشّرنا العولمة!؟ وهل انقضى عصر التخصص الدقيق، وأصبح لِزامًا على المبدع تخطي الأطُر القديمة وتحطيمها؟!
تحولات هائلة
يؤكد الناقد والمترجم سامي خشبة في البداية، أن التحولاتِ الهائلةَ في الواقع الإنساني والاجتماعي والنفسي والمعرفي والفكري أملت ان تتغير وسائل التعبير الفني ذاتها، وأن تتغير طبائع وملامح وأساليب ووسائل ولغات التعبير وأبنية الإبداع إلى الدرجة التي أصبح مِن الممكن أن تبدو الرواية بحثًا معرفيًا، أو إشراقات غنائية، أو خيالات أسطورية متراكمة، وأن تتخذ البنية الخارجية لنص شعري طبيعةً سردية، أو طبيعةً درامية متعددة الأصوات والمداخل والأمزجة. ولا شك أن هذا التغيير متعدد الوجوه قد أزال الكثير من الفوارق بين الأنواع التي أصبحت معها كلمة النص تستخدَم لتوصيف أي عمل أدبي، وإلى الدرجة التي أصبحت فيها فكرة تقسيم الإبداع فكرةً بدائية إلى حدٍ ما. إذَن فالتعبير مِن حولنا يدفعنا إلى تأكيد تغيّر حدود العلاقة بين الأنواع الأدبية, ومن ناحيةٍ أخرى يضيف الناقد د. مصطفى عبد الغني، أن التغييراتِ الحادةَ التي شهدها عالمنا المعاصر، في العقد الأخير منه على وجه خاص، تدعنا ندرك أن الخلاف بين وجود الحدود الأدبية أو عدم وجودها، هو مِن قبيل لزوم ما لا يلزم، وهو بأية حال يعبر عن مناخنا الأدبي، فضلا عن وعينا الاجتماعي والمعرفي، فقد مضى عصر أفلاطون الذي قسّم جمهوريتَه بين ثلاثة أنواع من المحاكاة، وأرسطو الذي سعَى لتحديد أنواع أدبية بعينها، ومِن المعروف أن هذا التقسيم أعيدت صياغته مع الوقت بامتداد دوائر الأنواع الأدبية وتطورها، ولو عُدنا لكثير من النصوص التي ظهرت، على الأقل منذ عصر النهضة في الغرب، سنلاحظ أن أيًا من الأنواع الأدبية ليس جنسًا مغلَقًا، ولكنها في الوقت نفسه تخضع لمؤثرات الواقع حولها التي تدفع لتداخل الأجناس. وعلى هذا النحو، فإن الإبداع والتلقي محكومانِ بواقعٍ لغوي محدد، وعلاقاتٍ اجتماعية وثقافية مغايرة، ونحن نميل إلى الربط بين التطور الفني والتطور الاجتماعي الفكري، خصوصًا في العصر الحديث، بحيث تتنوع الفنون وتتداخل، وتنشأ عادات ومدارك جديدة في التلقي.
التداخل حقيقةً وليس خيالا
أمّا الأديب إدوار الخرّاط، صاحب العديد من المصطلحات، مثل الحساسية الجديدة، والمتتالية القصصية، فيقول، لا بدّ من التأكيد أولا أنني لا أستحدِث هذه المصطلحات، أو أطلِقها من فراغ، ولكنها توجد لتفسير العديد من الظواهر الفنية القائمة بالفعل في العمل الإبداعي، وقد وجدت أنه يوجد نوع من التجاوز للأنواع الأدبية بمفهومها التقليدي الذي استقر في الأذهان فترةً طويلة، بمعنى أن القصة القصيرة على سبيل المثال، وفْقَ مفهومِها القديم، لم تعد تلبي المواصفاتِ المعروفةَ للقصة القصيرة حاليًا؛ فالأنواع الأدبية قد تداخلت بالفعل، ليس لمجرد استعارة بعض التقنيات الموجودة في بقية الأجناس الفنية، أو استعارة بعض تقنيات الشعر، أو الدراما، بل التداخل أصبح لازمًا بشكل يوجد به استيعاب لهذه التقنيات وانصهارها داخل العمل في بوتقة واحدة، وهذا التداخل يكون في الشكل والمضمون، فالكتابة عبْر النوعية تقوم الآن على إسقاط الحدود بين الأنواع الأدبية التقليدية التي ترسخت على مَر العقود، والآن لا يوجد عائق أمام الأديب في تخطي هذه الحدود، فعملية الانصهار التي أشرت إليها آنفًا تتم بحيث تصبح الكتابة شيئًا آخر، لا هو بالقصة القصيرة أو الرواية، بل يستوعبهما ويتجاوزهما في الوقت نفسه، بل يمكن استيعاب تقنيات ورؤى من الفنون غير القولية، مِن الفن التشكيلي، والنحت، والموسيقى، على سبيل الاستعارة أو الإقحام أو التزيين، وبشكل ما تصبح هذه المنجزات كلها وحدةً واحدة متنوعة النغمات، ولكنها متسعة في الوقت نفسِه.
الحدود لا تسقط
على عكس ذلك يرفض الأديب الكبير سليمان فياض مقولةَ ضياعِ الحدود الأدبية، ويرى أن هذه الحدود تعني ببساطة جوهرَ كل نوع وخصوصيته المميزة، فإذا تم إسقاطها فهذا يعني أن الشيء المكتوب ليس أدبًا، ولا ينتمي إلى أي نوع من الأنواع الأدبية، ورغم ذلك قد يكون هناك تأثير وتأثر بين هذه الأجناس المختلفة، وهذا التأثير لا يلغي الحدود، وإنما يندرج تحتَها.
يتفق مع هذا الرأي الأديب إبراهيم أصلان الذي يؤكد أننا لا نستطيع إطلاق مسمّى القصة القصيرة مثلاً على القصة المكتوبة بلغة شاعرية، أو نقول عنها إنها كتابة عابرة للأنواع الأدبية، وإنما هي نصٌّ إبداعي مكتوب بلغةٍ راقية، وتسمى قصة، وليست قصيدة؛ لأنه تتوفر فيها أدوات الفن القصصي، وهكذا تكون الرواية وكافة الأنواع الأدبية.
ومن ناحيته يرفض الناقد إبراهيم فتحي إسقاطَ الحدود الأدبية، مؤكدًا أنه رغم وجود التداخل بين الأنواع الأدبية إلا أنه في النهاية سيظل لكل منها عالمه القائم بذاته، ويضيف، إننا قد نجد ملامح الشعر تدخل في نطاق القصة أو الرواية، والعكس صحيح، وتوجد كثير من القصص يمكن أن نطلِق عليها قصائد غنائية، مثل بعض قصص يوسف إدريس، ويحيي الطاهر عبد الله، ورغم ذلك فالحدود بين الأجناس الأدبية قائمة ولن تسقط؛ لأن كل جنسٍ أدبي يتم بناؤه على حسب التصورات والأخيلة لأنواع التجارب الإنسانية، وقد يكون هناك تداخل بين الأنواع الأدبية، فالحوار، والنمط الملحمي، يمكن وجودهما في الرواية، ولكن في النهاية سيظل لكل نوعٍ العالَم الخاص به والقائم بذاته، فيجب أن يكون هناك توازن، وأن يتوافر في كل فن خصائصه.
بينما يرى الناقد “صلاح فضل”، أن الأنواع الأدبية قد استقرت في ضمير الأجيال، ولا يمكن إلغاء المساحة فيما بينها دون أن يخرج المبدع عن القوانين التي يعرفها المتلقي، وهذا ليس معناه أن المبدعين يتعين عليهم أن يختاروا هذه القواعد المحددة سلفًا؛ فهُم يلعبون دائمًا بتوترٍ محسوب يتردد بين قطبيْن، قطب إشباع توقّع القراء من ناحية باستيفاء الشروط، وقطب إدهاشهم بابتكار تنويعة جديدة على قواعد اللعب يفهمها الجمهور ويستجيب لها، ومِن هذا الهامش يتطور الفن، وتنمو الأجناس الأدبية محافِظةً بشكلٍ ما على هذا الهامش من الحرية، وعلى خواصها المحددة، غير أن هناك محاولاتٍ أخرى يغلب عليها طابع التجريب، وهذه تعَد إضافةً وليس إلغاءً للأنواع السابقة، لذلك فالدعوة إلى إلغاء الفوارق دعوةٌ لا يَعترف بها التاريخ، ولا تستسيغها الذائقةُ الأدبية.
أما الناقد والشاعر الدكتور يوسف نوفل، فيري أنه في مجال تطور الأجناس الأدبية، عبْر مسيرتها الفنية من جيلٍ إلى جيل ومن عصرٍ إلى عصر، حدثَ نوع من التمازج أو التقارب بين بعض الأصول الفنية لتلك الأجناس الأدبية، وهذا التمازج قد وصل إلى الحد الذي تمت فيه استعاراتٌ فنية بين الأجناس الأدبية، بحيث أصبحنا نرى أديبًا يستعير بعض الملامح الفنية من جنسٍ آخر، وهذه الاستعارات دقيقة للغاية، ويؤدي الإسراف في استعمالها إلى نوع من الفوضى الفنية، حتى أصبحنا نصادف في كثير من القصص ما يستعصى على الفهم، ورأينا أن هذا الفن يجنح إلى الذهنية ومتاهات التعقيد والغموض، ومِن حق قارئ اليوم أن يتساءل، هل أدت موجة التراسل بين الفنون إلى تلاشي الحدود الفاصلة بينها؟
وإجابتي بالنفي؛ إذ لا يتيسر لعصر أدبي ما أن يذيب الفواصلَ الفنية بين الأجناس الأدبية، ويطمس معالمها، ومن الصواب أن نقول إنه يوجد استعارات شتّى تتم بين الأجناس الأدبية، وليس إلغاءً أو ضياعًا للحدود الأدبية، وهكذا تظل القضية بين إثبات الحدود وإلغائها غير أن الأشكال الجديدة ستظل رهنَ المستقبل في إثبات سيادتها أو انتفائها.
يشبّه بعضُ دارسي السرد الأدبي الروايةَ بالنهر الذي يسيل من منبعٍ إلى مصب، في حين أن القصة القصيرة تمثّل موجةً وسط النهر.. وهي ليست في الوقت نفسه جزءًا ولا فصلاً من الرواية، ففي القصة القصيرة يقارب الكاتب مشهدًا أو عدة مَشاهد متخيّلة، لها صلة وثيقة بالواقع، أو بما يحتمل وقوعه، ويقتصر على سرد حادثةٍ يتألف منها موضوع مستقل، لكن رغم قِصره يجب أن يكون كاملاً ناضجًا من وجهة التحليل والمعالجة. ولا يتهيأ هذا إلاّ ببراعةٍ يمتاز بها كاتبها، إذ إن المجال أمامه ضيّق محدود يتطلب التكثيف والتركيز الفني الدقيق.
ويرى دارسون آخرون، أن القصة القصيرة لا تحتمل غير حدثٍ واحد، وربما تكتفي بتصوير لحظة شعورية واحدة نتجت عن حدثٍ وقعَ بالفعل، أو كان متوقعًا حدوثه، ولا يدهش القارئ إذا انتهى من القصة، ولم يعثر فيها على حدث؛ إذ يمكن أن تكون مجرد صورةٍ أو تشخيصٍ لحالةٍ محددة، أو رحلة عابرة في أعماق شخصية.
القاص والشاعر الأميركي “إدغار آلان بو”، مِن أوائل الذين كَتبوا بعض المبادئ المتعلقة بالقصة القصيرة، مِن خلال تجربته في كتابة القصة البوليسية، فقد ذهب إلى أنها يجب أن تمتلك “وحدة التأثير أو الانطباع″، وأن تُقرأ في نصف ساعة، أي في جلسة واحدة، في تأكيده على أهمية التأثير الواحد، ووحدة الحبكة، والشخصية، والمزاج، واللغة. وبربطِه بين القصة والأغنية الشعرية وضع “بو” القولَ الفصل، الذي سيصبح حاسمًا للقصة القصيرة التي تدين بالكثير لكثافة الشعر الغنائي ووحدتِه.
يتفق شارلز ماي مع إيخنباوم -أحد أقطاب الشكلانية- على أن القصة القصيرة شكلٌ أساسي أوّلي، بل إنه يشير إلى أنها شكل له صلة وثيقة بالسرد البدائي الذي يجسد التصورَ الأسطوري ويلخصه، والذي يكون مِن سماته التكثيف لا التوسع، والتركيز لا التشتت. وبدلاً من تقديم التفاصيل بشكل خارجي تمامًا، وبطريقة ثابتة في الزمان والمكان، فإن القصة لا تستغل إلاّ تلك التفاصيل الضرورية والنافعة لها، ويبدو التقدم فيها وكأنه متجِهٌ إلى هدفٍ وحيد. وفي شكلها الفني يصبح التوتر بين المتطلبات الجمالية ومتطلبات مشابهة الحقيقة أكثر حسمًا منه في الرواية؛ ذلك أن قِصر القصة القصيرة يتطلب شكلاً جماليًا أكثر مما يتطلب شكلاً طبيعيًا أو أساسيًا. وهي تظل -أكثر من الرواية- أقربَ إلى أسلافها في بناء القصة الأسطورية، كما أنها أكثر ارتباطًا بصيغة الرومانس منها بالصيغة الواقعية، ومن ثَم فإن الشخصياتِ فيها أقرب إلى أن تكون – كما يشير الناقد الكندي نورثروب فراي – شخصياتٍ مؤسلبة، أكثر منها أناسًا حقيقيين، فهي تبدو كأنها تشتغل وفقًا لتقاليد مشابهة الحقيقة والمعقولية، لكن لأن قِصر الشكل يمنع من التقديم الواقعي للشخصية عن طريق التفاصيل الكنائية الشاملة، وبما أن تاريخ القصة القصيرة هو التاريخ الذي تلتقي فيه الشخصيةُ بحادثةٍ حاسمة أو أزمة أكثر مما تتطور عبر الزمن، فإن الشكل والتراث الخاصيْن بالقصة القصيرة يعملان بقوةٍ ضد التقاليد المحورية في الواقعية.
إن الشخصياتِ في القصة القصيرة، كما يذهب “ماي”، هي في الوقت نفسه أقنعةٌ اجتماعية في قصٍ واقعي، وتجليات رمزية في قصٍ رومانسي، وتتحول في عملية السرد إلى مجاز، أي إنها تصبح واقعةً في خطاب مِن صُنعِ مجازها وهاجسِها الخاص. وهذه هي العملية التي يحوّل بها التحفيز الواقعي والعرض الرومانتيكي قصةَ الرومانس القديمة إلى خطابٍ قصصي جديد.
أما النقاد، فإن أغلبهم يرى أن القصة القصيرة أصبحت نوعًا أدبيًا هامشيًا على أطراف الحياة الثقافية العربية، وأن وضْعها يدعو إلى التساؤل والقلق . ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك مؤكدًا أن القصة القصيرة ميتةٌ مجازيًا وثقافيًا، وقد سلّمت الرايةَ إلى فن الرواية، ويجد أن مِن الاستحالة على القصة القصيرة الارتقاء إلى رتبة النوع القابل لتحولاتٍ حقيقية في بنيتِه ووظيفته الدلالية، فهي ما زالت أسيرةَ أصلِها الحكائي وشكلِها المغلَق، في عصرٍ أصبح كل شيء فيه مفتوحًا، ومحاولة الانفتاح فيها ستجعل منها مشهدًا سرديًا في نصٍ روائي. ومسألة حدود الجنس أو النوع لا تخيف التجريبَ ولا تعيقه، ولا توقِف تطورَ النوع، ولا تحد من حرية الكاتب في الكتابة، إنها أشبَه ما تكون بملامح أجناس البشر وأنواع النبات. ليس هناك ما يمنع من مراعاتها والانطلاق منها، دون أن يحد ذلك من أي فرصٍ للتجديد، بل إن المحافَظةَ عليها حفاظٌ على خصائص النوع، مع الإقرار بأنها خصائصُ عامة كبرى، وليست قيودًا أو حدودًا مغلَقة تؤدي إلى التنميط والتكرار والتشابه.
المراجع :
– تجلي الجميل: مقالات هانز جورج غاديمير
– الحساسية الجديدة: إدوار الخرّاط
– المشهد القصصي: إدوار الخرّاط
– المعجم الوسط: تعريفات للموقف والبلاغة والفصاحة
– عِلم الجمال وفلسفة الفن: هيجل
– القاعدة والخرق: د. لؤي علي خليل
– ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ، ﺘﺯﻓﻴﺘﺎﻥ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒـﻭ ﻋـﻼﻡ، ﺩﺍﺭ
ﺸﺭﻗﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1994.
– ﺠﻴﻨﻴﺕ، ﺠﻴﺭﺍﺭ، ﻤﺩﺨل ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﻴﻭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، 1986.
– القصة القصيرة العربية .. ملاحظات على تاريخ الجنس الأدبي وتكونه: د محمد عبيد الله، مجلة الرأي الإلكترونية
– عِلم الأجناس الأدبية: إيف استالوني
– أثواب الأدب العربي: توفيق الحكيم
– القصة القصيرة وإشكالية النوع الأدبي، دراسة تطبيقية: محمد عبد الحليم غنيم
– قصة قصيرة..-.. ١٠:٠٤ ص ١٢ ديسمبر ٢٠١٧: دكتور محمد العنتبلي
– قائمة كتاّب القصة القصيرة العرب “، wikiwand، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019.
– مفهوم القصة وأنواعها”، stories-blog، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2019.
محمود السانوسي

حدود النوع في القصة القصيرة بلاغـــة الموقــــف
المصطبةDecember 17 at 10:10 PM· الورقة البحثية المقدمة من الأستاذ / محمود السانوسي في إطار المحور الأول لقد عرّفَ “بومجارتن” عِلم الجمال ذات مرةٍ بأنه، “فن التفكير بطريقة جميلة&…