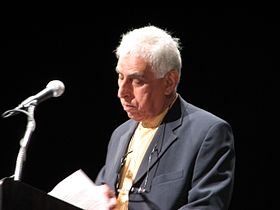انحسار الواقعية:
فى يونيو 1963 كتب الأستاذ والكاتب الرائد يوسف الشارونى كلمة موجزة فى مقدمة ديوانه الشعرى "المساء الأخير"، جاء فيها: "كنت هممت بجمع (مسائى الأخير) بين دفتىّ كتاب ترددت وتهيبت، فقد كنت أشهد كيف يطغى علينا تيار الواقعية_مؤلفين وقراء_ ويكتسح ما عداه، فانزوى_فيما انزوى_مسائى الأخير".
ولم يترك أو ينسى الشارونى استثمار هذه الفرصة كى ينسب هذا الانتصار للدكتور ثروت عكاشة، باعتباره أحد رجال السلطة وثقافتها السائدة وتوجهاتها المنشودة والمعممة كذلك، وكأنه يحتمى به أمام فلول الواقعية الذين يكمنون فى بعض أعمدة ومقالات الصحف والمجلات السيارة، خاصة بعد تغييب القادة الأوائل والطليعيين والطبيعيين لتيار الواقعية الاشتراكية المصريين فى أقبية المعتقلات منذ عام 1959، أقصد محمود أمين العالم ود.عبد العظيم أنيس، على وجه الخصوص، وكانا قد أصدرا كتابهما المشترك "فى الثقافة المصرية" عام 1955، والذى أثار جدلا لم ينته حتى الآن، وكتب الشارونى هذا الكلام فى ظل غياب نسبى لأصحاب هذا الاتجاه، واستكمل قائلا: "..ثم أقبل الدكتور ثروت عكاشة على ترجمة جبران، ليبعثه أمام جيل جديد من قراء العربية، وكان قد كاد يصبح مجرد علامة فى تاريخ أدبنا العربى، وما لبث أن ظهرت فى سوقنا العربية أخوات لمؤلفات جبران".
وكذلك واصل الشارونى بمقرعة نقدية _كانت جديدة بالنسبة له_ لإنزال بعض الضربات القوية على رأس تلك الواقعية التى أبعدت واستبعدت _كما يرى البعض_ كثيرا من المبدعين فى مجالات الشعر والقصة والرواية وربما المسرح كذلك، ويعطى اعتبارا كبيرا لذلك الحدث، وهو ترجمة د عكاشة ل"نبى" جبران خليل جبران، رغم أن هذا الكتاب كان مترجما ومتاحا ومقروءا ومتداولا بتوسع فى النصف الأول من القرن العشرين، فيضيف الشارونى: "..وهكذا أضئ الطريق من جديد إلى حيث الاحتفاء بنقاوة اللفظ، ورهافة المعنى وشفافية الأسلوب.. عندئذ وجدت أن "مسائى الأخير" قد آب من غربته، وعثر على صحبته، وآن لأشلائه المبعثرة _كأشلاء أوزيريس_ أن تجمع فى كتيب فيبعث من جديد".
كان لا بد أن نبرز ذلك الحديث أو البيان المهم للأستاذ يوسف الشارونى، باعتباره أحد رائدين مهمين لنهضة فن القصة القصيرة فى عقد الخمسينات، إذ أن مجموعته القصصية الأولى "العشاق الخمسة"، صدرت عن سلسلة الكتاب الذهبى فى ديسمبر 1954، وقد صدرت قبلها بشهور قليلة، أى فى أغسطس 1954 مجموعة "أرخص ليالى" ليوسف ادريس، وكان صدور المجموعتين القصصيتين بمثابة بلورة لتيارين أدبيين وفكريين وإبداعيين كبيرين كانا متجذرين قبل ذلك فى كتابات الجيلين السابقين، ولكنهما لم يكونا متبلورين بشكل واضح.
ولا أريد أن أسهب فى ماقدمته الأجيال الأولى فى القصة القصيرة، لكن على الأقل لا بد من الإشارة إليها فى بضعة سطور، وذلك لمحاولة التعرف سريعا على الجذور البكر التى أطلقت الأفكار الفنية التى نما عليها فن القصة القصيرة بتوسع، ونستطيع أن نضع بداية مجازية وموجزة، وليست حصرية، حيث أن باب الاجتهاد يظل مفتوحا دائما للعثور على نصوص أو إبداعات مهملة أو مجهولة، وفى هذا المجال اعتبر كثيرون أن قصة " فى القطار" للرائد محمد تيمور كانت البداية الفنية المكتملة لذلك الفن، والتى جاءت بعد أضغاث قصص على يد عبدالله النديم ومحمد المويلحى ونبوية موسى التى لا يذكرها أحد فى هذا المجال على وجه الإطلاق، وكان تيمور ورفاقه يحفرون أول مجرى إبداعى حقيقى للقصة القصيرة فى مصر والعالم العربى، وإن كان الباحث والمؤرخ الكبير محمد يوسف نجم، ينسب دور الريادة إلى ميخائيل نعيمة فى قصته "العاقر"، والتى كتبها عام 1914، وهذا سنعود له فى سياق آخر أكثر تخصصا وتوسعا، حيث أننى عثرت على قصة أخرى مكتملة من حيث البناء الفنى، وشديدة المجهولية لمحمد تيمور عام 1913، أى أنه كتبها بعد عودته مباشرة من باريس ليقضى إجازة قصيرة فى مصر، ثم يعود مرة أخرى إلى باريس، ولكن قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 منع تلك العودة التى كانت منشودة.
وفى جميع الأحوال فالجيل الذى رافق محمد تيمور منهم محمود طاهر لاشين، وعيسى واسحاق عبيد، وابراهيم المصرى، وأحمد خيرى سعيد، ومحمد أمين حسونة، وسعيد عبده، ومحمود تيمور، ومحمد حسين هيكل، ومن الممكن أن نضع فى هذا السياق توفيق الحكيم وغيرهم، استطاعوا بدأب وإصرار أن يؤسسوا الخارطة الأولى لفن القصة القصيرة، تلك المساحة التى أسماها محمود تيمور "الرياليزم"، أى القصة التى تنهل بشكل مباشر من الواقع، القصة التى تحمل من الحياة اليومية بعض تفاصيلها، ولا يعمل الخيال فيها بقوة الأحداث المباشرة، ولأن فن القصة القصيرة كان جديدا فى الثقافة المصرية، وكان الكتّاب متأثرين بشكل بالغ بالقصة الأوروبية، ومن ثم أراد محمد تيمور تخليص القصة المصرية من تلك التأثيرات الغربية القوية، وكانت قصة "فى القطار" دليلا واضحا على ذلك، فرغم أن بطل القصة وراكب القطار، كان يقرأ ديوان شعر "موسيه"، إلا أن الشخصيات التى كان يناقشها حوله فى القطار، كلها شخصيات مصرية، والقضايا محض مصرية، والأحداث محلية للغاية، وتبعا لذلك صار كل كتّاب المدرسة الحديثة يحرصون على تمصير القصة المصرية بشكل جاد، خاصة أن ترجمات كثيرة من اللغتين الفرنسية والانجليزية كانت تملأ الصحف والمجلات، وكان الأديب محمد السباعى ينشر قصة أسبوعية مترجمة فى صحيفة البلاغ، ومحمد عبد الله عنان ينشر قصة مترجمة فى السياسة الأسبوعية، وكانت الصحيفتان هما الأكثر رواجا فى ذلك الوقت، إذ كانت صحيفة البلاغ تصدر عن حزب الوفد، وصحيفة السياسة الأسبوعية تصدر عن حزب الأحرار الدستوريين، وهما الحزبان القطبان الكبيران، وعندما صدرت مجلة السفور عام 1915، بدأت فى نشر قصص مصرية خالصة، ثم جاءت مجلة "الفجر" عام 1925 لتعمل حالة تكثيف لنشر وتكريس القصة المصرية، وكان الكاتب الطبيب سعيد عبده يملأ الصحف بقصصه التى تعكس الواقع بشكل يمتزج بالخيال، كذلك ابراهيم عبد القادر المازنى.
هذه المدرسة التى اصطلح عليها اسم "المدرسة الحديثة"، والتى كانت ردّ فعل ثقافى قوى لما حدث فى الحرب العالمية الأولى "1914_1918"، أى رد على حالة التغريب العميقة فى الحياة المصرية عموما، وليست الحال الثقافية فحسب، ثم جاءت حقبة الأربعينات بعد ذلك، وأثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، لتبرز كتّابا آخرين جددا، يحملون "مزاج ما بعد التمصير"، وأستطيع أن أطلق علي تلك المرحلة "حالة تأصيل القصة القصيرة"، وكان أبرز هؤلاء محمود كامل المحامى، والذى أنشأ مجلة مستقلة ومتخصصة فى نشر القصص القصيرة، وهى مجلة "الجامعة"، وفيها برزت أسماء أخرى كثيرة، ولكن لم تكتب لهذه الأسماء الشهرة والذيوع، كذلك كان يحيي حقى ومحمود البدوى وصلاح ذهنى وسعد مكاوى ويوسف حلمى وفتحى رضوان من هؤلاء الكتاب الجدد علىالحياة الثقافية المصرية، وكان كل هؤلاء يكتبون القصة المصرية التى تحرص على الإمتاع، وربما الحكمة، وربما التحريض السياسى، ولكن فى سياق آخر، برزت أقلام قصصية تكتب قصصا لها توجهات سياسية واجتماعية بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه، وكان أبرز هؤلاء عبد الرحمن الخميسى وصلاح حافظ وابراهيم عبد الحليم وعبد الرحمن الشرقاوى وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب وأمين ريان وغيرهم، وكانت توجهات قصص هذين الجيلين غير محددة أو مؤطرة أو مؤدلجة، حتى جاءت مجموعتا اليوسفين "ادريس والشارونى"، لتحسم الأمر بشكل قاطع، ويتحدد بهما تياران كبيران يظلّان فاعلان ومتصارعان لفترة طويلة، وفى ذلك السياق يقول الناقد فاروق عبد القادر فى كتابه الصادر عام 1995 "نفق معتم ومصابيح قليلة": (..فى 1954 صدرت مجموعتان من القصص القصيرة، كانتا مثل دقات المسرح التقليدية قبل رفع الستار، ولعبتا دورا فى تطوير هذا الفن الذى أصابه شئ من الجمود والرتابة على أيدى قصاصى الثلاثينات والأربعينات، "أرخص ليالى" ليوسف ادريس، و"العشاق الخمسة" ليوسف الشارونى، ...يكفى القول هنا أن أولهما كان تشيكوفى الهوى، وثانيهما مخلصا فى قراءة كافكا).
لا أنوى مناقشة ما رآه فاروق عبد القادر فى جمود ورتابة ما أصاب القصة فى الثلاثينات والأربعينات، لكننى استندت إلى ما قرره من أهمية صدور مجموعتى ادريس والشارونى بشكل متعاقب عام 1954، وبالطبع فالتاريخ هنا مهم للغاية وله دلالته، إذ أن كل حدث كان محسوبا ومرصودا بدقة بعد قيام ثورة 1952، فمن الملاحظ أن الاهتمام بيوسف ادريس كان الأوسع والأشمل، إذ أنه نال ذلك الاهتمام من جموع وتكتلات اليسار، لأنه كان منتميا إلى تنظيمات اليسار، وكذلك نال الاهتمام من السلطة الثقافية وكبار المثقفين، بالإضافة إلى اهتمام القارئ العام، وفى الأول والأخير الموهبة الكبيرة التى كان يتمتع بها يوسف ادريس فى كتابة القصة القادرة عملت بقوة على جذب القارئ والباحث فى آن واحد، وهذا لا ينطبق بشكل دقيق على ما كتبه يوسف الشارونى، رغم أن موهبته كانت كبيرة، ولكنه كان ينشغل بتفاصيل أزمة ما بعد الحرب العالمية الثانية الوجودية، وهذا النوع من الكتابة آنذاك لم يكن مطلوبا خاصة فى أثناء واقع مابعد ثورة يوليو، ومن ثم شاع بأنه كان قارئا لكافكا ومتأثرا به، رغم أنه نفى كثيرا ذلك الزعم، وصرّح بأنه لم يقرأ كافكا إلا بعد صدور مجموعته الأولى.
بعد صدور مجموعتى "أرخص ليالى"،و "العشاق الخمسة"، وأحرزا اهتماما شديدا، ونهضة ملحوظة فى مجال القصيرة، تطور التكريس فن القصة القصيرة بشكل واضح، لدرجة أن كل المسرحيين المصريين بدأوا كتّابا للقصة القصيرة، منهم نعمان عاشور الذى أصدر "حوادبت عم فرج" 1955، وكتب مقدمة نقدية مستفيضة لكشف أهمية هذا الفن، كذلك سعد الدين وهبة الذى أصدر مجموعته وكتابه القصصى الأول "أرزاق" 1958، ورشاد رشدى الذى أصدر كتابه القصصى الأول "صنف الحريم" 1955، وألفريد فرج أيضا، كما أن كتّابا آخرين كانت أولى إصداراتهم مجموعات قصصية، مثل مصطفى محمود الذى أصدر مجموعة "أكل عيش" عام 1955، ومحمود السعدنى الذى صدرت له مجموعته الأولى "سماء سوداء" وبدر نشأت الذى أصدر "مساء الخير ياجدعان"، وقدم له أحمد بهاء الدين، وتوالى صدور مجموعات قصصية أخرى لكتاب جدد مثل عبدالله الطوخى وصالح مرسى وصبرى موسى وإدوار الخراط وغيرهم.
ولا شك فى أن التيار الذى كان يمثله يوسف ادريس، وهو ما اصطلح النقاد على أن ينسبونه إلى الواقعية، كان هو التيار الأقوى والسائد، وفى هذا الشأن يقول دكتور محمد مندور فى كتابه "قضايا جديدة فى أدبنا الحديث"، والصادر عام 1958 عن دار الآداب: "..والواقع أن القصة والأقصوصة موجودتان الآن على نطاق واسع، وليس يضيرهما أن ينكر أحد وجودهماـ بل لقد تطور هذا الفن تطورا واضحا وتنوعت اتجاهاته، وأخذ أحد هذه الاتجاهات يستهوى أدباءنا الشبان ويبشر بانتصاره إذا استطاع أن يصل إلى النضج الفنى والانسانى المرجو".
ولا شك أن هذا الاتجاه الذى يقصده مندور هو الاتجاه الواقعى، والذى ظلّ يكتب عنه، ويكرّس له، ويخوض المعارك من أجله مع طه حسين والعقاد وغيرهم، وظل هذا الاتجاه ينمو رويدا رويدا، للدرجة التى أغلق كافة الطرق أمام الاتجاه الآخر، والذى أطلق عليه النقاد "الاتجاه التعبيرى"، والذى كان يمثّله يوسف الشارونى بامتياز، وقد تناثرت على ضفافه كتابات لكتّاب شباب آخرين آنذاك، منهم وحيد النقاش، وادوار الخراط الذى أصدر مجموعة قصصية عام 1958، عنوانها "حيطان عالية"، ولم يأبه بها النقاد، ومن اهتم بها مثل الناقد فؤاد دوارة، لم ينصفها، وكان دوارة من المتابعين الكبار الذين لهم رأى وموقف مسموع، وكان له قراء كثيرون، بل قال عنها فى مقال له: "..يكتب ادوار الخراط القصة برأس مثقلة بنماذج الأدب الغربى ومدارسه، ويعبر عن نفسه فى شئ غير قليل من التعقيد والمعاناة.. فكأنما كلماته كانت تخرج من سرداب بعيد الأغوار.."، وهكذا سار دوارة يقرأ قصص الخراط بهذه الروح المتهكمة، إذ كان تيار الواقعية الجارف يعمل بقوة فى الحياة الأدبية والثقافية والفكرية.
كان يوسف ادريس قد أصدر سبع مجموعات قصصية من 1954 حتى عام 1962، وهى: "أرخص ليالى 1954، جمهورية فرحات 1956، أليس كذلك 1957، البطل 1957، حادثة شرف 1958، آخر الدنيا 1961، العسكرى الأسود وقصص أخرى 1962"، وكما يقول الناقد ابراهيم فتحى، أن يوسف ادريس ولد على القمة، ثم راح يغادرها رويدا رويدا، وانتبه للمسرح بعد نجاح عروضها فى مسارح الدولة، والاهتمام البالغ بها، كذلك بدأت وتيرة كتابة المقالات تطغى على إنتاجه القصصى، وباختصار حضور يوسف ادريس القصصى كان يقل كلما أوغل فى الانشغال بأنواع أخرى من الكتابة، وفى نهاية عقد الخمسينات اختفت القيادات التاريخية لتيار الواقعية فى المعتقلات، وهذا ما أعطى فرصة قوية لكى يصرخ بعض الأدباء الشباب، وكذلك كانت مقدمة يوسف الشارونى الواضحة والطامحة فى هزيمة تيار فرض نفسه لأكثر من عقد من الزمان، وكذلك انفتح الباب لكى يعبر الأدباء الجدد عن أنفسهم.
جيل القصة القصيرة الرابع:
نستطيع أن نقول بأن مجموعة "عيش وملح" عام 1960، والتى شارك فيها ستة من شباب الأدباء الذين يكتبون القصة القصيرة، وهم محمد جاد ومحمد حافظ رجب والسيد خميس شاهين والدسوقى فهمى وعز الدين نجيب وعباس محمد عباس، كانت الضربة الأولى فى إعلان صرخة جيل أدبى تم حرمانه بضراوة من فرص النشر والتعبير، لم يكن الاستبعاد سياسيا من سلطة الدولة، ولكن هيمنة جيل الخمسينات على منافذ النشر والتعبير والإشهار كانت قوية، كذلك كانت الحرب بين كتاب شباب، وكتاب راسخين، وكان هناك تقليد سائد فى ذلك الزمان وقبله، وهو أن الأدباء الجدد لا بد أن يوجد من يقدمهم، وللأسف لم يقبل أن يقدمهم أحد سوى يحيي حقى، وهو الذى كان النقاد يتعاملون معه باعتباره الأب الذى يمكن تجاوزه فى الريادة دون أن يغضب، فكان كتّاب كثيرون يعتبرون أن فن القصة القصيرة بدأ مع يوسف ادريس، وفى ظنّى واعتقادى، أن ذلك كان يؤلم يحيي حقى بقوة، ولكنه كان رجلا لا يعرف الشكوى، ولا إعلان المظلومية، ولذلك كان يجد انتصاره فى تقديم الآخرين، ومد يد المساعدة لهم، فكان سخيّا جدا فى تقديم الكتّاب الجدد، وذلك عبر مجموعات قصصية، منها مجموعة قصصية للشاعرة ملك عبد العزيز، ومجموعة قصصية لنوال السعداوى، وغيرهم، فضلا عن مجلة المجلة التى داوم فى تحريرها على تقديم كل أدباء الجيل الرابع، أو أدباء الستينات، وأعد لهم ملفات خاصة، وأعدادا كاملة من الغلاف للغلاف كما يقولون، وكان تقديمه لمجموعة "عيش وملح"، تقديما كريما، وذا مغزى عميق، ولم يبخل يحيي حقى فى أن يمنحهم الوجود الأدبى المرموق وسط مناخ وسياق ثقافى خانق بالنسبة لهم، وكذلك منحهم صفة الجدة والتجديد، بل أطلق عليهم بأنهم مدرسة جديدة فى القصة القصيرة المصرية، اسمها مدرسة عيش وملح.
لم تكن تلك المجموعة وحدها هى التى خاضت فى ذلك الزحام الأدبى، بل كانت الجوائز التى يقيمها نادى القصة تعمل على إبراز كتّاب جدد، منهم على سبيل المثال محمد حافظ رجب، الذى فاز عام 1959 بقصتين له دفعة واحدة، وهما "البطل والجنيه"، وهما من قصصه الواقعية الأولى قبل أن يتمرد على نفسه وعلى الواقعية السائدة، وكذلك أتى محمد البساطى من مساحة الجوائز، فكانت قصته "الهروب"، والتى فاز بها عام 1962، ولفتت له الأنظار آنذاك، وأجرت صحيفة المساء معه لقاء أبدى فيه رغبته فى ألا يعمل أدباء الجيل السابق على تضييق الخناق ومنافذ النشر على الجيل الجديد.
كذلك كانت المجلات الأدبية التى تصدرها وزارة الثقافة آنذاك، تعمل على نشر قصص للجيل الجديد، وكذلك تنشر لهم مقالات نقدية وترجمات، ونشر صنع الله ابراهيم وابراهيم أصلان وجميل عطية ابراهيم وجمال الغيطانى وغيرهم أولى نصوصهم على صفحات مجلات الرسالة _فى إصدارها الثانى_لأحمد حسن الزيات، ومجلة الثقافة لمحمد فريد أبو حديد، ومجلة المجلة ليحيي حقى، كما أن مجلة "القصة"، والتى كان يرأس تحريرها محمود تيمور، تنشر قصصا لكل الأدباء الشباب الجدد، وفى عدد لافت فى يونيو 1965، كرّست المجلة عددا كاملا تعت عنوان "الطلائع"، نشر فيه جمال الغيطانى ومحمد حافظ رجب ومحمد البساطى وضياء الشرقاوى وأحمد هاشم الشريف وغيرهم، وكلّفت نقادا كبارا لكى يكتبوا عن قصص هؤلاء الشباب، وهم د محمد مندور، د على الراعى، د عبدالقادر القط، د محمد غنيمى هلال، ومن خلال كل هذه الوسائط، بدأ الجيل القصصى الرابع يدّق عصاه فى قلب الحياة الأدبية، ويبدأ كذلك فى مغامراته الأدبية.
ولا ننسى فى هذا السياق صفحة عبد الفتاح الجمل، الراعى الرسمى لجيل الستينات، والناشر الأول لكثير من كتاب ذلك الجيل، فضلا عن إعداد ملفات وحوارات وتحقيقات لمناقشة الأدب الجديد، ومتابعة كافة إبداعاتهم بتكليف نقاد للكتابة عنهم.
يحيي الطاهر عبدالله وقدومه الحاد:
اختلف الباحثون والأصدقاء فى تحديد التوقيت الذى أتى فيه يحيي الطاهر عبدالله إلى القاهرة، قادما من بلده الكرنك فى جنوب مصر، إذ يكتب د سيد البحراوى فى بحثه يحيي الطاهر عبدالله ..كاتب القصة القصيرة"، والذى ألقاه فى مكناس_المغرب عام 1983، وصدر فى كتاب جماعى تحت عنوان "دراسات فى القصة العربية" عام 1986، وقدّم له محمد برادة، وبدأه قائلا: "حينما جاء يحيي الطاهر عبد الله من الكرنك إلى القاهرة سنة 1958، لم يكن يحمل بطاقة شخصية، ذلك أنه لم يكن يعرف أين توجد شهادة ميلاده"، ولكن الباحث يكتب هامشا حول ذلك قائلا: "راجع مجلة صباح الخير عدد ابريل 1981 ص3، وهناك شكوك حول تاريخ مجيئه إلى القاهرة، الأغلب أنه جاء إلى القاهرة، ولكنه لم يستقر فيها إلا فى سنة 1962"، بينما يذهب د حسين حمودة فى كتابه "شجو الطائر .. شدو السرب"، وهو قراءة فى أعمال يحيي الطاهر عبدالله، كان فى الأصل رسالة جامعية تقدم بها عام 1990، ونشرت فى الهيئة العامة لقصور الثقافة سبتمبر 1996، ويكتب حمودة تحت عنوان: "أهم التواريخ فى حياة يحيي الطاهر عبدالله": (ولد فى 30 ابريل 1938 بقرية الكرنك، مركز الأقصر، محافظة قنا، فى أسرة متواضعة الحال، كان أبوه شيخا يعمل بالتدريس فى إحدى المدارس الابتدائية، داخل القرية، وكان معظم أقاربه من المزارعين، وبعضهم عملوا بالنشاطات الخدمية المرتبطة بالسياحة فى هذه المنطقة الغنية بآثار المصريين القدماء، حصل على دبلوم "مدرسة الصنايع" المتوسط، وعمل بوزارة الزراعة فترة قصيرة، انتقل لمدينة قنا عام 1959، حيث التقى بالشاعرين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودى، وشارك الثلاثة فى بعض النشاطات الثقافية، فى الجامعة الشعبية، (الثقافة الجماهيرية فيما بعد)، انتقل إلى القاهرة عام 1964، وبدأ يتردد على المقاهى والمنتديات الثقافية، ويعرّف نفسه على أنه كاتب قصة قصيرة..".
إذن هناك تاريخان لوصوله إلى القاهرة، وإن كنت أرجّح ما ذهب إليه الناقد سيد البحراوى أن يحيي استقر فى القاهرة عام 1962، وكان قد سبقه الأبنودى وأمل دنقل، وكانت هناك شعبية للأبنودى وصحبة من المثقفين اليساريين، تعرّف من خلاله يحيي عليهم، وكان يحيي يحمل رصيدا من الثقافة الشعبية والشفاهية، ورغم أنه جاء إلى القاهرة فى ذلك الوقت المبكر، إلا أنه حمل قريته وناسها وعائلتها وأساطيرها وحكاياتها إلى قصصه، وكان مفتونا بقصص يوسف ادريس، ولكن الدرس الأول الذى ندركه فى قصته الأولى التى نشرتها له مجلة "روز اليوسف" عام 1962، وهى قصة "طاحونة الشيخ موسى"، ورغم أن القصة تنهل من واقع القرية كما فعل يوسف ادريس فى مجموعته الأولى، ومن الممكن أن نعتبر هذه القصة امتدادا لما جاء به يوسف ادريس، إلا أننى أضيف بأنه امتداد أشبه بالانقلاب، وهذه كانت سمة كتابة يحيي الأولى، يحيي يهتم بالأنساب، والأقارب، والجيران، والمفردات الحادة المحسوسة، وكل هؤلاء ينسجهم فى حكاية بالمعنى القديم التقليدى، أوفى قصة بالمعنى الحديث الذى يفعله الأدباء، ومن الطبيعى_فى اعتقاد يحيي_ أن القصة تنطوى على أساطير أو خرافات البلدة، ومن ثم لا تفقد القصة جرعات الإدهاش التى تثيرها فى قارئها، ومن الطبيعى أن كتابة يحيي تتمتع بالحسّ الدرامى الحاد لأنها تحمل من التناقضات الواقعية ما ينتج عنها دراما حادة بالفعل، وكأنه يقف على خشبة مسرح، ويلقى قصته، وكأنه يلقى قصيدة، كما كان يفعل دائما، فمن فرط استغراقه وتماهيه مع قصته، كان يحفظها ويلقيها وكأنه ينشدها، فهناك دائما موسقة لغوية وأسلوبية وإيقاعية نجدها فى مفردات وفقرات وتكرارات وتأكيدات قصص يحيي، يبدأ قصته هذه ب: "كأى رجل تزوج..تزوج الخواجة (يسى)..وكأى امرأة ولود.. أنجبت زوجته ابنهما (نظير)، وإذا كان الله وحده هو الذى يعطى ويأخذ_ فقد أعطى الله كثيرا وأخذ الكثير أيضا ماعدا نظير، فقد أبقاه الله، ليأخذ من الدنيا نصيبه.. ومن والده اسمه ولقبه ومتجره الوحيد".
هذه البداية التى لم تتجاوز خمسة سطور، يؤسس فيها الكاتب لعالمه الذى يشيده بدقة البنّاء المبدع، يشيّده فيما بعد من حكايات واعتقادات القرية، إذ يكبر نظير، ويموت والده، ويرث نظير دكانه الذى كان المتصرف الأساسى فى تموين القرية من شاى وزيت وسكر وغلال وما يستجد من سلع أخرى، ويعمل يحيي على تمييز نظير الذى لم يرث الدكان فقط، ولكنه ورث الأفعال أيضا وعمل على تطويرها: إذ ".. تناول الدكان بحرص والده..لم يطل سقفا، ولم يعلّق لافتة، ولم يعط الأقة أقة، ولا الرطل رطلا"، كل هذه المفردات الخشنة، تأتى فى إيقاعات ناعمة مموسقة، لكى تصبح مغناة ومنشودة، ولأن يحيي ابن الملاحم والحواديت والحكايات الشعبية والأهازيج، تسللت إليه كل تلك الطرائق من الشفاهى إلى الكتابى، وبالطبع كانت القصة تحمل حكايات أهله الفقراء، أهله الذين انبثق من جدرانهم دون أن يهجرهم حتى بعد أن جاء إلى المدينة الكبيرة، وكان يحيي يكتب عنهم دون أن ينزلق الأمر إلى حالة الهتاف، وكأنه يكتب نشيدا فنيا، ولكنه نشيد هامس.
فكّر نظير فى تطوير تجارته، عملا بمبدأ أبيه القائل: "..فكر تكسب، وفتّح عينك تغرق فى بحور الدهب"، فاتفق مع أحدهم على أن يشترى طاحونة نصف عمر، لكى يطحن أهل القرية فيها الغلال، وعندما اكتمل البناء الذى سيحتويها، هاج أهل القرية وماجو وهددوا "نظير" بما لا تحسن عاقبته، وهنا تتجلّى الأسطورة أو الخرافة التى يجعلها القاص محور الحكاية الرئيسى، لأن أهل القرية كانوا يعتقدون أن الطاحونة لكى تعمل، لا بد من إطعامها بأحد أطفالها، فهى لن تعمل إلا بهذا الشرط الأسطورى، واجتمع الناس وتزاحموا وصرخوا وهتفوا، وأخرج كل واحد منهم غضبه بطريقته الخاصة، ليمنعوا وضع الطاحونة، واستدعوا العمدة الذى خاض حوارا عنيفا وسلطويا وآمرا مع نظير، ولكن نظير كان عنيدا وخبيثا وقادرا على المراوغة والأخذ والرد، ولا فرق عنده بين الخبث والتودد، إذ علمته التجارة أن يكون طويل النفس، حتى يصل إلى غرضه، وبعد حوار طويل وجدل وشد وجذب، اتفق نظير والعمدة وأهل القرية، على أن يذهبوا للشيخ موسى، وهو "البركة" الذى تنفتح أمامه كل الأبواب المغلقة، وبخبث التاجر يقرر أن يجلب للشيخ موسى هدية معه، وعندما يصل حشد الناس يتقدمهم نظير والعمدة، ويبادر نظير على الفور وقبل أى حوار، بإعطاء الهدية للشيخ موسى، ويدور حوار بينهما، يبدأه الشيخ موسى:
(_النبى قبل الهدية..لكن المكنة لازمها عيل صغير..
ويرتجف الخواجة نظير..
بركاتك ياشيخ موسى..مددك واسع.. قد الدنيا..مقامك كبير وتحصل..بس انت ادخل الطاحونة وكله ينفك لجل خاطرك)
وبعد بضعة تمتمات ولعثمات وصرخات خافتة من المدد، يدخل الشيخ موسى، وهو ينادى:
(ياواسع الكرم..ويا..
وتصرّ التروس فى طحن مكتوم من قلة الزيت..وتشتد الفرقعة وتعلو الصرخات "توت..توت.." وتلعلع زغروتة.. وتهمهم شفاه بالخلاص..
_مدد ياشيخ موسى.. ياقطب..ياواسع المدد.. مدد..
ويتشعلق الخواجة نظير على أكتاف الزفة ليعلّق لافتة كبيرة بأعلى الحائط:
<..طاحونة الشيخ موسى، لصاحبها الخواجة نظير..وابنه مفيد..>)
هكذا ينهى يحيى الطاهر قصته الأولى_علامته البكر "طاحونة الشيخ موسى"، بعد أن بذر فيها حبوب ومفردات قريته الشائكة والخاصة والمختلفة عن قرية يوسف ادريس، وآثر يحيي ألا يسرد الحكاية دون أن يدس فيها خصوصية بلدته وناسها ورموزها، ورغم وضوح العالم الأسطورى الذى يحيط بالسرد وبالأحداث وبالناس وبالمكان والعلاقات المتنوعة بين المسلم والمسيحى وبين التاجر والمستهلك وبين العمدة الذى يمثّل سلطة ما وأهل القرية، إلا أننا لا نفقد ذلك الهامش الواقعى الذى يتسلل بين كل فقرة وأخرى، تكاد المفردات التى يحرص الكاتب على اختيارها تنطق بفرادة المكان والأحداث، تلك الفرادة التى كانت أول إيقاع حاد ولافت فى كتابة الجيل الرابع، أو جيل الستينات، وربما كان الوقت مبكرا، وغير موات لكى تصبح القصة علامة انقلابية، وينتبه لها كتّاب الجيل السابق.
يوسف ادريس يقدمه:
بعد قصة "طاحونة الشيخ موسى"، وتطور يحيي الطاهر، وإصراره على مزاولة الكتابة بطريقته الخاصة، فى ظل اشتباكه مع الحياة الثقافية المتمردة، يكتب يحيي قصصا مثيرة للغاية، ليكشف رويدا رويدا عن ذاته الإبداعية المشروعة والمقموعة فى الوقت نفسه، مشروعة لأن هذا حلمه الخاص والعام كذلك، ومقموعة لأن اتهامات كثيرة بدأت تنتشر حول هذا الجيل العدمى، والمتأثر بكتابة الغرب الغريبة كما قال الأستاذ دوارة عن ادوار الخراط، لكن يحيي لم يمتثل للكتابة السائدة، ولم يفلت خيط التمرد من روحه، ولذا لفت إليه الأنظار بقوة، وفى أغسطس 1965 قدّمه الدكتور يوسف ادريس فى مجلة الكاتب، والتى كان يشرف على نشر الإبداع فيها، وكانت القصة هى: "محبوب الشمس"، إحدى قصص يحيي اللافتة والمكتملة، والتى طرح فيها اقتراحات جمالية جديدة فى ذلك الوقت.
ورغم أن يوسف ادريس كان قد قدّم بهاء طاهر قبل ذلك بعام كامل، وأثنى على قصته "المظاهرة" بشكل مفرط، وقال إن قصص بهاء طاهر لا شك أنها قصص بهائية طاهرية من طراز فريد، وذلك لأن بهاء كان امتدادا ناعما طبيعيا ليوسف ادريس، وهذا بالطبع لا يعيب كتابة الأستاذ بهاء، لأنه استطاع أن ينفلت فيما بعد من التأثير الإدريسى الطاغى ليصنع إبداعه وأسطورته الخاصة، ولكن يحيي الطاهر كان شائكا منذ البداية، ويبدو أنه امتداد للجيل السابق أو الأسبق، لكنه امتداد يشبه الانقلاب كما أسلفنا القول، أو امتداد جدلى للكتابة السابقة عموما، وهناك من وضعه فى مواجهة كتابات طه حسين عن الجنوب المصرى.
بدأ ادريس تقديمه قائلا: "كنت أفضّل ألا أنشر ليحيي الطاهر عبدالله هذه القصة، بل كنت أفضّل فوق هذا ألا ينشر يحيي طاهر_هكذا_ أيا مما يكتبه الآن، فهذا الشاب الصعيدى النحيف الساخط على القاهرة والمدينة وكل شئ، يقوم، كما سترون كاللمحات الخاطفة، فى هذه القصة، بمغامرة فنية قد يجازى فى نهايتها بلون فريد من ألوان القصة يتميز به وقد لا يخرج بشئ بالمرة.."، ويستطرد ادريس فى الثناء على المغامرات الفنية بشكل عام، خاصة أن الحياة كلها _كما يقرر_مغامرة كبرى، وهو ينتصر للمغامرة دوما، ولكنه كان يفضّل _يكرر_ ألا ينشر له الآن_آنذاك_ حتى تنضج مغامرته وتتضح، "ولكن يحيي مثله مثل الجيل الجديد جدا من الكتاب، سريع التبرم بالأشياء وأولها قلة النشر.. سريع فى اتهاماته وأولها أن الناس لا تريد أن تفهمه ولا تقوى على طريقته فى الكتابة، مثله فى هذه النقطة مثل حافظ رجب والذى تعجبنى طريقة كتابته وإن كانت لا تعجب كثيرين"، ورغم هذا التقديم الملتبس، إلا أنه يثنى عليه بطريقة ما، طريقة تدلّ على ارتباك ادريس فى تقييم يحيي الطاهر، فيقول فى نهاية التقديم: "..أما قصة "محبوب الشمس" هذه، فقد كتبها يحيي طاهر فى عام 1963، وأعتقد أنه الآن قد جاوز مرحلتها بكثير، واعذرونى فى حماسى له، فإنى أعتقد أن هذا الشاب الصعيدى النحيف المشحون بكل ما فى الصعايدة من عناد وحدة، سيكون له فى أدبنا العربى شأن وشأن قريب".
مقدمة كلها ألغاز، تتراوح بين الحماس، والرغبة فى تأجيل النشر، وهو ينشر هذه القصة لأن يحيي كان متبرما وعصبيا وكثير الاتهام، كما يرى أن هذه القصة لا تعبّر عن يحيي فى ذلك الوقت، ولكنها نتاج فترة سابقة، ورغم كل هذه المؤاخذات، إلا أنه يبشّر بأن هذا الشاب الصعيدى النحيف سيكون له شأن فى الأدب العربى!
أما القصة فهى من فرائد يحيي الأولى، والتى أدرجها فى مجموعته الأولى التى صدرت عام 1970تحت عنوان "ثلاث شجيرات تثمر برتقالا"، وكلنا يعرف الأطفال ذوى الشعر الأصفر والرموش الصفراء، والذين لا يستطيعون النظر إلى الشمس، وطفلنا فى هذه القصة من هؤلاء الأطفال، لكن القرية تطلق عليه "محبوب الشمس"، ويضايقه المارة والجيران والأهل والأقارب، حتى شيخ الجامع، ويكثرون الضحك منه وعليه، ولا يريد يحيي أن يسرد وقائع سيرة لهذا الطفل، بقدر ما كان يطرح القرية بمفرداتها وسخرية أبنائها، وسماجة بعض من هؤلاء، سماجة تصل إلى حد السادية فى تعذيب الطفل والتنكيل به دون جريرة، والتنمر به _حسب الوصف المعاصر_، "ومحبوب الشمس فى الخامسة عشرة من عمره..قصير جدا.. ونحيل..أبيض شعر الرأس.. وكذلك كان لون حاجبيه.. ومن هنا كان الشيخ كامل أمام مسجد أبو عوضيتأمله فى صمت المؤمن.. ويدور فى تلك الحكمة الإلهية التى تنبت الدود فى بطن الحجر، والتى أثمرت هذا القزعة من والد فى طول السيمافور وأم فى حجم الدرفيل.. والحاج خليل والد محبوب طويل فى إفراط.. وصاحب شعر فى لون الليل الشتائى.. والحاجة نفيسة زوجته غنية باللحم والشحم .. وتملك ثروة من الشعر الأصفر كالسنابل القمح المستوية.."، لا أريد أن أسترسل فى قراءة القصة، ولكننى أكرر وأؤكد على غرام يحيي وشغفه ورغبته فى تأكيد الأنساب، ووصف الولد "القزعة"، والوالد الطويل الذى يشبه "السيمافور"، والوالدة الغنية باللحم والشحم، والتى تملك ثروة من الشعر، هنا تصبح الحكاية أو الحدوتة مجرد عنصر قليل الشأن فى بناء القصة، وتبرز السمات الحسّية، والتضاريس الجسدية، لتكون علامات واضحة وحيّة لا تنسى على وجه الإطلاق، وتظل عالقة بخيال القارئ، وممتعة له كلما قرأها وتذكرها، هذا فضلا عن نعومة السرد، واقترابه من الشفاهى الفصيح.
وكذلك يقدمه أيضا يوسف الشارونى:
لا أعتقد أن تقديم الرائدين يوسف ادريس ويوسف الشارونى، كان بمحض الصدفة، فإذا كانت مهمة الإشراف على مجال الإبداع فى مجلة الكاتب هى التى جاءت بمقدمة يوسف ادريس، إلا أننى أهجس بأن مقدمة الشارونى كانت اختيارا محضا، ربما يكون اختيار الشارونى نفسه بعدما ذاع صيت يحيي، أو أنه اختيار يحيي حقى رئيس تحرير المجلة، والذى كان متعاطفا مع يحيي الطاهر كثيرا وعلى كافة المستويات، فيحكى يحيي الطاهر_فى حوار مع يوسف أبورية_ حكاية يؤكدها يحيي حقى، "فى بداية حياتى بالقاهرة، عرفت يحيي حقى، وساعدنى كثيرا فى نشر قصصى الأولى بمجلة المجلة، وذات يوم _وكان مولد النبى_ بينما كنت أسير معه فى الشارع بعد خروجه من المجلة، اشترى لى ولنفسه حلاوة المولد.."، لذا لا أستبعد أن يكون يحيي حقى الذى كان يلعب دور الأب، هو الذى اختار الشارونى لكى يكون معقبا على قصة الطاهر "الثلاث ورقات"، والمنشورة فى مجلة المجلة فى أغسطس 1966، تلك القصة التى كان يحيي قد قطع شوطا فى تطوره من خلالها، وقدرته فى التلاعب مع لعبة الضمائر، والخفاء والتجلى بين الداخل السرى والمستتر، ذلك البعد النفسى للشخصيات، والحدث الخارجى الدائر فى الحياة المعلنة، كما أنه أتقن طريقة التقطيع بشكل يغمض على القارئ فى البداية، ولكن مع استعادة القراءة، تكون كل تفاصيل القصة متاحة للفهم والاستيعاب والاستمتاع أيضا بفنية السرد، وفنيّة اختيار المفردات والجمل والأحداث ذات الإيقاع السريع.
القصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الولد والشايب والبنت، ويختار يحيي هذه الأوراق الثلاث من لعبة "الكوتشينة"، وهى طريقة فنية جديدة، وهؤلاء الثلاثة يركبون قطار الصعيد القادم من الشلال تباعا، وتبدأ القصة بالولد الذى يستمع إلى المذياع، ويمزج بين مايسمعه من إعلانات تافهة وأخبار وأغنيات، وبين همومه الانسانية وما يفكر فيه، أو مايذهب إليه خياله، ولأن الولد هو الذى ركب القطار أولا، فهو الذى يسرد ويحكى تفاصيل ووقائع الرحلة، وأحداث الشايب والبنت، وهى لعبة فنية ممتعة، وقد أثنى عليها الشارونى، وهى جد جديدة وملهمة، إلا أن الشارونى يأخذ على يحيي استخدامه للعامية دون توظيف فنى_كما يرى_، مثل استخدامه مفردة "القزاز" بديلا عن "الزجاج"، وملاحظة الشارونى ملاحظة تقليدية تليق به وبتجربته الخمسينية، لكن يحيي الطاهر له مغامرته الخاصة، وله مراميه الفنية التى تختلف _بالتأكيد_ عن المرامى الفنية للجيل السابق، وهى تكاد تكون مغامرة مكتملة الوجوه، بداية من اختيار المفردات، ووضعها فى جمل، ثم بناء تلك الجمل، لتنتهى إلى قصة تقترح جماليات تناسب روح التجربة والمكان والزمان المحيطان بيحيي، وقد امتزج بهذه العناصر أشد الامتزاج، كما أن يحيي لا تتوقف قصته كما أسلفنا القول، بقدر ما كانت تستهويه اللعبة الفنية، حتى يقدم نصّا فنيا ذا إيقاعات وألوان ومفردات وتراكيب تخصه وحده، وتخص تجربته كذلك.
فاصل سياسى قصير:
لم يكن جموح يحيي الفنى، منفصلا عن جموحه السياسى إطلاقا، فارتباطه الفكرى والطبقى والاجتماعى بزميل صباه وشبابه وبلاده عبد الرحمن الأبنودى، لم يتوقف عند ذلك فقط، بل امتد إلى القاهرة، وصار أصدقاء الأبنودى، هم أصدقاء يحيي، ومقاهى الأبنودى، هى مقاهى يحيي، مع اختلافات قليلة فى مجال كل منهما، لكن كان الارتباط بين يحيي والأبنودى، ارتباطا لا يقبل أى خدوش أو كسور أبدا، وعندما قرر الأبنودى والسيدة عطيات عوض الزواج، حدث ما لم تتوقعه، وأترك الحديث لعطيات الذى سجلته فى كتابها "أيام لم تكن معه"، والصادر عام 1999، إذ تقول: "..قال لى الأبنودى قبل أن نتزوج: لا بد من موافقة صديق عمرى وأخى يحيي الطاهر عبدالله، فقدمنى إلى يحيي، وفى هذا اليوم تعرّفت على يحيي بالطريقة التى اختارها يحيي، قرأ لى يحيي قصتيه اللتين نشرتا فى مجلة الكاتب المصرية، وقدم لهما يوسف ادريس، قصة محبوب الشمس، وقصة 35 البلتاجى 52 عبد الخالق ثروت، وذكر لى أن القصة الأخيرة مكتوبة عن كمال الأبنودى الذى يعمل موظفا على الآلة الكاتبة فى إحدى الشركات فى شارع عبد الخالق ثروت"، وتستطرد عطيات: "..بعد يوم أو اثنين من هذه المقابلة التى تركنى فيها الأبنودى وحدى مع يحيي، جاءنى يحيي عند أمى فى السيدة زينب لكى يعلن موافقته على زواجى من الأبنودى_بطريقته أيضا_ قال: أريد أن أطلب يدك لى، إذا لم توافقى على زواجك من الأبنودى، قال يحيي مطبطبا على كتفى : من الآن أنت أختى المحرمة"
كان هذا الحوار فى سبتمبر 1965، وبعد موافقة يحيي على زواج الأبنودى من عطيات، تم الزواج فى أكتوبر عام 1965، وسكنا فى بيت والدتها، وكان يحيي وكرم الأبنودى يسكنان فى بولاق الدكرور، وبعد العثور على مكان مستقل للزوجية فى باب اللوق، 5 شارع أبوهيف، لم يترك الأبنودى يحيي لكى يعيش وحده، ولكنه اصطحبه إلى بيت الزوجية، ولكن مشاجرات يحيي الدائمة مع عطيات، أدت به لكى يهجر بيتهما، ويذهب إلى حال سبيل، فأرض الله واسعة.
ولكن هذا الفراق لم يمنع استمرار علاقة يحيي بالأبنودى، تلك العلاقة التى لا يغلبها غلاب، حتى الزواج، وكان يحيي يكتب قصصا للأطفال، وينشرها فى مجلة سمير، التى تصدر فى دار الهلال، وأود أن أسوق ملاحظة على ماقاله صديقى الدكتور حسين حمودة، عندما قال فى كتابه عن يحيي، بأن هذه ليست قصصا بالمعنى الفنى، ولكنها مجرد سيناريوهات لقصص مصورة، والحقيقة أن القصص كانت قصصا مكتملة، ولم تكن مكتوبة لقصص مصورة، ولكنها قصص مستقلة تماما.
ظلّت علاقة يحيي بالأبنودى مستمرة، وكانت هناك صحبة سياسية كبيرة، من هذه الصحبة كان صلاح عيسى وغالب هلسا وصبرى حافظ وسيد حجاب وسيد خميس وغيرهم، ولم يغب عن الأذهان أن كل هؤلاء ينتمون إلى اليسار فى إهاب واسع، ذلك اليسار الجديد الذى بدأ يرفع شعاراته، ويكتب إبداعاته، وفى هذه الإبداعات بعض تمردات واضحة، ومن الأكيد أن الأبنودى ويحيي كانا مبدعين على قدر كبير من التمرد، وكانت المقاهى تكتظ بجلسات هؤلاء الكتاب والمثقفين والمبدعين، حتى أن جاء 10 أكتوبر 1966، بعد مرور عام من الزواج، ويتم القبض على الأبنودى ورفاقه، ويختفى يحيي، ويظل هاربا من البوليس، حتى يفرج عن رفاقه فى مارس 1967، وبعدها يظهر يحيي، وهناك معلومة أوردها الناقد الدكتور سيد البحراوى، وهى أن يحيي تم القبض عليه، وهذا ما لست متأكدا منه، ورغم أن يحيي كان محاطا دائما بالهواجس التى تقضى على راحة باله _كما يقولون_، إلا أنه كان يجهر بالثورة دائما فى حياته.
تكريس نقدى جديد لفن القصة:
بعد تلك المحطات الأدبية الثلاث ليحيي الطاهر، وهى محطات بالفعل، حيث التقاطعات كانت حادة وجادة مع الآباء الكبار لفن القصة القصيرة، وهم على التوالى يحيي حقى ويوسف ادريس ويوسف الشارونى، لتأتى مرحلة أخرى جديدة عندما احتدمت مرحلة إبداعية فريدة فى مصر، وكان كتّاب القصة فى مصر يتبارون فيما بينهم فى تقديم التجارب الطليعية الجديدة، وصدرت مجلة "جاليرى68" الطليعية فى مايو 1968، لتكون شاهدا وسجّلا واضحا لتلك التجارب، واهتمت المجلة بشكل خاص بفن القصة القصيرة، ففضلا عن أنها كانت تنشر قصصا لأبناء الظاهرة فى كافة أعدادها، إلا أنها فى منتصف عام 1969، أصدرت عددا كاملا وخاصا تحت لافتة "القصة المصرية المعاصرة"، ونشرت فيها لكل نجوم الظاهرة: ابراهيم أصلان وبهاء طاهر وجمال الغيطانى وجميل عطية ابراهيم ومحمد حافظ رجب ويحيي الطاهر عبد الله وغيرهم، وفى هذا العدد نشر يحيي قصته "جبل الشاى الأخضر"، وهى كما كل قصصه تغوص فى الحسّى والملموس، وتنتقل القصة من الجد الذى يصب الشاى فى الأكواب، إلى حكاية الأخت التى وشى بها الطفل لأبيه، ومضمونها أن "..كانت نوال أختى راقدة ظهر جاموستنا.. وكانت نائمة بصدرها، وقد حضنت عنق الجاموسة بكلتا ذراعيها..وكانت تمرجح ساقيها وتحك فخذيها ببطن الجاموسة الأسود السمين، كنت أرى أصابع قدمها التى تواجهنى كخمسة مسامير دقت أسفل بطن الجاموسة.."، وكان تعبير أصابع القدم التى تشبه المسامير، تعبيرا يشى بقوة رغبة نوال الجنسية التى تفجرها فى محيط ظهر الجاموسة، وعندما أدرك الأب خطورة ذلك الفعل، وجن جنونه، وراح يضرب ابنته ضربا يكاد يصل بها إلى الموت"، وكتب الناقد شوقى خميس تعقيبا نقديا مطولا فى مجلة الهلال عدد أغسطس عام 1970 نقتبس من هذا التعقيب مايلى: "..عالم يخفى الرقة والتعاطف الحار فى أعماقه، فيبدو سخطه قاسيا قسوة المجمرة الملتهبة والوجوه والكلمات، عالم الرجال الذين تنغرس أقدامهم الحافية فى الرمل الساخن ويصعدون الجبل، ويضربون أطفالهم حتى تسيل الدماء من أجسادهم، ولا يستطيع رؤية وجههم الآخر إلا قصاص شاعر مثل يحيي الطاهر، فيجد كل ذلك حين يجمع فى نهاية القصة بين أنين الأخت التى عصفت بها القسوة والمشقة التى يتكلفها الآباء من أجل الحصول لأبنائهم هناك على أعشاب الشاى الخضراء، وحبات الليمون"، وبعض تفاصيل نقدية ينهى شوقى خميس تعقيبه قائلا: ".هذا الحب الفائض العميق المختفى وراء سطح الحياة الخشن القاسى، فهى ليست صورة القسوة وحدها، ولا صورة الحب وحده، وإنما صورتيهما معا ملتحمتين فى نسيج الحياة".
أثارت قصة يحيي والقصص الأخرى حماس النقاد الطليعيين لكى يعملوا على إبراز جماليات هذه الطفرة الجديدة فى مجال القصة القصيرة، حيث كتب ابراهيم فتحى تعقيبا على الملف قائلا: "لم يسبق للقصة القصيرة المصرية أن ازدهرت كما تزدهر هذه الأيام على أيدى كتّابها الجدد، وقد وصلت إلى درجة واضحةمن النضج تبرز فى جسارة الرؤية الفكرية وحيوية الشكل الفنى، وتلك الدرجة من النضج لا تطمح فى الاقتراب منها الأجناس الأدبية الأخرى من رواية ومسرح وشعر، وتبدو الأعمال النقدية التى تحاول ملاحقة تطور القصة القصيرة هزيلة عرجاء، فمسنوى الخلق الفنى فى هذا المجال، يعلو بما لا يقاس على المحاولات النقدية جميعا.."، ورغم أن ابراهيم فتحى أنهى تلك الفقرة قائلا: "..ونكتفى هنا بتسجيل تلك الظاهرة، دون أن نتعرض لتفسيرها"، إلا أنه قدّم عرضا وتفسيرا بديعا للظاهرة، وعقّب على كثير من الآراء التى ملأت الصحف والمجلات آنذاك.
ضمن هذه الأفكار التى سادت، كتب الناقد عبد الرحمن أبوعوف فى عدد الهلال الصادر فى أغسطس 1969تحت عنوان كبير "البحث عن طريق جديد للقصة المصرية القصيرة"، وجاء عنوان فرعى ضمن هذه الدراسة هو "واقعية جديدة"، أدرج فيه كتابات لمحمد البساطى وعبد الحكيم قاسم وكذلك كتابة يحيي قائلا: "..أما عند يحيي الطاهر عبدالله، فنحن نجد وربما لأول مرة بعد تجربة يحيي حقى عن الصعيد، ومدى تغلغل نظرته وعمق إحساسه الفنى خاصة فى مجموعة "دماء وطين"، ربما نجدةتكاملا فى بناء القصة يبلور قبض الحياة الحزينة المرتعشة من سطوة مجهول ... إن قصص "الوارث وجبل الشاى الأخضر والدف والصندوق والكابوس الأسود"، تقدم رصيدا يستحق الدراسة المستقلة.."، وفى النهاية يريد أبوعوف بأن كتابة يحيي واقعية، ولكن كتابة يحيي الطاهر واقعية جديدة، وفى تعقيب ابراهيم فتحى يدين هذا التوجه الذى يصف الكتابة الجديدة بالواقعية الجديدة، ويعتبر أن ذلك المصطلح، نوع من وضع المساحيق الكاذبة على وجوه قديمة، ويقرر بأن الكتابة الجديدة، كتابة جديرة بالقراءة بعيدا عن اختراع صناديق نقدية معتمدة من هنا أو هناك.
ولا تتوقف المعركة والسجال بين ابراهيم فتحى ونقاد آخرين، ولكن الحديث قد طال، واستدعى كثيرا من الوقائع التى أراها فى حياة يحيي الطاهر عبد الله وبقية أبناء الظاهرة الستينية، وبالطبع فيحيي الطاهر عبد الله يحتاج إلى تأمل دائم، فكتابته مغرية دائما بالقراءة والتجدد، ورغم أن دراسات كثيرة كتبها باحثون ونقاد كبار وجادون مثل سيد البحراوى وشكر عياد وحسين حمودة وصبرى حافظ ويوسف دريس ولطيفة الزيات وسعد الدين حسن وعلاء الديب ومحمد بدوى وشاكر عبد الحميد وغيرهم، إلا أننا سنعود لنستكمل المراحل الأخرى فى حياة يحيي الإبداعية التى مازالت تحتاج إلى تأمل، ومازالت بالفعل مثيرة للدهشة، ذلك الكاتب الذى أخلص لفنه ولإبداعه من ناحية، ولقريته الكرنك من ناحية ثانية، وللفقراء ملح الأرض من ناحية ثالثة.
شعبان يوسف
فى يونيو 1963 كتب الأستاذ والكاتب الرائد يوسف الشارونى كلمة موجزة فى مقدمة ديوانه الشعرى "المساء الأخير"، جاء فيها: "كنت هممت بجمع (مسائى الأخير) بين دفتىّ كتاب ترددت وتهيبت، فقد كنت أشهد كيف يطغى علينا تيار الواقعية_مؤلفين وقراء_ ويكتسح ما عداه، فانزوى_فيما انزوى_مسائى الأخير".
ولم يترك أو ينسى الشارونى استثمار هذه الفرصة كى ينسب هذا الانتصار للدكتور ثروت عكاشة، باعتباره أحد رجال السلطة وثقافتها السائدة وتوجهاتها المنشودة والمعممة كذلك، وكأنه يحتمى به أمام فلول الواقعية الذين يكمنون فى بعض أعمدة ومقالات الصحف والمجلات السيارة، خاصة بعد تغييب القادة الأوائل والطليعيين والطبيعيين لتيار الواقعية الاشتراكية المصريين فى أقبية المعتقلات منذ عام 1959، أقصد محمود أمين العالم ود.عبد العظيم أنيس، على وجه الخصوص، وكانا قد أصدرا كتابهما المشترك "فى الثقافة المصرية" عام 1955، والذى أثار جدلا لم ينته حتى الآن، وكتب الشارونى هذا الكلام فى ظل غياب نسبى لأصحاب هذا الاتجاه، واستكمل قائلا: "..ثم أقبل الدكتور ثروت عكاشة على ترجمة جبران، ليبعثه أمام جيل جديد من قراء العربية، وكان قد كاد يصبح مجرد علامة فى تاريخ أدبنا العربى، وما لبث أن ظهرت فى سوقنا العربية أخوات لمؤلفات جبران".
وكذلك واصل الشارونى بمقرعة نقدية _كانت جديدة بالنسبة له_ لإنزال بعض الضربات القوية على رأس تلك الواقعية التى أبعدت واستبعدت _كما يرى البعض_ كثيرا من المبدعين فى مجالات الشعر والقصة والرواية وربما المسرح كذلك، ويعطى اعتبارا كبيرا لذلك الحدث، وهو ترجمة د عكاشة ل"نبى" جبران خليل جبران، رغم أن هذا الكتاب كان مترجما ومتاحا ومقروءا ومتداولا بتوسع فى النصف الأول من القرن العشرين، فيضيف الشارونى: "..وهكذا أضئ الطريق من جديد إلى حيث الاحتفاء بنقاوة اللفظ، ورهافة المعنى وشفافية الأسلوب.. عندئذ وجدت أن "مسائى الأخير" قد آب من غربته، وعثر على صحبته، وآن لأشلائه المبعثرة _كأشلاء أوزيريس_ أن تجمع فى كتيب فيبعث من جديد".
كان لا بد أن نبرز ذلك الحديث أو البيان المهم للأستاذ يوسف الشارونى، باعتباره أحد رائدين مهمين لنهضة فن القصة القصيرة فى عقد الخمسينات، إذ أن مجموعته القصصية الأولى "العشاق الخمسة"، صدرت عن سلسلة الكتاب الذهبى فى ديسمبر 1954، وقد صدرت قبلها بشهور قليلة، أى فى أغسطس 1954 مجموعة "أرخص ليالى" ليوسف ادريس، وكان صدور المجموعتين القصصيتين بمثابة بلورة لتيارين أدبيين وفكريين وإبداعيين كبيرين كانا متجذرين قبل ذلك فى كتابات الجيلين السابقين، ولكنهما لم يكونا متبلورين بشكل واضح.
ولا أريد أن أسهب فى ماقدمته الأجيال الأولى فى القصة القصيرة، لكن على الأقل لا بد من الإشارة إليها فى بضعة سطور، وذلك لمحاولة التعرف سريعا على الجذور البكر التى أطلقت الأفكار الفنية التى نما عليها فن القصة القصيرة بتوسع، ونستطيع أن نضع بداية مجازية وموجزة، وليست حصرية، حيث أن باب الاجتهاد يظل مفتوحا دائما للعثور على نصوص أو إبداعات مهملة أو مجهولة، وفى هذا المجال اعتبر كثيرون أن قصة " فى القطار" للرائد محمد تيمور كانت البداية الفنية المكتملة لذلك الفن، والتى جاءت بعد أضغاث قصص على يد عبدالله النديم ومحمد المويلحى ونبوية موسى التى لا يذكرها أحد فى هذا المجال على وجه الإطلاق، وكان تيمور ورفاقه يحفرون أول مجرى إبداعى حقيقى للقصة القصيرة فى مصر والعالم العربى، وإن كان الباحث والمؤرخ الكبير محمد يوسف نجم، ينسب دور الريادة إلى ميخائيل نعيمة فى قصته "العاقر"، والتى كتبها عام 1914، وهذا سنعود له فى سياق آخر أكثر تخصصا وتوسعا، حيث أننى عثرت على قصة أخرى مكتملة من حيث البناء الفنى، وشديدة المجهولية لمحمد تيمور عام 1913، أى أنه كتبها بعد عودته مباشرة من باريس ليقضى إجازة قصيرة فى مصر، ثم يعود مرة أخرى إلى باريس، ولكن قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 منع تلك العودة التى كانت منشودة.
وفى جميع الأحوال فالجيل الذى رافق محمد تيمور منهم محمود طاهر لاشين، وعيسى واسحاق عبيد، وابراهيم المصرى، وأحمد خيرى سعيد، ومحمد أمين حسونة، وسعيد عبده، ومحمود تيمور، ومحمد حسين هيكل، ومن الممكن أن نضع فى هذا السياق توفيق الحكيم وغيرهم، استطاعوا بدأب وإصرار أن يؤسسوا الخارطة الأولى لفن القصة القصيرة، تلك المساحة التى أسماها محمود تيمور "الرياليزم"، أى القصة التى تنهل بشكل مباشر من الواقع، القصة التى تحمل من الحياة اليومية بعض تفاصيلها، ولا يعمل الخيال فيها بقوة الأحداث المباشرة، ولأن فن القصة القصيرة كان جديدا فى الثقافة المصرية، وكان الكتّاب متأثرين بشكل بالغ بالقصة الأوروبية، ومن ثم أراد محمد تيمور تخليص القصة المصرية من تلك التأثيرات الغربية القوية، وكانت قصة "فى القطار" دليلا واضحا على ذلك، فرغم أن بطل القصة وراكب القطار، كان يقرأ ديوان شعر "موسيه"، إلا أن الشخصيات التى كان يناقشها حوله فى القطار، كلها شخصيات مصرية، والقضايا محض مصرية، والأحداث محلية للغاية، وتبعا لذلك صار كل كتّاب المدرسة الحديثة يحرصون على تمصير القصة المصرية بشكل جاد، خاصة أن ترجمات كثيرة من اللغتين الفرنسية والانجليزية كانت تملأ الصحف والمجلات، وكان الأديب محمد السباعى ينشر قصة أسبوعية مترجمة فى صحيفة البلاغ، ومحمد عبد الله عنان ينشر قصة مترجمة فى السياسة الأسبوعية، وكانت الصحيفتان هما الأكثر رواجا فى ذلك الوقت، إذ كانت صحيفة البلاغ تصدر عن حزب الوفد، وصحيفة السياسة الأسبوعية تصدر عن حزب الأحرار الدستوريين، وهما الحزبان القطبان الكبيران، وعندما صدرت مجلة السفور عام 1915، بدأت فى نشر قصص مصرية خالصة، ثم جاءت مجلة "الفجر" عام 1925 لتعمل حالة تكثيف لنشر وتكريس القصة المصرية، وكان الكاتب الطبيب سعيد عبده يملأ الصحف بقصصه التى تعكس الواقع بشكل يمتزج بالخيال، كذلك ابراهيم عبد القادر المازنى.
هذه المدرسة التى اصطلح عليها اسم "المدرسة الحديثة"، والتى كانت ردّ فعل ثقافى قوى لما حدث فى الحرب العالمية الأولى "1914_1918"، أى رد على حالة التغريب العميقة فى الحياة المصرية عموما، وليست الحال الثقافية فحسب، ثم جاءت حقبة الأربعينات بعد ذلك، وأثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، لتبرز كتّابا آخرين جددا، يحملون "مزاج ما بعد التمصير"، وأستطيع أن أطلق علي تلك المرحلة "حالة تأصيل القصة القصيرة"، وكان أبرز هؤلاء محمود كامل المحامى، والذى أنشأ مجلة مستقلة ومتخصصة فى نشر القصص القصيرة، وهى مجلة "الجامعة"، وفيها برزت أسماء أخرى كثيرة، ولكن لم تكتب لهذه الأسماء الشهرة والذيوع، كذلك كان يحيي حقى ومحمود البدوى وصلاح ذهنى وسعد مكاوى ويوسف حلمى وفتحى رضوان من هؤلاء الكتاب الجدد علىالحياة الثقافية المصرية، وكان كل هؤلاء يكتبون القصة المصرية التى تحرص على الإمتاع، وربما الحكمة، وربما التحريض السياسى، ولكن فى سياق آخر، برزت أقلام قصصية تكتب قصصا لها توجهات سياسية واجتماعية بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه، وكان أبرز هؤلاء عبد الرحمن الخميسى وصلاح حافظ وابراهيم عبد الحليم وعبد الرحمن الشرقاوى وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب وأمين ريان وغيرهم، وكانت توجهات قصص هذين الجيلين غير محددة أو مؤطرة أو مؤدلجة، حتى جاءت مجموعتا اليوسفين "ادريس والشارونى"، لتحسم الأمر بشكل قاطع، ويتحدد بهما تياران كبيران يظلّان فاعلان ومتصارعان لفترة طويلة، وفى ذلك السياق يقول الناقد فاروق عبد القادر فى كتابه الصادر عام 1995 "نفق معتم ومصابيح قليلة": (..فى 1954 صدرت مجموعتان من القصص القصيرة، كانتا مثل دقات المسرح التقليدية قبل رفع الستار، ولعبتا دورا فى تطوير هذا الفن الذى أصابه شئ من الجمود والرتابة على أيدى قصاصى الثلاثينات والأربعينات، "أرخص ليالى" ليوسف ادريس، و"العشاق الخمسة" ليوسف الشارونى، ...يكفى القول هنا أن أولهما كان تشيكوفى الهوى، وثانيهما مخلصا فى قراءة كافكا).
لا أنوى مناقشة ما رآه فاروق عبد القادر فى جمود ورتابة ما أصاب القصة فى الثلاثينات والأربعينات، لكننى استندت إلى ما قرره من أهمية صدور مجموعتى ادريس والشارونى بشكل متعاقب عام 1954، وبالطبع فالتاريخ هنا مهم للغاية وله دلالته، إذ أن كل حدث كان محسوبا ومرصودا بدقة بعد قيام ثورة 1952، فمن الملاحظ أن الاهتمام بيوسف ادريس كان الأوسع والأشمل، إذ أنه نال ذلك الاهتمام من جموع وتكتلات اليسار، لأنه كان منتميا إلى تنظيمات اليسار، وكذلك نال الاهتمام من السلطة الثقافية وكبار المثقفين، بالإضافة إلى اهتمام القارئ العام، وفى الأول والأخير الموهبة الكبيرة التى كان يتمتع بها يوسف ادريس فى كتابة القصة القادرة عملت بقوة على جذب القارئ والباحث فى آن واحد، وهذا لا ينطبق بشكل دقيق على ما كتبه يوسف الشارونى، رغم أن موهبته كانت كبيرة، ولكنه كان ينشغل بتفاصيل أزمة ما بعد الحرب العالمية الثانية الوجودية، وهذا النوع من الكتابة آنذاك لم يكن مطلوبا خاصة فى أثناء واقع مابعد ثورة يوليو، ومن ثم شاع بأنه كان قارئا لكافكا ومتأثرا به، رغم أنه نفى كثيرا ذلك الزعم، وصرّح بأنه لم يقرأ كافكا إلا بعد صدور مجموعته الأولى.
بعد صدور مجموعتى "أرخص ليالى"،و "العشاق الخمسة"، وأحرزا اهتماما شديدا، ونهضة ملحوظة فى مجال القصيرة، تطور التكريس فن القصة القصيرة بشكل واضح، لدرجة أن كل المسرحيين المصريين بدأوا كتّابا للقصة القصيرة، منهم نعمان عاشور الذى أصدر "حوادبت عم فرج" 1955، وكتب مقدمة نقدية مستفيضة لكشف أهمية هذا الفن، كذلك سعد الدين وهبة الذى أصدر مجموعته وكتابه القصصى الأول "أرزاق" 1958، ورشاد رشدى الذى أصدر كتابه القصصى الأول "صنف الحريم" 1955، وألفريد فرج أيضا، كما أن كتّابا آخرين كانت أولى إصداراتهم مجموعات قصصية، مثل مصطفى محمود الذى أصدر مجموعة "أكل عيش" عام 1955، ومحمود السعدنى الذى صدرت له مجموعته الأولى "سماء سوداء" وبدر نشأت الذى أصدر "مساء الخير ياجدعان"، وقدم له أحمد بهاء الدين، وتوالى صدور مجموعات قصصية أخرى لكتاب جدد مثل عبدالله الطوخى وصالح مرسى وصبرى موسى وإدوار الخراط وغيرهم.
ولا شك فى أن التيار الذى كان يمثله يوسف ادريس، وهو ما اصطلح النقاد على أن ينسبونه إلى الواقعية، كان هو التيار الأقوى والسائد، وفى هذا الشأن يقول دكتور محمد مندور فى كتابه "قضايا جديدة فى أدبنا الحديث"، والصادر عام 1958 عن دار الآداب: "..والواقع أن القصة والأقصوصة موجودتان الآن على نطاق واسع، وليس يضيرهما أن ينكر أحد وجودهماـ بل لقد تطور هذا الفن تطورا واضحا وتنوعت اتجاهاته، وأخذ أحد هذه الاتجاهات يستهوى أدباءنا الشبان ويبشر بانتصاره إذا استطاع أن يصل إلى النضج الفنى والانسانى المرجو".
ولا شك أن هذا الاتجاه الذى يقصده مندور هو الاتجاه الواقعى، والذى ظلّ يكتب عنه، ويكرّس له، ويخوض المعارك من أجله مع طه حسين والعقاد وغيرهم، وظل هذا الاتجاه ينمو رويدا رويدا، للدرجة التى أغلق كافة الطرق أمام الاتجاه الآخر، والذى أطلق عليه النقاد "الاتجاه التعبيرى"، والذى كان يمثّله يوسف الشارونى بامتياز، وقد تناثرت على ضفافه كتابات لكتّاب شباب آخرين آنذاك، منهم وحيد النقاش، وادوار الخراط الذى أصدر مجموعة قصصية عام 1958، عنوانها "حيطان عالية"، ولم يأبه بها النقاد، ومن اهتم بها مثل الناقد فؤاد دوارة، لم ينصفها، وكان دوارة من المتابعين الكبار الذين لهم رأى وموقف مسموع، وكان له قراء كثيرون، بل قال عنها فى مقال له: "..يكتب ادوار الخراط القصة برأس مثقلة بنماذج الأدب الغربى ومدارسه، ويعبر عن نفسه فى شئ غير قليل من التعقيد والمعاناة.. فكأنما كلماته كانت تخرج من سرداب بعيد الأغوار.."، وهكذا سار دوارة يقرأ قصص الخراط بهذه الروح المتهكمة، إذ كان تيار الواقعية الجارف يعمل بقوة فى الحياة الأدبية والثقافية والفكرية.
كان يوسف ادريس قد أصدر سبع مجموعات قصصية من 1954 حتى عام 1962، وهى: "أرخص ليالى 1954، جمهورية فرحات 1956، أليس كذلك 1957، البطل 1957، حادثة شرف 1958، آخر الدنيا 1961، العسكرى الأسود وقصص أخرى 1962"، وكما يقول الناقد ابراهيم فتحى، أن يوسف ادريس ولد على القمة، ثم راح يغادرها رويدا رويدا، وانتبه للمسرح بعد نجاح عروضها فى مسارح الدولة، والاهتمام البالغ بها، كذلك بدأت وتيرة كتابة المقالات تطغى على إنتاجه القصصى، وباختصار حضور يوسف ادريس القصصى كان يقل كلما أوغل فى الانشغال بأنواع أخرى من الكتابة، وفى نهاية عقد الخمسينات اختفت القيادات التاريخية لتيار الواقعية فى المعتقلات، وهذا ما أعطى فرصة قوية لكى يصرخ بعض الأدباء الشباب، وكذلك كانت مقدمة يوسف الشارونى الواضحة والطامحة فى هزيمة تيار فرض نفسه لأكثر من عقد من الزمان، وكذلك انفتح الباب لكى يعبر الأدباء الجدد عن أنفسهم.
جيل القصة القصيرة الرابع:
نستطيع أن نقول بأن مجموعة "عيش وملح" عام 1960، والتى شارك فيها ستة من شباب الأدباء الذين يكتبون القصة القصيرة، وهم محمد جاد ومحمد حافظ رجب والسيد خميس شاهين والدسوقى فهمى وعز الدين نجيب وعباس محمد عباس، كانت الضربة الأولى فى إعلان صرخة جيل أدبى تم حرمانه بضراوة من فرص النشر والتعبير، لم يكن الاستبعاد سياسيا من سلطة الدولة، ولكن هيمنة جيل الخمسينات على منافذ النشر والتعبير والإشهار كانت قوية، كذلك كانت الحرب بين كتاب شباب، وكتاب راسخين، وكان هناك تقليد سائد فى ذلك الزمان وقبله، وهو أن الأدباء الجدد لا بد أن يوجد من يقدمهم، وللأسف لم يقبل أن يقدمهم أحد سوى يحيي حقى، وهو الذى كان النقاد يتعاملون معه باعتباره الأب الذى يمكن تجاوزه فى الريادة دون أن يغضب، فكان كتّاب كثيرون يعتبرون أن فن القصة القصيرة بدأ مع يوسف ادريس، وفى ظنّى واعتقادى، أن ذلك كان يؤلم يحيي حقى بقوة، ولكنه كان رجلا لا يعرف الشكوى، ولا إعلان المظلومية، ولذلك كان يجد انتصاره فى تقديم الآخرين، ومد يد المساعدة لهم، فكان سخيّا جدا فى تقديم الكتّاب الجدد، وذلك عبر مجموعات قصصية، منها مجموعة قصصية للشاعرة ملك عبد العزيز، ومجموعة قصصية لنوال السعداوى، وغيرهم، فضلا عن مجلة المجلة التى داوم فى تحريرها على تقديم كل أدباء الجيل الرابع، أو أدباء الستينات، وأعد لهم ملفات خاصة، وأعدادا كاملة من الغلاف للغلاف كما يقولون، وكان تقديمه لمجموعة "عيش وملح"، تقديما كريما، وذا مغزى عميق، ولم يبخل يحيي حقى فى أن يمنحهم الوجود الأدبى المرموق وسط مناخ وسياق ثقافى خانق بالنسبة لهم، وكذلك منحهم صفة الجدة والتجديد، بل أطلق عليهم بأنهم مدرسة جديدة فى القصة القصيرة المصرية، اسمها مدرسة عيش وملح.
لم تكن تلك المجموعة وحدها هى التى خاضت فى ذلك الزحام الأدبى، بل كانت الجوائز التى يقيمها نادى القصة تعمل على إبراز كتّاب جدد، منهم على سبيل المثال محمد حافظ رجب، الذى فاز عام 1959 بقصتين له دفعة واحدة، وهما "البطل والجنيه"، وهما من قصصه الواقعية الأولى قبل أن يتمرد على نفسه وعلى الواقعية السائدة، وكذلك أتى محمد البساطى من مساحة الجوائز، فكانت قصته "الهروب"، والتى فاز بها عام 1962، ولفتت له الأنظار آنذاك، وأجرت صحيفة المساء معه لقاء أبدى فيه رغبته فى ألا يعمل أدباء الجيل السابق على تضييق الخناق ومنافذ النشر على الجيل الجديد.
كذلك كانت المجلات الأدبية التى تصدرها وزارة الثقافة آنذاك، تعمل على نشر قصص للجيل الجديد، وكذلك تنشر لهم مقالات نقدية وترجمات، ونشر صنع الله ابراهيم وابراهيم أصلان وجميل عطية ابراهيم وجمال الغيطانى وغيرهم أولى نصوصهم على صفحات مجلات الرسالة _فى إصدارها الثانى_لأحمد حسن الزيات، ومجلة الثقافة لمحمد فريد أبو حديد، ومجلة المجلة ليحيي حقى، كما أن مجلة "القصة"، والتى كان يرأس تحريرها محمود تيمور، تنشر قصصا لكل الأدباء الشباب الجدد، وفى عدد لافت فى يونيو 1965، كرّست المجلة عددا كاملا تعت عنوان "الطلائع"، نشر فيه جمال الغيطانى ومحمد حافظ رجب ومحمد البساطى وضياء الشرقاوى وأحمد هاشم الشريف وغيرهم، وكلّفت نقادا كبارا لكى يكتبوا عن قصص هؤلاء الشباب، وهم د محمد مندور، د على الراعى، د عبدالقادر القط، د محمد غنيمى هلال، ومن خلال كل هذه الوسائط، بدأ الجيل القصصى الرابع يدّق عصاه فى قلب الحياة الأدبية، ويبدأ كذلك فى مغامراته الأدبية.
ولا ننسى فى هذا السياق صفحة عبد الفتاح الجمل، الراعى الرسمى لجيل الستينات، والناشر الأول لكثير من كتاب ذلك الجيل، فضلا عن إعداد ملفات وحوارات وتحقيقات لمناقشة الأدب الجديد، ومتابعة كافة إبداعاتهم بتكليف نقاد للكتابة عنهم.
يحيي الطاهر عبدالله وقدومه الحاد:
اختلف الباحثون والأصدقاء فى تحديد التوقيت الذى أتى فيه يحيي الطاهر عبدالله إلى القاهرة، قادما من بلده الكرنك فى جنوب مصر، إذ يكتب د سيد البحراوى فى بحثه يحيي الطاهر عبدالله ..كاتب القصة القصيرة"، والذى ألقاه فى مكناس_المغرب عام 1983، وصدر فى كتاب جماعى تحت عنوان "دراسات فى القصة العربية" عام 1986، وقدّم له محمد برادة، وبدأه قائلا: "حينما جاء يحيي الطاهر عبد الله من الكرنك إلى القاهرة سنة 1958، لم يكن يحمل بطاقة شخصية، ذلك أنه لم يكن يعرف أين توجد شهادة ميلاده"، ولكن الباحث يكتب هامشا حول ذلك قائلا: "راجع مجلة صباح الخير عدد ابريل 1981 ص3، وهناك شكوك حول تاريخ مجيئه إلى القاهرة، الأغلب أنه جاء إلى القاهرة، ولكنه لم يستقر فيها إلا فى سنة 1962"، بينما يذهب د حسين حمودة فى كتابه "شجو الطائر .. شدو السرب"، وهو قراءة فى أعمال يحيي الطاهر عبدالله، كان فى الأصل رسالة جامعية تقدم بها عام 1990، ونشرت فى الهيئة العامة لقصور الثقافة سبتمبر 1996، ويكتب حمودة تحت عنوان: "أهم التواريخ فى حياة يحيي الطاهر عبدالله": (ولد فى 30 ابريل 1938 بقرية الكرنك، مركز الأقصر، محافظة قنا، فى أسرة متواضعة الحال، كان أبوه شيخا يعمل بالتدريس فى إحدى المدارس الابتدائية، داخل القرية، وكان معظم أقاربه من المزارعين، وبعضهم عملوا بالنشاطات الخدمية المرتبطة بالسياحة فى هذه المنطقة الغنية بآثار المصريين القدماء، حصل على دبلوم "مدرسة الصنايع" المتوسط، وعمل بوزارة الزراعة فترة قصيرة، انتقل لمدينة قنا عام 1959، حيث التقى بالشاعرين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودى، وشارك الثلاثة فى بعض النشاطات الثقافية، فى الجامعة الشعبية، (الثقافة الجماهيرية فيما بعد)، انتقل إلى القاهرة عام 1964، وبدأ يتردد على المقاهى والمنتديات الثقافية، ويعرّف نفسه على أنه كاتب قصة قصيرة..".
إذن هناك تاريخان لوصوله إلى القاهرة، وإن كنت أرجّح ما ذهب إليه الناقد سيد البحراوى أن يحيي استقر فى القاهرة عام 1962، وكان قد سبقه الأبنودى وأمل دنقل، وكانت هناك شعبية للأبنودى وصحبة من المثقفين اليساريين، تعرّف من خلاله يحيي عليهم، وكان يحيي يحمل رصيدا من الثقافة الشعبية والشفاهية، ورغم أنه جاء إلى القاهرة فى ذلك الوقت المبكر، إلا أنه حمل قريته وناسها وعائلتها وأساطيرها وحكاياتها إلى قصصه، وكان مفتونا بقصص يوسف ادريس، ولكن الدرس الأول الذى ندركه فى قصته الأولى التى نشرتها له مجلة "روز اليوسف" عام 1962، وهى قصة "طاحونة الشيخ موسى"، ورغم أن القصة تنهل من واقع القرية كما فعل يوسف ادريس فى مجموعته الأولى، ومن الممكن أن نعتبر هذه القصة امتدادا لما جاء به يوسف ادريس، إلا أننى أضيف بأنه امتداد أشبه بالانقلاب، وهذه كانت سمة كتابة يحيي الأولى، يحيي يهتم بالأنساب، والأقارب، والجيران، والمفردات الحادة المحسوسة، وكل هؤلاء ينسجهم فى حكاية بالمعنى القديم التقليدى، أوفى قصة بالمعنى الحديث الذى يفعله الأدباء، ومن الطبيعى_فى اعتقاد يحيي_ أن القصة تنطوى على أساطير أو خرافات البلدة، ومن ثم لا تفقد القصة جرعات الإدهاش التى تثيرها فى قارئها، ومن الطبيعى أن كتابة يحيي تتمتع بالحسّ الدرامى الحاد لأنها تحمل من التناقضات الواقعية ما ينتج عنها دراما حادة بالفعل، وكأنه يقف على خشبة مسرح، ويلقى قصته، وكأنه يلقى قصيدة، كما كان يفعل دائما، فمن فرط استغراقه وتماهيه مع قصته، كان يحفظها ويلقيها وكأنه ينشدها، فهناك دائما موسقة لغوية وأسلوبية وإيقاعية نجدها فى مفردات وفقرات وتكرارات وتأكيدات قصص يحيي، يبدأ قصته هذه ب: "كأى رجل تزوج..تزوج الخواجة (يسى)..وكأى امرأة ولود.. أنجبت زوجته ابنهما (نظير)، وإذا كان الله وحده هو الذى يعطى ويأخذ_ فقد أعطى الله كثيرا وأخذ الكثير أيضا ماعدا نظير، فقد أبقاه الله، ليأخذ من الدنيا نصيبه.. ومن والده اسمه ولقبه ومتجره الوحيد".
هذه البداية التى لم تتجاوز خمسة سطور، يؤسس فيها الكاتب لعالمه الذى يشيده بدقة البنّاء المبدع، يشيّده فيما بعد من حكايات واعتقادات القرية، إذ يكبر نظير، ويموت والده، ويرث نظير دكانه الذى كان المتصرف الأساسى فى تموين القرية من شاى وزيت وسكر وغلال وما يستجد من سلع أخرى، ويعمل يحيي على تمييز نظير الذى لم يرث الدكان فقط، ولكنه ورث الأفعال أيضا وعمل على تطويرها: إذ ".. تناول الدكان بحرص والده..لم يطل سقفا، ولم يعلّق لافتة، ولم يعط الأقة أقة، ولا الرطل رطلا"، كل هذه المفردات الخشنة، تأتى فى إيقاعات ناعمة مموسقة، لكى تصبح مغناة ومنشودة، ولأن يحيي ابن الملاحم والحواديت والحكايات الشعبية والأهازيج، تسللت إليه كل تلك الطرائق من الشفاهى إلى الكتابى، وبالطبع كانت القصة تحمل حكايات أهله الفقراء، أهله الذين انبثق من جدرانهم دون أن يهجرهم حتى بعد أن جاء إلى المدينة الكبيرة، وكان يحيي يكتب عنهم دون أن ينزلق الأمر إلى حالة الهتاف، وكأنه يكتب نشيدا فنيا، ولكنه نشيد هامس.
فكّر نظير فى تطوير تجارته، عملا بمبدأ أبيه القائل: "..فكر تكسب، وفتّح عينك تغرق فى بحور الدهب"، فاتفق مع أحدهم على أن يشترى طاحونة نصف عمر، لكى يطحن أهل القرية فيها الغلال، وعندما اكتمل البناء الذى سيحتويها، هاج أهل القرية وماجو وهددوا "نظير" بما لا تحسن عاقبته، وهنا تتجلّى الأسطورة أو الخرافة التى يجعلها القاص محور الحكاية الرئيسى، لأن أهل القرية كانوا يعتقدون أن الطاحونة لكى تعمل، لا بد من إطعامها بأحد أطفالها، فهى لن تعمل إلا بهذا الشرط الأسطورى، واجتمع الناس وتزاحموا وصرخوا وهتفوا، وأخرج كل واحد منهم غضبه بطريقته الخاصة، ليمنعوا وضع الطاحونة، واستدعوا العمدة الذى خاض حوارا عنيفا وسلطويا وآمرا مع نظير، ولكن نظير كان عنيدا وخبيثا وقادرا على المراوغة والأخذ والرد، ولا فرق عنده بين الخبث والتودد، إذ علمته التجارة أن يكون طويل النفس، حتى يصل إلى غرضه، وبعد حوار طويل وجدل وشد وجذب، اتفق نظير والعمدة وأهل القرية، على أن يذهبوا للشيخ موسى، وهو "البركة" الذى تنفتح أمامه كل الأبواب المغلقة، وبخبث التاجر يقرر أن يجلب للشيخ موسى هدية معه، وعندما يصل حشد الناس يتقدمهم نظير والعمدة، ويبادر نظير على الفور وقبل أى حوار، بإعطاء الهدية للشيخ موسى، ويدور حوار بينهما، يبدأه الشيخ موسى:
(_النبى قبل الهدية..لكن المكنة لازمها عيل صغير..
ويرتجف الخواجة نظير..
بركاتك ياشيخ موسى..مددك واسع.. قد الدنيا..مقامك كبير وتحصل..بس انت ادخل الطاحونة وكله ينفك لجل خاطرك)
وبعد بضعة تمتمات ولعثمات وصرخات خافتة من المدد، يدخل الشيخ موسى، وهو ينادى:
(ياواسع الكرم..ويا..
وتصرّ التروس فى طحن مكتوم من قلة الزيت..وتشتد الفرقعة وتعلو الصرخات "توت..توت.." وتلعلع زغروتة.. وتهمهم شفاه بالخلاص..
_مدد ياشيخ موسى.. ياقطب..ياواسع المدد.. مدد..
ويتشعلق الخواجة نظير على أكتاف الزفة ليعلّق لافتة كبيرة بأعلى الحائط:
<..طاحونة الشيخ موسى، لصاحبها الخواجة نظير..وابنه مفيد..>)
هكذا ينهى يحيى الطاهر قصته الأولى_علامته البكر "طاحونة الشيخ موسى"، بعد أن بذر فيها حبوب ومفردات قريته الشائكة والخاصة والمختلفة عن قرية يوسف ادريس، وآثر يحيي ألا يسرد الحكاية دون أن يدس فيها خصوصية بلدته وناسها ورموزها، ورغم وضوح العالم الأسطورى الذى يحيط بالسرد وبالأحداث وبالناس وبالمكان والعلاقات المتنوعة بين المسلم والمسيحى وبين التاجر والمستهلك وبين العمدة الذى يمثّل سلطة ما وأهل القرية، إلا أننا لا نفقد ذلك الهامش الواقعى الذى يتسلل بين كل فقرة وأخرى، تكاد المفردات التى يحرص الكاتب على اختيارها تنطق بفرادة المكان والأحداث، تلك الفرادة التى كانت أول إيقاع حاد ولافت فى كتابة الجيل الرابع، أو جيل الستينات، وربما كان الوقت مبكرا، وغير موات لكى تصبح القصة علامة انقلابية، وينتبه لها كتّاب الجيل السابق.
يوسف ادريس يقدمه:
بعد قصة "طاحونة الشيخ موسى"، وتطور يحيي الطاهر، وإصراره على مزاولة الكتابة بطريقته الخاصة، فى ظل اشتباكه مع الحياة الثقافية المتمردة، يكتب يحيي قصصا مثيرة للغاية، ليكشف رويدا رويدا عن ذاته الإبداعية المشروعة والمقموعة فى الوقت نفسه، مشروعة لأن هذا حلمه الخاص والعام كذلك، ومقموعة لأن اتهامات كثيرة بدأت تنتشر حول هذا الجيل العدمى، والمتأثر بكتابة الغرب الغريبة كما قال الأستاذ دوارة عن ادوار الخراط، لكن يحيي لم يمتثل للكتابة السائدة، ولم يفلت خيط التمرد من روحه، ولذا لفت إليه الأنظار بقوة، وفى أغسطس 1965 قدّمه الدكتور يوسف ادريس فى مجلة الكاتب، والتى كان يشرف على نشر الإبداع فيها، وكانت القصة هى: "محبوب الشمس"، إحدى قصص يحيي اللافتة والمكتملة، والتى طرح فيها اقتراحات جمالية جديدة فى ذلك الوقت.
ورغم أن يوسف ادريس كان قد قدّم بهاء طاهر قبل ذلك بعام كامل، وأثنى على قصته "المظاهرة" بشكل مفرط، وقال إن قصص بهاء طاهر لا شك أنها قصص بهائية طاهرية من طراز فريد، وذلك لأن بهاء كان امتدادا ناعما طبيعيا ليوسف ادريس، وهذا بالطبع لا يعيب كتابة الأستاذ بهاء، لأنه استطاع أن ينفلت فيما بعد من التأثير الإدريسى الطاغى ليصنع إبداعه وأسطورته الخاصة، ولكن يحيي الطاهر كان شائكا منذ البداية، ويبدو أنه امتداد للجيل السابق أو الأسبق، لكنه امتداد يشبه الانقلاب كما أسلفنا القول، أو امتداد جدلى للكتابة السابقة عموما، وهناك من وضعه فى مواجهة كتابات طه حسين عن الجنوب المصرى.
بدأ ادريس تقديمه قائلا: "كنت أفضّل ألا أنشر ليحيي الطاهر عبدالله هذه القصة، بل كنت أفضّل فوق هذا ألا ينشر يحيي طاهر_هكذا_ أيا مما يكتبه الآن، فهذا الشاب الصعيدى النحيف الساخط على القاهرة والمدينة وكل شئ، يقوم، كما سترون كاللمحات الخاطفة، فى هذه القصة، بمغامرة فنية قد يجازى فى نهايتها بلون فريد من ألوان القصة يتميز به وقد لا يخرج بشئ بالمرة.."، ويستطرد ادريس فى الثناء على المغامرات الفنية بشكل عام، خاصة أن الحياة كلها _كما يقرر_مغامرة كبرى، وهو ينتصر للمغامرة دوما، ولكنه كان يفضّل _يكرر_ ألا ينشر له الآن_آنذاك_ حتى تنضج مغامرته وتتضح، "ولكن يحيي مثله مثل الجيل الجديد جدا من الكتاب، سريع التبرم بالأشياء وأولها قلة النشر.. سريع فى اتهاماته وأولها أن الناس لا تريد أن تفهمه ولا تقوى على طريقته فى الكتابة، مثله فى هذه النقطة مثل حافظ رجب والذى تعجبنى طريقة كتابته وإن كانت لا تعجب كثيرين"، ورغم هذا التقديم الملتبس، إلا أنه يثنى عليه بطريقة ما، طريقة تدلّ على ارتباك ادريس فى تقييم يحيي الطاهر، فيقول فى نهاية التقديم: "..أما قصة "محبوب الشمس" هذه، فقد كتبها يحيي طاهر فى عام 1963، وأعتقد أنه الآن قد جاوز مرحلتها بكثير، واعذرونى فى حماسى له، فإنى أعتقد أن هذا الشاب الصعيدى النحيف المشحون بكل ما فى الصعايدة من عناد وحدة، سيكون له فى أدبنا العربى شأن وشأن قريب".
مقدمة كلها ألغاز، تتراوح بين الحماس، والرغبة فى تأجيل النشر، وهو ينشر هذه القصة لأن يحيي كان متبرما وعصبيا وكثير الاتهام، كما يرى أن هذه القصة لا تعبّر عن يحيي فى ذلك الوقت، ولكنها نتاج فترة سابقة، ورغم كل هذه المؤاخذات، إلا أنه يبشّر بأن هذا الشاب الصعيدى النحيف سيكون له شأن فى الأدب العربى!
أما القصة فهى من فرائد يحيي الأولى، والتى أدرجها فى مجموعته الأولى التى صدرت عام 1970تحت عنوان "ثلاث شجيرات تثمر برتقالا"، وكلنا يعرف الأطفال ذوى الشعر الأصفر والرموش الصفراء، والذين لا يستطيعون النظر إلى الشمس، وطفلنا فى هذه القصة من هؤلاء الأطفال، لكن القرية تطلق عليه "محبوب الشمس"، ويضايقه المارة والجيران والأهل والأقارب، حتى شيخ الجامع، ويكثرون الضحك منه وعليه، ولا يريد يحيي أن يسرد وقائع سيرة لهذا الطفل، بقدر ما كان يطرح القرية بمفرداتها وسخرية أبنائها، وسماجة بعض من هؤلاء، سماجة تصل إلى حد السادية فى تعذيب الطفل والتنكيل به دون جريرة، والتنمر به _حسب الوصف المعاصر_، "ومحبوب الشمس فى الخامسة عشرة من عمره..قصير جدا.. ونحيل..أبيض شعر الرأس.. وكذلك كان لون حاجبيه.. ومن هنا كان الشيخ كامل أمام مسجد أبو عوضيتأمله فى صمت المؤمن.. ويدور فى تلك الحكمة الإلهية التى تنبت الدود فى بطن الحجر، والتى أثمرت هذا القزعة من والد فى طول السيمافور وأم فى حجم الدرفيل.. والحاج خليل والد محبوب طويل فى إفراط.. وصاحب شعر فى لون الليل الشتائى.. والحاجة نفيسة زوجته غنية باللحم والشحم .. وتملك ثروة من الشعر الأصفر كالسنابل القمح المستوية.."، لا أريد أن أسترسل فى قراءة القصة، ولكننى أكرر وأؤكد على غرام يحيي وشغفه ورغبته فى تأكيد الأنساب، ووصف الولد "القزعة"، والوالد الطويل الذى يشبه "السيمافور"، والوالدة الغنية باللحم والشحم، والتى تملك ثروة من الشعر، هنا تصبح الحكاية أو الحدوتة مجرد عنصر قليل الشأن فى بناء القصة، وتبرز السمات الحسّية، والتضاريس الجسدية، لتكون علامات واضحة وحيّة لا تنسى على وجه الإطلاق، وتظل عالقة بخيال القارئ، وممتعة له كلما قرأها وتذكرها، هذا فضلا عن نعومة السرد، واقترابه من الشفاهى الفصيح.
وكذلك يقدمه أيضا يوسف الشارونى:
لا أعتقد أن تقديم الرائدين يوسف ادريس ويوسف الشارونى، كان بمحض الصدفة، فإذا كانت مهمة الإشراف على مجال الإبداع فى مجلة الكاتب هى التى جاءت بمقدمة يوسف ادريس، إلا أننى أهجس بأن مقدمة الشارونى كانت اختيارا محضا، ربما يكون اختيار الشارونى نفسه بعدما ذاع صيت يحيي، أو أنه اختيار يحيي حقى رئيس تحرير المجلة، والذى كان متعاطفا مع يحيي الطاهر كثيرا وعلى كافة المستويات، فيحكى يحيي الطاهر_فى حوار مع يوسف أبورية_ حكاية يؤكدها يحيي حقى، "فى بداية حياتى بالقاهرة، عرفت يحيي حقى، وساعدنى كثيرا فى نشر قصصى الأولى بمجلة المجلة، وذات يوم _وكان مولد النبى_ بينما كنت أسير معه فى الشارع بعد خروجه من المجلة، اشترى لى ولنفسه حلاوة المولد.."، لذا لا أستبعد أن يكون يحيي حقى الذى كان يلعب دور الأب، هو الذى اختار الشارونى لكى يكون معقبا على قصة الطاهر "الثلاث ورقات"، والمنشورة فى مجلة المجلة فى أغسطس 1966، تلك القصة التى كان يحيي قد قطع شوطا فى تطوره من خلالها، وقدرته فى التلاعب مع لعبة الضمائر، والخفاء والتجلى بين الداخل السرى والمستتر، ذلك البعد النفسى للشخصيات، والحدث الخارجى الدائر فى الحياة المعلنة، كما أنه أتقن طريقة التقطيع بشكل يغمض على القارئ فى البداية، ولكن مع استعادة القراءة، تكون كل تفاصيل القصة متاحة للفهم والاستيعاب والاستمتاع أيضا بفنية السرد، وفنيّة اختيار المفردات والجمل والأحداث ذات الإيقاع السريع.
القصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الولد والشايب والبنت، ويختار يحيي هذه الأوراق الثلاث من لعبة "الكوتشينة"، وهى طريقة فنية جديدة، وهؤلاء الثلاثة يركبون قطار الصعيد القادم من الشلال تباعا، وتبدأ القصة بالولد الذى يستمع إلى المذياع، ويمزج بين مايسمعه من إعلانات تافهة وأخبار وأغنيات، وبين همومه الانسانية وما يفكر فيه، أو مايذهب إليه خياله، ولأن الولد هو الذى ركب القطار أولا، فهو الذى يسرد ويحكى تفاصيل ووقائع الرحلة، وأحداث الشايب والبنت، وهى لعبة فنية ممتعة، وقد أثنى عليها الشارونى، وهى جد جديدة وملهمة، إلا أن الشارونى يأخذ على يحيي استخدامه للعامية دون توظيف فنى_كما يرى_، مثل استخدامه مفردة "القزاز" بديلا عن "الزجاج"، وملاحظة الشارونى ملاحظة تقليدية تليق به وبتجربته الخمسينية، لكن يحيي الطاهر له مغامرته الخاصة، وله مراميه الفنية التى تختلف _بالتأكيد_ عن المرامى الفنية للجيل السابق، وهى تكاد تكون مغامرة مكتملة الوجوه، بداية من اختيار المفردات، ووضعها فى جمل، ثم بناء تلك الجمل، لتنتهى إلى قصة تقترح جماليات تناسب روح التجربة والمكان والزمان المحيطان بيحيي، وقد امتزج بهذه العناصر أشد الامتزاج، كما أن يحيي لا تتوقف قصته كما أسلفنا القول، بقدر ما كانت تستهويه اللعبة الفنية، حتى يقدم نصّا فنيا ذا إيقاعات وألوان ومفردات وتراكيب تخصه وحده، وتخص تجربته كذلك.
فاصل سياسى قصير:
لم يكن جموح يحيي الفنى، منفصلا عن جموحه السياسى إطلاقا، فارتباطه الفكرى والطبقى والاجتماعى بزميل صباه وشبابه وبلاده عبد الرحمن الأبنودى، لم يتوقف عند ذلك فقط، بل امتد إلى القاهرة، وصار أصدقاء الأبنودى، هم أصدقاء يحيي، ومقاهى الأبنودى، هى مقاهى يحيي، مع اختلافات قليلة فى مجال كل منهما، لكن كان الارتباط بين يحيي والأبنودى، ارتباطا لا يقبل أى خدوش أو كسور أبدا، وعندما قرر الأبنودى والسيدة عطيات عوض الزواج، حدث ما لم تتوقعه، وأترك الحديث لعطيات الذى سجلته فى كتابها "أيام لم تكن معه"، والصادر عام 1999، إذ تقول: "..قال لى الأبنودى قبل أن نتزوج: لا بد من موافقة صديق عمرى وأخى يحيي الطاهر عبدالله، فقدمنى إلى يحيي، وفى هذا اليوم تعرّفت على يحيي بالطريقة التى اختارها يحيي، قرأ لى يحيي قصتيه اللتين نشرتا فى مجلة الكاتب المصرية، وقدم لهما يوسف ادريس، قصة محبوب الشمس، وقصة 35 البلتاجى 52 عبد الخالق ثروت، وذكر لى أن القصة الأخيرة مكتوبة عن كمال الأبنودى الذى يعمل موظفا على الآلة الكاتبة فى إحدى الشركات فى شارع عبد الخالق ثروت"، وتستطرد عطيات: "..بعد يوم أو اثنين من هذه المقابلة التى تركنى فيها الأبنودى وحدى مع يحيي، جاءنى يحيي عند أمى فى السيدة زينب لكى يعلن موافقته على زواجى من الأبنودى_بطريقته أيضا_ قال: أريد أن أطلب يدك لى، إذا لم توافقى على زواجك من الأبنودى، قال يحيي مطبطبا على كتفى : من الآن أنت أختى المحرمة"
كان هذا الحوار فى سبتمبر 1965، وبعد موافقة يحيي على زواج الأبنودى من عطيات، تم الزواج فى أكتوبر عام 1965، وسكنا فى بيت والدتها، وكان يحيي وكرم الأبنودى يسكنان فى بولاق الدكرور، وبعد العثور على مكان مستقل للزوجية فى باب اللوق، 5 شارع أبوهيف، لم يترك الأبنودى يحيي لكى يعيش وحده، ولكنه اصطحبه إلى بيت الزوجية، ولكن مشاجرات يحيي الدائمة مع عطيات، أدت به لكى يهجر بيتهما، ويذهب إلى حال سبيل، فأرض الله واسعة.
ولكن هذا الفراق لم يمنع استمرار علاقة يحيي بالأبنودى، تلك العلاقة التى لا يغلبها غلاب، حتى الزواج، وكان يحيي يكتب قصصا للأطفال، وينشرها فى مجلة سمير، التى تصدر فى دار الهلال، وأود أن أسوق ملاحظة على ماقاله صديقى الدكتور حسين حمودة، عندما قال فى كتابه عن يحيي، بأن هذه ليست قصصا بالمعنى الفنى، ولكنها مجرد سيناريوهات لقصص مصورة، والحقيقة أن القصص كانت قصصا مكتملة، ولم تكن مكتوبة لقصص مصورة، ولكنها قصص مستقلة تماما.
ظلّت علاقة يحيي بالأبنودى مستمرة، وكانت هناك صحبة سياسية كبيرة، من هذه الصحبة كان صلاح عيسى وغالب هلسا وصبرى حافظ وسيد حجاب وسيد خميس وغيرهم، ولم يغب عن الأذهان أن كل هؤلاء ينتمون إلى اليسار فى إهاب واسع، ذلك اليسار الجديد الذى بدأ يرفع شعاراته، ويكتب إبداعاته، وفى هذه الإبداعات بعض تمردات واضحة، ومن الأكيد أن الأبنودى ويحيي كانا مبدعين على قدر كبير من التمرد، وكانت المقاهى تكتظ بجلسات هؤلاء الكتاب والمثقفين والمبدعين، حتى أن جاء 10 أكتوبر 1966، بعد مرور عام من الزواج، ويتم القبض على الأبنودى ورفاقه، ويختفى يحيي، ويظل هاربا من البوليس، حتى يفرج عن رفاقه فى مارس 1967، وبعدها يظهر يحيي، وهناك معلومة أوردها الناقد الدكتور سيد البحراوى، وهى أن يحيي تم القبض عليه، وهذا ما لست متأكدا منه، ورغم أن يحيي كان محاطا دائما بالهواجس التى تقضى على راحة باله _كما يقولون_، إلا أنه كان يجهر بالثورة دائما فى حياته.
تكريس نقدى جديد لفن القصة:
بعد تلك المحطات الأدبية الثلاث ليحيي الطاهر، وهى محطات بالفعل، حيث التقاطعات كانت حادة وجادة مع الآباء الكبار لفن القصة القصيرة، وهم على التوالى يحيي حقى ويوسف ادريس ويوسف الشارونى، لتأتى مرحلة أخرى جديدة عندما احتدمت مرحلة إبداعية فريدة فى مصر، وكان كتّاب القصة فى مصر يتبارون فيما بينهم فى تقديم التجارب الطليعية الجديدة، وصدرت مجلة "جاليرى68" الطليعية فى مايو 1968، لتكون شاهدا وسجّلا واضحا لتلك التجارب، واهتمت المجلة بشكل خاص بفن القصة القصيرة، ففضلا عن أنها كانت تنشر قصصا لأبناء الظاهرة فى كافة أعدادها، إلا أنها فى منتصف عام 1969، أصدرت عددا كاملا وخاصا تحت لافتة "القصة المصرية المعاصرة"، ونشرت فيها لكل نجوم الظاهرة: ابراهيم أصلان وبهاء طاهر وجمال الغيطانى وجميل عطية ابراهيم ومحمد حافظ رجب ويحيي الطاهر عبد الله وغيرهم، وفى هذا العدد نشر يحيي قصته "جبل الشاى الأخضر"، وهى كما كل قصصه تغوص فى الحسّى والملموس، وتنتقل القصة من الجد الذى يصب الشاى فى الأكواب، إلى حكاية الأخت التى وشى بها الطفل لأبيه، ومضمونها أن "..كانت نوال أختى راقدة ظهر جاموستنا.. وكانت نائمة بصدرها، وقد حضنت عنق الجاموسة بكلتا ذراعيها..وكانت تمرجح ساقيها وتحك فخذيها ببطن الجاموسة الأسود السمين، كنت أرى أصابع قدمها التى تواجهنى كخمسة مسامير دقت أسفل بطن الجاموسة.."، وكان تعبير أصابع القدم التى تشبه المسامير، تعبيرا يشى بقوة رغبة نوال الجنسية التى تفجرها فى محيط ظهر الجاموسة، وعندما أدرك الأب خطورة ذلك الفعل، وجن جنونه، وراح يضرب ابنته ضربا يكاد يصل بها إلى الموت"، وكتب الناقد شوقى خميس تعقيبا نقديا مطولا فى مجلة الهلال عدد أغسطس عام 1970 نقتبس من هذا التعقيب مايلى: "..عالم يخفى الرقة والتعاطف الحار فى أعماقه، فيبدو سخطه قاسيا قسوة المجمرة الملتهبة والوجوه والكلمات، عالم الرجال الذين تنغرس أقدامهم الحافية فى الرمل الساخن ويصعدون الجبل، ويضربون أطفالهم حتى تسيل الدماء من أجسادهم، ولا يستطيع رؤية وجههم الآخر إلا قصاص شاعر مثل يحيي الطاهر، فيجد كل ذلك حين يجمع فى نهاية القصة بين أنين الأخت التى عصفت بها القسوة والمشقة التى يتكلفها الآباء من أجل الحصول لأبنائهم هناك على أعشاب الشاى الخضراء، وحبات الليمون"، وبعض تفاصيل نقدية ينهى شوقى خميس تعقيبه قائلا: ".هذا الحب الفائض العميق المختفى وراء سطح الحياة الخشن القاسى، فهى ليست صورة القسوة وحدها، ولا صورة الحب وحده، وإنما صورتيهما معا ملتحمتين فى نسيج الحياة".
أثارت قصة يحيي والقصص الأخرى حماس النقاد الطليعيين لكى يعملوا على إبراز جماليات هذه الطفرة الجديدة فى مجال القصة القصيرة، حيث كتب ابراهيم فتحى تعقيبا على الملف قائلا: "لم يسبق للقصة القصيرة المصرية أن ازدهرت كما تزدهر هذه الأيام على أيدى كتّابها الجدد، وقد وصلت إلى درجة واضحةمن النضج تبرز فى جسارة الرؤية الفكرية وحيوية الشكل الفنى، وتلك الدرجة من النضج لا تطمح فى الاقتراب منها الأجناس الأدبية الأخرى من رواية ومسرح وشعر، وتبدو الأعمال النقدية التى تحاول ملاحقة تطور القصة القصيرة هزيلة عرجاء، فمسنوى الخلق الفنى فى هذا المجال، يعلو بما لا يقاس على المحاولات النقدية جميعا.."، ورغم أن ابراهيم فتحى أنهى تلك الفقرة قائلا: "..ونكتفى هنا بتسجيل تلك الظاهرة، دون أن نتعرض لتفسيرها"، إلا أنه قدّم عرضا وتفسيرا بديعا للظاهرة، وعقّب على كثير من الآراء التى ملأت الصحف والمجلات آنذاك.
ضمن هذه الأفكار التى سادت، كتب الناقد عبد الرحمن أبوعوف فى عدد الهلال الصادر فى أغسطس 1969تحت عنوان كبير "البحث عن طريق جديد للقصة المصرية القصيرة"، وجاء عنوان فرعى ضمن هذه الدراسة هو "واقعية جديدة"، أدرج فيه كتابات لمحمد البساطى وعبد الحكيم قاسم وكذلك كتابة يحيي قائلا: "..أما عند يحيي الطاهر عبدالله، فنحن نجد وربما لأول مرة بعد تجربة يحيي حقى عن الصعيد، ومدى تغلغل نظرته وعمق إحساسه الفنى خاصة فى مجموعة "دماء وطين"، ربما نجدةتكاملا فى بناء القصة يبلور قبض الحياة الحزينة المرتعشة من سطوة مجهول ... إن قصص "الوارث وجبل الشاى الأخضر والدف والصندوق والكابوس الأسود"، تقدم رصيدا يستحق الدراسة المستقلة.."، وفى النهاية يريد أبوعوف بأن كتابة يحيي واقعية، ولكن كتابة يحيي الطاهر واقعية جديدة، وفى تعقيب ابراهيم فتحى يدين هذا التوجه الذى يصف الكتابة الجديدة بالواقعية الجديدة، ويعتبر أن ذلك المصطلح، نوع من وضع المساحيق الكاذبة على وجوه قديمة، ويقرر بأن الكتابة الجديدة، كتابة جديرة بالقراءة بعيدا عن اختراع صناديق نقدية معتمدة من هنا أو هناك.
ولا تتوقف المعركة والسجال بين ابراهيم فتحى ونقاد آخرين، ولكن الحديث قد طال، واستدعى كثيرا من الوقائع التى أراها فى حياة يحيي الطاهر عبد الله وبقية أبناء الظاهرة الستينية، وبالطبع فيحيي الطاهر عبد الله يحتاج إلى تأمل دائم، فكتابته مغرية دائما بالقراءة والتجدد، ورغم أن دراسات كثيرة كتبها باحثون ونقاد كبار وجادون مثل سيد البحراوى وشكر عياد وحسين حمودة وصبرى حافظ ويوسف دريس ولطيفة الزيات وسعد الدين حسن وعلاء الديب ومحمد بدوى وشاكر عبد الحميد وغيرهم، إلا أننا سنعود لنستكمل المراحل الأخرى فى حياة يحيي الإبداعية التى مازالت تحتاج إلى تأمل، ومازالت بالفعل مثيرة للدهشة، ذلك الكاتب الذى أخلص لفنه ولإبداعه من ناحية، ولقريته الكرنك من ناحية ثانية، وللفقراء ملح الأرض من ناحية ثالثة.
شعبان يوسف