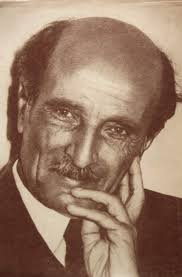حشرجة الموت !
كم سمعت بها قبل أن أسمعها . أما منذ تلك الليلة ــ ليلة العاشر من نيسان (ابريل) سنة 1931 ــ فإني أكاد لا أسمع غيرها . أسمعها في دقَّات قلبي وفي أنفاسي . أسمعها في صوتي وفي كل صوت . أسمعها في همس النسائم وحفيف الاوراق . أسمعها في سكينة الليل وجلبة النهار .
ألا تباركتِ حياةً تلتقي الآزال والآباد في لحظةٍ منها . فيندمجُ النقيضُ بالنقيض ، وتستوي الأضداد كالأنداد . تباركتِ لأنك تهزأين بمقاييس البشر . وفي هزئك قساوة . وفي قساوتك عدل . فلا تخجلين من أن تجمعي بين العرض والجوهر ، بين الهزل والجد ، بين المتاجر والمقابر ، بين حشرجة الموت وقرقعة التلفون !
النهار الجمعة . والساعة نحو الخامسة والنصف . أنا أستعد للانصراف من محل أنحر فيه كل يوم ساعاتٍ بكارى من حياتي لعددٍ محدود من مومسات الريالات ، وقلما أسمع حديثاً إلا عن البيع والشراء ، عن الربح والخسارة ، عن سوق تصعد وسوق تهبط . يقرع جرس التلفون فيطلبونني إليه . أهو أحد الزبائن يرغب في بضاعة أو يشكو بضاعة أو يعتذر عن عدم مقدرته على دفع ما عليه ؟
(( هلو ... نعم . أنا هو . مرحباً . مرحباً ... ماذا تقول ؟ جبران في المستشفى ؟ ))
(( في مستشفى القديس فِنْسِنْتْ . وهو في غيبوبة . والطبيب لا يقدّر أنه يعيش حتى منتصف الليل . وليس حواليه أحد من رفاقه وخلانه . فرأيت من واجبي أن أخبرك لعلمي أنك أقرب الناس إليه ))
(( تاكسي ! مستشفى القديس فِنْسِنْتْ . ـــ أسرع أيها السائق ، أسرع . ))
وكيف لهذا المسكين أن يسرع في شوارع مكتظة بالبشرية المسرعة على أقدامها وعلى دواليبها ؟ وإلى أين يُسرع هؤُلاء الناس ؟ ــ كل إلى مستشفاه . ومستشفى الكلّ واحد .
ومن هو هذا القديس فنسنت وبماذا تقدَّس حتى يُقدَّس ؟ ليس بيني وبين مستشفاه غير ميل وأقل من ميل . لكنه أطول ما قطعته في حياتي من المسافات . جبران على فراش الموت . أ أَدركه حياً ؟ أسرع أيها السائق ، أسرع
(( أنا اليوم رجل صحيح يا ميشا )) هذه آخر كلمات سمعتها منه وقد خاطبته بالتلفون قبل ذاك بأيام مستفحصاً عن صحته . فتواعدنا أن نلتقي فنتعشى معاً في أحد المطاعم ونقضي السهرة عندي . وها أنا ذاهب لأتناول واياه العشاء على مائدة الموت في مطعم القديس فنسنت !
(( أنا اليوم رجل صحيح يا ميشا ــ أنا غريب في هذا العالم يا ميشا ــ أنا أحبّ هذا العالم يا ميشا )) ــ الصحة والعلة . والموت والحياة ، والوطن والغربة ــ أَلا مَنْ يريني ما بينها من الفروق ؟
أسرع أيها السائق . أسرع .
(( في أية غرفة خليل جبران ؟ )) ــ سؤال أوجهه إلى رجل جالس إلى مكتب قريب من الباب داخل المستشفى . فيندفع يفحص تحت حرف (( الجيم )) في قوائمه المنظمة كأنه يفتّش عن كلمة في قاموس غير مبالٍ أن صوت الرجل الذي يخاطبه يتهدج بصوت الموت .
(( ليس عندنا عليل بهذا الاسم يا سيدي . )) واذ اؤكد له أن عندهم عليلاً اسمه جبران يحيلني إلى رجل آخر عند مدخل للمستشفى من شارع آخر فأخرج من حيث دخلت وأسرع إلى المدخل الذي ردَّني إليه . وهناك أعرف أنّ جبران في غرفة كذا في الطبقة الثالثة من تلك البناية المتعددة الطبقات . فأصعد سلالم كثيرة . وأدور في منعرجات كثيرة . وأتفحَّص أبواباً كثيرة قبل أن أهتدي إلى الباب الذي أطلبه . ووراء كل باب اقترب منه جسد يتكوَّى بالأوجاع . وروح تحارب القدر . ربَّاه . ربَّاه . ربَّاه ! هوذا جانب من خليقتك التي تطلب جابراً لما تكسَّر من عظامها . وراتقاً لما تفتَّق من جلودها . وجامعاً لما تفتَّت من أكبادها . فلا تحصل إلا على عقاقير ثم عقاقير . فأين دواؤك ؟ أم هو الألم مصهر المحبة ــ محبتك التي لا توصف . وسبيل الخلاص ــ خلاصك الذي لا يثمَّن ؟
راهبات يمرون بي وأمر بهنَّ كأنهنَّ خيالات من عالم لا أعرفه . وفي سواد أثوابهنَّ ما يسوّد القلب . وممرضات يدخلن من باب ويخرجن من باب وفي بياض ألبستهن ما يجرح العين
(( أين الغرفة كذا يا أختاه ؟ ــ إلى اليمين ؟ أشكرك . ))
أمام باب الغرفة رجل تحيط به نسوة ثلاث . واذا اقترب تنفرد من الثلاث واحدة طويلة القامة ، عظميَّة الهيكل ، زعفرانية اللون ، حادَّة الأنف ، غارقة العينين . فتخطو نحوي مادَّة يمناها إليَّ . هي شاعرة أميركية في النصف الأول من عقدها السادس . عرفَتْ جبران منذ سبع سنوات فتقربت منه وكانت تساعده في نسخ مؤَلفاته . وقد التقيتها مرّة عنده . واذ أضع يدي في يدها تتنهد وتقول :
(( أشكر الله . أشكر الله لأنك ههنا . ))
في قلبي وفي عينيّ وعلى وجهي سؤَال واحد يتردد لساني في طرحه فتجيبني عليه هذه السيدة قبل أن تسمعه من فمي :
(( لم يبق من أمل . لم يبق من أمل ))
(( أخبريني ماذا جرى ))
(( كنت البارحة عنده فوجدته يعاني آلاماً لم يعانِ مثلها من قبل . دعونا الطبيب وسألناه اذا كان من ضرورة لنقله إلى المستَشفى في الحال . فأجاب أن لا بأس لو بات ليلته في بيته . ولم أشأ أن أتركه وحده فقضيت الليل عنده . وفي الصباح ــ صباح اليوم ــ الجمعة ــ اشتدّ عليه الوجع فجئنا به إلى هنا بين الساعة العاشرة والحادية عشرة ))
(( ولماذا لم تخبريني أمس . أو اليوم باكراً ؟ ))
(( أمس كنا نظن أنه عرض ويزول . واليوم عندما جئنا به إلى هنا كنتَ أول من خطر ببالي . غير أني أجهل رقم تلفونك . فبقيت أفكّر بواسطة أتوصل بها إليك إلى أن خطر لي ــ وكان ذلك إلهاماً ربَّانيَّاً ــ أن أتلفن إلى إدارة مجلة (( العالم السوري )) لتطلعك على الأمر . وهكذا كان والآن أشكر الله لأنك آتيت . ))
(( كيف هو الآن ؟ ))
(( غاب عن الوعي بعد الظهر بقليل لا يزال في غيبوبة . ))
(( هل عرض عليه أحد أن يعترف ويتناول ؟ ))
(( سألته الراهبة ــ هل أنت كاثوليكي ؟ فأجابها بنبرة قوية (( كلا ! )) فتركته وانصرفت . وبعد أن انتقل إلى حالة الغيبوبة جاءه كاهن سوري ــ هو رجل قصير لعلك تعرفه ــ وأخذ يناديه بأعلى صوته : جبران ــ جبران . جبران ! وجبران لا يعي . ولقد بلغ استيائي من ذلك الكاهن وخشونته حدّاً تمنيت معه لو كانت لي القوة الكافية لطرحه من النافذة . ))
(( هل فعل الكاهن شيئاً ؟ ))
(( هذا كل ما فعله . ))
(( وأين الطبيب ؟ ))
(( ها هو )) مشيرة إلى الرجل الواقف أمام الباب .
(( ما هي علته أيها الطبيب ؟ اليس من أمل ... بالطب ــ بالجراحة ؟ ))
(( سرطان في الكبد . لا أظنه يعيش حتى منتصف الليل . هو الآن في غيبوبة ولا أخاله يفيق منها . )) ــ كلمات تلفظ بها كأنه يحدث عن الطقس . ولا عجب فليست هذه أولى مقابلاته للموت . ترى أيقابل موته بالبرودة عينها التي يقابل بها موت سواه ؟
الطب . الطب . الطب ! إله العالم المتوجع ووجعه الأكبر .
(( أتسمح لي بالدخول على المريض أيها الطبيب ؟ ))
(( لا مانع على الإطلاق ))
***
غرْ ــ غرْ ... غرْ ــ غرْ ... عنْـ ـــ ـــ ـنْ . . .
صوت غريب يفاجئ أذني حالما أفتح الباب وأغلقه بهدوء ورهبة فأشعر عندما أجتاز عتبتهُ كأني قد اجتزت من عالم لا سر فيه إلى عالم كلّه أسرار ، وأنسى أنَّ هذا العالم في ذاك . وذاك في هذا . وأن لا أبواب بين الأثنين ولا عتبات سوى الأبواب والعتبات التي يقيمها جهلي وتبصره عيني الكليلة من خلال أغشية الحواس المحدودة .
أدنو من السرير الأبيض الصغير القائم خلف الباب فلا أبصر لأول وهلة معاون الطبيب الواقف عند رأسه ، اذ لتسمر عيناي بوجهٍ عرفتاه من زمان فأحبَّتاه ، والآن تكادان لا تعرفانه ، فقد كان بلون الرمل يسقيه دم الحياة . فأصبح رملاً يعلوه رماد المنيّة .
ها هو الأنف المستقيم الأرنبة ، الممتلئ المنخرين قد انتصب نحو السقف الباهت القاسي ، وليس فيه من الدم إلّا بقية ضئيلة تنهزم لحظةَ فلحظة من وجه عساكر الانحلال . فهو يكاد لا يتنفس كأنّ به زكاماً من أنفاس الأرض والسّماء . وكأَنّ الطبيب الأكبر ــ الموت ــ يداويه بنفحاتٍ من سماءٍ غير سمائنا ، وأرضٍ غير أرضنا .
ها هما العينان اللتان كانتا تبوحان بأسرارهما . فكم رأيت فيهما من بريق إلهام ومن حرقة شوق ومن نور بهجة . كم رأيتهما تغتسلان بالدمع . وتلتهبان بالضحك . وتتغلغلان في وجوه الناس والطبيعة لتستجليا معانيها . وأحياناً تذبلان وتذهلان عن كل ما حواليهما كأنّهما تتطلعان إلى ما وراء الستار أو تداعبان طيوف أفكار وعواطف لا تجول في أزقة الناس ومساكنهم ومعابدهم . والآن لست أرى فيهما لا رعشة ولا ومضة . فهما مطبقتان تحت حاجبيهما المقوّسين وقد أسدلتا أهدابهما الطويلة حتى الوجنتين فلا تبوحان بما أُغلقتا عليه من أسرار . وقد يكون خلف أجفانهما وميض بروق كثيرة . فمن يدري ما في غيبوبة الموت من ظلمات وأنوار ؟
ها هما الشفتان الحسَّاستان ، وقد كانتا بلون القرمز فأصبحتا بلون الرماد . كم انفرجتا من قبل عن بسمة ، وكم تكمشتا بألم . كم قبلتهما أمٌّ وأخت وحبيبة ، وكم من الشفاه تشتاقهما حتى الساعة ! وتلك الشفة العليا كم ارتجفت بغضب شديد أو بفرح قوي أو بحزن عميق . أما الآن فها هي قد التصقت بأختها السفلى في خط كأنه خاتم الحكمة الصامتة أو الحد الفاصل بين ما يمكن وبين ما لا يمكن التلفظ به . ولا تنفصل عن أختها إلَّا لتفتح الباب لأَنَّة هي أشبه بزفرة مذبوح منها بأنة مريض .
ها هي الجبهة العالية التي تقهقر عنها الشَّعر فزادها ارتفاعاً . وابيضّ عن جانبيها فزادها جمالاً . وجعَّدتها السنون تجاعيد لطيفةً فأكسبتها جلالاً . هي الجبهة التي كنت إذا نظرت إليها أكاد ألمس وأبصر ما خلفها من الأشباح والرسوم والمقاصد والمتاعب . أما الآن فهي أبعد من مجال بصري ولمسي .
ها هو الشعر الكستنائي ، وقد عبث المشط بنصفه ، وبيّض الشيب نصف ما تبقّى منه ، يغطي الآن جانباً من الوسادة وكأنّه ، بعد أن هربت منه الحياة ، خصل من صوف لا لمعان فيها ولا تجاذب .
(( بلى )) ــ تقول لي عيني ــ (( بلى . هذا هو رفيق أحلامك . وصديق أفكارك . وشقيق روحك . هذا جبران . وهو الآن يحتضر . فاعلم أنك في حضرة الموت .
(( جبران ! )) ــ يناديه قلبي وتناديه كل جوارحي . أما لساني فلا يتحرك وشفتاي لا تتفتحان . لأنني عندما أحدق في وجهه ، وقد أمسكت بعضلاته أصابع الألم القاسية . وعندما أسمع تلك الغرغرة الهائلة في حلقه ، والزفرات المتقطعة الهاربة من صدره ، أقول في نفسي : (( لعله إن أنا ناديته يسمعني فيتألم إذ لا مقدرة له على الجواب . )) ثم أقول لعله يبصرني . وأسمع في داخلي صوتاً يقول ــ بل هو يبصرك . فأرتاح هنيهةً إلى هذا الصوت ، وأهبط إلى كرسي بجانب السرير فأصغي طويلاً إلى غرغرة تلك النارجيلة الجهنَّمية في حلق أخي وإلى الزفرات التي تولدها فأهم أن أصيح به ــ ألا اتفلها من فمك . أَلا تقيَّأَها . ــ جاهلاً أنه ساعة يتفلها يتفل معها آخر أنحابه .
وبعد أن أَستسلم إلى القدر النافذ أمام عيني أغرق في بحر من التأمل هو ملجأي في كل شدة . وأشعر كأَن جبران يحدثني وكأَني أحدثه . وكم تحدثنا قبل ذلك بالصمت ! ــ فأطمئن بعض الاطمئنان لاعتقادي أنه شاعر بوجودي معه . عارف أنه ليس وحده ، وأن قلب صديق يشيعه في عبوره من هذا الشاطىءِ إلى ذاك .
***
أدير طرفي في الغرفة فأتناول كل ما فيها . عرضها ثلاثة أذرع . وطولها ستة . وعلوها أربعة . في جدارها المقابل الباب نافذة تطل على الشارع . وفي النافذة طاقة من الأزهار الذاوية . إلى جانب النافذة خزانة صغيرة للثياب وبجانبها طاولة صغيرة بيضاء عليها عقاقير وطلاسم طبية . ووراء الطاولة السرير . وعند رأس السرير معاون الطبيب بسترته البيضاء وقد أخذ بذراع المريض يجسُّ نبضها بين الفينة والفينة ويحقنها بمخدرات أو منبهات هو أدرى بها .
(( هل هو يشعر بألم يا حضرة المعاون ؟ ))
(( ولا بشيء . ))
(( كم تدوم هذه المعركة ؟ ))
(( لقد قاربت النهاية . ))
وينتهي حديثي مع المعاون . فأعود إلى حديثي مع جبران . ومع الموت . ومع نفسي . فأقول لجبران :
(( ما الذي تزودته يا أخي لرحلتك هذه ؟ )) يجيبني جبران :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن . ))
وأقول للموت :
(( ما أنت فاعل بأخي يا موت ؟ )) فيجيبني الموت :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن ))
وأقول لنفسي :
(( ماذا تبصرين يا نفسي وماذا تسمعين ؟ )) فتجيبني نفسي :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن ))
ويصعد قلبي إلى أذني فيقرعهما قرعاً عنيفاً وإذ أسأله عن قصده يجيبني (( غر ــ غر . . . )) فتدلهم آفاق فكري وتضيق . لكنها لا تلبث أن تتسع وتلتهب بوابل من شهب الذكريات وبلعلعة بروقٍ كثيرة من الخيالات الدفينة في أعماق الروح . وكلها لا ينقاد إلى نظام ، ولا يتقيد بزمان . فقد تشتعل الذكرى الواحدة وتنطفئ مرات متوالية ، حين أن أختاً لها لا تنير إلا مرَّة واحدة . وقد تلمع ذكرى قديمة قبل ذكرى حديثة . ويبرق خيال هرِم بنور سطع من نور خيال لما يزال فتياً . وعلى أنوار هذه الذكريات والخيالات تبدو لعيني حياة المحتضر أمامي صفحات مبعثرة . لكنها مخطوطة بقلم واحد ، ومدادٍ واحد ، ويدٍ واحدة . واليد التي خطتها تعرف أن ليس فيها صفحة زائدة أو حرف مهمل . ولأني أعرف ذلك أحاول أن أفهم الصلة بين هذا السطر وذاك ، وتلك الكلمة وهذه : وبين بشري ونيويورك . فم الميزاب ومستشفى القديس فنسنت . جبران خليل جبران والنسوة الواقفات خارجاً . وبين كل من عرفهم وعرفوه من رجال ونساء وأطفال . والذين قرأوا ويقرأون في هذه اللحظة مؤَلفاته ، أو تأملوا ويتأملون الآن رسومه . والذين أسعدهم بحياته وأشقاهم . أو أسعدوه وأشقوه . وبينه وبيني ــ لماذا تلاقينا وتآخينا في لحظة من الزمن لا في سواها ، وفي فسحةٍ من المكان لا في غيرها . ولماذا كُتب له أن يموت بين يديّ ، ولي أن أشيعه من هذه الديار ؟ فهل تراه يستقبلني في تلك ؟ أو تراه يدرك ما هو فيه الآن ؟ كم تحدثنا عن الموت فرأيناه ولادة أخرى . وكم دعوناه والحياة توأَمين . أتراه يقول الآن ما كان يقوله أمس ؟ وإن كان لا يفكر الآن لا بالأرض ولا بالسماء ولا بالموت ولا بالحياة ، فبماذا يفكر ؟ أم ترى غيبوبة الاحتضار أعمق من الفكر والحلم والخيال . فقد تكون انعتاقاً قصيراً من الحسّ بالوجود إلى الوجود الذي لا حسَّ فيه . أو تمهيداً إلى الانعتاق الأبدي من الوجود الأدنى للحظوة بالوجود الأسمى ــ باللاَّوجود .
لا أكاد أفلت بخيالي من عالم الحس حتى تجذبني حشرجة الموت إليه . فتتدفق عليّ من النافذة أمواج حياة المدينة ــ أصواتها المبلبلة ، شهواتها الملتهبة مطامعها المنسابة كالأفاعي ، أفراحها الظاعنة وأوجاعها المقيمة . وتنسكب كلها في مقطعين صغيرين : (( غر ــ غر . . . )) ثم تنفرج جدران الغرفة وتتراجع إلى وراء الأفق . ويتقلص سقفها كما لو كان سحابة من دخان . فأدخل بيوت النائمين ، ومعابد المصلين ، ومخازن المتاجرين . وأطلّ على مخادع الحاملات ، ومضاجع العرائس ، وأسرَّة المحتضرين ، وعروش الملوك ، وكهوف المتنسكين . وأمشي مع الأسرى والمعتقلين ، وأجلس مع القضاة والمجرمين . أطوف الأرض كلها وأصيخ إلى أصواتها . وأجوب الفضاء وما فيه من عوالم محسوسة فأعود منها كلها بنغمة واحدة ــ (( غر ــ غر . . . )) وتستقر هذه النغمة في أعماق كياني كأنها كانت هناك منذ الأزل : فأستغرب كيف لم أسمعها من قبل . ويخيل إليَّ أنّها نغمة الحياة المثلى ولغتها الوحيدة . وإنَّ كل ما تدور به النجوم ، وتلظى به الشموس ، وتتغنى به الأرض ، ويتلفظ به الناس معناه (( غر ــ غر . . . )) وإنّ الـ (( وَع ْ .. وَعْ )) التي يقذفها صدر الطفل عندما يَطلُّ على عالمنا هذه هي عين الـ (( غر .. غر )) التي تنسلّ من صدر المحتضر ــ عندما يشرفُ على عالم غير هذا العالم .
كم سمعت بها قبل أن أسمعها . أما منذ تلك الليلة ــ ليلة العاشر من نيسان (ابريل) سنة 1931 ــ فإني أكاد لا أسمع غيرها . أسمعها في دقَّات قلبي وفي أنفاسي . أسمعها في صوتي وفي كل صوت . أسمعها في همس النسائم وحفيف الاوراق . أسمعها في سكينة الليل وجلبة النهار .
ألا تباركتِ حياةً تلتقي الآزال والآباد في لحظةٍ منها . فيندمجُ النقيضُ بالنقيض ، وتستوي الأضداد كالأنداد . تباركتِ لأنك تهزأين بمقاييس البشر . وفي هزئك قساوة . وفي قساوتك عدل . فلا تخجلين من أن تجمعي بين العرض والجوهر ، بين الهزل والجد ، بين المتاجر والمقابر ، بين حشرجة الموت وقرقعة التلفون !
النهار الجمعة . والساعة نحو الخامسة والنصف . أنا أستعد للانصراف من محل أنحر فيه كل يوم ساعاتٍ بكارى من حياتي لعددٍ محدود من مومسات الريالات ، وقلما أسمع حديثاً إلا عن البيع والشراء ، عن الربح والخسارة ، عن سوق تصعد وسوق تهبط . يقرع جرس التلفون فيطلبونني إليه . أهو أحد الزبائن يرغب في بضاعة أو يشكو بضاعة أو يعتذر عن عدم مقدرته على دفع ما عليه ؟
(( هلو ... نعم . أنا هو . مرحباً . مرحباً ... ماذا تقول ؟ جبران في المستشفى ؟ ))
(( في مستشفى القديس فِنْسِنْتْ . وهو في غيبوبة . والطبيب لا يقدّر أنه يعيش حتى منتصف الليل . وليس حواليه أحد من رفاقه وخلانه . فرأيت من واجبي أن أخبرك لعلمي أنك أقرب الناس إليه ))
(( تاكسي ! مستشفى القديس فِنْسِنْتْ . ـــ أسرع أيها السائق ، أسرع . ))
وكيف لهذا المسكين أن يسرع في شوارع مكتظة بالبشرية المسرعة على أقدامها وعلى دواليبها ؟ وإلى أين يُسرع هؤُلاء الناس ؟ ــ كل إلى مستشفاه . ومستشفى الكلّ واحد .
ومن هو هذا القديس فنسنت وبماذا تقدَّس حتى يُقدَّس ؟ ليس بيني وبين مستشفاه غير ميل وأقل من ميل . لكنه أطول ما قطعته في حياتي من المسافات . جبران على فراش الموت . أ أَدركه حياً ؟ أسرع أيها السائق ، أسرع
(( أنا اليوم رجل صحيح يا ميشا )) هذه آخر كلمات سمعتها منه وقد خاطبته بالتلفون قبل ذاك بأيام مستفحصاً عن صحته . فتواعدنا أن نلتقي فنتعشى معاً في أحد المطاعم ونقضي السهرة عندي . وها أنا ذاهب لأتناول واياه العشاء على مائدة الموت في مطعم القديس فنسنت !
(( أنا اليوم رجل صحيح يا ميشا ــ أنا غريب في هذا العالم يا ميشا ــ أنا أحبّ هذا العالم يا ميشا )) ــ الصحة والعلة . والموت والحياة ، والوطن والغربة ــ أَلا مَنْ يريني ما بينها من الفروق ؟
أسرع أيها السائق . أسرع .
(( في أية غرفة خليل جبران ؟ )) ــ سؤال أوجهه إلى رجل جالس إلى مكتب قريب من الباب داخل المستشفى . فيندفع يفحص تحت حرف (( الجيم )) في قوائمه المنظمة كأنه يفتّش عن كلمة في قاموس غير مبالٍ أن صوت الرجل الذي يخاطبه يتهدج بصوت الموت .
(( ليس عندنا عليل بهذا الاسم يا سيدي . )) واذ اؤكد له أن عندهم عليلاً اسمه جبران يحيلني إلى رجل آخر عند مدخل للمستشفى من شارع آخر فأخرج من حيث دخلت وأسرع إلى المدخل الذي ردَّني إليه . وهناك أعرف أنّ جبران في غرفة كذا في الطبقة الثالثة من تلك البناية المتعددة الطبقات . فأصعد سلالم كثيرة . وأدور في منعرجات كثيرة . وأتفحَّص أبواباً كثيرة قبل أن أهتدي إلى الباب الذي أطلبه . ووراء كل باب اقترب منه جسد يتكوَّى بالأوجاع . وروح تحارب القدر . ربَّاه . ربَّاه . ربَّاه ! هوذا جانب من خليقتك التي تطلب جابراً لما تكسَّر من عظامها . وراتقاً لما تفتَّق من جلودها . وجامعاً لما تفتَّت من أكبادها . فلا تحصل إلا على عقاقير ثم عقاقير . فأين دواؤك ؟ أم هو الألم مصهر المحبة ــ محبتك التي لا توصف . وسبيل الخلاص ــ خلاصك الذي لا يثمَّن ؟
راهبات يمرون بي وأمر بهنَّ كأنهنَّ خيالات من عالم لا أعرفه . وفي سواد أثوابهنَّ ما يسوّد القلب . وممرضات يدخلن من باب ويخرجن من باب وفي بياض ألبستهن ما يجرح العين
(( أين الغرفة كذا يا أختاه ؟ ــ إلى اليمين ؟ أشكرك . ))
أمام باب الغرفة رجل تحيط به نسوة ثلاث . واذا اقترب تنفرد من الثلاث واحدة طويلة القامة ، عظميَّة الهيكل ، زعفرانية اللون ، حادَّة الأنف ، غارقة العينين . فتخطو نحوي مادَّة يمناها إليَّ . هي شاعرة أميركية في النصف الأول من عقدها السادس . عرفَتْ جبران منذ سبع سنوات فتقربت منه وكانت تساعده في نسخ مؤَلفاته . وقد التقيتها مرّة عنده . واذ أضع يدي في يدها تتنهد وتقول :
(( أشكر الله . أشكر الله لأنك ههنا . ))
في قلبي وفي عينيّ وعلى وجهي سؤَال واحد يتردد لساني في طرحه فتجيبني عليه هذه السيدة قبل أن تسمعه من فمي :
(( لم يبق من أمل . لم يبق من أمل ))
(( أخبريني ماذا جرى ))
(( كنت البارحة عنده فوجدته يعاني آلاماً لم يعانِ مثلها من قبل . دعونا الطبيب وسألناه اذا كان من ضرورة لنقله إلى المستَشفى في الحال . فأجاب أن لا بأس لو بات ليلته في بيته . ولم أشأ أن أتركه وحده فقضيت الليل عنده . وفي الصباح ــ صباح اليوم ــ الجمعة ــ اشتدّ عليه الوجع فجئنا به إلى هنا بين الساعة العاشرة والحادية عشرة ))
(( ولماذا لم تخبريني أمس . أو اليوم باكراً ؟ ))
(( أمس كنا نظن أنه عرض ويزول . واليوم عندما جئنا به إلى هنا كنتَ أول من خطر ببالي . غير أني أجهل رقم تلفونك . فبقيت أفكّر بواسطة أتوصل بها إليك إلى أن خطر لي ــ وكان ذلك إلهاماً ربَّانيَّاً ــ أن أتلفن إلى إدارة مجلة (( العالم السوري )) لتطلعك على الأمر . وهكذا كان والآن أشكر الله لأنك آتيت . ))
(( كيف هو الآن ؟ ))
(( غاب عن الوعي بعد الظهر بقليل لا يزال في غيبوبة . ))
(( هل عرض عليه أحد أن يعترف ويتناول ؟ ))
(( سألته الراهبة ــ هل أنت كاثوليكي ؟ فأجابها بنبرة قوية (( كلا ! )) فتركته وانصرفت . وبعد أن انتقل إلى حالة الغيبوبة جاءه كاهن سوري ــ هو رجل قصير لعلك تعرفه ــ وأخذ يناديه بأعلى صوته : جبران ــ جبران . جبران ! وجبران لا يعي . ولقد بلغ استيائي من ذلك الكاهن وخشونته حدّاً تمنيت معه لو كانت لي القوة الكافية لطرحه من النافذة . ))
(( هل فعل الكاهن شيئاً ؟ ))
(( هذا كل ما فعله . ))
(( وأين الطبيب ؟ ))
(( ها هو )) مشيرة إلى الرجل الواقف أمام الباب .
(( ما هي علته أيها الطبيب ؟ اليس من أمل ... بالطب ــ بالجراحة ؟ ))
(( سرطان في الكبد . لا أظنه يعيش حتى منتصف الليل . هو الآن في غيبوبة ولا أخاله يفيق منها . )) ــ كلمات تلفظ بها كأنه يحدث عن الطقس . ولا عجب فليست هذه أولى مقابلاته للموت . ترى أيقابل موته بالبرودة عينها التي يقابل بها موت سواه ؟
الطب . الطب . الطب ! إله العالم المتوجع ووجعه الأكبر .
(( أتسمح لي بالدخول على المريض أيها الطبيب ؟ ))
(( لا مانع على الإطلاق ))
***
غرْ ــ غرْ ... غرْ ــ غرْ ... عنْـ ـــ ـــ ـنْ . . .
صوت غريب يفاجئ أذني حالما أفتح الباب وأغلقه بهدوء ورهبة فأشعر عندما أجتاز عتبتهُ كأني قد اجتزت من عالم لا سر فيه إلى عالم كلّه أسرار ، وأنسى أنَّ هذا العالم في ذاك . وذاك في هذا . وأن لا أبواب بين الأثنين ولا عتبات سوى الأبواب والعتبات التي يقيمها جهلي وتبصره عيني الكليلة من خلال أغشية الحواس المحدودة .
أدنو من السرير الأبيض الصغير القائم خلف الباب فلا أبصر لأول وهلة معاون الطبيب الواقف عند رأسه ، اذ لتسمر عيناي بوجهٍ عرفتاه من زمان فأحبَّتاه ، والآن تكادان لا تعرفانه ، فقد كان بلون الرمل يسقيه دم الحياة . فأصبح رملاً يعلوه رماد المنيّة .
ها هو الأنف المستقيم الأرنبة ، الممتلئ المنخرين قد انتصب نحو السقف الباهت القاسي ، وليس فيه من الدم إلّا بقية ضئيلة تنهزم لحظةَ فلحظة من وجه عساكر الانحلال . فهو يكاد لا يتنفس كأنّ به زكاماً من أنفاس الأرض والسّماء . وكأَنّ الطبيب الأكبر ــ الموت ــ يداويه بنفحاتٍ من سماءٍ غير سمائنا ، وأرضٍ غير أرضنا .
ها هما العينان اللتان كانتا تبوحان بأسرارهما . فكم رأيت فيهما من بريق إلهام ومن حرقة شوق ومن نور بهجة . كم رأيتهما تغتسلان بالدمع . وتلتهبان بالضحك . وتتغلغلان في وجوه الناس والطبيعة لتستجليا معانيها . وأحياناً تذبلان وتذهلان عن كل ما حواليهما كأنّهما تتطلعان إلى ما وراء الستار أو تداعبان طيوف أفكار وعواطف لا تجول في أزقة الناس ومساكنهم ومعابدهم . والآن لست أرى فيهما لا رعشة ولا ومضة . فهما مطبقتان تحت حاجبيهما المقوّسين وقد أسدلتا أهدابهما الطويلة حتى الوجنتين فلا تبوحان بما أُغلقتا عليه من أسرار . وقد يكون خلف أجفانهما وميض بروق كثيرة . فمن يدري ما في غيبوبة الموت من ظلمات وأنوار ؟
ها هما الشفتان الحسَّاستان ، وقد كانتا بلون القرمز فأصبحتا بلون الرماد . كم انفرجتا من قبل عن بسمة ، وكم تكمشتا بألم . كم قبلتهما أمٌّ وأخت وحبيبة ، وكم من الشفاه تشتاقهما حتى الساعة ! وتلك الشفة العليا كم ارتجفت بغضب شديد أو بفرح قوي أو بحزن عميق . أما الآن فها هي قد التصقت بأختها السفلى في خط كأنه خاتم الحكمة الصامتة أو الحد الفاصل بين ما يمكن وبين ما لا يمكن التلفظ به . ولا تنفصل عن أختها إلَّا لتفتح الباب لأَنَّة هي أشبه بزفرة مذبوح منها بأنة مريض .
ها هي الجبهة العالية التي تقهقر عنها الشَّعر فزادها ارتفاعاً . وابيضّ عن جانبيها فزادها جمالاً . وجعَّدتها السنون تجاعيد لطيفةً فأكسبتها جلالاً . هي الجبهة التي كنت إذا نظرت إليها أكاد ألمس وأبصر ما خلفها من الأشباح والرسوم والمقاصد والمتاعب . أما الآن فهي أبعد من مجال بصري ولمسي .
ها هو الشعر الكستنائي ، وقد عبث المشط بنصفه ، وبيّض الشيب نصف ما تبقّى منه ، يغطي الآن جانباً من الوسادة وكأنّه ، بعد أن هربت منه الحياة ، خصل من صوف لا لمعان فيها ولا تجاذب .
(( بلى )) ــ تقول لي عيني ــ (( بلى . هذا هو رفيق أحلامك . وصديق أفكارك . وشقيق روحك . هذا جبران . وهو الآن يحتضر . فاعلم أنك في حضرة الموت .
(( جبران ! )) ــ يناديه قلبي وتناديه كل جوارحي . أما لساني فلا يتحرك وشفتاي لا تتفتحان . لأنني عندما أحدق في وجهه ، وقد أمسكت بعضلاته أصابع الألم القاسية . وعندما أسمع تلك الغرغرة الهائلة في حلقه ، والزفرات المتقطعة الهاربة من صدره ، أقول في نفسي : (( لعله إن أنا ناديته يسمعني فيتألم إذ لا مقدرة له على الجواب . )) ثم أقول لعله يبصرني . وأسمع في داخلي صوتاً يقول ــ بل هو يبصرك . فأرتاح هنيهةً إلى هذا الصوت ، وأهبط إلى كرسي بجانب السرير فأصغي طويلاً إلى غرغرة تلك النارجيلة الجهنَّمية في حلق أخي وإلى الزفرات التي تولدها فأهم أن أصيح به ــ ألا اتفلها من فمك . أَلا تقيَّأَها . ــ جاهلاً أنه ساعة يتفلها يتفل معها آخر أنحابه .
وبعد أن أَستسلم إلى القدر النافذ أمام عيني أغرق في بحر من التأمل هو ملجأي في كل شدة . وأشعر كأَن جبران يحدثني وكأَني أحدثه . وكم تحدثنا قبل ذلك بالصمت ! ــ فأطمئن بعض الاطمئنان لاعتقادي أنه شاعر بوجودي معه . عارف أنه ليس وحده ، وأن قلب صديق يشيعه في عبوره من هذا الشاطىءِ إلى ذاك .
***
أدير طرفي في الغرفة فأتناول كل ما فيها . عرضها ثلاثة أذرع . وطولها ستة . وعلوها أربعة . في جدارها المقابل الباب نافذة تطل على الشارع . وفي النافذة طاقة من الأزهار الذاوية . إلى جانب النافذة خزانة صغيرة للثياب وبجانبها طاولة صغيرة بيضاء عليها عقاقير وطلاسم طبية . ووراء الطاولة السرير . وعند رأس السرير معاون الطبيب بسترته البيضاء وقد أخذ بذراع المريض يجسُّ نبضها بين الفينة والفينة ويحقنها بمخدرات أو منبهات هو أدرى بها .
(( هل هو يشعر بألم يا حضرة المعاون ؟ ))
(( ولا بشيء . ))
(( كم تدوم هذه المعركة ؟ ))
(( لقد قاربت النهاية . ))
وينتهي حديثي مع المعاون . فأعود إلى حديثي مع جبران . ومع الموت . ومع نفسي . فأقول لجبران :
(( ما الذي تزودته يا أخي لرحلتك هذه ؟ )) يجيبني جبران :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن . ))
وأقول للموت :
(( ما أنت فاعل بأخي يا موت ؟ )) فيجيبني الموت :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن ))
وأقول لنفسي :
(( ماذا تبصرين يا نفسي وماذا تسمعين ؟ )) فتجيبني نفسي :
(( غر ــ غر . . . غر ــ غر . . . عنـ ـ ــ ـن ))
ويصعد قلبي إلى أذني فيقرعهما قرعاً عنيفاً وإذ أسأله عن قصده يجيبني (( غر ــ غر . . . )) فتدلهم آفاق فكري وتضيق . لكنها لا تلبث أن تتسع وتلتهب بوابل من شهب الذكريات وبلعلعة بروقٍ كثيرة من الخيالات الدفينة في أعماق الروح . وكلها لا ينقاد إلى نظام ، ولا يتقيد بزمان . فقد تشتعل الذكرى الواحدة وتنطفئ مرات متوالية ، حين أن أختاً لها لا تنير إلا مرَّة واحدة . وقد تلمع ذكرى قديمة قبل ذكرى حديثة . ويبرق خيال هرِم بنور سطع من نور خيال لما يزال فتياً . وعلى أنوار هذه الذكريات والخيالات تبدو لعيني حياة المحتضر أمامي صفحات مبعثرة . لكنها مخطوطة بقلم واحد ، ومدادٍ واحد ، ويدٍ واحدة . واليد التي خطتها تعرف أن ليس فيها صفحة زائدة أو حرف مهمل . ولأني أعرف ذلك أحاول أن أفهم الصلة بين هذا السطر وذاك ، وتلك الكلمة وهذه : وبين بشري ونيويورك . فم الميزاب ومستشفى القديس فنسنت . جبران خليل جبران والنسوة الواقفات خارجاً . وبين كل من عرفهم وعرفوه من رجال ونساء وأطفال . والذين قرأوا ويقرأون في هذه اللحظة مؤَلفاته ، أو تأملوا ويتأملون الآن رسومه . والذين أسعدهم بحياته وأشقاهم . أو أسعدوه وأشقوه . وبينه وبيني ــ لماذا تلاقينا وتآخينا في لحظة من الزمن لا في سواها ، وفي فسحةٍ من المكان لا في غيرها . ولماذا كُتب له أن يموت بين يديّ ، ولي أن أشيعه من هذه الديار ؟ فهل تراه يستقبلني في تلك ؟ أو تراه يدرك ما هو فيه الآن ؟ كم تحدثنا عن الموت فرأيناه ولادة أخرى . وكم دعوناه والحياة توأَمين . أتراه يقول الآن ما كان يقوله أمس ؟ وإن كان لا يفكر الآن لا بالأرض ولا بالسماء ولا بالموت ولا بالحياة ، فبماذا يفكر ؟ أم ترى غيبوبة الاحتضار أعمق من الفكر والحلم والخيال . فقد تكون انعتاقاً قصيراً من الحسّ بالوجود إلى الوجود الذي لا حسَّ فيه . أو تمهيداً إلى الانعتاق الأبدي من الوجود الأدنى للحظوة بالوجود الأسمى ــ باللاَّوجود .
لا أكاد أفلت بخيالي من عالم الحس حتى تجذبني حشرجة الموت إليه . فتتدفق عليّ من النافذة أمواج حياة المدينة ــ أصواتها المبلبلة ، شهواتها الملتهبة مطامعها المنسابة كالأفاعي ، أفراحها الظاعنة وأوجاعها المقيمة . وتنسكب كلها في مقطعين صغيرين : (( غر ــ غر . . . )) ثم تنفرج جدران الغرفة وتتراجع إلى وراء الأفق . ويتقلص سقفها كما لو كان سحابة من دخان . فأدخل بيوت النائمين ، ومعابد المصلين ، ومخازن المتاجرين . وأطلّ على مخادع الحاملات ، ومضاجع العرائس ، وأسرَّة المحتضرين ، وعروش الملوك ، وكهوف المتنسكين . وأمشي مع الأسرى والمعتقلين ، وأجلس مع القضاة والمجرمين . أطوف الأرض كلها وأصيخ إلى أصواتها . وأجوب الفضاء وما فيه من عوالم محسوسة فأعود منها كلها بنغمة واحدة ــ (( غر ــ غر . . . )) وتستقر هذه النغمة في أعماق كياني كأنها كانت هناك منذ الأزل : فأستغرب كيف لم أسمعها من قبل . ويخيل إليَّ أنّها نغمة الحياة المثلى ولغتها الوحيدة . وإنَّ كل ما تدور به النجوم ، وتلظى به الشموس ، وتتغنى به الأرض ، ويتلفظ به الناس معناه (( غر ــ غر . . . )) وإنّ الـ (( وَع ْ .. وَعْ )) التي يقذفها صدر الطفل عندما يَطلُّ على عالمنا هذه هي عين الـ (( غر .. غر )) التي تنسلّ من صدر المحتضر ــ عندما يشرفُ على عالم غير هذا العالم .