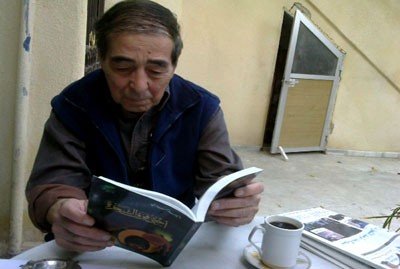ولدتُ في غرفة طينية
يضيئها قنديل معلق على ساموك خشبي.. وقرب موقد مشتعل، زاد في الإنارة التي تحتاجها (الداية)... وفي تلك الأيام كانت زوايا أزقة القرية تضاء ليلاً بالفوانيس التي وقودها من الكيروسين (زيت الكاز)، بعد المغرب بساعة، وتطفأ من قبل عامل، كان يعرف باسم «الدومري»، في العاشرة ليلاً.. ما عدا الليالي المقمرة في الصيف، حيث الإنارة الربّانية كانت تسهّل على الناس رؤية دروبهم...
ثم جاءت الكهرباء بنعمتها، ربما عام 1954، عبر جهود جمعية فلاحية تعاونية، لا علاقة لها بالدولة، فصار المحرّك الذي يعمل على (الديزل) يهدر، بعيد المغرب بقليل، ويمدنا بكهرباء الإنارة، ثم يُطفأ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وكان المستفيدون من نعمة الكهرباء، لا يدفعون ثمن فواتير، بل اشتراك شهري متساوٍ في القيمة، حيث لم تكن ثمة مراوح، ولا برادات، ولا غسالات، ولا مكيفات، ما كان موجوداً هو (لمبات) الإنارة التي ساعدت كثيراً من الطلاب على مضاعفة جهودهم الدراسية، ومن ثم التفوق بشكل ملحوظ على أبناء قرى القناديل والفوانيس!..
ولادتي الثانية تمت في مدينة دمشق، ولكن من دون معونة (داية)، حيث الكهرباء كانت تجري مثل جريان نهر بردى بفروعه السبعة دون انقطاع، أيام ذاك، وتلك كانت أعجوبة، واستمرت الأعجوبة منذ عهدي بالمدرسة الابتدائية، وحتى تخرجي في الجامعة أوائل الثلث الأخير من القرن المنصرم، ولا أدعي بأن الكهرباء (غير المقننة) هي سبب تخرجي، فقد تخرجت بدرجة (مقبول جداً) على الرغم من وجود الكهرباء!!.
الآن.. بعد هذا العمر المرسوم على إيقاع التوتر العالي، أضحت الكهرباء من الضروريات، ليس للإضاءة فحسب، بل لشؤون بيئية شخصية كثيرة، فالحاسوب هو أداة مهمة في مجريات عملي، فقد صار، بإمكاناته الهائلة، أداة الكتابة لدي، والتواصل مع العالم عبر الشابكة، وكذلك الرّاسل (أي الفاكس)، ناهيك عن خدمات كثيرة، دخلت في صلب الحياة الحديثة.
مسؤولو الانقطاعات الكهربائية يقولون إذا جاء الصيف إن ارتفاع نسبة الاستهلاك، زاد عن الحد المتوقع، ودرجات حرارة الطقس فاقت المتوقع، فإذا جاء الشتاء قالوا إن هبوط درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها، فراح الناس يلجؤون إلى التدفئة بالمشعات الكهربائية، ورأيي، أن كل ميزانيات الدول تترك هامشاً واسعاً للكوارث، أو للطوارئ.. خاصة في البنى التحتية إلا حكومتنا، فهي تتوسع في إشاعة الطيف الواسع لمشاريع الاستثمار، وتغفل عن الطيف الضيق للمواطن ذي الدخل المهدود.
وذات يوم، مضى وانقضى، ضاعفت وزارة الكهرباء تسعيرة (فواتيرها) المستحقة على المواطن المنتوف، ضمن عقد إذعان معروف، ولم تحسب حساب يوم تقصر فيه الكهرباء عن تلبية حاجات المواطن الملهوف. وحجتها أن مياه سد الفرات تدنت إلى مستوى لا يشغل إلا نصف عنفات توليد الكهرباء، وعلى عيني العنفات، وحزب العدالة والتنمية التركي، لكني أذكر أن مخترعاً سورياً، ابتدع مصيدة للرياح افترض أنها ستركب شرقي مدينة حمص، يمكن لها أن تولد عبر عنفاتها ما يزيد عن كهرباء السد، وقد أعطي المخترع براءة اختراع، ومكافأة خمسة آلاف ليرة، وصل إلى جيبه منها ألف ليرة (بعد الفلترة)، أما اختراعه فقد دفن في أضابير مملكة النسيان.
وأخشى أننا – نحن الذين اخترعنا ممالك الشمس – لانزال غارقين في ممالك الأحلام الجميلة.
يضيئها قنديل معلق على ساموك خشبي.. وقرب موقد مشتعل، زاد في الإنارة التي تحتاجها (الداية)... وفي تلك الأيام كانت زوايا أزقة القرية تضاء ليلاً بالفوانيس التي وقودها من الكيروسين (زيت الكاز)، بعد المغرب بساعة، وتطفأ من قبل عامل، كان يعرف باسم «الدومري»، في العاشرة ليلاً.. ما عدا الليالي المقمرة في الصيف، حيث الإنارة الربّانية كانت تسهّل على الناس رؤية دروبهم...
ثم جاءت الكهرباء بنعمتها، ربما عام 1954، عبر جهود جمعية فلاحية تعاونية، لا علاقة لها بالدولة، فصار المحرّك الذي يعمل على (الديزل) يهدر، بعيد المغرب بقليل، ويمدنا بكهرباء الإنارة، ثم يُطفأ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وكان المستفيدون من نعمة الكهرباء، لا يدفعون ثمن فواتير، بل اشتراك شهري متساوٍ في القيمة، حيث لم تكن ثمة مراوح، ولا برادات، ولا غسالات، ولا مكيفات، ما كان موجوداً هو (لمبات) الإنارة التي ساعدت كثيراً من الطلاب على مضاعفة جهودهم الدراسية، ومن ثم التفوق بشكل ملحوظ على أبناء قرى القناديل والفوانيس!..
ولادتي الثانية تمت في مدينة دمشق، ولكن من دون معونة (داية)، حيث الكهرباء كانت تجري مثل جريان نهر بردى بفروعه السبعة دون انقطاع، أيام ذاك، وتلك كانت أعجوبة، واستمرت الأعجوبة منذ عهدي بالمدرسة الابتدائية، وحتى تخرجي في الجامعة أوائل الثلث الأخير من القرن المنصرم، ولا أدعي بأن الكهرباء (غير المقننة) هي سبب تخرجي، فقد تخرجت بدرجة (مقبول جداً) على الرغم من وجود الكهرباء!!.
الآن.. بعد هذا العمر المرسوم على إيقاع التوتر العالي، أضحت الكهرباء من الضروريات، ليس للإضاءة فحسب، بل لشؤون بيئية شخصية كثيرة، فالحاسوب هو أداة مهمة في مجريات عملي، فقد صار، بإمكاناته الهائلة، أداة الكتابة لدي، والتواصل مع العالم عبر الشابكة، وكذلك الرّاسل (أي الفاكس)، ناهيك عن خدمات كثيرة، دخلت في صلب الحياة الحديثة.
مسؤولو الانقطاعات الكهربائية يقولون إذا جاء الصيف إن ارتفاع نسبة الاستهلاك، زاد عن الحد المتوقع، ودرجات حرارة الطقس فاقت المتوقع، فإذا جاء الشتاء قالوا إن هبوط درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها، فراح الناس يلجؤون إلى التدفئة بالمشعات الكهربائية، ورأيي، أن كل ميزانيات الدول تترك هامشاً واسعاً للكوارث، أو للطوارئ.. خاصة في البنى التحتية إلا حكومتنا، فهي تتوسع في إشاعة الطيف الواسع لمشاريع الاستثمار، وتغفل عن الطيف الضيق للمواطن ذي الدخل المهدود.
وذات يوم، مضى وانقضى، ضاعفت وزارة الكهرباء تسعيرة (فواتيرها) المستحقة على المواطن المنتوف، ضمن عقد إذعان معروف، ولم تحسب حساب يوم تقصر فيه الكهرباء عن تلبية حاجات المواطن الملهوف. وحجتها أن مياه سد الفرات تدنت إلى مستوى لا يشغل إلا نصف عنفات توليد الكهرباء، وعلى عيني العنفات، وحزب العدالة والتنمية التركي، لكني أذكر أن مخترعاً سورياً، ابتدع مصيدة للرياح افترض أنها ستركب شرقي مدينة حمص، يمكن لها أن تولد عبر عنفاتها ما يزيد عن كهرباء السد، وقد أعطي المخترع براءة اختراع، ومكافأة خمسة آلاف ليرة، وصل إلى جيبه منها ألف ليرة (بعد الفلترة)، أما اختراعه فقد دفن في أضابير مملكة النسيان.
وأخشى أننا – نحن الذين اخترعنا ممالك الشمس – لانزال غارقين في ممالك الأحلام الجميلة.