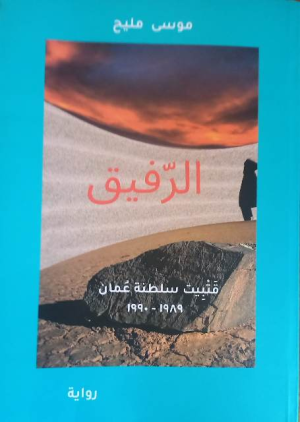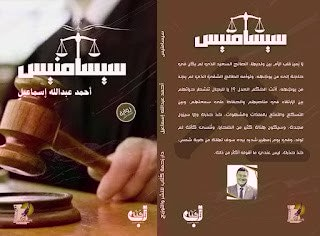لا يبدأ الشعر من فراغ، ولا يقوم على خلاء، ولا يمضي إلى العدم. إنما الشعر عالم له جغرافيته وتاريخه، مثلما له ماضيه وحاضره ومستقبله، وإنما يقوم دور الشاعر على العيش في تلك المساحات للشعر، يوما أو بعض يوم، وأن ينقلنا معه لنحيا لحظاته تلك في ذلك العالم الثري والمثير. فهل فعل الشاعر مؤمن سمير ذلك في كتابه (أَبْعَدُ بَلَدٍ في الخيال)؟
ها هو مثل مهندس معماري حينا، وخبير عقارات حينا آخر، يؤسس بيتا، ويمضي بنا بين غرفه يلقي عباراته الشاعرة والسردية بصوت عال، لنتأمل حياته ما بين الليل والنهار، وفي المسافة التي يقطعها بين واقع وخيال، وينهض فيها من سرير ليجلس بشرفة، يتأمل مدينة عارية حاملا مصباح الحكمة:
في جَيْبي دائماً مصباحٌ صغير
لطيفٌ وبرئ
لا يصحو إلا في الليل..
أخرجُ و أدندنُ بمقطعٍ مُجَرَّب
وأسلطُ الضوء القاسي
فأرى المدينةَ عاريةً..
كلَ صباحٍ
كلَ صباحْ
في هذه المدينة، يمضي الراوية، شاعرنا مؤمن سمير، ليتأمل ساكنيها، ولا يكتفي بعراء المدينة، وإنما يعري هؤلاء القاطنين واحدًا تلو الآخر، يقرأ سرائرهم، ويروي مصائرهم، وكأنه زيوس يباركهم مرة ويحاكمهم مرات.
تلك الصياغة الملحمية في (أَبْعَدُ بَلَدٍ في الخيال) تسمح بتوالد الحكايات، كما لوكنا نسمع لشهرزاد وهي تصنع أبوابا تنفذ منها حكاية بعد أخرى، مثلما تسمح – الصياغة – بإقامة مسرح يوناني على أطراف تلك البلدة الخيالية، ليقف عليه الأشخاص والجوقة يرددون مرثيات ويتلون ترانيم مقدسة. هذا (الشكل) الذي اختاره مؤمن سمير ليوزع على هيئاته النصوص يسمح بذلك التزاوج الآسر، وكأننا على ساحة مسرحية عملاقة تدور أمام القارئ، بمشاهد حية لتلك المدينة الخيالية وشخوصها المزيج بين سيرة حياة وسيرة قراءة.
عليك أن تتأمل كيف يقطر لك أسطورة جديدة، وفق طقوس شعرية: “حَكَّ الطيبُ رأسهُ وأغمض عينيهِ واستعادَ بهاء علاقته بالسماء– حبيبة الطيبين– وقال سأبتكر لأسمو.. هاتوا سبعاً من لترات ماء الندى ثم ضعوا عليه من أكياس الملح سبعاً ولتشرب العيون التي تتحرك وتسمونها إنساناً.. ضَعوا القدور على سطوحنا وسطوح الشارع كله وحَمِّلوا الماء المعكَّر بالطين الصادق والحشرات البريئة وحطُّوها بفخرٍ وسط مظاهرة الجيران في القلب، قلب الغرفة والذكريات القادمة.. تجمَّعوا وشالوني وسندتني أمي من اليمين وخالي من اليسار والأقدار من الأمام كي لا أقع في اليم وبدؤوا يسقونني وأتقيأ و يملؤونني برقةٍ في البداية ثم بعنفٍ وفروغ صبر، وأتقيأ وأتقيأ حتى فقدتُ الإحساس بالألم والأصوات….”
هذا المقطع وله أكثر من مثيل، يأخذنا إلى مدن الشعر، التي يؤسسها الخيال، فتعيد أسطرة الواقع. إنها كالوحي، قبس من التاريخين الفردي والجمعي، وهكذا هي هيئة مدن الخيال الشعرية.
تغري هذه الفضاءات بصك الشاعر لعبارات تشبه الشعارات التي يعلقها الحكام على الأعمدة في ممالكهم. إنها كالإشهارات الإعلانية التي تومض بمصابيح النيون، ويمكن أن ننزعها من سياقها لتصبح حكمة اليوم، أو أنها اللزوميات المرتبطة بتلك المدينة الشعرية وصاحبها:
كل ظُلْمَةٍ تدعو الآلهةَ كي تَنْبُتَ الأجنحةُ
بابُ المَسَرَّاتِ أخشابُهُ مرتعٌ للظِلالِ والبَصَماتِ الهاربةِ
الموت هو أوضح وأقسى جبل تقف أمامه
الريحُ صارت تكفيها الأسرارُ
.. حتى أن أجمل ما في الألم وأنقى ما في الخوف أن الضعفَ يفتح شُبَّاكَاً للشَرِّ الطائرِ والكُرْهِ العظيم..
لا أعرف كيف ورد إلى الخاطر صورة الشاعر المسجى فوق سرير الاحتضار، يروي وصاياه، ولا يمنع نفسه من كتابة حوارياته مع الملائكة والشياطين، بينما السرير بعجلاته الملتهبة يدور في تلك المدينة التي بناها الشعر، أو (أَبْعَدُ بَلَدٍ في الخيال)، ولنرى كيف شيدها مؤمن سميرـ ولنقرأ نصوصا يكتبها الشاعر تحت عنوان “طائرة ورقية تتنفس تحتَ الرمل”:
سِلالٌ فارغةٌ
أجلسُ، أُشبِّكُ ذراعيَّ و رأسي مستقيمٌ كأنَّهُ تأهُّبُ السهمِ، أُغني وأضحك ثم أعاتبني وأهنئُ نفسي وأَشُقُّ ظِلِّي وأرتعدُ وألهثُ و أمصمصُ خلايا أبي وأنسجتَهُ المتيبسة وأزأرُ وترقصُ الأرضُ وأدورُ وأقعِي وأحملها من تحت الخِصْرِ وألقيها في النهرِ، أهبطُ أهبطُ حتى يصطادني القاعُ، أُقبِّلها وأصطادُ الوردَ من سَلَّةِ الأميرةِ وأسرقُ مقشة الساحرةِ وألتصق بدخان السقفِ، أنحني بعد تصفيق الجمهور وأستمع لهمس الطينِ وأقفزُ بين خرومِ الظَهرِ، أغافلهم وأُفلِتُ مساميرَ النعشِ وأطاردُ قصبتَهُ الهوائيةَ وأشيلُ الصوفَ من الرئتينِ ومن جملته الطويلةِ وأنسكِبُ مع لونِ العَرَق وأشيلُ الكلامَ الساخنَ في الدُّرْجِ، أُجهِّزُ صفيحتينِ لماء المَطَرَةِ، أُحيطُ المستنقعَ بكل النخلِ وأغُشُّ في ميزانِ الجَدِّ وأُربِّي جَناحينِ تحت المقاعدِ وأقصُّ الذَيْلَ وأشتكي من اعوجاجِ الصَفِّ بعد النداء الأخيرِ وأنتقم من الطفلِ وأنظرُ لآخرِ الصحراءِ.. قبل شهقتِها المخفيةِ بالضبطْ..
أقبعُ وحدي
ذراعيَّ يَقصُرانِ
و رأسي يميلُ قليلاً..
أنقاض
كلُّ يومٍ يتضاءَلُ حجمي ويقِلُّ ضجيجُ جثماني، البنتُ وقفت فجأةً ونظرت في عيني ولم تهمس إلا بعد شهقةٍ من ذراعها وصرخةٍ من ساقها وركضٍ في الكبدِ، قالت لم تكن أنتَ أنتَ ساعةَ الطيرانِ ولم تَحْبِك المؤامرةَ بامتيازٍ.. عاديٌّ كعادتكَ ولا تلفت النظرَ وقد تمرّ عليكَ العاصفةُ فلا يتدغدغُ يقينُكَ، أَوْجعتَ سماءنا وقد ظننا بكَ القدرةَ على فَتْلِ الحروف الهربانةِ وتطريزها لنتسلى.. نَشَّفتَ أنهارنا يا أخي.. أنا واللهِ لم أحزن من قلبي لكنَّ حجمي هو الذي غافَلني وسقطَ على السلالم.. وصورتي في المرآة اختَنَقَت على يسار الظِلِّ قليلاً وأمي قالت لنفسها سقطَ في الهُوَّةِ يومَ ماتَ الأبُ ثم قامَ وركَلَ ابتسامتهُ في الوجوهِ.. أنا هنا يا أمُّ، سمعتُكِ رغماً عني وغافلتُ السِكَّةَ الملساءَ وفكرتُ في تلكَ الأحداق
لمَّا تطيرُ.. أنا هنا فسامحيني
ظننتُ باب المقبرةِ المفتوحِ، بسمة عابرة..
فتحةٌ متواريةٌ في شُبَّاك الصباح
متأرجِحٌ بين رغبتي في الهروبِ وبين تأهبي لاجتياح الذكرى وكسرِ أنفها..
..كان العابرُ قد أخرجَ من خزانتهِ خمراً معتقاً وأنا الحَذِرُ غرقتُ وأحببتُ صدرَ العابرةِ وخرجتُ من العين الكبيرةِ، الثابتة رغم اهتزازِ اليقين..
أمامنا دهرٌ كاملٌ، بشرفاتهِ وحُفَرِهِ وأنهارِهِ، للاقتراحات والاقتراعِ على من يحبهُ الموتُ أكثر..
سنفرحُ ونحتفلُ، وسنقدمُ نَخْباً و آخر..
أيتها الروحُ التي تشبهُ جَدِّي، صدقتِ
: حيَّةٌ تسعى، ثُمالتنا في الأحلامِ..
أمَّا لحمي
أمَّا عَظْمي..
فلن يراهُ القَنَّاصُ إذن
إلا تحتَكِ أنتِ..
شلالُ غابَاتٍ ونبيذ
كانَ راقداً، بحَذرِ المذعورِ من بريقِ الشَرَكِ، تارةً يَشُدُّ ألواناً تملأُ اطمئنانهُ، وتارةً يقبضُ على ضحكِ الجاراتِ ويبني سماواتٍ في عَظمِ طفلْ.. وهكذا حتى ارتعشَ قربَ الحافةِ وصَرَّ على أسنانهِ وقالَ أنا بردان، أحتاجُ لِضمَّةٍ عنيفةٍ من جدارٍ طيبٍ، يحنو على قلبي البعيدِ..
مَنْ يكشفُ الروعةَ لي
مَنْ يَذوقُ المراوغةَ تحتَ حليبها..
مَنْ يُكافِئُ ندهةً
على اقتناصِ القسوةِ في لقطةِ الرقصِ
مَنْ يحشو العَظمَ بي..
..
لطالما أَوْقَدتُ نارًا
لرشقةِ عطرٍ تسرحُ بينها و بيني
لطالما استقرَّ اللسانُ
في حبلِها..
بماذا أردُّ إذا سَاءَلَتني المفاصل الليِّنةُ
عن التحليقِ في ليالي الأعيادِ
عن قوسِ النصرِ..
عن رهنها لمرايا أمي ومجاملاتِ الربِّ..
عن سيارةٍ تحملُ جثَّةً غامضةً كانت تودُّ الصراخَ أولاً..
مَنْ لي بشظيةٍ تَصُرُّها السيدةُ في حقيبتها
وتحاصِرُ بها شلالَ الغاباتِ
مَنْ لي بشبيهٍ فأرتاحُ مني..
وأداعِبُ نَهَمي الذي يعوي هنا في النبيذِ
كأنني أحبو في التئامِ النَفَقِ،
فيركبَ الصوتُ السقفَ، ويحفرُ الخنادقَ
وتزحفُ ذؤاباتُهُ على شَمَّاعة الأسلافِ،
فلا نَشُمَّ وَتَرًا يُرَجِّحُ ذاكَ اللهاث..
ارتميْتُ،
في العمودِ الفقريِّ على جذوةٍ
و يمينها كثبانٌ وحراشِفُ و ابتساماتٌ
والطحالبُ تفتحُ كوةً للتنفسِ
فينهمِر اللهُ
ويسيب مخلباً في الذيْلِ النائمِ خلفَ
النبضِ..
مسافراً،
وكنتُ جَوَّالاً على صُدْفَةٍ..
فإذا بذراعي يصفو
و يَدُقُّ في روعةِ النبعِ رعدةً
و حيواناً ضالاً
و شجرةً
عمياء من غيرِ سوء..
إعلانٌ و نداء
بعدما ارتحتُ نهائيَّاً لفكرةِ أنني أُشبِهُ صَبَّارةً، كنتُ أحتاجُ السيجارةَ فعلاً، لتتواطَأ معي في بعث الدهشةِ والغيظِ والمحبةِ والقتلِ وفرشهم هنا على السريرِ، ثم قفل بوابة الكابوس عليهم.. إلا أنني لكوني جبانٌ طبعاً، صدَّقتُ الذُبابات التي حاصَرَت أذني وكانت في الفضاء كأنها شراييني التي تكرهني وتودُّ تجربة التحليق لعندِ الصامت المبتسمِ هناكَ.. وهكذا فارقتني السيجارةُ لأني لم أحمها ولم أنادي عليها بقلبٍ خاشعٍ.. أغني لها في الصباح وأغمز لها على شفاهِ الآخرينَ وأبحث في صندوقي الصغير علها تكون سابت رسالةً وأنا أرفرفُ بعيداً..
سنواتٌ مرت.. وأنا أتذكرها فأسعل..
.. كأنني نظرةُ أمي
للحنين الذي يفرُّ
من النوافذ..
نعودُ لنحكي
* في قلبِ البوحِ، كنتُ أدعو أن يَحُطَّ طائرُ الخَرَسِ أو تصلَ السِّكِّينُ التي تَلُفُّ حول أجزاءِ جسمي والقطراتُ تسقطُ وتسقطُ حتى تموتَ الملامحُ أو تعدوَ بعيداً..
لكننا نعودُ لنحكي: لولاهُ لكانت الساعةُ المشؤومةُ..
لولاهُ لَكُنَّا نُشبِهُنا من ناحيةِ الخوف..
..و الآن، نأخذُ نَفَسًا طويلاً، كي نزيحَ الصورةَ
إلى الخلفِ..
أو تحتَ الوسادةِ..
أو في مخبأٍ،
فوقهُ دخان..
*موقع The AsiaN السبت 5 فبراير 2022*
ها هو مثل مهندس معماري حينا، وخبير عقارات حينا آخر، يؤسس بيتا، ويمضي بنا بين غرفه يلقي عباراته الشاعرة والسردية بصوت عال، لنتأمل حياته ما بين الليل والنهار، وفي المسافة التي يقطعها بين واقع وخيال، وينهض فيها من سرير ليجلس بشرفة، يتأمل مدينة عارية حاملا مصباح الحكمة:
في جَيْبي دائماً مصباحٌ صغير
لطيفٌ وبرئ
لا يصحو إلا في الليل..
أخرجُ و أدندنُ بمقطعٍ مُجَرَّب
وأسلطُ الضوء القاسي
فأرى المدينةَ عاريةً..
كلَ صباحٍ
كلَ صباحْ
في هذه المدينة، يمضي الراوية، شاعرنا مؤمن سمير، ليتأمل ساكنيها، ولا يكتفي بعراء المدينة، وإنما يعري هؤلاء القاطنين واحدًا تلو الآخر، يقرأ سرائرهم، ويروي مصائرهم، وكأنه زيوس يباركهم مرة ويحاكمهم مرات.
تلك الصياغة الملحمية في (أَبْعَدُ بَلَدٍ في الخيال) تسمح بتوالد الحكايات، كما لوكنا نسمع لشهرزاد وهي تصنع أبوابا تنفذ منها حكاية بعد أخرى، مثلما تسمح – الصياغة – بإقامة مسرح يوناني على أطراف تلك البلدة الخيالية، ليقف عليه الأشخاص والجوقة يرددون مرثيات ويتلون ترانيم مقدسة. هذا (الشكل) الذي اختاره مؤمن سمير ليوزع على هيئاته النصوص يسمح بذلك التزاوج الآسر، وكأننا على ساحة مسرحية عملاقة تدور أمام القارئ، بمشاهد حية لتلك المدينة الخيالية وشخوصها المزيج بين سيرة حياة وسيرة قراءة.
عليك أن تتأمل كيف يقطر لك أسطورة جديدة، وفق طقوس شعرية: “حَكَّ الطيبُ رأسهُ وأغمض عينيهِ واستعادَ بهاء علاقته بالسماء– حبيبة الطيبين– وقال سأبتكر لأسمو.. هاتوا سبعاً من لترات ماء الندى ثم ضعوا عليه من أكياس الملح سبعاً ولتشرب العيون التي تتحرك وتسمونها إنساناً.. ضَعوا القدور على سطوحنا وسطوح الشارع كله وحَمِّلوا الماء المعكَّر بالطين الصادق والحشرات البريئة وحطُّوها بفخرٍ وسط مظاهرة الجيران في القلب، قلب الغرفة والذكريات القادمة.. تجمَّعوا وشالوني وسندتني أمي من اليمين وخالي من اليسار والأقدار من الأمام كي لا أقع في اليم وبدؤوا يسقونني وأتقيأ و يملؤونني برقةٍ في البداية ثم بعنفٍ وفروغ صبر، وأتقيأ وأتقيأ حتى فقدتُ الإحساس بالألم والأصوات….”
هذا المقطع وله أكثر من مثيل، يأخذنا إلى مدن الشعر، التي يؤسسها الخيال، فتعيد أسطرة الواقع. إنها كالوحي، قبس من التاريخين الفردي والجمعي، وهكذا هي هيئة مدن الخيال الشعرية.
تغري هذه الفضاءات بصك الشاعر لعبارات تشبه الشعارات التي يعلقها الحكام على الأعمدة في ممالكهم. إنها كالإشهارات الإعلانية التي تومض بمصابيح النيون، ويمكن أن ننزعها من سياقها لتصبح حكمة اليوم، أو أنها اللزوميات المرتبطة بتلك المدينة الشعرية وصاحبها:
كل ظُلْمَةٍ تدعو الآلهةَ كي تَنْبُتَ الأجنحةُ
بابُ المَسَرَّاتِ أخشابُهُ مرتعٌ للظِلالِ والبَصَماتِ الهاربةِ
الموت هو أوضح وأقسى جبل تقف أمامه
الريحُ صارت تكفيها الأسرارُ
.. حتى أن أجمل ما في الألم وأنقى ما في الخوف أن الضعفَ يفتح شُبَّاكَاً للشَرِّ الطائرِ والكُرْهِ العظيم..
لا أعرف كيف ورد إلى الخاطر صورة الشاعر المسجى فوق سرير الاحتضار، يروي وصاياه، ولا يمنع نفسه من كتابة حوارياته مع الملائكة والشياطين، بينما السرير بعجلاته الملتهبة يدور في تلك المدينة التي بناها الشعر، أو (أَبْعَدُ بَلَدٍ في الخيال)، ولنرى كيف شيدها مؤمن سميرـ ولنقرأ نصوصا يكتبها الشاعر تحت عنوان “طائرة ورقية تتنفس تحتَ الرمل”:
سِلالٌ فارغةٌ
أجلسُ، أُشبِّكُ ذراعيَّ و رأسي مستقيمٌ كأنَّهُ تأهُّبُ السهمِ، أُغني وأضحك ثم أعاتبني وأهنئُ نفسي وأَشُقُّ ظِلِّي وأرتعدُ وألهثُ و أمصمصُ خلايا أبي وأنسجتَهُ المتيبسة وأزأرُ وترقصُ الأرضُ وأدورُ وأقعِي وأحملها من تحت الخِصْرِ وألقيها في النهرِ، أهبطُ أهبطُ حتى يصطادني القاعُ، أُقبِّلها وأصطادُ الوردَ من سَلَّةِ الأميرةِ وأسرقُ مقشة الساحرةِ وألتصق بدخان السقفِ، أنحني بعد تصفيق الجمهور وأستمع لهمس الطينِ وأقفزُ بين خرومِ الظَهرِ، أغافلهم وأُفلِتُ مساميرَ النعشِ وأطاردُ قصبتَهُ الهوائيةَ وأشيلُ الصوفَ من الرئتينِ ومن جملته الطويلةِ وأنسكِبُ مع لونِ العَرَق وأشيلُ الكلامَ الساخنَ في الدُّرْجِ، أُجهِّزُ صفيحتينِ لماء المَطَرَةِ، أُحيطُ المستنقعَ بكل النخلِ وأغُشُّ في ميزانِ الجَدِّ وأُربِّي جَناحينِ تحت المقاعدِ وأقصُّ الذَيْلَ وأشتكي من اعوجاجِ الصَفِّ بعد النداء الأخيرِ وأنتقم من الطفلِ وأنظرُ لآخرِ الصحراءِ.. قبل شهقتِها المخفيةِ بالضبطْ..
أقبعُ وحدي
ذراعيَّ يَقصُرانِ
و رأسي يميلُ قليلاً..
أنقاض
كلُّ يومٍ يتضاءَلُ حجمي ويقِلُّ ضجيجُ جثماني، البنتُ وقفت فجأةً ونظرت في عيني ولم تهمس إلا بعد شهقةٍ من ذراعها وصرخةٍ من ساقها وركضٍ في الكبدِ، قالت لم تكن أنتَ أنتَ ساعةَ الطيرانِ ولم تَحْبِك المؤامرةَ بامتيازٍ.. عاديٌّ كعادتكَ ولا تلفت النظرَ وقد تمرّ عليكَ العاصفةُ فلا يتدغدغُ يقينُكَ، أَوْجعتَ سماءنا وقد ظننا بكَ القدرةَ على فَتْلِ الحروف الهربانةِ وتطريزها لنتسلى.. نَشَّفتَ أنهارنا يا أخي.. أنا واللهِ لم أحزن من قلبي لكنَّ حجمي هو الذي غافَلني وسقطَ على السلالم.. وصورتي في المرآة اختَنَقَت على يسار الظِلِّ قليلاً وأمي قالت لنفسها سقطَ في الهُوَّةِ يومَ ماتَ الأبُ ثم قامَ وركَلَ ابتسامتهُ في الوجوهِ.. أنا هنا يا أمُّ، سمعتُكِ رغماً عني وغافلتُ السِكَّةَ الملساءَ وفكرتُ في تلكَ الأحداق
لمَّا تطيرُ.. أنا هنا فسامحيني
ظننتُ باب المقبرةِ المفتوحِ، بسمة عابرة..
فتحةٌ متواريةٌ في شُبَّاك الصباح
متأرجِحٌ بين رغبتي في الهروبِ وبين تأهبي لاجتياح الذكرى وكسرِ أنفها..
..كان العابرُ قد أخرجَ من خزانتهِ خمراً معتقاً وأنا الحَذِرُ غرقتُ وأحببتُ صدرَ العابرةِ وخرجتُ من العين الكبيرةِ، الثابتة رغم اهتزازِ اليقين..
أمامنا دهرٌ كاملٌ، بشرفاتهِ وحُفَرِهِ وأنهارِهِ، للاقتراحات والاقتراعِ على من يحبهُ الموتُ أكثر..
سنفرحُ ونحتفلُ، وسنقدمُ نَخْباً و آخر..
أيتها الروحُ التي تشبهُ جَدِّي، صدقتِ
: حيَّةٌ تسعى، ثُمالتنا في الأحلامِ..
أمَّا لحمي
أمَّا عَظْمي..
فلن يراهُ القَنَّاصُ إذن
إلا تحتَكِ أنتِ..
شلالُ غابَاتٍ ونبيذ
كانَ راقداً، بحَذرِ المذعورِ من بريقِ الشَرَكِ، تارةً يَشُدُّ ألواناً تملأُ اطمئنانهُ، وتارةً يقبضُ على ضحكِ الجاراتِ ويبني سماواتٍ في عَظمِ طفلْ.. وهكذا حتى ارتعشَ قربَ الحافةِ وصَرَّ على أسنانهِ وقالَ أنا بردان، أحتاجُ لِضمَّةٍ عنيفةٍ من جدارٍ طيبٍ، يحنو على قلبي البعيدِ..
مَنْ يكشفُ الروعةَ لي
مَنْ يَذوقُ المراوغةَ تحتَ حليبها..
مَنْ يُكافِئُ ندهةً
على اقتناصِ القسوةِ في لقطةِ الرقصِ
مَنْ يحشو العَظمَ بي..
..
لطالما أَوْقَدتُ نارًا
لرشقةِ عطرٍ تسرحُ بينها و بيني
لطالما استقرَّ اللسانُ
في حبلِها..
بماذا أردُّ إذا سَاءَلَتني المفاصل الليِّنةُ
عن التحليقِ في ليالي الأعيادِ
عن قوسِ النصرِ..
عن رهنها لمرايا أمي ومجاملاتِ الربِّ..
عن سيارةٍ تحملُ جثَّةً غامضةً كانت تودُّ الصراخَ أولاً..
مَنْ لي بشظيةٍ تَصُرُّها السيدةُ في حقيبتها
وتحاصِرُ بها شلالَ الغاباتِ
مَنْ لي بشبيهٍ فأرتاحُ مني..
وأداعِبُ نَهَمي الذي يعوي هنا في النبيذِ
كأنني أحبو في التئامِ النَفَقِ،
فيركبَ الصوتُ السقفَ، ويحفرُ الخنادقَ
وتزحفُ ذؤاباتُهُ على شَمَّاعة الأسلافِ،
فلا نَشُمَّ وَتَرًا يُرَجِّحُ ذاكَ اللهاث..
ارتميْتُ،
في العمودِ الفقريِّ على جذوةٍ
و يمينها كثبانٌ وحراشِفُ و ابتساماتٌ
والطحالبُ تفتحُ كوةً للتنفسِ
فينهمِر اللهُ
ويسيب مخلباً في الذيْلِ النائمِ خلفَ
النبضِ..
مسافراً،
وكنتُ جَوَّالاً على صُدْفَةٍ..
فإذا بذراعي يصفو
و يَدُقُّ في روعةِ النبعِ رعدةً
و حيواناً ضالاً
و شجرةً
عمياء من غيرِ سوء..
إعلانٌ و نداء
بعدما ارتحتُ نهائيَّاً لفكرةِ أنني أُشبِهُ صَبَّارةً، كنتُ أحتاجُ السيجارةَ فعلاً، لتتواطَأ معي في بعث الدهشةِ والغيظِ والمحبةِ والقتلِ وفرشهم هنا على السريرِ، ثم قفل بوابة الكابوس عليهم.. إلا أنني لكوني جبانٌ طبعاً، صدَّقتُ الذُبابات التي حاصَرَت أذني وكانت في الفضاء كأنها شراييني التي تكرهني وتودُّ تجربة التحليق لعندِ الصامت المبتسمِ هناكَ.. وهكذا فارقتني السيجارةُ لأني لم أحمها ولم أنادي عليها بقلبٍ خاشعٍ.. أغني لها في الصباح وأغمز لها على شفاهِ الآخرينَ وأبحث في صندوقي الصغير علها تكون سابت رسالةً وأنا أرفرفُ بعيداً..
سنواتٌ مرت.. وأنا أتذكرها فأسعل..
.. كأنني نظرةُ أمي
للحنين الذي يفرُّ
من النوافذ..
نعودُ لنحكي
* في قلبِ البوحِ، كنتُ أدعو أن يَحُطَّ طائرُ الخَرَسِ أو تصلَ السِّكِّينُ التي تَلُفُّ حول أجزاءِ جسمي والقطراتُ تسقطُ وتسقطُ حتى تموتَ الملامحُ أو تعدوَ بعيداً..
لكننا نعودُ لنحكي: لولاهُ لكانت الساعةُ المشؤومةُ..
لولاهُ لَكُنَّا نُشبِهُنا من ناحيةِ الخوف..
..و الآن، نأخذُ نَفَسًا طويلاً، كي نزيحَ الصورةَ
إلى الخلفِ..
أو تحتَ الوسادةِ..
أو في مخبأٍ،
فوقهُ دخان..
*موقع The AsiaN السبت 5 فبراير 2022*