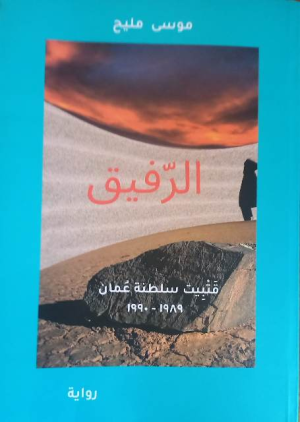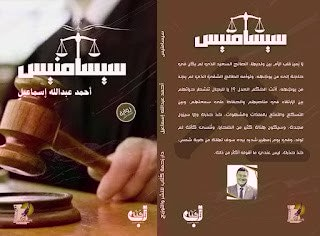تحفر القصيدة الجديدة في مصر فضاءاتها وتشكلاتها الجمالية الخاصة، منطلقة من التقريب بين الهاجس الشعري وهموم الحياة وانشغالاتها القريبة، وبلوغ الجوهر من أقصر الطرق وأقلّها التواءً، وتفتيت الأنا إلى أصوات متحاورة ومتصارعة في سبيل بحثها عن الألفة والدفء والائتناس، وإذابة الفواصل الوهمية بين الشعر والأجناس الإبداعية الأخرى، خصوصًا السرد والتشكيل والسينما والفنون الحركية.
تحت هذه المظلة من الانزياحات في البنية والرؤية واللغة والصورة، يأتي الإصدار الشعري "أصوات تحت الأظافر" (دار "خطوط وظلال"، عمّان، 2020) للمصري مؤمن سمير، إذ يتقصّى فيه الشاعر الأثر الغائر في الحياة، ويغوص عميقًا وراء النقش المطمور في العُمر، ليفتح بابًا على المجهول، ويعانق السّرّيين والمحجوبين والمشطوبين من الخرائط، بعدما يُحكم العالمُ إغلاق أزرار الظلام.
وفي الرحلة الاستكشافية ذاتها، فإنه يكشط الأسماء السخيفة من الوجود، ويراقص المحظوظين برشاقة وخفة، وهم أولئك الذين يُشْبهونه، إذ يعتقدون مثله أن قشرة الجرح السميكة تُخفي بالضرورة تحتها بهجاتٍ صغيرة، أفلتتْ من التسمّم، وضحكاتٍ مُبَرَّرة وغير مُبَرَّرة: "يبتسم، ويضغط على قلبه مرتين؛ مرةً لأنه يحسُّ بلذة غامضة، ومرةً لا يدري لها سبباً معلنًا".
يضمّ كتاب مؤمن سمير الشعري، الصادر في قرابة 200 صفحة؛ مختارات من دواوينه: "بورتريه أخير لكونشرتو العتمة"، "هواء جاف يجرح الملامح"، "بهجة الاحتضار"، "تفكيك السعادة"، "حَيِّزٌ للإثم"، "بلا خبز ولا نبيذ"، "سلة إيروتيكا تحت نافذتِك"، وغيرها، وهي في ترتيبها الزمني الطبيعي، بمثابة متواليات شعرية متناسقة، تشكّل في مجملها مشروعًا خاصًّا، يميزه بين رفقاء جيله من شعراء التسعينيات في مصر.
هذا المشروع، ينهض في جوهره على اللهاث خلف حفريّات الحنين، وتقصّي جذور الشجر المهملة، والمعاني الإنسانية المنسيّة، المنسوبة إلى الطمي الأخضر، وإعادة تدوير الرئات التالفة، وما فيها من خلايا ونيكوتين، والأظافر الرثّة، وما تحتها من نفايات، ليتخلّق البُنّيُّ الشهيّ، مُعيدًا إلى الأرض لونها ورائحتها وعافيتها، ويتفجّر الأحمر الحيويّ، الدمويّ والزهريّ، الذي يلوّن أذرع الهواء، ويصل إلى السماء المتعطشة إلى زيارة مباغتة: "الأحمر يجعلني منتشيًا، أرتعش/ شظيةُ السعادة أصابتني، فَطِرْتُ بخفةٍ.. مثل ورقة شجر".
مقاومة التحلل
قصائد "أصوات تحت الأظافر" هي ببساطة محاولات ساخنة لمقاومة التحلل والارتجاف، وصدّ أعوان التجمّد والتصحّر والذبول، فالأيام لا يمكن أن تبقى أبدًا محطات للهرب، لو تحوّل الإنسان ذاته إلى محطة وصول، والحناجر بإمكانها ذات مرة أن تنوب عن الشموس والأقمار الغائبة في إطلاق الأطياف. وعند نقطة سحرية من مراوغة المخاطر، والاستهزاء بالقسوة، والتلذذ بكل شيء حتى التعذيب، يجوز الحلم بالتمرد على جاذبية السقوط، وشراسة القبور، والانقلاب على العدم ذاته: "أصير بلا ملفاتٍ ثقيلة الوزن، أو هوية/ أكون عندئذٍ، قد ضحكتُ على الموت، المنتظر في الشارع المجاور".
في تخييله الفني، لا يعمد الشاعر إلى توليد صور متضادة، ولا يقصد إلى هندسة مفارقات جزئية، من أجل إحداث طرافة شعرية أو ابتكار مواقف مشحونة بالذهنية. وإنما على العكس، فهو يترك الأشياء على سجيتها، لتتحاور مع بعضها البعض، وتنعكس علاقاتها ومساجلاتها على مرايا الذات الشفيفة، فيتلاشى الجِلْد الميّت، ولا تتحطم الأشياء، ولا تُحطّم الذات. وتقود التفاعلات السهلة إلى عناصر ومركّبات جديدة، تنتمي إلى الكيمياء المعروفة، لكنها لم تظهر في مختبرات التجريب من قبل: "أُخْرج من قلبي هواءً، أوجهه نحو الزجاج، ثم أسرع وأمسحه بجلدي الميت، كي لا تظهر الأكاذيب؛ تلك التي انتظرَتَها الرياحُ طويلًا".
ولأنها مَشاهد بِكْر، فبلوغها مستحيل من غير المصداقية، التي تنطلي على كل شيء لكي يكون. وحتى الأكاذيب ذاتها، فإنها يجب أن تكون محبوكة، محكمة، قابلة للتصديق. وكذلك البكاء، اللغة التي تتفوق على الكلام، فلا جدوى لممارسته، إن لم يكن هو وجه الحقيقة بغير أقنعة: "أبكي كثيرًا، من مسامّ، لم تزل بعد محتفظة بصدقها".
لعبة السّرْد
في شغفه بتعدد الأصوات، وفق عنوان الكتاب، يقترح الشاعر، على امتداد نصوصه، لعبة تَكْسر الأحادية والمونولوج، وَتُفتّت الأنا، وتُشظّي اللحظات والأمكنة نثارات، هي لعبة السرد، حيث تتخلى الذات عن البطولة المنفردة في بعض القصائد، كما تبدو على الحياد أحيانًا، بل إنها قد تنسحب إلى خارج المنظر إذا اقتضى الأمر، وهنا تذوب الشَّعرة الوهمية تمامًا بين الشعر والقصة كجنسين أدبيين في التصنيف التقليدي، ويزداد التماهي بين النوعين وضوحًا مع تطعيم النصوص بالحوارات؛ الثنائية، والمتعددة: "البنتُ كانت فضية/ وكانت تنحتُ كل يوم، نبتة خضراء واسعة/ قالت لأمها: مَن يَحِلُّ الأمرَ، أنسى في فمه قُبلتي/ الحصان خَفَّضَ رأسه، ونَظَر معاتبًا".
يستعين الشاعر/السارد كذلك في لعبته بمفردات قاموس توصيلي، غير مجازي، متعطل عن الزينة والزخارف حدّ التقشف والمباشرة، إمعانًا في تحرير القصيدة من إرثها البياني والموسيقي المألوف، وتحريكًا للشعرية صوب ما يبدو للوهلة الأولى غير شعري، لكنه يهدف إلى اكتساب شعريته من الكلّي عندما يكتمل التعبير، وليس من جزئيات اللفظ والصورة والخيال في السطر النثري العاري: "تمصمص شفتيكَ/ لأنك الأفندي صاحب الشهادات/ لكنك بصراحة/ تخفي سعادةً/ سوف تُخرجها في يومٍ ما/ عندما تتغرَّب في بلدٍ بعيد".
سطوة العائلة
ملمح آخر يسم فضاءات تجربة مؤمن سمير، هو تضييق نطاق الكوني والعولمي لصالح العائلي والمحلي، فالذات الشاعرة في مطاردتها للبدائي والأوّلي والفطريّ، وفي تفتيشها عن الائتناس والدفء، تلتحف عادة المظلة الأُسَريّة. وفي سبيل هذا التجمُّع الصغير المنشود، تعيد الذات تسمية الموجودات والكائنات بأسرها، فمعنى اللون "التركواز" على سبيل المثال هو "أن تكون محاطًا بالطيبين". وفي المقابل، فعندما تهرب من الأب تعويذة العائلة، فإن الشيطان يشاركه في الأم، ولربما يصير الأطفال أبناء جِنّ، رؤوسهم كبيرة، ويسري في عروقهم دمٌ أسود!
هكذا، فإن ما هو غرائبي، وسوريالي، مثله مثل ما هو يومي اعتيادي، إذ تنطلي على الجميع قوانين الاستقطاب العائلي، ولا فرق بين قصة حياة نمطية مكرورة، وأخرى شيقة تصلح لأن تكون فيلمًا سينمائيًّا، فاللقطة الأهمّ دائمًا هي السلام المنزلي: "الأم والعمة والخالة والأخت يحلمن معاً/ الأم ترى الأب يموت مرة أخرى، فتفتح أيام "ابن سيرين"، وتقول: شخصٌ من رائحتنا، ستضحك عليه المصائب/ الهاتف الأسود القديم، نتجه إليه كلنا بسرعة الطيف، ونكون سعداء، حيث ننتظر الرنين".
مع ذلك، فإن الشاعر يتطلع إلى الصداقات الهوائية، ولا يسأم من مناداة الطيور البعيدة، على أملٍ وحيد، أن يصير فمه مرة وعاءً للموسيقى، وأن يرسم فضاءً تأكلهُ الأجنحة عشقًا، وتحاصره الألوان، وأن يقتنص الاستمتاع من براثن اللحظات المؤجلة: "سوف يتوقف رقصُ الفأس، في جَيْبي الصغير/ حانَ العملُ المؤجلُ/ حانت المتعة الصافية".
-------------------------------------------------
(*) نشرت هذه المقالة في العدد رقم34الصادر في يونيو2022 –الإصدار الرابع -من مجلة "إبداع" المصرية.
تحت هذه المظلة من الانزياحات في البنية والرؤية واللغة والصورة، يأتي الإصدار الشعري "أصوات تحت الأظافر" (دار "خطوط وظلال"، عمّان، 2020) للمصري مؤمن سمير، إذ يتقصّى فيه الشاعر الأثر الغائر في الحياة، ويغوص عميقًا وراء النقش المطمور في العُمر، ليفتح بابًا على المجهول، ويعانق السّرّيين والمحجوبين والمشطوبين من الخرائط، بعدما يُحكم العالمُ إغلاق أزرار الظلام.
وفي الرحلة الاستكشافية ذاتها، فإنه يكشط الأسماء السخيفة من الوجود، ويراقص المحظوظين برشاقة وخفة، وهم أولئك الذين يُشْبهونه، إذ يعتقدون مثله أن قشرة الجرح السميكة تُخفي بالضرورة تحتها بهجاتٍ صغيرة، أفلتتْ من التسمّم، وضحكاتٍ مُبَرَّرة وغير مُبَرَّرة: "يبتسم، ويضغط على قلبه مرتين؛ مرةً لأنه يحسُّ بلذة غامضة، ومرةً لا يدري لها سبباً معلنًا".
يضمّ كتاب مؤمن سمير الشعري، الصادر في قرابة 200 صفحة؛ مختارات من دواوينه: "بورتريه أخير لكونشرتو العتمة"، "هواء جاف يجرح الملامح"، "بهجة الاحتضار"، "تفكيك السعادة"، "حَيِّزٌ للإثم"، "بلا خبز ولا نبيذ"، "سلة إيروتيكا تحت نافذتِك"، وغيرها، وهي في ترتيبها الزمني الطبيعي، بمثابة متواليات شعرية متناسقة، تشكّل في مجملها مشروعًا خاصًّا، يميزه بين رفقاء جيله من شعراء التسعينيات في مصر.
هذا المشروع، ينهض في جوهره على اللهاث خلف حفريّات الحنين، وتقصّي جذور الشجر المهملة، والمعاني الإنسانية المنسيّة، المنسوبة إلى الطمي الأخضر، وإعادة تدوير الرئات التالفة، وما فيها من خلايا ونيكوتين، والأظافر الرثّة، وما تحتها من نفايات، ليتخلّق البُنّيُّ الشهيّ، مُعيدًا إلى الأرض لونها ورائحتها وعافيتها، ويتفجّر الأحمر الحيويّ، الدمويّ والزهريّ، الذي يلوّن أذرع الهواء، ويصل إلى السماء المتعطشة إلى زيارة مباغتة: "الأحمر يجعلني منتشيًا، أرتعش/ شظيةُ السعادة أصابتني، فَطِرْتُ بخفةٍ.. مثل ورقة شجر".
مقاومة التحلل
قصائد "أصوات تحت الأظافر" هي ببساطة محاولات ساخنة لمقاومة التحلل والارتجاف، وصدّ أعوان التجمّد والتصحّر والذبول، فالأيام لا يمكن أن تبقى أبدًا محطات للهرب، لو تحوّل الإنسان ذاته إلى محطة وصول، والحناجر بإمكانها ذات مرة أن تنوب عن الشموس والأقمار الغائبة في إطلاق الأطياف. وعند نقطة سحرية من مراوغة المخاطر، والاستهزاء بالقسوة، والتلذذ بكل شيء حتى التعذيب، يجوز الحلم بالتمرد على جاذبية السقوط، وشراسة القبور، والانقلاب على العدم ذاته: "أصير بلا ملفاتٍ ثقيلة الوزن، أو هوية/ أكون عندئذٍ، قد ضحكتُ على الموت، المنتظر في الشارع المجاور".
في تخييله الفني، لا يعمد الشاعر إلى توليد صور متضادة، ولا يقصد إلى هندسة مفارقات جزئية، من أجل إحداث طرافة شعرية أو ابتكار مواقف مشحونة بالذهنية. وإنما على العكس، فهو يترك الأشياء على سجيتها، لتتحاور مع بعضها البعض، وتنعكس علاقاتها ومساجلاتها على مرايا الذات الشفيفة، فيتلاشى الجِلْد الميّت، ولا تتحطم الأشياء، ولا تُحطّم الذات. وتقود التفاعلات السهلة إلى عناصر ومركّبات جديدة، تنتمي إلى الكيمياء المعروفة، لكنها لم تظهر في مختبرات التجريب من قبل: "أُخْرج من قلبي هواءً، أوجهه نحو الزجاج، ثم أسرع وأمسحه بجلدي الميت، كي لا تظهر الأكاذيب؛ تلك التي انتظرَتَها الرياحُ طويلًا".
ولأنها مَشاهد بِكْر، فبلوغها مستحيل من غير المصداقية، التي تنطلي على كل شيء لكي يكون. وحتى الأكاذيب ذاتها، فإنها يجب أن تكون محبوكة، محكمة، قابلة للتصديق. وكذلك البكاء، اللغة التي تتفوق على الكلام، فلا جدوى لممارسته، إن لم يكن هو وجه الحقيقة بغير أقنعة: "أبكي كثيرًا، من مسامّ، لم تزل بعد محتفظة بصدقها".
لعبة السّرْد
في شغفه بتعدد الأصوات، وفق عنوان الكتاب، يقترح الشاعر، على امتداد نصوصه، لعبة تَكْسر الأحادية والمونولوج، وَتُفتّت الأنا، وتُشظّي اللحظات والأمكنة نثارات، هي لعبة السرد، حيث تتخلى الذات عن البطولة المنفردة في بعض القصائد، كما تبدو على الحياد أحيانًا، بل إنها قد تنسحب إلى خارج المنظر إذا اقتضى الأمر، وهنا تذوب الشَّعرة الوهمية تمامًا بين الشعر والقصة كجنسين أدبيين في التصنيف التقليدي، ويزداد التماهي بين النوعين وضوحًا مع تطعيم النصوص بالحوارات؛ الثنائية، والمتعددة: "البنتُ كانت فضية/ وكانت تنحتُ كل يوم، نبتة خضراء واسعة/ قالت لأمها: مَن يَحِلُّ الأمرَ، أنسى في فمه قُبلتي/ الحصان خَفَّضَ رأسه، ونَظَر معاتبًا".
يستعين الشاعر/السارد كذلك في لعبته بمفردات قاموس توصيلي، غير مجازي، متعطل عن الزينة والزخارف حدّ التقشف والمباشرة، إمعانًا في تحرير القصيدة من إرثها البياني والموسيقي المألوف، وتحريكًا للشعرية صوب ما يبدو للوهلة الأولى غير شعري، لكنه يهدف إلى اكتساب شعريته من الكلّي عندما يكتمل التعبير، وليس من جزئيات اللفظ والصورة والخيال في السطر النثري العاري: "تمصمص شفتيكَ/ لأنك الأفندي صاحب الشهادات/ لكنك بصراحة/ تخفي سعادةً/ سوف تُخرجها في يومٍ ما/ عندما تتغرَّب في بلدٍ بعيد".
سطوة العائلة
ملمح آخر يسم فضاءات تجربة مؤمن سمير، هو تضييق نطاق الكوني والعولمي لصالح العائلي والمحلي، فالذات الشاعرة في مطاردتها للبدائي والأوّلي والفطريّ، وفي تفتيشها عن الائتناس والدفء، تلتحف عادة المظلة الأُسَريّة. وفي سبيل هذا التجمُّع الصغير المنشود، تعيد الذات تسمية الموجودات والكائنات بأسرها، فمعنى اللون "التركواز" على سبيل المثال هو "أن تكون محاطًا بالطيبين". وفي المقابل، فعندما تهرب من الأب تعويذة العائلة، فإن الشيطان يشاركه في الأم، ولربما يصير الأطفال أبناء جِنّ، رؤوسهم كبيرة، ويسري في عروقهم دمٌ أسود!
هكذا، فإن ما هو غرائبي، وسوريالي، مثله مثل ما هو يومي اعتيادي، إذ تنطلي على الجميع قوانين الاستقطاب العائلي، ولا فرق بين قصة حياة نمطية مكرورة، وأخرى شيقة تصلح لأن تكون فيلمًا سينمائيًّا، فاللقطة الأهمّ دائمًا هي السلام المنزلي: "الأم والعمة والخالة والأخت يحلمن معاً/ الأم ترى الأب يموت مرة أخرى، فتفتح أيام "ابن سيرين"، وتقول: شخصٌ من رائحتنا، ستضحك عليه المصائب/ الهاتف الأسود القديم، نتجه إليه كلنا بسرعة الطيف، ونكون سعداء، حيث ننتظر الرنين".
مع ذلك، فإن الشاعر يتطلع إلى الصداقات الهوائية، ولا يسأم من مناداة الطيور البعيدة، على أملٍ وحيد، أن يصير فمه مرة وعاءً للموسيقى، وأن يرسم فضاءً تأكلهُ الأجنحة عشقًا، وتحاصره الألوان، وأن يقتنص الاستمتاع من براثن اللحظات المؤجلة: "سوف يتوقف رقصُ الفأس، في جَيْبي الصغير/ حانَ العملُ المؤجلُ/ حانت المتعة الصافية".
-------------------------------------------------
(*) نشرت هذه المقالة في العدد رقم34الصادر في يونيو2022 –الإصدار الرابع -من مجلة "إبداع" المصرية.