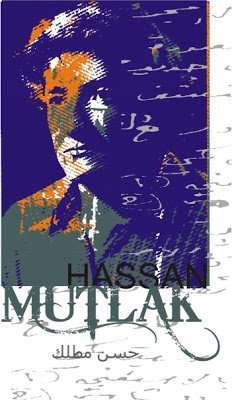(1)
وضعتُ أمامي كومة من المصادر التي تبحث كلها في موضوعة الأدب، في الرواية على الأخص. كنت جاهداً في أن أجد تعريفاً واحداً أركنُ إليه للشفاء من سؤال ملح ومؤرق يتعلق بطبيعة عملي (كروائي)، والسؤال يتعلق بموضوعة حياتية ساذجة: لماذا أكون روائياً وليس نجاراً مثلاً؟
وهذا السؤال بالتحديد، هو الذي جعلني أرفع مصادر البحث عن سطح المنضدة وأضع نفسي بدلاً عنها. وهذا السؤال قادني إلى نظرة فاحصة، بمثابة منهج تفكيري. لأفترض أنني الآن مستلقي على السرير، أي أنني لا أقوم بفعل الكتابة عن الكتابة. ترى: كيف كنتُ سأجيب، لو أن الأمر -مثلاً- يتعلق بمحض اختيار (مهنة)؟
كنت أعتقد أن الجواب يكمن في معطيات الأدب، ولذلك رحت أفاضل بين عمل روائي وآخر، بين كاتب وكاتب، بين موضوع موضوع، ولكنني بدلاً من أن أعرف، صرت أكثر تشتتاً وغباءً. لقد كانت النتيجة هي أني جمعت الكثير من (المعطيات) التي أبعدتني عن (جوهر) الأدب، وأبعدت عني إمكانية الإجابة عن الأسئلة التي تبدو في مظهرها بسيطة وسهلة الإجابة.
مثلاً، إن سؤال: ما الرواية؟ أصعب بكثير من سؤال: كيف يمكن أن أكتب رواية عظيمة؟ لأن السؤال الأول، بطبيعته، سابق على السؤال الثاني، ولذلك، متى ما تمكنا من الإجابة عن السؤال الأول، فإننا سنجيب عن السؤال الثاني ببساطة.
ولكن، يبدو لي الأمر، منذ الوهلة الأولى، في اللحظة التي أطلق بها السؤال. أن هذا البحث لا يتعلق بمشكلة البحث عن إجابة أو حل، بل أنه يبدو قائماً في المشكلة نفسها بقدر ما يولَّد فينا من إحساس بالتوتر، غير أن مجموعة الأسئلة التي نطلقها لمعرفة جوهر الأدب لن تعطينا إجابة نهائية طالما أنه يمكن أن نكتب عشرات المجلدات وبأقلام كتاب مختلفين، سنحصل على إجابات متباينة لا تشكل في امتيازها ولا في مجموعها جواباً مريحاً عن أبسط الأسئلة، غير أنها تعطينا في المقابل وعياً إضافياً بعملية الكتابة. لذا فإننا لن نحصل في يوم من الأيام على قوانين وتحديات يمكن أن نجعلها دروساً سهلة لطلاب المدارس، بل سنحصل على فهم و(وعي كتابي)، وحين نصل إلى فهم أعمق فإن المشكلة تظهَر من جديد متلبسة الأسئلة الأولية نفسها.
(2)
لقد برز سؤال: (ما الأدب؟) منذ عصر اختراع هذه التسمية مروراً بتاريخ الميثولوجيا، فأرسطو، وحتى الآن، ولا نستطيع، نحن الكُتاب الأحياء، أن نجيب عن هذا السؤال، رغم أننا اخترنا الكتابة (كمهنة) لنا، كما اختار سارتر هذا السؤال: (ما الأدب؟) كعنوان لكتابه، غير أنه في الحقيقة كان يتحدث عن فرنسا، وعن الموقف الأدبي، وليس عن الأدب مُطلقاً، والحقيقة أن ما قاله سارتر: «إذا حاولنا إدراك عملنا فنحن بصدد خلقه من جديد» (ما الأدب، فـ 2/ترجمة: محمد غنيمي هلال) يلغي مرة ثانية كل تصوراته عن الأدب، كما يلغي كل محاولة للإجابة.
لقد أكد أن الأدب هو (كشف) عن طريق الحقيقة الإنسانية ذات الطبيعة الكاشفة، لذا فهو يدلنا، دون أن يدري، بأن هنا شيئاً ما نكشف عنه بطرق مختلفة منها الأدب. أي أنه التجأ إلى (المعطيات) مرة أخرى متناسباً (الجوهر) الذي يجب أن نكشف عنه؛ طبيعة الجوهر، وطبيعة الكشف عن الجوهر.
إننا نعرف بأن اللغة هي وظيفة الفكر، أي أن اللغة تكشف عن طبيعة الفكر بصورة مصغرة، ولكن هل أن الفكر لا يستطيع أن يفكر بدون اللغة؟ يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة لو تناولنا قصة (حي بن يقظان) لابن طفيل. يُفترض أن حي بن يقظان قد تعرف على العالم بوعيه الخاص دون الاستعانة بالمسميات لأنه لم يكن يعرف اللغة بمعناها الشامل إلا بعض الأصوات والصرخات التي تعلمها عن طريقة تقليد الحيوانات. إن المشكلة التي واجهت ابن طفيل وتواجهنا الآن هي: كيف فكر بن يقظان؟ وكيف يمكن الكشف عن تفكيره وتوصيله بواسطة اللغة التي لا يجيدها حي. إذاً، إذا كان يريد ابن طفيل أن أصدقه، كان عليه ألا يكتب هذه القصة ولا يتحدث عنها، وإلا فإنها تجربة ابن طفيل نفسه، تجربته الصامتة مع الوجود، التي تكشف بطلان وزيف أية محاولة لمعرفة طبيعة بطله دون الالتجاء إلى اللغة التي تقتل محاولته في لحظة الكلام عنها. إنها محاولة تذهب بالأدب إلى مشاكل الميتافيزيقيا فيصير نوعاً من التفلسف، وبهذا لن يكون الأدب أدباً على الإطلاق.
ولكي يكون الأدب أدباً عليه أن يسلك الطريق المعاكس للفلسفة لكي يطرح المشكلات الفلسفية نفسها، أعني بشكل حسي عياني، حياتي بشكل أشمل. وأن يدير الأديب ظهره لمشكلات الفيلسوف، ليراها بعين فُتِحت في مؤخرة رأسه، وبصورة حدسية، متجاوزاً بذلك كل أشكال المنطق ومشكلات السبب والنتيجة.
(3)
إن الأدب يُصور لحظة التوتر هذه، لحظة إطلاق السؤال، ولكنه لا يمضي أبعد من ذلك، وإلا فإنه سيعلن حرباً ضد الفلسفة، ويخسر بذلك هذه الحرب لا محالة.
إن الوظيفة الأساسية للأدب هي أن تجعل الإنسان يتحسس مكانه في الوجود، وتجعله يعي هذا التحسس. إنها وظيفة إدراكية تصورية بحتة، وليست وظيفة حلول مقترَحة، أو كفاح لتطور الذوق، أو لعبة لتطوير الحساسية اللغوية لكي يمكن التعبير عن الحاجات الإنسانية. إنها وبشكل أدق: محاولة لإيجاد منطقة توتر مريح، أو منطقة مريحة للتوتر، معاً، في لجة الأبدية.
ولذلك فإن أي أدب لا يتناول مشكلات الإنسان الأولية في العالم، ويكتفي بتصوير حياة زائلة، هو أدب زائل بزوال الشرط التاريخي للمشكلة.
غير أن الأدب -بعكس الفلسفة- يطرح مشكلة الموت عن طريق النكتة، كما في (مائة عام من العزلة) لدى ماركيز ومشكلة التوق إلى الخلود كما في (النورس جوناثان) لريتشارد باخ. فإنه لا يمكن أن يمر بدون هذا الركام من الكلمات الهشة والقاسية، والأشياء والأدوات، والسيكولوجيا، وحالة السكن في كوخ، وعزلة كاتب العرائض... إلخ.
إن الأدب هو خيانة الفلسفة، ولذلك فهو أدب. وبالمقابل فإن الأدب لن يكن أصيلاً إذا ما قطع صلاته مع الفلسفة، لأنه بذلك يتناسى منطقة (الوقوف المتحرك) في الأبدية. إنه معني أيضاً بطرح الأسئلة ذاتها التي تطرحها الفلسفة، ولكن بأدواته الممكنة والمتوفرة، لأن الفلسفة بالمقابل يجب أن تعترف بالأدب لأنه وهبها الخيال، والا لكانت شيئاً آخر ليس له اسم.
إن هذه العلاقة الإشكالية بين الأدب والفلسفة، يجب أن تبقى قائمة، علاقة التجاذب والنفور، علاقة الغارات لاحتلال مواقع من الطرفين، علاقة التصالح الوقتي الأصيل الشائن، دون أن يُقدم أحد الطرفين على تقديم حلول معينة حتى لو صار جميع رجال العالم رجلاً واحدا، وجميع نساء العالم امرأة واحدة، فإن مشكلة هذين الفردين إزاء الوجود تبقى قائمة.. كأنها مشكلة العالم كله.
فعلى الأدب أن يتخلى إذاً عن مشكلة الشيوخ في دار العجزة، لأنها ستُحل تلقائياً بموتهم، ويعود بدلاً عن ذلك إلى الأسئلة الأولى؛ أسئلة الطفل التي لا نستطيع، نحن الكبار، أن نجيب عنها، دون أن نَكذب.
(4)
لقد ظلت الكينونة بمثابة جدار وهمي يفصل بين الفلسفة والأدب، على أساس أنه ليس من وظيفة الأخير أن ينظر فيما وراء الكينونة. إنه دائماً يناقش المعطيات، غير أن هذا الركام التجريبي السطحي، ركام الكلمات، جعلنا نكتب أدب الأدب، وقد تناسينا في الشرط الأول أن محاورات الفلاسفة اليونانيين كانت تجري على شكل حلقات أدبية، وما جمهورية أفلاطون إلا تصور أدبي عميق لمدينة مثالية.
إن هذه المناقشة الحامية مع نفسي، تعيدني مُجبَراً إلى المصبات والمصادر الأولى، والأسئلة الأولى، وبهذه الطريقة وحدها أستطيع أن أقيس مدى أصالة عمل أدبي معين، لا من خلال مقارنته بأعمال أخرى، ولا باجتهادات تجريبية، ولا حتى فيما يطرحه من مشكلات مؤثرة في الأسلوب، وإنما عن طريق رؤية أصلية فيما مدى ابتعاده واقترابه من مشكلتي (من، مع، في.. العالَم).
صحيح أن هذه المناقشات الشكلية قد حَسمت لنا معضلات كثيرة فيما يخص اللغة المناسبة لتوصيل عمل ما، وفيما كنا نعتقده أيضاً، من أن (السُمك) هو الفارق الرئيسي بين الرواية الكلاسيكية والرواية الحديثة. فليس من الصحيح أن نقول: إن (دوستويفسكي) كان يكتب المجلدات لأنه كان في عصر أقل ازدحاماً، لذا كان لديه متسع من الوقت للكتابة، كما كان لدى القارئ متسع من الوقت للقراءة. ولكن من الصحيح أن نقول: إن ارتقاء اللغة الأدبية وتطوير الأساليب جعلنا نستطيع أن نكتب في صفحة واحدة ما لم يستطع دوستويفسكي أن يكتبه في مائة صفحة.
إذاً فالمشكلة لا تعود بالدرجة الأساس إلى طول العمل أو قصره، إذا ما أردنا المفاضلة بين عملين، كما أنها لا تعود إلى الأسلوب وحده، ولكنها ترجع دائماً، إذا ما أردنا أن نتبين جدوى الأدب، إلى (منطقة الوقوف المتحرك في الأبدية). مشكلة الإنسان كوعي يعي نفسه ويعي العالم.
إننا نستطيع أن نَشعر بأهمية أي عمل أدبي بقدر ما يطرح من أسئلة مفتوحة، تكون في النهاية، أسئلة ميتافيزيقية يصعب الإجابة عليها، لأنها دائما تفلت منا في لحظة الانتقال من الوعي إلى العالم وبالعكس.
(5)
غير أننا سنبحث عن (الجدوى) حفاظاً على حياة الأدب والفلسفة معاً، ولكيلا يكون تصورنا عبثياً، فنفقد بذلك معنى الحياة.
نقول إن الجدوى هي هذا الكفاح لكي نجعل الوعي أكثر وعياً بذاته، وبذلك فإنه سيكون وعياً خلاقاً، طالما أنه يتمثل إشكاليته الأساسية التي تتشظى إلى إشكاليات لا نهاية لها، هي نفسها تشكل قوة الوعي. ولكي نفرق أكثر بين: التصور الأدبي-العبثي للعالَم، وبين التصور الأدبي-الإشكالي للعالم، علينا أن نفهم فارقاً أساسياً بين الإشكالي والعبثي.
فالعبثي هو أن يجعل من الإنسان عبداً لوعيه إلى الأبد، متمثلاً ذلك في (سيزيف) الذي يدفع ضريبة وعيه بحمل الصخرة إلى قمة الجبل، فهو في كل مرة (ملزَم) بهذا الفعل طالما أنه يعي، وكان لا يستطيع أن يرفض أو يسأل على الأقل، لأن دفع الصخرة هو ضريبة الرفض والسؤال، بينما نجد العكس في التصور الإشكالي، في أنه يعود دائماً إلى الحالة التي سبقت رفع الصخرة، ويستطيع أن يذهب إلى الحالة التي بعدها. أي أنه يستطيع أن يتمثل حالتي البداية والنهاية (الرفع والدحرجة) معاً. أو بشكل أدق، فإنه يتعامل مع الزمن بشكل خلاق، فيجعل الصخرة في حالة دحرجة دائمة دون أن يكلف نفسه عناء رفعها من جديد، لأن التحكُّم - اللاتحكُّم بالوعي، هو بالضرورة: تحكم - لاتحكم بالعالم.
ووفق هذا التصور للوعي الإشكالي، فإن هذا الوعي يستطيع أن يرحل مع أو ضد الأبدية متجاوزاً بذلك منطقة الوقوف المتحرك، ولهذا فهو وعي خلاق.
ونسأل السؤال مرة أخرى: كيف يكون الأدب مجدياً طالما أنه لا يحل لنا مشكلة؟
إن اللحظات التي تمضي من الحياة دون أن يرصدها الأدب، هي لحظات ميتة، ستمضي نحو العدم حاملة معها حالة توتر حساس لصالح الوعي، في تاريخ الشخص أو مجموعة الأشخاص. وهي إذاً، هذه اللحظات، تشكل في ماهيتها، حالة اختيار أو نفي أو انسحاق، أو قرار، بمثابة موجه في البحر، ترصد منطقة ظلت ميتة على الدوام داخل الوعي.
إن الإشارة الأدبية إلى هذه المنطقة-اللحظة، تعني أننا نرفض أن يكون جزءا منا ميتاً موتاً سرَطانياً داخل الموجود الإنساني، الذي يرفض بكل شدة أن يكون منسياً، أكثر من رفضه من أن يكون ميتاً.
لذا فإن الخطاب الأدبي يُذكرنا بأننا على قيد الحياة، لا عبر وسائليته لإيصال حدث أو واقعة حياتية معينة، وإنما لأنه مشروع خلاق لهدم عادات نسيان الوجود. وهو في جانب آخر أسلوب منتقى للكشف عن جانب، أو عدة جوانب من الحقيقة، والاقتراب بالمعنى الإنساني من معناه. لكي نعرف أننا كنا على قيد الحياة وما زلنا. ونعرف أن هناك جوانباً كثيرة يمكن أن نعتز بها، حتى بعض الجوانب الضئيلة، لأجل تكوّن وعينا التاريخي. إننا لم نأتِ من عدم، وأننا لن ننسى حتى بعد موتنا.
يبدو أن مسألة الاقتناع بأهمية الأدب باتت من أكثر المسائل إلحاحاً للأديب قبل القارئ، بسبب تلك التراكمات والزوائد الكلامية التي طمست تحتها التذوق والنقد.
كما يبدو، من جهة أخرى، أكثر خطراً؛ أننا لسنا جادين أبداً في كتاباتنا وفي قراءاتنا، وحتى في تفكيرنا. ولذلك فإن «النقطة العمياء» (ميرلوبونتي) قد اتسعت لتشمل كل مساحة العين الراصدة للوجود.
الخطوة الأولى تبدأ بالتشكيك بمعطيات الفن -وعلينا هذه المرة أن نكون أكثر جدية-، التشكيك بأدوات البحث والاستقصاء والمدارس الأدبية، وتجارب الشكل، على اعتبار أنها تشكل لنا «وعياً موروثاً» (خضير ميري) لا نعرف مدى صحته، وباعتبار هذه المعطيات (مزيفة)، وبحكم قاس، ليس لأجل نقطة بداية جديدة كل الجدة، فهذا غير ممكن طبعاً، بل لأجل توجه صحيح لتنقية الأدب من شوائبه، فلنقل إن كل هذه المعطيات تدور حول القيمة الإنسانية ولا تخترقها، وهو فرض خاطئ بكل تأكيد، إلا أننا لا نستطيع أن نخفي احترامنا لتلك الخطابات التي تلامس وعينا من الداخل.
ولكننا نريد أن نؤكد بأن القدسية، ما هي إلا ضرب من ضروب التعود الذي يحصر الإبداع ويقيده، لا سيما ما نسميه بـ(المدارس الأدبية) التي هي ليست أكثر من نغمة منفردة في الضوضاء (مع إعطاء التقدير والاحترام لمؤسسي هذه المدارس، ونستثني من ذلك المتأثرين بهم فهم ليسوا سوى توابع، مهما بلغ شأنهم، وهم أيضاً سارقو رؤية).
نحاول أن نُبطل مفهوم (ثبات الرؤية) لدى الأديب الواحد، باعتبار أن هذا الأمر سينتج منطقة ما، ميتة في الوعي، فكيف الحال مع من يأخذ رؤية ليؤسس عليها، هذا الذي لم يُجهد نفسه بالتعرف على منطقة وقوفه المتحرك في الأبدية، هذا الذي استعان بالآخرين لكي يفكروا بدلاً عنه. نعني أننا مع ثبات الأصالة ومع الصدق بأبسط صوره، باعتباره القاسم المشترك لكل التجارب. فليس على المبدع أن يفكر في كيفية الحفاظ على إبداعه فحسب، وليس عليه أن يحصر همه ليجعل صوته مرتفعاً، بل عليه أن يكافح ثبات خبرته وقولبتها، وأن يكون التراكم لديه وسيلة لتوليد أفكار جديدة ورؤية جديدة باستمرار، ولا يكون التراكم أبداً بمثابة قوانين بديهية.
لكل أديب، بالدرجة الأساس دور تثويري استفزازي مستمر، لصالح الوعي الآخر، وليس لصالح الأدب أبداً، لأنه من الخطأ أن يُسخر الأديب نفسه للأدب فحسب.
وبذلك يكون البدء أولا من القيمة الإنسانية التي تأخذ الحاجات الظرفية بحسابها، دون أن تراعيها.
الأدب في الإنسان، لأجل الإنسان، ومتى ما تَذكر الأديب بأنه أديب سينسى بأنه إنسان، ومتى ما نسي الأديب بأنه أديب سينسى بأنه إنسان، ويتجه نحو أدب مُغلق ميت في النهاية.. بعدما يعتقد بأن الأدوات قد اكتملت، وأن الإبداع قد وصل إلى أقصاه.
إن وظيفة الخطاب الأدبي، هي استخراج قيمة إنسانية بالدرجة الأساس، فكيف يسعى الأديب إلى تحجيم ذاته بالانشغال بألعاب (السيرك اللغوي) أو بالبحث -لمجرد البحث- عن متاهات تجعل القارئ يخاف أن يفتح الكتاب.
طالما أنه يبحث عما يطور وعيه، ولكن عليه بالمقابل ألا يترك عمله «مكشوفاً ومقنعاً بسرعة أكبر مما ينبغي، فسيكون عملاً زخرفياً لا يخضع إلا لنزوات الخيال» على حد قول (جان كوكتو).
* * *
يبدو أن الخطأ الذي نرتكبه في الكتابة، هو أننا نمارسها في وضع الجلوس، لو جربنا أن نكتب وُقُوفاً، وفعل (الوقوف) يتجاوز معناه الشائع.. أقصد أن نتلقى العالَم بشكل بطولي.
* * *
للأسف، إن الكتابة تكون أسيرة لفعل التدوين، وبهذا لا تكون إلا مجرد كتابة. إن الجملة التي تأتي لحظة الركوع على الورق هي جملة خاسرة، فلو عشنا حياتنا وشخصيتنا كما نعيش تلك اللحظة الشيقة الشبيهة بالفعل السري لأمكننا اختبار صدق ادعاءاتنا جميعا، ولأصبحنا أقرب إلى الحقيقة حين نتعرف على بعضنا على أننا كُتاب.
لقد توصلتُ إلى فهم بسيط، من أن الكاتب الحقيقي هو الذي يضع احتمالات روائية لسلوك زوجته، ويطرق باب الجيران على طريقة (زوربا) أو (بتشورين) -بالنسبة للروائي- فإنه ليصعب عليه الفصل بين ما يكتب وما يعيش.
* * *
لقد تخاصمنا كثيراً حول الاصطلاحات، وفاضلنا بين الواقعية والرمزية وبين الواقعية والسريالية، وصار بعضنا يدافع عن مذهب لا يعرفه، ونجح منا الذي اتبع جنونه وقلقه، والذي نجح جداً، هو الذي لم يتعلم طريقة واحدة في الكتابة.
* * *
أحياناً تساعد الرقابة كثيراً في خلق هذا الأسلوب أو ذاك، فعندما نريد أن نقول شيئاً خطيراً، فإننا نلجأ إلى طريقة لغوية تفوت على الرقابة فهم الموضوع مباشرة، ولذلك فأنا مدين بالكثير لهذه المؤسسة لأنها ساهمت في جوانب مهمة في نهضة الأسلوب.
* * *
لو كان الأمر يتعلق بمجرد تعريف للكتابة لأمكننا أن نجد عشرات التعاريف الصحيحة، ولكنها تتعدى حدود لحظة التدوين إلى حياتنا ككُتاب، تلك الحياة التي ندرج عادة على تسميتها بـ «السيرة الذاتية». برأيي؛ إن الأمر يحتاج إلى خلط أكثر مما يحتاج إلى تمييز. وهي هذا الفعل الهروبي المستمر من الحياة الصلبة بحثاً عن الحياة نفسها في أشكال أخرى. لحظة الإمساك بفكرة لابد أن تكون خاطئة لأنها مخالفة لقوانين المنطق الذي يمكن البرهنة عليه، فهذا الخطأ في التصور هو خطأ أدبي مقبول يعطينا شكلاً بديلاً عن الواقع يمكن أن نتعامل معه كشكل مقبول، ولذلك فإن معالجة مسألة الصدق هي من أعقد المشاكل، لأننا نكتب عن الأشباح دون أن نؤمن بها. فالصدق هو أن نؤمن (بنا)، بما نقول.
الهجران
منذ أن رأى الإنسان صورته معكوسة على سطح الزيت، أو في ماء المستنقع، وبعد ذلك، اختراع المرايا وفن البورتريه الشخصي ثم الوصف الأدبي المتقن للذات في أوراق الأدب الكلاسيكي، حدثت لهذا الموجود ثنائية عجيبة. وتعدد الانقسام بحيث لم يعد بالإمكان الاكتفاء بصورة ثانية فحسب، وصرنا نرى صورا لأنفسنا في كل مكان محطَّمَة أو مزيَّنة أكثر مما يجب، وتعرفنا على شكل آخر لوجودنا غير الوجود الجوهري الذي يصطدم دائما بالفكرة الأصلية (فكرة الخوف من الزوال).. وفررنا فرار الحيوان من ظِله..
ونظراً لدقة المرايا في رسم الصور، فقد غادرنا من العمق إلى السطح، نتأمل أنفسنا (هناك) بنوع من الإعجاب، وترت على ذلك:
1. صار من الصعب أن نعكس العين إلى الداخل ونرى أنفسنا (الجوهر).
2. في كل محاولة مكثفة من هذا النوع، هناك مجموعة إحالات تجزيئية (تحويل الموضوع باستمرار إلى موضوع آخر غيره) بحيث أن الجوهري يبتعد.
3. الانبهار بالشكل على حساب المحتوى.
4. تحطيم الموضوع (أو تحطيم النص)، بتوتر إشكالي، مثلاً؛ النص الأدبي الحديث:
توتر بين الشكل والمحتوى، اغتراب، صعوبة الإمساك بالمعنى، جنون الشكل، نسيان المشكلات الأولية.
5. الأشياء لم تعد كما هي، ولا كما نراها، لقد تحولت إلى أشياء أخرى.
6. شيوع مفهوم الوهم والخدعة (الإيهام في البناء الفني) الذي أخذ، أحياناً، مفهوم التشويق.
7. قوة أي عمل أدبي معاصر تأتي من نجاح الكاتب في تصوير هذا الهجران بين الموضوع الواقعي (سواء كان فكرة أو حدث واقعي) وبين التصور.
8. أصبح التصوّر الأدبي جهازاً في غاية التعقيد لأجل إدراك الإحالات اللامتناهية، وأصبح النجاح صعباً لأنه يتطلب قوة خارقة للإمساك (بالسِر)...
(السر بدل الثيمة)، السر هو مجموع وتفاعل الثيمات، ولكنه أصغر وأدق من الثيمة. السر داخلي بالضرورة، يتعلق بعلاقة الكاتب بإنتاج النص، والثيمة تتعلق بالموضوع الخارجي دائماً.. أي أنها حكم خارجي، أو مفردة للحكم ... إلخ.
* ملاحظة: سنجابه العالم الدموي بنص رقيق.
الهجران (الافتراق)
التذوق الجمالي هو أعلى درجات الهجران بين النص والواقع وذلك بتطابق النص كلياً مع الواقع.
الهجران باعتباره هجرانا للكينونة. اندماج في شيء مشابه للوجود أو لجانب مدرَك من الوجود ونسيان الكينونة الصلبة.
هناك إدراك كلي لحادثة في العالم، هناك واقع موضوعي خارجي، بعيداً عن كل تأمل فلسفي. العالم يبدو لنا كما هو.. ولكننا بصدد وصف هذا الحادث في العالم، وصف مكان، وصف فعل معين. نريد أن ننقل الـ (كما هو) الذي رأيناه إلى شخص آخر لم يره. هناك طرق كثيرة لنقله، وهي معروفة لدى الفنون: التصوير الموسيقي، المسرح... ثم النص الأدبي. سنجد أن النص الذي أنتجناه يأخذ احتمالين لدينا ولدى القارئ.
الاحتمال الأول: أن يكون النص مطابقاً للعالم - وهذا افتراض طبعاً -، إنني أعرف بأنه ليس مطابقاً تماماً، ولا غير مطابق. هناك شبه كبير بين النسخة والأصل، ولكن النسخة فيها الكثير من الانتقاء، وهذا الانتقاء هو الهدف الجمالي للفنون. ذلك أن جميع الفنون انتقائية. وفي كل محاولة لكي أرى الأصل عبر النسخة - النص،
تنشأ نتائج لهذه العلاقة - المحاولات، تحوّل العالم إلى شيء آخر غيره، لذلك عندما أعود إلى النص فإنني سأجده شيئاً مختلفاً بعدما وجدت الأصل شيئاً مختلفاً عنه كذلك. نفهم هنا، المحاولات التي بذلها الواقعيون والطبيعيون في التمسك الحرفي الدقيق للـ (كما هو)، محاولات لتخفيف التوتر بين الأصل والنص. في داخل المتلقي.
الاحتمال الثاني: في حالة كون النص مختلفاً تماماً عن العالم، فمن البديهي وجود افتراض وهجران مسبق. ما نجده في الاتجاهات (السوريالية، والأخرى الحديثة لدى السيد كلود سيمون وأصحابه مثلاً)، في هذا الاحتمال نبحث مسألة الواقعي والخيالي. (سنعود إليها في فصل لاحق).
لو كان الموضوع الفني (النص) هنا. لا يمكن أن يتبدى إلا من خلال علاقتنا به، فهل يمكن أن يطابق المشكلة الميتافيزيقية (مشكلة؛ الأنا - الآخر)؟
إذا كان كذلك، فهناك احتمال للخوض في هذا الجانب لأسباب عديدة نعتقد أنها ممكنة في:
1. المعطى الفني يمثل وجوداً حيوياً قابلاً للانفتاح على العالم، لأنه يكف عن أن يكون سلبياً لحظة قيام العلاقة بينه وبين المتلقي.
2. المعنى الفني (النص هنا) يحمل معنى خاص به، وربما يتجلى في معان عديدة (معنى مركب) من خلال إمكاناته الذاتية، (قوته في أن يُوجد لذاته) في: البناء، الرموز الدلالية واللغوية، الشكل... إلخ.
3. يمكن اعتباره طرفاً دائماً في العلاقة بعمليات (التَرَسب) المعلوماتي. وفي خلف الخبرات للذاكرة. ذكرى ألم، أو اكتشاف، كآبة... بمعنى أنه يمكن أن يشع عن نوع من السلوك الحيوي.
4. باعتباره عالماً موضوعياً مستقلاً (خارج الذات).
5. يمكن أن يزيح مناطق مهمة من الذات، ويحتل أو يحل محل المفاهيم الذاتية.
نرى ذلك في الإزاحة الكلية للذات على المسرح.. (ذات الممثل الذي نستبدل بذات النص).. أو في أن يمتلك كيان الكاتب لحظات تولده فيه.
هذه مطابقات رئيسية عامة تجعل النص يفعل، أو يسلك الوضع الميتافيزيقي نفسه للآخر. إذاً، يمكن أن تنظر إلى علاقتنا بالمعنى الفني باعتبارها علاقة بـ (آخر).
العلاقة بالآخر هي مجاهدات للتطابق معه. أي أن هناك إمكانية كبيرة في أن يصبح الآخر أنا.
ببساطة: الـ (أنا) كيان إدراكي. الـ (آخر) كيان إدراكي كذلك، لأن الأنا بالنسبة للآخر؛ آخر. والآخر بالنسبة لذاته: أنا.
قلنا إن (العلاقة) هي مجاهدات للتطابق بين اثنين. هي جسر مُفترَض، وهمي ذو قوة هائلة، قوة قابلة لتدمير ذاتها.
العلاقة بمعناها العادي تأخذ أشكالاً متعددة: (علاقة عاطفية كالحب العادي، الأمومة، الأخوة، روابط العصبية، الصداقة - أو علاقة مكان؛ كالسجناء في غرفة، السائق والمسافرين. - علاقة وعي: علاقات المثقفين والفنانين... إلخ) ومهما يكن، فإنها بجميع أشكالها، هي جسر للعبور إلى الآخر. هناك صفات مشتركة، أهداف مشتركة، هناك تطابق هندسي وفيزيائي وبيولوجي.
في لحظة عبور الجسر - العلاقة لا بد أن يلغي أحد الطرفين الطرف الآخر.
(ملاحظة: سنعود إلى هذا فيما بعد).
(الافتراق)
يقول برجسون في (كتاب الضحك) : «لقد عملت المصادفات السعيدة على ظهور أناس تبدو حواسهم وشعورهم أقل التحاماً بالحياة، وكأن الطبيعة قد نسيت أن تربط ملكة الإدراك الحسي عندهم بملكه الفعل أو التصرف، وهؤلاء حينما ينظرون إلى شيء، فإنهم لا يرونه لأنفسهم، بل لنفسه هو، وهم لا يدركون لمجرد العمل أو التصرف بل يدركون للإدراك ذاته، أعني لغير ما غاية، اللهم إلا المتعة وحدها. وهم يولدون منفصلين -في جانب من جوانبهم- سواء كان هذا الجانب هو إحدى الحواس أم هو الشعور نفسه - عن الواقع والحقيقة الخارجية، وبالتالي فإنهم يولدون مصورِين أو مَثّالين أو موسيقيين أو شعراء...».
لو قدر للحظة التلامس الجمالي مع العالم أن تكون جديدة كلياً (لحظة حادثة) وغير (ممكنة)، فإننا سنعتبر برجسون مكتشف السر الفني بلا منازع، ولكنه تحدث عن (الانفصال) كقطع في الصيرورة، أي أنه ينفي أن يكون العمل الفني (متحققاً)، فهو عمل جديد كلياً، ولم يكن أحد قد فكر به.
لو صح التصور البرجسوني لما كان هناك تراكم ندعوه بـ (تاريخ الفنون)، على الأقل في فن الرواية الذي تطور تطوراً مذهلاً.
في مكان آخر يكتشف برجسون أنه قد تورط في تسمية (الانفصال) قائلا: «لو قدر لذلك الانفصال أن يكون كاملاً، أو لو تهيأ للنفس ألا تتعلق بالفعل في أي إدراك حسي من إدراكاتها، لكنا إزاء نفس فنانة لم يشهد لها العالم نظيراً من قبل».
إن فكرة أن يكون العمل الأدبي جديداً كل الجدة، فكرة تطيح بمفهوم الخبرة والتمرين لدى الفنان، وعلى ذلك، فإنه لو أمكن أن يكون العمل الفني منتزعاً من (الديمومة) بصيغة (الآن) الفردية، لأصبحنا إزاء نظرة أحادية تلغي المفهوم الجدلي للوجود.
الذي سميناه (الافتراق) وسماه برجسون الانفصال، هو مفهوم معاكس لجميع تصورات برجسون. إن التلامس الجمالي، أو الاكتشاف الجمالي لابد أن يكون موضوع افتراق كلي، لا تطابق كلي. إن المشكلة تكمن في التوسط العلائقي بين الفنان وموضوعه. ليس الموضوع، ولا الفنان، بل الذي يحدث بينهما. إنه صراع مع تقبل (النفي)، أي صراع مع إمكان أن يتحوّل الاكتشاف إلى واقع. وبهذا فإننا ننكر أن تكون نتائج هذا التقبل مطابقة كلياً للتصورات، فمن المستحيل أن ينقل الفنان مشاهده الذهنية كما هي.
إن الاكتشاف الفني لا يعني نقل الموضوع ذاته، وبهذا يختلف عن الاكتشاف العلمي. فعندما يكتشف الكيميائي معدناً جديداً، فإنه سيحضره إلى المختبر كما هو، غير أن الموضوع الفني لا يمكن إحضاره، بل أن الفنان سيتحدث عن اكتشاف غائب، عن فعل الاكتشاف نفسه.
وضعتُ أمامي كومة من المصادر التي تبحث كلها في موضوعة الأدب، في الرواية على الأخص. كنت جاهداً في أن أجد تعريفاً واحداً أركنُ إليه للشفاء من سؤال ملح ومؤرق يتعلق بطبيعة عملي (كروائي)، والسؤال يتعلق بموضوعة حياتية ساذجة: لماذا أكون روائياً وليس نجاراً مثلاً؟
وهذا السؤال بالتحديد، هو الذي جعلني أرفع مصادر البحث عن سطح المنضدة وأضع نفسي بدلاً عنها. وهذا السؤال قادني إلى نظرة فاحصة، بمثابة منهج تفكيري. لأفترض أنني الآن مستلقي على السرير، أي أنني لا أقوم بفعل الكتابة عن الكتابة. ترى: كيف كنتُ سأجيب، لو أن الأمر -مثلاً- يتعلق بمحض اختيار (مهنة)؟
كنت أعتقد أن الجواب يكمن في معطيات الأدب، ولذلك رحت أفاضل بين عمل روائي وآخر، بين كاتب وكاتب، بين موضوع موضوع، ولكنني بدلاً من أن أعرف، صرت أكثر تشتتاً وغباءً. لقد كانت النتيجة هي أني جمعت الكثير من (المعطيات) التي أبعدتني عن (جوهر) الأدب، وأبعدت عني إمكانية الإجابة عن الأسئلة التي تبدو في مظهرها بسيطة وسهلة الإجابة.
مثلاً، إن سؤال: ما الرواية؟ أصعب بكثير من سؤال: كيف يمكن أن أكتب رواية عظيمة؟ لأن السؤال الأول، بطبيعته، سابق على السؤال الثاني، ولذلك، متى ما تمكنا من الإجابة عن السؤال الأول، فإننا سنجيب عن السؤال الثاني ببساطة.
ولكن، يبدو لي الأمر، منذ الوهلة الأولى، في اللحظة التي أطلق بها السؤال. أن هذا البحث لا يتعلق بمشكلة البحث عن إجابة أو حل، بل أنه يبدو قائماً في المشكلة نفسها بقدر ما يولَّد فينا من إحساس بالتوتر، غير أن مجموعة الأسئلة التي نطلقها لمعرفة جوهر الأدب لن تعطينا إجابة نهائية طالما أنه يمكن أن نكتب عشرات المجلدات وبأقلام كتاب مختلفين، سنحصل على إجابات متباينة لا تشكل في امتيازها ولا في مجموعها جواباً مريحاً عن أبسط الأسئلة، غير أنها تعطينا في المقابل وعياً إضافياً بعملية الكتابة. لذا فإننا لن نحصل في يوم من الأيام على قوانين وتحديات يمكن أن نجعلها دروساً سهلة لطلاب المدارس، بل سنحصل على فهم و(وعي كتابي)، وحين نصل إلى فهم أعمق فإن المشكلة تظهَر من جديد متلبسة الأسئلة الأولية نفسها.
(2)
لقد برز سؤال: (ما الأدب؟) منذ عصر اختراع هذه التسمية مروراً بتاريخ الميثولوجيا، فأرسطو، وحتى الآن، ولا نستطيع، نحن الكُتاب الأحياء، أن نجيب عن هذا السؤال، رغم أننا اخترنا الكتابة (كمهنة) لنا، كما اختار سارتر هذا السؤال: (ما الأدب؟) كعنوان لكتابه، غير أنه في الحقيقة كان يتحدث عن فرنسا، وعن الموقف الأدبي، وليس عن الأدب مُطلقاً، والحقيقة أن ما قاله سارتر: «إذا حاولنا إدراك عملنا فنحن بصدد خلقه من جديد» (ما الأدب، فـ 2/ترجمة: محمد غنيمي هلال) يلغي مرة ثانية كل تصوراته عن الأدب، كما يلغي كل محاولة للإجابة.
لقد أكد أن الأدب هو (كشف) عن طريق الحقيقة الإنسانية ذات الطبيعة الكاشفة، لذا فهو يدلنا، دون أن يدري، بأن هنا شيئاً ما نكشف عنه بطرق مختلفة منها الأدب. أي أنه التجأ إلى (المعطيات) مرة أخرى متناسباً (الجوهر) الذي يجب أن نكشف عنه؛ طبيعة الجوهر، وطبيعة الكشف عن الجوهر.
إننا نعرف بأن اللغة هي وظيفة الفكر، أي أن اللغة تكشف عن طبيعة الفكر بصورة مصغرة، ولكن هل أن الفكر لا يستطيع أن يفكر بدون اللغة؟ يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة لو تناولنا قصة (حي بن يقظان) لابن طفيل. يُفترض أن حي بن يقظان قد تعرف على العالم بوعيه الخاص دون الاستعانة بالمسميات لأنه لم يكن يعرف اللغة بمعناها الشامل إلا بعض الأصوات والصرخات التي تعلمها عن طريقة تقليد الحيوانات. إن المشكلة التي واجهت ابن طفيل وتواجهنا الآن هي: كيف فكر بن يقظان؟ وكيف يمكن الكشف عن تفكيره وتوصيله بواسطة اللغة التي لا يجيدها حي. إذاً، إذا كان يريد ابن طفيل أن أصدقه، كان عليه ألا يكتب هذه القصة ولا يتحدث عنها، وإلا فإنها تجربة ابن طفيل نفسه، تجربته الصامتة مع الوجود، التي تكشف بطلان وزيف أية محاولة لمعرفة طبيعة بطله دون الالتجاء إلى اللغة التي تقتل محاولته في لحظة الكلام عنها. إنها محاولة تذهب بالأدب إلى مشاكل الميتافيزيقيا فيصير نوعاً من التفلسف، وبهذا لن يكون الأدب أدباً على الإطلاق.
ولكي يكون الأدب أدباً عليه أن يسلك الطريق المعاكس للفلسفة لكي يطرح المشكلات الفلسفية نفسها، أعني بشكل حسي عياني، حياتي بشكل أشمل. وأن يدير الأديب ظهره لمشكلات الفيلسوف، ليراها بعين فُتِحت في مؤخرة رأسه، وبصورة حدسية، متجاوزاً بذلك كل أشكال المنطق ومشكلات السبب والنتيجة.
(3)
إن الأدب يُصور لحظة التوتر هذه، لحظة إطلاق السؤال، ولكنه لا يمضي أبعد من ذلك، وإلا فإنه سيعلن حرباً ضد الفلسفة، ويخسر بذلك هذه الحرب لا محالة.
إن الوظيفة الأساسية للأدب هي أن تجعل الإنسان يتحسس مكانه في الوجود، وتجعله يعي هذا التحسس. إنها وظيفة إدراكية تصورية بحتة، وليست وظيفة حلول مقترَحة، أو كفاح لتطور الذوق، أو لعبة لتطوير الحساسية اللغوية لكي يمكن التعبير عن الحاجات الإنسانية. إنها وبشكل أدق: محاولة لإيجاد منطقة توتر مريح، أو منطقة مريحة للتوتر، معاً، في لجة الأبدية.
ولذلك فإن أي أدب لا يتناول مشكلات الإنسان الأولية في العالم، ويكتفي بتصوير حياة زائلة، هو أدب زائل بزوال الشرط التاريخي للمشكلة.
غير أن الأدب -بعكس الفلسفة- يطرح مشكلة الموت عن طريق النكتة، كما في (مائة عام من العزلة) لدى ماركيز ومشكلة التوق إلى الخلود كما في (النورس جوناثان) لريتشارد باخ. فإنه لا يمكن أن يمر بدون هذا الركام من الكلمات الهشة والقاسية، والأشياء والأدوات، والسيكولوجيا، وحالة السكن في كوخ، وعزلة كاتب العرائض... إلخ.
إن الأدب هو خيانة الفلسفة، ولذلك فهو أدب. وبالمقابل فإن الأدب لن يكن أصيلاً إذا ما قطع صلاته مع الفلسفة، لأنه بذلك يتناسى منطقة (الوقوف المتحرك) في الأبدية. إنه معني أيضاً بطرح الأسئلة ذاتها التي تطرحها الفلسفة، ولكن بأدواته الممكنة والمتوفرة، لأن الفلسفة بالمقابل يجب أن تعترف بالأدب لأنه وهبها الخيال، والا لكانت شيئاً آخر ليس له اسم.
إن هذه العلاقة الإشكالية بين الأدب والفلسفة، يجب أن تبقى قائمة، علاقة التجاذب والنفور، علاقة الغارات لاحتلال مواقع من الطرفين، علاقة التصالح الوقتي الأصيل الشائن، دون أن يُقدم أحد الطرفين على تقديم حلول معينة حتى لو صار جميع رجال العالم رجلاً واحدا، وجميع نساء العالم امرأة واحدة، فإن مشكلة هذين الفردين إزاء الوجود تبقى قائمة.. كأنها مشكلة العالم كله.
فعلى الأدب أن يتخلى إذاً عن مشكلة الشيوخ في دار العجزة، لأنها ستُحل تلقائياً بموتهم، ويعود بدلاً عن ذلك إلى الأسئلة الأولى؛ أسئلة الطفل التي لا نستطيع، نحن الكبار، أن نجيب عنها، دون أن نَكذب.
(4)
لقد ظلت الكينونة بمثابة جدار وهمي يفصل بين الفلسفة والأدب، على أساس أنه ليس من وظيفة الأخير أن ينظر فيما وراء الكينونة. إنه دائماً يناقش المعطيات، غير أن هذا الركام التجريبي السطحي، ركام الكلمات، جعلنا نكتب أدب الأدب، وقد تناسينا في الشرط الأول أن محاورات الفلاسفة اليونانيين كانت تجري على شكل حلقات أدبية، وما جمهورية أفلاطون إلا تصور أدبي عميق لمدينة مثالية.
إن هذه المناقشة الحامية مع نفسي، تعيدني مُجبَراً إلى المصبات والمصادر الأولى، والأسئلة الأولى، وبهذه الطريقة وحدها أستطيع أن أقيس مدى أصالة عمل أدبي معين، لا من خلال مقارنته بأعمال أخرى، ولا باجتهادات تجريبية، ولا حتى فيما يطرحه من مشكلات مؤثرة في الأسلوب، وإنما عن طريق رؤية أصلية فيما مدى ابتعاده واقترابه من مشكلتي (من، مع، في.. العالَم).
صحيح أن هذه المناقشات الشكلية قد حَسمت لنا معضلات كثيرة فيما يخص اللغة المناسبة لتوصيل عمل ما، وفيما كنا نعتقده أيضاً، من أن (السُمك) هو الفارق الرئيسي بين الرواية الكلاسيكية والرواية الحديثة. فليس من الصحيح أن نقول: إن (دوستويفسكي) كان يكتب المجلدات لأنه كان في عصر أقل ازدحاماً، لذا كان لديه متسع من الوقت للكتابة، كما كان لدى القارئ متسع من الوقت للقراءة. ولكن من الصحيح أن نقول: إن ارتقاء اللغة الأدبية وتطوير الأساليب جعلنا نستطيع أن نكتب في صفحة واحدة ما لم يستطع دوستويفسكي أن يكتبه في مائة صفحة.
إذاً فالمشكلة لا تعود بالدرجة الأساس إلى طول العمل أو قصره، إذا ما أردنا المفاضلة بين عملين، كما أنها لا تعود إلى الأسلوب وحده، ولكنها ترجع دائماً، إذا ما أردنا أن نتبين جدوى الأدب، إلى (منطقة الوقوف المتحرك في الأبدية). مشكلة الإنسان كوعي يعي نفسه ويعي العالم.
إننا نستطيع أن نَشعر بأهمية أي عمل أدبي بقدر ما يطرح من أسئلة مفتوحة، تكون في النهاية، أسئلة ميتافيزيقية يصعب الإجابة عليها، لأنها دائما تفلت منا في لحظة الانتقال من الوعي إلى العالم وبالعكس.
(5)
غير أننا سنبحث عن (الجدوى) حفاظاً على حياة الأدب والفلسفة معاً، ولكيلا يكون تصورنا عبثياً، فنفقد بذلك معنى الحياة.
نقول إن الجدوى هي هذا الكفاح لكي نجعل الوعي أكثر وعياً بذاته، وبذلك فإنه سيكون وعياً خلاقاً، طالما أنه يتمثل إشكاليته الأساسية التي تتشظى إلى إشكاليات لا نهاية لها، هي نفسها تشكل قوة الوعي. ولكي نفرق أكثر بين: التصور الأدبي-العبثي للعالَم، وبين التصور الأدبي-الإشكالي للعالم، علينا أن نفهم فارقاً أساسياً بين الإشكالي والعبثي.
فالعبثي هو أن يجعل من الإنسان عبداً لوعيه إلى الأبد، متمثلاً ذلك في (سيزيف) الذي يدفع ضريبة وعيه بحمل الصخرة إلى قمة الجبل، فهو في كل مرة (ملزَم) بهذا الفعل طالما أنه يعي، وكان لا يستطيع أن يرفض أو يسأل على الأقل، لأن دفع الصخرة هو ضريبة الرفض والسؤال، بينما نجد العكس في التصور الإشكالي، في أنه يعود دائماً إلى الحالة التي سبقت رفع الصخرة، ويستطيع أن يذهب إلى الحالة التي بعدها. أي أنه يستطيع أن يتمثل حالتي البداية والنهاية (الرفع والدحرجة) معاً. أو بشكل أدق، فإنه يتعامل مع الزمن بشكل خلاق، فيجعل الصخرة في حالة دحرجة دائمة دون أن يكلف نفسه عناء رفعها من جديد، لأن التحكُّم - اللاتحكُّم بالوعي، هو بالضرورة: تحكم - لاتحكم بالعالم.
ووفق هذا التصور للوعي الإشكالي، فإن هذا الوعي يستطيع أن يرحل مع أو ضد الأبدية متجاوزاً بذلك منطقة الوقوف المتحرك، ولهذا فهو وعي خلاق.
ونسأل السؤال مرة أخرى: كيف يكون الأدب مجدياً طالما أنه لا يحل لنا مشكلة؟
إن اللحظات التي تمضي من الحياة دون أن يرصدها الأدب، هي لحظات ميتة، ستمضي نحو العدم حاملة معها حالة توتر حساس لصالح الوعي، في تاريخ الشخص أو مجموعة الأشخاص. وهي إذاً، هذه اللحظات، تشكل في ماهيتها، حالة اختيار أو نفي أو انسحاق، أو قرار، بمثابة موجه في البحر، ترصد منطقة ظلت ميتة على الدوام داخل الوعي.
إن الإشارة الأدبية إلى هذه المنطقة-اللحظة، تعني أننا نرفض أن يكون جزءا منا ميتاً موتاً سرَطانياً داخل الموجود الإنساني، الذي يرفض بكل شدة أن يكون منسياً، أكثر من رفضه من أن يكون ميتاً.
لذا فإن الخطاب الأدبي يُذكرنا بأننا على قيد الحياة، لا عبر وسائليته لإيصال حدث أو واقعة حياتية معينة، وإنما لأنه مشروع خلاق لهدم عادات نسيان الوجود. وهو في جانب آخر أسلوب منتقى للكشف عن جانب، أو عدة جوانب من الحقيقة، والاقتراب بالمعنى الإنساني من معناه. لكي نعرف أننا كنا على قيد الحياة وما زلنا. ونعرف أن هناك جوانباً كثيرة يمكن أن نعتز بها، حتى بعض الجوانب الضئيلة، لأجل تكوّن وعينا التاريخي. إننا لم نأتِ من عدم، وأننا لن ننسى حتى بعد موتنا.
يبدو أن مسألة الاقتناع بأهمية الأدب باتت من أكثر المسائل إلحاحاً للأديب قبل القارئ، بسبب تلك التراكمات والزوائد الكلامية التي طمست تحتها التذوق والنقد.
كما يبدو، من جهة أخرى، أكثر خطراً؛ أننا لسنا جادين أبداً في كتاباتنا وفي قراءاتنا، وحتى في تفكيرنا. ولذلك فإن «النقطة العمياء» (ميرلوبونتي) قد اتسعت لتشمل كل مساحة العين الراصدة للوجود.
الخطوة الأولى تبدأ بالتشكيك بمعطيات الفن -وعلينا هذه المرة أن نكون أكثر جدية-، التشكيك بأدوات البحث والاستقصاء والمدارس الأدبية، وتجارب الشكل، على اعتبار أنها تشكل لنا «وعياً موروثاً» (خضير ميري) لا نعرف مدى صحته، وباعتبار هذه المعطيات (مزيفة)، وبحكم قاس، ليس لأجل نقطة بداية جديدة كل الجدة، فهذا غير ممكن طبعاً، بل لأجل توجه صحيح لتنقية الأدب من شوائبه، فلنقل إن كل هذه المعطيات تدور حول القيمة الإنسانية ولا تخترقها، وهو فرض خاطئ بكل تأكيد، إلا أننا لا نستطيع أن نخفي احترامنا لتلك الخطابات التي تلامس وعينا من الداخل.
ولكننا نريد أن نؤكد بأن القدسية، ما هي إلا ضرب من ضروب التعود الذي يحصر الإبداع ويقيده، لا سيما ما نسميه بـ(المدارس الأدبية) التي هي ليست أكثر من نغمة منفردة في الضوضاء (مع إعطاء التقدير والاحترام لمؤسسي هذه المدارس، ونستثني من ذلك المتأثرين بهم فهم ليسوا سوى توابع، مهما بلغ شأنهم، وهم أيضاً سارقو رؤية).
نحاول أن نُبطل مفهوم (ثبات الرؤية) لدى الأديب الواحد، باعتبار أن هذا الأمر سينتج منطقة ما، ميتة في الوعي، فكيف الحال مع من يأخذ رؤية ليؤسس عليها، هذا الذي لم يُجهد نفسه بالتعرف على منطقة وقوفه المتحرك في الأبدية، هذا الذي استعان بالآخرين لكي يفكروا بدلاً عنه. نعني أننا مع ثبات الأصالة ومع الصدق بأبسط صوره، باعتباره القاسم المشترك لكل التجارب. فليس على المبدع أن يفكر في كيفية الحفاظ على إبداعه فحسب، وليس عليه أن يحصر همه ليجعل صوته مرتفعاً، بل عليه أن يكافح ثبات خبرته وقولبتها، وأن يكون التراكم لديه وسيلة لتوليد أفكار جديدة ورؤية جديدة باستمرار، ولا يكون التراكم أبداً بمثابة قوانين بديهية.
لكل أديب، بالدرجة الأساس دور تثويري استفزازي مستمر، لصالح الوعي الآخر، وليس لصالح الأدب أبداً، لأنه من الخطأ أن يُسخر الأديب نفسه للأدب فحسب.
وبذلك يكون البدء أولا من القيمة الإنسانية التي تأخذ الحاجات الظرفية بحسابها، دون أن تراعيها.
الأدب في الإنسان، لأجل الإنسان، ومتى ما تَذكر الأديب بأنه أديب سينسى بأنه إنسان، ومتى ما نسي الأديب بأنه أديب سينسى بأنه إنسان، ويتجه نحو أدب مُغلق ميت في النهاية.. بعدما يعتقد بأن الأدوات قد اكتملت، وأن الإبداع قد وصل إلى أقصاه.
إن وظيفة الخطاب الأدبي، هي استخراج قيمة إنسانية بالدرجة الأساس، فكيف يسعى الأديب إلى تحجيم ذاته بالانشغال بألعاب (السيرك اللغوي) أو بالبحث -لمجرد البحث- عن متاهات تجعل القارئ يخاف أن يفتح الكتاب.
طالما أنه يبحث عما يطور وعيه، ولكن عليه بالمقابل ألا يترك عمله «مكشوفاً ومقنعاً بسرعة أكبر مما ينبغي، فسيكون عملاً زخرفياً لا يخضع إلا لنزوات الخيال» على حد قول (جان كوكتو).
* * *
يبدو أن الخطأ الذي نرتكبه في الكتابة، هو أننا نمارسها في وضع الجلوس، لو جربنا أن نكتب وُقُوفاً، وفعل (الوقوف) يتجاوز معناه الشائع.. أقصد أن نتلقى العالَم بشكل بطولي.
* * *
للأسف، إن الكتابة تكون أسيرة لفعل التدوين، وبهذا لا تكون إلا مجرد كتابة. إن الجملة التي تأتي لحظة الركوع على الورق هي جملة خاسرة، فلو عشنا حياتنا وشخصيتنا كما نعيش تلك اللحظة الشيقة الشبيهة بالفعل السري لأمكننا اختبار صدق ادعاءاتنا جميعا، ولأصبحنا أقرب إلى الحقيقة حين نتعرف على بعضنا على أننا كُتاب.
لقد توصلتُ إلى فهم بسيط، من أن الكاتب الحقيقي هو الذي يضع احتمالات روائية لسلوك زوجته، ويطرق باب الجيران على طريقة (زوربا) أو (بتشورين) -بالنسبة للروائي- فإنه ليصعب عليه الفصل بين ما يكتب وما يعيش.
* * *
لقد تخاصمنا كثيراً حول الاصطلاحات، وفاضلنا بين الواقعية والرمزية وبين الواقعية والسريالية، وصار بعضنا يدافع عن مذهب لا يعرفه، ونجح منا الذي اتبع جنونه وقلقه، والذي نجح جداً، هو الذي لم يتعلم طريقة واحدة في الكتابة.
* * *
أحياناً تساعد الرقابة كثيراً في خلق هذا الأسلوب أو ذاك، فعندما نريد أن نقول شيئاً خطيراً، فإننا نلجأ إلى طريقة لغوية تفوت على الرقابة فهم الموضوع مباشرة، ولذلك فأنا مدين بالكثير لهذه المؤسسة لأنها ساهمت في جوانب مهمة في نهضة الأسلوب.
* * *
لو كان الأمر يتعلق بمجرد تعريف للكتابة لأمكننا أن نجد عشرات التعاريف الصحيحة، ولكنها تتعدى حدود لحظة التدوين إلى حياتنا ككُتاب، تلك الحياة التي ندرج عادة على تسميتها بـ «السيرة الذاتية». برأيي؛ إن الأمر يحتاج إلى خلط أكثر مما يحتاج إلى تمييز. وهي هذا الفعل الهروبي المستمر من الحياة الصلبة بحثاً عن الحياة نفسها في أشكال أخرى. لحظة الإمساك بفكرة لابد أن تكون خاطئة لأنها مخالفة لقوانين المنطق الذي يمكن البرهنة عليه، فهذا الخطأ في التصور هو خطأ أدبي مقبول يعطينا شكلاً بديلاً عن الواقع يمكن أن نتعامل معه كشكل مقبول، ولذلك فإن معالجة مسألة الصدق هي من أعقد المشاكل، لأننا نكتب عن الأشباح دون أن نؤمن بها. فالصدق هو أن نؤمن (بنا)، بما نقول.
الهجران
منذ أن رأى الإنسان صورته معكوسة على سطح الزيت، أو في ماء المستنقع، وبعد ذلك، اختراع المرايا وفن البورتريه الشخصي ثم الوصف الأدبي المتقن للذات في أوراق الأدب الكلاسيكي، حدثت لهذا الموجود ثنائية عجيبة. وتعدد الانقسام بحيث لم يعد بالإمكان الاكتفاء بصورة ثانية فحسب، وصرنا نرى صورا لأنفسنا في كل مكان محطَّمَة أو مزيَّنة أكثر مما يجب، وتعرفنا على شكل آخر لوجودنا غير الوجود الجوهري الذي يصطدم دائما بالفكرة الأصلية (فكرة الخوف من الزوال).. وفررنا فرار الحيوان من ظِله..
ونظراً لدقة المرايا في رسم الصور، فقد غادرنا من العمق إلى السطح، نتأمل أنفسنا (هناك) بنوع من الإعجاب، وترت على ذلك:
1. صار من الصعب أن نعكس العين إلى الداخل ونرى أنفسنا (الجوهر).
2. في كل محاولة مكثفة من هذا النوع، هناك مجموعة إحالات تجزيئية (تحويل الموضوع باستمرار إلى موضوع آخر غيره) بحيث أن الجوهري يبتعد.
3. الانبهار بالشكل على حساب المحتوى.
4. تحطيم الموضوع (أو تحطيم النص)، بتوتر إشكالي، مثلاً؛ النص الأدبي الحديث:
توتر بين الشكل والمحتوى، اغتراب، صعوبة الإمساك بالمعنى، جنون الشكل، نسيان المشكلات الأولية.
5. الأشياء لم تعد كما هي، ولا كما نراها، لقد تحولت إلى أشياء أخرى.
6. شيوع مفهوم الوهم والخدعة (الإيهام في البناء الفني) الذي أخذ، أحياناً، مفهوم التشويق.
7. قوة أي عمل أدبي معاصر تأتي من نجاح الكاتب في تصوير هذا الهجران بين الموضوع الواقعي (سواء كان فكرة أو حدث واقعي) وبين التصور.
8. أصبح التصوّر الأدبي جهازاً في غاية التعقيد لأجل إدراك الإحالات اللامتناهية، وأصبح النجاح صعباً لأنه يتطلب قوة خارقة للإمساك (بالسِر)...
(السر بدل الثيمة)، السر هو مجموع وتفاعل الثيمات، ولكنه أصغر وأدق من الثيمة. السر داخلي بالضرورة، يتعلق بعلاقة الكاتب بإنتاج النص، والثيمة تتعلق بالموضوع الخارجي دائماً.. أي أنها حكم خارجي، أو مفردة للحكم ... إلخ.
* ملاحظة: سنجابه العالم الدموي بنص رقيق.
الهجران (الافتراق)
التذوق الجمالي هو أعلى درجات الهجران بين النص والواقع وذلك بتطابق النص كلياً مع الواقع.
الهجران باعتباره هجرانا للكينونة. اندماج في شيء مشابه للوجود أو لجانب مدرَك من الوجود ونسيان الكينونة الصلبة.
هناك إدراك كلي لحادثة في العالم، هناك واقع موضوعي خارجي، بعيداً عن كل تأمل فلسفي. العالم يبدو لنا كما هو.. ولكننا بصدد وصف هذا الحادث في العالم، وصف مكان، وصف فعل معين. نريد أن ننقل الـ (كما هو) الذي رأيناه إلى شخص آخر لم يره. هناك طرق كثيرة لنقله، وهي معروفة لدى الفنون: التصوير الموسيقي، المسرح... ثم النص الأدبي. سنجد أن النص الذي أنتجناه يأخذ احتمالين لدينا ولدى القارئ.
الاحتمال الأول: أن يكون النص مطابقاً للعالم - وهذا افتراض طبعاً -، إنني أعرف بأنه ليس مطابقاً تماماً، ولا غير مطابق. هناك شبه كبير بين النسخة والأصل، ولكن النسخة فيها الكثير من الانتقاء، وهذا الانتقاء هو الهدف الجمالي للفنون. ذلك أن جميع الفنون انتقائية. وفي كل محاولة لكي أرى الأصل عبر النسخة - النص،
تنشأ نتائج لهذه العلاقة - المحاولات، تحوّل العالم إلى شيء آخر غيره، لذلك عندما أعود إلى النص فإنني سأجده شيئاً مختلفاً بعدما وجدت الأصل شيئاً مختلفاً عنه كذلك. نفهم هنا، المحاولات التي بذلها الواقعيون والطبيعيون في التمسك الحرفي الدقيق للـ (كما هو)، محاولات لتخفيف التوتر بين الأصل والنص. في داخل المتلقي.
الاحتمال الثاني: في حالة كون النص مختلفاً تماماً عن العالم، فمن البديهي وجود افتراض وهجران مسبق. ما نجده في الاتجاهات (السوريالية، والأخرى الحديثة لدى السيد كلود سيمون وأصحابه مثلاً)، في هذا الاحتمال نبحث مسألة الواقعي والخيالي. (سنعود إليها في فصل لاحق).
لو كان الموضوع الفني (النص) هنا. لا يمكن أن يتبدى إلا من خلال علاقتنا به، فهل يمكن أن يطابق المشكلة الميتافيزيقية (مشكلة؛ الأنا - الآخر)؟
إذا كان كذلك، فهناك احتمال للخوض في هذا الجانب لأسباب عديدة نعتقد أنها ممكنة في:
1. المعطى الفني يمثل وجوداً حيوياً قابلاً للانفتاح على العالم، لأنه يكف عن أن يكون سلبياً لحظة قيام العلاقة بينه وبين المتلقي.
2. المعنى الفني (النص هنا) يحمل معنى خاص به، وربما يتجلى في معان عديدة (معنى مركب) من خلال إمكاناته الذاتية، (قوته في أن يُوجد لذاته) في: البناء، الرموز الدلالية واللغوية، الشكل... إلخ.
3. يمكن اعتباره طرفاً دائماً في العلاقة بعمليات (التَرَسب) المعلوماتي. وفي خلف الخبرات للذاكرة. ذكرى ألم، أو اكتشاف، كآبة... بمعنى أنه يمكن أن يشع عن نوع من السلوك الحيوي.
4. باعتباره عالماً موضوعياً مستقلاً (خارج الذات).
5. يمكن أن يزيح مناطق مهمة من الذات، ويحتل أو يحل محل المفاهيم الذاتية.
نرى ذلك في الإزاحة الكلية للذات على المسرح.. (ذات الممثل الذي نستبدل بذات النص).. أو في أن يمتلك كيان الكاتب لحظات تولده فيه.
هذه مطابقات رئيسية عامة تجعل النص يفعل، أو يسلك الوضع الميتافيزيقي نفسه للآخر. إذاً، يمكن أن تنظر إلى علاقتنا بالمعنى الفني باعتبارها علاقة بـ (آخر).
العلاقة بالآخر هي مجاهدات للتطابق معه. أي أن هناك إمكانية كبيرة في أن يصبح الآخر أنا.
ببساطة: الـ (أنا) كيان إدراكي. الـ (آخر) كيان إدراكي كذلك، لأن الأنا بالنسبة للآخر؛ آخر. والآخر بالنسبة لذاته: أنا.
قلنا إن (العلاقة) هي مجاهدات للتطابق بين اثنين. هي جسر مُفترَض، وهمي ذو قوة هائلة، قوة قابلة لتدمير ذاتها.
العلاقة بمعناها العادي تأخذ أشكالاً متعددة: (علاقة عاطفية كالحب العادي، الأمومة، الأخوة، روابط العصبية، الصداقة - أو علاقة مكان؛ كالسجناء في غرفة، السائق والمسافرين. - علاقة وعي: علاقات المثقفين والفنانين... إلخ) ومهما يكن، فإنها بجميع أشكالها، هي جسر للعبور إلى الآخر. هناك صفات مشتركة، أهداف مشتركة، هناك تطابق هندسي وفيزيائي وبيولوجي.
في لحظة عبور الجسر - العلاقة لا بد أن يلغي أحد الطرفين الطرف الآخر.
(ملاحظة: سنعود إلى هذا فيما بعد).
(الافتراق)
يقول برجسون في (كتاب الضحك) : «لقد عملت المصادفات السعيدة على ظهور أناس تبدو حواسهم وشعورهم أقل التحاماً بالحياة، وكأن الطبيعة قد نسيت أن تربط ملكة الإدراك الحسي عندهم بملكه الفعل أو التصرف، وهؤلاء حينما ينظرون إلى شيء، فإنهم لا يرونه لأنفسهم، بل لنفسه هو، وهم لا يدركون لمجرد العمل أو التصرف بل يدركون للإدراك ذاته، أعني لغير ما غاية، اللهم إلا المتعة وحدها. وهم يولدون منفصلين -في جانب من جوانبهم- سواء كان هذا الجانب هو إحدى الحواس أم هو الشعور نفسه - عن الواقع والحقيقة الخارجية، وبالتالي فإنهم يولدون مصورِين أو مَثّالين أو موسيقيين أو شعراء...».
لو قدر للحظة التلامس الجمالي مع العالم أن تكون جديدة كلياً (لحظة حادثة) وغير (ممكنة)، فإننا سنعتبر برجسون مكتشف السر الفني بلا منازع، ولكنه تحدث عن (الانفصال) كقطع في الصيرورة، أي أنه ينفي أن يكون العمل الفني (متحققاً)، فهو عمل جديد كلياً، ولم يكن أحد قد فكر به.
لو صح التصور البرجسوني لما كان هناك تراكم ندعوه بـ (تاريخ الفنون)، على الأقل في فن الرواية الذي تطور تطوراً مذهلاً.
في مكان آخر يكتشف برجسون أنه قد تورط في تسمية (الانفصال) قائلا: «لو قدر لذلك الانفصال أن يكون كاملاً، أو لو تهيأ للنفس ألا تتعلق بالفعل في أي إدراك حسي من إدراكاتها، لكنا إزاء نفس فنانة لم يشهد لها العالم نظيراً من قبل».
إن فكرة أن يكون العمل الأدبي جديداً كل الجدة، فكرة تطيح بمفهوم الخبرة والتمرين لدى الفنان، وعلى ذلك، فإنه لو أمكن أن يكون العمل الفني منتزعاً من (الديمومة) بصيغة (الآن) الفردية، لأصبحنا إزاء نظرة أحادية تلغي المفهوم الجدلي للوجود.
الذي سميناه (الافتراق) وسماه برجسون الانفصال، هو مفهوم معاكس لجميع تصورات برجسون. إن التلامس الجمالي، أو الاكتشاف الجمالي لابد أن يكون موضوع افتراق كلي، لا تطابق كلي. إن المشكلة تكمن في التوسط العلائقي بين الفنان وموضوعه. ليس الموضوع، ولا الفنان، بل الذي يحدث بينهما. إنه صراع مع تقبل (النفي)، أي صراع مع إمكان أن يتحوّل الاكتشاف إلى واقع. وبهذا فإننا ننكر أن تكون نتائج هذا التقبل مطابقة كلياً للتصورات، فمن المستحيل أن ينقل الفنان مشاهده الذهنية كما هي.
إن الاكتشاف الفني لا يعني نقل الموضوع ذاته، وبهذا يختلف عن الاكتشاف العلمي. فعندما يكتشف الكيميائي معدناً جديداً، فإنه سيحضره إلى المختبر كما هو، غير أن الموضوع الفني لا يمكن إحضاره، بل أن الفنان سيتحدث عن اكتشاف غائب، عن فعل الاكتشاف نفسه.