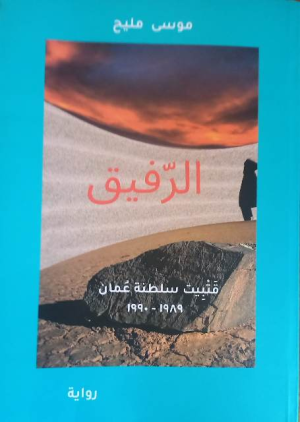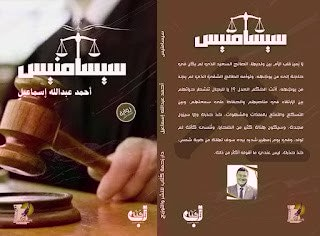(1-2)
الأذن تعشق، الأذن بوابة الكلام إلى القلب والعقل.. يبدو الفرق كبيرًا بين سماع الكلام وقراءته مكتوبًا على أي وسيلة، ورقية أو إلكترونية. الكلمة المكتوبة صمّاء، محكومة بحيز السياق، ولا تشير إلى شيء أبعد مما تدل عليه، أو لا تشير إلى ما هو أبعد مما يعرفه الناس من معناها في استخدامهم اليومي لها.. ولكنّك حين تسمع الكلمة تدرك منها دلالات أخرى أكبر مما تدل عليه الكتابة.. الكلمة المسموعة ذات طبقات متعددة، إنها هوية الكائن وطريقته الخاصة في النطق والتعبير، إنها أقرب إلى الشفرة الخاصة به، فنعرف منها صدقه وكذبه، ونعرف منها طبقات الحنين إذا كان المقام مقام شوق، ونعرف منها طبقات السخط والغضب إذا كان المقام كذلك.
كثيرًا ما ينشغل الدارسون بسجال اللسانيين (أساتذة اللغة) حول ثنائية الكلام والكتابة، وأسبقية الكلام للكتابة، وليس من غايتي هنا أن أعيد عليك هذا السجال الأكاديمي.. ولكني أودّ أن نتوقف معًا إزاء الحضور المميز للكلام في حياتنا، أريد أن أفكر معك في طبيعة هذا الصوت الذي يخرج من أفواهنا، وكيف يدلّ علينا بأكثر مما تدلُّ علينا الكتابة، وكيف ينقل الصوت الشفاهيّ رسالتنا كاملة إلى من نتحدث إليهم، إذ ينقل معها: نبض قلوبنا وتوترات عقولنا، وما صحّ عليه عزمنا وما نقوله دون أن نقصده تمامًا..إلخ.
فالكلام حضور حيّ وليس مجرد علامة كتابية يمكنك أن تنقلها على الورق أو تعيد كتابتها على جدارك في "فيس بوك" دون أن تفقد كثيرا من ظلالها. واللافت أن الكتابة تحتاج دائمًا إلى الكلام، تحتاج إلى التطعيم بطاقة الصوت وحيويته لكي تصل الرسالة إلى (المرسل إليه) بلا التباس أو انحراف عن المقصود. وربما لهذا احتاجت اللغات المكتوبة إلى علامات الترقيم، تلك العلامات الحيّة التي تجبر النقص وتعوض غياب الصوت.. فمن الصعب مثلا أن تهتدي إلى دلالات الاستفهام والتعجب والاستفهام المتعجب في المكتوب دون هذه الرموز التي تشير إليها.
وإذا دققت أكثر ستجد أن حضور الصوت في المكتوب يتجاوز علامات الترقيم، فلا توجد كتابة تخلو من العبارات الصريحة التي تشير إلى الصوت ودلالاته وحضوره المميّز، وتنقل أجواء الكلام الحي إلى نصوصنا المكتوبة، فما أكثر العبارات التي نجدنا مضطرين إلى كتابتها من أمثال: "صمت قليلًا ثم ردّ باقتضاب"، أو مثل قولنا: "تهدج صوته وهو يتكلم".. أو "وصاح بغضب: لعنة الله على الظالمين.. إلخ. وقل مثل ذلك في توظيف النبر (الضغط) على بعض الأصوات (الحروف) بما يميز دلالة عن سواها وبما ينقل الكلام نفسه من دلالة إلى أخرى قد تكون نقيضة لها تمامًا.
يحتاج المكتوب دائمًا إلى المنطوق، فلا توجد الكتابة الصمّاء، أو لا توجد الكتابة النقية، فالمكتوب يكتمل بالمنطوق، نجد ذلك في كل أشكال الكتابة، وإذ كنا قد تكلمنا عن تنوع طبقات الدلالة في الكلام المسموع، فإننا مع الأدب نجد أنفسنا إزاء حضور آخر للصوت، حضور فني شديد الكثافة والترميز، ويمكننا أن نأخذ مثالًا على ذلك مفتتح رواية "ملحمة الحرافيش" الخالدة؛ إذ يشكل الصوت المسموع مرتكز هذا المفتتح، حتى ليبدو الأمر وكأننا إزاء ولادة جديدة، وكل ولادة تبدأ بالصوت الحيّ الذي يدلّ على المجيء.. يقول السارد واصفًا رحلة الشيخ "عفرة زيدان" (الأعمى) اليومية في جوف الليل من بيته على مشارف القرافة حتى جامع الحسين:
"مضى يتلمس طريقه بطرف عصاه الغليظة، مرشدته في ظلامه الأبدي. مولاي يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد والإلهام الباطني.. على غير المعهود تناهى إلى أذنيه الحادتين بكاء وليد. لعله دويّ أكبر من حجمه في ساعة الفجر. الحق قد جذبه من سكرة الرؤى ونشوة الأناشيد.. هاهو الصوت يشتد ويقترب وعما قليل سيحاذيه تمامًا. وتنحنح كيلا يقع ارتطام في مشهد الفجر، وتساءل متى يكف الطفل عن البكاء ليرتاح قلبه ويعاود خشوعه. الآن صار البكاء ينخس جنبه الأيسر...".
علينا أن نقاوم رغبة كبيرة في تحليل هذا المفتتح العجيب الذي اهتدى فيه نجيب محفوظ إلى طاقة الصوت ورمزيته العالية وتمكّن بدقة من نسجه في تفاصيل المشهد، بداية من صوت عصا الشيخ "عفرة" التي ترشده إلى طريقه، وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد، ثم قدرته على سماع هذا الصوت الذي يصفه بالإلهام الباطني.. حتى نصل إلى الموضوع وهو صوت بكاء الطفل الذي أسكت كل الأصوات الأخرى في قلب الشيخ.. سوف يكبر هذا الطفل مجهول النسب، سيغدو النواة الأولى لهذا العالم الفريد: "ملحمة الحرافيش" ..!
كان الشيخ "عفرة زيدان" أعمى، وأنت تعلم بالتأكيد أن فقد حاسة البصر يستنفر الحواس الأخرى، فتنتبه الأذن إلى الأصوات بدرجة أعلى، ولذلك كان "نجيب محفوظ" دقيقًا ومحاججًا حين وصف أذن الشيخ بالحادتين، وشيّد فوق هذا الوصف بناءً رهيفًا انتقل بسمع الشيخ من الخارج إلى الداخل، من صوت بكاء الطفل إلى سماع الإلهام الداخليّ، مما أحاط المشهد برمته بطاقة علوية شفيفة، ينعطف ظاهرها على باطنها ويتلقى رسائله بإحسان وبصيرة..
ولا يقتصر الأمر على الأذن وحدها؛ ففي المفتتح نجد حضورًا مميزًا لحاسة الشم: "مولاي يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات..". نحن إزء عالم خصب، تلتقي مفرداته وتتعاشق وحداته، ويستسلم بهدوء لحكمة القدر التي تتخلق في هذه الساعة المبكرة من ولادة فجر هذا اليوم... تمامًا، كما قال الشيخ عفرة زيدان:
"سوف يهديني الله إلى مشيئته"..!

 www.facebook.com
www.facebook.com
الأذن تعشق، الأذن بوابة الكلام إلى القلب والعقل.. يبدو الفرق كبيرًا بين سماع الكلام وقراءته مكتوبًا على أي وسيلة، ورقية أو إلكترونية. الكلمة المكتوبة صمّاء، محكومة بحيز السياق، ولا تشير إلى شيء أبعد مما تدل عليه، أو لا تشير إلى ما هو أبعد مما يعرفه الناس من معناها في استخدامهم اليومي لها.. ولكنّك حين تسمع الكلمة تدرك منها دلالات أخرى أكبر مما تدل عليه الكتابة.. الكلمة المسموعة ذات طبقات متعددة، إنها هوية الكائن وطريقته الخاصة في النطق والتعبير، إنها أقرب إلى الشفرة الخاصة به، فنعرف منها صدقه وكذبه، ونعرف منها طبقات الحنين إذا كان المقام مقام شوق، ونعرف منها طبقات السخط والغضب إذا كان المقام كذلك.
كثيرًا ما ينشغل الدارسون بسجال اللسانيين (أساتذة اللغة) حول ثنائية الكلام والكتابة، وأسبقية الكلام للكتابة، وليس من غايتي هنا أن أعيد عليك هذا السجال الأكاديمي.. ولكني أودّ أن نتوقف معًا إزاء الحضور المميز للكلام في حياتنا، أريد أن أفكر معك في طبيعة هذا الصوت الذي يخرج من أفواهنا، وكيف يدلّ علينا بأكثر مما تدلُّ علينا الكتابة، وكيف ينقل الصوت الشفاهيّ رسالتنا كاملة إلى من نتحدث إليهم، إذ ينقل معها: نبض قلوبنا وتوترات عقولنا، وما صحّ عليه عزمنا وما نقوله دون أن نقصده تمامًا..إلخ.
فالكلام حضور حيّ وليس مجرد علامة كتابية يمكنك أن تنقلها على الورق أو تعيد كتابتها على جدارك في "فيس بوك" دون أن تفقد كثيرا من ظلالها. واللافت أن الكتابة تحتاج دائمًا إلى الكلام، تحتاج إلى التطعيم بطاقة الصوت وحيويته لكي تصل الرسالة إلى (المرسل إليه) بلا التباس أو انحراف عن المقصود. وربما لهذا احتاجت اللغات المكتوبة إلى علامات الترقيم، تلك العلامات الحيّة التي تجبر النقص وتعوض غياب الصوت.. فمن الصعب مثلا أن تهتدي إلى دلالات الاستفهام والتعجب والاستفهام المتعجب في المكتوب دون هذه الرموز التي تشير إليها.
وإذا دققت أكثر ستجد أن حضور الصوت في المكتوب يتجاوز علامات الترقيم، فلا توجد كتابة تخلو من العبارات الصريحة التي تشير إلى الصوت ودلالاته وحضوره المميّز، وتنقل أجواء الكلام الحي إلى نصوصنا المكتوبة، فما أكثر العبارات التي نجدنا مضطرين إلى كتابتها من أمثال: "صمت قليلًا ثم ردّ باقتضاب"، أو مثل قولنا: "تهدج صوته وهو يتكلم".. أو "وصاح بغضب: لعنة الله على الظالمين.. إلخ. وقل مثل ذلك في توظيف النبر (الضغط) على بعض الأصوات (الحروف) بما يميز دلالة عن سواها وبما ينقل الكلام نفسه من دلالة إلى أخرى قد تكون نقيضة لها تمامًا.
يحتاج المكتوب دائمًا إلى المنطوق، فلا توجد الكتابة الصمّاء، أو لا توجد الكتابة النقية، فالمكتوب يكتمل بالمنطوق، نجد ذلك في كل أشكال الكتابة، وإذ كنا قد تكلمنا عن تنوع طبقات الدلالة في الكلام المسموع، فإننا مع الأدب نجد أنفسنا إزاء حضور آخر للصوت، حضور فني شديد الكثافة والترميز، ويمكننا أن نأخذ مثالًا على ذلك مفتتح رواية "ملحمة الحرافيش" الخالدة؛ إذ يشكل الصوت المسموع مرتكز هذا المفتتح، حتى ليبدو الأمر وكأننا إزاء ولادة جديدة، وكل ولادة تبدأ بالصوت الحيّ الذي يدلّ على المجيء.. يقول السارد واصفًا رحلة الشيخ "عفرة زيدان" (الأعمى) اليومية في جوف الليل من بيته على مشارف القرافة حتى جامع الحسين:
"مضى يتلمس طريقه بطرف عصاه الغليظة، مرشدته في ظلامه الأبدي. مولاي يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد والإلهام الباطني.. على غير المعهود تناهى إلى أذنيه الحادتين بكاء وليد. لعله دويّ أكبر من حجمه في ساعة الفجر. الحق قد جذبه من سكرة الرؤى ونشوة الأناشيد.. هاهو الصوت يشتد ويقترب وعما قليل سيحاذيه تمامًا. وتنحنح كيلا يقع ارتطام في مشهد الفجر، وتساءل متى يكف الطفل عن البكاء ليرتاح قلبه ويعاود خشوعه. الآن صار البكاء ينخس جنبه الأيسر...".
علينا أن نقاوم رغبة كبيرة في تحليل هذا المفتتح العجيب الذي اهتدى فيه نجيب محفوظ إلى طاقة الصوت ورمزيته العالية وتمكّن بدقة من نسجه في تفاصيل المشهد، بداية من صوت عصا الشيخ "عفرة" التي ترشده إلى طريقه، وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد، ثم قدرته على سماع هذا الصوت الذي يصفه بالإلهام الباطني.. حتى نصل إلى الموضوع وهو صوت بكاء الطفل الذي أسكت كل الأصوات الأخرى في قلب الشيخ.. سوف يكبر هذا الطفل مجهول النسب، سيغدو النواة الأولى لهذا العالم الفريد: "ملحمة الحرافيش" ..!
كان الشيخ "عفرة زيدان" أعمى، وأنت تعلم بالتأكيد أن فقد حاسة البصر يستنفر الحواس الأخرى، فتنتبه الأذن إلى الأصوات بدرجة أعلى، ولذلك كان "نجيب محفوظ" دقيقًا ومحاججًا حين وصف أذن الشيخ بالحادتين، وشيّد فوق هذا الوصف بناءً رهيفًا انتقل بسمع الشيخ من الخارج إلى الداخل، من صوت بكاء الطفل إلى سماع الإلهام الداخليّ، مما أحاط المشهد برمته بطاقة علوية شفيفة، ينعطف ظاهرها على باطنها ويتلقى رسائله بإحسان وبصيرة..
ولا يقتصر الأمر على الأذن وحدها؛ ففي المفتتح نجد حضورًا مميزًا لحاسة الشم: "مولاي يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات..". نحن إزء عالم خصب، تلتقي مفرداته وتتعاشق وحداته، ويستسلم بهدوء لحكمة القدر التي تتخلق في هذه الساعة المبكرة من ولادة فجر هذا اليوم... تمامًا، كما قال الشيخ عفرة زيدان:
"سوف يهديني الله إلى مشيئته"..!

محمد عبد الباسط عيد
محمد عبد الباسط عيد. 12,566 likes · 3,770 talking about this. Writer
 www.facebook.com
www.facebook.com